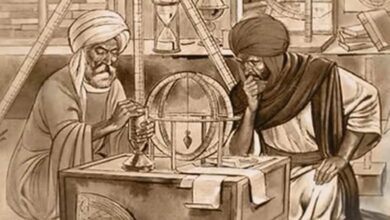06- التربية الحضارية
بحث مقدم لصالح مشروع إحياء نظام تربوي أصيل
إعداد: الأستاذ الدكتور / عماد الدين خليل
أنجز في: 23 محرم 1431ﻫ/9 يناير 2010م
جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمشروع ومسجلة رسميـًا ومحمية بموجب القانون.
عناصر الخطة:
- توطئة.
- إشكالية البحث.
- الفكرة المحورية للبحث.
- محاور البحث.
- مصطلحات ومفاهيم البحث الأساسية.
- الحاجة للبحث.
- علاقة البحث بالمشروع.
- منهجية البحث وأدواته.
- الدراسات السابقة.
- الإضافة النوعية للبحث.
1. توطئة
ينتمي البحث إلى المجالين الثالث والخامس لمشروع (إحياء نظام تربوي أصيل)، ويعالج جملة من المفردات المتضمنة في المجالين المذكورين، ويستهدف توظيف مادة (الحضارة الإسلامية) المعطاة في المدارس والمعاهد والجامعات، بتخليصها من الأخطاء المنهجية التي اعتمدت في تدريسها منذ أكثر من قرن، ولحدّ الآن، والتي انعكست سلباً على التكوين التربوي لأجيال المتعلمين، وبتصميم منهج جديد يمكن هذه المادة من الأداء بوتائر عالية توضّح للمتلقي طبيعة الارتباط بين عقيدته الإسلامية وبين الحضارة التي أنشأتها، وتعرض لمعطيات وخصائص ووظائف هذه الحضارة، ولجملة العوامل التي قادتها، عبر القرون المتأخرة، إلى الشلل وفقدان الفاعلية، وتنتهي إلى تحليل عوامل الدفع وشروط الانبعاث في هذه الحضارة، وامكاناتها البالغة في التعامل مع التحديات المعاصرة، والأكثر حداثة، ومن ثم تخريج طلبة يملكون الاعتزاز بحضارة الآباء والأجداد، والقدرة. في الوقت نفسه. على الفاعلية والإبداع.
ولسوف يرصد البحث، ويحلّل، الدور السلبي الذي مارسته المعرفة الإنسانية الغربية في مؤسساتنا التربوية، فان علوماً كعلوم النفس والاجتماع والإدارة والسياسة والاقتصاد والقانون والتاريخ وفلسفته والآداب والفنون والفلسفة… إلى آخره… تشكلت في رحم أوربي يرفض الغيب، ولا يؤمن أو يتعامل إلاّ مع المادي والحسّي والمنظور، وبالتالي فانها اختارت أن تبحر في اتجاه مناقض. ابتداء. لمعرفتنا الإسلامية المتجذرة في الغيب، والتي ترى في الظاهر انعكاساً للعمق الغيبي البعيد عن الحسّ.
ولقد خرّجت العلوم المذكورة أجيالاً من المسلمين تعاني من قدر كبير من الازدواجية، وتميل إلى تفسير الظواهر والتعامل معها من وجهة نظر مادية ذرائعية، وتكتفي بالتسليم بالمعطى الغربي دون أن تحاول تأصيله في ضوء ثوابتها العقدية، أو أن تضيف عليه جديداً مبتكراً، فأصبحت. بذلك. مجرّد مسخ مقلد للآخر، وفقدت القدرة على الإبداع، فضلاً عن أنها أخذت تشكك أكثر فأكثر، في قدرة عقيدتها وشريعتها ومشروعها الحضاري على منحها المعرفة المناسبة التي تضعها في قلب العصر.
وانضاف إلى هذا كله ذلك الجدار العازل الذي أقامته مؤسساتنا التعليمية والتربوية بين المعرفتين الإنسانية والإسلامية، فأنتجت. بذلك. جيلين من المتعلمين، أولهما لا يكاد يعلم شيئاً عن المعارف الإنسانية في جلّ تخصصاتها، فيما يؤهله لأن يكون حاضراً في قلب العصر، قديراً على مجابهة مطالبه وتحدّياته، والآخر لا يكاد يعلم شيئاً عن المعارف الإسلامية، فيما جعله ينفصل، بدرجة أو أخرى، عن مطالب هذا الدين.
2. إشكالية البحث
تمثل مادة (الحضارة الإسلامية) المعطاة في المدارس والمعاهد والجامعات، حلقة ذات قيمة بالغة، ليس على المستوى المعرفي فحسب، وانما على المستوى التربوي أيضاً. وبما أن التعامل مع هذه المادة مارس عبر القرنين الأخيرين جملة من الأخطاء، قادت بالضرورة إلى جملة من النتائج السلبية في بناء المواطن الصالح والمبدع والواثق بالمستقبل، فان هذا البحث يجيء لكي يشخص هذه الأخطاء، ويحدّد البدائل المناسبة للخروج من الأزمة، وتعديل الوقفة الجانحة.
وعلى كثرة ما كتب عن (حضارة الإسلام) فإننا لا نكاد نجد في جل الأدبيات المتعلقة بالموضوع، معالجة تفصيلية شاملة تضيء المسألة في مفرداتها كافة، بدءً بتأسيسات وشروط الفعل الحضاري الإسلامي في كتاب الله وسنة رسوله (ﷺ)، والتي أعانت على انبعاث وتشكل حضارة إسلامية متميزة بمعطياتها ووظائفها وخصائصها، مروراً بعوامل الانكفاء ودورها السلبي الذي أصاب قدرات الأمة الفاعلة بالعقم والشلل، وصولاً إلى امكانات الانبعاث مرة أخرى، من خلال تشخيص العوائق المتمثلة بالدور السلبي الذي مارسته المعرفة الإنسانية الغربية، في بنية مناهجنا التربوية، فضلاً عن العزلة المصطنعة بين المعرفتين الإنسانية والإسلامية، ومن ثم اقتراح الحلول الممكنة والمتمثلة بالتأصيل الإسلامي للمعرفة الإنسانية، من جهة، وكسر جدار العزلة بين المعرفتين الإنسانية والإسلامية، من جهة أخرى، وبصياغة منهج جديد في تدريس حضارة الإسلام في المدارس والمعاهد والجامعات. وهي خطوات تطبيقية قابلة للتحقّق على أرض الواقع، وإغناء (مشروع إحياء نظام تربوي أصيل) بمنهج عمل يساعد على تحقيق جانب من أهدافه المتوخاة.
إن الدراسات والأدبيات المنشورة ذات الصلة بموضوع البحث المقترح تتمركز عند جوانب محددة من الموضوع، ولا تكاد تشير إلى شبكة التأسيسات والشروط التي قدمها كتاب الله وسنة رسوله (ﷺ)، وشهدها عصر الرسالة، لوضع الأمة في مركز الفعالية الحضارية، كما أنها، الاّ قلة منها، لا تكاد تشير إلى عوامل الشلل التي أصابت الأمة بالتخلّف والعقم الحضاري، وهي إن أشارت فإنها تكتفي بالوقوف عند عوامل محددة، دون محاولة شاملة لاستقصاء العوامل كافة، كما أنها لا تولي اهتماماً بمعالجة منهج التعامل مع الحضارة الإسلامية في المدارس والمعاهد والجامعات، والثغرات التي تخترق بنية هذا المنهج، وسبل تداركها.
أما بخصوص امكانات الانبعاث، وسبل المواجهة، وتحديد العوائق والحلول الممكنة، فعلى كثرة ما قدّم من بحوث ودراسات حول هذه المفردة أو تلك من مفردات الموضوع، فإننا لا نكاد نجد بحثاً أو دراسة تلّم هذه المفردات كافة في نسق واحد يتناول الموضوع من جوانبه كافة. ولذا سيجيء هذا البحث المقترح لكي يملأ الفراغ الملّح قدر الامكان، بسبب من ارتباطه الوثيق بمشروع إحياء نظام تربوي أصيل يفترض الاّ يغفل واحدة من أهم الحلقات، وهي الحلقة الحضارية، التي يمكن إذا أحسن توظيفها وفق منهج محكم، أن تمارس دورها في بناء النظام المذكور، لاسيما وأن مساحات واسعة من البحث تنطوي على بعد تطبيقي يمكن التعامل مع مفرداته على الأرض، ويعين بالتالي على تحقيق أهم أهداف المشروع، وهو البعد التطبيقي.
هذا ولسوف يتضمن البحث المقترح لدى إنجاز نصّه كاملاً، مساحة مناسبة لتحليل أهم الأدبيات المنشورة حول الموضوع، مع ملاحظة أن البحث في مساحته الأوسع ينطوي على بعد تطبيقي تكاد تخلو منه الأدبيات المذكورة.
3. الفكرة المحورية للبحث
سيحاول البحث أن يتابع الاشكالية المشار إليها في الفقرة السابقة، ويقدم. في المقابل. الصيغ التي تمكن مؤسساتنا التعليمية والتربوية من مواجهة هذه الحالة الخاطئة، وإعادة الأمور إلى نصابها في تخريج أجيال من المسلمين تنطلق من رؤيتها العقدية الأصيلة في التعامل مع العلوم الإنسانية، وتملك -في الوقت نفسه- القدرة على الابتكار والإضافة والإبداع، وإعادة صياغة المعارف الإنسانية، وبالمنهج والأدوات العلمية، بما يجعلها تتوافق وتنبني على ثوابت ومرتكزات هذا الدين. إن الخندق الذي يفصل بين المعرفتين الغربية والإسلامية عميق شامل، قد تكون هناك نقاط التقاء وجزر مشتركة بكل تأكيد، ولكن المساحة الأوسع في نسيج المعرفتين تستمد خيوطها من رؤى متغايرة، وربما متناقضة، وبالتالي فان التأثيرات التربوية في عملية بناء الإنسان المسلم المعاصر قادت عبر القرنين الأخيرين تحديداً، إلى جملة من النتائج السلبية التي كان من ثمارها غياب الإنسان المبدع والقدير على الفاعلية والابتكار والمشاركة المؤثرة في صناعة الحياة، لأنها وضعته في حالة من الازدواجية بين مؤثرين متناقضين يلتصق أحدهما بالبعد المادي الذرائعي، حتى لا يكاد يترك أيما مساحة للبعد الغيبي القيمي، ويسعى الآخر إلى تعميق الإيمان بالغيب وبمنظومة القيم الإنسانية والأخلاقية التي تترتب عليه بعيداً عن الأخذ بالسنن والأسباب المادية.
ولقد آن الأوان لتجاوز هذه الإشكالية الخطيرة التي خرّجت أجيالاً من الشباب الذين خسروا الاثنتين معاً، فلا هم امتلكوا سر القوة والإبداع التي مكنت الغربيين من الإمساك برقبة العالم، ولا هم تحصنّوا برؤيتهم المتميزة التي منحت آباءهم يوماً السيادة على العالمين.
ولسوف يسعى البحث إلى وضع اليد على جذور المشكلة، والنتائج التي ترتبت عليها، ويحلل الصيغ العملية التطبيقية لمعالجتها بما يقدم البدائل المناسبة للجدل الفعال بين المعرفتين، والذي سيتمخض بالضرورة عن إعداد الإنسان المسلم المبدع والفاعل والمتعدد الأدوار مهنياً ومهارياً، بالتوازي تماماً مع تكوينه الإيماني والأخلاقي، ورؤيته المتميزة للحياة والوجود والمصير.
ومنذ قرون انكفائنا الحضاري ومؤسساتنا التعليمية والتربوية تخرج أجيالاً من الناس لا تملك القدرة على الابتكار والإبداع، ولا الرغبة المتأصلة في إعادة بناء الحياة الإسلامية وفق ما يريده الله ورسوله (ﷺ).
انطفأت الشعلة، وخبا وهجها، ودخلت الأمة عصر الظلمة والكسل والتقليد، بخلاف ما كان عليه الحال زمن تألقنا الحضاري الذي كان العالم أو الفقيه يقود فيه الحياة، ويساهم بفاعلية عالية، في إعادة بنائها، فيملك. بذلك. حضوراً مؤثراً في إعانة الأمة على المضي في بناء مشروعها الحضاري بما أنها الأمة الوسط التي أريد لها أن تكون شاهدة على البشرية، ويكون الرسول شاهداً عليها.
سيتابع البحث شبكة الشروط التي دفعت الأمة وقياداتها الفكرية إلى تلك الفاعلية المتألقة، زمن النهوض الحضاري، وسيحلل. في المقابل. جملة العوامل التي ساقتها إلى الانكفاء، ثم يخلص إلى امكانات العودة ثانية إلى مركز الفاعلية، والقدرة على المشاركة في صياغة المصير البشري. بعد التأشير على جملة من الخطوات الإجرائية التي ستعين على تحقيق المطلوب.
وثمة وقفة في المقطع الأخير من البحث، عند الخطأ الذي مارسته مدارسنا وجامعاتنا في طريقة تدريس مادة (الحضارة الإسلامية)، باعتمادها المنهج التفكيكي الذي يخرّج طلبة فقدوا الثقة والاعتزاز بما قدمه الآباء والأجداد، وسبل تدارك هذا الخطأ.
إن هذه المناهج المعطاة في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا تعاني من عيوب شتى أفقدت المربين القدرة على توظيف واحدة من أكثر الحلقات المعرفية توهجاً وقدرة على البناء التربوي الأصيل، وتخريج المبدعين والقادة والرواد، وتلك هي حلقة الحضارة الإسلامية التي عانت ولا تزال وعلى مدى جغرافية عالم الإسلام ومعاهدها وجامعاتها من عيوب شتى، أبرزها ولا ريب، تقطيع جسد هذه الحضارة وتقديمها للطالب مزقاً وتفاريق، وهي بهذا ستفقد شخصيتها المتميزة وملامحها المتفردة التي تمنحها الخصوصية بين الحضارات، وتصير مجرد أنشطة ثقافية أو معرفية أو مدنية في هذا المجال أو ذاك، قد تتميز ببعض الخصائص، لكنها لا تعكس التصور النهائي لرؤية المنتمين إليها للحياة والإنسان والعالم والوجود والمصير.
إن معاهدنا وجامعاتنا تقطع سياق هذه الحضارة ووحدتها فيما تسميه (الضرورات الزمنية) حيناً، و (المنهجية) حيناً آخر، و (التخصصية) حيناً ثالثاً، فتدرس النشاط الاقتصادي في سنة أو مساق، والحياة الاجتماعية في مساق آخر، والحركة العلمية في مساق ثالث، والنظم الإدارية في مساق رابع. لا بل انها حتى وهي تدرس كل واحد من هذه المسافات تتعامل معه مقطعاً مجزءاً لا يكاد يملك خصوصياته وتميزه على مستوى التصورات التي تعبر عنه والممارسات التي تنزل به إلى واقع الحياة.
ويتخرّج تلميذ الثانوية والطالب الجامعي وهو لا يكاد يملك معرفة معمقة بخصائص حضارته الإسلامية، وبالمكونات التي تميزها عن الحضارات الأخرى، فضلاً عن أنه يتخرج وهو لا يملك الاعتزاز بحضارته والفخر بها، بما أن النشاط التدريسي في التاريخ والحضارة ينطوي بالضرورة على بعد تربوي، لكن هذا البعد يتفكك ويغيب من خلال الخطيئة المنهجية التي لا تكاد تمنح الطالب أي ملمح يجعله يتشبث بتراثه الحضاري باعتباره أقرب إلى مطامح الإنسان ومهماته الأساسية في هذا العالم. بل اننا قد نصل -في نهاية الأمر- إلى نتائج معاكسة تتمثل في رفض حشود الخريجين لتراثهم الحضاري، وإنكاره، وإعلان التمرد عليه، والاندفاع بالمقابل في اتجاه إغراءات الحضارات الأخرى وإغواء بريقها الظاهري الخادع، وبخاصة الحضارة الغربية، وبهذا يصير تدريس الحضارة الإسلامية سلاحاً نشهره ضد أنفسنا لتدمير الثقة بمقومات حضارتنا وقدرتها على الاستعادة والفاعلية في صميم العصر، وفي مشاركاتها المحتملة في صياغة المصير البشري، كما يؤكد العديد من المفكرين والباحثين والمستشرقين الغربيين أنفسهم.
إننا في عصر ما يسمى بصراع الثقافات، زمن الغزو الفكري والعولمة ومحاولات الاحتواء، ونحن نتذكر مقولة (توينبي) بخصوص الحضارات الست المتبقية في العصر الراهن، بعد غياب ما يزيد عن العشرين، وان هذه الحضارات المتبقية، بما فيها الحضارة الإسلامية، تلفظ أنفاسها وتدور في فلك الحضارة الغربية الغالبة، وهي معرضة في أية لحظة للتفكك والتلاشي في مدارات هذه الحضارة.
فمن أجل مجابهة هذا المصير المحزن، والتأبي على إغوائه، علينا أن نتحصن في خصوصياتنا الحضارية، ان نتشبث بعناصرها الفاعلة ومكوناتها القديرة على الديمومة، وارهاصاتها الواعدة بالمشاركة في المصير، ولن يتم هذا كله ان لم نملك منهجاً شمولياً وليس تفكيكياً، لدراسة هذه الحضارة، وان لم نغرس في نفوس الطلبة وعقولهم خاصية الاعتزاز بحضارتهم، والثقة، ليس فقط بقدرتها على الانبعاث، وانما بمواصلتها النمو كرة أخرى، وتقديمها الوعد بالخلاص للبشرية المعاصرة التي أوصلتها الحضارة الغربية المادية، والأديان المحرفة، والمحاولات التلفيقية، إلى طريق مسدود.
وعلى ذلك فان الفكرة الأساسية للبحث المقترح تتمركز عند مهمة توظيف مادة (الحضارة الإسلامية) المعطاة في المعاهد والجامعات، توظيفاً إيجابياً فعالاً لتخريج أجيال من الطلبة تملك الثقة والاعتزاز بمشروعها الحضاري، والقدرة بالتالي على المساهمة في إعادة انبعاثه بأعلى وتائر الفاعلية والابتكار، بعد تشخيص شبكة العوامل التي قادته إلى الانكفاء، وسبل تجاوزها.
لقد أبحرنا على مدى أكثر من قرن في الاتجاه المعاكس، فاعتمدنا منهجاً تفكيكياً خاطئاً في التعامل مع حضارة الإسلام في المعاهد والجامعات، كان لابد وأن ينتج ثماراً تربوية مرة تتمثل في حشود الخريجين الذين يغمرهم الشك في قدرة حضارة الآباء والأجداد على أن تستعيد فاعليتها في العصر الراهن، الأمر الذي انسحب على هؤلاء الخريجين فدفعهم إلى مزيد من السلبية وفقدان القدرة على الابتكار والريادة والإبداع.
إن التعامل الجاد مع مادة (الحضارة الإسلامية) في المعاهد والجامعات، يمثل في بعده الحقيقي، مواجهة نوعية لخطر تلاشي الهوية الأصيلة لدى الأجيال من خلال الصيغ الخاطئة في التعامل مع هذه المادة، كما يعكس رؤية استراتيجية للمشكلات الخطيرة المصاحبة لتغيرات وتحولات العصر الحضارية، من عولمة ونظريات مساندة كنهاية التاريخ وصراع الحضارات، فضلاً عن أنه يمثل استجابة نوعية للمطالب الملحة في الأدبيات ذات الصلة لحماية خصوصيات الأمة وإنارة السبل لانبعاثها من خلال تشخيص الأدواء التي أوقفت اندفاع الفعل الحضاري الإسلامي، هذا إلى أنه يعكس تلبية شافية لأمنية الكثير من أولياء الأمور وقطاعات مجتمعية أخرى ممن يرغبون في تربية أبنائهم على قيمنا الحضارية الأصيلة، وذلك من خلال تصميم نموذج منهجي قابل للتطبيق في المدارس والمعاهد والجامعات.
4. محاور البحث
أولاً: مقدمة حول أهمية الدراسة الحضارية:
ثانياً:
أ- تأسيسات الفعل الحضاري الإسلامي ودورها في إعداد إنسان متعدد الأدوار (مهنياً ومهارياً، إضافة لتكوينه الإيماني، والأخلاقي) وفي إعداد مسلمين مبدعين حضارياً في شتى المجالات، ورواد أو قادة عالميين متميزين.
ب- دلالة المنجزات الحضارية لعصر الرسالة.
ثالثاً: عوامل الانكفاء ودورها السلبي الذي أصاب قدرات الأمة الفاعلة بالعقم والشلل.
رابعاً: إمكانات الانبعاث وسبل المواجهة (العوائق والحلول):
أ- العوائق:
- الدور السلبي للمعرفة الإنسانية الغربية في بنية مناهجنا التربوية.
- عزلة المائتي عام بين المعرفتين الإنسانية والإسلامية في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا، وتأثيراتها السلبية.
ب ـ الحلول الممكنة:
- التأصيل الإسلامي للمعرفة الإنسانية.
- كسر جدار العزلة بين المعرفتين الإنسانية والإسلامية.
جـ- تحليل المعطيات الغربية في تقييم احتمالات الانبعاث والمشاركة الإسلامية الفاعلة في مصير العالم.
خامساً: صياغة منهج جديد في دراسة وتدريس حضارة الإسلام في المدارس والمعاهد والجامعات، يبنى على الفقرات السابقة، ويملك القدرة على التعامل الإبداعي مع إشكالات واحتياجات المجتمعات العربية والإسلامية من جهة، وهموم واحتياجات المتعلمين في هذه المجتمعات من جهة أخرى.
سادساً: صياغة منهج جديد في دراسة وتدريس التاريخ الإسلامي بسبب من ارتباطه بالحضارة.
5. مصطلحات ومفاهيم البحث الأساسية
الحضارة الإسلامية:
جملة المعطيات الثقافية والمدنية التي أنتجها المسلمون عبر قرون تفوقهم الحضاري وفي حلقاته العقدية والمعرفية والسلوكية والمعنوية والمادية، وهذه المعطيات تتشكل في غالب الأحيان في سياقات خمسة:
- السياق الإداري والتنظيمي.
- السياق المعرفي.
- السياق الاقتصادي.
- السياق الاجتماعي.
- السياق العمراني.
الفعل الحضاري:
قدرة الأمة على الإنجاز الحضاري في سياقاته كافة، بما تملكه من طاقة فاعلة ومبدعة تستند إلى شروطها وتأسيساتها المحفزة على العمل والابتكار.
الانكفاء الحضاري:
تضاؤل الفعالية، وانطفاؤها، بسبب ما يصيب أمة ما من عقم وشلل يكفها عن الاستمرار في أدائها الحضاري، ويلغي قدرتها على الابتكار والإضافة والتجديد والإبداع.
الانبعاث الحضاري:
استعادة الأمة لقدراتها الحيوية في الإنجاز الحضاري، استناداً إلى الشروط والتأسيسات التي مكنتها أول مرة من صياغة حضارتها المتميزة.
المعرفة الإنسانية:
هنالك أربعة أصناف من المعارف والعلوم التي يتميّز بعضها عن الآخر وهي:
- المعرفة الإنسانية.
- المعرفة الإسلامية.
- العلوم الصرفة.
- العلوم التطبيقية. وتنطوي المعرفة الإنسانية على جملة من العلوم الوضعية كعلم الاجتماع، والنفس، والإدارة، والسياسة، والقانون، والاقتصاد، والفلسفة، والتاريخ، والحضارة، والآداب والفنون… إلى آخره…
المعرفة الإسلامية:
وهي التي تتشكل في دائرة معارف الوحي، والتي تضيف إليها وتغنيها المعطيات العقلية، وتنطوي المعرفة الإسلامية على العقيدة، وعلوم القرآن، والحديث، وأصول الفقه، والفقه… إلى آخره.
التأصيل الإسلامي للمعرفة:
اعتماد الثوابت والتأسيسات الإسلامية في كتاب الله وسنة رسوله (ﷺ) وضوابط التصوّر الإسلامي للكون والحياة والإنسان، لإعادة بناء المعارف الإنسانية، جنباً إلى جنب مع الإفادة من الخبرات والكشوف الموضوعية للمعرفة الغربية. ومعلوم أن هذه المعرفة تنطوي في الوقت نفسه على جملة من الاستنتاجات الخاطئة وغير المنضبطة علمياًَ، فضلاً عن ارتطام العديد من مسلّماتها بثوابت التصوّر الإسلامي للكون والحياة والوجود والإنسان، الأمر الذي يتطلب تأصيلاً علمياً منهجياً للمعارف الإنسانية تتوافق في تكوينه معطيات الوحي والعقل.
المنهج التفكيكي:
ذلك الذي يتعامل مع الحضارة الإسلامية دراسة وتدريساً وفق رؤية تجزيئية تتعاطى مع كل حلقة من هذه الحضارة وكأنها منفصلة عن الأخرى، فتفقد بذلك القدرة على تلّمس الخصائص الأساسية لهذه الحضارة عبر أطوارها كافة.
المنهج الشمولي:
ذلك الذي يدرس الحضارة الإسلامية -أو أية حضارة- كوحدة متميزة، ذات شخصانية متجانسة وملتحمة في حلقاتها كافة، ويتابع الخصائص المميزة لهذه الحضارة، ويتعامل معها كما لو كانت كائناً حيّاً يولد، وينمو، ويشيخ، وينبعث من جديد.
العولمة:
الإفراز الطبيعي للتقدم العلمي والتقني المدهش، وللنظام العالمي الجديد وخلفياته التنظيرية سواء في (صراع الحضارات) أو (نهاية التاريخ). والمصطلح يعني. بإيجاز. تحوّل العالم إلى نادٍ أو قرية صغيرة، تزداد فيها وتتداخل العلاقات المتبادلة بين الأمم والشعوب، سواء تلك المتمثلة في تبادل السلع والخدمات، أو انتقال رؤوس الأموال، أو في انتشار المعلومات والأفكار، ورفع الحواجز والحدود أمام المؤسسات والشركات متعددة الجنسية.
صراع الحضارات:
نظرية قال بها (صموئيل هنتنكتن) أستاذ العلوم السياسية، ومدير مؤسسة (جون أولين) للدراسات الستراتيجية بجامعة هارفارد، في محاضرته عن (صدام الحضارات)، والتي تضمنتها دراسته الموسومة بـ (المصالح الأميركية ومتغيرات الأمن) التي نشرت في (مجلة الشؤون الخارجية) في حزيران 1993م. وملخصها أن الغرب، يعد سقوط الاتحاد السوفياتي، بحاجة ماسّة إلى عدو جديد يوحّد دوله وشعوبه، وأن الحرب لن تتوقف حتى لو سكت السلاح وأبرمت المعاهدات، ذلك أن حرباً حضارية قادمة ستستمر بين المعسكر الغربي الذي تتزعمه أمريكا، وبين طرف آخر قد يكون عالم الإسلام أو الصين.
نهاية التاريخ:
نظرية قال بها المفكر الأمريكي (فرنسيس فوكوياما) في أخريات القرن الماضي، تضع مقدرات التاريخ البشري في الحالة الليبرالية التي تتزعمها أمريكا، وتلغي خصوصيات الأمم والشعوب وذاكرتها التاريخية !… عاد (فوكوياما) بعد سنوات لكي يعدّل في أساس النظرية بقبول فكرة (التغاير) بعد إذ أدرك أن نظريته التي تنطوي على مصادرة التاريخ، انما هي رؤية خاطئة تتشكل على النقيض من قوانين التاريخ، وهي الخطيئة نفسها التي وقعت فيها دعاوى الشيوعية في ماديتها التاريخية.
6. الحاجة للبحث
إذا قدّر (لمشروع إحياء نظام تربوي أصيل) أن يتحقق على أرض الواقع، من خلال معهد، أو مؤسسة، أو شبكة مدرسية، أو جامعة، فإنه سيجد بين يديه، من خلال هذا البحث، جملة من المقترحات العملية القابلة للتطبيق في مناهج وممارسات المعهد أو المؤسسة المذكورة، من مثل:
- منهج جديد في تدريس مادة (حضارة الإسلام) مقسّم على سنوات الدراسة، يعيد لهذه المادة قدرتها على تخريج طلبة متميزين، مبدعين، واثقين بعقيدتهم، وبمشروعها الحضاري، وبمعطيات الآباء والأجداد زمن تألّقهم الحضاري، قديرين على المشاركة الفاعلة في إعادة بناء الحياة الإسلامية بما يمكنها من أداء دورها المنوط بها في صياغة المستقبل.
- ومع المنهج الجديد، كسرٌ لجدار العزلة -في المؤسسة المنشودة- بين المعرفتين الإنسانية والإسلامية، من أجل تخريج نخب تمسك جيداً بمطالب العلوم الإسلامية، جنباً إلى جنب مع المعارف الإنسانية في أهم تخصصاتها، فيما يجعلها قديرة على أن تكون على وعي عميق بثقافة العصر وتحدياته، وتحكيم خبرتها الإسلامية فيها، للخروج بنتائج إيجابية تمكن الأمة من أن تستعيد مكانتها المتميزة، والتي طمست عليها قرون العزلة بين المعرفتين الإسلامية والإنسانية.
- هذا فضلاً عن قيام المعهد أو المؤسسة المنشودة بتنفيذ مبدأ التأصيل الإسلامي للمعرفة الإنسانية، فيما يعينها على التخلّص من الشوائب والأخطاء التي علقت بها بفعل الاجتهادات والمناهج الوضعية النسبية، ويجعلها أكثر توافقاً -وبقوة المنهج العلمي
وأدواته- مع ثوابت ومرتكزات التصوّر الإسلامي للكون والحياة والوجود والإنسان، وتحرير الإنسان المسلم بالتالي من حالة الازدواجية بين نتائج وكشوف المعرفتين.
- وسيعرض البحث -وبالإيجاز المطلوب- لمنهج بديل في دراسة وتدريس التاريخ الإسلامي، فيما يعطي للمؤسسة المنشودة خصوصية وفرادة في التعامل مع الموضوع.
وليس من المعقول أن يمضي المشروع إلى غايته دون أن يولي الحلقة الحضارية بكل ما تنطوي عليه من تأثيرات تربوية، اهتماماً كافياً، ولاسيما إذا تابعنا مجمل الخطط البحثية المقدمة للمشروع، والتي تعالج جوانب أخرى في بنية المشروع لا تقل أهمية، ولكنها لا تكاد تتعاطى مع الحالة الحضارية بأبعادها المذكورة، فيما يبدو واضحاً بمجرد إلقاء نظرة على عناوين الخطط المذكورة التي نوقشت في اللقاء التشاوري الأول، وقدمت بخصوصها جملة من الملاحظات لتجاوز أي قدر من التكرار في موضوعات هذه البحوث.
7. علاقة البحث بالمشروع
سيتابع البحث:
- شبكة الشروط التي دفعت الأمة وقياداتها الفكرية إلى تلك الفاعلية المتألقة زمن النهوض الحضاري.
- وسيحلل. في المقابل. جملة العوامل لتي ساقتها إلى الانكفاء.
- ثم يخلص إلى امكانات العودة ثانية إلى مركز الفاعلية، والقدرة على المشاركة في صياغة المصير باعتماد جملة من الإجراءات التطبيقية، وفي مقدمتها كسر جدار العزلة بين المعرفتين الإنسانية والإسلامية، والتأصيل الإسلامي للمعرفة.
- سيتم ذلك في ضوء الرؤية الكلية للمشروع الذي يستهدف بناء نظام تربوي أصيل قابل للاستمرار والتطبيق، وقدير على تخريج أجيال تتميز بالابتكار والإبداع، فضلاً عن تحصّنها في خصوصياتها، واستعصائها على الانزلاق باتجاه إغواء البريق الخادع للحضارة الغربية.
- ومن خلال التعامل مع تدريس مادة (الحضارة الإسلامية) في المدارس والمعاهد والجامعات وفق منهج شمولي يرفض التفكيك، ويستهدف تقديم تصوّر أقرب للموضوعية لبنية الحضارة الإسلامية، بدءً ونمواً وصيرورة وانهياراً وانبعاثاً، ستستعيد مؤسساتنا التعليمية والتربوية القدرة على توظيف هذه الحلقة المعرفية المهمة توظيفاً بنائياً يتوافق في نتائجه مع مرتكزات الرؤية الكلية للمشروع.
8. منهجية البحث وأدواته
سيعتمد البحث المنهجين الوصفي والاستقرائي في متابعة مكونات الظاهرة، بأوجهها الثلاثة: الانطلاق والانكفاء والانبعاث، وفي التعامل مع الواقعة التاريخية، واستقصاء جملة من الاستنتاجات المهمة لعدد من الباحثين والمفكرين، هذا فضلاً عن تسليط الضوء على أبعاد الدور الذي مارسته المعرفة الإنسانية الغربية في مؤسساتنا التربوية والتعليمية، والتأشير على سبل التعاطي مع هذه المعرفة. ولسوف يخلص البحث إلى وصف مكونات المنهج الجديد المقترح في دراسة وتدريس مادة الحضارة الإسلامية في المدارس والمعاهد والجامعات.
وما من شك في أن بحوثاً ودراسات عديدة كتبت في الموضوع، ولكن هذا البحث سيلّم شتات ما تناثر في تلك البحوث والدراسات من مرئيات واستنتاجات تتعلّق بالموضوع، وأن يدرجها في نسق متوحد، سيسعى، بما يضيفه إليها من جديد، لأن يمنح المعنيين بالمشروع القناعة بالنتائج والحلول التي خلص إليها البحث.
9. الدراسات السابقة
إذا أحلنا معظم البحوث والدراسات إلى خطة البحث التفصيلية، فلسوف نجد أنها تتمركز عند معالجة جانب من هذه المفردة أو تلك من مفردات الخطة أو محاورها، فلا نكاد نعثر على مرجع واحد يلمّها جميعاً في نسق واحد يؤول إلى جملة من المقترحات التطبيقية في مواجهة الإشكاليات والتحديات.
إن الدراسات والأدبيات المنشورة ذات الصلة بموضوع البحث المقترح تتمركز عند جوانب محددة من الموضوع، ولا تكاد تشير إلى شبكة التأسيسات والشروط التي قدمها كتاب الله وشهدها عصر الرسالة لوضع الأمة في مركز الفاعلية الحضارية، كما أنها، الاّ قلة منها، لا تكاد تشير إلى عوامل الشلل التي أصابت الأمة بالتخلف والعقم الحضاري، وهي إن أشارت فانها لا تستقريء العوامل كافة وانما تكتفي بالوقوف عند عوامل محددة، كما أنها لا تولي اهتماماً بمعالجة منهج التعامل مع الحضارة الإسلامية في المدارس والمعاهد والجامعات، والثغرات التي تخترق بنية هذ المنهج، وسبل تداركها.
أما بخصوص إمكانات الانبعاث، وسبل المواجهة، وتحديد العوائق والحلول الممكنة، فعلى كثرة ما قدّم من بحوث ودراسات حول هذه المفردة أو تلك من مفردات الموضوع، فإننا لا نكاد نجد بحثاً أو دراسة تلّم هذه المفردات كافة في نسق واحد يتناول الموضوع من جوانبه كافة، ولذا سيجيء هذا البحث المقترح لكي يملأ الفراغ الملّح قدر الامكان، بسبب من ارتباطه الوثيق بمشروع إحياء نظام تربوي أصيل لا يغفل واحدة من أهم الحلقات، وهي الحلقة الحضارية التي يمكن إذا أحسن توظيفها، وفق منهج محكم، ان تمارس دورها في بناء النظام المذكور، لاسيما وأن مساحات واسعة من البحث تنطوي على بعد تطبيقي يمكن التعامل مع مفرداته على الأرض، ويعين بالتالي على تحقيق أهم أهداف المشروع، وهو البعد التطبيقي.
ونستطيع من خلال التعامل مع الدراسات والأدبيات المنشورة ذات الصلة بموضوع البحث، أن نلحظ كيف أنها تنقسم إلى أربعة سياقات أساسية وفق الفضاء الذي تقدّم معطياتها فيه. فهنالك السياق الحضاري، فالسياق الثقافي -الفكري، فسياق التأصيل الإسلامي للمعرفة الإنسانية، فالسياق التربوي- التعليمي. مع طرح التحفظ الضروري بخصوص صعوبة، بل استحالة، وضع حواجز نهائية بين سياق وآخر، ما دامت أنها جميعاً تنتمي إلى دائرة المعرفة الإنسانية وليست العلمية الصرفة.
وفيما يلي عرض مفصل لأهم تلك الدراسات:
عرض بأهم الدراسات والأدبيات المنشورة عن الموضوع
أولاً : السياق الحضاري:
1- الحوار… الذات والآخر للدكتور عبد الستار الهيتي
يعتبر الكتاب بمثابة دعوة إلى عمل تأصيلي، ومساهمة في تغيير المسار النفسي وإشاعة ثقافة الحوار التي كادت تغيب بالأقدار المطلوبة عن الذهنية الإسلامية، سواء مع الذات أو (الآخر) على حدّ سواء، والدعوة إلى ممارسة الحوار الداخلي ابتداء من الحوار مع النفس والانطلاق به إلى الأسرة والمدرسة والنادي والمجتمع والدولة، حتى يشمل فعاليات الحياة كلّها، وانتهاء بالحوار مع (الآخر) المختلف في عقيدته وتاريخه وثقافته، والعمل على تصويب عملية الحوار ذاتها، وإيضاح شروطها وأدواتها وعناصرها وأخلاقياتها، والمعارف النوعية المطلوبة لها، سواء على مستوى الذات أو (الآخر) حتى تؤتي ثمارها، وتخلص الذهنية الإسلامية من الآفات التي انتهت إليها بسبب من المعاناة وردود الأفعال لتدرك أن ما تمتلكه من القيم في الكتاب والسنة ورصيد النبوة التاريخي هو سلاحها الفعال، وهو سفينة النجاة للإنسانية جميعاً، بعد هذه التجارب المريرة التي لم تحمل لنا الاّ الصاب والعلقم، وكانت السبب الرئيس في محاصرتنا وشل حركتنا وتلفيق التهم لديننا.
2- علوم حضارة الإسلام ودورها في الحضارة الإنسانية لخالد أحمد حربي
يمكن أن يعتبر أحد المحرضات الفكرية، وشواهد الإدانة التاريخية للحال التي
انتهت إليها الأمة، من الركود والتخلف والتوقف العلمي والثقافي. ذلك أن الحديث عن إنتاج العلماء، وتاريخ العلوم عند المسلمين دليل واضح على أن القيم الإسلامية لم تكن عائقاً في وجه التقدم العلمي، وانما كانت دافعاً ومحرضاً للتضلع في شعب المعرفة جميعاً، وكان الإنجاز العلمي يوازي دائماً الالتزام بقيم الدين وسلامة تنزيلها على واقع الناس، وأن الوهن في الاستمساك بقيم الدين وشيوع التدين المغشوش أدى إلى نوع من التخلف والارتكاس… ان الأمة التي لها مثل هذا التاريخ وهذا الانجاز وهؤلاء العلماء الأعلام، هي أمة مؤهلة لأن يكون لها حاضر ومستقبل، إذا وعت قيمها وتاريخها وأحسنت التقدير لامكانها الحضاري وأدركت كيفية التعامل معه.
3- الإسلام وصراع الحضارات للدكتور أحمد القديدي
دعوة لأن تنطلق صحوة الإسلام المباركة، من عملية إعادة قراءة تاريخ الإسلام، فتغيّر جذرياً من اعتباره تسلسل الدول فحسب، إلى اعتباره تسلسل المدارس الفكرية، والمذاهب الثقافية على مدى القرون، وعبر الدول الإسلامية المتعاقبة كان كل سلوك بشري مال إلى الاستبداد وخرج عن الشريعة، يواجه من الأمة فكراً إسلامياً صحيحاً لإعادة الحق إلى مجراه، والعدل إلى منتهاه، ورد الباطل عن هواه، لأن من خصائص الأمة المسلمة انها لا تتواطأ على الخطأ والمعصية.
إن المنظور التقليدي السائد اليوم في دراسة التاريخ، هو المنظور الأوربي، الذي يضع الحدث السياسي في قمة قراءة التاريخ، ولا يكون الحدث الفكري الا ثانوياً أو فرعياً، وهو منظور في التاريخ الأوربي لكنه منظور قاصر في التاريخ الإسلامي، فإذا كانت السياسة تحدد الفكر في أوربا، نظراً لأسباب تاريخية ودينية وجغرافية واجتماعية، فان الفكر هو الذي يحدّد السياسة في العالم الإسلامي.
والكتاب يعالج أيضاً إشكالية العلم المحض الذي وجد نفسه عاجزاً عن فهم لغز الكون والحياة بمفرده، بل وأكثر من ذلك، أحسّ بخطر انفراد العلم بإدارة الكون، لأن العلم يكتشف ولا يفسّر، فاستنجد العلم بالدين.
4- الظاهرة الغربية في الوعي الحضاري: أنموذج مالك بن نبي لبدران بن الحسن
يعتبر الكتاب محاولة جادة في تأسيس منهج لفهم الحضارة الأوربية المعاصرة، بأبعادها الفلسفية وتاريخها الثقافي، ومنظومتها المعرفية، وإنتاجها المادي الذي جاء ثمرة لذلك كلّه، حيث تشتد الحاجة إلى هذا الفهم وامتلاك هذه الأدوات البحثية اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لما تشكل هذه الحضارة من حضور في كل موقع، تفرض أنماطها، وتحاول من خلال دعوتها إلى العالمية احتواء العالم بخبراته وطاقاته وثقافاته، ومحاولة اكتشاف أمراضها ومداواة نفسها بنفسها، مما يجعل التداول الحضاري والدوران الحضاري يتم في داخل دائرة الحضارة نفسها وعلى محورها.
ولا سبيل أمام المسلم للقيام برسالته في إلحاق الرحمة بالعالمين الاّ بفهم هذه الحضارة، وتحديد موقعه منها، والتفكير في كيفية التعامل معها، من خلال حوار حضاري مستصحب لقيم الوحي، لأن الانفصال عن الحضارة يعني الخروج من الحياة.
والكتاب برؤيته وأنموذجه قد يحقق نقلة مهمة في الذهنية الإسلامية، فتتحول من التقليد إلى التفكير، ومن الاقتصار على حفظ النصوص إلى كيفية اعمالها في الحياة وإخراج الناس بها من الظلمات إلى النور.
5- الخطاب العربي المعاصر: قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة 1978–1987م لفادي إسماعيل
استقصاء لمجموعة الانحرافات الفكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمت ممارستها من قبل النخب الاجتماعية التي تسلمت من الغرب -بعد الاستقلال- زمام أمور هذه الأمة. وهي قائمة مأساوية بالنتائج التي نجمت عن تبني الأنموذج الغربي في التغيير وتحقيق التقدم. وكشف حساب يبين خداع مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة التي سادت بعد الاستقلال وآثارها السلبية نتيجة تطبيقها القسري وتقليدها المبتسر، واستهلاكها الاديولوجي الذي لم يرافقه إصلاح حقيقي في الفكر والثقافة والنظم.
والكتاب حث للبحث عن البديل، وان كان لم يقدمه، وحفز للأمة أن ترسم معالم المشروع الحضاري، بدءاً من الفكر والمعرفة، إلى القيم والعلاقات والنظم.
ويقدم الكتاب استعراضاً لبعض النماذج التاريخية، لمحمد علي ورفاعة الطهطاوي، محللاً ومحاوراً ومنبهاً، وداعياً إلى مخاض فكري لدى مثقفي الأمة، يؤدي إلى تشكيل العقلية النقدية القادرة على الإنتاج المتميز ثم المبدع.
6- قائمة مختارة حول المعرفة والفكر والمنهج والثقافة والحضارة
إعداد محيي الدين عطية
يعد الكتاب أداة ضرورية للمفكرين والباحثين في المجالات المعرفية، والثقافية، بوجه عام، وفي منظورها الإسلامي بوجه خاص.
إن رصد وانتقاء وتصنيف الأدبيات الإسلامية المعاصرة، في مجالات المعرفة والفكر والمنهج والثقافة والحضارة، عبر فترة زمنية تمتد إلى عشر سنوات، هو عمل توثيقي أصيل، يلبي حاجة ملحة في المكتبة العربية والإسلامية، طالما نادى بتلبيتها أهل الفكر والعلم، لما تتيحه لهم من بيانات، وما توفره لهم من الوقت، والجهد والمال.
غطت القائمة أكثر من سبعمائة مدخل تناولت أوعية متنوعة، كالكتب والبحوث والأطروحات الجامعية والمقالات والمحاضرات ذات المستوى العلمي اللائق.
7- فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي: دراسة إسلامية في ضوء الواقع المعاصر
للدكتور سليمان الخطيب
يطرح المؤلف في هذا الكتاب اجتهادات مالك بن نبي ومفاهيمه حول الحضارة، لكي يؤكد على أن الفكر الإسلامي يمتلك طاقات كبرى لحماية الشخصية المسلمة من الذوبان. وكل محاولة لإبعاد هذا الفكر عن واقع الحياة تصبح بغير ذي جدوى، لأن واقع الأمة الإسلامية وتاريخها يؤكدان عكس ذلك. فحقيقة الفكرة الإسلامية واقع صامد، وكائن موجود في عمق الشخصية والمحيط الاجتماعي للإنسان المسلم، وهي تستجيب دائماً لطموحات الإنسان المتجددة، شرط التفاعل مع هذه الفكرة عقيدة، وأخلاقاً، وحضارة.
وفي هذا الإطار قام مالك بن نبي، بتحليل أحداث الحضارة الإسلامية، ملقياً الضوء على مسارها، وصولاً إلى معترك الصراع الحضاري المحتدم في عالمنا المعاصر بين الإسلامية والغربية.
8- مذهبية الحضارة الإسلامية وخصائصها للدكتور محسن عبد الحميد
يتناول المؤلف بالتحليل تحديات الحضارة الغربية المعاصرة للحضارة الإسلامية، وطبيعة استجابة الأخيرة، وقدرتها على التحصّن، رغم أنها تمرّ في أضعف أدوارها. ويمهد لمعنى الحضارة، ودلالة المذهبية باعتبارها وصفاً للحضارة الإسلامية، ثم يتنقل لعرض خصائص هذه الحضارة، وأثرها في الحضارة الحديثة، ويدعو لمنظومة حضارية إسلامية في مواجهة المنظومة الحضارية الغربية، ويختم بالحديث عن الدور الحضاري للأمة الإسلامية في عالم الغد.
9- الإسلام والوعي الحضاري للدكتور أكرم ضياء العمري
يرى المؤلف أن المسلم الواعي هو إنسان الغد إذا كتب الله السعادة للبشرية، فهو يمتلك كل المؤهلات اللازمة لتصحيح مسيرة البشرية وتحويلها عن الدمار الذي تسير نحوه في ظل الحضارة الغربية التي صارت موضع شك كبير من قبل فلاسفتها أنفسهم.
والكتاب يمثل محاولة للكشف عن القيم الحضارية في القرآن والسنة، مع شواهد
وأمثلة من واقع التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، وهي تمثل مدى العمق والشمول والواقعية والإيجابية والصدق والفطرية في تلك القيم التي تمتلك قدرة التأثير المطلق في الزمان والمكان، لأنها نابعة من الوحي الإلهي، أي من خارج الزمان والمكان، ومن هنا كان إطلاقها وعدم نسبيّتها، وهو ما يبحث عنه الإنسان في الشرق والغرب من عالمنا المعاصر.
10- دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين لمالك بن نبي
يتضمن الكتاب محاضرتين ترتبطان بفلسفة التاريخ عند مالك بن نبي، وتعكسان تطبيقاً لفكرته عن الواقع المعاصر في محاولة للتفسير، وعلى المستقبل في محاولة للتوقع، وذلك بعد أن سبق له في دراسات أخرى أن استخدمها في دراسة الماضي وحسب.
هنالك شرطان للخروج من المأزق: شرط نفسي، وهو ما عبر عنه بـ (الإعجاز) جوهر رسالة المسلم الجديد، وهو أن يغيّر نفسه من خلال الاقتناع والإقناع، وبمعرفة نفسه ومعرفة الآخرين. عندها يستطيع تعريف الآخرين بنفسه.
وشرط موضوعي، وهو ما يمكن أن نعبر عنه بـ (المعاصرة الحضارية) أي الارتفاع إلى مستوى الحضارة المعاصرة. ذلك أن التجاوز هو تجاوز لها لا للفراغ. وهنالك علاقة جدلية بين الأمرين، إذ لا يمكن للمسلم الوصول إلى مستوى الحضارة ما لم يقتنع بأن له رسالة (الإعجاز)،
ولا يستطيع تحقيق رسالته ما لم يرتفع إلى مستوى الحضارة (الإشعاع).
ثانياً : السياق الفكري
1- العقل العربي وإعادة التشكيل للدكتور عبد الرحمن الطريري
حالة التشرذم والتشتت التي يحياها العالم العربي، من تعدد الأنظمة، واصطناع
الحدود، والفقر، والجهل، رغم ثراء المصادر الطبيعية، والتقوقع على الذات، وضياع الهوية، وافتقاد الريادة، كلها تستوجب التأمل والتبّصر في واقع العقل العربي.
الإسلام يوجه العقل نحو هدف واحد هو الله، الذي هو مصدر الخلق والرزق، وأهل العبادة، وبذلك تتحقق وحدانية التفكير التي سيكون من نتائجها قطع أسباب التشتت والتذبذب الذهني والصراع النفسي.
إن فاعلية الأمة لا يمكن أن تنطلق إلا من خلال فاعلية أفرادها التي هي شرط أساس في إحداث فاعلية الأمة، وتعتبر وسائل الإعلام والمسجد والمدرسة من أهم قنوات التحقق بالفاعلية.
على الصعيد الأكاديمي أصبح العربي مستهلكاً للنظريات الغربية والشرقية في السلوك والاجتماع والطبيعة، ولم يعد له إسهام يذكر. إن عملية الاجترار أصبحت منظراً مقبولاً، ومن ثم فان العودة إلى الذات تقتضي أن تكون لدينا شجاعة مصارحة الذات، وتعريفها بأخطائها، وأسلوباً علمياً نتمكن من خلاله الدخول في أعماق الذات والتعرف عليها.
2- قضايا في الفكر المعاصر للدكتور محمد عابد الجابري
يتناول المؤلف فيه بالتحليل جملة من القضايا الثقافية والفكرية ذات الارتباط الوثيق بمنظومة القيم التربوية، وهي قضايا تملك ثقلها وحضورها الملحوظ في الساحة العالمية، من مثل العولمة، وصراع الحضارات، والعودة إلى الأخلاق والتسامح والديمقراطية، ونظام القيم.
قد يختلف المرء مع المؤلف في العديد من الاستنتاجات ووجهات النظر، ولكن تبقى قيمة الكتاب في أنه ينطوي على رؤية نقدية ترفض الاستسلام لمعطيات العقل الغربي، في جوانب عديدة من نتاجه المعاصر.
3- تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها لمحمد جابر الأنصاري
يهدف الكتاب إلى إخراج القضايا الفكرية الجوهرية للأحياء الثقافي من إطارها الأكاديمي والبحثي الجامد، وتعريف القارئ العربي بها بصورة ميسّرة وحافزة على التفكير والمتابعة لمسائل التصحيح المنشودة في مسيرة الثقافة العربية الراهنة، في ضوء ظروفها الصعبة، لتحقيق بداية عصر التنوير النهضوي العربي الجديد القادر على التأسيس والمواجهة، في زمن المتغيرات والمتطلبات العالمية المذهلة، والاجتياح الثقافي المتصاعد.
وتتسع دائرة الكتاب لتشمل الأسئلة الكبرى، والمتطلبات الفكرية الأساسية لإنجاز هذه المهمة، وتتراوح قضاياه بين متطلبات التأسيس النهضوي، وتأسيس مدرسة فكرية مجتمعة لتشخيص الخصوصيات العربية المعيقة للنهضة وكيفية تحويلها إلى عوامل مساعدة لها.
4- رسائل في المعرفة والمنهج للدكتور أنور الزعبي
يعالج الكتاب بالبحث والتحليل والنقد قضايا فلسفية عديدة تتعلق بالمعرفة والمنهج، لاسيما علاقة العلوم المعيارية (الدين، الفن، الأخلاق) بالعلوم الطبيعية التجريبية. وبما أن الكاتب قد أنجز في وقت لاحق دراسات عديدة في حقل المعرفة والمنهج، وهو التخصّص الأثير لديه، فان إنجازه هذا يمكن ردّه محورياً إلى هذا المؤلف.
5- مسيرة المعرفة والمنهج في الفكر العربي الإسلامي للدكتور أنور الزعبي
بحث في حكمة العرب والمسلمين، يعرض لإسهامهم الثقافي والحضاري عبر التاريخ، ويسهم في إبراز عناصر ومسالك ذلك النظام المعرفي الإسلامي، في سبيل استشراف مستقبل أفضل.
ويرى المؤلف أن الاهتمام بالمنهج وتطبيقاته يسهم في تشكيل العقلية التي تهتم بالمنهجية والمعرفة. وهو لا يقف عند قراءة مسيرة الفكر الإسلامي، وانما يعيد هذه القراءة، باجتهاد جديد ووعي متميز بمسيرة هذا الفكر ودلالاته، وتوظيف هذا الوعي لخدمة النهوض بالذات الإسلامية. ولتحقيق ذلك يرصد البحث ينابيع الفكر الإسلامي، ثم يتتبع مسيرته، في نموّه وصعوده، وفي توقفه وتراجعه، ثم في بعثه واحيائه. وذلك كله من أجل تصميم البديل الإسلامي الذي نتقدم به لاستشراف المستقبل المأمول.
6- الإسلام على مفترق الطرق لمحمد أسد (ليوبولد فايس)
الكتاب يصارح المسلمين بحقائق قلّ أن جرؤ غيره على التصريح بها: إنه درس دقيق لحال المسلمين اليوم من الناحية الثقافية والروحية، وهو يدعو المسلمين إلى العودة إلى حقيقة دينهم، لأن الدين الذي استطاع أن يجمع العرب منذ أربعة عشر قرناً، ويجعل منهم قوة عظيمة في السياسة والعلم والاجتماع، يستطيع أن يقدم لهم اليوم ما قدم بالأمس: دستوراً للحياة لا يجدون مثله في النظم التي تعرضت منذ فجر التاريخ حتى اليوم لتهذيب البشر.
والكاتب يتحدث برؤية خبير عايش الثقافة الغربية وعناصر ارتطامها بثقافتنا الإسلامية، يتحدث عما فعلته عملية استيراد تلك الثقافة للعمل في مؤسساتنا التعليمية ومناهجنا التربوية، وهو عمل السّم الذي يتسرب في شرايين الجسد فيقوده إلى الدمار.
7- قضايا إشكالية في الفكر الإسلامي المعاصر إعداد حسين محمد نصر وزملاؤه
تحرير : نصر محمد عارف
يعرض الكتاب لجملة قضايا إشكالية طالما شغلت العقل المسلم ولا تزال تشغله حتى الآن، ويدخل معها في حوار ينطوي على رؤية ومنظور جديد يمثل قمة إسهام مدرسة إسلامية المعرفة في مسائل اجتماعية تمسّ حياتنا اليومية: كالفقه والشريعة، والتراث والتاريخ، والتربية والتعليم، والاقتصاد، وقضايا المرأة والفنون.
8- مراجعات في الفكر والدعوة والحركة لعمر عبيد حسنة
يأتي هذا الكتاب في هذه المرحلة الحرجة التي يمرّ بها العالم الإسلامي، والتي كشفت عن مواطن خلل بالغة الخطورة في العقل المسلم، الأمر الذي يستدعي المراجعة لدراسة أسباب الخلل والإصابات، لنفي الخبث، وتقويم الاعوجاج في المسيرة، وتصويب الخطأ في القول والفعل والممارسة، وإعادة إبراز المعالم الغائبة.
ويحاول الكاتب توجيه العقل المسلم إلى أهمية دراسة نواميس الكون وسننه وشروط قيام الحضارات وانهيارها، ورسم معالم العلاقة بين العقل والوحي. كما يدعو إلى تدريب العقل المسلم وتمرينه على الحرية في التفكير، وتخليصه من عقدة الخوف من الخطأ، وقبول الرأي الآخر.
ويؤكد الكتاب على أن أزمة الأمة هي بالدرجة الأولى أزمة فكرية، وأن سائر الأزمات الأخرى ما هي الاّ مضاعفات أو انعكاسات أو أعراض جانبية لها.
9- الأزمة الفكرية المعاصرة: تشخيص ومقترحات علاج للدكتور طه جابر العلواني
دعوة لأن يكون الكتاب والسنة هي الثوابت الأصول، والمراجع التي نريد أن نستمد منها فكرنا وثقافتنا، ونجعلها مرجعنا في كل شيء. أما تراثنا الإسلامي فعلينا أن نقوّمه فنأخذ منه ما ينسجم وتوجيهات الكتاب والسنة ومناهجهما، ونهمل ما صادم شيئاً من ذلك. كما
أن علينا أن نرجع إلى التراث المعاصر، بقطع النظر عن غربيه وشرقيه، ونستفيد من إيجابيّه، وننبذ سلبيّه.
إن علينا أن نتعامل مع الموجود الفكري والحضاري والثقافي من نظرة الإنسان المستنير الذي له مراجعه ومصادر هدايته التي يحاكم كل شيء عليها، وبالتالي فان لدينا الحماية الكافية، وعندنا الأمن الكافي الذي يحمينا من أي انحراف، أو ما يمكن أن يشكل خطراً على عقيدتنا وحضارتنا.
10- مشكلة الثقافة لمالك بن نبي
جرى العرف، إذا ما أريد الحديث عن الثقافة، أن تقتصر مشكلتها في ذهن القارئ على قضية الأفكار. والحق أن المشكلة هي كذلك في جانب من جوانبها، ولكنها لا تقف عند هذا الحدّ، بل تضم أشياء أعم من ذلك كثيراً، تخص أسلوب الحياة في مجتمع معين من ناحية، كما تخص السلوك الاجتماعي الذي يطبع تصرفات الفرد في ذلك المجتمع من ناحية أخرى.
إن تنظيم المجتمع وحياته وحركته، بل فوضاه وخموده وركوده، كل هذه الأمور ذات علاقة وظيفية بنظام الأفكار المنتشرة في ذلك المجتمع، فإذا ما تغير هذا النظام بطريقة أو بأخرى، فان جميع الخصائص الاجتماعية الأخرى تتعدل في الاتجاه نفسه. إن الأفكار تكون في مجموعها جزءاً هاماً من أدوات التطور في مجتمع معين، كما أن مختلف مراحل تطوره هي في الحقيقة أشكال متنوعة لحركة تطوره الفكري، فإذا ما كانت إحدى هذه المراحل تنطبق على ما يسمى بالنهضة، فمعنى هذا أن المجتمع في هذه المرحلة يتمتع بنظام رائع في الأفكار، وأن هذا النظام يتيح لكل مشكلة من مشاكله الحيوية حلاً مناسباً.
ثالثاً : سياق التأصيل الإسلامي للمعرفة الإنسانية
1- إسلامية المعرفة: المبادئ العامة –خطة العمل– الإنجازات
إصدار: المعهد العالمي للفكر الإسلامي
محاولة جادة لعرض فكرة متكاملة مع مبادئها وخطة عملها والأجزاء التي نفذت منها، وهو عرض لأسس المنهجية التي ينبغي أن يتوخاها العقل المسلم في سائر المجالات، ويربى عليها الإنسان المسلم ليحكم المنهج السليم سائر تصرفاته ونواحي سلوكه، وهو كذلك محاولة لبيان انعكاسات المنهج على قضايا المعرفة خاصة، ليتمكن المسلمون من معرفة حقيقة الأزمة التي تعاني منها الأمة، وجذور تلك الأزمة وانعكاساتها على الجوانب المختلفة من حياتهم، مع محاولة تخصيص المعرفة بشيء من العمق في البحث والدراسة واقتراح منهج للعمل جديد يكون فيه لكل مسلم دوره في معالجة هذا الجانب الأساسي من جوانب أزمة وجود الأمة.
2- إسلامية المعرفة للدكتور محمد عمارة
ماذا يعني هذا الشعار؟ هل يعني القطيعة مع معارف الحضارات الأخرى، أم يكفي لتحقيقه إضافة عدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلى معارف تلك الحضارات؟ أم أنه يعني شيئاً آخر تماماً: مذهباً متميزاً في معارف العلوم الإنسانية، وفلسفات ووظائف العلوم الطبيعية؟ ثم… ما هي منطلقاته ونماذجه في الكتاب والسنة؟ وماذا يعني الالتزام به في مشروعنا الحضاري، وفي تميز حضارتنا الإسلامية عن غيرها من الحضارات؟
تلك هي الأسئلة الأساسية التي يثيرها الكتاب ويحاول الإجابة عليها.
3- نحو نظام معرفي إسلامي: حلقة دراسية تحرير الدكتور فتحي ملكاوي
لا تقتصر المواجهة التي يجد المسلمون اليوم أنفسهم فيها، مع الواقع الثقافي والحضاري للعالم المعاصر، على الصور الظاهرة من تخلّف وتجزئة وتبعية، في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية وغيرها، وانما تتجاوز ذلك إلى أنماط التفكير والفهم والنظر، حتى أصبحت مصادر المعرفة الغربية مرجعية معتمدة في سائر العلوم، واخترقت هذه المرجعيات عقل المسلم ووجدانه، وعملت الألفة بما شاع وانتشر من معارف على حجب الأنظار عن خطورة كثير من المقولات العلمانية والافتراضات النظرية الكامنة، المتجاوزة للاعتبارات الخلقية والقيمية الإسلامية.
إن الوعي اللازم على تلك المقولات والافتراضات والقيم الكامنة في مصادر المعرفة السائدة، أمر ضروري وشرط حاسم للاستقلال الثقافي والتميز الحضاري، ولن يتوافر مثل هذا الوعي في غياب النظام المعرفي، وغياب الإدراك العميق لطبيعة القضايا الكلية والأسئلة النهائية التي يوفرها ذلك النظام.
وعليه فان البحث في النظام المعرفي الإسلامي هو بحث في الهوية الحضارية للأمة المسلمة، وأي إسهام في بناء النظام المعرفي وبلورته، هو إسهام في البناء الحضاري للأمة، وبيان للمتطلبات اللازمة لوضع قواعد النهضة، والجهود المبذولة من أجلها على أسس معرفية.
4- المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية: بحوث ومناقشات المؤتمر العالمي الرابع للفكر الإسلامي تحرير : الطيب زين العابدين
يتضمن الكتاب جملة بحوث تتعرض للرؤية الإسلامية للمعرفة والمنهجية والفكر والتعريب، من مثل (أزمة المعرفة وعلاجها) و (العلاقة بين العلم والدين) و (المنهجية في الفكر الإسلامي) و (الأزمة الفكرية والمأزق الحضاري) و (نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامي) و (المنهجية الإسلامية والمعايير الأخلاقية للبحث) و (تصنيف العلوم في الفكر الإسلامي). وهي جميعاً مما يمسّ قضية التأصيل الإسلامي للمعرفة، والعديد من محاور هذا البحث.
5- إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات: ورقة عمل للدكتور طه جابر العلواني
يؤكد الكتاب على أهمية الفكر والثقافة في البناء الحضاري الإسلامي الجديد، ويتحدث عن الظروف الصعبة التي تجتازها أمتنا الإسلامية والفترة الحرجة التي تحياها جماهيرها، وأنها قد تجعل الآذان أقل التفاتاً لقضايا الفكر، لأنها من وسائل الدواء الطويل المدى الذي نقدمه وننادي به، لكن استمرار الإحباط والفشل يؤكد حقيقة صارخة هي: لو أن هذه الأمة استقامت عقيدتها وصلح فكرها وتحررت إرادتها، وأحسن بناء وإعداد إنسانها، وتمتعت بحريتها الكاملة، هل كان يمكن أن يحدث لها ما حدث، وهل كان يمكن للشياطين أن تجتالها بين الحين والآخر لتدمر ما جمعت من قدراتها، ولتعيدها إلى نقطة البدء في جهودها؟
فلولا استحكام الأزمة الفكرية، وغياب الهوية الثقافية، والوحدة الأخوية، ما سقطت الأمة هذا السقوط المروّع في شراك خصومها وأعدائها.
6- الموسم الثقافي لمركز الدراسات المعرفية 2002–2003م لمجموعة محاضرين
تحاول محاضرات هذا الكتاب أن تتناول مفاهيم شائعة في عالمنا المعاصر من خلال رؤية إسلامية تأصيلية تسعى إلى وضع تصوّر لثقافة إسلامية صحيحة نابعة من الكتاب والسنة، رافضة للخرافات التي تعيش بيننا، من أجل إعداد مسلم قادر على أن يفهم ذلك الصراع القائم، والحوارات مع الحضارات الأخرى، بعقلية إسلامية واعية يستطيع من خلالها أن يتعامل مع الآخر مدركاً لآليات التعامل، دون إغفال لوضعه الداخلي والذي يتميز بالتخلف والتردّي، ساعياً إلى إيجاد الحلول الإسلامية التي تأخذ بيده من أجل الإصلاح، مستعيناً بذلك بمنهجية تربوية إسلامية تحدّد له السبل والأهداف دون إغفال لتحديد أبعاد شخصيته الإسلامية المعاصرة والتي يجب أن تكون مؤهلة للتعامل مع ذلك الواقع.
7- العلم في منظوره الجديد لروبرت أغروس وجورج ستانسيو
يدور البحث في هذا الكتاب في شكل موازنة بين مقولات النظرة العلمية القديمة والنظرة العلمية الجديدة. وقد عرض المؤلفان للظروف الصعبة التي نشأت في ظلها النظرة العلمية القديمة التي اصطبغت بصبغة مادية كرد فعل ازاء هيمنة الفلسفة المدرسية المسيحية على العقول، والتي وصلت إلى حالة من التحجر العقلي والتخبط الفكري. وقد انتهت النظرة القديمة إلى الإلحاد والاستهتار بكل القيم الأخلاقية والروحية، وفسّرت السلوك تفسيراً غريزياً فسيولوجياً.
إزاء هذه النظرة ظهرت -في مطلع القرن العشرين- نظرة علمية منافسة كان من ألمع روادها اينشتاين، وهايزنبرغ، وبور، وغيرهم. وقد أجمعت آراء كبار علماء الفيزياء النووية والكوزمولوجيا في هذا القرن على أن المادة ليست أزلية، وأن الكون في تطور وتمدّد مستمرين، فدعوا إلى الإيمان بعقل أزلي الوجود يدير هذا الكون ويرعى شؤونه.
وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية ظهرت حركة جديدة في علم النفس اعترف روادها بالعقل، ورفضوا تفسير السلوك البشري بلغة الدوافع والغرائز الحيوانية، وآمنوا -بدلاً من ذلك- بالقيم الأخلاقية والجمالية والجوانب الروحية والفكرية والنفسية.
والكتاب يستقصي نتائج بحوث هؤلاء الرواد التي أطاحت بالرؤية الإلحادية للعلم الحديث.
8- الإصدارات العربية للمعهد العالمي للفكر الإسلامي إصدار المعهد العالمي
يتضمن قوائم بسلاسل منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، وتعريفاً بالكتب التي تندرج في سياق كل سلسلة، والتي تعالج جملة من القضايا المتعلقة بالتأصيل الإسلامي للمعرفة، وهذه السلاسل هي:
أولاً: سلسلة إسلامية المعرفة.
ثانياً: سلسلة إسلامية الثقافة.
ثالثاً: سلسلة قضايا الفكر الإسلامي.
رابعاً: سلسلة المنهجية الإسلامية.
خامساً: سلسلة أبحاث علمية.
سادساً: سلسلة المحاضرات.
سابعاً: سلسلة رسائل إسلامية المعرفة.
ثامناً: سلسلة الرسائل الجامعية.
تاسعاً: سلسلة المعاجم والأدلة والكشافات.
عاشراً: سلسلة تيسير التراث.
حادي عشر: سلسلة حركات الإصلاح ومناهج التغيير.
ثاني عشر: سلسلة المفاهيم والمصطلحات.
ثالث عشر: سلسلة التنمية البشرية.
9- التوجيه الإسلامي للعلوم والمعارف : مفهومه وأهدافه للدكتور عدنان زرزور
إن الناظر في “علومنا التجريبية”، أو فيما نمارسه أو ندرسه -بعبارة أدق- من هذه العلوم أولاً، وفيما تشيعه جامعاتنا وتتبناه وتدافع عنه مما أطلق عليه “العلوم الإنسانية والاجتماعية” ثانياً، وفيما نذهب إليه من قراءة لديننا وتفسير لتراثنا وتاريخنا، أي لشخصيتنا الضاربة في أعماق التاريخ ثالثاً، أقول:
إن الناظر في هذا كله لا يصعب عليه أن يهتدي إلى أنه، أو معظمه، مترجم أو منقول، الأمر الذي تركنا عالة على غيرنا، غرباء عن أنفسنا، بل مفصولين عن حاضرنا وماضينا ومغامرين بمستقبلنا. ومن ثم فان أهم ما يهدف إليه التوجيه الإسلامي للعلوم هو حماية الأجيال من السقوط في مناخ المترجمات والمنقولات، دفعاً للعجز، واحياء للثقة، وبعثاً لروح التحدّي والقدرة على المنافسة والعطاء، وانتقالاً إلى عصر التفكير والاجتهاد والإبداع، وصولاً إلى مقام الشهادة على الناس الذي ناطه الله تعالى بهذه الأمة من بداية الطريق، وفي نهاية المطاف.
10- القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. للدكتور موريس بوكاي
يقول المؤلف عن كتابه هذا: لقد قمت أوّلاً بدراسة القرآن الكريم وذلك دون أي فكر مسبق وبموضوعية تامة باحثاً عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم الحديث… واستطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها، ان القرآن لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث… وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على العهد القديم والأناجيل… فوجدت مقولات لا يمكن التوفيق بينها، ناهيك عن التناقض بين الأناجيل واصطدامها بحقائق التاريخ.
الكتاب في ضوء هذه النتائج في غاية الأهمية، فهو فضلاً عن تأكيده القاطع على الإعجاز المعرفي للقرآن الكريم، يقدم نموذجاً (غربياً) أسوة بكتاب (العلم في منظوره الجديد)، على مصداقية التأصيل الإسلامي، أو الإيماني للمعرفة، وعلى ضرورته في الوقت نفسه.
رابعاً : سياق التربية والتعليم
1- المسؤولية أساس التربية الإسلامية: محاولة التأصيل للدكتور عبد السلام الأحمر
حاول البحث إبراز أهم معالم أساسية المسئولية في التربية الإسلامية، من خلال استعراض مسهب لموقع التكليف في رسم الحقيقة الإنسانية، ودوره الحاسم في بناء كيان الإنسان المستخلف. وكان من الملح منهجياً أن يتعرض لشرطيْ المسئولية وهما الحرية والعلم وما يؤديان إليه من قناعات اعتقادية وممارسات ممتدة على مستوى الموقف والسلوك.
كما سعى البحث إلى بيان مركزية المسئولية في التربية الإسلامية، منتقلاً بها من كونها إحدى خصائصها وأخلاقها البارزة، إلى ما هو أهم من ذلك وهو كونها أساساً لما تقوم عليه جميع الأخلاق والخصائص وتحتاج منه كل الطباع والمواقف البشرية المختلفة. وساق من الأدلة الضافية ما يشهد لمنهجية هذا الانتقال وصوابه.
2- التعليم وإشكالية التنمية للدكتور حسن الهنداوي
يشكل الكتاب لبنة في البناء التنموي الذي يرتكز إلى المعرفة، كما يعتبر محاولة للانفكاك من واقع التخلّف، والتحول من عملية الإحساس بإشكالية التخلف إلى محاولة إدراك أبعادها، ودراسة الأسباب المنشئة لها، والدعوة للنظر في كيفية التعامل معها، ووضع البرامج والخطط لمعالجتها، والتأكيد على أن التعليم هو سبيل الخروج، وأن عجز التعليم عن العطاء انما هو لأسباب خارجة عنه فلا مناص من النظر فيها.
إن معظم المفكرين والباحثين يرون أن إشكالية التنمية تكمن في نظام التعليم، وآليات التربية والتنشئة. لكن المشكلة -فيما يرى-الباحث- أن واقع التعليم وآلياته وسياساته هو إفراز لذهنية الاستبداد الذي يشكل قمة التخلف وأساسه، وأن فساد العملية التعليمية هو الذي أورث ذهنية الاستبداد، فهو مقدمة ونتيجة في الوقت نفسه.
ومهما يكن من أمر فان المؤسسات المعرفية عامة، والسياسات التعليمية الهادئة المبصرة، قادرة على عزل مواقع الاستبداد وأثرها على ضمير الأمة. كما انها قادرة على ان تحول التخلف إلى أداة لإيقاظ الأمة وشحذ فاعليتها، وجمع طاقاتها، ودفعها إلى التجاوز والنهوض.
3- انعكاسات العولمة على التربية العربية وأساليب المواجهة التربوية لمآرب المولى
تتضح خطورة العولمة في إلغائها وتهميشها للدور الحضاري لبعض المجتمعات التي ساهمت في تكوين الحضارة الإنسانية ومنها حضارتنا العربية الإسلامية الأصيلة، والتي أثبتت تاريخياً قدرتها على التفاعل الإيجابي مع حضارات المجتمعات الأخرى، التي تأثرت وأثرت فيها.
ومن هذا يتطلب الواقع الذي تفرضه العولمة بأنماطها المختلفة مواجهة عربية إسلامية يكون الإعداد لها كبيراً ومنظماً، يشمل جميع الطاقات البشرية، خاصة الطلبة بكل مراحلهم الدراسية وفئاتهم العمرية، لأنهم في مقدمة المستهدفين في مشروع العولمة. ومن هنا أصبحت مسؤولية المؤسسات التربوية بحجم مواجهة التصدي للعولمة.
وما تلبث المؤلفة، بعد شرحٍ واف لطبيعة العولمة وأهدافها، أن تقف طويلاً عند التغيرات التربوية المطلوبة وسبل مواجهة العولمة في المجال التربوي، وهي في معظمها معطيات تطبيقية تمنح الكتاب قيمته الحقيقية.
4- نحو صياغة إسلامية لمناهج التربية للدكتور اسحق فرحان وآخرين
المناهج الحالية الموروثة في معظم الأقطار الإسلامية، تعمل على تكريس الواقع الموروث من الفترة التي خضعت فيها تلك الأقطار للاستعمار، ذلك الواقع الذي كرس الانفصال والفرقة، وجعل الأمة الواحدة مزقاً وتفاريق.
لقد تعرضت مناهج التربية في بلادنا العربية الإسلامية إلى موجة الاستشراق والتغريب، فاستعرنا الكثير من المحتويات، كما استوردنا الكثير من الأطر الفكرية لمناهجنا بحيث أضحى الخطر الفكري يهدد معتقدات أبنائنا، والتسيب الاجتماعي يهدد هوية أجيالنا، وأصبحت ظاهرة الازدواجية في مناهج التعليم تصبغ كثيراً من مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا.
والحقيقة، كما يقول مؤلفو الكتاب أننا بحاجة إلى إعداد المثقف المسلم في كل مجال وميدان، لأن طبيعة الإسلام شاملة شمول الحياة، وطبيعة التربية الإسلامية شاملة لجميع ألوان المعرفة وحقولها. ويخطئ من يظن أن التربية الإسلامية مرادفة للتربية الدينية بالمعنى الكنهوتي في الغرب.
ويعرض المؤلفون في الكتاب لضرورات الحاجة إلى صياغة إسلامية لمناهج التربية والتعليم، ولأسس هذه المناهج الفلسفية والاجتماعية والنفسية والمعرفية لكي ينتهوا إلى تقديم جملة من الخطوات العملية لتحقيق المطلوب.
5- التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة للدكتور اسحق الفرحان
يهدف الكتاب إلى توضيح أهداف التربية الإسلامية، وسماتها المميزة، وتحديات العصر لها، ليكون عاملاً مساعداً للشباب المسلم، الواعي المستنير، وعاملاً مساعداً للمربي المسلم في تحديد معالم التربية الإسلامية، وما يعترضها من عوائق وتحديات. أما الفصل الأخير فقد حاول المؤلف أن يركز الانتباه فيه على جملة من القضايا المعاصرة، ليعالجها المربون المسلمون في ضوء سمات التربية الإسلامية الأصيلة، مبرزاً أهمية الربط بين مفهومي الأصالة والمعاصرة في معالجة تلك القضايا.
6- كيف توجه المعارف في الأقطار الإسلامية لأبي الحسن الندوي
يرى المؤلف أننا في البلاد الإسلامية في حاجة ملّحة إلى نظام تعليمي إسلامي في الروح والوضع والسبك والترتيب، بحيث لا يخلو كتاب من الكتب التي تعلم مبادئ اللغة إلى آخر كتاب يدرس في العلوم الطبيعية أو الآداب الإنجليزية من روح الدين والإيمان، هذا إذا أردنا أن ينشأ جيل يفكر بالعقل الإسلامي، ويكتب بقلم مسلم، ويعمل بروح مسلم، ويدير دفة البلاد بسيرة مسلم وخلقه، ويدير سياسة التعليم والمالية بمقدرة مسلم وبصيرة مسلم، وتكون البلاد الإسلامية إسلامية حقاً في عقلها وتفكيرها وسياستها وماليتها وتعليمها.
إذاً، فوضع هذا المنهاج التعليمي من حاجات البلاد الإسلامية الأولى التي لا يسعها التغافل عنها والتساهل فيها. وهو عمل شاق وواسع يأخذ وقتاً طويلاً وليس عمل فرد من الأفراد أو حفنة من الناس، انما هو عمل تقوم به جماعات ولجان ومجامع علمية…
7- معالم رئيسية في مسيرة الجامعات الإسلامية في العهد الحديث
للدكتور عزالدين إبراهيم
يعنى المؤلف بتقديم نماذج تطبيقية لعدد من الجامعات الإسلامية في مختلف البلدان الإسلامية، وهي تلك الجامعات التي ركزت جهودها على الدراسات الإسلامية، والتي لم تنصرف إلى غيرها. فهي بهذا متميزة بالاختصاص وبالتسمية أيضاً.
ويرى أن هذه الجامعات أصبحت معقد الأمل في القيام بدور ريادي في المجتمعات الإسلامية خاصة من الناحية الفكرية، ذلك أنها مجمع العلماء المتخصصين والمفكرين، وهي تشتغل بإعداد النخبة المتفتحة من شباب المجتمع، ولذلك حق لها وعليها أن تقوم بدور ريادي في المجتمع وخاصة من الناحية الفكرية.
8- نحو منهج إسلامي في التربية والتعليم للدكتور عباس محجوب
الكتاب نتاج سنوات تسع من العمل في مجال التعليم العام في السودان، وسنوات عشر في التعليم الجامعي. وموضوعات الكتاب تنتظمها فكرة واحدة هي معالجة هموم التعليم وصولاً إلى منهج ينطلق من الثوابت الإسلامية، والصبغة الإسلامية، والأهداف والوسائل الإسلامية، وفي سبيل الوصول إلى تعليم أكثر فائدة، وأجدى نفعاً، وأعمق أثراً في أبناء المسلمين الذين يعانون من فقدان الهوية الذاتية والشخصية المميزة، والأثر الفعال في إثراء الحياة وارتقاء الحضارة، نتيجة غياب الفلسفة الإسلامية في مجال التربية والتعليم، ونتيجة استيراد أنظمة التعليم ومناهجه وأهدافه ووسائله من بلاد غير إسلامية، دون صبغها بقيم الأمة المسلمة وشخصيتها وطموحاتها وآمالها في حياة تبنى على منهج الله وتسير على هديه، وتؤسس على تعاليمه، لتحقق في النهاية للإنسان سرّ وجوده على الأرض.
10. الإضافة النوعية للبحث
يسلّط البحث الضوء، ربما لأوّل مرة:
- على شبكة التأسيسات الإسلامية للفعل الحضاري الذي يستهدف إعداد إنسان متعدد الأدوار (مهنياً ومهارياً، إضافة إلى تكوينه الإيماني والأخلاقي)، وفي تكوين مسلمين مبدعين حضارياً في شتى المجالات، ورواد وقادة عالميين متميزين.
- أما الإضافة النوعية الأخرى فتتمثل في المتابعة الشاملة التي لم تنفذها الدراسات الأخرى بهذا القدر من الاستقصاء لعوامل الانكفاء الحضاري ودورها السلبي الذي أصاب قدرات الأمة الفاعلة بالعقم والشلل.
- ثم إن البحث من ناحية ثالثة يصمم خارطة عمل تعليمية -تربوية- تمكن المؤسسات المعنية من المساهمة في إعادة انبعاث الأمة وإعانتها على المشاركة العالمية في المصير البشري. ويؤشر على بعض الخطوات الإجرائية الضرورية للإعانة على تحقيق المطلوب، وعلى رأسها كسر جدار العزلة بين المعرفتين الإنسانية والإسلامية بوضع ستراتيجية عمل للقاء الطرفين، وتخريج طلبة يملكون القدرة على تحكيم خبرتهم الإسلامية في قلب العصر من خلال الإلمام بعلومه ومعارفه.
هذا فضلاً عن التأصيل الإسلامي للمعرفة الإنسانية من خلال تكوين بيئات علمية وتربوية تمكن من تخريج علماء أكفاء ينطلقون في بناء المعارف الإنسانية (السياسة والإدارة والاقتصاد والنفس والاجتماع والقانون والتاريخ والفلسفة والحضارة والآداب والفنون… الخ) من زاوية رؤية إسلامية أصيلة تستمد منطلقاتها -وبالمنهج العلمي الصارم- من كتاب الله وسنة رسوله (ﷺ)، والحلقات المضيئة والفاعلة من خبرات الأجيال السابقة.
- وثمة إضافة نوعية رابعة ينطوي عليها البحث، وذلك بصياغة منهج جديد في دراسة وتدريس حضارة الإسلام في المعاهد والجامعات، يملك القدرة على التعامل الإبداعي مع إشكالات واحتياجات المجتمعات العربية والإسلامية من جهة، وهموم واحتياجات المتعلمين في هذه المجتمعات من جهة أخرى. ولم يسبق لأي بحث أن عالج هذه المسألة أو أشار إليها.
والبحث بمواصفاته هذه، وإذا أحلناه على الرؤية الكلية للمشروع، يقدم:
- نموذجاً تربوياً مفصلاً قابلاً لأن يطبق فعلياً على أرض الواقع.
- ويتعامل بفاعلية مع التحديات.
- ويلتحم في نهاية الأمر، أسوة بالبحوث التي سيقدمها باحثون آخرون، في بناء نظرية رصينة يستهدفها المشروع في مرحلتنا الحالية، كخيار يوجه لكل الأمة، ويجمع فئاتها، وبرؤية شمولية ترتكز على فهم عميق لطبيعة المنطقة وخصوصيتها وثوابتها، وفهم مماثل -في الوقت نفسه -للعصر، وخصائصه، ومتطلباته، وتحدياته المستقبلية.
أولاً:
المقدمة
تعد الدراسة الحضارية واحدة من أكثر فروع المعرفة الإنسانية أهمية لأنها تعكس قدرة الأمم والشعوب على الاستجابة للتحديات، وإعادة بناء الحياة في حلقاتها كافة: المعرفية والإدارية والخدمية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، عن طريق استجاشة طاقاتها المبدعة للتحقق بمفاهيم التحضّر بأعلى وتائرها و (تربية) مواطنيها على أن يكونوا عناصر فاعلة قديرة على العطاء والتجدّد والإبداع.
وكل حضارة تنطوي على نسقها المتميز الذي يجري نسغه في عروقها فيمنحها شخصيتها المستقلة التي تميزها عن سائر الحضارات. وهي بهذا تذكرنا بخلايا الكائنات الحية التي تحمل في جيناتها المواصفات التي تمنحها خصوصياتها الخلقية والخلقية معاً.
ومن هنا يتبين ذلك الارتباط الصميم في الدراسة الحضارية بينها وبين المنهج الذي يتعامل معها، وبينها وبين الأهداف التربوية التي تتوخاها.
والذي يتابع طرائق تدريس هذه المادة في المدارس والمعاهد والجامعات منذ تشكل أولى المؤسسات التعليمية في ديارنا، وحتى اللحظات الراهنة، يرى بوضوح أن ثمة خلل ظاهر يأخذ بخناق هذه الطرائق، فيؤثر تأثيراً سلبياً في إدراك الظاهرة الحضارية، وفي النتاج التربوي الذي يتمخض عنها. ذلك أنه يتعامل معها وفق منهج تفكيكي تّم الوقوف عند مواصفاته في الخطة التفصيلية للبحث، بينما يتطلب الحال منهجاً شمولياً باعتبار أن كل حضارة من الحضارات البشرية تحمل شخصيتها المتميزة، ونسغها المتوحد الذي يجري في عروقها.
وبما أن الفعل الحضاري ليس مسألة فردية، أو قضية جماعة، أو مؤسسة، وانما هو قضية أمة في قدرتها على التحقق، أو في غيبوبتها عن الأداء التاريخي، فلنا أن نتصور كم هي ضرورية مسألة الدعوة إلى تعديل الوقفة الجانحة لمنهج تدريس حضارة الإسلام، وتصميم منهج جديد قدير على إنجاز المهمة بأعلى وتائر الفاعلية والأداء.
وبموازاة هذا، لابد من تصميم منهج جديد في تدريس التاريخ الإسلامي، باعتباره المادة الموازية للحضارة والملتحمة بها في الزمن والمكان، والتي يصعب فك الارتباط بين قطبيها، لاسيما إذا تذكرنا أن مناهج تدريس التاريخ، هي الأخرى، ظلت ولا تزال تعاني من الصيغ التقليدية العقيمة التي مارست دورها السلبي في تخريج أجيال من الطلبة لا يكادون يعرفون شيئاً عن خصائص تاريخهم، بل قد يقودهم الخطأ إلى مقت هذا التاريخ والتنكر له، والمرء -كما هو معروف- عدوّ ما جهل.
مهمة هذا البحث -إذن- تصميم مناهج بديلة للحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي، تتعامل بأناة مع شروط الدفع الحضاري في فعاليتها وانكفائها، وفي قدرتها على الانبعاث مرة أخرى، وما ينطوي عليه ذلك من تأثيرات تربوية بالغة الخطورة في الإعانة، إلى جانب عوامل متشعبة أخرى، على تخريج نخب مبدعة قديرة على المساهمة الفاعلة في صياغة وتفعيل المشروع الحضاري للأمة قبالة التحديات التي تحدق بها من كل مكان.
ومن ثم كان لزاماً على البحث الاّ يقف عند حرفيات المنهج فحسب، وانما أن يمضي لتشكيل فضائه الأكثر اتساعاً، والذي ترتبط حلقاته بعضها ببعض أشد الارتباط، من أجل تقديم تصوّر أكثر تكاملاً والتحاماً للظاهرة الحضارية الإسلامية، وما يتمخض عنه التعامل المبرمج معها من نتاج تربوي مؤكد.
وهكذا كان لابد من تصميم معمار هندسي للمفردات التي سيتم التعامل معها تحت العنوان الرئيسي للبحث.
فهناك تحليل لتأسيسات الفعل الحضاري الإسلامي لتبيّن دور كتاب الله وسنة رسوله (ﷺ) في بناء وصيرورة الحضارة الإسلامية، وهناك -في المقابل- وقفة عند عوامل الانكفاء التي قادت هذا الفعل إلى الشلل وغياب الفاعلية، من أجل وضع اليد على مكمن الداء، وإيجاد الحلول الناجعة لإشكالية التخلّف، وهذا سيقودنا بالضرورة إلى امكانات الانبعاث مرة أخرى، والتي ستجد قبالتها جملة من العوائق، وجملة من الحلول الممكنة، حيث سيتم التوقف عند أكثر العوائق والحلول أهمية وثقلاً… لكي ما يلبث البحث أن يفضي إلى تأكيد ظاهرة الانبعاث باستدعاء شبكة من الشهادات من خارج دائرة الإسلام، تكاد تجمع على الظاهرة، وتكون أكثر وقعاً وتأثيراً لكونها
لا تصدر عن المسلمين أنفسهم، وبالتالي فهي تنطوي على حياديتها وموضوعيتها المؤكدة.
وأخيراً، وفي ضوء الحلقات السابقة، يجيء الدور لتصميم منهج جديد لتدريس مادة حضارة الإسلام في المدارس والمعاهد والجامعات، يلبي المطالب التي أثارتها الاشكالات المشار إليها، وبموازاته منهج جديد آخر لتدريس مادة التاريخ الإسلامي، باعتبار أن التاريخ هو وعاء الفعل الحضاري وإطاره في خارطة الزمن والمكان، وباعتبار الالتحام المؤكد بين التاريخي والحضاري لدى الأمم والشعوب كافة.
وفي المنهجين الجديدين معاً، تتركز الرؤية على البؤرة المنشودة من العمل كله وهو تخريج نخب متميزة تؤمن برسالتها الحضارية ودورها التاريخي، وترى فيها امتداداً طبيعياً لما كان الآباء والأجداد قد صنعوه زمن تفوقهم الحضاري قيادة، وعطاءً، وإبداعاً.
إنها باختصار مهمة تربوية بالغة الخطورة، وقد تغري نتائجها، إذا أتيح لها التحقق على الأرض، بالمضي إلى سائر العلوم الإنسانية الأخرى لدراسة المناهج المعتمدة في توصيلها إلى عقول الطلاب، لتفحص ما إذا كانت تنطوي هي الأخرى على خلل ما يتطلب إعادة صياغتها، وإيجاد البدائل المعمارية الأكثر إحكاماً وتوافقاً مع منظومتها المعرفية، وبالتالي جعلها أكثر قدرة على “التأثير” التربوي الفاعل في تخريج النخب الإيجابية التي تتجاوز قوى الشدّ وعوامل السلب، وتنطلق للإعانة على ترشيد المسيرة، وإعادة صياغة الحياة لأمة “وسط” أريد لها أن تكون شاهدة على البشرية ويكون الرسول (ﷺ) شاهداً عليها.
وحيثما أدرنا المنظور وجدنا أنفسنا ازاء ذلك الارتباط الوثيق بين الفعل الحضاري والنشاط التربوي، فهذا الأخير يستهدف بناء الفرد والجماعة ووضعهما في مركز الفاعلية والعطاء والإبداع، وبالتالي إرفاد الفعل الحضاري بعناصر ديمومته وتجدده وغناه، الأمر الذي يوجب على أي مشروع تربوي أن يولي اهتماماً مؤكداً للفضاء الحضاري الذي سيؤول إليه المشروع.
وقد أولى العديد من الباحثين اهتماماً ملحوظاً بطبيعة الارتباط هذه، الأمر الذي يجعل معالجة الظاهرة الحضارية، بما تنطوي عليه من بعد ثقافي، مسألة ضرورية “ولابدّ لنا من الاعتراف أنه كان من المفروض والمنطقي أن تبدأ الكتابات الفكرية الإسلامية بطرح المسألة التربوية جنباً إلى جنب مع المسألة الثقافية، إن لم تكن المسألة التربوية هي الأسبق. ذلك أن الثقافة المطلوبة في الحقيقة، هي المحصلة النهائية للعملية التربوية والتعليمية، والهدف منها. فالتربية هي الرحم الذي تتخلق فيه الأجنة بكل طاقاتها وقدراتها، بشكل سليم، وهي المحضن والمناخ الذي يوفر الشروط لرعاية القابليات وتنمية كل القدرات والطاقات التي تتوزع وظائف الحياة الاجتماعية، واكتشافها وتوجيهها، وتشكل النسيج الاجتماعي للأمة وفق تخطيط تربوي صحيح”([1]).
والتنمية هي بؤرة الفعل الحضاري، وإذاً فلابد من “الاهتمام بالعلم والتعليم بوصفه مدخلاً ضرورياً للتنمية، ونقطة انطلاق لا مفر منها للتخلص من أزمات ومشكلات العالم الإسلامي كلها، لذلك فلا غرابة أن يعد التعليم الأزمة الأم، وما سواه تبع له، ناهيك عن أن عملية تنمية العالم الإسلامي وما يبذل في سبيل ذلك من جهود، لن تجدي نفعاً إذا لم تعن بأمر التعليم وتنميته قبل غيره من مجالات التنمية الأخرى”([2]).
وللأسف الشديد فان التعليم “لم يأخذ دوره كأداة للتغيير والتطور ومواجهة تحديات الواقع المتخلف البعيد عن الله ومنهجه في الحياة، وإيجاد المسلم المعتز بدينه الواثق بنفسه وبرسالته، والذي يرفض كل أشكال التخلف والجمود والتسلط والعبودية لغير الله تعالى. والأجيال المسلمة لا زالت بعيدة عن تراثها الروحي وثقافتها الإسلامية بل لا تزال بعيدة عن التراث الثقافي العالمي مما جعلها غير قادرة على التفاعل السريع المفيد مع الثقافات الإقليمية والعالمية والتي تؤدي إلى تحويل الأمة المسلمة من أمة سلبية تتلقى الحضارة إلى أمة تقدم الحضارة والخير إلى البشرية”([3]).
وتزداد المسألة خطورة إذا تذكرنا ما تمارسه العولمة من انعكاسات وضغوط على التربية الإسلامية التي “أصبحت مسؤوليتها كبيرة بحجم مواجهة التصدي للعولمة، ولابدّ من إحداث تغيير جذري في وظائفها وأساليبها ومحتواها وأهدافها وطرائق تقديمها للمعرفة، وأساليب التعامل مع الطلبة، وأخيراً أساليب تقويمها”([4]).
واختراقات العولمة لشخصية الأمة الإسلامية وعمقها العقدي والحضاري، لا تعد ولا تحصى، فهناك محاولة تذويب المعتقدات الدينية وتهميشها لأنها تتقاطع مع اهتماماتها المادية… وهناك السعي لتفكيك المجتمعات، وتبني ثقافة كونية عالمية تتضمن نسقاً من القيم والمعايير لفرضها على الشعوب كافة. كما أنها تنقل ولاء الفرد لوطنه وأمته إلى صورة العالم أو المجتمع الدولي الذي تؤكده القنوات الفضائية. هذا إلى سعيها لسيادة معايير الكفاءة المادية والربحية على حساب المعرفة([5]). وما لم تنهض مؤسسات تربوية فاعلة ومبرمجة بإحكام لمجابهة هذه التحديات جميعاً، فان المصير سيكون وخيماً.
الأمة في وضعها الراهن بأمسّ الحاجة إلى مشروع ثقافي تنوء بحملة المؤسسة التربوية التعليمية، ويرى المفكر الجزائري (مالك بن نبي) أن الشرط الأول لتحقيق مشروع كهذا هو الصلة بين الأشخاص أولاً. وها هو ذا القرآن يعطينا فكرة عن قيمة هذه الصلة حين وجه خطابه إلى النبي (ﷺ) قائلاً ) … لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ … ( (الأنفال: 63). فأساس كل ثقافة هو بالضرورة (تركيب) أو (تأليف) لعالم الأشخاص، وهو تأليف يحدث طبقاً لمنهج تربوي يأخذ صورة فلسفية أخلاقية. وإذاً فالأخلاق أو الفلسفة الأخلاقية هي أولى المقومات في الخطة التربوية لأية ثقافة، ويعد العنصر الديني من مكوناتها([6]).
إن تربية هذا شأنها في نظر القرآن والسنة والواقع التاريخي، لابدّ أن تتّسم بسمات أصيلة، يمكن إذا فهمت حق الفهم، وقدرت حق التقدير، أن تضع الأجيال تلو الأجيال على درب الإيمان والعلم، في طريق الهداية والرشاد، وما أحوجنا اليوم إلى مثل هذه التربية فهماً وعملاً، لنكون بحق خلف ذلك السلف، وورثة هذه الحضارة، لنؤدي دورنا على قدر وسعنا([7]).
إن المؤسسة التربوية، أو المدرسة، تعد من أكثر قنوات تشكيل العقل أهمية، فمن خلالها توضع البذور الأساسية لطريقة التفكير، من حيث السطحية أو العمق، وكذا من حيث المنطقية والعملية، أو الذاتية والموضوعية. كما أنه من خلال المدرسة يتم اكتساب المعرفة، والمعلومات، وتكوين الاتجاهات في كثير من قضايا الحياة. يضاف إلى ذلك تكوين نظام قيمي، وصقل مهارات في بعض الجوانب. إن المنهج المدرسي بما يحويه من معارف، ومعلومات، وصور، وأمثلة، وتمارين، يمثل حجراً أساساً في الكيفية التي ينمو بها ويشكل عقل الفرد… احتكاك الطالب بأستاذه وبزملائه، ووجوده في مناخ يعطيه حرية التعبير، والحركة، والتجريب، كلها أمور ذات أهمية بالغة عند الحديث عن البناء العقلي، فقد يحدث بناءً عقلياً سلبياً، أو مغايراً لما نريده، إذا لم نتمكن من خلق مناخ دراسي ملائم([8]). وبذلك نكون قد فرّطنا بالأداة الفاعلة للتغير والبناء الحضاري.
إن مسيرتنا الفكرية هي جوهر مسيرتنا الحضارية، وما لم نعكف بكل طاقاتنا على رصدها، والتعرف إليها، واستدعاء العقول المبدعة لتحليلها وإثرائها ودفعها إلى الأمام، فستظل الأمة الإسلامية مبعثرة الجهد، عاجزة عن إحداث التراكم الفكري المفضي إلى إحداث التغيير المأمول([9]).
في ضوء ذلك كلّه لابد من العودة إلى نصوص التراث الإسلامي الحديث والمعاصر، ليس لكونه مرغوباً لذاته، بقدر ما نتوخى منه الوقوف على القدر الذي ساهم فيه هذا المفكر أو ذاك في فهم الواقع الحضاري الإسلامي، واستيعاب وجهته من خلال الأصول الإسلامية التي صاغت وبلورت الموقف الإسلامي من المسألة الحضارية. وعليه نستطيع من خلال هذه القراءة المتأنية لفكرنا المعاصر، أن نساهم في معرفة طبيعة التكوين الذي انطلق من خلاله فكر أصحاب تلك النصوص، حيث يمكننا هذا الاسهام من مواجهة اشكاليات المسلم الفكرية والحضارية([10]).
جدلية التربية والحضارة، أو بناء الإنسان والجماعة وتمكينها من الفعالية الحضارية… هذا ما سيسعى البحث إلى معالجته، ومن ثم يبدو طبيعياً تداخل التربوي والحضاري في بنية البحث، وتفاعل قطبيهما في محاوره كافة، بدءً من استعراض وتحليل شروط وتأسيسات الفعل الحضاري الإسلامي، وعوامل انكفائه، وامكانات انبعاثه، وسبل مواجهته للعوائق التي تقف في طريقها، وانتهاء بصياغة منهجين جديدين في دراسة وتدريس مادتي الحضارة والتاريخ الإسلامي في المدارس والمعاهد والجامعات، باعتبارهما من أكثر المواد التعليمية أهمية، وقدرة على إعادة بناء الإنسان المسلم، المبدع، والملتزم، والقدير على ممارسة دوره الاجتماعي الفاعل في صناعة الحياة.
ثانياً :
أ ـ تأسيسات الفعل الحضاري الإسلامي
كان التصوّر الذي يسود البيئات العربية -قبل الإسلام- فيما عدا استثناءات الحنفية المحدودة والأديان السماوية المحرّفة، تصوّراً وثنياً جاهلياً لا يملك سويته المعقولة، ولا حتى في حدودها الدنيا، فهي الجاهلية التي تحدث عنها القرآن الكريم، والتي جعلت العرب، على تحضّر بعض بيئاتهم، يعايشون واحداً من أشد عصور التخلّف الفكري في التاريخ، شأنهم في ذلك شأن مساحات واسعة من العالم القديم يومذاك فيما تحدث عنه مؤرخو الحضارات بقدر كبير من التفصيل([11]).
ولقد ترك هذا أثره في بنية التفكير، المتمثل في التبعية والاقتداء بالغير، من أجل معرفة الحقيقة. فما اعتاد عليه الآباء والأجداد، يعتبر أمراً مقدساً لا يمكن التفريط به، ولا يمكن السماح لأي كائن ومن كان، أن يمسّه ويتعرض له: ) … إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ( (الزخرف: 23) ) … أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا … ( (هود: 62)… باختصار يمكن القول أن المنظومة المعرفية والثقافية المتوفرة للإنسان العربي (قبل الإسلام) كانت بحدود البيئة، المجتمع، القبيلة، ندرة المواد، تفشّي الأمية، وسيادة التعبير الشفهي، وافتقاد التدوين. وكل هذه العناصر مجتمعة، أوجدت قواعد ومبادئ التفكير، والمستوى العقلي، والذي لم يكن له ليبدع خارج إطار الشعر، والقصص، والأساطير، والأمثال والحكم، بالإضافة إلى سجايا السلوك العام، المعبّر عن الانتماء، والكرم، والشجاعة([12]).
ولم يكن حال العرب، أو غيرهم من الشعوب، ممن كانوا أفضل حالاً في الحضارة، يسمح بنشوء حضارة متقدمة، أو تطور خلاق، يدفع بهم وبغيرهم في مراقي الحضارة، مثلما حصل بعد مجيء الإسلام ونشر دعوته. بل كان من المستحيل أن يحدث هذا الأمر من غير معجزة حقيقية تجعله ممكناً، وهذا بالضبط ما حصل بحلول الإسلام، فإليه يعود الفضل في التطور الهائل الذي لحق بالعرب والمسلمين من مختلف الشعوب، ليتبوّأوا قلب العالم ومركز صدارته، والتأثير المعرفي شبه المتفرد فيه، والفاعل الأكبر في مجريات أحداثه وحمل لواء تطوره ورقيّه لعدة قرون([13]).
عندما جاء الإسلام -إذاً- قدر، بكتاب الله وسنة رسوله (ﷺ) ومنجزات عصر الرسالة، على مجابهة الجاهلية، ونقل العرب، أو وضعهم -بتعبير أدق- في البداية الصحيحة للتشكل الحضاري، من خلال شبكة الشروط التي مكنتهم من تجاوز حالة التخلف الفكري الذي هو أساس كل تخلّف، والانطلاق، بعد بناء الإنسان الفاعل والجماعة الحركية المبدعة، لصياغة حضارة متميزة، قدّر لها على مدى قرون عديدة، أن تكون واحدة من الحضارات الأكثر فاعلية وتأثيراً في مجرى التاريخ البشري.
لقد نفذ الإسلام نقلات أو تحوّلات ثلاثة شكلت المناخ الملائم للفعل الحضاري، ولذا سنقف عندها بعض الوقت.
النقلة التصوّرية الاعتقادية
وهي -بحق- أكثر النقلات أهمية، لأنها بمثابة القاعدة التي بنيت عليها سائر التحولات.
فانه ما من خطوة في تاريخ البشرية حررت العقل، وكرمته، ووضعته في موقعه الصحيح كهذه الخطوة: تحويل التوجّه الإنساني من التعدّد إلى التوحيد، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن عشق الحجارة والأصنام والتماثيل والأوثان إلى محبة الحق الذي لا تلمسه الأيدي ولا تراه العيون… كسر للحاجز المادي باتجاه الغيب، وتمكين للعقل من التحقّق بقناعات تعلو على الحسّ القريب.
لقد تحدث القرآن عن هذه النقلة فقال انها خروج بالناس ) … مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّوُرِ … ( (البقرة: 257)، التحوّل الكامل من الأسود إلى الأبيض، والانتقال من النقيض إلى النقيض، وقال أيضاً بأن الإسلام جاء لتحرير بني آدم ) … وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ … ( (الأعراف: 157)… ونادى أكثر من مرة بأن الدين الجديد هو (الصراط المستقيم) وما وراءه فليس سوى التيه، والاعوجاج، والضياع، والهوى، والضلال. ولن يقدر عقل مهما أوتي من فطنة على أن يعمل ويبدع ويعطي، وهو يتخبط في التيه ويكّبل بالأغلال.
إن العقيدة الجديدة جاءت لكي تنقل الإنسان إلى السعة والعدل والتوحيد، هنالك حيث يجد العقل نفسه، وقد أعيد تشكيله بهذه القيم، قديرا على الحركة والفعل عبر هذا المدى الواسع الذي منحه إياه الإسلام، غير محكوم عليه بظلم من سلطة فكرية قاهرة ترغمه على قبول ما لا يمكن قبوله باسم الدين، متحققاً بالتقابل الباهر بين الإنسان والله، حيث يملك وحده حق التوجّه، والتعبّد، والمصير.
ولكي ندرك البعد الشاسع لهذه النقلة التصوّرية في مجال العقيدة، فان لنا أن نستحضر في أذهاننا شيئاً من ممارسات العقل العربي في الجاهلية، وطرائق إدراكه للعالم، وصيغ تعامله مع ما تصوّره القوى التي تهيمن عليه، وتسيره، وذلك بالرجوع إلى كتاب (الأصنام) لابن الكلبي، ونقارن ما قصّه علينا ورواه لنا([14])، بالمصاف الذي تبوأه العقل المسلم بعد صياغته بالاعتقاد الجديد.
من ذلك المستنقع الآسن والحفرة الضيقة التي يختنق فيها العقل والروح والوجدان، ومن تلك الخرائب المهجورة التي يعشش فيها التخلّف والسخف والسذاجة، جاء الإسلام لكي يخرج بالإنسان إلى آفاق التوحيد، ونضج التصوّر، ونقاء الاعتقاد، فيحرر عقله وروحه ووجدانه، ويعيد تشكيلها من جديد.
لقد تبنّت هذه العقيدة حشداً من القيم التصوّرية، كالربانية والشمولية والتوازن والثبات والتوحيد والحركية والإيجابية والواقعية، تلتئم وتتداخل وتتكامل لكي تشكل نسقاً عقدياً ما بلغت عشر معشاره أية عقيدة أخرى في العالم، وضعية كانت أم دينية، ولن تبلغه أبداً… وكما أن هذا “النسق” المحكم يمثل تطابقاً باهراً مع معطيات الفطرة البشرية في أصولها النقية الحرّة، فانه يمثل في الوقت نفسه تطابقاً مذهلاً مع معطيات العقل المحضة، وتطلعاته وآفاقه.
إن التصوّر الإسلامي نسيج وحده، وان المغزل الإلهي الذي حاكه بإعجاز يصعب تنفيذه على الإنسان، هو الذي عرف كيف يصوغ العقل الجديد، ويدفعه في الوقت نفسه إلى الحركة والإبداع.
النقلة المعرفية
النقلة (الإسلامية) الأخرى، أو التحوّل الآخر، تحوّل معرفي… عمل في صميم العقل من أجل تشكيله بالصيغة التي تمكنه من التعامل مع الكون والعالم والوجود بالحجم نفسه، والطموح نفسه، الذي جاء الإسلام لكي يمنحهما الإنسان.
منذ الكلمة الأولى في كتاب الله نلتقي بحركة التحوّل المعرفي هذه: ) اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ# خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ # اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ # الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ # عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ … ( (العلق: 5-1).
وعبر المسيرة الطويلة، مسيرة الاثنتين والعشرين سنة، حيث كانت آيات القرآن تتنزل بين الحين والحين، استمر “التأكيد” نفسه لتعميق الاتجاه، وتعزيزه والتمكين للنقلة، وتحويلها إلى واقع يومي معيش.
إن نداءات القرآن المنبثقة من فعل القراءة والتفكير، والتعقل والتفقه والتدبر… إلى آخره . منبثة في نسيج كتاب الله… لم تخفت نبرتها أبداً هناك في العصر المكي، أو هنا في العصر المدني.
وليس عبثاً أن تكون كلمة (اقرأ) هي الكلمة الأولى في كتاب الله… وليس عبثاً أن تتكرر مرتين في آيات ثلاث… وليس عبثاً -كذلك- أن ترد كلمة (علم) ثلاث مرات وأن يشار بالحرف إلى القلم: الأداة التي يتعلم بها الإنسان([15]).
وبعدها، وعبر المدى الزمني لتنزّل القرآن، ينهمر السيل ويتعالى النداء المرة تلو المرة: اقرأ، تفكر، اعقل، تدبّر، تفقه، انظر، تبصّر… إلى آخره… ويجد العقل المسلم نفسه ملزماً، بمنطق الإيمان نفسه، بأن يتحول، لكي يتلاءم مع التوجه (المعرفي) الذي أراده الدين الجديد: ) أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءهُمُ الْأَوَّلِينَ ( (المؤمنون: 68) ) … قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ( (الزمر: 9)، ) … وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ ( (آل عمران: 7).
وسوف نلتقي في الحديث عن (النقلة المنهجية) بحشود أخرى من الآيات القرآنية عن الأفعال المعرفية الأخرى: النظر، السمع، البصر، التعقل، التفكر، التفقه… الخ. بل ان نسيج القرآن الكريم نفسه، ومعطياته المعجزة، من بدئها حتى منتهاها في مجال العقيدة، والتشريع، والسلوك، والتاريخ، والحقائق (العلمية)، تمثل نسقاً من المعطيات المعرفية كانت كفيلة، بمجرد التعامل المخلص الذكي المتبصّر معها، أن تهزّ عقل الإنسان وتفجّر ينابيعه وطاقاته، وأن تنشيء في تركيبه خاصية التطلع المعرفي لكل ما يحيط به من مظاهر ووقائع وأشياء.
لقد كان القرآن الكريم يتعامل مع خامة لم تكن قد حظيت من (المعرفة) الاّ بالقسط اليسير… مع جيل من الناس لم يبعد -بعد- عن تقاليد الجاهلية، وقيمها، وطفولتها الفكرية، لكنه قدر، بقوة الإيمان المعجون بالدعوة الجديدة، على أن يعلمهم فعلاً … وذلك بأن يعيد تشكيل عقولهم لكي تكون قديرة على استيعاب المضامين الجديدة، مدركة للأبعاد الشاسعة التي جاء هذا الدين لكي يتحرك الإنسان صوب آفاقها الرحبة، وما كان ذلك ليتحقق لولا إشعال فتيلة التطلع المعرفي للمسلم، ودفعه إلى البحث والتساؤل والجدل.
لقد انتهى عهد الاستسلام والسكون والرضى بأوساط الأشياء، وجاء عهد القلق والحركة، بحثاً عن الكمال الذي يليق بمعطيات الدين الجديد.
إن الإسلام لا يهتم بالتفاصيل، ولكنه يسعى إلى تكوين “بيئة” عمل وإنجاز تتضمن الشروط والمواصفات التي تمكنها من العطاء، وها هنا، في حقل التوجه المعرفي، تمكن الإسلام من تشكيل هذه البيئة، فبعث أمة من الناس لا يزال عقلها يعمل ويكد ويتوهج حتى أنار الطريق للبشرية يوم كانت تدلج في ليل بهيم.
لقد اقترن ظهور الإسلام بالدعوة إلى التعليم منذ بداية التنزيل، وكانت سيرة الرسول
(ﷺ) هي بذاتها مسيرة التعليم الإسلامي… الذي كان منفتحاً ومستمراً، بمعنى أنه كان للناس جميعاً وليس تعليماً نخبوياً، فلم يكن خاصاً بجنس دون آخر، ولا بفئة دون أخرى. ولم تكن هناك حجب بين المعلم الرسول (ﷺ) والمتعلم، وهم صحابته الذين عاصروه([16]).
إنه مع بروز الدعوة الإسلامية وانتشار حضارتها كانت كلمة الثقافة والعلم قرينة هذه الدعوة، فعمرت العالم بالفكر والمعرفة([17]).
النقلة المنهجية
أما النقلة الثالثة، فلم تكن لتقل عنهما خطراً بحال من الأحوال، وهي ترتبط بشكل ما بالنقلتين السابقتين، وتنبثق عنهما في الوقت نفسه. انها النقلة المنهجية. ونحن نعرف اليوم، كم يؤدي “المنهج” دوراً خطيراً في حركة الإنسان الفكرية والحضارية عموماً، ونعرف أنه دون “منهج” فليس ثمة طريق يوصل إلى الأهداف مهما بذل من جهد وقدّم من عطاء.
والنقلة المنهجية التي أتيح للعقل المسلم أن يتحقق بها، وأن يتشكل وفق مقولاتها ومعطياتها، امتدت باتجاهات ثلاثة: السببية، القانون التاريخي، منهج البحث الحسّي (التجريبي).
فلنقف قليلاً عند كل واحد من هذه الاتجاهات لتلّمس أبعاد المنحة التي قدمها الإسلام للعقل البشري، فأعطاه من الأدوات ما عرف به كيف يحيلها إلى إبداع حضاري موصول.
السببية:
من خلال التمعّن في نسيج كتاب الله نجد كيف منحت آياته البيّنات العقل المسلم رؤية تركيبية للكون والحياة والإنسان والوجود.. تربط، وهي تتأمل وتبحث وتعاين وتتفكر، بين الأسباب والمسببات.. تسعى لأن تضع يدها على الخيط الذي يربط بين الظواهر والأشياء في هذا الحقل أو ذاك، وفي هذه المساحة أو تلك. لقد أراد القرآن الكريم أن يجتاز بالعقل العربي مرحلة النظرة التبسيطية، المسطحة، المفككة، التي تعاين الأشياء والظواهر كما لو كانت منقطعة معزولة، منفصلاً بعضها عن بعض.. وهي خلال ذلك لا تملك القدرة على الجمع، والمقارنة، والقياس، والتقاط عناصر الشبه، وعزل عناصر الاختلاف.. لا تملك امكانية التركيب والاختزال والتركيز للوصول إلى الدلالات النهائية للظاهرة من خلال معاينة ارتباطاتها وعلائقها بالظواهر الأخرى.
ولقد تمكن القرآن الكريم، بطرقه المستمر على العقلية التبسيطية، أن يعيد تشكيلها من جديد بالصيغة التي أرادها لها: عقلية تركيبية، تملك القدرة على الرؤية الاستشرافية التي تطل من فوق على حشود الظواهر بحثاً عن العلائق والارتباطات، ووصولاً إلى الحقيقة المرتجاة.
بل ان إحدى طرائق القرآن المنبثة عبر سوره ومقاطعه من أقصاها إلى أقصاها، هي التأكيد على ضرورة اعتماد هذه الرؤية السببية للظواهر والأشياء من أجل الوصول إلى معجزة الخلق ووحدانية الخالق سبحانه… إذ بدون هذه القدرة على الربط بين الأسباب والمسببات فان العقل المؤمن لن يكون قادراً على التحقق بالقناعات الكافية، ولن يكون بمقدور آيات الله المنبثة في الطبيعة والعالم والوجود أن تحدث فينا هزة الإيمان العميق المتمخض عن اكتشاف الارتباط المحتوم بين معجزة الخلق وبين الخالق سبحانه.
القانونية التاريخية:
ولأول مرة في تاريخ الفكر يكشف الغطاء أمام العقل البشري عن حقيقة منهجية على درجة كبيرة من الخطورة: ان التاريخ البشري لا يتحرك فوضى وعلى غير هدى، وانما تحكمه سنن ونواميس كتلك التي تحكم الكون والعالم والحياة والأشياء… سواء بسواء… وأن الوقائع التاريخية لا تتشكل بالصدفة، وانما من خلال شروط خاصة تمنحها هذه الصفة أو تلك…، وتوجهها صوب هذا المصير أو ذاك.
القانون يحكم التاريخ… تلك هي المقولة التي لم يكن قد كشف النقاب عنها قبل نزول القرآن … ان كتاب الله يقدم أصول منهج متكامل في التعامل مع التاريخ البشري، والانتقال بهذا التعامل من مرحلة العرض والتجميع فحسب، إلى محاولة استخلاص القوانين التي تحكم الظواهر الاجتماعية-التاريخية، كما فعل ابن خلدون -فيما بعد على سبيل المثال- فأعطى بذلك الإشارة لغيره من فلاسفة التاريخ الذين ما تلقوا إشارته تلك وبنوا عليها إلا بعد انقضاء خمسة قرون، وهذا يتمثل بالتأكيد المستمر في القرآن على قصص الأنبياء (عليهم السلام)، وتواريخ الجماعات والأمم السابقة، وعلى وجود “سنن” و “نواميس” تخضع لها الحركة التاريخية في سيرها وتطورها، وانتقالها من حال إلى حال. ولقد وقع كثير من الباحثين وفلاسفة التاريخ المعاصرين في خطأ القول بأن (ابن خلدون) هو أول من مارس هذا المنهج في مقدمته، وأنه لا توجد قبله أية محاولة في هذا السبيل. ولنقرأ على سبيل المثال:
) قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ # هَـذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ # وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ # إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ # وَلِيُمَحِّصَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ( (آل عمران: 141-137)، ) … فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً ( (فاطر: 43)([18]).
منهج البحث الحسّي–التجريبي:
ولكن، لا الكشف عن السببية ولا القانونية التاريخية، يعدل الكسب المعرفي القيّم الذي أحرزه العقل المسلم خصوصاً، والعقل البشري عموماً، والذي تمثل بمنهج البحث الحسّي-التجريبي الذي كشف النقاب عنه، ونظمه، وأكده، كتاب الله.
لقد دعا القرآن الناس إلى التبصّر بحقيقة وجودهم وارتباطاتهم الكونية عن طريق
“النظر الحسّي” إلى ما حولهم، ابتداءً من مواقع أقدامهم وانتهاء بآفاق النفس والكون، وأعطى للحواس مسؤوليتها الكبيرة عن كل خطوة يخطوها الإنسان المسلم في مجال البحث والنظر والتأمل والمعرفة والتجريب… قال له: ) وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ( (الإسراء: 36)، وناداه أن يمعن النظر إلى ما حوله… إلى طعامه
) فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ # أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبّاً # ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقّاً # فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبّاً # وَعِنَباً وَقَضْباً # وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً # وَحَدَائِقَ غُلْباً # وَفَاكِهَةً وَأَبّاً # ( (عبس: 31-24) … إلى خلقه: ) فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ( (الطارق: 5)… إلى الملكوت: ) أَوَ لَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ؟ ( (الأعراف: 185)… إلى التاريخ وحركة الإنسان في الأرض:
) أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً … ( (غافر: 21)… إلى خلائق الله… ) أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ؟ ( (الغاشية:17) … إلى آياته المنبثة في كل مكان: ) … انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ … ( (المائدة:75)… إلى النواميس الاجتماعية: ) انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ … ( (الإسراء:21)… إلى الطبيعة وهي تنبعث من قلب الفناء برحمة من الله ومقدرة: ) فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا … ( (الروم:50)… إلى الأثمار وهي تتدلى من غصون الأشجار: ) … انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ … ( (الأنعام:99)… إلى الحياة الأولى كيف بدأت وكيف نمت وارتقت…
) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ … ( (العنكبوت: 20)… ودعاه أن يحرك سمعه باتجاه الأصوات لكي يعرف ويميّز، فيأخذ أو يرفض، فمن الاختيار البصير ينبعث الإيمان:
) وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ( (الأنفال:21).
وعلينا الاّ نتصور أن الإسلام ما جاء الا لكي يؤكد في موقفه من العمل الحضاري على الجوانب الأخلاقية والروحية فحسب… إننا بازاء آيات عديدة تضع الجماعة البشرية المؤمنة في قلب العالم والطبيعة، وتدفعها إلى أن تبذل جهدها من أجل التنقيب عن السنن والنواميس في أعماق التربة، وفي صميم العلاقات المادية بين الجزيئات والذرات. إننا بإزاء حركة حضارية شاملة تربط بين مسألة الإيمان ومسألة الكشف والإبداع، بين التلقي عن الله والتوغل قدماً في مسالك الطبيعة ومنحنياتها وغوامضها… بين تحقيق مستوى روحي عالٍ للإنسان على الأرض وبين تسخير طاقات العالم لتحقيق الدرجة نفسها من التقدم على المستوى المادي… ولم يفصل الإسلام -يوماً- بين هذا وذاك.
وبموازاة التحولات الثلاثة آنفة الذكر شهد عصر الرسالة والتنزيل القرآني تأكيدات متزايدة على جملة من القيم ذات الارتباط الوثيق بالفعل الحضاري، أعانت بدورها على تعزيز المناخ الملائم لهذا الفعل وتمكينه من الاستمرار.
النزوع إلى الأمام:
تضمن القرآن الكريم دعوة واضحة مؤكدة إلى أن ننظر إلى الأمام، وألاّ نلتفت للوراء. ان هذا الالتفات له ضرورات محددة في حالة التلقّي عن الآباء والأجداد معطيات تشريعية أو تراثاً معرفياً، قد تستهدي به الأمة لتبيّن مواقع الخطأ والصواب، أما أن يكون عملاً لا وعيياً يقوم على التقليد الأعمى فسيجعلنا في حالة تعارض مع ما يريده القرآن الذي نعى على المشركين والمتخلفين أنهم كانوا يتشبثون بما فعله الآباء والأجداد، بغض النظر عن مدى سلامة هذا الفعل ومنطقيته: )قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا … ( (يونس:78) ) … إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ( (الزخرف:23).
وهي هداية معكوسة يرفضها الإسلام أشد الرفض.
إن توينبي، المؤرخ البريطاني المعروف، يشير إلى نمطين من التعامل مع معطيات الآباء: نمط التقليد الأعمى في مرحلة السقوط الحضاري، ونمط الاقتداء بالنخب المبدعة وخبراتها الحيوية في مرحلة النهوض الحضاري، والقرآن الكريم يرفض الأولى لأنها تقود إلى التخلّف والسكون.
إن القرآن الكريم يضعنا -في مساحات واسعة منه- في قلب التاريخ بحثاً عن المغزى… عن صيغ العمل في الحاضر والمستقبل: )لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ( (يوسف: 111).
ولكنه في الوقت نفسه يحررنا من التاريخ لكي نتمحض للحاضر ونتحرك صوب المستقبل دون أن تعيقنا وتثقل كواهلنا أعمال الأجيال الماضية: ) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( (البقرة:141, 134).
التحذير من هدر الطاقة:
طالما أكدت المعطيات القرآنية والنبوية على رفضها لهدر الطاقة التي تعمل أحياناً في غير مجالاتها المرسومة. إن الرسول (ﷺ) يقول: (تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله)([19])، إنه -ها هنا- يدعونا للتفكير في الخلق الذي يقود إلى العلم والتكنولوجيا، بموازاة تأكيد ابداعية الله سبحانه في العالم، والإيمان بوحدانيته. ويحذرنا من التفكير في الذات الإلهية التي تعلو على الأفهام، وتستعصي على القدرات البشرية، وهو التفكير الذي يقود إلى الماورائيات والتعامل التجريدي مع “واجب الوجود” و “متناهي الأول” والميتافيزيقا، وما يتمخض عن هذا كله من هدر للطاقة العقلية.
إنه يريدنا أن نتعامل مع الكتلة الكونية، وأن نكشف عن قوانينها لتنمية الحياة التي سخرت امكاناتها للإنسان من أجل التحقق باستخلافه العمراني في العالم، بدلاً من هدر الطاقة فيما هو خارج عن حدودها وإمكاناتها وضرورات صيرورتها الحضارية في الأرض.
مبدأ الاستخلاف:
لقد استخلف الله سبحانه الإنسان في هذا العالم وأناط به مهمة تطويره وإعماره، وتذليل صعابه، والاستجابة لتحدياته، من أجل تسوية أرضيته كي تكون أكثر ملائمة لحياة مطمئنة تعلو على الضرورات، بعد أن تتحرر منها، وتكون أكثر قدرة على التوجّه إلى السماء، إلى خالقها جلّ وعلى، دون أن يحني ظهورها ثقل الجاذبية وضرورات المادة الصلبة.
إن مبدأ الاستخلاف يتكرر أكثر من مرة في القرآن الكريم: ) هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ … ( (فاطر:39) ) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ … ( (الأنعام:165) ) … وَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ …( (الأعراف:69) ) … قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ( (الأعراف:129) ) … وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ … ( (النمل:62).
ومسألة الاستخلاف تبدو في الآيات المذكورة مرتبطة بالخيط الطويل العادل من طرفيه: العمل والإبداع ومجانبة الإفساد في الأرض من جهة، وتلقّي القيم والتعاليم والشرائع عن الله سبحانه، والالتزام الجاد بها خلال ممارسة الجهد البشري في العالم من جهة أخرى. والعلاقة بين هذين الطرفين علاقة أساسية متبادلة، بحيث أن افتقاد أي منهما سيؤول إلى الخراب والضياع في الدنيا والآخرة، ويقود إلى عملية استبدال للجماعة البشرية بغيرها ممن تقدر على الإمساك بالخيط من طرفيه: العمل والجهد والإبداع، والتلقي الدائم عن الله لضبط وتوجيه هذا العمل والجهد في مسالكه الصحيحة التي تجعل الإنسان يقف دائماً بمواجهة خالقه، خليفة مفوضاً لأعمار العالم: ) … قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا … ( (هود:61).
ولن يكون بمقدور المسلم تنفيذ مطالب مهمته الاستخلافية، ومنحها الضمانات الكافية، وإعانتها على تحقيق أهدافها، ما لم يضع خطواته على البداية الصحيحة “للتحضّر” فيكشف عن سنن العالم والطبيعة ونواميس الكون القريب، من أجل الإفادة من طاقاتها المذخورة، وتحقيق قدر أكبر من الوفاق بين الإنسان ومحيطه، وبدون هذا فان مبدأ الاستخلاف لن يكون بأكثر من نظرية أو عقيدة تسبح في الفراغ.
مبدأ التسخير:
وهو يرتبط بسابقه أشد الارتباط، ويعدّ بدوره ملمحاً أساسياً من ملامح التصوّر الإسلامي للكون والعالم والحياة والإنسان، ويتطلب اعتماد مناهج العلم وآلياته لتحويله إلى أرض الواقع، والتحقق بعطائه السخي.
إن العالم والطبيعة، وفق المنظور الإسلامي، قد سخّرا للإنسان تسخيراً، وان الله سبحانه قد حدّد أبعادهما وقوانينهما ونظمهما وأحجامهما بما يتلاءم والمهمة الأساسية لخلافة الإنسان في العالم، وقدرته على التعامل معه تعاملاً إيجابياً فاعلاً.
وهناك آيات ومقاطع قرآنية عديدة تحدّثنا عن هذا التسخير، وتمنحنا التصور الإيجابي لدور الإنسان الحضاري، ينأى عن التصوّرات السلبية للعديد من الفلسفات والمذاهب الوضعية التي جرّدت الإنسان من كثير من قدراته الفاعلة وحريته في حواره مع كتلة العالم، وتطرّف بعضها فأخضعه لمشيئة هذه الكتلة وإرادة قوانينها الداينامية الخاصة التي تجيء بمثابة أمر لا رادّ له، وليس بمقدور الإنسان الاّ أن يخضع لهذا الذي تأمر به.
إننا نشهد في كتاب الله صيغة أخرى للعلاقة بين الإنسان والعالم تختلف في أساسها… صيغة السيّد الفاعل الذي سخّرت له وأخضعت مسبقاً كتلة العالم لتلبية متطلبات خلافته في الأرض وإعماره للعالم على عين الله سبحانه: ) وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ … ( (النحل:12) ) وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً … ( (النحل:14) ) وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ # وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ( (إبراهيم:33-32) ) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاء حَيْثُ أَصَابَ (
(ص:36) ) أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ … ( (لقمان:20) .
إن (التسخير) هو الموقف الوسطي الفعال الذي يقدمه القرآن الكريم بصدد التعامل مع العالم بدلاً من الخضوع والتعبّد، أو الغزو والانشقاق اللذين هيمنا على المذاهب الأخرى.
العمل…والإبداع:
نقرأ في كتاب الله هذه الدعوة الشاملة للعمل: ) وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ
عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (
(التوبة:105).
ونستمع إلى الرسول (ﷺ) وهو ينادينا: (إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع الاّ تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر)([20])، فنعرف جيداً كيف أن الدور الحضاري للإنسان المسلم يقوم على العمل والإبداع المتواصلين، منذ لحظة الوعي الأولى وحتى ساعة الحساب، ونعلم تماماً كيف أن الحياة الإسلامية انما هي فعل إبداعي مستمر.
ويبلغ من تأكيد القرآن على العمل والجهد البشري لإعمار العالم، على عين الله وتوجيهه، أن ترد اللفظة بتصريفاتها المختلفة فيما يزيد على الثلاثمائة والخمسين موضعاً، وهي كلها تشير -سلباً وإيجاباً- إلى أن المحور الأساسي لوجود الإنسان -فرداً وجماعة- على الأرض هو العمل الذي يتخذ مقياساً عادلاً لتحديد المصير في الدنيا والآخرة، وهو “موقف” ينسجم تماماً مع فكرتي “الاستخلاف” و “الاستعمار الأرضي”.
إن القرآن الكريم يحدثنا أن مسألة خلق الموت والحياة أساساً انما جاءت لابتلاء
بني آدم أيّهم أحسن عملاً: ) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ( (الملك: 2) كما يحدثنا في سورة العصر أن موقف الإنسان في العالم سيؤول
إلى الخسران بمجرد افتقاد شرطيه الأساسيين: “الإيمان والعمل الصالح”، ويصدر أمره الحاسم إلى الأمة المسلمة أن تلتزم دورها الإيجابي الفعال في قلب العالم: ) وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( (آل عمران: 104). وفي مكان آخر يصف هذه الأمة بأنها ) … خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ … ( (آل عمران: 110) لكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله.
إن الإيمان الذي يقوم عليه بنيان الدين يجيء دائماً بمثابة “معامل حضاري” يمتد أفقياً لكي يصب إرادة الجماعة المؤمنة على معطيات الزمن والتراب، ويوجهها في مسالكها الصحيحة، ويجعلها تنسجم في علاقاتها وارتباطاتها مع حركة الكون والطبيعة ونواميسها، فيزيدها عطاءً وقوة وإيجابية وتناسقاً. كما يمتد عمودياً في أعماق الإنسان ليبعث فيه الإحساس الدائم بالمسؤولية، ويقظة الضمير، ويدفعه إلى سباق زمني موصول لاستغلال الفرصة التي أتيحت له كي يفجر طاقاته، ويعبر عن قدراته التي منحه الله إياها على طريق “القيم” التي يؤمن بها و “الأهداف” التي يسعى لبلوغها، فيما يعتبر جميعاً -في نظر الإسلام- عبادة شاملة يتقرب بها الإنسان إلى الله، وتجيء مصداقاً للآية: ) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ( (الذاريات: 56).
ويتحدث القرآن الكريم عن هذا السباق الحضاري عندما يصف المؤمنين بأنهم (يسارعون في الخيرات) وأنهم (لها سابقون)، وفي كلا التعبيرين نلمس بوضوح فكرة “الزمن” ومحاولة اعتماده لتحقيق أكبر قدر ممكن من المعطيات، ما تلبث أن ترتقي بمقاييس الكم والنوع، بمجرد أن يتجاوز المسلم مرحلة “الإيمان” إلى المراحل الأعلى التي يحدثنا القرآن عنها في أماكن عديدة: “التقوى” و “الإحسان”. وهكذا تجيء التجربة الإيمانية لا لكي تمنح الحضارة وحدتها وتفردها وشخصيتها وتماسكها، وتحميها من التفكك والتبعثر والانهيار فحسب، وانما لكي ترفدها بهذين البعدين الأساسيين اللذين يؤول أولهما إلى تحقيق انسجامها مع نواميس الكون والطبيعة: ) أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ( (آل عمران: 83) ) وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ( (آل عمران: 85).
ويعطيها ثانيهما قدرات إبداعية أكثر وأعمق، تتفجر على أيدي أناس يشعرون بمسؤوليتهم، ويعانون يقظة ضمائرهم، ويسابقون الزمن في عطائهم، لأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر و: ) … لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً … ( (القصص: 83).
مجابهة التخريب والإفساد:
وفي مقابل هذا يندّد القرآن الكريم بكل عمل أو نشاط خاطئ من شأنه أن يؤول إلى الفساد في الأرض، وإلى هدم وتدمير المكتسبات التي يصنعها العمل الصالح بالصبر والدأب والمثابرة، وهو من موقفه هذا يسعى إلى حماية منجزات الإنسان الحضارية، ووقف كل ما من شأنه أن يعوق مسيرتها ونموّها، وملاحقة أية محاولة لإنزال الدمار بها من الداخل تحت أي شعار كانت.
وهذه الحماية الحضارية لا تنصبّ على الجوانب المادية “المدنية” من الإنجاز البشري فقط، بل تتجه إلى ما هو أكثر أهمية، وما يعد أساساً للإنجاز المادي نفسه، تلك هي المعطيات الفكرية والأخلاقية والروحية و “الثقافية” بمفهومها الشامل، من أجل الصمود في المواقع التي بلغها الإنسان وهو يواصل طريقه لإعمار العالم، عبر سلسة طويلة من كفاح مبعوثي الله إلى بني آدم.
إن الإصلاح والإعمار المنوطين بالاستخلاف مسائل تتداخل فيها كل الفاعليات الحضارية، مادية وأخلاقية وروحية، وإن أي ضرر أو إفساد يلحق بأحدها ينعكس -بشكل أو آخر- على الجوانب الأخرى، وهذا واضح بيّن في أكثر من آية: ) وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا … ( (الأعراف: 56) ) … وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ( (الأعراف: 142) ) ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ( (الروم: 41)
) وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ # الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (
(الشعراء: 152-151)([21]).
والقرآن الكريم لا يكتفي بتقديم هذه الأمور ذات الطابع السلبي عن الإفساد الروحي والمادي، وعما يؤول إليه من دمار لحضارة الإنسان، ولرقيه وسعادته وتقدمه، ومن عرقلة لدوره في العالم، كخليفة مستعمر فيه، ولكنه يطلب من الجماعة المؤمنة أن “تتحرك” لوقفه بأسرع ما تستطيع، وبأقصى ما تطيق، لئلا يتحول “الفساد” إلى فتنة عمياء لا ترحم أحداً ولا تبقي، وهي تدوّم فوق رؤوس الجماعة كلها، ظالماً أو مظلوماً: ) وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( (الأنفال: 25) ) فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ # وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ( (هود: 117-116).
إن الرؤية الإسلامية ترفض، في موقفها من الفعل الحضاري، أشد ما ترفض، صيغ التجزئة والفصل وإقامة الجدران بين مساحات التجربة البشرية، وترى فيها وحدة حيوية تسري فيها روح واحدة وتغذيها دماء واحدة، وان تجزئتها وعزل بعض جوانبها، خلال العمل، عن بعضها الآخر، ليس خطأ فحسب، لكنه مسألة تكاد تكون مستحيلة، إذا أردنا مسبقاً-أن نصل إلى نتائج صحيحة.
التوازن بين الثنائيات وتوحّدها:
هذه واحدة من أكثر المسائل أهمية في التصوّر الإسلامي للحضارة ولشروط فعاليتها.
فلقد أكد الإسلام موقفه من الفعل الحضاري من خلال رؤية متوازنة تضمّ جناحيها على كل ما هو روحي أخلاقي ومادي جسدي في الوقت نفسه. ونجد أنفسنا، ونحن نطالع كتاب الله أو نقرأ سنة رسوله (ﷺ) بإزاء تأكيدات عديدة، آيات وأحاديث، تضع الجماعة البشرية المؤمنة في قلب العالم والطبيعة، ملتحمة بفيزيائها وتدفعها إلى أن تبذل جهدها من أجل التنقيب عن السنن والنواميس في أعماق التربة، وفي صميم العلاقات المادية بين الجزيئات والذرات… إننا بإزاء حركة حضارية شاملة تربط، وهي تطلب من الإنسان أن ينظر في السماوات والأرض، بين مسألة الإيمان ومسألة الإبداع، بين التلقي عن الله سبحانه وبين التوغل قدماً في مسالك الطبيعة ومنحنياتها وغوامضها، بين تحقيق مستوى روحي عالٍ للإنسان على الأرض، وبين تسخير قوانين الكيمياء والفيزياء والرياضيات لتحقيق الدرجة نفسها من التقدم والعلو الحضاري على المستوى المادي “المدني”. ولم يفصل الإسلام بين هذا وذاك. إنه يقف دائماً موقفاً شمولياً مترابطاً، ويرفض التقطيع والتجزيء في تقييم الموقف “الحيوي” أو الدعوة إليه، ولقد انعكس هذا “التوحّد” بين قيم الروح والمادة بوضوح كامل عبر مسيرة الحضارة الإسلامية التي اجتازت القرون الطوال وهي تحتفظ بتوازنها المبدع بين الطرفين، وأنجزت وابتكرت وكشفت ونفذت الكثير من المعطيات الحضارية التي لم تهمل جانباً من الجوانب المرتبطة جميعاً، ارتباطاً وثيقاً، بخلافة الإنسان على الأرض ودوره الحضاري في العالم، وما كان لها الاّ أن تكون كذلك وهي تعمل في ظلال مناخ حضاري متوازن، نتلّمسه بوضوح من خلال جملة غنية من الآيات هذه بعض نماذجها: ) أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ ؟ … ( (الأعراف: 185) ) فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ # أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبّاً # ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقّا ً# فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبّاً # وَعِنَباً وَقَضْباً # وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً # وَحَدَائِقَ غُلْباً # وَفَاكِهَةً وَأَبّاً( (عبس: 31-24) ) فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ # خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ# يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ( (الطارق: 7-5) ) أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ
كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ # وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ # تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ # وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكاً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ # وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ( (ق: 10-6) ) … انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ … ( (الأنعام: 99) ) … وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْماً … (
(البقرة: 259) ) … قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ … (
(العنكبوت: 20)([22]).
إن القرآن الكريم -من خلال هذه الآيات، وغيرها كثير- يريد أن يضعنا في قلب الطبيعة على مستوى الكون والعالم، وأن يختار لنا موقعاً “تجريبياً” يعتمد النظر والتمعن والفحص والاختبار، من أجل الكشف والابتكار والإبداع، ومن أجل الاّ نفقد توازننا الحضاري، فنجنح باتجاه الروح أو الأخلاق ونهمل التكييف والتطور الماديين الملازمين لأية حضارة متوازنة تريد أن تتحقق بالشرط الأساسي للوجود الإنساني على الأرض، وهو عبادة الله والتوجه إليه أخذاً وعطاء.
إنه التوازن الذي يغطي سائر المساحات في النسيج الحضاري، إنه بأطرافه المتقابلة وثنائياته المتوافقة، بمثابة السدي واللحمة في النسيج… هذا التوازن الذي يتصادى هنا وهناك، في التصوّر والتطبيق على السواء… انه في صميم فكر الإسلام وفي قلب صيرورته الحضارية.
إن القرآن الكريم يقولها بوضوح: ) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً … ( (البقرة: 143). والوسطية هنا ليست موقعاً جغرافياً، ولكنها موقف عقدي، وستراتيجية عمل، ورؤية نافذة لموقع الإنسان المؤمن في الكون والعالم. إنها القدرة الدائمة على التحقق بالتوازن، وعدم الجنوح صوب اليمين أو الشمال، ومن خلال هذه القدرة يتحقق مفهوم الشهادة على الناس، لأنها تطل عليهم من موقع الاشراف المتوازن الذي لا يميل ولا يجور.
وسطية هذه الأمة ليست هي الوسط بين النقيضين -كما في المفهوم الإغريقي- وانما هي احتواء النقيضين، احتواء يزيل التناقض بينهما، أو هي جمع النقيضين أو المتوهم أنهما كذلك، فهي نقطة مجمع البحرين، وملتقى العذب الفرات بالملح الأجاج دون أن يبغي أحدهما على الآخر، فهي وسطية تنفي الثنائيات ولا تسمح بظهورها، فلا تعرف الثنائيات المتناقضة من الأفكار والقيم، فلا تناقض بين الدنيا والآخرة، ولا بين الماضي والحاضر، ولا بين العقل والنقل، ولا بين الظاهر والباطن، لأن المنظومة المعرفية الإسلامية في جوهرها، هي احتواء لكل ذلك دون طغيان لأحدهما على الآخر([23]).
لقد تحقق في مراحل عديدة من تاريخ الإسلام، والتقائه بالحضارات الأخرى، ونشأة دول مسلمة قوية تعددية -بالمفهوم الديني والعرقي والثقافي- متسامحة، متقدمة، ذات إيمان عميق بجوهر الشريعة، وكان سرّ عظمتها دائماً في قدرتها على التوفيق بين الروح والمادة، بين الوحي والعقل، بين الغيب والمحسوس، وبين الغايات والوسائل([24]).
القيمة القصوى هي لطاقة الإنسان… طاقتنا هي المحور في هذا الوجود، لأنها متجددة متنامية قابلة للاستمرار من خلال التوالد. هذا التصوّر بعينه هو الذي يجعل قيمة، كل القيمة للإنسانية ويوحدها، ويبرر بالتالي معاملة الفرد كذات، والجماعة كذات، مما يبرر تحقيق التوازن بينها كمطلب ضروري لتجميعها وتوافقها في المسيرة. أفراد بني الإنسان في هذا الاعتبار طاقات لا محدودة، لكونها طاقات متنامية ومسخرة (بكسر الخاء) للطاقات الأخرى التي تشاركها الوجود([25]).
لقد أكد (البرت شفيتسر) على حقيقتين هما: إن طابع الحضارة أخلاقي في أساسه، وأن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين الحضارة وبين نظريتنا في الكون. ثم تساءل: هل من الممكن أبدا إيجاد أساس ثابت حقيقي في الفكر لنظرية في الكون تكون في الوقت نفسه أخلاقية ومؤكدة للعالم والحياة([26])؟
إن الحضارة الإسلامية هي الحضارة الوحيدة التي قدرت، انطلاقاً من رؤيتها لمسألة التوازن بين الثنائيات، على أن تجمع في كل متناسق واحد: الوحي والوجود، والإيمان والعقل، والظاهر والباطن، والحضور والغياب، والمادة والروح، والقدر والاختيار، والضرورة والجمال، والطبيعة وما وراءها، والتراب والحركة، والمنفعة والقيمة، والفردية والجماعية، والعدل والحرية، واليقين والتجريب، والوحدة والتنوع، والإشباع والتزهد، والمتعة والانضباط، والثبات والتطور، والدنيا والآخرة، والأرض والسماء، والفناء والخلود.
ولقد كان لهذا التوحّد مردوده التربوي المؤكد في تشكيل الفرد والجماعة ودفعهما لتقديم أقصى ما يمكن للمسيرة الحضارية.
النزعة التحريرية:
لقد كان الإسلام، منذ اللحظة الأولى، عملاً تحريرياً، وعلى المستويات كافة. وقد رأينا ونحن نتحدث عن النقلة التصورية، الاعتقادية التي نفذها هذا الدين، كيف أنه حرّر الإنسان من الضلالات والأوهام والطواغيت والأرباب، وفي نقلته المعرفية مارس تحريره من الخوف والجهل والأمية. أما نقلته المنهجية بشعبها الثلاث، فكانت باتجاه تحرير الإنسان المسلم من الخضوع للفوضى، والانحناء للصدفة العمياء، وتبصيره بقوانين العمل والحركة التي يسير الكون والعالم والتاريخ بموجبها.
ونريد هنا أن نتوغل أكثر في هذه الميزة التحريرية التي تصبغ حضارة الإسلام وتتشابك مع نسيجها، فنضع أيدينا على دعوة ملحة لتحرير رغبات الإنسان وأشواقه الجسدية والحسّية والروحية، وفتح الطريق أمام دوافعه وحاجاته ومنازعه. وهذا التوجه يمثل امتداداً ولا ريب لرؤية الإسلام التوازنية الأصيلة التي المحنا بخطوطها العريضة.
إن إحدى الآيات القرآنية تتحدث بصراحة عن “الزينة” آمرة بني آدم أن يمارسوها، وأين؟ عند كل مسجد حيث يؤدي الإنسان غاية تجربته في التجرد والانسلاخ عن زخرف الحياة الدنيا: ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) تعقب ذلك دعوة صريحة -أيضاً- إلى الأكل والشرب، شرط الاّ يبلغ ذلك حدّ الإسراف ) يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ( (الأعراف: 31). ثم ما تلبث الآية التي تليها أن تتساءل بصيغة استنكارية واضحة، ) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ( (الأعراف: 32).
إن المحرم والمرفوض في الإسلام هو الفاحشة، أياً كان مصدرها، الجسد أم الروح، وليس ثمة رفض أو تحقير أو تحريم موجّه -ابتداء- إلى الجسد بما أنه جسد، وإلى غرائزه وحاجاته بما أنها غرائز وحاجات تقف في طريق الروح. اننا نقرأ في الآية التي تلي ذلك -وهذا الارتباط بين الآيات الثلاث يحمل مغزاه الواضح- ) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ( (الأعراف: 33).
وما أكثر الآيات التي تستنكر على بعض أتباع الديانات المنحرفة تحريمهم الكثير من
الطيبات التي أحلها الله وتدعو الإنسان إلى التمتع بها دون إفراط أو تفريط، وإلاّ لم كان خلق الله سبحانه لها وتنويعها في الأرض؟: ) قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللّهَ حَرَّمَ هَـذَا … ( (الأنعام: 150) ) قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ … ( (يونس: 59) ) … لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ … (
(الأنعام: 148)([27]).
إن آيات الله تضع التحريم الاعتباطي جنباً إلى جنب مع الشرك بالله، وتنعى على أولئك الذين يمارسون هذا التحريف بشأن الحقائق الكونية وبحق أنفسهم على السواء… ان كبت الغرائز هو تزوير للموقف الإنساني في الأرض، والشرك بالله هو أخطر تزوير، ومن ثم كانت الممارسة البشرية التي تعتمد التزوير مرفوضة في القرآن مهما صغر حجمها أو كبر.
إن إحدى كبريات البداهة الدينية التي نتعلمها من القرآن الكريم أن الحلال هو القاعدة العريضة في ميادين الإشباع الغريزي جميعاً: طعاماً وشراباً وجنساً ومسكناً وملبساً، وان التحريم مسألة “استثنائية” محدودة المساحة، حتى ان القرآن ليعتبر توسيعها بشكل اعتباطي كفراً وافتراءً على الله:
) … وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَاء عَلَى اللّهِ … ( (الأنعام: 140) ) وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ … ( (النحل: 116) ويحذر المؤمنين من هذا السلوك المنحرف المعارض لطبيعة التركيب البشري الذي صاغه الله: ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ
طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ … ( (المائدة: 87)، ويبين لهم ان إحدى مهام الأنبياء الأساسية، هو أن يجيئوا لكي يعيدوا الأمور إلى نصابها ويقفوا بمواجهة التزوير ) … وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ … ( (آل عمران: 50) ) … وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ … ( (الأعراف: 157).
الآية التالية ) … كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً … ( (البقرة: 168) تقودنا إلى مسألة طالما غفل عنها الكثيرون: ان الله سبحانه قد “سخر” لنا الأرض بما ينسجم وتركيبنا الآدمي من أجل أن نواصل مسيرتنا لإعمار العالم وعبادة الله وحده، وانه لمن التناقض الذي لا مبّرر له، هو أن يركب الإنسان من قبل خالقه تركيباً معيناً، وان تسخّر الأرض -بإرادة الله- لتلبية متطلبات هذا التركيب، ثم تجيء الأديان -من عند الله أيضاً- لكي تنصب الحواجز وتضع الأسلاك الشائكة بين متطلبات التركيب الآدمي وبين نعم الأرض ومنافعها المسخرة!
إن هذا التناقض انما يجيء على أيدي طبقات رجال الدين، التي يقوم دورها على التزييف، ووضع الحواجز، ونصب العراقيل في دروب الاتباع من أجل أن تضطرهم للجوء إليها وطلب معونتها، قبل السماح لهم بالذهاب إلى الله سبحانه… وهنالك يبدأ الاستغلال والابتزاز والأكل بآيات الله ثمناً قليلاً. وقد قطع الإسلام الطريق على بروز طبقات محترفة كهذه.
في سياق آخر وتعزيزاً لمفاهيم الحرية التي أكد عليها هذا الدين، فان المتتبع للحوارات التي أجراها النبي (ﷺ) مع مختلف الأطراف، يجد أنه حاول في أكثر من مناسبة توفير المناخ الطبيعي للأطراف الذين أدار عملية الحوار معهم، من خلال تأكيده على جانب البشرية قيه. فهو بشر مثلهم لا يملك أية قوة غير عادية في تكوينه الذاتي، فلا يستطيع تنفيذ المعجزات التي يقترحونها عليه، ولا يعلم الغيب، وانما هو إنسان يتلقى الوحي من ربه باعتباره رسول رب العالمين، ومهمته في ذلك هي تبليغ الرسالة بالوسائل المقنعة والصيغ العلمية إلى الناس عن طريق الحوار والمناظرة دون أن يشعرهم بتميزه عنهم، أو املاء أفكار يفرضها عليهم، فلا مكان عنده للضغط على الحرية الفكرية([28]).
إن مسألة النزعة التحريرية في الإسلام هذه تنطوي على خطورتها البالغة في بنية العملية التربوية بمفاصلها وحلقاتها كافة، كما أنها تنطوي على أثرها البالغ ودورها الكبير في الصيرورة الحضارية للأمة باعتبارها واحداً من أهم شروط الدفع الحضاري.
ب ـ دلالة المنجزات الحضارية لعصر الرسالة:
رغم مئات الكتب والبحوث التي أنجزت عن سيرة رسول الله (ﷺ) وعصر الرسالة، فقد ظلت هناك حلقة لم تنل حظها من البحث والدرس والاستقصاء والتحليل، بالمقارنة مع الحلقات الأخرى، تلك هي الحلقة الحضارية، أو بعبارة أكثر دقة، متابعة البعد الحضاري للسيرة وتقديم تصوّر متكامل عن معطياته الأساسية، وعن دورها إلى جانب التنزيل القرآني في التأسيس لشبكة الشروط التي مكنت الأمة من ممارسة فعاليتها الحضارية بذلك الزخم الذي يشهد له الجميع.
ورغم أن العقدين الأخيرين شهدا عدداً من المحاولات في هذا الاتجاه لا تتجاوز -ربما- أصابع اليدين، فان الحاجة لا تزال تتطلب المزيد من المحاولات، من أجل إعطاء هذا الجانب من السيرة حقه، والإلمام بجوانبه كافة، وتبيّن أبعاد دوره في الصيرورة الحضارية للأمة وشروط فعاليتها.
لقد بشر عصر الرسالة بمشروع حضاري، وتمكن من تنفيذ العديد من حلقاته، وشارك في وضع شبكة من الشروط التأسيسية التي مكنت الأمة الناشئة من بناء حضارتها المتميزة عبر عقود معدودة من الزمن.
ولعلّ المدوّنات الأولى لأخباريي ومؤرخي السيرة (كمغازي الواقدي، وسيرة ابن اسحق، وطبقات ابن سعد، وأنساب البلاذري، وتاريخ الطبري… الخ )، بإعطائها مساحة واسعة للمغازي (وأحياناً للرجال أو الشمائل) ضيّقت الخناق على البعد العمراني، أو الحضاري، لعصر الرسالة الذي تمكن بعد كفاح مرير من إقامة دولة الإسلام ووضع التأسيسات الأولى لحضارته المتميزة.
عشرات السنين ومئاتها ونحن نتحدث عن هذا العصر من الداخل، وبرؤية تجزيئية تتمركز عند الغزوات، والشمائل، والمفردات الفقهية. ولقد آن الأوان لاعتماد “رؤية الطائر” إذا صحّ التعبير، لاستشراف الملامح الأساسية للعصر، والإنجازات الكبرى لرسول الله (ﷺ) وصحابته الكرام (رضي الله عنهم).
ولابد، من أجل التحقق برؤية كهذه، من استدعاء المؤرخ والمفسر والمحدث والفقيه والجغرافي وفيلسوف التاريخ واللغوي والأديب، لتوسيع نطاق الفضاء المعرفي عن العصر… ها هنا حيث يصير النصّ القرآني، والحديث النبوي الصحيح، والممارسة التاريخية لعصر الرسالة التي يقدمها المؤرخ والفقيه، والملامح البيئية التي يقدمها الجغرافي، والخبرة الذاتية والموضوعية التي يقدمها الشاعر أو الأديب، فضلاً عن الدلالات المحددة والكلمات والتعابير التي يحددها اللغوي، المصادر الأساسية التي يكمل بعضها بعضاً، من أجل تحديد ملامح المشروع الحضاري الذي وعدت به ومهدت له، ووضعت شروطه التأسيسية، ونفذت بعض حلقاته، سيرة رسول الله (ﷺ).
إننا ونحن نتحدث عن “السيرة” وشروطها المنهجية، يجب ألاّ ننسى -لحظة واحدة- ان القرآن الكريم والحديث الصحيح، هما الوثيقة الأكثر أهمية في دراسة العصر ومحاولة الإلمام بنبضه الأساسي وملامحه المتفردة، وانهما ينطويان على شبكة خصبة من المعطيات التاريخية التي تحمل مصداقيتها، والتي تشكل -بالتالي- نقاط الارتكاز في بنية السيرة حيث يجيء المؤرخ والفقيه واللغوي والجغرافي والأديب فيقيم بنيانه عليها.
وبنظرة سريعة إلى “أسباب النزول” في التفاسير القرآنية والمصادر الخاصة بالموضوع، يتبين للمرء الالتحام الحميم بين التنزيل والتاريخ… ان المعطى القرآني يرهص، ويصف، ويعقب، وينذر، ويعد، وهو في خطواته الخمس هذه يمارس تغطية تاريخية للعديد من وقائع السيرة المتشكلة في الزمن والمكان، أي في التاريخ بما ينطوي عليه -بالضرورة- من بعد حضاري، أو عمراني، بالمفهوم الشامل للكلمة.
لقد كانت حياة الرسول (ﷺ) الكادحة، وجهده الموصول حتى
آخر لحظة، شهادة حية على قدرة هذا الرجل-النبي على الإنجاز والتغيير، بكل ما
تنطوي عليه الكلمتان من بعد حضاري. ولقد جاءت شهادة الباحث الأمريكي المعاصر “مايكل هارث” في “المائة الأوائل” تأكيداً لهذا المعنى.
لقد حاول الباحث المذكور أن يستقصي ويدرس بمعياري الإنجاز والتغيير، أعظم مائة شخصية في تاريخ البشرية، ثم مضى لكي ينفذ خطوة تالية، باختيار أعظم رجل من بين هذه الشخصيات المائة، وبالمعيارين ذاتهما، فإذا باختياره يقع على محمد (ﷺ) فيعتبره أعظم شخصية في التاريخ، وذلك في قدرته على تنفيذ إنجاز كبير، ومتغيرات انقلابية تنطوي على الديني والدنيوي معاً([29]).
وعندما جاءت السنة التاسعة للهجرة، ونزلت آيات (أو إعلان) براءة في صدر سورة التوبة، لتصفية الوجود الوثني في جزيرة العرب، كان رسول الله (ﷺ) قد حقق، وصحابته الكرام (رضي الله عنهم) على مستوى الفعل التاريخي، المنجزات التالية التي ينطوي كل منها على بعدٍ حضاري مؤكد:
التوحيد في مواجهة الشرك والتعدّد.
الوحدة في مواجهة التجزّؤ.
الدولة في مواجهة القبيلة.
التشريع في مواجهة العرف.
المؤسسة في مواجهة التقاليد.
الأمة في مواجهة العشيرة.
الإصلاح والاعمار في مواجهة التخريب والإفساد.
المنهج في مواجهة الفوضى والخرافة والظن والهوى.
المعرفة في مواجهة الجهل والأمية.
الإنسان المسلم الجديد الملتزم بمنظومة القيم الخلقية والسلوكية المتجذرة في العقيدة، في مواجهة “الجاهلي” المتمرّس على الفوضى والتسيّب، وتجاوز الضوابط والالتزامات، وكراهية النظام.
لقد جاء الإسلام لكي يتحرك وفق دوائر ثلاث تبدأ بالإنسان وتمر بالدولة وتنتهي إلى الحضارة التي سيقدّر لها أن تنداح لكي تغطي مساحات واسعة من العالم القديم.
ولقد اجتاز الإسلام في مكة دائرة بناء الإنسان والجماعة، ثم ما لبثت العوائق السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية أن صدته عن المضي في الطريق صوب الدائرة الثانية حيث الدولة، لأنه -بلا دولة- ستظل دائرة الإنسان والجماعة-التي هي أشبه بنواة لا يحميها جدار-مفتوحة على الخارج المضاد بكل أثقاله وضغوطه وامكاناته المادية والأدبية، ولن يكون بمقدور الإنسان الفرد أو الجماعة المؤمنة التي لا تحميها دولة، أن يمارسا مهمتهما حتى النهاية، لاسيما إذا كانت قيمهما وأخلاقياتهما ورؤيتهما للكون والحياة والإنسان والمصير تمثل رفضاً حاسماً للوجود الجاهلي، ولابدّ إذن من إيجاد الأرضية الصالحة التي يتاح فيها للمسلم والجماعة الإسلامية أن ينسجا مشروعهما قبل أن تسحقهما الظروف الخارجية وتنحرف بهما عن الطريق. وليست هذه الدائرة سوى الدولة التي كان على المسلمين أن يقيموها وإلاّ ضاعوا.
لقد تأكد للرسول (ﷺ) بعد كفاح طويل استمر أكثر من عقد، أن القيادة الوثنية المكية لا يمكن بحال أن تهادن الدين الجديد، الذي جاء يمثل رفضاً حاسماً لكل قيم الوثنية وأهدافها وتقاليدها ومصالحها، وأنها ستظل تدفع حتى النهاية الأخطار التي يمثلها الإسلام بوجه هذه المصالح والتقاليد والأهداف. وهكذا جاءت “الهجرة” لكي تنقل المسلمين إلى الدائرة الثانية، وتمكنهم من إقامة دولتهم، والبدء بنسج مشروعهم الحضاري المتميز.
ولقد كان هدف الجهد النبوي في عصر الرسالة، هو التأسيس لحضارة إيمانية تستمد منهجها ومفرداتها من هدي الله سبحانه، وتقوم على لقاء الوحي بالوجود، لمجابهة حضارات الكفر والضلال، وازاحتها، والتحقّق بالبديل الحضاري الملائم للإنسان ووظيفته التعبدية والعمرانية… البديل المتوازن في مواجهة حضارات الميل والانحراف: ) وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً ( (النساء: 27).
ثمة -أخيراً- ما يجب التأكيد عليه لدى الحديث عن تأسيسات الفعل الحضاري في سياقاتها الثلاثة: القرآن، السنة، عصر الرسالة، وهو أن قدرتها على التحقّق التاريخي في واقع حياة الأمة، ما كانت لتتم بهذه الصيغة التي وضعتها على طريق الفعالية الحضارية، وأنتجت في نهاية الأمر تلك الحضارة المتميزة، لولا الحضور المؤكد لجملة من العوامل (المساعدة)، يقف في قمتها قدرة نخب الأمة وطلائعها من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان من الأجيال التالية على استيعاب وتمثل المفاهيم والمطالب القرآنية والنبوية وفق مستوياتها العليا، أي في حدودها القصوى التي تمثل السقف الأعلى للخطاب القرآني والنبوي. ولكن ذلك وحده لا يفسر الظاهرة إلا بإضافة عامل آخر إليه يرتبط بالمؤسسة التعليمية والتربوية أشد الارتباط، ويمكن الأجيال من مواصلة الطريق، واقتفاء خطى الآباء والأجداد في التعامل الجاد الملتزم مع الخطاب الإسلامي في كتاب الله وسنة رسوله (ﷺ)، وعدم إتاحة الفرصة للانفصال عنه بهذه الدرجة أو تلك.
تلك المؤسسة التي مارست دورها الخطير على مدى قرون عديدة، وساعدت على تمكين الأمة ونخبها المثقفة من إرفاد الفعل الحضاري بما يتطلبه من عطاء موصول، وقد تمثلت بنقاط ارتكاز ثلاث هي: الشيخ (المعلم أو الأستاذ) و (المسجد) و (المدرسة).
فها هنا في المسجد أولاً، ثم في المسجد-المدرسة ثانياً، ثم في المدرسة المتخصصة ثالثاً، كان الشيوخ يكدحون عن طريق (المدارسة) المباشرة مع طلبتهم، من أجل تخريج النخب الفاعلة التي كان لها الفضل الأكبر في بناء حضارة الإسلام وتغذيتها باستمرار… وكان لطرائق التعليم دورها هي الأخرى في الإعانة على تحقيق الهدف المذكور. كما كان للتناقل المعرفي بين الأجيال دوره هو الآخر “فقد نهض بعبء هذا النشاط الخلاق -بتوفيق الله ومنه- العديد من المفكرين المسلمين المبدعين الذي توجّه كل منهم، بشكل فردي أو تعاوني، إلى ما يسّر له من أعمال الفكر والجهد، ليستخلص ويمنهج ويبلور مسلكاً معرفياً، يبذل فيه طاقته في حقل من الحقول، ليجعله حقلاً غنياً، تصب فيه الشريعة فيزهر ويزدان، ثم ليودعه لمن جاء بعده، والاستمرار على هذا المنوال في إغنائه وإثرائه، الأمر الذي انشأ العلوم الإسلامية المختلفة “([30]).
وليس من مهمة هذا البحث الدخول في تفاصيل النظم والممارسات التربوية والتعليمية التي سيتصدى لها باحثون آخرون في سياق المشروع، وانما التأشير فقط على الدور المؤثر والفعال لهذه النظم والممارسات في ظاهرة الدفع الحضاري موضوع البحث.
ثالثاً : عوامل الانكفاء الحضاري
قبل المضي للتأشير على عوامل تدهور وانكفاء الحضارة الإسلامية، لابدّ من التأكيد على جملة من الملاحظات الضرورية بهذا الخصوص.
وأولى هذه الملاحظات هي أن الانكفاء لا يعني بالضرورة السقوط النهائي، والانسحاب من الميدان، على الأقل بالنسبة لحضارة كالحضارة الإسلامية، تستمد مقوماتها في المنشأ والصيرورة، من مرتكزات هذا الدين متمثلة بكتاب الله وسنة رسوله (ﷺ) اللذين يتضمنان شبكة الشروط المناسبة، والمحفزة للفعل الحضاري، بخلاف العديد من الحضارات الأخرى التي اختفت-بالكلية- عوامل أو شروط نشوئها، وأصبح مستحيلاً استعادة قدرتها على الفعل كرة أخرى، فالذي يتعرض للتدهور والانكفاء بالنسبة للحضارة الإسلامية هو الفعل الحضاري نفسه، وليس أصوله العقدية بطبيعة الحال.
والملاحظة الأخرى هي أن الانكفاء لا يحدث فجأة، أو عبر فترات زمنية متقاربة، وانما تتجمع روافده من هنا وهناك خلال أزمان متطاولة في أغلب الأحيان، قد تستغرق القرون الطوال. هذا إلى أن الانكفاء لا ينفرد به عامل واحد، وانما هو وليد جملة من العوامل التي يتداخل بعضها مع البعض الآخر، بحيث يصعب -أحياناً- فك الارتباط بينها من أجل تبيّن الحجم الحقيقي لكل منها.
إن ظاهرة الانكفاء الحضاري تتشكل ببطء وعلى مكث، وتسهم في صنعها عوامل ومؤثرات شتى: عقدية وسياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية وجغرافية وأخلاقية… إلى أخره…ويمكننا -في ضوء ذلك- أن نضع أيدينا على حشود السلبيات المدمرة التي يمكن أن تتمخض -على سبيل المثال- عن أية تجربة سياسية أو إدارية تلتقي في قطبيها (القيادة) الظالمة والقاعدة (الساكنة)، أو أية ممارسة اجتماعية يتقابل فيها -بشكل حاد- الترف والحرمان، أو أي مجتمع يغفل عن أهدافه العقدية الأساسية التي قام بها ولأجلها، وتفشو فيه الممارسات اللاأخلاقية الهابطة، وأية حقبة يغيب فيها التوازن بين الثنائيات التي ينطوي عليها الوجود الحضاري…إلى آخره…
هذه الحشود التي تبدأ جزئيات وتفاصيل يومية صغيرة، متقطعة، مستعصية على الرؤية والضبط والتحديد، ولكنها تتجمع شيئاً فشيئاً لكي ما تلبث أن تشكل تيارات خطيرة جارفة تدمر في طريقها كل شيء، وتوقف كل نشاط فعّال، وتصيب بالتفكك والاضمحلال كل إنجاز او إبداع.
إن منحنى الانجاز الحضاري، بمفهومه الشامل، يرتبط بهذه المسائل جميعاً، وحيثما تراكمت وطغت السلبيات المتمخضة عن هذه المسلّمات، كفّت طاقة الإنسان والجماعة عن مواصلة صعود المنحنى وآل الأمر إلى التدهور والانكفاء.
إن التفسير الأحادي لانكفاء الحضارات، أو تدهورها، أي ردّ الظاهرة إلى عامل أو مؤثر واحد، كذلك الذي اعتمدته المثالية، أو المادية التاريخية، أو التفسير الاقتصادي، أو الجغرافي، أو العرقي… إلى آخره…انما هو تقليد فكري عتيق عفا عليه الزمن، ولابد من الاستعاضة عنه بالتفسير الشمولي الذي يستقصي العوامل والمؤثرات جميعاً، وهو أقرب التفاسير للتصوّر الإسلامي الذي يضع الأمور كافة في مكانها الحق.
أما الملاحظة الثالثة، فهي أن الحضارات كافة، بما فيها الحضارة الإسلامية، عرضة لتحديات التدهور والانهيار بمجرد غياب شروط الفعل الحضاري، أو فقدانها الحدّ الأدنى من التوتّر المطلوب، وليس ثمة حصانة الهية مسبقة لهذه الحضارة أو تلك بسبب نزوعها الديني أو الإيماني، فان استمرارية الحضارة رهن بما يصنعه أبناؤها أنفسهم في ضوء جملة من الضوابط والمعايير والعوامل التي إذا أسيء التعامل معها سيقت الحضارة إلى مصيرها المحتوم. فليس ثمة في سنن الله في الخلق، ونواميسه في العالم، محاباة أو مداجاة، وحاشاه، وانما هي الأسباب التي تقود إلى نتائجها المنطقية العادلة.
في سورة آل عمران التي تتحدث عن هزيمة المسلمين في معركة أحد (3هـ) ترد الآيات التالية: ] قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ # هَـذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ # وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ # إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ # وَلِيُمَحِّصَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ [
(آل عمران: 141-137).
إن القرآن الكريم يعرض في هذا المقطع ذي المغزى التاريخي العميق، والذي ترد فيه كلمات ذات علاقة وثيقة بالموضوع مثل: سنن، مداولة، تمحيص، قاعدة أساسية في مسألة تدهور أو سقوط الدول والحضارات. فهو يقرر-ابتداء- عدم ديمومة أي منها ولا يستثني المسلمين: ] وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ [ وقد قال: ] بَيْنَ النَّاسِ [ بمعنى عموم هذه السنة التي لا محيص عنها والتي تقوم -بلا ريب- على أسبابها ومقدماتها في صميم الفعل البشري نفسه.
إن القرآن الكريم يعرض لمبدأ (المداولة) كفعل داينامي يستهدف تمحيص الجماعات البشرية وإثارة الصراع الدائم بينها، الأمر الذي يتمخض عن تحريك الفعل التاريخي، وإيجاد التحديات المستمرة أمام المنتمين إلى هذا المذهب أو ذاك.
والمداولة لا تجيء في كتاب الله بصيغة حتمية مقفلة ونزوع مترع بالتشاؤم، كما هو الحال في العديد من المذاهب الوضعية. لكنها -على العكس- توحي بالحركة الدائمة، والتجدد، والأمل، وتقرر أن التاريخ ليس حكراً على أحد، ومن ثم فلا مبرر لليأس والهزيمة، فمن هم في القمة الآن، ستنزل بهم حركة الزمن إلى الحضيض، ومن هم في القاع ستصعد بهم الحركة نفسها، ومن خلال فعلهم وحركتهم واختيارهم، إلى القمة. ان المداولة القرآنية تحمل شروط إيجابيتها التاريخية كافة: حركة العالم المستمرة، وتمخض الصراع الفعال، وديمومة الأمل البشري الذي يرفض الحزن والهوان: ] وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ [.
ولابّد من الإشارة هنا إلى الأشكال أو الصيغ التي يقدمها القرآن عن (العقاب) أو (السقوط) بسبب ارتباطها بالموضوع الذي نتحدث عنه. ويجب أن نلاحظ أن العلاقة بين التعبيرين وثيقة، إذ أن سقوط أية تجربة لن يجيء إلا بمثابة عقاب إلهي مباشر، أو غير مباشر، عن طريق السنن التاريخية التي تعمل من خلال الإنسان والجماعة بسبب تخلّف الأخيرة عن أداء دورها المطلوب، وتملّصها من مسؤولية الاستخلاف ومطالبه الأساسية.
وهذا العقاب أو السقوط، بمفهومهما الشامل، لا يجيئان إلا بعد أن تكون الجماعة قد استنفدت مبررات استمرارها، ومن ثم فان أية ضربة توجه إليها تكون كافية لإزاحتها من مواقعها، وفسح الطريق أمام الجماعات الأكثر فاعلية وفق مفهوم المداولة القرآني.
وهكذا قد تجيء هذه الضربة على شكل غزو خارجي، أو عصيان داخلي، أو اصطراع طبقي، كما أنها قد تجيء بصيغة كارثة طبيعية قاسية تفوق في تحديها قدرة الجماعة المفككة على الردّ والصمود: ] قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ [(الأنعام: 65)،
] أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ # أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ [(الأعراف: 98-97).
وليس بالضرورة تمخض العقاب عن إبادة نهائية للجماعة، أو تصفية جسدية لا تبقي لها أثراً، كما كان الحال مع عدد من الأقوام البائدة، انما هو التمزيق والتفكيك والتشتت الذي يتسبب في إرغام هذه الجماعة أو تلك على التنازل عن مركزها القيادي والتراجع إلى الخطوط الخلفية لكي تمارس التبعية للجماعات الأقوى، بعد أن كانت متبوعة مطاعة: ] وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ [(الأنعام: 133)،
] فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّونَهُ شَيْئاً إِنَّ رَبِّي عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ [(هود: 57).
وبسبب من واقعية القرآن وتأكيده على المسؤولية البشرية، فانه يخاطب الجماعة المسلمة نفسها، كما يخاطب أية جماعة مؤمنة، بأنها ستلقى المصير نفسه بمجرد تخلّيها عن أداء دورها الفعّال في العالم والذي قادها إلى موقع القيادة والشهادة على الناس: ] …وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ [(محمد: 38) ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [(المائدة: 54).
وتبقى علاقة الاستبدال هذه ماضية إلى أهدافها، تداول الأيام بين الناس، بإرادة الله، وتضع أقواماً وترفع آخرين: ] كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ # وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ # وَنَعْمَةٍ كَانُوا
فِيهَا فَاكِهِينَ # كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِينَ # فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ [(الدخان: 29-25).
وهذا الاستبدال التاريخي أو الحضاري الذي يحدثنا عنه القرآن في أكثر من موضع،
لا يجيء وفق أساليب متعّسفة ومباشرة وبمقتضى حدود زمنية صارمة كالأرقام، انما هي سنن الله في التاريخ وارادته النافذة من خلال (النواميس) ذاتها التي تؤول إلى تحقق هذا الهدف الخطير:
] …فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ # وَلَنُسْكِنَنَّـكُمُ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ [(إبراهيم: 13-14) ] وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ
أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ # إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغاً لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ [(الأنبياء: 105-106)
] وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ
كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ [(الأعراف: 137) ] وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ # وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ … [(القصص: 5-6) ] وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [(النور: 55).
لقد دبّت في الحضارة الإسلامية تدريجياً عوامل الضعف الإيماني، والجدل العقيم، ونقل الصراع في الأرض من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، فبدأت تهوي رويدا رويدا، إلى أن هوى هيكلها السياسي، وتمزّقت وحدتها الاجتماعية، وذوت أصالتها المعهودة، وتوثّبها الدائم، وتجددها الواعي، إلى أن استسلمت إلى الاجترار والتقليد والاتكاء على الماضي، وترك الحياة الجديدة لغيرها من الأمم التي اقتبست منها ونقلت عنها علومها ومعارفها.([31])
إن العالم الإسلامي في بحثه عن صياغة بناء حضاري جديد، عليه أن يبحث أولاً في أسباب الغياب الحضاري الذي دام مدة طويلة، كان خلالها خارج التاريخ، كأن لم يكن له هدف. ولهذا يعتبر (مالك بن نبي) أن العالم الإسلامي أضاع وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً، بسبب عدم التحليل المنهجي للمرض الذي يتألم منه منذ قرون طويلة، فذهب يتلّمس الحلول الجزئية، ونظر إلى القضية في صورها التجزيئية، فاختلفت الأطروحات، من الطرح السياسي إلى الطرح الاقتصادي إلى الطرح الأخلاقي… وهكذا.([32])
إن غياب الحضارة الإسلامية الفاعلة هي المشكلة المركزية التي يتخبط فيها العالم الإسلامي.([33])
وفي محاولة استقرائية لمعطيات التاريخ الإسلامي عبر القرون، تم وضع اليد على إحدى وعشرين عاملاً داخلياً وعلى عامل خارجي رئيسي واحد ذي حلقات عشر، أعملت منشارها في افتراس عقل الأمة وروحها، وسوقها في نهاية الأمر إلى الشلل والعقم وغياب الفاعلية. ولن يتسع المجال لتحليل هذه العوامل، ولاستدعاء الشواهد التاريخية التي أسهمت في تشكلها، وسيتم -بدلاً من ذلك- التأشير على محاورها الأساسية التي تدلّ -بالضرورة- على ما تنطوي عليه من دلالات ومضامين.
ومن أجل الإمساك بها جيداً يمكن تصنيفها إلى مجموعات نمطية تنطوي كل واحدة منها على جملة من العوامل المتقاربة، وبالصيغة التالية:
المجموعة الأولى
- انحسار الحركة الجهادية وتضاؤل فاعلية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- الظلم الاجتماعي.
- الترف والتكاثر.
- التحلّل الخلقي والسلوكي.
المجموعة الثانية
- غياب مفهوم التوحيد وتسلل الشرك والصنمية.
- التمزّق المذهبي.
- الغلّو والتشدّد.
- انتشار الرؤية الإرجائية التي تفك الارتباط بين الإيمان والعمل.
- انتشار الصوفية المنحرفة والبدع والخرافات.
- غياب الاجتهاد وسيادة التقليد والاتباع.
- غياب العلم وانتشار الجهل.
- تضاؤل دور المؤسسات التربوية.
المجموعة الثالثة
- الاستبداد السياسي.
- الفصام النكد بين القيادتين الفكرية والسياسية.
- طغيان القبلية والإقليمية والعرقية على مفهوم الأمة.
- الفساد الإداري.
- أخطاء القيادات الإسلامية المتأخرة.
المجموعة الرابعة
- الصراع بين الثنائيات.
- فوضى التعامل مع خبرات الآخر.
- تضاؤل القدرة على توظيف المكان.
- تضاؤل القدرة على توظيف الزمن.
المجموعة الخامسة
- العوامل الخارجية: الحروب الصليبية، الغزو المغولي، حركة الاسترداد الإسباني، محاولات الالتفاف الإسباني+البرتغالي، الاستعمار القديم، الاستعمار الجديد، الصهيونية، الشيوعية، التبشير، الغزو الفكري.
ومن البديهي أن أية محاولة لانبعاثنا الحضاري، واستعادة قدرتنا على الفعالية، لن تمضي إلى هدفها بالضمانات المطلوبة، ما لم يتم تشخيص العوامل المضادة التي قادت الأمة إلى البوار، والكشف عن السبل التي تعين على مجابهتها واستئصالها من الحياة الإسلامية لتمكينها من استئناف الحركة صوب دورها الحضاري المنوط بها. ولسوف يكون لمؤسسات التربية والتعليم دورها الرائد في تحقيق المطلوب.
ومع ذلك كله فان هذه الحلقة لم تعط الاهتمام الكافي في تدريس مادة (الحضارة الإسلامية) في المدارس والمعاهد والجامعات… وسيكون التأكيد عليها في تصميم المنهج المقترح ضربة لازب وضرورة من الضرورات.
رابعا: إمكانات الانبعاث وسبل المواجهة (العوائق والحلول)
1- العوائق:
أ – الدور السلبي للمعرفة الإنسانية الغربية في بنية مناهجنا التربوية:
ليس ثمة كالعلوم المنضوية تحت مظلة (المعرفة الإنسانية) أداة ذات قدرة عالية على التبديل والتفكيك وإعادة الصياغة في البنية الحضارية، بسبب من كونها تنبثق عن خلفيات تصوّرية شاملة، وتنهض قائمة على منظومة من المذاهب والفلسفات التي تغذّيها وتمنحها الملامح والخصائص، وتنحاز بها -بالتالي- صوب هذا المنظور أو ذاك. إنها ليست محايدة كالعلوم الصرفة أو التطبيقية، ومن ثم فان تقبّلها في نسيج أية ثقافة مغايرة، سيقود تلك الثقافة، بدرجة أو أخرى، ليس إلى مجرد إضافة عناصر غريبة عن المناخ الذي تتنفّس فيه وتتشكل، وانما إلى أن تفقد شيئاً فشيئاً مقوماتها الأساسية، وتضحّي بتميزها، وتمارس -هي الأخرى- انحيازاً قد يؤذن بتفككها وسقوطها.
كان هذا أحد مداخل الغزو الفكري عبر القرنين الأخيرين: أن نتقبّل عن الحضارة الغالبة معطياتها التي تتعامل مع الإنسان، والتي قد تتقاطع منذ لحظات تشكلها الأولى، ليس مع المفردات الإسلامية فحسب، وانما مع أسسها وبداهاتها.
لقد تموضعت المعرفة الغربية شيئاً فشيئاً في دائرة صنمية ترفض الله (جلّ في علاه) وتصنع على هواها شبكة من الطقوس تنسّجها المصالح والأهواء حيناً، والظنون والأوهام حيناً آخر، وما يسمى بالأنشطة العلمية الإنسانية في معظم الأحيان. لقد أريد لنا -لسبب أو آخر- أن ندخل اللعبة نفسها، أن نفقد اليقين بالأساس الإيماني الموغل في بنياننا الثقافي، وأن ننسى الله.
إن هذا التقابل المحزن بين صنميات المعرفة الغربية وبين معرفتنا التي يراد لها أن تنسلخ عن جوهرها الإيماني القائم على التوحيد، يذكرنا بعبارة قالها (كارودي) وهو يتحدث عن “الصنمية التمائمية” التي تفرّخ وتتكاثر، في المجتمعات الغربية: “صنم النموّ، صنم التقدم، صنم التقنية العلموي، صنم الفردانية وصنم الأمة… بمحذوراتها جميعاً، ومحرّماتها، وبرموزها الـ (مقدسة) وبطقوسها “وأنه ليس ثمة في مواجهة هذا كلّه، سوى أن نتشبث أكثر فأكثر بـ (لا إله إلا الله) “هذا الإثبات الأساسي للإيمان الإسلامي… واننا لنعرف بالتأكيد ما لهذا اليقين في العقيدة من قوة هدم وتحرير… فالحوار هكذا مع الإسلام يمكن أن يساعدنا على ابتعاث خميرة عقيدتنا الحية فينا، تلك التي تستطيع نقل الجبال من مواضعها.” ([34])
نتذكر أيضاً عبارة أخرى في الكتاب نفسه تبيّن لنا أننا نمارس لعبة خاسرة ونحن نتعامل مع “إنسانيات” الغير، دونما أي قدر من التريّث أو النقد والتمحيص: “لم نشدد على الوجوه التي لعب فيها العلم الإسلامي باكتشافاته، دور (الرائد) للعلم الغربي الحالي، وانما على صفاته الخاصة في تبعيته وخضوعه للوسائل الإنسانية ذات الغايات الإلهية. في هذا المنظور، على القرن العشرين، وعما قليل على القرن الواحد والعشرين أن يتعلما كثيراً من الإسلام.” ([35])
فالذي يحدث منذ حوالي القرنين أننا لم نمارس تعليم الآخرين، أو نحاوله في الأقل، وانما رحنا نأخذ منهم معارف إنسانية تقطعت وشائجها بالإنسان -في أقصى حالات توازنه وأدناها- وفقدت أية غاية إيمانية تتجاوز الحاجات القريبة، وتبعد بالحياة البشرية عن أن تكون مجرد حركة في الطول والعرض.
والمشكلة، في نهاية الأمر، وكما يقول كارودي نفسه “كونية” “ولا يمكن للجواب إلاّ أن يكون على المستوى الكوني.”([36])
فما لم تكن أنشطتنا المعرفية (الإنسانية) متلبّسة بمطالب العقيدة، ومقاصد الشريعة التي انبثقت عنها، ما لم تكن هذه الأنشطة ذات طموحات كونية بمستوى المنظور العقدي للإسلام نفسه، فمعنى هذا أن هناك نقصاً… ثغرة ما… فراغاً… قد يكون فرصة ملائمة لتقبّل (إنسانيات) الآخرين (الصنمية)، فلا تزيدنا الاّ ضياعاً وتضاؤلاً وتبعية وانحساراً.
لقد دلّت التجربة نفسها، كما يقول رجل القانون الدولي المعاصر (مارسيل بوازار): “على أن محاكاة العقائد المستوردة من أوساط ثقافية أجنبية، غير ملائمة، والحركات التي تستلهم الإسلام (بما فيها شبكة التعامل المعرفي) قادرة وحدها على أن تدمج عند الاقتضاء مختلف التيارات الباقية على الساحة، لتقدم منها حلولاً مركبة تظهر الفضائل الأخلاقية من خلالها إحدى القوى الأساسية للحضارة”.([37]) وهذا يذكرنا بمقولة (الجابري) من أن العالم اليوم، وهو يدخل القرن الواحد والعشرين، “يعيش وضعية جديدة تماماً، تتمثل في هذا الإحراج، بل التحدي المتزايد الذي يسببه العلم
وتطبيقاته للأخلاق والضمير الأخلاقي، والذي أثار ويثير ردود فعل تسمح بالحديث عن (عودة الأخلاق) …” ([38])
فنحن نرى ونلمس كيف أن المنفعية الصرفة، وتعبّد الذات، وتعبيد الآخرين، وإرغام الكشف المعرفي المحدود على أن يكون عقيدة شمولية، والنزوع المادي-البيولوجي الصرف للمعرفة الإنسانية، هذه كلها، وغيرها كثير، تأخذ برقاب مساحات واسعة من علوم غربية كالنفس والاجتماع والتاريخ والحضارة والاقتصاد والسياسة والقانون والإدارة وغيرها من المعارف الإنسانية، وهي في كثير من الأحيان تفتقد “الفضيلة الخلقية”، فضلاً عن الرؤية الكونية، اللتين يتحتم على المعرفة الإسلامية، أن تقدمهما اليوم، أو غدا، للإنسان من أجل أن يكون النشاط المعرفي مع الإنسان وليس في مواجهته.
والمواجهة بين الإسلام والثورة التقنية، التي هي الإنجاز الغربي الأكثر تألّقاً، والأقرب إلى الحياد “لا تدفع المسلم -كما يؤكد بوازار أيضاً- إلى إنكار موقفه الديني، بل إلى تعميقه أمام العالم والله، متوجباً عليه… محاولة إدراك الإمكانيات بشكل أفضل في إطار إسلامي شامل… وعندئذ يعود الإسلام إنسانية حقيقية كما كان، عن طريق تخيّر المشاركات الثقافية… وتبنّيها… وتمثلها…” ([39])
والذي حدث، ويحدث أيضاً، ونحن نتعامل مع المعرفة الإنسانية الغربية عبر القرنين الأخيرين، أننا لم نحاول الاّ في حالات استثنائية لا يقاس عليها، أن “نتخيّر”، أي أن ننقد ونمحّص ونفرز ثم نختار، في ضوء موقف ديني معمّق إزاء الله سبحانه وإزاء العالم، من أجل التحقّق “بإمكانيات أفضل في إطار إسلامي شامل”، وليس في سياق انتماء غير ممحّص لثقافة الغير.
ومنذ أكثر من نصف القرن كان (ليوبولد فايس: محمد أسد) قد حذّر من ممارسة انهزامية كهذه، وأن يكون المسلمون أكثر تأصيلاً معرفياً، مشدّداً على “أن الإسلام، بخلاف سائر الأديان (والمعارف الوضعية بطبيعة الحال)، ليس اتجاه العقل اتجاهاً روحياً يمكن تقريبه من الأوضاع الثقافية المختلفة، بل هو فلك ثقافي مستقل ونظام اجتماعي واضح الحدود. فإذا امتدت مدنية أجنبية بشعاعها إلينا وأحدثت تغييراً في جهازنا الثقافي-كما هي الحال اليوم- وجب علينا أن نتبيّن لأنفسنا إذا كان هذا الأثر الأجنبي يجري في اتجاه امكانياتنا الثقافية أو يعارضها، وما إذا كان يفعل في جسم الثقافة الإسلامية فعل المصل المجدد للقوى أو فعل السمّ.”([40]) وهو يخلص إلى القول بأن “الشيء الوحيد الذي لا يستطيع المسلمون أن يتمنوه هو أن ينظروا بعيون غربية ويروا الآراء الغربية. انهم لا يستطيعون إذا أرادوا أن يظلوا مسلمين، أن يتبدّلوا بحضارة الإسلام الروحية تجارب مادية من أوربا.”([41])
وعلى مدى قرنين من الزمن، وبسبب من ضغط لا يرحم من الإحساس بالدونية تجاه معارف الآخرين، تناولنا سمّاً كثيراً، بدلاً من البحث عن المصل المجدّد للقوى. ولقد قاد هذا السمّ إلى انحلالنا الثقافي أكثر فأكثر. لقد تعاملنا، بقدر ما يتعلق الأمر بالمعارف الإنسانية، مع الماديتين الديالكتيكية والتاريخية في مجال البحوث الفلسفية والتاريخية، ومع الانتخاب الطبيعي في مجال أصل الإنسان، ومع نظرية التحليل النفسي في مجال البحوث النفسية، ومع العقل الجمعي في مجال علم الاجتماع، ومع الوجودية في مجال الآداب، ومع السريالية في مجال الفن، ومع الذرائعية في مجال التربية… ومع… ومع… فماذا كانت النتيجة؟
اليوم إذ تتساقط هذه الشبكة من المعطيات المتورّمة سرطانياً، ندرك أننا كنا مخطئين، وأننا خسرنا زمناً طويلاً كان بمقدوره لو أحسّتا التمحيص والتخيّر في أنشطتنا المعرفية الإنسانية، أن يجعلنا، ليس فقط أكثر أصالة، وانما -أيضاً- أن نقلّل الهوة بيننا وبين الغير، وأن نرغمه على احترامنا، وربما مدّ اليد لطلب العون منا.
والتعويض الوحيد الذي يمكن أن يعلمنا من الخطأ، وأن يغفره لنا، هو أن نبدأ، وبالجدّ الذي يقتضيه الموقف، نشاطاً تأصيلياً يجعل المعرفة الإنسانية تتشكل في رحم الإسلام، وليس في بيئة غريبة هجينة، وفي أن يكون نبض هذا التشكل متوافقاً مع المطالب الإسلامية، متناغماً مع المقاصد الشرعية، منسجماً مع التوجه الإيماني في الصيرورة والمصير.
لقد مارس الاختراق المعرفي الغربي دوره الخطير في بنية الشخصية الإسلامية “بانهيار مقوماتها الأساسية العقلية والنفسية. فالمقومات العقلية مبنية عند الإنسان المسلم -إضافة إلى الموهبة والاستعداد والوراثة والقدرة والملكات الثقافية والمعرفة والتصورات والفكر والتأملات والخبرات والتجارب والدراسات والتحليلات والملاحظة- على منهج ومعرفة، فإذا وجد المنهج والمعرفة، وجدت العقلية وصيغت وتم بناؤها. والمقومات النفسية متمثلة -إضافة إلى الاستعداد والقدرة- في الفنون والآداب وما يتصل بها، فهي التي تسهم عادة بتكوين ذلك الذوق الذي نطلق عليه النفسية وما يتعلق بها.” ([42])
ومنذ أواسط القرن الثامن عشر الميلادي، والعالم الإسلامي كلّه “مقتلع النوافذ والأبواب في وجه الفكر الغربي، والمنهج الغربي، والثقافة الغربية، والعلم الغربي، والحضارة الغربية، والفنون والآداب والأذواق والتقاليد الغربية بدرجات متفاوتة. فمنذ أن بدأ الغربيون ينشئون كنائسهم التنصيرية وبجوارها مدارسهم التعليمية في مدننا، والحصون الفكرية والثقافية الإسلامية التي كانت متبقية لدى هذه الأمة، كانت تتهاوى واحداً بعد الآخر، والأجيال المسلمة تتعرض لعملية استلاب فكري وثقافي هائل انتهت بأن أصبحت جميع معارفنا النظرية غربية مائة بالمائة، أو موضوعة في إطار وقالب غربيين، شمل ذلك الفكر والمنهج والمصدر والفلسفة المعرفية وموضوعاتها وأهدافها وغاياتها، بل حتى تلك العلوم التي نسمّيها بالشرعية لم تسلم من عملية الاستلاب والتغيير هذه.”([43])
إن النظم التربوية في الأقطار الإسلامية بعد استقلالها كانت “في فلسفتها ومضمونها، امتداداً للنظم التربوية التي أسستها القوى الاستعمارية لخدمة أغراضها، ولم تبذل حكومات الاستقلال جهوداً حقيقية كافية لتحرير التربية من رواسب النظم التربوية الاستعمارية. وان الإصلاح التربوي في الأقطار الإسلامية حتى الآن انما هو إصلاح توفيقي، لم يتعرض للأسس الجذرية لفلسفة التربية والتعليم واتجاهاتها الأساسية، بل كان يكتفي في معظم الأحيان بتلافي بعض النقائص من النواحي الفنية أو المهنية.”([44])
وهذه المناهج الموروثة في معظم الأقطار الإسلامية، تعمل على تكريس الواقع الموروث من الفترة التي خضعت فيها تلك الأقطار للاستعمار “ولقد تعرضت مناهج التربية في بلادنا العربية الإسلامية إلى موجة الاستشراق والتغريب، فاستعرنا الكثير من المحتويات كما استوردنا الكثير من الأطر الفكرية لمناهجنا، بحيث أضحى الخطر الفكري يهدد معتقدات آبائنا، والتسيّب الاجتماعي يهدّد هوية أجيالنا، وأصبحت ظاهرة الازدواجية في مناهج التعليم تصبغ كثيراً من مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا. والحقيقة أننا بحاجة إلى إعداد المثقف المسلم في كل مجال وميدان، لأن طبيعة الإسلام شاملة شمول الحياة، وطبيعة التربية الإسلامية شاملة لجميع ألوان المعرفة وحقولها. ويخطئ من يظن أن التربية الإسلامية مرادفة للتربية الدينية بالمعنى الكهنوتي في الغرب.”([45])
ويوم تستورد التربية والتعليم، كما تستورد الآلات والأجهزة والخضراوات والفاكهة، فأقرأ على الأمة السلام “لأنها ستخرج حينذاك أجيالاً من الشباب بلا هوية ولا شخصية، ألسنتهم عربية وثقافتهم أجنبية، ينظرون إلى أبناء جلدتهم نظرة الازدراء، ويتهمونهم بالرجعية والتخلّف. يخلطون بين التقدم العلمي المادي الذي تعلّموه وبين القيم والأخلاق والرسالة الأصيلة للتربية والتعليم، فينشأ هناك صراع بين الأجيال يفتّت الأمة، ويدعها في حالة من الضياع.”([46])
وعلى الرغم من أن الإسلام جاء ليخرج الإنسان من عبادة العبادة إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة “ومرور أربعة عشر قرناً أو يزيد على المدرسة التربوية، والمؤسسة التطبيقية الأولى في دار الأرقم بن أبي الأرقم، التي بدأت منها خطوات المسلم (الإنسان الجديد)، مع ذلك نرى اليوم الكثير من الثغور التخصصية التي يقتضيها إخراج الإنسان والأمة لتحقيق الشهود الحضاري، والشهادة على الناس والقيادة لهم، لا تزال مفتوحة، ولا نزال نؤتى من قبلها، لأنها تفتقد المرابطين من أهل الدراية والفقه التربوي. ولعل الاختراق، والاحتواء، والتحكم التربوي الذي نعاني منه، يعتبر من أخطر هذه الثغور جميعاً، بل يمكن اعتبارها ثغرة الثغور جميعاً.”([47])
لقد تعرّض عالمنا العربي الإسلامي مع بدايات العصر الحديث إلى عدة غارات، كانت إحداها، وربّما أشدها خطراً تلك التي تمثلت “في تبني العرب والمسلمين أنفسهم -دولاً ومجتمعات ومؤسسات- لنظم التربية والتعليم الغربية، تحت ما عرف باتجاه التعليم العصري، وذلك بتأثير مباشر أو غير مباشر للوجود الغربي في أراضيهم. ولقد كانت الغارة الأكثر نجاحاً، لأنها الأكثر إيغالا في الحذر والتستّر والحيطة، بل أنجح في التظاهر بالرغبة في خدمة المجتمعات المسلمة وتطويرها وترقيتها.”([48])
والحق أننا لو حاولنا استخدام الرؤية التحليلية للذات العربية الإسلامية في أزمتها الحاضرة، فإننا سنجد “أن الإخفاق الذي منيت به المجتمعات الإسلامية يرجع إلى غياب مشروع حضاري إسلامي، يستلهم الفهم الإسلامي لدور الإنسان واستخلافه من أجل التمدّن، بالإضافة إلى عدم استيعاب العقل العربي الحديث لخطورة الهيمنة الاستعمارية في المجال الثقافي والفكري والعقائدي، حيث يترك ذلك كله آثاراً واضحة في الممارسة الحضارية، بين شعوب تستلب هويتها في كل لحظة، ومذاهب وسياسات تضحي بذاتيتها التاريخية، وخصوصيتها الحضارية، عندما تخضع إرادتها لخصوصية المشروع الحضاري الغربي الذي يعاني أزمة واضحة في بيئته الخاصة. ومحصلة هذه التبعية الحضارية، الارتهان التاريخي لتطور الغرب وسياساته ونظمه ومذاهبه، وإمعان في ترسيخ التخلّف الحضاري وتنميته، عبر تثبيت استلاب الإنسان العربي المسلم لصالح الهيمنة الاستعمارية.”([49])
ولحسن الحظ فان الخطاب العربي الإسلامي المعاصر في كثير من حلقاته أخذ يدعو “إلى عملية قطع تدريجي مع التكوين النظري والمنهجي الذي يتحكم بحركتنا الفكرية والذي هو من مكوّنات الغلبة الحضارية مجسدة بسيادة الانموذج الغربي للمعرفة. وقد عبّر الفكر العربي والإسلامي والعالم ثالثي، وحتى بعض تيارات الفكر النقدي الغربي، عن رفض هذا الانموذج العالمي المهيمن، وعن توقه لأنموذج مختلف من خلال محاولاته للانفكاك من أسر هذا الانموذج، لكن هذه المحاولات المستمرة لم تنجح بعد في الوصول إلى تلك الاستقلالية المعرفية بين نظامين معرفيين متمايزين. وذلك يحصل عندما تبلغ النظرية والرؤية الجديدة مرحلة من التطور تكتشف فيها أنها وصلت إلى مناخ معرفي مختلف.”([50])
خلاصة القول أن تقبل المعرفة الإنسانية الغربية على عواهنها، في مناهجنا التعليمية، آتى حصاده التربوي السيئ وثماره المرة على مدى القرنين الأخيرين، وخرّج أجيالاً من الطلبة تعاني من ازدواجية الولاء المعرفي والنفسي والسلوكي، بين ما تلفّته من معطيات الغربيين، وبين أصولها الإسلامية. وقد نتج عن فقدان التوحّد هذا، تضاؤل القدرة على الفاعلية والإبداع، وهيمنة نوع من الشكوكية التي تجعل الإنسان معلقاً من رقبته في فضاء واسع تغيب فيه معالم الطريق ويضيع في مسالكه الدليل.
ب- عزلة المائتي عام بين المعرفتين الإنسانية والإسلامية في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا، وتأثيراتها السلبية:
سواء كان هناك قصدية مسبقة، أم هو الجهل بالمطالب والضرورات التعليمية والتربوية، فإننا منذ ما يقرب من القرنين من الزمن، أنشأنا نمطين من المؤسسات التعليمية، وأقمنا بينهما جداراً كونكريتياً صلباً يصعب تخطيّه.
المؤسسات المعنية بالعلوم أو المعارف الإنسانية، وتلك المعنية بالعلوم أو المعارف الإسلامية، حيث لم يتح لخرّيجي الأولى أن يتلقوا شيئاً ذا بال من العلوم الإسلامية التي تمكنهم من التأصيل الضروري لما يتلقونه من علوم إنسانية، قدمت إليهم جاهزة من الغرب، بكل ما تنطوي عليه من تضادّ -في بعض حلقاتها- مع أسس التصوّر الإسلامي ومقوّماته. كما أنه لم يتح لخرّيجي الثانية أن يتلقوا شيئاً ذا بال من العلوم الإنسانية التي تمكنهم من أن يكونوا في قلب العصر، ملّمين بالحدّ الضروري من معارفه، قديرين على المشاركة في إعادة صياغته برؤية معاصرة، تملك في الوقت نفسه معاييرها التصوّرية التي تحفظ لها شخصيتها وتحمي خصوصياتها.
على مدى أربعين عاماً وأنا أمارس تدريس عدد من العلوم الإنسانية في العديد من الجامعات. التاريخ وفلسفته، الحضارة، مناهج البحث، التربية، الاجتماع، الأدب، الاقتصاد… إلى آخره… فكنت الحظ هذا الفراغ المحزن في عقل الطالب الجامعي إزاء العلوم الإسلامية… إنهم وهم يدلفون إلى مرحلة الدكتوراه لا يحسنون حتى قراءة الآيات القرآنية، ولا يعرفون شيئاً عن مصطلح الحديث، أو العقيدة، أو أصول الفقه، ناهيك عن علوم القرآن الكريم.
رؤية العالم بعين عوراء، بل بعيون الآخرين، دون أن تضبط الرؤية، ولو بالحدود الدنيا من المعرفة الإسلامية. ولنا أن نتصوّر كيف سيكون هؤلاء الخرّيجون أرقاماً هجينة مضافة إلى الساحة الثقافية التي تعجّ بأنصاف المتعلمين… وكيف أن تعاملهم مع مطالب مجتمعاتهم وتحدياتها، سيزيدها فوضى واضطراباً. وهم في نهاية الأمر سيكونون ممن ينطبق عليهم مضمون الحديث الشريف عن ذلك المسافر المنبّت الجذور، الذي لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى!
فماذا عن خريجي علوم الشريعة، أو العلوم الإسلامية؟ إنهم -بالتأكيد- ليسوا بأفضل حالاً من زملائهم (الإنسانيين)! لأنهم غادروا معاهدهم دون أن يملكوا مقومات التعامل الفاعل مع الحياة، أو القدرة على إعادة صياغتها، بل وقيادتها كذلك! وأنى لهم ذلك وهم لا يكادون يعرفون شيئاً عن معارفها الإنسانية التي بدونها لن يكونوا قادرين على الإلمام بمطالبها، والاستجابة لتحدياتها، لأنهم لم يسبروا غورها العميق، بل لم يبلغوا -حتى- شواطئها.
لم يعقد جسر بين المعرفتين يعين كلاً منهما على التفاعل والأخذ والعطاء وتبادل الخبرات. وزاد الأمر سوءً أن معاهدنا وجامعاتنا قبلت المعرفة الإنسانية على عواهنها، وكما تشكلت في ديار الغرب، بمنطلقاتها، وفلسفتها، وأهدافها، ومعطياتها وتأسيساتها ونتائجها… تقبّل كامل لعلم الاجتماع الغربي، ولعلم النفس الغربي، ولعلوم الإدارة والاقتصاد الغربية، وللقانون والسياسة الغربيين، وللآداب والفنون الغربية، وللتاريخ وفلسفته، والدراسات الحضارية، وفق نموذجها الغربي.
عملية تنزيل للقوالب المعرفية الجاهزة وباستسلام تام لمعطياتها، ليس فقط في معاهدنا وجامعاتنا، بل وحتى في مدارسنا الابتدائية ومتوسطاتنا وإعدادياتنا. وبما أن تلك لمعرفة كانت تنبثق -في الأعم الأغلب- عن رؤية علمانية، وأحياناً، بل وفي كثير من الأحيان، مادية ذرائعية، ترفض الإيمان بالغيب، وتتنكر لله واليوم الآخر، وتلتصق بالمنفعي والمنظور، فيما يتناقض -ابتداء- مع تأسيسات المعرفة الإسلامية المبنية على الإيمان بالغيب، وعلى منظومة القيم الأخلاقية، فلنا أن نتصوّر، وقد عزلت هذه المعرفة عن معادلها الإسلامي، كيف سيكون الحصاد مريراً، وكيف ستخرج أجيال الطلبة وقد فكت ارتباطها بكل ما هو إسلامي أصيل.
والحق أنه “لا يوجد عربي مسلم مخلص يقف ضد تعلّم الجوهر الحقيقي في الحضارة الحديثة واستيعابه، من اكتشافات ومخترعات وعلوم نافعة وكل جديد مفيد يتفق مع جوهر عقيدتنا السمحاء. ولكن الذي حدث بالنسبة لحملة (التعليم العصري) في العالم الإسلامي أنها لم تبدأ البداية الصحيحة، ولم تتخذ شكل القرار الذاتي الحضاري المستقل والنابع من إرادة عربية مسلمة حرة، ومن تخطيط يمتلك الرؤية والوعي ويعرف مواقع أقدامه. لقد بدأ ما سمي بالتعليم العصري على أنقاض نظام التعليم الأهلي الذي كان سائداً في العالم الإسلامي، ولم يأت انبثاقاً منه وتطويرا له، كما كان يجب أن يبدأ ويكون، وكما حدث في الغرب ذاته في مطلع نهضته.”([51])
وزاد الأمر سوءً أن هذه المعرفة المستوردة، التي فعلت فعل السمّ في التكوين الثقافي للأمة (كما يقول محمد أسد: ليوبولد فايس)،([52]) لم تتقبل في مناهجها التربوية والتعليمية، أي شيء عن المعرفة الإسلامية، لكي تكون بمثابة الضابط والمرشّد، ولو في حدوده الدنيا، لمأساة الابحار في خضم المعارف الأجنبية، اللهم الاّ فيما يسمى دروس الدين، وأحياناً الثقافة الإسلامية، والتي تعمدًّ -لسبب أو آخر- في أن تنطوي على قدر كبير من الهزال، والتهميش، بل والتنفير، فيما يزيد من حالة التقبل النفسي للمعطى الغربي، والجهل المطبق بالمعطى المعرفي الإسلامي.
صحيح أن محاولات عديدة سعت عبر العقود الأخيرة، لتجاوز الأزمة وتحقيق اللقاء المنشود بين المعرفتين، لكنها في نهاية الأمر لم تشكل سوى بقع محدودة ومبعثرة على مساحة واسعة، تعاني فيها المعرفتان من قطيعة غير مبرّرة على الإطلاق.
لنقف لحظات عند جانب من الحصاد المرير لعزلة المائتي عام مع هؤلاء الخرّيجين: الحالة النفسية والاجتماعية والوظيفية التي عانوا منها ولا يزالون، مقارنة بالحالة نفسها في عصور ازدهار الحضارة الإسلامية، يوم أن كان المعني بالعلوم الشرعية، أو الفقيه، يقود الحياة، ثم ما لبث أن انسحب إلى هامش الحياة، فأصبحت تقوده بضغط الضرورات النفسية والاجتماعية والوظيفية. وكان يملك عقلاً ابتكارياً متوقداً، يقدر في لحظة على تكييف هذه المفردة أو تلك وفق مقاصد الشريعة، فيعين على تمكين الخبرة الإسلامية من التواصل والاستمرار بالالتحام بالحياة، ثم ما لبث أن فقد هذا التألق، أو تعمد أن يطفئه استجابة لحالة اجتماعية يحكمها تقليد السابقين، واتباع خطى الآباء والأجداد، وتعين على نسج خيوطها الكالحة ضغوط السلطة الاستعمارية (الخارجية) تارة، والمحلية (الداخلية) تارة أخرى، وهي الضغوط التي استهدفت عزل الشريعة عن الحياة، ونسف الجسور المقامة بين الطرفين، بما فيها “الفقيه” الذي أريد له ألاّ يشارك في عملية التغيير، أو الصياغة، أو إعادة تعديل الوقفة، وأن يتحول إلى واعظ، أو خطيب جمعة تقليدي، أو مدّرس دين أو لغة عربية، يتلقى في معظم الأحوال أجره الشهري من الحكومات. وإذ تعمّد أن يكون الأجر زهيداً لا يكاد يسدّ الرمق، وكان العالم أو الفقيه غير قادر على أية حرفة إضافية تعينه على الارتقاء بمستواه المعيشي صوب الحدّ الأدنى من سويته المعقولة، انعكس ذلك كله عليه، فأصبح مسحوقاً، ممتهناً، ضعيفاً، لا يملك في معظم الأحيان “الشخصية” الآسرة القوية المؤثرة التي تمكنه من أداء دوره المطلوب.
لقد رأينا جميعاً هذا بأم أعيننا… ثمة حالات استثنائية بكل تأكيد، ولكنه الاستثناء الذي يعزز القاعدة ولا ينفيها.
في محاضرة عن “قيمة التاريخ” ألقيتها على طلبة كلية آداب جامعة الموصل، أشرت إلى ما يمكن اعتباره إحساساً بالنقص “مركب نقص” يعاني منه طلبة أقسام التاريخ تجاه الفروع المعرفية الأخرى: إنسانية وصرفة وتطبيقية، بينما نجد هؤلاء الطلبة في جامعات العالم المتقدم يتمتعون بأعلى وتائر الثقة والطموح، والاعتقاد بأنهم يمضون للتخصّص في واحد من أكثر فروع المعرفة الإنسانية أهمية وفاعلية، ونحن نعرف جيداً كيف أن العديد من قادة الغرب وساسته ومفكريه، والمهيمنين على مفاصل الحياة الحسّاسة فيه هم من خريجي أقسام التاريخ.
الحالة نفسها تنطبق -بدرجة أو أخرى- على طلبة العلوم الإسلامية، بل اننا قد نجد بعضهم ينحدر باتجاه وضعية من الإحساس بالامتهان النفسي والاجتماعي لم يأذن بهما الله ورسوله لعلماء هذه الأمة ودارسي علومها الشرعية.
نحن -إذن- قبالة حالة نفسية -اجتماعية- وظيفية تتطلب العلاج والتجاوز، وإيجاد البدائل المناسبة لعالم متغيّر يدخل قرنه الحادي والعشرين… عالم تشاء إرادة الله سبحانه أن تشتعل فيه على مدى البصر، في مشارق الأرض ومغاربها، صحوة إسلامية تتطلب ترشيداً، من أجل الاّ تنعطف بها السبل وتضل الطريق بين الإفراط والتفريط… بين تشدّد لا يشكمه ويعيده إلى الجادة الاّ العلم الشرعي المنضبط الصحيح، وتسيّب لا يكفّه عن الترهل والارتجال الكيفي الاّ العلم الشرعي المنضبط الصحيح. وفي الحالتين لابدّ من عودة الفقيه. أو العالم، إلى قلب الحياة، وتسلّمه كرة أخرى مواقع الريادة والقيادة… لابدّ من التحقّق بأقصى وتائر الفاعلية والتألقّ من أجل تحقيق الهدف الملّح، قبل أن يفلت الزمام، وتتشرذم الصحوة، ونفقد جميعاً القدرة على توظيفها تاريخياً من أجل الإعانة على البدء بنسج خيوط المشروع الحضاري الإسلامي الذي آن له أن ينزل إلى الحياة لكي يجيب -كما يقول كارودي- على كل الأسئلة الكبيرة التي تؤرق الإنسان في العصر الراهن، ويقدم البديل المناسب بعد انهيار جلّ النظم والايديولوجيات الشمولية الوضعية التي لم تعرف الله.
وإذا كان الاستعمار يوماً، قد مارس دوره الماكر في لعبة تجهيل العالم وإفقاره وتعجيزه وتغريبه، ومضى أكثر لكي يعزله تماماً عن الحياة، و (يفصله) على الصورة التي يريد، فما يلبث أن يصير “حالة” يتندّر بها المتندّرون، فان هذا “المؤثر” السيء قد غادر بلادنا في نهاية الأمر، فلسنا ملزمين بالاستمرار على تقاليده، ولابدّ من التداعي لتعديل الوقفة الجانحة التي صنعناها بأيدينا -أولاً- ما في هذا شك، ثم جاء الاستعمار لكي يزيدها انحرافاً وجنوحاً.
-2 الحلول الممكنة
أ – التأصيل الإسلامي للمعرفة الإنسانية
منذ أكثر من قرن ونصف القرن انفتحت مؤسساتنا التربوية والتعليمية في مستوياتها كافة، على المعرفة الإنسانية الغربية، ونسجت مفردات مناهجها ومقرراتها من معطيات ونتائج هذه المعرفة، التي فعلت، كما يقول محمد أسد (ليوبولد فايس) “فعل السم في جسم الثقافة الإسلامية”([53])، لأنها أعطتهم في مساحات واسعة من مكوناتهم الفكرية والتربوية معرفة تتناقض في أسسها ومكوناتها ونتائجها مع ثوابت ومرتكزات العقيدة التي ينتمون إليها.
فثمة هوة عميقة لا يكاد ينعقد فوقها جسر، بين معرفة ترفض الغيب، وتتنكر لله واليوم الآخر، وتبهت فيها منظومة القيم الإنسانية، ومعرفة تتشكل -ابتداءً- من إيمانها بالغيب، وتلقّيها عن الله سبحانه، ويقينها باليوم الآخر، بكل ما يتمخض عن ذلك من قيم ومفاهيم ومكونات سلوكية ومعرفية.
ولقد قاد هذا كله إلى تخريج أجيال من الطلبة مهزوزي الثقة بدينهم وعقيدتهم، يعانون من حالة قاسية من الازدواج بين قناعاتهم السابقة وبين ما تلقوه من ثقافة الآخر.
ومن أجل ذلك كان لابدّ من القيام بحركة إعادة بناء للمعارف الإنسانية، وبقوة مناهج البحث العلمي، على أسس إسلامية. أي (تأصيلها) إسلامياً من أجل أن يتحقق الوفاق بين عقيدة المسلم ورؤيته للكون والعالم والحياة، وبين نتائج ومعطيات المعرفة التي يتعامل معها، فيما ينعكس إيجاباً -وبالضرورة- على إعادة توحّد الشخصية الإسلامية، ويتجاوز بها حالة الازدواج التي عانتها منذ زمن طويل. وهو أمر يرتبط أشد الارتباط بالاشتغال التربوي الذي تمارسه المؤسسات التعليمية، إذا أريد لها أن تؤدي دورها المرسوم في مستوياتها كافة.
فإذا تذكرنا أن المعرفة الإنسانية هي معرفة (مقاربة) للحقائق وليست مطابقة لها
Not exact sciences، وأن نتائجها في أحيان كثيرة ظنية وليست يقينية، كما هو الحال في العلوم الصرفة إلى حدّ كبير Exact sciences، أدركنا أن الاستسلام لنتائجها ليس قدراً محتوماً، وأن بالامكان نقدها وتفنيدها، وإعادة بنائها على أسس أكثر موضوعية، تستمد حيثياتها من ثوابت ومؤشرات هذا الدين، في كتابه وسنة نبيّه (ﷺ)، ولا تتنكر -في الوقت نفسه- للحلقات والكشوف الموضوعية المحكمة في نسيج المعرفة الغربية عبر علومها كافة.
سوليفان في (حدود العلم) Limitation of Science، على سبيل المثال، يؤكد، بعد سبر عميق لجوانب من هذه المعرفة، قلقها وظنيّتها، وعدم قدرتها على الوصول إلى حافات اليقين المطلق، وهو أمرٌ يكاد أن يكون مستحيلاً: “إنه ليس في نظريات علم النفس كافة شيء من شأنه أن يغيّر جدّياً في قناعتنا بأن هذا العلم لا يمكن اعتباره علماً حتى الآن. وللمعارف الأخرى أيضاًَ، مثل علم الاجتماع والاقتصاد وما إلى ذلك، بعض النواحي التي لا تعتبر مرضية من وجهة النظر العلمية. والعلم هو أقوى ما يكون عليه عندما يتناول العالم المادي. أما مقولاته في المواضيع الأخرى فتعتبر نسبياً ضعيفة ومتلجلجة.”([54])
وهي النتيجة نفسها التي ينتهي إليها الكسيس كاريل في “الإنسان ذلك المجهول”
Man the unknown: إن السيطرة على عينة من العالم المادي لغرض فهمها ممكنة إلى حدّ ما، أما السيطرة على عينة يدخل فيها الإنسان، والعقل، والحياة طرفاً، فتكاد تكون مستحيلة. والنتيجة التي نصل إليها في هذا المجال “ضعيفة ومتلجلجة”([55])، الأمر الذي يذكرنا بما سبق وأن قاله الاقتصادي البولندي المعروف أوسكار لانكه، أحد أكبر أخصائيي الدول النامية، لدى استعراضه جهود الكتاب الذين اهتموا بدراسة اقتصاد مجتمعات ما قبل الرأسمالية، منذ عصر ماركس وحتى عصر بورشييف، وهو “أن هذه الدراسات جميعها مفككة، لذلك فان الاقتصاد السياسي للنظم الاجتماعية ما قبل الرأسمالية لما يخرج بعد إلى حيّز الوجود باعتباره فرعاً منظماً من فروع الاقتصاد السياسي.” ([56])
واضع أسس الفلسفة الوضعية: (أوغست كونت) يتخذ، بسبب من دوافعه الذاتية التي لا تقوم على أي أساس موضوعي، موقفين متناقضين من المرأة، وهو عالم الاجتماع المعروف!
ففي بحث بعنوان (رسالة فلسفية في التذكار الاجتماعي) يبعث به (كونت) إلى محبوبته (كلوتيلددي فو)، يغيّر رأيه في المرأة ومكانتها الاجتماعية تغييراً تاماً! “فقد كان منذ أشهر يكتب إلى تلميذه (ستورات مل)، فيرى أنه ليس في المرأة أمل ولا خير، أما الآن فهو يرى المرأة عنصراً أساسياً في الإصلاح الاجتماعي الذي وقف نفسه عليه”([57])
والسبب في هذا الانقلاب الفجائي من النقيض إلى النقيض، هو أنه في الأولى كان يحب امرأة قبلت الزواج منه، ولكنها خدعته فدفعته إلى محاولة الانتحار والالتحاق بمستشفى المجانين حيناً من الدهر، وفي الثانية أحب فتاة لم يتح له الزواج بها، لكنها منحته نفسها وأحبته حباً صادقاً. ([58])
ونقارن هذا التأرجح الفكري بالموقف الديني من المرأة… الموقف الثابت الواضح المنبثق عن علم إلهي محيط بتكوين هذا الجنس وخصائصه ووظائفه المناسبة، فنراه شاسعاً، ونرى الذين يتجاوزونه صوب الأحكام النسبية المتغيرة، كأحكام (كونت) ويريدون أن يتعاملوا على أساسها المتقلب مع المرأة، يستحقون الرثاء وعدم التسليم بمقولاتهم.
وإذا كان موقف (كونت) مؤسس واحدة من أشد الفلسفات أهمية وانتشاراً في أوربا، يغيّر رأيه بسبب دوافع ذاتية صرفة، وفي واحدة من المسائل الأساسية في الحياة البشرية: المرأة، فكيف يرجى لفلسفته أن تمنح اليقين لتلامذتها والمعجبين بها، بل كيف نفسر تحوّلها، وغيرها كثير من الفلسفات البشرية العاجزة، إلى ما يشبه الدين الذي ينحني الغربيون لمسلّماته ويعتقدون أنه الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ ألا ينسحب الأمر على معظم الفلسفات والعقائد الوضعية؟
فالصيرورة الديالكتيكية التي جاء بها (هيغل) قد علمت الناس عبادة القوة. وقد ساند هو نفسه كل رجل ارتقى عرش السلطان “فحين حاول نابليون بحراب جيشه أن يدخل العلاقات البورجوازية إلى ألمانيا، كان (هيغل)، الذي كان في ذلك الوقت يضع أسلوبه الديالكتيكي، يتجاوب مع الثورة الفرنسية، ورحّب بدخول جيش بونابرت إلى (ينّا) باعتباره التجسيد التاريخي لشكل جديد للروح المطلقة. ثم سمى نابليون: (الروح المطلقة على جواد أشهب). ولكن بعد عشرين سنة من ذلك، حين قوي الحكم الملكي الإقطاعي في ألمانيا، والذي كان على رأسه فريدريك وليم الثالث، كان (هيغل) قد فقد أفكاره الثورية وأصبح فيلسوف الدولة في مملكة بروسيا.”([59])
وكان الدكتور وليم رايخ، وهو رجل ماركسي من اتباع فرويد، ومؤسس معهد (السياسة الجنسية)، قد أصدر تحت تأثير مالينوفسكي كتاباً أسماه (وظيفة الشهوة الجنسية) شرح فيه النظرية التي تزعم أن الفشل الجنسي يسبب تعطيل الوعي السياسي لدى الطبقة العاملة، وأن هذه الطبقة لن تتمكن من تحقيق امكانياتها الثورية ورسالتها التاريخية إلا بإطلاق الحافز الجنسي دون حدود أو قيود، وطرح نظريته التي أسماها (نظرية كأس الماء) وخلاصتها أن على المواطن السوفياتي إفراغ شهوته في أية امرأة تصادفه من أجل التحرّر من العطش الجنسي وما يقود إليه من كبت مدمّر… ولكن وبعد مضي أقل من سنتين أعلن (لنين) حملته ضد هذه النظرية التي كانت ستؤول إلى أن يتحول الجيل الجديد في الاتحاد السوفياتي إلى أولاد حرام، ودعا -بدلاُ من ذلك- إلى الاحتشام والتعفف واحترام الأسرة والإقبال على الزواج، رغم أن الفيلسوفين ماركس وانغلز أعلنا في المنشور الشيوعي المعروف حربهما ضد فكرة الأسرة واعتبراها عرضاً بورجوازياً زائلاً.([60])
ثم ها هو ذا جان بول سارتر، زعيم الفلسفة الوجودية الملحدة، في محاورته الأخيرة مع سيمون دي بوفوار، قبيل أسبوعين من وفاته يعترف “أنا لا أشعر بأني مجرد ذرة غبار ظهرت في هذا الكون، وانما أنا ككائن حسّاس تم التحضير لظهوره وأحسن تكوينه. أي بإيجاز ككائن لم يستطع المجيء الاّ من خالق.”([61])
وقد تكفي هذه الشواهد للتأكيد على قلق المعرفة الإنسانية الغربية، ونسبيّتها، وضرورة الاّ نجعلها الحكم الفصل في مناهجنا التعليمية ومؤسساتنا التربوية، وأن نتولى -بدلاً من ذلك- إعادة صياغتها وفق ثوابت التصوّر الإسلامي الذي لا يخضع للتقلبات والنسبيّات والأهواء التي أدانها القرآن الكريم بالحسم الواضح: ] إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى [(سورة النجم: 23).
لقد تشكلت حركة أسلمة المعرفة لتحقيق هذا الهدف الملّح وملء الفراغ الذي صنعته هذه المفارقة المحزنة والمتمثلة في الإذعان لمعرفة تتنكر لله، فلا تؤمن بالغيب، ولا بمنظومة القيم الأخلاقية التي جاءت الأديان لكي تقيمها بين الناس، وصياغة البديل الذي ينطلق من ثوابت الإيمان بالله، والعمق الغيبي، والغائية الكونية، ويتحقق في نسيجه اللقاء المنشود بين الوحي والوجود.
ما الذي أراده المعنيون بحركة التأصيل الإسلامي للمعرفة؟ لقد أدركوا “التدهور الحضاري الذي تعاني منه الأمة الإسلامية في عصرنا، إذ تجتاز الآن مرحلة من العجز وفقدان التوازن وغياب الهوية، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. ولاحظ هؤلاء أن الأصل في هذا التدهور الحضاري هو أنه أزمة فكرية في المقام الأوّل، وتندرج تحتها سائر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقدم هؤلاء محاولات فكرية متنوعة للخروج من هذه الأزمة. ولعل أبرز هذه المحاولات وأكثرها توفيقاً واقتراباً من حاضر الأمة وتراثها وعقيدتها تلك التي عرفت باسم (إسلامية المعرفة). وكتب أصحاب هذه المحاولة الكتب والمقالات العديدة لتوضيح وجهة نظرهم، واستقبلها المشتغلون بالفكر والثقافة استقبالاً حسناً، كما عقد هؤلاء مجموعة كبيرة من الندوات والمؤتمرات والمحاضرات وحلقات البحث لمناقشة أفكارهم.”([62])
إن أصعب مهمة تواجه الأمة الإسلامية اليوم في سبيل الخروج من أزمة الفكر والمعرفة الإسلامية “هي إيجاد حلّ لمشكلة التعليم، إذ لا يمكن أن يكون هنالك أي أمل في إحياء حقيقي للأمة ما لم يصحّح نظامها التعليمي وتقوّم أخطاؤه. بل ان ما نحتاج إليه -في الحقيقة- هو إعادة تشكيل هذا النظام من جديد. فالازدواجية الراهنة في التعليم الإسلامي التي تقسمه إلى نظامين أحدهما إسلامي والآخر علماني لا ديني يجب أن تلغى إلى الأبد. بل يجب أن يكون النظام التعليمي نظاماً واحداً ينبع من الروح الإسلامية ويعمل باعتباره وحدة متكاملة مع برنامج الإسلام العقيدي. ويجب الا يبقى نظام التعليم في العالم الإسلامي مقلداّ للنظام الغربي، أو أن يترك هائماً ليجد مخرجاً بنفسه. كما يجب الاّ يقتصر على تلبية الحاجات الدنيوية والرغبات المادية للطلبة، أو على تحقيق احتراف لحقل من حقول العلم والمعرفة وإحراز نجاح شخصي ومادي. بل يجب أن يعطى للنظام التعليمي رسالة، وهذه الرسالة لا يمكن أن تكون سوى إضفاء الرؤية الإسلامية وشحذ الإرادة لتحقيقها على أوسع نطاق.”([63])
والآن فان جهد حركة التأصيل الإسلامي للمعرفة، أو إسلامية المعرفة، قد تمخض عبر العقود الأخيرة عن معطيات غزيرة، أخذت تتشكل على مكث بادئ الأمر، ثم راحت تتدفق كالسيل في شتى المجالات المعرفية: مؤلفات وبحوثاً ودراسات في علم الاجتماع، في علم النفس، في الإدارة، في الاقتصاد، في السياسة، في التشريع، في الفلسفة، في الدراسات التاريخية والحضارية، وفي الآداب والفنون. وكانت تغذّيها باستمرار ندوات ومؤتمرات ودوريات متخصصة أنتجت مئات البحوث العلمية في المعارف المذكورة كافة، بحيث أصبح من السهولة بمكان أن يجد مدرّسو هذه المادة أو تلك، من المراجع والبحوث، ما يعينهم على تصميم المقرّرات الدراسية التي سيعتمدونها مع طلبتهم في هذه المرحلة الدراسية أو تلك.
والحق أن المكتبة الإسلامية المعاصرة التي تشكلت عبر القرنين الأخيرين، كان أصحابها قد سبقوا حركة إسلامية المعرفة بتقديم نتاجهم الخصب، في هذا العلم أو ذاك، متشكلاً بمقولات القرآن والسنّة، والحلقات المضيئة من تراث الآباء والأجداد.
وإذا كانت هذه المعطيات متوجهة في أساسها للقارئ العام، فان أدبيات التأصيل الإسلامي أريد منها ابتداء أن تغطي حاجة المؤسسات التربوية-التعليمية إلى المقررات المنهجية التي تعينها على أداء دورها الأصيل الفاعل.
وقد قامت حركة التأصيل هذه بالعمل على مستويين، أولهما تقديم المقررات الجاهزة لهذه الجامعة أو المؤسسة أو تلك، لدى اقتناعها بفكرة التأصيل وضروراته التعليمية التربوية. وثانيهما إنشاء معاهد ومؤسسات وجامعات تتبنى مفاهيم الحركة، وتسعى إلى تحقيق اللقاء الغائب بين الوحي والوجود، أي بين المعرفة الدينية القادمة بواسطة الوحي، وبين المعرفة الإنسانية المتشكلة بقوة العقل في تخصصاتها كافة.
إن (مشروع إحياء نظام تربوي أصيل)، يتشكل في هذا السياق بكل ما يعنيه المشروع، بدءً من عنوانه، مروراً ببحوثه التنظيرية والتطبيقية والداعمة، وصولاً إلى المؤسسة أو المؤسسات التي سيؤول إليها المشروع والتي ستجد نفسها بحاجة إلى المقررات المنهجية التي تغذي تخصصاتها كافة.
فلا يعقل، والحالة هذه، أن تتقبل معطيات المعرفة الغربية على عواهنها، وتعيد عقارب الساعة إلى الوراء… إلى زمن المدارس المعلمنة التي خرّجت -عن قصد أو دون قصد- أجيالاً من الطلبة الضائعين اللذين لا هوية لهم.
وبالتالي، فلن تتحقق “الأصالة” التي أعلنها المشروع، وساق بحوثه وأدبياته باتجاهها، إلاّ بتبنّي واعتماد المقررات المنهجية المؤصلّة إسلامياً، وبدون ذلك لن تكون قد فعلت شيئاً، وستعيد تمثيل المشهد نفسه الذي مارسته المدارس والمؤسسات المعلمنة على مدى أكثر من قرن من الزمن.
وإنها لمسألة تنطوي على بعديها التنظيري والتطبيقي، بما أن المشروع استهدف منذ البدء تصميم نظرية تربوية أصيلة تمثل قاعدة البناء التي يقوم عليها الجانب التطبيقي بصيغة مؤسسة أو معهد أو شبكة مدرسية أو جامعة، تبنى مقرراتها المنهجية في التخصصات كافة، على أسس إسلامية، وتتجاوز حالة الارتطام المحزنة بين الديني والدنيوي، إذا صحّ التعبير.
ب ـ كسر جدار العزلة بين المعرفتين الإنسانية والإسلامية :
منذ عمق زمني بعيد أعلن (أبو الحسن الندوي) أننا في البلاد الإسلامية “بحاجة ملحة إلى نظام تعليمي إسلامي في الروح والوضع والسبك والترتيب بحيث لا يخلو كتاب من الكتب يدّرس في العلوم والآداب من روح الدين والإيمان، هذا إذا أردنا أن ينشأ جيل جديد يفكر بالعقل الإسلامي، ويكتب بقلم مسلم، ويعمل بروح مسلم، ويدير دفة البلاد بسيرة مسلم وخلقه… وتكون البلاد الإسلامية إسلامية حقاً في عقلها وتفكيرها وسياستها وتعليمها.”([64])
واقترح الباحث المذكور أن تخصص لجان للتأليف تضع كتباً تشتمل على أحدث المعلومات مع الروح الدينية والنتائج الدينية، فيخرج الطالب، من كتب الجغرافيا على سبيل المثال، مؤمناً بأن هذه الأرض التي ولد عليها، والكون الذي يعيش فيه، منتظم منسق، وأن خالقه حكيم خبير، ويهتدي من المخلوقات إلى الخالق، ومن المعلومات إلى التفكير ومعرفة الله. وكذلك التاريخ حيث يعرف أن لله سنناً لا تتغير، وأن لحياة الأمم قانوناً، وأن كل أمة حادت عن السبيل عوقبت ومحيت من الوجود … وكذلك الحال مع العلوم الأخرى، وهو أمرُ ميسور للعلماء الذين يجمعون بين معرفة روح الإسلام والتعمق في هذه العلوم.”([65])
وفي فترة لاحقة أكد (عز الدين إبراهيم)، وهو الخبير في الإدارة الجامعية، على أن المطلوب من الجامعات الإسلامية هو أن نقوم بدور ريادي لتكوين جيل من القادة لا مجرد أصحاب التخصصات العلمية والمهنية “كل الجامعات تدرّب لمهن وتخرج أصحاب مهن. تستطيع أن تخرج المختص في مهنة معينة، حتى المهن الإسلامية كالقاضي، والمفتي، والمدرس، ومدرس اللغة العربية، ومدرس الدين، فهؤلاء أصحاب مهن لكننا نريد ما وراء ذلك، نريد أن نخرج قادة للمجتمع، ودعاة إسلاميين، والقادة لا يخرجون من كلية معينة، ولا من تخصّص معين، بل يفرزون من كافة التخصصات ومن كافة الكليات. فالقيادة والدعوة إلى الله ليستا تخصصاً مهنياً محصوراً.”([66])
ابتداءً، لابدّ من إعادة النظر في مسألة وجود كليات أو معاهد للعلوم الإسلامية منعزلة عن الكليات والمعاهد المعنية بالعلوم الإنسانية. الا يمكن –مثلاً- أن تخترق “موضوعات” أو “مفردات” العلوم الإسلامية سائر الكليات والمعاهد المعنية بالعلوم الإنسانية، أو أن تؤسس أقساماً أو فروعاً في تلك الكليات والمعاهد لكسر العزلة، وتحقيق التحام أكثر بين مقاصد الشريعة وبين سائر المعارف الإنسانية كالإدارة والاقتصاد، والقانون والسياسة، والنفس والاجتماع، والجغرافيا والتاريخ، واللغة والآداب والفنون، فيكون هذا فرصة مناسبة للتحقّق أكثر فأكثر بالتأصيل الإسلامي للمعرفة، أو على الأقل، تنفيذ بداية صحيحة قد تؤول، مهما طال الوقت، إلى نتائجها المنطقية المتوخاة في التعامل مع سائر المفردات المعرفية في شتى التخصّصات، من خلال الثوابت الإسلامية نفسها؟
قد يعترض على هذا بضرورة أن يكون هناك -في نسيج الأنشطة الجامعية- مؤسسات أكاديمية مستقلة لعلوم الشريعة، من أجل تخريج المتخصصين في هذا الفرع المعرفي بالذات، الذي قد تلحق به، قدر ما يسمح به المجال، موضوعات معرفية أخرى، في هذا الحقل أو ذاك، ولكن تبقى مهمة هذه المؤسسات منح الشهادة في علوم الشريعة وليس في أية علوم أخرى.
وهذا حق، وهو ضرورة من ضرورات التخصّص العلمي، ولكن هل يمنع هذا من تنفيذ صيغة مضافة تتمثل في مغادرة العلوم الشرعية لمؤسساتها التخصصية، والتحامها مع الفروع والأقسام والمعاهد والكليات الإنسانية، بل وحتى العلمية الصرفة والتطبيقية، لتحقيق هدفين ملحّين: أولهما ذلك الذي سبق وأن أشرنا إليه بخصوص محاولة وضع التأسيسات الأولى لإسلامية المعرفة التي لن تتحقق ما لم يتم اللقاء بين النمطين المعرفيين، فيصير الوحي والوجود معاً، أو الدين والعلم، مصدرين لصياغة المفردات؟
وثانيهما كسر جدار العزلة بين علوم الشريعة والحياة، وإعادة الدم إلى شرايينها المتصلبة، ومنحها الحيوية والمرونة التي تمكنها من التموضع في قلب العصر لا بعيداً عنه.
قد يعترض -أيضاً- بالقول في أن ساعات الفروع والأقسام الإنسانية لا تسمح باستضافة العلوم الشرعية، أو بأن مادة (الثقافة الإسلامية) أصبحت البديل المناسب للقاء بين الطرفين.
وهذا حق كذلك، لكن تبقى هنالك تساؤلات في هذا السياق قد تخطيء وقد تصيب: إن “ساعات” الفروع والأقسام الإنسانية ليست قدراً نهائياً لا فكاك منه، ولطالما جرى تكييفها واستبدالها وإعادة جدولتها في العديد من الكليات لتحقيق غرض أشد إلحاحاً. ومن ثم فانه ليس مستحيلاً -إذا كنا جادين في إيجاد مواقع مناسبة لعلوم الشريعة في الكليات الإنسانية- أن نعيد الترتيب فيما يعطي لهذه العلوم الفرصة المناسبة في خارطة الموضوعات المقررة على مدى سنوات الدراسة الجامعية.
وبالنسبة للثقافة الإسلامية، فإنها حققت ولا ريب قدراً طيباً لدى استضافتها في
المعاهد والكليات المختلفة، ولكنه -على أية حال- ليس القدر المطلوب لأنها لم تتجاوز -في معظم الأحيان- ساعة أو ساعتين أو ثلاثاً في الأسبوع، لا تكاد تغطي سوى جوانب محدودة من فكر الإسلام وثقافته، فضلاً عن معارفه الشرعية، ويتم فيها التعامل ركضاً على سطح الظواهر والمفردات، دونما أي قدر من التعمّق والايغال. ويتخرج طالب القانون أو السياسة أو الإدارة أو الاقتصاد أو الآداب… إلى آخره، وهو لا يملك عن الإسلام سوى شذرات وقطوف وخطوط عامة في أحسن الأحوال.
إن مادة “الثقافة الإسلامية” ضرورية لتكوين بعض الأطر الفكرية الأصيلة في عقل الطالب الجامعي، لكن هذا وحده لا يكفي إذا أردنا أن يكون القانوني والاقتصادي والإداري والمؤرخ والأديب، متوافقين في نبضهم ومعرفتهم وأنشطتهم التخصصية مع مطالب هذا الدين ومقاصد شريعته.
قد يكون هذا حلماً، أو هدفاً بعيد المنال، ولكن الأعمال الكبيرة تبدأ دائماً بالحلم، بالطموح للوصول إلى الأهداف البعيدة… ورحلة الألف ميل -كما يقول المثل- تبدأ بخطوة واحدة.
من ناحية أخرى، فان على المعاهد والكليات المعنية بعلوم الشريعة، أن تتقبل بدورها استضافة أكبر قدر ممكن من موضوعات المعرفة الإنسانية المذكورة، من أجل تمكين طلبة هذه المعاهد والكليات من المعارف المعاصرة، في أحدث كشوفها ومعطياتها، ومنحهم الخلفيات الكافية عنها، الأمر الذي يتمخّض ولا ريب عن جملة نتائج منها -على سبيل المثال- الإعانة على إزالة حواجز العزلة والتغريب بين الشريعة والمعرفة الإنسانية، وبينها وبين الحياة.
ومنها جعل خريجي هذه المؤسسات أكثر حيوية وقدرة على الخطاب، ووضعهم بتمكينهم من معارف العصر، في قلب العصر، قديرين على النقد والمقارنة والتمحيص، قديرين -أيضاً- على إيصال مطالب المعرفة الشرعية، والتحقق بمقاصدها، في ضوء تناقضات واحباطات المعرفة الوضعية، وعلى إسهام أكثر فعالية في صياغة المشروع الحضاري الإسلامي البديل.
إن هذا سيقدم -بدوره- ثمرة أخرى هي تجاوز الإحساس بالنقص الذي سبق وأن أشرنا إليه، والذي هيمن على أجيال المعنيين بالعلوم الشرعية عبر القرنين الأخيرين، والتحقق بالثقة والاعتزاز بالذات، في وتائرها المعقولة التي تتجاوز بهؤلاء الخريجين حالات العقم والشلل، وعدم القدرة على الإبداع والإحسان والابتكار والإضافة والتجديد…
إن على مشروع إحياء نظام تربوي أصيل أن يتجاوز الاستسلام لتقاليد منهجية قادمة من عصور عتيقة هي غير عصرنا، محملة بموضوعات ومفردات لم تعد تصلح للقرن الجديد، واستبدالها بمناهج أكثر مرونة، تملك القدرة على استضافة واستيعاب المعارف الحديثة، وتمكّن المتعاملين معها على تجاوز العزلة والتغرّب والانقطاع، إلى تنفيذ حوار فعال مع تحديات العصر وهمومه المعرفية والثقافية، والإعانة -بالتالي- على بلورة وصياغة المشروع الحضاري المرتجى.
وفي السياق نفسه يستحسن أن نكون حذرين من الانسياق وراء التقسيمات التقليدية لأجدادنا أنفسهم وهم يتحدثون عن علوم “نقلية” وأخرى “عقلية”، وكأن هناك جداراً فاصلاً بين العلمين.
ويتساءل المرء، ألم يدخل الإسلام لكي يصوغ العلوم العقلية ويتوغل في جزئياتها ومسالكها، برؤيته المتميزة وتحليله الخاص؟ ويتساءل –كذلك- ألم تكن العلوم النقلية نفسها عقلية بمعنى من المعاني؟ أي بكونها استجابة ناجحة متفردة لمطالب العقل البشري في هذا الفرع المعرفي أو ذاك؟
إننا بحاجة إلى التريّث قليلاً، ونحن نتعامل مع التقسيمات والمصطلحات وأن نتجاوز الكثير منها -إذا اقتضى الأمر- لكي ننحت ونصوغ مفرداتنا المنسجمة ورؤيتنا العقدية المتميزة.
إن الحلقات الإسلامية لا تزال تعاني -إلاّ في حالات استثنائية- من ثنائية يمكن لمؤسسات علوم الشريعة، ولمشروع إحياء نظام تربوي أصيل، أن تعين على تجاوزها: ففي أحد الطرفين يقف إسلاميون متمرسون بالمعرفة المعاصرة، ولا يكادون يعرفون شيئاً عن علوم الشريعة. وفي الطرف الآخر يقف إسلاميون متمرسون بعلوم الشريعة، ولكنهم لا يكادون يعرفون شيئاً عن العلوم الإنسانية والمعارف الحديثة.
والخندق عميق، والهوّة محزنة ولا ريب، والنتائج السيّئة لهذا الانفصال، أو الثنائية، تنسحب على مساحات واسعة من الجهد الإسلامي المعاصر الذي يلتحم بالحياة الثقافية والمعرفية دونما عمق فقهي، أو يمضي بالايغال في هذا العمق حيناً آخر، بعيداً عن مجرى الصراع الفكري المحتدم قبالته صباح مساء.
ولقد أوقعت هذه الثنائية، الطرفين، في مشاكل عديدة، قد يقود تراكمها إلى تشكل إرث من الأخطاء التي يصعب تداركها ما لم نسارع بإيجاد الحلّ المناسب، بالتحقق بتقارب بين الطرفين من خلال بذل جهود استثنائية، والاتفاق على منهج أكثر توازناً يضع في حساباته قطبي المسألة، حيث يصير التعامل الأكاديمي مع علوم الشريعة في ظل مشروع إحياء النظام التربوي الأصيل، فرصة طيبة لتحقيق الوفاق.
وما من ريب في أن فقه الحياة التي أراد لنا هذا الدين أن نعيد صياغتها وفق مقاصده، وأن نمسك بزمام قيادتها كي لا يعبث بمقدّراتها المضلّون عن سبيل الله، ويميل بها الذين يتبعون الشهوات والأهواء والظنون، الميل العظيم الذي حذّر منه كتاب الله ] وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً [ (النساء: 27)… إن فقه الحياة هذا ليس حالة بسيطة ذات وجه واحد، وانما هو حالة مركبة ذات وجوه شتى. فهناك الفقه الشرعي الذي يتعامل مع الجزئيات والكليات، أي مع مفردات الشريعة في هذا الجانب أو ذاك، ومع مقاصدها الكبرى التي تجعل المعطيات الفقهية تصبّ في هدفها الكبير ذي الفضاء الواسع سعة الحياة نفسها.
هناك الفقه الدعوي الذي يمنح الناس في كل زمن ومكان القناعة بأحقية هذه الشريعة في حكم الحياة وقيادتها.
وهناك، فضلاً عن هذا وذاك، الفقه الحضاري الذي يعيد تشكيل الحياة وفق مقاصد الشريعة في ضوء إدراكه لقوانين الحركة التاريخية، وسنن الله في الخلق والعالم والوجود، وعلى هدى رؤية مقارنة نافذة لخرائط العالم الحضارية من أجل صياغة المشروع الحضاري المتميز، والتحقق -في الوقت
نفسه- بصيغ مناسبة في التعامل مع الحضارات الأخرى أخذاً وعطاءً…
إن الفقه الحضاري، كما أنه عمل في التاريخ للبحث عن أصول وقوانين التشكل الحضاري، فهو عمل في صميم العصر، وتطلع للمشاركة في المصير البشري من خلال صياغة المشروع الحضاري البديل الذي يستمد حيثياته ويتلقى توجيهاته من مقاصد الشريعة وآلياتها الفقهية، والذي يجاهد من أجل التجذّر في الأرض والانتشار فيها بقوة الفقه الدعوي وآلياته الفاعلة.
والآن، فان إحدى مشاكل المناهج الجامعية بصدد علوم الشريعة أنها تعطي طلابها الفقه الشرعي، وتمضي معهم في الفقه الدعوي إلى منتصف الطريق، ولكنها لا تكاد تعطيهم شيئاً عن الفقه الحضاري. فها هي ذي الحلقة الضعيفة في “عقل” خريجي المعاهد الشرعية، والتي تساعد بدورها على حفر الخنادق وتعميق الهوّة بين الشريعة والحياة، وتعين على تأكيد تلك الثنائية المقيتة التي عزلت ولا تزال حشود الخرّيجين عن الدخول في نسيج الحياة، وإعادة صياغتها، فضلاً عن تسنّم مراكز القيادة فيها، والشهادة عليها.
إن الفقه الحضاري يستدعي دراسة علمية منهجية لتاريخنا الحضاري، من أجل استمداد مؤشرات العمل في الحاضر والمستقبل، وهي -كما هو واضح- ليست مسألة ترفية، ولا حتى أكاديمية صرفة، وانما هي مسألة حيوية ترتبط أشد الارتباط بالاشتغال التربوي، لأن حلقة كهذه معنية باستخلاص البدائل التي يمكن أن نتقدم بها إلى ذوات أنفسنا كأمة، وإلى العالم على امتداده، في سياق مشروع حضاري يشارك في صياغة المستقبل. فضلاً عن أن فقهاً كهذا يمنحنا صورة من مصداقية تحوّل الشريعة بمقاصدها وتأسيساتها التصورية والاعتقادية، إلى واقع تاريخي متحقق في الزمن والمكان، أي في التاريخ، كما أنه سيعرّفنا على عوامل الانهيار الحضاري التي ساقتنا إلى المواقع المتخلفة في خرائط العالم.
هناك -بكل تأكيد- نقص في محاولة توظيف بعض الحلقات الجامعية للارتفاع بوتائر العمل إلى مستويات أعلى.
بعض هذه الحلقات قد وظف بالفعل ولكن في حدوده الدنيا، وبصيغ مترعة بالشروخ والأخطاء (وربما الكسل العقلي)، وحلقات أخرى لم تمسها يد في هذه الجامعة أو تلك. وفي كلتا الحالتين فان المطلوب في مشروع الاحياء الذي يطمح إلى السقف العالي، هو الإفادة من كل الفرص المتاحة لتخريج عالم الشريعة الأقدر أكاديمياً، والأكثر فاعلية وقدرة على الابتكار والعطاء.
هناك -على سبيل المثال- (البحث الخاص) أو (بحث التخرج) الذي يكلف به طلبة المرحلة الأخيرة من البكالوريوس (الليسانس) على مدى عام دراسي بأكمله، ويشرف عليه -في الغالب- أستاذ المادة الأقرب في تخصصه الدقيق، إلى الموضوع مجال البحث.
إن البحث الخاص هذا، فرصة جيدة، في حالة الاختيار المدروس لموضوعاته، لتحقيق تلاحم أكثر مع المعرفة المعاصرة والحياة، ولجعل علوم الشريعة تغادر رفوف المكتبات العتيقة وتنفض عنها التراب، تتحرك وتنبض وتتنفس في قلب العصر، مقدمة الشاهد (العلمي) على قدرتها التي لا يأسرها زمن أو مكان، على متابعة المتغيرات والشهادة عليها.
والمسألة قد لا تكلف كثيراً، فبمجرد أن يبذل الأستاذ جهداً مخلصاً لترتيب منظومة من موضوعات البحث الخاص، في بدء كل عام دراسي، وتوزيعها على طلبة المرحلة المنتهية وفق توجهاتهم ورغباتهم وقدراتهم المعرفية قدر الامكان، ثم متابعة عملهم أولاّ بأول، من أجل أن تأتي بحوثهم بشكل أكثر إحكاماً وإبداعاً.
وبمجرد أن يتحقق هذا وذاك فان حصيلة طيبة قد تتمخض عنه متمثلة بحشود من البحوث التي تمرّن الطالب على البحث، وتمنحه الدربة المنهجية الكافية، والتي تقدم -في الوقت نفسه- نويّات أو مشاريع بحوث قد ترفد المكتبة الإسلامية أو تعدها بالمزيد من العطاء.
والذي يحدث -في كثير من الأحيان- اعتبار البحث الخاص، مفردة اعتيادية في مناهج المعاهد والكليات، كأية مفردة أخرى، قد لا تقتضي وقفة خاصة أو جهداً مضافاً أو اهتماماً كبيراً، وبالتالي فان التعامل معها سيتحرك عند السفوح الدنيا، فلا يبدع ولا يعلّم ولا يبتكر ولا يضيف جديداً. بل قد تنعكس الحالة أحياناً لما هو أسوء من هذا، وهي تأكيد عقلية التقليد والاجترار، والتعلّق بتقاليد عصور تجاوزها التاريخ، بل -ربما- تعميق “النفرة” في نفسية الطالب ازاء كل ما يتعلق بعلوم الشريعة، واندفاعه -في المقابل- صوب ما يعتبره تحققاً أكثر مع الحياة التي يعيشها بعقله ووجدانه، بعيداً عن مطالب الشريعة ومقتضياتها.
وبموازاة هذا، وفي حلقة تالية، أكثر أهمية، لم يحسن التعامل مع مرحلة الدراسات العليا: (الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه) ولم توظف هذه الفرصة الفريدة للتعامل مع موضوعات غير تقليدية، تعين على تحقيق الهدف المنشود. وها هنا أيضاً، يتحتم “الإحسان” في اختيار الموضوعات المناسبة لهذه الرسائل والأطاريح وتوضيح مبرراتها، وترتيب خططها، بما يجعل الطالب أقدر على التعامل معها وفق منهج أكثر دقة وإحكاماً.
ويتذكر المرء في هذا السياق ما فعلته وتفعله مؤسسة (كالمعهد العالمي للفكر الإسلامي) من وضع منظومة بحوث للدراسات العليا: بعناوينها، ومفرداتها، وخططها، ومسوّغاتها، ومستوياتها الأكاديمية، بين أيدي الباحثين، ليس هذا فحسب، بل الإعانة –أحياناً- على اختيارها وتنفيذها، ونشرها في نهاية الأمر، من أجل دعم أهداف المعهد وتوجهاته الأساسية في التأصيل الإسلامي للمعرفة.
فلا يكفي -في هذه المرحلة- أن نترك الطالب يختار موضوعه، فقد يكون هذا الموضوع تكراراً لما سبق وأن عولج أكثر من مرة، وقد يكون غير مناسب، كمشروع عمل لمرحلة الماجستير أو الدكتوراه، وقد يأتي -وهذا هو الأهم- بنتائج معاكسة قد تدفع الطالب، والقارئ معاً، إلى تأكيد العزلة والانفصام بين الشريعة والحياة.
ولا يتطلب الأمر أكثر من بذل اهتمام أكبر في مسألة الاختيار، وأن يدخل الأساتذة المشرفون، الذين يفترض فيهم الإخلاص والعلم والجدية، في مجال تخصصهم، بشكل أكثر فاعلية في إعانة الطالب على العثور على الموضوع المناسب، والأخذ بيده قدر الامكان، من أجل تنفيذ رسالة أو أطروحة ذات مستوى عالٍ منهجاً ومضموناً وتوثيقاً.
هناك ضرورة تنمية الخبرات التدريسية لطلبة الشريعة، قبيل تخرّجهم، وتعميق قدرتهم على الخطاب الإسلامي من خلال الدورات التدريبية، والاستفادة من علوم النفس والتربية وأصول التدريس، ومنحهم الفرصة “التطبيقية” المناسبة في التدريس في المتوسطات والثانويات أسوة بما تفعله كليات التربية التي تبذل جهداً مضافاً على المطالب الأكاديمية، من خلال منح طلبتها المعرفة والخبرة والآليات التي تمكنهم من أن يكونوا “مدّرسين” أكفاء. وقد ينضاف إلى الخبرة التدريسية بالنسبة لطلبة العلوم الشرعية، الخبرة الخطابية التي يمكن أن تحفز وتمنح الدربة الكافية من خلال فرص التطبيق عبر سني الدراسة الجامعية.
هناك –أيضاً- ضرورة تحفيز كليات الشريعة ومعاهدها على صياغة وتنفيذ برامج عمل مؤسسية تضعها في قلب العصر، وتزيد من فاعليتها، وتدفعها، إدارة وأساتذة وخرّيجين، إلى المواقع القيادية المؤثرة في المجتمع، فيما يمكن أن يكون واحداً من المهمات الأساسية لمؤسسات مشروع إحياء نظام تربوي أصيل.
لقد أخذ هذا التقليد، الذي يعمل تحت شعار “الجامعة والمجتمع” ينتشر أكثر فأكثر على مستوى العديد من الكليات والأقسام العلمية عبر العقود الأخيرة، فصرنا نجد مكاتب أو مؤسسات استشارية في هذا القسم أو ذاك من كليات الهندسة، أو العلوم، أو الطب، أو الزراعة، أو القانون، أو الإدارة، أو الاقتصاد، أو السياسة، أو -حتى- التربية والآداب. وأصبحت هذه المكاتب تحقق -بمرور الوقت- أكثر من هدف، ففضلاً عن الالتحام أكثر بالمجتمع والحياة، وفضلاً عن منح الفرصة للكفاءات الميدانية للتنفيذ، والإضافة، والاكتشاف والإبداع، فان هذه المؤسسات تجيء بمثابة فرصة مضافة لتعميق القدرات التخصصية والمعرفية للتدريسيين، وربما لطلبتهم كذلك. هذا إلى أن ممارسات كهذه تدّر دخلاً موفوراً يعين الأقسام والكليات، والإدارة الجامعية في نهاية الأمر، على توظيف هذا المردود لمزيد من العطاء والإبداع.
لماذا تظل معاهد الشريعة وكلياتها -في معظم الأحيان- بمعزل عن هذا كله؟ في الوقت الذي يتحتم أن تكون أكثر إفادة من هذه التجربة بسبب من كثرة القنوات التي تصل بينها وبين المجتمع الذي طالما انتظر الإشارة من علمائه وفقهائه لكي يعدلوا وقفته هنا، ويعينوه على المضيّ هناك وفق أكثر الصيغ التزاماً بمطالب هذا الدين؟
لا يسمح المجال في الاستفاضة، فلابّد –إذن- من الاكتفاء بالتأشير على بعض الحلقات الممكنة في ممارسة كهذه من مثل: النشر، مشاريع التأليف المشترك، التحقيق والفهرسة، الأعمال الموسوعية، الحلقات الدراسية، الندوات والمؤتمرات، الإنتاج الفني والإعلامي، إقامة الجسور وتوسيع التعامل مع المؤسسات المعنية بالمعرفة الإسلامية، المشاركة الفعالة في أنشطة التأصيل الإسلامي للمعرفة وصياغة حيثيات المشروع الحضاري، البحوث والدراسات والمقترحات الاستشارية.
سأقف لحظات عند إحدى هذه الحلقات كمقترح للعمل يمنح مشروع إحياء نظام تربوي أصيل فرصة ميدانية أخرى للتحقق، ويدفعه باتجاه مزيد من الالتحام بالحياة الاجتماعية، وبالواقع اليومي لجماهير المسلمين.
يتضمن المقترح إصدار دورية، أو سلسلة كتب ميّسرة في الفقه، تعالج المسائل المعاصرة والمستجدة، فضلاً عن القضايا الثابتة، وتعتمد أسلوباً حديثاً للغة، ومنهجاً يسعى لتوحيد المواقف في الحالات الخلافية الحادة التي تحيّر المسلم وتربكه.
يمكن تسمية المحاولة المقترحة بالمورد، أو الدليل الفقهي للمسلم المعاصر، أو المنهاج الفقهي، أو كتاب الجيب الفقهي لمفردات المسلم اليومية… أو غيرها من التسميات… والمهم أن يبذل المشروع جهداً حيوياً في تقديم البدائل الفقهية الواضحة المحددة لعدد من مفردات الحياة والسلوك، وبخاصة تلك القضايا الملحة من مثل (شروط الزكاة في زمن تحوّل النشاط المالي والاقتصادي، إلى شبكة معقدة من المعطيات التي تنطوي على عشرات الحالات وهي جميعاً تنتظر الجواب الفقهي… ومن مثل قضايا الزواج والأحوال الشخصية، والتعليم والعمل الوظيفي، وعمل المرأة والمساحة المتاحة لها للتحرك في الحياة العامة، وشروط الحجاب، ومعضلات الجاليات الإسلامية في الديار غير الإسلامية، ووسائل الترفيه… إلى أخره).
إن المحاولة ترتبط ولا شك بمسألة فتح باب الاجتهاد، أو توسيع قنواته، فلابدّ -أولاً- من تنفيذ جهد عملي وآخر دراسي لإضاءة هذه المسألة، وقد يجيء الدليل المقترح محاولة عملية لاختبار إمكان تحقيق تغطية فقهية لأهم المستجدات.
ويستحسن من أجل نجاح المحاولة، أن يقتصر الدليل، أول الأمر، على مسائل محددة وربما مسألة واحدة، كالزكاة، لكي تكون أشبه بجهد تجريبي لغرض اختبار مدى نجاحه وانتشاره، وبعدها يمكن التحول لإصدار جزء آخر يعالج مسألة أخرى كقضية الزواج، أو العمل الوظيفي، أو دور المرأة، أو التوظيف الإعلامي… الخ.
على المستوى الفني يمكن أن ينفذ المشروع بصيغة دورية أو مجلة فصلية تمضي أعدادها لتغطية المفردات الملحة واحدة إثر أخرى، أو بصيغة كتاب ذي أجزاء متتالية يختص كل جزء بموضوعة ما، ويتم توزيع المفردات على عدد من خيرة الفقهاء الذين يجمعون بين الإلمام بالعلوم الشرعية وبين الانفتاح على الثقافة المعاصرة وتحدياتها.
ويمكن -كذلك- من أجل كسب الوقت ولأغراض إعلامية، فتح ملف في واحدة أو أكثر من المجلات الإسلامية المعنية بالموضوع، تطرح فيه المسائل المنهجية والفكرية والفنية التي يتطلبها المشروع، وقد تمضي المجلة للبدء في معالجة إحدى المفردات ووضع الحلول الفقهية لجوانبها كافة ثم التحول إلى مفردة أخرى، لكي تتشكل في نهاية الأمر بديات جادة للدليل المقترح.
وقد يكون في سياق جهد كهذا القيام بمحاولة ببليوغرافية لحصر وفهرسة جل الجهود الدراسية التي عالجت المسائل الفقهية من خلال رسائل وأطاريح الدراسات العليا، أو في المؤلفات المستقلة، أو على صفحات الدوريات المتخصصة، أو في إصدارات المؤسسات الشرعية والفقهية والقضائية والتشريعية.
وقد يكون مهما -كذلك- وضع منظومة من الموضوعات الملحة، مع المسوّغات والخطط البحثية التفصيلية المرسومة بعناية، لكي تكون بمثابة حقل للاختبار بالنسبة لطلبة الدراسات العليا، ويستحسن توزيع كراريس مستقلة بهذه الموضوعات ومسوّغاتها وخططها على المعاهد والجامعات والمؤسسات المعنية بالدراسات العليا في مجال الفقه والعلوم الشرعية.
إن معضلات العصر الحديث ومستجداته تمثل تحدياً ملحاً للعقل المسلم، وهي بمثابة اختبار لقدرته على الفاعلية في صميم العصر من خلال اعتماد وتحكيم الأصول الإسلامية: القرآن والسنة والسوابق الفقهية، وان الاستجابة لهذا التحدي لا تحقق فقط إجابة على العديد من الأسئلة الملحة في معترك الحياة، وانما تؤكد -على المستويين العقدي والحضاري- قدرة هذا الدين على إعادة صياغة الحياة في كل زمن ومكان وفق تصوراته المتميزة، وهي مسألة ترتبط -مرة أخرى- أشد الارتباط بالمشروع الحضاري الذي يتوخاه المسلم الجاد بمواجهة، أو كبديل، عن كل الإخفاقات التي شهدتها القرون الأخيرة بسبب الممارسات الإسلامية الخاطئة نفسها، أو بتأثير من ضغوط الآخر، وغزوه الفكري، والحضاري بوجه عام.
ثمة -فضلاً عن هذا وذاك- ضرورة إغناء الخبرات المعرفية والتخصصية لأساتذة علوم الشريعة وطلبتها من خلال التوسع في تنفيذ نظام الأساتذة الزائرين ذهاباً وإياباً (أي استدعاء أساتذة من أقسام وكليات وتخصصات أخرى لإلقاء محاضرات في أروقة الشريعة، وإرسال أساتذة الشريعة إلى الأقسام والكليات الإنسانية للاحتكاك ببيئات تدريسية ومعرفية متنوعة). وهذا سيمنح التدريسيين والطلبة معاً خبرات أكثر تنوعاً وخصباً على مستوى الأداء التدريسي من جهة، وإغناء التخصص وتعميقه من جهة أخرى، ويحقق حواراً فعالاً بين علوم الشريعة والعلوم الإنسانية لتحقيق التحام أكثر بمطالب العصر ومقتضياته، واستجابة أشد فاعلية وتنوعاً وخصباً لمشاكله وتحدياته.
ولابد –أخيراً- من الإشارة إلى تجربة عدد من المعاهد والجامعات الإسلامية التي بدأت منذ عدة عقود، في هذا البلد أو ذاك، في تنفيذ مناهج أكثر حداثة في التعامل مع علوم الشريعة وتدريسها، فكسرت طوق العزلة، والتحمت أكثر بمطالب العصر، وقدرت على توظيف معارفه وتقنياته لتقريب أهدافها، وحققت الوفاق الضائع بين المعرفتين الإسلامية والإنسانية، وسعت -ولا تزال- لإقامة الجسور المقطوعة بين الفقيه والمفكر، من أجل أن تضع الفقيه في قلب الحياة، وتمنح المفكر خبرة بالمعرفة الإسلامية، تعينه على التأصيل، وتحميه من غوائل الارتجال والجنوح.
لا يستطيع المرء أن يكون مبالغاً في التفاؤل، ولكن رحلة الألف ميل تبدأ -كما يقول المثل- بخطوة واحدة، ويكفي هذه المعاهد والجامعات أنها وضعت خطواتها الأولى على الطريق، ونفّذت شيئاً من المأمول، وهو كثير، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جلّه.
ومهما يكن من أمر فان معاهد وجامعات كهذه تمثل فرصة جيدة لمؤسسات مشروع إحياء نظام تربوي أصيل، للاستفادة من خبرتها، وإقامة الجسور معها، والمضي لإغناء مطالب اللقاء والالتحام بين المعرفتين الإسلامية والإنسانية بالمزيد من المعطيات.
3. تحليل المعطيات الغربية في احتمالات الانبعاث والمشاركة :
لو حاولنا تحديد دور المسلم عامة في العصر الراهن “ما كان لنا أن نختار سوى ما اختاره الله له دوراً في التاريخ بقوله عز وجل : ]وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدا ً[ ( البقرة : 143). هكذا يحدد الله سبحانه دور المسلم بعامة، وليس لنا أن نختار له دوراً أشرف وأفضل منه، وانما نلفت النظر إلى خطورة هذا الدور وإلى مقتضياته التي هي من اختصاص الفقهاء والحقوقيين لأنهم يعرفون شروط تزكية الشهادة والشاهد من الناحية العقلية والأخلاقية معاً.”([67])
لكن ذلك لن يتم -كما يؤكد مالك بن نبي- دون أن يرفع المسلم مستواه بحيث يستطيع فعلاً القيام بهذا الدور. إذ بمقدار ما يرتفع إلى مستوى الحضارة بمقدار ما يصبح قادراً على تعميم ذلك الفضل الذي أعطاه الله له (أعني دينه). إذ عندها فقط يصبح قادراً أيضاً على بلوغ قمم الحقيقة الإسلامية، واكتشاف قيم الفضيلة الإسلامية، ومن ثم ينزل إلى هضاب الحضارة المتعطشة فيرويها بالحقيقة الإسلامية وبالهدى، وبذلك يضيف إليها بعداً جديداً. لأن الحضارة العلمانية، حضارة الصاروخ والإلكترون اكتسبت هذه الأشياء وضيّعت بعداً آخر تشعر بفقدانه وهو بعد السماء.([68])
إن هذا المسلم الواعي هو إنسان الغد “إذا كتب الله السعادة للبشرية، فهو يمتلك كل المؤهلات اللازمة لتصحيح مسيرة البشرية وتحويلها عن الدمار الذي تسير نحوه في ظل الحضارة الغربية التي صارت موضع شك كبير في صلاحيتها من قبل فلاسفتها أنفسهم، منذ أن كتب اشبنغلر (أفول الغرب) وحتى ظهور كتابات الناقد كولن ولسون: (سقوط الحضارة) و (اللامنتمي).”([69])
فإذا كان الإسلام هو الأمل الوحيد في “خلاص البشرية من ضعف الرشد الديني، وفقدان القيم الخلقية المطلقة، وغياب نظرية واعية عن علاقة الإنسان بالكون تعطي الوجود معنى وقيمة، ومن بدائية التفكير الاجتماعي، فان قائد عملية التغيير هذه لن يكون سوى المسلم الواعي بأهداف الرسالة الإسلامية ومضامينها، والقادر على تحليل واقع المجتمعات الحديثة، مع الاجتهاد في طرح الحلول المناسبة لها عن طريق الاستنباط من نصوص الكتاب والسنة، مع الاستعانة بالتراث العقدي والتشريعي الهائل الذي وصل إلينا من عصور تألقنا وعبر قرون الإسلام الأولى.”([70])
وخلاص البشرية الذي يعد به الإسلام لن يتحقق، بل لن يبدأ عمله، بطبيعة الحال، قبل أن ينهض المسلمون من كبوتهم، ذلك “إن مجتمعات العالم العربي والإسلامي تعاني -اليوم- من تخلّف مأساوي، لذلك فان تعبئة طاقات الأمة وتحريكها لخوض المعركة المصيرية ضد هذا التخلف الذي يعيق حل مشاكل وقضايا الأمة الكبرى الداخلية والخارجية، هو ضرورة موضوعية، وهذه المعركة
لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا إذا اكتسبت إطاراً يستطيع أن يدمج الأمة ضمنه، فحركة الأمة كلها شرط أساسي لإنجاح أي عملية بناء حضاري ونهضة شاملة، وحين نفتش عن هذا الإطار أو المنهاج فيجب البحث عن مركب يدخل في الحساب مشاعر الأمة ونفسيتها وذاكرتها الجمعية وتكوينها العقائدي والأخلاقي. وهذا ما نتعلمه من تجربة العقود القليلة الأخيرة من محاولات التحديث والتقدم.”([71])
إن الحضارة الإسلامية نفسها قامت -يوم انطلاقها- بعملية التجديد ببعدها المزدوج السلبي والإيجابي، وفي آنٍ واحد، وصدرت فيهما عن القرآن الكريم الذي نفى الأفكار الجاهلية البالية، ثم رسم طريق الفكرة الإسلامية الصافية التي تخطط للمستقبل بطريقة إيجابية. وهذا العمل نفسه ضروري اليوم للنهضة الإسلامية.([72])
والانبعاث الحضاري المرجو للأمة، والذي تنطوي معالجته على البعد التربوي الذي يستهدفه مشروع الاحياء، يقودنا بالضرورة إلى قضية مستقبل العالم والمشاركات الإسلامية المحتملة في المصير، والتي تمثل واحدة من أهم حلقات الدرس الحضاري.
ومما لا ريب فيه أن انعكاس المبادئ والقيم الإسلامية على مساحات واسعة من النشاط الحضاري عبر التاريخ، منحه خصائصه النوعية المتميزة. التي يمكن أن تمثل ليس مبرر استمراره في العالم فحسب، بل قدرته على اقتحام وإغناء شبكة النشاط المعرفي للحضارة الراهنة، والقدرة الفعالة على الإسهام المستقبلي فيه.
وإذا كان هدف العقيدة هو تكوين الإنسان المؤمن المتبّصر الفاعل المتوازن والسعيد، فان النشاط الحضاري المنضبط بالرؤية الإيمانية يجيء إعانة على تحقيق هذا الهدف. ونحن نستطيع أن نتصور القيمة الحقيقية لنشاط كهذا بمجرد أن نتذكر ما الذي فعلته الحضارات اللادينية بالإنسان والجماعة البشرية.
ليس هذا مجال الحديث المستفيض عن هذه المسألة وانما التأشير عليها فحسب. فان ما يعانيه الإنسان في البيئات التي رفضت الإيمان، أو عزلته عن مجرى الحياة الواقعة من تعاسة وازدواج وتمزق وشقاء نفسي وروحي وعاطفي واجتماعي، رغم ارتفاع منحنيات الإنجاز المادي والخدمي، أمر ملحوظ ينطق به واقع الحال هناك، وتؤكده شهادات المفكرين وإعلامهم الذي يمكن للمرء أن يلتقي به صباح مساء في عصر التواصل السريع.
ثم ان هذا النشاط المنشق عن مطالب الإيمان اندفع باتجاه إغراءات القوة، والتسلط، ونداء الأنانيات العرقية والدولية والمذهبية، ومضى أبعد من هذا باتجاه كل ما هو لا أخلاقي في السلوك البشري، لكي يحول المنجزات والكشوف المعرفية إلى سلاح يشهر بوجه الإنسان وليس لصالح الإنسان.
إن إنتاج القنابل الذرية والهيدروجينية والنيوترونية والأسلحة الجرثومية والذرية التكتيكية… الخ، واستعمالها في اللحظات الصعبة -كما حدث ويحدث في هيروشيما وناغازاكي وأفغانستان والعراق وفلسطين- ليؤشر بشكل واضح على الكارثة التي يمكن أن يساق إليها الإنسان والبشرية، إذا أتيح للمعرفة أن تظل على جموحها، على خروجها عن مطالب الإيمان العليا، على عدم انضباطها بالقيم والموازين الإلهية العادلة التي تجعل القوة والحكمة -دوماً- في كفتي ميزان.
هذا إلى أن المعرفة المؤمنة، على خلاف المعرفة اللادينية أو الملحدة، تسعى لأن تمنح أكلها للناس كافة، لا تحكمها أنانية الحفاظ على السرّ، وحجب الاكتشاف -بدافع براغماتي- عن الآخرين. إن الإنسان، مطلق إنسان، هو المستفيد في نهاية الأمر من المعرفة المؤمنة، وبالمقابل فان عشرات من الأمم والشعوب لم تحرم بالمعرفة اللادينية من حقها المشروع في الإفادة من ثمار هذه المعرفة فحسب، وانما وجهت نتائجها وكشوفها -في أحيان كثيرة- إلى أسلحة فتاكة لتدمير هذه الجماعات واستعبادها والهيمنة على مقدراتها.
إن الدلالة المعاصرة والمستقبلية لمغزى الحضارة الإسلامية، كما تحققت في التاريخ، تتكشف أكثر فأكثر بالمضي في متابعة الخصائص التي تعد بوضعها في حالة تقابل مع خصائص الحضارات الأخرى، والغربية الراهنة منها على وجه الخصوص، إضافة، أو تعديلاً ضرورياً لمسير هذه الحضارة، لأنها قديرة على تقديم البدائل المناسبة لحالات الخطأ والجنوح التي تعاني منها.
إن الخصوصية الإيمانية للحضارة الإسلامية -مثلاً- تقف بمواجهة التوجّه المادي المتزايد للحضارات الأخرى، والتزامها يلجم تفلتها الآخذ بالاتساع من منظومة القيم الخلقية، وواقعيتها تحدّ من شطط تنظيراتها الفكرية باتجاه طوباويات الحلم والخيال، وأصالتها تمنح المسار البشري طعماً جديداً متميزاً، وشموليتها، وقدرتها على موازنة الثنائيات ولّمها، توقف اندفاع المعارف والثقافات الأخرى، وميلها إلى هذا الجانب أو ذاك على حساب الجوانب الأخرى التي قد لا تقل أهمية وإلحاحاً… وإنسانيتها تتجاوز بها حواجز العرق واللون والجغرافيا والطبقة والمذهب، وميزتها التحريرية ستنقذ الإنسان في نهاية الأمر من سائر الضغوط والصنميات التي أذلت عنقه وهبطت به درجات عن مستوى بشريته كمخلوق متفرد في هذا العالم، وسيّد على مخلوقاته وموجوداته.
والباحثون الغربيون أنفسهم انتبهوا إلى هذا، وقدموا شهاداتهم بهذا الخصوص، والتي تجيء كاعتراف حر مدعم بالقناعات العقلية، وموثّق بالرؤية المقارنة لما تتضمنه حضارة الإسلام من قيم وخصائص متميزة، وفعالة، يمكن أن تمارس دورها في صياغة حاضر الإنسان ومستقبله.
إن هذا الدين، كما يقول (مارسيل بوازار) رجل القانون الدولي الفرنسي المعاصر، “يعود إلى الظهور في العالم المعاصر بوصفه أحد الحلول للمشكلات التي يطرحها مصير الإنسان والمجتمع”([73])، ولطالما أعرب عن اقتناعه “بأن في وسع العالم الإسلامي -من بين عوامل أخرى- أن يقدم مشاركة أساسية في تكوين المجتمع الدولي المرتقب.”([74]) وأنه “يبدو أحد العوامل الممكنة الهامة في الإنسانية العالمية الحديثة… وهو مستمر في البحث عن الأشكال الكفيلة بالتعبير بصورة ملائمة عن تطلعاته.”([75])
والمسلمون، كما يؤكد الرجل “لا يشكون على الإطلاق في أن التعاليم المنزلة والقيم المراكمة عبر العصور كفيلة بتقديم حل لمعضلات العالم المعاصر.”([76])
ولم يفت (بوازار) أن يشير إلى أن التقدم العلمي المادي لا يكفي وحده ما لم تضبطه القيم الخلقية، فتوجهه بالتالي لصالح الإنسان. ومن خلال هذه الرؤية للنشاط المعرفي المادي يمكن للإسلام “أن يؤدي دوراً حقيقياً في تنظيم العالم المعاصر” عندما يتقدم إليه “بمفهومه السامي للقيم الخلقية.” ([77])
وأهمية المشاركة الإسلامية تبدو في نظر (بوازار) في التوازن الذي يمنحه الإسلام، بما أنه تعبير عن روح ديني، لمسيرة المجتمع البشري، بين التقدم المادي (التقني) وبين المطامح الروحية والإنسانية عامة… لاسيما وأن “الانخراط في المجتمع التكنولوجي، والمواجهة بين الإسلام والثورة التقنية، لا تدفع المسلم إلى إنكار موقفه الديني، بل إلى تعميقه أمام العالم وأمام الله، متوجباً عليه… محاولة إدراك الامكانيات بشكل أفضل في إطار إسلامي شامل.”([78])
إن (بوازار) يضع يده ها هنا على واحدة من أهم خصائص المنظور الإسلامي للنشاط الحضاري، إنها معادلة التوازن الملّح والمطلوب بين الديني والدنيوي، بين السماء والأرض، وبين الروح والجسد، فليس ثمة إيمان متحقق في واقع الحياة إن لم يعبر عن نفسه في إطار نشاط تتداخل فيه وتتوحّد وتتناغم سائر الثنائيات. والمواجهة بين الإسلام والثورة التقنية بالتالي، ليست مواجهة أضداد متقابلة، بل هي مقاربة واحتواء وتوظيف للقدرات والامكانات التقنية من أجل تكوين حياة إسلامية أكثر أصالة وتقدماً. إن القناعة الدينية، كما يستنتج (بوازار)، “تفرض نفسها حكماً مطلقاً على كل المستويات، ولا يمكن بدونها، أو بالحري على النقيض منها، مواجهة أي تغيير اجتماعي ولا أي تجديد مادي.”([79])
وهذا الارتباط المحتوم بين الدين والتكنولوجيا في المنظور الإسلامي، لا يعني البتة أن الحضارة الإسلامية ستقود “تطورها داخل انبيق”، وبمعزل عن العالم، بل على العكس تماماً، فان هذه الحضارة “المتسامحة والمنفتحة بشكل طبيعي… تتطلع إلى العمل بصفة شريك فعال في الحياة الدولية”([80])، ويكفي أن نتذكر الجنوح المادي الذي تعانيه حضارة الغرب، يكفي أن نفكر في احتمالاته المنذرة بالخطر، والمتوعد لأماني الإنسانية، وللإنسان ذاته، لكي نعرف أن دخول الإسلام إلى الساحة، وإعادته الأمر إلى نصابه بتحقيق التوازن المطلوب، ليس مجرد مشاركة فعالة، وانما هو عملية إنقاذ للوضع البشري المنحرف عن الصراط.
وإذ يؤكد (بوازار) ما يقدمه القرآن الكريم في هذا السياق من “ثقة مطمئنة وحافز قوي في وقت معاً” فانه يحذر من “أن إسلام المستقبل ودوره في العلاقات الدولية” لا تجيء به الأماني والأحلام وانما هو “رهن بما يصنعه المسلمون أنفسهم.”([81])
وما قاله (بوازار) عن احتمالات الدور التوازني للحضارة الإسلامية في مستقبل العالم، وما يمكن أن تفعله الأسس الدينية لهذه الحضارة وإلزاماتها القيمية في ضبط وتوجيه النشاط المعرفي لصالح الإنسان، يمكن أن نلحظه -كذلك- لدى (ليوبولد فايس: محمد أسد) وبمزيد من التفاصيل والمقارنات، فهو يشير إلى أننا “قد نكون، نحن المحدثين، بحاجة إلى تلك الرسالة بأكثر مما احتاج إليها الناس في أيام محمد (ﷺ). إنهم كانوا يعيشون في بيئة أبسط كثيراً من بيئتنا نحن، وكانت مشاكلهم ومصاعبهم أسهل حلاً وأيسر إلى حدّ كبير. لقد كان العالم الذي كنت أعيش أنا فيه -كل ذلك العالم- يترنح بسبب من فقدان أي اتفاق على ما هو خير وما هو شرّ روحياً، وبالتالي اجتماعياً واقتصادياً أيضاً. إنني لم أكن أؤمن بأن الإنسان الفرد كان بحاجة إلى (الخلاص)، ولكنني كنت أؤمن فعلاً بأن المجتمع الحديث كان بحاجة إلى الخلاص. لقد شعرت أكثر من أي وقت مضى، بأن عصرنا هذا كان بحاجة إلى أساس أيديولوجي لمستوى اجتماعي جديد: بحاجة إلى إيمان يجعلنا نفهم بطلان الرقي المادي من أجل الرقي نفسه، ومع ذلك يعطي الحياة الدنيا حقها. إيمان يبيّن لنا كيف نقيم توازناً بين حاجاتنا الروحية والجسدية، وبذلك ينقذنا من الهلاك الذي نندفع إليه برعونة وتهوّر.”([82])
إن القضية بإيجاز هي أن يكون للحياة البشرية معنى أكبر وأعمق من مجرد التكاثر بالأشياء، وأن على المسلمين إذا أرادوا -بحق- أن يقوموا بدور في المستقبل، الاّ يسمحوا للأشياء بأن تجرّهم بعيداً عن جذورهم الروحية وقيمهم الأخلاقية التي منحهم الإسلام إياها “فلو أنهم احتفظوا برباطة جأشهم وارتضوا الرقي وسيلة لا غاية في ذاتها، إذن لما استطاعوا أن يحتفظوا بحرّيتهم الباطنية فحسب، بل ربما استطاعوا أيضاً أن يعطوا إنسان الغرب سرّ طلاوة الحياة الضائع.”([83])
لقد اندفعت الحضارة الغربية بعين واحدة، وبمرور الوقت أخذت تفقد قدرتها على إبصار كل ما هو روحي وأخلاقي، وبما أن هاتين القيمتين ترتبطان بالوجود البشري ارتباطاً صميماً، وتميزانه عن بقية الخلائق والموجودات، فان التقدم المادي الذي يمضي بعيداً عنهما لن يخدم الإنسان في نهاية الأمر، ولن يأمن من عواقب الاندفاع الذي لا تضبطه قيم ولا توجهه معايير، ولسوف تكون النتائج في المستقبل أشد خطراً، لأن التراكم المادي يتزايد بحسابات مذهلة لمتوالية هندسية، ويبعد أكثر فأكثر عن أي كابح أخلاقي أو استبصار روحي لمغزى الحركة ومعناها الأخير. من ثم فان أحداً لا يمكن أن يتهم مفكراً كـ (جورج سارتون)، غرق في دراسة تاريخ العلوم حتى شحمة أذنيه، بالمبالغة وهو يحكم على “التقدم المادي الخالص” بأنه أمر “مدّمر” وأنه “ليس تقدماً على الإطلاق بل تأخر أساسي” ذلك “أن التقدم الصحيح -ومعناه تحسين صحيح لأحوال الحياة- لا يمكن أن يبنى على وثنية الآلات ولا على العتلات، ولكن يجب أن يقوم على الدين وعلى الفن، وفوق ذلك كله على العلم، على العلم الخالص على محبة الله، على محبة الحقيقة، وعلى حب الجمال وحب العدل. وهذا يبدو لنا جلياً حينما نلقي نظرة واحدة إلى الوراء… إن ما نراه واضحاً هناك يجب أن يكون واضحاً أيضاً حينما نمدّ نظرنا إلى الأمام فيهدي خطانا إلى المستقبل.”([84])
والمدنية، كما يؤكد (سارتون) “ليست مرضاً، ولكن من الممكن أن تنقلب شراً وفساداً “([85])، وذلك بمجرد أن تفقد بطانتها الروحية وتتنازل عن ضوابطها الأخلاقية فتغدو مجرد محاولة للتكاثر المحض لا هدف لها ولا مغزى. ثم أن المدنية ليست حكراً على بيئة دون أخرى، إنها بتعبير (سارتون) ” ليست شرقية ولا غربية، وليس مكانها في واشنطن أكثر مما هو في بغداد، انها يمكن أن تكون في كل مكان يكون فيه رجال صالحون ونساء صالحات يفهمونها ويعرفون كيف يستفيدون منها من غير أن يسيئوا استعمالها. والشرق الأوسط كان مهد الثقافة ومنه جاءت أسباب إنقاذ العالم في أثناء العصور الوسطى حينما بدأ الستار الحديدي في أوربا يشطر العالم شطرين: الارثذوكسي والكاثوليكي. وها نحن اليوم ننظر إلى ماضي الشرق الأوسط بعين من عرفان الجميل ثم نرنو إلى مستقبله بعين من الأمل الحلو”([86])، وليس ذلك بالأمر المستحيل كما قد يخيل للبعض فان “شعوب الشرق الأوسط قد سبق لها أن قادت العالم في حقبتين طويلتين… وليس ثمة ما يمنع تلك الشعوب من أن تقود العالم ثانية في المستقبل القريب أو البعيد.”([87])
ولن تكون ممارسة الدور من خلال قدرات يتفوق فيها الغير بطبيعة الحال، انما بالتحقق بشيء كبير لا يملكه (الآخر) أو يعرف عنه شيئاً، فان الحضارة المادية لن تجعل الغرب يخلي الزمام لمن هم أقل شأناً في ميادينها كافة، ولكنها العقيدة التي تحتوي النشاط الحضاري، وتمنح المسيرة البشرية المغزى والهدف، تعيد إلى الغربيين أنفسهم ما فقدوه: “سرّ طلاوة الحياة الضائع” إذا استعملنا عبارة “ليوبولدفايس”.
وتؤكد (جميلة قرار) النمساوية التي اعتنقت الإسلام أن هذا الدين “هو في الحقيقة حركي” وأنه يستطيع “بفضل جهود المسلمين أن يشكل قوة ثورية تحرر الإنسان من العبودية للقوة، وخاصة القوة المدمرة المهلكة، وأن تقوده إلى التقدم البناء وتمكنه من تطوير قدراته وإمكاناته الإيجابية المختلفة”([88])، وهي تدعو “المسلمين المستنرين” إلى أن يبيّنوا لغير المسلمين “أولئك الذين يبحثون عن غايات جديدة وقيم لحياتهم، ان الإسلام هو نقطة البدء الجديدة أمام الإنسانية جمعاء”([89]) وهذا لا يعني بالتأكيد أي قدر من التنازل عن المكتسبات المادية، والمدنية عموماً، ذلك “ان الإسلام بصفته ديناً عالمياً وعقيدة كونية يعتبر مناسباً لكافة مراحل تطور الحياة الإنسانية في المستقبل. فهو ينسجم مع منجزات الإنسان الحديثة في كافة مجالات النشاط الإنساني.”([90])
ويشير (كويلر يونغ) إلى الإسهام الفعال للثقافة الإسلامية “في الحضارة العالمية المعاصرة… فليس من المعقول لثقافة حية كثقافة الإسلام… ألاّ يكون لها تأثير بالفعل أو بالقوّة”([91]) في معطيات المعرفة الراهنة وتشكلها في المستقبل. هذه المشاركة التي يؤكدها (درمنغهم) بصيغة تحقيق للتواصل بين الغرب والشرق، وإرفاد لعالم المستقبل “بأذخار العالم القديم”([92])، ويراها (اتبين دينيه) تبشر
“بمستقبل حافل بأعظم الآمال وأعلاها شأناً” وبإسهام حضاري فعال، وبتكشف متزايد لسنا الإسلام الحقيقي.([93])
أما المؤرخ البريطاني المعاصر (مونتغمري وات) فيؤمل بأن المسلمين سوف ينجحون رغم المصاعب “في جهدهم للتأثير على الرأي العام العالمي، على الأقل فيما يتعلق بالمبادئ الأخلاقية. وربما أمكنهم في ميدان الأفكار الدينية الأوسع، أن يساعدوا على اغناء العالم لأنهم احتفظوا بقوة كبرى في التعبير عن بعض الأفكار كحقيقة الله [سبحانه]، تلك الأفكار التي أهملت ونسيت في كثير من الطوائف والأديان الأخرى الموحدة.”([94])
ونصل في نهاية المطاف إلى (غارودي)، فان كتابه (وعود الإسلام) يعد بملاحظات خصبة عن المشاركة العالمية للحضارة التي شكلها هذا الدين. إن عنوان الكتاب يحمل بعداً مستقبلياً، وبالتالي فان مادته القيمة ستصب هناك لكي ترسم للإنسان المعاصر، الحائر، الممزق، ما يمكن أن تقدمه له الخبرة الإسلامية.
تتحرك ملاحظات (غارودي) حول المشاركة الإسلامية على عدد من المحاور، أهمها ولا ريب: توازن الإسلام ووسطيته، قيمه الأخلاقية، ثم رؤيته الشمولية وقدرته الفذة على منح المغزى لمسيرة الحياة البشرية في هذا العالم، “إن الإسلام يجد من جديد فرصة تاريخية لإظهار أن عقيدته وقصدياته هي إجابة على قلق عالم قاده النموذج الغربي للنمو إلى التفكك الاقتصادي والسياسي والأخلاقي، كما في أيام نشوئه ثم زمن انتشاره، إن الإسلام قدم جواباً على تفتت الإمبراطوريات.”([95])
هناك البطانة أو القاعدة الأخلاقية ما يتيح للحضارة الإسلامية مشاركة أشد فعالية في مستقبل العالم الذي أفلتت من بين يديه مؤشرات وضوابط القيم، فاندفع، بما يشبه الجنون، مشدوداً إلى هدف واحد: المزيد من التكاثر بالأشياء، والمزيد من التحقق بالقوة بغض النظر عن أي قدر من التساوق أو الانسجام بين هذين الهدفين، وبين الزامات القيم الخلقية من أجل صالح الإنسان. إن هذه المشاركة الأخلاقية، كما يلحظ (غارودي)، ضرورية جداً لوقف الاندفاع غير المنضبط وتجنيب البشرية “الهلاك المحتوم” الذي يسوق إليه “الضلال الغربي.”([96])
ونحن نعرف جميعاً، انطلاقاً من هذه الرؤية، ما الذي فعله ويمكن أن يفعله العلم الغربي المنفصل عن ضوابط القيم، وذلك بتعبّده للتكاثر والقوة، وما الذي فعله ويمكن أن يفعله العلم الإسلامي المنضبط بالأخلاق وبالغايات الدينية في نهاية الأمر: “لم نشدد على الوجوه التي لعب بها العلم الإسلامي باكتشافاته دور (الرائد) للعلم الغربي الحالي، وانما على صفاته الخاصة في تبعيته وخضوعه للوسائل الإنسانية ذات الغايات الإلهية. في هذا المنظور، على القرن العشرين، وعما قليل على القرن الواحد والعشرين أن يتعلما كثيراً من الإسلام”([97]) أيضاً فان الحضارة الإسلامية بتقديمها فكرة التسامي (الأخلاقي) للإنسان كواحدة من أهم مرتكزات الإسلام العقدية، التسامي الذي يكون المؤمن فيه في حالة صيرورة متواصلة نحو الأحسن والأعلى. هذه الفكرة لهي واحدة من أهم ما يمكن أن يقدمه المسلمون “لخلق مستقبل إنساني في عالم جعل استبعاد السمّو منه، وسيطرة نموذج جنوني من النموّ… لا يمكن أن يعاش.”([98])
أما الرؤية الشمولية للحضارة الإسلامية، والمغزى الذي تضفيه على الحياة البشرية، فتكاد تكون أهم إسهاماتها المقبلة، إذا ما تذكرنا كيف يتزايد الإحساس العالمي بالعبث واللاجدوى وكيف تفقد الحياة البشرية يوماً بعد يوم طعمها ومعناها، وكيف يتحول السعي المعرفي إلى نشاط تجريدي منفصل عن الإنسان، نقيض -أحياناً- لمطالبه ومطامحه، وكيف تتفكك الوشائج بين أقطاب الكون وموجوداته، فيعيش الإنسان في عزلة مخيفة قد يكفي لتذكر مراراتها وأحزانها أن نلقي مجرد نظرة على آداب العصر وفنونه وفلسفاته “لقد فقد الإنسان الغربي كل وحدة في علاقاته مع الطبيعة والمجتمع والله. انفصل عن الطبيعة التي اعتقد أنه سيدها ومالكها… ولم تساعد المسيحية الإنسان، مع حذرها الأول بإزاء الطبيعة، ومع تراجعاتها المتتالية، منذ عصر النهضة، أمام (علموية) تدعي الإجابة
على جميع مشاكل الحياة، على الحفاظ على هذا البعد الكوني، على هذا الاتحاد الحميم لجميع الكائنات… والإسلام عندما لا يكون قد أفسدته الرؤية الغربية المباشرة التي فرضها عليه الاستعمار، يستطيع أن يساعدنا على أن نعي هذه الوحدة التي هي عقيدته المركزية الأولى.”([99])
وبإيجاز شديد فان “عقيدة الإسلام وقصدياته” لهي الإجابة على قلق العالم الحديث الذي يصنعه ويقوده النموذج الغربي([100])، هذا النموذج الذي إن كان له أن يتباهى بما صنعته يداه فليس له أن يشير الا إلى العلم والتقنية اللتين بلغ بهما -والحق يقال- مرتقى صعباً. ولكن حتى ها هنا، حيث لا يمكن للعلم أو التقنية أن تنفردا بمصير الإنسان بعيداً عن ارتباطاتهما بفكرة ما، بفلسفة أو عقيدة تؤطّر حركتهما وتربطها بالإنسان نفسه وتمنحها المعنى والهدف والمغزى، حتى ها هنا فان الإسلام وحده يمكن أن يمنحنا الجواب. إن (غارودي) يتساءل “ماذا يستطيع الإسلام أن يقدم لنا ليعدنا للإجابة على المسؤوليات التي تفرضها قدرة العلم والتقنية على جميع البشر اليوم؟” وما يلبث أن يجيب: “ان المشكلة كونية، ولا يمكن للجواب إلا أن يكون على المستوى الكوني.”([101])
إنها إذن “قضية مستقبلنا، قضية مستقبل جميع البشر” ومن ثم فان (وعود الإسلام) ليس كتاباً في التاريخ، كما يؤكد صاحبه “لكنه اقتراب جديد من الإسلام، ومن وراء الإسلام كقوة حية ليس فحسب في ماضيه، وانما في كل ما يستطيع أن يسهم به في ابتكار المستقبل.”([102])
حقاً إن (الإسلام)، والحضارة التي تعبر عنه بالضرورة، ليحملان “بذور تغيير جذري على مستوى الإنسانية.”([103])
خامساً: صياغة منهج جديد في تدريس (حضارة الإسلام):
يعتمد المنهج المقترح في بنيته، على التأسيسات التي قدمها هذا البحث، والتي تمثل الحدود الدنيا الضرورية للمادة المطلوب إعطاؤها لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات، من أجل جعلهم يتخرجون وهم يحملون ثقة بالغة بمشروعهم الحضاري الإسلامي، وقدرة مبدعة على المشاركة الفاعلة في هموم الأمة واحتياجاتها.
على مستوى الجامعات لا توجد أية إشكالية في توزيع المادة على سنوات الدراسة الأربع (وفق النظام الإنكليزي)، أو المسافات الأربعة (وفق النظام الأمريكي). حيث تعطى (التأسيسات الإسلامية للفعل الحضاري) في السنة أو المساق الأول، و (معطيات الحضارة الإسلامية: النتاج والوظائف والخصائص) في السنة أو المساق الثاني، و (عوامل الشلل والانكفاء الحضاري) في السنة أو المساق الثالث، و (امكانات الانبعاث والمشاركة العالمية بعوائقها وسبل مواجهتها) في السنة والمساق الأخير.
وبهذا يكتمل لدى خرّيج الدراسة الجامعية، التصوّر الشامل والدقيق، لحضارته الإسلامية، انطلاقاً، وصيرورة، وتآكلاً، وانبعاثاً، وفق منهج شمولي يتعاطى مع هذه الحضارة باعتبارها تنطوي على فرادتها، وخصوصياتها، وشخصانيتها المتميزة.
وللأستاذ الجامعي الذي سيتولى تدريس المادة، عبر السنوات أو المساقات الأربعة، أن يبني جهده على المادة التأسيسية التي عرض لها هذا البحث بإيجاز، ولكن شرط الا يقف عند حدود هذه المادة، بل أن يوسّع الفضاء بالمزيد من الشروح والتحليلات والاستشهادات التاريخية التي تمنح المصداقية للأفكار المعروضة في البحث، وأن يعطي الفرصة للطلبة في أن يقدحوا زناد عقولهم، لتقديم إضافات نوعية على ما يعرضه الأستاذ، فيتحقق -بذلك- مبدأ المشاركة في بناء المحاضرة بين قطبي العملية التعليمية: المدرّس والطالب.
ولقد تعمّد البحث في الا يحقن مفرداته بالاستشهادات التاريخية تجاوزاً للتضخم من جهة، ولإعطاء الفرصة -من جهة أخرى- لكل من المدرس والطالب في عملية إثراء المحاضرات بالإضافات الضرورية.
مهما يكن من أمر فان السنة أو المساق الأول، الذي يمتد على مسافة ما يقرب من الشهور التسعة، سيكون فرصة مناسبة تماماً للاستفاضة في تحليل الشروط والتأسيسات الإسلامية للدفع الحضاري في كتاب الله، وسنة رسوله (ﷺ)، والمعطيات الحضارية المتحققة على الأرض في عصر الرسالة، وهي مسائل يمكن أن يقال فيها الكثير، حتى على مستوى استدعاء المزيد من الشواهد القرآنية والحديثية هذا إلى أن المتغيّرات الحضارية التي شهدها عصر الرسالة، والتي تمّ الاكتفاء بالتأشير على عناوينها في البحث، يمكن أن تأخذ العديد من الساعات التدريسية في محاولة لتجاوز المناهج التقليدية في التعامل مع السيرة النبوية، إلى منهج أكثر دقة ومقاربة يتعاطى معها ليس باعتبارها عصر حروب ومغازٍ فحسب، وانما بما بشرّت به، وأسست له، ونفذته باعتبارها مشروعاً حضارياً.
السنة أو المساق الثاني سيخصص لعرض معطيات الحضارة الإسلامية، وتحليل وظائفها، وتحديد خصائصها المتميزة، حيث لم يتطرق البحث إلى أية مفردة مما سيعنى بها هذا المساق، تجاوزاً للتضخم، وإتاحة للفرصة أمام المدرّس في أن يشترك هو وطلبته في لمّ شتات المادة، وتقديم صورة متماسكة عن هذه الحضارة التي قدمت عطاءً خصباً في شتى المجالات، والتي مارست جملة من الوظائف الإنسانية بالغة الخطورة إزاء ثقافات (الآخر)، والتي امتلكت خصائصها التي ميّزتها عن سائر الحضارات.
وقد ترك البحث للمدرس والطالب قائمة غنية من المراجع والدراسات التي يمكن اعتمادها في تشكيل الصورة المطلوبة عن الموضوع في فضائه الواسع الذي ينطوي على نتاج الحضارة الإسلامية في الدوائر التالية:
أولاً: دائرة النشاط العلمي والمعرفي والثقافي، وهذا الأخير يتضمن الجانب العقدي
(وفي الحالة الإسلامية يصاغ بالعقيدة)، فضلاً عن الجوانب الفكرية والروحية والجمالية والسلوكية والوجدانية والأخلاقية للحضارة، ويمارس دوره الحاسم في منحها سماتها المتفردة، وشخصيتها المستقلة.
ثانياً: دائرة النشاط الاقتصادي والتقني والعمراني، وهو الذي يتضمن الجانب المادي للحضارة، ويصطلح عليه أحياناً بالمدنية.
ثالثاً: دائرة لنشاط الإداري والتنظيمي والخدمي، وهو الذي يتضمن الجانب الفني ويتحرك من خلال النظم والمؤسسات السياسية والإدارية، التي تقوم بمهمة الإشراف والتخطيط والتنسيق بين المعطيات كافة، وتحديد العلاقات بين العاملين ضمن حلقات الحضارة الواحدة.
فإذا ما جئنا إلى النشاط المعرفي والثقافي الذي يمنح الحضارات شخصانيتها المتميزة، فإننا سنجده يتمحور في اتجاهات أربعة هي:
- العلوم بحقولها الأربعة، الإسلامية والإنسانية والصرفة والتطبيقية.
- الفنون (وقد تلحق بها الآداب أو تدرج ضمن حقل العلوم الإنسانية وهو الأرجح).
- التربية والتعليم.
- العادات والتقاليد والميول والأذواق في سياقاتها الاجتماعية.
ولقد كان من الطبيعي أن ترتبط المعرفة التي أنتجتها الحضارة الإسلامية بأصولها الإسلامية، وتسعى لتحقيق غايات إسلامية، فهناك على سبيل المثال:
- معرفة تعالج قضايا إسلامية (علوم القرآن والحديث، العقيدة، الفقه والتشريع…).
- معرفة تجادل عن قضايا إسلامية (علم الكلام، الفلسفة، الآداب).
- معرفة منبثقة عن قضايا إسلامية (التاريخ، علوم اللغة، البلاغة).
- معرفة متشكلة لحلّ قضايا إسلامية (الحساب، الطب…).
- معرفة متشكلة بدوافع إسلامية (العلوم الصرفة…).
- معرفة تعبّر عن قضايا إسلامية (الآداب والفنون).
- معرفة تستهدف تنفيذ مطالب الحياة الإسلامية (علوم الإدارة، السياسة، التربية العلوم التطبيقية).
- معرفة تحلّل ملامح الحياة الإسلامية (علم النفس، الاجتماع).
- معرفة تحكي وتوثّق للحياة الإسلامية (التاريخ، الجغرافيا، الآداب).
- معرفة تؤكد قيم الحياة الإسلامية وتدعو لها (الأخلاق، الرقائق، التربية، الآداب).
عبر هذه المساحة الواسعة من المعطيات سيتحول مدرس المادة مع طلبته فيعرض عليهم ما أنتجته الحضارة الإسلامية -على سبيل المثال لا الحصر- في التاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم الاجتماع والسياسة والاقتصاد والتربية والفقه وأصوله، والآداب والفنون، والفلك والفيزياء والكيمياء والرياضيات والهندسة والنبات والحيوان والطب والصيدلة والعلوم التطبيقية، حيث قدم العقل المسلم للعالم كشوفاً ذات قيمة بالغة في شتى العلوم والمعارف، كانت بمثابة التأسيسات التي بنى عليها الغربيون حضارتهم الراهنة.
إلاّ أن الأهم من هذه الكشوف على مستوى الموضوع العلمي، ما حققه المسلمون من كشف على مستوى المنهج. فبعقولهم وأيديهم أرسيت تقاليد منهج البحث العلمي، وبمتابعاتهم الدؤوبة تعزّز (المختبر) كمؤسسة ضرورية للبحث العلمي. وليس بمقدور أمريء أن ينكر التأثيرات الحضارية التي مارست دورها في هذا الكشف، وأولاها ولا ريب تلك النقلة المنهجية الحسّية التي دلّهم القرآن الكريم عليها ودعاهم إليها، هذا إلى تأكيدات القرآن الملّحة على ضرورة الكشف عن السنن والطاقات المذخورة والمسخرة أساساً لخدمة الإنسان، واعتبار نشاط كهذا ممارسة إيمانية يتقرب بها صاحبها إلى الله سبحانه. وقد يضاف إلى هذين العاملين المناخ الحرّ الذي نشط فيه الباحثون بعيداً عن أية رقابة أو مصادرة أو قسر، كذلك الذي شهدته الساحات الأوربية. ولقد شهد بالدور المنهجي المؤكد للحضارة الإسلامية كبار باحثي الغرب في تاريخ العلوم أمثال الدومييلي وسارتون وروزنثال وسيديو وهاملتون كب وروم لاندو وهونكه وغيرهم.
في هذا المساق سيتم كذلك الحديث عن الوظائف الكبرى للحضارة الإسلامية في حماية التراث المعرفي البشري، وتناقله الجغرافي، وإغنائه بالمزيد، كما سيتم تحليل الخصائص التي ميّزت حضارة الإسلام وأعطتها خصوصيتها، باعتبارها حضارة إيمانية عقدية ملتزمة، أصيلة منفتحة، قديرة على الاستجابة للتحديات، متوازنة، شاملة، إيجابية بناءة، واقعية قديرة على التحقق في سائر مناحي الحياة والوجود. ثم هي في إطارها ونسيجها، إنسانية تعبّر عن طموح الإنسان لعمارة العالم وتحضيره، وتسعى للاستجابة لأشواق الإنسان ومنازعه ومطالبه الأساسية، أياً كان الإنسان في الزمن والمكان والانتماء.
أما السنة أو المساق الثالث، فسيخصص للوقوف طويلاً عند عوامل الشلل والانكفاء الحضاري. إذ بدون تشخيص عوامل التآكل والانكماش لا يمكن أن يتحقق العلاج، والانطلاق ثانية إلى دائرة الفعالية الحضارية.
البحث، ها هنا أيضاً، وتجاوزاً للتضخم، ومنحاً للفرصة أمام المدرس وطلبته للمشاركة في بناء الموضوع، اكتفى بالتأشير على تلك العوامل الإحدى والعشرين بعد تقسيمها إلى خمس مجموعات نمطية لغرض السيطرة عليها، حيث ستتاح الفرصة لمدرّس المادة في أن ينتقل بطلبته إلى ساحة التاريخ الإسلامي لكي يقف معهم عند البقع السوداء التي شكلت نسيج السوء وآلت بالأمة إلى أن تنزل عن مكانتها المتقدمة، وأن تفقد روح العمل والإبداع والإضافة والتجديد، وتنكفئ على نفسها في نهاية الأمر، لكي تعطي الفرصة (للآخر)، الأكثر قدرة على الفعل، في أن يمسك برقبة العالم بحكم فعاليته.
وستكون السنة أو المساق الرابع والأخير، وبعد أن يكون الطلبة قد بلغوا حداً طيباً من النضج الفكري، فرصة مناسبة لتحليل إمكانات الانبعاث، والعوائق التي تقف في طريقه، وسبل المواجهة للخروج من المأزق والعودة ثانية إلى دائرة الفعالية الحضارية، والمشاركة الإيجابية في صياغة المصير البشري.
ورغم أن البحث قدم الكثير من المؤشرات في هذا المقطع، فتحدث عن الدور السلبي للمعرفة الإنسانية الغربية في بنية مناهجنا التربوية، وعن عزلة المائتي عام بين المعرفتين الإسلامية والإنسانية في مؤسساتنا التعليمية، وعن الحلول الممكنة متمثلة بالتأصيل الإسلامي للمعرفة من جهة، وبكسر جدار العزلة بين المعرفتين الإسلامية والإنسانية من جهة أخرى، ورغم أنه استدعى شهادات العديد من كبار المفكرين والباحثين في الغرب بخصوص احتمالات الانبعاث الحضاري الإسلامي، والمشاركة قي المصير، إلاّ أن المساق ظل مفتوحاً على مصراعيه أمام مدرس المادة وطلبته لمعالجة وتحليل جملة من القضايا الأخرى المتعلقة بالموضوع، كالعولمة، ونظرية نهاية التاريخ، وصراع الحضارات، وحوار الحضارات، والنظام العالمي الجديد، وتحديات التكنولوجيا والتفوق الغربي، ومقوّمات المشروع الحضاري البديل… إلى آخره.
وهكذا يتخرج الطالب الجامعي وهو يملك -كما تمّ التأكيد عليه في صلب البحث- رؤية معمقة لحضارته الإسلامية، وثقة بقدرتها على الفعالية والإنجاز، ويقيناً بإمكانات انبعاثها من جديد، كما يملك في الوقت نفسه عقلية إبداعية متوقدة، قديرة على الإضافة والتجديد والاغناء، وإرفاد أمته بما هي في أمسّ الحاجة إليه من مبدعين مبتكرين، قديرين على التعامل مع التحديات، مؤمنين حتى أعمق نقطة في وجدانهم بأن هذا الدين يحمل مشروعه الحضاري القدير على تقديم البديل، حيثما استكملت شروط العمل وتمّ الأخذ بالأسباب، وتلك هي مهمة التربية العليا في نهاية المطاف.
هذا على المستوى الجامعي، أما على مستوى الدراستين المتوسطة والإعدادية، فيمكن الاستهداء بالمنهج نفسه، بعد قدر كبير من التبسيط لكي يكون ملائماً لطلبة هذه المراحل المبكرة، وبعد توزيع مفرداته على سنوات الدراسة المذكورة. وليس ضرورياً أن تعطى هذه المفردات بكلّيتها، وانما أن يتم انتقاء ما يصلح منها لهذه المراحل الدراسية بحيث لا تشكل عبئاً على الطالب، وبحيث تغرس في نفسه خاصية الاعتزاز بحضارة الآباء والأجداد، والثقة بقدرتها على استئناف الدور، فضلاً عن غرس روح العطاء والإبداع في نفوس الطلاب تمهيداً للمرحلة الجامعية التي ستدفع بهم إلى المجتمع باعتبارهم قدرات فاعلة وليست طاقات معطلة. ويبقى المعلم أو المدرّس هو فارس الميدان، باعتباره المربّي الأوّل القدير على توظيف المادة، واختيار حلقاتها الأكثر أهمية، وايصالها إلى عقول الطلبة بأكبر قدر من التبسيط والايضاح.
سادساً: صياغة منهج جديد في تدريس التاريخ الإسلامي:
تنطوي الخبرة التاريخية على قيمة بالغة، ليس في السياقات الأكاديمية فحسب، وانما في البناء التربوي وفي واقع الحياة. فما ثمة معلّم لمسيرة الأمم والجماعات والشعوب كالتاريخ، وهو بما يتضمنه من تجارب الصواب والخطأ، وحشود السنن والنواميس، يمكن أن يغدو مرشداً مناسباً للإفادة من الخبرات الإيجابية، وتجاوز تكرار الخطأ الذي يجيء أحياناً “أكبر من الجريمة” إذا استخدمنا عبارة السياسي الفرنسي المعروف (تاليران).
والتاريخ كلّه تاريخ معاصر، كما يقول الفيلسوف الإيطالي (بنديتو كروتشه) مشيراً إلى التأثير البالغ للتجربة التاريخية على واقع الجماعات والشعوب، وإلى إمكان تجدّد الوقائع ذاتها، وبصيغ أخرى، بمجرد أن تتهيأ لها الشروط التي تشكلت أوّل مرة.
ومنذ منتصف القرن التاسع عشر ازداد اهتمام الغربيين بالدراسة التاريخية، وأخذت تتكشف لهم أكثر فأكثر أبعادها الفكرية والسياسية والتربوية، وضرورتها لمسيرة الشعوب والأمم، من أجل تجاوز خطيئة البدء من نقطة الصفر، والاستهداء بالخبرة التاريخية.
إن العلوم الإنسانية “وعلى رأسها التاريخ الإسلامي، بخاصة، والبشري بعامة، لابّد من دراستها من منطلق الإسلام وتفسيره ومفاهيمه، لأن خطورة التاريخ تكمن في اعتماد الدعوات الهدامة، والتحوير في كتابته، لتضليل الجيل الحالي والأجيال المقبلة، ولا زال التاريخ في بعض البلاد الإسلامية يدرس للطلاب من منطلقات رأسمالية ووجودية وماركسية، بل ان التفسير المادي لحركة التاريخ هو السائد اليوم في أغلب بلادنا. وتحتضن وزارات التربية (والتعليم العالي) هذه الفكرة في مناهجها، عن جهل من البعض، وعمداً من البعض الآخر، بل نجد كثيراً من المؤلفات عن السيرة وتاريخ الإسلام تفسّر من هذا المنطلق المادي الإلحادي.”([104])
ومن خلال نظرة شمولية إلى التاريخ الإسلامي في مساراته ومصائره، يبدو ذلك الاتصال الوثيق بين المسببات والأسباب، وذلك التلاحم المحتوم بين المقدمات والنتائج. إنها النواميس والسنن التي حدثنا عنها الله سبحانه في كتابه المبين.
ولقد أخطأ كثير من المؤرخين في فهم وحدة هذا التاريخ وطبيعة نسيجه ذي الخيوط المتجانسة، لأنهم نظروا إلى هذا التاريخ نظرة تتسم بالتجزيئية والمباشرة والتقطع حيناً، وبقياس التحوّلات بمقاييس التغيّر الدائم في الأسر الحاكمة حيناً آخر، دون أن يأخذوا بنظر الاعتبار حركة المجتمع الإسلامي، ووحدته، وصيرورته التي كانت تجد في قيم الإسلام ومبادئه ومثله مراكز ثقلها وضبطها، ومؤشرات تمخضها الدائم عن المزيد من الوقائع والأحداث.
ولسوف يكون المنهج المقترح لتدريس التاريخ الإسلامي في المدارس والمعاهد والجامعات، مجرد خطوط عريضة ومؤشرات شاملة، تتجاوز الجزئيات والتفاصيل، من أجل تقديم تصوّر عام عن مجرى التاريخ الإسلامي في اتجاهاته كافة، وعن طبيعة العلاقة المتبادلة بين العقيدة والحركة عبر هذا التاريخ. وهي أشبه بالمفاتيح، أو الاضاءات المركزة التي يمكن لمدّرس المادة -بمعونتها- فهم وتفسير وقائع هذا التاريخ الغنية، المتشابكة المزدحمة، بعيداً عن المنهج التقليدي في معالجة هذا التاريخ، ذلك المنهج الذي اجتمعت في نسيجه أكثر من نقيصة، منها:
- اعتماد التبدل الفوقي في الأسر والحكام أساساً للتقسيم الزمني.
- الرؤية التجزيئية التي تدرس هذا التاريخ أشتاتاً مبعثرة وتفاريق وتعجز عن لمّ الوقائع والتجارب، لكي تعاين وتحلّل من خلال تشكلها الأكثر شمولية وارتباطاً، وعبر نسقها النوعي الذي تضم معطياته حشوداً زاخرة من الوقائع ترفد هذا المجرى أو ذاك.
- التأكيد المتضخم على الجوانب السياسية والعسكرية لهذا التاريخ، وتقليص مساحات الجوانب العقدية والاجتماعية والحضارية.
- ممارسة نوع من فك الارتباط المفتعل بين مجريات هذا التاريخ وبين التأثيرات الإسلامية العميقة في نسيجه وشرايينه وخلاياه.
- تقطيع الظواهر التاريخية الكبيرة وبعثرتها من خلال المعالجة الأفقية المتزامنة التي تسعى لدراسة كل عصر بل كل سنة (أو حولية) على حدة، بكل ما تخلّق فيها من وقائع وأحداث، بدلاً من المتابعة العمقية، أو العمودية، لكل ظاهرة عبر مجرى التاريخ الإسلامي، من منابعه الأولى حتى اللحظات الراهنة.
وبدلاً من هذا فان المنهج المقترح يسعى لاعتماد المؤشرات والضوابط التالية:
- فهم التاريخ الإسلامي من خلال وحدة الحركة، وكسر القشرة الخارجية للأحداث والتبدلات.
- التحقّق برؤية شمولية تلّم التفاصيل والجزئيات لكي تستمد منها المؤشرات الأكثر امتداداً لمعطيات التاريخ الإسلامي.
- تحقيق التوازن المطلوب بين الجوانب السياسية-العسكرية، والجوانب العقدية والاجتماعية والحضارية.
- تسليط الضوء على العلاقة الأصيلة المتبادلة بين الإسلام وبين وقائع التاريخ الإسلامي في آفاقها كافة.
- متابعة الظواهر التاريخية الكبرى عمودياً، لكي لا تتعرض للتشتت والتقطيع، ولكي تتاح فرصة السيطرة على أبعادها وصيرورتها وصولاً إلى ملامحها الأساسية وسماتها المتفردة.
من أجل ذلك يتوخى المنهج المقترح معالجة التاريخ الإسلامي من خلال رؤية جديدة لمجراه الزاخر، تتجاوز التقسيم التقليدي للعصور الإسلامية، إلى صياغة هندسة جديدة لوقائعه ربما تكون أكثر قدرة على لمّ شتاته، وإضاءتها، والكشف عن مغزاها، من خلال إحالة وقائعه وأحداثه وتفاصيله على نسقها النوعي في مجرى الحركة التاريخية، لتبيّن طبيعة النسيج الذي آلت إليه بعد طول ذهاب وإياب لنول الزمن على الخيوط التي كانت تغذّيه.
تقوم هذه الهندسة المنهجية على معالجة أركان أو مساحات أساسية أربع في التاريخ الإسلامي هي:
- الدولة والسلطة والقيادة.
- الدعوة والانتشار والتعامل مع الآخر.
- التحديات والهجمات المضادة والعلاقات الدولية.
- الحياة الاجتماعية.
وبمقدور مدرّس المادة، أو أي طالب أو باحث، أن يحيل هذه الواقعة أو تلك، وذلك الحدث أو ذاك، مهما كبر أو دقّ، إلى واحدة من هذه المساحات. فكل التفاصيل والجزئيات التي يعجّ بها مجرى التاريخ الإسلامي، يمكن فرزها وتمحيصها من أجل وضعها هنا أو هناك، عبر المساحات أو الظواهر الأربع الأساسية.
هذا مع طرح تحفظ يبدو لبداهته أن ليس ثمة مبرر للإشارة إليه، وهو أن هذه المساحات الأربع، بكل ما تتضمنه من تفاصيل وجزئيات، تتداخل مع بعضها تداخلاً عضوياً صميماً على مستوى التأثر والتأثير… الفعل والانفعال، بحيث يغدو من الصعوبة بمكان دراسة كل ظاهرة على حدة، منفصلة بالكلية عن الظواهر الأخرى. إن هذا أمرٌ مستحيل ما دام أن الحركة التاريخية تتميز بذلك التداخل والتشابك وتبادل التأثير والانفعال، إلى الحدّ الذي تكاد معه أن تتوحد الظواهر والجزئيات في كل متماسك واحد.
إن التاريخ هو حركة حياة معقدة متشابكة في نهاية التحليل، وليس لهذا التقسيم المنهجي من مبرر مقنع سوى أنه يعين المدرس والطالب على فهم أعمق لمجرى الوقائع التاريخية، وقدرة أكثر على الإمساك بتلابيبها ومتابعة صيرورتها، منذ لحظة التخلّق الأولى وحتى لحظة اندماجها وفنائها في هذه الظاهرة أو تلك، شرط أن يحتفظ ذهنه دوماً بقدر من الصفاء والتركيز يمكنه -في الوقت نفسه- من فهم العلاقات المتبادلة بين الظواهر جميعاً.
ومهما يكن من أمر فان هذا التقسيم المنهجي، بما أنه يعتمد قدر الامكان متابعة النسق النوعي للوقائع والأحداث، فانه سيكون أقرب إلى هذا المفهوم التشابكي للتاريخ من سائر المناهج التقليدية التي مارست التقطيع والعزل، وعجزت عن امتلاك الرؤية الشمولية، التي تلمح سائر الارتباطات بين الوقائع والأحداث الجزئية من جهة، وبين الظواهر الكبرى من جهة أخرى.
إن كون المنهجين الجديدين لتدريس مادتي (الحضارة) و (التاريخ) قد صمّما للمستوى الجامعي، في سنواته أو مساقاته الأربعة، لا يمنع من توظيفهما في مستويات التعليم العام، وبخاصة (الإعدادي) الذي يسبق الدخول إلى الجامعة، حيث يكون الطلبة قد بلغوا درجة مقبولة من النضج العقلي الذي يؤهلهم لاستيعاب المفردات المعطاة في المادتين، ولكن شرط التخفيف من هذه المفردات إلى الحدّ الأدنى الممكن الذي لا يغيّر من الملامح الأساسية للمادتين، وشرط أن يعاد توزيع هذه المفردات على سنوات الدراسة الإعدادية الثلاث، بدلاً من السنوات الأربع للدراسة الجامعية.
ولسوف يساعد على ذلك الاقتصار على المفردات الأساسية للمادتين، والدور الفاعل الذي يمكن أن يمارسه (المدرّس) في تبسيطهما وتوصيلهما لطلبته بأكبر قدر ممكن من الوضوح والقدرة على الإمساك بالمادة.
ثم ان هذا البحث الذي يحمل عنوان (التربية الحضارية) لا يقدم سوى التأسيسات والخطوط العريضة للموضوعات التي يعالجها، ويترك -بعد ذلك- هامشاً واسعاً “للمدرّس” كي يشتغل مع طلبته على إكمال المادة بالمفردات اللازمة، وهذا سيمنح العملية التدريسية حيوية أكبر.
والآن، فإننا لو جئنا إلى سنوات الدراسة الإعدادية الثلاث فإن بالإمكان وضع التصميمين التاليين للحضارة والتاريخ بما يتناسب وهذا المدى الزمني المتاح:
1. الحضارة:
السنة الأولى: التأسيسات الإسلامية للفعل الحضاري في كتاب الله وسنة رسوله (ﷺ)، وتطبيقات عصر الرسالة.
السنة الثانية: نماذج مختارة من معطيات الحضارة الإسلامية في سياقاتها كافة، وعرض موجز لوظائفها وخصائصها الأساسية.
السنة الثالثة: عرض موجز لعوامل الانكفاء، وآخر لإمكانات الانبعاث بعوائقها وحلولها.
2. التاريخ :
السنة الأولى: القيادة والدولة والسلطة.
السنة الثانية: عرض موجز لظاهرة الدعوة والانتشار والتعامل مع الآخر، مع نماذج مختارة من الهجمات المضادة، والتحديات، والعلاقات الدولية.
السنة الثالثة: عرض موجز للحياة الاجتماعية عبر العصور التاريخية.
أما بالنسبة للمرحلتين المبكرتين: الابتدائية (التأسيسية) والثانوية (المتوسطة)، فالأمر يختلف، حيث تدمج مادة الحضارة بالتاريخ الإسلامي في سياق واحد وفي ساعات محدّدة، وحيث يكون الطلبة في مرحلة مبكرة من التكوين العقلي، لا تؤهلهم لتلقي وهضم ما يعطى لمرحلتي الإعدادية والجامعة، ويمكن -والحال كذلك- أن يقوم مدرّس المادة المشتركة بتقديم الخطوط العريضة، وبأقل قدر من التفاصيل، وأكبر قدر من التبسيط، فيما يمكن الطلبة من تمثّل المادة المعطاة، ومن الانتقال إلى المراحل التالية وهم يملكون المفاتيح والتصوّرات الأساسية التي تمكنهم من الدخول إلى المادتين بقدر كبير من الاستيعاب والقبول.
ويبقى مفتاح العملية التعليمية-التربوية في مراحلها كافة، بيد مدرّس المادة، وليس الكتاب المقرّر، ومن ثم يتحتم أن يمتلك المدرس الذي سيتولى إحدى المادتين أو كلتيهما، مجموعة من المواصفات التي لابدّ من توفّرها فيه لتحقيق المطلوب:
- أن يكون مقتنعاً بمبادئ مشروع إحياء نظام تربوي أصيل، وأهدافه الأساسية.
- أن يحمل رؤية إسلامية أصيلة لا غبش فيها ولا شائبة.
- أن يكون ملّماً تماماً بمطالب وتأسيسات المادة الحضارية أو التاريخية التي يتولى تدريسها، كما وردت في معطيات المشروع وتم اتفاق المشاركين عليها.
- أن يملك القدرة على إتمام المادة المعطاة بتغذيتها بالمفردات الضرورية من خزينة المعرفي والتخصّصي، الذي يفترض أن يكون غنياً ومتكاملاً.
- أن يتحلى بقوة الشخصية ودايناميكيتها التي تمكنه من الأداء التعليمي التربوي وفق مستوياته العليا، التي تجعل الطالب يعشق المادة التي يتلقاها ويلّم بمكوناتها الأساسية، ويتخرج وهو يملك الثقة والاعتزاز بما قدمه الآباء والأجداد، وبما يمكن أن يقدمه هو من إضافة وإبداع.
- بمعنى أن يجعل من مادتي (الحضارة) و (التاريخ) أداتين فعالتين في تحقيق مقاصد (التربية الحضارية) التي تستهدف تخريج أجيال من الطلبة المبدعين، والقديرين على الإسهام الفعّال في شروط انبعاث أمتهم ومجتمعاتهم من جديد، واستحضار احتياجاتها، مع استشراف المستقبل والتعامل مع تحدياته.
- وبذلك سيتحول تدريس المادتين من صيغتهما العتيقة التي خرّجت أجيالاً مهزوزة الثقة بتاريخها وحضارتها، عديمة القدرة على الفعالية والإبداع، إلى صيغ منهجية جديدة ترفد وتعين مشروع إحياء نظام تربوي أصيل على تحقيق أهدافه المتوخاة.
الخاتمة
استهدف البحث توظيف الدرس الحضاري في النشاط التعليمي-التربوي عبر حلقاته كافة: الابتدائية، المتوسطة، الإعدادية والجامعية. وبما أن المشروع الذي قدّم إليه البحث يتوخى (إحياء نظام تربوي أصيل)، فان المعطى الحضاري لأية أمة يعكس بالضرورة أصالتها وخصوصياتها وملامح تميزها عن الأمم الأخرى. فكان من الطبيعي محاولة سبر غور الحضارة الإسلامية في تأسيساتها المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله (ﷺ)، ومعطياتها التي تمخضت عن تلك التأسيسات، ومن ثم تحليل العوامل التي قادتها إلى الانكفاء، بعد مرحلة التألق والابتكار والإبداع… ومحاولة الإجابة على السؤال الملّح: هل بمقدور الأمة أن تتجاوز عوامل تخلّفها تلك، وأن تستعيد كرة أخرى قدرتها على الفعالية والانطلاق؟ وما هو دور الاشتغال التعليمي-التربوي في إضاءة هذه المسائل، وفي إعانة أجيال الطلبة على استعادة الثقة بمعطيات الآباء والأجداد، واليقين العميق بقدرة التأسيسات والشروط الحضارية في كتاب الله وسنة رسوله (ﷺ) على تمكين الأمة من تجاوز محنتها والانطلاق من جديد؟
فما الذي يعنيه (مشروع إحياء نظام تربوي أصيل) سوى الكشف عن عناصر الأصالة التي تمكن القائمين عليه من بناء مشروع تربوي متميز، يستمد حيثياته من مقومات هذه الأمة العقدية والتشريعية والحضارية في نهاية الأمر؟
وعلى كثرة (الساعات) التي أعطيت للحضارة الإسلامية في المدارس والمعاهد والجامعات، فان الأخطاء المنهجية التي تمّ التعامل بها مع هذه المادة، لم تمنح الطالب -في الأعم الأغلب- ما يعينه على التحقق بأهداف ومطالب الاشتغال التربوي الأصيل. وقد تمت -عبر البحث- معالجة هذه الأخطاء وتقديم البدائل الأكثر قدرة على تحقيق الهدف المطلوب.
ولذا انتهى البحث، في حلقاته الأخيرة، إلى ما يتوخاه المشروع من تقديم جملة من المرئيات ذات البعد التطبيقي، ومن خلال هندسة منهجين جديدين في دراسة وتدريس مادتي الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي، في المدارس والمعاهد والجامعات، بما أن التاريخ هو وعاء الفعل الحضاري وإطاره المتحقق في الزمن والمكان.
ولقد استهدفت تلك المناهج تغطية الحاجة الضرورية لتوظيف الدرس الحضاري في مراحل الدراسة كافة: الابتدائية والمتوسطة والإعدادية والجامعية، مع التركيز على الأخيرة باعتبارها جماع المراحل كافة. ووزعت مفردات المادتين الحضارية والتاريخية على سنوات الدراسة في مستوياتها الأربعة، وأعطيت المرتكزات والخطوط العريضة لما يمكن أن يقدم في كل سنة أو مساق، وترك الباب مفتوحاً للإضافة والاغناء من أجل جعل (المحاضرة) فرصة لاشتغال الطرفين: المدرس والطالب، تأسيساً على المرتكزات المشار إليها في البحث.
وكان لابدّ -إذن- من التأكيد على اختيار المعلم والمدرس والأستاذ ممن يمتلكون خلفيات ثقافية وتخصصية واسعة ومعمقة، قدر الامكان، وإمكانية على التحليل والمقارنة والاستنتاج والإضافة، من أجل أن يكونوا كفاء ما يتطلبه المنهج الجديد في الدرسين الحضاري والتاريخي.
وكان لابّد -كذلك- من الرجوع إلى منظومة من المراجع المعنية بالظاهرتين معاً: الحضارية والتربوية، لاستدعاء الشهادات العلمية التي صدرت عن باحثين من المشرق والمغرب، من داخل عالم الإسلام ومن خارجه، والتي تدعم وجهات النظر الأساسية التي يعالجها البحث، وتقدم اضاءاتها لهذه الحلقة أو المفردة أو تلك، والتي تكاد تجمع على أن ما قدمه المسلمون عبر تاريخهم من فعل حضاري، سواء في تألّقه، أو انكماشه، أو قدرته المتجددة على الانبعاث، يمكن أن يكون درساً مؤثراً ونافعاً لأي جهد يستهدف إحياء نظام تربوي أصيل، يسعى لأن يمسك جيداً بالخيط من طرفيه -إذا صح التعبير-: الأصالة التي لا تفرّط بخصوصيات الأمة ومرتكزاتها وتفيد منها بقدر ما تنسجم وبنية المشروع وشخصانيته المتميزة. وقد أضيف إلى هذه المنظومة قائمة أخرى بأهم المراجع (المساعدة) التي يمكن أن يعتمدها المدرس والطالب لإغناء مادتيْ التاريخ والحضارة بالمزيد من الشواهد والمفردات.
والمهم في كل الأحوال، وبقدر تعلّق الأمر بالتربية الحضارية تحديداً، فان مشروعاً كهذا، إذا قدر على توظيف مادتي الحضارة والتاريخ في تعزيز هدفه الأساس، وهو تخريج أجيال من الطلبة تملك الاعتزاز بتاريخها وحضارتها، والثقة العميقة بقدرتها على العمل في قلب العصر، وتحمل الاستعداد للمشاركة في إعادة صياغة الحياة الإسلامية، وتسنّم مفاصلها الحساسة والمؤثرة بروح ابتكارية قديرة على مجابهة التحديات وإيجاد الحلول الناجعة لها… فان هذا وحده سيكون مبرراً لاعتماد المنهجين الجديدين المشار إليهما في أعمال المؤسسات والأنشطة التطبيقية التي يتوخاها المشروع، والتي طالما أكد عليها في أدبياته كافة.
وبسبب من ارتباط الدرس الحضاري بالمشكلة الثقافية، متمثلة بالدور السلبي للمعرفة الإنسانية الغربية في بنية مناهجنا التربوية، وبعزلة المائتي عام بين المعرفتين الإسلامية والإنسانية، تمّ اقتراح جملة أخرى من المرئيات التطبيقية لمعالجة هاتين الإشكاليتين، والتي يمكن لمؤسسات المشروع أن تعتمدها كجهد للمنهجين المقترحين في الحضارة والتاريخ.
(1) قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم.
كتب الصحاح.
إبراهيم، عز الدين. معالم رئيسية في مسيرة الجامعات الإسلامية في العهد الحديث. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1984م.
ابن الكلبي، هشام بن محمد بن السائب. كتاب الأصنام. ط2. تحقيق أحمد زكي. القاهرة: دار الكتب المصرية، 1924م.
إسماعيل، فادي. الخطاب العربي المعاصر: قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة
1987-1978م. فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1991م.
الأنصاري، محمد جابر. تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1992م.
بن نبي، مالك. دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين. بيروت: الدار العلمية، 1974م.
مشكلة الثقافة. ط4. دمشق: دار الفكر، 1984م.
بوازار، مارسيل. إنسانية الإسلام. ترجمة عفيف دمشقية. بيروت: دار الآداب، 1980م.
الجابري، محمد عابد. قضايا في الفكر المعاصر. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2003م.
الحسن، بدران. الظاهرة الغربية في الوعي الحضاري: انموذج مالك بن نبي. قطر: كتاب الأمة، 1999م.
حسنة، عمر عبيد. مراجعات في الفكر والدعوة والحركة. فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1991م.
حسين، طه. ألوان. القاهرة: دار المعارف، 1958م.
الخطيب، سليمان. فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي: دراسة إسلامية في ضوء الواقع المعاصر. بيروت: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1993م.
درمنغهم، أميل. حياة محمد. ترجمة عادل زعيتر. ط2. القاهرة: دار إحياء الكتب، 1949م.
دينيه، اتيين. محمد رسول الله. ترجمة عبد الحليم محمود ومحمد عبد الحليم. ط3. القاهرة: الشركة العربية، 1959م.
الزعبي، أنور. رسائل المعرفة والمنهج. عمان: دار أزمنة، 2004م.
مسيرة المعرفة والمنهج في الفكر العربي الإسلامي. عمان: دار الرازي، 2007م.
زين العابدين، الطيب. (تحرير). المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية: بحوث ومناقشات المؤتمر العالمي الرابع للفكر الإسلامي. الجزء الأول: المعرفة والمنهجية. فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1990م.
سارتون، جورج. الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط. تعريب عمر فروخ. بيروت: مكتبة المعارف، 1952م.
سوليفان، أ. حدود العلم. بيروت: الدار العلمية، 1972م.
شفيتزر، البرت. فلسفة الحضارة. ترجمة عبد الرحمن بدوي. بيروت: دار الأندلس، 1980م.
صديقي، عبد الحميد. تفسير التاريخ. ترجمة كاظم الجوادي. الكويت: الدار الكويتية للطباعة والنشر، د.ت.
الطريري، عبد الرحمن. العقل العربي وإعادة التشكيل. قطر: كتاب الأمة، 1993م.
عبد الحميد، محسن. مذهبية الحضارة الإسلامية وخصائصها. بغداد: شركة الديوان، 2001م.
العشّي، عرفات كامل. رجال ونساء أسلموا، الكويت: دار القلم، 1983-1973م.
عطية، محيي الدين. (إعداد). قائمة مختارة حول المعرفة والفكر والمنهج والثقافة والحضارة. فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1992م.
العلواني، طه جابر. الأزمة الفكرية المعاصرة: تشخيص ومقترحات علاج. ط2. فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1991م.
إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات. ط2. فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1992م.
عمارة، محمد. إسلامية المعرفة. القاهرة: دار الشرق الأوسط، 1991م.
العمري، أكرم ضياء. الإسلام والوعي الحضاري. جدة: دار المنارة، 1987م.
غارودي، روجيه (رجاء). وعود الإسلام. ترجمة ذوقان قرقوط. القاهرة وبيروت: الوطن العربي، 1984م.
الفاروقي، إسماعيل. أسلمة المعرفة. ترجمة عبد الوارث سعيد. الكويت: دار البحوث العلمية، 1984م.
فايس، ليوبولد (محمد أسد). الإسلام على مفترق الطرق. ترجمة عمر فروخ. ط6، بيروت: دار العلم للملايين، 1965م.
الطريق إلى مكة. ترجمة عفيف البعلبكي. بيروت: دار العلم للملايين، 1956م.
فرحان، اسحق. التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة. ط3. أربد: دار الفرقان، 1991م.
نحو صياغة إسلامية لمناهج التربية. ط2. عمان: جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية، 1980م.
القديدي، أحمد. الإسلام وصراع الحضارات. قطر: كتاب الأمة، 1995م.
كاريل، الكسيس. الإنسان ذلك المجهول. ترجمة شفيق أسعد فريد. بيروت: مكتبة المعارف، د.ت.
كوستلر، آرثر (وآخرون). الصنم الذي هوى. ترجمة فؤاد حمودة، دمشق: د.ن. 1960م.
لانكه، أوسكار. الاقتصاد السياسي. ترجمة محمد سلمان الحسن. عن محمد علي نصر الله. أضواء على نمط الإنتاج الآسيوي، مجلة آفاق عربية، بغداد: سنة2، عدد6.
محجوب، عباس. نحو منهج إسلامي في التربية والتعليم. دمشق وبيروت: دار ابن كثير، 1987م.
محمد، خلف الله. الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة. تأليف جماعة من الباحثين. جمع وتقديم محمد خلف الله. ط2. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1962م.
المعهد العالمي للفكر الإسلامي. إسلامية المعرفة: المبادئ العامة. خطة العمل. الإنجازات. واشنطن: المعهد العالمي، 1986م.
الإصدارات العربية. فيرجينيا: المعهد العالمي، 1996م.
ملكاوي، فتحي، وأبوسل، محمد (محرران). كتاب مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات، 1994م. عمان: جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1995م.
نحو نظام معرفي إسلامي (حلقة دراسية). عمان: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2000م.
المولى، مآرب. انعكاسات العولمة على التربية العربية وأساليب المواجهة التربوية. الموصل: معهد الهدى، 2004م.
الندوي، أبو الحسن. كيف توجه المعارف في الأقطار الإسلامية. الرياض: رئاسة إدارات البحوث العلمية، د.ت.
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. ط5. القاهرة: مكتبة دار العروبة، 1964م.
نصر، حسني محمد وآخرون (إعداد). قضايا إشكالية في الفكر الإسلامي المعاصر. القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1997م.
هارث، مايكل. دراسة في المائة الأوائل. ترجمة خالد أسعد عيسى وأحمد غسان سبانو. ط2. بيروت: دار قتيبة، 1979م.
الهنداوي، حسن. التعليم وإشكالية التنمية. قطر: كتاب الأمة، 2004م.
الهيتي، عبد الستار. الحوار: الذات والآخر. قطر: كتاب الأمة، 2004م.
وات، مونتكمري. محمد في المدينة. تعريب شعبان بركات، صيدا وبيروت: المكتبة العصرية، د.ت.
(2) قائمة بالمراجع المساعدة للمعلم والمدرّس والأستاذ
أبو سليمان، عبد الحميد. أزمة العقل المسلم. ط3. فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1994م.
أبو عزة، الطيب. مشكلة الثقافة في الوطن الإسلامي. الدار البيضاء: منشورات الفرقان، 1992م.
الأحمر، عبد السلام. المسؤولية أساس التربية الإسلامية: محاولة في التأصيل. الرباط: الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، 2007م.
أغروس، روبرت وجورج ستانسيو. العلم في منظوره الجديد. ترجمة كامل خلايلي. الكويت: المجلس الوطني للثقافة، 1989م.
الدومييلي، العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي. ترجمة محمد يوسف موسى وعبد الحليم النجار. القاهرة: دار القلم، 1962م.
بدران، فاروق. (تحرير). سلسلة الندوات والمحاضرات التي نظمتها جمعية البحوث والدراسات الإسلامية والمعهد العالمي للفكر الإسلامي. المجلد الأول. عمان: 2002م.
البدراني، هشام. رؤية مستنيرة في مفهوم العقل. الموصل: مطبعة التعليم العالي، 1990م.
مفاهيم علماء النفس: دراسة وتقويم، رؤية إسلامية. الموصل: د.ن. 1988م.
بن نبي، مالك. شروط النهضة. ترجمة عمر مسقاوي وعبد الصبور شاهين. ط . القاهرة:
دار العروبة، 1961م.
مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي. ترجمة بسام بركة وأحمد شعبو. دمشق: دار الفكر، 1988م.
وجهة العالم الإسلامي. ترجمة عبد الصبور شاهين. القاهرة: دار العروبة، 1959م.
بوكاي، موريس. القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. ط2. القاهرة: مكتبة مدبولي، 2004م.
توينبي، أرنولد. مختصر دراسة للتاريخ. ترجمة فؤاد محمد شبل. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1965-1960م.
الجابري، محمد عابد. تكوين العقل العربي. ط8. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2002م.
جب، سير هاملتون. دراسات في حضارة الإسلام. ترجمة محمود زايد وآخرين. بيروت: دار العلم للملايين، 1964م.
الجرداوي، عبد الرؤوف. دراسة في علم الاجتماع الإسلامي: الإسلام وعلم الاجتماع العائلي. الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 1988م.
الجندي، أنور. الفكر الغربي: دراسة نقدية. الكويت. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 1978م.
حتّي، فيليب. الإسلام منهج حياة. تعريب عمر فرّوخ. بيروت: دار العلم للملايين، 1972م.
حربي، خالد. علوم حضارة الإسلام ودورها في الحضارة الإنسانية. قطر: كتاب الأمة، 2004م.
حسن، إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. ط5 و6 . القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1962-1960م.
خليل، عماد الدين. التفسير الإسلامي للتاريخ. ط4. بيروت: دار العلم للملايين، 1983م. مدخل إلى الحضارة الإسلامية، الرباط: المركز الثقافي العربي، 2005م. ابن خلدون إسلامياً. ط3. دمشق وبيروت: دار ابن كثير، 2005م. دليل التاريخ والحضارة الإسلامية في الأحاديث النبوية (بالاشتراك مع المهندس حسن الرزو). عمان: دار الرازي، 2004م. نظرة الغرب إلى حاضر الإسلام ومستقبله. بيروت: دار النفائس، 1999م. الوحدة والتنوع في تاريخ المسلمين. دمشق: دار الفكر، 2002م. أصول تشكيل العقل المسلم. ط4. دمشق: دار ابن كثير، 2005م. قالوا عن الإسلام. الرياض: الندوة العالمية للشباب الإسلامي، 1992م. الفن والعقيدة. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1990م. تهافت العلمانية. ط5. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1983م. حوار في المعمار الكوني. ط2. دمشق وبيروت: دار ابن كثير، 2005م. الإسلام والوجه الآخر للفكر الغربي. بيروت : مؤسسة الرسالة، 1997م. متابعات في الفكر والدعوة والتحديات المعاصرة. لندن: دار الحكمة، 2002م. مدخل إلى إسلامية المعرفة. ط3. دمشق وبيروت: دار ابن كثير، 2006م. حول إعادة كتابة التاريخ الإسلامي. ط2. دمشق وبيروت: دار ابن كثير، 2005م. مدخل إلى التاريخ الإسلامي. الرباط: المركز الثقافي العربي، 2005م. ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز. ط5. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1983م. نور الدين محمود: الرجل وتجربته الإسلامية. ط2. دمشق: دار القلم، 1987م.
روزنثال، فرانز. مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي. ترجمة أنيس فريحة. بيروت: دار الثقافة، 1961م.
ريسلر، جاك. الحضارة العربية. ترجمة غنيم عبدون. القاهرة: الدار المصرية، د.ت.
زرزور، عدنان. التوجيه الإسلامي للعلوم والمعارف: مفهومه وأهدافه. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1992م.
العالم المعاصر: مدخل إلى الحضارة البديل، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1990م.
شاخت، جوزيف وس.أ بوزورث. تراث الإسلام. ترجمة محمد السمهوري وزملائه. الكويت: المجلس الوطني للثقافة، 1978م.
شفيق، منير. الإسلام في معركة الحضارة. تونس: دار البراق، 1991م.
الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصر. تونس: دار البراق، 1991م.
بين النهوض والسقوط. تونس: دار البراق، 1991م.
شلبي، أحمد. التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية. ط2. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1966م.
صعب، حسن. الإسلام وتحديات العصر. ط4. بيروت: دار العلم للملايين، 1979م.
طوقان، قدري حافظ. العلوم عند العرب. القاهرة: سلسلة الألف كتاب، د.ت.
عبد الباقي، إبراهيم. الخطاب العربي المعاصر: عوامل البناء الحضاري في الكتابات العربية
(1996-1990م). فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2008م.
عبد الرحمن، حكمت نجيب. دراسات في تاريخ العلوم عند العرب. الموصل: مطبعة جامعة الموصل، 1977م.
علي: محمد كرد. الإسلام والحضارة العربية. ط3. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1968م.
غرونباوم، غوستاف فون (تحرير). الوحدة والتنوّع في الحضارة الإسلامية. ترجمة صدقي حمدي. بغداد: مكتبة دار المتنبي، 1966م.
الفاروقي، إسماعيل. أسلمة المعرفة. ترجمة عبد الوارث سعيد، الكويت: دار البحوث العلمية، 1984م.
جوهر الحضارة الإسلامية، تونس: الزيتونة للإعلام، 1989م.
قطب، محمد. كيف نكتب التاريخ الإسلامي. الرياض: دار الكتاب الإسلامي، 1992م.
واقعنا المعاصر. ط2. الجزائر: مكتبة رحاب، 1989م.
لاندو، روم. الإسلام والعرب. ترجمة منير بعلبكي. ط2. بيروت: دار العلم للملايين، 1977م.
لوبون، غوستاف. حضارة العرب. ترجمة عادل زعيتر. ط3. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1956م.
مركز الدراسات المعرفية، محاضرات الموسم الثقافي لعام 2003-2000م. القاهرة: 2003م.
مظهر، جلال. أثر العرب في الحضارة الأوربية. بيروت: دار الرائد، 1967م.
المعهد العالمي للفكر الإسلامي. المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية. بحوث ومناقشات المؤتمر العالمي الرابع للفكر الإسلامي، فيرجينيا. المعهد العالمي. 1990م.
مكتب التربية العربي لدول الخليج. من أعلام التربية العربية الإسلامية. الرياض: 1989-1988م.
منتصر، عبد الحليم. تاريخ العلم ودور العرب في تقدمه. الموصل: مطبعة جامعة الموصل، 1974م.
هونكه، سيغريد. شمس العرب تسطع على الغرب (في الأصل: شمس الله تسطع على الغرب).
ترجمة فاروق بيضون وكمال الدسوقي. بيروت: المكتب التجاري، 1964م.
وات، مونتغمري. تأثير الإسلام على أوربا في العصور الوسطى. ترجمة عادل نجم عبو. الموصل:
دار الكتب، 1982م.
يونغ، لويس. العرب وأوربا. ترجمة ميشيل أزرق. بيروت: دار الطليعة، 1979م.
([1]) عمر عبيد حسنة: مراجعات في الفكر والدعوة والحركة، ص 53.
([2]) حسن الهنداوي: التعليم واشكالية التنمية، ص 38.
([3]) عباس محجوب: نحو منهج إسلامي في التربية والتعليم، ص 11.
([4]) مآرب المولى: انعكاسات العولمة على التربية العربية وأساليب المواجهة التربوية، ص 69.
([7]) اسحق فرحان: التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة، ص 24.
([8]) عبد الرحمن الطريري: العقل العربي وإعادة التشكيل، ص 63-62.
([9]) محيي الدين عطية: قائمة مختارة حول المعرفة والفكر والمنهج والثقافة والحضارة، ص 10-9.
([10]) سليمان الخطيب: فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي: دراسة إسلامية في ضوء الواقع المعاصر، ص 6-5.
([11]) ينظر -على سبيل المثال- الباب الأول من كتاب أبي الحسن الندوي: (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين)، الطبعة 5، ص 77-24.
([12]) عبد الرحمن الطريري: العقل العربي وإعادة التشكيل، ص 73.
([13]) أنور الزعبي: مسيرة المعرفة والمنهج في الفكر العربي الإسلامي، ص 17.
([14]) ينظر: هشام بن محمد بن السائب الكلبي: كتاب الأصنام، تحقيق أحمد زكي، دار الكتب المصرية، القاهرة-1924م، طبعة 2، الصفحات 48,33,28,14,9,8,6.
([15]) بل إن هناك سورة كاملة في القرآن الكريم تحمل اسم (سورة القلم) حيث يقسم الله سبحانه في مطلعها بالقلم، أداة الكتابة والمعرفة: (نون والقلم وما يسطرون). هذا إلى أن التأكيد على قيمة العلم تبيّن منذ لحظات الخلق الأولى عندما علم الله سبحانه آدم الأسماء كلها، أي مفاتيح المعرفة ودلالات الأشياء (تنظر سورة البقرة، الآيات 33-31).
([16]) حسن الهنداوي : التعليم وإشكالية التنمية ، ص 51-49.
([17]) عبد الستار الهيتي : الحوار .. الذات والآخر ، ص 44.
([18]) وتنظر الآيات: الأحزاب 62، الكهف 55، الفتح 23-22، الأنعام 34، محمد 10، السجدة 26، الرعد 6.
([19]) رواه ابن عمر مرفوعاً ، كما رواه بلفظ آخر كل من أبي نعيم في الحلية والأصفهاني في الترغيب والطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان والديلمي في الفردوس ، ورغم ضعف الأسانيد فان اجتماعها يكسب الحديث قوة. ومعناه صحيح.
([20]) ذكره علي بن العزيز في المنتخب بإسناد حسن عن أنس (رضي الله عنه): عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني، “باب الحرث والزراعة”.
([21]) وتنظر الآيات: التوبة 110-109، الرعد 25، هود 88، المائدة 64.
([22]) وتنظر الآيات: الروم 50، الغاشية 20-17.
([23]) حسني محمد نصر وآخرون (إعداد): قضايا إشكالية في الفكر الإسلامي المعاصر، ص 7.
([24]) أحمد القديدي: الإسلام وصراع الحضارات، ص 55.
([25]) أنور الزعبي: رسائل في المنهج والمعرفة، ص 45.
([26]) تنظر: فلسفة الحضارة، ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار الأندلس، القاهرة -1980م، ص 7.
([27]) وتنظر الآيات: آل عمران 93، الأنعام 141، النحل 35.
([28]) عبد الستار الهيتي: الحوار… الذات والآخر، ص 51-50.
([29]) ينظر كتاب: دراسة في المائة الأوائل، ترجمة خالد أسعد عيسى وأحمد غسان سبانو، ط 2، دار قتيبة، بيروت-1979م، ص 24-23, 19.
([30]) أنور الزعبي: مسيرة المعرفة والمنهج في الفكر العربي الإسلامي، ص 18.
([31]) محسن عبد الحميد. مذهبية الحضارة الإسلامية وخصائصها. ص 6.
([32]) بدران الحسن. الظاهرة الغربية في الوعي الحضاري. ص 46.
([34]) وعود الإسلام. ص 218-217.
([37]) إنسانية الإسلام. ص 379-380.
([38]) قضايا في الفكر المعاصر. ص 35.
([39]) إنسانية الإسلام. ص 388-387.
([40]) الإسلام على مفترق الطرق. ص 18.
([42]) طه جابر العلواني، الأزمة الفكرية المعاصرة. ص 14.
([44]) اسحق فرحان وآخرون. نحو صياغة إسلامية لمناهج التربية. ص 6.
([46]) اسحق فرحان. التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة. ص 14.
([47]) عمر عبيد حسنة. مراجعات في الفكر والدعوة والحركة. ص 54.
([48]) محمد جابر الأنصاري. تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها. ص 49-48.
([49]) سليمان الخطيب، فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي. ص 7.
([50]) فادي إسماعيل. الخطاب العربي المعاصر. ص 12-11.
([51]) محمد جابر الأنصاري. تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها. ص 49.
([52]) الإسلام على مفترق الطرق. ص 18.
([53]) الإسلام على مفترق الطرق. ص 18.
([55]) ينظر بالتفصيل: عماد الدين خليل. تهافت العلمانية. هامش 5. ص 55-54.
([56]) الاقتصاد السياسي. 148/1.
([59]) عبد الحميد صديقي. تفسير التاريخ. ص 79-78.
([60]) آرثر كوستلر ورفاقه. الصنم الذي هوى. ص 58-57.
([61]) محمد جابر الأنصاري. المحاورة الأخيرة بين سارتر ودي بوفوار. مجلة الدوحة، عدد 77. مايو-1982م.
([62]) حسني محمد نصر (إعداد). قضايا إشكالية في الفكر الإسلامي المعاصر. ص 11. وللمزيد عن حركة إسلامية المعرفة وأهدافها ومعطياتها ينظر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. إسلامية المعرفة: المبادئ العامة -خطة العمل- الإنجازات. عماد الدين خليل. مدخل إلى إسلامية المعرفة. محمد عمارة. إسلامية المعرفة. طه جابر العلواني. الأزمة الفكرية المعاصرة. الطيب زين العابدين (محرّر). المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية. عبد الحميد أبو سليمان. أزمة العقل المسلم. قضية المنهجية في الفكر الإسلامي. إسماعيل الفاروقي. صياغة العلوم صياغة إسلامية. طه جابر العلواني. إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات. المعهد العالمي للفكر الإسلامي. الإصدارات العربية. فتحي ملكاوي (محرّر). نحو نظام معرفي إسلامي. إسماعيل الفاروقي. أسلمة المعرفة. فتحي ملكاوي ومحمد أبوسل (محرران). كتاب مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات.
([63]) المعهد العالمي للفكر الإسلامي. إسلامية المعرفة: المبادئ العامة -خطة العمل- الإنجازات. ص 42-41.
([64]) أبو الحسن الندوي. كيف توجه المعارف في الأقطار الإسلامية. ص 12.
([66]) معالم رئيسية في مسيرة الجامعات الإسلامية في العهد الحديث. ص 40.
([67]) مالك بن نبي. دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين. ص 12.
([69]) أكرم ضياء العمري. الإسلام والوعي الحضاري. ص 7.
([71]) فادي إسماعيل. الخطاب العربي المعاصر. ص 12.
([72]) مالك بن نبي: مشكلة الثقافة. ص 72.
([73]) إنسانية الإسلام. ص 431.
([76]) المرجع نفسه. ص 331-330.
([78]) المرجع نفسه. ص 388-387.
([82]) الطريق إلى مكة. ص 324-323.
([84]) الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط. ص 73-72.
([88]) رجال ونشاء أسلموا. 109-108/4.
([91]) الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة. ص 255.
([93]) محمد رسول الله. ص 346-345.
([94]) محمد في المدينة. ص 509.
([95]) وعود الإسلام. ص 209-208.
([96]) الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري. ص 145-144.
([97]) روجيه (رجاء) غارودي. وعود الإسلام. ص 111.
([100]) المرجع نفسه. ص 209-208.
([104]) عباس محجوب. نحو منهج إسلامي في التربية والتعليم. ص 91.