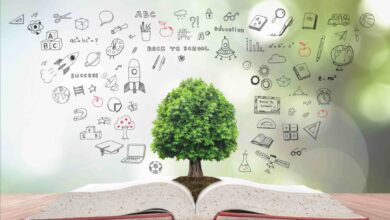04- الرؤية التربوية في القرآن والسنة
بحث مقدم لصالح مشروع إحياء نظام تربوي أصيل
أنجز في: 04 ربيع الأول 1431 هـ / 18 فبراير 2010م
جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمشروع ومسجلة رسميـًا ومحمية بموجب القانون.
الرؤية التربوية في القرآن والسنة
إن محور الرؤية التربوية في الإسلام هو إخراج الأمة الصالحة المصلحة، والتي أساسها هو الإنسان فردا واجتماعا، ومن ثم فإن أُفُقَ هذه الرؤية الأسنى هو إخراج الإنسان الصالح المصلح عن طريق ضبط تصوراته لعناصر الوجود – الله، الكون، الإنسان، الحياة والآخرة – وضبط علاقاته معها، وإكسابه الخبرات التي تمكنه من أن يجري هذه العلاقات وفق مقتضيات تلك التصورات… وذلك عن طريق بذل جهد واع ممنهج ومرحلي متوسل بكل الوسائل المشروعة، نستنتج من هذا – إذن – أن عملية إخراج الأمة الصالحة المصلحة تتم عبر خطين متوازيين: خط علمي ضابط للتصورات، وآخر عملي ضابط للعلاقات والتنزيلات، وتندرج تحت كل منهما أقسام سوف نخلص بمجرد استيفاء عرضها إلى الحديث المباشر عن غايات هذه الرؤية التربوية، والذي سنديره على محورين هما الربانية والقوة..
وفيما يلي الخطوط العريضة لهذه الرؤية، حتى إذا تمت الموافقة عليها، أو أدخلت عليها بعض التعديلات، مررنا إلى المرحلة الثانية من الإنجاز والتي سوف تكون إن شاء الله أكثر ضفاء.
المبحث الأول: ضبط تصورات الإنسان وعلاقاته.
أولاً: الخط العلمي
ضبط التصورات عن الله والكون والإنسان والحياة والآخرة.
القسم الأول: العقيدة في الله.
وهي أس بناء ديانة الإنسان المؤمن، إن استوت استوى الدين، وإن انحرفت انحرف، وقد وصف الله أسباب خسران أقوام فقال: ﴿فذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين﴾ [فصلت، 23] وهذا القسم ثابت كله، لا يتغير بتغير المكان ولا الزمان، ومصدره هو كتاب الله وسنة مصطفاه e.
القسم الثاني: العقيدة في الآخرة.
ومصدر العلم بها أيضاً كله خبري عن الله عز وجل، وعن رسوله e، وهو قسم ثابت أيضاً، لا يتغير بتغير زمان ولا مكان.
القسم الثالث:التصور للكون.
وهو يتفرع إلى فرعين: الأول ثابت ومصدره الكتاب والسنة، أقصد الآيات والأحاديث التي فيها بيان لحقيقة الكون ومآله.. وفرع ثان يتطور بتطور وسائل إدراك الإنسان ومناهج بحثه في الآفاق..
القسم الرابع: التصور للإنسان.
وهو كسابقه يتفرع إلى فرعين: الأول ثابت، ومصدره الكتاب والسنة، والثاني يتطور بتطور وسائل البحث والإدراك في مجال الأنفس، يقول تعالى: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد﴾ [فصلت، 53]
القسم الخامس: التصور للحياة.
وهو أيضاً يتفرع إلى فرعين: الأول مصدر المعرفة به الكتاب والسنة، والثاني تأتي معرفته من تنقيب الإنسان وبحثه، وهو فرع مركّب، لأنه ملتقى المعرفة بالآفاق والأنفس وما ينتج عن ذلك من علوم ومعارف.
ثانياً: الخط العملي
ضبط العلاقات بالله والكون والإنسان والحياة والآخرة:
القسم الأول:العلاقة بالله تعالى.
وهي علاقة عبودية، وهذا القسم يتفرع إلى ثلاثة فروع أساسية:
- فرع شعائري: وموضوعه علاقة العبد بربه وخالقه، ومصدر التنشئة عليه هو الوحي بشقيه.
- فرع اجتماعي: وموضوعه علاقة الفرد المسلم بالجماعة والحياة الاجتماعية، وهو يتطلب من التربية أن تعرّف المتعلمين بأشكال التكافل الاجتماعي، والفضائل الاجتماعية، وتوجيهات الوحي في ذلك، وتدرّبَهم على ممارستها، ويتفرع عن هذا دراسة ما ينتاب الاجتماع البشري وتعاقب الحضارات والعمران من نوازل، وتنوع في الأحوال والأحداث التي تنتاب مظاهر ذلك كله، واكتشاف قوانينها وعلاقاتها التي تترتب عليها، لأن ذلك كله يرشد إلى معرفة أفعال الله في الاجتماع البشري، وإلى آثار القرب منه وآثار البعد عنه. (1)
- فرع كوني: وموضوعه توجيهات الوحي حول علاقة الفرد بالكون المحيط، ويتطلب من التربية أن تُعرّف المتعلمين بدقة الصنعة الإلهية في الكون المحيط ومكوناته، وأن تدربهم على اكتشاف القوانين التي تنتظم الكائنات الطبيعية، واكتشاف خصائصها وتطبيقاتها، وتدريب المتعلمين على أشكال التعامل معها والانتفاع بها حسب التوجيهات الإلهية، لأنه من خلال هذا التعليم والتدريب يصل المتعلم إلى معرفة قدرة الله وإتقان صنعته في المخلوقات، وكثرة أصنافها وتنوع أحوالها، ووفرة نعم الله الناتجة من الانتفاع بها معرفة تفوق الحصر والإحاطة.
القسم الثاني: العلاقة بين الإنسان والآخرة.
وهي علاقة مسؤولية وجزاء تقتضي من التربية الإسلامية تنشئة المتعلمين على دوام استحضار الموقف بين يدي الله، واستحضار أحوال الآخرة، وتحمل المسؤولية التامة بخصوص المصير الذي سيؤولون إليه.
القسم الثالث: العلاقة بين الإنسان والكون.
وهي علاقة تسخير، وقد ذكر طرف مما يقتضيه هذا القسم من التربية الإسلامية، ويتطلبه منها، حين الكلام عن الفرع الكوني من العبادة.
القسم الرابع: العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان.
وهي علاقة عدل وإحسان وتقتضي تنشئة المتربين على العلم بأوامر الله بخصوص ذلك، وكذا العلم بأحوال المجتمعات المتقلبة، وبكون العدل والإحسان مكتسبَين لا يمكن الحفاظ عليهما حال وجودهما إلا بدوام رعايتهما وتحصينهما وبنائهما بالعمل الدؤوب الخالص لوجه الله قصد التوصل إلى ذلك حال غيابهما.
القسم الخامس: العلاقة بين الإنسان والحياة.
وهي علاقة ابتلاء لا فوز فيه ونجاة منه إلا بالإنجاز الإيجابي المسترشد بشرع الله، والذي هو عبارة عن قوانين وسنن منظمة ومعززة للعمل الصالح. مصداقا لقوله تعالى: ]الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور[ [الملك، 2] ويقتضي هذا من التربية الإسلامية تنشئة المتربين على اكتساب المهارات الممكنة لهم من هذا الفعل الإيجابي أثناء حياتهم مع دوام مراقبة الله في أعمالهم وتقلباتهم في هذه الحياة، لأنها –وكما سلف- ابتلاء مستمر، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً﴾ [الكهف، 7].
المبحث الثاني: التنشئة على محوري الربانية والقوة.
يمكن أن نستخلص مما مضى أن الدين الإسلامي يتغيّى تربية الإنسان حسب محورين أساسيين: الربانية والقوة، وفيما يلي بيان ذلك:
أولاً: الربانية.
والمقصود بالتربية الربانية أن تكون غايتها ربانية، يقصد بها وجه الله والدار الآخرة، ويكون مصدرها ربانياً لا تخترقه زيادات الناس أو تشوبه أهواؤهم، وقد جمع المعنيين قوله تعالى: ﴿ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون﴾ [آل عمران، 78]هذه التربية الربانية تصوغ النفس الإنسانية بعلم الله، فتكون نتيجتها الإنسان الرباني الذي يعيش بعلم الله فيما يصّدق وفيما يطّبّق، فيما يعتقد وفيما يفعل، فيلتقي الخلق والأمر، وينسجم العقل والفطرة، ويكون الوحي علما في صدره، ونوراً في قلبه.
يظهر ذلك في إيمانه بالله عز وجل، حيث يمتزج العلم به سبحانه مع محبته والخشية منه، فرؤيته لنعم الله تورثه محبته، وخوفه من بأسه وعقابه يورثه الخشية منه.
ويظهر ذلك أيضاً في إيمانه بالملائكة، حيث يمتزج الإيمان بهم مع المراقبة الشديدة للنفس حتى لا يشهدوا عليه بذنب، ولا يصعدوا له إلا بكلم طيب وعمل صالح.
ويظهر في إيمانه باليوم الآخر، حيث يمتزج العلم به مع الاستعداد له، فهو يوم غائب عن الحس، لكنه حاضر بمشاهده في القلب، يؤثر فيما يأتيه الإنسان في العمل وما يذره، وتصير الحياة الدنيا سعياً للآخرة.
ويظهر في إيمانه بالكتب والرسل، حيث يمتزج الإيمان بهم مع اتخاذ الكتاب النموذج النظري للسلوك، والنبوة النموذج العملي له، كما يظهر في إيمانه بالقدر، حيث يمتزج عنده شهود كلمات القدر وامتثال كلمات الشرع، ويلتقي في قلبه التسليم بالقدر، واتقاء سوء الخاتمة بالعمل.
وأهم ما ينبغي أن تركز عليه التربية الإسلامية في محور الربانية بعد الإيمان بأركانه الستة، الأمور الأربعة الآتية:
- إخلاص النية: فالعبادة لا تقبل، ولا الأعمال، إلا إذا أخلصت لله وحده، يقول تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء﴾ [البينة، 5] ويقول سبحانه: ﴿قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومما تي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين﴾ [الأنعام، 162-163] ويقول e: “إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً.” (2)
- مراقبة الله تعالى: وذلك لتأخذ الأعمال حظها من الإحسان والإتقان، ففي البخاري ومسلم أن جبريل سأل رسول الله e عن الإحسان، فقال له: “الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.” فما شيء يحفز الإنسان على الإحسان في الأعمال مثل اليقين بأن الله عز وجل مطلع عليها، ﴿وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير﴾ [الحديد، 4]
- محاسبة النفس: فإذا كان تصحيح النية قبل العمل، والمراقبة عند العمل، فإن المحاسبة تأتي بعد العمل، قال رسول الله e: “الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفس هواها وتمنى على الله الأماني.” (3) وأهمية المحاسبة تأتي من كونها ما تفتأ دافعة إلى الاجتهاد، وتصويب الأخطاء واستدراكها، وكذا حافزة على استكمال أوجه النقص، والتوق إلى الكمال، كما أنها تنأى بالإنسان عن أن يسقط في العجب والغرور، ولذلك قال الله عز وجل إشارة إلى أهمية محاسبة النفس: ﴿ولاأقسم بالنفس اللوامة﴾ [القيامة، 2]
- التوكل على الله: وهو لا يعنى بحال اطراح الأسباب، وإهمال السنن، وانتظار الحصاد بغير زرع، أو نمو الزرع بغير تعهد، بل التوكل ما كان عليه النبي e والرسل من قبله: بذل ما في الوسع مع الاعتماد على الله قبلاً وبعداً وأثناء، ثقة به، ويقيناً بوعده، وإيماناً بنصره. (4)
والتوكل من أقوى العدد الروحية والمعنوية التي تحيل ضعف الأمة قوة، وقلتها كثرة، وافتقارها وفرة، يقول جل ثناؤه: ﴿وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده﴾ [الفرقان، 58] ويقول سبحانه: ﴿فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين﴾ [آل عمران، 159] كما يقول سبحانه: ﴿إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين﴾ [يونس، 84].
ثانياً: القوة.
يقول الله عز وجل: ﴿خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه﴾ [البقرة، 63] ويقول سبحانه: ﴿خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا﴾ [البقرة، 93] ويقول تعالى مخاطباً موسى: ﴿فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها﴾ [الأعراف، 145] ويقول سبحانه: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل﴾ [الأنفال، 60] ويقول رسول الله e: “المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.” (5)
والتربية الإسلامية ينبغي أن تسعى إلى إكساب المربى القوة بكل أصنافها ومعانيها..
القوة في العقل، القوة في الروح، القوة في الخبرة بكل أنواعها، القوة في الإرادة، القوة في قدرة التسخير، القوة في الجسم ..
أولاً: القوة في العقل.
وذلك بإكساب المربى منهج التفكير السليم بمكوناته الإساسية الثلاثة: خطوات التفكير، أشكال التفكير، أنماط التفكير.
- خطوات التفكير: وهي كما بينها المنهج القرآني ينبغي أن تكون على الشكل الآتي:
- التعرف على الظاهرة، انطلاقاً من قوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً﴾ [الإسراء، 36]
- التعرف على التفاصيل: وذلك بتدبرها وتصنيفها، وعدم التسرع في إطلاق الأحكام انطلاقاً من قوله تعالى: ﴿إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم* لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم* يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين﴾ [النور، 15-17]
- اكتشاف الحكمة الكامنة وراء الظاهرة، واتخاذ الموقف عن طريق الاستنباط، انطلاقاً من قوله تعالى: ﴿وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً﴾ [النساء، 83]
- أشكال التفكير، وهي:
- التفكير المسؤول: انطلاقاً من قوله تعالى: ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم﴾ [الشورى، 30]، مما يدفع الإنسان دائماً إلى تحمل مسؤوليته وعدم شجب أخطائه على الغير، يقول تعالى: ﴿وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين * قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين﴾ [الأعراف، 22-23]
- التفكير الشامل غير الجزئي: انطلاقاً من قوله تعالى: ﴿بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله﴾ [يونس، 39]، فالتفكير الجزئي قد يؤدي إلى معاداة بعض الحقائق، لذلك وجب تكوين المربى على ان يكون عنده تفكير شمولي، وهو تفكير لا يتيسر ما دامت تخترقه فراغات يسببها الجهل الذي يعتبر العائق الأساس أمام الإبصار مصداقا لقوله تعالى: ﴿بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه﴾ وقوله سبحانه: ﴿وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم﴾ (6)
- التفكير التجديدي المهتدي بدل التفكير المقلد الضال: انطلاقاً من مثل قوله جل وعلا في حق ذي القرنين ]إنا مكّنا له في الأأرض وءاتيناه من كل شيء سببا، فاتبع سببا[، حيث نجد في هذا المشهد القرءاني الدّال بهذا الصدد، أن ذا القرنين كان يجدّد انطلاقا من إدراك السننية التي بني عليها الكون، بأن يضيف الأسباب المبتكرة إلى الأسباب المتاحة، وكذلك تجديده ابتكاره لأساليب متجددة في العمل الجماعي، وتحميل الناس مسؤولياتهم، في ربط لكل ذلك برحمة الله سبحانه ]كذلك، وقد أحطنا بما لديه خُبرا.ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السُّدّين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سُدًّا[[الكهف 91-94]. وذلك في تجانف عن التقليد الأعمى والذي نرى إدانته والتنفير عنه في مثل قوله تعالى: ﴿قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون﴾ [البقرة، 170] وقوله سبحانه: ﴿ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين * إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون * قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين * قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين﴾ [الأنبياء، 51-54]
- التفكير العلمي بدل الظن والهوى: فالمؤمنون في القرآن والسنة هم “أولو الألباب” و “أولو النهى”. والقرآن آيات “لقوم يعقلون” أو “يتفكرون” وفي القرآن دعوة واضحة إلى التثبت والبحث والتنقيب، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاًًًًً﴾ [الإسراء، 36] وقوله تعالى: ﴿قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق﴾ [العنكبوت، 20]، ونهى سبحانه عن اتباع الظن في مثل قوله تعالى: ﴿إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً﴾ [النجم، 28] وقوله سبحانه: ﴿إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس﴾ [النجم، 23]، وقال رسول الله e: “إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.” (7)
- التفكير الجماعي بدل التفكير الفردي: انطلاقاً من مثل قوله تعالى: ﴿والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون﴾ [الشورى، 35]. وقد جعل بعض المفسرين أمعن آية في التحدي بكتاب الله قوله تعالى: ﴿قل لئن اجتمعت الإنسا والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً﴾ [الإسراء، 88] وما ذلك إلا لما في التفكير الجماعي من قوة… ومن التوجيهات إلى التفكير الجماعي قوله تعالى: ﴿واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة﴾ [الأنفال، 25]، فالمصير مشترك، إذن فالتفكير ينبغي ان يكون جماعياً.
- التفكير السنني انطلاقاً من مثل قوله تعالى: ﴿فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنةالله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً﴾[فاطر، 43]. فأول درجات القدرة على تسخير الكون والقوة والإنتاجية في التفكير: العلم بأن كل شيء له سننه وقوانينه التي أودعها الله فيه، ويسير حسبها، وهي سنن لا تتخلف، ومن صادمها غلبته، ومن عرفها ووظفها أعانته، بمقدار ما ينجح الإنسان في الكشف عن هذه السنن والقوانين وفي حسن استخدامها، والتوافق معها، بمقدار ما يستطيع تسخير الكون والاجتماع البشري، ورقيه خلال أطوار النشأة والحياة والمصير.” (8)
- تعليم أنماط التفكير والتدريب عليها، ومنها:
- التفكير التحليلي: انطلاقاً من مثل قوله تعالى: ﴿قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً﴾ [الإسراء، 49] وقوله سبحانه: ﴿قل هل من شركائكم من يبدؤ الخلق ثم يعيده قل الله يبدؤ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون * قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهِدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون﴾ [يونس، 34-35] وقوله تعالى: ﴿أفنجعل المسلمين كالمجرمين * ما لكم كيف تحكمون * أم لكم كتاب فيه تدرسون * إن لكم فيه لما تخيرون * أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون * سلهم أيهم بذلك زعيم * أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين﴾ [القلم، 35-41]
- التفكير التجريبي: انطلاقاً من مثل قوله تعالى: ﴿قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق﴾ [العنكبوت] وقوله: ﴿أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت﴾ [الغاشية، 17-20]
- التفكير الأخلاقي: انطلاقاً من مثل قول الله جل وعز: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر الله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾ [البقرة، 230] وقوله تعالى: ﴿قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم * يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين * ومثل الذين ينففقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير * أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون﴾ [البقرة، 263-265] وقد عرفوا التفكير الأخلاقي بكونه “يهتم بالتقديرات التي تفاضل بين المواقف والأعمال وتقومها، ويصدر أحكامه إزاءها من حيث صلاحها أو سوؤها، وخيرها أو شرها، في ضوء عقائد ومبادئ معينة.” (9)
- التفكير الجمالي: وقد عرفوه بأنه “يهتم بالتقديرات التي تفاضل بين الأشياء والمواقف والأعمال والمنتجات ويقومها ويصدر أحكامه إزاءها من حيث جمالها أو قبحها، في ضوء معايير جمالية معينة.” (10) وهذا النمط من التفكير هو الذي كان العبد الصالح لقمان يربي عليه ابنه حين خاطبه قائلاً: ﴿ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور * واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير﴾ [لقمان، 17-18]
- التفكير المستقبلي: فمن معالم القوة التي ينبغي أن تكسبها التربية الإسلامية للمسلمين أن يكون تفكيرهم مستقبلياً، والمتدبر لكتاب الله تعالى يجده دائماً يعلق أنظارهم بالمستقبل الذي يغذون السير في الدنيا نحو الآخرة، حتى يعدوا لذلك أنفسهم، ففي سورة المزمل المكية التي نزلت في فترة لا مؤشر فيها على القتال جاء تنبيه الله للمسلمين أنهم مدعوون إلى القتال في سبيل الله حيث قال عز من قائل: ﴿إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه﴾ [المزمل، 18] وذكر ابن كثير في تفسير لقوله تعالى: ﴿سيهزم الجمع ويولون الدبر * بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر﴾ [القمر، 45-46] أن عمر بن الخطاب t قال حين نزلت: أي جمع يهزم؟ أي جمع يغلب؟ فلما كان يوم بدر رأى رسول الله e يثب في الدرع وهو يقول: ﴿سيهزم الجمع ويولون الدبر﴾ فعرف تأويلها يومئذ. (11) قال ابن كثير: وروى البخاري عن عائشة قالت: نزل على محمد e بمكة وإني لجارية ألعب ﴿بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر﴾. كما يتضح التدريب على هذا التفكير المستقبلي من خلال قوله تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد[ [الحشر، 18]، وبالجملة فالقرآن المجيد كله تدريب للإنسان أن لا ينحبس في الماضي ولا الحاضر ويكون دائم الرنو إلى المستقبل.
ويعجبني في ختام هذا المبحث حول وجوب تطلع التربية الإسلامية إلى أفق إكساب المسلمين القوة في الجانب الفكري – وقد بسطته لأهميته – أن أورد نصاً للدكتور مقداد يالجن بهذا الخصوص، قال فيه: “فكما أن كل فلسفة أو أيديولوجية اليوم تحاول عن طريق التربية تكوين عقلية تفكر بمنطقها، وتنظر بمنظارها على الكون والحياة، وتقوم الحياة بمعاييرها، كذلك يجب علينا اليوم أن ننشئ أفراد المجتمع ونكونهم عن طريق التربية، بحيث يفكرون بالعقلية الإسلامية، وينظرون بمنظار الإسلام إلى الكون والحياة، ويقومون الحياة بمعاييره، فإن التربية تكاد تكون فناً، أكثر من أن تكون علماً بحتاً، تهتم أكثر ما تهتم بتشكيل الأفراد وصياغتهم على النحو المراد.” (12)
ثانياً: القوة في الروح.
فطاقة الروح وحدها في كيان الإنسان هي التي لا تعرف الحدود والقيود، لاتعرف الزمان والمكان، لاتعرف البدء والنهاية، لا تعرف الفناء.. هي وحدها التي تملك الاتصال بما لا يدركه الحس، ولا يدركه العقل، هي وحدها تملك الاتصال بالخلود الأبدي والوجود الأزلي.. تملك الاتصال بالله، كما أنها هي التي تملك الاتصال بالوجود كله من وراء حواجز الزمان والمكان.. (13) وطريقة الإسلام في تربية الروح بالإضافة إلى ما ذكرناه في محور الربانية:
- التدريب على الكلم الطيب ﴿ولذكر الله أكبر ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ حتى تنعقد صلة دائمة بين الإنسان وربه.
- إكساب الإنسان مثلاً أعلى، ونعني به نموذج الحياة التي أراد الله للإنسان أن يحياها، وللأمة أن تعيش طبقاً لهم، والله عز وجل يقول: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً﴾ [الأحزاب، 21]
وفي القرآن الكريم آيات كثيرة من مثل فواتح سورة المؤمنون، وخواتيم كل من سورتي البقرة والفرقان – مثلاً – ترسم معالم النموذج الذي ينبغي للمسلم أن يكونه.
ثالثاً: القوة في الخبرة بكل أصنافها.
ونقصد الخبرة الكونية والشعائرية والكونية والاجتماعية… وقد مضى معنا طرف من ذلك.
رابعاً: القوة في الإرادة.
وجانب منها يتحقق بالقوة في العقل.. والثاني بتوعية الإنسان بالمسؤولية الملقاة على كاهله، وإخباره بأنه مراقب ( وقد مر الكلام عن رقابة الله ) وما الأمر بالصيام وإقامة الصلوات وتزكية الأموال واجتناب المحارم إلا خير سبيل لتقوية الإرادة عند الإنسان..
خامساً: القوة في قدرة التسخير.
وقد تضمنت آيات كثيرة من كتاب الله التوجيه إلى اكتساب هذه القوة من مثل قوله تعالى: ﴿وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز﴾ [الحديد، 24]
قال القرطبي في تفسير هذه الآية:”أي أنزل الحديد ليعلم من ينصره”(14). وقد أثنى رب العزة جل شأنه على ذي القرنين بما اتبع من الأسباب، فاكتسب القدرة التسخيرية التي مكنته من إقامة السد لإيقاف يأجوج ومأجوج، [الكهف، 82-94] فالتسخير قوة، وقد أُمر المسلمون بإعداد القوة في قوله تعالى: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل﴾ [الأنفال، 60]، وتم تنكير القوة في هذه الىية ليفيد ذلك الاستغراق والاستيعاب لكل أنواع القوة المشروعة الممكن تصورها.
سادساً: القوة في الجسم.
باعتبار أن الجسم مطية الإنسان في الدنيا، وأداته الإنجازية للأعمال المادية بكل أصنافها، فوجب أن تكون هذه الأداة قوية العرى وثيقة البنيان…
فهذه بعض معاني القوة التي ينبغي للتربية الإسلامية أن تربي عليها المسلمين كيما يرتادوا آفاق العزة المُمكّنة من إظهار هذا الدين على حقيقته، وإشاعة رحمة الله على العالمين، وغير خاف أن هذه الآفاق تقتضي بلورة مناهج عملية وممرحلة ديداكتيكيا لتمرير هذه المعاني إلى المستهدفين بالتربية، مناهج من المطلوب الاستفادة بشأنها بعد الكتاب والسنة من كل الجهود البشرية الراشدة.
خاتمة.
في ظل الحيرة والتيه العالميين، الناتجين عن الاستحواذ العضوي – استلحاقاً وهضماً – الذي تمارسه المادة اليوم على بني آدم، وفي ظل الاضطراب المذهبي والفكري والقيمي والتشريعي..وكذا في ظل الفوضى الذوقية والمعاشية والمسلكية.. في ظل هذا كله، نلمح صرامة منهجية وفكرية وعلمية بصدد التخلق.(15 وهي صرامة من شأنها أن تَهْبِطَ هذا البناء الذي لا ينبغي أن يغر.. رغم كثرته.. خصوصاً وأن رب العزة قد حفظ الذكر ليكون للناس في حياتهم وكسبهم إماماً، وأرسى لهم القبلة لتكون لهم في عيشهم وكدحهم قياماً، فقال سبحانه: ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم * اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم * ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون * قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون﴾ [المائدة، 99-102]
وعليه، فليس للعالم اليوم، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، غير القرآن المجيد والسنة النبوية المطهرة مَفْزَعاً، وهداها مَشْرَعاً ومَهْيَعاً، بما حفظ الله هذا الذكر وأودعه فيه إذ جعله ترتيلاً من علاماتٍ، ومن قدرة معجزة على التشكل فالتنزيل بشكل مستأنف كل مرة – إلى غير انتهاء – بما ينفع الناس بحسب كِبَر قدرتهم، وإبانة أفقهم في مجال التربية وغيره، إذ هذا الذكر الحكيم، لا يرد سائلاً إلا أغناه بالقدر الذي تتسع له حوصلته ﴿فلا أقسم بمواقع النجوم * وإنه لقسم لو تعلمون عظيم * إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون * لا يمسه إلا المطهرون * تنزيل من رب العالمين﴾ [الواقعة، 78-83].
والله المستعان.