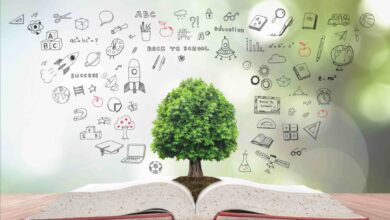02- المحضرة والمدرسة .. أوجه الاختلاف وآفاق الائتلاف
بحث مقدم لصالح مشروع إحياء نظام تربوي أصيل
إعداد : الخليل النحوي
أنجز في : 13 محرم الحرام 1431هـ/ 29 ديسمبر 2009
جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمشروع ومسجلة رسميا ومحمية بموجب القانون.
فهرس محتويات البحث
| خطة البحث |
| توطئة |
| إشكالية البحث |
| الفكرة المحورية للبحث |
| بنية البحث |
| مصطلحات ومفاهيم البحث |
| الحاجة للبحث |
| علاقة البحث بالمشروع |
| منهجية البحث وأدواته |
| الدراسات السابقة |
| الإضافة النوعية للبحث |
| صلب البحث |
| مدخل عام : نشأة النظامين وسماتهما |
| المبحث الأول : عن النظام التربوي الأصيل |
| أولا – في النشأة والتاريخ |
| الأنبياء متعلمين |
| الأنبياء معلمين |
| معلمون رواد |
| الكتاتيب والمجالس والحلقات.. وسائط تأسيسية |
| المدارس.. طور التنظيم |
| ثانيا – في الخصائص والسمات |
| المبحث الثاني: عن النظام التربوي الدخيل |
| أولا – في النشأة والتاريخ |
| ثانيا – في الخصائص والسمات |
| في الأهداف والغايات |
| في الآثار والمخرجات |
| الفصل الأول: المحضرة الشنقيطية |
| المبحث الأول : في نشأة التعليم المحضري |
| أولا – المحضرة / الرباط |
| ثانيا – العلم في الحواضر |
| ثالثا – العلم في البادية |
| المبحث الثاني: في الفكر التربوي عند الشناقطة |
| أولا : الفكر التربوي في التراث الشنقيطي المكتوب |
| ثانيا: أفكار ومبادئ تربوية أساسية |
| في طلب العلم |
| في بث العلم |
| في التأديب العقابي |
| في وسائط التعلم |
| التلقي من أفواه الرجال |
| الترابط العضوي بين الحفظ والفهم |
| المبحث الثالث: في الممارسات المحضرية |
| أولا – منهاج المحضرة: |
| الدرس المحضري (المحتوى) |
| التعليم القرآني |
| مضامين التعليم المحضري |
| معارف المحضرة |
| ترتيب المعارف المحضرية |
| منزلة اللغة العربية بين المعارف المحضرية |
| ترابط المعارف في المحضرة |
| الرياضة والتسلية |
| طرق التدريس |
| التعليم القرآني |
| تدريس المعارف الأخرى |
| وسائل التعليم |
| التقويم |
| التقويم في التعليم القرآني |
| التقويم في التعليم المحضري |
| إدارة الوقت في التعليم المحضري |
| مدة الدراسة والتدريس |
| أوقات الدراسة |
| العطل التعليمية |
| ثانيا – البيئة التربوية |
| موارد المحضرة |
| البيئة المعنوية الحافزة |
| التفرغ من الشواغل |
| قوة الدافعية للتعلم |
| طبيعة الحياة في المحضرة |
| مواعيد احتفالية |
| العلاقة بين الشيخ والطالب |
| المحضرة في خدمة المجتمع |
| المبحث الرابع: فاعلية المحضرة وخصائصها |
| أولا – أثر المحضرة وإشعاعها |
| القيم والمهارات |
| الحصاد الثقافي |
| مقاومة المد التغريبي |
| المساهمة في بناء الدولة الحديثة |
| الإشعاع الخارجي |
| الدارة.. محضرة إفريقية |
| ثانيا: عناصر قوة المحضرة وضعفها |
| الخصائص المميزة للمحضرة |
| عناصر قوتها |
| عناصر ضعفها |
| الفصل الثاني: العلاقة بين النظامين |
| المبحث الأول: المواجهة بين النظامين |
| أولا – الغزو التربوي |
| ثانيا – الممانعة المحضرية |
| المبحث الثاني: التواصل بين النظامين |
| أولا – في عهد الاستضعاف |
| ثانيا – في عهد الاستقلال |
| جسر المناهج |
| جسر الإجراءات التنظيمية |
| المبحث الثالث: تجربة المعاهد المحضرية |
| أولا – النشأة والتاريخ |
| ثانيا – المناهج والنظم |
| ثالثا – المخرجات |
| رابعا – المحضرة النموذجية |
| المبحث الرابع: خلاصة عن أوجه الاختلاف والائتلاف بين النظامين |
| الفصل الثالث: آفاق التواشج بين النظامين التربويين |
| أولا – واقع وآفاق نمو التعليم الأصيل في الفضاء المدروس |
| ثانيا – نحو المزيد من الجسور بين النظامين |
| تجربة المغرب والسودان |
| جسور موريتانية |
| ثالثا – نحو تعليم محضري معاصر |
| الفصل الرابع: دروس مستخلصة لصالح مشروع النظام التربوي الأصيل |
| أولا – منطلقات |
| ثانيا – مستخلصات |
| القسم الأول: الأصول المؤسسة للنظرية |
| المعضلة التربوية |
| الموجهات المرجعية |
| الرؤية التربوية في القرآن والسنة |
| قيمة العلم |
| شروط التعلم وآدابه |
| التجارب التربوية |
| الخصائص الأساسية المميزة للتربية الأصيلة |
| الغايات الأساسية للتربية |
| القسم الثاني: أركان وعناصر النظام التربوي المنشود |
| المنهاج التربوي |
| المقاصد |
| المضامين |
| طرق وأساليب التدريس |
| الوسائل التعليمية |
| التقويم |
| القيادة التربوية |
| مبادئ عامة |
| تنظيم الوقت واستثماره |
| تمويل التعليم |
| العلاقة مع المحيط |
| الخصائص المعمارية |
| القسم الثالث: الخطوط العريضة لملامح النموذج التطبيقي |
| مقاصد وغايات |
| وسائل وأدوات |
| لنحطم هذه الأغلال |
| لنتخفف من هذه الأثقال |
| لنكثف الأعمال |
| نحو خيارات تطبيقية كبرى |
| نحو تحقيب تربوي مختلف |
| أي إطار مؤسسي للتعليم الأصيل؟ |
| مؤسسات النظام التربوي الأصيل |
| قرية اللغة العربية |
| مؤسسات وتدابير التأصيل التربوي |
| ضوابط للعمل |
| ثالثا – ماذا عن الآفاق؟ |
| خاتمة |
| المصادر والمراجع |
خطة البحث
أولا – توطئة:
يطمح مشروع البحث هذا إلى تفحص العلاقات القلقة بين نظامين تربويين يتعايشان على أرضنا منذ أن ضرب فيها “الاستعمار” (بل الاستضعاف الأوربي) أطنابه. وفي تفحص تلك العلاقات، لا مناص من استقراء بعض أوضاع طقسها القلب، في قسمة ضيزى بين الأثيل والدخيل، وفي تذبذب بين التدافع والتدابر طورا والسعي على استحياء إلى التحاور والتواشج أطوارا. وعسانا نخلص من ذلك إلى استجلاء الفرص المتاحة لامتلاك آخية تشد المتحول إلى الثابت، وبوصلة تسدد مسار المتحرك، تأصيلا للدخيل، وتمكينا للأصيل، من غير انبتات ولا ارتكاس.
تمثل المدرسة، في هذه المعالجة، النظام التربوي الطارف الوافد الذي يأخذ هلوعا ويعطي ضنينا ويستأثر مع ذلك بأسباب القوة والنفوذ، من مال وجاه وتحكم في شئون العباد. وتمثل المحضرة (من الفضاء الشنقيطي الموريتاني) النظام التربوي المعمر التالد الذي يأخذ قنوعا، إن هو أخذ، ويعطي غير مكدٍ مما يملك، على قلة في ذات اليد، أو كساد في السوق.
وبين هذين الطرفين، تمثل المعاهد المحضرية حلقة وصل تحاول على استحياء أن تمد جسرا بين النظام التربوي التالد والنظام التربوي الطارف، محاولة الأخذ من كل بخير ما فيه.
ويسعى البحث إلى دراسة أوجه الاختلاف والائتلاف بين هذه الأنظمة الثلاثة، تطلعا إلى اشتقاق طريق للتأصيل التربوي في سياق عالم متغير، على الأمة أن تأخذ فيه بأسباب المنعة والقوة والريادة.
ثانيا – إشكالية البحث
يشكل تفرد التعليم المحدث الوافد بالساحة التربوية أو منافسته الحادة، في أهون الحالات، للتعليم الأصيل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمعات العربية والإسلامية فتسمها إما بطابع الاغتراب أو بطابع الانفصام. فنحن في ظل هذا الوضع بين خيارين أحلاهما مر: إما أن نرضخ لإغراء النموذج الوافد ونخضع لهيمنته ونسعى في اتجاه قولبة الحياة من خلاله، وندفع ثمن ذلك اغترابا واستلابا وانبتاتا من الجذور؛ وإما أن نقاوم ونعض على أصل الشجرة (التربوية) التي تفيء قلة منا إلى ظلها. ونوشك حينئذ أن نقذف بهذه القلة إلى الهوامش القصوى للحياة، حيث لا مشاركة ولا تأثير في صياغة مصائر البشر واختطاط مسارات التحول الحضاري. وخلف الخيارين الماثلين رأي العين هناك خيار ثالث يتعين البحث عنه، وقد يكون بخلاف ما نتوهمه قريب المناط سهل المنال، بشيء من العمل المنهجي السديد.
ولاستكشاف هذا المسار الثالث، يتعين علينا النظر في السبل الكفيلة بالحد من الآثار السلبية للوضع القائم على مجتمعاتنا، والبحث في سبل تغيير الواقع بدءا بما هو متاح من مراجعة للنظم التربوية القائمة، وسعيا إلى إنعاش النظام التربوي الأصيل وإمداده بالمزيد من مقومات الحياة والثبات و/ أو استنبات النظام الوافد في التربة، تأصيلا له ومواءمة بينه وبين البيئة الثقافية والروحية والوجدانية والاجتماعية الأصيلة.
ثالثا: الفكرة المحورية للبحث
يحمل البحث المقترح هم التأصيل في سياق عصر جديد مطبوع بالتحولات المتسارعة. ويسعى في هذا الصدد للإجابات على أسئلة جوهرية مثل:
- هل باستطاعتنا أن نحيي موات النظام التربوي الأصيل ونمد في عمر الحي المتهالك منه، ونفتح أمامه المزيد من آفاق النماء والانتشار؟
- ما هي متطلبات استحياء النظام التربوي الأصيل واستبقائه؟
- هل من سبيل لضخ دماء أصيلة في النظام التربوي الوافد ليتواءم بشكل أفضل مع المتطلبات الخاصة لبيئتنا ويساهم في المحافظة على هويتنا الحضارية وذاتيتنا الثقافية؟
- وهل من سبيل إلى ضخ دماء جديدة في البقية الباقية من نظامنا التربوي الأصيل تتجدد بها خلاياه ويمتد بها أمد حياته؟
- هل هناك فائدة لمد جسور متينة بين النظام التربوي الوافد والنظام التربوي التالد؟ وكيف يتأتى ذلك إن كان مفيدا، وهل باستطاعة النظامين في حالة تواشج بينهما أن يتعاونا على صياغة مجتمع منسجم متجذر في ثقافته الأصيلة متفتح على عصره ومحيطه؟
- ما هي الدروس التي يمكن استنباطها من الإجابات المحتملة عن الأسئلة السابقة، وبأي وجه نستطيع توظيفها في صياغة نظام تربوي أصيل جديد قابل للتطبيق والاستدامة؟
رابعا: بنية البحث
تقوم بنية البحث على أربعة قواعد هي مدخل عام وثلاثة فصول وخاتمة، وترد في نهايته قائمة المصادر والمراجع.
نتناول في المدخل العام نشأة النظامين التربويين موضع البحث وسماتهما، وذلك من خلال مبحثين:
- المبحث الأول : عن النظام التربوي الأصيل.
- المبحث الثاني: عن النظام التربوي الدخيل.
أما الفصل الأول، فنتناول فيه المحضرة الشنقيطية من خلال أربعة مباحث تتناول نشأة التعليم المحضري وتطوره والفكر التربوي عند الشناقطة والممارسات المحضرية وفاعلية المحضرة وخصائصها، وذلك وفق التفريعات التالية:
المبحث الأول : في نشأة التعليم المحضري
ويتضمن ثلاثة مباحث فرعية:
- المحضرة الأولى أو الرباط
- بوادر العلم في الحواضر
- انتشار العلم في البادية
المبحث الثاني: في الفكر التربوي عند الشناقطة
ويتضمن مبحثين فرعيين:
- الفكر التربوي في التراث الشنقيطي المكتوب
- أفكار ومبادئ تربوية أساسية بشأن طلب العلم وبثه وتأديب المتعلمين ووسائط التعلم الأساسية.
المبحث الثالث: في الممارسات المحضرية
وفيه نتطرق إلى مبحثين فرعيين هما منهاج المحضرة وبيئتها التربوية وفق التفصيل الآتي:
- منهاج المحضرة، متضمنا أربعة عناصر هي المحتوى التعليمي وطرق التدريس ووسائل التعليم والتقويم وإدارة الوقت، وذلك على النحو التالي:
- الدرس المحضرى (المحتوى)، مشتملا على خمسة فروع:
- المعارف المحضرية
- ترتيب المعارف المحضرية
- منزلة اللغة العربية بين هذه المعارف
- ترابط المعارف في المحضرة
- الهوامش المتاحة للرياضة والتسلية
- طرق التدريس
- وسائل التعليم
- التقويم
- إدارة الوقت في التعليم المحضري، متضمنة العناصر التالية:
- مدة الدراسة والتدريس
- أوقات الدراسة
- العطل التعليمية
- الدرس المحضرى (المحتوى)، مشتملا على خمسة فروع:
- أما البيئة التربوية المحضرية، فنتناول فيها عنصرين:
- موارد المحضرة
- البيئة المعنوية الحافزة، وتحتها نتناول العناصر الفرعية الخامسة التالية:
- التفرغ من الشواغل
- قوة الدافعية للتعلم
- المواعيد الاحتفالية في مسيرة الطالب
- العلاقة بين الشيخ والطالب
- دور المحضرة في خدمة المجتمع
المبحث الرابع: فاعلية المحضرة وخصائصها
وفيه نتطرق إلى مبحثين فرعيين عن أثر المحضرة وإشعاعها، وعناصر قوتها وضعفها:
- أثر المحضرة وإشعاعها، وفيه نتناول ستة عناصر:
- المخرجات البشرية
- الحصاد الثقافي
- مقاومة المد التغريبي
- المساهمة في بناء الدولة الحديثة
- الإشعاع الخارجي
- الدارة في السنغال وأثر المحضرة فيها
- عناصر قوتها وضعفها، وفيه نتناول ثلاثة عناصر:
- الخصائص المميزة للمحضرة
- نقاط قوة المحضرة
- ونقاط ضعفها
أما الفصل الثاني فنلقي فيه نظرة حول العلاقة بين النظامين من خلال أربعة مباحث تتناول أوجه التدابر والتواصل بين النظامين وتجربة المعاهد المحضرية، وفق التبويب التالي:
المبحث الأول: المواجهة بين النظامين، وفيه عنصران:
- الغزو التربوي
- الممانعة المحضرية.
المبحث الثاني: التواصل بين النظامين، وفيه عنصران:
- التواصل في عهد الاستضعاف
- التواصل في عهد الاستقلال، ومن خلاله ننظر في جسرين:
- جسر المناهج
- جسر الإجراءات التنظيمية.
المبحث الثالث: تجربة المعاهد المحضرية، وفيه نتطرق إلى المباحث الفرعية الثلاثة الآتية:
- النشأة والتاريخ
- المناهج والنظم
- المخرجات
- تجربة “المحضرة النموذجية”
المبحث الرابع: خلاصة عن أوجه الاختلاف والائتلاف بين النظامين.
وفي الفصل الثالث نعالج آفاق التواشج بين النظامين التربويين الأصيل والدخيل، ونتعرض في هذا السياق إلى:
- واقع وآفاق نمو التعليم الأصيل؛
- الجسور بين النظامين انطلاقا من تجارب مغربية وسودانية وموريتانية
- ملامح نظام محضري معاصر.
أما الفصل الرابع فنفرغ فيه لاستخلاص الدروس من البحث، بما يفيد مشروع النظام التربوي الأصيل. وفيه نعرض:
- منطلقات أساسية
- مستخلصات مبوبة وفق تبويب وثيقة الملامح النهائية للمشروع. ونتناول في هذه المستخلصات –على الخصوص- رؤية أولية لنمط المؤسسات التربوية المنشودة، وما يتصل بها من تحقيب وموجهات عمل.
- كلمة عن الآفاق المتاحة لخريجي النظام التربوي الأصيل المنشود.
وفي الخاتمة، نقدم أفكارا أساسية نخلص بها من البحث، طبقا لما يوصي به الإطار النمطي لتنظيم البحوث.
ثم نلحق بالبحث قائمة بالمصادر والمراجع.
خامسا: مصطلحات ومفاهيم البحث الأساسية:
ستستخدم في ثنايا البحث المصطلحات الآتية بالمفاهيم والمدلولات المبينة إزاء كل منها:
| المصطلح | مدلوله |
| المحضرة | مؤسسة شنقيطيية تعليمية أصيلة، تقوم على طوعية التدريس ويتلقى الدارسون فيها معارف متدرجة في علوم الدين واللغة وغيرها من المعارف الأصيلة. |
| النظام التربوي الوافد/ المحدث/ الطارف/ الدخيل | مترادفات يقصد بها النظام التعليمي الموروث بمناهجه ونظمه وآلياته عن الإدارة الفرنسية في عهد الاستضعاف والمتمثل في مؤسسات التعليم النظامي بمختلف مستوياتها، عمومية كانت أو خصوصية. |
| النظام التربوي التالد | النظام التربوي الأصيل المعمر المتوارث على مدى القرون، ممثلا بالمحضرة الشنقيطية |
| المعاهد المحضرية | مؤسسة تربوية خلاسية أخذت من المحضرة شطرا مهما من المنهاج، يتمثل خاصة في التركيز على المعارف الدينية واللغوية والاهتمام – غالبا – بالمتون التي درجت المحضرة على تدريسها، وأخذت من النظام التربوي الوافد نظمه وبناه فيما يتصل خاصة بالتسلسل الدراسي ونظام التقييم التربوي والشهادات والمنشآت الدراسية |
| الدولة | مصطلح محضري يطلق على مجموعة صغيرة من الطلبة (2-4) تشترك في دراسة متن واحد وتتعاون على تكراره ومراجعته، ويتم ذلك عادة بأن يقوم كل عضو في المجموعة بدور المدرس لزملائه في إعادة استطهار معاني الدرس بعد تلقيه من الأستاذ. |
| الراحلة | مصطلح محضري مناظر لمصطلح الدولة، ولكن في مجال السكن وتقاسم أعباء الحياة. ويطلق من هذا الوجه على مجموعة من الطلبة قد تصل إلى العشرة تتقاسم طعامها، وتتعاون على تأمين الخدمة الضرورية لها في مجال إعداد الشاي والطعام والشراب ورعاية الماشية ونحو ذلك من شئون المعاش. |
| مساق النحلة | يرد رديفا لما أسميناه مرحلة التعليم. ويقصد به السير على خطى النحلة التي تقول الحكمة المحضرية إنها ترعى من كل نابتة، على حد قول الشاعر: من كل علم تعلم تبلغ الأملا ولا يكن لك فن واحد شغلا فالنحل لما رعت من كل نابته أبدت لنا الجوهرين الشمع والعسلا ويعني ذلك أن تتاح للطالب في هذه المرحلة فرصة الاطلاع على تشكيلة مختارة من المعارف، منها معارف أساسية أصيلة، لا غنى لأي طالب عنها، ومعارف إضافية تستكشف بها قابليات الطلبة في بعض الميادين المعرفية لتوجيههم نحوها عند الاقتضاء. |
| مساق القبلة | يرد رديفا لما أسميناه مرحلة التزكية. ويشير إلى أن الطالب في هذه المرحلة أو في هذا الطور من ترقيه في مدارج المعرفة ينبغي أن يولي وجهه شطر غرض معرفي معين، يفرد له وجهته حتى يكون فيه حجة أو قدوة إماما. ولا مانع من أن يولي الطالب وجهه شطر قبلة أخرى (تخصص معرفي إضافي) إذا هو بلغ غابته من قبلته السابقة. |
| الاستضعاف | نستخدم هذا التعبير ومشتقاته عوضا من تعبير “الاستعمار” ومشتقاته”، لما يشي به ذلك التعبير الدارج من تيه في استخدام المصطلحات، فالاستعمار مصطلح قرآني ذو مدلول إيجابي يعبر عن المهمة التي أنيطت بالإنسان المستخلف في الأرض {هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها}، ولا ينبغي إطلاقه على عمل أوربي منكر، هو في حقيقته استضعاف لشعوب الأرض غير الغربية. ثم إن مصطلح “الاستضعاف” له أصالة في مبناه وفي معناه تؤهله لحمل الدلالة المتوخاة من مصطلح “الاستعمار” السائد. فقد جاء في القرآن الكريم: {إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم}، وهذه عين سياسة الأوربيين في العهد المعروف – خطأ – بعهد الاستعمار، فقد علوا في الأرض، وجعلوا أهلها شيعا بتمزيقها وبتطبيق سياسة “فرق تسد”، واستضعفوا فيها من ليس من بني جلدتهم. ثم إن واقع الأمر ينفي أن تكون الحركة الاستضعافية الأوربية في بلداننا حركة استعمارية بالمدلول الأصيل بما فيه مقصودهم الأصلى من نظيرها في اللغات الغربي colonisation ذلك أن الأوربينن في جل الحالات لم يهتموا بإعمار الأرض التي استوطنوها إلا في حدود حاجاتهم الخاصة، بل نهبوا خيراتها، وجعلوها إلى الخراب أقرب منها إلى العمران. وهذا أمر مؤكد في حالة موريتانيا – مثلا – التي لم يعبد فيها المستعمر إلا طريقا واحدا لا يبلغ طوله الكيلومتر هو طريق يربط بين معبر نهر السنغال ومقر الحاكم الفرنسية في مدينة القوارب التي أسموها “روصو”. |
سادسا: الحاجة للبحث
ليس بالإمكان بناء نظام تربوي أيا كان في فراغ أو من فراغ. بل لا بد من قواعد يقوم عليها البناء. ومن هذه القواعد فيما نحن بصدده تجارب التعليم الأصيل الحية المعيشة أو المحفوظة في ذاكرتنا الثقافية، حيث تشكل هذه التجارب التطبيق العملي لرؤى وتوجهات وخيارات منشؤها نصوص الوحي وتعاليم النبوة وهدي السلف. وعليه، فإنه لا بد من الرجوع إلى تلك التجارب واستنطاقها، كما أوصت بذلك وثيقة الاستكتاب، للظفر منها بقبس يساهم في إضاءة طريق العمل لبناء النظام التربوي المنشود.
ولعل من أكثر تجارب التعليم الأصيل المعيشة أهمية -في هذا السياق – تجربة المحضرة الشنقيطية الموريتانية، تلك المؤسسة العريقة التي نشرت العلم وبثت القيم وصاغت شخصية ذات مناعة، صمدت طويلا في وجه الاستضعاف الأوربي، وهي تواصل إلى اليوم جهادها في بناء إنسان أصيل غير مسخ ولا مستنسخ.
وتتأكد أهمية دراسة ظاهرة المحضرة في ضوء غياب أي دراسات تتناول بشكل مباشر نظائرها من المؤسسات التربوية العتيقة في الفضاء العربي الإسلامي، خاصة إذا نظرنا إلى قائمة الخطط البحثية المقدمة إلى المشروع لحد الآن.
كما أن هناك عوزا، في خريطة الأبحاث الحالية، في الدراسات المهتمة بالمقارنة بين النظم التربوية، إذا استثنينا ما قد يتم من خلال دراسة النموذج الياباني والاستيحاء منه في بناء النموذج المنشود أو ما تشير إليه بعض البحوث الأخرى من توجه إلى دراسة أوجه التدافع بين النظام التربوي الغربي ونظامنا التربوي العربي الإسلامي. ومن ثم فإن الخطة موضع النظر تلبي حاجة إضافية فيما يتصل بالدراسة المقارنة للنظم التربوية، خاصة وهي تنطلق من نظام تربوي عتيق لمقارنته بنظام تربوي محدث دخيل.
سابعا: علاقة البحث بالمشروع
علاوة على ما يستشف مما تقدم، يتناغم المقترح البحثي مع المشروع بما يطمح إليه من المساهمة في بلورة رؤية لنظام تربوي بديل، تشكل دراسة أوجه القصور وعوامل الإفادة في الأنظمة القائمة خطوة أساسية على طريقه. وهو في ذلك يلتزم بالغايات والأهداف الكبرى للمشروع ويتبنى منطلقاته. كما أنه يغطي مجالاته البحثية، مركزا بنحو خاص على المجالين الثاني والثالث، ومحاولا ملامسة جوانب تندرج في المجالات الأخر.
وهكذا فإن البحث سيكشف على الأخص جوانب أساسية من خصائص النظام التربوي الأصيل وممارساته التاريخية (المجال الأول)، وسيتناول المحضرة باعتبارها مؤسسة معاصرة تمثل وعاء حيا لنظام تربوي أصيل (المجال الثاني)، وسيتطرق إلى مظاهر التفاصل وفرص التواصل الواقعة أو المتوقعة بين هذا النظام الأصيل وبين النظام التربوي الدخيل وما تطرحه تلك العلاقة القلقة من تحديات، وما قد تفتحه من آفاق (المجال الثالث). ومن شأن طرح بعض المضامين المنهجية والمفاهيم والأصول والمرتكزات التي قام عليها التعليم المحضري أن يساهم وإن بقدر في إنارة الطريق لبناء نظرية أو رؤية بصيرة لتأصيل التعليم (المجال الخامس). وسيكون من هم البحث أن يقترح مسارا أو مسارات لتأصيل التعليم تعين بشكل مباشر على بلورة النموذج التطبيقي للنظام التربوي الأصيل المنشود (المجال الخامس).
ومن الطبيعي أن يكون البحث أمكن في بعض هذه المجالات منه في غيرها. فهو مكين أصيل في مجال “التجارب المعاصرة للنظم التربوية الأصيلة” وفي مجال “النظم التربوية الأصيلة – آفاق وتحديات”. لكنه بملامسة المجالات الأخرى يستجيب لضرورة التعامل مع مجالات الأبحاث بمقاربة إدماجية تعي كامل الوعي قوة التواشج بين هذه المجالات، فتسعى من خلال أحد هذه المجالات لخدمة المجالات الأخر. وهذه رؤية تعين على تعزيز الوحدة العضوية بين أركان المشروع باعتبارها أعضاء في جسد واحد.
ويأخذ البحث بالحسبان الموجهات المعتمدة في لقاء الآستانة، وهو في هذا الصدد يستحضر الموجهات العامة المشتركة لجميع الباحثين، ويعنى خاصة بموجهات الخطط الداعمة، ويتجه من هذا المنطلق إلى استخلاص ما يتأتى استخلاصه من التجربة المحضرية لرفد التأسيس النظري وإغناء النموذج التطبيقي للمشروع. ويسعى البحث كذلك إلى الرد على التساؤلات والإفادة من التعليقات التي صدرت عن المشاركين في اجتماع الآستانة بما فيها على الخصوص ما أثير خلال النقاش عن العلاقة بين العلم والعمران، ونواقص التعليم المحضري، والسلم التعليمي في المحضرة، وطرق التدريس فيها، والجدل بشأن التكامل أو التفاصل بين ملكة الحفظ وملكة التحليل والاستنباط، ودور المصاعب البيئية في حفز التعلم، والخصائص التربوية الأصيلة المفقودة في النظام التربوي المؤسسي المعاصر، إلخ.
ثامنا – منهجية البحث وأدواته
يقتضي البحث في موضوعنا اتباع منهج وصفي تحليلي مقارن يرصد الظواهر موضع الدراسة ويحللها ويقارن بينها، ويسعى من وراء ذلك إلى استنباط رؤى وأفكار ذات جدة وطرافة، سبيلا للمساهمة في بلورة رؤية جادة لتأصيل النظام التربوي في سياق عصر سريع التغير، دائب التحول.
وطبقا لما ورد في الموجهات العامة الصادرة بعيد اجتماع الآستانة، سيساهم البحث في استنطاق الأصول المؤسسة في حدود ما يتصل بالتجربة المحضرية فكرا وتطبيقا، كما سيهتم باستحضار الاحتياجات وتحديات الواقع وباستشراف المستقبل،
وسنستعين بجملة من أدوات البحث منها:
- النظر في المصادر والمراجع ذات العلاقة بالموضوع.
- المقابلات الشخصية مع بعض أهل الخبرة في ميادين البحث.
- إثارة حوار في الأوساط الأكاديمية والثقافية حول إشكالية تأصيل التعليم، وذلك بشكل محايد، وبدون إشارة إلى الدوافع المباشرة لإثارة الحوار.
- فرز المعلومات وتحليلها
- إعمال الفكر سعيا للمساهمة في بلورة نظام بديل.
ونحن في مسعانا ذلك كله لا ننحو منحى القطائع الفكرية، خصوصا فيما يتصل ببنى ومناهج ونظم التعليم الأصيل. بل نسعى للتأسيس على ما هو قائم وتجاوزه نحو الأفضل، غير أننا في التعامل مع النظام التربوي القائم، نميل أكثر إلى شيء من الجرأة في التحرر من المألوف المعهود المعيق للحركة والتجديد والابتكار، ونزعم أن في النظام الأصيل ما يعين على ذلك.
تاسعا – الدراسات البحثية السابقة
يمكن أن نصنف الدراسات ذات العلاقة بموضوعنا في أربع فئات:
- دراسات عامة حول التربية العربية الإسلامية
- دراسات تتناول بوجه خاص النظام التعليمي المحضري في موريتانيا
- دراسات تتناول المقارنة بين نظام التعليم الأصيل وأنظمة التعليم المستحدثة وتعالج إشكاليات التأصيل والتحديث التربويين.
- دراسات عامة حول التربية العربية الإسلامية
من الصعب بطبيعة الحال حصر هذا النمط من الدراسات لكثرته، لكننا سنقف بوجه خاص عند فئتين منه: فئة الدراسات الكبرى الصادرة عن مؤسسات العمل المشترك، العربية والإسلامية وما شاكلها، وفئة الدراسات التي تتناول قضايا التربية العربية الإسلامية وإشكالياتها في موريتانيا على الخصوص.
- ففي القسم الأول، كانت التربية مدار اهتمام هيئات عربية وإسلامية كبرى، مثل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب التربية العربي لدول الخليج ومؤسسة آل البيت في الأردن, وقد أنتجت هذه المؤسسات مجموعة من الدراسات والأعمال المرجعية حول التربية الإسلامية، لعل من أبرزها:
- الاستراتيجيات والخطط الشاملة للتربية والثقافة والعلوم والمعلومات والبحث العلمي
- كتاب الفكر التربوي العربي الإسلامي
- موسوعة التربية الإسلامية: المؤسسات والممارسات
- موسوعة التربية الإسلامية: الأعلام.
- وفي القسم الثاني، نلاحظ اهتمام عدد من الباحثين الموريتانيين بمعالجة إشكاليات التربية في الإسلام، انطلاقا ـ في الغالب ـ من واقع التجربة الموريتانية ـ الشنقيطية. ومن هذه الدراسات:
- الإسلام في البرامج التعليمية الموريتانية / بوننه بن محمد سالم / المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ـ نواكشوط: 1987 – 1988
- المدرسة الموريتانية في ضوء الشريعة الإسلامية/ محمد مفتاح بن محمد جد/ معهد ابن عباس ـ نواكشوط: 1993
- التربية الإسلامية في التعليم العام في موريتانيا / مريم بنت حمود / المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ـ نواكشوط: 1996 – 1997
- رسالة الإسلام التعليمية / عيشة بنت محمد محمود / المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ـ نواكشوط: 1999 – 2000
- الخصائص والوسائط في التربية الإسلامية وآراء الشناقطة في هذا المجال / دح بن هويدي/ المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ـ نواكشوط: 1999 – 2000
- التربية الشنقيطية للنشء / خديجة بنت عبد الرحمن / المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ـ نواكشوط: 1989 – 1990
- الشناقطة وتأديب الأطفال قراءة في تأديب الناشئة وتهذيب الأجيال / مريم بنت أحمدو/ المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ـ نواكشوط: 2000 – 2003
- اللغة العربية في التعليم النظامي الموريتاني من 1960 إلى 1988 / مريم بنت عبد الله سالم / المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ـ نواكشوط: 1988 – 1989
- دراسات عن النظام التعليمي المحضري في موريتانيا
هناك في هذا الباب كم لا باس به من الدراسات التي تعالج التعليم المحضري من زوايا مختلفة، متوسعة في المعالجة أحيانا، ومتجهة أحيانا أخرى إلى دراسة بعض الجوانب دون بعض، مثل التعريف بالمحاضر وبشيوخها، والمناهج المحضرية، والآثار التربوية والثقافية والسياسية والاقتصادية للمحضرة.
- ففي سياق عام، ألقى محمد بن ابراهيم الخليل “نظرة تاريخية على المحاضر الموريتانية في فترة ازدهارها” في رسالة تخرج من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بنواكشوط عام 1984. كما تناولنا في كتابنا “بلاد شنقيط المنارة والرباط” التعليم المحضري، مناهجه، وروافده ونظمه وأدواره المتشعبة في الحياة.
وتندرج في السياق ذاته مجموعة من المحاضرات، منها:
- محاضرة الشيخ مجمد سالم بن عدود (عبد الودود) عن التعليم المحضري في ملتقى عبد الله بن ياسين للفقه الاسلامي – نواكشوط، فبراير 1982؛
- محاضر الأستاذ المختار الشاعر عن المحاضر المعاصرة في موريتانيا
- مذكرة للأستاذ المختار محمد موسى عن المحاضر في موريتانيا.
- مقالات للأساتذة أحمد سالم بن مولاي علي وبوميه بن بياه ومحمد المصطفى بن الندي حول المحاضر وأعلامها، نشرت في الأعداد الثلاثة الأولى من مجلة الشعاع الصادرة عن المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بنواكشوط.
- محاضرتنا عن التعليم العربي الإسلامي في موريتانيا، ألقيت في قطر في ربيع الثاني 1406 هجرية/ 1986غ، ونشر ملخص عنها في مجلة الأمة القطرية.
- وقد انصب اهتمام بعض الباحثين على محاضر معينة فعرفوا بها في أعمال جلها رسائل جامعية. وكان من هؤلاء:
- محمد بن محمد يحي بن الدوه في رسالته عن “محضرة يحظيه بن عبد الودود” (المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية – نواكشوط 1985)؛
- عبد الله بن محمد الولي في رسالته عن “محضرة تنجغماجك تاريخها ومناهجها” (المعهد العالي د ب إ ـ نواكشوط: 1988 – 1989)
- محمد بن محمد عبد السلام في رسالته عن “محضرة الفريوه: رباط بعد رباط”/ المعهد العالي د ب إ ـ نواكشوط: 1998 – 1999).
- محظرة التيسير بن الماضى والحاضر / الولي بن محمد المصطفى بن طه / 2000 – 2001
- محنض بابا بن المختار بن محمدا في رسالته عن “دور محظرة محنض بابا بن اعبيد في الحياة الثقافية لمنطقة اترارزة خلال القرن 13 هـ / المعهد العالي د ب إ ـ نواكشوط:2003 – 2004).
- محمد علي بن محمد فال في رسالته عن “العطاء العلمي لمحضرة أهل الطالب بن اعلي خلال القرن 13 – 14 هجري / المعهد العالي د ب إ
- محضرة أهل السعيدي المجلسية وإشعاعها العلمي والأدبي/ محمد سالم بن محمد/ المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ـ نواكشوط: 2007
- وقد اهتم بعض الباحثين بدراسة شخصيات معينة كان لها حضور محضري مميز. ورغم أن أغلب الدراسات الخاصة بالترجمة لأعلام الشناقطة يمكن أن تندرج في هذا الباب، فإننا سنكتفي بالإشارة إلى نموذجين حملت عناوينهما إحالة مباشرة على المحضرة، وهما:
- رسالة عن “أعلام المحظرة في آفلة” (منطقة من مناطق موريتانيا[1] ) للباحث محمد المنير بن أحمد / المعهد العالي د ب إ ـ نواكشوط: 1996 – 1997.
- رسالة بعنوان “دراسة لمحضرة يحظيه بن عبد الودود من خلال خريجها سيدي المختار بن والد نموذجا” للباحثة أم المؤمنين بنت أحمد سالم / المعهد العالي د ب إ ـ نواكشوط: 1424 – 1425 / 2003- 2004.
- وقد حظيت مناهج الدرس المحضري بقسط محدود من عناية الباحثين، فكان مما دون في ذلك:
- مناهج تدريس رسم القرآن عند الموريتانيين/ الشيخ سيداتي بن عبد الودود / المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ـ نواكشوط
- فن التجويد في بلاد شنقيط/ أحمدنا بن محمد فاضل/ المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ـ نواكشوط: 2007
- الدرس العقدي في المحضرة الشنقيطية/ لاله بنت اليدالي/ المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ـ نواكشوط: 2008
- وقد انصرف اهتمام بعض الباحثين إلى دراسة الأدوار التاريخية والآثار الثقافية والتربوية والسياسية بل والاقتصادية للتعليم المحضري، فكان من هؤلاء:
- محمد المصطفى الندى في رسالته عن دور المحاضر في موريتانيا (المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بنواكشوط ـ 1986)؛
- محمد الصوفي بن محمد الأمين ، في رسالته عن المحاضر الموريتانية وآثارها التربوية (الرياض 1406)
- إبراهيم بن علي بن يركيث، في رسالته “إسهامات المحضرة الشنقطية في المجال التربوي والاقتصادي” (المعهد العالي د ب إ ـ نواكشوط 2002 – 2003)
ومما هو لصيق بهذا المحور، ما كُتب عن المقاومة والإشعاع الثقافيين وعن حركات الإصلاح في موريتانيا، ومنه:
- المقاومة ضد الاستعمار / د. المحجوب بن بيه، باريس 1975
- المحاولات الإصلاحية في موريتانيا / محمد بن بدو / المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ـ نواكشوط: 1990 – 1991
- علماء الأمة طليعة التغيير قراءة في القديم والحديث في بلاد شنقيط / عبد المالك الملقب ان بن عبد الله / المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ـ نواكشوط: 1997
- المقاومة الثقافية في موريتانيا / البار بن أحمد الحبيب / المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ـ نواكشوط: 1997
- المقاومة الثقافية الموريتانية للمدارس الفرنسية/ سيد أحمد بن عبد القادر/ المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ـ نواكشوط: 2007
- الدور الثقافي للعلماء الشناقطة خارج بلاد شنقيط/ الطالب مصطف بن ميلود/ معهد ابن عباس 2008
- دراستنا عن المحضرة رباطا للجهاد، في المجلد الرابع من موسوعة التربية الإسلامية: المؤسسات والممارسات الصادرة عن مؤسسة آل البيت بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية العربي لدول الخليج.
- دراسات حول تحديث التربية وتأصيلها والربط بين النظامين التربويين:
قليل من الدارسين من اهتم بإشكاليات التأصيل والتحديث والمقارنة بين مؤسسات التعليم الأصيل وضرائرها من مؤسسات التعليم المحدث الوافد.
ومع ذلك فنحن واجدون أعمالا تعالج هذه القضايا وتهتم خاصة بتحديث التعليم الأصيل وفحص العلاقة بين المحضرة والمدرسة النظامية والدعوة إلى مد جسور من التواصل بينهما. ومن هذه الأعمال:
- دراسة موسعة أنجزها الخبير السويدي لكرتوا بتكليف من اليونسكو عن المحاضر في موريتانيا وسبل الوصل بينها وبين المدارس النظامية. (André le Courtois : – Etudes Expérimentale sur l’Enseignement Islamique traditionnel, septembre 1978 SEMA)
- دراسة أنجزتها وزارة التوجيه الإسلامي والتعليم الأصلى في موريتانيا عام 2006 حول سبل مد جسور بين المحضرة والمدرسة النظامية.
- رسالة محمد محفوظ بن السعيد عن “الطالب الموريتاني بين المناهج المحضرية والمدرسية/ معهد ابن عباس ـ نواكشوط : 1994
- رسالة محمد بن سيد أحمد عن “التعليم بين المحضرة والمدرسة/ معهد ابن عباس ـ نواكشوط: 1995
- رسالة فاطمة بنت الب عن “التجديد التربوي في النظام المحظري من خلال جمع بعض مفاهيم التربيه السكانية (مكافحة السيدا)” / 2004 – 2005
هذا وسنعود إلى جرد جل هذه المراجع، مضافا إليها غيرها، في نقطة المصادر والمراجع.
عاشرا – الإضافة النوعية للبحث:
ربما يكون بمستطاعنا الآن أن نتوقع إضافة نوعية باعتبار ما يرمي إليه المقترح البحثي من المقارنة بين ثلاثة أنظمة تربوية (الأصيل، المعاصر، التوليفي)، فذلك عمل لم يحظ بكبير عناية من الباحثين لحد الآن. وسيستفيد البحث من قراءة الأبحاث الشتات التي سبقته ونقدها والتأليف بينها ومحاولة تجاوزها للمساهمة في بلورة رؤية لنظام تربوي أصيل قابل للتطبيق في ظروفنا الخاصة. وعلاوة على ذلك، يتوقع أن تفضي الدراسة إلى التقاط أفكار ورؤى جديدة تتخلق تدريجيا في سياق البحث والمقارنة والتحليل. ومن البدهي أن الوصول إلى النتائج رهين باستيفاء المقدمات.
صلب البحث
مدخل عام النظامان التربويان وسماتهما
المبحث الأول: عن النظام التربوي الأصيل
أولا – في النشأة والتاريخ
غار حراء، لا غيره.. كان أول مدرسة في الإسلام.. مدرسة منهجها التأمل والتفكر ثم التلقي، ولكن في سياق تفاعلي: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}(العلق : 1)..
كانت لهذا الأمر السماوي المزلزل أولية تاريخية لا نزاع فيها. وخلف تلك الأولية، كانت هناك أولوية منهجية، أحلّت القراءة والعلم محل الأساس في كل بناء. فقد قيل للنبي ص: {اقْرَأْ}، قبل أن يقال له: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} (المزمل : 2)، {قُمْ فَأَنذِرْ } (المدثر : 2)، {كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب} (العلق : 19)، {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (الكوثر : 2)، بل وقبل أن يقال له : {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (الإخلاص : 1). ولم يكن خلوا من الدلالة أن يؤمر النبي المعلم ص بالقراءة، وقد أريد له أن يختم سلك النبوة، ويدفع بالإنسانية إلى طور من الرشد يكون منهج غار حراء (القراءة والتأمل) منبع هديه المتجدد، في العصور الآتية.
كل الأنبياء، والرسل منهم خاصة، كانوا متعلمين ومعلمين بمقدار، لكن وحده النبي الخاتم ص كانت رسالة التعلم والتعليم طغراء الخطاب الرباني النازل إليه.
- الأنبياء متعلمين:
لقد اشترك نبينا عليه الصلاة والسلام مع رسل آخرين في التعلم، بوسائط شتى، بالتأمل أولا، وبالوحي النازل إليه مبادأة، وبالسؤال عند الحاجة، والمدارسة.
أما التعلم بالتأمل فقد كان من شأنه ص عندما كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، كما كان شأن إبراهيم عليه السلام وهو يتأمل حركة النجوم والكواكب، ليصل في خاتمة تأمله إلى الحقيقة المطلقة: {إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ(الأنعام : 79).
وأما التعلم بالوحي النازل مبادأة من الحق سبحانه، فذلك شأنه عليه الصلاة والسلام، وشأن سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ففي بدء الخليقة كان التعليم لأبي البشر: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ}(البقرة : 31)،
ومن بعده تعلم نوح {فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۙ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ} (المومنون : 27)،
ويعقوب: {وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ۚ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}( يوسف : 68) ،
و يوسف: {وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} ( يوسف : 6)، {قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ}(يوسف : 37)،
وتعلم داود: {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ} ( الأنبياء : 80)، {وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء} (البقرة : 251)،
وتعلم سليمان: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ} (النمل : 16)،
وكان تعلم عيسى (عليه وعليهم السلام جميعا) إيذانا برسالته: {وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ (48) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (49)} (آل عمران : 48-49)، {إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۖ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (110)} (المائدة : 110).
وكذلك وفوق ذلك تعلم النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (113)} (النساء : 113)، {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ (5)} (النجم : 4-5)، { الرَّحْمَٰنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4)} (الرحمن : 1-2).
وأما التعلم بالسؤال والمدارسة (والسؤال نصف العلم، كما يقال)، فقد كان أيضا من شأن الأنبياء عليهم السلام، فقد طلب إبراهيم عليه السلام أن يعرف بالمعاينة كيفية إحياء الموتى، وكان موسى عليه السلام رائدا في الرحلة لطلب العلم، حين سافر لحدّ النصَب من أجل تلقي العلم عن عبد من عباد الله لم ينعقد الإجماع أصلا على نبوته، فوقف بين يديه موقف التلميذ من أستاذه، وهو يقول: {قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (66)} (الكهف : 66)، ثم كان بينه وبينه من المناقشة ما هو من صميم المدارسة. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد كان يُسأل عن المسألة فيتوقف عن الإجابة ويقول: حتى أسأل جبريل! وكانت العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل علاقة مدارسة أسست من وراء القرون لما أصبح اليوم يعرف بالتفاعل الصفي في المدرسة، وبالتعليم المستمر، فكان النبي ص يتدارس القرآن مع جبريل في شهر رمضان، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما:
“كان رسول الله ص أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن”[2] ، فهي مدارسة لا تدريس.
وتأمل ما حاجة نبي يوحى إليه، ضمن له ربه أنه {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (4)} (النجم : 3-4)، وأنه لن ينسى {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ} (الأعلى : 6)، وتكفل له بحفظ الكتاب وبيانه { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}(الحجر : 9) ، { إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19)} (القيامة : 17-18-19)..
ما حاجة مثل هذا النبي لمدارسة القرآن، لو لم يكن مربيا عظيما يؤسس بإذن ربه لمبدأ خالد تالد، هو حاجة أي كان للتعلم والمدارسة أبدا.
ولم يكن ذلك شأن النبي ص مع جبريل عليه السلام فحسب، بل كان من شأنه مع أصحابه، فقد طلب من عبد الله بن مسعود – كما في صحيح مسلم- أن يقرأ عليه القرآن، قائلا: “إني أحب أن أسمعه من غيري”. وكان ص يستعين بأصحابه البررة في اكتساب معارف إنسانية، كما حدث حين أشار عليه الحباب بن المنذر بعناصر من استراتيجية الحرب في بدر، وسلمان الفارسي بحفر الخندق يوم الأحزاب. بل إنه استمع من تميم الداري إلى قصته ودعا الناس ليستمعوا إليها ويتعلموا منها.
وعلى ما كان من تعليم الله لنبيه {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} (النساء : 113)، ومن حسن تأديبه إياه “أدبني ربي فأحسن تأديبي”، جاء النبي الخاتم ص بنظرية التعلم والتعليم المستمر، فريضة وممارسة ، ولم يكن له أن يقنع بما أوتي من العلم وقد أوتي منه ما أوتي. لقد قيل لموسى عليه السلام: {قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ}(الأعراف : 144)، وقيل للنبي الخاتم ص: {فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا}(طه : 114). وكان كليم الله قد أوتي الألواح: {وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ}(الأعراف : 145).
وكما أخذها جملة، ألقاها جملة في لحظة غضب لربه :
{وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (الأعراف : 150)
ثم أخذها جملة: {وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ} (الأعراف : 154).
أما النبي الخاتم ص فقد نزل الكتاب على قلبه {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (194)} (الشعراء : 193-194)،
{وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ} (البقرة : 96).
ولئن كان هذا الكتاب الكريم قد نزل جملة باعتبارات يتحدث عنها المفسرون
{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (البقرة : 185)،
{إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ } (الدخان : 3)،
{إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} (القدر : 1)، فإنه نُزِّل منجما في تفاعل حي مع الأحداث التي عاشها معاصرو النبي ص، وفي تجاوز أبدي لها إلى عوالم رحبة من {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} (يونس : 38)،
فكان له إنزال يشترك فيه مع سائر الكتب السماوية {أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (البقرة : 4)، وكان له تنزيل يكاد يتمحض له:
{نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ (3) مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (4)} (آل عمران : 3-4)؛
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا } (النساء : 136)
وعلى ما هو مشترك في المعنى بين التنزيل والإنزال، فلعل الزيادة في مبنى التنزيل (نزّل بالتضعيف) تشير إلى زيادة في المعنى، ولعل من مدلولات هذه الزيادة نزول القرآن إلى الأمة نزولا بعد نزول على مدى 23 عاما: {وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً} (الإسراء : 106).
ولعل في استعمال التضعيف في آيات كثر بشأن القرآن خاصة إشارة أيضا إلى ما تقتضيه عملية التعلم من كبد، فهناك جهد لا بد من بذله حتى ولو كان العلم وحيا ينزل من عند الله على قلب عبده، فإنما العلم بالتعلم[3]. وقد تجسد هذا الجهد فيما كان يقع له صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، حيث كان ينزل عليه في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، وذلك وجه من الوجوه التي يفسر بها قوله تعالى: {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا} (المزمل : 5). بل إن النبي ص كان يبذل مجهودا إراديا هو مجهود المتعلم الحريص على أن يضبط ما يتلقى من معلمه، حتى جاءته رسالة ربانية تطمئنه: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17)} (القيامة : 16-17)
وتعده بأنه لن ينسى ما كلف بتبليغه : {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ (6) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ(7)}(الأعلى : 6-7)؛
{مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (البقرة : 106)؛
{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (الحجر : 9).
- الأنبياء معلمين
وبينما كان الكتاب ينزّل على قلب الحبيب المصطفى ص، ليقرأه على الناس على مكث، كان النبي ص يؤدي وظيفته الكبرى معلما. وهي وظيفة شاركه فيها أنبياء من قبله، بدءا بأبي البشر آدم عليه السلام، فقد كان معلما تلامذته ملائكة، حين جاءه الأمر من ربه: {قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ} (البقرة : 33). وقد أدرك موسى عليه السلام خطر هذه الوظيفة المقترنة بالتبليغ، فسأل ربه أن يؤهله لها نفسيا وحسيا، فقال: {قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28)} (طه : 25-26-27-28)؛ غير أن مهنة التعليم انتقلت إلى أسمى أطوارها مع النبي الخاتم، فجاءت مرتبطة بالتزكية:
{لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ} (آل عمران : 164)
{هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ} (الجمعة : 2).
وهكذا بعث النبي الأمي ص معلما، وأعلن هو أيضا عن وظيفته هذه تأكيدا لما ورد في القرآن، فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فرأى مجلسين أحدهما يدعون الله ويرغبون إليه والثاني يعلمون الناس، فقال: “أما هؤلاء فيسألون الله تعالى فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. وأما هؤلاء فيعلمون الناس وإنما بعثت معلما وجلس معهم”[4]. وعن جابر أيضا أنه ص قال: إِنَّ اللَّهَ لم يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا ولا مُتَعَنِّتًا وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا»[5]
وفيما كانت مهمة الأنبياء من قبل مهمة إنذار وتبشير في المقام الأول، كانت مهمة النبي الخاتم مهمة تعليم بذلك المفهوم الواسع المقتضي للتزكية والشامل للشهادة والبشارة والنذارة والدعوة والإنارة: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45)وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا (46)} (الأحزاب : 45-46).
وبينما كان على الأمم السابقة أن تتلقى ما أوتيت: {وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (الأعراف : 171)، كان على الأمة المحمدية أن لا تقتصر على التلقي والأخذ بقوة، بل كان عليها أن تنظر وتفكر وتتدبر وتحرث وتثور الكتاب الذي نزل إليها، أي أن تمارس من خلاله عملية تعلم مستمر واستكشاف دائب:
{أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} (محمد : 24)
{كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} (ص: 29)
وفي ذلك يقول النبي ص: “ من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين”[6]. وقد ورد أيضا: “احرثوا هذا القرآن”.
ولنا أن نقف مليا عند هذين المصطلحين (الحرث والتثوير)، ففيهما من الدلالة على الجهد العقلي المطلوب ما لا توفره مصطلحات العصر المتداولة مثل “الدراسة والتحليل”.
- معلمون رواد
كانت الرسالة المحمدية إذا رسالة تعلم وتعليم، وراثة لسائر الرسالات السماوية السابقة وتجاوزا لها. ولم تكن تنظيرا فحسب، ولا عملا مقصورا على النبي الكريم ص، بل كانت ممارسة حية منه وممن حوله من صحابته الأبرار، فقد كانت القراءة والإقراء والتعليم والتزكية وسيلة الدعوة الأولى وإحدى غاياتها الكبرى. وارتبط التعليم بالدبلوماسية برباط ما كان له أن ينحل، فقد كان السفير الأول مصعب بن عمير معلما عندما نزل المدينة، وكذلك كان رافع بن مالك الأنصاري الذي تلقى عن النبي ص في بيعة العقبة ما نزل عليه من الوحي في عشر سنين، وذهب يعلم قومه إياه، وعجب النبي ص من “اعتدال قلبه”. ولم يلبث التعليم أن ارتبط بالحرية برباط مقدس، حين جعل النبي ص تعليم الكتابة للمسلمين فدية لأسرى المشركين: عتق بعتق، حرية من الأسر تقابلها حرية من الجهل: عقد خالد لعل الكثيرين لم يسبروا بعد غوره.
وفي دولة المدينة الناشئة لم يكن الجهاد الدفاعي ليشغل الجيل الأول عن التعلم والتعليم، فكان للوحي كتبة وللكتاب حفظة قراء، وكان منهم من أمر بتعلم لغات أخر (مثلا، زيد بن ثابت الذي تعلم العبرانية في سبعة عشر يوما). وتأسست في حضن المسجد النبوي مدرسة للفقراء (أهل الصفة)، بينما كان المسجد وبيوتات النبي مراكز للتعليم. وكان بالمدينة مدرسة أخرى عرفت بدار القراء. وظهر فيها على عهد النبي ص جيل من المعلمين منهم الشفاء أم سليمان بن أبي حتمة التي علمت أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهم الكتابة. ومنهم زيد بن ثابت وعبد الله بن سعيد بن العاص. ونفر أعيان من الصحابة لحمل الدعوة والعلم توأما إلى البلاد الأخرى. وحين فتحت الشام كتب يزيد بن أبي سفيان والي جند دمشق للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب معلمين يلقنون أهل الشام القرآن ويفقهونهم في شؤون الدين فأرسل إليه معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبا الدرداء، رضوان الله عليهم[7]. وكان معاذ بن جبل معلما أيضا، في العهد النبوي، إبان بعثته إلى اليمن وخلال إقامته وعتاب بن أسيد في مكة المكرمة، بعد فتحها، مكلفين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقراء الناس.
وابتعث الخليفة الفاروق إلى العراق عبد الله بن مسعود، فكان أول مدرس بمدينة الكوفة. وقد حل بمصر أكثر من مائة وأربعين صحابيا بينهم الزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وأبو ذر، فكانوا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سليم بن عتر التجيبي من التابعين، أول من قص بمصر سنة 39 هـ. وقد أرسل عمر بن عبد العزيز نافعا مولى ابن عمر وشيخ مالك بن أنس، إلى مصر فكان يعلم الناس السنن[8]، كما أرسل عشرة فقهاء إلى إفريقية وبلاد المغرب[9].
- الكتاتيب والمجالس والحلقات.. وسائط تأسيسية
كان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (ر) أول من نظم الكُُتّاب، وضبط مواقيته وسن العطلة الأسبوعية. وقد فرض للمقرئ عامر بن عبد الله الخزاعي رزقا من بيت المال.[10] وقد انتشرت الكتاتيب ومجالس العلم منذ الصدر الأول، وكان التدريس في الغالب عملا طوعيا، يجري في فضاء مفتوح لا يحلّّأ عنه أحد. وقد تعددت مجالس العلم وحلقه في حواضر الإسلام. وكان من رواد هذا التعليم أبو موسى الأشعري (توفي عام 44هـ)، والي عمر على البصرة الذي عقد حلفا مجيدا بين الإدارة والتربية، فكان يجلس إلى رعاياه فيعلمهم. وكانت في البصرة من بعد حلقات ومجالس علم كثيرة منها مجلس الحسن البصري (100هـ/718م) لسماع القرآن الكريم وتفسير آياته ومجلس حماد بن سلمة (165هـ/781م) لرواية الحديث، وحلقات للقراءة واللغة والنحو كحلقة أبي عمرو بن العلاء (154هـ/770م) أحد القراء السبعة ومجلس الخليل بن أحمد الفراهيدي (175هـ/791م) وحلقته[11]. وفي دمشق، سن أبو الدرداء نظام الحلق، فكان له في جامعها حلق عظيمة يفيء إليها أكثر من 1000 متعلم. وقد وضع لهذه الحلق نظاما محكما، فكان لكل عشرة عريف. وكان العرفاء يعودون إليه إذا أشكل عليهم أمر من أمور التدريس[12].
وكان في مسجد الكوفة، من بعد عبد الله بن مسعود، مجالس علم وحلقات كثر منها حلقات للإقراء وعلوم القرآن التأمت حول عاصم بن أبي النجود (128هـ/745م) وحمزة بن حبيب الزيات (156هـ/772م) وعلي بن حمزة الكسائي (183هـ/799م) وهم من القراء السبعة، وحلقات فقه أبي حنيفة النعمان (150هـ/768م).
وفي مصر، كان لليث بن سعد (توفي 175هـ) مجلس لأصحاب الحديث ومجلس لأصحاب المسائل (الفتوى في الحلال والحرام).
وفي الأندلس، كان لشيخ المؤدبين بقرطبة أبي محمد الغازي بن قيس الأندلسي (توفي 199هـ) مجلس يعلم فيه الناس قراءة نافع وموطأ الإمام مالك[13]. وكان بقرطبة في أواسط القرن الرابع 27 مكتبا لتعليم القرآن[14]. وقد عرف عن الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر (توفي 366هـ) أنه حبس حوانيت بقرطبة على معلمي أولاد الضعفاء[15]، فكان تبعا للخليفة عمر رضي الله عنه في التأسيس لالتزام الدولة بتعليم الناس.
- المدارس.. طور التنظيم
كان ظهور المدارس عنوانا لمرحلة جديدة من ضبط وتنظيم العملية التربوية. وقد أنشأ الوزير السلجوقي نظام الملك المدرسة النظامية في بغداد عام 447 للتدريس على المذاهب الأربعة، ودعمها بمرتبات للمدرسين وسكن وغذاء للدارسين. وبعدها، نشأت المدرسة المستنصرية عام 631هـ وكان فيها عالم لكل مذهب من المذاهب الأربعة، ولكل عالم 75 طالبا. وللعلماء مرتبات وللطلبة منح. وألحق بالمدرسة مستشفى وحمام، وطعم منهاجها بمواد علمية مثل الرياضيات والطب والصيدلة وعلم الحيوان[16].
وفي مصر، نشرت الدولة الأيوبية المدارس، وأسس صلاح الدين الأيوبي عام 566 هـ بجوار جامع عمرو بن العاص المدرسة الناصرية وخصصها للفقه الشافعي، والمدرسة القمحية وخصصها للفقه المالكي[17]. وبلغ عدد مدارس القاهرة 63 وكانت المدرسة الناصرية أشهرها[18].
وذكر ابن جبير في رحلته أنه شاهد 20 مدرسة في دمشق و30 في بغداد. وقد بلغ عدد المدارس في غرناطة 97 مدرسة كبرى و120 مدرسة صغرى[19].
ولسنا بحاجة إلى الإفاضة في الحديث عن الدور الذي كان لجامعات عتيقة احتضنتها جوامع كبيرة، مثل جامع الزيتونة بتونس (114هـ 732م) وجامع القرويين بفاس (245هـ/868م) والجامع الأزهر بالقاهرة (358هـ/967م).
وسوف نلقي من بعد نظرة على المكانة الخاصة التي كانت للعلم في بلاد الملثمين.
ثانيا – في الخصائص والسمات:
ما من شك في أن السمة الكبرى للتعليم الأصيل تكمن في ربانية منبعه، وما تنجاب عنه من حوافز إيمانية ودوافع وجدانية تجعل هذا التعليم أعلق بقلوب الناس وأمكن في ضمائرهم، وأوفى باحتياجاتهم الروحية والنفسية. ومع ذلك، فقد كان لهذا التعليم مردوده الكبير في إشباع الحاجات المادية للمسلم ولغير المسلم، فقد تجهزت أجيال من صناع الحضارة من العرب والمسلمين بعدة فكرية قرآنية حافزة على النظر والبحث والتجريب والتعلم من الآخرين، ونشدان الحكمة أينما وجدت، وتواشجت الحضارة العربية الإسلامية بحميمية مع الحضارات السابقة فاستخلصت من رحيقها ما يتناغم مع كل معطى علمي أو فكري بشري لا يتعارض فيه النقل والعقل. وأبدع المسلمون في شتى صنوف المعرفة، بما فيها العلوم التجريبية، وأعطوا من ذلك للغرب وللبشرية ما كان عاملا أساسيا في نهضة الإنسانية وفي حراكها العلمي والتقني.
لقد تنوعت وسائط التعليم الأصيل ما بين الحلقة والمجلس (في المسجد أو البيت أو غيرهما) والكتاب والمدرسة، واختلفت أنماطه، ما بين تعليم فردي وزمري وجماعي، وتعددت روافده ما بين وحي منقول، وعلم معقول، وفهم أوتيه رجل مسلم، وحكمة مستوردة مستنبتة. لكن سمات “جينية” قارة ظلت تتحرك في شرايينه، معربة عن أصالته وفرادته.
وباستطاعتنا أن نذكر من هذه السمات:
- الديمقراطية، بالاصطلاح المعاصر، أي اعتبار العلم حقا مشاعا للجميع (كالماء والهواء والكلأ والنار)، وتحريم احتكاره،
- المجتمعية، ويقصد بها أن الرسالة التربوية كانت حِملا اجتماعيا عاما، ينهض به المجتمع ويقيم له المؤسسات ويكفله. ولم تكن مهمة حصرية للدولة، وإن كانت قد تدخلت فيها، في بعض الفترات، تدخل المشارك المنافس المعين، وليس تدخل المحتكر المهيمن المسيطر.
- الطوعية، وبمقتضاها يبذل العالم علمه بدون مقابل مادي، بل إن هذه الطوعية كانت فريضة أكدتها آيات بينات وأحاديث شريفة. وقد جاء التحذير من ابتغاء الثمن القليل بالعلم المغشوش: {فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ } (البقرة : 79). ولا تعارض بين طوعية التعليم ومبدأ المكارمة الذي ندب إليه الإسلام، وبمقتضاه يقدم الدارس للمدرس هدايا ذات طابع تطوعي أيضا.
- المجانية والإلزامية. أما المجانية فقرين الطوعية في حق المدرس، إذ ليست هناك رسوم مفروضة للقبول والتسجيل. وأما الإلزامية فهي خطاب للمدرس والدارس معا. فقد ألزم الإسلام جميع الناس بالتعلم: “طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة”، وألزم من يعلم بتعليم من لا يعلم، تحت طائلة وعيد شديد: ففي القرآن: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} (البقرة : 159)، وفي الحديث: “من كتم علما علمه الله إياه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة”.
- الحرية، فعلى ما كان من إلزامية التعليم، كانت العملية التربوية تدور في فضاء واسع من الحرية، حيث يتمتع الدارس بسلطة واسعة في اختيار الدرس، مضمونا ومقدارا بل وتوقيتا، وفي تقرير فترة دراسة، وفي اختيار المدرس. وكانت هذه الحرية مكفولة بشكل خاص للراشدين، باعتبارهم مسئولين عن أعمالهم[20]، بينما ظلت مسئولية أولياء الأمور قائمة في حمل أطفالهم غير الراشدين على التمتع بحقهم في التعلم. وليس بخاف على أحد تقلص هوامش الحرية تلك في ظل النظام التعليمي الدخيل.
- الفاعلية، ولها مظهران:
- نجاعة النظام التربوي الأصيل في بناء القيم، حيث كان العمل بالعلم غاية أساسية في المنهاج الرباني، وكان هذا المنهاج مصمما لبناء السجايا، وتحويل المعارف والمعتقدات إلى قيم ثابتة في السلوك البشري العادي.
- إعداده الإنسان للحياة، بمواءمته بين العرض والطلب الاجتماعي، وذلك بما يزود المتعلم به من معارف ومهارات وقيم تعلي مكانته الاجتماعية وتنشط دوره في صناعة الحياة في وسطه وبيئته الخاصة.
المبحث الثاني : عن النظام التربوي الدخيل
أولا – في النشأة والتاريخ
كانت المدرسة في طبعتها الغربية ربيئة للقوى الغربية ورفيقة لها وربيبة في غزوها لموريتانيا، كما كانت في سائر البلاد العربية الإسلامية، وقد نشطت الكنيسة بوجه خاص في العمل التربوي متخذة من المدرسة قنطرة إلى قلوب الناس وخصوصا الناشئة منهم. وقد مهدت الكنيسة بعملها التربوي للاستعمار وساهمت في التمكين له بالقوة المرنة التي تمثلها الكلمة التربوية وما أحيطت به من مغريات، فبدأت أول إرسالية مسيحية تعليمية عملها في السنغال سنة 1256 هـ/1814غ. ورغم أن الوثائق تشير إلى أن هذه الإرسالية افتتحت مدرسة عام 1817غ فإن هناك إشارات إلى أن بداية التعليم الفرنسي في هذا البلد قد سبقت ذلك التاريخ، فقد شهدت دكار في8 إبريل عام 2009 احتفالا بالذكرى المئوية الثانية للمدرسة الفرنسية. وعرضت بهذه المناسبة لوحة عن المدرسة التي أسسها جان دارد Jean Dard وحملت اسمه وطبق فيها منهج التعليم التعاوني الذي كان يعتبر أحدث نموذج فعال لتعميم التعليم، وكان قد استوحي من تجربة التعليم الإسلامي في الهند. وكانت مدرسة جان دارد أول مدرسة فرنسية فيما عرف بـ”إفريقيا السوداء”،بل لعلها أول مدرسة فرنسية في القارة، حيث سبقت احتلال الجزائر بخمسة عشر عاما.
ورغم الدور الأساسي الذي كان– وما يزال- للكنيسة في هذا الشأن، فقد شعرت الإدارة الأوربية الغازية بأنها تواجه، من خلال مؤسسات التعليم الأصيل، عقبة كؤودا لا يمكن اجتيازها بسهولة، فقررت إنشاء التعليم العلماني (اللائكي) عام 1854غ. وأنشات في السنة التالية (1272 هـ/1855غ) مدرسة لأبناء الأعيان.
ومن السنغال انطلقت الجيوش الغازية لاجتياح موريتانيا في مطلع القرن العشرين (بالتقويم الغريغوري)، واستطاعت فرنسا أن تؤسس أول مدرسة لها في كيهيدي على شاطئ نهر السنغال، عام 1904غ التحق بها في البداية 29 تلميذا، ثم انخفض العدد إلى سبعة ثم ارتفع من جديد إلى 24، لكن تطور أعدادها ظل ضعيفا، حيث لم يتجاوز عدد الدارسين بعد ست سنوات 48 تلميذا. وفي عام 1913غ فتح فيها قسم للكبار انتسب إليه 15 فردا. وبعد ما يقارب عشرين عاما ارتفع عدد تلاميذ مدرسة كيهيدي إلى 102. وقد نجحت فرنسا في افتتاح ثاني مدرسة لها في مدينة بوغي (على شاطئ نهر السنغال) عام 1912، بلغ عدد تلامذتها في السنة الموالية سبعة عشر تلميذا.
وكان عدم نجاح مدرسة كيهيدي في استقطاب السكان العرب الموريتانيين (حيث لم يلتحق بها إلا عربيان)، قد دفع بالإدارة الفرنسية إلى التفكير في أسلوب جديد لإغراء العرب الموريتانيين بالمدرسة الوافدة، وللتخفيف من تحفظ عدد كبير من الزنوج عليها.
وهكذا استطلع حاكم غرب إفريقيا آراء رجال الإدارة الفرنسية في تونس، وكتب إلى القنصلية الفرنسية بالقاهرة ليطلع على سياسة الإنجليز التعليمية في مصر، وأوفد أحد معاونيه إلى الجزائر سنة 1906، فتجمع لديه من الآراء والتقارير ما استند إليه في إصدار قرار بتأسيس مدرسة إسلامية لأبناء المرابطين (العلماء)، تكون لطلبتها منح مالية. وهكذا تم سنة 1908غ تحويل مدرسة اندر[21] لأبناء الأعيان إلى “مدرسة” تحمل هذا الاسم العربي (مدرسة) بدل الاسم الفرنسي «Ecole» وتؤمن تعليما ثنائي اللغة (عربيا فرنسيا). وتم افتتاح مدرستين مماثلتين في مالي في مدينتي جنة وتنبكتو، وهي ثلاثتها مدن وثيقة الصلة جغرافيا وبشريا وتاريخيا وإداريا ببلاد شنقيط. ولهذا كان افتتاح المدارس بها تمهيدا لا بد منه لتطبيق التجربة في “أرض البيضان”[22].
وكانت مدرسة بوتلميت[23] التي زاولت نشاطها عام 1914غ أول مدرسة وافدة تفتح أبوابها في محيط عربي بموريتانيا. وقد تعاملت الإدارة الفرنسية بحذر وحيطة مع هذه المدرسة، فأدرجت فيها مواد عربية حتى لا يرفضها السكان، وقصرت إدارتها على مدرسين مستقدمين من الجزائر متشبعين باللغتين العربية والفرنسية. وفي عام 1936 افتتحت فرنسا مدرسة جديدة في أطار، أعلنتها في البداية – ولأسباب تكتيكية – مدرسة عربية خالصة.
ثانيا – في الخصائص والسمات:
- في الأهداف والغايات
حددت الإدارة الفرنسية لمدارسها في موريتانيا وفي سائر البلاد المستضعفة أهدافا أساسية من أبرزها:
- نشر اللغة الفرنسية. وقد جاء في تعميم من الإدارة الفرنسية بهذا الشأن: «ينبغي أن تفرض الفرنسية على أكبر عدد ممكن من السكان المحليين لتكون لغة الاتصال وأداة التفاهم على امتداد الإقليم. وقد أصبح لزاما على الشيوخ، أن يتعلموا الفرنسية (…) من غير المقبول، بعد 40 سنة من الاحتلال، أن نجد جميع الشيوخ غير قادرين على التحدث معنا مباشرة بدون ترجمان، رغم أن علاقات عمل منتظمة تربطنا وإياهم. يجب نشر اللغة الفرنسية الجارية. يجب أن يكون في استطاعتنا، وفي أقصى القرى، أن نقابل شيخ مجموعة وعددا من السكان يفهمون الفرنسية ويتحدثون بها. إن الفرنسية هي اللغة الوحيدة التي ينبغي أن نعنى بها ويتعين علينا نشرها»[24].
- إظهار عظمة فرنسا وزرع محبتها في قلوب الشعوب المستضعفة، وهكذا نصت تعاليم الإدارة الفرنسية على أنه من واجب “مدرسي التاريخ والجغرافيا أن يبرزوا كيف أن فرنسا أمة غنية قوية قادرة على انتزاع الاحترام ولكنها أيضا قمة في نبل المشاعر ورقتها، سخية لم تتقاعس أبدا عن التضحية بالرجال وبالمال لتحرير الشعوب المظلومة ولتحمل إلى الشعوب المتوحشة السلام وثمار الحضارة».
- تكوين المستخدمين الذين تحتاج إليهم الإدارة الفرنسية في عملها، وفي حدود الحاجة القائمة، وذلك بتخريج كتبة وتراجمة وموظفين عاديين. ولأن حاجة فرنسا من السكان تكاد تنحصر في الوظائف الصغيرة، فإن تكوين كفاءات جامعية لم يكن هدفا إلا في حالات استثنائية نادرة. وقد نالت موريتانيا استقلالها وليس بين مواطنيها أكثر من خمسة جامعيين. وكان من أهداف فرنسا أن تجعل كتبتها وصغار موظفيها أقطابا في الأوساط الاجتماعية التي ينتمون إليها، بما هيأته لهم من بسطة في الرزق لم تكن لغيرهم، فقد عملت على تعزيز نفوذهم وتحويل مراكز الثقل الاجتماعي إليهم. وسهل هذه المهمة نسبيا اعتماد ثنائية التعليم (عربية – فرنسية) وسعي فرنسا الحثيث إلى تسجيل أبناء الأعيان في المدارس.
- في الآثار والمخرجات:
رغم إحاطة المدرسة بكثير من المغريات (منح ونفقة وكسوة للتلاميذ، وهدايا وتسهيلات للمشائخ والآباء)، فقد ظل حضورها ضعيفا في البلاد الموريتانية إلى حين رحيل الإدارة الغازية. ففي أواخر الخمسينيات، وبعد أكثر من نصف قرن من العمل الجاد، لم تكن فرنسا قد نجحت في افتتاح أكثر من 73 مدرسة، ينتسب إليها بضعة آلاف من التلاميذ. ومع استقلال البلد عام 1960غ ارتفع عدد التلاميذ إلى 11200 وهو عدد يمثل 7.3% ممن هم في سن التمدرس، ولم تكن هذه النسبة تتجاوز 1.6% عام 1944غ. وقد علق مفتش فرنسي في تقرير له على ضآلة الإقبال على المدرسة في موريتانيا قائلا إن مجموع تلاميذ المدارس في موريتانيا كلها في 1932 (عام إعداد التقرير) كان أقل من عدد تلاميذ مدارس بودور وحدها، وهي مدينة سنغالية صغيرة، تقع على الضفة الأخرى من نهر السنغال. [25]
ورغم كل ذلك فقد حققت الإدارة الفرنسية من المدرسة جل مبتغاها، فقد خرجت لها الكتبة والتراجمة ومعلمي اللغة الفرنسية وأعوان الإدارة ووكلاءها، وكان لها “الفضل” في إمداد الدولة الموريتانية الناشئة بـ”خبرات” بشرية لا غنى عنها في إقامة دولة على نظام محدث، ولعلها قد ساهمت، وخصوصا بعد الاستقلال، في نشر تعليم قاعدي كان له أثره في الحد من الفوارق الاجتماعية، بكسر ما حكمت به التقاليد العتيقة من استئثار بعض القبائل بإنتاج المعرفة وتداولها، وتفرغ قبائل أخرى للسلاح أو للرعاية وتنمية الماشية، وانصراف شرائح معينة لخدمة الآخرين. وقد ساهمت المدرسة الفرنسية في الإعداد لتحولات اجتماعية وثقافية لاحقة، تكشفت جوانبها السلبية تدريجيا، ولكن بشكل شبه مباغت، وتسارعت خطاها مع اختفاء شبح الدولة الغازية وتعزز شعور الموريتانيين بأنهم، وإن وهما، قد أصبحوا مستقلين.
ولعل من أبرز النتائج السلبية للمدرسة على هذا الصعيد أنها ساهمت في إضعاف المناعة الحضارية للمجتمع، وفي توهين عرى وحدته الوطنية وتماسكه الاجتماعي، وفي زعزعة نظامه القيمي.
- فقد كونت المدرسة فئة من السكان متنفذة تدين بنسبة كبيرة من الولاء للإدارة التي رعتها، وتؤمن بثقافتها. وقد سلمت فرنسا مقاليد الحكم إلى هذه الفئة، وحكّمتها في مصائر الاخرين، فكان لها من الحظوة والقدرة على جلب المصالح أو حجبها وإنزال الأذى أو دفعه عن السكان ما ساهم في إضعاف المناعة الحضارية والثقافية للبلد، وجعل العديد من الأوساط الاجتماعية التي قاومت المد الثقافي التغريبي تشعر في بواطنها بالندم لأنها ضيعت على أبنائها فرص المشاركة في حكم البلاد وإدارة شئونها، فصاروا في ضرورات الحياة العادية تبعا لآخرين كان كثير منهم في دركات دنيا من السلم الاجتماعي التقليدي.
- وأحدثت المدرسة شرخا عرقيا في جدار الوحدة الوطنية لأبناء موريتانيا، فقد كانت اللحمة بينهم قوية في كنف الإسلام. وكان الأفارقة منهم ومن جيرانهم ينافسون العرب ويبزونهم في خدمة الإسلام ونشر ثقافته. ومع ظهور المدرسة وانتشارها، كان الزنوج في موريتانيا والسنغال أكثر تقبلا لها من العرب. وهكذا أصبحت المدرسة الفرنسية في موريتانيا مدرسة عرقية بنسبة كبيرة، إلى حد أن المفتش الفرنسي Beart كتب في تقرير عن جولة له سنة 1946 يقول: «هناك ظاهرة تثير الاستغراب وتنذر بعواقب خطيرة.. إنني حين أرى التلاميذ مجتمعين في ساحة المدرسة لا أشعر بأنني في مدرسة للبيضان، بل في مدرسة سوداء». ويبرز تقرير إحصائي عن حالة التعليم في موريتانيا سنة 1931 أن نسبة التلاميذ العرب إلى مجموع تلاميذ المدارس الفرنسية كانت نحو 25%. ونتيجة لهذا التفاوت الكبير في أعداد الملتحقين بالمدرسة الفرنسية كان جل خريجيها من أبناء الأقليات الموريتانية. ونجحت الإدارة الفرنسية في إقناع كثير من هؤلاء بأن مصالحهم مرهونة بمكانة اللغة الفرنسية في البلد، وأن أي تراجع لهذه المكانة سيكون وبالا عليهم، وهكذا تكونت عند فئات واسعة من الشبان الزنوج في موريتانيا نزعة شعوبية ترفض اللغة العربية وتتمسك بحق خريجي المدرسة الفرنسية في الاستئثار بإدارة البلد. وكان من نتائج هذا الوضع أن كادت تنشب حرب أهلية عام 1966غ، بعد أن قررت الحكومة في خطوة حيية تطبيق ازدواجية التعليم، أي إعطاء العربية مكانة مماثلة لمكانة الفرنسية في النظام التعليمي الحكومي، فكان أن اندلعت مواجهات بين السكان وخاصة في الوسط المدرسي، نتيجة رفض الأفارقة الموريتانيين لهذا القرار. وحين خطت الحكومة خطوة أكثر شجاعة عام 1973غ فقررت تعريب التعليم كادت تنشب مواجهات جديدة، ونشأت حركات ذات نزعات زنوجية ضيقة، قابلتها ردة فعل من حركات عروبية. وكادت موريتانيا تسقط في يد حكم عسكري زنجي حين أعلنت السلطات عام 1987غ عن اكتشاف محاولة انقلاب كانت في آخر مراحل تحضيرها، يقف وراءها ضباط وجنود زنوج. وكان لهؤلاء حضور قوي في المؤسسة العسكرية نتيجة مقاطعة العرب الواسعة لها إلى وقت قريب. وقد تعاملت السلطات الحاكمة بقسوة مع من اعتبرتهم مدبرين لمحاولة الانقلاب التي كانت، فيما يقال، تحمل مشروعا لترحيل العرب “وإعادتهم من حيث أتوا”، وتغيير اسم موريتانيا إلى “نغروتانيا” Negrotanie (من Nègre بمعنى زنجي). وكان من الأخطاء التي ارتكبتها السلطات الموريتانية الحاكمة أن أخذت كثيرا من المواطنين الزنوج بالظنة وقامت بتصفية أعداد كبيرة من الزنوج العاملين في المؤسستين العسكرية والأمنية. وتزامن ذلك كله مع حدوث أزمة 1989 بين السنغال وموريتانيا، فتضعضعت إلى حد ما أركان وحدة البلد، وتشكلت حركات زنجية ما تزال إلى اليوم تطالب بوضع نظام جديد للتعايش بين العرب والأفارقة في موريتانيا. إن هذا الوضع المأزوم يشكل أثرا من الآثار المباشرة للنظام التربوي الدخيل الذي جاء بمشروع مجتمعي مختلف وضرب بسور من الحساسيات والحزازات بين أبناء موريتانيا، بل وبين كل المسلمين في المنطقة، وقد كانوا من قبل ينهلون من معين معرفي واحد، ويحتكمون إلى مرجعية واحدة، ويشعرون بأنهم أمة واحدة.
- وفي سياق مشابه، تفاقمت حدة الفوارق الاجتماعية بين أبناء البلد، تحت تأثير النظام التربوي الوافد، وخصوصا في فترة الاحتلال. فقد أسست الإدارة الفرنسية مدارس لأبناء الأعيان، وركزت جهدا كبيرا على اكتتاب التلاميذ من أبناء البيوتات ذات المقام الاجتماعي المرموق، وكانت في ذلك تناقض بشكل صريح الأفكار التي تروج لها عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ومبادئ الثورة الفرنسية.
- كانت للمدرسة مساهمة كبرى في قلب هرم القيم الاجتماعية، فقد أنتجت قيما جديدة، أعطت فيها للمادة والسلطة ما لم يكن لهما، ففي المجتمع التقليدي الموريتاني، كانت السلطة المسلحة بيد أمراء، مارسوا بها سطوتهم على السواد الأعظم من الناس، لكنهم –بالمقابل- كانوا يخضعون خضوعا تاما لسلطة العلماء والمشايخ الروحيين. وفي المجتمع التقليدي، كان العلم مصدرا للجاه والمال، وكان يتسنم ذروة القيم الاجتماعية فيتقدم فيها على الغنى. ومع انتشار خريجي المدارس واستحواذهم على مراكز العمل والقيادة في الدولة، تضعضعت القيم الأصيلة وانقلب هرمها، فأصبحت السلطة والمال في القمة ورُدّت المعرفة أسفل سافلين، إلا من رحم ربك، وأصبحت قيمة المرء ما يملكه لا ما يحسنه. وإلى ذلك ساهمت المدرسة بمخرجاتها وبمناهجها في نشر ثقافة التزلف والتملق، وفي إضعاف مشاعر النخوة والإباء والوطنية في النفوس، فقد نجحت الإدارة الغازية على سبيل المثال في الاستعانة بالمدرسة في إخماد جذوة الرفض لدى كثير من الأعيان، حيث كان وجود أبنائهم في المدرسة حاجزا دون اتخاذ أي موقف معارض أو مشاكس، لخوفهم على هؤلاء الأبناء، ولما يلقونه أيضا من “الرشاوى” مقابل بقاء هؤلاء الأبناء في المدرسة. ولأنها نبتة غرست في تربة الطمع والخوف فإن مخرجاتها جاءت حاملة لسمات منبتها، فكانت في الغالب طيعة للحاكم مستخذية له، جاثية على أعتابه، مسبحة بحمده. ولعل من أبلغ الوقائع دلالة على أثر المدرسة وثقافتها في توهين المجتمعات الإسلامية في موريتانيا وإفريقيا تصويت كثير من هذه المجتمعات (أو تصويت المصوتين منها) لصالح بقاء السلطة الغازية (في الاستفتاءات التي نظمتها لهذا الغرض)، رغم أن هذه السلطة كانت تعد نفسها للخروج –وقد فعلت، شكليا على الأقل- إذ أدركت أن خروجها قد يحقق لها من مآربها القصية ما لا يحققه بقاؤها على الأرض المستضعفة.
- أضعفت المدرسة قيم الإنتاج والكدح والعمل اليدوي والاعتماد على الذات والتطوع والإيثار، ونشرت ثقافة الوظيفة والراتب الشهري والعطلة السنوية والاستئثار والعمل في الظل وتحت المراوح أو المكيفات وعلى الكراسي الهزازة والإضراب عن التعلم أو عن خدمة المجتمع والتوكل على “المخزن” وانتظار ما يجود به، فنشأ بسبب ذلك كله مجتمع طفيلي مسترخٍ، مستنكف عن العمل اليدوي، ميال إلى الراحة والدعة والثراء السريع والكسب السهل.
- كانت المدرسة الدخيلة بذلك كله وبقدرتها التنافسية في الجوانب المادية، وما فتحته لبعض خريجيها من آفاق الكسب والنفوذ، مدرسة ضرارا، زاحمت المحضرة وحاصرتها حصارا شديدا، خصوصا بعد الاستقلال، فحدت من الحضور الكمي والكيفي للمحضرة في الفضاء الموريتاني.
الفصل الأول: المحضرة الشنقيطية
المبحث الأول: في نشأة التعليم المحضري
أولا- المحضرة / الرباط:
أخذت رسالة {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} (العلق : 1) طريقها إلى بلاد الملثمين مع توجه الفاتحين غربا إلى مصر (16-20 هـ) ثم إلى إفريقية، مرورا بطرابلس (22هـ)، وصولا إلى قاعدتها قرطاجة التي فتحها عبد الله بن أبي سرح عام 27هـ/647م، بإذن من الخليفة الثالث عثمان بن عفان. وتبعه معاوية بن حديج عام 40هـ/660م ثم عقبة بن نافع الفهري (توفي عام 360هـ/683م) عام 46هـ/666م، وهو الذي اختط مدينة القيروان، وواصل فتوحه في حملة ثانية حتى وصل بلاد السوس الأقصى، ففتح قاعدتها تارودنت[26]. وإلى ذلك يذهب ابن عذاري في قوله: »أخبرني الشيخ الصالح أبو علي صالح بن أبي صالح أنه لم يصح عنده أن عقبة حضر بنيان شيء من المساجد بالمغرب إلا مسجد القيروان ومسجدا بالسوس الأقصى «[27].
وتقول بعض الروايات أن عقبة بن نافع واصل سيره من السوس حتى وصل ولاته بشرق بلاد الملثمين (موريتانيا اليوم)، وخلف بها ابنه العاقب، وقبره –كما يقولون- بصحن مسجدها الذي هو بانيه[28]. فإذا صح ذلك يكون الإسلام قد دخل بلاد الملثمين في أواسط القرن الهجري الأول. وثمة، مهما اختلف المؤرخون، ما يطمئن إلى أن حملة سيرها عبيد الله بن الحبحاب والي إفريقية وقادها حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع (وفي رواية عبد الرحمن بن حبيب) قد دخلت الصحراء ما بين عامي 114 و116هـ وحفرت فيها الآبار ووصلت إلى تخوم بلاد السودان، ولعلها نقلت معها قبسا من نور النبوة وهدي القرآن.
ومن المؤكد أن دولة المرابطين التي ولدت في عمق صحراء الملثمين، وعلى مقربة من شواطئ الأطلسي ونهر صنهاجة (نهر السنغال اليوم)، قد أسست من أول يوم على ركن ركين من طلب العلم وبثه؛ فقد حج الأمير اللمتوني يحيى بن إبراهيم الكدالي، ومر في طريق العودة بالقيروان عام 426هـ/1033م، فلقي بها الفقيه أبا عمران الفاسي وشكا إليه حال قومه في عبارات تناقلها المؤرخون: «إننا في الصحراء منقطعون لا يصل إلينا إلا بعض التجار حرفتهم الاشتغال بالبيع والشراء، وفينا أقوام يحرصون على تعلم القرآن ويرغبون في الفقه والدين لو وجدوا إلى ذلك سبيلا»، فكتب له أبو عمران إلى وكاك[29] بن زلو اللمطي، أحد تلامذته بالسوس، وكان عالما فوافاه بمقره في «ملكوس»، فانتدب له عبد الله بن ياسين الجزولي الصنهاجي.
ويبدو أن أهل الصحراء تأبوا أول الأمر على الفقيه عبد الله بن ياسين، ولم يتحملوا ما أخذهم به من الشدة في أمر الدين. وذكر البكري أن فقيها من الملثمين اسمه الجوهر بن سكم ورجلان من أعيانهم (أيار واينتكو) خرجوا على عبد الله بن ياسين فعزلوه وأخذوا منه بيت المال وطردوه وهدموا بيته، فخرج إلى شيخه وكاك بن زلو، يشكو إليه صنيع القوم به. وكان وكاك ذا كلمة مسموعة فيهم فعاتبهم وأمر عبد الله بالرجوع إليهم. ولعل إعراضهم استمر، فلم يجد الفقيه عبد الله بن ياسين وزميله الأمير يحي بن إبراهيم (أو خلفه، خلاف بين المؤرخين) إلا أن ينتبذا، وثلة قليلة من المؤمنين، مكانا قصيا (جزيرة في المحيط الأطلسي على بعد نحو 60كم شمال غربي نواكشوط، على الراجح) فأنشؤوا هناك رباطا[30] اعتزلوا فيه، وكانوا سبعة، فأخذ خيار القوم يفدون عليهم ويلتفون حولهم، يربيهم الفقيه ويعلمهم ويرشدهم إلى أن صاروا ألفا من «المرابطين»، فعندئذ خرج بهم الفقيه والأمير من الرباط وانطلقوا في جهادهم المظفر.
ولعل هذا الرباط كان المحضرة الأولى في بلاد شنقيط، محضرة انعقد في رحابها حلف بين الإمارة والفقه في شخص المجاهدين عبد الله ويحي. ولم يلبث الفقيه عبد الله أن استشهد في جهاد برغواطة عام 451هـ/1059م دون أن يتاح له كبير وقت للتوسع في أداء رسالته العلمية في بلاد الملثمين.
ورغم انشغال المرابطين بالجهاد واستشهاد معلمهم الأول، فإن راية العلم لم تسقط من أيديهم، فقد اغتنم الزعيم اللمتوني أبو بكر بن عمر –وقد جمع بين الإمارة والإمامة- فرصة سفره من المغرب عائدا إلى الصحراء، بعد استتباب الأمر في مراكش لابن عمه يوسف بن تاشفين، فمر بأغمات وريكه واصطحب منها أربعة علماء هم: الإمام أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي وإبراهيم الأموي، وعبد الرحمن بن أبي بكر الركاز جد تركز وعبد الله الزينبي جد الزينبيين.
وكان الإمام الحضرمي قاضيا بمدينة أزوكي (125 كم جنوب شنقيط)، وبها استشهد مجاهدا عام 489هـ. أما إبراهيم الأموي، فكان يقضي ويعلم الناس في مجلس الأمير، يرحل معه كلما ارتحل. ومن «مجلس» العلم ذاك اشتُقت «مدلش» التي سارت علما على قبيلة من أطول القبائل الشنقيطية يدا في المعرفة، وهي تعتبر إبراهيم الأموي جدها الجامع.
وهكذا نستطيع أن نؤرخ لبداية النشاط المحضري (التعليمي) في بلاد شنقيط بتأسيس رباط عبد الله بن ياسين حوالي سنة 431هـ/1039م، وأن نقرر أن دولة المرابطين في الصحراء كانت دولة علم وجهاد في آن[31].
وقد تعزز مسارها هذا في شطرها الشمالي الذي استقل به الأمير يوسف بن تاشفين، فقد قال عنه عبد الواحد المراكشي[32]: “أما يوسف فانقطع إليه من أهل كل علم فحوله (…) واجتمع له ولابنه من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتماعه في عصر من الأعصار”[33]. وأما ولده علي فقد “اشتد إيثاره لأهل الفقه والدين، وكان لا يقطع أمرا في جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء، فبلغ الفقهاء في أيامه مبلغا عظيما، لم يبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس”[34].
وهكذا كون العلم والسلطة والجهاد، في كنف دولة المرابطين، حلف فضول، فكان الفقيه والأمير – وكلاهما مجاهد – :
رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق.
إلا أن عقد دولة المرابطين لم يلبث أن انفرط في شطرها الجنوبي (بلاد الملثمين) فوهن عظمها وانحلت عراها بعد استشهاد الأمير اللمتوني أبي بكر بن عامر[35] (480هـ/1087م)، فهل كان لانفراط عقد هذه الدولة تأثير سلبي على الحركة العلمية في بلاد شنقيط؟
الجواب الطبيعي هو: أجل! فإن هناك تأثيرا متبادلا مشهودا بين الوضع السياسي للدولة أيا كانت، وبين مجمل أوضاع السكان بما فيها –على الخصوص- أوضاعهم التربوية. ومع ذلك، فإن مؤشرات عديدة تؤكد أن الحركة العلمية في صحراء الملثمين استطاعت أن تقاوم، شيئا ما، ذلك الخطر الناجم عن انحلال دولة المرابطين، بل وأن تنبعث، بعد قرون، قوية، وكأنها طائر الفينيق كما تتحدث عنه أساطير الأولين.
ثانيا: العلم في الحواضر
ولعل مما هيأ للحركة العلمية قدرا من أسباب البقاء في المرحلة الأولى تمكنها من التحصن بحواضر كانت محطات للقوافل الآتية من الشمال والشرق. ولم تكن هذه الحواضر، حتى قبل قيام دولة المرابطين، خلوا من حركة علمية ما؛ فقد تحدث البكري عن أوداغست[36] في كتابه «المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» وقال: «إنها مدينة كبيرة (…) بها جامع ومساجد كثيرة آهلة، في جميعها المعلمون للقرآن”. بل إن البكري يمضي فينقل خبرا غريبا مفاده أن عبد الله بن ياسين قتل في أوداغست رجلا من العرب المولدين قيروانيا “معلوما بالورع والصلاح وتلاوة القرآن وحج البيت يسمى زبافرة”[37].
وتحدث البكري أيضا عن “غانة”[38] التي أعطت اسمها لامبراطورية إفريقية كبيرة، قبل الفتح، وذكر أنها: ” مدينتان سهليتان إحداهما المدينة التي يسكنها المسلمون وهذه مدينة كبيرة فيها 12 مسجدا أحدها يجمعون فيه. ولها الأئمة والمؤذنون والراتبون وفيها فقهاء وحملة علم”[39]. بل إن بعض المصادر تذكر أن كل مسجد من المساجد الاثني عشر كانت له مدرسة ملحقة به[40].
وهناك مدينة مندثرة تدعى “تنيكي”[41]، يرجح أن تكون أول حاضرة علم في البلاد بعد رباط عبد الله بن ياسين وآزوكي مرقد الإمام الحضرمي. وقد ازدهرت هذه المدينة في القرن العاشر الهجري، ويقال إنه كان فيها يومئذ 300 فتاة تحفظ موطأ الإمام مالك، وقال اباه بن محمد الأمين اللمتوني (1330هـ) إن “أكثر بقاع الدنيا علما إذ ذاك تنيكي ومصر”[42].
وهناك حاضرتان أسس بنيانهما، من أول يوم، على تقوى وعلم، هما تيشيت[43] ووادان[44]. وربما كانت شنقيط[45] – العاصمة التاريخية لموريتانيا الحالية – ثالثتهما في ذلك. وكان العلم مكينا في حواضر أخرى بعضها ما زال حيا ، كما هو شأن مدينة ولاته[46]، وبعضها اندثر كما هو شأن مدينة تنيكي.
أما تيشيت فقد أسسها عام 536 هـ الشريف عبد المؤمن تلميذ القاضي عياض السبتي (توفي 544هـ). وأما وادان، فقد أسسها –على ما يذكر- في يوم عرفة من العام ذاته ثلاثة علماء، كانوا قد حجوا البيت الحرام وتلقوا العلم خارج بلدهم، هم الحاج عثمان الأنصاري، تلميذ القاضي عياض السبتي وزميل الشريف عبد المؤمن، والحاج يعقوب القرشي والحاج علي الصنهاجي. والتحق بهم بعد التأسيس عبد الرحمن الصائم. ومن التأويلات الطريفة لاشتقاق اسم وادان أنها «واديان مليء أحدهما علما ودينا ومليء الآخر نخلا وتمرا»[47]. ويروى أنه كان في وادان 40 دارا متوالية في كل منها عالم ضليع. وفي المدينة إلى اليوم شارع يسمى شارع العلماء. ومن وادان ظهر أول مصَنّف شنقيطي محفوظ، بعد عهد المرابطين، هو كتاب «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» لمحمد بن أحمد بن أبي بكر (ق10هـ).
ولشنقيط شأن آخر، فقد سار اسمها علما على البلاد كلها. وكان من أسباب ذلك، فيما يذكره بعض المؤرخين، أنها كانت منطلق قوافل الحجيج، وكان أهلها أكثر أهل البلاد حجا. وقد هيأ لها وضعها ذلك أن تكون قاعدة مكينة للحركة العلمية في البلاد وفيما حولها، فقد كانت القوافل تعود إليها محملة بعلم في الصدور وآخر في السطور، حيث يعود من يعود من الحجيج وقد ازداد علما في سفره، ويعودون محملين بالكتب. وقد حل بها منذ قرون خلت علماء قدموا من ديار العروبة والإسلام، منهم الشريف التلمساني أحمد الذهبي (ق10-11هـ) الذي كان أول من درّس بها مختصر خليل بن إسحاق المالكي. ولم تلبث شنقيط، وقد غدت قبلة لطلاب العلم ومركزا لباذليه، أن أصبحت منارة إشعاع امتد أثرها العلمي إلى قاصية الديار بما فيها بلاد المنبع، مثل الحرمين ومصر والعراق.
وكانت ولاته، ويرجح أن تكون أقدم ضريباتها الثلاث آنفة الذكر، مركزا لحركة علمية نشطة. وقد زارها الرحالة ابن بطوطة سنة 753هـ/1352م ووصفها بأنها «تبدو عليها مظاهر الشيخوخة والقدم»، ووصف رجالها بأنهم «محافظون على الصلوات وعلم الفقه وحفظ القرآن”[48]. وكانت ولاته على تواصل نشط مع الحاضرة العلمية الإسلامية الكبيرة تنبكتو الواقعة اليوم في شمال جمهورية مالي. وقد ورثت ولاته المجد العلمي لتنبكتو عندما هجم عليها سلطان السنغاي سني عالي عام 873هـ/ 1468غ، فاضطر علماءها للنزوح منها إلى ولاته. وكذلك كان الأمر بعد حملة السعديين عليها عام 1000هـ/1592غ، وهي الحملة التي أُسر فيها العلامة أحمد بابا التنبكتي (توفي عام 1036هـ/1627غ) وجلب إلى المغرب ، مسترقا أول الأمر ، قبل أن يكتشف الناس علمه ويتداعوا للأخذ عنه[49].
ومن قبل ذلك كانت ولاتة قد استقبلت، في القرن السادس الهجري، علماء مهاجرين من مملكة غانة بعد تصدع أركانها تحت ضغط أمراء صوصو. وفي القرن التاسع الهجري، نزل بها العبد الصالح سيدي أحمد البكاي الكنتي (ت 920هـ/1591غ) فاتخذها دارا له، وأثر عن ابنه الشيخ سيدي عمر أنه حج مرتين وزار الشام والمغرب ومصر والتقى بالشيخ جلال الدين السيوطي وبالشيخ المغيلي التلمساني. [50]
وعلى ما كان لهذه الحواضر وتلك من أثر محمود في نشر العلم، في البلاد وخارجها، فإن معالم المحضرة الموريتانية وسماتها المميزة لم تتحدد بشكل لافت ومثير للتأمل إلا بعد أن التقطت البادية الشنقيطية مشعل العلم من الحاضرة.
ثالثا – العلم في البادية
لم تأخذ المحضرة زخرفها وزينتها ولم تفصح عن عبقريتها ولم ترفع أركان دولتها المكينة ومجدها الأثيل إلا في رحاب البادية، فقد بدأت المحاضر تنتشر في البادية منذ القرن العاشر الهجري وفيه ولدت محضرة «الكحلاء» العريقة، وإن لم يقو ساعدها إلا من بعده. وقد ظهرت هذه المحضرة في حي بدوي متنقل، وسميت باسم خيمة من صوف الضأن سوداء. وبلغ من شهرتها وإقبال الطلبة عليها أن قيل إن مختصر خليل بن إسحاق كان يوجد فيها موزعا كله بين الألواح في يوم واحد، ويعني ذلك أن منتسبيها كانوا يبلغون المئات. وفي محضرة بدوية أخرى، هي محضرة محمد عالي بن سعيد، وجدت ألفية ابن مالك موزعة كلها بين الألواح في يوم واحد لكثرة الدارسين. وكان في محضرة الشيخ محمد حامد بن آلا ما بين 300 و400 طالب، وهي أيضا محضرة بدوية.
وبغض النظر عن المحاضر قوية الاستقطاب، لم يكن حي بدوي في موريتانيا يخلو من مدرسة قرآنية أو محضرة. وكان من نتائج ذلك انتشار العلم في أوساط المجتمع الشنقيطي بما في ذلك بعض الأوساط المهمشة تقليديا، فقد ذكر أن العبيد في المجتمع البدوي الموريتاني القديم كانوا يغنون على الطبل بمقامات الحريري. وقد سجل الفرنسيون عند اجتياحهم البلاد استغرابهم لهذه الظاهرة، حيث لا يندر أن يوجد “راع بدوي يترنم بأشعار الجاهليين”.
وقد سجل طلبة المحاضر السمة البدوية، بما تقتضيه من ترحال دائب، بلغة الشكوى، فوصف أحدهم شيخه بقوله:
إنما البوني غول وبه الريح تجول
أما شيخه المعني وهو العلامة المختار بن بونه الجكني المتوفى عام 1220هـ، فقد سجل الظاهرة باعتزاز:
ونحن ركب من الأشراف منتظم أجل ذا العصر قدرا دون أدنانا
قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة بها نبين دين الله تبيانا
وقد فاخر بالعلم علماء شناقطة عاشوا حياتهم كلها في البادية، منهم الشيخ محمد المامي القائل:
إن لم يكن شنقيط فيه زمزم فلهم في العلم أصل قدم
ومحمد مولود بن أغشممت القائل:
ونحن المجالس شق اسمنا من العلم والعز إن تسألوا
ونحن قريش إذا ننتمي ومن تحت أخمصنا الأعزل
وينتمي هذا الشاعر المفاخر إلى قبيلة مدلش (مجلس العلم) البدوية، وهي قبيلة يذكر أن الأطفال كانوا يحفظون فيها مدونة الإمام مالك قبل البلوغ، وذكر أنه اجتمع لهم في فترة واحدة 300 شاب يحفظون كلهم المدونة ويحملون كلهم اسم “محمد الأمين”[51].
المبحث الثاني: في الفكر التربوي عند الشناقطة
للشناقطة مساهمة في نشر وتأصيل الفكر التربوي العربي الإسلامي من خلال مصنفاتهم المكتوبة ومأثوراتهم المروية وتقاليدهم المرعية,
أولا : الفكر التربوي في التراث الشنقيطي المكتوب:
عالج العديد من العلماء الشناقطة قضايا تربوية في منظومات ومؤلفات وفتاوى. وكان من بين هؤلاء:
- محمد اليدالي الديماني (توفي 1166هـ)، فقد أصدر فتوى في شأن تسريح الأطفال (العطل) وخلف رسالة في 25 صفحة، عرفت بعنوان “النصيحة” حث فيها على طلب العلم. وقد صدرت الرسالة بتحقيق محمذن باباه عن بيت الحكمة في تونس عام 1990غ.
- سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي، المتوفى عام 1233هـ، له آراء في التربية مبثوثة في عدد من مؤلفاته. وقد استخرج الطالب المصطفى بن المبروك هذه الآراء من عدة كتب ومنظومات للعلامة العلوي، منها: نور الأقاح وشرحها فيض الفتاح، وطلعة الأنوار وشرحها هدي الأبرار، وكتاب “طرد الضوال والهمل عن الكروع في حياض مسائل العمل”، وذلك في رسالة تخرج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، بعنوان “الرؤية التربوية والأسس التعليمية في تجربة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم المحضرية” (2005غ).
- النابغة الغلاوي 1245هـ له نظم من 45 بيتا في آداب المعلم والمتعلم وفتوى في تسريح الصبيان.
- حماد بن الأمين المجلسي 1257هـ له وصية للناشئة في 36 بيتا. وقد حث فيها على طلب العلم.
- الشيخ محمذن فال بن متالي المتوفى عام 1278هـ ، وقد عقد لتأديب الأبناء فصلا خاصا في كتاب فتح الحق (مخطوط في 233 صفحة) وذكر من حقوق الولد على والده أن يعلمه رمي السهام والسباحة والمكايدة والخدعة للجهاد.[52]
- محمد مبارك اللمتوني المتوفى عام 1293هـ له منظومة في آداب العالم والمتعلم في 142 بيتا.
- محمدُ بن حنبل الحسني، له قصيدة طويلة يحث فيها على طلب العلم ويقارن بينه وبين المال، وفيها يقول:
جرع النفس على تحصيله مضض المرين: ذل وسغب
واصحب الدائب في استنباطه لا جهولا خدن لهو ولعب.
- بابا بن حمدي الحاجي المتوفى عام 1316 له رسالة في أحكام المعلم والمتعلم.
- محمد مولود بن أحمد فال المتوفى عام 1323هـ، له رسالة في تعليم الأطفال ونظم بعنوان “الظفر بالمراد في البر بالآباء والأجداد” في 95 بيتا، تناول فيه قضايا تربوية. وقد أفتى في رسالته بوجوب العدل في التعليم ولو تخالف المتعلمون في الجعل[53]. كما أكد أهمية اختيار المعلم معتبرا التعليم بمثابة “رضاع ثان”[54].
- الشيخ أحمد الهيبة بن الشيخ ماء العينين المتوفى عام 1337هـ له كتاب “سراج الظلم فيما ينفع العالم والمتعلم”.
- أحمد بن محمد الحاجي المتوفى عام 1351هـ له نصيحة في الأدب والأخلاق.
- البشير بن مباريكي المتوفى عام 1354هـ له منظومة “النصيحة” وجهها لابنه محمد في 141 بيتا.
- محمد حبيب الله بن مايابى المتوفى عام 1364هـ له منظومة في آداب العلم وحسن الأخلاق
- محمدن بن محمد النابغة المتوفى عام 1382، له رسالة في شأن اكتساب العلم وبذله في 21 صفحة ، حققتها الطالبة عيشة بنت محمد عبد الله في رسالة تخرج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية (نواكشوط: 2008غ) بعنوان: “مباحث في آداب العالم والمتعلم للشيخ محمدن بن محمد النابغة التندغي”.
- أحمد بن محمد محمود بن فتى المتوفى عام 1390هـ/ 1971 غ، له نظم في 389 بيتا خصص جلها للحث على طلب العلم، وقد حقق هذا النظم الطالب محمد عبد الله بن شامخ عام 1989، في رسالة تخرج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.
- محمد حامد بن آلا توجه إلى إحدى الفتيات بنصيحة ضمن أرجوزة في مكارم الأخلاق.
- سيدي المختار بن النعيم اليعقوبي نصح ابنه في قصيدة صدرها بالترغيب في التعليم.
- الشفيع بن المحبوبي المتوفى عام 1407هـ له نظم صفوة التحف في الآداب في 196 بيتا.
- أحمد بن التاه بن حمينا له أرجوزة في 21 بيتا موجهة إلى حفيدته اهتم فيها بتهذيب الفتيات.
- محمد الحسن بن أحمد الخديم (معاصر) له كتاب بعنوان “إعانة المتفهم في آداب المتعلم” في 325 صفحة، عقد فيه نظما وشرح مضمون كتاب الزرنوجي المتوفى عام571 هـ “تعليم المتعلم لتعلم طريق التعليم “. وقد صدر كتاب الشيخ محمد الحسن عام 1999غ عن مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء.
وسنتطرق إلى نماذج من أراء الشناقطة وأفكارهم في التربية، من خلال بعض ما أورده ثلاثة من العلماء المذكورين.
- فقد تناول حماد بن الأمين المجلسي في وصيته شروط طلب العلم، وذكر منها على الخصوص ما يلي:
| له تغرب وتواضع واترع واقصد به وجه الذي أنشاكا حتى ترى حالك حال المنشد: ودقة في عظم ساقي ويدي | عضت من الوجد أنامل اليد” | وجع وهن واعص هواك واتبع ولا تناو فيه من ناواكا “لو أن سلمى أبصرت تخددي وبعد أهلي وجفاء عودي |
وهكذا اعتبر هذا الشيخ الشنقيطي الغربة عن الوطن والأهل والتواضع للمعلم والورع عن المحارم والشبهات ومكابدة شظف العيش وتحمل أذى الآخرين ومجاهدة النفس والطاعة لله ولرسوله وللشيخ شروطا ضرورية لطلب العلم.
وفي مثل ذلك المعنى يقول الشيخ سيدي محمد الكنتي:
| تفرد وعاهد واجتهد واجتنب أخا | سفيها وصاحب ذا الصّلح ذا الحلم | |
| وباكر وذاكر واسهرن والزم الطّوى | بقط ولا تفرط يؤدي إلى السّقم | |
| ودارس ومارس واعتكف وتملقن | لدى كلّ وقّاد يؤول إلى فهم | |
| وحاجل وساجل كلّ صاحب همّة | يسوقك للتّقوى ويدعو إلى الحزم | |
| وقارب وراقب كلّ شيح مؤدب | أريب لبيب لا يميل إلى وصم | |
| وساير وسامر كلّ ندب مجرب | يصون خبايا السّرّ حتى عن الوهم | |
وإلى مثل تلك الآداب يشير الإمام الشافعي بقوله:
أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببيان
ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان.
وفي المعنى ذاته يرددون بيتين:
قالت مسائل سحنون لقارئها بالدرس يدرك منا كل ما استترا
لا يألف العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشرا.
- وأكد أحمد بن محمد محمود بن فتى وجوب طلب العلم. وتحدث عن التدرج في العلوم واعتبر النظر (أي التفكير ) واجبا للوصول إلى الإيمان بالله، وبعد أن ذكر ما يتصل من العلم بفرض العين تحدث عن بقية العلوم وأشار إلى قول من قال إن الفرض الكفائي أفضل من العيني:
| ثم إلى باقي العلوم يرتقي من الكفائي، وفي الكفائي | يركب فيه طبقا عن طبق في الفضل والعيني خلف جاء |
وذهب في نظمه إلى حد اعتبار ترك التعلم مدرجة للكفر فقال ناصحا للشباب:
عليكم العلم شباب العصر لا تسقطوا في هوة من كفر
ورجح كون عبادة الجاهل لا تنفعه، بعد أن ذكر قولا بأنه مأزور فيها غير مأجور، فقال:
وابن أبي جمرة قد ذكر في عبادة الجاهل أقوالا تفي
فقيل يوجر وقيل يوزر وقيل لا ولا وهو الأشهر
ودعا العلماء إلى التحلي بالجرأة والشجاعة:
يا علماء شمروا لا تهنوا لسنة الهادي ولا تداهنوا
ولا تخافوا في العلي الهادي لومة لائم من العباد
- أما سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم فقد تناول جملة واسعة من آداب العالم والمتعلم، منها:
- وجوب إخلاص النية في طلب العلم وفي بثه
- وجوب زجر من رفع صوته في درس الحديث.
- الإنصات وقت الدرس
- تحديث الناس بما يفهمون
- وقوع التعليم في مكان خال من التحجير مثل المسجد، حيث لا يمنع أحد من الدخول “لأن العلم لا يهلك إلا إذا كان سرا”.
- المساواة بين الطلبة، واحتج لذلك برفض الإمام مالك تخصيص مجلس لهارون الرشيد وأبنائه، وبما قاله أبو حيان التوحيدي عن أبي الحسن التوحيدي: “كان يجتمع على بابه نحو مائة رأس من الدواب للرؤساء والأشراف الذين يقصدونه. وكان إقباله على صاحب المرقعة كإقباله على صاحب الديباجة والدابة”.
- تذلل المتعلم للمعلم، وذكر فيه بقول الإمام الشافعي: “ما طلب أحد العلم بالتعمق وعز النفس فأفلح ولكن من طلبه بضيق اليد وذل النفس أفلح”، وأورد ما رواه أبو عثمان الحيري النيسابوري في قوله: “صحبت أبا حفص الحداد وأنا شاب فطردني مرة… فقمت ولم أوله ظهري… وجعلت في نفسي أحفر حفيرة على بابه ولا أخرج منها إلا بأمره، فلما رأى مني ذلك أدناني وجعلني من خواص أصحابه”.
- التسلية والترويح عن النفس. وفي ذلك يقول:
وروح القلب بذكر الطرف فإن ذاك من صنيع السلف
ومما يشهد لذلك ما ذكره الغزالي من أنه ينبغي أن يؤذن للصبي بعد الانطلاق من الكتاب “أن يلعب لعبا جميلا يستريح إليه من تعب الكتاب، فإن منع الطفل من اللعب وإرهاقه إلى التعليم دائما يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش”.
قال أحدهم:
أفد طبعك المكدود بالجد راحة يجم وعلله بشيء من المزح
ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بقدر الذي يعطى الطعام من الملح
ثانيا: أفكار ومبادئ تربوية أساسية:
مما تقدم ومما استقر في فكر الشناقطة التربوي وفي ممارساتهم المحضرية، يمكن أن نستخلص المبادئ الأساسية التالية:
- في طلب العلم:
- اعتبار طلب العلم من آكد الواجبات الشرعية، وهو اعتبار أكده الشناقطة في فتاواهم ومؤلفاتهم وقصائدهم ومنظوماتهم، واستحضروا فيه تراث الفتاوى التي ناقشت حكم قيام المعلم لصلاة الضحى، في أوقات الدراسة.
- حرية الطالب، حيث تعود إليه وحده (ربما باستشارة ذويه) سلطة اختيار المادة التي يدرس والشيخ الذي يتلقى منه العلم، ومقدار الدرس، ومدة الدراسة، بل وربما توقيتها.
- شد الرحال لطلب العلم وعدم الاكتفاء بتلقيه بين الأهل والأقربين بالغا ما بلغ تمكنهم من العلم وتبحرهم فيه.
- مكابدة شظف العيش ومشقته، في طلب العلم، وعدم الركون إلى الرخاء والدعة.
- التواضع والتذلل للمعلم وخدمته.
- في بث العلم:
- طوعية التعليم، حيث لا ينبغي للمدرس أن يطلب أجرا من الدارسين أو أوليائهم، جزاء بث العلم، وإن كان يقبل الهدية وخدمة طلبته. ولمعلم القرآن خاصة استثناء حيث تقضي الأعراف بتقديم هدايا له في أيام معينة وعند استيفاء تحفيظ القرآن أو تحفيظ أقسام منه معينة. لكنه لا يرفض تعليم طفل يعجز أهله عن القيام بالواجب العرفي تجاه المعلم.
- مشاعية التعليم، حيث لا يمنع أحد من حضور مجلس العلم، ولا يعقد هذا المجلس خلف أبواب موصدة، خشية احتكاره.
- المساواة بين طلبة العلم غنيهم وفقيرهم، شريفهم ووضيعهم في التدريس، إلا ما يكون من اهتمام بالنجباء والمجدين منهم.
- إفساح المجال لممارسة الرياضة وأصناف التسلية ونحوها مما يروح عن القلوب المكدودة لطلبة العلم. وقد أعطى المجتمع الشنقيطي للطلبة في هذا السياق ما يشبه الحصانة الدبلوماسية، فكان يغض الطرف عما يصدر منهم، وخصوصا على وجه التسلية، ويفسح لهم في مجالها ما لا يفسح فيه لغيرهم.
- في التأديب العقابي:
عالج الشناقطة قضية التأديب، كما عالجها أسلافهم من أعلام الفكر التربوي العربي، وقد جنحوا عامة إلى جواز ضرب التلميذ (الطفل خاصة)، وفي مرحلة الدراسة القرآنية بشكل أخص، لكنهم قيدوا ذلك بقيود منها ما ذكره النابغة الغلاوي في قوله:
والضرب باختلافهم قد يختلف إذ منهم ممتثل ومنحرف
ومنهم من ضربه حرام وهو الذي يصلحه الكلام
وفي ذلك، يقول محمد مولود بن أحمد فال: “وللمعلم ضربه (أي الطفل) ضربا معتادا يقع به الأدب ولا يضرب وجها ولا رأسا فإن ظن عدم نفعه فهو شفاء غيظه وهو حرام إجماعا”. وقد سلك الشناقطة في ذلك مسلك علماء سابقين. فقد سئل القابسي: هل يستحب للمعلم التشديد على الصبيان، أو أن يرفق بهم ولا يكون عبوسا؟ فأجاب: إذا أحسن المعلم وضع الأمور في موضعها… فالنظر في زجر الصبيان لا يخرجه من حسن رفقه بهم ولا من رحمته إياهم. إنما هو لهم عوض عن آبائهم، فكونه عبوسا أبدا من الفظاظة الممقوته وسيأنس الصبيان بها فيجترئون عليه ، ولكنه إذا استعملها عند استئهالهم الأدب صارت دلالة على وقوع الألم فلم يأنسوا بها”. ويقول ابن خلدون في المقدمة: إن إرهاف الحد بالتعليم مضر بالمتعلم ولاسيما في أصاغر الولد… ومن كان مرباه بالعسف والقهر سطا به القهر وضيق على النفس في انبساطها، وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمله على الكذب والخبث خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه وعلمه المكر والخديعة، لذلك صارت له عادة وخلقا ، فينبغي للمعلم في متعلمه والوالد في ولده ألا يستبدا عليهما في التأديب. [55]
- في وسائط التعلم:
لا بد في هذا الشأن من وقفة خاصة عند مبدأين أثيرين جامعين من مبادئ التعلم والتعليم في المحضرة، هما مبدأ التلقي من أفواه الرجال، ومبدأ الترابط بين الحفظ والفهم.
- التلقي من أفواه الرجال:
أولى الشناقطة عناية خاصة للكتاب والكتابة، وجاء في أدبهم التربوي المتواتر: “من أراد أن ينظر إلى فم كذاب فلينظر إلى معلم بغير كتاب”، كما نصحوا طلبة العلم باتخاذ الكنانيش ليدونوا فيها أحسن ما يسمعون:
لا بد للزاوي من كناش يحوي به العلوم وهو ماش
ومن المؤلفين في شأن التربية من أورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول : “يا هلال بن يسار لا تفارق المحبرة فإن الخير فيها وفي أهلها إلى يوم القيامة”. ويقول أحد الشعراء:
إذا كنت طالب علم فلا تكونن يوما بلا محبره
فلا بد أن تلتقي بعض ما تود لنفسك أن تسطره
وقال آخر:
تمسك بالكتاب ولا تعره فإن إعارة المحبوب عار
ومحبوبي من الدنيا كتاب وهل أبصرت محبوبا يعار[56]
وهم يروون في هذا الشأن بيتين ينسبان للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه:
العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الموثقه
فمن الحماقة أن تصيد حمامة وتردها وسط الأوانس مطلقه
لكنهم من وراء ذلك كله كانوا يعتبرون الكتاب والكتابة أدوات مساعدة، لا يعتمد عليها وحدها، بل إن الأساس في تداول المعرفة هو التلقي من أفواه الرجال. وفي ذلك يروون أبيات أبي حيان:
يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم
وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم
إذارمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم
وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم.
ويقول غيره:
أمدعيا علما وليس بقارئ كتابا على شيخ به يسهل الحزن
أتزعم أن الذهن يوضح مشكلا بلا موضح، كلا لقد كذب الذهن
وإن الذي يبغيه دون معلم كموقد مصباح وليس له دهن
ومن المقولات التي يروونها في ذلك: من لا شيخ له فالشيطان شيخه.
ومما يروى في ذلك لأبي عبد الله الشمني المغربي:
من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتصحيف في حرم
ومن يكن آخذا للعلم عن صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم[57]
- الترابط العضوي بين الحفظ والفهم:
يشاع عن المحضرة وعن غيرها من مؤسسات التعليم الأصيل أنها لا تهتم إلا بالتلقين وحشو الأذهان بالمعلومات. وتذهب الاتهامات في هذا الصدد إلى حد افتراض تعارض بين ملكة الحفظ وملكة الفهم والتحليل. وهو أمر مردود من وجهين:
الوجه الأول أن المحضرة تولي عناية خاصة للفهم وما يفضي إليه من قدرة على تحليل المعارف وتفكيكها وإعادة تركيبها وترتيبها. ويتجلى ذلك جليا في مصنفات الشناقطة الكثيرة. كما أن كثيرا من النصوص والمقولات المتداولة في الوسط المحضري تؤكد تأكيدا كبيرا أهمية الفهم والنظر. ومبدأ ذلك كله من القرآن الكريم الذي يضرب مثلا لمن يعلم ولا يعمل بما يعلم {كمثل الحمار يحمل أسفارا}. ويروى عن النبي r قوله: “كونوا دراة ولا تكونوا رواة”، وفي الأثر أيضا “فهم سطرين خير من حفظ وقرين”[58]. فللتعليم المحضري مقصد أساسي في الفهم وما يترتب عليه من إنماء ملكة النظر والاستنباط والتحليل والتعليل. ويشكل هذا الهدف مقصدا وسيطا بين استظهار المعلومات والعمل بصالحها.
الوجه الثاني: هو أن التعليم المحضري يولي أيضا عناية كبيرة، بدون شك، لحفظ النصوص لكنه ينظر إلى هذه الغاية باعتبارها وسيلة لغاية أسمى هي تمثل المعارف وهضمها وتقليب النظر فيها. ولهذا أثر عن كثير من العلماء أنهم حفظوا النصوص ولم يقتصروا على ذلك، بل واصلوا دراستها مرة تلو المرة في سعي دؤوب لفهمها واستيعابها. وإنما رأوا أن حفظ النص معين على الفهم وأن نسيانه مدرجة لنسيان معانيه. وهم يؤمنون بالتدرج في عمليات التعليم والتعلم، ويعتبرون الفهم ومتعلقاته درجة أساسية في ذلك السلم. وفي ذلك يقول سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم نقلا عن سيدي أحمد زروق: “فطالب العلم في بدايته شرطه الاستماع والقبول ثم التصور والتفهم ثم التعليل ثم العمل والنشر ومتى قدم رتبة عن محلها عدم الوصول لحقيقة العلم من وجهها”[59].
ومما يشهد لأهمية حفظ النص في القدرة على استظهار معانية واستيعابها ما يرويه ابن سينا في قصة كبده الطويل من أجل فهم كتاب الطبيعة، حيث يقول: “قرأت كتاب ما بعد الطبيعة فما كنت أفهم ما فيه، والتبس علي غرض واضعه، حتى أعدت قراءته أربعين مرة وصار لي محفوظا. وأنا مع ذلك لا أفهمه، ولا المقصود به. وأيست من نفسي وقلت: هذا كتاب لا سبيل إلى فهمه. وإذا أنا في يوم من الأيام حضرت وقت العصر في الوراقين، وبيد دلال مجلد ينادي عليه فعرضه علي فرددته رد متبرم، معتقدا أن لا فائدة من هذا العلم، فقال لي اشتر مني هذا فإنه رخيص أبيعكه بثلاثة دراهم، وصاحبه محتاج إلى ثمنه، واشتريته فإذا هو كتاب لأبي نصر الفارابي في أغراض كتاب ما بعد الطبيعة. ورجعت إلى بيتي، وأسرعت قراءته، فانفتح علي في الوقت أغراض ذلك الكتاب بسبب أنه كان لي محفوظا على ظهر القلب. وفرحت بذلك وتصدقت في ثاني يومه بشيء كثير على الفقراء شكرا لله تعالى”[60]. وقد أظهرت التجربة المعاصر ما لتنمية ملكة الحفظ في النظام المحضري من أثر حميد على ملكات التحليل والفهم والاستيعاب. ومن أبرز الشواهد على ذلك تفوق كثير من طلبة المحاضر في الامتحانات وفي الدراسات الجامعية على نظرائهم ممن اقتصروا على الدراسة النظامية. وقد خاضت فرنسا تجربة من هذا القبيل حين قررت منذ نحو عقدين من الزمن تخصيص منح للطلبة الأوائل في الثانوية العامة العربية بموريتانيا، فاكتشفت أن هؤلاء الطلبة كثيرا ما يكونون من خريجي التعليم المحضري، وأنهم – بعد سنة تمهيدية من دراسة اللغة الفرنسية – يندمجون بيسر في التعليم النظامي الجامعي الفرنسي ويتفوقون فيه على نظرائهم، ويبدون قدرة متميزة على الفهم والاستيعاب والتحليل.
وقد أكدت الدراسات الحديثة الأهمية الحيوية للحفظ في التعلم، ففي دليل منهجي صادر عن جامعة لافال حول القراءة النشطة والحفظ، جاء أن البحث العلمي يؤكد أننا ننسى عادة 98 % من الأفكار التي خزناها في الذاكرة بمجرد مرور أربعة أسابيع بل إن نصف هذه الأفكار يتبخر عادة مباشرة بعد الانتهاء من قراءة النص. ويشير الدليل إلى أن الذاكرة هي ملكة قابلة للإنماء وأن الحفظ والتكرار هما من أبرز وسائل تنميتها، وأن تنظيم المعلومات وترابطها معين أيضا على حفظها، وهذا ما يذهب إليه المربون القدامى في تحويلهم المعارف إلى منظومات تسهيلا لحفظها. ويذهب الدليل إلى أن الحفظ والتكرار هو وحده الوسيلة الناجعة لاستبقاء المعلومات[61].
وفي بحث نشرته المجموعة الفرنسية في بلجيكا حول الحفظ نجد بيانا بالغ الأهمية حول دور المحفوظات السابقة في تيسير عمليات التعلم اللاحقة، فـ”المعلومات السابقة التي نستطيع استعادتها بسهولة [تذكرها] تشكل أرضية تنغرس عليها المعلومات اللاحقة وتسهل حفظها، وعليه، فإن من واجبنا إذا لم تكن تلك الأرضية متوفرة أن نبادر بتوفيرها، وقد يكلفنا ذلك [إن تأخر عن مرحلة الصبا] مجهودا أكبر”. بل إن البحث يمضي إلى حد تشبيه العلم بالثروة، فإذا كانت الثروة تنطاع غالبا للأثرياء فإن العلم أيضا ينطاع عادة للعلماء، أي للذين امتلكوا بالفعل تلك الأرضية التي يمكن أن تغرس عليها معلومات جديدة. وهكذا فإن “تحفيظ التلاميذ مخزونا من المعلومات هو أمر ذو أهمية لما يتعلمونه لاحقا”. ويقدم البحث نتيجة استطلاع آراء مجموغة من الطلبة البلجيكيين حول الحفظ، ويظهر من النتيجة أن 91% من المتسجوبين يرون أنه ينبغي بذل الجهد اللازم في التمارين المعينة على تنمية الذاكرة، ويرى 78% أن الحفظ يتطلب تكرار القراءة. وحول فائدة الحفظ يجيب 61% بأهميته للنجاح في الدراسة، ويرى 38% أهميته للحياة اليومية وللمستقبل. [62]
المبحث الثالث: في الممارسات المحضرية
للفكر قيمته، لكن ما يتنزل منه على الأرض يكتسي قيمة إجرائية مضافة، بما يشي به من القابلية للتطبيق، وبما يتيحه من فرص المقارنة بين المثال المتصور في الذهن والنموذج المتحقق على الأرض. وقد كان للمحضرة الشنقيطية فكرها التربوي الماتح من معين الفكر التربوي العربي الإسلامي العتيق، وكانت لها إزاء ذلك ممارسات تقترب أو تبتعد حسب الظروف من ذلك الفكر، ونريد في هذا المبحث أن نتفحص تلك الممارسات، في مواطنها التنفيذية الراتبة بدءا بالمنهاج بشتى مكوناته والمناشط اللصيقة به، وانتهاء بالبيئة التربوية المحضرية.
أولا – منهاج المحضرة
نتناول تحت هذا العنوان الدرس المحضري وطرق التدريس ووسائله والتقويم وإدارة الوقت،
- الدرس المحضرى (المحتوى التعليمي)
ينبغي أن نذكر بدءا بأن التعليم الأصيل في بلاد شنقيط قابل للتصنيف في مستويات متداخلة، ينتظمها مستويان رئيسان، أولهما التعليم القرآني، وثانيهما التعليم المحضري المستوعب في تدرج للمعارف الأساسية المتداولة في تاريخ الحضارة الإسلامية، وما تمس إليه الحاجة منها بشكل أخص في البيئة الصحراوية الشنقيطية.
- التعليم القرآني
يعتبر التعليم القرآني تعليما ممهدا للدخول إلى المحضرة، وإن جرى العرف في بعض مناطق موريتانيا على اعتبار الكُتّاب محضرة، لكنها تبقي محضرة تحضيرية متمحضة لتعليم القرآن في العرف السائد.
وقبل الشروع في دراسة القرآن، يمر الطفل بمرحلتين تمهيديتين قد تتداخلان: المرحلة الأولى هي مرحلة تعليم منزلي، يجري فيه تلقين الطفل شفهيا معلومات أولية أساسية منها أسماء والدي النبي r وأبنائه وبناته الطاهرين واسم أميهم خديجة بنت خويلد ومارية القبطية رضوان الله عليهما وأسماء العشرة المبشرين بالجنة. وقد يحفظ الطفل في هذه المرحلة بعض أسماء الله الحسنى، كما قد يحفظ عمود النسب الشريف إلى عدنان. وفي المرحلة التمهيدية ذاتها، يتعلم الطفل الأعداد إلى العشرة، وقد يتجاوزها، ويحفظ بعض التعاويذ القصيرة التي تحصنه بها أمه عادة في المساء.
أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التهجي، والغالب أن تتولاها النساء دون الرجال، ربما باعتبارها ضربا من ضروب الرضاعة. ولعل المجتمع التقليدي آنس في المرأة قدرة تربوية أكبر، خصوصا في المراحل العمرية المبكرة، وهذا ما انتبهت إليه بعض الدول في العصر الحديث، حيث أصبح التعليم ما قبل المدرسي والتعليم الابتدائي مهنة نسائية بالأساس.
وقد جرى العرف بأن ينفرد التعليم القرآني في البداية، بحيث لا يزاحمه غيره، إلى أن يفرغ منه الطفل. لكن هذا القانون التربوي الاجتماعي اختل في الحقب الأخيرة، مع انتشار التعليم المدرسي النظامي، حيث أصبحت نسب متزايدة من السكان ترسل أبناءها إلى المحضرة القرآنية أولا، على سبيل التفرغ، ثم تلحقهم بالمدرسة النظامية إذا بلغوا سنها، ويواصلون حينئذ تعلمهم في المدرستين، بشكل متواز.
وفي مستوى التعليم القرآني يبدأ الأطفال عادة بدراسة القرآن وحفظه على رواية ورش عن قارئ المدينة نافع بن عبد الرحمن. ويقتصرون على حفظ النص القرآني. وتختلف الحصص الدراسية من طفل إلى طفل، ومن طور من أطوار الدراسة إلى طور، متراوحة ما بين الكلمة والكلمات القليلة إلى الأسطر المعدودة، إلى ثلث الثمن، إلى نصفه إلى ثمن كامل إلى أربعة أثمان. ويشكل الثمن الوحدة الأساسية في تقسيم المصحف عند الشناقطة، ومن ثمانية أمثاله يتكون الحزب، وهو أيضا وحدة أساسية مرجعية، وإليها يحيلون أكثر مما يحيلون إلى السور. وباختلاف الحصص الدراسية تبعا لاختلاف القدرات والاستعدادات الذهنية للأطفال تختلف سن الحفظ، من السبع إلى العشر، أو إلى ما فوقها بقليل، بحيث يندر أن يبلغ الفتى الحادية عشرة من العمر، في الأوساط المحضرية، إلا وقد حفظ القرآن عن ظهر قلب.
وفي مرحلة أخرى متقدمة من التعليم المحضري، يتوجه من شاء من الحفظة إلى دراسة بعض علوم القرآن خاصة ما يتصل بتجويده ورسمه وضبطه. ويتوجه بعضهم إلى إتقان رواية قالون عن نافع. وفي بعض الأوساط، يمر دارس القرآن بمرحلة السلكة، وهي العودة بعد حفظ القرآن لكتابته في اللوح حصة بعد حصة إلى حين استكماله، وتخصص هذه الدورة الجديدة من دراسة القرآن لإتقان حفظه مع رسمه وضبطه وتجويده.
وبعد إتقان حفظ القرآن يتجه الطفل عادة إلى دراسة المتون الأساسية التي درج المجتمع على اعتبارها مدخلا للتعليم المحضري.
- مضامين التعليم المحضري
يبدأ التعليم المحضري عادة بدراسة مجموعة من المتون الأساسية المبسطة، يتدرج الدارسون بعدها صعدا إلى متون أكبر ومستويات أكثر تقدما في الدراسة. وللإلمام بالبرنامج التعليمي المحضري، ينبغي أن نتطرق إلى معارف المحضرة عموما، وننظر من بعد في ترتيب هذه المعارف، وفي منزلة اللغة العربية بينها، ثم ننظر في ترابطها، ونلم أخيرا بما يتيحه الوسط المحضري من فرص للتسلية والرياضة.
- معارف المحضرة
تقدم القصيدة التالية للشيخ سيديا بن الشيخ أحمد بن سليمان لمحة عامة حول عدد من معارف المحضرة وشواغل أهلها:
| فمن لي بفتيان كرام أعزة يخوضون في كل العلوم بفهمهم فمن كاتب “قف” طويل وكاتب ومن كاتب بانت سعاد وكاتب ومن كاتب قف بالديار وقارئ ومن منشد يشدو بأحسن صوته ومن معرب يرمى فيعرب كلمة فمن قائل هي اسم كان أو اسم لا ومن قائل هي اسم فعل وقائل ومن كاتب علم البيان وشارح ومن كاتب علم البديع ومظهر ومن كاتب عكس النقيض مكرر ومن كاتب علم الحساب بخطه ومن حامل عيشا كثيرا لقومه | يكونون أصحابي وأصحبهم دهرا فهذا بذا أدرى وذاك بذا أدرى علوم أصول الفقه يجعلها ذخرا خليلي مرا أو قفا نبك من ذكرى أمن أم أوفى أو سما لك إذ يقرا خليلي غضا أو إذا مضر الحمرا من البيت إذ يرمى ويسقط في الأخرى ومن قائل تلك اختصاص وذا إغرا لقد حاز هذا بالمجاورة الجرا لكاتبه الإنشاء والحد والقصرا لكاتبه التدبيج واللف والنشرا لكيفية الكبرى وكمية الصغرى إذا خطه قالوا له زد هنا صفرا ومن حامل لحما ومن حامل تمرا |
وفي القصيدة كما هو جلي إشارة إلى الفقه وأصوله ودواوين الشعر العربي والنحو وعلوم البلاغة والمنطق والحساب.
وفي قصيدة أخرى للشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيديا، نلتقط الصورة الآتية:
| وكم سامرت سمارا فتوا حووا أدبا على حسب فداسوا إذا كر جمعهم ويذاكروني كخلف الليث والنعمار طورا وأوراد الجنيد وفرقتيه وأقوال الخليل وسيبويه نوضح حيث تلتبس المعاني وأطوارا نميل لذكر دارا ونحو الستة الشعراء ننحو وشعر الأعميين إذا أردنا ونذهب تارة لأبي نواس | إلى المجد انتموا من محتدين أديم الفرقدين باخمصين بكل تخالف في مذهبين وخلف الأشعري من الجويني إذا وردوا شراب المشربين وأهلي كوفة والأخفشين دقيق الفرق بين المعنيين وكسرى الفارسي وذي رعين ونحو مهلهل ومرقشين وإن شئنا فشعر الأعشيين ونذهب تارة لابن الحسين(87) |
ولئن اتفقت هذه الصورة مع سابقتها في أمور، فإنها تفيض عنها بإضافة معارف أخرى، منها الفقه المقارن، والعقائد، والتصوف، والتاريخ.
وفي نص شعري ثالث، نجد ابده الصغير (محمد بن سيدي أحمد بن محمود) يلتقط لنا صورة مشابهة.
| ومــورد أقـــلام لحبـر دواتـــه يحلى بهـا بيض الطـروس جواهـــرا فما أنكرت «حتى» المعاني عنهم ولا «أي» ولا «لكن» لا أخواتها يميلون نحو النحو يفشون سره يخوضون في مهما: أمهما بسيطة وذا منشد «بأن الخليط» ومنشد وذاك التي منها «يهيجني» وذا يخوضون في الأعشى وغيلان مية وطورا إلى من صاغ «زارت على» أو وآونة في الشيخ سيدي وابنه وآونة في ابن الحسين وفي أبي | فآونـة تروي وآونـــة تظمــا فلا مهرق إلا بها يشتهي الرقما ولا «أو» ولا «أما» ولا «أم» ولا «ثما» ولا «أن» ولا «كلا» ولا «لم» ولا «لما» فلا حفظ عنهم يطيبك ولا فهما يخوضون في لولا وفي أم وفي أما «أمن أم أو في» أو «صحا القلب عن سلمى» «طحا» والتي منها «غدا طفت ع الما» يخوضون في حسان وابن أبي سلمى لواشي التي منها «سرى يخبط الظلما» وفي سيد عبد الله طورا وفي «حرما» علي وفي الشامي أو في أبي تما(88) |
وفي هذا النص إضافتان أساسيتان إحداهما وظيفة المحضرة من حيث هي دار وراقة ينسخ فيها الخطاطون الكتب، والأخرى مكانة النصوص الشنقيطية ذاتها في المنهاج المحضري، وهو الموضوع الذي خصص له الشاعر البيتين قبل الأخير.
وهذه قائمة إجمالية بأبرز المعارف والمتون التي تدرس في المحضرة، يتواتر تدريس بعضها في المحاضر، وينفرد بعض المحاضر ببعضها عن بعض:
في علوم القرآن الكريم:
- نظم ابن بري (الدرر اللوامع على مقرأ الإمام نافع)؛
- الشاطبية في القراءات السبع لأبي القاسم الشاطبي؛
- نظم الشوشاوي في القراءات؛
- رسم الطالب عبد الله (الإيضاح الساطع على المحتوى الجامع) في الرسم والضبط؛
- مورد الظمآن في الرسم والضبط للشريشي؛
- رسم عبد الودود بن حميه؛
- حذف المرابط عبد الفتاح؛
- حذف الشيخ الحضرمي بن عبيدي؛
- منظومة المترادف لمحمد مولود بن أحمد فال الشنقيطي.
في الحديث ومصطلحه:
- ألفية زين الدين العراقي؛
- منظومة البيقوني؛
- طلعة الأنوار لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم؛
- غرة الصباح له؛
وقد جرت العادة في بعض الأوساط بعقد مجالس لقراءة موطأ الإمام مالك وصحيح البخاري.
في العقيدة:
- مقدمة المرشد المعين لابن عاشر،
- عقيدة نظم الكفاف
- عقيدة أسهل المسالك
- عقيدة ابن أبي زيد القيرواني،
- الواضح المبين لعبد القادر بن محمد سالم
- منظومة البليمي وهو نظم للعقائد التي يجب الإيمان بها
- إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للمقري،
- العقائد السنوسية،
- وسيلة السعادة للمختار بن بونة الجكني،
في الفقه:
في الأصول:
- مراقي السعود لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم؛
- جمع الجوامع للسبكي؛
- الورقات لإمام الحرمين.
في القواعد:
- المنهج للزقاق.
في الفروع:
- مختصر الأخضري،
- نظم ابن عاشر،
- منظومة العبقري في السجود لسهو الصلاة،
- أسهل المسالك، وهو نظم في المذهب المالكي للشيخ محمد البشار المصري الأزهري.
- رسالة ابن أبي زيد،
- نظام الكفاف لمحمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي،
- مختصر خليل بن إسحاق،
- تحفة الحكام لابن عاصم.
في السيرة والأنساب:
- قرة الأبصار لعبد العزيز اللمطي،
- الغزوات لأحمد البدوي المجلسي الشنقيطي،
- عمود النسب العربي له.
- نظم غالي بن المختار فال البصادي لأمهات المؤمنين
- نظم لأمهات أزواج النبي r للمؤرخ أحمد محمود بن يداده
- نظم حوادث السنين لمحمد فال بن العاقل
- نظم أهل بدر لأحمد بن دهاه
- شرح وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأم معبد لنفس المؤلف
- صفة النبي r لعبد الله السالم بن حنبل
- مؤلفات في الشمائل النبوية.
في اللغة العربية:
- المعلقات العشر،
- ديوان الشعراء الستة الجاهليين،
- ديوان غيلان،
- لامية العرب للشنفرى،
- قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير،
- شعر حسان بن ثابت،
- قصائد العلامة الشيخ محمد بن حنبل الشنقيطي،
- مقصورة ابن دريد،
- مثلث قطرب،
- مثلث ابن مالك،
- ديوان المتنبي،
- ديوان الحماسة لأبي تمام،
- ديوان المعري،
- الشمقمقية،
- المقصور والممدود لابن مالك،
- مقامات الحريري.
في النحو والصرف:
- مختصر ابن آجروم،
- منظومة عبيد ربه (محمد بن آب الغلاوي)،
- عون الطالبين وهو نظم للعلامة أحمد محمود الحاجي،
- منظومة العمريطي وهي للعلامة الأزهري المصري،
- ملحة الإعراب للحريري،
- ألفية محمد بن مالك الأندلسي،
- ألفية جلال الدين السيوطي،
- احمرار ابن بونة على ألفية ابن مالك،
- لامية الأفعال لابن مالك،
- اخضرار الخضرمي واحمرار الحسن بن زين على اللامية.
في العروض والقوافي:
- الخزرجية،
- نظم ابن عبدم الشنقيطي،
- نظم يحيى بن أحمد فال.
في علوم البلاغة:
- ألفية السيوطي (عقود الجمان)،
- الجوهر المكنون للأخضري،
- نور الأقاح لابن الحاج إبراهيم الشنقيطي.
في المنطق:
- مختصر السنوسي،
- منظومة السلم المرونق للأخضري،
- احمرار السلم لعبد السلام العلوي الشنقيطي،
- قواعد المنطق للمغيلي،
- جواهر ابن الطيب
- مقدمة ابن مشاش في المنطق
- منطق إضاءة الدجنة.
في الحساب:
- أراجيز للرسموكي،
- أرجوزة للسملالي،
- أرجوزة للأخضري.
في الفلك والجغرافيا:
- المقنع لأبي عبد الله محمد بن سعيد السوسي،
- نظم ليحيى بن أحمد فال،
- قصائد شعبية.
في الطب وخصائص الأشياء:
- منظومة العمدة لأوفى بن الفغ منصر.
في التصوف والتربية الإيمانية:
- مقدمة الأخضري،
- خاتمة ابن عاشر،
- خاتمة التصوف لمحمد اليدالي،
- مطهرة القلوب لمحمد مولود بن أحمد فال.
- نظم مكفرات الذنوب للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم
- تصوف المقصور والممدود لابن مالك.
في الأخلاق والآداب العامة:
- نظم محارم اللسان
- نظم آداب المسجد
- نظم مأدبة الأكل
- نظم البرور
- آداب التلاوة وهذه المتون كلها لمحمد مولود بن أحمد فال
- نصيحة البشير بن امباريكي في الأخلاق والآداب العامة
- نصيحة محمد اليدالي
- نظم المنكرات الشائعة في المجتمع للشيخ أحمد بن أحمذيه
- نظم محمد مولود بن أغشممت حول آداب الصلاة
- آداب المرأة المسلمة للشيخ محمد حامد بن آلا.
في أسرار القرآن والحروف والأعداد ونحوها[63]:
- خصائص أسماء الله الحسنى لسيدي محمد الكنتي،
- رشد الغافل لابن الحاج إبراهيم، وفيه يحذر من تعاطي كثير من هذه العلوم مبينا الصلة بين (علوم السر) بإهمال السين و(علوم الشر) بإعجامها.
- ترتيب المعارف المحضرية
مثل ترتيب أولويات التعلم إحدى الشواغل الأساسية في الفكر التربوي العربي الإسلامي وخاصة في المغرب الإسلامي. وقد عالج ابن العربي هذه القضية، في نطاق السجال الثقافي بين أهل الأندلس وأهل المغرب، آخذا على المغاربة طريقتهم، فقال: “وحدثت قاصمة أخرى في تعلم العلم، فصار الصبي عندهم إذا عقل، فإن سلكوا به أمثل طريقة له، علموه كتاب الله فإذا حذقه نقلوه إلى الأدب، فإذا نهض فيه حفظوه الموطأ، فإذا لقنه نقلوه إلى المدونة، ثم ينقلونه إلى وثائق ابن العطار، ثم يختمون له بأحكام ابن سهل”. والعاصم من هذه القاصمة عنده أنه على الولي إذا عقل الصبي “أن يلقنه الإيمان ويعلمه الكتابة والحساب ويحفظه أشعار العرب العاربة، ويعرفه العوامل في الإعراب وشيئا من التصريف، ثم يحفظه إذا استقل واشتد في العشر الثاني كتاب الله (…) ثم يحفظه أصول سنن رسول الله r، وهي نحو من ألفي حديث في الصحيحين (…) ويأخذ هو بعد ذلك نفسه بعلوم القرآن ومعاني كلماته” ويوصي ابن العربي بتعلم الفرائض والأنساب وأصول الطب[64]. ويمضي ابن العربي في استغراب التبكير بتعليم القرآن الكريم إلى حد القول: “يا غفلة أهل بلادنا أن يؤخذ الصبي بكتاب الله يقرأ ما لا يفهم وينصب في أمر غيره أهم”[65].
ولئن لم يلق منهج ابن العربي هذا قبولا، فيما يتعلق بتأخير تعلم القرآن، فإن الشناقطة أخذوا – أو شطر كبير منهم- بما أوصى به من ضرورة التبكير بتعليم أشعار العرب.
وتختلف المحاضر الشنقيطية، بعض الاختلاف، في ترتيبها للأولويات، مع اتفاقها جميعا على أن لا يزاحم القرآن بدراسة أي متن إلى أن يفرغ الطفل من حفظه.
وإلى أولوية علم القرآن وما يتصل به من علوم الشرع يشير الشيخ سيدي المختار الكنتي في دعوته لتعليم الصغار قبل الكبر:
| وعلم بنيك للكتاب بداية | * | وثنّ بعلم الدين يعقب في الأثر |
| وأدبهم بالعلم قبل بلوغهم | * | وعلمهم حسن الشمائل بالجبر |
| ولا تمهلنهم بالشؤون سبهللا | * | ورضهم بفعل الخير قبل صدى الكبر |
| فان أنت قومت الغصون تقومت | * | وان رمت تقويم الجذوع فبالكسر |
| وان تركوا يعدون في سن الردى | * | تراهم لدى الادراك كالحمر الجفر |
وقد جرت العادة بأن يبدأ الأطفال بدراسة متون قصيرة ميسرة، من أبرزها: مختصر ابن آجروم أو منظومة عبيد ربه في النحو، مختصر الأخضري ونظم ابن عاشر في الفقه، وقرة الأبصار لعبد العزيز اللمطي في السيرة النبوية، ومعلقات الشعراء الجاهليين. وباستطاعة من مر بهذه المتون أن ينتقل إلى دراسة متون أكبر مثل الرسالة لابن أبي زيد، ونظم الكفاف لمحمد مولود بن أحمد فال ومختصر خليل وثلاثتها في الفقه المالكي؛ وملحة الإعراب للحريري وألفية ابن مالك ولا مية الأفعال له، وثلاثتها في النحو والصرف؛ ودواوين الست الجاهليين ومقصورة ابن دريد وديوان ذي الرمة ونحوها في الشعر واللغة، كما يتضمن منهاج السيرة النبوية متونا أخرى مثل نظم المغازي للبدوي الشنقيطي ونظم السرايا والبعوث لغالي بن المختار فال، ويلحقون به عمود النسب للبدوي أيضا. وفي مرحلة أكثر تقدما، يدرس طلبة المحاضر منظومة الوسيلة في العقيدة وعلم الكلام لابن بونه، وقد يمهدون لها بدراسة إضاءة الدجنة للمقري، كما يدرسون منظومة مراقي السعود لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في أصول الفقه، والمنهج للزقاق في قواعده، ولاميته ومنظومة ابن عاصم في القضاء، واحمرار الألفية لابن بونه ولامية الأفعال باحمرارها واخضرارها للحضرمي والحسن بن زين. ويأتي بعد ذلك دور المتمات، وهي متون في المنطق والبلاغة وعلم الكلام ومزيد من دواوين الشعر ومنظومات في الفلك وربما درسوا متونا في الحساب والجغرافيا والطب. ويعتبر التدرج من المتن القصير أو البسيط إلى المتن المعقد الطويل شرطا عندهم في الاستفادة. وفي ذلك يقول أحدهم منتقدا تجاوز بعض المتون القصيرة إلى المتون الكبيرة:
علامة الجهل بهذا الجيل ترك الرسالة إلى خليل
وترك الاخضري إلى ابن عاشر وترك ذين للرسالة احذر
ومن المهم الإشارة إلى أنه ليس هناك منهاج دقيق منضبط يلتزم به الطلبة، إذا استثنينا مبدأ التدرج، فللطالب حرية الاختيار بين المتون والنصوص وله هامش واسع من الحرية أيضا في ترتيبها. كما أن تقاليد المحاضر في هذا الشأن تختلف، فهناك محاضر موسوعية تتيح للطالب فرصة أوسع للتنقل بين المتون والمعارف وترتيب أولوياته. وهناك محاضر تميل إلى التخصص أو تتميز بالتركيز على دراسات معينة، فيتجه إليها الطلبة الراغبون في التبحر أو التعمق في هذا العلم أو ذاك. فقد كانت محاضر آل محمد سالم المجلسي في غرب البلاد قبلة لمرتادي علوم الفقه، وكانت محاضر المناطق الشرقية من البلاد قبلة للمتطلعين إلى التضلع من علوم القرآن، وكانت محاضر “القبلة” (أي جنوب البلاد) مهتمة أكثر باللغة والشعر.
- منزلة اللغة العربية بين المعارف المحضرية
تحتل اللغة العربية مكانة خاصة في التعليم المحضري. وتتجلى هذه المكانة في مستوى الاهتمام بدراسة دواوين الشعر العربي وعلم النحو والصرف، بل إن متون الفقه تخدم اللغة، بما تتضمنه المنظومات خاصة من التراكيب والمفردات المفيدة. ويشكل مختصر خليل بكثافة عبارته ومتانة سبكه ودقة اختزاله نموذجا راقيا في التعبير اللغوي، يساهم في تعزيز الملكة اللغوية عند الدارسين.
كما تتعزز هذه الملكة بما يصحب الدرس المحضري من حفظ للشواهد اللغوية، ومن تنافس في رواية الشعر واستحضاره، خاصة خلال الأسمار الليلية.
ويصل الأمر عندهم في ذلك إلى حد الفتوى الشرعية، فتعلم اللغة أفضل من التفرغ للعبادة، كما يقول العلامة محمذ فال بن متالي:
تعلم اللغة شرعا فضلِ على التخلي لعبادة العلي
يؤخذ ذا من قوله وعلما آدم الاسماء، الزم التعلما
وعليه فإنه لا يحق للفقيه أن يفتي ولو في شئون الشرع إذا كان جاهلا بالنحو، كما يقول النابغة الغلاوي:
وبعضهم يفتي وهو جاهل إعراب باسم الله عنه ذاهل
فليس من أهل اللسان العربي وفي الأصول ما له من أرب
فمثل هذا لا يكون مرشدا لجهله النحو ومما أنشدا:
عليك بالنحو فإن النحوا لحن الخطاب ملكه والفحوى[66]
بل إنه ليس لفقيه بالغا ما بلغ أن يدعي أنه إنسان إذا كان يلحن في كلامه:
اللحن أنتن من لحم على وضم أتت عليه ليال من جديدان
لو كنت في الفقه كالنعمان أو زفر أو ابن إدريس أيضا وابن شعبان
وفاتك النحو لم تحسب إذا ذكرت أفاضل الناس إلا نصف إنسان[67]
ويستغرب ابن أحمد يوره أن يضحك جاهل بالنحو والشعر أو يضاحك أترابه:
عجبت من ضحك من لم يعربن به ولم يكن عنده للضحك غير هه
لا هو يستطرد الأشعار في ملأ وليس للوح والآداب ذاو له
بل هو يضرب جدا كف صاحبه ويرفع الرجل عند الضحك من سفه
فهذه عبرة تبدو لمعتبر يا نفس فانزجري لذاك وانتبهي[68]
والأمر أدهى من ذلك وأمر عند الشيخ محمد بن حنبل فليس لمن لا يتقن الإعراب أن يتزوج الحسان، بل إنه والغراب عنده سواء:
كل فتى شب بلا إعراب فهو عندي مثل الغراب
وإن رأيته لخود عاشقا فقل لها اتقي الغراب الناعقا
عار على حسناء ذات منصب ترى ببيت فيه غير معرب
لا انتفعت بالأكل والشراب من آثرت مالا على إعراب
حلي الفتى إعرابه لا ماله ولا نجاره ولا جماله
وإن رأيت ذات دل تستبي تنازع الحديث غير المعرب
فقل رايت العجب العجابا هذا غزال غازل الغرابا
ما للغراب وشذى الحسان شأن الغراب جيف الغربان
ولعل مما يشهد لمذهب القوم في العناية باللغة العربية قول الفراء: قل رجل أنعم النظر في العربية ثم أراد علما غيره إلا سهل عليه.
- ترابط المعارف في المحضرة
في الثقافة المحضرية، هناك وعي مستحكم بالترابط بين المعارف، يرفده اهتمام واسع بـ”الأخذ من كل فن [أي علم] بطرف”، بحيث تترابط المعارف في الذات الإنسانية الواحدة، فيحصل لها بذلك قسط من الكمال، لا يتأتى بعلم بعض المواد وجهل غيرها، وهذا ما عبر عنه ابن العربي بقوله ناصحا لطالب العلم: “ولا يفرد نفسه ببعض العلوم فيكون إنسانا في الذي يعلم بهيمة فيما لا يعلم (…) فالإحاطة غير ممكنة، والمشاركة ممكنة، والإحاطة بعلم واحد غير ممكنة”[69]. لقد آمن الشناقطة بشيء من ذلك ، وأجروا مجرى المثل قول الشاعر:
من كل علم تعلم تبلغ الأملا ولا يكن لك فن واحد شغلا
فالنحل لما رعت من كل نابتة أبدت لنا الجوهرين الشمع والعسلا.
لكن لإيمان الشناقطة بالترابط بين المعارف وجها أجلى وأبلغ دلالة يتمثل فيما يتداولونه من أن بإمكان من أتقن فنا من الفنون (أي علما من العلوم) أن يستخرج منه سائر الفنون. وفي ذلك يقول الشيخ محمدن بن محمد النابغة التندغي “إن العلوم كلها متقاربة مرتبطة بعضها ببعض”. ومن أوجه ذلك الترابط استثمار الأبجدية في تعلم الحساب (حساب الجمل)، والترابط بين الحساب وبين الدرس الفقهي، خاصة فيما يتعلق بالزكاة والمواريث، والترابط بين الفلك ومواقيت الصلاة. ومعلوم أن للنحو شواهد من القرآن والسنة وكلام العرب شعرا ونثرا، وللفقه شواهد من الشعر قد لا تخلو من لغة. وقد كان الشيخ الوالد يستحسن أن يتدرج المدرس فيقدم شواهد على درسه من القرآن ثم من السنة ثم من كلام العرب. وكان يحثنا على رواية الشعر، إذ كثيرا ما يسأل في معرض الحديث عن كلمة أو حكم لغوي: أتعرف لهذا شاهدا من كلام العرب؟
وقد ذكر أن رجلا انصرف عن دراسة الفقه واشتغل بدراسة النحو، فقيل له في ذلك، فزعم أنه يستطيع أن يستخرج الأحكام الفقهية من قواعد النحو، فاختبروه بأن استفتوه في شأن من سها في سجود السهو، أعليه أن يسجد لسهوه هذا أم لا؟ فأجاب: لا سجود عليه، قالوا: ومن أين جئت بهذا الحكم؟ قال: من قولهم (أي النحاة الصرفيين) إن المصغر لا يصغر مرتين. وصادفت فتواه ما به الفتوى عند الفقهاء.والحال أنه نظر إلى سجود السهو فاعتبره صلاة مصغرة. وبنى فتواه على هذا النظر العقلي، وفيه من الطرافة ما لا يخفى. وقد أعملوا العقول في استجلاء أوجه الترابط بين المعارف، خاصة في تدريس المتون الكبيرة ذات الشهرة والسيرورة، وفي مقدمتها ألفية ابن مالك في النحو ومختصر خليل ابن إسحاق، فقد كانا مسرحا خصيبا لاستحضار معارف أخرى متنوعة. ومن أمثلة ذلك في مختصر خليل[70]:
- تدريس أصول الفقه، ومثاله ما يذكرونه عند قول خليل: “وخمر تحجر أو خلل” من أن العلة في نجاسة الخمر وتحريمها الإسكار، وأن العلة تدور مع معلولها وجودا أو عدما. ومن ذلك كلامهم في أن أصل المني الدم، وإنما غيرته الشهوة. وإذا كان ذلك كذلك فهل يعفى عما دون الدرهم منه باعتبار الأصل، أو لا يعفى عنه، لأنه يوجد في الفرع ما لا يوجد في الأصل. ومن ذلك ما يذكرونه من تعاريف الرخصة وحدودها عند قول خليل: “رخص لرجل أو امرأة”. كما يتساءلون أيضا عند قول خليل “وأمر صبي بها لسبع” : هل الأمر متعلق بالصبي أو الولي أو متعلق بهما معا، ويشهد له حديث الخثعمية التي أخذت بضبعي ولدها إلى النبي r فقالت ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر.
- تدريس القواعد الفقهية، ومن ذلك قولهم هل المخلوط المغلوب تنتقل عينه إلى ما خالطه أو إنما خفي عن الحس، وهي قاعدة يذكرونها في أماكن متعددة من خليل في الطهارة عند الماء المتغير بغيره وفي الرضاعة إذا خلط لبن المرأة بغيره. ويذكرون عند قوله: “وعفي عما يعسر”: كل مأمور به شق فعله سقط الأمر به وكل منهي عنه شق تركه سقط النهي عنه والمشقة تجلب التيسير إلخ…
- تدريس الفقه المقارن، ومنه ما يذكرونه عند قول خليل: “وورود النجاسة على الماء كعكسه”، حيث يوردون اختلاف المذاهب وأدلة كل منها، خاصة مذهبي مالك والشافعي. كما يذكرون اختلاف المذاهب في سجود السهو.
- تدريس اللغة، ومن أمثلته: ما يوردونه في تفسير فاتحة المختصر عند قوله: “يقول الفقير المضطر”، فهم يذكرون أن أصل “يقول”يقوُل – بتصحيح الواو وضمها- كينصر فنقلت حركة اللين إلى الساكن قبلها وبقي اللين على حاله لمجانسته للحركة المنقولة عنه. وقد عبر المصنف بالمضارع لأن المحكي جميع أجزاء التأليف وهي لا تحصل إلا بأزمنة متطاولة. أما المضطر، فهي اسم فاعل من اضطر وأبدلت تاء الافتعال طاء لقول ابن مالك: طاء افتعال رد إثر مطبق…إلخ.
- تدريس المنطق، ومن أمثلته ما يذكرونه عند قوله “وبعد فقد سألني جماعة…” من أنه شرع في مقدمة الكتاب ومقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع في مسائله جمع مسألة وهي مطلب خبري يبرهن عليه في ذلك العلم كمعرفة حده وغايته وموضوعه والمعرفة تنقسم إلى قسمين تصور وتصديق… إلخ
أما ألفية ابن مالك، فإن درس النحو فيها كثيرا ما يكون أداة لتدريس نحو القلوب، فقد حفلت الألفية بأمثلة وعبارات وجد فيها المتأملون من الصوفية بغيتهم في استنباط حكم ومقولات خادمة للتربية الروحية. ومن ذلك قوله في التمثيل للمبتدأ والخبر: “الله بر والأيادي شاهدة”، وقوله في الحال:
الحال وصف فضلة منتصب مفهم “في حال” كفردا أذهب
وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا
فقد وجدوا في هذين البيتين عن الحال في اللغة تعريفا وافيا بالحال عند الصوفية. ويكاد لا يخلو بيت من أبيات الألفية عندهم من إشارات لطيفة إلى معاني دقيقة في مجال التربية الروحية.
وأيا يكن الأمر فإن المنهج التربوي المحضري يوفر من الربط بين المعارف ما لا توفره التربية النظامية المهيمنة التي تعلم الفصل والتشتيت باختزالها المركب في البسيط وبتطبيقها على الإنسان منطق الآلة وإقصائها كل ما لا يقبل القيس والتكميم، حاجبة إنسانية الإنسان، كما يقول أدغار موران[71].
- الرياضة والتسلية
ليست الرياضة مادة للدراسة في المنهج المحضري، لكن البيئة المحضرية المتنقلة غالبا، وما تستلزمه من كد وكدح في شئون الحياة، تمثل بطبيعتها إطارا طبيعيا لممارسة أنماط من الرياضة، وعلى الأخص السير مسافات طوالا على القدمين وامتطاء الدواب. وعلاوة على ذلك، تشجع البيئة المحضرية ممارسة الرياضة التقليدية، وخاصة منها كرة الصولجان أو المقلاء، كما يسمونها، وهي – بصيغتها البدوية – كرة صغيرة يتقاذفونها بعصا معقوفة. ويكون الهدفان غالبا متباعدين بمسافة قد تصل إلى عشر كيلومترات أو أكثر، ويختارون لذلك الأماسي المعطلة من العصر فما بعده، وقد يستمرون فيها إلى أن يحجز المغرب بين المتبارين. وقد احتلت هذه الرياضة مكانة في الشعر الشنقيطي، فتناولها – على سبيل المثال- شعراء كبار منهم محمد بن ابنو ومحمد بن الوالد ومحمد المختار بن اباه.
وعلاوة على ما توفره هذه الرياضة من متعة، فإن الوسط المحضري يفسح لطلبة العلم في مجال التسلية بأوجه أخرى. ويعتبرون ذلك ضرورة في الدرس المحضري للحد من جفافه. وفي ذلك يقول العلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم:
وروح القلب بذكر الطرف فإن ذاك من صنيع السلف.
ويقول غيره:
أفد طبعك المكدود بالجد راحة يجم وعلله بشيء من المزح
ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بقدر الذي يعطى الطعام من الملح
وإلى مثله أشار الإمام الغزالي من قبل في قوله: “ينبغي أن يؤذن للصبي بعد الانطلاق من الكتاب أن يلعب لعبا جميلا يستريح إليه من تعب الكتاب، فإن منع الطفل من اللعب وإرهاقه إلى التعليم دائما يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش”.
ويتمتع طلبة المحاضر في هذا الشأن بما يشبه الحصانة الدبلوماسية، حيث يصفح لهم المجتمع عما قد يرتكبونه من أخطاء، على وجه التسلية والترويح عن القلوب. وفي ذلك يقول أحدهم معتذرا:
همنا العلم لا مراض الجفون لا تظنوا مرجمات الظنون
إن هزلا أقوله في المجون لمعين على صعاب الفنون.
- طرق التدريس
تختلف طرق التدريس، بعض الاختلاف،تبعا للمادة المدروسة. وسنعرض أولا لطرق تدريس القرآن الكريم، ثم نقف على طرق تدريس المعارف المحضرية الأخرى.
- التعليم القرآني
تبدأ هذه المرحلة عادة باقتناء لوح خشبي صغير يسلم للطفل، وغالبا ما يختار أهله من يأنسون فيه الصلاح ليكتب له البسملة في أعلى اللوح دون أن يقرئه إياها، ثم يبدأ التعليم وفق الطريقة الجزئية التركيبية، فيكتب المعلم للطفل حرف الألف (ا) ثم حرف الباء (ب) مفردتين. ويستمر الطفل في تعلم حروف الهجاء بأسمائها، وتبعا لقدراته في الاستيعاب، وبترتيب قد يختلف اختلافا يسيرا حسب المناطق. لكن الجميع يدرجون في حروف الهجاء لأغراض التعليم في هذه المرحلة النون بشكلين (نـ/ ن) و لام الألف (لا)، فضلا عن الألف واللام مفردتين، والهمزة في ترتيب متأخر، باعتبارها حرفا غير الألف (وهذا هو الصحيح)، والهاء بشكلين (هـ/ ه) والتاء بشكلين (ت/ ة، وهي تاء التأنيث التي تتحول هاء عند السكت) والياء بشكلين (يـ/ ي). وبعد أن يتعلم الطفل أسماء الحروف على هذا النحو ينتقل إلى مرحلة أكثر وظيفية، فيتعلم الحروف مشكولة، بأصواتها وأسماء حركاتها، بهذا الترتيب: بَ، بُ، بِ، بْ، وينطق الحرف بحركته، لكنه في كل مرة يذكر اسم الحركة (مثلا: بَ فتحه، بُ ضمّه، بِ كسره)، وهكذا حتى يستوفي دورة جديدة من دراسة الحروف بهذه الطريقة. ثم ينتقل إلى طور ثالث في تعلم الهجاء من خلال المقاطع الصوتية، فيدرس جميع الحروف بدءا من الباء ممدودة على الأوجه الأربعة (با – بو – بي- بى وهذه الرابعة تنطق بالإمالة، وبها ترسم، إعدادا لقراءة القرآن برواية ورش)، وينطق الحرف بحركته المشبعة بالمد، لكنه في الوقت ذاته، يسمي الحركة ويسمي حرف المد، فيقول مثلا: بُــو ضمّة جابدها الواو أي ممدودة بالواو، ويقول في الشكل الرابع بى إمالة، وهكذا إلى أن يستوفي دراسة الحروف كلها بهذا الشكل. ثم ينتقل إلى دور رابع في دراسة الحروف الهجائية، فيتعلمها مركبة أبجديا على النحو المألوف (أبجد، هوز، حطي…إلخ)، ثم ينتقل إلى طور خامس وأخير يتعلم فيه الحروف الهجائية مركبة أيقشيا على نحو آخر (أيقش، بكر، جلس دمت… إلخ)، والتركيب الأول (الأبجدي) هو تركيب حساب الجمل التصاعدي الطبيعي. أما التركيب الثاني (الأيقشي) فهو تركيب تتوالى فيه الآحاد وما يناظرها من العشرات والمئات إلى الألف (الألف=1، تليه الياء = 10، فالقاف = 100 فالشين = 1000). ولا يتعلم الطفل في هذه المرحلة شيئا عن القيم العددية للحروف، لكنه بحفظها على هذين النسقين يتمكن لاحقا من تعلم حساب الجـُمّل بسهولة. وهكذا تحظى مرحلة تعليم الحروف الهجائية بعناية كبيرة وتستغرق وقتا غير يسير، باعتبارها الأساس، وحين يتقنها الطفل يصبح جاهزا للبدء في تعلم القرآن الكريم.
يتم البدء، عادة، بتعليم الفاتحة وقصار السور، والأصل – زيادة في ترسيخ الألفباء- أن تكتب الكلمات وتلقن حرفا حرفا بحركاتها، فإذا أتقنها الطفل مقطعة صوتيا على هذا النحو، عادوا به لـ”تجريتها” أي لقراءتها كلمة متصلة.. فالحمد مثلا تكتب متكاملة متصلة مشكولة، لكنها تقرأ أولا مقطعة هكذا: الـْ حَ مْ دُ، فإذا كررها الطفل مرارا بشكل سليم طـُلِب منه أن يقرأها متصلة قراءة مسترسلة، فيقرأها : الْحَمْدُ… ويستمر التعليم على هذا النحو إلى أن يتقن الطفل قراءة الحروف مشكولة والربط بينها فيتوقف عندئذ عن التقطيع الصوتي، ويكتفي بقراءة الكلمات متصلة مسترسلة. وبعد قراءة الفاتحة يدرس الطفل قصار السور من خواتم القرآن: الإخلاص والمعوذتين. وربما بدأ بعضهم بسورة القلم، مراعاة لاستهلال الوحي بها، وقد يكون ذلك تيمنا بما تضمنته من الأمر بالقراءة والامتنان بالتعليم. ثم ينتقل الطفل لرأس الحزب، أي لسورة الأعلى ويستمر في الدراسة إلى آخر الحزب ثم ينتقل تصاعديا إلى رأس الحزب الموالي (سورة النبأ). وهكذا يكون تدريس أحزاب القرآن في اتجاه معاكس لترتيب المصحف، حتى إذا تقدم الطفل في الدراسة تقدما بينا، فأكمل نصف القرآن أو أكثر منه أو ربعه على الأقل، أمره معلمه أن “يرصف” أي يقفز، بمعنى أن يبدأ في الدراسة من أول حزب (من بداية سورة البقرة) ويستمر إلى أن يصل إلى حيث انتهى في مساره الدراسي الأول. وطيلة هذه المرحلة، يكون التعليم فرديا بحتا، حيث يدرس كل متعلم القرآن بالوتيرة التي تناسب قدراته وطاقاته واستعداداته الذهنية. لكنه يندمج في مجموعة الدارسين في وقت التكرار ووقت تلاوة القرآن، فيكون فيها جزءا من جماعة، وفيما يتعلق بدرسه الخاص به محور اهتمام كامل مستقل. ويصر مدرس القرآن الكريم إصرارا كبيرا على القراءة الجهرية، فيتنافس تلامذته في رفع عقائرهم بتلاوة القرآن، خاصة من هم منهم في مرحلة التكرار للحفظ، وتتداخل أصواتهم دون أن يشغل ذلك أيا منهم عن درسه الخاص به.
وقد جرت العادة بأن يبدأ الطفل في تعلم الكتابة إذا تقدم شيئا ما في دراسة القرآن واستقام به لسانه. والغالب أن يطلب من شخص ذي خط جميل أن يكتب له في لوحه أو على ورقة كلمات يقلدها. وغالبا ما تكون متضمنة لحكمة يراد لها أن تنغرس في الذهن. وأذكر لحظة البداية مع الكتابة، يوم كتب لي والدي – أغدق الله عليه شآبيب رحمته – بخطه الجميل بيتا من همزية البوصيري:
ألف النسك والعبادة والخلــوة طفلا، وهكذا النجباء
وبدأت أتمرن على الكتابة بتقليد خطه الجميل، وهذا ما لم أدركه، ربما لتشتت النظر في الخطوط ومحاولة تقليد عدد منها.
وبعد البداية الرمزية مع ذي خط جميل، يترك التمرين على الكتابة للمعلم ولاجتهاد الطفل، فربما كتب له معلمه كلمات وأمره بتتبع آثار القلم الجاف على اللوح، أو بإعادة كتابة الكلمات. والأغلب أن يترك الطفل، بعدئذ يتعلم الكتابة بنفسه وبشكل تدريجي، ودون تدخل من معلمه إلا لإصلاح خطأ. وإذا كان العرف قد جرى باعتماد الطريقة الجزئية التركيبية في تعليم القراءة، فإن تعليم الكتابة يجري غالبا وفق الطريقة الجملية الكلية، حيث يبدأ الطفل في محاكاة شخص آخر بكتابة كلمات وربما جمل.
- تدريس المعارف الأخرى
تسود في التعليم المحضري طريقة التعليم الفردي، غير أنها تجري غالبا في سياق جماعي، حيث يتلقى الدارس درسه على شيخه في جماعة تشارك في الاستماع إلى الدرس وتساهم في إغنائه بما تطرحه من أسئلة واستشكالات وإضافات، قد لا تخطر على قلب الدارس، وربما خطرت به واستحيا أن يطرحها. ومع ذلك، فإن التعليم الزمري يمثل أيضا عرفا من الأعراف المحضرية المرعية، ويكون ذلك بأن يتفق جماعة من الطلبة (اثنان إلى أربعة مثلا) على دراسة متن واحد، يبدؤون فيه معا،ويتفقون على الحصص الدراسية اليومية ويتعاونون على تكرار الدرس. ويسمى هؤلاء في الاصطلاح المحضري “دولة”.
ويلخص بيت رجز محطات الدراسة في خمس تنطبق على التعليم زمريا كان أو فرديا:
كتب، إجازة، وحفظ الرسم قراءة، تدريس: أخذ العلم
وهذا تفصيل لتلك المحطات:
- كتابة الدرس، وتعني أن يقوم الطالب بكتابة الحصة الدراسية بيده في لوحه أو على كراس، ولهذه الكتابة أهميتها في ملابسة النص والتهيؤ للغوص فيه.
- إجازته، أي عرضه على المدرس، ليقوم له ما يحتمل أن يخطئ فيه من كلمات أو عبارات، وحتى يضبط النص بالشكل الصحيح، قبل الشروع في الحفظ.
- حفظ النص: تولي المحضرة عناية كبيرة لحفظ النص، وتشترط تقدم الحفظ على دراسة المعاني، منطلقة من أن امتلاك المباني معين على استيعاب المعاني. وهو أمر مشهود، ملاحظ بالتجربة.
- قراءة النص في مجلس الدرس، ويقصد بها عرض النص بعد حفظه على الشيخ، ويكون ذلك بقراءته عن ظهر قلب مكتملا، ثم العودة لقراءته بشكل مجزأ متدرج، يقف فيه الطالب حيث يرى أن يقف أو حيث يستوقفه شيخه.
- التدريس ويتخلل القراءة الثانية (المجزأة للنص) حيث يقوم الشيخ بتدريس كلمات النص وجمله وفقراته، فيشرحها حتى يفهم الطالب عنه، وتتخلل التدريس أسئلة الطالب، وأسئلة الحضور. وقد يطرح بعض الحاضرين تساؤلات مفتعلة بقصد الإيضاح والإفهام للدارس أو لبقية الحاضرين.
وللتعلم، من بعد، مراحل أخرى أهمها التكرار، ويقصد به ترسيخ المعاني في الذهن. ويقع بطريقتين، إحداهما أن يكون الطالب فردا من مجموعة تدرس نفس المتن. وفي هذه الحالة يجتمع أفراد المجموعة، ويكرر كل منهم للآخرين بأن يؤدي دور المدرس أمام بقية زملائه، وهكذا دواليك. أما الطريقة الثانية، فهي أن يجرد الطالب من نفسه شخصا يخاطبه، فتراه جالسا يتكلم بصوت مسموع مع نفسه، وكأنه يخاطب غيره ليشرح له معاني الدرس. ولا تختص هذه الطريقة بالمنفرد بالدرس، بل إن المشتركين فيه يجمعون بين الطريقتين، بحيث يكررون معا، وينفرد كل منهم بنفسه في عملية تكرارا أحادية، يناجي فيها نفسه بصوت مسموع، بحيث يستنفر قواه السمعية لمساعدة حافظته. ومن أمثل الطرق عندهم لترسيخ النص طريقة ينسبونها للإمام أحمد بن حنبل، تقوم على أن يكرر الدرس في اليوم الأول 7 مرات وفي الثاني 6 مرات وفي الثالث خمسا، وهكذا تنزلا حتى يقتصر على مرة واحدة في اليوم السابع. وبذلك قد تتحصل للطالب في اليوم الواحد نحو 30 عملية تكرار، إذا هو طبق الطريقة المذكورة.
وفي أهمية التكرار، يقول أحدهم:
خليلي لا تكسل ولا تهمل الدرسا ولا تعط طوعا في بطالتها النفسا
ولا تترك التكرار فيما حفظته فمن ترك التكرار لا بد أن ينسى[72]
وفيه لغيره:
إذا ترك العلم يوما هجر وزال فلم يبق منه أثر
كماء ترقرق فوق الصفا إذا انقطع الماء جف الحجر.
- وسائل التعليم
من أبرز وسائل التعليم في المحضرة الكتاب واللوح والقلم، وللوح أهمية خاصة عند الشناقطة، حيث يعتبرون أن للدراسة فيه بركة. ويتأكد ذلك خاصة في مرحلة التعليم القرآني، حيث يوزع اللوح – عندما يتقدم الطفل شيئا ما في دراسة القرآن- إلى أربعة أقسام، في كل وجه من وجهيه قسمان، يكتب الدارس حصة في أعلى اللوح ويكتب الثانية في نصفه السفلي ويكتب الثالثة والرابعة في وجهه الثاني على النحو ذاته. ويكون عليه أن يعيد حفظ كل حصة من الحصص الأربعة في كل يوم من أربعة أيام قبل أن ينتقل إلى الحصة التالية، عندما يأذن له شيخه بمحو أقدم الحصص الأربعة وكتابة الحصة الجديدة في محلها، وهلم جرا.
وفي شأن اللوح، يقول محمد سالم بن الشين :
ولوحك إن لوحك خير إلف يزينك في المجامع والألوب
ولا تتركه خلف البيت تسفي عليه السافيات من الجنوب
ويقول الشيخ محمد بن حنبل:
| عم صباحا أفلحت كل فلاح أنت يا لوح صاحبي وأنيسي فانتصاح امرئ يروم اعتياصي بك لا بالثرا كلفت قديما | فيك يا لوح لم أطع ألف لاح وشفائي من غلتي ولواحي طلب الوفر منك شر انتصاح ومحياك لا وجوه الملاح |
ورغم أن الشناقطة حذروا من الاعتماد على الكتب، فإنهم حضوا على تقييد العلم بالكتابة، وعلى اتخاذ الكنانيش، وعلى استعانة المدرس بالكتاب، كما أشرنا إلى ذلك في فقرة المبادئ التربوية في الفكر الشنقيطي.
وقد استخدمت المحضرة وسائل إيضاح ومعينات تربوية بسيطة منها: الشواهد، وهي غالبا أبيات من الشعر تشهد للقواعد اللغوية، أو مقطوعات رجزية قصيرة يستعان بها في ترسيخ المعارف الفقهية ونحوها. كما استعانوا بالتلوين في النصوص المكتوبة خاصة على الورق، للفرز بين المضامين ولإبراز بعضها، واستخدموا التطرير للغرض ذاته. ويتمثل التطرير في كتابة حواشي بأشكال هندسية مختلفة تحلي هوامش المتن، وكثيرا ما يتحول النص المطرر إلى لوحة جميلة بما يحمله من ألوان وأشكال هندسية مرسومة بالخط، تحيط بالمتن من جوانبه الأربعة أو ثلاثة منها. وقد يستعين الدارسون في حفظ النصوص برسم ما يسمونه “عشراية المختار” على الأرض، وهي صيغتان صغيرة وكبيرة، تتكون الصغيرة من 10 نقاط في شكل هرم قاعدته أربعة نقاط وقمته نقطة واحدة. أما الصيغة الكبيرة فتتشكل من هرم من خمسين نقطة، تسعة في القاعدة ونقطة واحدة في القمة. ويمثل محو النقطة الأخيرة هدفا نبيلا يسعى الدارس بمتعة واهتمام إلى بلوغه، وذلك بقراءة النص مرة ومحو نقطة وهكذا إلى أن يمحو النقطة الأخيرة بالقراءة العاشرة أو الخمسين. ويختار الدارس بين الصيغتين الكبيرة والصغيرة، وفق اعتبارات منها مستوى ذكائه ومستوى طول أو صعوبة النص المدروس ومدى رغبة الدارس في إتقان درسه.
- التقويم
تختلف أساليب وعمليات التقويم تبعا لاختلاف المراحل والمواد الدراسية. فلكل من التعليم القرآني والتعليم المحضري أساليبه في التقويم، مواكبا كان أو بعديا ختاميا.
- التقويم في التعليم القرآني
يكتسي التقويم أهمية خاصة في التعليم القرآني لقوة التركيز فيه على الحفظ، ويتم التقويم قبليا بعرض النص على الشيخ وقراءته عليه حتى يستقيم لسانه به، ولا يؤذن للتلميذ بكتابة حصة جديدة حتى يقرأ عن ظهر قلب حصته الأخيرة وثلاث حصص سابقة عليها. وهذا تقويم يومي لا تنازل عنه في المحضرة. وإضافة إلى ذلك، يعرض الدارس كل يوم، استظهارا من الذاكرة، قسما مما حفظ من القرآن يتحدد مقداره تبعا لمستوى تقدم الدارس في دراسة الكتاب العزيز، ويتدرج في ذلك من السورة والسور المعدودة إلى 10 أحزاب (5 أجزاء) أو أكثر. وهناك بشكل خاص مواعيد أسبوعية لاختبارات في حفظ القرآن، ففي مساء الثلاثاء وليلة الأربعاء –غالبا- يدعو الشيخ تلامذته واحدا بعد الآخر فيختار بشكل شبه عشوائي ثمنا أو حزبا يطلب من التلميذ قراءته. فإذا قرأه بدون تلعثم ولا توقف اعتبر ناجحا وأذن له بالانصراف، فيتولى إلى أهله مسرورا، وإذا تعثر فيه، وخاصة إذا استغلقت عليه كلمتان أو ثلاثة يعتبر ساقطا في الامتحان، ويحبس فيتأخر عن زملائه، ليعكف على استظهار الأجزاء التي لم يتقن حفظها. وتكون تلك “عقوبة” من عقوبات التعليم المحضري. وربما انضافت إليها عقوبات أخرى قد تصل حد الضرب. ولعل أقساها عقوبة حسية – معنوية تتمثل في أن يأمر الشيخ اثنين أو ثلاثة من التلاميذ بالبصاق على رأس التلميذ الراسب في الاختبار. وفي بعض المحاضر التي تهتم بالقرآن حفظا وتجويدا ورسما ، تخصص ليلة الاثنين لاختبار الدارسين في الرسم.
وتتمثل المحطة الختامية في التقويم فيما يسمونه “التنزال” أو “السلكة”، ويقصد به أن يتلو الطفل القرآن كله عن ظهر قلب أمام شيخه و شخصين آخرين من الحفظة، ليشهدوا كلهم على أنه أتقن حفظ القرآن، ولا يقع ذلك إلا إذا تأكد المدرس سلفا من جاهزية تلميذه، بحيث يطمئن إلى أن أخطاءه في الحزب الواحد من القرآن ستكون معدومة أو قليلة. وقد اختلف الفقهاء المتقدمون في تحديد عدد الأخطاء التي لا يتجاوز عنها في الحزب (أي أنها قادحة في دعوى حفظ القرآن)، فقال ابن غازي : كلمتان، وقال الجزولي: أربعة ، وقال الكصري إن المرجع في ذلك عرف البلد[73].
- التقويم في التعليم المحضري
هناك – مقابل الصرامة التي تتسم بها عملية التقويم في التعليم القرآني- مرونة بالغة في مرحلة التعليم المحضري، حيث يعتبر المتعلم راشدا، والدافعية للتعلم عنده أكبر، والمادة المدروسة، على أهميتها، لا تبلغ مبلغ القرآن الذي كان حفظه بالنسبة لهم أقرب إلى الضرورة منه إلى الحاجة. ومع ذلك تحفل المحضرة بأساليب تقويم متعددة ، يشكل درس اللغة العربية والأدب مجالها الأهم. ومن الطريف أن الطلبة هم الذين يأخذون –غالبا- مبادرة المطالبة بتقويم مكتسباتهم الدراسية. ومن الأساليب المتبعة في التقويم المحضري:
- الألغاز والأحاجي، وتتناول الفقه واللغة. وربما كانت اختبارات للذكاء والفهم دون الحفظ والعلم. وقد يتوجه الشيخ إلى بعض تلامذته بهذه الألغاز والأحاجي، وقد يتبادلها الوسط المحضري طلبة ومثقفين من أهل الحي.
- تمارين الأعراب. وتقع هذه التمارين غالبا بمبادرة من الطالب حيث يتوجه إلى شيخه أو إلى أحد شيوخ الحي أو أحد الطلبة المتقدمين، فيطلب منه أن يختبره في الإعراب، فيكون ذلك بأبيات مختارة من الشعر العربي. وغالبا ما تقع حصص الإعراب في الليل، وتكون بمثابة تسلية وتعلم في الوقت ذاته. ويراعى في هذه التمارين التدرج، فأول ما يمتحن فيه الدارس هو ما يسمونه التمييز، ويطلب منه فيه أن يحدد ما إذا كانت الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا، لا غير. فإذا أتقن التمييز بين الأقسام الثلاثة، انتقل إلى مستوى أولي من الإعراب، ثم تدرج في ذلك صعدا مع تقدمه في استيعاب النحو العربي.
- الندوة الشعرية، وهي سمر محضري أثير، يختبر فيه طلاب المحضرة مروياتهم الشعرية، ويقوم على أن يروي أحدهم بيت شعر، ويبادر من يليه برواية بيت شعر يبدأ بالحرف الأخير من بيت صاحبه، ويستمر الأمر في الحلقة هكذا إلى أن يعود الدور من حيث بدأ. ومن لم يستطع استحضار بيت شعر يعتبر منكسرا في هذه المنافسة، ويشكل ذلك حافزا له على حفظ المزيد من الشعر العربي.
- متابعة شيخ المحضرة لطلابه، وهي عادة متابعة لبقة، لا تسند فيها درجات، ولا تقوم على اختبارات مباشرة، إلا نادرا. لكن نظام التعليم الفردي وما يواكبه من تعلم جماعي ومن مشاركة من الحاضرين يسمح للشيخ برصد مستويات طلبته من طرف خفي، فتتكون لديه فكرة عن استعداداتهم الذهنية وقدراتهم العلمية، ورغم أن الشيخ يلتزم مبدئيا بالمساواة في التدريس بين سائر طلبته، فإنه يجد طرقا أخرى لتشجيع الطلبة المتميزين، منها التضحية بوقت إضافي لصالحهم، خاصة في أوقات الراحة، وتكليفهم بخدمات معينة، وتنصيبهم أساتذة معيدين مكلفين بتدريس آخرين أو التكرار لهم.
- تقويم السلوك العام، ويجري فيه شيوخ المحاضر على السنن النبوي، متمثلين قوله r: “ما بال أقوام…”. وفي مثل ذلك يقول الشيخ يحي بن أحمد فال التندغي:
وفعل ما لا ينبغي لا ينبغي لتندغ ولا لغير تندغ
- تقويم يقوم به المجتمع، ويتم خاصة في المناسبات التي يتوجه فيها طلبة المحاضر إلى بيوتات الحي أو إلى القافلة العابرة ليطلبوا الدعم لهم أو ليجمعوا صدقات للفقراء، فقد جرت التقاليد بأن يبدأ البيت المزور أو القافلة باختبار رمزي لمحفوظات الطلبة أو قدراتهم الذهنية، وأيا كانت نتيجة الاختبار، فإنهم يدفعون لهم من بعد ما يستطيعون دفعه. لكن تألق الطالب في الاختبار قد يشحذ همة الطرف المزور ويرفع من أريحيته.
- ويبقى التقييم الأهم هو ذلك التقييم النهائي لذي يمارسه المجتمع وشيخ المحضرة معا في المراحل المتقدمة من الدراسة، ويكون ذلك من قبل الشيخ بإجازة الطالب في مروياته ومسموعاته ومقروءاته كلا أو بعضا، أو بمجرد أمره إياه أو إذنه له بالتصدر للتدريس أو التربية. وغالبا ما تتضمن الإجازة نصائح وتوصيات من الشيخ لتلميذه المتصدر. أما من جانب المجتمع –وهو الأهم- فالتقويم عملية إجرائية قوامها الاهتمام بالطالب “المتخرج” وتوجه الطلبة إليه للتعلم منه والأخذ عنه، وربما رحل بعضهم معه حين يرحل من المحضرة ليواصل الدراسة عليه.
- إدارة الوقت في التعليم المحضري
نتناول في هذا المبحث مدة الدراسة والتدريس في حياة الطالب والمدرس، وأوقات الدراسة في اليوم، والعطل المدرسية.
- مدة الدراسة والتدريس:
من المهم في البداية أن نشير إلى أن التربية بمفهومها الواسع تبدأ عند الشناقطة في سن مبكرة، حتى إن منهم من يرى ضرورة تأديب الطفل الرضيع، معتقدا أن ذلك نافع له في كبره. ومما يشهد لذلك، وإن لم يكن بالضرورة في مجال العقوبة البدنية، ما يروى من أن رجلا استنصح مالك بن نبي بشأن تربية ولد له، فقال: كم عمره؟ قال: شهر. قال: فاتك القطار! ومعلوم أن بعض المربين يرون أن التربية تبدأ من مرحلة الحمل، ويعتقدون أنه من المهم – مثلا – أن يسمع الجنين وهو في بطن أمه تلاوة القرآن، ويعاملون الأم الحامل معاملة خاصة، مراعاة لوضعها البدني والنفسي، ومراعاة فيها للجنين. وقد عشنا في واقعنا الاجتماعي أنماطا من تلك التربية المبكرة التي تستهدف تقويم السلوك البشري.
وقد مر بنا أن الأطفال يتلقون في سن مبكرة (الثالثة – الرابعة)، بالتلقين الشفهي المتكرر، بعض المعلومات الأولية ذات الصلة بالسيرة والأدعية النبوية. وليس هناك بعدئذ ضوابط ملتزمة، لا في تحديد الوقت الذي يتوجه فيه الطفل إلى المدرسة القرآنية، أو ينخرط فيه – طفلا أو يافعا- في المحضرة، ولا في تحديد مدة الدراسة والسقف العمري الأقصى لمزاولتها أو للتخرج. كما أنه لا وجود لضوابط من هذا القبيل، تحدد “السن القانونية” لممارسة التدريس، حيث لا يوجد تقاعد في العرف التربوي الإسلامي، ولا نص ولا عرف يمنع الطالب النابه من الشروع في التدريس مبكرا وإن في مرحلة المراهقة. بل إن ذلك يعتبر أمرا محمودا، كما أن الشيخ يظل يبذل علمه ما دامت صحته تسمح له بذلك. ومع ذلك فإن هناك سهولة أكبر في تحديد موعد الالتحاق بالدراسة، حيث تحرص الأسر على إرسال أبنائها إلى معلم القرآن في سن مبكرة، غالبا ما تكون بعيد اكتمال السنة الرابعة. ورغم أن بعض التقاليد تحبذ أن يرسل الطفل إلى المدرسة إذا أكمل أربعة أعوام وأربعة أشهر وأربعة أيام، فإن معيارا موضوعيا غالبا ما يتدخل لتحديد التاريخ، ويكون ذلك بالتثبت من أن الطفل قد أصبح قادرا على حساب الآحاد إلى العشرة أو نحوها، وقد يكون الاختبار فيزيولوجيا، حيث يطلب من الطفل أن يدير يمناه فوق رأسه ليمسك بها أذنه اليسرى، فإذا تمكن كان ذلك مؤشرا على أهليته للتوجه إلى الكتاب. وفي ذلك إشارة – تستحق أن تفحص وتدرس- إلى الترابط بين النمو البدني والنمو الذهني للأطفال.
وليست هناك مدة محددة للدراسة القرآنية، فالغالب أن يكون الهدف هو حفظ القرآن، ويكون هو الضابط المهيمن في تحديد المدة، في تفاعل مع معايير أخرى من أهمها ذكاء الطفل. وهكذا نجد الأطفال يحفظون القرآن في عمر يتراوح – غالبا – ما بين السابعة والثانية عشرة، وبشكل أغلب في حدود التاسعة والعاشرة.
أما التعليم المحضري فالفضاء الزماني فيه فضاء مفتوح، يحبذ أن يكون متصلا بالفراغ من حفظ القرآن، ولكنه قد ينفصل. وحين يلتحق الطفل بالمحضرة، يلتحق بها وله أهداف يسعى إلى تحقيقها، أعلاها أن يتبحر في المعارف المتاحة في محضرة معينة ثم ينتقل إلى غيرها ليزدادا علما على علمه. وقد يكون له هدف محصور في دراسة بعض المتون، لكن تعلم بعضها قد يغريه بتعلم المزيد فتمتد إقامته في المحضرة بامتداد همته وطموحه، ووفقا لما تسمح له به ظروفه، وظروف محيطه.
- أوقات الدراسة
تختص مرحلة التعليم القرآني عادة بأن الدراسة فيها قد تبدأ وقت السحر، وتستمر إلى أن يحين موعد إفطار الصباح، بعد صلاة الصبح بنحو ساعة، ثم تستأنف إلا إذا كان الطفل يزاوج بين المدرسة القرآنية والمدرسة النظامية. ويتمثل برنامج الحصة الصباحية عادة في إتقان حفظ آخر حصة يكتبها التلميذ في لوحه، فإذا قرأها عن ظهر قلب على شيخه، أمره بمراجعة الحصص الثلاثة السابقة عليها وعرضها عليه، فإذا تلاها كلها عن ظهر قلب، أمره بأن يمحو أقدمها من لوحه ويكتب محلها الحصة الجديدة، فإذا كتبها عرضها عليه قراءة من اللوح ليقوم له ما قد يقع من خلل، ثم أذن له في الانصراف إلى أهله. وينتهي بذلك برنامج الدراسة الصباحية، ويتفاوت الوقت بتفاوت قدرات الأطفال على الحفظ والاستيعاب. وربما أضيف إلى جدول المهمات هذه تلاوة عدد محدد من أحزاب القرآن الكريم بالنسبة لمن اتسع رصيدهم منه. وتبدأ الفترة المسائية مع الظهر أو قبله، وتكون مهمة الطفل فيها أن يشرع في حفظ الحصة الجديدة، ويستظهر محفوظاته السابقة من القرآن، بالمقدار الذي يحدده له شيخه.
وقد حدد النابغة الغلاوي في نظمه لآداب تعليم الصبيان زمن الدراسة على النحو التالي:
وسرح الصبيان بالإبكار من بعد محوهم إلى الإفطار
وبعد كتبهم ضحى للظهر للاستراحة وبعد العصر[74]
غير أن هذا التوزيع الزمني لا يطبق بشكل حرفي، حيث يظل الهدف لا الزمن هو المرجع في تحديد الوقت الذي يمكثه الطفل في الدراسة، كما أن الموروث الشعبي يحث على أن تستعمل فترة الأصيل (قبيل الغروب) في تكرار الحصص الدراسية الجديدة لإتقان حفظها، ويقولون في ذلك، في عبارة عامية مسجوعة : ” غباد المسا ما ينتسى”، أي أن ما تقرأه بصوت عال وقت المساء يبقى في الذاكرة فلا ينسى. وعموما، فإن وقت الدراسة يستمر أحيانا إلى ثلث الليل وربما إلى ما بعده، ما لم يتمكن الطفل من إنجاز برنامجه الدراسي اليومي المقرر من قبل شيخه.
أما في مرحلة التعليم المحضري، فإن التعليم يبدأ غالبا وقت الضحى، بعد الفراغ من الإفطار ومن شئون الصباح، ولا ينقطع إلا مدة يسيرة للقيلولة، ثم يستمر إلى صلاة العشاء أو ثلث الليل أو نحوه. وتختلف تقاليد المحاضر، فمن الشيوخ من لا يضع أي برنامج زمني، بل يعلم الناس تبعا لورودهم عليه، أو لاختياراتهم هم في أوقات دراستهم، غير أن بعض المحاضر المكتظة بالطلبة قد ابتدعت جدولة زمنية للدراسة اليومية، نجد مثالا لها في محظرة تنجغماجك التي وزعت الزمن على النحو التالي: من الرابعة سحرا (وهذا نادر في المحاضر) إلى التاسعة صباحا: لدراسة مختصر خليل؛ من التاسعة إلى الثانية عشرة والنصف قبل الظهر لدراسة الكفاف ولامية الأفعال ونحوها من المتون المتوسطة، ومن الظهر: لدراسة ألفية ابن مالك، وما بقي من الوقت يخصص لبقية الفنون والمتون إلى صلاة العشاء.
- العطل التعليمية:
يتمتع الدارسون -سواء في مرحلة التعليم القرآني أو في مرحلة التعليم المحضري- بعدد محدود من العطل، بينها عطلة الأسبوع العمرية: الخميس وجناحاه (مساء الأربعاء وصباح الجمعة). كما يتمتعون بعطل محدودة بمناسبة الأعياد، تصل إلى 5 أيام في عيد الأضحى وثلاثة في عيد الفطر. كما يعطلون عادة ذكرى المولد النبوي. وتنتشر في الوسط المحضري ثقافة مؤداها أنه، باستثناء العطل المذكورة، لا ينبغي للإنسان أن ينقطع عن الدراسة يوما من الأيام، بل إنهم يذهبون في التنظير للتعلم المستمر إلى حد إشاعة نظرية تقول بأن دماغ الإنسان يتكون من كمية من المسام التي لا تنفتح إلا بالتعلم، وكلما واظب الإنسان على اكتساب معارف جديدة انفتحت تلك المسام (انفتاحا يشير إلى توقد القريحة وتنور البصيرة)، فإذا مر عليه يوم لم يتعلم فيه جديدا انغلق بعض تلك المسام، وهكذا دواليك.. وقد عكست اللهجة الحسانية هذا الولع بالتعلم في تعبيرها عن تعطيل الدراسة في غير عطلة عرفية، فإذا مضى على الطالب يوم لم يستوعب فيه درسا جديدا، يقولون إنه “غبّ” أو يصفونه بأنه “غابُّ”، وهي نفس المفردة التي يعبرون بها عن مضي يوم على الماشية بدون شرب، وهي مفردة عربية أصيلة، فكأن العلم هو شراب ذلك اليوم، فإن غاب بقي صاحبه على ظمأ إلى أن يتعلم درسا جديدا في يوم جديد.
ثانيا – البيئة التربوية
ازدهر التعليم المحضري في بيئة مادية صعبة، لكنه استفاد في الوقت ذاته من بيئة معنوية حافزة استطاعت أن تعوض النقص الحاصل في البيئة الطبيعية، ومن أبرز معالم هذه البيئة ما يتصل بمواصفات شيخ المحضرة والعلاقة بينه وبين الطالب، وجماعية الحياة والنشاط في كنف المحضرة، ومنزلة العلم في سلم القيم الاجتماعية، وأثر هذه المنزلة وما يتقدم عليها من اعتبارات دينية في تحبيب طلب العلم إلى الناس. وتمهيدا لذلك سنتطرق أولا إلى ما وفرته البيئة الاجتماعية من موارد للمحضرة للتخفيف من المصاعب المادية، على أن ننظر من بعد في جوانب البيئة المعنوية الحافزة للتعليم المحضري.
- موارد المحضرة
اتسمت الحياة المحضرية في بعدها المادي بمصاعب جمة، لصيقة بحياة البداوة وما يطبعها من شظف عيش وظعن دائب تتبعا لمساقط الغيث ومواقع الكلأ. لكن هذه الحياة، وقد ألفها القوم واعتادوا عليها وأحبوها، كانت– في جل جوانبها- جالبة للمتعة حافزة للهمم. وقد استنبط المجتمع المحضري آليات لكفالة طلبة العلم الفقراء وموارد لمكافأة شيوخ المحاضر، رغم الطابع الطوعي لعملهم في الغالب الأعم، وخاصة فيما بعد مرحلة تحفيظ القرآن. أما هذه المرحلة فقد جرت الأعراف بأن يتلقى المعلم فيها مكافآت في مناسبات معينة، حيث يحمل إليه تلامذته هدية ما كل يوم أربعاء، وفي حدود ما تتيحه إمكانات أسرهم. كما يحصل على هدايا في محطات فاصلة، مثل إكمال التهجي، وإنهاء حزب من القرآن، أو ربع القرآن أو نصفه، وتعظم جائزة المدرس عندما يكمل تلميذه حفظ القرآن. وتتمثل الجوائز الكبرى في رؤوس من الضأن أو الإبل، تبعا لمستوى التحصيل. وقد ترجمت هذه المنح في العصر الحديث إلى مبالغ مالية، خاصة في المناطق الحضرية.
أما في التعليم المحضري، فالقاعدة أن لا يكون هناك أي التزام مسبق تجاه الشيخ، لكن الموسرين من تلامذته (أو من أسرهم) يقدمون له، على وجه الهدية، ما تيسر بمناسبة وبغير مناسبة. وكثيرا ما يتولى شيخ المحاضر– عكس ما هو سائد في التعليم النظامي – الإنفاق على طلبة العلم الذين يفدون إليه، يساعده في ذلك المجتمع المحلي. وقد رتب المجتمع للمحضرة حقوقا أخرى، منها أوقاف ومنائح تتمثل خاصة في الحلائب ومد من كل حمل من أحمال العير التي تمر بجوار حي به محضرة، والظهر من كل ذبيحة بقر والعنق من كل جزور تنحر وشاة عقيقة عن كل مولود جديد ووليمة بمناسبة أي زفاف والدلو الثالثة أو الرابعة من الماء الممتوح من البئر، وضيافة خاصة تبعث للطالب الذي يكمل متنا كبيرا. كما تتكفل نساء الحي بخياطة ملابس الطلبة وخيمتهم عند الحاجة. ولهم حق الخومسة، وهي قضاء عطلة الخميس عند أحد البيوت. ولهم طرق أخرى يستدعون بها العون، منها الأذان بهدأة من الليل إذا تغيبت الحلائب فيرسل إليهم أهل الحي ما توفر لديهم، ومنها نصب قلم أمام بيت من بيوتات الحي فيفهم أهل البيت من تلك الإشارة أن الطلبة ينتظرون منهم مأدبة.
وللطلبة رسالة مدبجة معروفة يبعثون بها إلى الأحياء المجاورة، فيستقطبون بها الدعم عندما لا يكون الحي الذي يقطنونه قادرا على سد حاجاتهم. إن هذا النمط من التكافل بين المجتمع والمحضرة يوجد له نظير اليوم في المؤسسات التربوية الغربية، حيث يعيش كثير منها على الهبات والتبرعات أو يغطي بنها نسبة طيبة من نفقاته. كما توفر هيئات وأفراد منحا دراسية للطلبة. ففي بريطانيا –مثلا- تبرع رجال الأعمال بين 1997 و2001 بـ 120 مليون جنيه استرليني للبعثات الدراسية للمتميزين[75]. ويشكل هذا التكافل سرا من أسرار نجاح التربية النسبي في تلك الأوطان، كما شكل تاريخيا سرا من أسرار نجاح نظامنا التربوي الأصيل.
- البيئة المعنوية الحافزة
يجري التعليم المحضري عادة في بيئة معنوية ثرية بالمثيرات النفسية والثقافية والاجتماعية المعينة على تذليل صعاب البيئة الحسية المادية. ومن أبرز أركان هذه البيئة المعنوية: التفرغ من شواغل الدنيا، والدافعية القوية للتعلم، وأسلوب الحياة الجماعية، والمواعيد الاحتفالية في محطات الدراسة، والعلاقة المتميزة بين الطالب وشيخه وتفاعل المحضرة مع محيطها الاجتماعي.
- التفرغ من الشواغل:
تقوم الحياة المحضرية على مبدأ أثير هو ضرورة تفريغ القلب من هموم الدنيا وشواغلها حتى يفرد الطالب وجهته لدراسة العلم فلا ينشغل عنه بطلب الرزق ولا بغيره من هموم الحياة. وإلى هذا المبدأ يشير الإمام الشافعي بقوله: “لو كلفت شراء بصلة ما حفظت حديثا واحدا”، وقيل إن كثرة حفظ السلف إنما كانت لفراغ قلوبهم من الاشتغال بالدنيا وهمومها[76].
ويقول أبو محمد الديباجي
لا يدرك الحكمة من دهره يكدح في مصلحة الأهل
ولا ينال العلم إلا امرؤ خال من الأغراض والشغل
فإن لقمان الحكيم الذي سارت به الأمثال في الفضل
لو ابتلي يوما بفقر لما فرق بين الثور والبغل
وحرصا على تأمين هذا الشرط الضروري من شروط التحصيل الدراسي، يوفر المجتمع نظاما للكفالة والرعاية المادية للطلبة على النحو الذي أشرنا إليه أعلاه.
- قوة الدافعية للتعلم
لا يتوقع طالب المحضرة شهادة ولا ينتظر لقبا، ولا يتطلع الى راتب مقتطع، ولا يحمل في قلبه عبء سنوات محددة العدد عليه أن يمضيها، ولا هو يخشى من معلمه عقوبة بدنية أو”سجنا” لأنه أحرص من معلمه على حياته العلمية. ولهذه الأسباب، ولما يعززها من الوعي العميق بالمنزلة الدينية والاجتماعية السامقة للعالم ولطالب العلم، يتميز الطالب المحضري بدافعية نقية وعالية للتعلم. فهو يقبل بشغف على الدراسة، ويستمرئ في سبيلها العيش الضنك الخشن. وتزخر أدبيات المحضرة بأشعار المولهين بالعلم. ومن أمثلتها قول الزمخشري:
سهري لتحصيل العلوم ألذ لي من لثم غانية وطول عناق
وتمايلي طربا لحل عويصة أشهي بقلبي من مدامة ساق
يا من يحاول بالأماني رتبتي كم بين منسفل وآخر راق
أأبيت سهران الدجى وتضيعه نوما وتأمل بعد ذاك لحاقي؟!
وقول أبي القاسم الحسين بن علي بن الحسين:
وشاكية للبين قلت لها اقصري فللموت خير من حياة على فقر
سأكسب علما أو أموت ببلدة يقل بها فيض الدموع على قبري
وليس اكتساب العلم يا نفس فاعلمي بميراث آباء كرام ولا صهر
ولكن فتى الفتيان من راح واغتدى يدرس علما بالتجلد والصبر
فإن نال علما عاش في الناس سيدا وإن مات قال الناس بالغ في العذر
أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا نفع وتحسب من عمر
وقول المختار بن بونه
يا مجلس العلم والمجد المؤثل والـ دين المورث من ماحية الملل
لو لم تك الرسل بالمختار قد ختمت آليت أنكم من جملة الرسل
الناس في شغل مما تعيش به وأنتم باكتساب المجد في شغل
وإنما يقصد بالمجد هنا الاشتغال بالعلم فقد كان ذروة المجد عندهم. وفي ذلك أيضا يقول ابن رازقه، سيدي عبد الله بن محم (محمد):
| إذا جلت فكرا في العلوم عويصها تصاغرت الدنيا لدي وأهلها ونلت لذيذ العلم بالذوق وحده | وجئت بما يشفي غليل مريدي ومادت بي الأفراح كل مميد وكل لذيذ غيره كهبيد |
وتتعزز تلك الدافعية الذاتية بعوامل موضوعية خارجية، منها طبيعة الحياة الاجتماعية داخل المحضرة.
- طبيعة الحياة داخل المحضرة
توفر المحضرة بيئة معنوية حافزة على التعلم بطبيعة الحياة داخلها، فالطالب ينخرط مباشرة في سلك جماعة، فينغرس لديه الشعور بأنه عضو في جسد واحد. وتتأكد حميمية هذه العلاقة العضوية أكثر بانتظام الطالب في سلك مجموعة أصغر تسمى “الراحلة” تتقاسم طعامها وشرابها وأعباء الخدمات التي تقتضيها الحياة ضمن مجموعة. وقد تكون للطالب “أسرة” أخرى ينتمي إليها فتعزز لديه الاعتزاز بانتمائه المحضري، وذلك حين ينخرط في سلك “دولة” أي مجموعة صغيرة تتعاون على دراسة متن واحد، حتى تفرغ منه. وتشكل المحضرة بهذه الصيغة بيئة اجتماعية متكافلة متماسكة، منفتحة على بيئة أخرى أكبر لا تعدم أن تحتفي بالطلبة الناجحين في محطات نجاحهم.
- مواعيد احتفالية:
يرتب المجتمع مواعيد احتفالية للطالب طيلة مساره الدراسي. ففي مراحل الصبا الباكرة، يعيش الصبي على أمل أن “يرفد اللوح” أي يحمل اللوح ليكون مثل أقرانه الأسن منه. ويوم يمنح لوحا، ويؤمر بالتوجه إلى معلمه ويكتب له فيه الحرف الأول (ا) يشعر الصبي بالزهو، ويعتز بأن يباهي بلوحه والحرف أو الحروف المكتوبة فيه. ويعزز المجتمع عنده ذلك الزهو بسؤاله عن لوحه وعما كتب له فيه. وبذلك تقترن غريزة حب التملك والتميز بالتعلم من أول لحظة. وحين يفرغ الطفل من التهجي يشعر أيضا بالزهو والاعتزاز، كما أن تمكنه من حفظ الفاتحة يعتبر إنجازا مهما، يجعله يشعر بأنه اكتسب قيمة مضافة. ولئن كانت مراحل دراسة القرآن من بعد قد تتحول في حق الطفل إلى نوع من الكبد قد يصل به إلى التكاسل والتهرب فإن له مواعيد احتفالية تعيد إليه نشوة الدراسة في مراحل متقدمة من مساره في تعلم القرآن، فحين يكمل حفظ ربع القرآن ثم نصفه ثم ثلاثة أرباعه، يكتسي لوحه حلة مزركشة بديعة من الزخارف الملونة. وله حينئذ أن يتجول في الحي ومعه لوحه المزركش وبصحبته بعض زملائه في الدراسة، ليعرض نفسه لاختبار ساكنة الحي في حفظ القرآن ويظفر منهم بهدايا للمحضرة. أما عند حفظ القرآن فالجائزة عادة أكبر والجو الاحتفالي أعظم، فقد جرت عادة القوم بأن تغمس يد الحافظ الجديد في سمن أو سمن وعسل، وينادى على جارية تلعق أصابعه ويده، ويتم الإشهاد عندئذ على تمليكه إياها (وهي عادة انقرضت)، كما أن بعض أسر الحي تعد مأدبة متميزة ترسل لدارسي القرآن الكريم إكراما للحافظ الجديد.
- الشيخ والطالب.. علاقة من نوع آخر..
من محفزات الحركة العلمية، تلك العلاقة المتميزة التي تنشأ بين الشيخ والطالب في كنف المحضرة، وهي علاقة لحمتها تعظيم الطالب لمعلمه وسداها تواضع المعلم لتلميذه وحدبه عليه. وإلى ذلك يشير أحمد اللمتوني بقوله من نظم في التربية والتدريس :
فإن الانتفاع بالتعلم من شرطه التعظيم للمعلم
… ومن حقوق المتعلم على أستاذه لين الكلام مسجلا
وتشكل صورة المعلم في ذهن التلميذ عنصرا أساسيا في تحقيق الدافعية اللازمة للتعلم. وقد أوصى الغزالي المعلم بخصال منها: الشفقة على المتعلم، عدم طلب الأجر، النصح للمتعلم ، الزجر بالتعريض، أن لا يقبح في نفس المتعلم العلوم الأخرى ويراعي التدرج، وأن يعلم الدارس على قدر فهمه وعقله[77]. وذكر الشيخ محمدن بن محمد النابغة التندغي مجموعة من الآداب يبنغي أن يتحلى بها العالم (وهو عندهم ضرورة معلم)، منها: الخشية والنصيحة والشفقة واحتمال الأذى والصبر والحلم والتواضع والعفة عن أموال الناس ومداومة النظر في الكتب وقلة الحجاب و أن يجري تلامذته مجرى أولاده، كما حث على تحسين الزي والهيئة على القانون الشرعي، مستشهدا لذلك بقول عمر رضي الله عنه: “أحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب ليعظم عند الناس فيعظم عندهم ما لديه من الحق”[78].
وهاهي ذي صورة شيخ المحضرة (المدرس) عند مم أحمد محمود بن عبد الحميد في قوله عن شيخه يحظيه بن عبد الودود:
كان لطالب العلوم يرحم لا سيما إذا اعتراه سقم
يونسه بعرك أذن وشعر وقد يضمه إليه فيسر
ولا يصون كتبه عن طالب وليس دون بابه من حاجب
وحري بهذه المزايا إن تحققت في عالم أن تكون بحد ذاتها درسا حيا لتلامذته.
وينبغي أن نشير هنا إلى فرق جوهري، في التقليد المحضري (بل وفي الممارسات التربوية العتيقة جملة) بين مدرس القرآن ومدرس المعارف الأخرى.. صحيح أن العلاقة في مرحلة التدريس القرآني فيها قدر من التسلط، يجعل نسبة الهيبة غالبة على نسبة المحبة في العلاقة بين التلميذ ومعلمه، خصوصا في مرحلة الصبا، فذلك عندهم من متطلبات تعلم القرآن. لكن الوضع مختلف غاية الاختلاف في مرحلة التعليم المحضري، حيث يمارس الطالب حرية واسعة في اختيار الشيخ الذي يدرس عليه، فيتوجه إليه راغبا متعلقا، وتتجسد له في شيخه الصورة الفاضلة التي يحلم بها إذا هو كبر ونجح في مساره العلمي. وبذلك تكون المحبة والإعجاب – ممزوجين بمقدار من الهيبة والإجلال- هما السمة الأساسية لشعور الطالب نحو شيخه. وتتعزز هذه الصورة في الواقع، من خلال سلوك الشيخ، حيث يمارس عمله على وجه التطوع، ويباسط تلامذته ويجلس معهم على الأرض وهم متحلقون حوله، ولا يمارس تجاههم أي نوع من أنواع التسلط حتى إن الطالب يحضر متى يشاء ويغيب متى شاء، ولا يلزمه شيخه بميقات معين إلا في حالات نادرة تلجأ فيها المحضرة إلى توزيع الزمن بين المواد. وفي هذه الحالات، يتمتع الطالب أيضا بهامش متسع من الوقت، حيث يدرس الطلبة أولا بأول، حسب وقت وصولهم أو حسب الترتيب الذي يتفاهمون عليه فيما بينهم. ويتسم شيوخ المحاضر عادة بالتواضع الجم والرعاية الحانية لتلامذتهم، بل إنهم يرون فيهم أساتذة، وإلى ذلك يشير قول العلامة الجليل القاضي يحي بن أحمد فال “تلامذتنا أساتذتنا”. ومما يعزز تلك الصورة تسمية العالم طالبا في اللهجة الحسانية، فهناك أسر علمية كبيرة جرى العرف بتسميتها “الطلبة”، كما جرى بإطلاق المفرد “طالب” أو “طالبنا” على علماء أجلاء. ويصف التلميذ أشياخه عموما بأنهم “طلبته”.
كذلك يكون الطالب الحر الراغب طالبا متميزا ، يتمنى أن يعهد إليه شيخه أو أهل بيته بخدمة ليسارع إلى أدائها، ويستمرئ شظف العيش بجانب شيخ يربطه به رباط روحي ووجداني غليظ.
- المحضرة في خدمة المجتمع
تقوم الحياة داخل المحضرة على التآزر والتعاون والتكافل، فالطلبة يعيشون في العادة معا، يتقاسمون ما يملكون ويتوزعون أعباء خدمة مجموعاتهم بالقسط، فيتولى كل طالب – على سبيل المثال – دورة من رعاية الماشية، وأخرى من جلب الماء من الآبار التي تكون غالبا بعيدة من الحي، كما يتناوبون مهمات حلب ماشيتهم وطهي طعامهم وإعداد الشاي والشراب ونحو ذلك من المهمات اليومية، فيتعلم كل طالب خدمة نفسه وخدمة الآخرين. ورغم أن طالب العلم، فيما عدا ذلك، معفى من حيث المبدأ من تكاليف الحياة المادية وأعبائها، فإن المحضرة تؤدي دورا وظيفيا مهما في إسناد محيطها الاجتماعي، حيث ينتدب الطلبة من غير أمر يصدر إليهم إلى مساعدة الأسر المحتاجة فيعينونها في الإعداد للرحيل من مكان إلى آخر وفي بناء الخيمة والعريش وفي جلب الماء من الآبار النائية وفي رعاية الماشية والبحث عن ضوالها وحلبها وذبحها وسلخها عند الاقتضاء. وبذلك، علاوة على الحياة الجماعية المتآزرة التي يعيشها الطلاب ، تتحول المحضرة إلى مركز للخدمة الاجتماعية ومدرسة للحياة تعد الشباب لمواجهة أعباء الحياة السائدة في محيطهم وبيئتهم، وتضفي نكهة خاصة على الحياة الدراسية للطلاب.
المبحث الرابع: فاعلية المحضرة وخصائصها
اتسمت المحضرة بالفاعلية في السياق الاجتماعي والطبيعي الذي نشأت وازدهرت فيه، وسننظر إلى تجليات هذه الفاعلية من خلال الأثر الذي كان للمحضرة في محيطها وما كان لها عبر العالم من إشعاع، كما سنتطرق إلى خصائصها المميزة ونقاط قوتها وضعفها.
أولا – أثر المحضرة وإشعاعها
نلقي فيما يلي نظرة على أثر المحضرة في محيطها من خلال ستة زوايا تفصح عن نوعية مخرجاتها البشرية، هي القيم والمهارات، والحصاد الثقافي، ومقاومة المد التغريبي، والمساهمة في بناء الدولة الحديثة، والإشعاع الخارجي عموما، والإشعاع المؤسسي في إفريقيا خصوصا وفي السنغال بشكل أخص (حالة الدارة).
- القيم والمهارات
نجحت المحضرة في تنشئة أجيال متشبعة بالقيم، متعددة المهارات في حدود ما يتطلبه محيطها.
- أما في جانب القيم، فقد تميز التعليم المحضري بانعتاقه من إسار المادة ورغبات النفس الجامحة، وميلها إلى الدعة والسكون وحبها للعاجلة، فكان ذلك من أسرار نجاحه. وهكذا ربت المحضرة الأجيال على حب العلم والشغف به والتضحية في سبيله والصبر على طلبه وبثه، وأشاعت روح التطوع، وشجعت الحياة الجماعية والعشرة المشتركة والتعاون في مواجهة أعباء الحياة، هذا فضلا عن رسالتها الأساسية في غرس قيم التقوى ومثل البر في نفوس الناس.
- وأما في جانب المهارات، فإن المحضرة كانت – كما أسلفنا – مدرسة للحياة، تعود الشباب على الاخشيشان وتهيئهم لمغالبة الصعاب، وتؤهلهم لممارسة مهن عصرهم ومحيطهم، فالخريج المحضري في البادية مثلا كثيرا ما يكون مؤهلا للإفتاء -وربما القضاء- والتعليم والإمامة ورعاية الماشية وحلبها وبناء البيوت البدوية وجلب الماء وفتل الأرشية وقطاف القتاد والزراعة والتجارة والجزارة، وقد يكون ذا إلمام بالطب والبيطرة وغير ذلك من المهارات والمعارف التي تتطلبها الحياة البدوية. وبذلك تؤدي المحضرة إحدى الوظائف الأساسية التي لا تؤديها المؤسسات التعليمية المعاصرة، وهي خدمة المجتمع، وتكوين الإنسان متعدد المهارات. ولنسق مثالا من تجارب بعض العلماء المتقدمين، فقد كان الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الحافظ بن الطلبة من أجل مشايخ عصره، وأثر عنه أنه كان يخرج وقت العتمة يتجول بين خيام الحي، يسأل: من يبحث عن “حلاب” متوضئ، أي عمن يحلب له بقره أو إبله، ذلك أن مهنة الحلب كانت خالصة للعبيد في ذلك العصر، ولم يكونوا مضرب مثل في النظافة والتطهر، وكانت بعض الأسر لا تجد من يحلب لها مواشيها، فكان هذا الشيخ الجليل يترشح لهذه المهمة تطوعا. ويحكى أن العلامة البشير بن امباريكي كان في رحلة مع طلابه فطال بهم السفر في الصحراء ولا ما ء معهم، ومع المغرب، وصلوا إلى بئر التوامه، أطول الآبار الموريتانية الموجودة في إينشيري، وقد أجهدهم العطش، لكنهم لم يجدوا عند البئر أحدا ليسقيهم، فقال البشير لرفاقه: اقطعوا لي ما استطعتم من الحلفاء، ففعلوا وبات هو يفتل منها رشاء، فما أصبح الصباح حتى جهز رشاء طوله بعمق البئر، واستطاعوا عندئذ أن يمتحوا الماء ويشربوا. وقد سجل البشير هذه الليلة بقوله:
وليلة بت بها بالتوأمين طالت علي مثل طول ليلتين
فلا يسوغ مضجعي في الحالتين وفي جفون مقلتين حرتين
وكبدي من الظماء شعلتين لكنني من جلد للناظرين
أظهر أني رافل في حلتين من السرور والمنى ضافيتين
كأنني ما بت قط بالحرمين ولا لدى آل مامين الأكرمين
ولم أحرر ضحوة مسألتين من غامض مع فتيين حاذقين[79]
- الحصاد الثقافي
يتجلى الحصاد الثقافي للمحضرة في تخريج مجتمع شاعر عالم منتج ثقافيا، كما يشهد لذلك انتشار تعاطي الشعر قرضا ورواية في المجتمع الشنقيطي – الموريتاني، وطابع الفتوة، بمفهومها الشنقيطي، الذي يسم حياة السواد الأعظم ممن ارتادوا المحضرة،وهو أن يكون الفتى مشاركا، مؤهلا للمطارحة والمساجلة والمحاورة العلمية في مجالات مختلفة. كما يشهد له كثرة مؤلفات الشناقطة ومخطوطاتهم في شتى المعارف، وهو ما يمكن الرجوع فيه إلى كتابنا “بلاد شنقيط – المنارة والرباط”.
- مقاومة المد التغريبي
شكلت المحضرة قلعة حصينة احتمى بها المجتمع الشنقيطي في مواجهة المد التغريبي الذي حملته السلطات الفرنسية عند احتلالها البلاد. وقد تجسد ذلك في المظاهر الأساسية التالية:
- مقاطعة شاملة من المجتمع الشنقيطي للمدرسة الوافدة، كما سنرى لاحقا.
- تعبئة السكان لمواجهة السلطة الغازية بأساليب شتى. فلئن كان بعض المشايخ قد مال إلى المهادنة على أساس عقود موثقة تلزم الغزاة بعدم التعرض للناس في أمور دينهم، بل وعدم الطمع في مصاهرتهم، والاقتصار على تأمين الطرق وإرساء الأمن وإنهاء الحروب القبلية والقبض على أيدي قطاع الطرق، فإن طائفة كبيرة من العلماء ذهبت أبعد من ذلك إلى الفتوى إما بوجوب الجهاد المسلح أو بوجوب الهجرة عن البلد إذا تغلب الغزاة وانسدت أمام المقاومين سبل الجهاد. وهكذا قاد مشايخ أجلاء، مثل الشيخ ماء العينين، حركة المقاومة المسلحة، وسخر آخرون روائع شعرهم لتعبئة الناس للمقاومة، كما هو حال سيدي محمد بن الشيخ سيديا، وقاد آخرون حملة هجرة من البلاد هربا من مساكنة الغزاة المتغلبين كما هو شأن الشيخ محمد الأمين بن زيني الذي رافقه في هجرته نحو 600 فرد، استقر أغلبهم في لواء أضنة بتركيا، في أواخر عهد الخلافة العثمانية، وما تزال ذراريهم هناك. وتخلد اللهجة الحسانية الارتباط التاريخي بين المحضرة والمقاومة بإطلاقها اسم “مرابط” على العالم الكبير، فكأنه لا يكون عالما إلا وهو مجاهد، منذ أن تعانق القلم والسيف في رباط عبد الله بن ياسين قبل ألف عام.
- المساهمة في بناء الدولة الحديثة
قدر لموريتانيا، وقد قاومت المدرسة الفرنسية، أن تنشأ دولة مستقلة، وليس لها كفاءات بشرية مدربة مؤهلة للوفاء بحاجات الدولة في لبوسها الحديث. وقد واجه المجتمع الموريتاني في البداية خطر الاعتماد على فئة محدودة ممن درسوا في المدرسة الفرنسية من أهل البلاد ومن خارجها، مما سبب احتكاكا داخليا كاد يفضي إلى نشوب حرب أهلية، غير أن القابليات التي زودت بها المحضرة خريجيها مكنت كثيرا من هؤلاء من المشاركة النشطة في إدارة شئون البلاد، إما بتوظيف بعضهم مباشرة أو بإعدادهم إعدادا وجيزا أبدوا فيه لياقة فكرية عالية، فكانوا من أبرز بناة الدولة الموريتانية الحديثة. وكان من هؤلاء، على الأخص، معلمون وأساتذة، ورجال إدارة، وقضاة، بل إن أغلب أطر الدولة وكفاءاتها في مرحلة السبعينيات وما بعدها كانوا من خريجي المحضرة.
- الإشعاع الخارجي
مكنت المحضرة المجتمع الشنقيطي من ممارسة إشعاع واسع، في غياب دولة مركزية، فقد انتشر خريجو التعليم المحضري يبثون الدين في أرجاء إفريقيا، تجارا وباعة ماشية ومشايخ مربين. ويصرح رجل الإدارة الفرنسية بول مارتي Paul Marty ، تأكيدا لذلك بأنه لا يوجد في السنغال بيت إلا وله تلمذة على مشايخ موريتانيا. وقد امتد هذا الإشعاع إلى قاصية الربوع في إفريقيا، بل وفي المغرب والمشرق العربيين، وفي آسيا وأوربا، كما تشهد لذلك سير أعلام أجلاء من أمثال الشيخ أحمد بابا التنبكتي الصنهاجي والشيخ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم والشيخ المجيدري بن حبيب الله والشيخ محمد محمود الشنقيطي شيخ طه حسين والشيخ أحمد بن الأمين والشيخ محمد الأمين فال الخير والشيخ محمد حبيب الله بن مايابى والشيخ محمد الأمين بن محمد المختار (آبه بن اخطور) صاحب أضواء البيان وغيرهم. ففي سير هؤلاء ترجمة بليغة عن نوعية مخرجات المحضرة وعن إشعاعها الذي امتد إلى قاصية الديار.[80] ولنا شاهد على الإشعاع ذي الطابع المؤسسي في الدارة التي نشأت على مثال المحضرة، وأدت دورا شبيها بدورها في البلاد الإفريقية وخاصة في السنغال.
- الدارة.. محضرة إفريقية
كان من أبرز تجليات الإشعاع الخارجي للمحضرة أن انتشر التعليم العربي الإسلامي في البلدان الإفريقية ونشأت فيها مؤسسات تحاكي المحضرة في سعيها لنشر الثقافة العربية الإسلامية. ولئن تعددت أسماء تلك المؤسسات (الدارة في السنغال، الماكارنتا في مجتمعات الهوسا بنيجيريا والنيجر وغيرهما، الدودال في مجتمعات الزرما) فإن هذه المؤسسات كانت بوجه عام نسخا محضرية مطوعة للبيئة الإفريقية. وقد ظهرت أولى هذه المؤسسات في بير بالسنغال، قبل بضعة قرون. وتخليدا لها تستضيف هذه القرية اليوم كلية للدعوة الإسلامية أنشئت بدعم من جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بليبيا.
وكان من المشايخ الأجلاء الذين نشروا التعليم القرآني والشرعي في السنغال وبلدان الجوار الإفريقي الحاج مالك سي والشيخ أحمد بمبا والحاج عبد الله نياس وأبناء العلامة المجاهد الشيخ عمر بن سعيد الفوتي. وقد بلغت العناية بالتعليم أوجها مع سطوع نجم الشيخ إبراهيم نياس الكولخي الذي جمع بين توجهين، فكان يرسل بأبنائه والصفوة من أبناء مجتمعه إلى موريتانيا ليتعلموا القرآن ويتقنوا مخارج اللغة العربية ويتعلموا مبادئ من علوم الدين واللغة. لكنه في الوقت ذاته أنشأ شبكة من الدارات استقدم لها معلمين ومعلمات من موريتانيا، كما أنشأ معهدا سماه باسم والده الحاج عبد الله نياس خصصه لتعليم الناشئة على المنهج العصري، تمهيدا لإرسالهم إلى الأزهر أو المغرب لاستكمال دراساتهم الجامعية في البلدان العربية. وتواصل سليلته الشيخة مريم نياس أداء تلك الرسالة من خلال مؤسستها المشهورة في السنغال “دار القرآن” التي يوجد لها مقر رئيس في دكار وفروع في مناطق أخرى، وهي تزاوج في هذه المؤسسة بين نظامين تعليميين، أحدهما تعليم قرآني صرف والثاني تعليم نظامي عربي إسلامي. ويشكل الموريتانيون الأغلبية الساحقة من مدرسي المؤسسة بشقيها. وقد أطلق الرئيس السنغالي عبد الله واد برنامجا جديدا لتطوير الدارات، وأنشأ بموجبه مجموعة من الدارات العصرية خصصت لكل منها مساحة 4.5 هكتار من ضمنها مساحات مخصصة للزراعة وتنمية الماشية ومعامل للتكوين الحرفي.
تتفق الدارة مع المحضرة في جوانب عديدة من المنهج، وإن كان التركيز فيها أكبر على الفقه والسيرة النبوية والأخلاق، باعتبار اللغة العربية وآدابها مادة يحتاج طالبها أكثر من غيره إلى مساكنة العرب الجيران والتتلمذ عليهم. فالغالب أن تهتم الدارة بتعليم القرآن الكريم، أو أجزاء منه وأن يرسل التلميذ من بعد إلى موريتانيا لاستيفاء دراسته. وتتم دراسة القرآن في الألواح وبطريقة مشابهة لطريقة تدريسه في موريتانيا، غير أن بعض الأوساط تطلق على السور أسماء محلية محرفة أو مختصرة، فيسمون سورة آل عمران ( آلي) والأنبياء (لاميي ) والعنكبوت ( أنكا )، ويترجمون أسماء بعض السور إلى اللغة المحلية فيسمون سورة النساء – مثلا- ( جيكين).
وقد توسعت بعض الدارات في تدريس المعارف الأخرى، وشمل منهجها المواد والمتون التالية:
- التوحيد : عقيدة الباجوري.
- الفقه : العشماوية والرسالة وابن عاشر ومختصر خليل.
- النحو والصرف : الآجرومية ، وملحة الإعراب وألفية ابن مالك واحمرار ابن بونه عليها.
- البلاغة : تبصرة الاذهان للجكني.
- المنطق : سلم الأخضري.
- مصطلح الحديث : المنظومة البيقونية وطلعة الأنوار لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم.
- الاصول : تسهيل الطرقات في نظم ورقات إمام الحرمين للعمريطي.
- السيرة : المغازي للعلامة البدوي.
- التصوف : خاتمة التصوف لليدالي، الحكم لابن عطاء الله ، وبعض مؤلفات شيوخ الطرق الصوفية بالبلاد.
- الأدب: بانت سعاد لكعب بن زهير ، بردة المديح والهمزية للبوصيري، مقامات الحريري، المعلقات.
ويلاحظ من تأمل هذه العناوين التواشج الكبير بين الدارة والمحضرة، والحضور الملحوظ لمصنفات الشناقطة في منهاج الدارة السنغالية.
ولعل الدارة السنغالية امتازت عن المحضرة بارتباط أكبر بالأرض، ذلك أن الدارة السنغالية كانت حاضرة في مجتمعات ريفية قروية زراعية يغلب عليها الاستقرار وأن طلبتها كانوا كثيرا ما يرسلون إلى الحقول للعمل فيها بشكل مبرمج أو على سبيل العقوبة. وقد نجحت الدارة، في تكامل غالبا مع المحضرة المجاورة، في تكوين شخصيات متعددي المهارات (المرابط المعلم الشيخ المربي، المزارع أو الصياد أو التاجر…).
ثانيا – عناصر قوة المحضرة وضعفها
- لخصائص المميزة للمحضرة
تشترك المحضرة مع مؤسسات التعليم الأصيل في خصائصها المشتركة المشار إليها في الفقرة (ثانيا- الخصائص والسمات) من المبحث الأول (عن النظام التربوي الأصيل)، وتنفرد المحضرة بميزة أساسية هي أنها المؤسسة العلمية اليتيمة التي ازدهرت في رحاب البادية، ونجحت في صياغة مجتمع بدوي عالم، فكان ذلك خرقا لقوانين علم الاجتماع القاضية بأن العلم ربيب الحضارة، كما يقول ابن خلدون.
وإلى ذلك، يحسن التذكير بسمات بارزة طبعت الحياة المحضرية بطابع أخص، منها:
- الترويض على كبد الحياة والتعايش مع الناس وخدمتهم. وتتحقق للمحضرة هذه الوظيفة بحكم ما تعرض له طلبتها من مشاق الترحال المتكرر ومستلزماته من تقويض للخيم وبناء لها وللأعرشة والحظائر ومعاناة لمشقة السفر ونشدان الضوال والسقاية وغير ذلك من تكاليف الحياة البدوية. كما تتعزز هذه الوظيفة أيضا بالسكن الجماعي والدرس الجماعي ونظام الراحلة الذي يقتضي من الطلبة أن ينتظموا في مجموعات عمل متآزرة متعاونة. وعلاوة على ذلك كله، فإن شح الموارد وشظف العيش في المجتمع المحضري يقوي من مناعة الطلبة ويزيد من قدراتهم على مواجهة مشاق الحياة بجلد قلما يتوفر لمن يعيشون في المجتمعات الحضرية أو القروية المستقرة، خاصة منها تلك التي تتوفر لها بيئة مادية ملائمة. وإلى ما ينتج عن هذه التربية الخشنة يشير ما ورد في الأثر: “اخشوشنوا تمعددوا فإن النعم لا تدوم”. وقد أوصى الغزالي من هذا المنطلق بتعويد الطفل على الاخشيشان في المأكل والملبس لتتصلب أعضاؤه. وفي مثل ذلك يقول الشيخ إبراهيم نياس الكولخي، إن الإنسان إذا جعل حديدا في الصغر صار ذهبا في الكبر، وإذا جعل ذهبا في الصغر صار حديدا في الكبر. ويعني بذلك أن الحديد معرض للطرق والصدأ بينما العادة أن يصان الذهب وأن لا تزيده النار إلا جلاء ونضارة. وتؤكد دراسة يابانية حديثة صحة هذه النظرية، حيث خضع آلاف من التلاميذ لتجربة علمية، وضع قسم منهم في ظروف حرجة، لا يحظون فيها بعناية صحية ملائمة ولا يحتاطون من البرد وتقلبات الطقس، وأحيط نظراؤهم بكل العناية المعهودة في المجتمعات الحضرية المعاصرة، فتبين أن أولئك تمتعوا بمناعة أكبر في مواجهة الأمراض.
- المزاوجه بين فردية التعليم وجماعيته. وتتجلى هذه المزاوجة في ثلاثة عناصر أساسية:
- إعطاء الطالب حق الانفراد بالدرس، فيختار المتن الذي يشاء والحصة الدراسية التي تناسب قدراته؛
- تشجيع الطلبة ذوي الاهتمامات المشتركة على تكوين “دول” وهي في الاصطلاح المحضري زمر تعليمية مصغرة تشترك في دراسة متن واحد وتتعاون على تكراره؛
- إفساح المجال أمام جميع الطلبة، بل ومن شاء من أهل الحي وضيوفه، لحضور مختلف الدروس. وينتج من ذلك أن تتهيأ للطالب – علاوة على درسه الخاص به – فرصة ترسيخ معارفه السابقة أو اكتساب معارف تمهيدية جديدة من خلال الاستماع اليومي للدروس التي تقدم للآخرين.
- طوعية الممارسة، وقوامها أن يقدم الشيخ دروسه لطلبته دون مقابل مادي، لكنه يقبل منهم ومن أولياء أمورهم ما يقدمونه من هدايا طوعية، كما يقبل منهم خدمته والقيام في شئون بيته. وتساعد هذه الخصلة في تحقيق “ديمقراطية التعليم ومجانيته” حيث لا يخشي أي طالب الطرد لعدم تمكنه من دفع الرسوم. كما أن العملية التعليمية تصبح مجالا رحبا للمكارمة، عبر الهدايا التي لا يعتبرها الشيخ فريضة مستحقة، فيحجم عن العطاء العلمي إذا لم تؤد إليه، ولا يعتبرها الطالب عبئا ملزما فيستثقله من شيخه، و ينفر منه أو من الدراسة جملة، أو يحمله وهو كاره له ولما يقترن به.
- عناصر قوة المحضرة
تكشف المباحث السابقة جملة مهمة من نقاط قوة المحضرة، نستطيع أن نستعيد منها على وجه الاختصار والإضافة النقاط الأساسية التالية:
- الرصيد الحضاري والفاعلية المشهودة في المجتمع الشنقيطي التقليدي، فقد أنتج التعليم المحضري على مدى القرون بشرا عالمين عاملين، كانوا في محيطهم، وحيثما حلوا، قدوة بمعارفهم ومهارات عصرهم وقيمهم المجسدة في سلوك حي مشهود. وكذلك كانوا بآثارهم الباقية من مصنفات غزيرة ومدونات أدبية بديعة. وفي ذلك ما يشجع على الاستمداد من تجربة المحضرة، في السعي لصياغة مجتمع معاصر فاعل ومؤثر في عصره وفي بيئته.
- المرونة: تعتبر المحضرة مؤسسة مرنة غير معقدة، فهي لا تحتاج إلى بنى تحتية كبيرة ومتعددة كالتي تحتاجها المؤسسات التربوية المعاصرة، فباستطاعة شيخ المحضرة، إذا لم تتوفر لديه قاعة مخصصة لأغراض التدريس، أن يدرس في حجرة من بيته أو في فناء البيت أو في المسجد أو في خيمة أو عريش أو تحت ظل شجرة، بل إن من عاداتهم أن لا يشغلهم التنقل بين بيوتات الحي أو النزهة خارجه عن التدريس، فترى الشيخ يدرس أحيانا ماشيا أو راكبا ومعه زمرة من تلامذته. كما أن المحضرة، في صيغتها التقليدية، لا تحتاج إلى ملاك بشري مكلف، له مرتبات وحقوق وامتيازات مادية ملزمة.
- القناعة: تعتبر المحضرة في مرونتها المشار إليها مؤسسة قنوعا، محدودة التكاليف، خاصة إذا قيست بالمدرسة النظامية عالية الاستهلاك. ولكن قناعتها تلك رهينة ببقاء منظومتها التقليدية على وضعها الأصيل، بما يعنيه ذلك من استمرار الطابع الطوعي للتعليم، وتكافل المجتمع في رعاية الطلاب المعوزين واستغلال الفضاءات المتاحة للتدريس من بيوت ومساجد وساحات أو قاعات قليلة العدد مخصصة لأغراض التدريس، والاقتصاد في استهلاك الورق، استغناء في حالات كثيرة بالكتابة في الألواح. ومن الطبيعي أن يتغير هذا الوضع بتغير الظروف، فالتوجهات السائدة لتطوير التعليم المحضري في الوقت الراهن تجنح إلى إعادة تعديل هذه المنظومة على أسس جديدة قد تضاعف من الأعباء المادية للتعليم المحضري، لكنها ستظل على الأرجح أقل إجحافا من أعباء التعليم النظامي الوافد.
- الخلو من منغصات التعليم النظامي، وخاصة ما يشل حركته غالبا من إضرابات واحتجاجات تحركها دوافع سياسية أو نقابية أو مادية. فالتعليم المحضري القائم على الممارسة الطوعية والدافعية الذاتية العالية محصن بطبيعته من هذه الظواهر غير الصحية.
- عناصر ضعف المحضرة
إلى جانب نقاط القوة تلك، هناك نقاط ضعف تهدد المحضرة وتحد من مناعتها في مواجهات عاديات الزمان المعاصر وغوائله. ولعل من أبرز تلك النقاط:
- التراجع الكبير للنظام التعليمي الأصيل تحت ضغط التحولات الاجتماعية والتربوية والاقتصادية العاصفة التي يشهدها المجتمع الموريتاني، خصوصا منذ حقبة الستينيات من القرن الغريغوري العشرين، فقد تقلصت إلى حد كبير أعداد المحاضر تحت وطأة الجفاف والتصحر وما نتج عنهما من نزوح المجتمع البدوي نحو المراكز الحضرية الكبرى، وتغير أنماط الحياة الاقتصادية التي كانت المحضرة تعتمد عليها. كما أن استقلال البلاد أسقط الحاجز النفسي الذي جعل المجتمع الزاوي الموريتاني يعزز من اعتصامه بالمحضرة واحتمائه بها في وجه المدرسة النظامية الوافدة، فقد بدأ الأهالي يرسلون أبناءهم إلى مدرسة أصبحت تعتبر في نظرهم مدرسة وطنية، وتطورت أعداد الدارسين في النظام التربوي الجديد، حتى أصبحت موريتانيا من أرفع نظائرها نسبة تمدرس (نحو 95%). وكان لذلك انعكاسه السلبي على انتشار التعليم المحضري.
- وقد تعززت المنافسة الشرسة للمحضرة، بقصور مناهجها عن الوفاء بالحاجات المستجدة للعصر، وبما أتاحته المدرسة النظامية الوافدة لخريجيها من آفاق عمل وفرص كسب ونفوذ، فبينما كانت المحضرة أقدر مؤسسات المجتمع العتيق على صناعة المجد وتأمين الحياة المستقرة الشريفة لأبنائها، أخذت المدرسة النظامية تختطف منها تدريجيا ذلك الدور. وكادت تستأثر عنها بالأهلية لإطعام الناس، بل إنها استأثرت فعلا بالتحكم في مصائر الناس وإدارة دفة الشأن العام. ولا تتمتع المحضرة على هذا المستوى بأي قدرة تنافسية تذكر، إلا في حالات نادرة حين يتخرج منها نوابغ يرجع إليهم في مجالات العلم التقليدي أو في حالات أخرى يتمكن فيها طلبة المحاضر من اختراق النظام التعليمي الوافد والتزود منه بالمؤهلات الورقية المطلوبة للتعيين في الوظائف وببعض المهارات والخبرات الإضافية التي لا تتيحها المحضرة.
- يعاني التعليم المحضري من قصور نسبي فيما يتصل خاصة بمهارات التواصل والقدرة المنهجية على توظيف المعارف والخبرات المكتسبة، فكثيرا ما تخرج المحاضر علماء متضلعين، لكنهم غير قادرين أحيانا على التواصل المؤثر، سواء من خلال الكتابة الأدبية بالأساليب المعاصرة أو من خلال الخطابة والشرح والتحليل والإفصاح والإبانة والترتيب المنهجي للمعارف، هذا على الرغم من أن المحضرة خرجت نوابغ من ذوي العقل المنظم والفكر المرتب، كما يشهد لذلك عدد كبير من مصنفات الشناقطة.
- يواجه التعليم المحضري في موريتانيا المزيد من مخاطر الاستنزاف الخارجي، ليس فقط بسبب ضرته الكبرى (المدرسة النظامية الوافدة)، وإنما أيضا بسبب النزعة السائدة المهيمنة لتحديث المحضرة وتطويرها بدافع الشفقة عليها والحرص على مواءمتها مع احتياجات العصر. فقد تكاثرت مبادرات تأسيس المعاهد المحضرية، وأصبحت المحضرة التقليدية تواجه من خلالها ضرائر من نمط جديد، لعلها أخطر عليها – وإن شكليا- من المدرسة النظامية الوافدة. وسنتناول تجربة هذه المعاهد في مبحث مستقل. ومن ناحية أخرى، هناك طلب متنام من بعض البلدان العربية (خاصة دول الخليج واليمن) على خريجي التعليم المحضري. ومن شأن ذلك أن يساهم في استنزاف الثروة البشرية التي يعتمد عليها لتجديد دماء المحضرة وتنميتها داخل موريتانيا ذاتها. لكن من فوائد هذه الحركة أنها تتيح للمزيد من الأشقاء العرب فرصة الاستفادة من المنتوج المحضري الشنقيطي، كما أنها تعين طلبة المحاضر على مواجهة الضغط الناتج عن اعتقاد كثير من الناس أن المدرسة وحدها –لاالمحضرة- هي التي تستطيع أن تطعم من جوع.
- يؤخذ على التعليم المحضري عدم مساهمته في الإعمار والتشييد المادي. وهذا أمر صحيح، فقد ازدهر التعليم المحضري أكثر ما ازدهر في ربوع البادية. ولم يكن من هم أهله -إلا نادرا- الاستقرار والانشغال بالعمارة المادية للأرض. ومع ذلك فإن كثيرا من حواضر البلاد نشأت على أيدي علماء مهاجرين، بل تكاد تكون خلف نشوء كل مدينة قديمة قصة هجرة عالم. ولنضرب على ذلك مثلا بشنقيط الثانية وتيشيت ووادان وتجكجة وغيرها، فهي حواضر أسسها علماء مهاجرون. كما أن رسالة المحضرة البدوية كانت رسالة إعمار معنوي بالغة الأهمية لمجتمع تقليدي يعيش على الانتجاع. ولعل الضرب في عرض الصحراء وطولها كان صيغة من صيغ الإعمار الوسيطة لهذه الأرض اليباب، حيث كان تنقل البدو في أرجائها أفضل وسيلة متاحة لاستكشاف الأرض واستغلال خيراتها وبسط السيطرة عليها. ومن المهم أيضا الإشارة إلى أن المجتمع البدوي المحضري كان مهتما بتنمية الماشية والزراعة وهما من أهم وسائل إعمار الأرض، وقد كتب له في ذلك قدر من النجاح.
الفصل الثاني: العلاقة بين النظامين
شهدت العلاقة بين النظامين التربويين التالد والطارف حالات مختلفة ومتباينة من التدافع والتنابذ إلى التحاور والتجاور، وصولا إلى نسبة من التواصل والتواشج.
المبحث الأول: المواجهة بين النظامين
كانت مرحلة الاستضعاف الفرنسي لأهل البلاد مرحلة مواجهة حادة بين النظامين التربويين، تجسدت في اتجاهين، كان أحدهما اتجاه غزو وضغط من النظام التربوي الوافد مدعوما بسلطة الاستكبار الغربي، بينما كان الثاني اتجاه ممانعة ورفض من النظام التربوي الأصيل.
أولا – الغزو التربوي
بغض النظر عما ذكرناه في مبحث “التعليم الوافد: النشأة…”، نريد هنا أن نشير بشكل خاص إلى محطات الغزو التربوي الأساسية وما رافقها من تطور في أنماط هذا الغزو. وينبغي أن نلاحظ بدءا أن الحرب على النظام المحضري كانت في جانب منها حربا استباقية بدأت بالحزام المحضري في السنغال، فاستهدفت درات تعليم القرآن في هذا البلد. وكان إنشاء التعليم العلماني (اللائكي) عام 1854غ محاولة من سلطة الاستضعاف للنجاح فيما لم تنجح فيه المدارس الكنسية السافرة. وقد تأسست لهذا الغرض مدرسة لأبناء الأعيان سنة 1272 هـ/1855غ.
وفي 22 يونيو 1857غ، أصدر الحاكم الفرنسي فيدرب المقرر رقم 96 القاضي بإخضاع “المدارس الإسلامية” لرخصة من السلطة الفرنسية. ونصت المادة 2 من هذا المقرر على أن هذه الرخصة لا يمكن أن تمنح إلا لأبناء سان لويس (عاصمة الإدارة الاستضعافية) أو لمن أقام فيها لمدة 7 أعوام. وكان من أهداف هذا القيد الجلية استبعاد المدرسين الشناقطة، وحصر الرخصة فيمن يقعون تحت نظر السلطة الغازية. وفي مادته الخامسة نص المقرر المذكور على إلزام أصحاب المدارس القرآنية بإرسال تلامذتهم ممن هم في سن الثانية عشرة فما فوق كل مساء إما إلى المدرسة الفرنسية الحكومية أو إلى مدرسة الإخوة (الكنسية).[81] وتطبيقا لهذا المقرر أصدر الحاكم الفرنسي بتاريخ 1 أكتوبر 1857 قرار يأذن بالعمل لـ25 مدرسة من أصل أكثر من 250 في اندر بالعمل. ونص هذا القرار في مادته الثانية على منع هذه المدارس من استقبال الفتيات بحجة أن شيوخها رجال. وقد تطورت المواجهة في قرار آخر بتاريخ 9 مايو 1896 إلى حد منع المدارس القرآنية من استقبال الأطفال ما بين سن السادسة والخامسة عشرة في أوقات عمل المدارس الفرنسية[82]. وقد طورت الإدارة الفرنسية من أساليب المواجهة فجمعت بين الترغيب والترهيب، ووصلت إلى حد إعلان إدراج اللغة العربية في مدارسها، في سعي منها لاستدراج الأسر وللاستحواذ على أكبر عدد ممكن من تلامذة المدارس القرآنية.
ثانيا – الممانعة المحضرية
حين عبرت الجيوش الفرنسية نهر السنغال إلى موريتانيا وبدأت تحكم عليها قبضتها، سعت الإدارة الفرنسية إلى افتتاح مجموعة من المدارس في الأراضي الموريتانية متوسلة لذلك في جل الحالات بإدراج التعليم العربي. ورغم ذلك واجه المجتمع الشنقيطي هذه المؤسسة التربوية الدخيلة بالرفض والممانعة. وبادر عدد من شيوخ المحاضر إلى تحرير فتاوى تحرم إرسال الأطفال إلى المدرسة الوافدة. ونسوق– مثالا على ذلك- فتوى للعلامة محمد سالم بن آلما يقول فيها: “لم أفهم أحدا لم يزل يسأل ربه عزو وجل أن يرزقه ولدا صالحا تقر به عينه ، تقيا، كما فسر به الطبري قوله تعالى: {ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين}، ويرجو أن يدعو له في قبره كما في الحديث “وولد صالح يدعو له بالخير”، ويرجو أن يجمعهما الله بفضله في الجنة بوعده الصادق في قوله عزو وجل {ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم}، فما من الله عليه به تركه حتى إذا أوقدت الفتن نيرانها من كل جهة وأظلم جو السنة بدواجن البدع العامة وناء الدين بكلكله ذاهبا، أخذه فعرضه لهذه الفتن اختيارا بالدخول تحت سيطرة السلاطين لتعلم لغة النصارى والعلوم العصرية ويتركه من كتاب الله الذي {لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد} رغبة في الحطام الفاني وإيثارا للمراكز الخبيثة كأن أبواب الرزق قد أغلقت إلا هذا الباب وحده الذي أحدقت به الفتن من كل جهة”[83]. وهكذا كان الإقبال على المدرسة الوافدة طيلة عهد الاستضعاف ضعيفا، كما رأينا سابقا.
المبحث الثاني: التواصل بين النظامين
سنعرض لصور من هذا التواصل في عهدي الاستضعاف والاستقلال.
أولا – في عهد الاستضعاف
ظهرت المحاولات الأولى لتحقيق نسبة من التقارب بين النظامين التربويين عن الإدارة الفرنسية الغازية ذاتها، ولم يكن هذا المسعى خلوا من الكيد، إذ كان الهدف منه استدراج السكان ليقبلوا دراسة الفرنسية. وقد اتسمت المساعي الفرنسية في هذا الشأن بمقدار كبير من الصبر والمثابرة، على مدى عقود من الزمن. وكانت الخطوة الأولى اعترافا بواقع حضور اللغة العربية سعيا لتجاوزه، ويتلخص مسار المدرسة الوافدة “للتقرب” من النظام التربوي الأصيل في الخطوات والمحطات التالية:
- 1883: قررت الإدارة الفرنسية أن لا تعين معلما instituteur جديدا في مدارسها الحكومية بالسنغال إلا إذا كان يتحدث العربية ويكتب بها. وأسندت إلى هذه الفئة من المدرسين مهمة تدريس العربية، بل أذنت في اللجوء إلى “مرابط” (شيخ معلم) إذا لم يتوفر مدرس موظف يعرف العربية.
- 1886: تقرر إدماج العربية إلى جانب الإنجليزية في مرحلة التعليم الثانوي. ويخدم هذا الإجراء وسابقه الأغراض الاستراتيجية والتكتيكية معا للإدارة الفرنسية، حيث كانت بحاجة إلى وكلاء يعرفون هذه اللغة، وكان هذا الموقف قابلا للتوظيف الدعائي لدى السكان.
- 1896 (9 مايو): اشترطت سلطة الاحتلال الخبرة بالعربية لدى مدرسي القرآن. وقد ورد هذا الشرط في نفس القرار الذي يمنع عمل المدارس القرآنية في الأوقات التي تعمل فيها المدرسة الفرنسية. وكان من أهدافه إيهام السكان باهتمام السلطة الغازية بالمستوى العلمي لمدرسي القرآن، والسعي في الوقت ذاته إلى تقليص عدد المدرسين، فقد كان من المألوف في الأقطار الإفريقية أن يوجد حفظة ومعلمون يتقنون حفظ القرآن وتدريسه دون أن يكونوا متمكنين من اللغة العربية.
- 1908(15 يناير): صدر القرار 68 المؤسس لمدرسة سان لويس العربية الفرنسية. وقد نص على أن يكون معلمو المدرسة من الجزائر.
كان تأسيس هذه المدرسة تدشينا لعهد جديد من المواجهة الذكية بين النظامين، يطبعه سعي المدرسة الوافدة للتأقلم مع البيئة الثقافية الاجتماعية الجديدة. وفي هذا الصدد، افتتحت مدرستان مماثلتان في مالي في مدينتي جنة وتنبكتو، وهما واندر (سان لويس) مدن وثيقة الصلة جغرافيا وبشريا وتاريخيا وإداريا ببلاد شنقيط. ولهذا كان افتتاح المدارس بها تمهيدا لا بد منه لتطبيق التجربة في “أرض البيضان”[84].
وكانت مدرسة بوتلميت[85] التي زاولت نشاطها عام 1914غ أول مدرسة وافدة تفتح أبوابها في محيط عربي بما أصبح يعرف بموريتانيا. وقد تعاملت الإدارة الفرنسية بحذر وحيطة مع هذه المدرسة، فأدرجت فيها مواد عربية حتى لا يرفضها السكان، وقصرت إدارتها على مدرسين مستقدمين من الجزائر متشبعين باللغتين العربية والفرنسية.
ولشدة مقاومة العرب للمدرسة الفرنسية حتى في لبوسها ثنائي اللغة لم تتمكن فرنسا من افتتاح مدرستها في أطار عام 1936غ إلا بعد أن أعلنتها مدرسة عربية خالصة، تعليم العربية فيها إلزامي، بينما تدرس الفرنسية فيها بشكل اختياري. ولم تلبث بعد أن استقرت المدرسة في بيئتها الجديدة أن أخذت في رفع نسبة حضور الفرنسية فيها تدريجيا، وحولتها عام 1944غ إلى لغة إجبارية طبقا لقرار أصدرته بتوحيد لغة التعليم في البلاد المستضعفة، ومع ذلك فقد طبق هذا القرار بكثير من المرونة في موريتانيا مراعاة لخصوصية وضعها.
ورغم هذه “التنازلات” فإن السكان لم يمنحوا المدرسة الوافدة ثقتهم إلى أن انتهى عهد الاستضعاف المباشر بحصول البلاد على استقلالها عام 1960غ.
ثانيا – في عهد الاستقلال
حطم الاستقلال حاجز الخوف والريبة الذي كان يمنع السواد الأعظم من سكان البلاد من إرسال أبنائهم إلى المدرسة. وتوافرت أجواء جديدة، استثمرتها الدولة الوطنية في موريتانيا لنشر التعليم المدرسي على حساب التعليم المحضري. وكان لا بد لها في هذا الصدد من تعزيز مسالك التواصل بين النظامين لتعزز الثقة في المدرسة. وقد تحقق لها بمد جسور بين النظامين كان أبرزها جسر المناهج الدراسية وجزر الإجراءات التنظيمية.
- جسر المناهج الدراسية
يعود هذا الجسر إلى عهد الاستضعاف، كما أسلفنا، وقد أسندت فيه مهمة أساسية إلى معهد أبي تلميت للدراسات الإسلامية الذي كان مؤسسة تعليمية منظمة تستقبل طلبة المحاضر وتقدم إليهم برنامجا دراسيا يتقاطع في جل مضامينه مع البرنامج المحضري. وقد عزز مكانة هذا المعهد إسناد التدريس فيه إلى نخبة من شيوخ المحاضر. لكن طاقة استيعاب المعهد كانت محدودة، ولذلك لم يكن باستطاعة أي طالب الالتحاق به إلا عبر مسابقة. وكان على الدولة أن تسير قدما نحو زرع الثقة بين المجتمع والمدارس النظامية الموروثة عن قوى الاستضعاف الأوروبي.
وكان القرار الرسمي القاضي بازدواجية التعليم (1966) أول خطوة ذات بال تهدف إلى إحلال اللغة العربية في المدرسة الوافدة محل الشريك الند للغة الفرنسية. وقد تعزز هذا التوجه لاحقا (1973) بالقرار القاضي بتعريب التعليم، وكان ذلك مدعاة لاطمئنان السكان إلى المدرسة وقبولهم التدريجي بها شريكا للمحضرة، بل وبديلا عنها في كثير من الحالات. وتعزيزا لهذا التوجه، أدخلت في امتحانات شهادة البكالوريا الوطنية (الثانوية العامة) ابتداء من سنة 1974غ شعبة “الآداب الأصلية”. وكان أغلب من حصلوا عليها من خريجي التعليم المحضري. وبتعريب التعليم (خطوة تم التراجع عنها نسبيا بعد سنوات)، أغلق معهد أبي تلميت لانتفاء الحاجة الخاصة إليه، وأصبحت المدارس عامة مؤهلة نسبيا لخلافته في مهمته المتمثلة في اصطياد طلبة التعليم المحضري.
- جسر الإجراءات التنظيمية
دخلت مراجعة مناهج التعليم (خاصة ما يتصل بتعزيز مكانة اللغة العربية) ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الدولة للربط بين المحضرة والمدرسة (وإن على حساب الأولى) والاستفادة من طاقات التعليم المحضري عموما في بناء مرافق الدولة الحديثة. وكان من بين هذه الإجراءات:
- اختيار معلمين وحكام وقضاة من خريجي التعليم المحضري وإخضاعهم لتكوين أكاديمي عصري؛
- إنشاء شهادات مكيفة مع الواقع التربوي للمجتمع المحضري، وكانت أولى هذه الشهادات شهادة الكفاءة التي أنشئت في الستينيات وأتاحت لعدد مهم من خرجي التعليم المحضري أن يصبحوا معلمين في المدارس النظامية الوافدة. وقد جاء تأسيس البكالوريا الأصلية خطوة على هذا الطريق.
- إنشاء المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية سنة 1979. وقد منح صلاحية استقبال حملة البكالوريا مباشرة، وتنظيم مسابقة للمترشحين من طلبة المحاضر، وتمكين الناجحين في المسابقة من الالتحاق به.
- تأسيس مجموعة من مراكز التكوين المهني، موجهة أصلا نحو استقبال خريجي المحاضر وتزويدهم بمهارات مهنية وحرفية، تعينهم على الاندماج النشط في الحياة العامة.
- الإذن لطلبة المحاضر بالترشح الحر لنيل الشهادات ما قبل الجامعية دون اشتراط التدرج التعليمي. وقد تعزز هذا الإجراء في مرحلة من المراحل بالسماح بالاستماع الحر في الإعداديات والثانويات. لكن الدولة أغلقت من بعد هذا الباب.
ورغم ما تشف به هذه الإجراءات من اهتمام بالمحضرة وسعي للاقتراب منها، وحرص على تأمين آفاق العيش الكريم لخريجيها، فإنها كانت – في وجه العملة الآخر – حربا على هذه المؤسسة العتيقة عرضتها لحركة استنزاف متواصلة.
وقد كان للوسط المحضري نسبة من المبادرة في السعي للربط بين النظامين بأسلوب مختلف شيئا ما عن الأسلوب الذي اتبعته الجهات الحكومية، وذلك ما سنتطرق إلى نماذج منه في مبحث المعاهد المحضرية..
المبحث الثالث: تجربة المعاهد المحضرية
أولا – النشأة والتاريخ
عرفت موريتانيا، خاصة في فترة ما بعد الاستقلال انتشارا واسعا لنموذج من المؤسسات التعليمية حاول أصحابه التوفيق من خلاله بين المحضرة والمدرسة، فأخذوا من المحضرة جل مضامين التعليم وأخذوا من المدرسة نظمها وتراتيبها.
وكان من بين هذه المؤسسات ما انحصر في مراحل التعليم العام، ومنها ما اتجه نحو التعليم الجامعي. أما الفئة الأولى فمن أبرزها:
- شبكة مدارس الفلاح التي أسسها المرحوم الحاج محمود باه عام 1360هـ/ 1941غ. وقد بدأت بمدرسة بسيطة في قريته “جول” بجنوب موريتانيا ثم توسعت فافتتحت فروعا داخل موريتانيا وخارجها، وخاصة في السنغال ومالي وغينيا وليبريا والكاميرون وزايير والكونغو. وكان وجه الشبه بين هذه المدارس وبين المحضرة هو تفرغها لنشر التعليم العربي والدراسات الإسلامية، غير أنها انتظمت في قالب مؤسسي متدرج من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية، وكانت تزود طلبتها بشهادات وتبحث لهم عن فرص لمتابعة الدراسة النظامية في الأزهر الشريف وبعض المؤسسات التربوية الإسلامية في البلدان العربية.
- شبكة مدارس ابن عامر التي أسسها المرحوم محمد الأمين الشيخ يوم الأحد 29صفر 1383هـ/ 21 يوليو 1963غ، وأعطاها اسم أبي بكر بن عامر أبرز أمراء دولة المرابطين في منشئها من بلاد الملثمين (موريتانيا). وقد وجهها لتدريس المعارف الأصلية السائدة، وأضاف إليها بعض العلوم العصرية ورتبها في مراحل تبدأ من الابتدائية وتنتهي بالثانوية. وقد غطت هذه المدارس جل المراكز القروية والحضرية في موريتانيا، وأخذت من المحضرة أساليب مبسطة في الإدارة، فكانت تكتتب في كل حي تفتح فيه فرعا جديدا مدرسا أو مدرسين من أهل الحي ومديرا مشرفا غير متفرغين توفر لهم مبالغ رمزية زهيدة تشجيعا على عمل كان عليهم أن يقوموا به على سبيل التطوع. ولا تسلم هذه المبالغ إلا دفعة واحدة في ختام السنة الدراسية، وبعد استلام التقارير.
- وأما الفئة الثانية (المؤسسات الجامعية) فمن أبرزها معهد خالد بن الوليد الذي جمع بين المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية، ومعهد إبراهيم الخليل وقد سار على النهج ذاته، ومعهد ابن عباس، وقد تمحض للدراسة الجامعية، وكان له حظ أكبر من الاستمرارية. ويعود الفضل في تأسيس هذا المعهد الجامعي إلى “لجنة المساجد والمحاضر” التي أنشأتها مجموعة من رجال الأعمال المحسنين. وقد تأسس يوم السبت 8 ربيع الأول 1405هـ/ فاتح ديسمبر 1984غ.
ثانيا – المناهج والنظم
اتفقت هذه التجارب جميعها في الالتقاء مع المدرسة الوافدة باستيحاء نظمها وجانب من مضامين التعليم فيها، والانطلاق من الرصيد المحضري بالتركيز على مضامين التعليم المحضري والتخفيف من غلواء الأساليب الإدارية المستحدثة.
وتتمثل الجينات المدرسية في هذا الجسد التربوي الخلاسي في:
- ترتيب التعليم على مراحل مطابقة للمراحل المدرسية النظامية الموروثة عن الغرب؛
- اتباع أسلوب إدارة مدرسية مشابه، وذلك بتعيين مديرين واعتماد مدرسين وإخضاع الطلبة لنظم مدرسية فيما يتصل بمواعيد الدراسة في السنة وفي اليوم وبالامتحانات وأساليب التقويم المدرسي.
- اعتماد فضاءات حضرية منظمة على الطريقة المدرسية (فصول دراسية مبنية ومجهزة بالمقاعد والسبورات…).
- إدراج مواد مهملة أو مهمشة في التعليم المحضري، مثل اللغة الفرنسية والإنجليزية والحساب والهندسة والعلوم الطبيعية والفيزياء والكيمياء والتربية وعلم النفس والتاريخ والجغرافيا، مع اختلاف في نسب حضور هذه المواد ما بين مؤسسة وأخرى.
أما الجينات المحضرية فتتمثل، قبل كل شيء، في أن هذه المؤسسات تدلي كلها بنسب إلى المحضرة، وتعلن أن عملها مدفوع بالحرص على بقاء المحضرة واستمرار إشعاعها. وهذا ما نص عليها نظام معهد ابن عباس، في إعلانه أن من أهدافه أنه “يسعى في حدود إمكاناته إلى إعادة الاعتبار إلى المحاضر وإعطاء تلامذتها فرصها لتركيز معلوماتهم في مجالات علمية تخصصية تجعلهم جديرين بممارسة الوظائف وتحمل المسؤوليات وإبلاغ كلمة الله تعالى وتشجيع التعليم الأصلي وتطويره بما يتلاءم ومقتضيات العصر”. وكذلك نص معهد خالد على أن من أهدافه تكوين شباب “يعتز بانتمائه الإسلامي والمحضري ويدرك إدراكا كاملا حق الإسلام والمحاضر نحوه “.
وفيما سوى ذلك، ورثت المؤسسات التربوية المحضرية المعاصرة من المحضرة التقليدية الجينات التالية:
- انفتاحا أكبر على خريجي المحاضر أو طلبتها، حيث تركز مسابقات الدخول على المواد التي تدرسها المحضرة.
- جانبا مهم من مضامين التعليم، تفاوتت تلك المؤسسات في مستوى الأخذ به، وكان من أوفرها حظا منه معهد ابن عباس الذي عني عناية خاصة بتدريس مؤلفات الشناقطة.
- الاهتمام بالحفظ، مع تفاوت فيه كذلك. وقد اعتبر معهد ابن عباس “إعطاء الشهادة لمن لا يحفظ شيئا مما درس ضربامن شهادة “الزور”. لكن أثر المدرسة كان واضحا على هذا الصعيد أيضا، حيث اقتصر سقف المطالب على حفظ نسبة 25% من المقرر.
- مرونة نسبية في أساليب الإدارة المالية، فقد كان معهد ابن عباس يقدم إلى طلابه منحا دراسية لا تكاد تجاوز ثمن المنح التي يتلقاها نظراؤهم في المعهد العالي للدراسات الإسلامية الذي أنشأته الدولة، لكن جل المعاهد المحضرية الأخرى لم تكن تقدم أصلا أية منح للدارسين، وإنما كانت تكتفي بمجانية التعليم.
- الاعتماد على المجتمع (تجربة لجنة المساجد والمحاضر، مثلا) في كفالة المؤسسة التربوية ماليا، ودون ترتيب أعباء على الدارسين أو أسرهم.
ثالثا – المخرجات
في غياب الاعتراف الرسمي بهذه المؤسسات ظل دورها منحصرا في تعزيز الثقافة المحضرية لدى الدارسين وتزويدهم بثقافة عصرية إضافية تسمح لهم بالبحث عن فرص عمل غير مصنفة، أو بطرق أبواب المؤسسات التربوية النظامية للحصول منها على مؤهلات معترف بها. وقد سعت المعاهد والمدارس المحضرية لمساعدة طلابها على تحضير الامتحانات الرسمية الكبرى، خاصة شهادتي الإعدادية والثانوية العامة. وسجل طلبتها تألقا في هذه الامتحانات. ومن ثم، فإن المعاهد المحضرية شكلت روافد للتعليم النظامي أمدته بفئة من الطلبة (الموظفين لاحقا) ذوي عدة معرفية أصيلة وقدرة مشهودة على التألق في الدراسة والعمل.
رابعا – المحضرة النموذجية
قد لا تكتمل الصورة عن السعي للتوفيق بين المحضرة والمدرسة إلا بالتطرق إلى تجربة حديثة عهد، لكنها متميزة، عرفت باسم “المحضرة النموذجية”.
وقد انطلقت هذه التجربة عام 2007غ بمبادرة من رابطة علماء موريتانيا، وبالتعاون مع لجنة المساجد والمحاضر. وتحدد هدفها في “تخريج فطاحلة العلماء الشناقطة المطلعين على واقع بلدهم وعصرهم”. وتشترط المحضرة النموذجية لقبول المترشحين لها الحفظ الكامل للقرآن الكريم ومختصر خليل بن إسحاق المالكي وألفية ابن مالك الأندلسي. وتتضمن المسابقة أسئلة للحفظ وأسئلة للفهم. وقد تحددت مدة الدراسة في هذه المحضرة بأربع سنوات، تستغرق الدراسة في كل منها 8 أشهر ويخصص شهر بالتناصف لامتحانين نصفي ونهائي، وشهر بالتناصف بين عطلتين قصيرتين، وشهران للعطلة الكبيرة ما بين السنتين الدراسيتين.
ويهتم منهاج المحضرة النموذجية بتعزيز المكتسبات المعرفية المحضرية للدارسين، في مواد علوم القرآن الكريم والحديث والعقيدة والفقه واللغة العربية ودواوين الشعر والمنطق. وقد أضيفت إلى المنهاج المحضري مواد أخرى هي العلوم الطبيعية والحساب والهندسة والتاريخ والجغرافيا والفكر الإسلامي والتربية المدنية. وتفرد “المحضرة النموذجية” حصص المساء لدراسة المعلوماتية واللغات الأجنبية (الفرنسية/ الإنجليزية). ولعل من بديع ما استحدثته هذه التجربة (استيحاء من تجارب التعليم المحضري) أن طلبتها هم أساتذتها، فقد وزعوا إلى مجموعات “دول” صغيرة وزعت بينهم مواد المنهج الدراسي، وطلب من كل مجموعة أن تتقن نصيبها إتقانا يمكنها من تدريسه باقتدار. وهكذا فإن كل طالب يصبح أستاذا في قسم من أقسام المنهاج. ويقوم عالمان ماهران بمراقبة العملية، مؤديين دور المفتش/ الموجه أو المرشد التربوي.
المبحث الرابع: خلاصة عن أوجه الاختلاف والائتلاف بين النظامين
نخلص مما سلف إلى أن التعليم المحضري في لبوسه التقليدي يواجه خطرا محدقا من ضرته (المدرسة النظامية الوافدة) التي استطاعت أن تلمع وجهها في عيون السكان، بعد أن أصبحت “مدرسة وطنية” وتقدم فيها التعريب أشواطا. ولكنه يواجه خطرا آخر من المؤسسات التي تنتمي إليه وتسعى لوراثته، فالمدرسة تقف بالمرصاد للأطفال في بداية الطريق، والذين يفلتون منها ويخصصون وقتا للتعليم المحضري، يجدون “المعاهد المحضرية” بالمرصاد في منتصف الطريق، حيث تقترح عليهم مسارا فيه من الائتلاف مع المحضرة (من خلال المناهج) ما يطمئنهم إلى المحتوى التعليمي، وفيه من الاختلاف عنها (في النظم والتراتيب الإدارية) ما يعدهم بآفاق أرحب للاندماج في الحياة النشطة الحديثة.
ويلخص الجدول التالي أوجه الاختلاف والائتلاف بين الأنماط التربوية الثلاثة :
| المدرسة | المحضرة | المعاهد المحضرية | |
| في المناهج | |||
| حضور مناسب للغة العربية | 3 | 4 | 4 |
| دراسات إسلامية ولغوية متقدمة | 2 | 4 | 3 |
| حضور للغات الأجنبية (الفرنسية خاصة) | 4 | 2 | |
| مواد علمية ورياضية | 4 | 2 | |
| تكوين مهني وحرفي | 4 | 4 | |
| في الإدارة التربوية والتمويل | |||
| إدارة مرنة | 4 | ||
| كفالة اجتماعية | 4 | 3 | |
| كفالة رسمية حكومية | 4 | 1 | |
| عمل تطوعي | 4 | 2 | |
| هوامش حرية وسعى للطالب | 4 | ||
| في آفاق الاندماج في الحياة النشطة | |||
| مراكز الحظوة الدينية في المجتمع | 4 | 3 | |
| مراكز الحظوة الإدارية في الدولة | 4 |
تشير الألوان إلى أربع مستويات من الحضور، متدرجة من الأقوى إلى الأضعف على النحو التالي:
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |
وبإمكاننا أن نخلص من الجدول إلى ملاحظة ما يلي:
- تنفرد المدرسة (ويقصد بها النظام التربوي الوافد بمختلف مراحله) بأنها تفتح أبواب الحظوة الإدارية، حيث لا تقبل الدولة موظفين في مراكز مهمة إلا إذا كانوا مزودين بشهادات مدرسية/ جامعية مناسبة. كما تنفرد بالتمتع بكفالة الدولة. وهناك معونات رمزية غير ذات بال، تقدمها الدولة إلى عدد من المحاضر.
- تنفرد المحضرة بمرونة الإدارة وبهوامش الحرية الوسعى للطلبة.
- ليس للمعاهد المحضرية سمة تنفرد بها عن المدرسة والمحضرة، لكونها نشأت أصلا لتكون جسرا بين النظامين التربويين.
- تشترك المحضرة والمعاهد المحضرية في اعتماد اللغة العربية أداة أساسية للتعليم، بينما تدرس بعض المواد العلمية في المدرسة باللغة الفرنسية. وتشترك المحضرة والمعاهد المحضرية، بنسب متفاوتة في عنايتهما الخاصة بالدراسات اللغوية والدينية المتقدمة وفي تمتعهما بكفالة المجتمع، وفي مشاركتهما في صناعة مراكز الحظوة الدينية في المجتمع (علماء، أئمة…)، كما تشتركان على تفاوت بيّن في مبدأ طوعية التعليم.
- تشترك المعاهد المحضرية مع المدرسة في توفير التكوين المهني والحرفي للطلبة، وتشتركان بمقدار أقل في حضور اللغات الأجنبية والمواد العلمية والرياضية.
- تشترك المؤسسات الثلاث، في عنايتها باللغة العربية على تفاوت بينها في ذلك.
وتبقى هذه الملاحظات أفقية وسطحية إلى حد يتعين معه التنبيه إلى أمرين أساسيين: أحدهما أن نقاط الالتقاء – وإن بدت متعددة- ضئيلة إذا قيست بأوجه الاختلاف. وثاني الأمرين أن أوجه الاختلاف أعمق بكثير، خصوصا في أبعادها النوعية، مما تشي به مظاهرها الكمية.
وبحسبنا أن نعيد التذكير هنا ببعض الفروق الجوهرية بالغة الدلالة على التباين النوعي بين النظامين؛ فقد كان الطلبة يقطعون مئات الأميال، وربما الالاف سعيا وراء محضرة يطلبونها بشوق رغبة ولهفة. أما اليوم فالمدرسة تطاردهم وهم عنها هاربون حتى إذا أدركتهم عاشوا معها عيشا ضنكا ملؤه الدلال والتمنع والغيظ لأبسط الأسباب، فلا تفتأ ترى الطلبة يخاصمون أساتذتهم وادارتهم ويهجرون قاعة الدرس ويضربون كأنما هم في سجن يودون لو أفلتوا منه. وقد كانت المحضرة غاية في ذاتها، فالطالب يلتحق بها خلو الخاطر من التفكير في المآلات الدنيوية لدراسته، فلا هو يبحث عن شهادة، ولا هو يطلب بعلمه وظيفة أو عملا عند الدولة أو لدى شركة خاصة. أما المدرسة فهي وسيلة لا غاية، والتلميذ من اللحظة الأولى يحمل هم موعد الخروج من المدرسة والمكسب الذي يتوقع نيله منها، فإذا ما وصل غيره إلى مكسب أسمى دون المرور بالمدرسة (كما يحدث كثيرا مع التجار “الشاطرين” اعتبر طالب المدرسة أنه مغبون، وأن الأولى به أن يختصر الطريق إلى غايته التي لن تضمنها له المدرسة؛ ومن هناك فإن العلم الذي تبثه المحضرة جوهر نفيس مطلوب لذاته، تبذل فيه النفائس. أما العلم الذي تبذله المدرسة فهو سلعة معروضة في سوق كاسدة، وإذا وجد الإنسان سلعة أنفق منها بادر إليها، وقال: وداعا للكتاب والقلم.
الفصل الثالث: آفاق التواشج بين النظامين التربويين
أولا – واقع وآفاق نمو التعليم الأصيل في الفضاء المدروس
تغيرت البيئة الطبيعية للمحضرة، في جانب كبير من أبعادها المادية والمعنوية، فقد تراجع نمط الحياة البدوي، وبعد أن كان أهل الريف والبادية يشكلون نحو 90% من سكان البلاد قبل نحو 50 عاما، تراجعت نسبة هؤلاء حاليا إلى نحو 5%. وتراجع بذلك نمط الحياة الاقتصادية التي كانت تكتنف المحضرة، بما فيها العادات الغذائية، وعادات المسكن والملبس السائدة. وعلى المستوى المعنوي، تقلصت أيضا حدود البيئة الحافزة للتعلم، بتراجع القيمة الاعتبارية الاجتماعية والمردود المادي لمخرجات المحضرة.
ورغم ذلك، فإن المحضرة ما تزال صامدة. وهناك حاليا مئات المحاضر تواصل رسالتها، على اختلاف في المستويات. وقد أخذت هذه المحاضر تجدد من وسائلها وآلياتها لمقاومة شبح الاندثار، كما انفتحت لها آفاق جديدة، منها إمكانية انتداب بعض خريجيها المميزين أساتذة جامعيين، وفتح الباب أمام طلبتها للالتحاق –عبر مسابقة- بالتعليم الجامعي الإسلامي، فضلا عن إمكانية ترشحهم لنيل الثانوية العامة ومواصلة دراستهم الجامعية في أي شعبة يتأهلون لها. وقد بدأت دول الخليج العربي واليمن تستقدم علماء ومفتين وقضاة وأئمة من خريجي المحاضر وشيوخها.
وهكذا فإن المحضرة ما تزال تحتفظ بدور وظيفي يؤهلها لمقاومة عوامل الاندثار. بل ربما كانت وظيفيتها في تنام، خصوصا في ظل وعي متنام بأهمية المحافظة عليها، وبأن خريجيها – خاصة المتميزين منهم – لن يعانوا من مشكلة البطالة.
ولتؤكد المحضرة فاعليتها ووظيفيتها في السياق المعاصر، يتعين عليها اليوم أن تستفيد من الفرص المتاحة لها للمساهمة في تأصيل التعليم المنافس المحيط بها أو تحسين نوعية مخرجاته. وقد يتحقق هذا الغرض بتعزيز جسور التواصل بين النظامين التربويين (التالد والطارف)، وذلك بأن تقطع المحضرة خطوة نحو المدرسة، وأن تقطع المدرسة خطوة أو أكثر نحو المحضرة. وليس من الضروري أن ينتهي بهما المطاف إلى الاندماج، بل إن ذلك قد لا يكون مفيدا أصلا. وإنما المطلوب أن يحصل بينهما من التقارب ما تأخذ به كل منهما بعض مزايا ضرتها، وما يسمح خاصة للمحضرة بممارسة دور فاعل ومؤثر في عصر متغير.
ثانيا – نحو المزيد من الجسور بين النظامين
خاضت دول عديدة تجارب للمواءمة بين النظام التربوي الأصيل والنظام التربوي الدخيل. ونود في هذا السياق الإشارة إلى تجربتي المغرب والسودان تمهيدا لتناول مستقبل جهود المواءمة في موريتانيا.
- تجربة المغرب والسودان
أصدر المغرب قانونا ينظم التعليم العتيق ويصنفه إلى مراحل موازية ومساوية زمنيا لمراحل التعليم النظامي وله امتحاناته كامتحانات نظيره، ويقبل التلاميذ الناجحون في سنة من سنوات التعليم العتيق لمتابعة الدراسة في السنة الموالية من التعليم العمومي. وكان من أهداف الخطة الحكومية بهذا الشأن تعزيز استعمال تلاميذ وطلبة التعليم العتيق للغات الأجنبية وتقنيات الإعلام والتواصل[86].
أما في السودان، فقد كان من أبرز الأفكار المستحدثة للربط بين التعليمين فكرة المنهج التكميلي الهادف إلى إلحاق الحفظة من خريجي الخلوات بالمرحلة الثانوية، مرورا بمنهج دراسي مركز يستغرق ما بين عامين وثلاثة أعوام. ومن التجارب الناجحة في هذا الميدان تجربة الشيخ إبراهيم المكاشفي في الجزيرة والمدارس التكميلية للشيخ موسى عبد الله حسين في دارفور[87]. وقد أبدى الذين مروا بهذه التجربة من خريجي الخلاوى لياقة عالية في استيعاب المعارف العصرية والتفوق فيها على من لم يتعمقوا في دراستهم القرآنية.
ولعل تجربة المحضرة النموذجية في موريتانيا تشكل تطويرا لهذه التجربة السودانية. أما التجربة المغربية فهي شبيهة بما انتهجته بعض المدارس المحضرية (مدرسة ابن عامر، مدارس الفلاح…) مع فارق أساسي هو أن الدولة المغربية تنظم الشهادات وتمنح الناجحين فيها درجة النظير في التعليم النظامي الوافد، وهي بذلك أكثر إنصافا وعدلا، وإن كانت تهدد بنية التعليم الأصيل (كما تهدده التجارب المماثلة في موريتانيا) بإخضاعه لنظم وتراتيب المدرسة.
- جسور موريتانية
عكف فريق عمل في موريتانيا على دراسة السبل الملائمة لتحقيق مواءمة أفضل بين التعليم الأصيل والتعليم الدخيل، فكان من أهم ما وصل إليه فكرة تعزيز وتنويع الجسور التي تسمح للتلميذ أن يعبر من المحضرة إلى المدرسة بيسر وسلاسة.
ويقترح أن تنصب هذه الجسور في خمس محطات:
- الجسر الأول: على مستوى السنة الأولى من التعليم الأساسي، ويعبر إليه من حصلوا على مقدار من الدراسة القرآنية قد يكون حصيلة عامين.
- الجسر الثاني: على مستوى السنة الأولى (إعدادية)، ويعبر عليه من استمروا في دراستهم القرآنية والمحضرية حتى أكملوا السن القانونية للتعليم الابتدائي، ويمنحون عندئذ الحق في الترشح لشهادة الدروس الابتدائية ومسابقة دخول المرحلة الإعدادية.
- الجسر الثالث: على مستوى السنة الأولى (ثانوية)، ويعبر عليه أبناء المحضرة الذين يترشحون أحرارا لنيل شهادة الدروس الإعدادية وينجحون.
- الجسر الرابع: على مستوى السنة الأولى جامعية، ويعبر عليه الناجحون من المترشحين الأحرار لشهادة الباكلوريا أو الناجحون في مسابقات دخول المؤسسات الجامعية (المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية).
- الجسر الخامس: على مستوى التعليم الفني والمهني، ويتمثل في سلسلة من المعابر يمكن أن يستخدمها التلميذ في المحطات الأربعة السابقة للانتقال إلى مستوى مناسب من التعليم الحرفي والمهني بدل الانتقال إلى مرحلة موازية من التعليم العام.
ويتطلب تعزيز هذه الجسور (القائمة فعليا، إلى حد ما وإن كانت غير مرتبة رسميا) إنشاء سلسلة من الشهادات الأصلية (ابتدائية، إعدادية، ثانوية عامة…) واتخاذ الإجراءات المصاحبة الضرورية بما فيها بعض التعديلات على منهاج المحضرة. وتختلف الفكرة الموريتانية عن التجربة المغربية في أن الدراسة المحضرية تظل خاضعة لنواميسها التقليدية أي أنها لا تنمط في فصول دراسية وامتحانات سنوية، وإنما تهيأ ترتيبات تمكن الدارسين من الإعداد في فترة مناسبة وبمنهاج مناسب لخوض امتحان الشهادة الأصلية التي تناسب مستوياتهم. ويمكن أن يكون ذلك في شكل دورات قصيرة مكثفة تنظم تمهيدا لخوض الامتحان.
والواقع أن هذه الجسور على ما لها من فائدة قد تعود بالضرر على المحضرة، فهي تترصد أبناءها في كل محطة من المحطات، بينما يفترض الإقلال شيئا ما من هذه الكمائن التي تنصب في طريق المحضرة، وترك طلابها يرتوون من معينها ما أمكن إلى أن يتزودوا منها برصيد أساسي يمنحهم حصانة كافية على المستوى الروحي والخلقي والمعرفي، ويشحذ قابلياتهم لاستيعاب أنماط جديدة من المعارف. ولعل ذلك لا يتأتى إلا بالتركيز على جسر مفصلي أساسي هو جسر العبور إلى التعليم الجامعي. أما الجسور الأخرى، فقد يكون من الأولى أن تترك – كما كانت – أنفاقا وسراديب يعبر منها من آنس حاجة إلى العبور، بشكل غير رسمي وغير مقنن. كما أنه سيكون من المفيد أن تكون المعابر ذات اتجاهين لا اتجاه واحد. فمن المفيد للتلميذ الذي أنهي دراسته الابتدائية أن يعود أدراجه إلى المحضرة ليتزود منها بثقافة شرعية ولغوية رصينة، لا تمنعه أن يعود من جديد (في مرحلة الثانوية العامة مثلا) إلى التعليم النظامي، ليواصل دراسته الجامعية. ولا شيء يمنع في نظم المحضرة وأعرافها من الانتقال إليها في أي مرحلة من مراحل الدراسة النظامية، لكن الأمر يحتاج إلى أن تتخذ له تراتيب مناسبة، تجعل الدارسين يتنافسون في العودة إلى المنابع والتزود منها. ولا أقل في هذا الصدد من حسن استثمار العطل الصيفية لتكون عطلا منتجة معرفيا بعودة طلبة المدارس فيها أو في الجزء الأكبر منها إلى حضن المحضرة. كما أن التوأمة بين بعض المحاضر وبعض المؤسسات المدرسية قد تحقق تفاعلا إيجابيا، يمكن طلبة المحضرة من الاستفادة في هوامش زمنية مضبوطة من دروس يقدمها معلمو المدرسة، وتمكن طلبة المدرسة من استغلال هوامش مماثلة لمتابعة دروس محضرية، ترفع من مستوياتهم في اللغة والمعارف الشرعية.
ثالثا – نحو تعليم محضري معاصر
رغم ما تحمله تجربة المعاهد المحضرية (وتجربة “المحضرة النموذجية” خاصة) من وعود لتحديث التعليم المحضري ومواءمته مع مقتضيات العصر، فإنها لا تقدم الإجابة الكافية على السؤال الجوهري: كيف نضمن للمحضرة الحياة والفاعلية في هذا العصر؟ إنها تقدم نفسها امتدادا للمحضرة في مراحل معينة، وبديلا لها في المراحل التالية. وعلى هذا الأساس، يبقى السؤال قائما..
ولعل من أهم الأسباب المعينة على صيانة المحضرة وتهيئتها للاندماج في العصر دون مساس بخصوصياتها وبجوهر رسالتها:
- أن ترسم للمحاضر أهداف محددة لا تكلفها الانسلاخ من جلدها ولا تقبل منها التقوقع في أوضاع سادت ثم بادت. ولعل أبرز هذه الأهداف:
- أن تمضي قدما في أداء رسالتها التقليدية المتمثلة في تفقيه طائفة من الناس، بما يعنيه الفقه من تمكن من علوم اللغة والشريعة، فليس مطلوبا من المحضرة أن تكون مؤسسة لمحو الأمية، وإن كان باستطاعتها أن تؤدي دورا بالغ الأهمية على هذا الصعيد، وليس مطلوبا منها أن تتحول إلى كليات متخصصة للطب والهندسة والرياضيات ونحوها. فباستطاعة المؤسسة المدرسية على قصورها، وبشيء من الإصلاح، أن تنهض بهذه المهمات؛
- أن تساهم في تحصين الناشئة وتعزيز مناعتهم الثقافية في وجه عاديات الزمان الذي يعيشونه، وتلك أيضا إحدى مهماتها التقليدية؛
- أن تتطامن لمرتاديها، شيئا ما، لتيسر لهم الاندماج في الحياة المعاصرة.
- أن تحدد على هدى من الأهداف السابقة مناهج المحضرة ونظمها. أما الهدف الأول والثاني فلا يتطلبان منها كبير تغيير في مناهجها ولا في نظمها، فتلك رسالتها الطبيعية، وهي بها قادرة على أن تزود مرتاديها بالمعارف والقيم الأصيلة التي تضع المتقدمين منهم على طريق الرسوخ في علوم الشريعة واللغة، وتضع عامتهم في حصن حصين يقيهم مخاطر الاستلاب والارتداد الفكري والحضاري. لكن الهدف الثالث يتطلب شيئا من التكيف مع متطلبات واقع قُلّب لا مناص من التعامل معه. وفي هذا الصدد تحتاج المحضرة إلى إدماج برامج تكميلية تضمين لمرتاديها ترويض العقول والسواعد وتطوير المهارات الأساسية، خاصة مهارات التواصل والتعبير والحرث والتثوير. وهكذا فإن المحاضر بحاجة، خصوصا في البيئة الحضرية، وقد أصبحت غالبة، إلى امتلاك مهارات معلوماتية، وإلى تشجيع الطلبة على البحث والتأليف المبكر وإخضاع أعمالهم – بأسلوبها المرن- للتقييم التكافلي (فيما بين الطلبة أولا) ثم لتقييم الوسط المحضري. كما تحتاج المحضرة إلى العناية بتعليم الحرف والصنائع، وهو أمر غريب على أبنائها، لكن الجهاد من أجل تغيير العقليات ضرورة، والحاجات المعيشية معينة عليه. والمطلوب حتى لا يكون الانصراف إلى الحرفة طلاقا بائنا مع المحضرة، هو أن تكون مشاغل التكوين الحرفي قائمة على مقربة من المحضرة متواصلة معها جغرافيا وعمليا. أما إعداد المعابر فهو مهمة ظرفية يمكن أن تتم خارج المحضرة، فيتاح لطلبتها بعد أن يتزودوا بزاد مناسب من معارفها أن يلتحقوا بدورات تحضيرية مكثفة، تيسر لهم التدارك وتمكنهم من التهيؤ لخوض الامتحان المناسب، تبعا لميولهم واستعداداتهم الذهنية ومستوياتهم العلمية.
- وإلى ذلك تحتاج المحضرة إلى الاستفادة من نظام حوافز أفضل، ينصف خريجيها، فمن غير المعقول في بيئة مسلمة أن لا يمنح حافظ القرآن الكريم أي درجة معتبرة في سلم الوظيفة العمومية. لقد اتجهت بعض الدول نحو اعتبار حفظ القرآن الكريم بمنزلة شهادة جامعية (قرار اتخذ في ليبيا، ويجري الإعداد لاتخاذه في بعض ولايات نيجيريا). ومن الضروري أن تتجه الأنظمة الرسمية العربية إلى اعتماد مجموعة مؤشرات (حفظ القرآن الكريم واستيعاب مجموعة من المتون حفظا وفهما) بمثابة مؤهل يمنح صاحبه حقوقا مناظرة لحقوق بعض حملة الشهادات الرسمية، متى ما التحق بالعمل.
الفصل الرابع: دروس مستخلصة لصالح مشروع النظام التربوي الأصيل
أولا – منطلقات:
هناك ثلاثة منطلقات أساسية تمثل صوى هادية للبحث عن مشروع نظام تربوي أصيل قابل للتطبيق والحياة في هذا العصر.
- المنطلق الأول، هو الاقتناع بأن النظام التربوي الموروث عن حقبة الاستضعاف هو نظام مأزوم في ذاته، فضلا عن كونه نبتة مستنسخة غرست في بيئة غير بيئتها. إنها أشبه ما تكون بشجرة الينبوت (البروزوبيس) التي استوردناها من آمريكا الجنوبية، مفتونين بقدرتها على مكافحة التصحر، فارتفعت بسرعة وانتشرت، لكننا لم نلبث أن اكتشفنا أن مخاطرها أكبر، فهي تهدد البيئة بعدوانيتها تجاه محيطها، حيث تنشر عروقها تحت الأرض في اتجاهات كثيرة وبعيدة، فتقتلع عروق الأشجار الأخرى وتخرب شبكات المياه المطمورة وتهدم المباني. إنها شجرة عدوانية متسلطة غير ملائمة لبيئتنا رغم أوراقها الخضراء. وكذلك هي المدرسة النظامية الوافدة. وإذا كانت بعض الدول قد أعلنت حملة لاقتلاع أشجار البروزوبيس رغم ما توفره من غطاء نباتي أخضر، وعيا بأن خطرها أكبر، فإنه قد يأتي يوم يشعر فيه الآخرون بالحاجة الماسة إلى اقتلاع نظيرتها في نظامنا التربوي، فلم لا نأخذ زمام المبادرة، ولنا غناء في نظمنا الأصيلة، كما في أشجارنا الأليفة. لقد ارتفعت أصوات كثيرة من رحم النظام التربوي الغربي تشكو من علل هذا النظام، وقد قال أحدهم “لقد دخلنا الألفية الجديدة بعلوم معقدة وتكنولوجيا مذهلة، بيد أننا ما زلنا نجهل كيف نعلم أبناءنا جميعا”[88]. ويتحدث المشفقون عن عيبين في نظام التعليم الآمريكي هما: انخفاض مستوى متوسط تحصيل الطلاب والارتباط القوي بين الطبقة الاجتماعية والمستوى التعليمي. وفي تقرير الولايات المتحدة عن “أهمية التعليم” Education counts (1991) ورد على سبيل النقد: “علينا أن نتعلم الشيء الذي نرى فيه القيمة بدلا من أن نرى القيمة فيما يسهل علينا قياسه”[89]، وجاء ذلك في سياق نقد أساليب التقويم الكمي القاصر السائدة في النظام التربوي المعاصر. ومهما يكن من أمر، فإن النظام التربوي المذكور مأزوم في عقر داره، ولا فائدة من التشبث به لحد الغرق مع الغارقين. إنه يحسن بنا أن نستحضر في حقه كلمة روسو: “قم بعكس ما يقوم به المربون وأنا ضامن لك أن تصيب”[90].
- المنطلق الثاني هو الإيمان بأن لنا في موروثنا الثقافي كنوزا ينبغي أن نستكشفها ونستثمرها في توفير المزيد من الشروط لنهضة علمية معاصرة، تتحرر بها الأمة من رق التخلف، وتنهض بها من وهدة الإعاقة الحضارية. ففي الماضي استطاعت الأمة بنظمها التربوية الأصيلة أن تقود ركب الحضارة البشرية، قرونا طوالا من العطاء الموصول والإبداع المشهود. وفي العصر الحاضر، نجحت أمم أخرى في النهوض بتفعيل ثقافاتها الوطنية، كما حصل في اليابان والصين وكوريا، بل وكما فعلت إسرائيل، ذلك الخنجر المغروس في خاصرة الأمة. فما الذي يمنع من وقفة تأمل وعودة إلى الكنوز، فربما وجدنا أنفسنا في حال القائل:
ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول
كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول
- المنطلق الثالث هو التسليم بأن العودة إلى موروثنا الثقافي لا ينبغي – ولا يمكن أصلا – أن تكون عودة على طريقة الاستنساخ الصرف. فـ”الأصالة في أفق التحرير والنهوض هي المعاصرة ذاتها”، على حد تعبير أحد الباحثين[91]. ومن حكمة الآشانتي (بإفريقيا) قولهم: “إن من يحفر جدولا مكبا على وجهه لا يستطيع أن يرى اعوجاج ما حفر”. والسواحيليون يقولون: “النهر يتعرج في طريقه لأنه يصر على السير منفردا “[92]. وعليه، فإن العودة المنشودة إلى المنابع هي بالضرورة عودة من بوابة العصر والواقع، تمتح من معين تراثنا الفياض، وتلتقط الحكمة أنى وجدتها في أرجاء العالم الفسيح.
ثانيا – مستخلصات
تأسيسا على تلك المنطلقات، سنحاول في الورقات التالية استخلاص أهم الأفكار التي أوحى إلينا بها النظر في تجربتي المحضرة والمدرسة، محاولين الانفكاك في التوجهات الكبرى والخيارات التربوية التي سنخلص إليها من أسار هاتين التجربتين، وإن بمقادير متفاوتة.
وقد اخترنا لتسكين الأفكار والرؤى في مواقعها الانطلاق من مشروع الوثيقة النهائية للنظام الأصيل (المحررة خلال لقاء اسطنبول 2) وإيداع الأفكار تحت مظانها من محاور الوثيقة المذكورة. ونحن واعون بأن بنية هذه الوثيقة معرضة للتعديل، ولكن الانطلاق منها متعين منهجيا إلى أن يحل غيرها محلها.
القسم الأول: الأصول المؤسسة للنظرية التربوية الأصيلة…
- المعضلة التربوية العربية:
نقترح في هذا الصدد إدراج الأفكار الأساسية التالية:
- تراجعت الأنظمة التربوية الأصيلة تحت ضغط المنافسة الحادة من قبل المدرسة النظامية الوافدة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عصفت بجل مقومات التعليم الأصيل. وإزاء هذا التحول العاصف، لم يشبع النظام البديل المستورد لا الحاجات القديمة التي كان يشبعها النظام الأصيل ولا الحاجات المستجدة التي تتطلبها حياة أمتنا ومجتمعاتنا في العصر الحاضر.
- تراجع النظام الوقفي، بل وتم إلغاؤه جملة في بعض الدول. وكان ذلك سببا من الأسباب الكامنة وراء ضمور التعليم الأصيل، ينضاف إليه تراجع مختلف الآليات التي كان المجتمع يكفل بها طلبة العلم ومؤسسات التعليم الأصيل.
- يتميز التعليم النظامي الوافد بتكاليفه الباهظة، وهي تكاليف تشكل عبئا كبيرا على الدولة ومواطنيها، دون أن تحقق مردودا يعوض الهدر المالي المترتب على هذا العبء، ويمكن أن يستأنس لذلك أيضا بالإنفاق الكبير على أعداد متنامية من الطلاب يقذف بهم النظام التعليمي في النهاية إلى الشارع أو إلى المجهول، بعد أن تكون الدولة قد خسرت فيهم ما خسرت من أموال، ويمكن الاستشهاد بأرقام تقريبية عن متوسط كلفة تكوين الطالب في مراحل دراسية مختلفة، والهدر المترتب على إنفاق هذه المبالغ الكبيرة دون الوصول إلى المخرج المنشود، كما يحسن في هذا السياق الوقوف عند النفقات الباهظة للتعليم الحر الذي يتوسع تدريجيا على حساب التعليم العمومي، ويحكمه أساسا منطق التجارة، لا منطق التعاون والعمل الأهلي.
- علاوة على ما تقدم، يمكن توظيف المبحث الثاني (عن النظام التربوي الدخيل) خاصة الفقرة (2- في الآثار والمخرجات) في تشخيص المعضلة، انطلاقا من جملة الآثار السلبية التي تم رصدها، بما فيها ما يسجله البحث من أن المدرسة أضعفت “قيم الإنتاج والكدح والعمل اليدوي والاعتماد على الذات والتطوع والإيثار، ونشرت ثقافة الوظيفة والراتب الشهري والعطلة السنوية والاستئثار والعمل في الظل وتحت المراوح أو المكيفات وعلى الكراسي الهزازة والإضراب عن التعلم أو عن خدمة المجتمع والتوكل على “المخزن” وانتظار ما يجود به، فنشأ بسبب ذلك كله مجتمع طفيلي مسترخٍ، مستنكف عن العمل اليدوي، ميال إلى الراحة والدعة والثراء السريع والكسب السهل”. وينبغي تحويل هذه الصفات السالبة إلى صفات موجبة في النظام التربوي الأصيل المنشود. كما أن في المباحث التالية عناصر معينة على تشخيص المعضلة.
2. الموجهات المرجعية
- الرؤية التربوية في القرآن والسنة
يقدم البحث جملة من الأفكار الخادمة لهذا المحور، نذكر منها ما يتصل بقيمة العلم، وشروط تحصيله، وآدابه :
- قيمة العلم، وتخدمها الأفكار التالية:
- عموم الأمر بالتعلم عموما يستغرق جميع الأزمنة وفق مبدأ “اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد”، ويستغرق أنواع المعارف النافعة طبقا لقوله تعالى {وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم} ووفق مبدأ “علم كل شيء أفضل من جهله”، ويستغرق جميع المسلمين وفق مبدأ “طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة” بل يستغرق جميع الأفراد استغراقا يشمل الأنبياء المرسلين، فقد كان الأنبياء متعلمين حتى إنهم أخذوا العلم – وقد كان يوحى إليهم من عند الله – على بشر ممن دونهم، فكان ذلك تشريعا ربانيا بضرورة سعي كل إنسان كائنا من كان في طلب العلم وتأسيسا لما عرف لاحقا في عرف العلماء بأخذ الأكابر عن الأصاغر (يراجع مبحث الأنبياء متعلمين).
- العلم فريضة وعبادة: تعتبر ممارسة العلم دراسة وتدريسا عبادة من أجل العبادات وأفضلها، مقدمة في ملتنا على سائر العبادات باستثناء المفروضات. ويشهد لذلك استهلال الرسالة النبوية الخاتمة بالأمر الرباني “اقرأ” والحيز الكبير الذي شغلته قضية التعلم والتعليم في الكتاب والسنة وآثار السلف، بما فيها قول من قال إن عبادة الجاهل لا تنفعه.
- العلم حرية وانعتاق، ويشهد له ذلك الربط العامر بالدلالات بين عتق الأسير المشرك المتعلم وبين تحرير إنسان مؤمن من رق الأمية والجهل بالكتابة.
- العلم هو مجلى الكرامة الإنسانية الأكبر، فإكراما للإنسان العالم أمر الله ملائكته الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بالسجود لأبي البشر. وعلى سبيل التجديد المستمر لذلك السجود الأول تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع، كما جاء في الحديث الشريف.
- شروط التعلم وآدابه:
في هذا الشأن يرفدنا النظام المحضري بمنظومة من الآداب تتصدرها آداب الاتباع والطاعة والصبر التي حكمت العلاقة بين موسى والخضر عليهما السلام. وتندرج فيها ضرورة التفرغ الكلي للعلم وطلبه بالذل والتواضع، والكد والمجاهدة، والغربة عن الأهل في سبيله. وهي مبادئ أصيلة في التراث التربوي العربي الإسلامي، ولها حضور في تراث الأمم الأخرى، كما هو الشأن في النظام التربوي الياباني الذي يقوم التعلم فيه على فكرة بذل الجهد، كما ينبهنا إلى ذلك الأستاذ ناصر يوسف. وعليه، فإن المستهدفين بالنظام التربوي الأصيل المنشود ينبغي أن يكونوا من هذه الفئة القادرة على تمثل آداب طلب العلم والتحلي بفضائله واستمراء التضحيات في سبيله.
- التجارب التربوية
يندرج البحث بمجمله في هذا الحيز، وبالإمكان أن تستخلص منه في الوثيقة النهائية معلومات عن المحضرة باعتبارها مؤسسة من مؤسسات التعليم الأصيل عتيقة ومعاصرة في الآن نفسه.
3. الخصائص الأساسية المميزة للتربية الأصيلة…
يرصد البحث مجموعة من الخصائص والسمات المميزة للنظام التربوي الأصيل، نذكر منها:
- الديمقراطية، بما تقتضيه من فتح باب التعلم أمام جميع الطلبة فقيرهم وغنيهم شريفهم ووضيعهم، ومعاملتهم بالسوية، كما فعل الإمام مالك حين رفض أن يخص هارون الرشيد بمجلس وحمله على أن يجلس منه مجلس سائر الطلبة.
- المجتمعية، ويقصد بها استقلال المؤسسة التعليمية عن أجهزة الدولة وارتباطها بالمجتمع، فهو لها كافل، وهي له خادمة مفصحة عن خصوصياته راعية لمثله.
- الطوعية، فالمهنة التربوية في النظام الأصيل هي مهنة طوعية أساسا. وطوعيتها لا تتناقض ومبدأ المكارمة. وأقل ما يترتب على ابتعاث هذه الخاصية اليوم في النظم التربوية المعاصرة هو إحياء الروح الرسالية عند المدرسين، واختيارهم من بين من يعتبرون هذه المهنة هواية وقربة إلى الله (شرعا يوافق هوى في النفس)، ويرونها عنوانا للشرف وسلما للمجد. ومن المهم إذا ما توفر مدرس بتلك المواصفات الأصيلة أن يُكفى مؤونة عيشه بأن يتوفر له مورد رزق كريم، يعينه على التفرغ لطلب العلم. ولا مكان، في هذا المضمار، للموظفين التقليديين الذين يتخذون المهنة تجارة ولا يتورعون عن التطفيف في الكيل، تقصيرا في أداء الواجب المهني وتطلعا إلى مزيد من المكاسب المادية العاجلة.
- المجانية، وهي ثمرة الطوعية والكفالة الاجتماعية للمؤسسة التربوية الأصيلة، وبمقتضاها لا يكون الفقر معيقا للتعلم لدى الطالب المجد. وسنرى في مباحث لاحقة جانبا من الآليات التي تتيح تطبيق هذا المبدأ في سياق تجربة لا تستهدف بالضرورة عموم الناس. فـ”التعليم للجميع” شعار جميل ومقصد شرعي، لكن النظام التربوي المنشود ينبغي أن يكون تعليما “طائفيا” بالمفهوم القرآني، أي موجها إلى طائفة من الناس لا إلى كل الناس، هذا رغم انفتاحه بآليات شتى على الجميع (يذكر بعضها لاحقا). أما مهمة محو الأمية فيمكن أن تترك للنظام التعليمي المستورد، خاصة إذا طعم بأمصال من النظام التربوي الأصيل ترفع من كفاءته لأداء هذه المهمة الجليلة.
- الإلزامية، وهي ذات خطابين، يتجه أحدهما إلى المتعلم فيذكره بأن طلب العلم فريضة، ويتجه الثاني إلى المعلم فيذكره بوجوب بث العلم، وبأن من كتم علما علمه الله إياه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة.
- الحرية، فالطالب حر سيد في قراره باختيار معلمه ومادته الدراسية ومدة دراسته. وإذا كان من الصعب اليوم أن تتسع هوامش الحرية إلى الحد الذي كانت عليه في نظمنا الأصيلة، فإن منها ما يبقى متاحا؛ ففي حدود “طاقة الاستيعاب” ونحوها من المحددات، ينبغي أن يكون بمقدور الطالب أن يختار الدراسة على المعلم/ الشيخ الذي يرى فيه نموذج القدوة، وينبغي أن تترك للطالب، مستفيدا بالطبع من مشورة أهل الشأن، الحرية أيضا في اختيار المواد التي يدرسها، وينبغي أن يطلق لقدراته العنان في اختزال مدة الدراسة ضمن منظومة إجراءات تتعامل مع الطلبة باعتبارهم أفرادا ذوي قدرات متفاوتة لا باعتبارهم كتلة واحدة يفترض فيها التجانس، ويتعين عليها أن لا تتحرك إلا مجتمعة. لقد انتبهت ماريا مانتسوري Mentossori إلى أهمية هذا العامل في التربية، حين دعت إلى حرية الطفل في تعلم ما يشاء متى شاء[93]، كما انتبه إليه هولت J. Holt حين قال: “إننا لا نستطيع أن نوفر تعليما حقيقيا في المدرسة ما دمنا نفكر بأن من واجبنا ومن حقنا أن نفرض على الطلاب ما ينبغي تعلمه”[94]. ورغم أن تراثنا لا يؤكد هذه الحرية في فترة الصبا التي لم تكتمل فيها مدارك الطفل اكتمالا يكون به مسئولا عن تصرفاته، فإنه يتخذها ممارسة مستقرة في فترة المراهقة وما بعدها، أي في المرحلة التي يتأهل فيها الفرد في ملتنا لتحمل مسئولياته في الحياة.
- الفردية والجماعية متلازمتين. لعل سرا من أسرار نجاح النظام التربوي الأصيل يكمن في المزاوجة بين هاتين السمتين. فالنظام التربوي الأصيل يمنح الطالب حق السير وفق طاقته وتبعا لاختياراته المعرفية دون أن يعوقه سير أترابه أو تنوع اختياراتهم، لكن هذه الفردية مطوقة بمقاربة عمل تربوي جماعية تقوم من ناحية على تشجيع التعليم الزمري، تلقيا ومراجعة وتقويما، وتقوم من ناحية أخرى على قبول الطلبة الآخرين وسائر الزوار “مستمعين أحرارا” في درس أي طالب من الطلبة. وسنرى في الأقسام اللاحقة صيغا عملية لتحقيق التواؤم بين الخاصيتين في سياق معاصر.
- الإعداد للحياة. وبه كانت المؤسسة التربوية الأصيلة مدرسة للمجتمع وللحياة لا يقتصر دورها على تلقين المعارف، وإنما تتجاوز ذلك – إن لم يكن بمنهاجها المقرر فبطبيعة الحياة فيها وبتفاعلها مع محيطها – إلى تهيئة الطالب نفسيا ووجدانيا وبدنيا لحمل المشقة ومواجهة أعباء الحياة في محيطه.
قد لا تكون جميع هذه السمات قابلة للتطبيق في نموذج تربوي أصيل معاصر، لكن باستطاعة النظام المنشود أن يستلهم منها ويستصحب ما يمكن استصحابه. ويتحدد مستوى الاستلهام ومدى الاستصحاب في ضوء الخيارات المؤسسية التي يقع اعتمادها. وينبغي، بوجه عام، أن يستهدف النظام التربوي المنشود تعويد الطلبة على العيش المشترك والتعاون الوثيق، وأن يعرضهم لأنواع من النشاط والظرفيات المعينة على الاخشيشان (المعززة للمناعة). كما أن المراعاة الجوهرية للفروق الفردية، وهوامش الحرية العلمية والتنظيمية للطلبة، والانفتاح الواسع على المحيط، والاغتناء بالمجتمع – قدر الإمكان – عن الدولة، واختيار مدرسين رساليين يؤمنون بأن التعليم رسالة وليس مجرد وظيفة أو مهنة للارتزاق هي بعض من السمات الأساسية التي ينبغي غرسها في النظام المنشود أيا كانت طبيعة الخيارات المؤسسية المستهدفة.
4. الغايات الأساسية للتربية
يطرح البحث أفكارا خادمة للتربية الفكرية بما يثيره من قضايا تتعلق بالتعلم عبر التأمل (مرحلة التحنث في غار حراء/ تأمل إبراهيم عليه السلام في الكواكب)، والتعلم بالتفكر والتدبر والحرث والتثوير.
ومن شأن العيش معا والتعاون على مهمات الحياة وملماتها (نظام الراحلة) والتعاون في الدراسة (نظام الدولة) أن يربي في المتعلمين مجموعة من قيم التعايش والتعاون الأساسية في حياة الجماعة.
القسم الثاني: أركان وعناصر النظام التربوي المنشود
- المنهاج التربوي
- المقاصد
في مجال مقاصد المناهج، ينبغي أن تكون تنمية الملكات وإكساب السجايا في مقدمة الغايات التي يسعى المنهاج التربوي لتحقيقها. وفي هذا الصدد يتعين استحضار مفاهيم “أخذ الكتاب بقوة” من منطلق {يا يحي خذ الكتاب بقوة}، بما يعنيه ذلك من الإتقان والتمثل التام للمادة المدروسة، وعدم التعجل عن استيعابها. كما ينبغي تنمية ملكات النظر والتفكر والتدبر والاستنباط والحرث والتثوير باعتبارها متطلبات إيمانية وعملية، وفقا لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بهذا الشأن. وينبغي أن تبتعث هذه المصطلحات لتكون حاضرة اسما ومسمى في العملية التربوية.
وفي هذا الصدد أيضا، ينبغي استدعاء نظريات أصيلة في موروثنا الفكري، أهمها نظرية الولادة على الفطرة، ونظرية السجايا المكنونة وهما متكاملتان.
أما الولادة على الفطرة، فإليها الإشارة بقول النبي r: “كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه”. ومنها استقى المربون المسلمون، مثل الغزالي في طرحه لنظرية الصفحة البيضاء وحديثه عن نفس الطفل الخالية من النقش، القابلة لما يصور عليها. ومن شأن هذه النظرية أن تحمل المؤسسة التربوية بكل أجنحتها (الأسرة، المدرسة، الإعلام، الشارع…) مسئولية كبيرة في مصير الناشئة الذين تشكلهم هذه المؤسسة قبل أن يكونوا قادرين على التمييز والتشكل الواعي.
أما نظرية السجايا المكنونة، وقد تحدث عنها ابن المقفع، فهي بيان إضافي لنظرية الفطرة، وتنبيه إلى قوى كامنة في نفس الإنسان لا يجوز تعطيلها، ذلك – كما يقول – أن “للعقول سجيات وغرائز بها تقبل الأدب، وبالأدب تنمو العقول وتزكو”. وقد شبه ابن المقفع هذه السجايا الكامنة بالحبة المدفونة في الأرض تحتاج إلى ماء لتحيا، وهذا الماء هو الأدب. ومن جملة الأدب المطلوب حتى تفصح النفس البشرية عن فطرتها، وتكشف عن جوهرها وقوتها ونضارتها وحيويتها تعويد الناشئة على بذل الجهد المفضي إلى تفجير الطاقات وحسن استثمارها[95].
- المضامين
هناك هدفان يحكمان اختيار مضامين التعليم الأصيل، هما هدف خاص بمرحلة الأساس وهدف عام فيما بعدها.
- أما الهدف العام فهو ربط شتى المعارف الإنسانية والعلمية التي يكتسبها الدارس في أي مرحلة وفي أي مجال بمنابعها في ثقافتنا، بحيث يكون ابن سينا والرازي مثلا حاضرين في الدرس الطبي، وابن رشد والفارابي في الفلسفة، وابن الهيثم في البصريات، والخوارزمي في الرياضيات، ويكون الإعجاز العلمي في القرآن والسنة حاضرا في سائر الدروس، حيثما تأتى ذلك، وبالحكمة اللازمة، بحيث يتلاقح النقل والعقل، ويتواصل التراث المذخور والمبتكرات العلمية تواصلا لا انبتات فيه.
- أما الهدف الخاص بمرحلة الأساس فينبغي أن يكون بناء القاعدة التي تنبني عليها أشتات المكتسبات المعرفية اللاحقة، أي استصلاح تربة الذهن و”تسميدها”، ليتهيأ الفرد وهو طفل لاكتساب شتى المعارف، بتألق وذكاء. وقد ثبت علميا أن التمرين على الحفظ أساسي في بناء هذه القاعدة. وينبغي أن يتحقق هذا التمرين في المقام الأول بحفظ القرآن الكريم ومنتخبات من الحديث النبوي الشريف (خصوصا جوامع الكلم وأحاديث الآداب) ثم بحفظ منتخبات من دواوين العرب، يركز فيها على الشعر الحامل للغة الوظيفية والمعاني الحكمية الرفيعة والتراكيب البديعة. كما ينبغي تأهيل الدارس للنظر والتفكير والتواصل والتعبير، وإخراجه منذ البداية من البرج الذي تضع المدرسة فيه جل مرتاديها، وهو برج التعامل مع القلم أو الحاسوب حصرا، والاسترخاء على المقعد والتأنف عن الحركة والعمل اليدوي. وتتحقق هذه الأغراض بحضور المواد التالية في المراحل الدراسية المبكرة:
- القرآن الكريم؛
- منتخبات من الأحاديث؛
- قصائد ومقطعات شعرية للحفظ والدراسة والرواية والمحاكاة (التمرين على قرض الشعر)؛
- نماذج من النثر الرفيع، إن لم تكن بالدراسة المنهجية، فضمن برنامج مطالعة منزلية مساعد، خاضع للملاحظة؛
- منظومات قصيرة ومؤثرة في السيرة النبوية لخلق النموذج الذهني الذي يسعى الطالب لمحاكاته وتمثله؛
- مبادئ أساسية من الفقه متضمنا إجماعيات العقيدة وحِكَم العبادات وأساسيات المعاملات بين البشر وبينهم وبين البيئة الكونية (إعادة المواد المهجّرة إلى منبتها من الفقه والعقيدة).
- مواد معينة على ترويض العقل والجوارح، أما ترويض العقل فبالتدريب على مناهج النظر والتفكير والتفكيك والتركيب والاستنباط والتثوير. وأما ترويض الجوارح، فبتنمية مهارات التواصل والتعبير الشفهي والكتابي، وتعليم الحرف والصنائع اليدوية البسيطة التي تكثر الحاجة إليها. ويتعزز ترويض العقل والجوارح معا بإحياء الرياضات البدنية والذهنية الأصيلة وإدراجها في المنهاج التربوي. إلى ذلك كله، يتأكد في عصرنا هذا اكتساب المهارات المعلوماتية في سن مبكرة، فهي خادمة لجل الأغراض المذكورة آنفا، ومعينة على الاندماج الإيجابي في العصر.
- أما الهدف الخاص بمرحلة الأساس فينبغي أن يكون بناء القاعدة التي تنبني عليها أشتات المكتسبات المعرفية اللاحقة، أي استصلاح تربة الذهن و”تسميدها”، ليتهيأ الفرد وهو طفل لاكتساب شتى المعارف، بتألق وذكاء. وقد ثبت علميا أن التمرين على الحفظ أساسي في بناء هذه القاعدة. وينبغي أن يتحقق هذا التمرين في المقام الأول بحفظ القرآن الكريم ومنتخبات من الحديث النبوي الشريف (خصوصا جوامع الكلم وأحاديث الآداب) ثم بحفظ منتخبات من دواوين العرب، يركز فيها على الشعر الحامل للغة الوظيفية والمعاني الحكمية الرفيعة والتراكيب البديعة. كما ينبغي تأهيل الدارس للنظر والتفكير والتواصل والتعبير، وإخراجه منذ البداية من البرج الذي تضع المدرسة فيه جل مرتاديها، وهو برج التعامل مع القلم أو الحاسوب حصرا، والاسترخاء على المقعد والتأنف عن الحركة والعمل اليدوي. وتتحقق هذه الأغراض بحضور المواد التالية في المراحل الدراسية المبكرة:
وفي جملة المعارف المذكورة، ينبغي أن يشكل القرآن الكريم واللغة العربية العمود الفقري التأسيسي للتعليم الأصيل.
أما القرآن، فلأنه – وبغض النظر عن البواعث الإيمانية العقدية لدراسته – يحقق لمن يحفظه (ولو بدون فهم معانيه) ذلك الغرض الجوهري المتمثل في تمرين الذاكرة وترويض الحافظة واستصلاح التربة التي تنغرس عليها حدائق المعارف المكتسبة لاحقا (راجع مبحث الحفظ). هذا فضلا عما يتيحه الدرس القرآني إذا حسنت منهجية التعليم من فرص لتقديم دروس إضافية من خلاله (اللغة، الأحكام الشرعية، التربية الخلقية، التدريب على النظر والتفكير…). وقد ثبتت بالتجربة الحية بركة حفظ القرآن، بما يترتب عليه من تيسير التحصيل الدراسي اللاحق.
وأما اللغة العربية، فلأن إتقانها وحسن تمثلها في الصغر معين على هضم جميع المعارف المقدمة بها لاحقا، بل ومعين على الاكتساب الإضافي للغات أخرى في مراحل متقدمة من الدراسة. وقد قال عمر رضي الله عنه: ” تعلّموا العربيّة، فإنها تثبّت العقل ، و تزيد في المروءة”، وقال أحد الأعلام السابقين – ولعله الفراء- ما معناه: قل من اشتغل بعلم العربية ثم أراد فنا غيره إلا وسهل عليه. وقد أثبتت الدراسات الحديثة الأثر الكبير للتدريس باللغة الأم الفصيحة في تيسير استيعاب المعارف وتفجير الطاقات الذهنية للدارسين. وكأني بذلك يتحقق عندما يتمكن الدارس من ناصية اللغة فيكتشف أسرارها ويتذوق مفاتنها، وهو أمر لا توفره نظمنا التربوية السائدة حتى وإن نطقت شكليا باللغة العربية.
وعلاوة على كل ما سبق، ينبغي أن تتاح للأطفال في سن مبكرة فرصة التعلم عن العلم، أي تلقي معارف تغرس في أذهانهم صورة باذخة عن شرف العلم وعلو شأنه. ويتحقق ذلك عبر المرويات الأدبية الجميلة عن مكانة العلم وقصص العلماء والنوابغ، فضلا عما توفره البيئة من حوافز أخرى نعود إلى بعضها لاحقا. بل إنه من الضروري استحداث مادة تدرس بشكل متدرج في سائر المراحل حول “تاريخ العلم والعلماء”، تؤسس للوعي العميق المتنامي بمكانة العلم والتمثل الصادق لقصص العلماء والنوابغ المتميزين، خاصة ما يتصل منها بالكبد والنجاح في طلب العلم وبثه.
وعموما، فإن هدف مرحلة الأساس في التكوين الأصيل ينبغي أن يكون تحقيق سمة “الفتوة” بمدلولها المحضري، وهي أن يكون الفتى محاورا عن علم وفهم، مشاركا في بيئته عن نشاط. ولا يتأتى له ذلك إلا برصيد أساسي من المعارف الشرعية، ومرويات من أدب الحكمة، ومهارات معلوماتية، وقدرات منهجية، وقابلية لحل المشاكل العمرانية البسيطة (إصلاح عطل بسيط في الكهرباء أو شبكة المياه أو في سيارة). ومن شأن تكوين أساسي من هذا القبيل أن يهيئ صاحبه لاحقا للتألق في مجال تخصص محدود.
- طرق وأساليب التدريس
يكشف بحث المحضرة عن مجموعة من المبادئ والأساليب التربوية الأصيلة، تستوقفنا منها ستة مبادئ أساسية ذات صلة بطرائق التدريس، تتفاوت مستويات حضورها وغيابها في الأنظمة التربوية المعاصرة، وهي التدرج، ووحدة المتن الدراسي، وحفظ النصوص، والتلقي من أفواه الرجال، والمزاوجة بين فردية التعليم وجماعيته، والربط بين المعارف..
- أما مبدأ التدرج فهو حاضر في سائر الأنظمة التربوية، مع اختلاف في بعض الجزئيات نعود إليه. وهو يتمثل في البدء بالنصوص القصيرة والبسيطة والتدرج صعدا نحو الطويلة والمكتنزة. وعن مبدأ التدرج يتفرع في مرحلة الصبا أسلوب تدريس الحروف الهجائية بالطريقة الجزئية التركيبية. لقد اختلفت المدارس التربوية المعاصرة، فمنها ما ذهب إلى اعتماد الطريقة الكلية التحليلية، وفيها يبدأ التعليم من الكلمة بل من الجملة لتفكك إلى كلمات ثم تفكك الكلمات إلى حروف أو رموز صوتية. ومنها ما رجح الطريقة الجزئية التركيبية، وهي الطريقة الأصيلة في النظام المحضري. ولعل مما يشهد لها قربها إلى الفطرة والطبيعة، فالطفل يبدأ محاولات الكلام بحرف ثم بمقطع أو جزء من كلمة، ثم يرتقي إلى نطق الكلمات مفردة ثم يبدأ في تركيبها، وإذا كانت تلك هي الطريقة الفطرية في تعلم الكلام، فإنه حري بها أن تكون طريقة مناسبة في تعلم القراءة، وإن جاز أن يكون للبصر نواميس غير نواميس السمع. ولعلنا بحاجة لدراسة مخبرية للاستيثاق من مدى فائدة طريقة التقليبات الهجائية (ا، ب ، ت…/ بَ، بُ، بِ، بْ../ با بو بي بى/ أبجد/ أيقش…) في تيسير امتلاك اللغة.
- وأما مبدأ وحدة المتن الدراسي فهو شبه غائب في الأنظمة التربوية الوافدة، وفحواه أن يفرد الطالب وجهته لدراسة متن واحد في علم من العلوم، ولا يجمع معه غيره، إلى أن يفرغ من ذلك المتن عينا، وله عندئذ أن ينتقل إلى متن مشابه أو مقارب (في مستواه) مختلف في مادته وموضوعه، ثم يعود إلى متن أرفع في العلم الذي سبق أن درسه، وهكذا بمراعاة مبدأ التدرج، والالتزام الصارم بعدم “حمل التوأمين على التزاحم في الخروج”، فلا بد أن تترك لأحدهما فرصة الخروج أولا، وإلا فإنهما سيختنقان معا. ولا بد من هناك أن تستأثر مادة دراسية واحدة بعناية الطالب وتركيزه إلى أن يفرغ منها أو من مستوى من مستوياتها. ومما يقترب من هذه الممارسة نظام الوحدات الدراسية والدورات التخصصية؛ بيد أن النظام الأصيل يفتح نوافذ تعين الطالب المتفرغ لمادة معينة من تنفس أوكسجين المواد الأخرى، دون أن يكون معنيا بإتقانها في تلك المرحلة، فهو من خلال الحضور والاستماع الحر لدروس أقرانه، ومن خلال المراوحة بين المتون ذات المجالات المعرفية المختلفة (نحو، أدب، فقه…إلخ)، يحقق ضربا من ضروب الترويح بالتنويع غير الإلزامي، ويهيئ نفسه للتفرغ لاحقا لدراسة متن جديد، ويحفظ الصلة بمادته التي فرغ منها بحضور دروس الآخرين فيها، وبالعودة إليها لاحقا من خلال متن دراسي ذي مستوى أعلى. ويتأكد مبدأ “وحدة المتن” في حق دارس القرآن الكريم، فمن الخير أن يتفرغ له حتى يستوفيه ويتقن حفظه، وقد أثبتت التجربة أنه لن يجد صعوبة بعدئذ في اختزال السلم التعليمي (المرحلة الابتدائية بالذات) واللحاق بأقرانه الذين سبقوه بسنتين أو ثلاث، بل وربما التفوق عليهم إذا كانوا لم يتفرغوا مثله لحفظ القرآن بإتقان قبل دخول المدرسة. وعلى صعيد عام، يحقق مبدأ “وحدة المتن الدراسي” في النظام التربوي الأصيل المنشود غرضا مهما هو إتاحة الفرصة أمام الطالب للنجاح في مادة يميل إليها ويتذوقها فيحبس عليها نفسه، حتى يحقق فيها نجاحا يحسب له، بدل أن يحكم عليه بالسقوط الحر لمجرد فشله في غيرها.
- وللحفظ أهميته في النظام التربوي الأصيل. ودون الرجوع إلى تفاصيل ما ورد في البحث بهذا الشأن، نكتفي بالإشارة إلى ما أثبتته الدراسات الحديثة من أثر إيجابي للحفظ في خلق القاعدة التي تنغرس عليها المعلومات المكتسبة لاحقا. وتتأكد أهمية الحفظ في المراحل الأولى من التعليم لأنها هي مجال خلق القاعدة المذكورة. ثم إن الحفظ في النظام الأصيل يشكل – علاوة على دوره في تمرين الذاكرة وترويضها – أداة فعالة لتيسير الفهم ولاستبقاء المعلومات واستدعائها وتركيبها وتحليلها. وعليه، فمن الضروري إعادة الاعتبار للحفظ خاصة في المراحل العمرية المبكرة، وتوظيف العمليات المعينة عليها، بما فيها أن يقوم الطالب بنسخ درسه بيده، وأن يقرأه جهرا، بحيث يسمع نفسه ويسمع الآخرين، وبشكل متكرر، وهذا ما تمارسه المدرسة النظامية الوافدة ولكن في نطاق محدود، من خلال القراءة الجهرية الجماعية، وقراءات فردية محدودة. ولعل نظام القراءة الجهرية الفردية الذي تتداخل فيه الأصوات، خاصة في مراحل الدراسة القرآنية، يكسب الدارس مهارة لا تتيحها القراءة الفردية التناوبية ولا القراءة لجهرية الجماعية لنص واحد، ذلك أنه يمرن الدارس على تركيز انتباهه وعدم الانشغال بما يحدث حوله من ضجيج، فيكون بذلك أقدر على العمل تحت الضغط وضمن مجموعة، وفي سائر الظروف. ويحتل التكرار، فرديا أحيانا وضمن مجموعة أحيانا أخرى، وسيلة أساسية للحفظ. ولا يتكل فيه على مجرد تكرار الدرس الجديد إلى حين حفظه، بل لا بد من استظهار الحصص السابقة واستعادتها من الذاكرة مرة تلو المرة في أيام متعددة وفق نظام منضبط، يتحقق به تعزيز المكتسبات الدراسية على آماد متطاولة. ولعل مما يعين على ذلك:
- الاستفادة من ثمرات تكنولوجيا المعرفة لتعزيز المكتسبات الدراسية عن طريق التكرار. فمن المهم أن تزود المؤسسة التعليمية الأصيلة جميع طلبتها بأجهزة تسجيل دقيقة يستطيعون أن يوثقوا عليها الدروس المقدمة ويستعيدوها المرة تلو المرة إلى حد إتقانها.
- استدعاء أسلوب “الاعتكاف” أو “الخلوة” من التربية الروحية في تراثنا وتوظيفه في الحياة الدراسية. فكما أن الطالب يظفر بفترات محددة للراحة والسياحة، ويتفرغ في فترة أخرى للامتحانات فينهمك في المراجعة ليل نهار، فإنه من المفيد إرساء تقليد جديد تبرمج المؤسسة التعليمية بمقتضاه خلوة أو اعتكافا دراسيا لمدد معينة مبرمجة لصالح طلبتها، وخاصة من يحتاجون إلى تعزيز مكتسباتهم، على أن توجه هذه الخلوة أساسا للمراجعة وحل المشكلات، بإشراف أستاذ يؤدي مع الطالب دور الشيخ مع المريد. وهكذا تتحدد مواعيد متكررة في السنة يعلن فيها الطالب لذويه وأصدقائه أنه سيدخل خلوة لمدة ثلاثة أيام أو سبعة أو نحوها، ويتخلى عن هاتفه، وينصرف عن كل مغريات الحياة وشواغلها إلى أن تنتهي خلوته.
- أما المبدأ الرابع فهو التلقي من أفواه الرجال. ومؤداه التحذير من الاعتماد على الكتاب (أو الحاسوب في عصرنا) استغناء به عن الرواية. وعليه، فإن أنظمة التعليم عن بعد، ما لم يكن هذا التعليم تفاعليا (بالصوت والصورة أو بالصوت على الأقل)، لا تستجيب لمقتضيات التربية الأصيلة التي جعلت الصحبة والمعاشرة وسيطا أساسيا للتلقي والأخذ. وعلى أهمية هذا المبدأ في تأصيل النص المكتوب وتصحيحه، فإن استصحابه يؤدي غرضا جوهريا آخر، هو تلقي الدرس بكل أبعاده المعرفية والقيمية والمهارية مجتمعة. إن التعليم عن بعد قد يوصل المعلومة (دون أن يضمن توثيقها ودقتها) لكنه لا يوصل سمت الأستاذ ولا مهاراته التواصلية الحية، ولذلك فإن دور هذا النمط من التعليم ينبغي أن يظل دورا تكميليا استثنائيا، لا يُلجأ إليه إلا إذا تعذرت المدارسة بالمشافهة والمعاينة. وتلك قاعدة تربوية نستلهمها أيضا من درس النحو، حيث يقول ابن مالك عن الضمائر:
وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل.
ويتفرع عن مبدأ التلقي من أفواه الرجال مبدأ آخر أثير في النظام الأصيل هو مبدأ المدارسة أي التفاعل بين الدارس والمدرس إلى حد يؤدي فيه كل منهما دور صاحبه، وهذا ما نجده جليا في نظام التكرار المذكور آنفا، وفيه يتقمص الدارس شخصية الأستاذ، وهو يعيد إلقاء درسه على زملائه أو على نفسه، وقد جرد منها شخصا آخر يخاطبه.
- يميل النظام التربوي الأصيل محل الدراسة إلى ترجيح فردية التعليم، فهو يعطي الطالب حق الاختيار المستقل لمادته الدراسية، ويجعله رقيبا على نفسه، ويمنحه من هناك حق اختيار حجم الحصة الدراسية اليومية. لكنه يرتب تدابير للتخفيف من هذه “الصبغة الفردية للتعليم”، أهمها:
- مبادرة الطلبة ذوي الخيارات المتطابقة المتزامنة إلى التآزر في دراسة متن واحد ومراجعة مبانيه ومعانيه، فيشكلون مجموعة متكاملة متعاونة تسمى في الاصطلاح المحضري “الدولة”. ويعتبر هذا التقليد امتدادا لممارسة محضرية عتيقة، حيث يكل الشيخ إلى طلبته المتفوقين تدريس ومراقبة طلبته ذوي المستويات الأدنى. وقد اكتشفت أوربا إيجابيات هذا النمط من التعليم، عندما اطلع أندريو بل Andrew Bell في آخر القرن الثامن عشر الغريغوري على نجاح تجربة التعليم الإسلامي في المدراس بالهند وما تميزت به من قدرة معلم واحد على تعليم مئات الطلبة، مستعينا بالمتقدمين منهم على تدريس من دونهم. وقد عرف بل بهذه التجربة في كتابه The Madras System of Education المنشور عام 1798غ. وسرعان ما بدأ تطبيق التجربة في بريطانيا وفرنسا منذ أوائل القرن التاسع عشر. وطبقها مؤسس أول مدرسة فرنسية في السنغال. وحمل هذا التعليم اسم Enseignement mutuel بالفرنسية و Mutual instruction أو Learning by teaching بالإنجليزية. وقد أعيد اكتشاف هذا النمط من التعليم في ثمانينيات القرن العشرين في ألمانيا حيث انتشر انتشارا واسعا[96]. وفي إعادة صياغة محدودة للعناوين وتلوين محدود أيضا في المضامين، طلع مفكرون غربيون بدعوات للتعلم التعاوني cooperative learning فقد نادى كيرت كوفكا Kurt Koffka أحد واضعي نظرية الجشطالت في علم النفس بضرورة أن يتعلم الطلبة بعضهم من بعض. وتبعه في ذلك عدد من المربين منهم ديفيد جونسون David Johnson الذي طور نظرية الاعتماد المتبادل الاجتماعي[97]. ومن الطريف أن تنص تلك النظريات “الحديثة” على أن تتشكل المجموعات الطلابية من 2- 6 أشخاص. وهذا هو ما يجري في المحضرة، وإن كان الغالب أن لا تزيد “الدولة” فيها على أربعة أشخاص. وقد أصبح هذا التعلم التعاوني مطبقا في بعض الجامعات في عدد من البلدان (آمريكا، بريطانيا، كندا، الصين…)، رغم أنه ما يزال محدود الانتشار، فما تزال أفضل الأنظمة التربوية “المعاصرة” تسعى إلى حصر طلبة الفصل الواحد في عدد يتراوح بين 16 و19 (تجربة اليابان) و 30 (في نظام LMD). وقد كان سقف الزمرة في تجربة الصحابي الجليل أبي الدرداء عشرة أشخاص. ورغم أصالة التعلم التعاوني في تراثنا التربوي، نجد منظمة اليونسكو تعرف هذا النمط من التعلم بأنه “أحد نتاجات التربية المعاصرة”. وينحو باحثون تربويون من أبناء جلدتنا نفس المنحى، فهذا وصفي عصفور – مثلا – ينص على أن التعليم التعاوني يمثل إحدى تقنيات التدريس التي جاءت بها الحركة التربوية المعاصرة. بل إن مجلس القوى العاملة السعودي يعرف التعلم التعاوني بأنه “أسلوب حديث في مجال تطوير أداء الطلبة الفعلي والفعال”[98]. وهذا هو التيه بعينه..
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر!
- فتح المجال أمام الجميع لحضور الدروس كافة، فلا يستبد بها الطالب أو مجموعة الطلبة الموجهة إليهم أصلا. هذا في حدود ما يسمح به الفضاء الدراسي.
وهكذا تتحقق مزايا التعليم الزمري والجماعي، على خلفية تعليم فردي، فقد جمعت التجربة المحضرية بين الأمرين جمعا يتوخى تحقيق ما يقتضيه تقليل العدد من الإتقان، وما يقتضيه تكثيره من تعميم الفائدة. وبإمكان النظام التربوي المنشود أن يستلهم هذا المسعى التوليفي بين فردية التعليم وجماعيته. ولئن تعذر تحقيق جماهيرية التعليم بفتح قاعة الدرس أمام جمهور غير منتظم، لا يتسع له الفضاء المكاني، فإن بالإمكان الاستعاضة من ذلك في أوضاعنا الراهنة بوسائل أخرى ناجعة:
- فبالإمكان استخدام مكبرات الصوت ليصل الدرس إلى من هم في الشارع ويستفيدوا منه، وهم عابرون. ما الذي يجعل هذه الوسيلة مقصورة على المسجد في وقت خطبة الجمعة مثلا؟ لما ذا لا تستعملها المؤسسة التعليمية، خصوصا في أوقات لا تتزامن فيها الدروس، أو بنظام تناوبي يكون فيه التسميع الخارجي يوما لدرس هذه المادة ويوما آخر لدرس تلك وهلم جرا.. إن ذلك يحقق مزيدا من الاندماج بين المؤسسة التعليمية ومحيطها، ويحمل المعرفة خارج الأسوار المدرسية التي تحاصرها.
- ثم إنه بالإمكان أيضا استخدام أدوات بسيطة وميسورة لتأمين بث الدروس في دائرة جغرافية محصورة، تستوعب محيط المدرسة المباشر، بحيث يستطيع من شاء أن يلتقط الدرس الذي يريد على جهاز ترانزستور صغير محمول، تتوفر فيه الموجة الترددية إف إم. إن هذه الوسيلة قد تتيح لأولياء التلاميذ – مثلا –، وهم في منازلهم، فرصة “استراق السمع” لدروس أبنائهم، ليكون بمستطاعهم أن يتعلموا منها وأن يساعدوا أبناءهم في مراجعتها.
- وبالإمكان أيضا أن تنشئ المؤسسة التعليمية الأصيلة نظام بث سمعي بصري عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة. وقد يكون هذا النظام وسيلة لمساهمة جيران المؤسسة التعليمية في تمويلها، وذلك بأن يشتركوا في خدمة البث التلفزيوني المغلق للدروس. قد يترتب على ذلك انصراف الطلبة عن الحضور المباشر استغناء بالمتابعة عن بعد، لكن شبكة من الاحتياطات، في مقدمتها تخير نوعية من الطلبة ذات دافعية عالية والتزام، وكفالتهم، وإشراكهم عبر منهج تفاعلي نشط، يمكن أن يحد من تلك المخاطر، بل وأن يمنح الطلبة دوافع إضافية للحرص على حضور الدروس والمشاركة النشطة فيها.
- من شأن المبدأ السادس أن يحد من التأثيرات السلبية للتفرغ لمادة واحدة.. إنه مبدأ “الترابط بين المعارف” حين يتحول إلى مهارة لدى المدرس، فتجده يبدع في استدعاء علوم الفقه والعقيدة والتاريخ مثلا، من خلال علم النحو، أو العكس. فبالإمكان على سبيل المثال استخدام الربط بين معارف الوحي ومعارف العقل في كثير من المجالات كالربط بين الطهارة والنظافة، وبين تحريم الزنا وخطر السيدا، وبين دراسة الإخصاب وعلم الأجنة عموما وبين ما جاء في سورتي “المؤمنون والحج” ، وبين دارسة الكسور والآيات المتعلقة بتوزيع التركة والميراث. إن هذا المبدأ الذي يتطلب خبرة مكينة ومهارة سامية يعزز التواشج بين المعارف ويخفف من جفاف الدرس المنفرد في مادة بعينها، ويساعد على ترسيخ المعلومات لما للربط بينها من تأثير مشهود في ذلك، كما أنه ينمي ملكة الاستنباط لدى الدارسين، ويقرب صورة سائدة في الوسط المحضري تزعم أن من أوتي ملكوت فن، استطاع أن يستخرج منه سائر الفنون.. إنها صورة تقوم على أن الإتقان ملكة عقلية تتعدى الحفظ إلى استنباط قواعد وأصول وأقيسة يستطيع الإنسان الذي فقه مادة معينة أن يستعملها في استكشاف مادة أخرى، فخلف الجميع نواميس فكرية فيها نسبة من الانضباط تسمح للفكر البشري بالوصول إلى المجهول بقياسه على المعلوم.
- الوسائل التعليمية
لا تحمل التجربة المحضرية دروسا كبيرة فيما يتعلق بالوسائل التعليمية غير أنها تولي عناية خاصة للتدريس على ألواح الخشب، وتزعم أن فيها بركة خاصة. وهذا ما يحسن أن يكون محل تجربة مقارنة بين فئتين من الدارسين الصغار، تستخدم إحداهما الألواح التقليدية وتستخدم الثانية الكراريس، على مدى فترة زمنية معتبرة. ومن الواضح الجلي أن التعليم بواسطة الألواح أقل استنزافا للموارد المالية.
- التقويم
تدعونا التجربة المحضرية إلى اعتماد الأفكار التالية في عمليات التقويم:
- الالتزام بالتقويم المباشر في القرآن الكريم خاصة؛
- التخلي عن التقويم الكمي في المرحلة الأساس (وهذا ما بدأت تطبقه بعض الدول مثل اليابان)؛
- تشجيع الدارسين على أن يمارسوا التقييم الذاتي ويطالبوا به، بدل أن يتصوروه سيفا مسلطا عليهم مفروضا من الآخرين؛
- إحياء الألغاز والأحاجي واختبارات الذكاء والندوة الشعرية باعتبارها أساليب للتقويم، حاملة لمتعة وفائدة؛
- إلغاء الطرد من القاموس إلا أن يكون انسحابا من الطالب أو قرارا من ذويه أو استجابة لوضعيات قاهرة، فالطرد من الفضاء التعليمي معول يهدم حياة الناس، ويتعارض مع مبدأ بذل العلم لكل من طلبه، ومواصلة التعلم مدى الحياة؛
- منح دور للمجتمع في عملية التقييم، في شتى أبعادها، وخاصة منها البعد القيمي، فانطباع الجيران –مثلا- عن هذا الطالب أو ذاك ينبغي أن يكون عنصرا أساسيا في التقويم المدرسي لسلوكه، بحيث لا يقتصر التقييم على سلوك الدارس داخل حجرة الدرس، ولا على تعامله مع معلمه ومع زملائه في الدراسة؛
- إعطاء الناجح في مادة ما فرصة تعزيز نجاحه بالتقدم فيها، وعدم تعطيله بسبب فشله أو عدم اهتمامه بمادة أخرى.
- القيادة التربوية، والمناخ التنظيمي
تعطينا المحضرة دروسا في هذا المجال نستخلص منها مبادئ أساسية عامة، وأفكارا حول تنظيم الوقت وتدبير التمويل.
- مبادئ أساسية عامة:
يدعونا استلهام التجربة المحضرية إلى استحضار المبادئ التالية:
- العمل على بناء علاقة متميزة بين الطالب والمدرس، قوامها تربية روح إكبار العلم والعلماء في نفوس الناشئة منذ الصغر (وهي عملية للبيت والبيئة فيها دور أساس)، وتنزل الأستاذ إلى حيث تكون أستاذيته “صحبة” (وفق المصطلح القرآني النبوي)، ومن مقتضيات ذلك تخفيف المسافة الفارقة بين الأستاذ وطلبته، وعدم تميزه بكرسي رفيع وبارز العلو، والتخلي عن هندسة التقابل بالتوازي في الصف الدراسي (حيث يكون الأستاذ أمام الطلبة ويكونون صفوفا متوازية تجاهه. إن النظام الأصيل يرجح هندسة التقابل الدائري، وفيها يشكل الطلبة حلقة بين يدي أستاذهم يحصل فيها من التقابل بينهم وبينه وبين بعضهم وبعض ما هو أدعى للحمة والتواصل الوجداني. وهذا ما يتطلب تصميما خاصا لفصول الدراسة أو لمواقع الجلوس فيها.
- إسناد مهمة تعليم الصبيان في مراحل الدراسة المبكرة، وفي مرحلة التهجي على الأخص (إلحاقا لها بمرحلة الرضاعة، كما يشير إلى ذلك العلامة الشنقيطي محمد مولود بن أحمد فال في قوله إن التعليم رضاع ثان)، إلى معلمات إناث، لما تؤيده التجربة من أنهن أقدر على أداء هذه الوظيفة التربوية من الرحال.
- تحويل الدارسين فورا إلى مدرسين (معيدين) بمجرد إتقانهم لمادة ما، وذلك بأن يتبادل الطلبة مهمة التدريس، بإشراف أستاذ ومراقبته.
- التخفيف من القيود الكثيرة التي تجعل المؤسسة التربوية أشبه بالقلاع العسكرية (وسنعود إلى هذا المنحى لاحقا).
- تنظيم الوقت واستثماره:
بإمكاننا أن نستوحي من التجربة المحضرية في هذا الشأن الأفكار التالية:
- تحكيم الهدف الإجرائي في تحديد مدة الدراسة اليومية، وليس العكس. فالأصل في التعليم النظامي الوافد أن يحدد الإطار الزمني مسبقا وتحشر المادة فيه، فإذا انتهت المدة المقررة لها انتهى الدرس فهم الطلبة أم لم يفهموا، اكتمل البرنامج الأصلي المقرر أم لم يكتمل. وفي النظام التربوي الأصيل يحصل العكس، حيث يحدد الطالب هدفه الإجرائي مع أستاذه (مثلا: دراسة حصة معينة محددة المقدار)، ويستمر الطالب عاكفا على درسه إلى أن ينجز هدفه، دون نظر إلى قضية التوقيت.
- تخير الوقت الأجمع للدروس المفتوحة أمام سائر الناس، لتيسير حضورهم واستفادتهم منها.
- إعادة جدولة أوقات الدراسة وفق ميزان أصيل، تربط فيه الدراسة الصباحية بموعد الصلاة، بحيث يصلى الطلبة الصبح في وقتها، ولا يكون أمامهم من بعدها إلا الوقت اللازم للإفطار والوصول إلى مواقع الدراسة. إن بعض الأنظمة التربوية العربية تثبت – على سبيل المثال – موعد انطلاق الدراسة يوميا على الثامنة صباحا، رغم أن هذا الموعد يقع في بعض الفصول بعد صلاة الصبح بنحو ثلاث ساعات (أو أكثر حسب المناطق)، وهذه عادة موروثة عن الإدارة الغربية العلمانية، لها عذرها فيها، إذ ليس لديهم التزام مربوط بوقت الفجر. أما عندنا فاليوم يبدأ بصلاة الصبح، وينبغي أن يتواصل وأن تتاح فرصة الاستراحة وقت الظهيرة قدر الإمكان، وتكون هناك عودة لدراسة مسائية، بعد العصر، لما ترويه الحكمة المحضرية من أهمية استغلال هذا الوقت، خصوصا ساعة الأصيل، لاستظهار النصوص. ولعل تطبيق هذه الجدولة يكون أيسر في حالة تفرغ الطلبة وإقامتهم قرب مقر دراستهم.
- منح الدراسة وقتا أطول في الجدولة السنوية، وتقليل مدة العطل وربطها بالأعياد، بدل ربطها بموسم الصيف، فقد كان الناس يدرسون صيف شتاء في زمن لا توجد فيه وسائل تكييف. وكانوا يدرسون ليل نهار، وكانوا يدرسون طيلة السنة تقريبا إلا أياما معدودات بمناسبة الأعياد. أما اليوم فإن الدراسة تختزل فيما لا يصل إلى 8 أشهر سنويا، بل فيما لا يكاد يتجاوز أحيانا 400 ساعة من أصل 8760 ساعة في السنة، أي نحو 5 % فقط لا غير، وهذا هدر كبير لأهم ثروة يملكها الإنسان بعد قواه وقدراته الشخصية. وعليه، فمن الضروري التأسي بالسلف من أهل الأمة (وبالمعاصرين من اليابانيين مثلا) في إعادة الاعتبار لبذل الجهد الواسع وإنفاق الوقت الطويل في الدراسة. وقد جربنا قابلية البشر للتكيف والتأقلم مع المجهود الإضافي، حيث رأينا الأطفال ينهضون سحرا ويواصلون دراستهم طوال اليوم وإلى ما بعد صلاة العشاء، لا يرتاحون إلا قليلا وقت الظهيرة، وهم في ذلك بخير، ودراستهم في تقدم. إنها دعوة لإعادة النظر فيما أصبح يعتبر مسلمات، منافحة عن منطق الكسل والاسترخاء، ودعوة إلى تقليص عدد السنوات التي يحتاجها الشباب لاكتساب المؤهلات العلمية والتربوية، عبر التكثيف الدراسي..
- قد يكون من المفيد أيضا، على بساط التأصيل، استعادة العطلة العمرية (الخميس وجناحاه) والاستعاضة بها من العطلة السائدة اليوم.
- هدم الحواجز الزمنية أمام التعلم والتعليم، فلا ينبغي أن يكون هناك حد زمني يحال فيه المدرس المقتدر المتمتع بصحته على التقاعد، ولا أن يكون هناك سقف زمني يمنع من وصل إليه من الانتساب لمؤسسة تعليمية.
- استصحاب مبدأ تعلم الجديد في كل يوم جديد.
- تمويل التعليم:
من المعلوم أن استقلالية المؤسسة التربوية في تاريخنا ما كانت لتكون لو لم يوفر لها المجتمع الكفالة المادية الضرورية بآليات مختلفة نستطيع أن نستدعي بعضها ونعيد إنتاج بعضها في لبوس ملائم لعصونا، وهذه بعض الأمثلة:
- إقامة الأوقاف الاستثمارية الآمنة وتحبيسها على العمل التربوي؛
- إحداث فضاءات تحمل اسم “الصفة” في الأحياء السكنية المدرسية/ الجامعية، تخصص لإيواء الطلبة الفقراء وإعاشتهم على نحو ما كانت عليه تجربة أهل الصفة، في العهد النبوي الأنور. ويمكن في هذا الصدد وضع نظام لاستقطاب التبرعات والكفالات من المحيط الاجتماعي المجاور وغيره؛
- إنشاء صندوق لدعم التعليم الأصيل، يكون من بين موارده: تبرعات من الدولة/ الدول، ومساهمات شركات وأفراد؛
- حث الدولة الراعية والدول المهتمة على إصدار تشريعات تلزم المؤسسات والهيئات الربحية بتخصيص نسبة، مهما قلت، من أرباحها للصرف على التعليم، بحيث تقوم هذه الأسهم أو النسب مقام مد القافلة في التراث المحضري.
- إثارة التنافس الإيجابي بين رجال الأعمال والمستثمرين، خواصا ومؤسسات، في ميدان كفالة طلبة العلم، وتشكيل مجلس أمناء أو لجنة مؤازرة من هؤلاء للنظام التربوي الأصيل.
- إحياء سنة الإخاء لأغراض تعليمية، ويكون ذلك بأن يطلب من كل رجل أعمال أو موظف سام أو فرد من أولي اليسار له ولد في مؤسسة تعليمية أصيلة أن يتأسى برسول الله r، بعقد إخاء تربوي بين ولده وبين طالب آخر، قليل ذات اليد، بحيث يتولى كفالتهما معا كما لو كانا سواء في مقام البنوة. لقد تأكد بالتجربة أن حاجات الإنسان تتقلص وتتزايد تبعا لعاداته. فإذا عود الإنسان نفسه على أن يقلص كمية غدائه مثلا بالنصف لم يلبث ذلك أن يصير له عادة فيتعذر عليه الزيادة على هذا المقدار إن هو أراد. وهذا ما أكدته تجارب معيشة في المجتمع المحضري الشنقيطي، وهو مصداق قول النبي r في حديث متفق عليه “طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة”، وفيه من رواية مسلم “وطعام الأربعة يكفي الثمانية”. وفي نحو ذلك يقول الشاعر:
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع.
وعليه، فإن المفيد أن يرسخ النظام التربوي الأصيل سنن الإخاء، واشتراك الزاد على طريقة الأشعريين، وأكل الجماعة من إناء واحد (مع مراعاة قواعد النظافة والصحة) ففيه بركة مشهودة، يتحقق بها ما ورد في الحديث المذكور.
- العلاقة مع المحيط
هناك عناصر عديدة تعزز العلاقة بين المؤسسة التعليمية الأصيلة وبين محيطها، منها التهيئة المنزلية للناشئة، وتطبيق نظام الراحلة، والمواعيد الاحتفالية، والخدمة الاجتماعية، والنشاط الترفيهي:
- تقع التهيئة المنزلية للطفل بتحفيظه معلومات رمزية مهمة من السيرة والآداب ونحوها، يسأل عنها في المدرسة فتعزز ثقته بنفسه، كما يسأل في البيت عما تعلمه في المدرسة، فيمنح فرصا مضاعفة لإثبات ذاته…
- يشكل نظام “الراحلة” أداة مهمة لتعليم العيش الجماعي وإرساء تقاليد التعاون، ويتأكد ذلك في حق المثاوي الجماعية للطلبة، فلئن وفر المثوى نفسه فرصة عامة للتساكن، فإنه من الخير أن ينقسم المقيمون فيه إلى مجموعات “رواحل” صغيرة، يمارس أفرادها الحياة الجماعية بشكل أدق، وبما تقتضيه من تقاسم الأعباء والتعاون اليومي.
- هناك حاجة لإحياء المواعيد الاحتفالية التي تسجل للدارس إنجازه السابق وتشجعه على الإنجاز اللاحق. ويكون ذلك –مثلا- بإشراك المجمتع في تكريم المتفوقين، بل وسائر الذين ينجزون في دراستهم ويصلون منها إلى محطات فاصلة.
- ومن الضروري أن تتأسى المؤسسة التربوية الأصيلة بالمحضرة فيما كانت تقوم به من خدمة اجتماعية للمحيط. كذلك على طلبتنا المعاصرين أن يقدموا مساهمة دورية تطوعية منتظمة في خدمة محيطهم (مثلا: حملات تنظيف، تشجير، حصاد أو قطاف، محو أمية، بناء مرافق عمومية…إلخ). وعموما فإنه ينبغي للمؤسسة الأصيلة أن تكون مؤسسة للحياة تربي مرتاديها على مواجهة مشاق الدنيا والسعي في خدمة الآخرين، بحيث يكون للحياة فيها معنى من معاني الخدمة المدنية (أو العسكرية) التي تحتاج إليها الدول للبناء ولغرس مفاهيم التضامن، ويحتاج إليها الشباب لكيلا يعصف بقواه الترهل والخور والاسترخاء.
- لا يجوز أن تخلو الحياة التعليمية من مقدار ما من النشاط الترفيهي النظيف، يروح به الدارسون عن قلوبهم المكدودة ويجددون به نشاطهم. ولئن كان بإمكان المؤسسة التعليمية أن تبرمج مثل هذا النشاط من خلال أندية ومسابقات وحصص الرياضات الذهنية والبدنية، فإن هذا النشاط ينبغي أن يقع في سياق تفاعلي مع البيئة المحيطة، حتى يؤدي مفعولا تربويا أفضل. وينبغي أن يتعامل المحيط مع الطلبة، في نشاطاتهم الترفيهية النقية، بروح إيجابية قوامها التشجيع والتفاعل والغض عن الهفوات. وينبغي أن لا يستثنى من ذلك إفساح المجال للتنافس في التعبير عن المشاعر الإنسانية الرقيقة بما فيها الحب العفيف، فذلك سلوك أصيل في ثقافتنا أقره الشرع الكريم (إلقاء الشعر ذي المقدمات الغزلية بين يدي الرسول r)، كما أنه مجال أثير لتنمية ملكات التعبير والإبداع الأدبي.
- إلى ذلك كله يحتاج النظام التربوي الأصيل إلى بيئة متميزة مستحدثة، سنعرض أفكارا عنها لاحقا إن شاء الله.
- الخصائص المعمارية
تحتاج الخصائص المعمارية للمشروع إلى تقديم تصاميم هندسية تستوحي صورة الفضاء المعماري وشكله من مفاهيم الحلقة والمجلس، وتكون فيه فضاءات في شكل خيم عربية، وتتحقق في التصميم والتأثيث الداخلي مقتضيات مجلس الدرس الحلقي (شبه الدائري ) الأصيل. ومن المفيد أن تحمل مباني المؤسسات التربوية الأصيلة المستحدثة أسماء مؤسسات ومرافق تربوية عتيقة، مثل الصفة، النظامية، المستنصرية، الآصفية، الأزهر، الزيتونة، القرويين، المحضرة، الخلوة، الدارة، الحوزة، على أن يعكس معمار كل من هذه المباني خصائص مستوحاة من المؤسسة التي يحمل اسمها.
القسم الثالث : الخطوط العريضة لملامح النموذج التطبيقي
يتطلب تحديد ملامح النموذج التطبيقي رسم خيارات مؤسسية والتمهيد لذلك باستحضار الخصائص الأساسية التي يفترض توافرها في النظام. وسنتحرى ذلك بدءا باستحضار ثلاث غايات وثلاث أدوات.
- مقاصد وغايات مميزة
تتلخص الغايات الأساسية التي نرى ضرورة تمثلها في النظام التربوي المنشود في غرس السجيات واستكشاف الملكات وتفجير الطاقات..
ولتتحقق هذه الغايات ينبغي أن نستخدم حزمة من التدابير والإجراءات بينها:
- حسن اختيار المدرسين ليكونوا قدوة حية حاملة للناشئة، بالحال قبل المقال، على تمثل السجايا السوية والشمائل الزكية. وفي هذا الصدد ينبغي أن تصاغ شبكة اختيار المعلمين من حزمة الخصال والسمات المقررة في تراثنا، وفي بحث المحضرة منها طائفة طيبة؛
- توجيه مجمل المعارف التي يتلقاها الدارسون نحو المساهمة في غرس هذه السجايا، وتمرين الطلبة على تمثلها والتخلق بها حتى تصير لهم خلقا من خلال مواقف حية معيشة (نترك تفصيل هذا الجانب للبحوث المتعلقة بالقيم…). ويعني ذلك إحياء رسالة التأديب التي كانت بالأساس رسالة قيم وسجايا، لا يتقنها كل العلماء، ولكن لها أهل اختصاص، ينبغي أن يعهد إليهم بها.
- العمل على إيقاظ الرغبات واستثارة الميول الإيجابية الكامنة في نفس الإنسان تجاه المعرفة والنشاط الإنساني النافع والمبدع، واختبار مدى قدرة الدارس على امتلاك المعرفة المستحثة لتلك الملكات، ووضعه تحت التجربة العملية للتثبت من تناغم الرغبة والمعرفة والعمل، بالنحو الذي يؤكد حضور الملكة ووجود الطاقة وقابليتها للتفجير والتحرير.
- وسائل وأدوات أساسية
ونحن إذ نقر بتعدد الوسائل والأدوات المعينة على تحقيق هذه الغايات حتى من داخل النظام التربوي الوافد، فإننا سنركز على ثلاثة وسائل وأدوات هي بالنظام التربوي الأصيل أخص وأعلق. وهي تحطيم الأغلال والتخفف من الأثقال وتكثيف الأعمال.
- لنحطم هذه الأغلال
يطوق النظام التربوي الوافد المجتمع التعليمي بسلسلة من القيود والأغلال تقدم في شكل أنظمة وضوابط ومعايير، وهي في جوهرها متضمنة لكوابح وحواجز تعطل الحركة وتحد من فضاءاتها، وهي أغلال متشابكة، يتولد بعضها عن بعض.
- غل الوهم بعلوية النظام المدرسي الوافد وبحتمية الاستسلام له. إنه قيد القيود الذي ينبغي أن نبدأ بكسره، حتى لا نظل مرتهنين لأسلوب التعليم الدخيل المستنبت وأنظمته وبناه، فعلينا أن نتحرر من الوهم بأنه الأفضل، وبأن العصر يفرضه، وبأنه لا بديل عنه؛ والحال أن العصر كله يئن تحت وطأة العلل المستحكمة لهذا النظام التربوي. وفي الغرب – خاصة – حيث ولد هذا النظام وترعرع وقدم أحسن ثماره، يتحدث الناس اليوم بصوت عال عن “أزمة المدرسة” ويبحثون عن “المدرسة الأخرى” و”مدرسة المستقبل” و”التعليم البديل”، وتنتظم مئات آلاف الأسر في أمريكا خاصة في جمعيات تناهض التعليم المدرسي، وتسعى لتعليم أبنائها في البيت وفي فضاءات أخرى، حرصا على حسن تربية أبنائهم ويأسا من أن توفر لهم المدرسة النظامية الحالية التكوين الذي يطمئنون إليه. لقد ارتفعت في الشرق والغرب أصوات كثيرة تشكو من خطر القطيعة التي تحدثها المدرسة بين المتعلم ومحيطه إلى حد أن عامل الاجتماع الصيني فاي Fei وصف المدرسة بأنها عامل انجراف اجتماعي facteur d’érosion sociale [99]بل إن الضيق بعجر المدرسة وبجرها بلغ حدا جعل بعض المفكرين في الغرب يدعو إلى “مجتمع بلا مدارس” Deschooling society ، كما يشير إلى ذلك عنوان كتاب للمفكر والأكاديمي الكبير إيفان إيليتش Ivan Illich ويبشر بوفاة المدرسة School is dead كما ورد في عنوان كتاب آخر لريمر E. Reimer. لقد اعتبر هؤلاء أن المدرسة مؤسسة تسلطية، وأنها نشأت لتلبية أغراض محدودة للمجتمعات الصناعية الغربية في مرحلة من مراحل تطوره. ونحن واجدون بين دعاة الثورة على المدرسة من أولئك الغربيين من يردد مقولة شبيهة بما يقوم عليه النظام التربوي المحضري الأصيل، فقد مر بنا –مثلا- انتقاد هولت J. Holt للطبيعة السلطوية للمؤسسة المدرسية وتعارض هذه الطبيعة مع الرسالة التربوية. لقد أدرك أولئك وهم أعلام مرموقون في معاقل المدرسة الغربية بعض مكامن الداء فيها، ودعوا للثورة عليها؛ فهل يعقل أن نتخذ نحن موروثنا التربوي ظهريا، ونظل نلهث خلف أولئك الذين اتخذوا مدرستهم النظامية صنما إلى أن تحين منهم انتباهة، فيغيروا المسار وقد أدركوا أن الطريق التي سلكوها غير سالكة، فنسرع خلفهم القهقرى، مرة أخرى، لنصل بعد ضياع وقت واستفراغ جهد إلى نقطة كانت إلينا أقرب منها إليهم ؟
إن إنشاء مؤسسات تربوية عادية منضبطة بضوابط التعليم النظامي، محكومة بمناهجه -وإن بجرعة تجديد وتأصيل- متوجة بشهادات من نفس النوع لن يخرجنا من التيه الذي تقلبنا فيه أربعين سنة وتزيد من أعمار “دولنا المستقلة”، بل سنظل أسرى الواقع المألوف ورهائن الأمر المعهود.. المطلوب هو حركة تثوير في التعليم ترفض المفروض، وتخرج على المألوف، وتطلع بجديد يصلح لنا ويُصلح مما بنا، ويكون باستطاعتنا من خلاله أن نقدم مساهمة معتبرة للعالم في معالجة أزماته التربوية الخانقة. وسيمر ذلك حتما بتحطيم المزيد من الأغلال..
- غل الارتهان لنظام الضوابط والمعايير المتكلس الذي يقوم عليه التعليم المدرسي الوافد. بل دعونا نذكر أن النظام التربوي العربي الإسلامي نفسه هو في أرقى تجلياته التاريخية نظام ضد المؤسسة. لقد برزت من رحم هذا النظام مؤسسات مدرسية عتيقة عريقة، كما هو موضح في المباحث الأولى، لكن دور هذه المؤسسات ظل محدودا قياسا إلى دور الأفراد الذين كان كل منهم أمة بعلمه وعطائه. فقد ذكر د. بشار عواد معروف أن الإحصائيات التي أجريت على العلماء في كتب التراجم والسير بعد ظهور المدارس (في القرن الخامس الهجري) تشير بكل وضوح الى أن الذين تلقوا علومهم في المدارس كانوا قلة قليلة قياسا إلى من تلقى العلم خارجها. وقد روى عن بعض العلماء أنهم لما بلغهم تأسيس المدارس ببغداد “أقاموا مأتم العلم وقالوا: كان يشتغل به أرباب الهمم العليا والأنفس الزكية يقصدون العلم لشرفه والكمال به فيأتون علماء ينتفع بهم وبعلمهم. واذا صار عليه أجرة تداعى إليه الأخساء وأرباب الكسل فيكون (ذلك) سببا لارتفاعه “[100]. وعليه، فإن مجتمعا يقاوم مؤسسة مدرسية برزت من رحمه، قمين بأن يجد المؤسسة المدرسية الوافدة أبعد رحما، وأعجز عن الوفاء بحاجاته. وليست المشكلة والحال هذه في المناهج والمضامين التعليمية وحدها، وإنما هي -قبل ذلك وبعده- في أساليب الضبط والسيطرة على الأفراد، فمن خلال التقيد بتعليمات جافة مثل “أوقات الدوام وأوقات النوم وأوقات الفراغ وقواعد السلوك [داخل المدرسة] وقوائم الممنوعات الطويلة، يتعلم التلميذ شيئا آخر إضافيا هو المحافظة على” قيم ترسخ الوضع القائم، وهذا ما يطلق عليه إيليش “المنهج الخفي” لذي يؤثر في الدارس أكثر مما يؤثر فيه المنهج الجلي (المعلومات). ومن ناحية أخرى، فإن عملية التعلم الخطي تجعل “الكتب الدراسية وأساليب التقويم مملة ورتيبة، تخنق روح الإبداع والابتكار بين الطلبة”[101]ا. وهكذا فإنه لا يستغرب أن تكون المؤسسة المدرسية على هذا النحو أداة لإعادة إنتاج النظام الاجتماعي الذي ولدها، على حد تعبير عالمي الاجتماع الفرنسيين بورديو وباسرون Bordieu – Passeron[102]. ويصبح الأمر أكثر إرعاجا عندما تكون هذه المؤسسة – كما هو الحال في بلداننا- أداة لاستنساخ أنماط فكرية وأوضاع حسية لمجتمعات غير مجتمعاتنا، ثم لا تنجح في تعديلها وتكييفها مع أوضاعنا إلا في حدود استنساخ أجزاء، كثيرا ما تكون معيبة، من أوضاعنا الخاصة.
- غل السير بسير الضعفاء.. ذلك مبدأ سديد وجميل في شأن الرفقة تجوب الموامي والبراري الطبيعية، لا يجوز أن يتعجل بعضها عن بعض، وهو –ولك أن تعجب- مبدأ يحكم بعض المبتكرات العلمية الحديثة، فقد وقعت لي واقعة ذات دلالة، إذ بينما كنت أحبر هذه الورقات، تعطلت فجأة بطارية ناظومي المحمول (الكمبيوتر)، فذهبت به إلى مهندس صيانة معلوماتية. فتح البطارية أمامي فانكشفت لي بعض أسرارها الداخلية.. وجدت بداخلها صفا متراصا من ثلاث بطاريات صغيرة متماسكة متضامنة. فحص المهندس البطاريات، فوجد اثنتين بصحة جيدة، ووجد الثالثة معتلة، قد فقدت نحو 60% من طاقتها الأصلية. قلت لصاحبي: ما السر في أن البطاريتين السليمتين عاجزتان عن تعويض النقص في البطارية المعتلة؟ قال إن نظام الرقابة الألكترونية (وأراني موقعه) قائم على تعطيل عمل البطارية الصحيحة بمجرد وقوع اعتلال في إحدى البطاريات. قلت هذا هو تماما ما تفعله المدرسة بأبنائها حين تفرض عليهم قانون سير القافلة في الصحراء القاحلة.. إنها تعطل سير الأصحاء الأسوياء، لأن معهم في ذلك الصف غير المرصوص مرضى سقاما أو معوقين. وما ينبغي لمثل هذا القانون أن يحكم على السائرين في مسالك العلم الصاعدين في معارجه، فلهؤلاء شعار آخر هو بهم أولى: {واستبقوا الخيرات}، {وفي ذلك فليتنافس المتنافسون}.. لكن النظام التربوي الوافد لا يفقه هذا المبدأ إلا في حدود ما يسمح به نظام المسايرة الإجباري في الفصل الدراسي (نظام بطاريات الناظوم أو القافلة العابرة لمتاهات الصحراء).. لماذا نفرض على طالب ذكي متفوق قادر على الهرولة أو العدو نحو هدفه المعرفي أن يسير ببطء لأن معه في الفصل طالبا آخر لا يستطيع أن يعدو أو يهرول؟ لماذا لا نطبق على المتبارين في التعليم نظام المتبارين في الرياضة مثلا؟ أليس من حق أحدهم أن يقطع في ساعة ضعف ما يقطعه آخر فيها؟ إذا كان باستطاعة طالب أن يختزل برنامج عشر سنوات في خمس، فلماذا نحكم عليه بالتأخر خمسا، فنهدرها من حياته لأن نظام الدراسة يقتضي أن تسير الجماعة بنفس النسق ونفس الوتيرة؟ لندع كلا يسير حسب طاقته، حتى لا يختل عمل الناظوم كله باختلال جزء منه…
- غل نظام التقييم الكمي المتحكم في مصائر الدارسين، عبر اختبارات متسارعة وامتحانات متلاحقة، وبأدوات غير دقيقة ولا موضوعية.. إنه نظام يرتهن مصير الطالب لتقدير فرد، قد يكون في حالة إعياء أو استعجال، وقد يخطئ في قراءة كلمة، وقد يكون غير كفء أصلا للعمل الذي يقوم به، وقد يسند نقطة أو درجة بشكل شبه عشوائي لكثرة ما مر به من النقاط، وقد يؤثر عليه تقييم ورقة سابقة. وهو – إذا اجتهد وأصاب – لا يعدو أن يقيم جانبا كميا صرفا، يتعلق غالبا باستذكار قسط من المعلومات، لا غير. إنه نظام يرهق الدارسين ويرهبهم ولا ينصفهم بالوصول إلى تقدير قيمهم ومهاراتهم وسائر معارفهم.. إنه نظام يحصر همّ الطالب في الحصول على مؤهل ورقي في نهاية دراسته، ويخفض بهذا الشكل سقف طموحه. وهو نظام لا يقيم وزنا للعالم إذا كان لا يحمل ذلك المؤهل الورقي. ولنتأمل واقعة سجن نحو 20 إماما في المغرب، مؤخرا، بتهمة تزوير شهادات بكالوريا (ثانوية عامة!).. إمام يرشد الناس ويعلمهم، له بحكم إمامته شهادة جماعة المصلين وتقييمهم الإيجابي، يفشل في تسويق معرفته في النظام التربوي المعاصر، فيضطر للبحث عن “ورقة” يشرع بها مؤهلاته! ذلك دليل جلي على إفلاس نظام التقييم المعاصر وضيق عطنه وعدم صدقيته. وقد بلغت النقمة على هذا النظام حدا جعل بعض من تمكنوا من النجاح فيه يكفرون به وبالتعليم النظامي كله في نهاية الأمر، كما وقع لحسين بدر الدين الحوثي الذي حصل على شهادة الماجستير، وشرع في التحضير لنيل شهادة الدكتوراه، ثم ترك مشروعه الدراسي، ومزق شهادة الماجستير، متعللا بأن الشهادات الدراسية عبارة عن تجميد للعقول. وبالمقابل، نجد آخرين، من أهل العلم، لا يشفع لهم نصيبهم من العلم في الدخول إلى النادي المغلق لموظفي الدولة. وقد بدأ الغربيون أنفسهم ينتبهون إلى مزالق هذا النظام ومثالبه، فهذا ريتشارد جاردنر يكتب في صحيفة الأندبندانت: “إننا في الوقت الحالي ننتج جيلا من الأطفال هم الأكثر تعرضا للاختبارات والامتحانات، وهو ما يدفعهم لترك المدارس”. ووعيا بقصور هذا النظام، تعالت في أمريكا أصوات تدعو إلى استصدار قانون النجاح للجميع Success for All Act ، ورفعت مشروع “لا للتخلي عن أي طفل” No child left Behind Act ، ودعت إلى تغيير النظرة التي تقيس الذكاء بالمعدل الدراسي. وترديدا لذلك الصدى، تحدث بعض الباحثين العرب عن “رؤية جديدة” تتجاوز التقييم الجزائي المستند إلى أحكام تصنيفية معيارية نحو تقييم تكويني أي موجه لأغراض التقويم وتسديد عمليات التكوين[103]. ألا نجد في كل ذلك ما يدعونا للعودة إلى أساليبنا التربوية المرنة الحكيمة والحصيفة، لنجد فيها ترياقا لتلك الكوابيس التي تقض مضاجع أبنائنا؟
- غل المعدل العام، وهو فرع من سابقه.. لماذا يحصل طالب ما على معدل 17/ 20 في العلوم ونحكم عليه بالفشل لأن معدله في الرياضيات أو في اللغة أو في الجغرافيا كان صفرا أو فوق الصفر بقليل؟ لما ذا نحبط عمل الدارس ونشطب نجاحه في مادة ما لأنه فشل في غيرها؟ لما ذا لا نسمح له بالسير في الاتجاه الذي يحبه ويستسيغه ويملك القدرة على التقدم فيه؟ ما ذا لو شهرنا على الخليل بن أحمد سيف المعدل العام وقلنا له: لا يجوز لك أن تكون نحويا أو عروضيا إلا إذا كنت ضليعا في خمس عشرة مادة أخرى؟ ما ذا لو قلنا لسيبويه: لا ، لا يحق لك أن تكون نحويا لسانيا إلا إذا نجحت في امتحان التاريخ والجغرافيا؟ ذلك غل من الأغلال وإصر من الآصار ينبغي أن نضعه.
- غل الغرف المغلقة.. حيث لا يحق لطالب علم غير مسجل أن يغشى مجلس الدرس، وحيث يتحول مجلس العلم إلى ناد مغلق محصور العضوية.. ليس على النظام التربوي الأصيل أن يستوعب كل الناس، ولكن من همه أن لا يطرد عن مجلس العلم أحدا، إذا كان له متسع فيه. وبإمكانه اليوم أن يحقق جماهيريته عبر الاستماع الحر، بل والمشاهدة حيثما توفرت الظروف لذلك.
- غل السقوف الزمنية: الزمن في النظام التربوي الوافد عامر بإشارة منع المرور:
- ممنوع أن تحضر الدرس، إذا تأخرت بضعة دقائق.. ممنوع أن تدخل المدرسة قبل سن الخامسة أو السادسة.. وممنوع أن تدخلها بعد التاسعة أو العاشرة.. والحال أن العلم في تراثنا منهل عذب لا يحلّأ عنه أحد، ولا حد له في العمر ولا أمد.. والأطفال عندنا مؤهلون للشروع في تعلم القرآن وهم في سن الرابعة، فكيف نستصغرهم ونذودهم عن حوض المعرفة فيما سواه، إلا إن كان ذلك بقصد تفرغهم له؟ ثم لماذا نحكم على أشخاص أحياء لهم الرغبة في التعلم والقابلية له بالسجن في جهالتهم بحجة أن سنهم القانونية لا تسمح؟! لو أن علماء أجلاء مثل صالح بن كيسان والفضيل بن عياض والكسائي وابن القاسم وأصبغ وابن العربي وابن حزم والعز بن عبد السلام والرازي والقفال توجهوا إلى المدرسة يطلبون علما وهم فيما بين الثلاثين والسبعين لقيل لهم: ممنوع الدخول، وأوصدت في وجوههم إلى الأبواب، والحال أنهم نبغوا وتألقوا في النظام التربوي الأصيل، رغم أنهم إنما انصرفوا لطلب العلم عن كبر.
- ممنوع على العالم أن يعلم (موظفا) بعد تجاوز “السن القانونية” أو قبل الوصول إلى “السن القانونية”.. وتراثنا قائم على بذل العلم متى حصل وإلى آخر نفس.. ليس العلم مادة للكنز والاحتكار، وإنما هو مادة للبذل والعطاء بغير حدود، ولذلك انتصب النوابغ من علمائنا للتدريس قبل سن العشرين، وواصلوا بعد الستين والثمانين والتسعين، بل إلى اللحظات الأخيرة من حياتهم.. لا يحال العالم في تراثنا على المعاش لكبر سنه، ولا يمنع من التدريس لصغر سنه.
- ممنوع أن تعيد السنة الدراسية للمرة كذا، بل ومحكوم عليك بالطرد.. وتراثنا حافل بقصص العلماء الذين أعادوا دراسة المتن الواحد مرارا كثيرة ومددا طويلة حتى تمكنوا من فهمه واستيعابه وبرعوا فيه، ولو طردوا بعد المحاولة الأولى أو الثانية لكان لهم وضع آخر.
- هذه المادة الدراسية تدرس في هذا الوقت حصرا من اليوم وفي هذا الحيز من السنة الدراسية حصرا، وحين تنتهي المدة الزمنية المقررة يطوي السجل الكتاب، وترفع المادة، ويودعها الطالب أحيانا إلى غير رجعة.. لا يهم إن كان أتقنها أم لم يتقنها.. المهم أن يحصل على معدل عام يسمح له بالتجاوز، بينما الأصل أن لا يترك الدارس مادته حتى يتقنها.. ومراعاة لهذا الأصل، مكث عمر بن الخطاب رضي الله عنه اثني عشر عاما في حفظ سورة البقرة، فلما أكمل حفظها نحر جزورا إطعاما للناس وشكرا لله.
- المدرسة مغلقة في أوقات من اليوم وفي شهور من السنة.. والناس في إجازة من طلب العلم.. والأصل أن يعتبر العلم غذاء للروح، فلا تطلب منه الإجازة إلا لماما، كما لا يطلب البدن الإجازة من غذائه إلا لماما.
إن علينا إذا أردنا أن نجدد ونبدع أن نحطم تلك الأغلال، ونعطي الجمهور التربوي حريته ونطلق يديه، ومن متطلبات ذلك أن نخفف الأحمال التي تنوء بظهور أبنائنا قبل صدورهم.
- لنتخفف من هذه الأثقال:
هي ثلاثة أثقال أساسية، لا ندعو إلى رميها أرضا، وإنما ندعو إلى التخفف منها، وهي:
- كمية المواد الكثيرة التي تفرض المدرسة على الطفل “تعلمها”؛
- عدد الاختبارات والامتحانات ذات الطابع الكمي الصرف؛
- عدد السنوات التي يتطلبها الحصول على مؤهل للمشاركة النشطة في الحياة.
- إن التلميذ أو الطالب في النظام التربوي الوافد هو – غالبا- ذلك المنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى:
- لا أرضا قطع، لأن ذهنه يتشتت بين كمية كبيرة من المواد، يطلب منه أن يفقه كلا منها، ولا يمنح لذلك الوقت الكافي، ولا المناخ النفسي التربوي الحافز، ولا آليات الاستذكار والاستبقاء بعد فوات الغرض من تعلم المادة (اجتياز اختبار أو امتحان). وكل ما يقع في النهاية، وفي أغلب الأحوال، هو أن يعجز الدارس عن السير قدما في أي مادة من هذه المواد، وإنما يتقدم خطى وئيدة قد تحرره من الأمية ولكنها لا تمكنه من ناصية العلم والمعرفة. وهكذا وصفت والدتي – رحمها الله – المدرسة حين قالت إنها “قضت على الجهل وقضت على العلم”.
- لا ظهرا أبقى، لأنه ينوء بثقل العبء الذي يحمله حسيا (لاحظ كمية الكتب والكراريس التي يحملها الطفل على ظهره كل يوم إلى المدرسة) ومعنويا (كشكول المواد الدراسية التي يطلب منها أن يحصل فيها أو في كثير منها على المعدل).
وعليه فإن التخفف من هذا الحمل يقتضي تطبيق مبدأ التعليم الأصيل المتمثل في إفراد الوجهة والانصراف إلى دراسة مادة واحدة إلى حين الفراغ منها، ثم الانتقال إلى غيرها، وفي التفرقة بين ما هو في العرف التقليدي تعليم أساس، وما هو من قبيل “المتمات”، وقد كانت تتمثل عند سلفنا في المنطق وعلوم البلاغة والطب ونحوها.. لكن المطلوب اليوم هو تمثل روح هذا التصنيف لا شكله، بحيث يركز الدارس على مادة بعينها، تضاف إليها وفق نظام مرن ولكن دقيق مواد أساسية ينبغي تعميمها، ويمكن تيسيرها بأسلوب يجمع بين الإفادة العلمية والترويح الناتج عن التنويع. وفي هذا الصدد، يمكن أن تشكل المواد المشار إليها في فقرة المضامين التعليمية الجذع المشترك والقاعدة التي تنبني عليها وتتواشج معها كل التعلمات المتخصصة. كما أنه يمكن تقديم مقادير محدودة من مواد دراسية متنوعة، ليس بغرض الانخراط في دراستها كلها ولكن بغرض استكشاف ميول الدارسين وملكاتهم العلمية، فإذا أثبت العملية الاستكشافية أن طالبا ما له ملكة خاصة في الرياضيات، وجه إليها في وقت مبكر، واقتصر له من غيرها على مواد “الجذع المشترك”، وقل بمثل ذلك في سائر المواد. وإذا تكشفت ملكة موسوعية لدى بعض الدارسين عومل على أساسها وهيئت له أسباب التبحر تدريجيا في معارف شتى. وهكذا يسدد الجهد ويحدد القصد، وتصرف المواد الكثيرة التي تشوش عقول جل الفتيان إلى برامج المطالعة الحرة ليأخذوا منها وفق الحاجة أو الإمكان أو الرغبة.
- أما الاختبارات والامتحانات فهي أيضا حمل ثقيل ينبغي التخفف منه، خاصة وأنه قد يكون حمل قش وتراب، فقد عززت الامتحانات من سلعية المدرسة، وجعلت الهدف الأسمى للطالب هو الشهادة أو كشف الدرجات، ولا يعنيه في شيء أن يكون هذا الكشف صادقا أو لا يكون؛ لذلك تفشت ظاهرة الغش المدرسي، وبلغ الأمر ببعض طالبي “المؤهلات” العليا حد التعاقد مع مكاتب دراسات لتنجز لهم رسائلهم وأطاريحهم مفصلة على المقاس، فذلك هو منطق المؤسسة المدرسية عندما تصبح –عبر نظام الامتحانات- سلعة أو شركة تجارية، خلافا لما حذر منه الكاتب الفرنسي كريستيان لافال Christian Laval في كتابه “المدرسة ليست مؤسسة تجارية”[104].. لكن تلك هي طبيعة ذلك النظام التربوي، فينبغي أن نواجهها بحذر، وأن نخضع حمل الامتحانات الذي تثقل به كواهل أبنائنا لمراجعة تتناول كمياتها ومواعيدها وأساليب تقديمها وتقييمها.. وينبغي التوجه خاصة نحو:
- تشجيع المبادرة الذاتية لدى الطالب للتقويم؛ممارسة أساليب التقويم المرنة التفاعلية، التي يجريها الطلبة بشكل شبه عفوي فيما بينهم خاصة وفيما بينهم وبين محيطهم التربوي؛التركيز على التقويم التطبيقي (مثلا: الطالب الذي يدرس مادة ما يقوم بتدريسها، تحت نظر أستاذ متمكن…)؛
- الاهتمام بالتقويم الإجمالي الجامع بين تقييم المعارف والمهارات والقيم.
وعموما فإن كابوس الامتحان الذي يشكل، في ذهن الدارس، هوة عميقة يخشى أن يسقط فيها، فتنكسر أشرعته، ينبغي أن ينحى بشكل حكيم وحصيف.
- أما حمل السنين الدراسية فهو أيضا بحاجة إلى تخفيف، ذلك أن أسواق العمل الذهني مصممة غالبا لاستقبال حملة شهادات جامعية، قل من يصل إلى الظفر بها إلا وقد أوغل في العشرين وشارف الثلاثين.. ونحن أولو ثقافة يصبح الفرد فيها مكلفا، أي مؤهلا لتحمل المسئوليات ما بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة. ومن المفروض أن يعمل النظام التربوي الأصيل المنشود على تخريج كفاءات قيادية وتنفيذية في مثل هذه السن. لقد كان أسامة بن زيد أميرا على جيش المسلمين وفيه كبار الصحابة، وهو ابن ثمانية عشر عاما، وكان ابن عباس ركنا في المجالس العلمية وهو في حدود العاشرة. وانتصب مالك والشافعي وابن تيمية للتدريس والإفتاء دون العشرين. وفي العمر الذي يكون فيه أحدنا اليوم يكدح من أجل الحصول على شهادة جامعية عليا، متفرغا لها بالكلية، كان رجال من أمثال النووي قد ملأوا الدنيا وشغلوا الناس بعلمهم وبمؤلفاتهم الثمينة. ولئن كان الطفل الآمريكي بارمورال أمباتي قد تخرج من كلية الطب في نيويورك وهو في سن السابعة عشرة، فإن ابن سينا كان قد أصبح طبيبا ومدرسا للطب في سن السادسة عشرة، ولم يبلغ الثامنة عشرة حتى استوفى علوم عصره، حيث يقول: “فلما بلغت ثماني عشرة سنة من عمري، فرغت من هذه العلوم كلها. وكنت إذ ذاك للعلم أحفظ ولكنه معي اليوم أنضج، وإلا فالعلم واحد لم يتجدد لي بعده شيء”[105].
ولا يعني تقليص الآجال الزمنية أن نوقف الدراسة في وقت مبكر، وإنما أن نفرغ من إعداد الفرد لتحمل مسئولياته والمشاركة الفاعلة في محيطه، ولخدمة أمته والإنسانية، وهو دون العشرين، ثم نتركه بعدئذ يطور مواهبه وقدراته بنفسه، وعلى قدر همته.
وليكن واضحا أن التخفف من تلك الأثقال ليس دعوة إلى التكاسل والاسترخاء، بل هو على العكس من ذلك دعوة إلى تكثيف الجهود ومضاعفة الأعمال.
- لنكثف الأعمال
للإنسان طاقات كبيرة مهدرة. وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن البشر لا يبذلون في المتوسط إلا 4% من الطاقة العظيمة التي زودهم بها الخالق. وكان هذا المعنى حاضرا في موروثنا وتقاليدنا، فقد قالوا إن “همة المؤمن أقطع من السيف”… “ولو تعلقت بما وراء العرش لبلغته”، وقديما قال المعري:
وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل.
فينبغي للنظام التربوي أن يربي الناشئة على تمثل هذه المعاني، بما يقتضيه ذلك من استفراغ الوسع وطلب الإتقان والتميز، والطموح إلى الأعالي، وعدم الإخلاد إلى الأرض. وهذا ما لا تقدمه المدرسة الوافدة، بما فيها من هدر للطاقات وتبذير للأوقات في العطل والراحات. إنها مؤسسة تربي أبناءها على اعتبار العلم عبئا يحمله الطالب ليتخلص منه في أول سانحة، ولذلك سبب عضوي جلي؛ فقد كان الالتحاق بالمدرسة أشبه شيء بعمليات التجنيد، ذلك أن قوى العسكر والإدارة كانت تستنفر لها في كل موسم، ولا تتردد في استعمال الإكراه عند الاقتضاء. وكان العبء مضاعفا في جانبه النفسي بما يتجشمه “المجند” وذووه من عناء جراء هذه العملية. ومن هذا المنظور كان من الطبيعي أن تبرمج عطل وإجازات متكررة وطويلة يتنفس فيها “المجندون” الصعداء. أما في نظامنا التربوي الأصيل فإن طلب العلم يمثل نقطة تقاطع بين المتعة والمجاهدة، فالإنسان يستمرئ تعلم الجديد في كل يوم، ويدخل في منافسة مع أقرانه، بل ومع نفسه، يتوق من خلالها إلى التفوق والتميز، فيتجاوز عتبة المتعة المحضة إلى ميدان الكد المتواصل، الذي تتضاعف به من جديد متعة التطويح الدائب في سماوات العلم والمعرفة. وعليه، فإنه لا معنى في ثقافتنا لأن تعطي الإنسان راحة طويلة من أمر يستمتع به وينتفع به. وبقياس أدنى، يمثل طلب العلم ترويضا للعقل وتمرينا للروح. وكما أنه من المطلوب المحمود أن يمارس الإنسان الرياضة يوميا لترويض بدنه، فإنه من المطلوب من باب أولى أن لا يترك “عضلات” عقله وروحه تترهل بالإقلاع يوما ما، أحرى مدة طويلة، عن التعلم والبحث والتأمل. وهكذا فإنه من الضروري أن يقلص الزمن الميت في النظام التربوي المنشود تقليصا بينا، وأن تنمى لدى الطلبة الدوافع الذاتية للإكباب المستمر على المطالعة، حتى تحصل لهم حال كحال أسلافهم ممن كانوا ينشغلون بطلب العلم ليل نهار إلى حد أن بعضهم قد تعتاص عليه مشكلة علمية فيجد حلها في نومه من كثرة ما ينشغل بها ذهنه. ويتطلب ذلك التفرغ جل الوقت للدراسة والمراجعة والمذاكرة، وحجز أوقات محدودة لممارسة الرياضات الذهنية والبدنية ومشاهدة التلفزيون أو البرامج السمعية البصرية (مع تخير المادة) ونحو ذلك من الأنشطة الترفيهية التي يحسن أن تكون كلها حاملة لرسالة تربوية. وبهذا النحو من تكثيف الجهد، وبما يواكبه من تدابير تحفيزية، يتمكن النظام التربوي من تفجير الطاقات الكامنة في الأفراد، فيحسن من أدائهم في الدراسة وفي الحياة، ويقلص من المدد الزمنية المعهودة لإعدادهم لتحمل المسئوليات.
- نحو خيارات تطبيقية كبرى
يدعونا تطوافنا السابق إلى البحث عن مسار آخر غير المسار المدرسي التقليدي. وها نحن نعرض أدناه رؤية لهذا المسار تنطلق من تحقيب تربوي مختلف وتصل إلى اقتراح نمط مؤسسي مختلف أيضا، محكوم بضوابط أساسية للعمل.
- نحو تحقيب تربوي مختلف
في المسار المنشود، نقترح إعادة تحقيب مراحل الدراسة بأسماء ومضامين جديدة، لتتشكل من ثلاثة مراحل هي:
- مرحلة التأديب، وفيها يقع التركيز على حفظ القرآن الكريم والمتون الصغيرة التأسيسية، والتنشئة على مكارم الأخلاق ومحاسن القيم. وهدف هذه المرحلة هو بناء الأساس الصلب المتين الذي تنبني عليه كل المكتسبات اللاحقة، ويكون لها بمثابة التربة الطيبة التي تنغرس عليها الأشجار المثمرة. وهي بذلك تعتبر مرحلة التأسيس والبذر لأي تعليم أصيل؛
- مرحلة التعليم أو مساق النحلة (= الرعي من كل نابتة)، وفيها يتلقى الدارس معارف أساسية متنوعة، يصدر منها بثقافة عامة واسعة في ميادين معرفية مختارة، يكون بها من أهل “الفتوة“. وفي هذه المرحلة يقع استكشاف القابليات الذهنية والميول المعرفية للدارسين، بحيث يكون باستطاعة النظام التربوي أن يوجههم الوجهة الملائمة لهم في المرحلة اللاحقة؛
- مرحلة التزكية، أو مساق القبلة (=إفراد الوجهة). وهي مرحلة تنمية كبرى للمعارف، ينتسب إليها أولئك الذين تتكشف لديهم قابليات خالصة لاكتساب معارف معينة والتعمق فيها، فيتعين عليهم أن يولوا وجوهم شطر تلك المعارف تحديدا. ومنها يصدرون بمؤهل القدوة / الإمام في مجال معين أو مجموعة مجالات.
وتقاس جميع هذه المراحل بمضامين التكوين لا بالسنين. ومع ذلك، فإن هدف النظام التربوي الأصيل المنشود ينبغي أن يكون تقليص المدة الضرورية لتأهيل قيادات المجتمع لا إطالة هذه المدة. وعليه، فإنه يفترض أن يكون الطالب المنتسب لهذا النظام قادرا على التخرج بما يفوق أو يعادل مؤهلا جامعيا عاليا في سن الثامنة عشرة، وهي سن البلوغ التي لا خلاف عليها بين الفقهاء، وفيها ينبغي أن يتأهل الشاب للقيادة واتخاذ القرارات الحرة المسئولة.
هذا، ومن المعلوم ضرورة أن العمليات الثلاث (التأديب والتعلم والتزكية) تتداخل لتنتظم جميع المراحل أو الأطوار المذكورة، لكن كل واحدة منها تتقدم على الأخريات في مرحلة معينة فتعطيها اسمها، من باب تسمية الشيء بجزئه الأعظم.
- أي إطار مؤسسي للتعليم الأصيل؟
مر بنا أن التعليم الأصيل هو في جوهره تعليم غير مؤسسي (بالمعنى التنظيمي المعهود)، وأن ذلك كان سرا من أسرار قوته ونجاعته. ومرت بنا كذلك الدعوات الحديثة التي ارتفعت من الغرب، حربا على المؤسسة المدرسية، ودعوة إلى كسر قيود النظام التربوي المستحدث، شبيهة في جوانب كبرى بدعوة نظامنا التربوي الأًصيل. ومع ذلك فالتخطيط للمشروع المنشود يقتضي نسبة من العمل المؤسسي نقترح هنا الأخذ بها دون التضحية بهوامش الحرية الحافزة للسير الإبداعي. ومن هذا المنطلق نقترح العمل في مسارين: مسار يخوض فيه المشروع تجربته الخاصة المكثفة الموجهة لبناء نظام تربوي أصيل مبدع، وفيه نتحدث عن “مؤسسات النظام التربوي الأصيل”؛ ومسار يتواصل فيه نظامنا المنشود مع الأنظمة التربوية المحيطة به من أجل تلقيحها والتأثير الإيجابي فيها، وفي هذا المسار نتحدث عن “مؤسسات وتدابير التأصيل التربوي”.
- مؤسسات النظام التربوي الأصيل..
نقترح اعتماد أربع مؤسسات موجهة مباشرة لأغراض النظام التربوي الأصيل، وذلك على النحو التالي:
- تكون لمرحلة التأسيس (التأديب) مؤسسة مختصة تناظر ما يعرف بمرحلتي روضة الأطفال والتعليم الأساسي. وفيها يركز على غرس الأخلاق والقيم الفاضلة وحفظ القرآن الكريم والمتون والمعارف التأسيسية المشار إليها عاليه.
- تكون لمرحلة التعليم (مساق النحلة) مؤسسة مختصة تناظر ما يعرف بمرحلتي التعليم الإعدادي/ المتوسط والثانوي. وفيها يركز على استيعاب معارف متعددة، طبقا لمبادئ التدرج ووحدة المادة الدراسية والأخذ من كل علم بطرف. ويكون للبرنامج الأساسي برنامج تكميلي إضافي يقدم مفاتيح مختارة من المواد العلمية والرياضية ونحوها من المعارف العصرية الأساسية، لا بهدف التعمق فيها، وإنما بهدف استكشاف الملكات والقابليات الذهنية لتحديد توجهات الدارسين لاحقا.
- تكون لمرحلة التزكية (مساق القبلة) مؤسسة تناظر التعليم الجامعي، وفيها يتجه الطلبة إلى إتقان المعارف التي أظهروا قابلية خاصة لاستيعابها والتعمق فيها.
- قرية اللغة العربية
تشكل قرية اللغة العربية بيئة اجتماعية مباشرة للنظام التربوي الأصيل، تعيد الدارس إلى البيئة العربية الأصيلة، بحيث يعيش في محيط لا يسمع فيه إلا اللسان العربي المبين، فينطلق به لسانه وينطبع به فكره، وتصبح العربية لديه لغة وظيفية معبرة عن جميع شئون الحياة. وتقوم الفكرة على بناء قرية تحمل اسم إحدى قبائل العرب الفصحاء التي كانت تعتبر مصادر لتقويم اللسان العربي. وحيث أن تميما كانت تعتبر عند اللغويين القدامى معدنا للفصاحة، فإنه سيكون من الموافقات الجميلة أن تحمل قرية لغوية تقع في قطر اسم هذه القبيلة، خاصة وقد كان هذا البلد، وما يزال، موطنا لتلك القبيلة.
- من حيث التخطيط العمراني، تأخذ مباني القرية شكل خيم ومضارب بدوية، ولا مانع من أن تكون فيها بالفعل خيم ومضارب تطوى وتنصب إلى جانب المباني الحديثة المشاكلة لها في البنية المعمارية. وتسمى شوارع القرية بأسماء لغويين كبار مثل الخليل بن أحمد وسيبويه والكسائي والفراء، وتكون لها ساحات ذات أسماء موحية أيضا، مثل ساحة البصرة وساحة الكوفة وساحة طيئ. وتكون القرية ذات مرافق متكاملة (السوق، المركز الصحي، المطاعم، إلخ) لتوفر بيئة معجمية وافية قدر الإمكان. وتزين شوارعها وجدرانها وساحاتها بمختارات بديعة من أشعار العرب وحكمها، بحيث يكون التجول فيها بمثابة مطالعة ديوان شعري ممتع ومفيد. ويحسن أن تكون البيئة جامعة بين الصحراء والبحر مزدانة بأبرز الأشجار العربية بما فيها النخيل. ويحسن أن تنشأ في محيطها حديقة نموذجية للأشجار والنباتات التي تغنى بها الشعراء العرب. كما يحسن أن تقام فيها مزرعة نموذجية للنباتات الطبية المذكورة في كتب الطب العربي القديم. ويمكن أن تتحول هذه المزرعة إلى مرفق استثماري يسوق الأعشاب الطبية العربية.
- ومن حيث البيئة البشرية والثقافية، يتخير سكان القرية من بين المؤمنين بقضية اللغة العربية ومن الأسر المثقفة القادرة على خوض غمار هذه التجربة. ويخضع اختيارهم لمعايير تضمن تحقق الشروط المطلوبة فيهم، بحيث تكون عبارة “مواطن في قرية اللغة العربية” أو “مقيم سابق….” بمثابة وسام شرف يحمله الإنسان، ويغنى عن الترجمة له بعبارات مسهبة. والمفروض أن يكون جل مواطني القرية ممن لهم داخلها وظائف تربوية أو وظائف خدمية مساعدة. وينبغي أن يكون لهذه القرية بث فضائي منتقى مغلق، يتخير من البرامج والمسلسلات ونشرات الأخبار ومواد التسلية والترفيه في القنوات العربية ما هو فصيح غير عامي. وينبغي أن تقام على أرض هذه القرية أكبر مكتبة عربية.
- ومن حيث النظم، يمنع في هذه القرية منعا باتا التحدث بغير اللغة العربية، ويكتب ذلك على بواباتها وشوارعها وساحاتها العامة. ويوقع المقيمون والعاملون فيها قبليا على عقود يلتزمون بمقتضاها باحترام نظمها ويتمتعون فيها بامتيازات خاصة مثل السكن والعمل وأية حوافز أخرى تعينهم على الخروج من المدينة “الملوثة ثقافيا” والتحرر من التزاماتهم الأخرى فيها. وتكون للمدينة شرطة لغوية تراقب التزام الناس فيها بالحديث بالعربية الفصيحة، وترتب على المخالفين عقوبات تأديبية رمزية.
- ويحسن أن تشمل خدمات القرية اللغوية استقبال الطلبة غير العرب الراغبين في العيش في بيئة عربية والتعلم فيها لإتقان اللغة العربية. ويمكن أن يشكل ذلك مرفقا من المرافق الاستثمارية للقرية. كما يحسن أن تقام فيها مهرجانات شعرية دورية تحمل بالتناوب أسماء موحية مثل المربد وعكاظ، وربما أسماء بعض عمالقة الشعر العربي.
- مؤسسات وتدابير التأصيل التربوي
تشكل هذه المؤسسات والتدابير جزءا من الجهاز الوظيفي للمشروع، غير أن لها دورا متميزا باعتبارها أذرعا ممدودة نحو الأنظمة التربوية المحيطة، تتواصل معها وتخدمها، وترفدها بما يعين على أداء رسالة أكبر وأشمل في تأصيل المحيط التربوي كله، وإن بشكل متدرج. وفي هذا الشأن نقترح المؤسسات والتدابير التالية:
- تنشأ مؤسسة لتأصيل التعليم النظامي السائد، يكون هدفها الأساسي:
- تكوين المدرس الأصيل (تكوينا أكاديميا إعداديا، وتكوينا تحديثيا أثناء الخدمة) الموجه للعمل في مؤسسات النظام التربوي المعاصر الوافد.
- إنتاج مناهج لتأصيل التعليم موجهة للتطبيق في مؤسسات التعليم النظامي السائد.
- ينشأ مركز أبحاث يهتم بالبحث الدائب والمتمعن في التراث التربوي وفي الفكر الإنساني المعاصر، وبإنتاج الأفكار واقتراح المناهج والبرامج ومراجعتها وتقييمها.
- تعزز هذه المؤسسات وتلك بمجالس علمية على النمط الأصيل، مفتوحة للجميع وبالبيئة التربوية الداعمة، وأهم أركانها قرية اللغة العربية.
- يعمل مشروع النظام التربوي الأصيل على إبرام اتفاقيات توأمة أو تعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات التربوية، بغية الإسهام في تأصيل مناهجها ونظمها التربوية.
- ضوابط للعمل
تحتاج المؤسسات المذكورة إلى تطبيق مسطرة نظم أصيلة مستفيدة من صالح التجارب الإنسانية، وفق ما سبق بيانه في المستخلصات الخاصة بأركان النظام التربوي. ونذكر هنا، على وجه الخصوص، بأهمية الأخذ بالتوجهات الآتية:
- استهداف جمهور خاص من أولي الهمم والعزائم والرغبة الصادقة في خوض هذه المغامرة، وهو ضرورة جمهور نوعي محدود (وإن كانت للنظام ذراعه الممدودة نحو التعليم المدرسي الجماهيري، على النحو الذي أشرنا إليه بشأن مؤسسة تأصيل التعليم السائد)؛
- تبني نظام “الدولة” في الدراسة (حلقات صغيرة للتعلم التعاوني)، مفتوحا في اتجاهين: اتجاه المتابعة الحرة لدروس الحلقات (الدول) الأخرى، واتجاه التعليم الفردي لذوي الملكات والطاقات الذهنية العليا حتى لا يعطل الآخرون سيرهم.
- تبني نظام “الراحلة” (مجموعات صغيرة تتكافل في النهوض بأعباء الحياة) في السكن والمعاش والعمل التطوعي.
- مقاومة مخاطر “التكلس الإداري” المصاحبة للعمل المؤسسي بتطبيق معايير النظام التربوي الأصيل، بما يقتضيه ذلك من تحطيم للأغلال وتخفيف للأثقال وتضعيف للأعمال.
- تقليص المدة الإجمالية لجميع العطل إلى ما لا يتجاوز شهرين في العام (وهما وقت طويل من الفراغ، حسب معايير النظام التربوي الأصيل). وحرصا على عدم إضاعة هذه الفترة، ينبغي أن يكلف الطالب خلالها بمطالعة كتب يختارها بنفسه وتقديم تقرير (مستخلصات مركزة عنها) عند عودته، يتبادلها مع زملائه الطلبة ويعرضها على أساتذته، ويمكن أن تقدم للنشر في نطاق برنامج لتلخيص كتب مهمة.
- اشتراك طلبة جميع الحلقات في برنامج رافد يشمل دروسا في المعلوماتية واللغات الأجنبية وتنمية الذات وإعمال العقل (المناظرة، المحاورة،حل المشكلات، الألغاز والأحاجي)..
- وضع برامج للمطالعة الحرة، تغطي مواد لا تحتاج ضرورة إلى تدريس صفي. ولضمان حسن استيعاب هذه المواد واكتشاف القابليات الخاصة للطلبة بشأنها، ينبغي أن تتاح لهم فرصة عرض منتخبات وخلاصات مركزة عن مطالعاتهم على نظرائهم وبإشراف مرن من مدرس مقتدر.
- كفالة الطلبة، في مأواهم وغذائهم وملبسهم، دون أن يفتح لهم باب الترف والتبذير، بل يحدد سقف أعلى لما يقدم لأحدهم من مصروفات جيب، بحيث يقع قدر من التكافؤ بينهم في الظروف..
- وضع برامج منتقاة للتسلية والترفيه، تضمن مقادير مقبولة من الراحة والاستجمام. وينبغي أن تشمل هذه البرامج ضروبا من الرياضات البدنية والذهنية وألعاب الذكاء والمسابقات، ووقتا محدودا لمشاهدة برامج تلفزيونية مختارة، وفق نظام بث مغلق.
- تعزيز الارتباط بين الدارسين وبين البيئة والطبيعة، وذلك بتوجيه جزء من جهودهم إلى الخدمة الاجتماعية المنتجة (خدمة الناس، غراسة، زراعة، تحويل أرض جدباء إلى مروج…).
ومن الضروري أن نشير إلى أن هذه التوجهات غير حصرية، بل هي أمثلة مما ينبغي استحضاره، وتذكرة بتوجهات أخرى وردت في مظنتها من البحث في فقرات الرؤى المستخلصة عاليه.
ثالثا – ماذا عن الآفاق؟
يبقى السؤال مطروحا حول الآفاق المتاحة لخريجي نظام تربوي مبتكر لا يطبق مناهج الدولة ولا يحمل خريجوه شهاداتها.
الواقع أن النظام المنشود ليس بحاجة إلى أن يحمل هذا الهم فمهمته ليست أصلا تخريج حملة شهادات، وإنما هي تكوين نوابغ وقادة مجتمع وعلماء يشار إليهم بالبنان. وفي هذا النوع من الحالات فإن المخرجات تقدم نفسها بنفسها، وتفرض نفسها من غير واسطة، فالسوق -ثقافية كانت أو اجتماعية أو تقنية- تبحث عن المتألقين، ويمكن أن تكيف أنظمتها بسهولة لاستيعابهم إذا ما قدموا أنفسهم بمهاراتهم وقيمهم ومعارفهم وحسن صيتهم، لا بمؤهلاتهم الورقية. لم يكن بيل غيتس حامل شهادة عليا، ولكن كل مؤسسة تتمنى أن توظف مثله.. ولو بعث اليوم الغزالي وابن تيمية والسيوطي وابن رشد والشاطبي وابن حزم وابن خلدون وابن سينا ولسان الدين بن الخطيب وأضرابهم لما كان لهم مكان في نظم الوظيفة العمومية في دولنا. إنهم لا يستحقون أن يعينوا مدرسين في مدرسة ابتدائية، لأنهم لا يحملون الشهادة التي “تؤهلهم” لذلك، لكنهم لن يعدموا حلقة تلتئم عليهم فتعطيهم بقدر ما تأخذ منهم..
ليس من مهمات النظام التربوي الأصيل، في نظرنا، أن يكون مهندسين أو أطباء مثلا، فلأولئك مساراتهم ومساقاتهم ومسالكهم القائمة.. وإنما مهمته أن يكون نوابغ يمكن أن يهديهم تفكيرهم المبدع وطاقاتهم الذهنية العالية إلى الاختراع والابتكار والاستيعاب السريع للمعارف الأخرى، بما فيها الهندسة والطب والمعارف التجريبية، متى ما التفتوا إليها.. وهكذا، فإن التعليم الأصيل المنشود هو ذلك التعليم الذي يسبر الأغوار ويهوم في الآفاق، ثم يقذف بخريجيه في الفضاءات الوسعى للحياة وهو واثق مطمئن أنهم سيشقون طريقهم، بما سيقدمونه للحياة..
ومع ذلك، فإن هناك مجموعة من التدابير قد تعين على تحسين آفاق استثمار مخرجات النظام التربوي الأصيل:
- يفترض أن تتعهد الدولة أو الدول الراعية للمشروع بترسيم الخريجين النابهين بمؤهلات النظير الجامعي التقليدي (دكتوار، مثلا) أو تمنحهم فرصة التقدم مباشرة بأعمال بحثية ومصنفات وإبداعات توزن علميا وتسند على أساسها الدرجة العلمية والوظيفية المناسبة.
- باستطاعة النظام التربوي الأصيل أن يصالح بين العمل الذهني والعضلي، فيعيد الاعتبار للمهارات اليدوية، ويتيح لطلبته فرصة التدرب على حرف يستطيعون أن يستعينوا بها في كسب قوته، فجميل أن نجد نجارا أو حدادا أو مهندس صيانة معلوماتية عالما بشئون اللغة والشريعة، قادرا على أن يكسب قوته بمجهوده الذهني والبدني معا أو بأيهما شاء. وغير بعيد منا ما يحفل به تراثنا من أسماء العلماء الأعلام الذين سرت مهنتهم لقبا عليهم (الكسائي، الفراء، الزجاج، الجزار، الخواص، القفال، الإسكافي، الباقلاني، الجصاص، الذهبي…).
- باستطاعة النظام التربوي الأصيل أن يستخدم خريجيه في نطاق اتفاقيات تعاون بينه وبين مؤسسات النظام التربوي السائد، أوبينه وبين أية مؤسسات أخرى مستهلكة للخبرات التربوية الأصيلة.
- يستطيع النظام التربوي الأصيل أن يستعيد خريجيه في مواقع عمل ومسئولية لصالحه، فيستفيد منهم –مثلا- في توسيع رقعة تجربته وفي تطوير أدائه.
خاتمة
ما الذي نستطيع أن نستفيده من إنشاء مؤسسات نمطية تقليدية، ولو بتحسينٍ مّا في البرامج والمناهج؟
إن المدرسة السائدة عندنا اليوم مؤسسة، وللمؤسسة ثقافتها الغالبة، وستظل أي مدرسة (أو معهد أو كلية…) تقوم على القواعد المرعية في النظام التربوي المهيمن مؤسسة كنظيراتها، محكومة حاكمة بمنهج خفي مريب. ولن يغير التعديل في المناهج كبير شيء، فهناك جامعات إسلامية ومعاهد عليا عديدة تقدم مادة أصيلة في لبوس “عصري”. قد يكون ذلك شيئا جميلا ومقنعا، لكنه لن يكون مبدعا، وليس هو – مهما يكن من أمر – المدخل الذي ينبغي أن نطمح إليه.
التعليم الذي ينبغي أن نطمح إليه هو تعليم يأتي بنمط غير مألوف، في لبوس غير مألوف، ويعد بمخرجات فيها أيضا خروج على المألوف.. فأين نحن من هذا التعليم؟
لقد دخلنا منذ أن أصبحنا أمة مستضعفة في تيه حضاري كتيه بني إسرائيل غير أن أمده طال، فقد أخذ الغرب عنا بعض ما اعتبره أفضل الأنظمة التربوية المتاحة لرفع مردودية المعلم، وحين كيّف نظامه مع أوضاعه وحاجاته الخاصة، استنسخ مدرسته وغرسها في تربتنا، فقبلناها واعتبرنا أن ليس في الإمكان أبدع مما كان. ورغم استقلال بلادنا منذ عقود –ظاهريا على الأقل- لم نخضع هذا النظام التربوي المستنسخ لأي مراجعة جادة، بل بقينا نراوح مكاننا، ونبحث عن مزيد من جحور الضباب لندخلها تقليدا لمحتل مستضعِف يفترض أنه أخذ عصاه وارتحل. وهكذا عشنا الأزمة التربوية مضاعفة، عشناها أولا مع من أورثونا هذا النمط التربوي لأنهم أدركوا بحسهم النقدي ويقظتهم خطر الداء المستفحل المستشري في جسد نظامهم التربوي، وعشناها ثانيا لأن فشلها في بيئتها الأصلية جاء مدعوما بفشل ثان وثالث أقسى وقعا هو فشل استنباتها في تربتنا وفشلنا في تنقيحها وتهذيبها وتطويعها لبيئتنا. ورغم أن الغرب نفسه بدأ يبحث عن الخلاص في أنظمة ومسالك تربوية شبيهة بأنظمتنا التربوية الأصيلة، فإننا لم ننتبه لذلك بعد، بل إن كثيرا من مثقفينا المأسورين بتكوينهم في النظام التربوي الوافد ظنوا أن النظريات الإصلاحية التي يبشر بها بعض المفكرين في الغرب هي “نظريات جديدة” والحال أنها عتيقة عريقة في موروثنا الثقافي.
إن السبيل للخروج من هذا التيه الحضاري يمر ضرورة بابتداع نظام تربوي أصيل مضمخ بعطر التراث، ملون بقزحيات التجارب الإنسانية المعاصرة الناجحة، قادر على تثوير الأمة عبر الوعي بالذات أولا، والتواصل مع الآخر ثانيا، والتجاوز المستمر ثالثا: تجاوزا للوضع الراهن المأزوم، ولحرفية الاستنساخ التراثي، ولحرفية أخطر هي أيضا حرفية استنساخ ولكن من “الغير” حاضرا وغابرا.
إن الوعي بالذات واستكشاف مخدرات الطاقات التي يحفل بها تراثنا هو المقدمة الأولى لبناء نظام تربوي يغير القوالب الذهنية الجاهزة ويهز الأنماط الفكرية الرتيبة هزا محكما سديدا ويقوض ما بني عليها من أطر مؤسسية حاكمة معيقة للحركة. ومن شأن هذا الوعي أن ينير الطريق لاستكشاف الحاجات الموضوعية التي تتطلب استلهاما واعيا من الآخرين. فإذا استعدنا ثقتنا بأنفسنا واستكشفنا طاقاتنا المعطلة كأمة سهل علينا أن نرصد حاجاتنا الإضافية الموضوعية كبشر يشتركون مع الآخرين في الإنسانية وفي العيش على هذه القرية الكونية الصغيرة (الكرة الأرضية ومحيطها).
وهكذا فإنه يتعين علينا في سعينا للخروج من القفص الحضاري الذي نحن فيه أن نشتق في البحر طريقا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى رصدا، فنخرج من بين فلقي الاستسلام الجبري للنظام التربوي الدخيل، لنعيد استكشاف أنظمتنا التربوية الأصيلة، كما استكشفها منبهرا ذات يوم أندريو بل وهو ينظر في النظام التربوي الإسلامي في الهند بعيني هدهد أو صقر لا بعيني دودة، ذلك أنه يريد – وقد فعل- أن يأتي أهله “من سبأ بنبأ يقين”.
علينا أن نكسر الأصنام، ونتحرر من رق الوهم بأن لا بديل عن المدرسة الوافدة. ولن تكون أداة التحرر والانعتاق إلا نظاما تربويا يتخذ العلم حلية وغاية في مواجهة منطق السلعة والأداة الرخيصة، ويجعل التأديب والتزكية قرينين للتعليم قسيمين للتلقين الصرف، ويتسلح بالرسالة في مواجهة الوظيفة، وبالقناعة في مواجهة الجشع المدرسي، وبالكدح والكبد والتضحية بنفس مطمئنة راضية راغبة في مواجهة الكسل والاسترخاء والدلال، وبالمجتمع الكافل الراعي في مواجهة الدولة الوصية الحارسة، وبالأبواب المفتوحة لطالبي العلم في مواجهة الحواجز والسقوف والحدود، وبالحرية المسئولة في مواجهة الضبط والربط والاسترقاق والوصاية، وبالحياة الجماعية النشطة في مواجهة الانغلاق والانكماش الفردي، وبالمواءمة بين الفردية والجماعية في مواجهة تسلط الجماعة على الفرد وتفلت الفرد من الجماعة، وبالحب والتعلق والإكبار في العلاقة بين أركان البيئة التربوية (خاصة المعلم والمتعلم) في مواجهة الرهبة والبغضاء والاحتقار، وبالتركيز والتسديد في العمل التربوي في مواجهة الحشو والتشتيت، وبالمتعلم المعلم في مواجهة العلاقة الخطية بين معلم يرسل ومتعلم يستقبل، وبخدمة المجتمع في مواجهة الانفصام عنه والتعالي عليه.
إن نظاما هذا شأنه لا يمكن أن يبنى بين عشية وضحاها أحرى أن يقدم مخرجاته في موسم حصاد قصير. إنه – على وجه التمثيل- شجرة خيزران صينية، تكمن أعواما في تربة ممهدة، لكنها حين تخرج تنطلق بسرعة مذهلة لتبلغ قامتها 90 قدما في بضعة أسابيع!
ما علينا إذا إلا أن نسدد ونقارب ونستعين بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.. {وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين}.
ثبت المصادر والمراجع
تطلب البحث العودة إلى مصادر أساسية في مقدمتها القرآن الكريم وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن ابن ماجه. وفي القائمة أدناه، أبرز المراجع التي عدنا إليها في البحث
إبراهيم الخليل، محمد بن -. “نظرة تاريخية على المحاضر الموريتانية في فترة ازدهارها”. (رسالة تخرج، المعهد العالي للدراسات الإسلامية: نواكشوط، 1984).
ابن بطوطة. الرحلة (تحفة النظار في عجائب الأسفار). ط 1 مصر: المطبعة الأزهرية، 1346هـ/ 1928.
ابن سينا. مجربات ابن سينا الروحانية. مؤسسة النور للمطبوعات، د ت.
أبيض، مليكة. “التعليم الإسلامي في المسجد الجامع بدمشق قبل نشوء المدارس، مجلة العربي. عدد 330 (شعبان 1405/مايو1986.).
اجتماع الخبراء شبه الإقليمي حول مواءمة مخرجات التعليم الأصيل لسوق العمل. مجموعة أوراق عمل. الخرطوم، 23/ 12/2008.
أحمد الحبيب، البار بن -. “المقاومة الثقافية في موريتانيا”. (رسالة تخرج، المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بموريتانيا، 1997).
أحمد سعادة، جودت. التعلم التعاوني. عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، 2008.
أحمدو. مريم بنت -. “الشناقطة وتأديب الأطفال”. (رسالة تخرج، المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بموريتانيا، 2003).
إدغار موران. تربية المستقبل. ترجمة عزيز لزرق ومنير الحجوجي. ط 1 الدار البيضاء: دار توبقال للنشر – منشورات اليونسكو، 2002.
إسحاق، خليل بن -. المختصر في الفقه المالكي.
إسماعيل على، سعيد. فلسفات تربوية معاصرة. الكويت: عالم المعرفة، 1995.
أمين، أحمد. ضحى الإسلام. ط10 بيروت: دار الكتاب العربي.
أنور الجندي. العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي. دار الكتاب اللبناني – دار الكتاب المصري، 1979.
اهويدي، دح بن -. “الخصائص والوسائط في التربية الإسلامية وآراء الشناقطة في هذا المجال”. (رسالة تخرج، المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بموريتانيا، 2001).
البُ، فاطمة بنت -. “التجديد التربوي في النظام المحظري من خلال جمع بعض مفاهيم التربيه السكانية”. (رسالة تخرج، المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بموريتانيا، 2004 / 2005).
البراء، يحي بن -. “ألفية ابن مالك وتأثيرها في الثقافة الموريتانية” (رسالة تخرج، المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، 1982).
البكري، أبو عبيد الله. المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب. باريس، 1965.
بولا، عبد الله. “التعليم ـ التأصيل في أفق التحرير”، احترام، المجلة السودانية لثقافة حقوق الإنسان والتعدد الثقافي، العدد الثالث (يوليو 2006).
الجراري، عباس. ثقافة الصحراء. الدار البيضاء: دار الثقافة، 1978.
حسين حجاج، علي. نظريات التعلم (ترجمة كتاب مصطفى ناصف). الكويت: عالم المعرفة. أكتوبر 1983.
حميتو، عبد الهادي. حياة الكُتّاب وأدبيات المحضرة. الرباط: منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية، 1427هـ/ 2006م.
الزنتاني، عبد الحميد الصيد. أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية. ط2 ونس – ليبيا: الدار العربية للكتاب، 1993.
عبد الجواد، محمد أمين وموسى فايز أبو طه. المدرسة الذكية (ترجمة The intelligent school. Barbara MacGilchrist-Kate Myers–Jane Reed). غزة: دار الكتاب الجامعي، 2006.
عبد الرحمن، خديجة بنت -. “التربية الشنقيطية للنشء”. (رسالة تخرج، المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بموريتانيا، 1989 / 1990).
عبد القادر، سيد أحمد بن -. “المقاومة الثقافية الموريتانية للمدارس الفرنسية”. (رسالة تخرج، المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بموريتانيا، 2007).
عبد القادر، سيد أحمد بن -. “المقاومة الثقافية الموريتانية للمدارس الفرنسية”. (رسالة تخرج، المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بموريتانيا، 2007).
عبد الودود، الشيخ سيداتي بن -. “مناهج تدريس رسم القرآن عند الموريتانيين”. (رسالة تخرج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية: نواكشوط).
علي بن يركيت، إبراهيم بن -. ” إسهامات المحضرة الشنقيطية في المجال التربوي والاقتصادي”. (رسالة تخرج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية: نواكشوط، 2002 / 2003).
علي، محمد سعيد عبده. علم التربية وأسسه. الرياض: مكتبة الرشد، 1425هـ.
الكنتي، الشيخ سيدي محمد. الرسالة الغلاوية، مخطوط.
مالك، محمد بن -. الألفية في النحو والصرف.
المبروك، المصطفى بن -. “الرؤية التربوية والأسس التعليمية في تجربة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم المحضرية” (رسالة تخرج، المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، نواكشوط: 2005).
محمد عبد السلام، الحسن بن -. “محضرة الفريوة رباط بعد رباط”. (رسالة تخرج، المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، نواكشوط: 1999).
محمد فال بن الجيل، زينب بنت -. “تفعيل النظام التربوي في التعليم الأصلي” (رسالة تخرج، المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بموريتانيا، 2007).
محمد الولي، عبد الله بن -. “محضرة تنجغماجك تاريخها ومناهجها”. (رسالة تخرج، المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بموريتانيا، 1988/1989).
محمد سالم، بوننه بن -. “الإسلام في البرامج التعليمية الموريتانية”. (رسالة تخرج، المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بموريتانيا، 1987 / 1988).
محمد عبد السلام، محمد بن -. “محضرة الفريوه: رباط بعد رباط”. (رسالة تخرج، المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بموريتانيا، 1998 / 1999).
محمد محمود، عائشة بنت -. “رسالة الإسلام التعليمية”. (رسالة تخرج، المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بموريتانيا، 2001).
محمد النابغة، الشيخ محمدن بن – التندغي. مباحث في آداب العالم والمتعلم. تحقيق عيشة بنت محمد عبد الله. المعهد العالي للدراسات الإسلامية بموريتانيا، 2008.
محمد يحي بن الدوه، محمد بن -. “محضرة يحظيه بن عبد الودود”. (رسالة تخرج، المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بموريتانيا، 1985).
مركز دراسات الوحدة العربية. التربية والتنوير في تنمية المجتمع العربي. ط1 بيروت، 2005.
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. الفكر التربوي العربي الإسلامي. تونس 1988.
موسوعة ويكيبديا الألكترونية.
موقع منتديات التاريخ الإسلامي
ميلود، الطالب مصطف بن -. “الدور الثقافي للعلماء الشناقطة خارج بلاد شنقيط”. (رسالة تخرج، معهد ابن عباس: نواكشوط، 2008).
النحوي، الخليل. بلاد شنقيط المنارة والرباط. تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1987.
وزارة التوجيه الإسلامي والتعليم الأصلى في موريتانيا. دراسة عن سبل مد جسور بين المحضرة والمدرسة النظامية. نواكشوط، 2006.
Anne-Sophie LANGOUCHE, Marie-Christelle PHILIPPE, Jacques RIFON, Marc ROMAINVILLE. Une compétence de base : « la mémorisation », Le Point sur la Recherche en Education. N° 2 (Mars 1997).
Mamadou Ndiaye. L’enseignement arabo islamique au Sénégal. Istanbul : Centre de Recherche sur l’Histoire, l’Art et la Culture Islamiques, 1405H/ 1985.
Université LAVAL. La lecture active et la mémorisation. 4e édition Centre d’orientation et de consultation psychologique, 1999.
[2] أخرجه البُخَارِي 1/4(6) و4/229(3554) وأحمد 1/230(2042).
[3] البخاري. الصحيح. كتاب العلم، 1/160
[4] ابن ماجه. السنن. 1/83(229).
[5] مسلم.الصحيح. 2/1104(1478).
[6] الهيثمي، نور الدين. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، باب منه في فضل القرآن ومن قرأه، 76611، نقلا عن الطبراني.
[7] النحوي، الخليل. بلاد شنقيط المنارة والرباط.
[8] أمين، أحمد. ضحى الإسلام 1/85-90.
[9] النحوي، مرجع سابق ص 57.
[10] حميتو. حياة الكُتّاب وأدبيات المحضرة. ص 31.
[11] عليان، رشيد محمد. الفقه الإسلامي. حضارة العراق، 7/200، 202
[12] أبيض، مليكة: التعليم الإسلامي في المسجد الجامع بدمشق
[13] حميتو. حياة الكتاب. ص 63.
[14] المرجع نفسه. ص 79.
[15] المرجع نفسه. ص 80
[16] اهويدي. الخصائص والوسائط في التربية الإسلامية، ص 22-23.
[17] راجع موقع منتدبات التاريخ الإسلامي: http://www.islamichistory.net/forum/archive/index.php/t-1935.html
[18] اهويدي، الخصائص.. المرجع السابق.
[19] محمد محمود، عائشة بنت -. رسالة الإسلام التعليمية. ص33.
[20] تأمل -على سبيل المثال- نصيحة العلامة الشنقيطي الجليل الشيخ محمد اليدالي لولده المختار سعيد:
يا أيها المختار قرة مقلتي العلم زين للرجال محبب
واعدتني بمبرة وتعلم والحر منجز وعده لا يكذب
وتشوقت نفسي لذاك فها أنا أبدا لوعدك لي أجيء وأذهب
أنجز رعاك الله خيفة قولهم هذا مسيلمة وذلك أشعب.
راجع مريم بنت أحمدو. الشناقطة وتأديب الأطفال. ص 35، 36.
[21] مدينة سنغالية على المحيط الأطلسي متصلة برا وبحرا بموريتانيا، اتخذتها الإدارة الفرنسية عاصمة لموريتانيا قبل استقلالها. وقد أطلقت عليها فرنسا اسم أحد قديسيها فسمتها Saint Louis وتبعتها في ذلك الإدارة الحكومية السنغالية إلى اليوم.
[22] هكذا سمى الفرنسيون في البداية بلاد شنقيط، فكانوا يدعونها في وثائقهم “تراب البيضان” ويترجمونها بـ Pays des Maures إلى أن استقر الرأي عندهم على تسميتها بـ”موريتانيا”.
[23] مدينة تقع على مسافة 150 كم شرقي مدينة نواكشوط
[24] مستخلص من تعميم صادر عن الإدارة الفرنسية. راجع: النحوي، بلاد شنقيط، مرجع سابق، ص 347.
[25] راجع عن تاريخ المدرسة الفرنسية في موريتانيا: النحوي، بلاد شنقيط، مرجع سابق، و سيد أحمد بن عبد القادر: المقاومة الثقافية الموريتانية للمدارس الفرنسية، ص 8-22.
[26] ابن عبد الحكم. فتوح إفريقية والأندلس. راجع النحوي، بلاد شنقيط.
[27] الجراري، عباس. ثقافة الصحراء، ص 10، عزوا إلى البيان المغرب.
[28] الكنتي، الشيخ سيدي محمد. الرسالة الغلاوية.
[29] بكافين فارسيتين معقودتين، أولاهما مشددة.
[30] يذكر أن وكاك بن زلو شيخ ابن ياسين كان قد بنى دارا لطلبة العلم سماها “دار المرابطين”، انظر حميتو. حياة الكتاب. ص 145.
[31] النحوي. بلاد شنقيط.
[32] في كتابه “المعجب في تلخيص أخبار المغرب”، نشر دار الكتاب – الدار البيضاء.
[33] حميتو. حياة الكتاب. ص 150
[34] المرجع نفسه. ص 151.
[35] هكذا يسميه الموريتانيون، وهو في بعض المصادر التاريخية: أبو بكر بن عمر.
[36] عاصمة صنهاجية مندثرة، تقع أطلالها في منطقة الحوض الغربي بشرق موريتانيا، على مسافة 40كم شمال شرقي تامشكط. وصل إليها حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع في حملته سنة 116هـ/734م وفتحها المرابطون سنة 446 هـ/ 1054م.
[37] البكري، أبو عبيد الله. المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب. باريس: 1965، ص ص 158-159، 168
[38] ترجح الأبحاث التي جرت في شرق «موريتانيا» أن تكون مدينة كومبي صالح المندثرة (100 ميل جنوب غربي ولاته / 60 جنوبي تمبدغه، في شرق موريتانيا) هي مدينة غانة. ويذكر أنها تأسست في القرن الثاني “الميلادي”.
[39] البكري. المغرب. ص 174-175.
[40] أنور الجندي. العالم الإسلامي والاستعمار السياسي… ص 370
[41] تقع أطلال هذه المدينة بين شنقيط ووادان، ويقال إنها خربت نتيجة حرب أهلية وقعت فيها، وسار خرابها مثلا عند الشناقطة: «أخلى من تنيكي».
[42] البراء، يحي بن – . ألفية ابن مالك وتأثيرها في الثقافة الموريتانية، رسالة جامعية مرقونة، نواكشوط: 1982، ص 6.
[43] تقع تيشيت في منطقة تكانت على مسافة نحو 250 كم إلى الشرق من مدينة تجكجة، بوسط موريتانيا، وهي إحدى المدن التاريخية الموريتانية المصنفة في قائمة التراث الإنساني العالمي، وبها ثروة كبيرة من المخطوطات.
[44] تقع وادان على بعد 100 كلم إلى الشمال الشرقي من مدينة شنقيط، وهي أيضا أحد مستودعات التراث المخطوط الكبرى، وإحدى المدن المصنفة في قائمة التراث الإنساني العالمي.
[45] تقع شنقيط في قلب موريتانيا على مسافة نحو 540 كم شمالي العاصمة نواكشوط. وقد تأسست شنقيط عام 160 هـ/776م وعاشت قرونا ثم اندثرت لتنهض على أنقاضها شنقيط الثانية سنة 660هـ/1262م، وهي إحدى المدن التاريخية المصنفة في قائمة التراث الإنساني العالمي، وأحد أكبر مستودعات التراث المخطوط في البلاد.
[46] تقع ولاته في شرق موريتانيا على مسافة نحو 100 كم شمالي مدينة النعمه في منطقة الحوض الشرقي، ويرى بعض المؤرخين أنها تأسست في القرن الأول الهجري، وهي إحدى المدن التاريخية المصنفة في قائمة التراث الإنساني العالمي، وبها مكتبات زاخرة بالمخطوطات. وقد ظهرت في المصادر القديمة بأسماء متعددة منها إيولاتن، وبيرو، أو سيرو.
[47] أحمدان، المصطفى بن – . مساهمة في كتابة تاريخ ودان. رسالة مرقونة. ص23، نقلا عن العلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي.
[48] ابن بطوطة. الرحلة. ص661-663
[49] ربما كان لهذه الحملة أثر في انبراء الفقيه أحمد بابا لتأليف رسالة في تحريم الرقيق المجلوب من بلاد السودان. وقد استندت تونس إلى هذه الرسالة وإلى فتوى الشيخ إبراهيم الرياحي في إلغاء الرق.
[50] راجع لمزيد من المعلومات عن الحواضر الشنقيطية وعطائها العلمي مبحث: “الحواضر مهد الحواضر” من كتاب النحوي: “بلاد شنقيط المنارة والرباط. ص ص 66-74.
[51] محمد عبد السلام، الحسن بن – . محضرة الفريوة رباطا بعد رباط. ص 30، 32. وراجع لمزيد من التوسع : النحوي في بلاد شنقيط، مرجع سابق.
[52] أحمدو، مريم بنت – . الشناقطة وتأديب الأطفال. ص42.
[53] محمد محمود، عائشة بنت -. رسالة الإسلام التعليمية. 2001. ص 36.
[54] اهويدي، دح بن -. الخصائص والوسائط في التربية الإسلامية. ص 41.
[55] دح بن اهويدي. الخصائص والوسائط. ص 21.
[56] الشيخ محمدن بن محمد النابغة، مباحث ص47
[57] حميتو. حياة الكتاب. ص 600.
[58] محمد النابغة، الشيخ محمدن بن – . مباحث. ص46.
[59] المبروك /المصطفى بن – . الرؤية التربوية. ص 43، نقلا عن هدي الأبرار. ص 99.
[60] مقدمة مجربات ابن سينا الروحانية.
[61] Université LAVAL. La lecture active et la mémorisation.
[62] Une compétence de base : la mémorisation. P2.
[63] ليس من المألوف أن تدرس هذه المادة أمام الملأ خلافا لغيرها من المواد، بل تقدم فرديا للخاصة وفي كنف الكتمان غالبا، باعتبارها من الأسرار، ولما يرونه من أن “السر في السر”. وهي – إلى ذلك – غير مطردة في المحاضر، بل إن كثيرا من شيوخ التدريس لا يهتمون بها ولا يلقنونها لطلابهم، وأكثر ما توجد عند غيرهم من المشايخ الذين لا يمتهنون التدريس.
[64] حميتو. حياة الكتاب. ص 349-351.
[65] المرجع نفسه. ص 343
[66] محمد فال، زينب بنت -. تفعيل النظام. ص 30.
[67] أحمدو، مريم بنت – . الشناقطة وتأديب الأطفال. ص 79.
[68] محمد محمود، عائشة بنت – . رسالة الإسلام التعليمية. ص50.
[69] حميتو. حياة الكتاب. ص 351.
[70] محمد الولي، عبد الله بن – . محضرة تنجغماجك. ص 67، 68.
[71] في كتابه تربية المستقبل. ص 38.
[72] محمد النابغة، الشيخ محمدن بن – . مباحث.. ص 46.
[73] أحمدو، مريم بنت -. الشناقطة… ص 76.
[74] اهويدي، دح بن – . الخصائص.. ص 34-35.
[75] راجع محمد أمين وموسى… المدرسة الذكية (ترجمة). ص 31.
[76] محمد النابغة، الشيخ محمدن بن – . مباحث. ص 45.
[77] محمد محمود، عائشة بنت – . رسالة الإسلام التعليمية.. ص33-35.
[78] محمد النابغة، الشيخ محمدن. مباحث… ص 54.
[79] إبراهيم بن علي بن بركيت. إسهامات المحضرة. ص 45.
[80] راجع مبحث “سفراء المحضرة”في كتابنا : بلاد شنقيط ـ المنارة والرباط.
[81] Mamadou Ndiaye. L’enseignement arabo islamique au Sénégal. P76
[82] Idem. P76, 96.
[83] ميلود، المصطف بن – . الدور الثقافي للعلماء الشناقطة. ص 41.
[84] هكذا سمى الفرنسيون في البداية بلاد شنقيط، فكانوا يدعونها في وثائقهم “تراب البيضان” ويترجمونها بـ Pays des Maures إلى أن استقر الرأي عندهم على تسميتها بـ”موريتانيا”.
[85] مدينة تقع على مسافة 150 كم شرقي مدينة نواكشوط
[86] “تأهيل التعليم العتيق بالمملكة المغربية”، ورقة غفل من اسم صاحبها، مقدمة إلى اجتماع الخبراء شبه الإقليمي حول مواءمة مخرجات التعليم الأصيل لسوق العمل.
[87] عثمان البشير الكباشي. الوسائل الفاعلة لتعزيز التفاعل بين مؤسسات التعليم الأصيل والقطاعات الخدمية والاقتصادية… ورقة مقدمة لاجتماع الخبراء شبه الإقليمي حول مواءمة مخرجات التعليم الأصيل لسوق العمل.
[88] محمد أمين وموسى فايز. المدرسة الذكية. ص27.
[89] المرجع نفسه. ص 22، 61.
[90] اهويدي، دح بن – . الخصائص والوسائط. ص8.
[91] بولا، عبد الله. التعليم ـ التأصيل في أفق التحرير. احترام، المجلة السودانية لثقافة حقوق الإنسان.
[92] المرجع نفسه.
[93] اهويدي، دح بن – .الخصائص والوسائط. ص 8.
[94] إسماعيل على، سعيد. فلسفات تربوية معاصرة. ص 193 وما بعدها.
[95] اهويدي، دح بن – . الخصائص والوسائط. ص16، عزوا إلى الأدب الصغير لابن المقفع ص 5-6.
[96] راجع موسوعة ويكيبديا الألكترونية.
[97] أحمد سعادة، جودت.التعلم التعاوني. ص 36.
[98] المرجع نفسه. ص 74، 80.
[99] بالراشد، محمد. المدرسة العربية في مطلع قرن جديد. كتاب التربية والتنوير في تنمية المجتمع العربي. ص 165.
[100] عواد معروف، بشار. حضارة العراق. 8/ 59.
[101] حسن النقيب، خلدون. المشكل التربوي والثورة الصامتة. التربية والتنوير. ص 44، 57.
[102] إسماعيل علي، سعيد. فلسفات تربوية. ص 143.
[103] بالراشد، محمد. “المدرسة العربية”. التربية والتثوير. ص 177.
[104] L’Ecole n’est pas une entreprise : Le néo libéralisme à l’assaut de l’enseignement public, Cahiers libres. La Découverte. Paris 2003
راجع: عبد الدائم، عبد الله. العرب والهجمة على التربية والثقافة. في كتاب: التربية والتنوير. ص 12.
[105] ابن سينا. مقدمة كتاب المجربات.