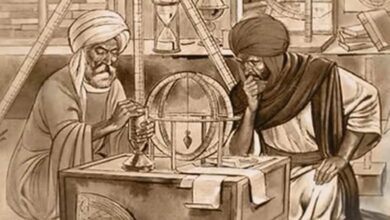01- المدرسة الآصفية .. نموذجاً معاصراً لنظام تربوي أصيل
المدرسة الآصفية نموذجـــاً معاصراً لنظــام تربوي أصيــل
بحث مقدم لصالح مشروع إحياء نظام تربوي أصيل
إعداد : د. محمد عيــّاش الكبيسي
أنجز في: محرم 1431 هـ / ديسمبر 2009م
جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمشروع ومسجلة رسميـًا ومحمية بموجب القانون.
فهرس البحث
| العنوان |
| المقدمة |
| الفصل الأول – تمهيدات |
| أولاً – الحاجة للبحث |
| ثانيا – صلة البحث بالمشروع |
| عنوان المشروع |
| تعريف المشروع |
| أهداف المشروع: |
| المخرجات |
| ثالثا – إشكالية البحث |
| رابعاً – الإضافة النوعية للبحث |
| خامساً – منهجية البحث |
| سادساً – المصطلحات المستخدمة في البحث |
| الفصل الثاني : الآصفية التاريخ والجغرافيا والامتداد |
| تاريخ الآصفية |
| أولا: باعتبار السند العلمي |
| ثانيا: باعتبار الجانب الإداري الرسمي |
| ثالثا: باعتبار المنهج والبرنامج العلمي والتربوي |
| الموقع الجغرافي والبيئة الحاضنة |
| الامتداد والانتشار |
| الفصل الثالث: المعلّم (الشيخ) |
| صفات الشيخ ومؤهلاته |
| الفصل الرابع : المتعلم |
| أولا – الشروط والمؤهلات |
| ثانيا- المتعلم والبيئة |
| ثالثا- الناجحون والفاشلون |
| رابعا – التواصل مع برامج التعليم المعاصر |
| خامسا – الإنتاج العلمي |
| سادسا – المجال الوظيفي وخدمة المجتمع: |
| الفصل الخامس – المنهج والنظام |
| أولا – المنهج العلمي والمقررات الدراسية: |
| خطة الدراسة للصف الأول |
| خطة الدراسة للصف الثاني |
| خطة دراسة للصف الثالث |
| خطة الدراسة للصف الرابع |
| خطة الدراسة للصف الخامس |
| خطة الدراسة للصف السادس |
| ملاحظات موجزة على هذا النموذج: |
| ثانيا ً- المنهج التربوي (القيمي) |
| ثالثا – التدريب وتنمية المهارات |
| رابعا – النظام الإداري |
| الأفكار المستوحاة من البحث |
| أولا- الصورة الذهنية للمشروع: |
| ثانيا – السمات المنهجية |
| ثالثا – الضوابط الإدارية |
| رابعا – التفاعل مع المجتمع |
| خامسا – شكل المبنى الذي يضم المشروع |
| المصادر |
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فإنه رغم الإمكانات الهائلة التي تبذل اليوم في مراحل التعليم المختلفة في العالم العربي والإسلامي وتطور تقنيات التعليم والبحث العلمي إلا أن هناك حقيقة لا تخفى على المراقبين تتلخص بهبوط المستوى التعليمي وعجز مؤسساتنا العلمية عن مواجهة التحديات الخطيرة ومواكبة التطورات المتسارعة في هذه الساحة على المستوى العالمي..
لم تحقق مؤسساتنا العلمية كثيراً من الأهداف التي وضعتها لنفسها فهناك إخفاق في توفير الكوادر القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في (التكنولوجيا) أو العلوم (الخدمية) كالطب أو الإدارية والاقتصادية.. وتراجع أيضًا الجانب القيمي حيث سادت في المجتمع النظريات المادية والتغريبية ونزعة الأنانية والانكفاء على الذات وضعفت الأواصر التي كانت تربط بين المهنة وأخلاقيات المهنة، ووصل هذا الضعف إلى كليات الشريعة[1] حيث لم تعد هذه الكليات قادرة على تخريج العلماء والفقهاء الأكفاء كما كان في تأريخنا التربوي الأصيل.
نحن إذاً أمام واقع يحتاج إلى تشخيص وتحليل بمنظور علمي للوصول إلى وضع البرنامج الإصلاحي القادر على النهوض بهذه الأمة من جديد، وإذا كان النظام التربوي المعاصر قد ولّد كل هذه الإخفاقات، وفي الجوانب المختلفة فإن هناك تجارب لا زالت قادرة على تجاوز هذه الإخفاقات، وتقديم مخرجات أكثر استجابة لحاجة الأمة ومتطلبات المرحلة رغم الفارق في الإمكانيات والرعاية بين التجربتين، وإن الباحث قد عاش التجربتين وخبر خصائصهما فهو خريج المدرسة الآصفية وحاصل على الإجازة العالِمية على المنهج الأصيل ثم هو أستاذ جامعي تخرج ودرّس في مراحل التعليم المعاصر المختلفة وفي أكثر من بلد ، وهذا ما يمكنه من الحكم على التجربتين بخلاف الذي يعيش التجربة الواحدة.
إن المدرسة الآصفية في مدينة الفلوجة تعد بحق نموذجًا معاصرا وناجحًا لمنهج تربوي أصيل يمتد في عمقه إلى ينابيع المعرفة الإسلامية الأولى، حيث تتصل هذه المدرسة بسند علمي متين إلى الدعاة والمعلمين الأوائل الذين حملوا الإسلام عقيدة وشريعة إلى بلاد الرافدين من الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود مرورا بكبار التابعين ثم المحدثين والفقهاء والنحاة المعروفين الذين أنجبتهم المدرسة العراقية الغنية عن التعريف، وقد نجحت الآصفية في رفد الأمة بكفاءات موسوعية متميزة في مجال العلوم الإسلامية، وكذلك بالقيادات المجتمعية الرائدة التي تحظى بالمهابة والوقار.
إن هذه الدراسة لهذه التجربة من شأنها أن تسهم في تقديم نموذج قابل للإضافة والتطوير بحيث تشكل عندنا رؤية نقدية وتحليلية ومقارنة للتجارب المختلفة، وهذه مقدمة لرسم معالم النظام التربوي الذي ننشده في هذا العصر ، هذا وقد قسمت البحث بعد هذه المقدمة إلى:
الفصل الأول: وهو فصل تمهيدي..
يتناول فيه الباحث: سبب اختيار الموضوع وأهميته بالنسبة لمشروع إحياء نظام تربوي أصيل، وهو ما سيتضمن في الغالب الخطة الأولية للبحث.
الفصل الثاني: المدرسة الآصفية: الجغرافيا والتاريخ والامتداد
يتناول الباحث في هذا الفصل:
1 – الموقع الجغرافي للمدرسة، الأرض، والبيئة، والمجتمع، ودور الموقع في نجاح المدرسة وامتداد تأثيرها والتفاعل البنّاء بين المدرسة والمجتمع.
2 – التاريخ: ويتناول فيه الباحث: تأسيس المدرسة وجذورها التاريخية والمراحل المختلفة التي مرت بها..
3 – الامتداد: ويتناول فيه الباحث مخرجات المدرسة وإسهاماتها الواسعة في مجال الإصلاح العلمي والتربوي داخل العراق وخارجه.
الفصل الثالث: المعلم
ويتناول الباحث في هذا الفصل:
- شخصية المعلم القادر على تحقيق الأهداف (العلمية والمهارية والقيمية)، ودور المعلم في الريادة الاجتماعية خارج المدرسة، ويتم كل هذا بعرض نماذج بارزة من معلمي المدرسة على الأوائل..
- ملاحظات نقدية لشخصية المعلم ( المؤهلات والممارسات)
الفصل الرابع: المتعلم
ويتناول الباحث في هذا الفصل:
- شروط القبول المرتبطة بتحقيق الأهداف (العلمية والمهارية والقيمية) والامتيازات التي يحصل عليها الطالب أثناء الدراسة.
- عرض نماذج تطبيقية (الناجحون والفاشلون )مع بيان أسباب الفشل.
- الدور الوظيفي لخريجي الآصفية ومجالات العمل.
- الإنتاج العلمي لخريجي الآصفية.
الفصل الخامس : النظام والمنهاج.
ويتناول الباحث في هذا الفصل منهج المدرسة في:
- الجانب العلمي (المقررات الدراسية) وتوزيعها على مراحل الدراسة والخطة الدراسية بشكل عام.. وسلم التقويم.
- الجانب المهاري: أساليب المدرسة في تنمية المهارات المتنوعة كالتعبير والتواصل.. إلخ وسلم التقويم..
- الجانب القيمي: أساليب المدرسة في ترسيخ معاني الإيمان والتقوى وآداب العالم والمتعلم.. وسلم التقويم..
- الجانب الإداري : نظام الدراسة ، وساعات العمل ، وطرق التقويم
الخاتمة:
ويتناول فيها الباحث أهم الاستنتاجات والتوصيات التي تصب في خدمة المشروع، ولا يفوتني أن أذكر في ختام هذه المقدمة الصعوبة البالغة التي واجهتني وهي فقدان أغلب الوثائق التابعة للمدرسة بسبب القصف الأمريكي المكثف للمدرسة إبان معركة الفلوجة المعروفة، وقد بذلت مجهوداً استثنائيا للحصول على بعض الوثائق وجمعها من أطراف متعددة، وحاولت أن أسد النقص بالمقابلات التي أجريتها مع روّاد المدرسة الأوائل إضافة إلى تجربتي الخاصة حيث كنت أحد طلابها وخريجيها
الفصل الأول: تمهيدات
أولاً – الحاجة للبحث :
يرى الباحث أن أزمة التعليم الحالي تتمثل في الفجوة الكبيرة بين مناهج التعليم المعاصر والمناهج التاريخية الأصيلة، وأن مشروع (إحياء نظام تربوي أصيل)، ومن خلال كل المقدمات التي قرأها الباحث عن هذا المشروع.. فإن هذا المشروع يهدف إلى ردم هذه الفجوة والاستفادة من التجارب الأصيلة لبناء نظام تربوي جديد ليتناسب مع تحديات العصر، ولذلك تمس الحاجة لدراسة نموذج أصيل لكنه معاصر.. فالمدرسة الآصفية هي مدرسة موجودة الآن وتخرج أجيالاً من العلماء الربانيين وقادة المجتمع المهابين، ولكنها تمتد ببرامجها وآليات عملها إلى مدرسة تربوية أصيلة متجذرة في تاريخ هذه الأمة. حيث تعد امتدادًا للمدرسة العراقية التي تأسست بعد فتح العراق، ولذلك فهي تغطي جانبًا من نظامنا التربوي الأصيل حيث تمثل هذه المدرسة نموذجًا للفضاء المشرقي في مقابل التجارب المغربية المعروفة..
ثانيا – صلة البحث بالمشروع :
للبحث صلة وثيقة بمشروع (إحياء نظام تربوي أصيل) تتجلى في:
1 – عنوان المشروع: حيث تمثل المدرسة الآصفية نموذجًا حياً للنظام التربوي الأصيل وهي حلقة من سلسلة طويلة من الحلقات المدرسية والمنهجية التي مثلت النظام التربوي الأصيل لهذه الأمة..
2 – في تعريف المشروع (4/17) جاء: “إحياء الخصائص والسمات الفذة لتلك الممارسات والخبرات التربوية الأصيلة والعريقة التي نجحت بامتياز عبر العصور الإسلامية في إنتاج فطاحلة في شتى حقول العلم”.. ولا شك أن الآصفية هي النموذج الأقرب لتلك الخبرات والممارسات..
3 – أهداف المشروع: حيث أستطيع القول إن تجربة الآصفية تخدم كل الأهداف المرسومة للمشروع وتلتقي لقاء مباشرًا مع الهدف (2،4،5،6) حيث تركز هذه الأهداف على “الانعتاق من التبعية في الفكر والسلوك”، “واتخاذ ينابيعنا الأصيلة متكًأ للتفاعل”، “وتقديم تربية شاملة بمختلف جوانب الشخصية”، ” وإحياء روح تقديس العلم وإجلال العلماء”.
4 – في المخرجات: حيث إن مخرجات المشروع المنشودة تلتقي كذلك مع التجربة الآصفية سيما في المخرج الثاني: “قادة مجتمع مهابون ومتبعون” والمخرج الثالث: “مربون وقرون ومؤثرون”..
ثالثا – إشكالية البحث:
لا يختلف اثنان في أن المدارس التاريخية الأصيلة قد قدمت للأمة مخرجات فاعلة ومتميزة.. فكل الأسماء اللامعة في تاريخنا الوضيء كانوا مخرجات ذلك النظام التربوي الأصيل.. المحدثون.. الفقهاء، المفسرون، الأدباء، القادة والإداريون والدعاة الربانيون.. إلخ، الذين شكلوا نسيجاً متجانساً للنموذج المعرفي الأرقى على مدار قرون عديدة..
لكن القراءات لذلك التاريخ بقيت ناقصة (لأنها قراءات تاريخية) من الصعب تقويمها إلا في ضوء النظر المجرد.. لكن وجود مدارس معاصرة تمتد في عمقها من حيث المصادر وطريقة التعليم، وآلية التقويم يقود إلى استكمال الدراسة وإضافة التجربة الميدانية إلى الملاحظات النظرية..
إن مدرسة الآصفية تعد من النماذج الماثلة لذلك التعليم الأصيل وتميزت بقدرتها على الاستمرار والعطاء حيث قدّمت للأمة كفاءات علمية عالية المستوى وقادة مجتمع لهم التأثير الواسع في مجال الدعوة والإصلاح والريادة الاجتماعية داخل القطر وخارجه، ويكفي أن نستذكر بعض المؤسسات ذائعة الصيت مثل (رابطة علماء العراق) و(مجلس علماء العراق) و(هيئة علماء المسلمين) لنكتشف أن أغلب المؤسسين لهذه المؤسسات الفاعلة هم من خريجي هذه المدرسة أو من امتداداتها المعرفة، لكن هذه المدرسة رغم إنتاجها الواسع والمتواصل لم تحظ باهتمام لتحليل وتقويم منهجها؛ وبالتالي فإن هذا البحث يحاول فيه الباحث أن يعالج هذه الثغرة ليس من أجل التغذية الراجعة للمدرسة نفسها والتي كان الباحث واحداً من مخرجاته، لكن لتقديم رؤية أوسع لسد الثغرة الأكبر التي تمثل بحاجة الأمة اليوم إلى صياغة نظرية جديدة ومتوازنة في مجال التربية والتعليم..
إن الفكرة المحورية الأساسية للبحث يمكن تلخيصها بـ:
تقديم نموذج معاصر لنظام أصيل يمتد إلى بدايات تأسيس النظام التعليمي والتربوي في الأمة. وأن هذه الدراسة تطمح إلى بيان أصالة التجربة وقدرتها على العطاء المتواصل وبيان معالم منهجها المتكامل (المعرفي، القيمي، المهاري)، وعوامل نجاح المدرسة الذاتية والخارجية والتحديات التي واجهتها..
والهدف من كل هذا: رفد المشروع (مشروع إحياء نظام تربوي أصيل) بتجربة تربوية أصيلة ومستمرة تتكامل مع التجارب الأخرى وقد كان من المشجع للباحث أن يقدم هذه التجربة كونه قد عاشها بنفسه..
رابعاً – الإضافة النوعية للبحث:
يمكن تلخيص الإضافة النوعية المتوقعة للبحث في النقاط الآتية:
- تقديم نموذج معاصر لنظام تربوي أصيل..
- توضيح المنهج المتوازن الذي تتطلبه النظم الإسلامية كونها نظمًا توازن بين جوانب التربية المتعددة: المعرفة العلمية، والقيم الإيمانية، والأخلاقية، ومهارات التعبير والاتصال..
- تقديم نموذج للتفاعل المتبادل بين المؤسسة التربوية ومجتمعها الذي تعيش فيه.
- دراسة غير مسبوقة بحسب علمي للمدرسة الآصفية وهي النموذج الأقرب للنظام الأصيل الذي عرفته الأمة..
- كون الباحث قد عاش هذه التجربة بنفسه، فإن الدراسة ستكون مسيسة بالواقع الحقيقي للتجربة وستكون ملمة بتفاصيل وأمثلة يومية من مسيرة المدرسة..
- كون الباحث قد مارس التعليم المعاصر بكل مراحله حيث درّس في الثانويات العامة ثم في عدد من الجامعات العراقية والعربية فمن المتوقع أن تأتي الدراسة بنتائج موضوعية متوازنة منبثقة من رؤية تستوعب التجربتين الأصيلة والحديثة.
هناك دراسات قدمت لنماذج من التعليم الأصيل كالمدارس المغربية، إلا أن الآصفية تعد النموذج الأقرب للفضاء المشرقي وبالتالي فمن المؤمل أن تسهم هذه الدراسة في إكمال الصورة الكلية للتعليم الإسلامي الأصيل.
خامساً – منهجية البحث
بما أن هذه الدراسة تعد الدراسة الأولى للمدرسة الآصفية، فستتخذ الدراسة طابع التأسيس لرؤيةٍ نقدية شاملة لهذه التجربة، تعتمد في الأساس على:
1 – تجربة الباحث الشخصية : كونه واحدا من خريجي هذه المدرسة ومن سكان مدينة الفلوجة المحضن الداعم لهذه المدرسة
2 – الاستفادة من شيوخ المدرسة وطلابها المميزين من خلال الاتصال بهم وتسجيل شهاداتهم والاستفادة من معلوماتهم وخبراتهم، وهم في الغالب إما شيوخ وأساتذة للباحث أو زملاء له.
3 – فحص الوثائق والبيانات المتوفرة.. والتي سعى الباحث إلى توفيرها.. حيث تعرضت المدرسة للتدمير على يد قوات الاحتلال الأمريكي في معركتي الفلوجة الأولى والثانية ( 2004 و2005)
4 – دراسة البيئة والمحيط الحاضن للمدرسة (مدينة الفلوجة وأريافها وقبائلها) ثم محافظة الأنبار والتي هي أكبر محافظات العراق. وسيتم التركيز على التأثير المتبادل بين المدرسة ومحيطها هذا.
وستكون المرحلة الأولى مرحلة جمع المعلومات الرصينة ثم تبويب هذه المعلومات بحسب الخطة المعدة في محاور البحث..
بعد ذلك يتم تحليل هذه المعلومات في سياق مقارنة يعتمد النقد الموضوعي وإبراز النواحي الإيجابية وجوانب القصور والإخفاق، واستخلاص النتائج في خاتمة كل فصل بصياغة مقترحات للمشروع.
سادساً – المصطلحات المستخدمة في البحث
تجدر الإشارة هنا أن بعض المصطلحات المستخدمة في هذه التجربة تحتاج إلى توضيح، وأهم هذه المصطلحات:
1 – الشيخ: يقصد به المعلم أو الأستاذ في المدرسة…
2 – طالب العلم: هو الطالب المسجل رسميًا في المدرسة..
3 – أحباب الشيخ: هم أتباع الشيخ ومؤيدوه من غير الطلاب الرسميين، وهؤلاء قد يحضرون حلقات الشيخ العلمية ومنهم من امتلك علومًا لا بأس بها لكنهم لا يمنحون الإجازة العلمية من الشيخ..
4 – الإجازة العلمية: وهي الشهادة التي يمنحها الشيخ للطالب الذي أكمل متطلبات الدراسة بنجاح.
5 – العالِـمية: هو اسم للإجازة العلمية التي يمنحها الشيخ للطالب..
6 – عالِم: هو اسم يطلق على كل من تخرج من المدرسة..
7 – حلقة العلم: هي المحاضرة أو الدرس..
8 – حلقة الذكر: هو مجلس يضم الشيخ والطلاب وبعض الأحباب لقراءة القرءان أو المأثورات ويختم بالدعاء..
9 – علوم الآلة: ويقصد بها العلوم التي تساعد على فهم العلوم الأخرى ــ مثل علوم اللغة العربية والمنطق..
10 – خارجي: ويقصد به كل شخص لم يصنف أنه من أحباب الشيخ كما أنه ليس طالبًا في المدرسة.. وهذا لا يجوز الاختلاط به إلا بإذن من الشيخ..
وهناك مصطلحات يستخدمها الباحث، أهمها:
1 – الجانب المعرفي: ويقصد فيه المعلومات النظرية في شتى الفروع العلمية..
2 – الجانب القيمي: ويقصد به القناعات الإيمانية ومستوى الالتزام التطبيقي للمبادئ الدينية والأخلاقية..
3 – الجانب المهاري: ويقصد به القدرة على التعبير والتحرك في البيئة والمحيط بالمعلومات المكتبية مثل الدعوة والتواصل والإدارة… إلخ.
4- تجربتي الشخصية: معايشة الباحث لهذه التجربة كونه واحدا من خريجيها، وكونه أيضا واحدا من سكان مدينة الفلوجة التي تعد المحضن الداعم لهذه المدرسة.
5- المشروع: ويقصد به: مشروع إحياء نظام تربوي أصيل.
الفصل الثاني: الآصفية التاريخ والجغرافيا والامتداد:
تاريخ الآصفية:
يصعب على الباحث في تاريخ المدارس الدينية الأصيلة في العراق تحديد التاريخ الذي أنشئت فيه كل مدرسة، حيث أن هناك اعتبارات كثيرة ومتداخلة، ولو أخذنا الآصفية وهي مادة بحثنا فسنجد هذه الاعتبارات على النحو الآتي:
أولا – باعتبار السند العلمي:
يدخل طالب العلم في الآصفية فيسمع أول ما يسمع من شيخه عبارات ذات دلالات عميقة مثل (الإرث المحمدي)[2] و(حمل الأمانة الثقيلة) و(إسناد الركبتين للركبتين)[3] ويتخرج الطالب بعد اثنتي عشرة سنة من الدراسة المتواصلة ليحصل في النهاية على (الإجازة العالمية) وفيها وصية الشيخ لتلميذه: “فتحقق لديّ أنه من الفضل على جانب عظيم، وأنه حقيق بأن تدخله الطلبة في سلك آباء التعليم فعاهدته على التوبة الخالصة لله تعالى، وعلى دوام ذكره تعالى، وأن لا يراه مولاه حيث نهاه” وفيها السند العلمي حيث يقول الشيخ: “كما أخذت ذلك جميعا قراءة وسماعا… ثم يذكر علماء ورموزا كبارا في تاريخنا العلمي من مثل (الفخر الرازي) و(حجة الإسلام الغزالي) و(إمام الحرمين الجويني) مرورا بـالإمام الشافعي ثم الصحابة الأجلاء –رضي الله عنهم- وانتهاء بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم”[4]
إن الآصفية بهذا الاعتبار لا يمكن إلا أن نقول: إنها مدرسة عريقة ممتدة إلى بدايات الفتح الإسلامي لبلاد الرافدين حيث أقام الصحابة رضي الله عنهم حلقاتهم العلمية الأولى في البصرة والكوفة وغيرهما [5].
ثانيا – باعتبار الجانب الإداري الرسمي
وفي هذا الجانب الذي يفترض أن يتمكن الباحث من تحديد البداية الرسمية لهذه المدرسة لكنه عند الرجوع إلى الوثائق المتوفرة تبين أن هناك تداخلا أيضا فالمدرسة كانت عبارة عن حلقات علمية على الطريقة القديمة تقوم في المسجد الجامع لمدينة الفلوجة والذي أسسه القائد العثماني الفريق كاظم باشا سنة 1898م[6] والمعروف اليوم بـ (الجامع الكبير) لكن اسم (الآصفية) كان يطلق على المدرسة الدينية القائمة في مسجد (الآصفية) المعروف في بغداد والذي تم بناؤها مع المسجد بأمر من والي بغداد العثماني آنذاك داود باشا الملقب بـ (آصف الزمان)[7] سنة 1242 هـ بحسب ما ينتج من تأريخ المدرسة بحساب الجمل (مئذنتان) والمدرسة مجاورة للمدرسة المستنصرية المعروفة في التاريخ ويقال إنها كانت جزءا منها[8]، وكان لهذه المدرسة (وجهتان) أي درجتان رسميتان بحسب نظام الوقف الذي كان سائدا آنذاك ، انتقلت واحدة منها إلى مدرسة الفلوجة بكامل امتيازاتها الإدارية[9] وكان ذلك سنة 1944هـ تقريبا بعد أن نقل الشيخ حامد الملا حويش –رحمه الله- من بغداد مدرسا في وإماما وخطيبا في مسجد الفلوجة الكبير، ثم تمكن من نقل درجة الآصفية، وعلى هذا يكون الشيخ حامد الملا حويش أول مدرس رسمي لآصفية الفلوجة[10]، ثم نقل بعد ذلك إلى بغداد سنة 1946 ليحل محله الشيخ محمد أمين الخطيب حتى توفي –رحمه الله– سنة 1948 ليحل محله العلامة الكبير الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي –رحمه الله– والذي يعد أبرز علماء الآصفية على الإطلاق وربما أبرز علماء العراق من حيث النشاط العلمي الواسع وكثرة العلماء الذين تخرجوا على يديه حتى سمّي بـ (ناشر العلم على ضفاف الفرات) وقد ساعده في ذلك طول مكوثه في الآصفية حيث أنه لم يخرج منها إلا بعد أن أقعد بسبب المرض سنة 1972 ليتعاقب تلامذته الفضلاء من بعده على إدارة المدرسة حيث خلفه الشيخ إبراهيم رحيم الهيتي –رحمه الله– ثم الشيخ خليل محمد الفياض ثم الشيخ علي هاشم ثم الشيخ جمال شاكر النزال، ثم بعد ذلك قامت حكومة البعث بغلق المدرسة وتحويلها إلى (إعدادية الدراسات الإسلامية) لتخضع كليا لنظام وزارة التربية والتعليم، وبهذا
سلسلة السند العلمي المبارك، وتم إلغاء جميع المناهج العلمية والتربوية في المدرسة وكانت هذه المرحلة من أسوأ مراحل التعليم الديني في العراق، لكن أهالي الفلوجة لم يهدأ لهم بال حتى تمكنوا من إعادة المدرسة بشكل مختلف بعد أن تم تغيير الاسم وبعض الجوانب الإدارية والرسمية، ثم جاء الاحتلال الأمريكي للعراق ليضرب بقنابله المدمرة هذه المدرسة العريقة ويتلف كل وثائقها[11] وكان ذلك سنة 2005، ولا تزال محاولات أهالي الفلوجة جادة لإعادة بناء الآصفية كما كانت بالاسم والرسم والمنهج.
ولا يفوتني هنا أن أذكر ملاحظة الأستاذ عمر الفاروق -المستشار السابق لرئيس الحكومة التركي والمشرف على كثير من مناهج التربية والتعليم في تركيا اليوم- حيث ذكر لي أن الآصفية واحدة من المدارس التي أحيتها الدولة العثمانية للحفاظ على هوية العراق وعقيدة أهل السنة والجماعة إبان التحديات الكبيرة التي كان يتعرض لها العراق والمتمثلة بالغزو الطائفي (الصفوي) القادم من الشرق في تلك المرحلة، إلا أني من خلال تجربتي الطويلة في المدرسة لم ألحظ أي تعبير عن ذلك الصراع، ولم يكن في مناهج الآصفية أي اهتمام بالخلافات الطائفية أو المذهبية بل كان مما ينقص المدرسة وجود برامج للفرق أو الأديان المقارنة، لكنه في النتيجة أن هذه المدارس كانت بلا شك من أهم أسباب الحفاظ على هوية العراق العربية والإسلامية والحفاظ على عقيدة أهل السنة والجماعة بشكل خاص.
ثالثا – باعتبار المنهج والبرنامج العلمي والتربوي:
هناك تداخلات كثيرة في هذا الجانب يعود أغلبها إلى ارتباط تلك المدارس بشيخها وليس بالأطر الرسمية أو الحكومية ولتوضيح الصورة فإن الشيخ عبد العزيز السامرائي تأثر كثيرا بمنهج شيخه أحمد الراوي الذي أخذ العلم عنه في سامراء ثم عين الشيخ في مدرسة هيت وفي سنة 1948 نقل إلى مدرسة الفلوجة لكنه حينما جاء إلى الفلوجة طبق برنامجه الذي مارسه في مدرسة هيت والذي هو امتداد لمدرسة سامراء، واللطيف أن الشيخ لما تحول من هيت إلى الفلوجة انتقل معه بعض تلامذته في هيت ومنهم الشيخ عبد الملك السعدي وإبراهيم الهيتي، وحين أكمل الشيخ عبد الملك دراسته في الفلوجة ومارس التدريس في مدرستها أسس مدرسته الجديدة في مدينة الرمادي والغريب أن بعض طلاب الفلوجة تحولوا معه إلى الرمادي.
ومثال ثان حيث تخرج الشيخ عبد الستار الكبيسي من الآصفية ففكر بإحياء مدرسة كبيسة القديمة لكنه واجه بعض العقبات الإدارية حتى تمكن من إقناع المسؤولين في بغداد[12] بأخذ وجهة مدرسة “عثمان أفندي” البغدادية وتحويلها إلى كبيسة بامتيازاتها الإدارية، لكن الشيخ عبد الستار لم يأخذ من عثمان أفندي إلا الدرجة الوظيفية الرسمية أما المنهج فيكاد يكون مطابقا تماما لمنهج الآصفية في الفلوجة.
وهذا يؤكّد حقيقة أن تلك الأسماء والترتيبات الإدارية لم تكن سوى محاضن رسمية لذلك المنهج التربوي العريق، والذي كان الشيخ يمثل الحلقة الأمتن في حلقاته التاريخية.
نخلص من كل ما تقدم أن تأريخ الآصفية باعتبارها منهجا وسندا علميا متصلا قد بدأ مع الفتح الإسلامي الأول للعراق[13]، أما باعتبار الأسماء والترتيبات الإدارية فهناك أكثر من تغيير طرأ على المدرسة بحسب الظروف والمختلفة وما شهدته الساحة العراقية من تقلبات سياسية وثقافية.
الموقع الجغرافي والبيئة الحاضنة:
لمع اسم مدينة الفلوجة مرتين في تأريخنا القريب، المرة الأولى إبان الاحتلال البريطاني الأول للعراق حيث دارت على ترابها واحدة من أبرز معارك التحرير آنذاك وقد خلدها شاعر العراق معروف الرصافي بقوله:
أيها الإنجليز لن نتناسى بغيكم في مساكن الفلوجة
والثانية حيث دارت معركة الفلوجة مع الجيش الأمريكي الذي غزا البلاد سنة 2003 حيث وقف أهالي الفلوجة بصمود أسطوري أمام الجيش الأقوى في العالم حيث أجبروه على الانسحاب وفق شروط الأهالي[14]، وتساءل الناس عن هذه المدينة وسر قوتها ؟
ولا نريد هنا أن نجيب على هذا التساؤل إلا بالقدر المتعلق بموضوع البحث:
تقع مدينة الفلوجة على ضفاف نهر الفرات، بين العاصمة بغداد التي تبعد عنها 60كم والرمادي مركز محافظة الأنبار والتي تبعد عنها 45كم، وتشكل بغداد والفلوجة أقرب نقطتين بين نهر دجلة والفرات من دخولهما الأراضي العراقية حتى التحامهما معا في شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.
يحيط بمدينة الفلوجة ريف واسع يشكل جزءا متميزا لما يعرف بأرض السواد حيث انتشار الأراضي الخصبة والبساتين المتواصلة على ضفتي النهر والترع الفرعية.
ينتسب سكان الفلوجة لقومية واحدة هي القومية العربية والطابع القبلي هو السائد في مركز المدينة وأطرافها على السواء، ولا زالت كل قبيلة تحتفظ بمضاربها الخاصة حول المدينة، فعشائر “المحامدة” مثلا وهم من القبائل الزبيدية يتركز وجودها في منطقة “الصقلاوية”، وعشائر “البوعيسى” وهي من القبائل “الطائية” تتركز في منطقة العامرية، بينما تتركز عشائر الجميلة القيسية في منطقة الكرمة وهكذا “البوعلوان” و”الحلابسة” و”زوبع”… إلخ وهذا يعني أن كل عشيرة تحتفظ بنظامها وآصرتها المتينة وأعرافها وتقاليدها.
أما مركز المدينة فيمثل مزيجا متجانسا من هذه العشائر يضاف إليهم بعض أبناء القبائل العربية الوافدة من أعالي الفرات ضمن محافظة الأنبار نفسها وذلك مثل القبائل الوافدة من هيت وكبيسة وحديثة وعانة وراوة والقائم، وهؤلاء كلهم دون استثناء يلتقون مع قبائل الفلوجة بأصول عرقية واحدة.
يضاف إلى ذلك أن أهالي الفلوجة ينتسبون كلهم إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا يعني أنهم متجانسون عرقيا ودينيا على خلاف الكثير من مناطق العراق.
إن قبائل الفلوجة لم يعرف عنهم إلا الخلق النبيل والمنافسة والتزاحم في المروءة والشجاعة والكرم وهم شديدو التمسك بتراثهم وأدبياتهم حتى أنك لا تكاد تجد في كل الفلوجة امرأة سافرة واحدة، ولا يوجد في كل الفلوجة محل لبيع الخمر -وقد حصلت مصادمات عديدة بين أهالي الفلوجة– والأحزاب العلمانية التي هيمنت على دفة الحكم في العراق مثل الشيوعيين والبعثيين بسبب محاولات هذه الأحزاب اختراق المجتمع المحافظ للمدينة.
إن كل ما تحتاجه تلك القبائل المحافظة هو الوعي الإسلامي وهذا ما اضطلعت به الآصفية حيث تمكنت هذه المدرسة من تغطية هذا الجانب من خلال:
- التعاون مع الأهالي لبناء المساجد في كل مناطق الفلوجة حتى لقّـبت المدينة بـ (مدينة المساجد) وكل مساجد الفلوجة مساجد أهلية إلا القليل منها[15].
- تخريج الأئمة والخطباء وتعيينهم في تلك المساجد، وقد فاض عدد الأئمة والخطباء الذين خرّجتهم الآصفية عن حاجة الفلوجة فانتشروا في كل محافظة الأنبار والعاصمة بغداد.
- تخريج المدرسين الشرعيين.
- توفير الدعاة (السيّارين) الذين يتجولون في مضارب القبائل.
- إقامة الدورات التثقيفية ومجالس العلم المتخصصة في الكثير من المساجد.
- إقامة التجمعات الكبيرة في المناسبات الدينية مثل: (المولد النبوي)[16] (الإسراء والمعراج) و (ذكرى معركة بدر) و (ليلة القدر) وغير ذلك.
- تقديم الفتاوى والمساهمة بحل مشاكل الناس المادية والاجتماعية وغيرها.
إن هذا الذي قدمته الآصفية لأهالي الفلوجة لم يكن دون مقابل! فقد كان التفاعل من الطرفين حيث كان الأهالي يقدمون الدعم المادي والمعنوي وحتى الحماية التي تتطلب قدرا كبيرا من التضحية لاسيما أيام المحن والمصادمات مع الحكومات العلمانية وكذا في معارك التحرير التي كان لعلماء الآصفية الدور الأبرز فيها ولم يتمكنوا حقيقة من لعب هذا الدور إلا بمؤازرة الأهالي.
وبهذا الصدد لا بد من بيان بعض الحقائق وأهمها:
أولا: موقع مدينة الفلوجة حيث هي أقرب مدينة في كل محافظة الأنبار إلى العاصمة بغداد، تلك المحافظة التي تشكل ثلث مساحة العراق، والتي تحدها ثلاث دول عربية وهي المملكة العربية السعودية والأردن وسوريا، والمحافظة تمتلك صلات وثيقة مع هذه الدول، وقد تجد القبيلة الواحدة وربما العائلة الواحدة منقسمة بين المحافظة هذه وبين هذه الدول، وكل القادمين إلى بغداد من هذه الدول ومن أطراف المحافظة لابد لهم أن يمروا بمدينة الفلوجة، وقد ترك هذا أثرا واضحا في ثقافة أهالي الفلوجة، وتعاطفهم المستمر مع قضايا الأمة، وقد انعكس هذا على توجهات المدرسة وعلاقة خريجيها بمحيطهم العربي.
ثانيا: أن المدرسة بنيت على شكل مربع واسع يقع ضلعاه الأولان قريبا من مساكن المدينة وفيهما البوابتان الرئيستان للمدرسة، بينما يدخل ضلعاه الآخران في عمق نهر الفرات في المصب الأوسع للنهر، وقد جعلت أغلب قاعات المدرسة مع مساحة واسعة ومفتوحة تطل وبصورة مباشرة على النهر، كما أن الضفة الأخرى للنهر لا يقع عليها أي مبنى سوى المزارع الخضراء والبساتين الممتدة على طول النهر.
من الواضح أن اختيار هذا الموقع كان مقصودا بدقة فمن ناحية تكون المدرسة قريبة من الناس وأسواقهم وفعالياتهم الاجتماعية، ومن ناحية أخرى تشكل المدرسة واحة جميلة ووادعة تعين المرء على التأمل والتركيز والهدوء النفسي.
ثالثا: أن المدرسة تشكل مع الجامع الكبير وحدة معمارية في غاية التنسيق، حيث يكون رواق المدرسة المعتمد على صف طويل من الأعمدة يقابل بالضبط رواق المسجد وبينهما مساحة واسعة ومفتوحة تزينها بعض الحدائق الجميلة، والجامع الكبير يحظى بمكانه خاصة في قلوب الأهالي مما ساعد على تكوين بيئة صالحة للتفاعل بين طلاب المدرسة والأهالي الذين يفدون للمسجد ليس للصلاة فقط وإنما هناك حركة دءوب لا تكاد تنقطع ليلا أو نهارا، والمسجد مفتحة أبوابه لكل قاصد وسائل وقد وفّر هذا أرضا خصبة لتنمية المهارات التواصلية والتفاعلية وحتى المعرفية لطلاب المدرسة فهناك حلقات علمية أو وعظية يعقدها الطلاب لهؤلاء الناس، وهناك المناسبات الكبيرة مثل أيام رمضان ومواسم الأعياد وذكرى المولد النبوي التي يحتشد فيها الناس لسماع الكلمات والمواعظ والأشعار التي يتبارى فيها طلاب المدرسة بإشراف شيخ المدرسة نفسه.
ولا يفوتني هنا أن أذكر أنه لا توجد مدرسة شقيقة للآصفية أو متفرعة عنها إلا وهي ملتصقة بالمسجد الجامع للمدينة مما يؤكد وجود منهج ناظم لكل هذه المدارس بهذا الصدد[17].
رابعا: لقد كان المبنى نفسه معبرا تعبيرا جيدا عن رسالة المدرسة، ليس في طرازه الإسلامي المعروف فحسب وإنما في الأقواس المزينة بحكيم القول شعراً ونثراً وأذكر من ذلك: (الشكر أن لا تستعين بنعم الله على معاصيه) و:
حياة الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته
ومن فاته التعليم وقت شبـابه فكبّر عليه أربعاً لوفاتــه[18]
لقد كان الطالب يمسي ويصبح في ظلال هذه الحكم فيستقي ما يعينه على مواصلة الطريق.
الامتداد والانتشار:
إن ما يميّز الآصفية أنها لم تكن تلك المدرسة القائمة على مساحة محدودة من الأرض، وإنما تمكنت بفضل منهجها الهادف أن تشكل ظاهرة لها امتداداتها الواسعة في الساحة العراقية والفضاء الأوسع المحيط بالعراق، ومن المناسب تسليط الضوء على معالم ذلك المنهج الذي حقق للآصفية كل هذا الامتداد:
المعلم الأول: تشجيع المتميزين من خريجي المدرسة لفتح مدارس جديدة مشابهة في منهجها للآصفية، ولنأخذ النماذج الآتية من هذه المدارس:
1- مدرسة الرمادي:التي أسسها فضيلة الشيخ عبد الملك عبد الرحمن السعدي والذي يعد أبرز خريجي الآصفية وواحد من أقدم تلاميذ الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي، وقد حدثني الشيخ عبد الملك –حفظه الله- أن فكرة تأسيس المدرسة برزت بالتشاور مع السيد محمد أحمد النبهاني الحلبي أحد رموز الصوفية وعلمائها المعروفين في سوريا[19] والذي كان الشيخ عبد الملك على صلة وثيقة به، ولكن هذه الفكرة لا يمكن أن تأخذ طريقها للوجود إلا بعد مباركة شيخ الآصفية الذي كان مترددا بادئ الأمر لحاجة الشيخ إلى من يساعده داخل الآصفية، لكن الشيخ قد شرح الله صدره لتخفيف الزخم عن الآصفية نفسها ولإحياء المنهج التربوي الأصيل في مدينة الرمادي وهي مركز محافظة الأنبار ، والتي تبعد عن الفلوجة 45كم.
لقد تمكن الشيخ عبد الملك من تأسيس المدرسة الجديدة باسم “منوّرة خاتون” وهو اسم رسمي كان لابد منه في الوضع الإداري الذي كان سائدا آنذاك كدرجة معترف بها رسميا في مؤسسات الدولة، ولقد كان لهذه المدرسة دور كبير في رفد الساحة العراقية والمحيط العربي بكفاءات علمية متميزة –ربما يأتينا نماذج منها لاحقاً–
2- مدرسة كبيسة: والتي أسسها الشيخ عبد الستار الملا طه –رحمه الله- وهو أحد أبرز خريجي الآصفية وقد قام بتأسيس المدرسة بعد تخرجه باسم “مدرسة عثمان أفندي” بالسياق الرسمي الذي أسست به مدرسة “منورة خاتون” وقد كان ذلك بتوجيه من شيخ الآصفية الشيخ عبد العزيز سالم، وقد حدثني والدي -رحمه الله – أن الشيخ عبد العزيز زار مدرسة كبيسة بعد تأسيها واطلع على منهجها وقابل تلامذتها[20]، وكان كثيرا ما يذكر باعتزاز مدرسة كبيسة ومؤسسها ويعدّها ثمرة من ثماره وامتدادا طبيعيا لمدرسته الآصفية.
لقد بارك الله بـ “عثمان أفندي” حتى خرّجت أعدادا كبيرة ومتميزة من العلماء، وقد احتضنت كثير من الجامعات العربية خريجي هذه المدرسة –وسيأتي ذكرهم لاحقا- لكن الذي تجدر الإشارة إليه هنا أن هذه المدرسة قد أنتجت مدرسة أخرى وهي مدرسة “الرطبة” التي تبعد عن الفلوجة قرابة 400كم كما تبعد عن كبيسة قرابة300كم وقد أشرف عليها الشيخ حامد عطيوي الكبيسي أحد تلاميذ الشيخ عبد الستار –رحمه الله-.
3- مدرسة الخالدية وهي المدرسة التي أشرف عليها الشيخ أيوب محمد الفياض الكبيسي[21] وهو خريج الآصفية ونجل مرشدها الروحي، وقد تأسست المدرسة باسم “الأحمدية” ودرّس فيها عدد من خريجي الآصفية أبرزهم الشيخ عقلة جروان الكبيسي وهو من الرعيل الأول للآصفية، وتقع هذه المدرسة في مدينة الخالدية التي لا تبعد سوى 30 كم عن الفلوجة، لكنها تقع في وسط قبائل عربية أصيلة يرجع أغلبهم إلى قبائل “الدليم” المعروفة في العراق.
4- المدرسة الإسلامية في نيجيريا : التي أسسها الشيخ مصطفى بابير النيجيري وهو واحد من خريجي الآصفية، والذي انقطعت أخباره بسبب ظروف العراق السياسية والأمنية، إلا أن الشيخ خليل محمد الفياض –وهو من علماء الآصفية المعروفين بالعلم والصلاح والذي تولى رئاسة الآصفية لفترة- ذكر لي أنه قد التقى بالشيخ مصطفى وبشّره بأن المدرسة النيجيرية قائمة والحمد لله[22]، وللأسف فإن معلومات الباحث قد توقفت عند هذا الحد وإن شاء الله تتوفر السبل المناسبة للتعرف على هذه المدرسة التي تعد امتدادا عميقاً للآصفية.
المعلم الثاني: تكليف الشيخ لطلابه بالانتشار في مختلف المناطق لأداء خطبة الجمعة ودروس الوعظ، حيث كان الشيخ يشرف بنفسه على بناء المساجد في الأرياف والمضارب النائية[23]، وقد كان كثير من طلاب الشيخ يسعون في طول البلاد وعرضها لأداء رسالة المسجد، ومن ثم جاء اسم الفلوجة “مدينة المساجد”، وقد حدثني والدي أن الشيخ عبد الستار كان قد أشرف على بناء عدد غير قليل من المساجد، ولقد زاد من تعاطف الأغنياء معه أن الشيخ كان يساهم بيده في بناء المسجد أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم[24]
المعلم الثالث : التأثير في المؤسسات العلمية والمجتمعية، حيث ساهم علماء الآصفية وطلابها في مختلف المؤسسات العلمية داخل العراق وخارجه مثل:
- رابطة علماء العراق: وهي أقدم تجمع يضم علماء العراق في مختلف المحافظات.
- هيئة علماء المسلمين: وقد شكلت بعد العدوان الأمريكي على العراق وساهم بتأسيسها عدد من علماء العراق جلّهم من علماء الآصفية مثل رئيسها الحالي الشيخ حارث الضاري ورئيسها السابق الدكتور محمد عبيد الكبيسي، والناطق الرسمي الدكتور بشار الفيضي، وممثل الهيئة في الخارج الدكتور محمد عياش الكبيسي وغيرهم.
- مجلس علماء العراق الذي يرأسه الآن الدكتور محمود عبد العزيز العاني وهو من خريجي الآصفية والمجلس يضم كثيرا من علماء الآصفية إضافة لإخوانهم من المدارس المماثلة.
- جماعة علماء العراق: وفيها عدد من خريجي الآصفية، وقد قام بتأسيسها الشيخ الدكتور عبد اللطيف هميم، وهو من خريجي المدرسة الدينية في الرمادي وعلى صلة وثيقة بشيوخها، وقد كان يساعدهم في إلقاء بعض الدروس.
- الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: والذي يرأسه اليوم العلامة الشيخ يوسف القرضاوي وهو يضم عددا من علماء الآصفية مثل الشيخ حارث الضاري والدكتور محمد عياش الكبيسي.
أما إذا أخذنا الجامعات ومراكز البحوث العلمية في العراق والدول العربية المجاورة فإن هناك أعدادا كبيرة من خريجي الآصفية يعملون في هذه المؤسسات، وسيأتي شيء من تفصيل هذا في فصل “المتعلم”.
الفصل الثالث: المعلّم (الشيخ)
يمكن القول: إن الشيخ كان عنوان المدرسة ورمزها وصورتها الكلية المرتبطة في أذهان الناس، حتى أن عامة أهل الفلوجة لا يذكرون اسم الآصفية بقدر ما يذكرون (مدرسة الشيخ عبد العزيز) ويقولون: “هذا تلميذ الشيخ عبد العزيز” أكثر من قولهم: “هذا تلميذ الآصفية”، وهكذا في كل المدارس المتفرعة عن الآصفية فيقال في الرمادي: “مدرسة الشيخ عبد الملك” وفي كبيسة: “مدرسة الشيخ عبد الستار”، وربما يرتبط باسم الشيخ أيضا المسجد اللصيق بالمدرسة فيقال: “مسجد الشيخ عبد العزيز” و”مسجد الشيخ عبد الملك” و”مسجد الشيخ عبد الستار” وهكذا، وقد رأيت عامة الناس يتمسكون بهذا الاسم حتى بعد وفاة الشيخ أو انتقاله إلى مكان آخر! خاصة إذا كان الذي يأتي بعده هو أحد تلامذته، أو أنه لا يحمل الرمزية نفسها التي كان يحملها الشيخ، وكل هذا يدل بشكل قاطع على قوة تأثير الشيخ في محيطه الواسع الذي يتجاوز حدود المدرسة، وهذا ما يفقده الأستاذ الجامعي المعاصر أو رئيس الجامعة، وفي الغالب لم نر ذلك في التعليم المعاصر إلا لمن كان خريجا لتلك المدارس الأصيلة أصلا.
صفات الشيخ ومؤهلاته:
إن الشيخ الذي يصل إلى مثل هذه المكانة لابد أنه يتميز بصفات ومؤهلات يصعب تحققها في غيره، ولابد أنه كذلك قد قطع أشواطاً بعيدة في صلاته الاجتماعية ومن موقع الريادة فلا تكفي في مثل هذه الظاهرة الصفات الشخصية الذاتية، وإذا أردنا أن نشير إلى هذه الصفات والمؤهلات فيمكن إجمالها في الآتي:
أولاً: حصوله على الإجازة العالِمية، وهذه هي الوثيقة الرسمية التي تلحق الشيخ بذلك التاريخ العلمي العريق في الأمة، وتجعله حلقة في سلسلة متواصلة، ليصبح في نظر الناس امتدادا لأعلام الأمة الأوائل كأي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وشرف الدين النووي والقرطبي والجرجاني وحجة الإسلام الغزالي.
إن الإجازة العالمية هذه تجعل الشيخ منتمياً انتماءً حقيقياً لهوية الأمة وتأريخها[25]، وهذا ما يفتقر إليه الأستاذ الجامعي، ليس فقط لأن الجامعات لا تمنح هذه الإجازة لخريجيها، وإنما لأن الجامعة ليس فيها مقوّمات الحصول على هذه الإجازة حيث أن الجامعات لا تحتوي على أدوات تقويم حقيقية للجانب القيمي أو الأخلاقي وبالتالي فيسهل على هذه الجامعات أن تخرج أساتذة لا يشعرون بالانتماء لهذه الهوية وقد امتد هذا إلى كليات الشريعة نفسها!.
ثانياً: حصوله على التزكية من أركان العلم في عصره، أما حصوله على التزكية من أشياخه فهذا أمر ظاهر لكني وجدت الكثير من علمائنا الرموز يمنحون التزكية والدعم الكبير لغير تلامذتهم ن وأذكر في هذا أني كنت أذهب كل أسبوع تقريبا من الفلوجة إلى بغداد لزيارة “علامة العراق” الشيخ عبد الكريم المدرس المعروف بـ(بياره) –عليه رحمة الله- وكان حينها رئيس رابطة علماء العراق، وكنت أحمل كل أسبوع للشيخ دقائق المسائل المشكلة ففوجئت مرة وهو يقول لي بالنص:”والله بابا لو كان عندي وقت لذهبت أكمل العلم عند الشيخ جمال شاكر” وكان الشيخ جمال حينها مديراً للآصفية، ولقد كان مقصود الشيخ واضحاً وهو تعزيز الثقة بالآصفية وشيوخها وإلا فالشيخ جمال يأتي في الطبقات المتأخرة (زمنياً على الأقل) مقارنة بعلماء الآصفية الأوائل فضلا عن رمز كبير كالشيخ (بياره).
وأذكر بهذا الصدد موقفاً طريفا للشيخ (بياره) –رحمه الله- حيث ذهبنا إليه نشكو له ضغوط حكومة البعث على المدارس الدينية وطلابها فقال بالنص : “والله لو كان عبد العزيز سامرا موجودا ما يحصل هذا”، ومعنى كل هذا أن الدعم لشيوخ المدرسة لم يأت من عامة الناس فحسب، بل جاء من العلماء الأقران والرموز الكبار.
ثالثاً: العلم الموسوعي، فالشيخ في هذه المدارس لا يكون شيخا أصلا إلا إذا كان حائزا على الإجازة في كل العلوم (النقلية والعقلية وعلوم الآلة)[26] فهو يقوم عملياً بتدريس هذه العلوم جميعها، وربما يقوم فوق هذا بتأليف الكتب المناسبة للمقررات الدراسية، وهو كذلك يقوم باستقبال أسئلة الناس واستفتاءاتهم في مختلف العلوم والفنون، وهذا ما يعزز من الصورة الرمزية الكبيرة للشيخ في محيطه الواسع، وربما يكفينا هنا أن نذكر نماذج مما توصلت إليه من مؤلفات شيخ الآصفية الأكبر الشيخ عبد العزيز –رحمه الله- :
- علم أصول التفسير (مخطوط)
- علم أصول الحديث ( مخطوط)
- العقائد الإسلامية شرح المقاصد النووية (منشور)
- إيضاح العقائد النسفية ( مخطوط)
- إيضاح بدء الأمالي ( مخطوط)
- إيضاح متن الشيبانية (مخطوط)
- رسالة في علم أصول الفقه (مخطوط)
- إيضاح متن الغاية والتقريب (مخطوط)
- إيضاح متن الرحبية في الفرائض ( مخطوط)
- إيضاح السراجية في الفرائض (مخطوط)
- إيضاح متن الآجرومية ( منشور)
- إيضاح قطر الندى وبل الصدى (مخطوط)
- إيضاح متن المقصود ( مخطوط )
- جداول الأمثلة في الصرف ( منشور)
- تحفة الإخوان في فن البيان ( منشور)
- رسالة في المعاني والبيان والبديع ( مخطوط)
- رسالة في فن العروض (مخطوط)
- رسالة في فن الوضع (منشور)
- رسالة في الحكمة والمقولات العشر (منشور)
- إيضاح إيساغوجي في المنطق (مخطوط)[27]
إن الناظر في هذه المؤلفات يستنتج أن هم الشيخ الأول كان المدرسة، حيث جاءت كل مؤلفات الشيخ – تقريباً – لخدمة مقررات المدرسة، كما أن هذه المؤلفات قد تناولت مختلف العلوم والفنون مما يدل على موسوعية الشيخ وهي صفة عامة في غالب شيوخ المدارس الدينية الأصيلة.
رابعاً: التقوى: حيث كان الشيخ قدوة لطلابه وأتباعه، وتحقيق هذه الصفة ناتج عن فلسفة عميقة مؤدّاها أن الشيخ وارث للنبي صلى الله عليه وسلم فــ (العلماء ورثة الأنبياء)[28] والعالم لا يرث من النبي العلم المجرد، إذ التقوى شرط في هذا الإرث، وأستطيع الجزم من خلال تجربتي الشخصية أن هذه الفلسفة أو القيمة التربوية العميقة كانت هي الدافع الأكبر لتكوين شخصية الشيخ ثم الطلاب والأتباع[29].
لقد صحبت عددا من شيوخ الآصفية دهراً طويلا فما رأيت واحدا منهم متلبسا بإثم ظاهر، بل كانوا مثالاً للتمسك بالنوافل والمحافظة على المأثورات مع شدة الخشية والحضور القلبي مع الله ، وأذكر بعض الأمثلة الظاهرة على هذا :
– كان الشيخ خليل الفياض يعتكف في مصلاه كل يوم ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وقبل صلاة المغرب بنحو ساعة إلى ما بعد صلاة العشاء بنحو ساعة كذلك، وكان غالب هذا الوقت يقضيه بالذكر والدعاء إلا إذا بادره أحدنا بسؤال فيجيب بقدر السؤال.
– وقد صحبت الشيخ عبد الله الحديد أكثر من ست سنوات متواصلة فما سمعت منه غيبة، أو انتقاصا لأحد ولو بالتلميح، وكنا نراه في أغلب صلواته يرتجف من البكاء دون صوت كأنه يغالب نفسه على الكتمان وكان هذا منظرا مألوفا لنا ومتكررا كل يوم.[30]
خامساً: الشجاعة: لقد كان شيوخ الآصفية مضرب المثل في المواقف الشجاعة التي تمليها تحديات المراحل المختلفة والمتقلبة في سياسة العراق، وقد كانت تلك التقلبات تمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة مدرسة الآصفية وبيئتها الحاضنة، وكان على شيوخ الآصفية أن يقفوا بوجه هذه التحديات وسأكتفي بمثالين من هذه المواقف عايشتهما بنفسي:
– حاولت حكومة البعث أن تخترق البيئة المحافظة لمدينة الفلوجة وذلك سنة 1973 قبل تبني الحكومة لما عرف فيما بعد بـ (الحملة الإيمانية) بإقامة حفلة ليلية راقصة ومختلطة، ووزعت دعوات واسعة ومشجعة على الحضور، وكان كل الكادر الفني من خارج الفلوجة، وكانت هذه الخطوة بمثابة جس نبض للروح المحافظة لدى الأهالي، لكن الأهالي تصدوا لهذه الخطوة بالقوة بعد أن فشلت كل المحاولات السلمية التي قادها علماء الفلوجة ووجهاؤها، وعلى رأسهم شيخ الآصفية في ذلك الوقت الشيخ إبراهيم الهيتي –رحمه الله- وبعد أن حصلت المواجهات وتعطلت الحفلة تماما قامت قوات الأمن باعتقال الشيخ إبراهيم[31] وبقي في السجن من 9/4/73 إلى 30/6/74 وبعد خروجه من السجن قص علينا المواجهة التي حصلت بينه وبين جلاد العراق في ذلك الوقت ” ناظم كزار” حيث قال له الشيخ :
إن الملوك ليحكمون على الورى وعلى الملوك لتحكم العلماء
– والمثال الثاني حين تصاعدت التهديدات الأمريكية بغزو العراق وصدرت في حينها فتوى لأكثر من خمسمائة عالم تدعو المسلمين للوقوف بوجه هذه التهديدات، إلا أن هذه الفتوى لم تحظ بالمصداقية لأنها ربطت بضغط من حكومة صدام حسين –رحمه الله- فانبرى عدد من علماء العراق المقيمين في الخارج وغالبهم معارض للنظام الحاكم وكان هذا سبب خروجهم، لكنهم مع هذا أصدروا فتوى بوجوب الجهاد في حالة حصول
وإذا نظرنا في أسماء الموقعين على الفتوى فسنجد أن أكثر من نصف الموقعين كانوا من خريجي الآصفية منهم (الشيخ الدكتور هاشم جميل، والشيخ الدكتور أحمد عبيد الكبيسي، والشيخ الدكتور حارث الضاري، والشيخ الدكتور عبد القادر السعدي، والدكتور محمد عياش الكبيسي) وأنقل هنا مقطعا من نص الفتوى :
“إن جهاد (الدفع) هو قتال الكفار المعتدين إذا احتلوا بلدا ً من دار الإسلام أو عزموا على ذلك وباشروا مقدماته، ففي هذه الحالة يجب هذا الجهاد –جهاد الدفع– على كل مسلم قادر على قتال الكفار لأن قتالهم في هذه الحالة فرض عيني قال الفقهاء فيه: “تخرج المرأة القادرة على القتال بدون إذن زوجها، ويخرج الولد بدون إذن والديه، ويخرج العبد بدون إذن سيده” وحيث أن الأمريكان قد عزموا على احتلال العراق المسلم وباشروا مقدماته فعلى جميع المسلمين في العراق قتالهم والاستعداد لهذا القتال، لأن قتالهم صار فرض عين على المسلمين في العراق”.
سادساً: خدمة المدرسة: فقد كان الشيخ حقيقة كأنه منذور أو موقوف للمدرسة، فهو يدخل المدرسة قبل صلاة الفجر وغالبا ما يبقى إلى ما بعد العشاء بنحو ساعتين، ولا يخرج إلا للضرورات والحاجات الملحّة، وحينما كنا تلاميذ صغارا ما كنا ندرك حجم التضحية التي يقدمها الشيخ بهذا الدوام الذي يفرضه هو على نفسه، إذ لا أحد يحاسبه على هذا، لكننا حين كبرنا أدركنا أن الشيخ كان يضحي بكل شيء من أجل المدرسة، حتى صحته وصحة أهل بيته واحتياجاتهم، ولقد وطن الشيخ نفسه وأهله على الزهد والتخفف من أعباء الدنيا وقلة الالتزامات الاجتماعية لصالح المدرسة، وقد ذكر لي والدي –رحمه الله– أن بعض أصدقاء الشيخ عبد الستار الكبيسي عرضوا عليه الزواج فقال لهم: أنا لا أفكر بالزواج حتى تكمل المدرسة ويتخرج الجيل الأول منها القادر على مساعدتي في التدريس وإدارة شؤون المدرسة، وقد توفي –رحمه الله– دون زواج[32].
وقد كانت هذه الخدمة لا تقتصر على التدريس وإنما كانت خدمة شاملة وممزوجة بالتواضع، فالشيخ كان يسعى بنفسه لتوفير المال اللازم للمدرسة ومساعدة الطلاب الفقراء، وقد حدثني والدي عن الشيخ عبد الستار أنه كان يحمل الصخر ومواد البناء بنفسه وكأنه واحد من العمال، والشيخ عبد العزيز كان يملأ أباريق الماء للوضوء ويهيؤها قبل وقت الصلاة، وبهذا الصدد فلا زلت أذكر موقفاً أثّر بي كثيرا حيث مرّ بي شيخنا الشيخ جمال شاكر وأنا جالس على درج المدرسة فجاء إلي بهيبته وأخذني من يدي ومشى بي حتى وصلنا إلى حنفية ماء قريبة فمد يده على طرف ثوبي وأخذ يغسله لأنه رأى عليه أثرا من الأرض!
لقد كان الشيخ بحق كأنه أب لجميع الطلاب وربما أكثر من الأب لأن الطالب في فترة الدراسة قطعا لا يرى أباه وأمه بقدر ما يرى الشيخ!
سابعا: استيعاب التوجهات الإسلامية المختلفة: لقد كان التوجه الديني لدى أهل العراق محكوماً برؤية المدارس الدينية فيه، وهي مدارس تمثل امتدادا –كما قلنا- للفتح الإسلامي وما رافقه من قيام كبار الصحابة بمهمة التربية والتعليم في العراق، ثم تكونت المذاهب الكبيرة في الأصول كالمعتزلة والإمامية والأشاعرة، والفروع كالحنفية والشافعية، ثم تكونت المدارس الدينية النظامية بتوجهين اثنين: مدارس الشيعة الإمامية (الحوزات) وكانت منحصرة في مدينة النجف، ومدارس أهل السنة وكانت منتشرة في غالب مناطق العراق ومدنه، وتمكنت المدارس السنية أن تتجاوز الخلافات المذهبية الداخلية والتي كانت تحدث بين الشافعية والحنفية والحنابلة –مع قلة أتباع المذهب الحنبلي في العراق– حيث أصبحت المدارس لا تسأل عن كون الطالب شافعيا أو حنفيا، وكان رموز هذه المذاهب وهم في الغالب شيوخ هذه المدارس على توافق تام، مما انعكس هذا على المناهج الدراسية حيث كان فيها الفقه الشافعي إلى جانب الحنفي وفي المدرسة الواحدة –كما سيأتي-.
لقد بقيت هذه المدارس تشكل المرجعية المنضبطة القادرة على قيادة المجتمع بلا منافس حتى أواسط القرن العشرين، بعد هذه المرحلة ونتيجة لغياب المرجعية السياسية بسقوط الخلافة العثمانية والتي كانت على وفاق مع المرجعية الدينية، وسيطرة القوى والأحزاب العلمانية واللادينية على مقدرات البلاد، حصلت حالة من الارتباك في الوسط الديني وصار كثير من الشباب يبحث عن الحل، وأصبح المجتمع مفتوحا على التجارب والأفكار الواردة من مجتمعات أخرى تختلف بظروفها وخصوصياتها عن المجتمع العراقي، فتأثر بعض الشباب بمنهج الإخوان المسلمين القادم من مصر، وقد حظي هذا التوجه بدعم محدود من بعض شيوخ المدارس العراقية كالشيخ أمجد الزهاوي[33] الذي وفّر غطاءً مناسبا لتحركات الشيخ محمد محمود الصواف بدعوة الإخوان، وكان الشيخ الصوّاف أوّل المبشّرين بهذه الدعوة.
ثم وفد الفكر السلفي من الجزيرة العربية ورغم أنه لم يحظ بأي دعم من هذه المدارس إلا أنه وجد له أرضاً خصبة في أوساط الشباب الناقمين على الأوضاع السائدة والتي ما كانت إلا انعكاسات طبيعية لسقوط الخلافة.
وقد تزامن مع هذين الفكرين الوافدين جنوح بعض الطرق الصوفية إلى ما يشبه الاستقلال عن مرجعية المدارس الدينية وشيوخها، فكان للطريقة مقرها الذي يجتمع فيه أبناء الطريقة كل يوم ليس للذكر فقط وإنما للتداول في الأمر العام، ومناقشة بعض الأفكار والمستجدات.
وأصبحت الساحة الفكرية الدينية لأهل السنة في الغالب لا تخرج عن هذه التوجهات الثلاث: الإخوان المسلمون، السلفيون، الطرق الصوفية، وفي الغالب كانت هذه التوجهات تشهد استقطابات وولاءات قاصرة ومناكفات مؤذية للوسط الديني أمام التحديات الأخطر المتمثلة بالعلمنة والتغريب وحتى الإلحاد، إلا أن السواد الأعظم من الناس لا زال ملتفاً حول المدارس الدينية وشيوخها وغالب الفتاوى لا يسمعها الناس إلا من هذه المدارس.
لقد كان على شيوخ هذه المدارس استيعاب هذه الحالة الجديدة، وقد تفاوتت قدراتهم الذاتية في هذا، وقد وفّق الله كثيرا منهم لأن يحافظوا على التوازن فرفعوا السقف ليضم كل تلك التوجهات في آن واحد، وأذكر هنا بعض الشواهد المعبـّرة:
– حدثني الشيخ محمود اللافي[34] –رحمه الله– أنه قدم من الرمادي إلى الشيخ عبد العزيز السامرائي في الفلوجة ليسأله عن جماعة الإخوان المسلمين التي تكونت قريبا في الرمادي وبدأ نشاطها يظهر في أوساط الشباب، فقال له الشيخ: “ابعثوا أولادكم معهم أفضل من أن يذهبوا مع البعثيين والشيوعيين أما أنتم فلا! لأني لا أريد الشيخ متحزبا لأي جهة، أريد الجامع يبقى جامعا لكل المسلمين” وفي هذا يقول الدكتور خالد الصالح: “كان –رحمه الله– غير متعصب لجماعة، بل كان يسلك الطريق الذي لا يفرّق بين الناس، لا يفرق بين طريقة وأخرى مادامت كل الطرق تؤدي إلى الله، وكذلك لم يكن يفرض على صوفي أو سلفي، بل يتكلم لجمع الكلمة” وحتى حينما كأن يأتي بعض الدعاة من جماعة التبليغ “كان يخرج معهم يبيت الليالي خارج مدينته ويسافر معهم إلى المحافظات الأخرى”.
– وقد حدثـني والدي أن الشيخ عبد الستار الكبيسي كان كثيرا ما يلتقي بالشيخ الصوّاف وينسق معه في بعض الأمور، مع أن الشيخ لم يكن له صلة تنظيمية بالإخوان.
– وقد رأيت الشيخ عبد الملك السعدي كيف يلتقي في مجلسه الشيخ خليل إبراهيم نده الداعية المستقل والشيخ أبو القيم الكبيسي أول سلفي عرفته الأنبار وبعض أصحاب الطرق الصوفية وبعض رجال الإخوان وكلهم يشهد له بالعلم والفضل.
لقد كانت كل تلك الصفات التي يتميز بها غالب شيوخ المدارس الدينية هي المؤهلات الحقيقية لدورهم الريادي الكبير في المجتمع.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه في مقابل هذه الصفات والتضحيات الجسام من قبل الشيخ، فإن هناك امتيازات للشيخ تقابل هذه التضحيات فعلى مستوى الطلاب كان الطلاب يسعدون بخدمة شيخهم وحبه وتقديمه على آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم ولقد رأيت الكثير من زملائي خريجي الآصفية وقد أكملوا دراساتهم النظامية في الجامعات وحصلوا على الشهادات العليا وقد تتلمذوا في هذه الجامعات على أساتذة مرموقين لكنهم لا يقدّمون أحدا من هؤلاء على شيخهم الأول ولم أر واحدا منهم يقبل يد واحد من أساتذته الجامعيين لكنه حينما يرى شيخه يسارع إلى تقبيل يده ويقف أمامه مطرقا ويكلمه بصوت منخفض.
أما على مستوى البيئة الحاضنة، فقد كانت هذه البيئة تعترف للشيخ بدوره القيادي وتتعامل معه على هذا الأساس، فتوفر له كل ما يحتاج من دعم مادي ومعنوي وحماية قد تتطلب قدرا من التضحية، ويذكر أهل الفلوجه –كمثال على هذا– حين اعتقل البعثيون الشيخ عبد العزيز السامرائي كيف خرجوا في الشوارع وحول المركز الأمني حتى اضطرت الحكومة للإفراج عنه، ويذكر الدكتور عبد الستار الهيتي أن أهالي الفلوجة هم الذين ضغطوا على حكومة البعث لتخفيف الحكم على والده من الإعدام إلى السجن لمدة ثلاث سنوات بعد أحداث الفلوجة المعروفة في 1973م[35]، وقد ذكر لي والدي أن أهالي كبيسة كانوا يتناوبون على حماية الشيخ عبد الستار أيام عبد الكريم قاسم حيث عاث الشيوعيون فسادا في العراق وكان الشيخ عبد الستار يواجههم ويتصدى لهم في كل مناسبة رغم ما عرف عنهم من وحشية قل نظيرها في تاريخ البشرية، حيث كانوا يسحبون الجثث بالحبال في الشوارع العامة، مع شذوذ في الأفكار نجملها بشعاراتهم التي يرفعونها في مناسباتهم (لا عروبة ولا إسلام نحن أنصار السلام) و(ما كو مهر بس هالشهر) وفي مدينة هيت المحافظة والقريبة من كبيسة كان الشيوعيون يهتفون (هيت قطعة من السوفيت) وكان الشيخ عبد الستار وكذلك زملاؤه في هيت و الفلوجة والرمادي يتصدون لهؤلاء ويصدرون البيانات والفتاوى الصريحة بشأنهم.
وللأمانة المنهجية فإن هذه البيئة لم تكن بمستوى واحد في مواقفها وإنما هي تخضع للظروف والتجاذبات المختلفة، فحينما كان النظام السياسي في العراق غير مستقر ولا يمتلك القبضة الأمنية على البلاد كان الناس أقدر على التعبير عن حبهم وولائهم ودفاعهم عن “الشيخ” لكن هذا التعبير يضعف إلى حد ما حين يستقر النظام كما حصل أيام صدام حسين الذي حكم البلاد لفترة طويلة مكنته من مسك الأمور بيد حديدية.
مكنته من إصدار قرارات مست بشكل صارخ هيبة المدرسة وشيوخها فعزل الكثير من شيوخ هذه المدارس وقلّص سنوات الدراسة حيث أوصلها في النهاية إلى ثلاث سنوات بعد أن كانت اثنتي عشرة سنة!! ولم يتمكن الناس من مجابهة هذه القرارات بطريقة عملية، وفي تقديري لو حصلت مثل هذه القرارات أيام الحكومات السابقة لوقف الناس موقفا آخر، وأذكر في هذا السياق لطيفة أنه حين تم اعتقال شيخنا الكبير الشيخ عبد الملك السعدي وأخيه الشيخ عبد القادر وكان ذلك سنة 1979 وتعرضا للتعذيب الجسدي والنفسي حتى كسرت يد الشيخ عبد الملك وكان الناس يسمعون بهذه الأخبار ويجتمعون هنا وهناك في المساجد والبيوت بعيدا عن أعين رجالات الأمن وتنفض أغلب هذه الاجتماعات عن حيرة وتردد حتى يقوم أحد المشايخ فيخبر المجتمعين أن فضيلة الشيخ عبد الملك قد أوصى وهو في الزنزانة بالصبر وعدم التحرك خشية من الفتنة الأكبر، فيجد الناس بهذا الخبر أن ذمتهم تجاه الشيخ قد برئت!! وحينها كنت شابا شديد الحماس فكنت أكتب بخط يدي يوميا على بعض قاعات الدراسة بشكل واضح :
لهفي على تلك المنابر إذ خلت من عبقرية أبلغ الخطباء
أمضى من السيف الصقيل لسانه وبيانه بالحجة العصماء
فكان طلاب الشيخ يرتاحون بعض الشيء دون معرفة الكاتب، وكنت في معاناة من البعثيين الذين يبادرون بمحو هذه الأبيات لأعيد كتابتها في اليوم الثاني، ويأخذون نماذج من كتابات الطلبة لفحصها في الأجهزة الأمنية لكن الله سلم!! وأجرأ من هذا حين تمكنا من إعلان الإضراب الشامل في المدرسة فأغلقت كل القاعات –فور سماعنا بقرار الحكومة بعزل الشيخ عبد الملك عن المدرسة– وسرنا فيما يشبه التظاهرة من ساحة المدرسة باتجاه مبنى مديرية التربية في محافظة الأنبار، وقد استجاب كل الطلاب بلا استثناء لهذا الإضراب وكان من أبرز الداعين له والمحرضين عليه فضيلة الشيخ عبد الجليل إبراهيم الفهداوي[36] نائب الأمين العام الحالي لمجلس علماء العراق.
لقد أحببت أن أضع بين يدي المشروع نماذج واقعية نقرأ من خلالها مكانة الشيخ وهيبته وصلته بطلابه[37] ومحيطه الأوسع والصفات الذاتية التي أهلته لكل ذلك، ثم بعد هذا أعرج على بعض الانتقادات التي وجّهت لشيوخ الآصفية والتي ربما سجلها الباحث من خلال تجربته الشخصية، وهذا ما تتطلبه الأمانة العلمية للوصول إلى النتائج الأقرب للصواب، وذلك من خلال الملاحظات الآتية:
الملاحظة الأولى: في الجانب العلمي ونجملها في الآتي :
- مع كثرة ما يحفظ شيوخ هذه المدارس من المتون في مختلف الفنون إلا أنهم لم يكونوا يحفظون القرآن الكريم! وربما نصلي خلف أحدهم دهرا طويلا فلا يقرأ إلا ببعض السور التي كان يكررها، وقد سمعت من الشيخ عبد الكريم بيارة –رحمه الله– قال: “والله أنا ندمت أني لم أحفظ القرآن الكريم مع أن حفظه كان أسهل كثيرا من الكتب التي حفظتها”، وما يقال عن القرآن يقال عن السنة حيث لم يكن هناك اهتمام بحفظها إلا ما يتعلق بأحاديث الأخلاق والرقائق حيث يستشهد بها في دروس الوعظ العامة، وربما كانت لهم في هذا فلسفة ستأتينا لاحقا في المنهج، لكن هذا ولّد إرباكا عند العامة بعد ظهور تيارات الإخوان والسلفية حيث أصبح الكثير من شبابهم يحفظون القرآن بشكل خاص وشيئا من السنة، مما سجّل فراغا في أذهان العامة عن الشيوخ ومكانتهم بشكل عام.
- البعد عن الثقافات المعاصرة خاصة في جانب السياسة، وربما كان هذا مبررا بوجود المرجعية السياسية المتمثلة بالخلافة، لكن بعد سقوط الخلافة أحس المسلمون بالفراغ الكبير الذي لم تتمكن هذه المدارس من ملئه، ونحو هذا موقف الشيوخ من تعلم اللغات الأجنبية، فأنا لا أعرف واحدا منهم يتقن لغة أجنبية واحدة، بل كانوا يعدّون تعلم الإنجليزية مثلا نوعا من الاستسلام للغزو الثقافي، وأذكر مرة كان بيدي كتاب في اللغة الانجليزية فرآه شيخنا الشيخ جمال شاكر النزّال فأخذه مني ورماه وقال: لا يشغلك الانجليزي عن العلم! وللأمانة فربما كان هذا الموقف المتشدد يعبر عن ردة فعل لما كانت تتعرض له المدارس الدينية من ضغط مباشر من قبل الحكومات العلمانية لتغيير مناهجها وحرف مسيرتها، وكان مقرر الإنجليزية الذي فرضته الحكومة عنوانا بارزا على هذا الضغط.
الملاحظة الثانية : في الجانب التربوي، ونجملها في النقطتين الآتيتين :
- قسوة التعامل مع الطلاب في بعض المجالات المحددة[38]، وكانت هذه القسوة منسجمة ربما مع ما وصفه الدكتور خالد الصالح عن نظام المدرسة بقوله :”إن الطالب فيها يتفرغ تفرغا تاما ويعد إعدادا شبه عسكري”[39] لقد كانت هذه العسكرية تستدعي قدرا كبيرا من الانضباط –وسيأتينا هذا في المنهج– لكن هناك سلبيات كبيرة في التطبيق وعلى سبيل المثال : فقد كان الشيخ عبد العزيز لا يسمح لطالب العلم باصطحاب الراديو أو سماعه ، والطالب الذي يضبط متلبسا قد يتعرض لعقوبة الطرد من المدرسة، وقد ذكر لي أخي الشيخ مكي الكبيسي أن الشيوخ (المعيدين) في مدرسة كبيسة كالشيخ محمود مجيد سعود والشيخ صادق عبيد بندر والشيخ شاكر جمعة بكري كانوا يمنعونه وأقرانه من قراءة حتى المجلات الإسلامية في حين كانوا هم أنفسهم يشتركون فيها ويداومون على قراءتها، وربما يكون هذا مقصودا في المراحل الأولى لطلب العلم، وأذكر من تجربتي أننا خرجنا يوم الخميس بعد العصر –وكان هذا الوقت إجازة للمدرسة– لنلعب كرة القدم في أرض فلاة خارج الفلوجة لا يرانا أحد، ففوجئنا بالشيخ إبراهيم الهيتي يتبعنا فنظر إلينا بغضب فارتجفنا فرقا لكنه اكتفى بأخذ أبنائه (محمد وأحمد ومحمود) على ما أذكر فضربهم وانتهرهم قائلا: “أنا سجلتكم بالعلم حتى تتعلموا لا لتلعبوا”[40]، وربما اكتفى الشيخ ذلك اليوم بمعاقبة أبنائه لأنه كان في ذلك الوقت مبعدا من المدرسة بقرار من الحكومة.
ولكن كل هذا لم يؤثر على ولاء الطلاب وحبهم لشيوخهم، وأذكر هنا الشيخ مكي حسين الكبيسي الذي كان يشكو من أسلوب معاملة الشيوخ له ولأقرانه لما توفي شيخ الآصفية الشيخ عبد العزيز رثاه بقصيدة طويلة ومبكية جاء فيها:
ماذا فعلت بقلبي أيهــا الناعي أدميته إذ نعيت العالم الواعي
عبد العزيز الذي أهدى لأمتـه نورا يشع عليها أي إشعاع[41]
- التشدد في معاملة الأتباع والمؤيدين خاصة ثم العامة ، خاصة لما يتعلق الأمر بمعالم الهوية، فلقد كان الشيخ عبد العزيز شديد النكير لمن يراه يلبس ملابس (الأوربيين) أو يقلدهم في أسلوب حياتهم، حتى بالنسبة للأطفال كان ينكر على آبائهم بجهرة وقوة أمام الحضور، وأهل الفلوجة يعرفون هذه الشدة من الشيخ، أما بعد ظهور (التليفزيون) فقد كان شيوخ الآصفية يحذرون منه على المنابر، وكان بعض الشيوخ لا يدخلون البيت الذي فيه تليفزيون، ويسمونه (المفسديون)، ولقد كان كل هذا من وجهة نظري سدا لمنافذ الغزو المكثف الذي تعرضت له الأمة إبان سقوط الخلافة.
يجدر التنويه هنا أن هناك صنفين من الشيوخ في المدرسة غير مصطلح (الشيخ) الذي أفردناه بهذا الفصل وهما:
أولا– الشيخ المساعد (المعيد)[42]: وهو الطالب المتقدم الذي ينتدبه الشيخ لمساعدته في تدريس المراحل الأدنى لتفوقه وثقة الشيخ به، وأظهر مثال على هذا الشيخ عبد الملك السعدي الذي كان طالبا في الآصفية وهو بنفس الوقت مكلف من قبل الشيخ بتدريس الطلاب من المراحل الأدنى، وقد حدثني الشيخ حارث سليمان الضاري أنه طيلة فترة دراسته في الآصفية لم يأخذ العلم عن الشيخ عبد العزيز وإنما الذي تولى تدريسه الشيخ عبد الملك، وقد سالت الشيخ عبد الملك في زيارتي له في عمان فأكد لي هذا إلا أنه أضاف أنه مارس التدريس كمعيد قبل تخرجه ثم انتدبه الشيخ بعد تخرجه ليدرس معه في نفس المدرسة وبعد ذلك ذهب إلى الرمادي ليؤسس مدرستها الدينية.
ثانيا– الشيخ المربي: وهو الذي يتولى الإشراف على تربية الطلاب تربية روحية خالصة ، وليس له دور في الدروس العلمية ، ومثال هذا الشيخ محمد الفياض الكبيسي[43] الذي كان يربي طلاب الآصفية على كل معاني الإحسان والزهد والتجرد وأعمال الآخرة، وكان يؤثر فيمن حوله بحاله قبل مقاله، وكان يحظى بدعم شيخ الآصفية حتى أن الشيخ عبد الملك ذكر لي أنهم ربما يكونون في الدرس العلمي فيدخل الشيخ محمد الفياض فيقطع الشيخ عبد العزيز الدرس ويقول للطلاب: اسمعوا للحاج محمد الفياض، وحين توفي الحاج محمد الفياض تولى هذه المهمة نجله المربي الشيخ خليل الفياض إضافة إلى مهمته في التدريس، ثم قم بهذا الدور الشيخ عبد الله الحديد العيساوي، ولا يفوتني هنا دور الشيخ هشام الآلوسي الذي كان مقيما في الآصفية صباح مساء وكان دوره الأساس بث روح الحماس في طلاب العلم وتقوية الجانب الروحي عندهم، وبمثل هذا الدور كان يقوم الحاج حمدان رويجع الكبيسي في مدرسة كبيسة، وكأن هذا منهجا متبعا في الآصفية وفروعها.
إن شيوخ الآصفية لم يكن ينقصهم الجانب الروحي بل كانوا بحق مثالا يحتذى به -وهذه شهادتي فيهم– إلا أنهم لفرط تواضعهم وتجردهم كانوا يكلون هذا الجانب لغيرهم من أهل الخير والصلاح، وربما يكون في هذا حكمة أخرى: أن الشيخ المربي لا تقع بينه وبين الطالب أي مشكلة بسبب الدرجات أو النظام الإداري لأنه ليس له علاقة بهذه الأمور، فيكون كلامه في التقوى ومعاني الإحسان مقبولا أكثر عند الطلاب.
الفصل الرابع : المتعلم
لا ريب أن المتعلم هو المحور الأساس في العملية التربوية، فالشيخ والمنهج موجودان أصلا لتحقيق غاية في هذا المتعلم، إلا أن حديثنا عن الشيخ قد تضمن الحديث عن المتعلم، لأن كثيرا من شيوخ الآصفية كانوا طلابا فيها، فهم نماذج ناجحة ومتميزة لطلاب الآصفية، كما أن الفصل الأخير المتعلق بالنظام والمنهج سيتناول بعض الجوانب ذات الصلة بهذا الفصل ولذا سنختصر الحديث هنا عن المتعلم من خلال الجوانب الآتية:
أولا – الشروط والمؤهلات:
ربما سنتناول شروط القبول في الفصل الأخير (النظام والمنهج) ونكتفي هنا ببيان صفات طلاب الآصفية من حيث الواقع وكما يأتي :
- حسن السمعة[44]، فلم تكن المدرسة تقبل أي متقدم لها إلا إذا كان من أسرة معروفة، وله سمعة طيبة في بيئته، وكثيرا ما كان يحدث أن الأب كان شديد الحرص على قبول ابنه في المدرسة لكن المدرسة ترفض لمعلومات تصلها عن ابنه، وأذكر هنا رجلا من أهل الفلوجة الملازمين لصلاة الجماعة والمقربين من الشيخ نفسه وقد حاول جاهدا أن يقدم لابنه في المدرسة لكن المدرسة رفضت وبشكل قاطع لأن ولده لم يحظ بتزكية من جيرانه فقد كان مراهقا نزقا، وقد قال لي والده أنا أعرف ابني لكن تمنيت أن يصلحه الله معكم! والجميل أن الأب لم يأخذ موقفا من المدرسة ولا من شيخها.
إلا أن هذا الشرط لم يكن منضبطا في كل الأحوال، فقد حصل بعض الخرق في حالة المتقدمين للمدرسة من مناطق بعيدة، التي تنتشر فيها الأمية، وكان بعض الشيوخ يتنازل عن الصيغة المطلوبة في هذا الشرط رغبة بالانفتاح على هذه المناطق التي كانت بحاجة إلى من يقيم فيها الصلاة ويعلمها قواعد الدين الأولى، ولقد تحقق بعض هذا فانتشرت في تلك المناطق المساجد التي يديرها أبناء المناطق هذه أنفسهم، لكن كان بالجانب الآخر سلبيات داخل المدرسة نفسها، حيث لم يكن هؤلاء الطلاب قادرين على الحفاظ على سمت المدرسة وأدبياتها الروحية والأخلاقية، مع أن هذا النوع من الطلاب قد أخفق في إكمال الدراسة وانسحب من المدرسة أو أبعد منها.
- القدرة على التعلم، حيث كان المتقدم يلزم بالمكوث في المدرسة لشهرين أو ثلاثة أشهر قبل البت بقبوله، وكان يتعلم في هذه الفترة قراءة القرآن الكريم والمبادئ الأولية للمدرسة، وهذه كانت مرحلة اختبار كافية للحكم على الطالب بالقبول أو الرفض.
- التعهد بالخضوع لنظام المدرسة الصارم –والذي سيأتينا في الفصل القادم إن شاء الله– هذه هي الشروط التي كانت تشترطها المدرسة للمتقدمين، ثم أضيفت شروط أخرى أملتها سياسات التعليم في الدولة وتعد بمثابة سبل الدولة في محاولاتها لوضع يدها على المدرسة، وكان من هذه الشروط أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الابتدائية من المدارس الرسمية، وتبع هذا اشتراط سن معينة في المتقدم.
ثانيا- المتعلم والبيئة:
رأينا آنفا كيف أن البيئة لها دور في قبول الطالب، فما لم يكن الطالب مقبولا في بيئته لا يمكن أن يكون مقبولا في هذه المدرسة ، ونضيف بعد هذا :
- الصلة الوثيقة بين الأسرة والمدرسة ، فقد كان الأب ثم الإخوة الكبار في الأسرة يتابعون ابنهم في المدرسة متابعة شبه يومية خاصة من الآباء الملازمين للصلاة في مسجد المدرسة، وأما البعيدون فقد كانوا يحرصون على الحضور في المدرسة أسبوعيا، وأستطيع الجزم أن بعض الآباء كانوا كأنهم موظفون في المدرسة لحضورهم اليومي واهتماماتهم التفصيلية! ولم يكن الوالد فقط يقوم بهذا الدور فكان بعض الأحيان العم والخال وربما الجار أيضا، وهذا يعكس مدى اهتمام البيئة بهؤلاء الطلاب.
- وقد انعكس هذا الاهتمام في نقطة رأيت أن أفردها لأهميتها، وهي أن كثيرا من الطلاب كانت تربطهم روابط أسرية، فقد كانت الأسرة تقدم كل أولادها أو أكثرهم للمدرسة ويكون الأخ الأكبر بمثابة الأب لإخوانه داخل المدرسة، ويحسن أن نأخذ بعض النماذج :
- أسرة الحاج عبيد الكبيسي حيث كان أولاده الشيخ الدكتور حمد عبيد والشيخ الدكتور أحمد عبيد من تلاميذ المدرسة وتبعهم شقيقهم الثالث على طريق العلم وهو الدكتور محمد عبيد عميد كلية العلوم الإسلامية /جامعة بغداد الحالي.
- أسرة الحاج عبد الرحمن السعدي حيث كان كل أولاده من خريجي المدرسة وهم الشيخ الدكتور عبد الملك والشيخ الدكتور عبد العليم والشيخ الدكتور عبد الحكيم والشيخ الدكتور عبد الرزاق والشيخ الدكتور عبد القادر والشيخ الدكتور عبد الله، وكل هؤلاء علماء وأساتذة جامعات ، وقد سار على نهجهم غالب أولادهم.
- آل الفياض، وهي أسرة كبيرة قد ضمت عددا من طلاب المدرسة مثل : الشيخ خليل الفياض والشيخ يحيى الفياض والشيخ أيوب الفياض والشيخ ذا النون الفياض والشيخ عبد المنعم الفياض والشيخ الدكتور عبد العزيز الفياض والدكتور سامي الفياض وآخرون.
- أسرة الحاج رحيم الهيتي وقد ضمت عددا من طلاب المدرسة ومنهم الشيخ إبراهيم الهيتي وشقيقاه الشيخ الدكتور عبد القادر و الشيخ الدكتور عبد الرزاق، وأبناؤه وهم الشيخ الدكتور عبد الستار والشيخ محمد نبهان والشيخ أحمد والشيخ محمود.
- آل الشامي الكبيسي وقد ضمت الشيخ عبد الله حسين والشيخ الدكتور مكي حسين والشيخ زاهد محيسن، الشيخ فاضل كرينص.
- أسرة الحاج عبد العزيز العاني، وقد ضمت الأشقاء الشيخ الدكتور محمود والشيخ الدكتور عمر والشيخ أحمد والشيخ محمد والشيخ حسن والشيخ حمزة.
- آل الوليد وقد ضمت الدكتور فرج توفيق، والشيخ عيادة أمين، والشيخ ياسين محمد سعيد، والشيخ حامد عبد الهادي ،والشيخ الدكتور صلاح عواد جمعة والشيخ الدكتور أحمد عواد جمعة والشيخ محمد سبتي جمعة.
- أسرة الحاج عبطان العيساوي وقد ضمت الأشقاء الدكتور عبد الحميد عبطان والشيخ أحمد عبطان والشيخ محمد عبطان.
- أسرة الحاج جمعة بكري الكبيسي وقد تخرج منها الشيخ شاكر جمعة أحد الأئمة والخطباء المشهورين بغداد، وشقيقه الشيخ عارف جمعة.
- وربما شمل هذا النسق حتى الطلاب القادمين من خارج العراق كالشقيقين الشيخ الدكتور عبد السميع الأنيس الحلبي والشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس.[45]
- إن هذه النماذج تبين لنا مدى رعاية هذه الأسر المسلمة للآصفية ، بالرغم مما كان يعانيه طلاب المدرسة وخريجوها من تحديات نتيجة للظروف السياسية العصيبة التي مر بها العراق، إن هذه الأسر الكريمة هي التي جعلت المدرسة تقف على أقدامها في تلك الظروف الصعبة، كما أن هذا الجو الأسري داخل المدرسة أعطى للمدرسة مكانة متميزة في ذلك المجتمع الإسلامي المحافظ.
- البيئة هي مجال التدريب للطلاب على مختلف المهارات ذات الصلة، ومنها:
- ممارسة الإمامة في المساجد القريبة من المدرسة، وممارسة الخطابة في المحيط الأوسع، حيث كان الشيخ يبعث بالطلاب ليغطي كل المساجد التي لم يعين فيها خطباء رسميون، وكانت هذه الحاجة قائمة مع التوسع الكبير في بناء المساجد على يد الشيخ عبد العزيز وتلامذته، وكانت غالب هذه المساجد تبنى من أموال المتبرعين من أهل الخير.
- إلقاء المحاضرات ودروس الوعظ الأسبوعية إلا في رمضان فقد كانت يوميا ، وكان غالب طلاب المدرسة يشاركون في هذا النشاط.
- الصلاة على الأموات والمشاركة في العزاء وتقديم النصح والوعظ في هذه المناسبات.
- عقد القران الشرعي، حيث كان الناس لا يكتفون بعقد الزواج في المحاكم الرسمية وإنما يطلبون تأكيد العقد بالصيغة الشرعية وكان الشيخ يبعث واحدا من طلابه لهذا الغرض.
- حل مسائل المواريث، حيث كانت محكمة الفلوجة تحيل هذه المعاملات إلى المدرسة الآصفية وكان الشيخ عبد الله الحديد يتصدى لهذه المهمة، وكان يكلف عددا من الطلاب لمساعدته ولتدريبهم أيضا، وكان يأمرهم أن يكتبوا أسماءهم أسفل المعاملة مع التاريخ والتوقيع، وكنت واحدا من هؤلاء الطلاب الملازمين للشيخ في هذا العمل، ومن يرجع إلى ملفات محكمة الفلوجة فسيجد أسماء كثير من طلاب الآصفية يوقعون على معاملات المواريث.
ثالثا : الناجحون والفاشلون :
حين أعود بذاكرتي إلى الوراء أتذكر كثيرا من الصور والأسماء التي مرت في أروقة الآصفية، لكن من هذه الأسماء ما اختفى من المشهد العلمي تماما فلم يعد له ذكر أو أثر، ومنها ما لازال يتمتع بحضوره المشهود في بيئته ومحيطه، فلم يكن كل طلاب الآصفية ناجحين، ومظاهر الفشل متعددة قد تبدأ بالانسحاب من هذا المشروع العلمي والتربوي واختيار وظائف وأسباب للرزق مع الحفاظ على السمت الإسلامي وآداب المدرسة، وقد تنتهي بما يشبه الردة عن المشروع ومرجعيته الدينية والثقافية بالكامل، وأكتفي هنا بذكر عوامل الفشل البارزة وهي:
- الحرب النفسية التي كانت تشنها القوى العلمانية وأحزابها المعروفة في العراق، حيث كان طالب العلم يتعرض من هؤلاء لحملات التشويه والانتقاص والاتهام بـ (الرجعية) و (التخلف)، والتخويف بضياع المستقبل حيث كانت الدولة بمركزيتها الشديدة تسير بالاتجاه المضاد لمشروع المدرسة، هذا عدا ما يتعرض له شيوخ المدرسة من اعتقال أو طرد[46].
- تمكن البعثيين من اختراق المدرسة حيث زجوا بعناصرهم داخل المدرسة وأنشؤوا مؤخرا ما عرف بـ (اتحاد الطلبة) يضم عددا من الطلبة البعثيين داخل المدرسة المفروضين بالقوة، وكان غالبهم لا يصلي! بل أستطيع الجزم أنهم كانوا أقرب إلى الإلحاد ، كانوا يستهزؤون بالصلاة والمسجد والقرآن، وينتقصون من الشيخ والمدرسة، وكانوا يمارسون مع هذا دور المخبر السري، وكان مجرد وجود هؤلاء في صفوف المدرسة يضعف من مكانة المدرسة وهيبتها في نفوس العامة.
- التساهل في بعض الشروط رغبة في حل مشكلة نقص الدعاة في الأرياف والمناطق النائية، حيث قبلت المدرسة في بعض السنوات الأخيرة طلابا لا يمتلكون الرؤية ولا الأسس التربوية التي يتميز بها طلاب الآصفية، وغالب هؤلاء تسربوا خارج المدرسة ولم يتمكنوا من مواصلة المسير، بعد أن أرهقوا المدرسة بجهود تعليمية ومتابعات مضنية، كما أنهم ساهموا في تخفيض مستوى الدرس أو (الحلقة العلمية).
- تعرض المدرسة في السنوات الأخيرة لما يمكن أن نصفه بـ (عدم الاستقرار) في كل شي، حيث كانت الحكومة تحاول أن تغير كل شيء في المدرسة (المعلم والمتعلم والنظام والمنهج)بينما تحاول المدرسة أن تحتفظ بثوابتها وفي هذا الصراع تغير اسم المدرسة ومكانها ونظامها[47] طرد كثير من شيوخها، ثم يحاول الشيوخ أن يجدوا صيغا أخرى رسمية وغير رسمية للتواصل مع طلابهم ، فابتكرت مثلا في تلك الظروف الدروس الخاصة التي لا تخضع لنظام المدرسة الرسمي، فأصبح عندنا نموذجان من الطلاب نموذج يكتفي بالمساقات الرسمية وغالب هؤلاء لم يكتب لهم النجاح فتسربوا إلى تخصصات ووظائف أخرى، ونموذج يتابع شيوخه ومربيه داخل المدرسة وخارجها ويتواصل معهم لإكمال المناهج العلمية وقد قدر الله لهؤلاء النجاح والتفوق في كل شيء والحمد لله.
رابعا – التواصل مع برامج التعليم المعاصر :
جدير بالذكر هنا أن كثيرا من طلاب الآصفية قد تمكنوا من مواصلة التعليم في الجامعات وتمكنوا من تحقيق تفوق شاخص على زملائهم من خريجي المدارس الرسمية ، والمعيار المنضبط في هذا أن غالب الذين واصلوا الدراسات العليا في تخصصات العلوم الإسلامية هم من خريجي الآصفية وشقيقاتها المدارس الأصيلة الأخرى، فكل الأسماء اللامعة من الأساتذة العراقيين في الجامعات العراقية والعربية في التخصصات الإسلامية هم من هذه المدارس، في حين هؤلاء لم يكونوا يشكلون من مجموع طلاب الجامعات الإسلامية في العراق إلا الأقل من الثلث أو الربع، وهذا مؤشر واضح على تفوق مخرجات التعليم الأصيل حتى في مساقات التعليم المعاصر وأدوات التقويم فيه وستمر بنا بعض النماذج والشواهد على هذا.
خامسا – الإنتاج العلمي :
يصعب على الباحث هنا أن يسرد كل المنتج العلمي لطلاب الآصفية، وبعملية حسابية مبسطة إذا افترضنا أننا نتمكن من متابعة المنتج العلمي لمائة طالب فقط وإذا افترضنا أن لكل طالب ثلاثة منتجات فقط فنحن أمام ثلاثمائة منتج، مع أن المنتج الحقيقي هو أكبر من هذا الرقم بكثير ، ولذلك سأكتفي بذكر نماذج من العلوم والفنون المختلفة وكالآتي :
- علوم القرآن والتفسير:
- المنتهى في علوم القرآن، د / فرج توفيق الوليد.
- فقه القرآن وخصائصه، د/ فرج توفيق الوليد.
- التأويل الباطني للقرآن الكريم، د/ خليل رجب الكبيسي.
- التفسير الإشاري ماهيته وضوابطه، د/مشعان سعود العيساوي.
- أبي بن كعب ومكانته من مفسري الصحابة، د/مشعان سعود العيساوي.
- آيات الأمن في القرآن الكريم، د/عبد السلام داود الكبيسي.
- آيات خلق الإنسان في القرآن الكريم، د/عبد الكريم عبد الحميد القيسي.
- تصوير القرآن للمجتمع الجاهلي، د/موفق عبد الرزاق الدليمي.
- وجوه التناسب بين سور القرآن الكريم، أنس عبد العليم السعدي.
- قرآن ربك أيها المسلم، د/عبد العليم عبد الرحمن السعدي.
- آيات الأحكام المتعلقة بالنساء، الشيخ عبد الله الجنابي.
- التفسير الحديث للأستاذ محمد عزة دروزة، دراسة تحليلية، د/عبد الحكيم الأنيس الحلبي.
- علوم السنة النبوية :
- الإمام الزهري وأثره في السنة، د/حارث سليمان الضاري.
- الأحاديث التي سكت عنها الترمذي في جامعه، د/عبد الحميد العاني.
- وصل مرسلات الإمام الشافعي في كتابه الأم، د/أحمد عواد جمعة الكبيسي
- التعارض بين الأحاديث وكيفية دفعه عند المحدثين، د/حارث الضاري.
- السنة النبوية ودراستها بين الماضي والحاضر، د/طه جابر العلواني.
- السنة النبوية ونقد المتون، د/طه جابر العلواني.
- صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، د/عيادة أيوب الكبيسي.
- الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح، د/عبد العزيز شاكر الكبيسي.
9-الإمام يحيى بن معين ومكانته بين علماء الجرح والتعديل، د/أحمد عواد الكبيسي.
10 – الحافظ السخاوي ومنهجه في فتح المغيث، د/عبد السميع الأنيس
- علم العقيدة:
- شرح النسفية في العقيدة الإسلامية، د/عبد الملك عبد الرحمن السعدي
- .فعال العباد بين الجبر والاختيار، د/عبد الملك عبد الرحمن السعدي.
- العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم ومناهج المتكلمين، د/محمد عياش الكبيسي.
- الصفات الخبرية عند أهل السنة والجماعة، د/محمد عياش الكبيسي.
- الإيمان ماهيته وحقيقته عند المتكلمين، الشيخ علي حسين العيساوي.
- عقيدتك أيها المسلم، د/عبد العليم السعدي.
- منهج إمام الحرمين الجويني في الصفات، د/محمد عياش الكبيسي.
- آراء ابن حجر العسقلاني في الإلهيات، د/إحسان لطيف الدوري.
- عقيدة القدر وآثرها العملية، د/محمد عياش الكبيسي.
- الإلهيات والنبوات والسمعيات، د/فرج توفيق الوليد.
- العقيدة الإسلامية في مواجهة التنصير، د/عبد الجليل الفهداوي.
- أصول الفقه :
- أصول الأحكام وطرق الاستنباط، د/ حمد عبيد الكبيسي.
- الدلالات عند الأصوليين، د/عبد الملك السعدي.
- القواعد الفقهية والأصولية، د/عبد الملك السعدي.
- الاجتهاد والتقليد في الإسلام،د/طه جابر العلواني.
- أدب الاختلاف في الإسلام، د/طه جابر العلواني.
- مباحث العلة في القياس عند الأصوليين، د/عبد الحكيم السعدي.
- أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية، د/عبد القادر السعدي.
- الشاطبي ومنهجه في مقاصد الشريعة، د/بشير مهدي الكبيسي.
- النسخ عند الأصوليين، د/أحمد عبطان العيساوي.
- الفقه :
- فقه سعيد بن المسيب ( 4 مجلدات )، د/هاشم جميل عبد الله.
- مسائل في الفقه المقارن، د هاشم جميل عبد الله.
- السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية، د/أحمد عبيد الكبيسي.
- الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، د/أحمد عبيد الكبيسي
- فقه الزكاة و مستجداتها المعاصرة، د/عبد الملك السعدي.
- العلاقات الجنسية غير الشرعية، د/عبد الملك السعدي.
- أحكام المعاهدات في الفقه الإسلامي، د/إسماعيل كاظم العيساوي.
- أحكام العيب في الفقه الإسلامي، د/إسماعيل كاظم العيساوي.
- كيفية استيفاء العقوبات في الفقه الإسلامي، د/مجيد صالح الكرطاني
- الشريعة الإسلامية ومدى مصدريتها للقانون، د/حمد عبيد الكبيسي.
- الاقتصاد الإسلامي:
- المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، د/عبد الرزاق رحيم الهيتي.
- مساهمات الإمام الغزالي في الفكر الاقتصادي الإسلامي، د/عبد الرزاق الهيتي.
- السياسة السعرية في المذهب الاقتصادي الإسلامي، د/عبد الستار إبراهيم الهيتي.
- الاستهلاك وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي، د/عبد الستار الهيتي.
- العلاقات الاقتصادية الدولية في الفقه الإسلامي، د/عمر عبد العزيز العاني.
- الرقابة في الاقتصاد الإسلامي، د/عمر عبد العزيز العاني.
- الحاجات الاقتصادية في المذهب الاقتصادي الإسلامي، د/أحمد عواد محمد الكبيسي
- ضوابط استخدام الموارد البشرية في الاقتصاد الإسلامي وآثارها في التنمية، د/كامل صكر القيسي.
- التأمين في ضوء الفقه الإسلامي، د/إسماعيل عبد الرزاق الهيتي.
- اللغة العربية :
- إزالة القيود عن ألفاظ المقصود، د/عبد الملك السعدي.
- البيان والإيضاح لفهم متن مراح الأرواح في الصرف، د/عبد الملك السعدي.
- أثر حروف الجر في ألفاظ الطلاق، د/عبد الله السعدي.
- شرح مقصورة ابن دريد، الشيخ حامد محمد سرحان العبدلي.
- إعراب شواهد ابن يعيش على المفصل، الشيخ حامد محمد سرحان العبدلي.
- القرطبي وجهوده في النحو واللغة، د/عبد القادر رحيم الهيتي.
- البحث النحوي واللغوي عند علم الدين السخاوي، د حامد فرحان الفهداوي[48]
إن هذه النماذج التي لا تشكل إلا نسبة ضئيلة من المنتج العلمي لخريجي الآصفية لتؤكد عدة حقائق منها:
- النجاح الكبير لمنهج التعليم في الآصفية، حيث أن المقياس الأدق لنجاح أي مؤسسة علمية إنما هو المخرجات الواقعية، ونذكر هنا أن لهؤلاء الخريجين زملاء أكثر منهم وقد تخرجوا من الجامعات نفسها التي تخرّج منها هؤلاء، لكنهم لم يلحقوا بهم وما ذلك إلا لسبب واحد وهو الفارق في التعليم الأولي.
- التنوع الكبير في الاختصاصات وهذا يؤكد أن الآصفية مدرسة حقيقية فيها رؤية علمية شاملة ومتوازنة إلى حد ما.
- قدرة طلاب الآصفية على مواكبة العصر وربما أكثر بكثير من خريجي التعليم المعاصر، وأنا أتكلم هنا عن المجال الشرعي فقط، حيث أن خريجي الجامعات الإسلامية العراقية الذين لم تتح لهم فرصة التعلم في المدارس الأصيلة لم يتمكنوا من مواكبة التطورات العلمية والثقافية ذات الصلة باختصاصاتهم.
- وأخيرا فإن الناظر في عناوين هذه المؤلفات يجد فيها لغة مشتركة وسمتا واحدا وهذا يعكس روح الأخوة والزمالة بين خريجي الآصفية والتواصل العلمي فيما بينهم، إضافة غلى التأثر المشترك بسمت الآصفية نفسها.
سادسا – المجال الوظيفي وخدمة المجتمع:
سبق أن تطرقنا إلى دور الآصفية في قيادة المجتمع، وحمايته من الغزو الثقافي، وتأسيس المشاريع العلمية والدعوية وحتى الجهادية (في ظروف الاحتلال الحالي)،
وسأكتفي هنا بذكر نماذج من خريجي الآصفية الذين يمارسون الدعوة إلى الله من خلال المساجد، أما الجامعات والمدارس فإن كل الذين مروا بنا في النقطة السابقة هم في الغالب أساتذة جامعات، وكثير منهم يجمع بين عمله في الجامعة وعمله في المسجد، ومنهم من يعمل في جامعات عربية وإسلامية خارج العراق، في الإمارات وقطر والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية والأردن وليبيا واليمن وماليزيا وغيرها، أما الدعاة الذين يعملون من خلال المساجد داخل العراق فنذكر منهم النماذج الآتية :
- الشيخ خليل محمد الفياض: وهو من أشهر الدعاة المصلحين في الفلوجة، عرف بالورع وحبه للمساكين، قام بتوسيع بيته وتحويله إلى مسجد كبير يضم مكتبة وقاعات للدرس وغرفة الضيافة إضافة إلى مكتبه الخاص، وهو متواجد في مسجده هذا غالب الوقت.
- الشيخ حمزة عباس العيساوي: كان يسمى شافعي العصر لشدة تمكنه من المذهب الشافعي، وقد اختير مفتيا للفلوجة، كان رجلا صالحا وورعا، وقد استشهد في أحداث الفلوجة الأخيرة –رحمه الله-.
- الشيخ محمد مطلق المحمدي: أحد طلاب الشيخ عبد العزيز السامرائي، وهو محافظ على سمت المدرسة مواصل للإمامة والخطابة في مساجد الفلوجة لما يقارب الأربعين سنة.
- الشيخ جمال شاكر النزال: وهو من أشهر علماء الفلوجة وخطبائها درّس في الآصفية بطريقة كأنه موقوف لها، ولازال يمارس الدعوة والخطابة في الفلوجة وغيرها منذ ما يزيد على ثلاثين سنة، وقد عرف بغيرته الشديدة على الدين وصراحته في الحق.
- الشيخ كمال شاكر النزال: وهو شقيق الشيخ جمال، لم أر مثله تفانيا في خدمة الآصفية مع شجاعته البالغة قضى كل حياته في الدعوة والخطابة حتى استشهد في أحداث الفلوجة الأخيرة –رحمه الله-.
- الشيخ أحمد عبد وطبان الجنابي: وقد وفد إلى الآصفية من قضاء المسيب ناحية جرف الصخر من محافظة بابل، لكنه استقر في الفلوجة ولا يزال يمارس الإمامة والخطابة في مساجد الفلوجة بما يزيد عن 30 سنة، تجدر الإشارة هنا إلى أن هناك عدداً من أبناء هذه المنطقة قد وفدوا للآصفية وتخرجوا منها وحافظوا على سمت الآصفية كالشيخ عبد الله الجنابي الداعية والمجاهد المعروف الذي رأس مجلس شورى المجاهدين لمدينة الفلوجة، ومارس الخطابة فيها قرابة الثلاثين سنة، وكذلك الشيخ حامد صخي الجنابي وشقيقه حسين صخي، وآخرون.
- الشيخ توفيق شافي: الوافد إلى الآصفية من قضاء المحاويل من محافظة بابل وقد استقر في الفلوجة وعرف بتصوفه وشدة تعلقه برجالاتهم حتى أنه كتب رسالة الماجستير في السيد أحمد الرفاعي، وكتب رسالته في الدكتوراه عن محي الدين ابن عربي، وقد مارس الإمامة والخطابة في مساجد الفلوجة أكثر من ثلاثين سنة.
- الشيخ ختال مخلف العبيدي: وهو نموذج لامتداد الآصفية حيث درس على يد شيوخ الآصفية المعروفين كالشيخ عبد العزيز السامرائي والشيخ عبد الملك السعدي، لكنه آثر العمل إماما وخطيبا في محافظة ديالى أقصى الشرق العراقي.
- الشيخ صبحي خليل الهيتي: وهو من أشهر خطباء العراق، عرف بغيرته الشديدة على الدين، له مواقف مشهودة وشجاعة، جند نفسه لمقارعة المد الإيراني الذي حاول ابتلاع العراق تحت ما يسمى بـ (تصدير الثورة) إلا أنه في الوقت نفسه خسر الكثير من مؤيديه لأن موقفه هذا من إيران فسّر على أنه تقرب من حكومة البعث، وهذه هي طبيعة التجاذبات السياسية وخاصة في الساحة العراقية وإلى اليوم.
- الشيخ عبد الهادي جاسم: أحد الذين نذروا أنفسهم للدعوة في الأرياف حيث بقي إماما وخطيبا قرابة الأربعين سنة في ناحية الصقلاوية التابعة لمدينة الفلوجة.
- الشيخ عيادة أمين الوليد: أخذ العلم عن شيوخ الآصفية ثم انتقل إلى بغداد ليأخذ العلم عن علمائها المعروفين كالشيخ قاسم القيسي والشيخ أمجد الزهاوي وقد مارس الدعوة إماما وخطيبا ومعلما في محافظة ديالى و الفلوجة، إلا أنه بعد إحالته على التقاعد مارس التجارة كمصدر رزق لكنه لم ينقطع عن بيئة العلم، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد دفع بولده الشيخ صلاح الدين عيادة ليسلك مسلك العلم فانتسب إلى الآصفية بعد دراسته في المدارس النظامية ثم تخرج من الآصفية والتحق بكلية الشريعة / جامعة بغداد ولا زال يمارس الإمامة والخطابة بما يزيد عن 25 سنة ويقوم بالتدريس الطوعي في بيته أو في مساجد الفلوجة.
- الشيخ الدكتور ياسين ناصر الخطيب الكبيسي: الذي دخل الآصفية سنة 1953م ولا زال مستمرا على طريق العلم والدعوة حيث كان يخطب في جامع المسيب ثم انتقل إلى المملكة العربية السعودية ليمارس التدريس في جامعاتها الإسلامية، وهو داعية معروف بغيرته على الدين والعلم وتواضعه وخدمته لإخوانه وطلاب العلم خاصة، وقد رزقه الله بأولاد ساروا على نهجه ومنهم: الدكتور طه الخطيب المدرس في جامعة البحرين والدكتور عبد القادر الخطيبالمقيم في الرياض.
- الشيخ إبراهيم صايل الفهداوي: وهو نموذج آخر لامتداد الآصفية حيث دخلها سنة 1963 وبعد تخرجه آثر أن يقوم بمهمة الإمامة والخطابة في محافظة واسط شرق العراق، ثم رأى أن يكمل مسيرته العلمية فدخل جامعة بغداد ثم رحل إلى مصر ليحصل على الماجستير والدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من جامعة الأزهر، ثم عاد يمارس التعليم والدعوة في الجامعات والمساجد المختلفة، وبالمناسبة هنا فإن عددا كبيرا من طلاب الآصفية قد أكملوا دراساتهم العليا في جامعة الأزهر كالشيخ حارث الضاري والشيخ هاشم جميل والشيخ أحمد الكبيسي[49].
ربما أن هذه النماذج لا تشكل أي نسبة للأعداد الحقيقية لطلاب الآصفية ودورهم في هذا المجال ، لكن طبيعة هذا البحث لا تسمح بأكثر من هذا، وهناك مجالات وظيفية أخرى انخرط فيها خريجو الآصفية مثل:
- العمل في مراكز البحوث والدراسات ومثال هذا الشيخ الدكتور طه جابر العلواني الذي يدير المعهد العالمي للفكر الإسلامي، و الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس الذي يدير الآن المجلة العلمية المحكمة والمعرفة باسم (الأحمدية) والتابعة لدار البحوث للدراسات الإسلامية في دبي.
- العمل في سلك المحاماة والمحاكم الشرعية ومن أمثلة ذلك الشيخ حمد المحمدي الذي يعمل الآن في المحاكم القطرية، وكذلك الأستاذ المحامي أحمد مجيد سعود الكبيسي، تجدر الإشارة هنا إلى هناك من خريجي الآصفية من تخصص في القانون المعاصر مثل الشيخ الدكتور أحمد عبيد الكبيسي، والشيخ الدكتور عايش رجب الكبيسي وكلاهما مقيم الآن في دولة الإمارات.
- العمل في سلك الجيش كمرشد ومفت في القوات المسلحة وهؤلاء يحصلون على رتب وترقيات عسكرية وأذكر منهم الشيخ ياسين محمد سعيد الوليد، والشيخ طيب أحمد السرحان وكلاهما من أوائل طلاب الشيخ عبد العزيز السامرائي في الآصفية.
الفصل الخامس : المنهج والنظام
أولا : المنهج العلمي والمقررات الدراسية :
تنتسب المدارس الدينية الأصيلة في العراق إلى سند علمي متقارب يرجع في نهاياته إلى فقهاء الصحابة والتابعين الأوائل، كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والحسن البصري وسعيد بن المسيب -رضي الله عنهم أجمعين– ولذلك فهذه المدارس تتشابه في مناهجها، وهذا ما ساعد على المحافظة على هوية هذه المدارس وسمتها، إلا أن هناك بعض المؤثرات التي أدت بالمجمل إلى اختلاف المناهج الدراسية لهذه المدارس، وللمدرسة الواحدة في امتدادها الزمني ، ومن هذه المؤثرات :
- اجتهاد شيخ المدرسة في اختيار الكتاب المقرر، حيث يقوم بعض الشيوخ بتأليف بعض المقررات بأنفسهم كما فعل الشيخ عبد العزيز في إيضاح الأجرومية ، وإيضاح القطر[50]، وشرح العقائد النووية، وكما فعل الشيخ عبد الملك في شرح النسفية، وإزالة القيود عن ألفاظ المقصود، وقد رأيت للشيخ عبد الستار الكبيسي بعض الشروح المخطوطة على بعض المتون والتي كان يمليها على طلابه.
- تغيير بعض المقررات بما يتناسب مع ما يحتاجه الطلاب، وأذكر بهذا الصدد أن الشيخ جمال شاكر خيرنا بين دراسة الهداية في الفقه الحنفي أو دراسة المنهاج في الفقه الشافعي، وقد اختار الطلاب الثاني بحكم أنهم ينتسبون كلهم – على ما أذكر – للمذهب الشافعي في تلك المرحلة، وأذكر بهذا الصدد أيضا أننا طلبنا من الشيخ خليل الفياض أن يقرر علينا فتح المبدي بشرح مختصر الزبيدي على صحيح البخاري بدلا من الأحاديث المختارة في رياض الصالحين والتي كانت مقررة على المراحل التي قبلنا، لكن الشيخ عبد الحكيم السعدي حدثني أن الشيخ خليل الفياض كان قد درسهم فتح المبدي في المراحل السابقة، وهذا يؤكد وجود مرونة لا بأس بها في اختيار المقررات.
- تدخلات النظام الحاكم ، فبينما كانت مثلا دائرة الأوقاف في محافظة بغداد والتي كانت المرجع الإداري الرسمي للآصفية لم تكن تتدخل في البرامج والمقررات الدراسية وتكتفي برعاية الجانب الإداري وكان ذلك على عهد الشيخ حامد الملا حويش والشيخ عبد العزيز والشيخ إبراهيم الهيتي، جاءت حكومة البعث فقطعت صلة الآصفية بالأوقاف وألحقتها بوزارة التربية والتعليم وتدخلت هذه الوزارة بالمقررات الدراسية فأضافت اللغة الإنجليزية والتاريخ والجغرافية، وغيرت كل مقررات المدرسة الأخرى واستبدلتها بكتب حديثة يشرف على تأليفها لجان في الوزارة لا صلة لها بتاريخ الآصفية ومنهاجها وسمتها، إلا أن شيوخ الآصفية كانوا يدرسون مناهجهم الأصيلة إما بدون علم الوزارة أو للطلاب الذين يتوسمون فيهم الخير لكن خارج النظام التدريسي الرسمي، إلا أن هذه الحالة لم تدم سوى سنوات يسيرة ثم رجعت الآصفية بصيغة قريبة إلى حد ما بصيغتها المعهودة.
إن منهج الآصفية العام -خارج الحالة المرتبكة والشاذة التي أملتها ظروف الحكم العلماني– يمكن أن نحدد معالمه الأساسية في النقاط الآتية :
- التركيز على الكتب القديمة التي ألفها علماء معتبرون في الأمة يحظون برمزية ومهابة خاصة في ذاكرة الأمة ، وكانت تلك الكتب بمثابة الدلائل القوية على هوية الآصفية ، فمن الإمام النووي نأخذ المقاصد السبعة في العقائد والسلوك ونأخذ رياض الصالحين في الحديث ونأخذ المنهاج في الفقه ، وهكذا المقررات الأخرى كالشيبانية والسنوسية والنسفية في العقائد، وتفسير النسفي والجلالين، ومختصر صحيح البخاري ، والآجرومية والقطر ومغني اللبيب وألفية بن مالك في النحو ،وفي الصرف الأمثلة والبناء والمقصود والعزي، والورقات وجمع الجوامع في الأصول ، ولا أذكر مقررا حديثا إلا اللهم في السيرة النبوية والأدب العربي وبعض مقررات البلاغة، وقد ساعد هذا المنهج على التواصل مع لغة التراث بخلاف المناهج الحديثة للمدارس الرسمية التي قطعت صلتها بتلك اللغة
- التسلسل العلمي المنهجي بالصيغة الأصيلة في مقررات العلم أو الفن الواحد[51]، وعلى سبيل المثال ففي النحو هناك منهج متسلسل وضعه ابن هشام يبدأ بالقطر مع شرحه ثم شذور الذهب بشرحه ثم مغني اللبيب، وقد كانت الآصفية تأخذ بهذا التسلسل إلا أنها وضعت الأجرومية بالشرح كمقدمة للمبتدئين، وربما يحصل تغيير –كما أسلفنا– بالاتفاق مع الطلاب كما اتفق على تدريس الألفية بشرح ابن عقيل في بعض المراحل، وأذكر أن الشيخ جمال شاكر رأى أن نراجع حاشية الخضري على ابن عقيل، وفي المنطق كانت البداية بمقدمة في المنطق للشيخ عبد العزيز ثم متن السلم ثم فناري على إيساغوجي ثم تهذيب المنطق بشرح الخبيصي، لقد كان لهذا المنهج المتسلسل أثره في تكوين البناء العلمي لدى الطالب، ولا ريب أن هذا التسلسل وضع وفق خبرات متراكمة ولأجيال متواصلة. ولا ريب أيضا أن المدارس الحديثة تفتقر إلى مثل هذه الخبرات لانقطاع السند العلمي فيها أصلا.
- المنهج المتسلسل لبناء المعلومات في المقرر الواحد، حيث يبدأ بناء المعلومة الأولية من خلال المتن ثم تتوسع هذه المعلومة من خلال الشرح، وبعدها تكتمل الدائرة من خلال الحاشية، ثم تأتي المناقشات مع الشيخ لسد بعض الثغرات، وفي كثير من الأحيان كان الكتاب المقرر يضم المتن مع الشرح والحاشية، فلو نظرت مثلا في كتاب إعانة الطالبين في الفقه الشافعي وهو في الأصل حاشية موسّعة جدا على فتح المعين وفتح المعين هو شرح موجز على متن قرة العين، وهذه الكتب الثلاثة مطبوعة في كتاب واحد بأربع مجلدات، ويخطئ من يظن أن هذه الشروح وجدت من أجل تسهيل فهم المتون أو حل عباراتها، لأن هذه الشروح هي وإن سميت شروحا لكنها في الحقيقة كتب أخرى توسع دائرة المعلومات والمعارف أكثر من كونها شروحا لمفردات المتن، ولذلك تجد واضع المتن قد يكون هو نفسه واضع الشرح كما فعل ابن هشام في شرحه على متن القطر وفي شرحه كذلك على متن شذور الذهب، وبالإضافة إلى توسعة دائرة المعلومات فقد كانت هذه الشروح والحواشي تعزز المعلومات بالأدلة والأمثلة ورد الشبهات الموجودة والمحتملة ومناقشة الخصوم وهكذا.
- الجمع بين (الحفظ والفهم) بمنهج تربوي مدروس، فالخارطة الأولية للمعلومات ينبغي أن تكون محفوظة بالكامل والخارطة هذه هي من مهمة المتن وعلى سبيل المثال فإن الذين يستحقون الإرث من الرجال عشرة (الابن وابن الابن…)الخ ومن النساء سبع ( بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة) الخ فالطالب يحفظ هذه الأعداد كما هي من متن الرحبية ثم تتوسع مداركه من خلال الشروح والتطبيقات، وهكذا هو في الصرف يحفظ أبواب الثلاثي المجرد (فتح ضم، فتح كسر، فتحتان- كسر فتح ، ضم ضم، كسرتان ) وهكذا في الفقه والنحو والمنطق..الخ ولذلك تعددت وسائل تسهيل الحفظ من المتون المنثورة إلى الأرجوزات المختصرة ثم الألفيات المطولة وهكذا.
ولإلقاء نظرة على نموذج من المقررات التي كانت مطروحة في فترة محددة من التاريخ القريب للآصفية فإني سأنقل نص المنهج المعدل وفق الصيغة الأخيرة المعمول بها الآن، وكنت أود أعثر في وثائق الآصفية على أي منهج متكامل وقديم لكني لم أعثر لحد كتابة هذه السطور، لكن هذه الصيغة الأخيرة تشابه المقررات التي أخذناها في الآصفية بما يزيد عن 60 % وهذا قد يغني في إعطاء صورة تقريبية لتلك المناهج القديمة، ولعل بعض الفروق ترجع إلى أن بعض المقررات القديمة تدرس الآن في الجامعات الإسلامية الرسمية، ولأن خريجي الآصفية سيضطرون لإكمال الدراسة في هذه الجامعات فقد رأى بعض الشيوخ استبدال بعض المقررات تفاديا للتكرار– كما حدثني بهذا الشيخ عبد الملك السعدي-.
خطة الدراسة للصف الأول
| المادة | الحصص | الكتاب المقرر والموضوعات |
| القرآن الكريم والتفسير والحفظ | 3 | الأجزاء من (26-30) للتلاوة فقط والجزء (30) للحفظ و التفسير من الجلالين. |
| التجويد | 1 | فتح الأقفال على شرح تحفة الأطفال |
| الحديث | 2 | رياض الصالحين من أوله إلى نهاية إكرام أهل البيت مع حفظ (30) حديثاً من الأحاديث المقررة. |
| التوحيد | 1 | حفظ المقصد الأول من مقاصد الإمام النووي مع شرح مفرداته للشيخ عبد العزيز السامرائي. |
| الفقه | 3 | العبادات من متن الغاية والتقريب أو القدوري مع ملاحظة الشرح. |
| النحو | 3 | حفظ الأجرومية مع ملاحظة شرح محي الدين بن عبد الحميد. |
| الصرف | 2 | الأمثلة والبناء. |
| الأدب والتعبير | 2 | الأدب /الجاهلية –تعريفها لغة واصطلاحاً– خطباء الجاهلية منهم: قس بن ساعدة الأيادي –خطبته / من الشعر الجاهلي– المعلقات السبع –أصحاب المعلقات السبع– مع نبذة عن قائلها. التعبير /كلمات كتاب حمدي عبيد. |
| السيرة والتاريخ | 2 | سيرة نور اليقين. |
| الجغرافية | 1 | الباب الأول والثاني من كتاب الأول المتوسط بوزارة التربية. |
| الرياضيات | 1 | كتاب مبادئ الرياضيات للأول المتوسط الفصل الأول والثاني مع مراجعة النسبة المئوية والتقسيم المتناسب بوزارة التربية. |
| العلوم العامة | 1 | كتاب مبادئ العلوم للأول المتوسط بوزارة التربية – النصف الأول. |
| الانجليزي | 2 | الفصول السبعة الأولى من كتاب الصف الأول المتوسط مع تعريف الطلاب بالمصطلحات الدينية والإكثار من المناقشات ما أمكن. |
| التربية الوطنية | 1 | الكتاب المقرر في الأول المتوسط بوزارة التربية. |
| خطة الدراسة للصف الثاني | |||
| المادة | الحصص | الكتاب المقرر والموضوعات | |
| القرآن الكريم للتفسير والحفظ | 3 | الأجزاء من-21-25-للتلاوة فقط- الجزء(29) للتفسير والحفظ من الجلالين. | |
| التجويد | 1 | كفاية المريد. | |
| الحديث | 2 | رياض الصالحين-من باب توقير العلماء إلى نهاية باب جواز الشرب من صحن الأواني الطاهرة مع حفظ (30) حديث والمقرر سابقاً. | |
| التوحيد(العقائد) | 1 | حفظ متن الشيبانية مع دراسة شرحها. | |
| الفقه | 3 | من المعاملات إلى آخر الكتاب من متن الغاية والتقريب أو القدوري أو ما يقاربهما | |
| النحو | 3 | النصف الأول من متن القطر-إلى الفاعل- مع مراعاة شرحه تحقيق محي الدين عبد الحميد. | |
| الصرف | 2 | إزالة القيود أ.د. عبد الملك السعدي إلى نهاية الفوائد. | |
| الأدب والتعبير | 2 | الأدب / كتاب وزارة التربية للصف الثاني المتوسط. التعبير/ تختار مواضيع من خطب الجمعة والعيدين مع تحفيظ النصوص، إعداد لجنة من كبار علماء الأزهر. | |
| السيرة والتاريخ | 2 | التاريخ العربي و الإسلامي للثاني المتوسط بوزارة التربية من أوله إلى نهاية الباب الرابع. | |
| الجغرافية | 1 | جغرافية العراق للثاني المتوسط الأبواب الثلاثة الأول. | |
| الرياضيات | 1 | الفصل الثالث والرابع والخامس من كتاب الرياضيات للأول المتوسط في التربية. | |
| العلوم العامة | 1 | النصف الثاني من كتاب العلوم للأول المتوسط. | |
| الانجليزي | 2 | الفصول الباقية من الصف الأول المتوسط مع مراعاة المناقشات الصفية. | |
| التربية الوطنية | 1 | الكتاب المقرر بوزارة التربية. | |
| خطة دراسة للصف الثالث | |||
| المادة | الحصص | الكتاب المقرر والموضوعات | |
| القرآن الكريم والتفسير والحفظ | 3 | الأجزاء من 16- 20 للتلاوة فقط الجزء- 28- للحفظ والتفسير من الجلالين. | |
| الحديث | 2 | رياض الصالحين- من كتاب اللباس الى نهاية كتاب العتق مع حفظ (40) حديث المقررة سابقاً. | |
| التوحيد(العقائد) | 2 | حفظ متن السنوسية مع مراعاة الشرح. | |
| الفقه | 3 | العبادات من المنهاج أو المختار مع ملاحظة الشرح. | |
| النحو | 3 | النصف الباقي من القطر مع حفظ المتن مع مراعاة ما تبقى شرحه تحقيق محي الدين عبد الحميد | |
| الصرف | 2 | ما تبقى من إزالة القيود أ.د.عبد الملك السعدي. | |
| الأدب والتعبير | 3 | حصتان للأدب- كتاب الصف الثالث بوزارة التربية حصة للتعبير-المواضيع الآتية: 1-احترام الوالدين -2-العلم -3-إكرام الضيف -4-الصدق والكذب -5-الأمانة -6-الأخلاق -7-حقوق الجار -8-التعاون -9-التقوى -10-الوفاء بالعهد -11-التوبة -12-الأمر بالمعروف. | |
| التاريخ | 2 | التاريخ العربي الإسلامي للصف الثاني بوزارة التربية من باب الخامس إلى نهاية الكتاب. | |
| الجغرافية | 1 | جغرافية العالم الإسلامي- أو تختار مواضيع بما يناسب الطلاب من الكتاب المقرر بوزارة التربية. | |
| الرياضيات | 1 | الباب السادس من كتاب الأول المتوسط بوزارة التربية. | |
| العلوم العامة | 2 | الكتاب المقرر للصف الثالث المتوسط بوزارة التربية. | |
| الانكليزي | 2 | الفصول السبعة الأولى من كتاب الصف الثاني المتوسط في التربية. | |
| التربية الوطنية | 1 | الكتاب المقرر بوزارة التربية. | |
| خطة الدراسة للصف الرابع | |||
| المادة | الحصص | الكتاب المقرر والموضوعات | |
| القرآن الكريم و التفسير والحفظ | 3 | الأجزاء -11-15- للتلاوة فقط الجزء27للحفظ وللتفسير من النسفي. | |
| علوم القرآن | 1 | علوم القرآن لأحمد كمال. | |
| الحديث | 2 | رياض الصالحين من باب فضل الإحسان إلى الملوك إلى آخر الكتاب مع حفظ (50) حديثا المقرر. | |
| علوم الحديث | 1 | علوم الحديث للطائي من أوله إلى أقسام الحديث. | |
| التوحيد | 2 | جوهرة التوحيد مع الشرح حفظ الجوهرة مع مراعاة الشرح | |
| المنطق | 1 | الشرح الواضح المنسق على السلم المرونق أ.د. عبد الملك السعدي. | |
| الفقه | 3 | من البيوع إلى النهاية الجعالة / المنهاج. أومن البيوع إلى نهاية الوقف/ المختار. | |
| أصول الفقه | 1 | شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني. | |
| النحو والصرف | 2 | شرح ابن عقيل من أوله إلى نهاية المفعول لأجله مع حفظ المتن. والصرف البيان والإيضاح | |
| البلاغة | 2 | المعاني فقط من جواهر البلاغة. | |
| التعبير والأخلاق | 2 | حصة تعبير يختار المدرس المواضيع. | |
| التاريخ | 1 | فقه السيرة للبوطي من أوله إلى نهاية عام الحزن. | |
| الانكليزي | 2 | بقية كتاب الصف الثاني المتوسط. | |
| علم الاجتماع | 1 | كما هو مقرر في وزارة التربية. | |
| خطة الدراسة للصف الخامس | |||
| المادة | الحصص | الكتاب المقرر والموضوعات | |
| القرآن الكريم والتفسير والحفظ | 3 | الأجزاء من6-10- للتلاوة فقط والجزء26فقط للحفظ و للتفسير من النسفي. | |
| الحديث | 2 | بلوغ المرام من أوله إلى نهاية العبادات مع حفظ (50) حديثا يعينها المدرس. | |
| علوم الحديث | 1 | علوم الحديث للشيخ الطائي أقسام الحديث إلى نهاية الكتاب. | |
| التوحيد | 1 | شرح النسفيه ما تبقى إلى نهاية أمور الآخرة أ.د. عبد الملك السعدي. | |
| المنطق | 2 | فناري على إيساغوجي. | |
| الفقه | 3 | من أول الفرائض إلى نهاية مؤنة المملوك من المنهاج أو من أول الهبة إلى نهاية باب الإيمان المختار. | |
| أصول الفقه | 2 | عبد الوهاب خلاف القسم الأول والثاني. | |
| النحو والصرف | 3 | شرح ابن عقيل من باب المفعول معه إلى نهاية الاستغاثة مع حفظ المتن والصرف ما تبقى من البيان والإيضاح. | |
| البلاغة | 2 | البيان فقط من جواهر البلاغة. | |
| التعبير والأخلاق | 2 | حصة للتعبير يختار المدرس مواضيعها وحصة للأخلاق من كتاب الأربعين في أصول الدين للغزالي. | |
| الفرائض | 2 | الرحبية حفظ المتن مع مراعاة الشرح. | |
| التاريخ | 1 | فقه السيرة للبوطي من الهجرة إلى نهاية صلح الحديبية. | |
| الانكليزي | 2 | النصف الأول من كتاب الصف الثالث المتوسط. | |
| علم الاجتماع | 1 | الكتاب المقرر في وزارة التربية. | |
| خطة الدراسة للصف السادس | |||
| المادة | الحصص | الكتاب المقرر والموضوعات | |
| القرآن الكريم والتفسير والحفظ | 3 | الأجزاء من1-5 للتلاوة فقط الجزء(25) للتفسير والحفظ من النسفي. | |
| الحديث | 2 | بلوغ المرام بقية آخر الكتاب مع حفظ (50) حديثا المقررة. | |
| التوحيد | 1 | ما تبقى من شرح النسفية | |
| الفقه | 4 | ما تبقى من المنهاج. أو ما تبقى من المختار | |
| أصول الفقه | 2 | عبد الوهاب خلاف القسم الثالث والرابع. | |
| تاريخ التشريع | 1 | خلاصة التشريع لعبد الوهاب خلاف. | |
| النحو والصرف | 3 | ما تبقى من شرح ابن عقيل مع حفظ المتن. | |
| البلاغة | 2 | البديع من جواهر البلاغة. | |
| التعبير وأصول الدعوة | 2 | حصة للتعبير ارتجال المواضيع الآتية:1-الصحة و التداوي في الإسلام. 2-الأسرة.3-صلة الرحم.4-الجهاد.5-الكرم.6-الإسلام والمرأة. 7-العبادة.8-الزواج في الإسلام.9-الاقتصاد في الإسلام.10-الإسلام والوطن.11-التسامح.12-العدل.13-الظلم.14-العدالة الاجتماعية.15-الإسلام والحضارة. وحصة لأصول الدعوة: للدكتور عبد الكريم زيدان. | |
| التاريخ | 1 | فقه السيرة بقية الكتاب للبوطي. | |
| الانكليزي | 2 | بقية كتاب الصف الثالث المتوسط. | |
| علم الاجتماع | 1 | الكتاب المقرر في وزارة التربية. | |
ملاحظات موجزة على هذا النموذج :
- أثر التدخل للنظام الرسمي في هذه المدرسة بدا واضحا من خلال المقررات المتعلقة بالوطنية بشكل صارخ، وكذلك اللغة الانجليزية والتي كانت مرفوضة عند شيوخ المدرسة الأوائل.
- الأخذ من الكتب الحديثة، وقد ظهر هذا واضحا في علوم الحديث لبعض المراحل وكذلك السيرة النبوية، وحتى أصول الفقه.
- التركيز على علوم الآلة، وهذا سمت قديم ومعروف للآصفية[52].
- قلة الحفظ من القرآن الكريم والسنة النبوية، وهذا معروف في مناهج الآصفية من الأصل، والحقيقة أن هذا الموضوع مثار جدل إلا أن شيوخ الآصفية يرون أن التحفيظ ليس مهمة العلماء وإنما هو شيء ينبغي أن يشجع عليه خارج المقررات الدراسية، وأذكر بهذا الصدد أن الشيخ هشام الآلوسي وكان أحد المربين في الآصفية جمعنا بأحد التجار المعروفين في الفلوجة وقال أريد منكم أن تحفظوا القرآن كاملا، ومن يحفظ فله مكافأة (مائة دينار) والدينار في ذلك الوقت كان يساوي على ما أذكر غراما واحدا من الذهب، لكن النتيجة أن خريجي الآصفية يقل فيهم حفظة القرآن إلى اليوم.
ثانيا ً: المنهج التربوي (القيمي)
- المبادئ والأهداف:
يمكن القول إن تحقيق الإرث المحمدي في حمل الرسالة الخاتمة عبر الأجيال المؤمنة بوعي وبصيرة هو الرسالة الكلية للآصفية ، وهو القيمة العليا التي تنبثق منها الأهداف القيمية التفصيلية والتي يمكن أن نجملها في النقاط الآتية.
- الربانية: حيث تسعى الآصفية لتحقيق هذا الهدف بكل أبعاده، فالربانية مصدر المعارف المطلوبة، وهي المعيار القيمي الذي تقاس به المعارف والثقافات والسلوكيات، وهي كذلك الغاية الأسمى لكل هذا الجهد.
- الهوية: فلم تكن الآصفية تعرف شعار (العلم للعلم) وإنما كان العلم مرتبطا بالهوية العربية والإسلامية، وكان تحصين هذه الهوية وتعزيزها لدى الطالب من أولويات الآصفية، وقد برز هذا الهدف بشكل أوضح بعد تعرض البلاد لحملات التغريب والعلمنة والمد الشعوبي.
- العبادة: تتميز الآصفية بسمتها التعبدي الواضح المقترن بمسحة صوفية ظاهرة تتجلى في النشاط اليومي والسلوك التفصيلي وحتى الزي والمظهر الخارجي.
- الأخلاق: وكان هذا الهدف الأكثر حساسية ومتابعة من قبل شيوخ الآصفية، وقد كانت أغلب قاعات الآصفية تزينها عبارة (علامة أهل الجنة الأدب) وفي رواق الآصفية توجد لوحة (أدبني ربي فأحسن تأديبي)، وقد وصل الحد بتعظيم الأخلاق أنه كان يطلب منا أن ننظف (الصابونة) بعد استعمالها لأنه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟!
- احترام الشيخ وطاعته: فبالرغم مما يتزين به شيوخ الآصفية من تواضع وزهد إلا أنهم يركزون على غرس مهابة الشيخ وحبه وطاعته في قلوب الطلاب، ويعتقدون أن هذا شرط لتحصيل العلوم وتحقيق الأهداف[53]، وأذكر أني سألت شيخي الدكتور عبد الملك السعدي عن هذا المنهج وغايته فقال: لا تظن أن هناك علما حقيقيا من دون أن يجثو الطالب على ركبتيه أمام شيخه
- الأخوة الصادقة: والمقصود بهذا الهدف تحقيق معاني الأخوة والصداقة الصادقة بين الطلاب[54]، وكان شيوخ الآصفية يرعون بأنفسهم هذا الهدف ويحثون طلابهم على كل ما من شأنه أن يعزز الثقة والمودة والتعاون بين طلابهم، وقد يربطون اثنين من الطلاب برباط أخوي خاص، وأذكر بهذا الصدد كيف تآخينا أنا العبد الفقير وأخي في الله الشيخ الدكتور عمر عبد العزيز حتى كنا نتواصى بتحقيق بعض السلوكيات التفصيلية المرتبطة بسيرنا إلى الله بحيث أننا بعد أن ننجح في إلزام أنفسنا بسلوك نتعاهد على الرقي إلى سلوك آخر ومن هذه السلوكيات مثلا: المحافظة على الوضوء طيلة اليوم، ومحاسبة النفس والتنافس في إنزال دمعات التوبة قبيل النوم من كل ليلة، ولو ترى مجلسا يضم الشيخين الجليلين عبد الملك السعدي وخليل الفياض لعلمت أن هذه الأخوة لا تزيدها الأيام إلا أودا، وأذكر أيضا أن الشيخ إبراهيم الهيتي قد أسمى ولده البكر عبد الستار حبا بزميله الشيخ عبد الستار الكبيسي، وهذا على خلاف ما عهد من التنافس بين الأقران.
- الدعوة والإصلاح: حيث كان الطالب يعد ليكون داعية ومرشدا ومصلحا، فإن الإرث المحمدي لا يتحقق بالعلم النظري ولا بصلاح الذات من دون حمل هذه الأمانة كما حملها المعلم الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى (العلماء ورثة الأنبياء) ولذلك فغالب خريجي الآصفية اليوم هم أئمة المساجد وخطباؤها وأساتذة الجامعات وقادة المؤسسات الفكرية والدعوية في البلاد.
- الوسائل:
يمكن أن نجمل أهم الوسائل التي وضعتها الآصفية لتحقيق أهدافها القيمية بالنقاط الآتية :
- إنشاء البيئة المساعدة: وقد مرّ بنا كيف ارتبطت الآصفية بالمسجد في كل نشاطاتها، وهكذا كل فروع الآصفية، وتزيين أروقة الآصفية بالعبارات التي تربط بين العلم والتقوى والخلق.
- شرط التزكية في قبول الطلاب، فلا يكفي معدل الدراسة السابقة ولا الرغبة في التعلم بل لا بد من حصول الطالب على تزكية تثبت حسن سمعته وسلوكه في مجتمعه.
- وجود المرشد الروحي في المدرسة، وقد كان الشيخ محمد الفياض نموذجا شاخصا لأهمية هذا الدور في تحقيق الأهداف القيمية للآصفية، فإن جميع خريجي الآصفية لا ينكرون دور الشيخ الفياض في هذا الجانب والذي لا يقل عن دور الشيخ عبد العزيز السامرائي في الجانب المعرفي، وقد كان التعاون بينهما قائما بأبهى صوره مما انعكس على جميع الطلبة، وقد عاصرت الشيخ عبد الله الحديد والذي كان له دور مقارب لدور الفياض، وكان الشيخ هشام الآلوسي الذي كان مقيما في المدرسة ليل نهار له دور مشابه، هذا كله في الفلوجة، أما في فروع الآصفية فأذكر هنا دور الحاج حمدان الكبيسي الذي كان مكملا لدور الشيخ عبد الستار في مدرسة عثمان أفندي، تجدر الإشارة هنا على أن هذا الدور على أهميته كان طوعيا رغم أنه كان يستدعي التفرغ التام للمدرسة.
- الأنشطة التربوية المتنوعة، وأذكر منها حلقات القرآن والذكر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان شيوخ الآصفية يتوسعون في تشجيع كل أنواع الذكر الفردي والجماعي والسري والجهري، رغم ما يقع بينهم في بعض الأحيان من اختلاف في بعض الصيغ تبعا للاجتهاد الفقهي، فقد رأى الشيخ خليل الفياض مثلا أفضلية الذكر الخفي في التربية والابتعاد عن استخدام الدف، في حين نرى بعض الشيوخ يشجعون الذكر الجهري لما فيه من التشجيع على الحضور والمشاركة أما الدف فإن عامة شيوخ الآصفية لا يحبذونه إلا في المناسبات، أما صلاة الجماعة وبخاصة صلاة الفجر والعصر فقد كان الشيخ يسجل الحضور والغياب عقب الصلاة مباشرة والذي تفوته الجماعة يتعرض للعقوبة وإذا تكرر ذلك منه يطرد من المدرسة.
- مقرر التربية الروحية، فقد كان هناك مقرر لهذا الغرض نأخذه في الغالب من إحياء علوم الدين أو من مختصراته، وقد عايشت في هذا تجربة نافعة حيث كان الشيخ حامد صخي الجنابي يرى عدم الاعتماد على كتاب مقرر وإنما يرى حالة الطلاب وحاجتهم فينتقي لنا المواضيع انتقاء موفقا من كتب التربية والرقائق وتجارب الصالحين وقصصهم.
- التأكيد على المظهر المعبر عن تلك التربية فقد كان الطالب ملزما بزي موحد وهو الثوب العربي المعروف مع العمامة البيضاء[55]، وكان الشيخ عبد العزيز السامرائي لا يسمح بلبس الجبة لأنها تثير عند الطالب نوعا من الخيلاء والغرور !! ثم جاء تلامذته من بعده فرأوا التأكيد على لبس الجبة لما فيها من إظهار المهابة لطالب العلم! أما اللحية فقد كانت واجبة بالنسبة لشيوخ الآصفية وطلابها ولازال عامة أهل العراق لا يأخذون العلم عن حليق مهما كان علمه !! لكن من المظاهر التي كانت مؤكدة تأكيدا شديدا حلاقة الرأس فكان في المدرسة موظف مكلف بحلاقة الطلاب داخل المدرسة بمعدل مرتين في الشهر-حلاقة بالماكنة الكهربائية التي تبقي على أصول الشعر- وقد كان تبرير الشيخ أن الطالب ينبغي أن ينشغل بالعلم وأن طول الشعر يحتاج إلى عناية ووقت! والأمر الأهم أن الطالب لا يستطيع أن يخلع عمامته حتى لو كان بعيدا عن الآصفية في أيام الإجازات ولن يستطيع أن يخالط أقرانه من الشباب في لهوهم، فالقصد التربوي في هذا واضح رغم ما كان يثور حول هذه النقطة من جدل.
- عدم السماح بمخالطة (الخارجي) والخارجي مصطلح كان يطلق على كل شخص غير مصنف على أنه من طلاب الشيخ أو أحبابه، رغم أن المدرسة تفتح مسجدها الكبير وباحاتها الواسعة لطلاب المدارس الرسمية للمطالعة والمذاكرة والتي كانت المدرسة تعج بهم كخلايا النحل إلا أن هؤلاء عليهم أن لا يتصلوا بطلاب الآصفية إلا بحدود ضيقة كمساعدتهم في حاجة معينة أو إجابتهم عن سؤال شرعي أو لغوي وما إلى ذلك ، أما العلاقات والصداقات فهي ممنوعة، لكن شيوخ الآصفية أنفسهم يتمتعون بعلاقات طيبة مع هؤلاء وكان هناك نوع من التفهم للموقف من طلاب الآصفية يتلخص في عدم إشغالهم عن العلم! إلا أن الصحيح أن هناك أسبابا أخرى مثل الخوف على طلاب الآصفية من الأفكار الدخيلة خاصة بعد انتشار الأحزاب العلمانية في البلد، وكذلك كانت بعض أجهزة الأمن والمخابرات يحاولون اختراق الآصفية وقد حصل هذا في مدرسة الرمادي حيث تمكن البعثيون من تأسيس ما سمي بـ (الاتحاد الوطني) والذي عمل على هدم كل مبادئ المدارس الدينية وأعلن الحرب صراحة على شيوخ المدرسة ومناهجها، وقد كان أفراد الاتحاد جواسيس يقدمون التقارير اليومية على شيوخهم وزملائهم وحتى على العامة الذين يحبون الشيخ ويساعدونه.
- عدم السماح بمتابعة وسائل الإعلام داخل المدرسة، وقد حدثني أخي الشيخ مكي أن شيوخ مدرسة كبيسة كانوا يمنعونهم حتى من قراءة الصحف الإسلامية بالرغم من أن الشيوخ هؤلاء كانوا حريصين على متابعتها، وكان الشيخ عبد العزيز قد عاقب أحد طلابه لأنه كان يقتني جهاز راديو صغير الحجم في حين أن الشيخ كان عنده في مكتبه جهاز كبير يتابع من خلاله بعض التطورات السياسية في البلد! ومعنى هذا أن الشيوخ هؤلاء لم يكونوا يحرمون استخدام هذه الوسائل لكنهم كانوا حريصين على تفريغ الطلاب في مرحلة التلقي مع أن استخدام هؤلاء الطلاب لهذه الأدوات وهم في سن الشباب قد يعرضهم للفتنة والإثم[56]
ثالثا : التدريب وتنمية المهارات[57]:
تتميز الآصفية بقدرتها على تنمية المهارات العملية خاصة تلك المتصلة برسالة المدرسة وأهدافها، ومن أهم تلك المهارات التي يتزود بها طالب الآصفية:
1-الخطابة: وهي المهارة الأبرز التي يتخرج بها طالب الآصفية، فلا يمكن لطالب الآصفية إلا أن يكون خطيبا، ولم أر من طلاب الآصفية من يستخدم الورقة في الخطبة لأن هذا معيب في عرف الآصفية وحتى البيئة المحيطة بها! ولتنمية هذه المهارة اعتمدت الآصفية على الوسائل الآتية:
- مقرر إلزامي (نظري وعملي) خاص بالخطابة.
- مقررات إلزامية مساندة مثل (البلاغة) و (الأدب العربي).
- تكليف الطلاب بخطبة الجمعة في مساجد الفلوجة المنتشرة وخاصة في الأطراف.
2-الإمامة وهذه مهارة متصلة بما قبلها يمارسها الطالب في المسجد الذي يكلف بخطبة الجمعة فيه، وقد يمارسها في مسجد الآصفية عند غياب الشيخ مثلا، وقد يكلف الشيخ من يؤم الناس بحضرته، ويلزم من هذا تمرس الطالب على قواعد التلاوة وضبطها، وكان في منهج الآصفية مقرر إلزامي لهذا الهدف.
3-الوعظ والدروس العامة ويمارسها طلاب الآصفية عصر كل يوم من أيام رمضان، وهذا سياق متبع في كل مساجد العراق تقريبا ، إضافة إلى الوعظ الأسبوعي، ومحاضرات المناسبات التاريخية المختلفة كالهجرة النبوية ومعركة بدر والمولد النبوي..الخ
4-مهارة التواصل مع المجتمع وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في مناسبات الناس، فكان طلاب الآصفية يشاركون في أعراس الناس وكان يقومون بتنظيم مسيرة الفرح والتي تنطلق عادة من المسجد بهتافات وأهازيج إسلامية وشعبية، وكذلك المشاركة في مجالس العزاء وحتى ختان الأطفال..الخ
5-مهارة الإنشاد، حيث كانت حلقات الذكر الأسبوعي والتي تتخللها أناشيد ومدائح للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحين، وكانت مناسبة لاكتشاف أصحاب الأصوات الجميلة وتطوير أدائهم، وكان بعضهم يتعمق في دراسة أنغام المقام العراقي، وأذكر من هؤلاء الشيخ إسماعيل عبد الرزاق الهيتي، والشيخ عمر عبد العزيز العاني.
6-مهارة كتابة الشعر، حيث كانت المناسبات التاريخية المختلفة والتي تحتفي بها الآصفية تشكل بيئة محفزة للمشاعر ولذلك ترى أكثر الناتج الشعري لطلاب الآصفية مرتبطا بهذه المناسبات، ففي كل احتفال يتبارى شعراء الآصفية بتقديم قصائدهم الجديدة وكأن الناس بالفعل كانوا ينتظرون ذلك، وكانت القصائد متعددة الأغراض فمنها الوجداني ومنها الوعظي ومنها السياسي الذي يعالج هموم الأمة وقضاياها، وأذكر من شعراء الآصفية الدكتور عمر حمدان الكبيسي ومكي حسين الكبيسي وعمر عبد العزيز العاني، وقد كان للباحث دور في هذا أيضا، وقد قام منتدى شباب الفلوجة بجمع ما تيسر من قصائد الباحث ونشرها بعنوان (أناشيد المقاومة)[58].
7-مهارة الخط، وهذه من المهارات الجميلة التي تحظى باهتمام واسع وشبه يومي من طلاب الآصفية، حيث كانوا يتداولون قواعد الخط الأصيل وخاصة رسالة الخطاط الشهير هاشم البغدادي وكان الطلاب يتنافسون في تقليدها، ومنهم من نجح نجاحا متميزا وأذكر منهم الأشقاء الثلاثة: الشيخ عبد الحميد عبطان، والشيخ أحمد عبطان، والشيخ محمد عبطان، وكذلك الشيخ عمر عبد العزيز العاني.
8-مهارة تجليد الكتب: فقد كان طلاب المدرسة يحتفظون بكتبهم ويغلفونها بأيديهم بأدوات تغليف تحفظ الكتاب لعقود طويلة، وقد رأيت بعض الشيوخ الكبار يحتفظون لليوم بهذه الأدوات اعتزازا بذلك التراث الذي يعبر عن اهتمام صادق بالعلم ومصادره.
9-هناك مهارات كثيرة متصلة بخدمة المدرسة وأذكر بهذا الصدد كيف أن الشيخ عبد الملك السعدي قد بنى بيده وبمعاونة إخوانه وبعض الطلبة منارة الجامع الكبير في الفلوجة وهي جزء من بناء الآصفية ويبلغ ارتفاع المنارة حوالي الثلاثين متر وهي لوحة فنية رائعة، وأذكر كيف كان الشيخ هشام الآلوسي والشيخ عبد المنعم شاكر الفياض والشيخ كمال النزال يعتنون بحديقة المدرسة وتزيينها وكذلك بنشرات المصابيح التي ترتفع فوق المدرسة بحدود الثلاثين متر، وكان كل الطلاب يتعاونون في صيانة المدرسة ومرافقها وأثاثها أكثر من بيوتهم بكثير.
10-أما وسائل الإعلام فكانت هناك مجلتان الأولى (مجلة التربية الإسلامية) ولا زالت، والثانية (مجلة الرسالة الإسلامية) وقد انقطعت، وكان بعض طلاب الآصفية يكتبون فيهما، أما وسائل الإعلام الحكومية فكان هناك فجوة كبيرة بينها وبين الآصفية، ولا أذكر إلا محاولات محدودة من الدكتور عمر عبد العزيز العاني.
11-ولا يفوتني هنا أن أذكر نشاطا يسجل للآصفية وهو أن محكمة الفلوجة كانت ترسل المعاملات التي تحتاج إلى تقسيم التركة إلى الآصفية وكان الشيخ عبد الله الحديد يتصدى لهذه المهمة وكان يشجع الطلاب على حل هذه المسائل والتوقيع عليها بأسمائهم، ومن يرجع اليوم إلى ملفات محكمة الفلوجة فإنه سيجد كثيرا من المعاملات الرسمية موقعة باسم طلاب الآصفية، حيث كانت المحكمة تعتمد رسميا هذا التوقيع، وقد كانت هذه ظاهرة يومية في الآصفية.
إن هذه المهارات كانت جزءا من شخصية الآصفي، وهي بمجملها تفتح الأبواب للتأثير المجتمعي، لكن هناك مساحات كان من الممكن أن تملأ بمهارات نافعة أخرى مثل إتقان اللغات الأخرى سيما اللغات العراقية غير العربية كالكردية والتركمانية، وكذلك المهارات المتصلة بالوعي السياسي والإعلامي، وأخيرا مهارات البحث العلمي المعروف اليوم في الجامعات خاصة في الدراسات العليا.
رابعا : النظام الإداري
مع فقدان وثائق المدرسة فإنه يصعب على الباحث رسم الخارطة الكلية لنظام المدرسة الإداري، لكن بالتجربة الشخصية والاتصالات المتنوعة حاولت أن أصل إلى المعالم الأساسية لذلك النظام ويمكن تلخيصها بالاتي :
1-العلاقة مع الجهات الرسمية[59]، حيث كانت مدرسة الفلوجة مرتبطة إداريا بمديرية أوقاف بغداد، وكانت هذه المديرية توفر للمدرسة الآتي :
- الموافقة على افتتاح المدرسة، وقد رأينا كيف أخذت درجة الآصفية من آصفية بغداد وهكذا مدرسة عثمان أفندي في كبيسة، ومدرسة منورة خاتون في الرمادي.
- تعيين المدرسين في المدرسة حيث كان المدرس يعين بكتاب رسمي من هذه المديرية وللمدرس مرتب شهري.
ج- صرف راتب بسيط لكل طالب وكان مقداره دينار واحد في الشهر، وهو قطعا لا يسد حاجة الطالب مع التقشف والزهد الذي عرف به طلاب الآصفية، لكن بقية الحاجات تسد إما من ذوي الطالب أو من الجهات الخيرية أو من التبرعات والهبات الأهلية.
د-رعاية المدرسة وصيانة مرافقه، لكن الواقع أن هذا في الغالب يقوم به أهالي الفلوجة أنفسهم.
هـ – التنسيق بين الآصفية وشقيقاتها كالمدرسة الحميدية في سامراء وبعض المدارس العريقة في الشمال، وذلك من حيث المناهج والنظر في حاجات هذه المدارس، وأذكر هنا كيف نقل الشيخ محمد طه البليساني وهو من أجل علماء الأكراد في الشمال إلى مدرسة كبيسة بعد وفاة مؤسسها الشيخ عبد الستار –عليهما رحمة الله-.
و- تعيين خريجي الآصفية في المدارس الدينية كما تم تعيين الشيخ عبد الملك والشيخ إبراهيم الهيتي في الآصفية نفسها، أو تعيينهم أئمة وخطباء، تجدر الإشارة هنا إلى أن مديرية الأوقاف لا تكتفي بالإجازة العلمية التي يحصل عليها الطالب من المدرسة وإنما تقوم باختبار الطالب عبر مؤسسة خاصة تسمى (المجلس العلمي)، وربما يتمكن الطالب من اجتياز هذا الاختبار قبل حصوله على الإجازة العلمية !! ويعين بناءا على هذا.
وبعد مجيء نظام البعث انفصلت الآصفية عن الأوقاف تماما وألحقت بوزارة التربية والتعليم وأصبحت شهادة المدرسة تعادل شهادة الثانويات العامة ويحق للطالب بهذه الشهادة أن يدخل في الجامعات العراقية الرسمية بحسب تخصصه، لكن هذا كان له تداعيات خطيرة على برامج المدرسة ومناهجها العلمية والتربوية، وقد تم بهذا إعفاء جميع شيوخ المدرسة واستبدالهم بمدرسين أقل كفاءة، لكن بفضل الله أن هذا الوضع لم يستمر طويلا حيث جرى تعديل آخر بعد التغيرات السياسية على عهد الرئيس صدام حسين الذي حاول أن يتقرب للعناوين الإسلامية في ظروف الحرب المتعددة.
2-نظام التدريس:
يلزم الطالب بإنهاء المقررات المطلوبة في فترة اثنتي عشرة سنة[60]، لكن من حق الطالب إذا كان متميزا أن يكمل هذه المقررات قبل هذه المدة فيأخذ المقررات بصورة مكثفة، لكن هناك تغيير جوهري حصل في عهد حكومة البعث حيث تم تقليص هذه المدة إلى النصف لتصبح ست سنوات فقط، وقد كان هذا مبررا بعض الشيء باعتبار أن الآصفية كانت تقبل الطلاب بلا مقدمات تعليمية وأما على عهدنا فالآصفية اشترطت إكمال الطالب لمرحلة الابتدائية وهي ست سنوات قبل دخوله في الآصفية، ومع الفارق بين التعليمين إلا أنه من حيث عدد السنوات الكلي يصبح متساويا، إلا أن الخطوة الأكثر استفزازا هو تقليص الدراسة إلى ثلاث سنوات فقط، غير أن هذا لم يستمر طويلا والحمد لله.
وكانت الدراسة تعتمد النظام السنوي فالطالب ينهي المقرر في سنة كاملة ،وكان معدل المقررات في السنة الواحدة أربعة عشر مقررا، تتخلل هذه السنة ثلاث إجازات رسمية دورية وهي أسبوعان إجازة منتصف العام، وشهران إجازة نهاية العام ،وشهر رمضان إذا لم يتداخل مع إجازة نهاية العام، أما على عهدنا فلم تكن هناك إجازة في شهر رمضان ربما لأن السنوات الست التي قضيناها في الآصفية كان رمضان يوافق فيها أشهر الصيف، وكانت هناك استراحة كل يوم ثلاثاء وجمعة يبقى فيهما الطلاب في المدرسة لكن بدون محاضرات وفي الغالب تستثمر هذه الأيام بالمراجعة والأنشطة المجتمعية المختلفة، لكن هذا ما نسمعه من الأجيال المتقدمة في الآصفية أما الذي عاصرناه فالإجازة الأسبوعية يوم الجمعة فقط، ويحق للطالب أن يخرج ظهر يوم الخميس ليعود فجر يوم السبت.
أما جدول الأعمال اليومي فقد كان الدوام يبدأ مع صلاة الفجر ويسجل الشيخ حضور الطلاب عقب الصلاة ثم تبدأ المحاضرة الأولى مباشرة وبعدها تتاح فرصة للراحة وتناول الإفطار، ثم تبدأ المحاضرات الأخرى إلى صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر تتاح فرصة للراحة وتناول الغداء، ثم يلزم الطلاب بحضور صلاة العصر لتبدأ عملية القراءة والمذاكرة الإلزامية إلى قبيل صلاة المغرب، بعد المغرب يتم تناول العشاء، ثم يلزم الطلاب بحضور صلاة العشاء لتبدأ المذاكرة الإلزامية لنحو ساعتين، وكان الشيخ يقرأ ويذاكر مع الطلاب في هاتين الفترتين، ولم يكن في هاتين الفترتين دروس علمية إلا إذا كان هناك ظرف طارئ لم يتمكن فيه الشيخ من إعطاء الدرس في الفترة الصباحية، وللأمانة العلمية فإن هذا الجدول كان يفعــّل بحسب همة الشيخ وظرفه والظروف المحيطة بالمدرسة أيضا وأذكر أن من الشيوخ الذين كانوا يهتمون بهذا الجدول ويحاسبون عليه بشدة هو شيخنا الشيخ جمال شاكر النزال –حفظه الله-.
وأخيرا فإن نظام الدرس (المحاضرة) كان متميزا أيضا حيث لم يكن هناك مدة زمنية محددة للدرس، وإنما كان ذلك مرتبطا بموضوع الدرس نفسه فقد يستغرق الدرس الساعة الواحدة وقد يستغرق الساعتين أو أكثر، المهم أن الشيخ لا ينهي الدرس حتى يتأكد أن الطلاب قد استوعبوا الموضوع بالكامل وأجابهم عن كل الأسئلة وهكذا، وكان الطلاب يجلسون في الغالب على شكل حلقة مستديرة يرى الشيخ فيها جميع الطلاب مرة واحدة ويسمع لهم ويحاورهم ، ولكن في بعض الأحيان كنا نأخذ الدرس في مكتب الشيخ المعد لاستقبال الضيوف والزائرين والمستفتين وهو على عهدنا كان مجلسا فارها وواسعا وفيه أسرّة مريحة للجلوس وفي الغرفة مكتب للشيخ ومكتبة متوسطة الحجم وحمّام نظيف جدا، وكان مجلس الشيخ هذا يطل على نهر الفرات من جانبين، نعود إلى المحاضرة حيث كانت الآصفية تعتمد نظاما لم أسمع بمثله فالشيخ كان يلزمنا بقراءة موضوع المحاضرة قبل المجيء للمحاضرة وفي الدقائق الأولى يختبر الشيخ قراءتنا الأولية للموضوع ثم يطالبنا بقراءة الموضوع على ضوء شرح الشيخ مرة أخرى وفي المحاضرة الثانية يختبرنا في موضوع المحاضرة الأولى ويكون الطالب وفق هذا ملزما بقراءة كل موضوع قراءتين الأولى ك قبل المحاضرة والثانية بعدها والطالب معرض للاختبار في كل موضوع مرتين!! عدا الاختبارات الشهرية والنصفية والنهائية، لكن من المآخذ على دروس الآصفية أنها كانت تفتقر إلى وسائل الإيضاح فلم يكن الشيخ يستخدم حتى الوسائل التي كانت متاحة كالسبورة ونحوها، إلا في بعض المسائل العملية كالوضوء والتيمم فكان الشيخ يوضح ذلك عمليا.
- نظام التقويم :
قبول الطالب في الآصفية واستمراره فيها مرهون بحسن سمعته وسلوكه ، وهذا هو الخط الأحمر في الآصفية أما الجانب المعرفي فهناك اختبار أولي يختبر الشيخ فيه قدرة الطالب العقلية واستعداده للتعلم فإذا اقتنع الشيخ قبل الطالب وإذا لم يقتنع وكان الطالب حريصا على العلم فإن الطالب يتصل بأحد الطلاب المتميزين ليعلمه المسائل الأولية ويعيش بكفالته ربما لشهور حتى يتهيأ للاختبار مرة ثانية وهذا ما حصل للشيخ حمزة عباس – رحمه الله – حيث رفضه الشيخ عبد العزيز ثم كفله الشيخ عبد الملك وتولى تربيته وتعليمه فترة طويلة حتى تهيأ لاختبار الشيخ عبد العزيز مرة أخرى فوفقه الله وأصبح من فقهاء العراق المعدودين وتولى منصب (مفتي الفلوجة) حتى توفاه الله في معارك الفلوجة وتداعياتها الأخيرة.
وكانت الاختبارات على صنفين:
أ-الاختبارات الشفوية وهي في الغالب لمقررات الحفظ كالقرآن الكريم ومتون الصرف والنحو والفقه، وكان نظام التقويم في غاية الصعوبة فلم تكن هناك درجات نسبية كما هو في نظام التعليم المعاصر مثلا درجة النجاح 60% بمعنى أنه لو أخطأ الطالب 40 خطأ في مائة مسألة يعد ناجحا!! في الآصفية كان الطالب لو قرأ مائة بيت من الألفية وأخطأ بضعة أخطاء أو أنه تلكأ في الأداء فإن الشيخ سيعتبره (غير حافظ) فالتقويم كان (حافظ) أو (غير حافظ) لا غير! وكانت الاختبارات الشفوية تتناول القضايا المتعلقة بالأداء اللفظي مثل التلاوة والخطابة.
ب- الاختبارات الكتابية وفي الغالب كانت تتعلق بالمقررات التي تعتمد الفهم كالتفسير وشروح الحديث وكتب الفقه واللغة من غير المتون، وكانت الاختبارات لكل مقرر بمعدل ثلاث اختبارات قبل الاختبار النصفي ثم ثلاث اختبارات بعد الاختبار النصفي ثم الاختبار النهائي، ويؤخذ المعدل العام كالآتي:
| الشهر الأول | الشهر الثاني | الشهر الثالث | الفصل الأول | نصف السنة | الشهر الأول | الشهر الثاني | الشهر الثالث | الفصل الثاني | معدل السعي | الامتحان النهائي | الدرجة النهائية |
| 90 | 80 | 70 | 80 | 75 | 60 | 70 | 80 | 70 | 75 | 85 | 80 |
وبهذا يكون وزن الامتحان النهائي 50% ومجموع الفصل الأول (ما قبل المنتصف) ومجموع الفصل الثاني (ما بعد المنتصف) مع درجة المنتصف تساوي 50%.
أما توزيع الدرجة على ورقة الامتحان فلا تعتمد على تجزيء الدرجة بحسب عناصر السؤال ، وإنما في الغالب ينظر الشيخ إلى جزئيات السؤال كوحدة متكاملة وعلى سبيل المثال فلو جاء سؤال مثلا: عدد أركان الصلاة، فإذا نسي الطالب تسعة أركان من أصل ثمانية عشر فإنه لا يستحق نصف درجة السؤال وإنما يأخذ صفرا، لأن النتيجة الحقيقية أن الطالب هذا لا يعرف كيف يصلي! ومما لا شك فيه أن هذا يختلف بحسب المقرر وطبيعة السؤال، وكأن الشيخ هنا يتحرر من القوالب الشكلية ليقضي بما يعلمه من شأن الطالب هل تحقق هذا الطالب من أهداف المقرر فعلا؟ واليوم بدأنا نلمس في التعليم المعاصر جنوحا نحو هذا المنهج حيث بدأنا نقرأ عن (تقويم المخرجات) باعتباره المعيار الأدق في نجاح المؤسسة العلمية أو فشلها.
وأخيرا فإن التقويم النهائي للطالب يتوّج بمنحه الإجازة العالمية –وقد أشرنا إليها سابقا– وهي التي تجعله حلقة في سلسلة العلماء الذين حملوا هذه الأمانة عبر الأجيال المتواصلة من المعلم الأول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم.
- الجانب النسائي:
لم يكن في الآصفية اهتمام بتعليم المرأة، فقد كان هذا النظام مقصورا على الذكور طيلة الفترة التي عاصرها الباحث، لكن ما ينبغي الإشارة له هنا أن الشيخ خليل الفياض شيخ الآصفية كان قد وجّه بإقامة دار لتعليم القرآن الكريم خاصة بالنساء وقد وقع اختيار الشيخ على والدة الباحث للقيام بهذا الدور، وقد شهد بيتنا المتواضع دورات لأجيال متعددة من النساء كلهن تعلمن القرآن وتعلمن معه المعاني الإيمانية والسلوكية الجميلة، وكانت الوالدة تعقد درسا في الصباح وآخر بعد العصر تقسّم فيه الطالبات على قسمين، وقد سبقت هذه الدار دار أخرى في كبيسة بتوجيه من الشيخ عبد الستار وكانت شقيقة الشيوخ الكرماء الشيخ عبد الله حسين والشيخ مكي حسين والشيخ سعيد حسن هي التي تقوم بتعليم القرآن وكانت والدة الباحث إحدى تلامذتها.
الأفكار المستوحاة من البحث
في نظرة تفاعلية بين تجربة الآصفية التي تناولها هذا البحث بأبعادها المختلفة وبين رؤية المشروع وسماته وأهدافه فإنه يمكن تحديد هذه النظرة التفاعلية في الأفكار الآتية :
أولا :الصورة الذهنية للمشروع :
يمكن تصور المشروع كنقاط مضيئة في فضاء الأمة الواسع ، يقوم على مؤسسات تربوية قابلة للانتشار والتكرار في أكثر من بلد ، تهدف هذه المؤسسات إلى:
- رفد المجتمع بالقيادات المجتمعية المهابة التي تحظى بثقة المجتمع علميا وسلوكيا ومهاريا (القدوة الحسنة).
- أن تكون هذه المؤسسات مثالا يحتذى لتشجيع المؤسسات القائمة على محاكاتها وتقليدها ولو في بعض الجوانب[61].
إن هذه الصورة تتميز بكونها صورة قابلة للتطبيق، كما أنها توفر إمكانياتها الذاتية لتحقيق أهداف محددة تتناسب مع هذه الإمكانيات، في حين تسعى بطريقة غير مباشرة لاستنهاض الطاقات الكامنة في الأمة.
إن سد حاجة الأمة من العلماء المتخصصين في كل الجوانب والمجالات هدف عظيم لكنه غير قابل للتطبيق، كما أن العمل على تحقيق هذا الهدف في بلد معين هو الآخر ليس بالسهل طالما توجد مؤسسات رسمية كبيرة تخرج أجيالا متتابعة وإن كانت هذه الأجيال ضعيفة ولا تلبي الطموح، لكن الفراغ الحقيقي هو أن كل هذه المؤسسات العلمية الرسمية لم تتمكن بل لم تضع في حسابها تخريج (قادة مجتمع مهابين) وبالتالي فإن بصمة المشروع الحقيقية ستظهر في ملء هذا الفراغ. آنذاك ستتوفر فرصة كبيرة للمقارنة بين التجربتين مما يمهد الطريق لمحاكاة التجربة الناجحة وتقليدها.
ثانيا : السمات المنهجية :
من الممكن صياغة المنهج الذي يقوم عليه المشروع بامتدادين: أفقي وعمودي، أما الأفقي فيتوزع على المساحات الآتية:
- المساحة المعرفية: ويكون الخيط الناظم في كل مقرراتها (الإعداد المعرفي لقادة المجتمع) ويكون التركيز فيها على:
- علوم الآلة كاللغة العربية واللغة الأنجليزية إضافة إلى لغة ثالثة تناسب البيئة والمكان الذي يتوقع من الخريج أن يعمل فيه، وكذلك علم المنطق، ووسائل البحث الحديثة، والحاسب الآلي.
- العلوم الإسلامية (أصول الدين وشريعة ونظم حياة ودعوة)
- علوم إدارة المجتمع (التاريخ والسياسة والإدارة)
- المساحة القيمية والسلوكية : ويكون الخيط الناظم لمفرداته (إعداد القدوة الحسنة والمهابة) ويتم التركيز فيها على :
- ترسيخ الهوية العربية والإسلامية.
- الولاء للأمة الإسلامية وتاريخها ورموزها.
- الالتزام بالعبادة المفروضة والمنافسة في النوافل.
- الالتزام بأخلاقية القائد المتواضع المهاب.
- تنمية الشورى والعمل بروح الفريق.
- المساحة المهارية: ويكون الخيط الناظم لمفرداتها (بناء الشخصية المؤثرة في المجتمع) ويتم التركيز فيها على :
- بناء الشخصية القوية والمتوازنة.
- تنمية الشجاعة الأدبية والقدرة على التعبير عن الذات.
- التدريب على مهارات الاتصال والتواصل.
- التدريب على إدارة الفعاليات المختلفة و المؤسسات المتخصصة
- استخدام التقنيات الحديثة في البحث والتواصل.
- التعامل الهادف مع وسائل الإعلام.
أما الامتداد العمودي فيمكن توزيعه على أربع مراحل:
الأولى: مرحلة الاختبار والإعداد الأولي، وتتضمن هذه المرحلة فحص المتقدمين وتهيئة المقبولين مبدئيا وتقويم فترة التهيئة هذه، بحيث يترجح لدى القائمين على المشروع جاهزية المتقدم لأن يكون قائدا مؤثرا في مجتمعه.
الثانية: مرحلة التأسيس ويتم فيها التكوين الأساس لشخصية القائد من المساحات الأفقية المتقدمة (المعرفية والقيمية والمهارية) بالمستوى الموحد لجميع الطلاب، وهذا هو القاسم المشترك بين كل الطلاب.
الثالثة: مرحلة التخصص، والتي يتم فيها توزيع الطلاب لإعدادهم إعدادا يتناسب مع أهداف المشروع ولا يغفل استعدادات الطلاب ورغباتهم ، فيكون عندنا:
- قيادة إسلامية تخصص (إفتاء وقضاء)
- قيادة إسلامية تخصص (فكر وفلسفة)
- قيادة إسلامية تخصص (تاريخ ومجتمع)
- قيادة إسلامية تخصص (سياسة)
- قيادة إسلامية تخصص (إدارة مؤسسات)
المرحلة الرابعة : ما بعد التخرج وهي مرحلة القيادة الفعلية للمجتمع، حيث لا يصح أن يترك هؤلاء الخريجون وشأنهم فأهداف المشروع السامية لا تتحقق إلا في هذه المرحلة ، ويمكن وضع استراتيجية من نقطتين:
- تشكيل رابطة فعالة للخريجين لها مقر معلوم وتديرها أمانة عامة منتخبة بشكل دوري، وتمارس أنشطة مباشرة وتشرف على أنشطة أخرى بطريقة غير مباشرة.
- بناء المؤسسات القادرة على توظيف طاقات هؤلاء الخريجين لتحقيق أهداف المشروع على أن تزود هذه المؤسسات بكل ما من شأنه إظهار هذا المشروع ومخرجاته كنموذج تربوي يحظى بالمهابة والإعجاب.
وبهذا يعتق المشروع من ربقة الاعتراف أو الاعتماد الرسمي.
ثالثا – الضوابط الإدارية: ويمكن اختصارها بالنقاط الآتية:
شروط القبول: يشترط في المتقدم:
- حسن السمعة والسلوك له ولأسرته، ويتم هذا بشهادة اثنين من الثقاة مع عدم وجود شاهد مخالف.
- لضمان التجانس بين الطلاب يتم تحديد عمر المتقدم أن لا يقل عن 12 سنوات مثلا ولا يزيد على 14.
- أخذ تعهد خطي من الطالب بالعمل في خدمة المشروع بعد التخرج بما لا يقل عن سني الدراسة.
- اجتياز المرحلة الأولى (مرحلة الاختبار والإعداد الأولي).
النظام:
- يلزم الطالب بالمكوث في (المؤسسة التربوية) طيلة اليوم ولا يسمح له بالخروج إلا ليوم واحد في الأسبوع، وإجازات الساعات المحددة يقدرها المشرف، ويمنح الطلاب إجازة منتصف الفصل (أسبوع واحد) وإجازة منتصف العام (أسبوعين) وإجازة نهاية العام (شهر واحد) إضافة إلى إجازتي العيد.
- تحدد المرحلة الأولى بفصل واحد (خمسة شهور)، بينما تتكون المرحلة الثانية من أحد عشر فصلا، أما المرحلة الثالثة فتتكون من ثمانية فصول، وعلى هذا يلزم توزيع المنهج على 10 سنوات.
- يحجز لكل محاضرة ساعتان من الجدول اليومي، ويمكن للمدرس أن ينهي المحاضرة قبل ذلك بحسب الموضوع والظرف، على أن تكون المحاضرة الأولى بعد صلاة الفجر مباشرة.
- يلزم الطلاب بالقراءة المكتبية الحرة، وتقديم قائمة بأسماء الكتب ويجري اختبار كل طالب وفق القائمة التي قدمها.
- يلزم الطلاب بزي موحد يتناسب مع الدور المناط بهم مستقبلا.
- توفر المؤسسة الطعام والشراب والكسوة والرعاية الصحية والخدمات الضرورية الأخرى.
- درجة النجاح في الاختبارات المعرفية والمهارية لا تقل عن 80% أما في الجانب القيمي والأخلاقي فيكون وفق سلم الإنذارات والمخالفات التي يسجلها المرشد التربوي في ملف الطالب بناء على ملاحظاته الخاصة أو شكاوى الطلاب أو الشكاوى المقدمة من المجتمع، وهنا لابد من وضع سلم لدرجة الإنذار وعدد الإنذارات ونوعية العقوبة التي تصل إلى الطرد.
- يقرن بنتيجة التخرج إجازة علمية في تخصص ما أو أكثر بسند متصل.
- يحمل الخريج لقبا علميا مميزا مثل (العالم الداعية) أو (العالم المفكر) أو (العالم الحجة) ويثبت هذا اللقب في وثيقة التخرج، ويوقع على الوثيقة كل الأساتذة الذين قاموا بتدريسه، أو نخبة منهم.
- يتم توزيع المناوبة على الأساتذة والمشرفين طيلة اليوم داخل المؤسسة.
رابعا : التفاعل مع المجتمع: ويمكن تلخيص هذا التفاعل بالنقاط الآتية:
- تعزيز الثقة مع الجهات الرسمية والحكومية.
- التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية في المجتمع.
- التواصل مع وسائل الإعلام.
- التعاون مع المؤسسات الخيرية في المجتمع.
- الاستفادة من الرموز العلمية والشعبية لدعم المشروع.
- فتح مجالات للتدريب وتنمية المهارات في أوساط المجتمع الرسمي والشعبي.
- الاستفادة من المناسبات التاريخية والمجتمعية للتعريف بالمشروع وإبراز نجاحاته الميدانية.
- التعاون مع أسر الطلاب والتشاور المستمر معهم وإطلاعهم على مستوى أبنائهم وطلب دعمهم المستمر ومساندتهم.
خامسا : شكل المبنى الذي يضم المشروع: وهنا يمكن تدوين الأفكار الآتية:
- أن يتصل المبنى بمسجد جامع كبير ومفتوح للنشاطات الدينية والدعوية العامة.
- أن يتصل المبنى بسكن مناسب للطلاب والمشرف المناوب، ويضم السكن مطعما وحمامات كافية وصيدلية الإسعافات الأولية.
- أن يضم المبنى إضافة إلى قاعات الدرس والمكاتب الإدارية مكتبة عصرية شاملة تضم أمهات الكتب والمصادر الأساسية للعلوم الإنسانية المختلفة إضافة لأدوات البحث الإلكتروني.
- أن تكون قاعة الدرس صالحة لعمل حلقات ومجاميع نقاشية، ومزودة بوسائل الإيضاح الحديثة.
- أن يضم المبنى صالة ألعاب رياضية وساحة للجري والكرة المناسبة.
- أن يكون شكل المبنى يوحي برسالته وهويته.
- أن يتمتع المبنى بالسعة والهدوء.
تم بحمد الله وفضله
المصادر
- الإجازة العالمية رقم (48) نسخة الباحث، والموقعة من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي.
- أدب المعلم تجاه المعلم في تأريخنا العلمي، الدكتور عبد الحكيم الأنيس، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي /إدارة البحوث، الطبعة الأولى 1429هـ – 2008 م.
- أناشيد المقاومة ، الدكتور محمد عياش الكبيسي، المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية،الطبعة الأولى،1428هـ -2008 م.
- بلاد شنقيط المنارة والرباط، الخليل النحوي، تونس /المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1987م.
- تفسير ابن كثير، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1421 هـ – 2001 م.
- جوانب من الواقع التربوي المعاصر، منى بنت عبد الله بن داود، (رسالة ماجستير) الطبعة الأولى 1417 هـ – 1996 م.
- الحاج محمد عبد الله الفياض في ركاب الصالحين، الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي، مطبعة سليمان الأعظمي، بغداد 1972.
- خطة الدراسة من المرحلة الأولى إلى المرحلة السادسة في المدارس الدينية (مخطوطة ) المعمول بها حاليا.
- الخطيب (مجلة شهرية إسلامية تصدر في مدينة الفلوجة) العدد 32 1430هـ.
- ديوان الإمام الشافعي،
- سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، بيت الأفكار الدولية، بدون تاريخ.
- سنن البيهقي الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، دار الباز /مكة المكرمة ، 1414 هـ 1994م.
- سيكولوجية التعلم ونظريات التعليم، جابر عبد الحميد جابر، دار النهضة العربية / القاهرة، 1400 هـ 1980 م.
- الشيخ حامد الملا حويش حياته وآثاره، محمد الملا حويش، مطبعة الأمة، بغداد 1993 هـ – 1973 م.
- الشيخ عبد الستار الملا طه الكبيسي المصلح الديني والاجتماعي الكبير، حامد عطيوي الجهجاه الكبيسي، دار الأنبار ،1999 م.
- الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي، الدكتور خالد أحمد الصالح، بغداد 1424 هـ – 2004 م.
- الشيخ المجاهد إبراهيم رحيم الهيتي الفقيه والمربي ، الدكتور عبد الستار الهيتي، (بحث لم ينشر بعد) أرسل لي الباحث مشكورا نسخة الكترونية منه.
- صحيح مسلم بشرح النووي، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية ،بون تاريخ.
- العلامة الشيخ أمجد الزهاوي شيخ علماء العراق المعاصرين، محمد محمود الصواف، دار الاعتصام 1988م.
- الفكر التربوي والنفسي عند الغزالي، د.كفاح يحيى العسكري، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 2000 م.
- فقه أهل العراق وحديثهم، العلامة المحقق محمد زاهد الكوثري، تحقيق الدكتور محمد سالم أبو عاصي، دار البصائر، الطبعة الأولى 1430هـ 2009م.
- القصيدة النبوية وشعراؤها المعاصرون في العراق، الدكتور بهجت عبد الغفور الحديثي، الإمارات العربية 2001 م.
- مشروع إحياء نظام تربوي أصيل (وثائق متنوعة لم تنشر بعد)
- معركة الفلوجة هزيمة أمريكا في العراق، أحمد منصور، دار الكتاب العربي ، بيروت / لبنان ، 2008 م.
- ملامح فكرية عن المدرسة الآصفية في الفلوجة، الدكتور ياس حميد السامرائي، ( بحث لم ينشر بعد)
- نشرة المنتدى العلمي والثقافي في الفلوجة، 1424 هـ- 2003 م.
- نظريات المناهج التربوية، الدكتور علي أحمد مدكور، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى 1417هـ- 1997م.
- هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس، الدكتور ماجد عرسان الكيلاني، دار الفرقان، عمّان / الأردن ، 1419 هـ – 1998 م.
- وثائق ورقية أصلية يحتفظ بها متعلقة بالآصفية.
- ويكيبيديا الموسوعة الحرة ar.wikipedia.org
- ملتقى أهل الحديث www.ahlahdeeth.com
- موقع العارف بالله الشيخ محمد النبهان. alsayed-alnabhan.com
- الأمة الوسط، الموقع الرسمي للشيخ الدكتور عبد الملك السعدي alomah-alwasat.com
- موقع الدكتور طه جابر العلواني alwani.org
[1] أنظر البحث الذي خصصته الباحثة منى بنت عبد الله بن داود “ضعف طلبة كليات العلوم الشرعية” في كتابها جوانب من الواقع التربوي المعاصر ص128 – 137.
[2] إشارة لحديث “إن العلماء ورثة الأنبياء” الذي رواه أبو داود وغيره ، سنن أبي داود / كتاب العلم، رقم الحديث 3641. وكانت هذه العبارات من أشد دوافع التعلم بخلاف التعليم المعاصر حيث إن ” إثارة دوافع التلاميذ من أهم المشكلات التي تواجه المعلمين، وكسل بعض التلاميذ وعدم إقبالهم على التحصيل والتماسهم المعاذير …) سيكولوجية التعلم ونظريات التعليم للدكتور جابر عبد الحميد جابر، ص 24 .
[3] إشارة لحديث جبريل وفيه ” فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ” صحيح مسلم بشرح النووي ،كتاب الإيمان، ج1ص 157 .
[4] من الإجازة العالمية التي نالها الباحث عن شيخه عبد الملك عبد الرحمن السعدي.
[5] ذكر المؤرخون أن عدد من استوطن الكوفة وحدها من الصحابة بلغ ألفاً وخمسمائة منهم سبعون بدرياً، في حين لم ينزل في مصر كلها من الصحابة إلا ثلاثمائة، أنظر فقه أهل العراق وحديثهم للعلامة المحقق محمد زاهد الكوثري ص40.
[6] نشرة المنتدى العلمي والثقافي في الفلوجة سنة 2009م.
[7] يبدو أن اسم (آصف) قد جاء من الذي عنده علم من الكتاب صاحب سليمان الذي جاء بعرش بلقيس، حيث تذكر كثير من الروايات أن اسمه كان آصف بن برخيا، أنظر سنن النسائي الكبرى ج6 ص 288 . وتفسير ابن كثير ج 2 ص 982. وكان شائعا في الآصفية أنها مشتقة من هذا الاسم.
[8] انظر ويكيبيديا الموسوعة الحرة مادة (آصفية).
[9] بحسب ما رواه لي الشيخ عبد الملك السعدي .
[10] محمد الملا حويش /الشيخ حامد الملا حويش : حياته وآثاره ص19.
[11] جاء في نشرة المنتدى العلمي والثقافي في الفلوجة سنة 2009 ما نصه (لكنها –أي الآصفية- تعرضت لأضرار بعد أحداث الفلوجة الثانية وكان من المفترض ترميمها وإعادتها من جديد ، ولكن فوجئ أهل الفلوجة وطلاب العلم ومحبو الآصفية بهدمها وإزالتها)
[12] حامد عطيوي الكبيسي/ الشيخ عبد الستار الملا طه الكبيسي المصلح الديني والاجتماعي الكبير ص44
[13] أنظر بلاد شنقيط المنارة والرباط للأستاذ خليل النحوي ص51، حيث ذكر بدايات تأسيس المدارس الإسلامية في العراق من مدرسة عبد الله بن مسعود والحسن البصري إلى مدرسة أبي حنيفة ثم المدرسة النظامية ثم المستنصرية، وقد مر معنا أن الآصفية أنشئت في الأرض التابعة للمستنصرية، ربما أن الوالي العثماني الذي أراد تجديد المستنصرية رأى أيضا الحفاظ على بناء المستنصرية كمعلم تاريخي كبير.
[14] أنظر معركة الفلوجة هزيمة أمريكا في العراق، للإعلامي أحمد منصور.
[15]د خالد أحمد الصالح / الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي :حياته وجهوده ص 34.
[16]كان الاحتفال بمولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم الوسيلة المناسبة لتجميع الناس وتوعيتهم ولذلك كان الدعاة يهتمون بهذه المناسبة التي تستمر الأنشطة الدعوية فيها لأكثر من شهر، وكانت هذه الوسيلة المتاحة التي لا تثير حساسية النظام الحاكم آنذاك.
[17] مثل مدرسة الرمادي ومدرسة الخالدية ومدرسة كبيسة ، وكل هذه المدارس التي درس الباحث فيها أو زارها مرارا متصلة بالمسجد الكبير في المدينة، وقد رأيت فيها غاية التفاعل والتكامل بين المدرسة والمسجد.
[18] ديوان الإمام الشافعي ص21.
[19] لقد كانت الآصفية والمدارس المتفرعة منها على صلة برجال التصوف من أهل العلم، وكان للشيخ النبهاني حضور متميز في هذه المدرسة، تجدر الإشارة أن للشيخ النبهاني مدرسة شبيهة بالآصفية في حلب، أنظر موقع الشيخ النبهاني الالكتروني . وكتاب السيد النبهان العارف بالله للشيخ هشام عبد الكريم الآلوسي.
[20] يقول الشيخ حامد عطيوي : ” ولقد زار المدرسة صاحب الفضل الأول على منشئها الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي والتقى بالطلاب يسألهم ويمتحنهم من صلاة العشاء وحتى صلاة الفجر ” الشيخ عبد الستار الكبيسي المصلح الديني والاجتماعي الكبير ص 44.
[21] يقول الدكتور خالد الصالح :” وللشيخ أيوب – رحمه الله تعالى -الفضل في تأسيس المدرسة الدينية في الخالدية، وهي مدرسة أسست على غرار المدرسة الآصفية في الفلوجة، وبقي فيها مدرسا ومعلما ومشرفا إلى أن وافته المنية” الشيخ عبد العزيز السامرائي حياته وجهوده العلمية ص76.
[22] وقد أكد هذه المعلومات الدكتور خالد الصالح ، المصدر السابق ص 91.
[23] يقول الدكتور خالد الصالح :” بعد أن عمر الشيخ مسجده بالعمارة الربانية انطلق في بناء المساجد ونشرها في الأحياء الجديدة والقرى والأرياف ،ومن المناسب أن نذكر أنه عند مجيئه إلى الفلوجة لم يكن فيها سوى الجامع الكبير ومدرسته فحث الناس وشد عزائمهم…” الشيخ عبد العزيز السامرائي وجهوده العلمية ص35.
[24]يقول الشيخ حامد عطيوي الكبيسي وهو يروي موقفا من عشرات المواقف المعبرة :” في أحد الأيام القارصة البرد وقد جمع العمال الطين لإلقائه على سطح المسجد … حيث لم يستطع أحد من العمال الدخول إلى وسط الطين لتلبيسه …فخلع القدوة المجاهد عمامته وعباءته وشمر عن ساعده ودخل وسط الطين بأقدامه…” الشيخ عبد الستار الكبيسي المصلح الديني والاجتماعي الكبير ص 43.
[25] وهذا الانتماء القيمي مكرس في الإجازة نفسها ولنقرأ هذا النص : “فعاهدته على التوبة الخالصة لله تعالى، ودوام ذكره بظاهره وباطنه …وأن يكون من الأخلاق الكريمة في المحل الأعلى، ومن الأفعال الحميدة بالمكان الأسنى” من إجازة الباحث ص2 .
[26] ولذاك جاء في الإجازة العالمية :” فأجزت له بتدريس العلوم النقلية ونشر فوائدها ، وتقرير الرسوم العقلية وبسط موائدها ” من إجازة الباحث ص3.
[27] أنظر الشيخ عبد العزيز السامرائي وجهوده العلمية للدكتور خالد الصالح ،ص115- 154.
[28] الحديث … وقد تقدم تخريجه
[29] وهذا السمت يؤكد العمق التربوي للآصفية والذي يربطها بمدارس العراق الأولى، يقول الدكتور ماجد الكيلاني: (إن التحليل الدقيق للنظام التربوي الذي طبقه عبد القادر – أي الجيلاني – يكشف عن تأثر كبير بالمنهاج الذي اقترحه الغزالي، فقد وضع الشيخ عبد القادر منهاجا متكاملا يستهدف إعداد الطلاب والمريدين علميا وروحيا واجتماعيا، ويؤهلهم لحمل رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) هكذا ظهر جيل صلاح الدين ص215، تجدر الإشارة أن المدرسة القادرية لازالت قائمة في بغداد.
[30] إن هذا النمط هو الذي يشكل القدوة التي هي من أهم الأساليب أثرا في نفس المتعلم كما يرى ذلك الإمام الغزالي ، الفكر التربوي والنفسي عند الغزالي / كفاح العسكري ص184.
[31] يقول الدكتور عبد الستار الهيتي: “تكالبت عليه قوى الشر، واتهموه بالتحريض ضد الدولة، وأصدروا عليه قرارا بالسجن المؤبد، ثم تم تخفيفه إلى السجن ثلاث سنوات، وعزلوه عن الوظائف الحكومية” الشيخ المجاهد إبراهيم رحيم الهيتي (مخطوط) ص8.
[32] يقول الشيخ حامد عطيوي :”كان رحمه الله يحب الطلاب ويعطف عليهم، ويعتبرهم أبناءً له، ويجالسهم و يؤاكلهم …ويقضي أكثر أوقاته معهم” الشيخ عبد الستار الكبيسي…ص45. وهذا يذكرنا بالشيخ عبد القادر الجيلاني في مدرسته القادرية في بغداد حيث أنه (كرس معظم أوقاته للمدرسة فكان لا يخرج منها إلا يوم الجمعة) هكذا ظهر جيل صلاح الدين ص 215
[33] الشيخ الإمام أمجد الزهاوي أكبر من أن يعرف ، وحسبنا أن ننقل ما قاله فيه الشيخ الصواف :”رحمك الله أبا العلماء،وإمام الفقهاء، وسيد الزهاد العظماء،وقائد المجاهدين …” العلامة المجاهد الشيخ أمجد الزهاوي شيخ علماء العراق المعاصرين ص3 ، وقول العلامة عبد الكريم زيدان فيه :” ما رأت عيني مثله على كثرة من رأيت …لقد كان رحمه الله أمة في الإخلاص ” المصدر السابق ص42-43.
[34] الشيخ اللافي من شيوخ الرمادي ووجهائها المعروفين ، عرف بحبه لطلاب العلم وتواضعه لهم ، وغيرته الشديدة على الدين.
[35] يقول الدكتور عبد الستار الهيتي :” ولكن أبناء الفلوجة الأماجد ثارت ثائرتهم وارتفعت حميتهم الإيمانية ليقفوا وقفة رجل واحد مطالبين بالإفراج عن شيخهم المجاهد، وتحت ضغط مواقف أولئك الرجال لم يجد النظام بدا من التراجع عن قراره ليحيلوه ثانية إلى محكمة الثورة “ثكنة الأحكام العرفية” لتصدر عليه حكما بالسجن مدة ثلاث سنوات ” الشيخ المجاهد إبراهيم الهيتي…ص13
[36] الشيخ الدكتور عبد الجليل الفهداوي له عدد من المؤلفات منها:خوارق العادات عند المسلمين ،و العقيدة الإسلامية في مواجهة التنصير و أثر القرآن في تغيير الحياة الاجتماعية.
[37] وهذه الصلة من مشجعات التعليم ، يقول الدكتور جابر عبد الحميد جابر : (يتقبل التلميذ آراء واتجاهات من يحب من الناس على نحو أسرع من تقبله للآراء التي يقول بها أناس لا يتقبل شخصياتهم) سيكولوجية التعلم ونظريات التعليم ص 168 . ولذلك حرص الإمام الغزالي “على إقامة علاقة عاطفية متينة بين العالم والمتعلم ” الفكر التربوي عند الغزالي ص184.
[38] يرى الإمام الغزالي أن الإرشاد والتوجيه والتعرف على الدوافع الكامنة وراء السلوك أولى من تأنيب التلميذ ومعاقبته ، أنظر الفكر التربوي والنفسي عند الغزالي ص 184.
[39] الدكتور خالد الصالح ، الشيخ عبد العزيز السامرائي وجهوده العلمية ص58.
[40] يقول الدكتور عبد الستار الهيتي :”تميز الشيخ الهيتي بصياغته التربوية …رغم ما رافق تلك الصياغة من شدة وضغوط في بعض الأحيان، لكن تلك الصياغة آتت ثمارها ، وتخرج من خلالها مجموعة من الطلاب المتميزين …وقد بلغ عدد الطلاب الذين تتلمذوا على يديه أكثر من ثلاثمائة طالب” الشيخ المجاهد إبراهيم الهيتي …ص11.
[41] الدكتور خالد الصالح ، الشيخ عبد العزيز السامرائي حياته وجهوده العلمية ص 42.
[42] يقول الدكتور خالد الصالح : ” وكان المتبع في مدرسته في التدريس ما يشبه الإعادة لأنه لا يمكن أن يدرس الشيخ جميع الطلاب وعلى شتى المستويات في زمن واحد ، فكان يدرس الطبقة العليا من الطلاب .ثم كان له مساعدون في التدريس من تلاميذه ” الشيخ عبد العزيز السامرائي ص60
[43] ألف الشيخ عبد الملك السعدي كتابا أسماه (الحاج محمد الفياض في ركاب الصالحين) والكتاب منشور في العراق ومما جاء فيه : “إذا حضر الحاج محمد الفياض إلى المدرسة والشيخ يلقي الدروس على الطلاب توقف الشيخ عن الدرس وقال : نستمع إلى كلام الحاج محمد فإنه كلام قريب العهد بربنا لأنه ينطق بنور الله ويتحدث بالله” ص 45.
[44] وهذا أهم ما يميز التعليم الأصيل عن التعليم الوظيفي ولذلك “اعتبر الغزالي نظام التعليم القائم نظاما فاسد الأهداف والغايات لا يركز على خدمة أهداف الرسالة الإسلامية، وإنما غايته تخريج موظفين للدولة… ممن وصفهم الغزالي بأنهم علماء دنيا لا علماء آخرة” هكذا ظهر جيل صلاح الدين ص149.
[45] للشيخ عبد الحكيم رسالة ذات صلة مسيسة بهذا الفصل تحت عنوان (أدب المتعلم تجاه المعلم)
[46] لقد تعرض كثير من شيوخ الآصفية وخريجوها للاعتقال مثل الشيخ عبد العزيز السامرائي والشيخ إبراهيم الهيتي والشيخ عبد الملك السعدي وشقيقه الشيخ عبد القادر ، والشيخ مكي حسن الكبيسي ، ود . محمد عياش الكبيسي. كما تعرض كثير منهم للطرد أو المنع من ممارسة وظائفهم في التدريس أو الخطابة ، واستبدالهم بمدرسين بعثيين من خريجي المدارس الحكومية وكان غالبهم لا صلة له بالدين ولا بسمت وأخلاق المدرسة.
[47] لقد غيرت الحكومة اسم المدرسة إلى (المعهد الإسلامي) ثم نقلت المعهد بعيدا عن المسجد، وقلصت سنوات الدراسة من 12 سنة إلى ثمان ثم إلى ست ثم إلى ثلاث، ثم عادت تحت الضغط وبعد الحرب العراقية الإيرانية ورفع شعار الحملة الإيمانية لتعيدها إلى ست سنوات وتعيد إليها بعض الشيوخ المطرودين.
[48] لقد استفدت أسماء هذه المؤلفات العلمية بالاتصال الشخصي مع المؤلفين ، وقد جاء قسم منها في: الشيخ عبد العزيز السامرائي حياته وجهوده، وفي موقع ملتقى أهل الحديث.
[49] وردت تراجم هؤلاء في كتاب ” الشيخ عبد العزيز السامرائي حياته وجهوده العلمية ” للدكتور خالد الصالح وفي كتاب ” الشيخ المجاهد إبراهيم الهيتي ” للدكتور عبد الستار الهيتي ، وفي بعض المواقع الالكترونية الشخصية مثل موقع الأمة الوسط للشيخ عبد الملك السعدي ، وموقع الشيخ الدكتور طه جابر العلواني ، إضافة إلى تجربة الباحث الشخصية حيث هو على معرفة شخصيه بأغلبهم .
[50] – يقول الدكتور خالد الصالح : ( يقرأ الطالب في الصرف جداول الأمثلة التي هي من ترتيب الشيخ نفسه ، وفي الفقه متن الغاية والتقريب لأبي شجاع وعليها تعليقات وتفسير الغريب من كلمات الشيخ نفسه ) الشيخ عبد العزيز السامرائي وجهوده العلمية ص 59
[51] يقول الدكتور أحمد محمد السروان : (وأما منهج شيخنا رحمه الله في تدريس العلوم فكان يختار من المادة الكتاب الأساس ثم يتوسع في تسلسل هرمي إلى ما هو أوسع منه وهكذا إلى أعلى كتاب وأرقاه في ذلك العلم … على عكس ما نراه اليوم … ولا شك أن طريقة الشيخ القديمة كانت أنفع وأوسع … فهي التي خرجت أجل العلماء الأعلام ) مجلة الخطيب ، صفحة ورثة الأنبياء ، والمجلة تصدر في مدينة الفلوجة منذ سنة 2004 م .
[52] يقول الشيخ حامد الكبيسي: (وكان يحث الطلاب على تعلم علم الآلة ويعتبرها طريقة للوصول إلى العلوم الشرعية، وهذا المنهج السديد ذو فاعلية في تحصيل سائر العلوم الإسلامية، لأن اللغة التي كتبت بها تلك العلوم لغة ذات فقه وأسرار ودلالات، ومن دون معرفة حقائق تلك اللغة وكيفية تراكيبها يكون الوصول إلى الفهم السديد صعب المنال) الشيخ عبد الستار الكبيسي المصلح الديني..ص 46.
[53] روي عن الإمام مالك أنه قال : (وجّه إلي هارون الرشيد يسألني أن أحدثه ، فقلت : يا أمير المؤمنين إن العلم يؤتى ولا يأتي، قال : فصار إلى منزلي، فاستند معي إلى الجدار فقلت: يا أمير المؤمنين إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، قال : فجلس بين يدي، قال فقال لي بعد مدة: يا أبا عبد الله تواضعنا لعلمك فانتفعنا به، وتواضع لنا علم سفيان بن عيينة فلم ننتفع به…) أدب المتعلم تجاه المعلم ص36.
[54] جدير بالذكر هنا أن هذه الأخوة تجاوزت الحدود القطرية والقومية، يقول الشيخ الدكتور ياس حميد السامرائي وهو أحد خريجي الآصفية: (لقد عشت في هذه المدرسة مع الشيخ طه حمدون سالم السامرائي، واحمد أبي ذر التركي ، وسليمان دكري الأفريقي، ومحمد الثاني إبراهيم النيجيري، ومصطفى موسى النيجيري كما عشت مع رياض إبراهيم الدوري…) من بحث له مخطوط بعنوان “ملامح فكرية عن المدرسة الآصفية” ص2.
[55] يقول الدكتور خالد الصالح : ( وكان للطلاب زي خاص بهم يلبسونه ولا يجوز إطلاقا أن يتنازلوا عنه وبخاصة لبس العمامة ) الشيخ عبد العزيز وجهوده …ص 61
[56] يتميز التعليم الإسلامي الأصيل بجمعه بين المعرفة والسلوك ، يقول الدكتور علي أحمد مدكور : (منهج التربية في الإسلام لا توجد فيه تلك الفجوة المعهودة بين العلم والعمل، أو بين المثال والواقع، أو بين النظرية والتطبيق… لا بد أن تكون المناهج الدراسية نظرية وعملية معا) نظريات المناهج التربوية ص152.
[57] صنف بنجامين بلوم الأهداف التربوية إلى أهداف معرفية ووجدانية وحركية مهارية، أنظر نظريات المناهج التربوية ص168، ويظهر السبق للتعليم الإسلامي الأصيل من خلال تجربة الآصفية هذه.
[58] قام بنشر الكتاب المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية 2008م
[59] يحتفظ الباحث بوثائق أصلية يطلب فيها شيخ الآصفية من مديرية أوقاف منطقة بغداد صرف الراتب الشهري للطلاب ، وتمديد إقامة الطلاب الوافدين …الخ
[60] جاء في نشرة المنتدى العلمي والثقافي في الفلوجة سنة 2003 (نظام التعليم في الآصفية …يعتمد على اجتياز اثني عشر صفا وكان الدوام يبدأ فيها من صلاة الفجر إلى ما بعد العشاء).
[61] يقول الدكتور ماجد الكيلاني عن المدرسة القادرية ودورها في نهضة الأمة : (تأسست هذه المدرسة في العاصمة بغداد وتسلمت زمام القيادة لحركة الإصلاح والتجديد ، ولقد ركزت نشاطها في عدة ميادين : الأول : تخريج القيادات اللازمة … الثاني : تنسيق العمل الإسلامي بين مدارسة المختلفة ، الثالث : وضع مناهج العمل التربوي ) هكذا ظهر جيل صلاح الدين ص 202.