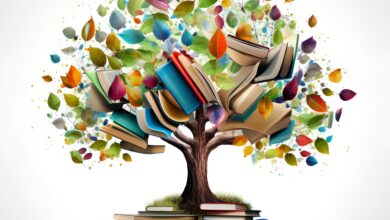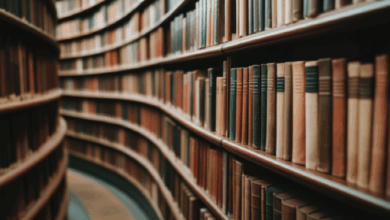03- النظام التربوي الأصيل: الآفاق والتحديات
بحث مقدم لصالح مشروع إحياء نظام تربوي أصيل
أنجز في: 14 محرم1431ﻫ/31 ديسمبر 2009م.
جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمشروع ومسجلة رسميا ومحمية بموجب القانون.
فهرس المحتويات
خطة البحث
1- توطئة
يفرض النظام التربوي الأصيل نفسه على الأمة المسلمة من منطلق حاجتها الملحة إلى الاستقلال الثقافي، كأساس لتعبئة الذات، واستنفار مكنوناتها وطاقاتها الإبداعية، في اتجاه التميز، باعتبارها رقما متفردا على المستوى الحضاري والإنساني، ذلك بأن مختلف التجارب التربوية التي خاضتها الأمة في منأى عن مرجعية النظام الأصيل، لم يكن لها مناص من السقوط في الإخفاق، لسبب جوهري، هو غربة تلك التجارب عن هوية الأمة وجذورها الحضارية، ومن ثم عجزها عن تحريك مكامنها وقدح زنادها.
إن هذه الحقيقة الصارخة ترسخ في أذهاننا يقينا بحقيقة أخرى، متولدة عنها لا محالة، هي أننا في السياق الحضاري لأمة الإسلام، لا نحتاج فقط إلى تعليم وتربية وكفى، وإنما نحتاج إليهما وفق رؤية خاصة، قائمة على حقيقة الإسلام، معبرة عن مقاصده، وهي ما نصطلح عليه بنظام التعليم الأصيل، لأن ذلك وحده هو الذي يفي بالمقصود، ويحقق المراد، المتمثل في تحقيق حلم الانبعاث وتجديد نسيج الأمة، لاستعادة الزمام والعودة إلى حمل أمانة الشهود من جديد. وأمر آخر لابد من التأشير عليه، هو اعتقادنا الراسخ القائم على أساس موضوعي صريح، في أن الحاجة إلى رفع بنيان ذلك النظام، هي من العمق والسعة، بحيث تشمل الإنسانية جمعاء. ولعل بعدا بارزا من أبعاد الإشكالية المؤطرة لهذا الموضوع، يكمن في كشف النقاب عن أوجه تلك الحاجة، ورفع الوهم والالتباس، الذي عشش في أذهان بعض الناس، حول طبيعة هذه الحاجة إلى النظام التربوي الأصيل، التي تكتسي طابع الضرورة القصوى.
2- إشكالية البحث
تتبلور إشكالية البحث من خلال الأسئلة الآتية:
– إلى أي مدى يملك النظام التربوي الأصيل القدرة على الفعل الإيجابي البناء، في خضم عصر يرفع شعار التقدم والتطوير، وتحقيق أعلى مستويات النماء؟
– ما هي عناصر القوة في هذا النظام، الكفيلة بإقداره على الصمود في معترك الصراع بين النماذج والنظم العاملة في ميدان التربية والتعليم؟
– هل يملك النظام التربوي الأصيل من خلال تجاربه الحالية أن يستجيب لطموحات الأمة إلى استئناف مهمة الشهود الحضاري من جهة، وتحقيق التفوق والظهور على المستوى الإنساني من جهة أخرى؟
– وفي حالة الجواب بالنفي، ما هي الصيغة المثلى التي تؤهل النظام التربوي الأصيل في الأوضاع الراهنة لتحقيق المراد؟
3- الفكرة المحورية للبحث
تتمثل الفكرة المحورية للبحث، في السعي العلمي الموضوعي، للبحث في مدى جدارة النظام التربوي الأصيل بالوجود أولا، وبتمثيله للبديل التربوي الفعال، وسط خريطة النماذج المتنافسة ثانيا، والذي يؤهل الأمة لتجديد نسيجها، وإنجاز النقلة النوعية المنشودة على صعيد إعادة البناء الحضاري؟
4- محاور البحث
سينصب الاهتمام، بإذن الله تعالى، على الإجابة على الإشكالية بجميع أبعدها، من خلال المحاور التالية:
– خصائص العصر الحالي وتوجهاته في المجال التربوي التعليمي:
أ- خصائص المجتمعات المتقدمة المعاصرة.
- مجتمعات قائمة على التعددية الإيديولوجية والسياسية.
- مجتمعات تأخذ بمبدأ اقتصاد السوق والتبادل الحر.
- مجتمعات تأخذ بمبدأ الحرية الفكرية والثقافية.
- مجتمعات ترفع شعار حقوق الإنسان.
- مجتمعات تتبنى شعار الجودة.
- مجتمعات يسودها التنظيم الصارم والثورة الرقمية.
- مجتمعات تخضع لآليات العولمة.
ب- سمات وركائز النظم التربوية المعاصرة ومعالم توجهاتها.
– نظم تربوية قائمة على التدقيق في المدخلات، في ضوء المنشود من المخرجات.
- نظم تعتمد أعلى مقاييس التسيير والتدبير، مستثمرة أفضل ما توصل إليه علم الإدارة.
- نظم تتحرى الجودة في المخرجات، من خلال استعمال أنجع التمشيات.
- نظم تربطها علاقة تبادل الخدمات والمصالح مع مؤسسات المجتمع.
- نظم تسترشد بنتائج البحث التربوي، بقصد التحسين والتطوير.
- نظم تعتمد مبدأ التكوين والتكوين المستمر.
- نظم تقل فيها نسب الأميين.
- نظم يسود فلسفاتها الموجهة المبدأ الليبرالي وتقديس الحريات الفردية.
ج- خصائص المجتمعات العربية والإسلامية المعاصرة.
- مجتمعات تسود فيها أعلى نسب الأمية.
- مجتمعات موسومة بسمة التخلف الاقتصادي والاجتماعي.
- مجتمعات تتعرض للتفكك في شبكة علاقاتها الاجتماعية.
- مجتمعات تدين بالتبعية للآخر.
- مجتمعات تتميز بسلطان التقاليد.
– مجتمعات تحتوي على مخزون قيمي هائل وتراث ثقافي عريق.
د- ملامح الواقع التربوي في العالم العربي.1
- واقع يشكو من اضطراب الرؤية التربوية بسبب تشوش المقاصد وغياب وضوح القصد.
- واقع لا يأبه بخصوصيات الأمة، بل لا يتورع عن انتهاكها لحسابات ضيقة.
- واقع تطبعه الازدواجية اللغوية، وترجيح غير كفة اللغة الأم.
- واقع يعيش آفة الفصام بين علوم الشريعة وعلوم الإنسان والمجتمع.
- واقع لا تشده أواصر قوية لمؤسسات المجتمع ولا يستجيب لحاجاته الحقيقية.
- واقع يفتقر لصرامة التدبير والتسيير.
- واقع يعوزه الضبط في التعامل مع المدخلات والمخرجات على حد سواء.
- واقع لا يعطي للبحث التربوي الجاد اعتباره الحقيقي على مستوى الإنجاز والاستثمار.
- واقع لا يولي كبير اهتمام بالتكوين المستمر، ولا كبير تقدير للكفاءات والتخصصات.
سيسعى البحث إلى مقاربة هذا المحور من خلال العناصر التالية:
* عملية تفكيك، ثم دراسة وتحليل، لعناصره ومكوناته، وذلك من حيث:
- نماذجه واتجاهاته،
- مواده ومدخلاته، أي مناهجه ومقرراته،
- نتائجه ومخرجاته،
- المناخ الاجتماعي والثقافي الذي يكتنفه.
* على مستوى تحديد العلل والاختلالات:
– من حيث مدى التناغم والانسجام، أو عدمهما، بين مكونات المؤسسة التربوية باعتبارها وحدة سوسيولوجية، أي من حيث كونها كيانا قائم الذات داخل المجتمع.
– من حيث مدى التناغم والانسجام، أو عدمهما، بين المؤسسة التربوية والنظام التربوي من جهة، وبين خصائص المجتمع العربي والإسلامي، واحتياجاته من جهة أخرى.
– من حيث صراع وتنازع القيم الكامنة في ثنايا النظام التربوي السائد، أو طبيعة المنظومة القيمية المهيمنة عليه. وهذا يقتضي رصد وتعيين القيم المتحركة، أو السابحة في سديم النظام التربوي السائد.
- من حيث الفلسفة أو الفلسفات التربوية التي تحكمه وتوجهه.
- من حيث الغايات التي ترسم حركته ومساره.
- من حيث الطرق والتقنيات المتبعة في التدريس.
- من حيث فلسفات وبرامج التكوين المعتمدة في مراكز التكوين، أو كليات التربية.
- من حيث لغة التعليم، وطبيعة التعامل مع باقي اللغات.
- من حيث آثار تغلغل قيم الثقافة الغربية في المناهج التربوية في العالم العربي والإسلامي، وفي مجمل النظم التربوية السائدة فيهما.
– من حيث تحديد عوامل إخفاق النظم التعليمية القائمة في تحقيق الأهداف والمكاسب التي حققتها النظم التربوية الأصيلة للمسلمين عبر تاريخهم.
– آثار ذلك الإخفاق في تعميق أزمة الأمة على مستوى مشاريع النهوض.
– آثار ذلك على مستوى إضاعة الهوية الفكرية والحضارية للأجيال المتعلمة، وللأطر المتخرجة من نظام هذه طبيعته ومواصفاته.
هـ- النظام التربوي الأصيل كنظام بديل:
* خصائص النظام التربوي الأصيل.
الخصيصة الأولى: نظام يتميز بالسبق والريادة:
الخصيصة الثانية: نظام يتميز بالاستمداد من القرآن والسنة والاسترشاد بهما في صياغة النموذج وتطويره.
الخصيصة الثالثة: نظام يتميز بالثبات:
الخصيصة الرابعة: نظام يتميز بالشمول والتكامل:
الخصيصة الخامسة: نظام يتميز بالجمع بين التنظير والممارسة أو بين العقيدة والعمل:
الخصيصة السادسة: نظام يأتلف فيه القرآن والبيان:
الخصيصة السابعة: نظام تنموي بامتياز:
الخصيصة الثامنة: نظام يتمحور حول القيم والمواقف:
الخصيصة التاسعة: نظام عالمي إنساني:
الخصيصة العاشرة: نظام منفتح على الحكمة في مواطنها:
الخصيصة الحادية عشر: نظام يجمع بين علوم الشريعة وبين علوم الكون والمجتمع في كل نسقي.
* أبعاد الحاجة إلى النظام التربوي الأصيل.
- من حيث كونها حاجة وجودية.
- من حيث كونها حاجة فطرية ونفسية على مستوى المستهدفين.
- من حيث كونها حاجة إنسانية على مستوى المجتمع الإنساني.
- من حيث كونها حاجة أمنية على مستوى توطين السلم والعدل في العالم.
- من حيث كونها حاجة علمية منهجية.
- من حيث كونها ضرورة علاجية: تجاوز الفصام النكد.
* مستلزمات تطبيق هذا النظام لإصلاح أوضاع التعليم الممارس في المجتمعات العربية والإسلامية، ومعالجة أمراضه وعلله:
- نشر الوعي الكامل بأصالة الفكر التربوي المنبثق من الإسلام وقدرته على الإعداد الرشيد للأجيال، وإثبات الجدارة على البناء الحضاري الراقي وفق أعلى مقاييس الجودة والإتقان.
- إيلاء اللغة العربية مكانتها اللائقة لغة للتعليم، باعتبارها لغة الرسالة الخاتمة والأمة الشاهدة.
- إرساء دعائم الفلسفة التربوية الإسلامية واضحة المعالم، والقائمة على الربانية والتوحيد والشمول وسائر الخصائص المعلومة.
- الرصد الدقيق لمنظومة القيم الموكول إلى النظام بثها في المستهدفين.
- بناء مناهج دقيقة ومتكاملة لجميع الشعب والأسلاك، تستجيب في موادها ومضامينها لمقتضيات الفلسفة التربوية الإسلامية، وما رسم في ضوئها من مقاصد وغايات.
- بناء طرائق وتقنيات فعالة وأصيلة، تستثمر تراث الأمة التربوي، وتنتفع بأفضل ما توصلت إليه علوم التربية في العصر الحديث، مما زكته وأثبتت نجاعته التجربة.
- بناء طرائق وتقنيات وأساليب للتقويم، تتميز بالمصداقية والفعالية والشمول، وتصب في مجرى تنمية القدرة على الإبداع والابتكار لدى التلاميذ والطلاب.
- تنصيب لجان للتأليف المدرسي تراعى فيها أعلى معايير الخبرة والإتقان.
- إقامة مراكز للتكوين ذات جودة عالية من حيث البرامج والتأطير، ومعايير صارمة من حيث القبول، وشروط التخرج والنجاح.
- تعيين لجان مختصة من الخبراء التربويين متعددي التخصصات، تسهر على المتابعة والتطوير، بناء على ما تتمخض عنه المتابعة والتقويم، من تقارير وافية وأمينة.
- تبني اختيار تربوي يزاوج بين تفتيق القدرات الذهنية العليا، وشحذ المهارات التقنية اليدوية.
* التحديات التي تواجه النظام التربوي الأصيل.
- تحد سياسي.
- تحد ثقافي.
- تحد نفسي.
- تحد بنيوي.
- تحد عولمي.
* كيفية التعاطي مع التحديات.
* الأحوال الراهنة المساعدة على إرساء دعائم النظام التربوي الأصيل.
* آليات استثمار الظروف المواتية للإرساء.
– خلاصة وتركيب وتوصيات.
5- مصطلحات ومفاهيم البحث
يستهدف البحث في هذا النقطة تسليط الضوء على المصطلحات التالية:
أ- النظم التربوية الأصيلة:
– المفهوم العام:
يعتبر نظاما تربويا أصيلا كل نظام يستند في رؤيته الفلسفية، وفي سائر أركانه، وفي أدوات اشتغاله ونوعية مخرجاته، إلى القيم الأصيلة الضاربة بجذورها في عمق تاريخ الأمة التي ينتمي إليها ذلك النظام، وكيانها الحضاري.
– بالمفهوم الخاص:
النظام التربوي الأصيل، هو كل نظام يستند في بنائه وتطويره، إلى الكتاب والسنة، وما يرتبط بهما من اجتهادات وفهوم، بهدف صياغة إنسان رسالي وجيل رسالي، مؤهل لصناعة الحياة الراشدة، وإشاعة العدل والأمان، ورفع ألوية السلام، دون أن تعني هذه الأصالة انغلاقا على الذات، وإغلاقا للنوافذ والأبواب، دون ما يسبح في محيطها الواسع من تجارب وأفكار، بل إن خاصية الأصالة كصفة لتلك النظم، تقتضي منها الانفتاح الموزون، على مجاني الحكمة الإنسانية، التي أدركها العقل البشري، عبر تفاعله الموصول، مع الكون والحياة والإنسان والمصير.
ج- خصائص النظام التربوي الأصيل:
الخصيصة الأولى: خطاب يتميز بالسبق والريادة،
الخصيصة الثانية: خطاب يتميز بالربانية،
الخصيصة الثالثة: خطاب يتميز بالثبات،
الخصيصة الرابعة: خطاب يتميز بالشمول والتكامل،
الخصيصة الخامسة: خطاب يتميز بالجمع بين التنظير والممارسة أو بين العقيدة والعمل،
الخصيصة السادسة: خطاب يأتلف فيه القرآن والبيان،
الخصيصة السابعة: خطاب تنموي بامتياز،
الخصيصة الثامنة: خطاب يتمحور حول القيم والمواقف،
الخصيصة التاسعة: خطاب عالمي إنساني،
الخصيصة العاشرة: خطاب منفتح على الحكمة في مواطنها،
الخصيصة الحادية عشر: خطاب يجمع بين علوم الشريعة وبين علوم الكون والمجتمع في كل نسقي.
د- المقصود بالآفاق:
جاء في اللسان: “الأفق ( بتسكين الفاء وضمها)… ما ظهر من نواحي الفلك وأطراف الأرض، وكذلك آفاق السماء نواحيها… وجمعه آفاق، وقيل مهاب الرياح الأربعة: الجنوب والشمال، والدبور والصبا…”2
وآفاق النظام التربوي الأصيل، في ضوء الدلالة اللغوية، هي ما يظهر من علامات ومؤشرات ترتسم حوله، وتظهر في أجوائه ونواحيه، باعتباره كيانا ذا سمات وخصوصيات تميزه عن غيره من الأنظمة، إنها، بتعبير واضح، ما يعد به ذلك النظام، على مستوى تأمين البديل الإنساني والحضاري، بمقتضى الرؤية الفلسفية المؤطرة له، وما يختزنه من قيم، ومن إمكانات للفعل التربوي، بما يمكن عند التطبيق السليم، من درء المثالب ومظاهر الاعوجاج التي تعاني منها النظم التربوية القائمة.
كما يقصد بالآفاق من وجه آخر، ما يكشف عنه تميز النظام التربوي الأصيل، بالنظر إلى ما يعتري المجتمعات المعاصرة من علل وأدواء، من إمكانيات الظهور، وسط خضم هائل من التجارب والنظم، أي أن ما يظهر من نتائج وثمار لتطبيق تجارب محكمة تحت عنوان النظام التربوي الأصيل، كفيل بأن يمثل القدوة التي تغري بالاحتذاء، من يعايشونه، ومن تصلهم نتائجه وأصداؤه.
هـ- المقصود بالتحديات:
جاء في مختار الصحاح: “الحد”: الحاجز بين الشيئين… والحد المنع… والمحادة المخالفة”3 والتحدي -يجمع على تحديات- كلمة مستحدثة، راجت مع رواج “نظرية التحدي والاستجابة” للمؤرخ البريطاني أرنولد توينبي، والتي يفسر من خلالها نشوء الحضارات،4
يدخل في مفهوم التحديات كل صعوبة أو عائق أو إكراه، داخليا كان أو خارجيا، يؤثر سلبا على المستوى المرئي، وقد يؤثر إيجابا على المستوى الخفي، على النظم الأصيلة، سواء تعلق الأمر بإخراجها من القوة إلى الإمكان، أو باستمرارها وبلوغها ما هو منوط بها من مقاصد وأهداف.
و- الحداثة:
الحداثة من المصطلحات المعاصرة التي فرضت نفسها بشكل طاغ على الساحة الفلسفية والفكرية، واحتلت مركزا مرموقا في سجالاتها الساخنة، وأسالت مدادا كثيرا في ذلك السبيل، وتوزع المفكرون في شأنها إلى فريقين: اتخذ أحدهما منها موقف المناصرة والتأييد، والدعوة إلي تبنيها باعتبارها المفتاح السحري ومقدمة الخلاص، والإبداع على الصعيدين: الفكري والأدبي، والخروج من الوضع المأزوم الموسوم بالتخلف والجمود، واتخذ الثاني منها موقف التوجس والعداء والتصدي، لاعتبارها معولا من معاول الهدم والتدمير، يستهدف من خلال غرسه في المجتمعات العربية والإسلامية إتلاف هويتها ونسف كيانها، من خلال تفكيك أوصالها وتشتيت جهازها المفاهيمي، بشكل ممنهج مدروس، يشكل أحد أوجه المكر الكبار ضد وجود الأمة الحضاري.
والبحث المستقصي للحداثة، من خلال مظانها وروادها5 في الفكر والأدب، ينتهي إلى كونها رؤية للكون والفكر والحياة تجعل الوكد من أمرها إحداث القطيعة مع كل ما له صلة بالدين والقيم والتقاليد وميراث الماضي، وانتهاك حرمة المقدس، ومعانقة المدنس. فالحداثة لا مكان في منظورها للثبات، لأن التطور يعصف بكل شيء، بما في ذلك القيم التي تتشكل في كل لحظة حسب الأمزجة والأهواء.
وتتبين أبرز مميزات الحداثة المشار إليها من تعريف هبرماس لعصرها بأنه “هو العصر الذي يختل فيه التوازن بين الماضي والمستقبل، فهو العصر الذي يحيا بدلالة المستقبل، وينفتح على الجديد الآتي، وبالتالي لم يعد يستمد قيمته ومعياريته من عصور ماضية، بل يستمد معياريته من ذاته، وذلك عبر تحقيق قطيعة جذرية مع التراث والتقليد.”6
لقد بلور فكر الحداثة منظوره للإنسان كذات فاعلة وقيمة عليا، باعتباره المرجعية الكبرى على صعيد الفكر والممارسة، “غير أن هذا التصور العقلاني للإنسان الذي بلوره فكر الحداثة الأوروبية سرعان ما تعرض للمراجعة والنقد. فمقابل هذا التصور العقلاني للإنسان كذات مركزية، عاقلة وعارفة، مريدة وفاعلة، بدأ يبلور خط فكري معاكس، قوامه أن الإنسان ذات مشروخة ومشروطة، غير عارفة بذاتها، وخاضعة لحتمية البنيات المختلفة: الاقتصادية والاجتماعية واللسانية والرمزية، ذات يداهمها اللاعقل والوهم، والمتخيل من كل جانب.“7.8
6- حاجة المشروع للبحث
حاجة المشروع إلى هذا البحث حاجة التطبيق إلى النظر، إذ إن الإقدام على تطبيق تجربة ما، دون علم مسبق بطبيعتها الفلسفية، وسوابقها الحضارية، وآفاقها على مستوى العمران البشري من جهة، وإدراك شامل ودقيق لمعطيات الواقع من حيث إكراهاته، أو من حيث مبشراته، من جهة أخرى، سيكون بمثابة مجازفة، أو ارتماء في المجهول. ولن يقلل من وجاهة هذا الحكم ما للنظم التربوية الأصيلة من سابقة تاريخية مشهود لها بالنجاح، نظرا لاختلاف ظروف التنزيل، والإكراهات التي تمثل عنصرا هاما ضمنها.
ويؤكد حاجة المشروع للبحث، ما يوفره من عدة مفاهيمية تساعد على حسن إحكام الإطار النظري، وتجلية معالم رؤية النظام الفلسفية، وما يتوخى بلوغه من أهداف، وبلورته من شروط القابلية للتعاطي الإيجابي معه. فتعميق النظر في خصائص النظام التربوي الأصيل، على سبيل المثال، أو ترشيحه بديلا للقائم من الأنظمة التي استنفدت أغراضها، معززا بذكر الحجج والمقتضيات النفسية والاجتماعية الكامنة وراء ذلك الترشيح، أو الكشف عن أبعاد الحاجة إلى النظام الأصيل، كفيل بالإسهام البناء في عملية ضبط نسق القيم الموائمة، والمؤهلة لتحقيق أهداف النظام التربوي الأصيل.
وأعود إلى العدة المفاهيمية المشار إليها لأقول بأن المقصود بها، هو ما يتوصل إليه البحث من خلاصات واقتناعات عبر المناقشة والتحليل، من قبيل ما يتعلق بمفهوم الأصالة من حيث كونها تفاعلا إيجابيا بين الرؤية الإسلامية للمسألة التربوية، وبين الممارسة التطبيقية المسترشدة بتلك الرؤية، في ظل أوضاع معينة، بما في ذلك أسلوب التعامل مع الآخر على مستوى التلاقح الفكري والمنهجي، ومن قبيل الخصائص التي ينضبط من خلالها مفهوم الأصالة باعتبارها وصفا للنظام المنشود، وكذا ما يتعلق بمفهوم النسق الذي تتبلور ضرورته في الأذهان، كأساس لنجاح تجربة ما في المجال التربوي على وجه الخصوص، وذلك في ضوء إدراك واقع الإخفاق، بصفته نتاجا حتميا لانعدام النسقية في الرؤية والممارسة التربويتين على حد سواء، في النظم التربوية السائدة في العالم العربي والإسلامي.
7- علاقة البحث بالمشروع
بالإضافة إلى ما تم إدراجه في النقطة السابقة، وهو وجه من وجوه علاقة البحث بالمشروع، فإن هذه العلاقة تتجلى أيضا فيما يلي:
– البرهنة على أن رسم طريق للاستقلال الثقافي للأمة، رهين بترسم خطى نظام تربوي متسم بالأصالة، بالمعنى العميق والكامل للأصالة، لأنه بمثابة الرحم النفسي والاجتماعي والحضاري، الذي يتخلق فيها ذلك الاستقلال، أي توفير الشرط الأساسي والحاسم لتحقيق ذلك المطلب العزيز.
– ويرتبط بما سبق، أن إخراج نماذج فذة مؤهلة للإبداع الفكري والعلمي، ولبلوغ درجة مقدرة في الاجتهاد المطلوب حضاريا، لا يتأتى إلا في ظل نظام تربوي يخدم سائر جوانب الشخصية، وينأى بطبيعته عن إسقاط جوانب من الاعتبار، تحت أي ذريعة من الذرائع الفجة الواهية. ولعل هذا مما أولته الخطة عناية واضحة، ويحاول البحث إبرازه وبيانه جهد الإمكان.
– يتمثل موطن أساس من مواطن علاقة البحث بالمشروع، في أن تأمين شروط تكوين شخصية قادرة على التلاقح الحضاري البناء مع الغير، بعيدا عن أي استلاب، لا يتحقق إلا في بيئة فكرية وقيمية يصنعها ويؤثث فضاءاتها النظام التربوي الأصيل.
إن تجلية هذه القضايا رهن بما يورده البحث من برهنة على أن النظرة التفكيكية للشخصية، أو التعامل المبتور معها هما من وراء كثير من البلايا وأشكال التعويق المتراكمة في واقع العرب التربوي والتعليمي.
8- منهجية البحث وأدواته
سيسلك البحث -بإذن الله- المنهج الوصفي التحليلي، المستند إلى رؤية نظرية محددة، كما سيعتمد على منهج المقارنة عند الاقتضاء، لإبراز الفرق الشاسع بين ما يحققه النظام الأصيل، وبين مظاهر العجز والفتنة التي تعبر عنها النظم غير الأصيلة.
وسيتم استخدام منهج تحليل المحتوى لقراءة ما يتوقف البحث عليه من وثائق.
ومنهج الملاحظة والاستبطان، وقد يتم اللجوء إلى تقنية المقابلة والاستبيان، لاستطلاع الفئات المحتاج إليها بحسب الإمكان. ولإعطاء البحث صفته الموضوعية. كما سيتم اللجوء إلى المدخل السوسيولوجي المتمثل في علم اجتماع التربية، وذلك لتحديد المجال السوسيوثقافي الذي يكتنف ذلك الواقع على مستوى المؤسسات التربوية، وعلى مستوى ما يحيط بها من ظروف ومؤثرات خارجية، بما فيها متطلبات المجتمع ومنتظراته المتعلقة بقضايا التنمية والنهوض. بتعبير آخر، تحليل وظائف المدرسة، في إطار المجتمع والعلاقات التي بين المدرسة والمجتمع.
وسيتم اللجوء إلى دراسة الحالة، كمرجعية استناد وتدليل، ويتعلق الأمر بحالة المغرب، وحالة قطر أو الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما يتوفر من وثائق في الموضوع.
9- مسح أولي موجز للدراسات المنشورة، ذات الصلة بالموضوع
مما لا شك فيه، أن كما هائلا قد تجمع من الدراسات والأبحاث التي توخت الكشف عن حقيقة الواقع التربوي في العالم العربي والإسلامي، بقصد تحديد بنياته وهياكله، والتعرف على آليات اشتغاله، وتوصيف مظاهر أزمته، وما يكمن خلفها من علل وأسباب، ومن الأكيد أن هناك تفاوتا بين تلك الدراسات والأبحاث من حيث عمق التناول والتشخيص، ومصداقية النتائج والأحكام التي انتهت إليها، ونوعية الخطط والحلول التي تقترحها للخروج من ذلك الواقع المأزوم. غير أن الاطلاع على كل ما بذل من جهود، وفق رؤية واضحة ومنهج سليم وصارم، كفيل بإعداد قاعدة من المعطيات، تؤهل الباحثين لحسن الفهم والتشخيص، ومن ثم لوضع أنضج التصورات، وأقرب النماذج المجسدة لها على أرض الواقع.
سأحاول فيما يلي أن أقوم بمسح أولي موجز لبعض ما له صلة بمجال البحث من الدراسات والبحوث، على أن أقصر النظر على ما تعرض منها للإشكالات المطروحة على مستوى نظم التعليم القائمة في أقطار الوطن العربي والإسلامي، مرجئا مسح ما تعلق من تلك الدراسات والبحوث بتصورات الحلول وسبيل الخروج، إلى حين تنفيذ خطة البحث -بعد المصادقة عليها- بإذن الله.
وسيتضمن المسح النقاط التالية:
– إشكالية أصالة الخطاب التربوي الإسلامي: رغم أصالة الخطاب التربوي الإسلامي التي تستمد مقوماتها من طبيعة الإسلام، باعتباره دينا قائما على الربانية والشمول، وحاملا لمنهج متفرد في الإعداد والبناء، يكتسي صبغة الإعجاز، فإن ذلك الخطاب لم يسلم من حملة التشويش والإنكار التي استهدفت الإسلام جملة وتفصيلا، وذلك من خلال رميه بالضحالة
والعجز في المجال التربوي. وقد تجرد الباحثون، في سياق تصديهم لحملات المناوئين، لإبطال دعوى خلو الإسلام من الاهتمام بالتربية، ومن ثم لإثبات أحقيته وجدارته وتفوقه في هذا المضمار.
من جملة الذين قاموا بذلك، مصطفى بنحمزة في بحث له تحت عنوان: “مقاصد التربية الإسلامية“، حيث عرض لموقف أحد رؤوس المبطلين من أئمة الاستشراق: كرادي فو الفرنسي “الذي ألف كتابا دعاه مذهب الإسلام، زعم فيه أن الإسلام لم يهتم بأمر تربية الطفل، وأن القرآن لا يتضمن إلا بعض الآيات الخاصة بمعاملة الأيتام، وأن المسلمين لم يعتنوا تبعا لذلك بالتربية، وأن الذين اهتموا بها في ديار العرب في القرون الوسطى هم عرب مسيحيون”، وأعقب ذلك بالإشارة إلى التأثير السلبي الذي نتج عن تلك الدعوى الباطلة، والذي وجد صداه في انصراف الواقعين تحت طائلته عن البحث “عن معالم التربية الإسلامية”، ثم بالبرهنة على أن النموذج التربوي أو مقومات المنهج التربوي في الإسلام، هي من البروز بمكان، إلا لمن تمسك بالجحود والنكران. ثم راح يقيم الدليل على أن القرآن الكريم هو باعث النهضة التربوية “التي تجلت خلال فترات التاريخ في أشكال مؤلفات تربوية، وشيوخ مربين يتعهدون الناس بالتوجيه، ويحرصون على استئصال السلبيات التي تبرز في سلوكهم”، كما تجلت في الكم الهائل من الرسائل التربوية التي أتحف بها العلماء والمربون المسلمون التراث التربوي الإسلامي، والإنساني على وجه العموم، والتي استعرض بعض نماذجها على سبيل التمثيل.
وعالج الإشكالية ذاتها من زاوية أخرى أحد رواد البحث التربوي في الوطن العربي، سعيد إسماعيل علي، حين حسم في أمر إضافة صفة “الإسلامي” إلى الخطاب التربوي المعبر عن المذهبية الإسلامية، والذي يتوخى الداعون إليه اعتماده في حقل التربية والتعليم في المجتمعات الإسلامية، جريا على ما درجت عليه جميع الأمم والشعوب في حرص كل منها على الاستقلال بمذهبه التربوي المعبر عن شخصيته الحضارية المتميزة. ويؤكد المؤلف ضرورة استخدام هذه الصفة في ظل مناخ تشتد فيه وتيرة التدافع الحضاري، بل وموجات العداء، ضد كل ما يحمل بصمة الإسلام وصفة الإسلام. يقول المؤلف: “فما الغريب اتساقا مع هذا، أن ينطلق بعضنا من عقيدته الإسلامية ليستنبط تربية إسلامية تسعى إلى صياغة الشخصية الإنسانية بما يتفق والتصور الإسلامي، على أساس أن خالق الإنسان هو الأدرى والأعلم بكيفية بناء شخصيته.”9
– التربية الإسلامية وإشكالية المفهوم:
ويرتبط بهذه الإشكالية، بل يعتبر وجها من وجوهها وتجليا من تجلياتها، المفهوم الذي تنصرف إليه الأذهان عند استعمال عبارة ” التربية الإسلامية”، وقد تمثل الإشكال في حصر الصفة الإسلامية في سياق المنظومات التربوية في المجتمعات العربية والإسلامية، داخل مادة أطلق عليها “مادة التربية الإسلامية”، وقد شكل ذلك عائقا خطيرا في وجه الحركة التربوية من المنظور الإسلامي، واعتبرت إزالته فتحا مبينا ضمن جهود إرجاع الأمور إلى نصابها بإقرار التصور السليم للتربية الإسلامية، أي النظر إليها باعتبارها أسلوبا متكاملا في الفكر والبناء، والممارسة والسلوك، قائما على خصائص ومقومات، أبرز خصائصها الربانية والثبات، والعالمية والشمول.
من الجهود الرائدة والمؤسسة في التصدي لهذه القضية على درجة عالية من العمق والشمول ما ضمنه علي عيسى عثمان بحثه المعنون بـ:”النظام التعليمي السائد في المجتمعات الإسلامية واستبداله بنظام إسلامي” والمنشور بمنابر عدة منها مجلة الفكر العربي التي خصصت عدد مايو يونيو يوليو 1981م “للتربية الإسلامية والتربية المقارنة” فقد وضع أسئلة مركزية كبرى بين يدي بحثه تنم عن عمق فهم ومعاناة للإشكال المطروح، من قبيل: “ماذا لو تبين لنا أن النظام التعليمي السائد في المجتمعات الإسلامية نظام غريب عن الإسلام، يتناقض في نظرته إلى الدين، وفي نظرته إلى المعرفة، وفي نظرته إلى الإنسان مع نظرة الإسلام، ويولد في الذين يتخرجون فيه آثارا عقلية، وقيما واتجاهات خلقية ووجدانية، تتناقض مع غايات الإسلام ومقاصده في تربية الإنسان؟”
وماذا لو تبين لنا أن هذا النظام السائد ولد في نفوس أجيال منا في هذا العصر الغربة بينهم وبين الإسلام، وولد الغربة بين المجتمعات الإسلامية، وأنه ينذر -إذا لم يستبدل استبدالا كليا بنظام إسلامي في التربية- بتعميق هذه الغربة، إلى درجة ابتعاد أكثرية المثقفين من المسلمين عن التوجه بالإسلام وأصوله؟”
وفي خضم البحث والتحليل يطرح سؤالا في غاية الأهمية، يرتبط بصميم القضية التي نحن بصددها: “هل يجوز في نظام تعليمي إسلامي أن يفصل الدين “كمادة مدرسية” من بين مجموعة من المواد المدرسية الأخرى تساويه ويساويها في تنظيم المعرفة وفي تحصيلها، وفي توظيفها في حياة الإنسان؟”
وعبر استجماع لمفردات القضية وعناصر الإشكالية يجيب الباحث عن الأسئلة المطروحة بما يطرد الأوهام ويشفي الغليل، ومفاد الإجابة ينتهي إلى ضرورة الحفاظ على اجتماع عناصر المركب الكلي التي لا تقبل التفتيت أبدا، وهي عناصر الدين الإسلامي باعتباره تصورا شاملا للألوهية والكون والمجتمع والإنسان.
ومن الذين قاموا بتأصيل هذه القضية وفق منظور فلسفي عميق، ماجد عرسان الكيلاني في كتابه “فلسفة التربية الإسلامية“ 1419ﻫ-1998م، وذلك من خلال تحليله وبيانه لمعنى العبودية والعبادة وما يرتبط بها من مظاهر: مظهر شعائري “يتمثل في شعائر وممارسات ترمز إلى أشكال الحب والطاعة التي يعبد بها الإنسان الخالق” ومظهر اجتماعي يتعلق بالثقافة والقيم والعادات والتقاليد والنظم، ومظهر كوني يتمحور حول العلوم الطبيعية التي تشكل ممارستها دخولا إلى محراب استكشاف سنن الله في الأنفس والآفاق، وبيان ما هنالك من تكامل بين تلك المظاهر، يعتمد أساسا لبرنامج تربوي خصب ودقيق، يستهدف بناء الشخصية الرسالية البانية الواعية بأمانة الاستخلاف على هذه الأرض، والتي يكون قوامها اليقين في النفس والقناعة في العقل والاستقامة في المعاملة في السلوك. وقد وضع ماجد عرسان الكيلاني أصبعه على موطن الداء، بتدليله على أن الفصل بين تلك المظاهر الثلاثة للعبادة في المنظومات التعليمية والعملية التربوية، قد شكل خرقا سافرا أدى و”يؤدي إلى تعطيل فاعلية كل منها ويحيله إلى مجرد حركات وممارسات خاوية لا روح فيها ولا أثر لها.”10
ويؤكد على هذا المعنى الشامل للتربية الإسلامية مصطفى بنحمزة في البحث الذي سبق الإلماع إليه إذ يقول: “إن التربية الإسلامية التي نعني هي أكبر من الحجم الذي يحاول بعض الناس أن يحجموها فيه استغفالا للمتدينين، إنها ليست مادة مخصوصة تدعى مادة التربية الإسلامية، إنما هي أسلوب في البناء، ونمط في تكوين وتشكيل وتوجيه الإنسان.
وقد كانت هذه التربية حاضرة فاعلة حتى في الأزمنة التي لم تكن هناك معاهد ومؤسسات تعليمية من النمط الحديث، إنها تربية لا تفرط في الإنسان في كل مراحل تكونه، لتلاحقه أخيرا وتتداركه بمادة يتيمة باردة تدعى مادة التربية الإسلامية، وإنما هي تربية تجعل الوكد من مهمتها أن تنمي الإنسان وتطوره في كل مستوياته، لتجعله إنسانا يعيش اهتمامات عصره، ومشاغل زمانه بكامل الوعي واليقظة، مزودا بكل إمكانيات المتابعة والملاحقة والتأثير والتوجيه للحياة المعاصرة.“ 11
– النظام التربوي في العالم الإسلامي ومعضلة الفصام:
ومرد هذا الفصام إلى وجود ازدواجية بين نظامين تعليميين: أحدهما تقليدي إسلامي، والآخر وضعي علماني، بما تعنيه تلك الازدواجية من معاني التنازع والصراع، نظرا لقيام كل منهما على أسس عقدية ومنظومة قيمية مناقضة الأخرى، تفضي كل منهما إلى صياغة وتخريج نموذج أو شاكلة تعكس حتما ذلك التناقض والخلاف. ورغم محاولات بذلت من أجل التقريب بين النظامين، إلا أن التجربة الواقعية دلت على استحالة محتومة نابعة من استحالة الجمع بين النقائض، لأن “الخلاف -كما جاء في كتاب “أزمة التعليم الإسلامي” لسيد سجاد حسين وسيد علي أشرف– ليس خلافا في البناء الخارجي فحسب، بل ثمة خلاف آخر في المنهاج والأهداف، فالتعليم الإسلامي التقليدي يقوم على القيم الدينية والأخلاقية المستمدة من كتاب الله، ومن ثم فإن الهدف من مثل هذا اللون من ألوان التعليم هو بناء الإنسان المسلم الراسخ الإيمان بالله، والذي لا يتعدى حدود الله، بل يحاول أن يفهم ظواهر الكون خارجية كانت أم داخلية في ضوء قدرة الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، أما نظام التعليم الحديث، فإنه يحاول أن يفسر أصل الوجود وظواهر الكون التي يتعامل بها الإنسان في حياته اليومية دون الرجوع إلى الله، وإن لم يقل بذلك صراحة.” 12
وينتهي المؤلفان في سياق معالجتهما لهذه المعضلة في الفصل الثالث المعنون ب: “ازدواجية التعليم” إلى اقتناع راسخ بعدم جدوى التوفيق بين هذين النوعين من التعليم، ويضربان مثلا تجربتي “السير سيد أحمد” و”مولانا وحيد” في الهند، واللتين باءتا بالإخفاق، ثم إلى أن المخرج من هذه الدوامة لا بد أن يمر من خلال إنجاز عملية جذرية جادة، وذلك بـ”إعادة تقويم كل أنواع المعرفة الحديثة التي لا بد للطالب المسلم من تحصيلها.” ويؤكدان نفس المعنى في موضع آخر بقولهما: “لا بد إذن من القضاء على الازدواجية في التعليم، والقضاء على الازدواجية لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أخضعنا العلوم الحديثة القادمة إلينا من الغرب للفحص الدقيق والمراجعة قبل إقرارها في مدارسنا وجامعاتنا.” 13
ويرى المؤلفان أن الكفيل بعصمة أجيال المسلمين من تسرب نمط الحياة الغربية إليهم وتغلغله في كيانهم، إنما هو: “محاولة إيجاد نظام تعليمي مترابط متكامل يحافظ على قيمنا، وينقل لنا في الوقت ذاته علوم الغرب ومعارفه.”14
وتعليقا على هذا الرأي أقول: إلى أي حد تتوفر الشروط الكاملة، لنجاح مثل هذا السعي، وإنجاز هذه المحاولة، في ظل هيمنة طاغية لنمط من التفكير والسلوك يغشى كل جزئية من الجزئيات في معاش الناس، جدها ولهوها، على حد سواء؟ وحتى إذا تم ذلك بجهود مضنية خارقة، فأي ثمن باهض يتطلبه الصراع المرير بين مثل ذلكم النظام الغريب، وباقي الأنظمة التي تناصبه الكراهية والعداء، داخل نفس البناء؟ ومهما يكن من أمر، فإنه في غياب دخول أجهزة المجتمعات الإسلامية ونظمها في السلم كافة، وإلى أن يتحقق ذلك بحول الله وقوته في يوم لا ريب فيه، يظل رهان الاختراق التعليمي التربوي متصدرا خارطة الإنقاذ، فهو رأس الحربة في استراتيجية إعادة البناء الشاقة والطويلة النفس، التي تتطلع إليها أجيال أمة الشهادة على الناس.
وتعزف منى بنت عبد الله حسن بن داود على نفس الوتر، فهي تحمل جانبا كبيرا من وزر التردي الذي تشهده أوضاع التعليم في العالم الإسلامي لداء الازدواجية الذي ينخر كيانه ويمتص طاقاته، ذلك أن تأسيس المشهد التعليمي على وجود نظامين متجاورين ومتنافرين في ذات الوقت، يصمه بعبثية سافرة، ويبعده عن أدنى سمة من سمات الرشد.
ففي إحدى جانبي المشهد نظام تعليمي مدني تضفى عليه صفة العصرنة والديناميكية والقدرة على الإنتاج والإبداع والابتكار، ويحظى خريجوه بالمناصب وفرص الشغل، ويبوأون مواقع التسيير ومراكز القرار داخل المجتمع، وقبل ذلك تغذى شعبه وتخصصاته بكفاءات معتبرة على مستوى التأطير، وبروافد غنية على مستوى التلاميذ والطلاب.
وفي الجانب الآخر، نظام التعليم الديني الذي يوصف بالتقليدية والماضوية، ويوصف بالعجز والقصور والتخلف، والانزواء عن الحياة ومعاداة العصر، ويحرم خريجوه من المناصب ويقصون من مواقع المسؤولية وصنع القرار. إن هذه الازدواجية التي تنخر عظام النظام التعليمي، من أشد أسباب البؤس والجمود والتفكك في حياة الأمة العربية والإسلامية. ترى منى بنت عبد الله أن: “من عوامل استعادة الأمة الإسلامية مكانتها العلمية والحضارية، …، متانة نظامها التعليمي، وهذه المتانة لن تتحقق ما دامت الازدواجية قائمة، إذ لا نفع في مؤسسات دينية مقطوعة الصلة بالحاضر، ولا نفع في مؤسسات مدنية مقطوعة الصلة بالأصول الإسلامية.”15 ولقد كان لا محالة من تقديم الأمة ثمنا باهضا من تماسك نسيجها الثقافي والاجتماعي، ووحدة ولائها الفكري، وقد وجد ذلك تجلياته الصارخة في ظهور جيلين على طرفي نقيض، من حيث نمط التفكير، ومن حيث طبيعة التطلعات والآمال، وغدا المجتمع جراء ذلك مسرحا للصراع المدمر الذي يشل الحركة ويعطل الطاقات.
– النظام التعليمي التربوي وتعدد المرجعيات:
إن ما ذكرناه آنفا في شأن معضلة ازدواجية التعليم، قد يعبر عن نفسه على مستوى نظام التعليم المدني في حد ذاته، من خلال تعدد في المرجعيات الفكرية والفلسفية، يمسك بخناق ذلك النظام، فيحيطه بحشد من القيم المتضاربة، والتصورات المتناقضة، وهذا الوضع ينذر لا محالة بشر مستطير، يتمثل في القابلية للانفجار في كل وقت وحين، والتهديد بإسقاط أعداد هائلة من الضحايا في دوامة التيه والضياع.
وقد يكون وصف “شركاء متشاكسون” القرآني أبلغ وصف يعبر عن هذا الوضع الغريب والمهين الذي يطبق على الأنظمة التعليمية التربوية في أقطار العالم العربي والإسلامي -على تفاوت في درجة التشاكس وحدته في هذا النظام أو ذاك- وقد تطرقت في مقال بعنوان: “المنظومة التربوية المغربية في ميزان القيم”، لهذا التشاكس باعتباره إحدى أبرز سمات تلك المنظومة، وأخطرها على الإطلاق،… فنحن عندما نقرا النقطة المتعلقة بالاختيارات والتوجهات في مجال القيم في “الكتاب الأبيض” يبدو لنا ذلك التشاكس في مظاهره الصارخة، إنها اختيارات وتوجهات لم تتورع عن أن تجمع في جعبتها بين ما لا يحتمل التواجد والاجتماع، إلا على حلبة التنازع والصراع: “قيم العقيدة الإسلامية“، “قيم الهوية الحضارية ومبادئها الأخلاقية والثقافية“، “قيم المواطنة“، “قيم حقوق الإنسان ومبادئها الكونية”، فنحن نتساءل منكرين: ما الذي يجمع في صعيد واحد بين قيم العقيدة الإسلامية وقيم حقوق الإنسان ومبادئها الكونية، والحال أن مرجعية كل منهما على طرفي نقيض؟ إذ أن مصدر الأولى سماوي رباني، بينما مصدر الثانية أرضي إنساني، وهل يليق أن يتخذ الإنساني ندا لما هو رباني، إلا إذا اختلت الموازين واختلطت الرؤى لدى من تولوا كبر إقرار هذا الجمع الغريب بين ما لا يقبل الاجتماع؟ ولمعترض أن يعترض قائلا: أوليست هناك قواسم مشتركة بين هذه وتلك؟ والجواب على هذا الاعتراض من الوضوح بمكان، لأن ما يبدو قواسم مشتركة لا يتجاوز الظواهر والألفاظ، فقيم من قبيل الحرية والكرامة والمساواة على سبيل المثال، في المرجعية الأولى غيرها في المرجعية الثانية على مستوى المفاهيم والأبعاد.
إنه من غير المستساغ والمقبول أبدا أن يسقط القيمون على أمر التربية والتعليم في البلاد العربية والإسلامية في مغبة مثل هذه الفوضى الفكرية وهذا التخبط المشين، لأن ما تملكه من المواريث الصافية على مستوى تصور الحياة وفلسفة التربية، كفيل، إن هي استلهمته وترسمت خطاه، أن يكفيها شر ذلك التخبط والفوضى الذي وقع ويقع فريسته الأمم التي وكلت إلى أوهامها وتجاربها غير المسنودة بأي ميزان ثابت، ولا ضوابط محكمة، ويعفيها من التردي في دوامة فقدان المعنى الذي جأر منه أحد المفكرين الغربيين: كريستوفر لوكاش، إذ يقول: “ولقد أضعفنا القدرة على رؤية الحياة رؤية كلية ثابتة. وهكذا فإن الإنسان الحديث والمجتمع الحديث يعانيان من مرض العقل والروح. إن صور الحياة اليومية تعكس الانحطاط والعزلة والاغتراب، ونحن بحاجة إلى تصورات جديدة وقيم جديدة. نحن نحتاج إلى البلسم الشافي الذي تقدمه حكمة أعمق تقودها خارج الأزمة القائمة” “فلسفة التربية الإسلامية، ماجد عرسان الكيلاني16 وهل تملك أمة حكمة أعمق مما تملكه الأمة المسلمة؟
– النظام التربوي ولغة التعليم: معضلة الازدواجية:
يعتبر موقع اللغة في منظومة تربوية تعليمية في شعب من الشعوب، أو أمة من الأمم، مؤشرا على مدى التقدير أو سوء التقدير الذي يضمره أو يعلن عنه من قلدوا زمام الأمر فيها، كما يعد ذلك الموقع عاملا حاسما في تفسير طبيعة كثير من الظواهر التي تبرز على صعيد تلك المنظومة، سواء من حيث الضعف أو القوة، أو من حيث السواء والاعتلال.
فالذي يستقرئ سلسلة الهزائم والنكبات التي منيت بها المنظومات التربوية في العالم العربي على وجه الخصوص، يجد أن الازدواجية الهجينة، هي من وراء ذلك الضياع بقدر كبير، ويتأكد لديه أن من يمسكون بزمام الشأن التعليمي، إذ يقصون لغة القوم ويجعلونها تحت رحمة لغة دخيلة يمكن لها في سياق حسابات ضيقة، وفي ظل انعدام الحس الحضاري العاصم من الانزلاق، يحكمون على ذلك الشأن بالمراوحة والجمود، ومن ثم بالحرمان من تحقيق أي إنجاز يذكر في ساحة التدافع الحضاري.
يقول مصطفى بنيخلف: “إن عدم تعريب التعليم العالي جعل الطلبة يعيشون في مشاكل عديدة، فمنطقيا، من يدرس بالمرحلة الثانوية الرياضيات بالعربية وينتقل إلى الجامعة، فإنه، حتما، سيجد صعوبات إضافية من أجل دراسة الرياضيات باللغة الفرنسية، وسيضيع مجهودا في اكتساب مفاهيم جديدة عبر الترجمة والبحث، عوض التوجه نحو اكتساب معلومات جديدة في الميدان”.
هذا الوضع، يضيف بن يخلف، سيضع الطالب أمام خيارات عديدة، أولها: أنه سيحاول الاجتهاد ما أمكن، من أجل التحصيل في الجامعة، أو يجد نفسه مضطرا للتخلي عن الدراسة، إذا لم يستطع المواكبة، وسيبدأ في البحث عن عمل، وحينها سيجد الفرص نادرة أمامه، لأن مختلف الإدارات والمؤسسات تبحث عمن يتقن اللغة الفرنسية.
وأوضح بن يخلف أن عدم استعمال اللغة العربية في التعليم العالي، خصوصا في الميادين العلمية، سواء في الكليات أوفي المعاهد التي تدرس العلوم أو التكنولوجيا، هو “استخفاف بها وحيف يمارس ضدها”، وهو ترويج لشائعة عدم قدرتها على مواكبة المفاهيم العلمية.
وبخصوص مكانة اللغة العربية في التعليم الابتدائي والثانوي، تطرق مصطفى بن يخلف، إلى ما سماها الأخطاء التي يرتكبها العديد من الآباء والأمهات عبر إقبالهم على تعليم أطفالهم اللغة الفرنسية في سن مبكرة، معتقدين بذلك أن أطفالهم سيصبحون نجباء في اللغات، وهذا ليس صحيحا، حسب المتحدث نفسه، الذي يرى أن المختصين برهنوا على أن ثنائية اللغة في ميدان التعليم في سن مبكر مقاربة فاشلة، حيث يتم التشويش على الطفل، فلا هو يتقن العربية ولا هو يتقن الفرنسية، فيحصل بذلك خليط من اللغتين في ذهنه.
وتطرق إلى حرص العديد من الدول مثل فرنسا وإسبانيا وانجلترا على تعليم الأطفال كل المعارف باللغة الرسمية للبلاد إلى حين بلوغهم سن 12 أو 13 ثم بعدها يبدأ هؤلاء في اكتساب لغة أجنبية جديدة.17
إن معطيات العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية تؤكد أن لا بديل عن اللغة الأم في تحقيق القدرة على التحصيل وتوفير إمكانيات النبوغ والتفوق، جاء في تقرير لليونسكو نشر عام: 1963، أن اللغة الوطنية الأم: “هي من الناحية السيكولوجية منظومة من الرموز تعمل أوتوماتيكيا في ذهن الطفل عندما يريد أن يتكلم أو يفهم، وهي من الناحية السوسيولوجية تربط الطفل بقوة مع المجموعة البشرية التي ينتمي إليها، ومن الناحية البيداغوجية، تمكنه من التعلم بسرعة أكبر من السرعة التي يتعلم بها إذا كانت اللغة أجنبية عنه.”
“إن هذه الحقائق أصبحت ثابتة لكل ذي عينين بالنسبة للغة أي لغة، مهما كان شأنها من الصعوبة والتعقيد، فما بالك والأمر يتعلق بلغة اختارها الله عز وجل لتكون وعاء لإنزال كتابه الخاتم والخالد، ويكفي ذلك برهانا على كونها لغة الحضارة بامتياز، بما وهبها الله عز وجل من قدرة على التكيف والتطور، ومن قابلية فائقة للتخصيب.“18
10- الإضافة النوعية
تتمثل الإضافة النوعية التي يتوخى البحث تقديمها -بإذن الله- فيما يلي:
– إبراز خصائص النظام التربوي الأصيل، ومدى عمقه النظري، وكفايته التطبيقية، وقدرته على إثبات جدارته في مهمة تجديد نسيج الأمة الحضاري.
– الطرح الحضاري الشمولي للمسألة التربوية، وتجاوز الطروح الجزئية لها، والتي تسقطها في المحدودية وانسداد الآفاق.
– المعالجة الفلسفية للمسألة التربوية، درءا للتسطيح، وإبرازا للصفة الكونية والعالمية التي تعتبر عنصرا ذاتيا في النظام التربوي الأصيل المؤطر بالإسلام، بينما تدعيها مذاهب أخرى بغير حق ولا استحقاق.
الكشف العلمي عن احتياج الإنسان والحضارة على حد سواء، لحمولة قيمية ضاربة بجذورها في أعماق الفطرة، تحقيقا لأعلى درجة من الإبداع، وأكبر قدر ممكن من الأمن والسلام.
إعطاء الدليل على أن النظام التربوي الأصيل، مؤهل بحكم طبيعته الفذة، لاستيعاب المواريث الصالحة التي تفتقت عنها جهود البشر في تفاعلهم مع الكون والحياة.
تمهيد
يفرض النظام التربوي الأصيل نفسه على الأمة المسلمة من منطلق حاجتها الملحة إلى الاستقلال الثقافي، كأساس لتعبئة الذات، واستنفار مكنوناتها وطاقاتها الإبداعية، في اتجاه التميز، باعتبارها رقما متفردا على المستوى الحضاري والإنساني، ذلك بأن مختلف التجارب التربوية التي خاضتها الأمة في منأى عن مرجعية النظام الأصيل، لم يكن لها مناص من السقوط في الإخفاق، لسبب جوهري، هو غربة تلك التجارب عن هوية الأمة وجذورها الحضارية، ومن ثم عجزها عن تحريك مكامنها وقدح زنادها.
إن هذه الحقيقة الصارخة ترسخ في أذهاننا يقينا بحقيقة أخرى، متولدة عنها لا محالة، هي أننا في السياق الحضاري لأمة الإسلام، لا نحتاج فقط إلى تعليم وتربية وكفى، وإنما نحتاج إليهما وفق رؤية خاصة، قائمة على حقيقة الإسلام، معبرة عن مقاصده، وهي ما نصطلح عليه بنظام التعليم الأصيل، لأن ذلك وحده هو الذي يفي بالمقصود، ويحقق المراد، المتمثل في تحقيق حلم الانبعاث وتجديد نسيج الأمة، لاستعادة الزمام والعودة إلى حمل أمانة الشهود من جديد. وأمر آخر لابد من التأشير عليه، هو اعتقادنا الراسخ القائم على أساس موضوعي صريح، في أن الحاجة إلى رفع بنيان ذلك النظام، هي من العمق والسعة، بحيث تشمل الإنسانية جمعاء. ولعل بعدا بارزا من أبعاد الإشكالية المؤطرة لهذا الموضوع، يكمن في كشف النقاب عن أوجه تلك الحاجة، ورفع الوهم والالتباس، الذي عشش في أذهان بعض الناس، حول طبيعة هذه الحاجة إلى النظام التربوي الأصيل، التي تكتسي طابع الضرورة القصوى.
أولا: إشكالية البحث
تتبلور إشكالية البحث من خلال الأسئلة الآتية:
1- إلى أي مدى يملك النظام التربوي الأصيل القدرة على الفعل الإيجابي البناء، في خضم عصر يرفع شعار التقدم والتطوير، وتحقيق أعلى مستويات النماء؟
2- ما هي عناصر القوة في هذا النظام، الكفيلة بإقداره على الصمود في معترك الصراع بين النماذج والنظم العاملة في ميدان التربية والتعليم؟
3- هل يملك النظام التربوي الأصيل من خلال تجاربه الحالية أن يستجيب لطموحات الأمة إلى استئناف مهمة الشهود الحضاري من جهة، وتحقيق التفوق والظهور على المستوى الإنساني من جهة أخرى؟
4- وفي حالة الجواب بالنفي، ما هي الصيغة المثلى التي تؤهل النظام التربوي الأصيل في الأوضاع الراهنة لتحقيق المراد؟
ثانيا: الفكرة المحورية للبحث
تتمثل الفكرة المحورية للبحث، في السعي العلمي الموضوعي، للبحث في مدى جدارة النظام التربوي الأصيل بالوجود أولا، وبتمثيله للبديل التربوي الفعال، وسط خريطة النماذج المتدافعة ثانيا، والذي يؤهل الأمة لتجديد نسيجها، وإنجاز النقلة النوعية المنشودة على صعيد إعادة البناء الحضاري؟
ثالثا: محاور البحث
سينصب الاهتمام، بإذن الله تعالى، على الإجابة على الإشكالية بجميع أبعدها، من خلال المحاور التالية:
المبحث الأول: خصائص العصر الحالي وتوجهاته في المجال التربوي التعليمي:
أولا: تمهيد:
إن الإجابة عن الأسئلة المطروحة في صدر هذا الموضوع لا تتأتى بالصورة المناسبة، إلا في ضوء استجلاء خصائص العصر وما يكتنفه من تحولات تلقي بظلالها لا محالة على العمل التربوي بجميع مفرداته وأركانه، فالتأسيس لنظام تربوي أصيل ذي مواصفات محددة ومقاصد معلومة، لا يمكن أن يتم في غياب فهم عميق لطبيعة عصر يموج بالأحداث المتلاحقة، والتغيرات النوعية الحاسمة، وأول خطوة في هذا السبيل، هي تسليط الضوء على المجتمعات المسماة متقدمة، للكشف عن الآليات التي تحكم سيرها، ومنظومة المبادئ والأفكار التي تشكل شخصيتها وكيانها الفكري والاجتماعي.
ثانيا: خصائص المجتمعات المتقدمة المعاصرة.
تتميز المجتمعات الغربية المعاصرة بدرجة عالية من التطور التكنولوجي، ومن التعقيد على مستوى الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يسعى لمواكبته، ومجاراة إيقاعه المتسارع، فهي من حيث النظام الاقتصادي تقوم على ليبرالية جامحة، تجعل نصب عينيها تحقيق أكبر قدر من الأرباح، بأقل جهد وأقل تكلفة، وبغض النظر عن سمو القيم والمقاصد التي تحكم حركة الإنسان الغربي وسلوكه، ومع ذلك، فإنه يرفع شعار الحرص على تحصيل أعلى مستوى ممكن من الجودة، ومن حيث نظامها الاجتماعي، تقوم المجتمعات الغربية على التراتب وتقسيم الأدوار، الذي يفرز تفاوتات صارخة على مستوى الدخل وامتلاك الثروة والجاه والنفوذ، وهي على صعيد السياسة تقوم على ما يسمى باللعبة الديمقراطية التي تحكمها ثوابت مرعية من شأنها أن تفرز نخبا معينة تتربع على هرم السلطة، بجميع أنواعها ومستوياتها. هذا على المستوى الداخلي، أما على صعيد العلاقة مع الخارج أو الآخر، فإن النزعة إلى الاستحواذ والهيمنة، هي الطاغية على سلوك تلك المجتمعات، مما يترجم عن نفسه في نهج أساليب ماكرة لنهب ثروات البلاد المستحوذ عليها وامتصاص خيراتها، مستعينة على ذلك بجيوب ممن يدينون لها بالتبعية والولاء، للحفاظ على مصالح ضيقة آنية، مدفوعين إلى ذلك بتأطير إيديولوجي وسياسي من قبل مركز التحكم والقرار.
ونظرا لجملة من العوامل المساعدة، منها إطلاق العنان لحرية البحث والرأي والتفكير، والإنفاق على ذلك بسخاء، وتشجيع المواهب والمبادرات، واستثمارها إلى أقصى الحدود، تعرف المجتمعات الغربية انفجارا معرفيا هائلا في جميع ميادين العلم والمعرفة، يزيد من صولتها وتحكمها وبسط نفوذها الواسع، وينعكس بشكل جلي، على مستوى الوفرة في المنتوجات التي تفرض البحث لها عن أسواق لتصريفها، واستثمار عائداتها من جديد، في تعزيز دورة الإنتاج، واستغلال فائض الثروة لإعداد السلاح ووسائل الدمار، للترهيب، بل والعدوان على شعوب مستضعفة آمنة، إن دعت إلى ذلك الحاجة، وهي دائما قائمة، بحكم النزعة الماكيافيلية التي تسكن كيان الغرب. ومن أوجه التناقض الصارخ في سلوك الغرب، أن يتصدر الدعوة إلى حماية حقوق الإنسان، ويرفع شعارها بكل كبرياء، بل إنه ليتخذها في حالات كثيرة ذريعة سافرة للتدخل في شؤون الأنظمة والشعوب التي لا تسلس له القياد.
ونظرا للعوامل السالفة الذكر، من سيادة للسلوك الليبرالي الجامح، على مستوى الإنتاج والاستهلاك، ونزعة للهيمنة، وتداعيات ذلك، فإنه من ثوابت المعيشة في مجتمعات الغرب المعاصرة، أن تخضع لأزمات دورية تنخر نظامها الاقتصادي والمالي، ويترتب عنها هزات عنيفة واضطرابات مرهقة، تذوق بأسها تلك المجتمعات، وتمتد بلهيبها إلى من يسبح في فلكها من الشعوب المغلوبة على أمرها.
ولنفس الأسباب تشكو تلك المجتمعات والعالم من حولها من أزمات وكوارث بيئية ماحقة، تهدد مقومات الأرض ومن عليها، بسبب الجور الممارس عليها واختلال عناصرها.
ثالثا: سمات وركائز النظم التربوية المعاصرة ومعالم توجهاتها.
من المعلوم أن للنظام التربوي ارتباطا وثيقا بالمجتمع الذي نشأ فيه وتطور، فهو يحمل خصائصه وسماته،، ويتفاعل معه أخذا وعطاء، إيجابا وسلبا، ويعكس أهدافه وتطلعاته، ومعالم توجهاته، فما هي سمات النظم التربوية المعاصرة؟ وما ركائزها؟، وما طبيعة توجهاتها؟
تكمن أول سمة للنظم التربوية المعاصرة في تبني مبدأ التدبير العقلاني الصارم الذي يقوم على التدقيق في تحديد المدخلات الواجب توفيرها وحشدها، من أجل الحصول في نهاية المطاف على المنشود من المخرجات، حال القيام بتنزيلها على الوجه المناسب، مما يتيح القدرة على رسم المسار، أو ما يسمى بالتمشيات19، الكفيلة بإيصال جملة الفاعلين التربويين المعنيين، إلى القيام بذلك التنزيل. وتأمل هذه السمة في ضوء طبيعة العصر، تجعلنا على اقتناع، بأن العملية التربوية، وإن ارتبطت منذ أول عهدها بما هو متوخى منها من أهداف، إلا أن طبيعة العصر بمكتسباته على مستوى نضج الحس التدبيري، بما فيه شيوع مفهوم وثقافة التخطيط، أعطى للعمل التربوي الهادف طابع الصرامة والإلحاح، ولعل مما يبرز لنا ذلك التأثير، أن التدريس الهادف20، أي الذي يمارس في ضوء أهداف مرسومة، في مستوويها العام والخاص، قد أخذ نموذجه من النموذج الصناعي الخاضع للبرمجة والتقنين، فيما يتعلق بتقنيات الإنتاج، والوحدات المنتجة.
ومن المصطلحات المفاتيح التي تمكننا من التعامل الواعي مع النظم التربوية المعاصرة في هذا السياق، مفهوم “الكفاءة” الذي تحدده طبيعة العلاقة بين المدخلات والمخرجات، “فالنظام التعليمي يعتبر كفؤا إذا ما أنتج بأقل تكلفة، المخرجات المطلوبة، من حيث تخريج أقصى عدد من الشباب الذين اكتسبوا المعارف والمهارات اللازمة التي يفرضها المجتمع. وبعبارة أخرى، يعتبر النظام التعليمي كفؤا إذا ما أنتج بمدخلات محددة من الموارد( البشرية والمالية والمادية) أقصى ما يمكن من النتائج المرجوة من حيث الكمية والنوعية معا.” 21
وتكمن ثاني سمة لتلك النظم في التجاوب الواسع بينها وبين المستجدات في عالم التكنولوجيا، بحيث أضحى لهذه الأخيرة حضور وازن في توجيه النشاط التربوي، فهي تؤخذ في الحسبان في هيكلة ذلك النشاط وتدبيره، بما في ذلك المعلم والمتعلم وطرق التعلم والتعليم وما يرتبط بها من وسائل وأساليب. فإذا أخذنا المعلم على سبيل المثال، ونظرنا إلى طبيعة الأدوار المنوطة به في ضوء التطور التكنولوجي وانعكاساته على الميدان التربوي، لمسنا بشكل واضح البون الشاسع بينها وبين ما كان يسند إليه من أدوار ومهام في المرحلة السابقة، فالمعلم لم يعد، في العصر الراهن، يمثل المصدر الأعلى ولا الأوحد للمعرفة، بل أصبح مركز الثقل في دوره كامنا في ما يقدمه من إرشاد وتوجيه للمتعلمين لحسن التصرف والتعامل مع الكم الهائل من المعرفة الذي تتيحه قنواتها المتدفقة باستمرار، وعلى رأسها الشابكة أو شبكة الأنترنيت العنكبوتية، أي أن اللب في مهمة المعلم ذو طبيعة منهجية، لكونها تتعلق بالبناء المنهجي لعقول المتعلمين.
فالمطلوب من المعلم في ظل تحولات العصر وفتوحاته التكنولوجية، هو أن يكون أداة ولوج ناجعة إلى عوالمه المليئة بالحقائق والأسرار، وامتلاك المفاتيح الكفيلة بفهمها واستثمارها على الوجه الصحيح والبناء، وبأسلوب إبداعي.
“ما نحتاجه كما يرى أيان جاك هو القدرة على زيادة قدرتنا على تفسير ما نملكه من معلومات، وعلى تطبيق هذه المعلومات على ما يواجهنا من مشكلات وبأقصى قدر من الخيال والقدرة على الابتكار وخلق مواد واستخدامها ومشاركة الآخرين بها، وهي المهارات المطلوبة لسوق العمل في القرن الواحد والعشرين“22
ويسلمنا الحديث عن المعلم المرشد المبدع كإحدى ركائز النظم التربوية المعاصرة، إلى الحديث عن موقع المتعلم في تلك النظم، إنه موقع المركز الحيوي الذي تتمحور حوله العملية التربوية برمتها، باعتباره المخرج النهائي المتوخى بلوغه والظفر به وفق مواصفات معينة، حتى إذا ما تم ذلك، كان بمثابة مفتاح النهوض، وركيزة التجديد في حياة الأمم المعاصرة.
إن “الهدف المنشود من التعليم هو إنشاء جيل من الطلاب قادر على تعليم نفسه. ويعتبر هذا الأمر غاية في الأهمية خصوصًا في القرن الواحد والعشرين، عصر التغير السريع في التكنولوجيا، حيث يجب تعلم المهارات باستمرار وإعادة تعلمها. يعتبر المتعلمون الذاتيون عناصر فعّالة للتخطيط ويكملون مسيرتهم دون مطالبتهم بذلك. إنهم يعرفون كيفية تحديد نطاق واسع من المصادر والأدوات واستخدامه. كما يتحملون المخاطر المناسبة ويتعلمون من أخطائهم.
يوضح الأدب أن الصفوف الدراسية التي تؤيد التعليم الذاتي تعمل على تطوير الطلاب الذين لديهم فضول وميل لتجربة أشياء جديدة (جاريسون، 1997م)، والنظر إلى المشكلات على أنها تحديات والرغبة في التغيير والاستمتاع بالتعليم (تايلور، 1995م). كما اكتشف تايلور أيضًا أن الطلاب في هذه البيئات يتميزون بالإقدام والإصرار والاستقلال والانضباط الذاتي والثقة بالنفس وأن لديهم هدفا يوجههم. تدعم كل هذه الخصائص مهارات القرن الواحد والعشرين التي يجب على الطلاب اكتسابها لينجحوا في مساعيهم المستقبلية”.23
ومن نافلة القول: إن الحصول على متعلمين بالمواصفات السالفة الذكر، يتوقف وجوبا على مناهج خصبة وطرائق فعالة تحرك مكامن العقل والوجدان في شخصيات المتعلمين، وتشحذ طاقاتهم وملكاتهم الإبداعية، وتحافظ عليها في حالة توقد وإشعاع. وهذه ثالث سمة تميز النظم التربوية المعاصرة.
إن طبيعة البيئة التي تكتنف النظم التربوية في المجتمعات المعاصرة، هي من التنوع والتعقيد، وخاصة في بعدها التقني والمعلوماتي، بحيث تولد لدى المتعلمين اتجاهات وقابليات لمواكبة ذلك الوضع، والاستجابة لحوافزه ومثيراته، ومن ثم اكتساب مهارات جديدة لم تكن موجودة عند الأجيال السابقة.
لقد أصبح” للأطفال طرق متنوعة وجديدة لإيجاد الروابط البصرية واللغوية والمنطقية، وهذه الطرق الجديدة التي فرضها التعلم الرقمي لا تتوافق مع مفهومنا المتعارف عليه حول مدى التفكير ومستوى التركيز، فطبيعة المعلومات المتعددة والمصادر اللامحدودة لهذه المعرفة، تتيح للمتعلم أن يفكر بشكل أسرع بكثير مما كان متعارفًا عليه عقليًا.
لقد أثرت بيئة النت على مفاهيم التعلم:
– فبيئة النت لا تعترف بالتعليم الموجه ضمن خطوط مستقيمة وبمراحل متتالية كما هو الأمر في المدارس التقليدية.
– وطلبتنا لا يفكرون فقط بشكل مختلف وإنما يتعلمون بشكل مختلف، وحين نعترف بذلك سنتمكن من إعادة تشكيل البيئة التعليمية بما يتوافق مع هذه المتغيرات.
وأشارت البحوث أيضًا إلى أن التكنولوجيا واستخداماتها قد عملت على تحسين مهارات الذكاء البصري، وكذلك التوافق البصري والحركي لدى هذه الأجيال.
– أن ثراء وتعقد البيئة المحيطة بالشخص وكما يرى عالم الاجتماع الأمريكي سكولر تتحدد بالمثيرات المتاحة وطبيعة خصائص هذه البيئة بمتطلباتها المحددة” 24
وتتمثل رابع سمة من سمات النظم التربوية المعاصرة في الحرص على الاسترشاد بنتائج البحث التربوي، بقصد التحسين والتطوير، اعتقادا منها بأن تلك البحوث، هي الكفيلة بالكشف عن عوامل التعثر وجوانب الاختلال، وتكوين تصورات، ووضع خطط لسدها وتجاوزها، وهي الكفيلة أيضا بالكشف عن جوانب القوة في السلوك التربوي لإبرازها ودعمها.
غير أن الإشادة بموقع البحث التربوي في النظم التربوية المعاصرة، لا تعني أن نتائج ذلك البحث تجد طريقها دوما إلى التنفيذ، كما أنها لا تحجب عنا بحال، ما يعتري بعض تلك النتائج من بعد عن التفسير الحقيقي لبعض الظواهر، بسبب اختلال في الرؤية التي تحكم مناهج المقاربة للظواهر التي يزخر بها الميدان التربوي.
وتكمن السمة الخامسة من سمات النظم التربوية المعاصرة في اعتماد مبدأ التكوين المستمر الذي من شأنه أن يحافظ على نجاعة النظام، بإقداره على مواكبة المستجدات، وتجنيبه عوامل التآكل والجمود على القوالب المعهودة. وغير خاف ما لبرامج التكوين المستمر، من علاقة تفاعل تربطه بالبحث التربوي، فهذا يزود تلك بالعناصر الجديدة، والرؤى، ومسوغات التكوين على مستوى المواد والمنهجيات.
وتكمن السمة السادسة في علاقة التكامل وتبادل المصالح و الخدمات التي تربط بين النظام التربوي التعليمي، وبين مؤسسات المجتمع ومنشآته، وذلك من خلال ما تبذله هذه من تمويل سخي، وما يقدمه ذاك في مستوياته العليا من ثمرات البحث وبراءات الاختراع، وهذا وجه من وجوه التساند والتعاضد داخل المجتمع الغربي، والتي تجري مجرى إحدى قيمه العليا ذات الأثر البليغ في مسيره ومآلاته.
وتتمثل سمة سابعة على جانب كبير من الأهمية والخطورة، في سيادة المبدأ الليبرالي الفلسفات الموجهة للنظم التربوية المعاصرة، بما ينعكس على مناهجها على مستوى التصورات والقيم، تذبذبا واضطرابا، فلا تكاد المنظومة تعرف استقرارا ولا تماسكا على ذلك المستوى، وهي ثغرة قاتلة وخرق عظيم في الكيانات التربوية المعاصرة، لأنها تخلف آثارها الوخيمة على صعيد بناء الأفراد والمجتمع، وعلى مستقبل حضارة الغرب بشكل عام.
لقد أفاض علماء التربية وفلاسفتها في الغرب في مناقشة أزمة التربية هناك، لتحديد أسبابها، وانتهى كثير منهم إلى إرجاعها إلى الفجوة القائمة في المناهج التربوية، بين العلوم وبين الإنسانيات، وفي تمركزها على الجانب الاقتصادي المادي، على حساب البعد الروحي، ومن هؤلاء العلماء، إرنست بيكر الذي ناقش “مشكلة ضعف العلوم الإنسانية في التربية الغربية عامة، فدعا إلى مواجهة هذه الأزمة بشجاعة ووضوح، إذا أراد الغربيون إحكام النظام الاجتماعي. وذكر أن من الأسباب التي تجعل الإصلاح الاجتماعي يبرز دائما ضعيفا، وينقلب ضد الإنسان الغربي، هو أن التربية استبعدت البعد الروحي والتسامي بالنفس اللذين يعطيان الحياة الدنيوية معنى أسمى.”25
رابعا: خصائص المجتمعات العربية والإسلامية المعاصرة
1- مجتمعات تسود فيها أعلى نسب الأمية
إن من أبرز الخصائص التي تطبع المجتمعات العربية والإسلامية ارتفاع نسب الأمية فيها، بما يعنيه ذلك من إعاقة لحركة التنمية والنهوض، وقطع لجسور التواصل بين فئات المجتمع، وتوهين لعوامل التماسك والتوحد على المستوى الثقافي والفكري. ورغم التسليم بأن الأمية ليست في حد ذاتها العامل الأوحد من وراء أوضاع التخلف في المجتمعات العربية والإسلامية، فإن الاقتناع قائم بأنها تشكل بيئة خصبة لتفريخ ما سواها من العوامل، فهي إذن أصل أصيل لعدد كبير من الكوارث والبلايا على أكثر من صعيد في تلك المجتمعات.
ويكفي أن نعرف الرقم الهائل لاستشراء هذه الآفة، لندرك هول ما يترتب عنها من عواقب.26 وندرك جسامة هذه العواقب، عندما ندرك ثقل وأهمية “مؤشر المعرفة والتعليم، (…)، باعتباره مؤشرا أساسيا معتمدا في باب فهم وتفسير مظاهر التخلف السائدة في مجتمعاتنا. (…) وقد ازدادت أهمية هذا المؤشر في النظريات الاجتماعية الجديدة في مجال التنمية، حيث أصبحت العناية تتجه لإبراز الأدوار الهامة التي تلعبها المعرفة في مجال التنمية الإنسانية الشاملة، كما أصبحت البنيات المعرفية وبنيات التنشئة الثقافية تشكل مداخل أساسية، في باب مقاربة كثير من الظواهر السلبية المهيمنة على المجتمعات المتخلفة”27
ولا بد هنا من التعقيب على هذا الكلام بالقول: إن اعتماد معيار أو مؤشر المعرفة، كمعيار تفسيري في مجال تحليل الظواهر المجتمعية، ومنها موضوع التنمية والتخلف، لا يمكن أن يؤخذ على علاته، أي مجردا عن سياقه وإطاره الحضاري. وإذا كان هذا الحكم ساريا بشكل عام على سائر المجتمعات، فإنه يسري بشكل أوثق وألزم على المجتمعات العربية والإسلامية التي قام كيانها على أساس الدين، في صيغته النهائية الشاملة، وفي وضعه الصحيح المبرأ من الوهم والتحريف. فمؤشر المعرفة هنا، لا بد أن يؤخذ مقترنا بالمعيار الأسمى الذي هو القراءة باسم الله، أول أمر نزل به الروح الأمين على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
وإذا كان الخروج من الأمية الأبجدية مدخلا لازما لما بعدها من درجات مفترضة في سلم الارتقاء المعرفي، فإن ذلك لا يمكن أن يكون حجابا دون التمييز بين مفهومين في نطاق الرؤية الإسلامية، هما مفهوم الأمية ومفهوم الجهل، فليس الثاني موازيا للأول بالضرورة، بل إنه قد يحضر بكثافة حتى في ظل ركام معرفي، لا يهتدي بنور الإسلام. ومن ثم وجب التنصيص في هذه النقطة على أن منهجية تناول مشكلة الأمية في سياق “مشروع نظام تربوي أصيل”، منهجية تعلو على المعالجة السطحية التي لا تتجاوز الأرقام المجردة، والإحصائيات الباردة، فهي منهجية تتسم بالعمق والشمول، وترتبط برؤية الإسلام، ومنظومته القيمية الخالدة.
2- مجتمعات موسومة بسمة التخلف الاقتصادي والاجتماعي
لست معنيا بمعالجة هذه النقطة على سبيل التوسع والتفصيل، ولكن من باب الإشارة والتركيز على البعد التربوي، باعتباره العامل الذي يحتل الصدارة في المسؤولية عن أوضاع المجتمعات واتجاهاتها، سلبا أو إيجابا، نموا أو تخلفا، وهذا أمر تقتضيه طبيعة المشروع الذي نحن بصدد بحث أسسه وجوانبه ومقتضياته، فهو مشروع تربوي بامتياز، وإن كان يتغلغل، من حيث آثاره ونتائجه، في كل الميادين والقطاعات، لكونه يتجه إلى صناعة الإنسان، وصياغة شاكلته، بقصد إسعاده في نفسه، وجعله وسيلة لإقامة المجتمع الآمن السعيد.
وبناء عليه أقول: إن سمة التخلف التي تصم المجتمعات العربية والإسلامية، ترجع في قسط كبير منها إلى الاختلال المزمن الذي تعانيه على المستوى التربوي، بسبب غياب النموذج الأصيل، الذي يشحذ المواهب ويحرك الطاقات، بفضل استجابته لنداء الفطرة، وقدرته على التجميع والتركيز والتنظيم، في اتجاه المقاصد والأهداف.
إن أوضاع التخلف الشامل الذي يطبق على عموم الأمة، إنما مرده إلى اختراق جسمها بعناصر غريبة عنه كل الغربة، أدت إلى تحطيم بنيته وتعطيل حيويته، وامتصاص طاقاته، “لقد أثبتت الوقائع أن الأرضية الغربية التي سادت في بلادنا تحت شعار ( الحداثة) لم تأت لتحق تقدما وتطويرا، لا على المستوى المادي، ولا على المستوى الثقافي والفكري، بل دمرت عوامل التقدم والتطوير حين حطمت مصادر الاستقلالية، وحولت الوطن الواحد إلى أوصال مقطعة وملحقة وتابعة. ورغم ذلك يقال للشعب: عليكم أن تتبعوا النمط الغربي، وتروا العالم ضمن رؤاه، وتتطوروا وفق مساره وسياقه”28
ومن الأكيد أن جوهر المشكلة في كل ذلك، تصوري قيمي، يتعلق بنوعية القيم السائدة في المجتمع، وبالمرجعية الكبرى التي تستند إليها، وبمدى التجانس الفكري بين تلك القيم. وما سوى ذلك من العوامل، يمكن إرجاعه بشكل منطقي وواقعي إلى ذلك الجوهر باعتبارها (أي العوامل) نتائج وأعراضا.
وعندما نتحدث عن التجانس الفكري بين القيم، فإننا نتحدث عن جو ثقافي تتوحد فيه المواقف والأفكار، وتتوحد على صعيده المقاييس والأهداف، يقول مالك بن نبي رحمه الله مبرزا أهمية هذا الوضع وحيويته بالنسبة لحياة المجتمع وفعاليته الحضارية: “إن عناصر الثقافة تذوب في كيان كل من المجتمع والفرد، لتطبع أسلوب حياة الأول وسلوك الثاني، اللذين يجري التفاعل فيما بينهما، بحيث لا يسمح المجتمع للفرد بالنشوز، ولا الفرد للمجتمع بالانحراف، وهو ما يسمى بعملية النقد الذاتي، التي يعبر عنها الإسلام بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الوضع عندما يزول، نصبح أمام أزمة ثقافية تعبر عن نفسها في تعذر تركيب العناصر الثقافية في منهج تربوي.”29 أي نكون أمام حالة من التفكك والضعف والوهن، تترجم عن نفسها في مختلف ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تخلفا وتدهورا.
إن من أعظم الثغرات القاتلة في التعامل مع موضوع التقدم ومشاريع النهوض في البلاد العربية والإسلامية، النظر المبتور الذي يسلخ الجانب التقني المادي عن البعد القيمي الروحي، والذي يعتقد بمقتضاه، أن عملية النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، هي عملية تقنية إجرائية ليس إلا، أي أنها بتعبير آخر، عملية ميكانيكية مجردة عن أي محتوى روحي، أو مضمون قيمي، يحرك أجهزتها ودواليبها في الاتجاه المرغوب. يقول محمد سعيد رمضان البوطي: “يظن كثير ممن يثورون على التخلف وأسبابه، وينشدون التقدم ويبحثون عن سبيله، أن مفتاح التقدم العلمي والرقي الاقتصادي، كامن في الوسائل العلمية والتنظيمات والتخطيطات المباشرة فقط. ولا يتصورون أن للمعارف والأخلاق الإنسانية وأصول الثقافة أي دور في الموضوع”.30 ثم يضيف ما معناه: إن قواعد التكنولوجيا وأصول الاقتصاد لا تعدو أن تكون سلما يحتاج من يريد ارتقاء درجاته إلى حوافز، وليست تلك الحوافز إلا تغذية العقول “بالمعارف الإنسانية المختلفة، مضمومة إلى ثقافة الأمة من لغة وآداب وتاريخ وأعراف”31. ولن تكون تلك الثقافة ولا الآداب – بطبيعة الحال – إلا نابعة من معين الإسلام، معبرة عن مكارمه ومقاصده.
3- مجتمعات تحتضن أفكارا وقيما تنتمي إلى أنساق متناقضة ومتنافرة
من أبرز الأزمات ومظاهر الاختلال التي تعاني منها المجتمعات العربية والإسلامية، ما يتعلق منها بانعدام الوحدة والتجانس على مستوى القيم والتصورات وأنماط التفكير، فقد تصل هذه الظاهرة إلى درجة التناقض والتناحر، الذي يتحول معه الوضع الاجتماعي والثقافي إلى ساحة للصراع الشرس الذي يهدر الطاقات، ويقضي على المبادرات، ويفوت فرصا ثمينة للبناء والارتقاء، وإن الذي يزيد الأزمة تفاقما، أن تعمق منظومات التربية والتعليم ذلك الشرخ، وتزيده امتدادا وتغلغلا في أوساط الأجيال التعليمية، من خلال التمكين لأنماط الفكر والسلوك الغريبة عن وجدان الأمة التاريخي وميراثها الحضاري، بما يؤدي حتما إلى تمزيق شبكة العلاقات الاجتماعية وتفكيك أوصالها.
وغير خاف أن أصل هذا الداء، هو ما توارثته النظم التربوية عن سياسات المستعمر من نظم ومذاهب منبتة، واحتضنته النخب المغربة المصنوعة على عينه، مستهترة بذلك أيما استهتار، بهوية الأمة وكرامتها وشهودها.
لقد نبه إلى خطورة هذا الوضع على مستقبل الأمة المسلمة والجهود الرامية إلى تحررها واستقلالها، المفكر النمساوي المسلم محمد أسد رحمه الله بقوله: “ما دام المسلمون مصرين على النظر إلى المدنية الغربية على أنها القوة الوحيدة لإحياء الحضارة الإسلامية الراكدة، فإنهم يدخلون الضعف على ثقتهم بأنفسهم، ويدعمون بطريقة غير مباشرة ذلك الزعم الغربي القائل بأن الإسلام “جهد ضائع”. لقد بسطنا في الفصول الماضية بعض الأسباب المؤيدة للرأي القائل بأن الإسلام والمدنية الغربية – وهما يقومان على فكرتين في الحياة متناقضتين تماما – لا يمكن أن يتفقا. فإذا كان ذلك كذلك، فكيف نستطيع أن نتوقع أن تظل تنشئة أحداث المسلمين على أسس غربية، تلك التنشئة القائمة في مجموعها على التجارب الثقافية الأوروبية وعلى مقتضياتها، خالصة من شوائب النفوذ المعادي للإسلام؟”32
فمن بدائه الأمور، إذن، أن يكون المخرج من هذا الوضع المأزوم، هو إعادة الوحدة والتجانس المفقودين إلى المحيط الاجتماعي والثقافي، عبر إعادة هيكلة النظم التربوية القائمة، وما يرتبط بها من نظم داعمة أو قرينة، على أساس المفهوم الأصيل للتربية والتثقيف.
4- مجتمعات تتميز بسلطان التقاليد
يقصد بالتقاليد ما ترسخ في المجتمع من تصورات واعتقادات وأنماط للتفكير والتصرف والسلوك، عن طريق التقليد والمحاكاة، أو عبر آليات الضغط الاجتماعي، وعن طريق التنشئة الاجتماعية. وتكتسب التقاليد صفتها من خلال جريانها التلقائي عبر علاقات الناس الاجتماعية، باعتبارها معايير للتمييز بين البدائل في موقف من مواقف الحياة.
ويمكن التمييز في التقاليد السائدة في المجتمعات العربية والإسلامية بين ما له جذور في تصورات الدين وقيمه وأحكامه، وبين ما لا يعدو أن يكون مجرد تصورات شعبية فجة، لا أصل لها من شرع أو عقل، وسيادة هذا النوع الأخير في أوساط المجتمع، من شأنه أن يطبعه بطابع الجمود الفكري، ويعوقه عن التطور والإبداع.
والمعول في ضبط مسار هذه المجتمعات على تصحيح المفاهيم والتصورات، على أساس الرؤية الشرعية ومنهجها القائم على التوحيد والواقعية والشمول، وعلى نشر الثقافة البانية المتشبعة بقيم الدين، مما يستحث في الناس روح العمل والعطاء، والتعاون على البر والتقوى، ويعمق فيهم نزعة الخير والإصلاح.
وتمثل مؤسسات النظام التربوي الأصيل، عند إحيائها وبثها عبر ربوع العالم الإسلامي، طلائع البعث والإحياء، وإرجاع حركة الحياة إلى مجراها الأصيل، على هدى من سنن الله في الكون والاجتماع، ومن أحكام شرعه القويم. وسبيلها إلى إنجاز تلك المهمة الشاقة، هو بناء الشخصية المتميزة، المتسلحة بالرشد المنهجي، والتحصين الخلقي، والوعي الحضاري، وفعالية المبادرة، وعلو الجاهزية للإنجاز والتنفيذ.
إن في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والسيرة العطرة، زادا وفيرا، وخزانا لا ينضب، لإعداد العدة المنهجية، ولصياغة الآليات التطبيقية المعينة على تحقيق ذلك المطلب العزيز. وإذا كانت الجهود المبذولة عبر العصور التاريخية قد خلفت قاعدة صلبة في ذلك المضمار، فإن الباب يظل مفتوحا لكل إضافة، على هدى من النموذج وما يرتبط به من مقاصد من جهة، وفي ضوء الحاجات المتجددة من جهة أخرى.
خامسا: ملامح الواقع التربوي في العالم العربي33
1- تمهيد
إن الذي يخول لنا الحديث عن الواقع التربوي العربي في صيغة العموم، كما هي مثبتة في العنوان أعلاه، هو اشتراك شعوب ذلك العالم والنظم السائدة فيه، في جملة من الخصائص والمقومات العامة، ترتبط بالجغرافية والسياسة والتاريخ، وبالميراث الثقافي والحضاري في شموله، وكذا بالتجارب النهضوية والتنموية التي انخرطت فيها تلك الأنظمة والشعوب، بما فيها ما تعلق بالتربية والتعليم، وبمجمل التأثيرات التي خضعت لها، بفعل عوامل خارجية.
وليس يحجب هذا التعميم عنا ما هنالك من خصوصيات ينفرد بها كل قطر على حدة، مما له علاقة ببعض التفاصيل والجزئيات، بما فيها تلك التي تكتسي طابعا إحصائيا، فالعبرة في هذا المقام بالوضع العام.
وفي ضوء هذه القاعدة، سيان أن نقوم بجرد عام لأحوال المنظومات التربوية، من خلال بعض المعايير، أو أن نختار حالة أو أكثر، نسلط عليها ضوء الدرس والتحليل في ضوء نفس المعايير، فالراجح أن الأمر يؤول إلى نتائج متشابهة أو متقاربة.
سأعالج هذا المحور بالأسلوب الثاني، أي من خلال دراسة حالة هي حالة النظام التربوي المغربي، مع إيراد بعض أوجه المقارنة بنظام دولة قطر التربوي، وذلك من خلال النقاط التالية:
2- تحديد المفاهيم
أ- ملامح الواقع التربوي:
الملامح هي القسمات التي تشي، عند ملاحظتها، بمعنى من المعاني، أو تنطق بحقيقة معينة، تدرك من خلال مجموعها أو بعض أجزائها، وملامح الواقع التربوي، هي السمات التي تعبر عن شخصية ذلك الواقع، بما تعكسه من اتساق أو اختلال، أو استواء أو اعتلال، يتصف به ذلك الواقع، بحكم طبيعة العناصر التي يتألف منها، وطبيعة التفاعلات التي تجري بينها، ونوعية الإفرازات التي تنتج عن تلك التفاعلات.
والواقع التربوي المغربي هو ما يتمخض عن اشتغال النظام التربوي بجميع مكوناته وعناصره، من ظواهر ومخرجات، تتراوح بين تلبية الحاجات، التي ترصد من قبل من هم في مركز التسيير والقرار، وبين القعود عن تلبيتها وتحقيقها، لعدم كفاية ذلك النظام.
ب- مفهوم المنظومة:
المنظومة هي النسق، وقد عرفه معجم التقويم والبحث التربوي بأنه “كل مؤلف من عناصر متساندة ومترابطة، وهي في تفاعل مستمر. وكما أشار مينون إلى ذلك، فإننا لا نستطيع أن نتحدث عن نسق حقيقي، إلا إذا كان الفعل الخاص لمختلف العناصر نتاجا للتفاعلات بين تلك العناصر، تلك التفاعلات التي تخضع لمنطق خاص بها”34
“يرشدنا هذا التعريف على جملة خصائص، لا بد أن تتصف بها المنظومة أو النسق، نحددها فيما يلي:
– “المنظومة” كل مؤلف من عناصر متساندة ومترابطة“. ومن ثم فإن حصول أو تحقق مطلب التجانس في الطبيعة والهدف بين تلك العناصر، أمر ضروري، إلا إذا كنا بالضرورة، وبحكم هذا التعريف، أمام شتات من العناصر لا يشدها خيط ناظم ولا نسق مرصوص.
– توجد عناصر المنظومة أو النسق “في تفاعل مستمر“. ونفهم من ذلك انتفاء وقوع التنافر، بمعنى التناقض بين عناصر النسق، وإلا كان النسق – مع التجاوز في تسميته كذلك – محتويا على إمكانية انتسافه، لأنه لا يملك عوامل الاستمرار في الحياة.
– الفعل الخاص لمختلف العناصر نتاج “للتفاعلات بين تلك العناصر“. وهذه الصفة أو الخاصية، وإن كانت تتضمن قدرا وافرا من الصواب، إلا أنه يمكن التحفظ عليها في جانب واحد، هو جانب الإطلاق في الحكم، لأنها تنفي أدنى استقلالية لكل واحد من عناصر النسق، وهذا نفي لأمر واقع بالنسبة لكل عنصر، على تفاوت في درجة الاستقلالية بين عناصر النسق.
تفاعلات عناصر “المنظومة” أو “النسق”، تخضع لمنطق خاص بها” ومما لا شك فيه، أن ذلك المنطق الخاص، هو بمثابة المرجعية الفكرية والفلسفية التي تحكم تفاعلات العناصر فيما بينها، وتقوم بتسديد حركتها ومسارها.
– ونخلص في نهاية هذا التحديد، إلى أن هناك ارتباطا وثيقا وعلاقة محكمة بين الخاصية رقم (1) والخاصية رقم (2)، تتمثل في أن خاصية المنطق، ( أو المنطقية)، تنعدم بالضرورة في حالة انتفاء عنصر أو خاصية التساند والترابط والتجانس والانسجام، ومعنى ذلك، أن نصبح بإزاء وضع الفوضى والشتات كما أسلفت القول.”35
ويميز البعض بين المنظومة والنظام على اعتبار أننا في “المنظومة” نحيل إلى بنية تتميز عناصرها الداخلية بالانسجام والتماسك بين محتواها المعرفي، وطرق اشتغالها على المستوى البيداغوجي ومؤسساتها المادية، في حين أن “نظام” التربية والتعليم، يفترض فيه أن يكون حاملا ومترجما لمشروع اجتماعي واضح متوافق بشأنه، باعتباره جزءا من النظام المجتمعي، ومترجما لحاجياته، ومعبرا عن اختياراته الاستراتيجية وتطلعاته.”36
ومن ثم فإننا لا بد أن نأخذ هذا التمييز بعين الاعتبار عند ممارسة التحليل، مع التسليم بالارتباط الكائن بين الكيانين، أي المنظومة والنظام، إذ المفروض في الأولى أن ترتكز في اشتغالها على الثاني، وتستمد منه مصداقيتها الخارجية، التي تتمثل في ضرورة الاستمداد والاسترشاد بالرؤية الفلسفية العامة التي يعبر عنها النظام.
سأتناول واقع النظام التربوي المغربي من خلال شقين: يتعلق أولهما بلمحة وصفية تحليلية لمظاهر وظواهر وتجليات ذلك الواقع، كما أبرزتها البحوث والدراسات، وعكستها معطيات الإحصاء، ويتعلق ثانيهما بدراسة تحليلية شاملة، لمحتوى وثيقة مرجعية قعدت لإصلاح مأمول، خلال العشرية المنصرمة، ورسمت حدوده واختياراته ومنطلقاته الكبرى، على مستوى المضامين والكفايات والقيم، وأعني بذلك “الكتاب الأبيض”.
سادسا: لمحة وصفية تحليلية37 عن الواقع التربوي المغربي
1- من حيث مدى التناغم والانسجام، أو عدمهما، بين مكونات المؤسسة التربوية باعتبارها وحدة سوسيولوجية، أي من حيث كونها كيانا قائم الذات داخل المجتمع.
إن المفروض في الواقع التربوي، أي النظام التربوي مطبقا في الواقع، من خلال مؤسساته المختلفة والمتعددة، أن يعبر عن انسجام وتساند بين مختلف المهام والأدوار المنوطة بمن يشتغلون في إطاره، فضلا عن ملاءمة البيئة المدرسية وما حولها لكل ذلك، وأن يعبر قبل ذلك ومن خلاله، عن انسجام وتوافق بين القيم التي تسري في أوصاله، وبينها وبين المرجعية المصرح بها من طرف مركز السلطة والقرار، وأن تشكل الأسرة سندا صالحا يدعم أهداف المؤسسة التعليمية، فإلى أي حد يعكس الواقع ذلك المطلب؟
يقتضي الجواب على هذا السؤال، الوقوف عند مكونات العملية التعليمية أو أركانها، وكذا البيئة المحيطة بها، وكل العوامل المؤثرة في توجيهها وضبط مساراتها، وتحديد محصولها ونتاجها.
– الوضع التعليمي المغربي بلغة الأرقام.
“احتل المغرب المرتبة الأخيرة بين دول المغرب العربي على الصعيد التربوي وفق دراسات دولية نشرت أخيرا وتعترف الحكومة بمضمونها إلى حد بعيد في وقت يسعى فيه هذا البلد إلى تحقيق تنمية مستدامة.
وأقر مزيان بلفقيه مستشار العاهل المغربي محمد السادس والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم أخيرا: “وضعنا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المرتبة 126 من أصل 177 بلدا على صعيد التنمية البشرية والتعليم المدرسي هو سبب هذا التصنيف”، وتابع “إننا نخسر عمليا ثلث تلاميذنا مع كل مرحلة دراسية (…) على طول المسار الدراسي من المدرسة الابتدائية إلى الجامعة.”
وحسب الإحصاءات الرسمية التي قدمها الوزير أمام برلمانيين ومختصين بالشأن التربوي فإن 40% من التلاميذ لا يكملون دراستهم، إذ غادر مقاعد الدرس أكثر من 380 ألف طفل قبل بلوغهم 15 سنة عام 2006.
وتؤكد دراسة بعنوان “التعليم للجميع” أن أكثر من 80% لا يفهمون ما يدرس لهم، وتضيف أن 16% فقط من تلاميذ الرابع الابتدائي يستوعبون المعارف الأولية لجميع المواد المقدمة لهم.
هذه الفئة من التلاميذ احتلت مراتب متأخرة في الاختبار الدولي للرياضيات عام 2003 حول 25 دولة واحتلت المرتبة الـ24 في مادة العلوم، بينما احتل تلاميذ الثانوي المرتبة الـ40 على 45، وأكثر من نصفهم لم يحصلوا على النقاط الدنيا.
وتشير إلى هذا الانهيار دراسة للبرنامج الدولي للبحث حول القراءة أجريت عام 2006م، إذ احتل تلاميذ الفصل الرابع ابتدائي المرتبة الـ43 على 45، وربعهم فقط وصلوا للمستوى الأدنى المطلوب.
تشخيص وزارة التعليم تناول أيضا وضعية المدرسين ومدى مسؤوليتهم، وخلص إلى أنهم “ضحايا ومسؤولون” في الوقت نفسه مؤكدا أنهم بحاجة إلى تكوين مستمر وأن العاملين بالقطاع الخاص يلجونه دون أي تكوين.
وصنف تلامذة المدارس الابتدائية في المغرب في المرتبة الأخيرة في العلوم والقراءة وقد اثبت البرنامج الدولي لقياس مدى تقدم القراءة في مدارس العالم (بيرلز) ومقره كيبيك في كندا أن أداءهم تراجع عام 2006م عما كان عليه قبل خمس سنوات.
وقد دعت منظمة اليونسكو الرباط إلى تغيير جذري في سياستها لضمان التعليم للجميع عام 2015م” خلال اجتماع عقد أخيرا في تونس.
وقال بلفقيه “إن النفقات التي يكلفها التلميذ مغربي تبلغ 525 دولارا في السنة مقابل 700 في الجزائر وأكثر من 1300 في تونس.”
وقال محمد ضريف لوكالة فرانس برس “إن تاريخ نظام التعليم منذ الاستقلال هو تاريخ أزمة. فكل عقد تظهر إصلاحات جديدة غير أنه لم يتم حتى الآن وضع أي إستراتيجية فاعلة ودقيقة التحديد.”
من جهته قال وزير التربية أحمد اخشيشين “إننا البلد الوحيد في العالم الذي لا يملك نظاما لتقييم التحصيل الدراسي.”
ونددت صحيفة “ليكونوميست” المقربة من أوساط الأعمال ب”عيوب” في النظام التعليمي مضيفة انه “مع سقوط التعليم في المغرب يتوجب إجراء علاج استثنائي لسلك المعلمين.”
ومنذ الاستقلال شهد المغرب تعديلات جذرية في مجال التعليم لينتقل من نظام اعتماد اللغتين الفرنسية والعربية إلى التعريب الكامل للتعليم في نهاية السبعينات قبل التشجيع مؤخرا من جديد على تعلم اللغات الأجنبية.
ويخصص المغرب الذي يعد حوالي سبعة ملايين تلميذ و170 ألف أستاذ ميزانية بقيمة 31 مليار درهم (72 مليار يورو) للتعليم خلال العام 2008م ما يمثل 26% من ميزانية الدولة.
وان كان التعليم في المدارس حتى سن الحادية عشرة تحقق بشكل شبه كامل فان الأمر يصبح أكثر تعقيدا بعد ذلك، فمن بين مئة تلميذ في الصفوف الابتدائية لا يواصل منهم سوى 13 فقط الدراسة حتى الحصول على شهادة الباكالوريا عشرة منهم يعيدون الصف مرة على الأقل.
كما يجرى التنديد باستمرار بتهالك البنى التحتية مع اعتبار تسعة ألاف قاعة صف غير صحية ولا سيما في المناطق الريفية حيث لا يصل التيار الكهربائي إلى 60% من المدارس وتفتقر 75% منها إلى مياه الشرب وأكثر من 80% منها ليس بها مرافق صحية.”38
وصف أحد الباحثين الوضعية التعليمية بالمغرب بقوله: “إن آفاق التعليم بالمغرب تتحكم فيها عدة عوامل ذاتية وموضوعية، ويمكن حصر أهم هذه العوامل في:
– فرض المقررات بشكل صارم.
– افتقار المؤسسات إلى المرافق والتجهيزات المساهمة في توفير ظروف تسمح للتلاميذ بالمشاركة والعمل.
– إهمال إعادة تطوير الأطر التعليمية بشكل منظم و جاد.
– تكريس الأنشطة غير المناسبة لمستوى و أعمار التلاميذ.
– نهج الوسائل التربوية غير الصالحة للتلاميذ.
– التأخر الدراسي.
– بالإضافة إلى عدم اطمئنان التلاميذ على مستقبلهم، خاصة تلاميذ التعليم الثانوي.
– تكريس العلاقة السلطوية التي تؤدي إلى عقوبات تأديبية تصل إلى حد الطرد”39
إننا إذا نظرنا إلى الوضع التعليمي التربوي المغربي من خلال المعطيات الإحصائية أعلاه، والأحكام المعبر عنها سواء من طرف المسؤولين النافذين في سدة القرار، أو الدارسين والملاحظين، في حقه، أيقنا أننا أمام مشهد يبعث على المرارة والألم، ويثير المخاوف على الأجيال، وعلى الأمة جمعاء.
إن من العوامل المذكورة ما يندرج في خانة الأسباب، ومنها ما يندرج في خانة النتائج، ومنها المتعلق بالشروط المادية، والمتعلق بالشروط النفسية، غير أن الركن الغائب في هذه العوامل والأسباب، والحال أنه هو الذي يحتل الصدارة في الأهمية، هو المتعلق بالرؤية والمقاصد، فهو الذي عنه تنبثق كل أشكال الانحراف والاعوجاج في البرمجة والتطبيق، في حال الزيغ عن التصور السليم، والاختيار التربوي الصائب. والدليل على ذلك، أن محاولات الإصلاح التي عرفها النظام التربوي المغربي، والتي منيت بالإخفاق، هي من الوفرة بمكان. إن ما لا يمكن أن يتطرق إليه الشك، هو ألا تكون العلة وراء المراوحة والإخفاق كامنة في الجانب المادي والتنظيمي الإداري فقط، على ما له من كبير أهمية، وإنما العلة الكبرى كامنة بكل يقين، في الاختيارات الكبرى للنظام التربوي، بما فيها لبها المتمثل في المرجعية العقدية الفلسفية التي تبسط سلطانها على سائر مفاصله وأركانه، وفي منظومة القيم المرتبطة بها والسائرة في ركابها، وفي الاختيارات السياسية العليا في الميدان.
لقد عبر عن هذه الإشكالية المؤرقة بعض الدارسين المهتمين بالشأن التربوي بأسئلة مشروعة ووجيهة تعكس ذلك الهم العميق:
– “هل المنظومة التعليمية مؤهلة من حيث غاياتها ومناهجها، للتوفيق بين أسس الأصالة ومستلزمات الحداثة؟ ألا تسيء “النظرية الموحدة” التي تطبع القيم التي تحملها البرامج التعليمية إلى فعالية العملية التربوية؟
– هل يمكن لهذه المنظومة أن تكون متجانسة في تربية المواطن على الوفاء للأصالة والتطلع الدائم للمعاصرة، وذلك بالتركيز على التراث من جهة، والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان من جهة أخرى؟
– ألا يعد نمط التعايش المفترض بين الأصالة والحداثة وهما، إن لم نقل إعاقة، خاصة إذا علمنا أن القطيعة المثالية وفرت شروطا أكثر كفاية لتطور المجتمعات، مقارنة بتلك التي وفرتها الاستمرارية؟”40
بغض النظر عن الخلفيات الإيديولوجية التي تحرك صاحب هذه الأسئلة، فإن الذي يهمنا فيها هو مصداقيتها على مستوى الطرح المنطقي للمسألة، وهو الطرح الذي يقتضي عدم إمكان الجمع بين النقائض على مستوى المرجعيات الموجهة لأنظمة التعليم.
إن الأمر يتعلق بوهم فعلا على مستوى التصور والنظر، وبإعاقة على مستوى الفعل والتطبيق، إعاقة لا يمكن أن تزال، إلا بزوال الوضع الشاذ الذي أنتجها.
من جهة أخرى، إننا لا نجد بدا في ظل وضعية التعثر المستمر والتأزم المزمن للنظام التربوي المغربي، من الذهاب مع الباحث التربوي مصطفى الراشدي فيما ذهب إليه وهو يطرح سؤالا جوهريا يمس صميم المسألة ويضع الإصبع على الداء؟
يقول:
“هل الإصلاحات المتكررة التي عرفها النظام التربوي المغربي في النصف الثاني من القرن العشرين كانت إصلاحات جذرية للمنظومة التربوية؟ أم أنها لا تعدوا أن تكون تغييرات شكلية مست القشور دون أن تنفذ إلى عمق المشكل؟ فالفرق بين هذين المفهومين كما يقدمه لنا ريتشارد ساك R. Saak يتمثل في أن: “الإصلاح التعليمي هو جهود تبذل في جميع قطاعات النظام التعليمي أثناء إجراء التغيير، وغالبا ما تتجاوز موجباته وآثاره ونتائجه النظام التعليمي. أما التغييرات التعليمية فهي محاولات متفرقة لتغيير أو تحسين بعض جوانب النظام التعليمي دون أن يشمل النظام بأكمله...”41
فأصل الداء ولب المعضلة إذن، يتمثل في غياب شرطين اثنين، تتوقف عليهما صلابة المنظومة وسلامتها على حد سواء: الانسجام والشمول، ويضاف إلى هذين الشرطين شرط الترشيد وحسن تدبير الموارد المادية والبشرية المرصودة لتشغيل النظام.
سأتناول فيما يلي مظاهر الأزمة بنوع من التحليل والتفصيل:
– مظاهر الأزمة:
– على مستوى الرؤية: والمقصود بها نظرة النظام التربوي إلى كل من الدين، والمعرفة والإنسان.
تتجلى الأزمة على مستوى الرؤية في الفصل التعسفي الذي يقيمه ذلك النظام بين الدين وبين المعرفة في بعديها الطبيعي والإنساني. وفي التصدي العلمي الفلسفي لهذا الفصل، يطرح علي عيسى عثمان رحمه الله، أسئلة إنكارية يعرب من خلالها عن موقف الإسلام العميق من المسألة، يقول:
“هل يجوز في نظام تعليمي إسلامي أن يفصل الدين “كمادة مدرسية” من بين مجموعة من المواد المدرسية الأخرى تساويه ويساويها في تنظيم المعرفة وفي تحصيلها، وفي توظيفها في حياة الإنسان؟
هل يجوز في نظام تعليمي إسلامي أن تفصل العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإنسانية عن الدين، وكأن لكل منها كيانه المستقل في نظام العلم والمعرفة، وكأن توظيفها في حياة الإنسان له مقاصد وغايات تختلف عن مقاصد الدين وغاياته؟
هل يجوز مثلا فصل العلوم الطبيعية عن الدين في نظام إسلامي، وقد جعل الإسلام هذه العلوم (أي معرفة آيات الله في كونه) سبيل الإنسان إلى رفض الشرك، والإيمان بالله؟
هل يجوز فصل العلوم الاجتماعية عن الدين في نظام إسلامي، وقد جعل الإسلام سلوك الإنسان وعلاقاته بالواقع الاجتماعي، وبكل ما فيه من نظم ومؤسسات سياسية واجتماعية وغيرها، ومواقفه منها، وحدة متكاملة، وهو المسؤول مسؤولية تامة عن تلك العلاقات والمواقف؟
هل يجوز فصل المعارف والعلوم الإنسانية عن الدين في نظام إسلامي، وقد جعل الإسلام معرفة النفس ومعرفة أحوالها، ومعرفة تجارب الشعوب والأمم المختلفة مرجع الإنسان في التبصر بمصير الإنسان، وبمصير الشعوب والأمم في اتباع هذا النظام أو ذاك في الحياة؟
ألا ينبغي أن تندرج هذه العلوم والمعارف جميعا في إطار الدين الكلي كما يراه الإسلام، فيخدم كل واحد منها، من زاوية اختصاصه في كشف الحقيقة، مقاصد الدين وغاياته في تربية الإنسان؟”42 إنه سؤال يحمل في ثناياه الإثبات لكل القضايا والحقائق المعلنة في الأسئلة الإنكارية السابقة، للتدليل على خصوصية النظام التربوي الأصيل، باعتباره نظاما فريدا بين سائر النظم، وأن هذه الفرادة أو التفرد علامة على ولوجه العالمية من بابها الواسع الممدود.
أما الإنسان الذي يستهدف بناءه النظام التربوي الذي يقوم على التصور السابق للدين والمعرفة، فهو الإنسان العالمي الذي يعبر عن مخزون الفطرة وخصائصها، لا الإنسان المحلي أو الإقليمي المحصور في الأطر الضيقة، والموسوم بموجب ذلك بضيق الأفق، وما يتولد عنه من سلوك لا إنساني ولا حضاري. وهذا هو مظهر التأزم في الأنظمة التربوية غير الأصيلة، ومنها النظام المغربي الذي نحن بصدد معالجته.
– على مستوى المناهج الدراسية:
المناهج جمع منهج، وهو “لغة: الطريق البين الواضح، يقال: نهجت هذا الطريق، وتعني أمرين: أولهما: أبنت معالم الطريق وأوضحتها، بوسائل مختلفة، والثاني سلكت الطريق وسرت في منعطفاته”43. ويقول أحمد المهدي عبد الحليم بعد استعراض نقدي لبعض التعاريف الرائجة في الميدان، بأنه: “مصطلح منسوج، يشير إلى مجموعة مشروعة وصادقة من المعتقدات، والقيم والمعارف، والمهارات، وألوان التذوق، والاتجاهات.
– ومن شأن هذه المجموعة المعقدة أن تدفع من يكتسبونها- بطريقة واعية أو غير واعية – إلى القيام بأنماط معينة في التفكير، وفي التواصل العقلي، وفي السلوك الفردي والمجتمعي.
– ويعهد المجتمع في إكساب هذه المجموعة المعقدة لأجياله الناشئة إلى مؤسسات أيكولوجية (المدارس والجامعات)، حيث تضطلع مجموعات مختلفة من المهنيين الملتزمين( المعلمون وغيرهم) بتقديمها لفئات مختلفة من المتعلمين. وينجح المهنيون في تقديم هذه المجموعة المعقدة بدرجات مختلفة، من خلال استخدامهم لتنظيمات وطرق وأساليب ومواد تعليمية، تختار إثر تبصر جاد، وتتخذ في شأنها قرارات، يستأنس في صنعها بآراء ممثلين لمن لهم معرفة وخبرة كافية بالخصائص الثقافية والعقلية والوجدانية لمجموعات معينة من المتعلمين”44 يرشدنا هذا التعريف الدقيق إلى جملة استنتاجات بالغة الأهمية، تسعفنا في بلوغ ما نتوخاه من هذا المحور، ومن موضوع مشروع الإحياء على حد سواء. وسأسوقها تباعا حسب ترتيب ورود العناصر المرتبطة بها في التعريف:
– ضرورة أن تكون عناصر ومكونات المنهج مشروعة وصادقة، لأنها إن لم تكن كذلك، كانت سبب تعمية للطريق وطمس معالمها بدلا من إبانتها وتوضيح مسالكها.
– لا بد أن توكل مهمة تقديم المنهج وتنفيذه إلى مهنيين ملتزمين، أي معلمين يجتمع لديهم الالتزام بقضية الأمة التي يعملون لها، أي ارتباطهم الديني والوجداني والحضاري بها، من جهة، والعلم وفن الصناعة التربوية من جهة أخرى. فليس العنصر الأول بمجزئ عن الثاني، ولا الثاني بمجزئ عن الأول.
– لا مناص من خضوع اختيار عناصر المنهج لصرامة فائقة ومن استفراغ الوسع في ذلك، إذ لا عذر في التقصير ولا في القصور في هذا المقام، لأنها أمانة ثقيلة.
– وهذا يرتب على مسؤولي التربية في الأمة أن يسندوا أمر انتقاء خبرات المناهج وما يتعلق بها، للمؤهلين لذلك علميا وتصوريا، وثقافيا وفنيا، أي لمن يتصفون بالرسالية ويؤرقهم هم الأمة ومصيرها، فضلا عن حدة وعيهم بتاريخ الأمة وميراثها الحضاري، وحاجاتها الآنية والمستقبلية.
نخلص من هذه الاستنتاجات إلى حقيقة ناصعة مفادها أن المنهاج التربوي إذا لم تتوفر فيه شروط المشروعية والصدق، والخبرة وحسن الانتقاء، والاختصاص والالتزام، فسيكون اسما على غير مسمى، لأنه بدلا من أن يكون دليل إبانة للحق وسبيل إدراك للمقاصد، سيكون سبب تعمية للطريق، وطمس للحقائق، وتفويت للمقاصد، أو معاكسة لها وسد لمنافذها في أحسن الأحوال.
ونحن إذا نظرنا إلى النظام التعليمي المغربي في ضوء هذه الحقائق، وجدناه يشكو من علة قاتلة، تتمثل في الفجوة الهائلة، بين بعض ما يصرح به من مبادئ على مستوى فلسفة التربية، وبين الصيغ التطبيقية الإجرائية، في الميدان، ومنها ما يتعلق بالمنهج التربوي، بناء وتنفيذا. فضلا عن مظاهر الخلط والتلفيق الموجودة على صعيد مكونات الفلسفة التربوية نفسها.45 وإذا أخذنا مثالا لاختلال المناهج التربوية، ما يتعلق من ذلك بالشروط النفسية ومراعاة الفروق الفردية للأطفال الممدرسين، واجهتنا علة النمطية والقولبة. فقد ناقش في القاهرة “خبراء وأكاديميون وتربويون أيام 11-14 \ 2008م. أكثر من عشرين بحثاً علمياً في المؤتمر العلمي الثامن الذي أقامته الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة تحت عنوان ماذا يقرأ الأطفال والشباب؟ ولماذا يقرؤون؟ ولمن يقرؤون؟ في دار الضيافة، جامعة عين شمس. وقد توج اللقاء بالنتيجة التي أعلنها رئيس المؤتمر وأستاذ المناهج بكلية التربية عين شمس «بأن الطفل العربي مغيب ولا قرار له ولا رغبات لديه في مناهج المدرسة العربية، وأن مليون طالب عربي في مرحلة واحدة يدرسون ذات المنهج وكأنهم زكائب تعبأ في (أكياس كبيرة) لا فرق بينها.”46
– على مستوى المنهج الخفي و الحضور الثقافي المدرسي:
يتحدث التربويون عما يسمى بـ “المناهج الخفية” أو “الضمنية” التي تنبثق في ثقافة المدرسة وفي الفصول الدراسية ممثلة في سلوك المعلمين والمديرين الذين يقلدهم المتعلمون ويحتذونهم، وفي التنظيمات الإدارية (جامدة ومستبدة، في مقابل مرنة وديمقراطية) وفي نوعية العلاقات القائمة داخل الصف الدراسي وفي المدرسة جميعها (علاقات تشاور، وود واحترام للآخر، ومحاولة تنميته، في مقابل الأوامر والتعليمات للآخرين وازدرائهم.47
إن مجموع هذه العناصر والمكونات، هي جزء مما يمكن نطلق عليه: المناخ المدرسي، أو الفضاء المدرسي، وهو يسهم بقدر هام في بناء الشاكلة الثقافية للمتعلمين، أي صياغة شخصياتهم، وما يمكن أن تحمله من سمات واتجاهات على مستوى الفكر والسلوك.
ويتمثل جزء آخر من ذلك المناخ، فيما يبرمج من أنشطة ثقافية تندرج فيما يسمى بالأنشطة الموازية. يقول عبد الحميد عقار منبها على أهمية هذا النوع من الأنشطة: “إن المدرسة المرغوب فيها، ينبغي أن تكون أيضا فضاء لتعميم الثقافة، بتوفير الظروف، ليصبح البعد الثقافي حاضرا متناغما مع برامج التكوين في المدرسة المغربية، فالبعد الثقافي بالمدرسة عامل يمكن أن يسهم في تحسين تكوين المدرسين، وتطوير مردوديتهم، ويخلق للتلاميذ فرصا إضافية لإغناء تعلماتهم، وإذكاء روح التنافس الإبداعي بينهم، ولإشباع فضولهم المعرفي، وتوسيع مداركهم، وتقريبهم أكثر من الحياة والوجود.
إن التجديد البيداغوجي عليه أن يأخذ في الاعتبار، المكون الثقافي والتثقيفي، وبخاصة ما يتصل بالفنون والآداب وتاريخ الأفكار، والموروث، ووسائط الاتصال المتطورة، وأوراش الإبداع والابتكار بالمدرسة، وفرص التواصل والحوار المباشر مع الكتاب والفنانين”.
ويحذر بعد ذلك من مغبة فقر المدرسة المغربية في هذا المجال قائلا:
“إن محدودية الحضور الثقافي في برامج التربية والتكوين حاليا، ثغرة تؤثر سلبا في مستوى التحصيل المعرفي والمنهجي لدى المتعلمين، وتجعل المدرسة والدروس يبدوان معزولين عن سياق المتعلمين وانشغالاتهم وارتباطاتهم الحياتية والوجدانية والتواصلية في آن واحد.” 48
إننا ونحن نعالج قضية المنهج الخفي، لا مناص من أن نخص بالذكر أحد أخطر عناصره من حيث التأثير على التشكيل الثقافي والنفسي لشخصيات المتعلمين، بل وعلى التحصيل الدراسي العلمي، وأعني به الاختلاط بين الجنسين. وأعبر، بداية، عن استغرابي من الصمت المريب الذي يطبق على مجمل الدوائر الرسمية في سائر الأنظمة التعليمية في الوطن العربي في شأن هذه المشكلة الشائكة. وسواء كان ذلك الصمت بفعل الجهل بعواقب الاختلاط، أو مجاراة لما هو شائع من ممارسات، أو بنية وسبق إصرار -وهذا أدهى وأمر- فإن النتائج الوخيمة الناجمة عن التعليم المختلط، لم تعد تخفى على كل ذي نظر سليم. ولفرط وضوحها، لم يجد بدا من الاعتراف بها حتى أولئك الذين يشكل الاختلاط بين الذكور والإناث عندهم سمة ثقافية وثابتا بنيويا في المجتمع، وما يسود فيه من قيم وعلاقات49.
فلا مناص إذن من اتخاذ موقف جاد في البلدان العربية والإسلامية، في شأن هذه المسألة، تطهيرا للبيئة المدرسية من واحد من أخطر عوامل الاستنزاف التي جرت وتجر ويلات كثيرة على الأجيال.
– على مستوى العلاقة بين المدرسة والأسرة:
المفروض في العلاقة بين المدرسة والأسرة أن تكون علاقة تساند وتضامن وانسجام، بما يحتمله ذلك من نقد ونصح وتقويم، من كلا الطرفين تجاه الآخر، كل ذلك في إطار رؤية المجتمع واختياراته في المجال التربوي والحضاري. أما إذا حصل تنافر أو شقاق بينهما، فذلك وضع شاذ ينذر بالتعثر والجمود، وفوات ما هو مرصود من أهداف وغايات، فما هي الصورة التي تتجلى فيها العلاقة بين المدرسة والأسرة في المجتمع المغربي؟
إننا إذا نظرنا إلى هذه العلاقة سواء من زاوية التواصل المباشر بين الأسر والمؤسسات، أو التواصل غير المباشر (الذي يتم عن طريق جمعيات آباء وأولياء التلاميذ)، فإن واقع الحال يعكس لنا صورة على قدر كبير من السلبية والفتور، مردهما بالنسبة للنوع الأول من التواصل، إلى تدني مستوى الوعي العلمي والثقافي لدى الآباء، بأهمية ذلك التواصل وآثاره الإيجابية والبناءة على الأبناء، من حيث سيرهم التكويني ومستواهم الخلقي والسلوكي، وبالنسبة للنوع الثاني إلى موقف الاستقالة واللامبالاة، التي تعود إلى ضعف أو انعدام استشعار روح المسؤولية تجاه النشء.
فإذا كانت السلطة التربوية تحفل من خلال بعض ما تصدره من مذكرات وتوجيهات، بإمكانيات الدعم التي قد تتيحها العلاقة الإيجابية البناءة بين الأسرة والمدرسة على صعيد مراكمة التصورات والأفكار والمقترحات التي تصب في جهود الارتقاء بالتربية، فإن الواقع الميداني يكشف عن ضعف كبير في استثمار تلك الإمكانيات، وترجمتها إلى سلوك عملي ترى نتائجه وثماره في جوانب العمل التربوي، من برامج وأنشطة موازية، وأعمال اجتماعية، وغيرها.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن علاقة المدرسة بالأسرة تتجلى من خلال ما يمكن أن تقدمه الأسرة باعتبارها قاعدة خلفية للمدرسة، من فرص للتفوق والازدهار، بفضل ما يبذله الآباء مع الأبناء من أجل تذليل ما يعترضهم من صعاب في عملية التعلم والاستيعاب، وتنوير أذهانهم على مستوى التعامل المنهجي مع البرامج والمقررات.
إلا أن هذا الهدف يعترضه عائقان، يتمثل أحدهما في الأمية المتفشية في صفوف الآباء، الأمر الذي يترتب عنه، فضلا عن الصعوبات الماثلة على مستوى التحصيل، شعور بالإحباط لدى أغلب الفئات، بسبب عدم تكافؤ الفرص بينهم وبين الفئة المحظوظة التي تجمع بين اليسر المادي، والارتقاء التعليمي والثقافي.
إن كون التعليم مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة يرتب على هذه الشراكة ،كي تكون ناجحة، أن تقوم على الدعائم التالية:”
1- وجود عقد اجتماعي واضح بين المدرسة والأسرة يوضح الحقوق والواجبات لجميع الأطراف.
2- وجود برنامج تفاعلي مستمر تساهم فيه الأسرة بشكل إيجابي في تعليم وتربية أبنائهم في المدرسة.
3- النظر للأسرة كشريك وليس كمستفيد أو زبون، لذلك لا بد للأسرة من أن تشارك في صناعة واتخاذ القرار في المدرسة في العديد من المجالات والموضوعات، حتى تشعر الأسرة بالانتماء للمدرسة والمسؤولية تجاهها.
4- ضرورة وجود برامج توعية مستمرة للأسرة والمدرسة تهدف لتوثيق العلاقة بينهما وتطويرها.
5- ضرورة وجود فريق عمل أو لجنة مشتركة بين الأسر والمدرسة، ويعمل هذا الفريق على توثيق العلاقة بين الطرفين، وتنظيم البرامج والفاعليات المختلفة، لتحقيق الأهداف المرجوة لتعليم وتربية أفضل لأجيالنا.” 50
– على مستوى موقع اللغة الأم في المنظومة التعليمية المغربية:
تكتسي لغة التعليم في أي منظومة تعليمية إحدى أركانها الكبرى وأحد المقومات الأساسية، التي يرتهن بها مدى القوة والاتساق والانسجام، في البناء الداخلي للمنظومة، ومن ثم على مستوى شخصيات المستهدفين بها، على أساس أن اللغة ليست مجرد حروف وكلمات جوفاء، بل هي خزان للفكر والحضارة والتاريخ، وبقدر ما تكون لغة التعليم ذات صلة بوجدان المتعلمين الديني والتاريخي، يكون حظ العملية التربوية التعليمية من الخصوبة والعطاء، لأن اللغة الأم تحمل سر الإبداع، في ظل شروط مخصوصة، على رأسها ارتباطها بثوابت الدين، وتشبعها بحقائق الحضارة والتاريخ.
يقول مصطفى بنيخلف موضحا هذه الحقائق: ” إن معطيات العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية تؤكد أن لا بديل عن اللغة الأم في تحقيق القدرة على التحصيل وتوفير إمكانيات النبوغ والتفوق، جاء في تقرير لليونسكو نشر عام: 1963م، أن اللغة الوطنية الأم: “هي من الناحية السيكولوجية منظومة من الرموز تعمل أوتوماتيكيا في ذهن الطفل عندما يريد أن يتكلم أو يفهم، وهي من الناحية السوسيولوجية تربط الطفل بقوة مع المجموعة البشرية التي ينتمي إليها، ومن الناحية البيداغوجية، تمكنه من التعلم بسرعة أكبر من السرعة التي يتعلم بها إذا كانت اللغة أجنبية عنه”51
“إن هذه الحقائق أصبحت ثابتة لكل ذي عينين بالنسبة للغة، أي لغة، مهما كان شأنها من الصعوبة والتعقيد، فما بالك والأمر يتعلق بلغة اختارها الله عز وجل لتكون وعاء لإنزال كتابه الخاتم والخالد، ويكفي ذلك برهانا على كونها لغة الحضارة بامتياز، بما وهبها الله عز وجل من قدرة على التكيف والتطور، ومن قابلية فائقة للتخصيب.”52
إن الدارس للنظام التربوي المغربي من زاوية التعامل مع لغة التدريس، يتبين له أنه خاض تجربة غير موفقة في هذا المقام، لأنه لم يحترم شخصية الأمة، عندما لم يحترم ما يقتضيه قانون اللغة الأم، من ضرورة اعتبارها الوعاء الشامل الذي يستوعب سائر الأنشطة التربوية التعليمية، دون أدنى إخلال بذلك المقتضى، ومن ثم لم يكن هناك مفر من جني الحصاد المر لمصادمة القانون المذكور، وذلك بالسماح للغة أجنبية، ليس بمقاسمتها السلطة على أذهان المتعلمين، ولكن بالتسليم لها بحق النظر والهيمنة التي يتضاءل أمامها ما تبثه اللغة الأم من إيحاءات وتأثيرات، وذلك بإعطائها حق تقرير مصير فئات عريضة من المتمدرسين، بسبب إعطائها حق الحسم في النتائج النهائية لهم في المراحل العليا، وخاصة بالنسبة للشعب العلمية والتقنية، لأن التدريس فيها يعتمد اللغة الأجنبية (الفرنسية). وذلك فضلا عن استباحة هذه اللغة لمجال عدد كبير من المدارس المنتمية للقطاع الخاص التي تستورد كتب القراءة المعتمدة فيها من وراء البحار، محملة بمحتواها الحضاري، ورصيدها القيمي الغريب عن هوية الأمة.
2- من حيث مدى التناغم والانسجام، أو عدمهما، بين المؤسسة التربوية والنظام التربوي من جهة، وبين خصائص المجتمع العربي والإسلامي، واحتياجاته من جهة أخرى:
إن احتياجات الأمة العربية والإسلامية تنبع من كونها أمة ذات رسالة عالمية تتمثل في هداية الناس، ورفع ألوية الخير والمحبة و الأمن والسلام فيما بينهم، ووضع الأسس السليمة والراسخة لمجتمع تحظى فيه الإنسانية بالتكريم. ومما لا شك فيه أن النظام التربوي يعد في طليعة المصادر التي تعتمد في تلبية تلك الحاجات، من حيث كونه أساس التشكيل والبناء، للأجيال التي تحمل الرسالة وتتشبع بقيمها ومبادئها، لأجل ذلك، يشترط في ذلك النظام، أن يكون في انسجام تام، مع خصائص المجتمع، من حيث هو ذو كيان خاص، وسأتناول الإجابة على السؤال أعلاه، من خلال نموذج النظام التربوي المغربي، من خلال الكتاب الأبيض:
3- دراسة شاملة للنظام التربوي المغربي من خلال الكتاب الأبيض:
سأسلط الضوء على النظام التربوي التعليمي المغربي،، من خلال المرتكزات والاختيارات والمداخل التي ارتضاها كإطار للنظر والتفكير، والممارسة والتطبيق، والتي عبر عنها الكتاب الأبيض، باعتباره دليلا وحلقة وسطى بين الوثيقة المرجعية التي يمثلها “الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وبين مرحلة الأجرأة والتطبيق التي تمثلها الكتب المدرسية وما يرتبط بها ويتمحور حولها من أنشطة صفية، ومخرجات على مستوى التربية والتكوين لفئات المتعلمين.
سأنهج في هذه الدراسة النقدية، المنهج التحليلي الفلسفي، الذي ينطلق من جهة، من المبادئ العامة المتعارف عليها إنسانيا، وينطلق من جهة ثانية، من وعي حاد، بضرورة تحرك المنظومة التعليمية في إطار الرؤية الحضارية الشاملة التي تؤطر المجتمع أو الأمة التي يستهدف أجيالها بالبناء والتشكيل.
وسأحافظ في سيرورة التحليل والمناقشة والنقد، على نفس الهيكلة والنسق الذي اتبع في بناء “الكتاب الأبيض“. وأتوج ذلك بملاحظات عامة تتعلق بتنظيم الدراسة في الأقطاب والأسلاك المختلفة، وقد جاء تنظيم الكتاب على الشكل الآتي:
- الاختيارات والتوجهات التربوية العامة.
- اختيارات وتوجهات في مجال القيم.
- اختيارات وتوجهات في مجال تنمية وتطوير الكفايات.
- اختيارات وتوجهات في مجال المضامين.
- اختيارات وتوجهات في مجال تنظيم الدراسة.
إشارات لابد منها: لا بد من الإشارة، قبل مباشرة التحليل، إلى الحقائق التالية:
تتمثل الحقيقة الأولى في أن “الكتاب الأبيض” قد استصحب جوهر مضمون «الوثيقة الإطار»، إن على مستوى التوجهات والاختيارات الكبرى، أو على مستوى مواصفات المتعلمين المتوخاة في نهاية الأسلاك التعليمية.
وتتمثل الحقيقة الثانية، في التراجع عن الخطيئة التي كانت ستقترف في حق «المنظومة التعليمية» بحرمان أغلب شعبها من مادة التربية الإسلامية.
الحقيقة الثالثة: وتتمثل في أن بعض التعديلات التي طالت نصوص أو فحوى “الوثيقة الإطار“، مما انتقل إلى “الكتاب الأبيض”، لم يكن لها مساس جذري بالتوجه العام، أو الرؤية التي حكمت ذلك الفحوى.
أ- الاختيارات والتوجهات التربوية العامة:
يقر “الكتاب الأبيض” منذ الانطلاق استلهامه “للفلسفة التربوية” المتضمنة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين (53).
ويصرح بالانطلاق بموجب ذلك من “العلاقة التفاعلية بين المدرسة والمجتمع“، باعتبار المدرسة محركا أساسيا للتقدم الاجتماعي وعاملا من عوامل الإنماء البشري المندمج» ومن «وضوح الأهداف والمرامي البعيدة من مراجعة مناهج التربية والتكوين، والتي تتجلى أساسا في:
– المساهمة في تكوين شخصية مستقلة ومتوازنة ومتفتحة للمتعلم المغربي، تقوم على معرفة دينه وذاته ولغته وتاريخ وطنه وتطورات مجتمعه.
– إعداد المتعلم المغربي لتمثل واستيعاب إنتاجات الفكر الإنساني في مختلف تمظهراته ومستوياته، ولفهم تحولات الحضارات الإنسانية وتطورها.
(…)- استحضار أهم خلاصات البحث التربوي الحديث في مراجعة مناهج التربية والتكوين باعتماد مقاربة شمولية ومتكاملة تراعي التوازن بين البعد الاجتماعي الوجداني، والبعد المهاراتي، والبعد المعرفي، وبين البعد التجريبي والتجريدي، كما تراعي العلاقة البيداغوجية التفاعلية وتسيير التنشيط الجماعي.
(…)- اعتماد مبدأ التنسيق والتكامل في اختيار مضامين المناهج التربوية، لتجاوز سلبيات التراكم الكمي للمعارف ومواد التدريس”54 إن مطلب انطلاق الاختيارات والتوجهات التربوية من “العلاقة التفاعلية بين المدرسة والمجتمع“ يغض الطرف –عن غفلة أو قصد- عن مطلب حيوي وضروري يجب أن يتحقق كشرط أساس يؤمِّن سلامة التفاعل المنشود، بين المدرسة والمجتمع، ويظل ذلك التفاعل عند غيابه مجرد دوران عقيم في حلقة مفرغة، أي أنه لا يعدو أن يمارس وظيفة مَرَضِية تتمثل في إعادة إنتاج واقع موبوء يشكو الناس من مغبة طغيانه، وإعادة إنتاج مجتمع مفلس يؤتى من أسسه وأركانه. وأقصد بهذا المطلب الحيوي ذاك المتمثل في إصلاح سياسي واجتماعي، وتطهير ثقافي، ترسى بموجب الأول دعائم الشورى الحقة والعدالة الاجتماعية الشاملة، وتستأصل بمقتضى الثاني عوامل التسيب الخلقي الذي أضحى سمة تسود وجه المجتمع وتسبب له ضيقا وحرجا. ويرتبط بهذا المطلب الحيوي مطلب يمس طرف العلاقة الثاني، وهو المدرسة، ويكمن في ضرورة هيكلتها وإقامة أسسها الإدارية والتنظيمية والتربوية وفق تصورات سليمة ومعايير محكمة وضوابط صارمة، تمكن جميعها من إيجاد فضاءات مدرسية، تتفتق في ظلها المواهب والقدرات، وتبرز الكفاءات.
قد يعترض معترض فيقول: إن تحقيق هذا المطلب، جزء لا يتجزأ من منظومة شاملة، يبشر بها “الكتاب الأبيض” ويعد الآليات التصورية والتطبيقية لإقامتها وتحقيقها. والجواب على هذا الاعتراض واضح للأذهان، لأن المشروع الذي يبشر به الكتاب الأبيض لا يحتوي على أدنى المقومات التي تؤهله للاستجابة لذلك الهدف السامي، بل إن جماع ما يتضمنه ذلك المشروع من مفاهيم وتصورات، يفضي حتما إلى تعميق واستفحال وضعية التلوث التي تسود البيئة المدرسية. ويكفي على سبيل المثال أن نشير إلى أن “الكتاب الأبيض” لم يرد فيه ما يدل على تكسير ما أصبح في حكم الثابت البنيوي في المدرسة المغربية، ألا وهو “التعليم المختلط“، أو بأدق تعبير “التعليم المخلَّط” الذي جر ويجر الويلات على الناشئة، وعلى صيرورة المجتمع علميا وأخلاقيا، ويزج به في أتون من المآسي التي تهدد الأمة بالذبول والانقراض. أما إذا أضفنا إلى بنية المؤسسة الداخلية، الغلاف الخارجي الموبوء، أدركنا إلى أي حد نكون أمام منظومة تعليمية مرشحة –بحكم بنائها الداخلي وغلافها الخارجي- لأن تكون عامل تثبيط، بل عامل إبادة حضارية ممنهجة.
– أما المنطلق أو المرتكز الثاني فيما يتعلق بالاختيارات والتوجهات التربوية العامة، المتمثل “في وضوح الأهداف والمرامي البعيدة من مراجعة مناهج التربية والتكوين“، فإنه يظل مجرد زعم لا يجد معادله الموضوعي على مستوى الأهداف المسطرة.
فإذا كان “الكتاب الأبيض” يتوخى من البرامج والمناهج “المساهمة في تكوين شخصية مستقلة ومتوازنة ومتفتحة للمتعلم المغربي تقوم على معرفة دينه وغايته…”55، فإنه يتوخى منها –في هدف آخر- “إعداد المتعلم المغربي لتمثل واستيعاب إنتاجات الفكر الإنساني في مختلف تمظهراته ومستوياته، ولفهم تحولات الحضارة الإنسانية وتطورها“(ص 5). إن تدبر الهدفين والمقارنة بين حمولة ودلالات ألفاظ كل منهما، يكشفان عن اختلاف نوعي في المقصود من كل هدف. فشتان بين المعرفة في بعدها العادي، وبين التمثل والاستيعاب. فالأولى قد لا تبرح مستوى التعامل السطحي البارد، الذي لا ينتج أثرا، بينما التمثل والاستيعاب يمثلان مستوى أعمق من العلم والخبرة، قد يتمخض عنه تفاعل عميق، يتخذ أبلغ مستوياته، في تحويل المتَمَثَّل والمستوعب، إلى أنماط من الفعل والسلوك. فالمفروض بموجب المرتكز الأساسي الكبير الذي صدر به «الميثاق الوطني للتربية والتكوين»، أن يصاغ الهدف الأول على الشكل التالي: “المساهمة في تكوين شخصية مسلمة، سوية ومتوازنة صالحة ومصلحة، قائمة على أساس العلم الصحيح، والعمل الصالح.” وأن يصاغ الهدف الثاني الصياغة التالية: “إعداد المتعلم المغربي للقراءة الواعية للتراث الإنساني والإفادة منه، ولفهم ما يجري من تحولات، من منظور الشهود الحضاري، وبناء على إدراك السنن والآليات المتحكمة في تلك التحولات.”
– وإذا كانت صياغة المنطلقين السالف ذكرهما، تفتقد –كما تبين- لميزة الخضوع لمعيار الدقة والانسجام مع المرتكز الأول الأساس للوثيقة المرجعية الأم، فإن صياغة منطلقات أخرى قد حظيت بالدقة والوضوح في حد ذاتها، غير أن عرضها على مجمل الرؤية العامة التي تهيمن على مكونات “الكتاب الأبيض”، يكشف بجلاء عن افتقادها للترجمة العملية على مستوى البرامج والمناهج التي لا يشد بعضها إلى البعض الآخر، إلا خيوط باهتة واهية. ذلك أن المنطلق المتمثل في “اعتماد مبدأ التنسيق والتكامل في اختيار مضامين المناهج التربوية، لتجاوز سلبيات التراكم الكمي للمعارف ومواد التدريس” منطلق لا يجد صداه العميق على مستوى “المنظومة التعليمية”، إلا إذا كانت هذه «المنظومة» خاضعة بشكل كامل لرؤية فلسفية متجانسة. أما أن تكون تلك الرؤية خليطا هجينا ومركبا ملفقا بين عناصر متشاكسة، أو خضوعا لأرباب متفرقين، كما هي الحال في “الكتاب الأبيض”، فإنه لا مفر من الوقوع في شراك فصام نكد، تحصد عواقبه الأجيال الناشئة. ذلك أن “الكتاب الأبيض” يصرح بالولاء لمرجعيتين على مستوى المنظور العقدي والفكري، مع بروز ميل جارف وتحيز بيِّن لإحدى تلك المرجعيتين. ومما يزيد الأمر تعقيدا واستشكالا، أن المرجعية المتبناة على مستوى التطبيق والتنزيل، هي أيضا تفتقد إلى التجانس والوحدة. لأنها تضم في جوفها ألوانا شتى وخطوطا متعددة لا يشدها محور واحد أو يجمع بينها قاسم مشترك. وسينكشف لنا ذلك في غضون هذه الدراسة بجلاء.
ب- اختيارات وتوجهات في مجال القيم:
في هذا الجانب ينص –الكتاب الأبيض- على أنه “انطلاقا من القيم التي تم إعلانها كمرتكزات ثابتة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والمتمثلة في: –قيم العقيدة الإسلامية- قيم الهوية الحضارية ومبادئها الأخلاقية والثقافية – قيم المواطنة – قيم حقوق الإنسان ومبادئها الكونية. وانسجاما مع هذه القيم، يخضع نظام التربية والتكوين للحاجات المتجددة للمجتمع المغربي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من جهة، وللحاجات الشخصية للمتعلمين من جهة أخرى.”56
– ثم يحدد “الكتاب الأبيض” مجموعة من الغايات يتوخاها نظام التربية والتكوين في علاقة بالحاجات التي سبقت الإشارة إليها.
من جملة تلك الغايات: “ترسيخ الهوية المغربية الحضارية والوعي بتنوع وتفاعل وتكامل روافدها“.
– “التفتح على مكاسب ومنجزات الحضارة الإنسانية المعاصرة“.
– “التشبع بروح الحوار والتسامح وقبول الاختلاف“.
– “ترسيخ قيم المعاصرة والحداثة“.
إن أول شيء يلفت نظر الدارس في هذا المجال، هو ما سبق أن ألمحت إليه قبل من الجمع بين عناصر تنتمي إلى أكثر من مرجعية. ويمكن القول بأننا هنا إزاء ثلاث مرجعيات: الإسلام –الهوية الحضارية– قيم حقوق الإنسان ومبادئها الكونية. إن هذا التشتت على مستوى المرجعية المتحكمة في القيم التي يتوخى نظام التربية والتكوين ضخها في دماء الناشئة، يعتبر داءا وبيلا ومرضا عضالا، لا بد أن يَلْحق المنظومة التربويةَ من جرائه تسمم شامل، ينتهي إلى إصابة من يتخرجون فيها بكساح محتم إلا من رحم الله.
إن دعوة “الكتاب الأبيض” إلى ترسيخ “الهوية المغربية الحضارية”، في نفس الوقت الذي يدعو فيه إلى “ترسيخ قيم المعاصرة والحداثة”، يعتبر من قبيل الجمع بين أمرين على طرفي نقيض. فإذا ما قبلنا التعامل –مع تحفظ– مع مصطلح “الهوية المغربية الحضارية” فإنه يحق لنا أن نتساءل عن مقصود واضعي”الكتاب الأبيض”، “والميثاق الوطني للتربية والتكوين” من قبله، من المبادئ الأخلاقية والثقافية لتلك الهوية الحضارية، كما يحق لنا أن نتساءل عن المقصود بقيم المواطنة، وعما إذا كانت تنفرد بكيانها في استقلال عن قيم العقيدة الإسلامية وقيم الهوية الحضارية. والسؤال نفسه يمكن وضعه فيما يخص علاقة قيم “حقوق الإنسان” بالقيم الأولى والثانية. والحقيقة أن تصنيف القيم بالشكل الذي هي عليه في “الكتاب الأبيض”، يشكل جوابا على بعض هذه التساؤلات، ويبقى البعض الآخر في طي الغموض والكتمان إلى أن يتم الشرح والبيان.
إن دعوة الوثيقة إلى “التفتح على مكاسب ومنجزات الحضارة الإنسانية المعاصرة“ تحمل في طياتها إقرارا بكمال هذه الحضارة وبراءتها من العيوب، وإلا فإنه كان من مقتضى مصداقية الكلام، أن تقيد صياغة هذه الغاية بقيود تضفي عليها طابع التجرد والموضوعية، وتدفع عنها وصمة التبعية العمياء. فكان يمكن صياغة هذه الغاية- على سبيل المثال كما يلي: “الإفادة من مكاسب المدنية المعاصرة ومنجزاتها، في وجهها الإيجابي، بعد سلخها من خلفياتها الفلسفية المادية، والحذر من السقوط في إفرازاتها المرضية المدمرة الناجمة عن النزعة المادية المسرفة والمشينة للإنسان“.
أما غاية: “التشبع بروح الحوار والتسامح وقبول الاختلاف“، فيلزم أن تكون هي أيضا كسابقتها مسيجة بضوابط تحميها من غوائل التسيب والوقوع بين براثن الفوضى الفكرية، وعرضة لعبث الليبرالية الجامحة الخرقاء. والضابط الأساس في كل ذلك، هو الحفاظ على وحدة الأمة وكرامتها وثوابتها ومقدساتها.
وتبقى قاصمة الظهر التي تأتي على أدنى ملمح من ملامح الهوية كما يقتضيها المرتكز الأساس، متمثلة في الدعوة إلى: “ترسيخ قيم المعاصرة والحداثة”57. ذلك أن الحداثة باعتبارها رؤية فلسفية وموقفا من العالم، يرفض الدين وينزع إلى تفجير جميع المثل والقيم، لا تملك أدنى شرط يؤهلها –للتعايش مع أي نمط يتحرك في محيطها. فالحداثة إلغاء واجتثاث وهدم مستمر لا يبقي ولا يذر.
وفي سياق نقد هذه الغاية، يبرز سؤال مشروع يتعلق بقيم المعاصرة-، فإذا كانت قيم الحداثة واضحة لمن يعرفون حقيقتها، فهل المعاصرة تتخذ شكل مذهب حتى يكون لها قيم؟ إن مما نعرفه عن المعاصرة هو -بكل بساطة أن تعيش عصرك بكل ما يتطلبه من مواجهة ما يبرز فيه من قضايا ومشكلات ومعالجتها وفق المنظور الأصيل الذي يمثل هويتك. ومن ثم فالمعاصرة صفة أو أسلوب في الممارسة أو موقف من الأحداث والواقع لا ينفك عن أي أمة، مهما كانت على تفاوت في الدرجة واختلاف في المنطلقات من حيث الصواب أو الخطأ.
ومما يلحظ بشكل جلي في مجال القيم، سيادة النظرة التبعيضية، بحيث إن “الكتاب الأبيض” يميز بين قيم متوخاة في تلاميذ قطب أو أقطاب بعينها، دون غيرهم، فقد ورد في سياق جرد المواصفات المرتبطة بالقيم والمقاييس الاجتماعية في قطب التعليم الأصيل، جعل المتعلم “متشبعا بقيم الدين الإسلامي، ومعتزا بهويته الدينية والوطنية، محافظا على تراثه الحضاري، ومحصنا ضد كل أنواع الاستلاب الفكري، متمسكا بالسلوك الإسلامي القويم والمثل العليا المستمدة من روح الدين الإسلامي” فإذا كانت هذه المواصفات من الدقة بمكان، فإننا لا نظفر ولو بجزء منها عندما يتعلق الأمر بالأقطاب الأخرى. فهل هناك من مسوغ تربوي لهذه النزعة التبعيضية؟ ولهذا الفصام على مستوى المنظومة التربوية الواحدة التي تستهدف جيلا واحدا في شعب واحد وأمة واحدة؟
إننا بإزاء ازدواجية واضحة في الخطاب، تتمظهر أول ما تتمظهر على مستوى الألفاظ والمصطلحات المستعملة. فشتان بين «التشبث بقيم الدين الإسلامي» وبين ترسيخ الهوية المغربية الحضارية أو حتى قيم العقيدة الإسلامية السمحة.
وفي سياق التدليل على التشوش السائد على مستوى القيم أو المواصفات المرتبطة بالكفايات والمضامين في نهاية السلك التأهيلي على سبيل المثال، يتوخى «الكتاب الأبيض» من المتعلم أن يكون ملما بالأخلاقيات المرتبطة بالتطور المعرفي، وبقيم المواطنة وحقوق الإنسان في أبعادها الخصوصية والكونية».
وإن من حق كل واحد أن يتساءل عن هذه الأخلاقيات المرتبطة بالتطور المعرفي، وعن حقيقتها ودرجتها في سلم القيم.
وفي سياق إبراز معالم التشويش والغموض دائما، يجد دارس “الكتاب الأبيض” نفسه مدفوعا إلى التساؤل عن المقصود بمفهوم التفاعل الإيجابي مع المحيط الاجتماعي الذي تكرر وروده عبر المواصفات، هل هو التطبيع مع المحيط على علاته أم ماذا؟
إن وثيقة من هذا الحجم وعلى هذا القدر من الخطورة والمصيرية لا عذر لها في أن تكون عرضة للفضفاضية والتهلهل، فضلا عن أن تكون عرضة للتناقض بين أجزائها ومكوناتها. وإذا كنا نستبعد أن يكون ذلك وليدا للصدفة، فإن اليقين بأن يكون بنيَّةٍ وسَبْق إصرار، يولد استغرابا حادا وألما ممضا.
ج- اختيارات وتوجهات في مجال تنمية وتطوير الكفايات:
يمكن القول في مستهل معالجة هذه النقطة، أن اعتماد مدخل الكفايات من المنظور الشمولي، إطارا لجريان العملية التعليمية، يكتسي أهمية ملحوظة، من حيث إن هذا المدخل يستهدف مجمل الميول والاستعدادات ويسعى إلى تنميتها وفق منظور بيداغوجي قائم على التدرج والتوازن.
غير أن محل الخلاف بخصوص هذه المسألة، إنما يتعلق بالمحتويات والأبعاد، التي يسندها «الكتاب البيض» لبعض الكفايات التي يحصرها في خمس: الكفايات الاستراتيجية، والكفايات التواصلية والكفايات المنهجية والكفايات الثقافية والكفايات التكنولوجية، كما يتعلق (أي الخلاف) بمدى نجاح “الكتاب البيض” في توفير الشروط السليمة والمواد الكافية والكفيلة بتحقيق التنمية الصحية والموزونة لتلك الكفايات.
ففيما يتعلق بالأبعاد والدلالات المرتبطة بالكفايات الاستراتيجية، يذهب «الكتاب الأبيض» إلى أنها تتمثل في “-معرفة الذات والتعبير عنها –التموقع في الزمان والمكان– التموقع بالنسبة للآخر بالنسبة للمؤسسات المجتمعية (الأسرة، المؤسسة التعليمية) – تعديل المنتظرات والاتجاهات والسلوكات الفردية وفق ما يفرضه تطور المعرفة والعقليات والمجتمع.”58
إن نظرة فاحصة إلى هذه العناصر والأهداف، تكشف لنا عن ضعف في الصياغة، فضلا عن فقر في التصور والرؤية. فأي ذات هي المقصودة والمطلوب معرفتها والتعبير عنها؟ هل هي الذات الشخصية أم الذات الحضارية؟
ويتجلى الفقر التصوري والاهتزاز الفكري أيضا، وبشكل خطير، في ما يعبر عنه “الكتاب البيض” بـ”تعديل المنتظرات والاتجاهات السلوكية الفردية وفق ما يفرضه تطور المعرفة والعقليات والمجتمع“.
فأي استراتيجية هذه التي تجعل من الإنسان كرة تتقاذفها رياح المعرفة والعقليات والمجتمع، فهل هذه المصادر منزهة عن الانسياق وراء تيارات هوجاء، مبرأة من الأهواء والرغبات الرعناء؟ إن واقع التاريخ الإنساني يقدم البراهين الساطعة على أن المصادر المذكورة كثيرا ما وقعت عرضة للتزوير والتحريف والتسميم، وإن الذي يمَكِّن الإنسان من التحرر من مغبة الوقوع في شرك الكيد الذي كثيرا ما يتزيّى بشعار المعرفة، إنما هو الميزان الصارم والدقيق الذي توفره المرجعية الدينية الصحيحة القائمة على الحق والعلم والحكمة. وهذا بالضبط ما قصدته بالرؤية التصورية التي يفتقد إليها “”الكتاب البيض” وهو يتناول الكفايات الاستراتيجية بالتحليل.
وما المقصود “بالتموقع في الزمان والمكان”؟ إنه في ظل غياب أي بيان دقيق، يبقى الباب مفتوحا أمام حشد من التأويلات.
والمفروض بموجب الفلسفة التربوية الإسلامية، أن يتمثل هذا المطلب في رسالة الشهود الحضاري الذي تملأ به الأمة المسلمة الوجود الإنساني، وتنطلق به في آفاق المكان والزمان. يقول الله سبحانه وتعالى {ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض لله يرثها عبادي الصالحون} (الأنبياء/105) ثم إن “التموقع في الزمان والمكان” لا يمكن تحقيقه في ظل غياب جملة من المضامين التي تتوزع بنسب متفاوتة عبر المناهج الدراسية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية.
فإذا ما ألقينا نظرة على مقررات التاريخ والجغرافيا عبر الأسلاك والمستويات فإننا لا نقف في عناوينها على ما يعزز مطلب “التموقع في الزمان والمكان” بحسب هذا المدلول الذي أسندناه إليه، بل إن القضايا والمواضيع التي شكلت قوام المقررات في السنوات (الرابعة والخامسة والسادسة) التي تدرس فيها الاجتماعيات في المرحلة الابتدائية، من شأنها أن تساهم في طمس الوعي التاريخي لدى التلاميذ أو تزييفه في وجدانهم.
ولنقف عند تلك العناوين حتى يتبين لنا ذلك بجلاء.
التاريخ
السنة الرابعة: تحسيس أولي بالتاريخ
السنة الخامسة: الحاضر والماضي حولنا
السنة السادسة: المغرب عبر التاريخ: ملتقى الحضارات
الجغرافيا
السنة الرابعة: التعريف الأولي بالجغرافيا وبفائدتها اليومية
السنة الخامسة: المجال الريفي والمجال الحضري
السنة السادسة : الجهة والوطن
التربية على المواطنة
السنة الرابعة: أنا والآخر كائنات إنسانية
السنة الخامسة: الحقوق والواجبات
السنة السادسة: اتفاقية حقوق الطفل.
إنه في غياب إعطاء المفردات التفصيلية للبرامج السالفة الذكر، لا نستطيع إصدار حكم حاسم ودقيق فيما يتعلق بما نحن بصدده، ولكننا مع ذلك يمكن أن نستشف من خلال تلك الخطوط الكبرى بعض السمات المتعلقة بالاتجاه الفكري الذي يحكمها. فيكفي أن نتدبر المحاور التالية: -المغرب عبر التاريخ: ملتقى الحضارات –أنا والآخر كائنات إنسانية –اتفاقية حقوق الطفل، على سبيل المثال، ليتبين لنا مؤشرات النزعة الأممية التي تريد أن تنصِّب نفسها مذهبا، بل ديانة جديدة تفرض هيمنتها على الأمم والشعوب قاطبة. وإلا فإن المرجعية الإسلامية التي صُدِّر بها الميثاق تمتلك منظورها الشامل والمتكامل لحقوق الطفل، الذي يغني عن التسول والاستجداء عبر أروقة الأمم المتحدة، والسقوط في خطيئة استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، إذ إن المواثيق التي تصاغ في تلك الأروقة موصومة بالنقص، متلبسة بالهوى، فضلا عن كونها تحمل بصمات الأقوياء ماديا وتعكس مصالحهم، ونظرتهم الضيقة للكون والحياة والإنسان.
وإذا أضفنا إلى المحاور السالفة الذكر بعض الوحدات الخاصة باللغة العربية، تأكد لنا ما ذكرناه بشكل جلي.
فمن جملة الوحدات الثمانية المرصودة للسنتين الثالثة والرابعة ابتدائي نجد: “القيم الإسلامية والوطنية والإنسانية”، و”الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
إن هاتين الوحدتين تنتميان إلى جهاز مصطلحي يعبر بجلاء عن المجال الإيديولوجي الذي سلفت الإشارة إليه.
ويزداد الجزم بتغلغل الاتجاه الأممي باستحضارنا لمفردات برنامج أو منهاج مادة الاجتماعيات بالتعليم الإعدادي والتعليم التأهيلي:
– في التعليم الإعدادي:
| الدورات | التاريخ | الجغرافيا |
| د 1 | – الحضارات القديمة في البحر الأبيض المتوسط – سيادة الحضارة الإسلامية في العصر الوسيط | – الأرض كوكبنا (1) “مكونات وخصائص كوكبنا. – الأرض كوكبنا – الإنسان وأنشطته الاقتصادية |
| د 2 | – الدولة المغربية في العصر الوسيط. – العصر الحديث. | – تنوع سكان المغرب واستغلال المجال (1) – ماذا توفر لنا الطبيعة |
| د 3 | – تاريخ العالم الحديث والمعاصر (1) | – تنوع سكان المغرب واستغلال المجال (2) |
| د 4 | – سكان المغرب واستغلال المجال | |
| د 5 | – تاريخ العالم الحديث والمعاصر (2) | – المغرب العربي: التكامل والتحديات |
| د 6 | – العالم من حولنا (1) الاتحاد الأوروبي مثال التكتل الإقليمي |
– في التعليم التأهيلي:
في الجذع المشترك:
– التاريخ: تطور النضال من أجل الديمقراطية والحرية.
– الجغرافيا: الإنسان والأرض.
برنامج مختلف أقطاب التعليم العام والتكنولوجي المهني.
- التاريخ:
– العالم الغربي في العصر الحديث، الانبعاث والانطلاق للسيطرة على العالم.
– المغرب في مواجهة الأطماع الأجنبية: 1415ﻫ/1912م.
– العالم المعاصر: الأزمات الكبرى.
– العالم المعاصر، تحرر العالم الثالث والقضايا الراهنة.
– المغرب من الحماية إلى بناء الدولة الوطنية (ما بعد الاستقلال)
- الجغرافيا:
– الإنسان وتنظيم المجال.
– جغرافية المغرب، إعداد التراب الوطني.
– جغرافية العالم العربي.
– جغرافية العالم المتقدم.
– جغرافية العالم الثالث.
فبقراءتنا لهذه المحاور والمجزوءات، يمكن استنتاج ما يلي:
– جعل التاريخ يتمحور حول قضية النضال من أجل الديمقراطية والحرية، مما يشكل تعميقا وترسيخا لأحد المفردات الأساسية في الجهاز المصطلحي للعالم الغربي، في ذهنيات الأجيال المتعلمة.
– اختزال وجود الإنسان في علاقته بالأرض إيحاء بانفصاله عن السماء، وقد تكون صياغة المجزوءة الأولى، والثانية ببرنامج الدورة الأولى والثانية بالتعليم الابتدائي تحت عنوان: “الأرض كوكبنا” مما يؤكد هذا الاستنتاج، ونفس الأمر ينسحب على العنوان التكميلي في المجزوءة الثالثة لمادة الجغرافيا وهو: “ماذا توفر لنا الطبيعة؟”.
– إعطاء الصدارة في مجزوءات التاريخ لـ”العالم الغربي في العصر الحديث” ينطوي على خلفية الانبهار والتسليم بالمركزية الغربية، ويؤكد هذا الحكم عنوان المجزوءة السادسة في مادة الجغرافيا في التعليم الابتدائي: “الاتحاد الأوربي مثال للتكتل الإقليمي”.
– الحرص في كل المحاور على تجنب استعمال بعض الألفاظ ذات الحمولة القدحية، والمثيرة لشعور معين تجاه الغرب، لاقترانها بتجربته المريرة في العدوان على الشعوب.. وأقصد هنا بالخصوص لفظ “الاستعمار”59 ويظهر هذا من خلال استعمال ألفاظ وأوصاف بديلة مثل “السيطرة” و”الأطماع الأجنبية”.
– لا ندري ما إذا كانت أزمة فلسطين ومأساة الشعب الفلسطيني، قد أدرجت ضمن الأزمات الكبرى في العالم المعاصر، أم أنها قد عدَّت في عداد القضايا الميتة، أم أنها قدمت في سياق من التقزيم وسلخها من أبعادها الأصيلة وجوهرها الحقيقي.
– هناك إقبار لمفهوم العالم الإسلامي، فهو ليس موجودا ضمن العوالم كعالم متميز له كيانه الخاص، ويبدو جليا أنه اعتبر جزءا داخلا في نطاق “جغرافية العالم الثالث”. وغير خاف عن أولي الألباب أن هذا التغييب لكيان “العالم الإسلامي” ضمن المجزوءات، يعتبر إجراءً منسجما مع سعي قوى العولمة الطاغية إلى تذويب جميع الكيانات الثقافية في بوتقة “ثقافتها” التي تصر على التهام أو إقصاء جميع الثقافات، وتراهن على المنظومات التعليمية في القيام بمهمة تجفيف منابع الشعور بالهوية الدينية والاعتزاز بها. خاصة عندما يتعلق الأمر بالهوية الإسلامية الموسومة بالرسوخ والجاذبية والمناعة.
– ومما يسجل، في علاقة بهذا النزوع إلى إقصاء الحمولة الدينية، واستبعاد كل ما يحيل عليها من مصطلحات، تغليب الصبغة المكانية الجغرافية والعرقية على حساب الصبغة العقدية أو الفكرية. يتجلى لنا ذلك أوضح ما يكون في عناوين المجزوءات التالية: “الحضارات القديمة في البحر الأبيض المتوسط – تنوع سكان المغرب واستغلال المجال”60.
فأنى للـ”تموقع في الزمان والمكان” وللـ”تموقع بالنسبة للآخر”، أن يتخذا صبغتهما الحضارية الأصيلة في وجدان التلاميذ، في ظل هذا الخواء العقدي، وفي ظل مفهوم للزمن موسوم بالضحالة والسطحية، فضلا عن كونه يتأسس على رؤى غربية ويتأثث بجهاز مصطلحي علماني حداثي؟!!
– وفي إطار معالجة الكفايات الثقافية، يتحدث “الكتاب الأبيض” عن “هوية المتعلم كمواطن مغربي وإنسان منسجم مع ذاته ومع بيئته والعالم61 وهنا لا يسعنا إلا أن نتساءل عن طبيعة هذا الانسجام المطلوب تحقيقه من قبل المتعلمين، وعن إمكانية الجمع بين الانسجام مع الذات، والانسجام مع البيئة والعالم. وسواء اعتبرنا الذات في وضعها الفطري أو في بعدها الحضاري (الذات الحضارية)، فإن مشروعية السؤال تبقى قائمة. ذلك أن لا أحد من العقلاء يجهل ما عليه البيئة بمفهومها الواسع، من تلوث رهيب، لا يسلم من عدواه إلى ذو حظ عظيم، ومن سلم منها، فلا يكاد ينجو من غبارها. ولا أحد من العقلاء يجهل أيضا ما يغرق فيه العالم من مستنقعات الفساد، وما يكتنفه من تيارات الغواية والظلم والطغيان، ومخططات العدوان على الفطرة والكرامة.
د- اختيارات في مجال المضامين:
ينص “الكتاب الأبيض” على “الانطلاق من اعتبار المعرفة إنتاجا وموروثا بشريا مشتركا و”اعتبار المعرفة الخصوصية جزءً لا يتجزأ من المعرفة الكونية” و”اعتماد مقاربة شمولية عند تناول الإنتاجات المعرفية الوطنية في علاقتها بالإنتاجات الكونية”.
إن هذه العبارات ناطقة بدلالاتها في غير ما التباس أو غموض، وهي دلالات جازمة باستبعاد المرجعية الإسلامية، بل ونفي صفة الكونية عنها، بدليل عدها ضمن المعرفة الخصوصية، كجزء يلزمه الانضواء تحت لواء المعرفة الكونية التي من أبرز صفاتها كونها “إنتاجا وموروثا بشريا مشتركا”.
وإذا كان الكتاب الأبيض قد أضاف إلى هذه الفقرة الواردة في “الوثيقة الإطار” عبارة “مع الحفاظ على ثوابتنا الأساسية”، فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئا، ما دامت المرجعية الكبرى التي يحتكم إليها هي ما سمي ب-“المعرفة الكونية”.
إن هذه الملاحظات تؤكد بشكل سافر وصريح مواكبة “الكتاب الأبيض” لسعي دعاة الأممية الرأسمالية المدعاة “العولمة” إلى إرساء دعائم دين جديد، يسمى “الشرعية الدولية” أو “ديانة الأمم المتحدة” أو ما إلى ذلك من أسماء ما أنزل الله بها من سلطان.
هـ- اختيارات وتوجهات في مجال تنظيم الدراسة:
وردفي “الكتاب الأبيض” في مستهل هذه الاختيارات: تقتضي ضرورة تنظيم الدراسة في مختلف الأسلاك التعليمية للارتقاء بجودة الفعل البيداغوجي من خلال الرفع من فعالية التدريس ومن جدوى التعلم ومواءمة الفضاءات التربوية لهما، اعتمادا على مبدأ التدرج من سلك إلى آخر بما يضمن:
– في التعليم الابتدائي: المرونة في تنظيم الحصص الدراسية وتكييف مضامينها مع حاجات المتعلمين بالأساس، ومع متطلبات البيئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المباشرة.
– في التعليم الثانوي: الانتقال من التنظيم الحالي في سنوات دراسية إلى تنظيم دورات دراسية نصف سنوية من جهة، والانتقال من برامج مبنية على مواد دراسية كلها إجبارية في السلك الإعدادي، إلى برامج مبنية على مجزوءات، معظمها إجباري وبعضها اختياري”.
وفي نهاية الحديث عن هذه الاختيارات والتوجهات الخاصة بتنظيم الدراسة ينص “الكتاب الأبيض” على أنه “لاستعمال الجسور الممتدة بين الأقطاب الدراسية في السلك التأهيلي بما يفيد تربية المتعلمين على الاختيار، ينظم كل قطب في مكونين:
– مكون إجباري: تندرج فيه المجزوءات ذات الارتباط العضوي بطبيعة القطب، والمجزوءات المكملة لها.
– مكون اختياري: تندرج فيه المجزوءات ذات الارتباط بمجزوءات المكون الإجباري، أو التي تساعد المتعلم على الاستدراك أو على تيسير المرور من قطب إلى آخر على الجسور، أو على تهيئ ولوج مؤسسات التعليم العالي”62.
إن تسليط الأضواء النقدية على هذا الكلام يكشف لنا عن الملاحظات التالية:
– إن الحديث عن الارتقاء بجودة الفعل البيداغوجي ورفع فعالية التدريس وجدوى التعلم، وما إلى ذلك، لا يبرح نطاق الكلام المنمق الجميل والأمنيات الحالمة، لأنه يفتقد إلى أدنى الشروط التي تمكنه من مجاوزة ذلك النطاق إلى حيز الفعل التعليمي التربوي المنتج.
إن أول شرط يجب توفيره لتحقيق تلك المطالب، هو شرط الوضوح الكامل فيما يتعلق بالإطار المرجعي الذي يتحرك داخله الفعل التعليمي التربوي بجميع مكوناته وروافده ومعيناته. لأن الفعل التعليمي لا بد أن يكون متشبعا بوعي فلسفي عميق يضرب بجذوره في أعماق البيئة الحضارية التي يتحرك في مجالها المتعلمون. وهذا فضلا عن اتساع الآفاق المعرفية لدى الفاعلين التربويين وفي مقدمتهم المدرس، وبدون ذلك يظل الفعل التعليمي يتحرك في عماء، محكوما عليه بالعقم، مهما كانت درجة النماذج التقنية، والوسائل الديداكتيكية من الحبكة والإتقان والصلاحية في الميدان.
– ويؤكد الحقيقة السابقة أن التدريس بنظام المجزوءات يظل فاقدا للمعنى، وتظل مجزوءات المواد المختلفة عبارة عن جزر متناثرة في محيط متلاطم، مفتوح على المجهول، ما لم تكن تلك المجزوءات مشدودا بعضها إلى بعض، بخيط رفيع، هو عينه تيار الفلسفة التربوية الدافق المستكن في صلب المنظومة التعليمية التربوية.
– إن تنظيم الأقطاب في مكونين: إجباري مع مكملاته، واختياري، يظل تنظيما ناقصا محفوفا بمخاطر لا مفر منها، ما لم يُعد النظر في عدد المواد الإجبارية من جهة، وما لم يدخل على هذا التنظيم تعديل يجعله مقبولا، شريطة أن يتم ذلك في إطار تغيير شامل يمس كل مكونات النظام التربوي، وعلى رأسها المدرس. وأقترح في هذا السياق أن تنظم الأقطاب في مكونات ثلاثة: مكون استراتيجي ومكون تكميلي ومكون اختياري. وأما المكون الاستراتيجي فيضم المواد التي تمثل ثقلا واضحا في عملية تشكيل العقول والشخصيات، وهي في نظري المواد التالية: اللغة العربية، التربية الإسلامية، الاجتماعيات، الفلسفة، شريطة انتقاء مفردات تلك المواد بعناية بالغة، على أن يمتحن التلاميذ في المكون الأول على المستوى الوطني.
و- ملاحظات عامة تتعلق بتنظيم الدراسة في الأقطاب والأسلاك المختلفة.
* وضعية مادة التربية الإسلامية:
– في التعليم الابتدائي:
إن أول ملاحظة تستوقفنا لدى تأمل الغلاف الزمني الأسبوعي لمواد التعليم الابتدائي عبر سنواته الست، هي ضعف حصص مادة التربية الإسلامية قياسا إلى مادة الفرنسية. ففي مقابل خمس ساعات ونصف الساعة كمعدل للغلاف الزمني الأسبوعي المخصص لتدريس اللغة الفرنسية خلال السنوات الست لا تحظى مادة التربية الإسلامية إلا بمعدل ثلاث ساعات وخمس دقائق. علما بأن تدريس مادة اللغة الفرنسية لا يشرع فيه إلا في السنة الثانية أساسي.
ومن ثم فإننا إذا اقتصرنا في حساب المعدل على خمس مستويات فإننا سنصبح أمام معدل أعلى وهو ست ساعات وست دقائق أي ضعف معدل مادة التربية الإسلامية تقريبا.
– في التعليم الإعدادي:
بقراءتنا لجدول المواد في هذا السلك، والغلاف الزمني المخصص لكل منها، تتأكد لنا نفس الظاهرة وهي تدني حصص مادة التربية الإسلامية، التي لم يخصص لها سوى حصتين في الأسبوع، فجعلت بذلك على قدم المساواة مع مواد مثل التربية البدنية والعلوم الفيزيائية وغيرهما، بل وحتى مع اللغة الأجنبية الثانية التي هي حديثة عهد كمادة من مواد هذا السلك، أما اللغة الأجنبية الأولى (الفرنسية) فمكانها محفوظ، وأقل غلاف زمني ترضاه لا يمكن أن ينزل عن ذلك المخصص للغة العربية، وهو أربع ساعات في الأسبوع. ولا ندري هل يستقيم –في ظل هذه الوضعية– أن تحتفظ اللغة العربية بالعبارة الواصفة لمكانة اللغة الرسمية عند جميع شعوب الأرض، أي اللغة الأم، لأننا إذا انطلقنا من مقياس الزمن في ذلك، فسنكون أمام أمين اثنتين، إحداهما أصيلة، والأخرى دخيلة، ومع ذلك فالقسط الأكبر من البرور والإحسان استبدت به الثانية دون الأولى!
– في السلك التأهيلي:
نفس المكانة تحتلها مادة التربية الإسلامية في الجذع المشترك، إذ أنها حشرت مع المواد ذات المجزوءة الواحدة، غير أنها وجدت نوعا من الإنصاف، بالتسوية بينها وبين أغلب المواد، وذلك بإعطائها مجزوءتين، ابتداء من الدورة الثانية من دورات السلك التأهيلي، ولكن هذا لا يطرد في جميع الشعب، فقد اقتصر في بعضها على مجزوءة واحدة كما هو الأمر بالنسبة لقطب الفنون (شعبة الفنون التشكيلية، شعبة التربية الموسيقية، شعبة الفنون البصرية والوسائطية) وبالنسبة لقطب العلوم (شعبة العلوم الرياضيات، شعبة العلوم التجريبية، وشعبة الأنشطة الحركية وشعبة العلوم وتقنيات البيئة) وبالنسبة لقطب التكنولوجيات (شعبة الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكيميائية وشعبة التدبير المحاسباتي).
وهكذا يتبين لنا أن التمييز بين الشعب الأدبية من جهة، والشعب العلمية والتقنية من جهة أخرى، في جرعات التربية الإسلامية التي يلزم إعطاؤها لتلامذة كل منها، يظل (أي التمييز) ثابتا في “المنظومة” الجديدة، الأمر الذي يأباه البعد الذي تكتسيه مادة التربية الإسلامية باعتبار المركز الذي من حقها أن تحتله في صدارة مجموعة مواد المكون الاستراتيجي. فالتلاميذ كلهم سواء فيما يجب أن يأخذوه من غذاء روحي وتشكيل عقدي، لا فرق بين علميِّهم وأدبيِّهم، إلا في بعض الخصوصيات التي يمكن مراعاتها في عملية البرمجة التي يجب أن تضع في الحسبان التمييز بين ما هو قاسم مشترك وحاجة عامة، وبين ما هو ذو علاقة بالتخصصات العلمية. والتربية الإسلامية بشمولها واتساع آفاقها، تؤمِّن كل الحاجات وتملك القدرة لتخصيب جميع التخصصات بحوار معرفي خلاق يرتاد أعمق الآفاق، ويثير أكبر التساؤلات.
وإذا كان التمييز المشار إليه مما يثير الاستغراب لافتقاده لأي مسوغ علمي أو تربوي، فإن هناك ما هو أكثر غرابة وأعني به حذف بعض المكونات من أقطاب برمتها، ومن بعض الشعب في بعض الأقطاب.
فقد جاء برنامج التربية الإسلامية في شعبة اللغات والآداب وشعبة التربية الموسيقية خاليا من التربية العقدية. وجاء البرنامج خاليا من التربية العقدية والتعبدية من شعب (العلوم الإنسانية، الفنون التشكيلية، العلوم الرياضية، علوم الأنشطة الحركية).
وتم الجمع بين التربية المنهجية والبيئية، وحذف التربية الفكرية من شعب الفنون البصرية والوسائطية، وغيبت التربية الفكرية والمنهجية من شعبة العلوم الاقتصادية.
أليس تلميذ الشعبة الاقتصادية أحوج ما يكون للتربية الفكرية من منظور الإسلام باعتبارها الحصن الحصين، ضد أي فكر سقيم يقدم نفسه في زي علمي رصين؟
هل هناك إنسان عاقل يدعي أن تلامذة الشعب التي حذفت منها التربية العقدية والتعبدية، مستغنون عن تعميق معارفهم، وعن تفقههم في جانبين يكتسيان خطورة بالغة وشأنا عظيما في حياة الأفراد والمجتمعات على مستوى إصلاح الحال، وعلى مستوى خلاص الإنسان في يوم لا ريب فيه، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟
إن موقع التربية الإسلامية ضمن مواد المكون الاستراتيجي -كما سميته- ينبغي أن يعامل بما هو أهله، باعتباره موقعا ممتازا، لأن مادة التربية الإسلامية تمثل صمّام الأمام ضمن “منظومة تعليمية” معرضة للغو، ولاجتياح الفطريات، وتهريب المواد المحرمة، وإلا فإن الوضع الطبيعي والسليم هو أن تدخل المنظومة التعليمية التربوية في السلم كافة، لأن ذلك وحده هو الكفيل بحماية الأجيال من التيه والضياع وتجنيبها مغبة الفصام النكد، الذي يتعرض له الناشئون الأبرياء جراء “منظومة” ملغومة، بما يجتمع فيها من سموم، ومواد، تسبب الدمار الشامل لإنسانية الإنسان وجوهر فطرته.
ز- وضعية التعليم الأصيل:
يعتبر “الكتاب الأبيض” “عملية مراجعة المناهج التربوية فرصة حقيقية لتجديد التعليم الأصيل تنظيميا وبيداغوجيا:
تنظيميا بإدراجه ضمن النظام التربوي وإخضاعه من حيث الهيكلة ونظام الدراسة، لقواعد النظام التربوي باعتباره مكونا من مكونات المنظومة التربية، وجعله قطبا يضاهي ويكمل الأقطاب الأخرى من حيث الأدوار والوظائف والأهداف”63
والحقيقة أن ما خضع له التعليم الأصيل، في ظل هذا التغيير الجديد، ليس إدراجا له في النظام التربوي على الوجه الصحيح، لأنه ما يزال في وضعيته القديمة المتمثلة في حرمانه من روافد سليمة، تغذيه وتحفظ له قوته واستمراريته وازدهاره، على مستوى السلك الابتدائي والإعدادي.
ومن المستجدات في تنظيم هذا القطب “عدم إدراج شعبة العلوم التجريبية الأصيلة، نظرا لانعدام ما يبرر استمرار هذه الشعبة بعد تعريب المواد العلمية بالتعليم الثانوي العام من جهة، ولقلة الإقبال عليها من جهة أخرى”64.
والواقع أن تبرير حذف شعبة العلوم التجريبية الأصيلة بتعريب المواد العلمية بالتعليم الثانوي العام، يظل مجرد تبرير لا معنى له، لأن ما كان يميز الشعبة المحذوفة ليس اللغة فقط، وإنما طبيعة مواد التكوين. بل إن هناك مسوغا إضافيا، يتمثل في غياب الروح الإسلامية من التعليم العام. ومن ثم فإن الحاجة إلى مثل هذه الشعبة تظل قائمة، لتخريج فئة ممتازة من العلماء المتشبعين بالثقافة الشرعية والوعي الحضاري العميق، والذين يصلون الحاضر بالماضي التليد الذي أنجب أمثال الفارابي وابن رشد وجابر بن حيان وابن الهيثم وابن النفيس وغيرهم من العلماء الأفذاذ، ولكن هذا الهدف، يظل تحقيقه رهينا بتوفير شروطه، على مستوى صيرورة التعليم، بمد جسور التعريب إلى التعليم العالي، وبتعريب الحياة العامة بجميع مناشطها ومجالاتها، وهي شروط تشكل المجال الحيوي للمنظومة التعليمية برمتها ولحياة الأمة على حد سواء.
ملاحظات حول مشاريع البرامج الجديدة في التعليم الأصيل: نموذج الشعبة الشرعية بإلقائنا نظرة على مشاريع برامج شعب التعليم الأصيل فيما يخص العلوم الشرعية يتبين لنا مدى الارتباك وانعدام النسقية العلمية والمنهجية في بنائها واختيار مفرداتها، فضلا عن وجود خلل في بعض المصطلحات المستعملة في التعبير عن بعض المفردات (المواضيع). وللوقوف على ذلك بشكل ملموس، يقتضي المقام استعراض نماذج من تلك البرامج.
– التفسير والحديث: -خصوصيات القرآن الكريم –الإعجاز وأوجهه –أشهر مصادر السنة ومناهج مصنفيها -روابط المجتمع الإسلامي –الحديث بين القبول والرد –التصنيف الإسلامي للقيم –الاعتدال والتسامح في الإسلام –العلاقة بين الإنسان والكون علاقة تسخير –أسس تحقيق العدل في الإسلام –الأمن الصحي والاجتماعي في الإسلام –اقتضاء العلم العمل.
– الفقه والأصول: –أسباب تفكك الأسرة والحفاظ على حقوق الزوجة والأبناء –الحكم التكليفي وأقسامه –تنظيم المعاملات في الفقه ا لإسلامي –أقسام الحكم الوضعي –أحوال الورثة وما يتعلق بهم –حماية الحقوق –تنظيم المعاملات في الإسلام –طرق استنباط الأحكام من النصوص –مسائل متعلقة بالإرث –من القواعد الأصولية”65.
– أول مأخذ نسجله على هذه المشاريع، خلطها بين مفردات علمين يستقل كل منهما بكيانه الخاص: علم التفسير وعلم مصطلح الحديث، وإذا كان الأمر يتعلق بنصوص حديثية فالدقة تقتضي النص على ذلك بوضوح. ونفس الأمر ينطبق على علم الفقه وعلم أصول الفقه.
– ويتمثل المأخذ الثاني في أننا لا ندري وجه العلاقة التي تربط بين بعض المفردات، وبين أحد العلمين الذي أدرجت تحته، مثل روابط المجتمع الإسلامي –التصنيف الإسلامي للقيم –الاعتدال والتسامح في الإسلام! إلى آخر مفردات البرنامج كما سبق عرضها. وينسحب نفس الحكم على مفردات الفقه والأصول. فما علاقة موضوع “حماية الحقوق” بأي من العلمين؟ خاصة وأنه جاء غفلا من أي صفة.
– أما على صعيد الاصطلاح والصياغة لمفردات البرنامج، فإننا نسجل مثلا الخروج عن الاصطلاح العلمي الذي ظل محفوظا لدى علماء المصطلح، فعبارة “الحديث بين القبول والرد” غير مألوفة ومن ثم فليست مقبولة، وما هو متعارف عليه علميا هي ألفاظ “الصحيح والحسن والضعيف والموضوع”…
خاتمة:
وختاما أقول: إنه لا بد من الإقرار بالجهود الهائلة والمضنية التي بذلت من أجل إخراج هذا المنتوج إلى الوجود ولكن يؤسفني أن أقول بكل مرارة، بأن تلك الجهود على أهميتها أخطأت طريقها نحو الحق والصواب، فكانت أشبه بقطار يزيغ عن السكة أو سفينة تبحر بركابها نحو المجهول، أو نحو حتفها المعلوم. ولو أن تلك الجهود سخرت في الطريق الصحيح، وقامت على استشارة حقيقية صادقة، لانبثقت منها معالم منظومة تحقق الأمل وتكشف الغمة.
إن الذي يبيض وجه الكتاب الأبيض حقا وصدقا، إنما هو استمداده من الفلسفة التربوية الإسلامية وخضوعه لمقتضياتها، سواء تعلق الأمر في ذلك برسم التوجهات والاختيارات الكبرى، أو تعلق بتحديد القيم والكفايات، أو بتحديد مواصفات المتخرجين من الأسلاك التعليمية أو من المنظومة التعليمية جملة وتفصيلا.
أما أن يتأسس الكتاب على رؤية علمانية حداثية، مرشوشة ببعض البهارات ذات الطعم الإسلامي، والتي تتشتت عبر فضاء منظومة حداثية الجوهر والسمت، فذلك مما يجعل صفة البياض في “الكتاب الأبيض” مجرد اسم على غير مسمى.
وواضح أن صفة البياض أو عدمها، كما تتعلق بروح الفلسفة السارية في الكتاب، فإن لها تعلقا بأسلوب التعامل ومدى الأمانة في ترجمة المرتكز الأول الذي يزين صدر الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
المبحث الثاني: عوامل إخفاق النظم التعليمية القائمة في تحقيق الأهداف والمكاسب التي حققتها النظم التربوية الأصيلة للمسلمين عبر تاريخهم.
إن هناك عوامل عدة ومتشابكة، كامنة وراء إخفاق النظم التعليمية القائمة في تحقيق الأهداف والمكاسب التي حققتها النظم التربوية الأصيلة للمسلمين عبر تاريخهم. وقبل الخوض في هذه العوامل، لا بد من وصف مجمل للأهداف والمكاسب المشار إليها، فما هي تلك المكاسب والأهداف؟
من الواضح عند المختصين في الشأن التربوي، أن أسمى هدف تنشده النظم التربوية، هو تكوين أجيال من العلماء والمثقفين والخبراء، في شتى الميادين والتخصصات، يغذون شبكة المجتمع، ويمدون شرايينها بالقوة، من خلال تلبية حاجياتها في كل ما يتعلق بإعمار ذلك المجتمع، وتنميته وتطويره، بما يحقق شروط الأمن النفسي والسلم الاجتماعي، والنهوض الحضاري العام، وإن أسهم النظام التربوي لتعلو بين النظم، بقدر ما تحققه من تلك النتائج والأهداف. وإنها لتنخفض، بقدر ما تخفق في تجسيد ذلك.
ومما لا شك فيه أن هدفا جليلا يرتبط بالتبع، بالهدف الذي ذكرناه، هو إسهام النظام التربوي الجاد، في حراسة التوجه العام، وتوفير الانسجام بين مكونات المجتمع، بفضل نوعية القيم التي يعمل على بثها في ثناياها، بالشكل الذي يجعل كل تلك المكونات تدخل في السلم كافة.
فما الذي جعل النظم التعليمية الراهنة تخفق، إذن، في تحقيق ما حققته النظم التربوية الأصيلة، بما في تلك النظم ما يسمى بنظام التعليم الأصيل؟
أولا: انعدام الوئام بين النظام التربوي التعليمي، وبين المجتمع:
إن تحقق الوئام بين النظام التربوي ، وبين المجتمع الذي يعتبر ضمنه أحد مصادر التشكيل والتوجيه لحركته ومناشطه، يعتبر شرطا أساسيا لنجاح النظام التربوي في أداء وظيفته، المتمثلة في إمداد المجتمع بعناصر الدفع إلى الأمام، على اعتبار أن الكل يجب أن يخضع لرؤية واحدة، ويسعى لتنفيذ استراتيجية موحدة. والناظر إلى أنظمتنا التعليمية الراهنة، ينتهي إلى أن هذا الشرط منتف تماما، بحيث إن علاقة التضارب والنزاع هي السائدة، ليس فحسب، بين تلك الأنظمة وبين المجتمعات التي تشكل حقل حركتها ونشاطها، ولكن أيضا بين عناصر ومكونات تلك الأنظمة ذاتها. فلا غرابة أن نفتح أعيننا على ظواهر مرضية، وانعكاسات مدمرة، تتعرض لها الأجيال، واضطرابات وزلازل يتعرض لها المجتمع العام.
يقول زكي بدوي في معرض الحديث عن ضرورة وأهمية الترابط بين المجتمع والنظام التربوي، ” لم يكن التعليم الإسلامي التقليدي في يوم من الأيام نشاطا منفصلا عن المجتمع، بل كان هذا التعليم يسير في انسجام مع ألوان الأنشطة الأخرى تدعمه وتقويه كافة المؤسسات الاجتماعية، ولم يكن من الغريب أن يحتل المسجد قمة النظام التعليمي، لا سيما أنه قلب كل الأنشطة الدينية، أضف إلى ذلك، أن المعلم والطالب، لم ينفصلا قط عن باقي المجتمع، بل كانا في أغلب الأحيان يشتغلان بالتعليم، وفي نفس الوقت يمارسان مهنا أخرى، وعلى هذا النحو لم يفقدا اتصالهما الوثيق بالحياة اليومية، كذلك كفلت العلاقة الشخصية التي كانت تقوم بين الطالب وأستاذه توفير الرعاية الروحية والأخلاقية، جنبا إلى جنب، مع تعليم المهارات المختلفة”66.
فأين نحن من ذلك التواؤم والانسجام، في هذه العصور التي نعيشها؟ والتي أصبح من أبرز سماتها وعلاماتها، تعرض مجتمعاتنا لوابل من القصف الفكري الخارجي الممنهج، في ظل استيلاء جرثومة” القابلية للاستعمار” -كما سماها مالك بن نبي رحمه الله- على شرائح كبيرة من المجتمع.
قد يقول قائل، أو يتساءل متسائل: وما شأن أنظمة التعليم الأصيل التي طبقت في بعض مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟ هل ينطبق عليها نفس الحكم بالإخفاق؟
ليس من الحكمة أن ننساق وراء تعميم الأحكام في هذا المقام، ولكن هذا الاحتياط لا يمنعنا من القول، بأن غير قليل من التجارب المنضوية تحت التعليم الأصيل، أو التقليدي، لا تخرج عن الحكم بالإخفاق، وذلك بالاستناد إلى مقياس صارم، يتمثل في تجربة العصور الذهبية للمسلمين.
والسبب وراء إخفاق تلك التجارب، هو من جهة، ضعف وخلط في تركيبها وبنائها، وضبابية في الرؤية الموجهة لها، ومن جهة أخرى، وجودها في مناخ لا يمت إلى الأصالة بصلة، أو إلا بصلة باهتة. فإذا أخذنا على سبيل المثال، تجربة الأزهر العريقة، ألفيناها لا تخلو من عيوب وجوانب نقص، يقول محمود محمد سفر في سياق الحديث عما لحق نظام التعليم بالأزهر، نتيجة عملية التلفيق التي أخضعت لها برامجه: “خذ مثلا محاولات الأزهر في مصر،في الستينات من القرن الميلادي، عندما اجتهد في تجاوز مشكلة الانفصال هذه، بين النوعين من التعليم، فافتتحت كليات مهنية متنوعة، لا تختلف في أي شيء عن أي كلية أخرى من حيث المناهج،مع إضافة منهج إسلامي فوق المناهج الأخرى، فجاءت التجربة ممسوخة، حيث كان من الأجدى -في رأينا- ” أسلمة” مناهج العلوم الاجتماعية، من علم نفس،واقتصاد، واجتماع، وما إليها بمعاصرة، وفعالية، بدلا من خلطة” سمك لبن تمر هندي”التي سارت عليها الأمور”67.
ثانيا: فقدان السيادة في الميدان التربوي التعليمي:
إن الوضع الذي يكاد يكون ثابتا في مجال الاختيارات التربوية والتعليمية في أغلب أقطار العالم العربي والإسلامي، هو وضع التبعية، أو المراوحة والتأرجح في أحسن الأحوال، فلا تكاد تجد في الأنظمة التربوية التعليمية لتلك الأقطار ملمحا من ملامح السيادة المعبرة عن واقع الأمة واحتياجاتها وطموحاتها ، باعتبارها أمة ذات رسالة، بل إنك لتجد في تلك النظم ركاما من المعارف التي لا يشدها نسق واضح المعالم والأهداف، وخليطا من القيم المتنافرة، التي تنتمي إلى مرجعيات متناقضة. فنظم من هذا القبيل، لا يستغرب أن تخطئ طريقها نحو النجاح في تحقيق ما هو منوط بالنظم التربوية التي تحترم نفسها، باحترامها لخصائص الأمة وأصولها.
إنه ليس من الرشد في شيء، أن يبنى نظام تربوي تعليمي، من خلال إملاءات تأتي من هنا أو هناك، من قوى ولوبيات ومنظمات، من قبيل صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي، وغيرهما، والتي ينحصر همها في تحقيق الهيمنة الشاملة، وصب الشعوب والمجتمعات في قالب واحد، ودمغها بطابع واحد ووحيد68
إن حرمان النظم التربوية القائمة في أغلب الدول العربية والإسلامية، من استنادها إلى فلسفة تربوية تعكس هوية الأمة و خصوصياتها الدينية والثقافية، ومن استحضار معادلتها الاجتماعية في بناء لبنات ذلك النظام، يمثل رأس الحربة ضمن عوامل الإخفاق، في تحقيق النتائج والأهداف التي حققتها النظم التربوية الأصيلة.
ثالثا: انعدام الوحدة المجتمعية:
إذا كانت الوحدة المجتمعية شرطا أساسيا من الشروط التي ضمنت فعالية النظام التربوي الأصيل في ماضي الأمة الإسلامية العريق، وذلك بالتفاف جميع شرائح الأمة حول مثل أعلى واضح وفعال، فإن انعدام ذلك الشرط في حاضر الأمة، قد شكل سببا لتفويت المكاسب والثمار، التي جنتها الأمة في عهود التألق والازدهار، ذلك بأن الأمة تفرقت أشتاتا، بسبب النعرات الضيقة، الحزبية منها والعرقية، والانتماءات الإيديولوجية التي زرعت كما تزرع الألغام في تربة الأمة وحقولها. فما كان للأنظمة التعليمية وهي تنشأ في ظل هذا المناخ، أن تحظى بصفة القوة والفعالية والعطاء، بل إنه لم يكن لها مفر من الاتجاه إلى طريق مسدود، ومن السقوط في العقم والإحباط.
وإذا نخن أخذنا نموذج النظام التربوي المغربي كما يتجلى من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وجدناه مثالا صارخا لما يمكن أن يصنعه الانقسام المجتمعي إلى ولاءات سياسية وفكرية متعددة، بمصير التعليم، حيث إنه يكون عائقا كبيرا أمام ما يعلن من أهداف، على مستوى مواقع القرار، فلقد قام “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” ولو ظاهريا ، على ما سمي بالتوافق بين الفرقاء ، فكان ما كان من بقاء عجلة التعليم رهينة العطالة والجمود، بعد عشر سنوات من وضعه في حيز التطبيق، أريد لها أن تكون أساسا للتحول وتصحيح المسار، فلم يجن منها المجتمع ما كان يؤمله ويرجوه.
المبحث الثالث: الحاجة إلى نظام تربوي أصيل، أو النظام التربوي الأصيل كنظام بديل:
أولا: خصائص النظام التربوي الأصيل.
تمهيد:
لقد بات من آكد الأمور لدى الخبراء والعارفين بأوضاع الأمة العربية والإسلامية، أن جميع المشاريع والخطابات التي رفعت شعارات الإصلاح التربوي والإنمائي من خارج نطاق الرؤية الإسلامية، قد آلت إلى طريق مسدود، ولم تحصد غير الهشيم والأشواك، ولقد وقر في أذهان هؤلاء العارفين، أن الطريق اللاحب، الذي يمثل سبيل الخروج من النفق المظلم إلى الفضاء الوضاء المنير، والعودة الآمنة من رحلة التيه إلى واحة الهدى والأمان، إنما هو تطبيق النظام التربوي الأصيل، مشروعا لإنجاز مهمة الإصلاح، والتحرر من حالة الإحباط التي وسمت بطابع الكآبة القاتمة والصراع المرير واقع التربية والتعليم في بلاد العرب والمسلمين.
وليس ذلك إلا لخصائص وسمات، يتفرد بها ذلك الخطاب دون غيره من الخطابات، فما هي تلك الخصائص والسمات؟
الخصيصة الأولى: خصيصة السبق والريادة:
الخاصية الأولى التي تتصدر جميع الخصائص، بحسب المقصد الذي نتوخاه في هذا المقام، تتمثل في رصيد السبق الذي يتمتع به النظام التربوي الأصيل، على مستوى التجربة التاريخية الرائدة، التي سجلت نجاحا نوعيا في مجال العطاء العلمي والفكري والثقافي، والإبداعي، والذي شهد له المنصفون من خارج نطاق الحضارة الإسلامية، أي في مجال إنجاب الرواحل، أو الأقوياء الأمناء، فلولا ما تميز به ذلك الخطاب من عمق روحي، ونجاعة منهجية، وخصوبة في الوسائل والطرق، وغنى في الإمكان الحضاري، لما تحقق ذلك التألق وذلك النجاح. قد يقول قائل: تلك تجربة مضت، وأصبحت في ذمة التاريخ، وهيهات أن تعود. غير أن سنن العمران البشري ترد هذا القول، على اعتبار أن الروح التي سرت في كيان حضاري، في تجربة سابقة فأثمرت وأينعت، إذا سرت في كيان لاحق، لا يمكنها إلا أن تحقق نفس المحصول، من حيث الهيكل العام، والسمات النوعية للشخصية الحضارية، لا من حيث التفاصيل، لأن التاريخ إذا أعاد نفسه بمقتضى تلك السنن، فضمن سياقات تاريخية أخرى، ومزيج حضاري مغاير في نسبه وتفاعلاته.
ويمكننا القول على سبيل الوثوق واليقين: إذا جاز أن يخامر الناس شك في هذه المسألة، إذا تعلق الأمر بتجارب خارج نطاق الحضارة الإسلامية، على سبيل الاحتياط، ما دام التعامل مع تجارب بشرية في إطار هياكل بشرية، فإن ذلك ليس بجائز حينما نكون بصدد نظام محصن بثوابت الدين الحق، ومهما كانت الأخطاء الناتجة عن الاجتهاد في الفهم والتنزيل لذلك الخطاب، فإنها لن تبلغ مبلغا يفت في عضد البناء الذي أقيم على أساسه. وهنا لا بد أن نستحضر قولة الإمام مالك رضي الله عنه الشهيرة: “لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها”، فأكيد هنا، أن الأمر يتعلق بالروح والهيكل العام، لا بالنقل الحرفي والمحاكاة الجامدة، فتلك، لعمري، آفة تربوية وحضارية ينكرها المنهج التربوي الأصيل، وهو منها براء.
الخصيصة الثانية: خصيصة الربانية:
وهذه الخصيصة، وإن جاءت ثانية من حيث هيكلة نقاط هذا المحور، للاعتبار المذكور أعلاه، فإنها بالنظر إلى خصائص التصور الإسلامي بعامة، أو خصائص الخطاب التربوي الأصيل، تتصدر الخصائص الأخرى. وكون الخطاب التربوي الأصيل موصوفا بالربانية، معناه أنه يستمد رؤيته وهيكله ومقاصده ووسائله واستراتيجيته العليا، وقواعد تجدده، من مصدري الإسلام الموصوفين بالربانية: القرآن والسنة، لكونهما وحيا من رب العالمين، الله جل جلاله، أي أنه استفراغ للوسع في استلهام أصول الدين الإسلامي الكبرى، واستلهام منظومته القيمية في شمولها وتكاملها، عند إرساء دعائم النظام وإقامة بنيانه، والتزام صارم بالمراجعة والتقويم المستمرين، لجميع أركانه ومقوماته، في ضوء النظر المتجدد للأصول، وما تستدعيه حاجات الوجود الحضاري للأمة، بما فيها استمرار ومواصلة رسالة الشهود الحضاري.
الخصيصة الثالثة: خصيصة الثبات:
والمقصود بالثبات صفة للخطاب التربوي الأصيل، تلبسه بالقيم والمقومات التي ينبني عليها التصور الإسلامي69، والتي تحمل تلك الصفة أو الخاصية بشكل مباشر، وينشأ عن ذلك التلبس والامتزاج، أن يظل الخطاب الأصيل ثابتا في هويته، ثابتا في أهدافه ومقاصده، لا ينحرف عنها ولا يحيد قيد أنملة، وإلا تعرض للخلط والتهجين، بحسب درجة التزحزح والانحراف.
وثبات الخطاب التربوي الأصيل لا يعني البتة تقوقعا ولا جمودا، لأن ذلك يتنافى مع طبيعته وعمق رسالته، التي هي إعداد الإنسان للاضطلاع بوظيفة العمران، بما تتطلبه هذه من جاهزية عالية، وقدرة على المواكبة، والاستجابة للحاجات المتجددة للأمة، وللإنسانية جمعاء.
وإن الذي يعطي للنظام التربوي الأصيل هذه السمة الفريدة، هو كون قيم ومقومات التصور التي يستند إليها، تشكل إطارا واسعا ومجالا رحيبا، يمكن أن تجري فيه حركة الإنسان الدائبة، بشكل إبداعي موصول، وفي أمن من أي عوامل لتثبيط أو تعويق.
الخصيصة الرابعة: خصيصة الشمول والتكامل:
والمقصود بخاصية الشمول كصفة من صفات النظام التربوي الإسلامي، أن العملية التربوية فيه، تراعي جميع أبعاد الإنسان ومكوناته، وتضعها في الحسبان، عند التشكيل والبناء، طلبا للتوازن والكمال، ودرءا لأي تعويق أو إقصاء، فمن البعد البيولوجي الجسدي، إلى البعد العقلي، إلى البعد الروحي والنفسي، إلى البعد الأخلاقي الاجتماعي، الكل يأخذ نصيبه من الإشباع والإعمال، وذلك وفق ضوابط ونسب ومقادير، تحدد في ضوء الرؤية أو الفلسفة التربوية المعتمدة، وتجد تدقيقاتها ونموذجها التطبيقي الرفيع في القرآن والسنة، وفي سيرة سيد الأنام، الرسول الأعظم: سيدنا محمد r.
ويندرج تحت خصيصة الشمول أيضا، من باب التلازم والارتباط مع ما سبق، شمول الخطاب التربوي للوجود الدنيوي والوجود الأخروي، وطبيعة التعامل معهما، انطلاقا من كون الدنيا مزرعة الآخرة، كما ورد عن رسول الله r، وهو أمر يتفرد به الإسلام دون غيره من العقائد والمذاهب، وهو وحده العاصم من مغبة الفصام النكد، والازدواجية القاتلة، التي تتولد عنها العقد والعلل والأسقام، مما تجرعت سمومه الناقعة سائر النظم التربوية القائمة في العصر الراهن، بما فيها، بالطبع، النظم القائمة في العالم العربي70، وورثته الجماهير العريضة من روادها، التي تكبدت من الخسائر والجراح على جميع مستويات الكيان، فنالها من التشوهات، بحسب ما أخذت من الجرعات.
كما ينضوي تحت خصيصة الشمول، شمول الخطاب التربوي الأصيل، للبعد الفردي والبعد الجماعي في كيان الإنسان، أي للفرد وللجماعة71 على حد سواء، فلا جور لأحدهما على الآخر، فيجوز وصف وضعهما المثالي الذي يتوخاه المنهج التربوي الإسلامي في شأن العلاقة والتفاعل فيما بينهما، بما وصف به الله تعالى في كتابه العزيز، النظام الضابط الذي يحكم البحرين اللذين لا يبغي أحدهما على الآخر، إذ يقول جلت قدرته: {مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان} (الرحمن: 19-20).
إذا كان الشمول يعني إيلاء الأهمية لكل الجوانب والأبعاد، فإن التكامل في منطق الخطاب التربوي الأصيل، يتعلق بذلك المزيج النوعي، الذي يتحقق من خلال التفاعل الإيجابي بين عطاءات الأبعاد جميعا، والتي تمر عبر ما تقدمه المنظومة من قيم وخبرات، أي ما تمثله مدخلات المنهاج، بمفهومه الواسع العميق.
الخصيصة الخامسة: الجمع بين التنظير والممارسة أو بين العقيدة والعمل:
العمل التربوي في عرف النظام التربوي الإسلامي، يعلي من شأن التنظير إعلاءه من شأن الممارسة، على أساس اقتناع راسخ بالتفاعل المنتج والبناء الذي يمكن أن يحصل بينهما في حالة احترام القواعد التي يجري بموجبها ذلك التفاعل.
إن إلقاء العصا، والهز بجذع النخلة، والركض في المغتسل البارد، وحفر الخندق، وتلقي الأمر بالسعي لغرس الفسيلة ولو كانت ستقوم القيامة، والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، لربط المعلولات بعلتها، والسؤال عن كيفية وقوع الظواهر، وغير ذلك من مظاهر الممارسة والنظر، أمثلة حية مما لا يحصى من حشد هائل من الأمثلة والنماذج التي يحفل بها القرآن الكريم والسنة المطهرة والسيرة العطرة، مما هو قمين بأن يذكي عند المتلقي المتفاعل مع تعاليم الإسلام، حاسة الربط المحكم العميق بين عنصري المعادلة الصعبة: العقيدة والعمل، النظر والممارسة، وتذهب به بعيدا في مستويات النضج الفكري، ومراقي الإبداع التدبيري والإنتاج العملي.
تتجلى هذه العلاقة الجدلية كأبرز ما تكون، وأعمق ما تكون، في المضمون الذي يحمله لفظ الشهادة في كلمة الشهادة التي يعلن النطق المسؤول عنها عن ميلاد كيان وجودي نفسي متفرد، أو عن رقم صعب، يحمل عنوان الإسلام، فيؤسس من خلاله لكيان حضاري فريد، ونسيج وحده بين سائر الكيانات. يسوق الحديث عن هذه الحقيقة بوضوح، المفكر والخبير التربوي القدير، علي عيسى عثمان رحمه الله، في بحثه القيم والبديع، في سياق تحليل وبيان علاقة قول وفعل الشهادة، بمعاني الولادة على الفطرة ومقتضيات ذلك، يقول: ” ويتبين من نظرة مبدئية لقول الشهادة أنه مكون من ثلاثة أجزاء أساسية هي: 1- أشهد أن 2- لا إله 3- إلا الله.
وأول ما يلفت في هذا القول أنه استهل بفعل صيغ بصيغة المتكلم المفرد: “أنا” هو من يشهد، و”أنا” هو من يقوم بكل العمليات المطلوبة في قول الشهادة، و”أنا” هو من تحدث به وفيه هذه العمليات كلها، و”أنا” هو من سيرفض الشرك، وهو من سيتوصل إلى التوحيد، و”أنا” هو من سيلتزم بهذه النتائج، فأشهد“72.
فعملية الشهادة – كما يتبين من هذا التحليل – لا تجري في عالم من التجريد المحض، أو الخيال المجنح الفضفاض، وإنما من خلال تفاعل حي بين قوى العقل والحواس الفطرية، وبين عالم الأشياء، وما يكتنزه من سنن وقوانين، وما يكشف عنه من أسرار تباعا، عبر آفاقه الممتدة، مصداقا لقوله تعالى: {سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد} (فصلت: 51).
إن من شأن الخطاب التربوي الأصيل بهذه الرؤية المتكاملة الضاربة في أعماق الفطرة، المنبثقة من متطلباتها واحتياجاتها، أن يتيح للناشئة عند بلورته في واقع مؤسساتي، فرصا حقيقية للنمو المتكامل والمتوازن، وذلك عبر آليات وصيغ منهجية فعالة من جهة، وتوفير فضاءات اجتماعية سليمة مساعدة من جهة أخرى.
الخصيصة السادسة: نظام يأتلف فيه القرآن والبيان:
إن أعظم عنوان يميز مشروع الخطاب التربوي الأصيل، هو نهله من بينات وبصائر القرآن، واقتباسه من نوره وهداه، لأنها تمثل الروح والغذاء، وتضطلع بوظيفة الهداية والتسديد، وهي العاصم وصمام الأمان، للاستمرار على سواء الصراط. إن أقوم منهاج على الإطلاق، في مجال البناء التربوي، كما في غيره من المجالات، هو منهاج القرآن، لأمر بسيط وعظيم: هو العلم الكامل والدقيق بحقيقة الإنسان. يقول جل جلاله: {إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم} (الإسراء: 9).
فلا بناء يوسم بالصلاح والكمال، وبالسداد والرشاد، إلا إذا كان على هدى من علم القرآن.
أما قضية البيان التي تمثل الوجه الآخر في هذه الخصيصة، فهي في جميع أشكالها وتجلياتها، تستمد عمقها التطبيقي المتمثل في شساعة الفضاء اللغوي والتركيبي، وثرائه الدلالي المعنوي، تستمده من القرآن، لأنه خزان المعاني الذي لا ينضب له معين، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: {قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا} (الكهف: 109).
ومن الواضح أن هذه الحقيقة القرآنية الكونية تدفع بثقلها الكبير في اتجاه تعزيز مكانة اللغة العربية ضمن النظام التربوي الأصيل، على أن يكون التعامل معها في إطار الوعي بجدلية القرآن والبيان. ومن الواضح أيضا، أن التعامل مع لغات الكون، لن يكتسب عمقه وثراءه إلا في ضوء المعرفة الدقيقة الواسعة بأسرار لغة73 القرآن، والفقه الكامل لشبكة مفاهيمه وتصوراته، وإلا أصبح ذلك التعامل مدخلا واسعا للتيه، ومعولا فتاكا للاستئصال والتدمير.
إن استيحاء هذه الحقيقة في بناء النموذج التطبيقي يشكل أرضية صلبة للاستقلال الثقافي، وحافزا قويا لتفجير ينابيع الإبداع في رواد المدرسة الأصيلة.
الخصيصة السابعة: النظام التربوي الأصيل، نظام تنموي بامتياز:
لأنه لا يترك منبعا من منابع الطاقة في الإنسان إلا وفر له شروط التفجير، لكونه يملك مادة التخصيب وعوامل التخصيب والترتيب، ويدرأ عوامل الإهدار والتثبيط والتعويق. ولم تدخل أقطار العرب والمسلمين في دوامة التخلف والجمود، إلا لحرمانها من الإطار الناظم الذي يكفل تجميع الطاقة وتوظيفها في أبوابها ومجالاتها، مع مراعاة مقاديرها وسلم أولوياتها. فهي على العكس مما ينبغي فعله، مكنت من نفسها لكل عناصر التفتيت والتمزيق، فذهبت إلى حتفها بظلفها.
ولن تعود الروح وتبعث الحياة في كيان الأمة الراكد من جديد، إلا إذا عادت الروح إلى نظامها التعليمي التربوي، فهو الرافعة الأساسية وجهاز الدفع المتين، الذي يمد شرايين المجتمع بأسباب القوة والاستمرار في الوجود، ومباشرة رسالة الشهود.
الخصيصة الثامنة: النظام التربوي الأصيل يتمحور حول القيم والمواقف:
إن مما يجعل النظام التربوي الأصيل أهلا لمهمة الإصلاح، أنه يتأسس على القيم المعبرة عن الفطرة، ويتشبع بها إلى حد بعيد، ويتوخى من خلال ذلك بناء المواقف الرسالية الرفيعة والثابتة، والتي ترفع الإنسان إلى مستوى التكريم المرتبط بحمل أمانة الاستخلاف.
فقيم التوحيد والتقوى، والصدق والإخلاص، والعفة والوفاء، والرحمة والإحسان، والتعاون والإيثار، والتوبة والعرفان، والمجاهدة والجهاد، وحب العلم والعلماء، وحب الخير للناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها من القيم، تحكم بناء الشخصية الرسالية على نحو متين، يؤهلها لاتخاذ الموقف المناسب في الظرف المناسب والإطار المناسب، ومن خلال إحكام الصلة بين النية والعمل الصالح، وتصحيح النية والاستيثاق منها حالة العمل، مع الاقتباس من نور القدوة، من رصيد التاريخ، وفي الواقع على حد سواء، والتوكل على الله في كل الأحوال، يتم رسوخ تلك القيم والأخلاق في نفوس الناشئة التعليمية، فتصبح هيأة راسخة توجه الممارسة والسلوك، وتساهم بقسط وافر في صناعة المجتمع الآمن، والحياة الآمنة.
الخصيصة التاسعة: النظام التربوي الأصيل نظام عالمي إنساني:
إن مهمة الإصلاح التي يحملها على عاتقه الخطاب التربوي الأصيل، لا تنحصر في حدود جغرافية معينة، أو أقوام معينين، بل إنها لتمتد بإشعاعها لتحتضن العالم أجمع، والإنسانية جمعاء، ومن ثم عالمية ذلك النظام وإنسانيته، وهما صفتان نابعتان من صفة الربانية كأعلى صفة من صفاته، فالله رب العالمين، وخطابه للناس كافة، وخاتم رسله سيدنا محمد r لم يرسل إلا رحمة للعالمين، مصداقا لقوله جل وعلا: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} (الأنبياء: 107) وقال جل جلاله: {وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون} (سبأ: 28). ومن هذا المنطلق يكون الخطاب التربوي الأصيل هو خطاب الرحمة، علم ذلك من علمه، وجهله من جهله، وآزره من آزره وجافاه من جافاه.
ولكن الذي لا مراء فيه عند العقلاء العارفين، أنه هو الملاذ والخلاص، وطوق النجاة.
وتستتبع هذه الحقيقة الناصعة، أن تبنى المناهج التربوية المترجمة للرؤية الأصيلة، بطريقة حكيمة متقنة، تعكس حقائق الشريعة بجلاء، وما تحمله من عناصر الرحمة وفيض الحنان. وتتوخى من خلال ذلك تخريج أجيال تحمل رسالة الرحمة والخير للناس، بحيث تبنى على أساس الفهم العميق لوسطية الإسلام، التي تحق الحق وتدحض الباطل، وتدافع عن حق الناس فيما خولوه بموجب آدميتهم.
الخصيصة العاشرة: النظام التربوي الأصيل، نظام منفتح على الحكمة في مواطنها:
تتأسس هذه الخصيصة على كون الخطاب التربوي الأصيل يملك ثقة عالية في تفرده وتميزه، لا بسبب تبجح وغرور، ولكن بسبب يقينه في انتسابه للدين الحق، واستقائه من معينه، ومراجعة برامجه وأطاريحه، بشكل مستمر موصول، في ضوء ذلك المعين. فالتفتح المنضبط الموزون من هذا الباب، يمكن النظام التربوي الأصيل من الاستفادة من خلاصة التجارب الإنسانية المتصلة بعناصر العمل التربوي، ومن مراعاة الخصوصيات التي لا تتنافى مع الجواهر والأصول، ويجعله على استعداد للبحث الدؤوب والموصول، عن الصيغ المتنوعة والحيوية الكفيلة بالإيصال إلى المقصود.
الخصيصة الحادية عشر: نظام يجمع بين علوم الشريعة وبين علوم الكون والمجتمع في كل نسقي:
ليس هناك انفصال بمقتضى أصالة النظام التربوي الأصيل، بين علوم الشريعة، وبين علوم الكون والمجتمع، لأن كلا الطرفين موجه لغاية واحدة، هي دعم وظيفة الاستخلاف المنوطة بالإنسان. وما يؤكد هذه الحقيقة التي هي في حكم البديهيات، وحدة الخلق والتدبير، وصفة الحكمة والإبداع، فالذي أودع في الشريعة أحكامها وسننها وحقائقها، هو نفسه الذي أودع في الكون والمجتمع ما يتعلق بهما من سنن وقوانين، ومن ذخائر وكنوز وطاقات، الله العلي الحكيم جل جلاله، فلا مناص إذن من انسجام وتطابق وتكامل يحكم الكتابين: كتاب الله المسطور، الذي هو القرآن، وكتاب الله المنظور الذي هو الكون والمجتمع، ويترتب عن ذلك، إذن، أن يكون النظام التربوي الأصيل ترجمة أمينة وحية، لذلكم التطابق والانسجام، بما يحقق انسجام النفوس والعقول مع حقائق الكتابين، ومن ثم الاستقامة على الصراط.
يقول علي عيسى عثمان رحمه الله: “لكي يكون نظام التربية نظاما إسلاميا، لا بد أن يكون هو الآخر نظاما كليا، يحيط بكل ما يقتضيه نمو الإنسان المتكامل، إن كان ذلك في نموه العقلي، أو الخلقي أو الوجداني، أو كان في تشكيل اتجاهاته الأساسية نحو الإنسان ونحو العالم وما فيه من أشياء وكائنات، وتنمية هذه الاتجاهات، أو كان في تشكيل اتجاهاته نحو الأنظمة والمؤسسات الاجتماعية وتنمية هذه الاتجاهات.”74
إن كل هاتيك الخصائص والسمات المميزة للنظام التربوي الأصيل، تجسد البرهان الساطع على أن الحاجة إلى تفعيله في المجتمعات العربية والإسلامية حاجة على قدر كبير من الإلحاح، من مختلف الأوجه والأبعاد، فأين تتجلى هذه الحاجة؟
ثانيا: أبعاد الحاجة إلى قيام النظام التربوي الأصيل:
1- من حيث كونها حاجة وجودية:
والمقصود بالحاجة الوجودية حاجة الأمة المسلمة إلى النظام التربوي الأصيل، إما لأجل الحفاظ على وجود حضاري قائم، وترسيخ دعائمه، وتحصينه ضد عوامل المحو أو التآكل والإضعاف، وإما لبعث ذلك الوجود من جديد، في صورته المشرقة المتكاملة، بعد أن تعرض لجملة من التشوهات، نتيجة عوامل داخلية أو خارجية، أو هما معا.
والحالة التي نحن بصددها هي الحالة الثانية، فالأمر يتعلق بإصلاح ما فسد، وبعث ما اندرس من بناء كان يوما ما شامخا متألقا، إنها عملية إحياء، بنفخ الروح من جديد، في جسد تعطلت كثير من أدواره ووظائفه، لتعود أجهزته للالتئام والالتحام، لمعاودة الإنتاج.
إنه مما لا شك فيه، أن عملية الإحياء، عملية من التعقيد بمكان، لأنها تتعلق بمجمل النظام المجتمعي العام، بجميع مفاصله ومكوناته، بمختلف مناشطه وفعالياته، ولن يكون هناك إحياء بالمعنى الحق والكامل، إلا إذا امتدت يد الإصلاح إليها بأسرها. فمفردات البناء الحضاري، يشد بعضها بعضد البعض الآخر، لتشكل شبكة واسعة الأرجاء.
ومع ذلك، فإن صدارة النظام التعليمي التربوي ضمن باقي النظم التي يؤلف معها النسق المجتمعي العام، حقيقة واضحة للعيان، مما أسلفناه من البرهنة والبيان، فهو المختص في صناعة الإنسان، الذي يعد الدعامة الكبرى وركن الأركان، في كل ما يرام إجراؤه من التغييرات والنقلات، على مستوى هياكل المجتمع.
فالنظام التربوي التعليمي، إذا بني بإحكام على هدى من أسس الهوية وقيمها ومقوماتها، كفيل بكل تأكيد، أن يضخ دماء الحياة في شرايين الأنظمة الأخرى.
ولعل استقراء لتجارب الأمم المعاصرة التي خرجت من وهدة التخلف، وأعادت اكتشاف ذاتها، ونجحت في معترك التدافع الحضاري، يدلنا على مصداقية هذه الأطروحة، وهذا بصرف النظر عن الهوية الثقافية لتلك التجارب، ومدى صلاحيتها للتعميم على المستوى الإنساني.
2- من حيث كونها حاجة فطرية ونفسية على مستوى المستهدفين:
إن الدارس لأنظمة التربية والتعليم في المجتمعات البشرية من منظور فلسفي يستند إلى الفطرة معيارا ذهبيا يتسم بالصلاحية والثبات، ينتهي به الدرس والتحليل إلى وضع تصنيف لها، يميز بين نظم تتماشى مع الفطرة، على تفاوت في النسب والمقادير، التي ترتهن بها درجة النجاح في ترجمة أهداف الفطرة في واقع الأجيال التعليمية، وبين نظم مجافية للفطرة، على تفاوت في النسب والمقادير التي ترتهن بها درجة التضعضع والارتكاس، أي درجة الجدع، بالمفهوم الوارد في حديث الفطرة الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: “ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء، حتى تكونوا أنتم تجدعونها“75
ولن يخرج عن وضع مجافاة الفطرة أنظمة هجينة تجمع في جعبتها بين النقائض، لأنها لن تخرج في محصلتها ومخرجاتها عن اللافطرية التي تترجم عن نفسها في التشوهات الخلقية والخلقية الناجمة عن اجتيال الشياطين.
3- من حيث كونها حاجة إنسانية على مستوى المجتمع الإنساني:
تكتسي حاجة المجتمع الإنساني إلى إرساء نظام تربوي أصيل طابع الإلحاح، نظرا لعمق نظرته وسعة أفقه، بسبب اتصافه بالخصائص التي سبق إيرادها، فهو يتيح من خلال نوعية التنشئة التي يقدمها للأجيال، عبر ما يبثه من قيم رفيعة، وما يرسيه من أنماط راقية للتعامل والممارسة والسلوك، تكوين مناخ إنساني قائم على التعارف، بفضل ما يربط الأفراد من جسور الحوار حول القضايا والمشكلات التي تحدد مصير الجميع، وتؤرق أهل الفكر والتدبير، مثل قضايا التحرر والاستقلال، والتعليم والغذاء، والبيئة والأمن والسلام، وما إلى ذلك من مشكلات، تهم الأفراد والمجتمعات.
إن النظام التربوي الأصيل بفضل إقراره لمبدأ التكريم العام لبني آدم، ونبذه لنزعات الميز والاستئثار، والطغيان والاستكبار، واتخاذه التقوى والعمل الصالح مقياسا للتفاضل، وأفقا للتنافس، واعتماده مبدأ الحرية أساسا للاعتقاد، والعدل أساسا للملك وتوزيع الخيرات، بإمكانه أن يؤسس فضاء إنسانيا فسيحا، تترسخ فيه قيم التعاون والتعارف، ويتوطد فيه النزوع نحو الإصلاح والبناء، وتتوفر في جنباته الشروط المساعدة على استتباب وتوطين الأمن والسلام، ونبذ الفتن والحروب.
4- من حيث كونها حاجة علمية منهجية.
إن إفساح المجال أمام النظام التربوي الأصيل، لينتشر ويسود، ويمسك بزمام الحركة التربوية التعليمية، يشكل حاجة علمية منهجية، بفضل ما يملكه من ضوابط وقواعد يستطيع بموجبها أن ينظم مجالات الفكر والمعرفة، ويضبط حدودهما، مما ينعكس إيجابا على الحركة العلمية، من حيث سلامة التوجه والأهداف، وسداد السير، وعمق النتائج والثمار. يقول عماد الدين خليل في سياق حديثه عن إحدى ضرورات إسلامية المعرفة، وهي “الضرورة العلمية”: “تستمد هذه الضرورة إلحاحها من أن إضافة البعد الإيماني إلى مختلف الأبعاد التي تكتسيها الرغبة في الكشف العلمي وارتياد آفاق الكون، ستشكل لا محالة دفعا قويا لتلك الرغبة وذلك النزوع، على اعتبار أن انطلاق الإنسان في طلب العلم وكشف أسرار الكون، استجابة لأمر الله وابتغاء رضوانه، سيشحنه بشحنات هائلة، تضاف إلى المقتضيات المعيشية والاقتصادية والعمرانية، لتعزز قوة تأثيرها.
إن “أسلمة المعرفة” تعني وفق هذا التحليل، منح النشاط العلمي عل مستويي الكم والنوع، وقودا جديدا يدفعه للمزيد من الاشتعال والتألق اللذين يكشفان عن الحقائق.”76
وفي اعتقادي أن من أهم العناصر أو الأبعاد التي تضاف إلى هذه الضرورة، أي الضرورة العلمية والمنهجية، كون الروح المنهجية التي يستبطنها النظام التربوي الأصيل، بمقتضى ما يملكه من خصائص، من شأنها أن تصرف المتعاطين معه، المنطلقين من مذهبيته، المتشبعين بفلسفته، عن إنفاق أي جهد فيما لا طائل تحته من الأبحاث، سواء على مستوى الطبيعة، أي طبيعة تلك الأبحاث، أو على مستوى المقاصد والأهداف.
5- من حيث كونها ضرورة علاجية: تجاوز الفصام النكد:
المقصود بالفصام النكد، هو ذلك الفصل التعسفي والقطيعة اللاشرعية اللذين أقيما بين الحياة بجميع مناشطها الفكرية والمادية والمدنية عامة، وبين الدين بجميع أبعاده وعناصره وأركانه ومقتضياته، الأمر الذي نتج عنه اضطراب وانحراف، وتكلس وجفاف، في حياة الإنسان، وفي علاقاته بكل شيء: بذاته، وبالناس من حوله، وبالطبيعة التي تكتنفه، وما فيها من أشياء وكائنات، وقبل ذلك وبعده، بربه ورب كل شيء ومليكه، فكان ما كان من إحساس بالشقاء، وشعور طاغ بالتيه والاغتراب، وفقدان لمعنى الحياة، ولطعم السعادة والاطمئنان على الإطلاق.
وتتحمل المناهج التربوية السائدة في العالم بمختلف نظمه، وزر ذلك الفصام النكد، وقد جأر العقلاء من مفكري الغرب، بمر الشكوى من عقابيل ذلك الفصام، ووجهوا إصبع الاتهام، إلى تلك الأنظمة التربوية الشاردة. يقول واحد من أبرزهم، وهو أبراهام ماسلو منتقدا التربية الحديثة: إنها ” اقتصرت على علوم المادة وأهملت ما أسماه بـ”خبرات القمة” كالدين، وأفرزت علما يشوه روعة كل جميل، ويهدم كل ما يوحي بالخشية والقدسية، ويفرض على الحياة عنجهية زائفة، في الوقت الذي يجعلها كئيبة رتيبة لا لون فيها ولا متعة فيها. وضرب لذلك مثلا من خبراته الشخصية فقال: إنه ما زال يذكر أول عملية جراحية حضرها خلال دراسته الطبية، حيث تم استئصال ثدي امرأة بالمبضع الكهربائي، وكان الثدي مجرد قطعة من لحم مشوي، وكيف ألقى الجراح في مسحة من الزهو والتبجح، القطعة المبتورة وكأنها مجرد كيس من الدهن، دون اعتبار لإنسانية الإنسان. وأضاف ماسلو مثلا آخر من سلوك طلبة الطب، وكيف أنهم كانوا يجلسون على جثث الموتى في قاعة التشريح، ويأكلون الساندويتش، ويلتقطون الصور الفوتوغرافية ويتبادلون النكات، خلال وجبات الطعام، عن المناطق الحساسة في الجثث التي يشرحونها.”77
ويبقى الطريق إلى الانفكاك من هذا الفصام النكد، والخروج من ظلماته المتراكبة، هو إعادة الارتباط بين الحياة والدين، وإرجاع الإنسان إلى فطرته التي فطره الله عز وجل عليها، ولن يتم ذلك إلا عن طريق إعادة تشكيل شخصيته وفق قوانين الفطرة، بتسخير أمثل الأساليب والمنهجيات، ورصد أنضج المعارف وأعمق القيم، دون أن ننسى العملة الصعبة أو الرقم الصعب في مجمل العملية التربوية المعقدة الذي هو المعلم المحنك الخبير بأسرار الصنعة وأسرار النفوس.
والنظام التربوي المرشح للاضطلاع بهذه المهمة الصعبة الشاقة، هو النظام التربوي الأصيل، بشروطه ومستلزماته، فما هي مستلزمات تطبيق هذا النظام؟
ثالثا: مستلزمات تطبيق هذا النظام لإصلاح أوضاع التعليم الممارس في المجتمعات العربية والإسلامية، ومعالجة أمراضه وعلله:
1- نشر الوعي الكامل بأصالة الفكر التربوي المنبثق من الإسلام وقدرته على الإعداد الرشيد للأجيال، وإثبات الجدارة على البناء الحضاري الراقي وفق أعلى مقاييس الجودة والإتقان.
إن أول مستلزم يتوقف عليه تطبيق النظام التربوي الأصيل، يتعلق بنشر الوعي، والإقناع بجدارة هذا النظام بالتطبيق، لكونه يشكل الإطار الأسلم والأمثل لتشكيل النفوس، وإعداد الأجيال المعول عليها في بناء صرح الحياة، وتدبير شؤونه، وحراسته من الغوائل والأخطار.
وينبثق هذا المستلزم من أن الضامن الأساسي لنجاح أي مشروع أو نظام، هو الوعي بأهدافه وتميزه، وتفوقه على غيره من المشاريع والنظم، من حيث القدرة على تحقيق الأهداف المنوطة به، على قاعدة من الإجادة والإتقان، ومن ثم على حل المشاكل والمعضلات القائمة والطارئة، على أساس من العمق والشمول، والنجاعة والإحكام.
2- إرساء دعائم الفلسفة التربوية الإسلامية واضحة المعالم، والقائمة على الربانية والتوحيد والشمول وسائر الخصائص المعلومة:
من المعلوم لدى الخبراء والمهتمين بالشأن التربوي، أن الرؤية الفلسفية التي يقوم عليها أي نظام تربوي، تشكل فيه اللب والأساس، وهي بمثابة البوصلة التي تهدي، أو من المفروض أن تهدي أي حركة أو جهد أو إنجاز يتم في إطاره. وتتحقق مصداقية أي نظام تربوي في أي مجتمع من المجتمعات، بناء على ما يكون هناك من نجاح في اتخاذ ذلك النظام فلسفة تربوية تمثل روح ذلك المجتمع وثقافته وعبقريته. هذا على وجه العموم، وإلا فإن أنجح نظام تربوي على الإطلاق، إنما هو ذاك الذي تكون غايته استخراج مكنونات الفطرة، والتعبير عن صوتها بكل صدق وشفافية، والتمكين للمتربين، من أن يحققوا التطابق مع ذواتهم، في إطار سنن الكون والمجتمع، وما هو منوط بالإنسان من وظائف ومهام تخص الاستخلاف وشكر نعمة التسخير.
ومن الأكيد أن النظام التربوي الذي يبشر بتحقيق تلك المقاصد العليا والأهداف السامية، ويملك مقومات ذلك، هو النظام التربوي الأصيل، بالمواصفات التي ذكرت في ثنايا هذا البحث.
فمن الأكيد، أن مدخل الشر والتعويق في أي نظام تربوي، هو تأرجح هذا الأخير، بين آفتين قاتلتين: تتمثل إحداهما في اتخاذ فلسفة تربوية غريبة عن هوية المجتمع وأصالته، وتكمن الأخرى في سير النظام التربوي في عماء، يتخذ شكل فلسفة هجينة، هي خليط من أفكار وتصورات تائهة، وشتات من مبادئ وأفكار، ذات علاقة بثقافة الأمة، ولكنها عديمة القوة والفاعلية، لأن وجودها لا يعدو أن يكون للتمويه والخداع.
والدليل على صحة هذه الدعوى، هو أن ما قدمته الحضارة الإسلامية من عطاء، ومن نتاج على مستوى إنجاب عباقرة الفكر والعلم والأدب وسائر المعارف والفنون، إنما هو ثمرة لاستناد تلك الحضارة إلى أصل راسخ، هو فلسفة الأمة ومذهبيتها، ولإطار ثقافي متماسك يضرب بجذوره في أغوار المجتمع، ويأخذ بتلابيب كل شيء فيه.
3- إيلاء اللغة العربية مكانتها اللائقة لغة للتعليم، باعتبارها لغة الرسالة الخاتمة والأمة الشاهدة:
كما أن اللغة العربية هي المقوم الثاني بعد مقوم الدين في هوية الأمة المسلمة، فإنه ينبني على ذلك أن تكون هي المقوم الثاني أيضا في نظام تربوي يوسم بالأصالة، إذ بدون ذلك المقوم، ينتفي الولوج الطبيعي والصحيح إلى عالم الأصالة والتأصيل، فاللغة العربية هي “لسان الوحي ومفتاحه”78، ولا يمكن أن يكون هناك بديل لها أبدا، لتحصيل الفهم السليم لما تختزنه ألفاظه وآياته من معاني ودلالات، واستخراج ما تزخر به من كنوز وأسرار، تتعلق بهداية الإنسان في شعاب الكون والحياة، إلى أوضح المسالك المؤدية إلى صناعة القوة بجميع مستوياتها، وتحقيق سعادة الدنيا والآخرة.
ولا يتعارض هذا المقام الذي ينبغي أن تتبوأه اللغة العربية في النظام التربوي الأصيل، مع العناية بتدريس اللغات الحية الأخرى، شريطة أن يتم ذلك في ضوء استراتيجية واضحة، يكون أحد أسسها عدم المساس مطلقا بموقع اللغة الأم، وكونها هي الوعاء الأسمى والمحضن الخصب الذي تتخلق فيه العملية التربوية في مجمل عملياتها وأطوارها.
4- الرصد الدقيق لمنظومة القيم الموكول إلى النظام بثها في المستهدفين.
لا نخطئ الصواب إذا قلنا إن القيم تشكل عصب المنظومة التربوية، حتى إنه ليمكننا القول: إن أزمة منظومة تربوية ما، هي أزمة ما تحمله في جوفها من قيم، ورجاء غارودي ممن يذهب إلى هذا الرأي إذ يقول: “إن التربية لضاربة الجذور في أزمة القيم”79 ويعني ذلك بكل وضوح، أن الذي يتولى توجيه المنظومة التربوية في اتجاه معين، هي القيم، وهذا ما يذهب إليه جل الباحثين التربويين، ومنهم في العصر الحديث، دولانتشير، وداينو الذي يرى أن السياسة التربوية تتمثل في: “مجموعة من التصريحات بالنوايا المرتبطة بالتوجيهات أو القيم المراد تبنيها“80 وهذه الحقيقة التي هي محل إجماع من أهل التربية، تفرض على القيمين على النظام التربوي الأصيل، أن يحددوا شبكة القيم التي تشكل قوامه ومحتواه، بأعلى درجة ممكنة من الدقة، وذلك في ضوء الفلسفة التربوية المتبناة، و لا نجانب الصواب أيضا إذا قلنا بأن النجاح في إرساء المنظومة، يظل رهينا بقسط كبير، بمدى النجاح في ذلك التحديد.
5- بناء مناهج دقيقة ومتكاملة لجميع الشعب والأسلاك، تستجيب في موادها ومضامينها لمقتضيات الفلسفة التربوية الإسلامية، وما رسم في ضوئها من مقاصد وغايات.
إذا كانت القيم تكتسي ذلك الوزن الكبير في بناء المنظومة التربوية وإرساء أسسها، فإن الفضاء الذي تتحرك فيه هو المناهج، التي تشكل الإطار الناظم الكفيل يتنسيقها، من خلال ما ينتقى من عدة معرفية، هي المحتويات والنصوص، ومن خلال الآليات النفسية والديداكتيكية التي تستخدم لبث القيم وتمريرها إلى نفوس المستهدفين. فالإحسان في بناء المناهج التربوية يعد امتحانا آخر في طريق بناء منظومة ناجحة، فبدونه قد لا يكون في القيم المرصودة كبير جدوى، لأننا نكون في هذه الحالة أمام ركام فوضوي، يخرج عما حدد له من أهداف في حالة النظام.
6- بناء طرائق وتقنيات فعالة وأصيلة، تستثمر تراث الأمة التربوي، وتنتفع بأفضل ما توصلت إليه علوم التربية في العصر الحديث، مما زكته وأثبتت نجاعته التجربة.
ليس موقع الطريقة من المنظومة التربوية بالأمر الثانوي أو الهين، بل هو من الأهمية بمكان، إذ إن الطريقة وما يلحق بها من وسائل وتقنيات، على اختلاف أنواعها وأشكالها، تعد ركنا لازما في عملية التبليغ والتواصل التربوي، يتوقف عليها تحقيق الأهداف بقسط هام. والتفاوت بين الطرائق في القيمة رهين بالتفاوت بينها في الوفاء بناط بها من أهداف. ومهما يكن من أمر التنوع فيها فهو تنوع يحقق التكامل والغنى.
ويسهم الاختيار الصائب لأنجع الطرق، أو الاستخدام الأمثل لها في بلوغ العملية التربوية أهدافها، وبنفس القدر يشكل الإخفاق في ذلك، عائقا دونها، أو على الأقل دون درجة الكمال في إدراكها.
والنظام التربوي الأصيل، لا بد أن يربح رهان الطريقة، في إطار سعيه إلى تقديم نموذج أمثل، وذلك باعتماد الطرق والأساليب الموافقة للفطرة، بتجاوبها مع آمال المتعلمين وتطلعاتهم نحو المعرفة والاكتشاف، المراعية لضوابط المعرفة وغاياتها. فلا حجر ولا تسيب، ولا قهر ولا تمييع، ولكن أخذ بالأيدي، في رفق وحكمة، وصبر وأناة، وتفاعل يستثير المكنون من المواهب والطاقات، فما أكثر ما جنت الطرائق والأساليب المسلوكة في التربية والتعليم على الناشئة، فورثتهم أوخم الإعاقات، بمحاصرة تلك الطاقات، وسد منافذها نحو التفتح والانطلاق في رحاب التفكر والإبداع.
لقد انتهت كثير من الدراسات إلى نتائج مؤسفة في هذا الصدد، تتمثل في عقم الطرائق المتبعة في النظم التعليمية في الوطن العربي، جاء في كتاب “السلطوية في التربية العربية”، يزيد عيسى السورطي ما خلاصته أن الطرق المتبعة في المدارس العربية يغلب عليها اللفظية المتمثلة في ترجيح جانب الاستظهار والاسترجاع، وتغييب النقد والتحليل والمناقشة والحوار، والتعليل والتطبيق، والربط والاستنتاج، وغلبة استخدام الطريقة اللفظية القهرية، ليس فقط في تدريس المواد النظرية، ولكن حتى في المواد ذات الطابع العلمي التجريبي، وينقل السورطي قول أحمد صيداوي حول هذه الآفة التربوية: “إن معظم غرف التدريس في بلادنا ساحة للخطب الكلامية، حتى في العلوم الطبيعية، فالمعلم يجنح إلى الإلقاء والتلقين، وحصر مدى التساؤل والنقاش والحوار والنقد، ويميل المتعلم إلى الخضوع والحفظ والاستظهار والاستذكار والأداء الشكلي.“81
من جهة أخرى، ينبغي للنظام التربوي الأصيل، وهو يرسي أسسه وقواعده، أن يستفيد من الأفكار الكبرى التي تفتقت عنها أذهان المفكرين العباقرة، وأذكر هنا فكرة عميقة للمفكر البوسني المسلم علي عزت بيغوفيتش، رحمه الله، هي الفكرة التي يميز فيها بين التدريب والتنشئة، يقول: “إن التدريب لا تأثير له على الموقف الأخلاقي للإنسان. تستطيع أن تدرب جنديا أن يكون خشنا، ماهرا قويا، ولكنك لا تستطيع أن تدربه لكي يكون مخلصا، شريفا متحمسا شجاعا. فهذه جميعا صفات روحية. من المستحيل فرض عقيدة بقرار، أو عن طريق الإرهاب أو الضغط أو القوة. ويستطيع أي مرب أن يعطيك عددا من الأمثلة عن أطفال يقاومون التوجيه الملح، وكيف أنهم ينمون -نتيجة لذلك- اهتماما بسلوك مضاد تماما. ويرجع هذا إلى “الخاصية الإنسانية” للإنسان. فلا يمكن تدريب الإنسان كما يدرب الحيوان.
وهذا القصور في التدريب، والتشكك في أثر التعليم هما البرهان الواضح الصريح، أن الإنسان حيوان قد منح روحا، أعني حرية. ولذلك، فإن كل تنشئة حقيقية، هي في جوهرها تنشئة ذاتية، وهي مناقضة للتدريب، فهدف التنشئة الصحيحة ليس تغيير الإنسان تغييرا مباشرا، حيث إن هذا غير ممكن، وإنما هي تحفز فيه قوى جوانية دافعة من الخبرات، وتحدث قرارا جوانيا لصالح الخير، عن طريق المثل الصالح والنصيحة والمشاهدة، إلى غير ذلك، ولا يمكن تغيير الإنسان بغير هذا الأسلوب. لعل سلوكه قد يتغيرن ولكنه سيكون تغييرا ظاهريا ومؤقتا. ذلك، لأن السلوك الذي لا ينبع من أعماق إرادتنا هو تغيير لا يأتي عن طريق التنشئة، وإنما ينتج عن طريق التدريب. فالتنشئة تنطوي على مساهمتنا وجهدنا، ومن ثم يأتي أثرها مختلفا دائما ولا يمكن التنبؤ به”82
خلاصة الأمر في هذه النقطة المتعلقة بالطرق التربوية، وما يرتبط بها من وسائل وأساليب، أنه لا بد أن تكون ذات فاعلية قصوى، ولن تكون كذلك إلا إذا كانت تنهل من الحكمة، بقيامها على العلم بفطرة الإنسان، وما يرتبط بها من أحوال.
7- بناء طرائق وتقنيات وأساليب للتقويم، تتميز بالمصداقية والفعالية والشمول، وتصب في مجرى تنمية القدرة على الإبداع والابتكار لدى التلاميذ والطلاب.
إن من معالم الحكمة في العملية التعليمية التربوية، أن توضع في ميزان التقويم باستمرار، بحيث يصاحبها عبر لحظاتها وأطوارها، ويتعقبها بعد إنجازها، أي من خلال رصد ما تم اكتسابه وتحصيله، على مستوى مختلف جوانب الشخصية.
وكلما كانت طرائق التقويم على جانب من الفعالية والمصداقية والشمول، آتت أكلها في الارتقاء بالمحصول، على مستوى التنشئة والبناء.
8- تنصيب لجان للتأليف المدرسي تراعى فيها أعلى معايير الخبرة والإتقان:
يعتبر الكتاب المدرسي وسيلة هامة ضمن عملية التعليم والتنشئة، شريطة أن يحاط بعناية فائقة، وذلك بتسخير كل الخبرات النفسية والسوسيولوجية والديداكتيكية والفنية التي انتهى إليها البحث في مجال علوم التربية، ولا يمكن أن يتجرد لمهمة التأليف إلا من يتوفر فيهم القسط الكافي من الخبرة في التخصص العلمي، وفي الإحاطة بالفن التربوي عل حد سواء، إذ لا يجزئ أحد الشرطين عن الآخر. وعلامة نجاح الكتاب المدرسي، أو الكتاب المدرسي الناجح، هي قدرته على أن يكون حافزا للنشاط، شاحذا للذهن، مقدما لمفاتيح الحركة والتفكير، قادحا للوجدان، باعثا لقوى التأمل والبحث والتواصل البناء.
9- إقامة مراكز للتكوين ذات جودة عالية من حيث البرامج والتأطير، ومعايير صارمة من حيث القبول، وشروط التخرج والنجاح.
إن إقامة استراتيجية تربوية محكمة الصنع والبناء، تقتضي أن تكون جميع حلقاتها ومكوناتها خاضعة لهذا الوصف، وإن تسرب الضعف والوهن إلى حلقة واحدة من حلقات السلسلة، أو لبنة من لبنات البناء، كفيل بأن يتسبب في انفراط عقد السلسلة، أو انخرام لبنات البناء بأكمله.
إن مراكز تكوين الفاعلين التربويين على اختلاف فئاتهم وأنواعهم، ينبغي أن يتحرى فيها الصرامة الكاملة أثناء عملية القبول والانتقاء، سواء تعلق الأمر بالولوج أو التخرج، ضمانا للجودة وتحقيق أهداف الخطة المرسومة.
فمن المعلوم، أن التهاون في شرط الصرامة والنزاهة، هو من وراء كثير من الكوارث التي ألمت بمنظومات التربية والتعليم في البلاد العربية. فماذا ينتظر من معلم أو أستاذ واهن العزيمة ضعيف الإيمان، أو ضحل الخبرة والمعرفة؟، وماذا يجني النظام التربوي من مدير مؤسسة فاقد للإحساس بالمسؤولية، مصاب بالغفلة واللامبالاة؟، فما بالك إذا كان مفسدا لاهيا؟ وقس على ذلك كل الأطر من مفتشين ونظار وحراس ومعيدين، وقيمين على الخزانات المدرسية، وما إلى ذلك، فلا ينبغي أن يؤتى صرح المدرسة من واحد من هؤلاء.
10- تعيين لجان مختصة من الخبراء التربويين متعددي التخصصات، تسهر على المتابعة والتطوير، بناء على ما تتمخض عنه المتابعة والتقويم، من تقارير وافية وأمينة.
إن النظام التربوي الأصيل، لن يكون جديرا بصفته على الوجه الكامل، إلا إذا كان قادرا على التجدد المستمر، وعلى مواكبة التطورات الأصيلة المعتبرة، من خلال وعي كامل باحتياجات الأمة، وبما هو مفروض عليها من تحديات وإكراهات، بما يفي بتلك الحاجات، و يستجيب للتحديات، ويزيل الإكراهات.
ومما لا شك فيه، أن مما يؤهل النظام التربوي الأصيل للوفاء بهذه المهمة الاستراتيجية والحيوية، أن ينصب لها لجان متخصصة على قدر كبير من الكفاءة، والإحساس بثقل الأمانة وجسامة المسؤولية، وأن تمكن من كل ما تحتاج إليه من وسائل وإمكانات، وأن تحاسب بصرامة في كل ما تخطوه من خطوات، وما تتوصل إليه من إنجازات.
رابعا: التحديات التي تواجه النظام التربوي الأصيل.
تمهيد:
من الواضح جدا أن إرساء قواعد النظام التربوي الأصيل لن يتم أبدا في جو هادئ من التسليم والإجماع بين جميع الفرقاء، ذلك بأن الواقع المحيط بتجربة من هذا النوع، ينبئ عن تربص بها، أو تشكيك في أمرها، انطلاقا من مستبقات تتعلق بطبيعتها، قائمة على جهل بها، أو عداء مستحكم لها، صادر عن موقف إيديولوجي ليس إلا. وتتخذ هذه المواقف شكل تحديات متعددة الأبعاد، أعرض لها فيما يلي:
1- التحدي السياسي، يتمثل فيما ينصب من إكراهات وطواغيت، تحاول أن تأخذ كل سفينة غصبا.
2- التحدي الثقافي، يعبر عن نفسه في تلوث المناخ الثقافي الذي تتحرك في خضمه دواليب النظام المرتقب الجديد، وما يفرضه من يقظة وحذر وجهد تطهيري استثنائي. وخطورة هذا التحدي قد تكون أبلغ من التحدي السياسي، لأنه إذا تغلغل في ثنايا المجتمع من خلال تصورات خاطئة وقيم مناوئة، سيشكل حائلا دون فهم قيمة النظام التربوي الأصيل، وداعيا إلى الاستهانة بأمره، ومن ثم، الإعراض عنه.
3- التحدي النفسي، يتمثل فيما وقع من جفوة بين الناس، وبين قيم الإسلام، بفعل مكر الليل والنهار، وما نجم عن ذلك من تطبيع مع القيم الليبرالية والحداثية الدخيلة، في ظل علاقة لامتكافئة بين غالب ومغلوب، علاوة على الحرب النفسية المعلنة على الإسلام والمسلمين، تحت ذريعة اتهامه”بالإرهاب” أو التطرف أو العنف.
4- التحدي البنيوي، يتمثل في تجذر واستشراء داء الأمية في بناء الأمة طولا وعرضا، مما يشكل عائقا خطيرا على مستوى انعدام شرط التواصل، وبلوغ الرسالة إلى شرائح الأمة على حد سواء.
5-التحدي العولمي، يتمثل التحدي العولمي )نسبة إلى العولمة(، فيما تسعى قوى العولمة إلى ممارسته من هيمنة وتسلط على المجتمعات البشرية، تحت دعوى كونيتها، وذلك من خلال هدم الحدود الجغرافية والسياسية والسيادية، ومحو خصوصيات المجتمعات الثقافية، لفائدة ما تزعمه توحيدا للعالم فيما يسمى القرية العالمية الواحدة، التي تنتقل فيها البضائع والأشخاص ضمن حركة يطبعها التبادل الحر، وتسودها ثقافة واحدة اسمها “ثقافة السوق“.
وإذا نحن تساءلنا عن موضع التحدي الذي تشهره قوى العولمة بآلياتها المتطورة على التربية بعامة، وعلى النظام التربوي الأصيل بخاصة، ألفيناه متمثلا في السعي المحموم والرهيب من قبل تلك القوى، إلى الاستئثار بالموارد البشرية، لصبغها بصبغة “ثقافة السوق” من خلال تشبعها بقيم محددة، يقول مصطفى محسن فيما يتضمن هذا المعنى: ” إذا كان من بين المهام والوظائف الأساسية للتربية والتكوين، الاستثمار الرشيد للموارد البشرية وتنميتها، فإن الخلفية الاقتصادية لثقافة العولمة في بعدها السوقي، لم تعد تنظر إلى الرأسمال البشري، موضوع العملية الاستثمارية للتربية، سوى في مضمونه الاقتصادي البحت، وقيمته البضاعية والتبادلية، وذلك على حساب أبعاده ومقوماته الثقافية والروحية والحضارية، مما ساهم في إطار هذا المناخ الفكري والاقتصادي، في تبلور منظور قائم على: “تسليع المعرفة وتبعيض البشر”، واعتبار مدخلات ومخرجات عملية التعليم والتكوين مجرد قوى “بشرية: مؤهلة، في أحسن الظروف، تنحصر قيمتها في قوانين العرض والطلب في أسواق الشغل والاستخدام والاندماج الاجتماعي العام”.83 )…( وفق هذا التصور التبسيطي، ستكف المؤسسة التربوية عن أن تظل مرتبطة بوظائفها وأدوارها التقليدية، بل و”رسالتها” التربوية والسوسيوثقافية والأخلاقية المتعلقة مثلا بنشر المعرفة، وبث قيم “المواطنة” وتنشئة المواطن… الخ. وستتحول، استجابة لإكراهات الظرفية، وانسجاما مع منطق وثقافة العصر، إلى ما يشبه المصنع / المقاولة، تعلم وتكون وتنظم برامجها” الاستثمارية” وتعد “منتوجات” تحت الطلب، تماما كما تنتج المؤسسة الصناعية أو الخدماتية منتوجات وخدمات قابلة للترويج والتسويق، وفق الدورة الاقتصادية المتنفذة في المجتمع المعني.”84
والعولمة التي هي تعبير في روحها ومفاهيمها عن “اللبرالية الجديدة” neoliberalisme، تعتمد جهازا مفاهيميا خاصا بها يوظفه في مواجهة الأنساق الأخرى، من قبيل: التنافسية والشراكة والخوصصة والتبادل الحر، والاندماج، والسوق الكونية… إلخ، وما يرتبط بذلك أيضا من مفاهيم مثل: الحوار، والتواصل، والتعاون، واحترام الديمقراطية والاستحقاقية وحقوق الإنسان) الأفراد والجماعات، والأقليات والشعوب، والأمم والمجتمعات(. “وهي قيم ومفاهيم، قد أمست رغم مضمونها الظاهري الإيجابي، مثار جدل فكري وسياسي وحضاري عميق المداولات والأبعاد”.85
وعلى الرغم من كل التحديات التي لا تخلو من شراسة في كثير من الأحيان،، فإن آفاقا واعدة تلوح من بين ثناياها، تعطي لخيار نظام تربوي أصيل، منبثق من مذهبية الإسلام، حظوظا أكيدة في التخلق والنجاح، ينبئ عن ذلك وعي86 حاد بالأزمة والإفلاس، يكاد يشكل تيارا عاما في أوساط الأمة، واقتناع كامل بمردهما إلى الأنماط الدخيلة، والنظم الثقافية والتربوية الغريبة التي فرضت قسرا على شعوب الأمة المسلمة، فكانت وراء كل ما أصابها من عقم ووهن وذهاب ريح، بل إن مما يدعم ذلك التيار، ما أصبح يسري في العالم الغربي، وخاصة عند فئة هامة من نخبه الفكرية الممتازة، من إدانة لمنظومة القيم السائدة فيه، واعتبارها مسؤولة عن الانتكاس الرهيب، على مستوى الأخلاق والاقتصاد والاجتماع. وما أمر الانهيار المالي الذي هز قلب النظام الرأسمالي عنا ببعيد، فقد أورث قادته هما ونكدا، فراحوا يولولون ويقلبون أكفهم على ما أنفقوه لإدارة آلته الجائحة، وتغذية طاحونته الهوجاء. أما عقلاء القوم، فقد بلغ الاعتبار ببعضهم درجة الدعوة بصوت جهير، إلى تحكيم مبادئ الاقتصاد الإسلامي، كمخرج من الأزمة الخانقة، التي التفت كثعبان هائل حول عنق اقتصاد مغشوش ومجتمع منخور.
إنه على الرغم من تهيؤ الشروط والأسباب على كل صعيد، لإرساء النظام التربوي البديل الذي يبشر به هذا المشروع الكبير، فإن تنزيله في واقع الناس، يحتاج إلى نفس طويل وجهد جهيد وعزم لا يلين، يحمله أولو الهمم، ممن حملوا على عاتقهم هم انعتاق هذه الأمة من ربقة التبعية، وخروجها من التيه، ومعانقتها لسيادتها الضائعة، فعسى أن يكون رواد هذا المشروع المبارك، بإذن الله، طليعة هذا الفتح المبين، الذي ينبغي أن يساهم فيه كل الشرفاء الصادقين المخلصين، ممن يرعون الأمانة ويرجون وجه الله العزيز الحكيم.
خامسا: كيفية التعاطي مع التحديات:
أعتقد أن أول شرط لنجاح التعاطي مع التحديات السالفة الذكر، هو الشعور بالثقة في مشروع الإحياء، على أساس الاعتزاز بما يملكه من منابع القدرة وخصائص التفوق والقوة والصمود، والاقتناع بالمقابل، بتهافت الأنظمة القائمة على مستوى هياكلها أو أبنيتها العامة، مع استثناء، ما تحتوي عليه من القطع والأجزاء الصالحة في ذاتها، مما يمكن الاستفادة منه بإخضاعه لروح النظام الأصيل.
ويتمثل الشرط الثاني، في مراعاة الخصائص التي يتصف بها النظام الأصيل، فيتم التعاطي مع التحديات، مع استحضار الربانية والثبات، والتوحيد والواقعية والشمول والإيجابية والتوازن، أي يكون أسلوب المواجهة والتعاطي حاملا صبغة تلك الخصائص، مبتعدا عن التسرع والاستعجال في تحقيق النتائج وقطف الثمار، فكل شيء بأجله وإبانه.
ويتمثل الشرط الثالث في بناء جبهة واسعة عريضة، من الذين يتبنون اختيار الإحياء، ويعملون بدأب وإصرار، على تنفيذ مشروعهم، مع توخي الإحسان في التطبيق، والابتكار في الأساليب، لتقديم النموذج المقنع الذي يملك الجاذبية، ويفرض نفسه رقما صعبا في الميدان.
ويتمثل الشرط الرابع في مراعاة طبيعة كل تحد من التحديات، باختيار ما يناسبه من الوسائل والأدوات، كأن يتخذ للتحدي السياسي، وسيلة الإقناع والحوار، لطمأنة أصحاب القرار بجدوى إقرار النظام التربوي الأصيل، على كل المستويات: العلمي والأمني والتنموي، وما إلى ذلك، مع تعزيز ذلك المسعى بالحجج والشواهد المدعمة بالأرقام وخلاصة الدراسات في المجال التربوي التعليمي، والمجال النفسي والاجتماعي، من زاوية علاقة كل منهما بنوعية التعليم، وطبيعة المنظومة القيمية السائدة فيه.
ويتخذ للتحدي الثقافي، الإسهام الفعال في إقامة جبهة عريضة للعمل الثقافي الأصيل، لترسيخ “ثقافة الجمع”87 وتوسيع نطاق مفاهيمها، ومطاردة “ثقافة الجدع”88 وتسفيه قيمها ونماذجه الهابطة، واتخاذ، من أجل ذلك، مختلف الوسائل والقنوات، للتغلغل في مساحات الشعب ومحافله، والنفاذ إلى مواقع الصياغة والتأثير.
وهذا المسلك يعطي أكله حتى بالنسبة لمواجهة التحدي النفسي، بإعادة الثقة للناس من خلال تحسيسهم بأهمية النظام التربوي الأصيل، وإزالة الجفاء والتخوف من أنفسهم تجاه النظام، وحل عقدتهم إزاءه.
ويتخذ للتحدي البنيوي مدخل محو الأمية الذي يمكن لدعاة النظام الأصيل، أن يسهموا فيه بفعالية، من خلال صيغ مبتكرة تعتمد المدخل الإدماجي الذي يمزج الثقافة الأصيلة بتعليم المفاتيح ) الحروف والجمل(.
أما التحدي العولمي فيمكن إبطال سحره وكشف دعواه، بالبرهنة على بطلان ادعائه للكونية، وأن ما يزعمه كونيا من القيم والمذاهب والأفكار، لا يعدو أن يكون مزيجا من الأوهام، ومن الرغبات الشوفينية، ألبست مسوح الحقيقة، ووشحت بوشاح الزعامة والسيادة بغير استحقاق، فالأمر يتعلق بكل بساطة بصولة ليبرالية منفلتة الزمام، متأهبة للنهش والافتراس، ولأن تدوس بحوافرها الأخضر واليابس، تحت لافتة إقرار هيبة النظام.
سادسا: الأحوال الراهنة المساعدة على إرساء دعائم النظام التربوي الأصيل:
إن كل الأحوال السائدة على المستوى العالمي، تشكل بيئة ملائمة لإرساء دعائم النظام التربوي الأصيل:
فأزمة القيم ضاربة أطنابها على كل صعيد، والنظم السياسية أضحت معاقل للبطش والطغيان، بسبب غلبة الطمع والأنانية والاستئثار، والغطرسة والاستكبار.
والفطرة الإنسانية راحت تتعرض لتشوهات رهيبة، بسبب تهميش أحكام الدين، وإلغائها من الحساب، وإطلاق العنان للشهوات والأهواء.
وإشعال الحروب المدمرة أضحى هو القاعدة، بينما يراد بالسلم أن يشكل الاستثناء، وأصبح النظام الاقتصادي قائما على الشطارة واستفراغ الوسع في اجتراح المكايد والحيل، لأكل أموال الناس بالباطل.
أما النظم التعليمية فقد باتت هياكل بغير روح، وأصبحت آلة خرقاء، لا تخرج في غالب أحوالها إلا أجيالا مفرغة من الروح، مفتقرة إلى مكارم الأخلاق، متحفزة للشر في كل وقت وحين.
وقس على ذلك كل الأحوال في كل ميدان. أفلا يكون للنظام التربوي الأصيل فرصة للعمل والنجاح في إعادة الإعمار، وسط هذا الحطام والدمار؟، فليست اللافتات التي يحملها “النظام”، أو بالأحرى الفوضى العالمية المسماة بالنظام، إلا أغطية زائفة، لا تستر إطلاقا عوراته التي غدت مكشوفة للعيان.
إننا نزعم للنظام التربوي الأصيل، بفضل فلسفته التربوية البديلة الرائدة، وخصائصه التي تم بيانها في خضم هذا البحث المتواضع، وبفضل ما يمكن أن يجند حوله من دوائر، أن يؤدي دور المنقذ من الضلال.
– آليات استثمار الظروف المواتية للإرساء:
كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: “كان الناس يسألون رسول الله r عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني”.
في ضوء هذا الحديث، يمكن أن نرسم معالم استراتيجية للاستثمار المشار إليه، يكون من مكوناتها رصد البلايا والشرور التي ألمت بالبشرية التائهة، وفي طليعتها الغرب الذي يزعم التقدم، ويرفع لافتة الحداثة عاليا، بكل تبجح واستكبار، وفي طليعة هذا الغرب أمريكا التي تقود ركب التائهين المتغطرسين.
وبالقيام بذلك الرصد، بطريقة ممنهجة قائمة على جمع الأشباه والنظائر، وترتيب الكوارث والآفات التي أفرزتها أنظمة شاردة طبقت في كل الميادين، مع تعزيز ذلك بالإحصائيات والأمثلة، يمكن أن نقيم الحجة على إفلاس “الفوضى العالمية” التي سميت زورا وادعاء بالنظام، ونزيد الناس استعدادا للاقتناع بحقيقة ذلك الإفلاس، وقابلية لتجاوزه.
وفي سياق التشخيص العام للإفلاس المستحكم، يفرد باب خاص بتشخيص النظم التعليمية التربوية في العالم، مع بيان الخسائر الفادحة التي حاقت وتحيق بالناس، جراء انتشارها. ويمكن أن يندرج في هذا الباب على سبيل المثال، ما قدمه ماجد عرسان الكيلاني في الفصل الثاني من كتابه” مناهج التربية الإسلامية والمربون العاملون فيها“، تحت عنوان: “أزمة التربية المعاصرة في ميدان المناهج التربوية“89.
وتتمثل الخطوة الأساسية الأخرى في عرض النظام التربوي الأصيل على الناس، باعتباره بديلا وطريقا للخلاص مما أورثتهم إياه الأنظمة الأخرى من كوارث وأزمات، مع توخي بيان حقيقته وعمقه الفلسفي ونبل مقاصده، وخصوبة ما يعد به من عطاء.
ويشفع ذلك بإعطاء النماذج التقريبية من التاريخ الإسلامي الذي شهد بعض تجاربه.
خلاصة البحث90:
أولا: الخصائص والسمات الفذة الفعالة للأصول، أو الأفكار، أو الممارسات التربوية الأصيلة التي كشف عنها البحث؟
ليست الخصائص التي كشف عنها البحث في هذا الصدد سوى خصائص التصور الإسلامي التي تفرض استلهامها وتمثلها وترجمتها في أي مستوى من مستويات الفكر أو التطبيق على حد سواء، من ربانية وتوحيد وثبات وشمول وواقعية وإيجابية وتوازن، وعالمية وما إلى ذلك، ويبقى الجديد المتوخى كامنا في نوعية التعاطي مع تلك الخصائص والسمات، ورهينا في مدى عمقه بمدى وعمق الفهم و مقدار التمثل لما تحمله تلك الخصائص والسمات من أبعاد وإمكانات وأسرار وتوجيهات.
لقد توصل البحث في سياق تلمس الأسس والأصول التي ينبني عليها نظام يوسم بالأصالة، إلى أن هذه الأصول تتمتع من جهة بالصرامة والضبط، ومن جهة أخرى بالمرونة والانفتاح الموزون، مما يتيح لها دوما أن تكون في مستوى القدرة الفائقة على استيعاب كل ما هو إيجابي وفعال، في مجال الفعل التربوي، لا على أساس النقل والاقتباس، ولكن على أساس ما يتيحه طابع الكلية والشمول فيها من الإحاطة بكل ما يتفتق عنه عقل الإنسان في علاقته مع الكون والمجتمع، من أفكار وتصورات، وصيغ ووسائل، للتعامل معهما واستثمار ما يختزنانه من ذخائر وكنوز، وما ينطويان عليه من قوانين وسنن، وتلك حكمة الله عز وجل في إقدار الإنسان على مواكبة ما يجري في الكون من تطورات، وما يجد فيه من تحولات من جهة، وعلى ضبط كل ذلك وفق منظومة القيم والأحكام التي جاء بها الشرع الحكيم.
ثانيا: الكيفيات المتصورة لتنزيل كل خاصية من تلك الخصائص على أرض الواقع بجوانب النموذج التطبيقي المنشود للمشروع (سياسات وأهدافا ومناهج وتدريسا وتقويما وقيادة وعلاقات مع المحيط.)؟
تتمثل أولى الصيغ والكيفيات لتنزيل الخصائص النظرية على أرض الواقع، والتي تمثل شرط صحة في هذا المقام، في فهم واقع التنزيل بأبعاده النفسية والاجتماعية والثقافية والحضارية التي تكتنف النموذج التطبيقي بكل مكوناته وأركانه، وبكل مراحله وأطواره. ذلك بأن أي إخلال بهذا الشرط بنسبة من النسب، يترتب عنه لا محالة انحراف عن الهدف المنشود، وزيغ عن المقاصد الكبرى لذلك النموذج.
فخاصية الربانية على سبيل المثال، يتم تنزيلها على النموذج التطبيقي في جميع مفرداته، من خلال الحرص الشديد، واليقظة الدائمة، لئلا يتسرب أدنى عنصر دخيل إلى نسيج تلك المفردات، فيكدر صفوها، كأن يتسرب إليها مفهوم أو فكرة أو أسلوب، أو غير ذلك، مما يتجافى مع حقيقة التصور الإسلامي، فيكون ذلك إخلالا بصفة الأصالة التي هي سمة المشروع وجوهره، على اعتبار أن المرتكز الأساس لتلك الأصالة، إنما هو القرآن والسنة، وما يرتبط بهما من أصول معتبرة.
وينسحب هذا الحكم بجميع مقتضياته على كل مكونات النموذج، من أهداف ومناهج، وتدريس، وتقويم وقيادة وعلاقة مع المحيط، وما إلى ذلك.
فالأهداف المرصودة للنموذج، أو لبعض مراحله أو مستوياته، لا بد أن تكون خاضعة لمقتضيات الربانية، غير خارجة عنها، ولو في أقل القليل، لأنها بطبيعتها تتأبى على أي دخيل. فلا يستساغ في عرف الربانية أن تجمع أهداف النموذج التطبيقي للمشروع، في أي تجل من تجلياته، بين ما هو واضح في دلالته عن الربانية، كإلحاق الرحمة بالناس كافة وإرساء أسس مجتمع إنساني يسوده العدل والسلام، وبين ما تشوبه النعرات الضيقة والنزعات التسلطية إلى استعباد الناس، وإخضاعهم لمنطق البطش والطغيان.
ولا يستساغ في المناهج المعتمدة في النظام التربوي الأصيل، أن تخترق منظومة القيم الربانية السارية فيها من قبل قيم تنتمي إلى “منظومات” بشرية، والحال أنها موسومة بالعجز والقصور، من قبيل ما يطلق عليه القيم الكونية، وما هي بالكونية في شيء، أو حقوق الإنسان بمفهومها الشائه، لأنها محض إفراز للتخرصات والأهواء.
كما لا يسوغ في عرف النظام التربوي الأصيل، أن يكون في هيئة مدرسيه خاصة، ولا في مختلف القيمين عليه عامة، من يشكل نشازا عن تصوراته واختياراته، كأن يكون حاملا لأفكار حداثية، ومبشرا بنموذج حضاري مخالف لما يبشر به النظام التربوي الأصيل، فهذا إن حصل، يكون بمثابة نقض الغزل الذي نهى عنه الله جل جلاله في كتابه العزيز بقوله: {ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا} (النحل: 92)
وإذا نحن تناولنا خاصية الثبات باعتبارها إحدى الخصائص التي ينبغي تنزيلها على النموذج التطبيقي للنظام التربوي الأصيل، وجدنا ذلك التنزيل يتجلى من خلال ثبات القيم التي تضطلع المنظومة ببثها في نفوس الأجيال، فلا مجال للانسياق على ذلك الأساس، مع الموجات الفكرية السائبة الساعية إلى النيل من القيم الأصيلة، بتغيير مفاهيم بعضها وطمس البعض الآخر وإقصائه من خارطة القيم، لصالح قيم أخرى مختلقة، مناقضة لها تماما.
وقبل ذلك ينبغي أن تحذر منظومة التصورات والقيم التي ينبني عليها النظام التربوي الأصيل مما يمكن أن تستدرج إليه من تقديم تنازلات في حق مفهوم الإنسان، مما ينجر عنه انقلاب خطير في أسلوب التعامل معه، ومن ثم في مسار المنظومة التربوية برمتها، فشتان بين النظر بموجب التصور الإسلامي للإنسان باعتباره كائنا مكرما مستخلفا في الأرض، مجبولا من نفخة من روح الله وقبضة من طين الأرض، ضمن نسيج عجيب يحقق مراد الله في الكون، وبين النظر إليه على أنه كائن تترجح فيه التطلعات المادية والصبغة الحيوانية.
ويسلمنا هذا إلى الحديث عن تنزيل خاصية أخرى هي خاصية الشمول، فلا معنى لمنظومة تربوية تدعي الأصالة، تبرز في بنائها لشخصيات المتعلمين، أبعادا وجوانب على حساب الأخرى، كأن تهتم بالجانب الروحي الوجداني على حساب الجانب الجسدي والمهاري، أو تهتم بالجانب الدنيوي على حساب الجانب الأخروي، أو بالجانب الفردي على الجانب الجماعي، أو بالجانب الفكري النظري على حساب الجانب العملي، فأصالة النظام التربوي تقتضي الجمع بين كل الجوانب والأبعاد، في كيان منسجم متلاحم، تنفتح أمامه آفاق واسعة للارتقاء والنماء، والإبداع والعطاء، في ظل رؤية عقدية سليمة، تغذي ذلك الكيان، وتحفزه نحو الخير والصلاح، ومعالي الأمور.
وتنزيل خاصية التوازن على النموذج التطبيقي يمكن أن تتم من خلال مظاهر شتى، منها تحقيق التوازن بين التعمق في الجانب العلمي الأكاديمي من جهة، والجانب التقني واليدوي من جهة أخرى، على مستوى برامج التربية والتكوين، وتحقيق التوازن بين تنمية ملكة الحفظ وملكات النقد والتفكير والمناقشة والحوار، وإقامة التوازن على مستوى التقويم بين الجوانب المذكورة، وبين الجانب المعرفي والوجداني والمهاري، بما يؤمن عدم التضخم في جوانب، والضمور في أخرى، فذلك هو مناط بناء الشخصية المتوازنة التي ينشدها النظام التربوي الأصيل.
وتتنزل العالمية في النظام التربوي الأصيل المنشود، من خلال التجاوب مع نداء الفطرة وصوت الحق، واحترام سنن الله عز وجل، وعرض دين الإسلام على الناس في صورة بهية مشرقة، وتقريبه إلى الأفهام بيسر وحكمة، من خلال الحجة العقلية والدليل العملي والإسوة الحسنة التي تفتح الطريق لاعتناق القيم السامية، كالصدق والإخلاص، والرحمة والنجدة، وحمل الكل وإغاثة الملهوف، والصبر وكظم الغيظ، والشجاعة والإباء، والسماحة والسخاء، والتعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مفهومهما الشامل، بما يضمن طهارة العالم من سيطرة الظغائن و الأحقاد، وتفشي الفساد والطغيان. ويتمحور كل هذا السعي، حول مفهوم وحدة الأصل والخلق، ووحدة المصير التي يقوم عليها الإسلام، وتفرض الارتباط بين الشعوب والقبائل بوشيجة التعارف، والاجتماع على كلمة سواء.
أما الإيجابية فتتنزل من خلال حقن البرامج والمناهج بروح الرسالية وما يؤدي إلى استشعار أمانة الاستخلاف، وغرس الفسيلة في كل وقت وحين، والتحلي بروح المبادرة، والحيلولة دون تسرب كل ما يؤدي إلى السقوط في شرك الهزيمة واليأس، ويرصد لهذه المهمة التربوية ما يزخر به القرآن الكريم والسنة الشريفة والسيرة العطرة، من توجيهات وقيم ومشاهد، وما يحفظه التاريخ من صور البطولة والبلاء الحسن، لأجيال من الرجال والنساء، من الأئمة الأعلام، الذين صنعهم الإسلام على عينه، وتربوا في مدرسته، فكانوا منارات للهدى ومفاتيح للخير ومغاليق للشر.
ويؤطر كل هاتيك الخصائص على مستوى التنزيل، خاصية التوحيد بنوعيه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، واللذين يثمر تغلغلهما في نفوس الناشئة الولاء واليقين، في القوة الكبرى التي تمسك بيدها مقاليد الكون وتصرفه كيف تشاء، على أساس الحكمة والعدل، كما يثمر الاستعداد التام لدى العباد، للخضوع والانقياد لرب العباد، والقابلية القصوى لتصحيح السير المستمر على الله، وحمايته من كل الشوائب والأكدار.
وإن الذي يؤمن التنزيل الصحيح والسليم لكل تلك الخصائص جميعا، توفير قيادة إدارية وتربوية رشيدة، تسهر بحرص وأمانة على التنفيذ المحكم لما هو مرصود من أهداف، مسخرة في سبيل ذلك كل الوسائل والتقنيات، ومناهج الرصد والتقويم المعتبرة، وتستثمر حصيلة ذلك التقويم، كتغذية راجعة للتحسين المستمر.
ثالثا: مدى مساهمة الخصائص وكيفيات تنزيلها في تحقيق غايات المشروع وأهدافه الكبرى.
أرى -والله أعلم- أن هذه الخصائص، شريطة الإحسان في تنزيلها على الواقع التربوي، ستساهم مساهمة مقدرة في تحقيق الأهداف الكبرى للمشروع، وأبرهن على ذلك فيما يلي:
إن الانعتاق والتحرر لا يتأتى تحقيقهما على الوجه الأكمل في أمة من الأمم عامة، والأمة المسلمة خاصة، إلا عبر فعل تربوي جاد وناجع، أي مستوف لشروط الفعالية كافة، والمدخل الأساس في ذلك الفعل التربوي، إنما هو مدخل العقيدة، والعقيدة في الموضوع الذي نحن بصدده، لها صبغة خاصة تميزها عن سائر العقائد، هي كونها مبرأة من كل تحريف أو تبديل، وموسومة بالصحة والصلاحية لكل زمان ومكان، ومرتبطة بمنظومة من القيم معبرة عن الفطرة والحق، ومن ثم فإن النظام الذي تشكل بالنسبة إليه أساس فلسفته التربوية، لا بد أن يوتي أكله بإذن ربه، ما دام تمثلها والتخلق بها كاملا والتطبيق لها مستوفيا للشروط. وقولة ربعي بن عامر رضي الله عنه تعتبر بيانا خالدا في هذا الباب،: “لقد ابتعثنا الله عز وجل لنخرج من شاء من عبادة غير الله على عبادة الواحد القهار، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا على سعة الدنيا والآخرة“.
والتربية الشاملة المنشودة في النظام التربوي المنشود، لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل الإسلام الذي يعبر منظوره عن الفطرة بجميع أبعادها وأسرارها، ويحرص على إشباعها وتنميتها على أساس من التوازن والتكامل. وهذا الشمول في تناول الكيان البشري وبنائه وتشكيله، هو السر من وراء العطاء الحضاري الخصب الذي وهبته حضارة الإسلام للإنسانية على مر العصور. ولكي يكتسب تجسيد هذا الشمول نجاعته في العصر الراهن، لا بد من تسخير ما تحقق نضجه من الدراسات النفسية والتربوية، وما ثبتت صلاحيته وصدقه من التجارب والطرائق والتقنيات.
ومن البدهي، أن تفعيل الهوية الحضارية للأجيال الصاعدة على أساس قيمنا الحضارية وتنمية الروح الرسالية لديهم، يمثل ثمرة طبيعية لتمثل جميع الخصائص والسمات التي سبق تناولها بالتحليل والبيان، وهل الهوية إلا قيم الدين في علاقتها الحميمة الوثيقة بكيان الإنسان المسلم ووجود الأمة المسلمة ذات الرسالة المقدسة المتمثلة في الشهادة على الناس؟
وهل إنتاج قادة مؤثرين وقدوات حسنة للأجيال، وإعداد مربين فاعلين وموقرين إلا نتاج طيب لبيئة تربوية ومحاضن ثقافية تتغذى على قيم الإسلام؟، وأنظمة تربوية تلتقي مهما تنوعت أشكالها ونماذجها، حول قاسم مشترك، هو الولاء للدين، وتحقيق مقاصده، في إطار من الوسطية التي تجسد الرحمة، وتنشد القوة التي تحمي كرامة الإنسان؟.
أما العلماء النابغون المبدعون، فإن تجربة النظام التربوي الأصيل عبر العالم الإسلامي إبان ازدهاره الحضاري، تثبت لنا أن منابت العبقرية والنبوغ والإبداع، قد وجدت تربتها الخصبة في هدي القرآن والسنة والسيرة، والتعاطي العميق مع ما تنطوي عليه من بصائر وتوجيهات، وما نبهت عليه العقول من قضايا وإشكالات.
وهذا يسلمنا إلى قضية إثراء حقول العلم والفكر بمستوى عالمي، لنقول بكل ثقة واطمئنان: إن كل العلوم في حضارة الإسلام قد خرجت من بين ثنايا تعاليم القرآن وتوجيهاته وبصائره، وهذه الحقيقة الدامغة الناصعة، تقتضي منا ونحن نؤسس لنظام تربوي أصيل منشود، أن نبحث عن الصيغ المثلى لربط الاتصال بين القرآن وبين الأجيال، وفي غياب هذا المسعى، لن نصل إلى طائل فيما نصبو إليه.
رابعا: مدى فعالية الخصائص وكيفيات تنزيلها في السياق الحضاري المعاصر.
إن السياق الحضاري المعاصر، هو سياق تدافع وصراع كما تنطق بذلك السنة العامة التي تجري بموجبها العلاقة بين قوى العالم وتكتلاته، وهو في ذات الوقت سياق ابتلاء المجتمع البشري بنزوع طاغ للتحكم في مصيره واستعباده وسلب إرادته، تحمله قوى غاشمة متعطشة للبطش والافتراس، في ظل غياب جبهة متماسكة تمارس عملية الردع لذلك الوحش الذي يحمل لافتة العولمة، إذ إن الموجود على الساحة من قوى الممانعة لا يعدو أن يكون مجرد أصوات خافتة لا تكاد تسمع، أو تيار باهت رغم تناميه البطيء، فهو لا يكاد يوقف تيار العولمة الهادر الذي يأتي على الأخضر واليابس.
ومن ثم فإن الخصائص الكبرى التي يتسم بها النظام التربوي الأصيل، منزلة أحسن تنزيل، أو لنقل إن النظام التربوي الأصيل الذي يبشر به المشروع، قادر بفضل ما يتمتع به من تلك الخصائص التي ذكرنا بعض معالمها، أن يمارس وظائفه وأدواره بفعالية كاملة، لأنه يحمل على عاتقه أمانة تصحيح الأوضاع المنحرفة، وبعث روح الثقة في الناس، وإقناعهم بإمكانية الإصلاح عن طريق تصحيح المفاهيم، والتكتل حول قيم الحق والخير والجمال، في حركة ثابتة تنشد السلم والأمن والعدل، وإحقاق الحق، وإزهاق الباطل، لانتشال الإنسانية المعذبة مما هي فيه من عذاب وعناء.
إننا نستطيع أن نقول بكل اطمئنان، بأن النظام الأصيل بما يحمله من خصائص، إذا استفرغ الوسع في توفير العدة الكافية من برامج محكمة الصنعة والبناء، ومدرسين مخلصين أكفاء، يجمعون بين عمق العلم وحسن الأداء، قادر بإذن العلي الأعلى الوهاب، أن يزحزح البشرية عما هي فيه من أوضاع مشينة مهينة، وأن يفتح أمامها بابا واسعا للأمل في التحرر والانعتاق واسترجاع الكرامة الضائعة، فالتربية هي السر المكنون الذي به تفتح المغاليق، شريطة الإحسان وتأمين الأجواء الصالحة للإنبات، وإبعاد المشوشات والمنغصات.
خامسا: المعوقات والتحديات التي يمكن أن تحول دون تنزيل فعال للخصائص المعلومة في النموذج التطبيقي المنشود للمشروع، وسبل قهر تلك المعوقات.
1- العقبات والتحديات
المعوقات والتحديات المتربصة بالنظام الأصيل الدوائر عديدة ومتنوعة تنوع العوائق والتحديات التي تعترض طريق الإسلام، وفيما يلي استعراض لبعض تلك التحديات:
أ- تخذيل المخذلين:
إن هناك طوائف في العالم العربي والإسلامي، نظرا لانبتاتها واغترابها عن أصولها نتيجة ظروف استلابية كالحة، تسعى باستماتة، وبجميع ما أتيح لها من الوسائل والحيل، أن تحيط أي مشروع لنظام تربوي ينشد الأصالة والاستقلال، بالأراجيف والأباطيل، كأن تدعي بأن نظاما من ذلك القبيل، نظام يحمل بذور الإرهاب، ويعد مشاريع إرهابيين، بغض النظر عن سلامة ودقة مفهومهم للإرهاب، فتشن عليه حربا ضروسا عبر وسائل الإعلام، بجميع أنواعها، لتحول دون قيامه، علما منها أنه إذا تم له القيام، سيبرهن عن نجاحه المبهر، وسيحصن الناس ضد الإرهاب الحقيقي، ويعيد تأسيس الرابطة الإنسانية على دعائم الحق وصيانة كرامة الإنسان.
ب- قوى العولمة والاستعمار:
تمثل قوى العولمة أعتى التحديات في وجه التنزيل الفعال لخصائص الأصول والأفكار والممارسات التربوية الأصيلة، لأنها – أي قوى العولمة – لا تدخر وسعا في نصب جميع العراقيل أمام استتباب أي نظام فيه رائحة الأصالة ويحمل أدنى خصائصها كما دلت التجارب91 المريرة على ذلك، فما بالك إذا تعلق الأمر بنظام أصيل يستوفي جميع الشروط بتنزيل مجمل خصائص ومقومات التصور الإسلامي فيه، إذن تقوم قيامتها، لأن الأصل فيها أن لا تسمح بظهور إي نموذج مخالف للنموذج الغربي في الفكر والسلوك، لأنها ترى فيه منافسا حقيقيا يهددها بسحب البساط من تحت قدميها، والظهور عليها، بل وتقويض دعائمها والتعفية عليها بفعل جاذبيته وقوة منطقه وكمال بنائه.
ج- أخطاء الفهم والتنزيل:
إذا كان التحديان الأول والثاني يتربصان بالنظام التربوي الأصيل من خارج الذات، فإن هذا التحدي الثالث ذو صبغة داخلية، لأنه ينبع من داخل الذات، فقد يكتسي هذا العائق صبغة السطحية في فهم مضمون الخصائص المراد تنزيلها، فينجم عن ذلك سلسلة من الأخطاء والتجاوزات التي تطول كل مفردات النظام وعملياته على مستوى التطبيق.
وقد يكتسي صبغة الخطأ في إسناد مهام التنظير أو التطبيق لطائفة ممن يفتقدون للاستيعاب الكامل لطبيعة النظام الأصيل، رؤية ومنطلقات وأهدافا، ووسائل وطرائق وتقنيات، فضلا عن افتقادهم لفهم واقع التنزيل، أو الواقع العالمي بخصائصه وأزماته واحتياجاته، فهم لأجل ذلك، يكونون غير مؤهلين لشغل أي موقع في النظام، سواء كان موقع إشراف أو تطبيق، وهذا الخطأ إن وقع، ستترتب عنه عواقب وخيمة على النظام، تتمثل فيما يلحقه من تشويه وتحريف، يتخذه أعداء النظام الصرحاء، ذريعة للطعن فيه والتحذير من الإقبال عليه وزعزعة ثقة الناس فيه.
2- سبل قهر المعوقات:
إجمالا يمكن القول: إن التصدي للعقبات والتحديات، يفترض التحلي بالحكمة واليقظة اللتين تمكنان من تفويت الفرصة على المندسين والمتآمرين، سواء في الداخل والخارج.
ومن الصيغ العملية لمواجهة التحديات الخارجية، اتباع أسلوب التدرج والمرحلية في التنزيل، مع توخي الإحكام والإتقان في كل الإجراءات والخطوات، والعمل بموازاة ذلك على التعريف بالتجربة وإظهار محاسنها، بالحجة والمثال، لكسب الأنصار الذين يدعون لها ويقفون في صفها، وأن يوظف في سبيل ذلك الإعلام بجميع أشكاله.
يضاف إلى ذلك توسيع نطاق الدراسات التي تظهر فشل الأنظمة القائمة، وتبرز عقمها وتأزمها، وإخفاقها في تحقيق أهدافها المنشودة، بل وتظهر خطورتها على مصير الأفراد والمجتمعات، على المستوى النفسي والثقافي والاجتماعي والإنساني والحضاري.
ومن وسائل تأمين أسباب النجاح وتجنب عوامل التعثر والإخفاق، البحث عن الأقوياء الأمناء الذين يرعون تطبيق النموذج، ويتابعونه خطوة خطوة، ممارسة وتقويما وتحسينا وإشرافا، والحذر كل الحذر من أن يتسرب إلى المشروع، أو يدعى إلى المشاركة فيه، عناصر قد لا تزيده إلا خبالا، لعدم حمل همه بإخلاص، أو عدم التأهل من حيث الرؤية والقناعات الفكرية للدخول في نسقه الشامل.
سادسا: جوانب التضارب والتلاقي، وجوانب التميز بين خصائص الأصول، أو الأفكار، أو الممارسات التربوية الأصيلة، وبين خصائص الممارسات التربوية القائمة في نظم الدول المتقدمة، وصور وأوجه الاستفادة من جوانب التضارب والتلاقي والتميز، في استجلاء القيمة المضافة التي سيحققها -بمشيئة الله تعالى- النظام التربوي المنشود للمشروع على معطيات الفكر التربوي الحديث.
1- جوانب التضارب والتضاد:
إن أبرز جانب من جوانب التضارب بين النظامين، يتجلى في الجانب المتعلق بالرؤية العقدية، وبنظرة كل منهما للكون والحياة والإنسان، فهما على طرفي نقيض في هذا المقام، فشتان بين رؤية قائمة على الربانية والثبات والشمول والتوازن والواقعية والإيجابية و التوحيد، ورؤية تخلو من الاتساق واليقين، لخلوها من الخصائص السابقة، واتكائها على الأهواء المعبر عنها من خلال لبيرالية جامحة، تستند إلى مفهوم للحرية مغلوط.
وشتان بين نظام، الهدف والوسيلة فيه سيان، من حيث التزامهما بنبل القصد وصدق النية وخلوصها، وبين نظام، الغاية فيه تبرر الوسيلة، وهو ما يعرف بالميكيافلية، نسبة إلى مكيافل الإيطالي صاحب كتاب “الأمير“.
وشتان بين نظام يتحد فيه العلم مع الدين، وتؤطر فيه الشريعة المجتمع، وتنبني فيه علوم الإنسان، على شريعة الرحمن، وتعتبر الدنيا مزرعة للآخرة، وبين نظام يعصف فيه الفصام النكد بين العلم والدين، وبين الدين والمجتمع، وبين الدنيا والآخرة، وبين الفرد والجماعة.
وما أوسع الشقة بين نظام تربوي تتسم فيه القيم بالخلود، ويؤمن بالحركة والتطور في إطار الثبات، وتتمحور فيه القيم حول قيمة مركزية عليا منها الانطلاق وإليها الإياب، وبين نظام لا تستقر فيه القيم على حال، وتبدل جلدها بتغير الأحوال، لأنها تفتقد للجوهر الناظم الذي تلتف حوله، وتستمد منه مسوغات الفعل بعد الوجود.
2- جوانب التلاقي والاتفاق:
جوانب التلاقي والاتفاق بين خصائص النظام الأصيل، وخصائص الممارسات التربوية القائمة في النظم المتقدمة، تتمثل بصفة عامة في ما يعتمد من وسائل وتقنيات، وما تسفر عنه البحوث في المراكز والمختبرات، من نتائج تتعلق بعلوم التربية، من علم النفس وعلم الاجتماع، وعلم النفس الاجتماعي وعلم التدريس، (الديداكتيك)، شريطة تكييفها مع روح الفلسفة التربوية التي يقوم عليها النظام التربوي الأصيل.
3- جوانب التميز:
تستشف جوانب التميز من جوانب التضارب، وعلى الإجمال، فإن جوهر تميز خصائص النظام التربوي الأصيل هو طابعها الرباني الغيبي، وطابعها الواقعي الملائم للفطرة، الملبي لأشواقها، على أساس التوازن بين مطالب الروح ومطالب الجسد، في مزيج يشرف عليه سلطان العقل والحكمة، وينزع فيه الكيان الكلي نحو التسامي الروحي والارتقاء الإيماني الذي يمر عبر ممارسة العبادة في جميع مظاهرها وأشكالها، بما فيها المعاملة والسلوك، الأمر الذي يجلي لنا بوضوح، الحقيقة الكبرى المتمثلة في امتزاج العقيدة والعبادة والأخلاق( السلوك)، في نظام الإسلام، الذي يستلهمه النظام التربوي على مستوى بناء الشاكلة المتميزة عن سائر الشاكلات أو الشواكل التي تنتجها النظم الأخرى، ومنها النظام الغربي المعاصر.
4- صور الاستفادة من جوانب التضارب والتلاقي والتميز في استجلاء القيمة المضافة
تتمثل الاستفادة من الجوانب المذكورة أعلاه، في استثمار كل ذلك عبر البحث العلمي الرصين، في بث اليقين، في نفوس المستهدفين، في أن النظام التربوي الصالح لتجديد نسيج الإنسانية، وضبط سيرها على المسار الصحيح، إنما هو النظام التربوي الأصيل، بحمولته الدينية ومنهجه القويم.
والله ولي التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
مراجع البحث ومصادره:
- إسماعيل علي، سعيد. الخطاب التربوي الإسلامي. سلسلة كتاب الأمة. العدد 100. ربيع الأول. 1425ﻫ، السنة الرابعة والعشرون. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
- الأنصاري، فريد. مفهوم العالمية من الكتاب إلى الربانية. منشورات رسالة الفرقان رقم: 1، الطبعة الأولى. 1427ﻫ/2006م.
- بري، عبد اللطيف. الإنماء الروحي والإصلاح الاجتماعي. دار التعارف للمطبوعات. بيروت. لبنان. 1399ﻫ/1979م.
- بن عاشور، محمد الفاضل. روح الحضارة الإسلامية. ضبطها وقدم لها: عمر عبيد حسنة. الدار العالمية للكتاب الإسلامي. والمعهد العالمي للفكر الإسلامي. 1401ﻫ/1981م.
- بنحمزة، مصطفى. “مقاصد التربية الإسلامية”. الجامعة الصيفية للصحوة الإسلامية، الدورة الثانية، دور التوجيه التربوي الإسلامي في بناء المجتمع الحديث، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطبعة فضالة، الدار البيضاء، 9، 10، 11 ربيع الأول 1412ﻫ. 18، 19، 20 شتنبر 1991م.
- بنعبود، المهدي. أزمة الحضارة المعاصرة والتطلع إلى مستقبل الإنسانية، الأعمال الكاملة للدكتور المهدي بنعبود. جمع وترتيب ومراجعة محمد الدماغ الرحالي. الطبعة الأولى. الرباط. مطابع أمبريال. 2005م.
- بنمسعود، عبد المجيد. القيم الإسلامية التربوية والمجتمع المعاصر. سلسلة كتاب الأمة رقم: 67. رمضان 1419ﻫ/1999م.
- بنمسعود، عبد المجيد. مفهوم السلطة في ضوء المنظومة التربوية الإسلامية دراسة نقدية لبعض الطروحات المناهضة. المجلة التربوية. مجلس النشر العلمي. جامعة الكويت. العدد الخامس والثلاثون. المجلد التاسع. ربيع 1995م.
- البهي، محمد. الإسلام في الواقع الإيديولوجي المعاصر. الطبعة الأولى. بيروت. دار الفكر. 1970م.
- البوشيخي، الشاهد. نحو تصور حضاري للمسألة المصطلحية. سلسلة دراسات مصطلحية)3(. مطبعة أنفو برنت. فاس. المغرب.
- جماعة من علماء التربية في العالم العربي. فلسفة تربوية متجددة لعالم عربي يتجدد. دائرة التربية في الجامعة الأمريكية في بيروت. الطبعة الثانية. 1958م.
- حسنة، عمر عبيد. تأملات في الواقع الإسلامي. الطبعة الأولى. المكتب الإسلامي. بيروت. 1411ﻫ/1990م.
- الحسني الندوي، أبو الحسن علي. محاضرات إسلامية في الفكر والدعوة. جمعها وحققها وعلق عليها: سيد عبد المجيد الغوري. الطبعة الأولى. دمشق. بيروت. دار ابن كثير. 1411ﻫ/1990م.
- الرابع الحسني الندوي، محمد. تقديم أبي الحسن علي الحسني الندوي. التربية والمجتمع. الطبعة الأولى. دمشق. دار القلم. بيروت. الدار الشامية. 1412ﻫ/1991م.
- حسين، سيد سجاد ، سيد علي أشرف. ترجمة أمين حسين الرباط. مراجعة محمد عبد الحميد الخريبي. أزمة التعليم الإسلامي. شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع. جامعة الملك عبد العزيز. الطبعة الأولى. 1403ﻫ/1983م.
- خوري، أنطون.) تعريب( الثقافة الإسلامية وفلسفة التربية في الشرق والغرب. دار النشر للجامعيين. طبعة قديمة. د.ت.
- شايغان، داريوش. ما الثورة الدينية؟ الحضارات التقليدية في مواجهة الحداثة. الطبعة الأولى. بيروت. لبنان. المؤسسة العربية للتحديث الفكري. جنيف. دار الساقي. 2004م.
- شفيق، منير. الإسلام في معركة الحضارة. الطبعة الأولى. دار الكلمة للنشر. 1982م.
- صالح عبد الله، عبد الرحمن. الفكر التربوي الإسلامي. الطبعة الأولى. عمان. دار البشير. مؤسسة الرسالة. 1417ﻫ/1996م.
- الصمدي، خالد. خطاب التربية الإسلامية في عالم متغير. تجديد الفلسفة وتحديث الممارسة. الطبعة الأولى. الرباط. طوب. بريس. ماي 2006م.
- عرقسوسي، محمد خير. محاضرات في الأصول الإسلامية للتربية: المبادئ العليا. الطبعة الأولى. بيروت. المكتب الإسلامي. مكة المكرمة. المداد العربي. 1419ﻫ/ 1998م.
- محمد الحر، عبد العزيز. التربية والتنمية والنهضة، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت لبنان . الطبعة الأولى.2003
- عقار، عبد الحميد. “في وظائف المدرسة”، مجلة المدرسة المغربية، العدد 1 ماي 2009م.
- عيسى عثمان، علي. “النظام التعليمي السائد في المجتمعات الإسلامية واستبداله بنظام إسلامي”. مجلة الفكر العربي، عدد مايو يونيو يوليو 1981م.
- غاندي. التربية الأساسية. ترجمة محمد الشبيني. دار المعارف. مصر. 1959م.
- قطب، محمد. واقعنا المعاصر. الطبعة الأولى. دار الشروق. 1418ﻫ/1997م.
- القيسي، مروان إبراهيم. المنظومة القيمية الإسلامية كما تحددت في القرآن الكريم والسنة الشريفة. الطبعة الأولى. بيروت. لبنان. المكتب الإسلامي. 1416ﻫ/1996م.
- الكيلاني، ماجد عرسان. الأمة المسلمة: مفهومها، مقوماتها، إخراجها. الطبعة الثانية. بيروت. لبنان. مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع. 1421ﻫ/2000م.
- الكيلاني، ماجد عرسان. أهداف التربية الإسلامية. بيروت. لبنان. مؤسسة الريان. 1419ﻫ/1998م.
- الكيلاني، ماجد عرسان. فلسفة التربية الإسلامية. دراسة مقارنة بين فلسفة التربية الإسلامية والفلسفات التربوية المعاصرة. بيروت. لبنان. مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع. 1419ﻫ/1998م.
- الكيلاني، ماجد عرسان. مناهج التربية الإسلامية والمربون العاملون فيها. بيروت. مؤسسة الريان. 1419ﻫ/1998م.
- محسن، مصطفى. مدرسة المستقبل، رهان الإصلاح التربوي في عالم متغير. منشورات الزمن. سلسلة شرفات رقم 26. مطبعة النجاح. الدار البيضاء. ط 2009م.
- سفر، محمود محمد، دراسة في البناء الحضاري، سلسلة كتاب الأمة، العدد
- مطهري، مرتضى. التربية والتعليم في الإسلام. بيروت. لبنان.دار الهادي.
- المهدي عبد الحليم، أحمد. الثقافة الإسلامية محور لمناهج التعليم، رؤية التعليم من منظور إسلامي. الطبعة الأولى. القاهرة. المعهد العالمي للفكر الإسلامي. مكتبة الشروق الدولية. 1425ﻫ/2004م.
- البكر، فوزية. “النظم التعليمية وتحديات القرن العشرين”. مجلة المعرفة، العدد 129، نقلا عن: www. mohyssin. com
- تشجيع التوجيه الذاتي والتعاون، تطوير متعلمين مستقلين: www79. intel. com
- النظم التعليمية وتحديات القرن الواحد والعشرين: www. mohyssin. com.
- مدونة موقع مدرسة ابن تومرت www.elaphblog.com
- واقع النظام التعليمي المغربي، إلى أين؟ انظر: ousrattalim.jeun.fr.
- محمد عثمان كشميري www. alriyadh. com