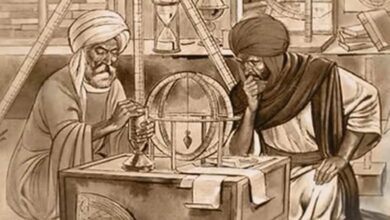12- تشخيص المعضلة التربوية في العالم العربي والإسلامي
تشخيص المعضلة التربوية في العالم العربي والإسلامي
بحث مقدم لصالح مشروع إحياء نظام تربوي أصيل
إعداد
د. رضا بن المبروك ساسي
أنجز في:
ذي القعدة 1430ﻫ /2009م
جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمشروع
ومسجلة رسميـًا ومحمية بموجب القانون
خطة البحث
- توطئة:
لقد بلغ مشكل التربية والتعليم في العالم العربي والإسلامي درجة الإعضال” ويكفي أن تكون طرفا في المشهد التربوي التعليمي، بأي صفة من الصفات، ليصيبك غبارها وشررها المستعر بحسب درجة المعايشة والوعي والإدراك وبحسب المدى الذي تبلغه في علاقتك وانتظاراتك من نظام التربية والتعليم. (عبد المجيد،بنمسعود،2009).
إلا أنّ التأكد من تلك الأزمة التي اكتسبت صيغة المعضلة واكتسبت إجماعا تلقائيا فيستوجب الموضوعية والتريث العلمي لتجميع المعطيات وتحليلها وتمحيصها وتشخيصها تشخيصا استقرائيا نسقيا منظوميا.
هكذا إذن وأمام تواتر التأكيد على وجود مظاهر الإعضال في عديد الأدبيات التربوية العربية والأجنبية وبغض النّظر عما يصدق منه فالاجماع حاصل حول الأزمة، لكن الذي بقي مثار تباين واختلاف هو نوعية التشخيص وما يعتمد فيه من معايير وما يحكمه من رؤى وتصورات وما ينتهى إليه من نتائج وقرارات وما يستتبعه من حلول ومعالجات.
ذلك هو في حقيقة الأمر هو موضوع البحث الذي أوكل إلينا الاهتمام به ليكون ضربة البداية في بلورة الرؤى النظرية لارساء نموذج تربية أصيلة في عالمنا العربي.
هذا البحث الموكول إلينا سيسعى إذن إلى تحديد أوجه الإعضال القائم في النظام التربوي العربي ورصد الأعراض المرضية التي أضحت مستفحلة ومزمنة فيه مع محاولة استقصاء للأسباب الفكرية والتطبيقية وتوقع الانعكاسات والآثار على الأجيال والمجتمعات العربية.
كما سنحاول من خلال ذلك التشخيص الكمي والنوعي التعرف على “سرّ لصوق سمة الاخفاق ببنية نظام التربية والتعليم في الوطن العربي على الرغم من محاولات الإصلاح المتعددة التي أجريت على مدى نصف قرن أو يزيد من حصول الأنظمة العربية على استقلالها والحال أن طاقات أهدرت وأموالا باهضة أنفقت في ذلك السبيل”(بنمسعود،2009). كما سنسعى لصياغة الفرضيات الفرعية والرئيسية المفسرة لذلك الإعضال والأزمة الخانقة عسانا نسهم في رسم معالم رؤية تقترح البدائل وتساعد على إخراج أمتنا من معضلة خانقة بتأسيس خيار تربوي يحقق شهودا حضاريا بتحقيق المشاركة العالمية لتكون أمة شاهدة كما أرادها الله عزّ وجل: ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَىٰ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (البقرة: 143).
- الإشكالية:
وبناء على ما تقدم و بعد التأكد من تفاقم معضلة حقيقية أبرزتها لنا الدراسات السابقة التي تمكننا من الإطلاع عليها لحد الآن يجدر بنا أن نحاول الإجابة عن الأسئلة التشخيصية الواصفة للمشكل وهي على التوالي:
ما سر لصوق سمة الإخفاق ببنية نظام التربية و التعليم بالوطن العربي بالرغم من محاولات الإصلاح المتعددة التي أجريت على مدى نصف قرن أو يزيد من حصول الأنظمة على استقلالها و رغم الأموال الباهضة التي أنفقت في الغرض؟
ما الذي يفسر هذا التردي الذي آلت إليه مخرجات التعليم والتربية العربية رغم المجهودات التي بذلت في صياغة المناهج العديدة و العمل على تعديلها عند كل إصلاح؟
وسعيا منا لاقتراح تحليل دقيق لمظاهر الأزمة التربوية في العالم العربي والإسلامي ارتأينا اعتماد مقاربة منظومية متعددة الأوجه تهتم بالدال من المدخلات والتمشيات والمخرجات التعليمية والتربوية الملفتة للنظر والظافرة بإجماع الباحثين. سنعتمد إذن منهجية تحليل النظم لعلها تساعدنا على الكشف عن طبيعة مختلف العناصر التي يتألف منها النظام التربوي السائد في العالم العربي والإسلامي ونوعية العلاقة التي تشد بعضها إلى بعض، والعلاقة بين مدخلات ذلك النظام وبين مخرجاته للوقوف على مدى نجاعته أو عدم نجاعته في أداء ماهو منوط به من الوظائف والأدوار.
3- الفكرة المحورية:
تتمثل الفكرة المحورية في بحثنا هذا بإذن الله في محاولة إجرائية تشخيصية للمعضلة التربوية في العالم العربي والإسلامي والتعرف على أسبابها الفكرية والتطبيقية وأثرها في تكوين الأجيال وفي أوضاع المجتمعات العربية.
يهدف بحثنا هذا إلى إنارة السبيل لكل الأبحاث و من بينها بحثنا عساه يهدي سبيلنا وسبيل العاملين معنا إلى بلورة رؤى نظرية وإلى تحديد ملامح نموذج يتجاوز مظاهر الإعضال واقتراح فرضيات تفسيرية وأخرى رئيسة.
لذلك سنسعى في هذا العمل للإجابة عن الأسئلة التالية:
ماهي مظاهر الإعضال في الأنظمة التربوية العربية؟
ما الذي يكمن وراء ذلك الإعضال؟ وبعبارة أخرى ما الذي يفسر تدني المخرجات التعليمية ويشرح درجة الابتعاد عن الأهداف المنشودة؟
ما طبيعة الانعكاسات المترتبة عن ذلك التأزم على مستوى تكوين الأجيال؟
ما هي الآثار المتوقعة في المجتمعات العربية في مستقبل الأيام؟
4- بنية البحث:
انطلاقا من إشكالية البحث ومن أسئلته الفرعية تمكنا بعون الله وتوفيقه في مرحلة أولية من تحليل ما تكرر من
مظاهر دالة تعلقت بالمدخلات أوبالتمشيات أو بالمخرجات فحاولنا استقراء الأدبيات بجرد ما تواتر من مشكلات وعملنا على فرز وتجميع ما تقارب معنويا في فئات واصفة تجنبا للتجزئة المشتتة فكانت المحاور كالآتي:
- معضلة الأمية الأبجدية بالعالم العربي والإسلامي
- مظاهر معضلة الأميّة الأبجدية
- من الأسباب المفسرة لمظهر الأمية
- من انعكاسات الأمية على تكوين الأجيال وآثارها على المجتمعات
- معضلة التربية قبل المدرسية في العالم العربي والإسلامي
- معضلة القيد للالتحاق بالتربية قبل المدرسية
- انعكاسات ضعف القيد المسجلة بمرحلة التربية قبل المدرسية في العالم العربي والإسلامي
- أثر ضعف القيد في نهضة المجتمع العربي
- الأسباب الكامنة وراء القصور البيداغوجي
- تدني المخرجات المتعلقة باللغة العربية قراءة وكتابة وتخاطبا
- مظاهر الضعف في اللغة العربية
- الأسباب الكامنة وراء الضعف اللغوي الموصوف
- من انعكاسات تدني المخرجات المتعلقة باللغة العربية
- تدني المخرجات المتعلقة بالرياضيات والعلوم والتفكير النقدي
- مظهر المعضلة المتعلق بتدني المردود العلمي والفلسفي للمدرسة العربية
- من الأسباب المفسرة لندرة التفكير العلمي والنقدي
- من الأسباب الفكرية والتطبيقية المفسرة للظاهرة
- من انعكاسات تدني المردود الفكري على مستوى تكوين الأجيال
- من آثار التدني في المخرجات المتعلقة باكتساب التفكير العلمي في أوضاع المجتمعات العربية
- مظاهر الاغتراب لدى الطلاب ومعلميهم
- واقع الاغتراب لدى الطلبة العرب
- من الأسباب المفسرة لظاهرة الاغتراب الطلابي
- من آثار الاغتراب الطلابي
و- ضعف استبطان القيم الأخلاقية والمدنية
– العنف المدرسي: بعض مظاهره، انعكاساته ،آثاره،
– الغش الطلابي في الامتحانات المدرسية لدى الطلاب:بعض مظاهره ،انعكاساته ،آثاره
ز- صياغة الفرضية الرئيسية للمشروع
اقترحنا هذه المحاور بعد عملية استقراء للأدبيات والدراسات ذات العلاقة بالتأزم و الإعضال الذي أصاب التربية العربية و بعد الاتفاق على تحليل نسقي منظومي ساعدنا على وصف وتحليل مظاهر المعضلة الممثلة في الفشل الذي لصق بالمخرجات المعرفية و القيمية أن غياب الأصالة وغياب ميزان الإيمان والأمانة الاستخلافية كل ذلك كان وراء ما تردت إليه التربية في العالم العربي والإسلامي.
هكذا إذن حاولنا أن تكون المحاور المقترحة مستجيبة للمنهج التحليلي الذي اخترناه ومراعية لطبيعة لطموح البحث- المشروع الموكول إلينا.
5 – بعض مصطلحات البحث:
من المفاهيم النظرية أو الإجرائية التي يمكن للقارئ أن يلتبس عليه الأمر في فهمها نشير إلى أهمها لذلك كان لزاما علينا أن نفيدهم بقصدنا في المصطلحات التالية وهي:
- التأصيل: “التأصيل في اللغة مشتقّ من (أصل) الشي أي أساسه الذي يقوم عليه ورجل (أصل الرأي) أي محكم الرأي وهي القاعدة والأساس المتين الذي يقوم عليه الشيء.”
أما التأصيل في الاصطلاح فهو وثيق الصلة بمعناه اللغوي إذ هو بناء مناهج الحياة على الأصول الثابتة للمجتمع أو الأمة أو هو بعبارة أخرى أن نرُدّ ما ندّ أي (ما أخرج) عن أصله إلى هذا الأصل مرة أخرى…
والأصل أو الأصول المقصود بردّ الأشياء إليها (لدى المسلمين) هي مصادر الشريعة الإسلامية حيث الأصل الأول هو القرآن الكريم والأصل الثاني هو السنّة النبوية ثمّ تأتي أصول التشريع الأخرى تبعا لهذين الأصلين كالإجماع والقياس فيما ليس فيه نصّ قرآني أو نبوي.
وبعبارات أخرى فإنّ” التأصيل هو إعادة كليات الحياة كلها لا سيما الحياة العامة إلى أصول الأمة الدينية وما تأسس عليها من أعراف كريمة أو هو إرجاع مناهج الحياة وما يتفرّع عنها من قوانين وخطط إلى هذه الأصول”.
والتأصيل من وجه آخر هو إعمال الأصول في القضايا المعاصرة، مع الانتفاع من المعرفة والتجربة البشرية فهو تأصيل مستنير متفتّح على التحديث الرشيد.( محمد عبدا لله النقرابي، 2005 م).
يقتضي فهم الأصالة ما يلي :
- ضرورة المعرفة والفهم لثقافتنا: فهم هذه الثقافة من مصادرها الأصلية، ومن أهلها الثقات، وبأدواتها ومناهجها الخاصة.
- الاعتزاز بالانتماء العربي الإسلامي: يشعر المثقف العربي المسلم، الذي ينتمي إلى ثقافة العرب والمسلمين، أنه عضو في جسم هذه الأمة، وأنه متحرر من عقدة النقص التي يعاني منها بعض الناس تجاه كل ما هو غربي. إنه يعتز بلغته، لغة القرآن والعلوم، ويعمل على أن تكون لغة الحياة، ولغة العلم، ولغة الثقافة.
- العودة إلى الأصول: أي إلى أصولنا وجذورنا العقدية والفكرية، والأخلاقية، و تحويل اعتزازنا النظري والعاطفي إلى سلوك عملي حتى لا يصبح ظاهرة مرضيَة أو مجرد كلام يردد، وشعارات ترفع، وصيحات تتعالى، لسرد الأمجاد، وتعظيم الأجداد.
د- الانتفاع الواعي بتراثنا: والغوص في حضنه الزاخر، لاستخراج لآلئه وجواهره..
- التربية قبل المدرسية: هي تلك المرحلة التي تسبق دخول الطفل إلى المدرسة الابتدائية، أي المرحلة التي تمتد من الولادة إلى سن السادسة تقريباً. وهي لا تتم في مؤسسات قائمة بذاتها ومستقلة تمام الاستقلال عن جوانب الحياة الاجتماعية بل ترتبط بها وتؤهل الطفل لها.
وتنقسم مرحلة التربية ما قبل المدرسية إلى مرحلتين:
- مرحلة دار الحضانة: وهي مؤسسات تستقبل الأطفال من الأيام الأولى حتى الثالثة من العمر، وتستهدف توفير الرعاية لهم بما يتناسب ومكوناتهم البيولوجية والصحية والغذائية والحركية والعاطفية والكلامية في فترة غياب أمهاتهم، سواءً أكان الغياب بسبب العمل أم لسبب آخر. تقوم دار الحضانة بدور البيت البديل، وتلبي حاجات الطفل الأساسية، وتسهم المربية فيها بتقديم وجبات الطعام، والرضاعة واللباس والنظافة، والنوم، وتعمل على تنظيم جو الدار على نحو يجعله قريباً جداً من جو المحيط الأسري.
- رياض الأطفال: وهي مؤسسات تربوية تستقبل الأطفال من عمر الثالثة حتى السادسة، وتسعى إلى توفير الشروط التربوية المناسبة، والجو الملائم لرعاية القوى الكامنة للطفل بغية إيقاظها، وتسهيل سبل نموها من النواحي الجسدية والعقلية والنفسية والاجتماعية جميعها.
- الكتّاب:
ظهرت مع انتشار الإسلام الكتاتيب، وبدأت تعلم الأطفال القرآن الكريم والأحاديث وبعض أحكام الدين، حيث بدأت بتعليم الطفل منذ سن الخامسة، القراءة والكتابة في منازل المعلمين أو في مكان مخصص لتعليم القرآن ومبادئ الدين الإسلامي (كالمسجد).
هذا وقد قامت الكتاتيب مقام رياض الأطفال في العصر الأموي والعباسي وما تلاه من العصور التي استمرت حتى فترة قريبة من الوقت. ظلت الكتاتيب مدة طويلة قبل الخمسينات المؤسسة التربوية الأساسية لتعليم الأطفال في المراحل المبكرة من حياتهم في معظم البلدان العربية.
تطورت بعض تلك الكتاتيب باتجاه التحول إلى روضات فقيرة بالأثاث والمواد التربوية.
– المعضلة التربوية : عرف السوسيولوجي المغربي (مصطفى محسن) المعضلة بكونها مجموعة العوائق والمشكلات والعراقيل والفشل الذي يعاني منه قطاع أو مجال والتي تشل حركيته العادية وتعوق إيقاع سيره الطبيعي أو تجعله محدود المردودية والكفاية غير مستجيب بشكل فعال لمجمل الغايات والأهداف والمقاصد التي يفترض أن يسير في اتجاه تحقيقها .
(مصطفى محسن، 1999).
أما الباحثان (رضا ساسي و مصدق الجليدي ،2009) فقد عرفا المعضلة في هذا البحث – المشروع بكونها المسألة التربوية الصعبة والخانقة التي تصف واقعا تربويا معقدا وأزمات متعددة يصعب حلها إلا بتظافر جهود الباحثين والتربويين والممارسين وتوظيف مقاربات متعددة المداخل (الفلسفية،الأنتروبولوجية،الاجتماعية والنفسية…). وفي هذا البحث – المشروع نحدد مظاهر المعضلة التربوية بتعريفها بالموضوع المتعلق بها وهو مجموع ما يعتبر معضلات جزئية. هذه المعضلات الجزئية هي مظاهر المعضلة، إذا ما تضافرت كونت معضلة كبرى ومعقدة..
وصفنا كل مشكلة مستفحلة بالمعضلة التربوية كلما اتجهنا ناحية مخرجات النظام التربوي ووجدناها مناقضة للأهداف القيمية والنفعية المرسومة للنظام التربوي العربي أو لملامح الإنسان العربي المنشود.
– التشخيص: التشخيص هو فهم طبيعة مشكلة وتفسيرها في ضوء العوامل المتعددة التي لعبت دورا هامّا في إنتاجها.
ويتمثل تشخيص الواقع التربوي مثلا وفهمه في الاستقراء و تحليل للدراسات والتقارير العربية و الدولية ذات العلاقة بالواقع التربوي قصد تنظيم مجموعة من العناصر المنفصلة عن بعضها في بنية دالة وإحصاء المؤشرات الواصفة للمعضلة التربوية في العالم العربي و الإسلامي وتنظيمها لعلها توجه الباحث المشخص إلى الفعل والانطلاق في سيروة التنظير والتطبيق .
- مفهوم الاغتراب : “الاغتراب هو حالة تضع الإنسان خارج ذاته، تحت تأثير نسق من العوامل التي تعيق انتاجية الإنسان وتعطل عملية الإبداع لديه وتدمر إمكانيته في التعبير الحر عن وجوده، فتمنع عليه ازدهاره وتفتحه الإنساني.
هذا ويحدد (مولفان سومان) خمسة أبعاد أساسية لمفهوم الاغتراب هي:
الحرمان من السلطة غياب معنى الحياة. غياب المعايير. غياب للقيم.إحساس بالغربة عن الذات.
فالاغتراب في حدود ما ننظر إليه هو:
الوضعية التي ينال فيها القهر والتسلط والعبودية من جوهر الإنسان وهو الحالة التي تتعرض فيها إرادة الإنسان أو عقله للاغتصاب والقهر والاعتداء والتشويه.
وفي هذا السياق يمكن القول أن مظاهر الاغتراب تتبدى في أشكال أحاسيس مفرطة: بالدونية واللامبالاة والقهر والضعف والسلبية والانهزامية.
ويشير مفهوم الاغتراب إلى الحالات التي تتعرض فيها وحدة الشخصية للانشطار أو للضعف أو للانهيار، بتأثير العمليات الثقافية والاجتماعية التي تتم في داخلها أو داخل المجتمع.
ومفهوم الاغتراب هو الحالة أيضا التي يتعرض فيها جوهر الشخصية للعسر والإكراه. وفقا لذلك يمكن القول إن مفهوم الاغتراب في الشخصية يتحدد بالجوانب التالية:
- حالات عدم التكيف النفسي (عدم الثقة بالنفس، القلق المستمر، الرهاب الاجتماعي، المخاوف المرضية)
- غياب الإحساس بالتماسك الداخلي في الشخصية
- حالة ديمومة العقد النفسية
- ضعف أحاسيس الشعور بالهوية مثل الشعور بالانتماء، الشعور بـ:الجهد المركزي، الشعور بالحب، الثقة بالنفس، الشعور بالقيمة، غياب الإحساس بالأمن.
هكذا إذن يبدو أن مفهوم الاغتراب معقد يرتكز إلى منظومة من العمليات الأساسية للعملية الاغترابية ويمكن في هذا السياق تحديد أربعة أبعاد أساسية في بنيته: الإكراه والتسلط.
التسلط والعبودية والإكراه، مفاهيم مركزية في تحديد الوضعية الاغترابية. فالإنسان المستلب المغترب، إنسان فقد حريته في الجوهر، لأن الاغتراب لا يكون تغييبا للحرية.
فالإنسان حر عندما يستطيع أن يمتلك زمام نفسه ويسيطر على وسطه الشخصي والفيزيائي والاجتماعي ويكون حرا عندما يكون قادرا على إبداع أشياء توضع في خدمته.
وعلى خلاف هذا التصور إذا كان الإنتاج الإنساني يأخذ طابعا استعباديا مضادا لحرية الإنسان، عبر عمليات القهر والتسلط فإن الإنسان يتحول إلى كائن مستلب مغترب مهزوم بكل المعايير والدلالات الحقة في مفهوم الاغتراب ولذلك فإن غياب المشاركة في السلطة أو في القرارات التي توجه حياته ووجوده يشكل واحدا من أهم عوامل اغترابه واستلابه.
ومن مؤشراته:
- اللاّانتماء: يشكل اللاانتماء ركنا أساسيا من أركان مفهوم الاغتراب. إن الانتماء إلى جماعة أو طبقة أو مجتمع يتضمن وضعية من وضعيات التجانس الاجتماعي وبالتالي فإن تحقيق الذات الاجتماعية عملية تقوم على أساس بناء علاقة إيجابية مع الآخر وإذا كانت هناك تناقضات حقيقية في طبيعة هذه الانتماءات فإنها تمنع الشخص من الانتماء إلى نفسه أي تشطره، وبالتالي تمنعه من امتلاك هوية خاصة أي الشعور بالكيان الواحد الذي يستجمع تجارب الفرد، أو الشعور بامتلاك الإنسان معنى خاصا لحياته الإنسانية.
- الوعي المزيف: يشكل الوعي بالنسبة للإنسان طريقة في الوجود ومنهجا في الكينونة. والوعي هو التنظيم الدينامي للحياة النفسية إنه الحالة أو الكيفية التي يتمكن الإنسان بموجبها من أن يصبح موضوعا لذاته أي أن يجعل الفرد من نفسه موضوعا للمعرفة (Métacognition) وأن يكون بالتالي عبر وعيه بذاته سيدا لنفسه.
ومن هنا فإن أي تناقض بين الواقع والتجربة من جهة وبين الوعي الذاتي من جهة أخرى يشكل أهم عوامل الاغتراب.
- الجمود والانقطاع: يكون الإنسان مستلبا عندما لا يستطيع تجاوز الوضعيات النفسية والحالات الاجتماعية التي تحاصره وتحيط به.
فالإنسان الذي لا يغير الأشياء ولا يتغير يقع في مستنقع الجمود والعدمية الاغترابية، وهذا يعني أن الإنسان الذي لا يؤثر في وسطه ولا يجدد في معالم وجوده هو إنسان يعيش حالة اغترابية إلى حد كبير.
والإنسان المستلب هو الإنسان الذي يعيش حالة جمود تمنعه من تجاوز نفسه والظرف الذي يحيط به أي هذا الذي ينغلق على ذاته ولا يستطيع المبادرة إلى الإنجاز والإبداع والتجديد والابتكار وبالتالي فإن الإنسان يعيش نسقا من التناقضات في مختلف جوانب حياته ووجوده.
والإنسان يمتلك نزعة سيكولوجية لتحقيق التوازن إزاء هذه التناقضات وتتجلى هذه النزعة في منظومة من العمليات النفسية التي تفعل فعلها في تحقيق التوازن بين تجربة الفرد وبين تقديراته العالية لهذه التجربة، وبمعنى آخر تحدث هذه العمليات توازنا حقيقيا بين وجود الفرد وذاته كما أنها تعمل على تحقيق التوازن بين الهوية الفردية وصورة الفرد عن ذاته.
فالإنسان يعيش حالة صراع مستمرة بين النزعة إلى التوازن والنزعة إلى التجديد والابتكار.
ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن الفهم السيكوسوسيولوجي (النفسي-الاجتماعي) يمكننا من الكشف عن المسافة التي تفصل بين تجربة الفرد الخاصة وتجارب الجماعات التي ينتمي إليها.
فالاغتراب مفهوم أداتي يمكننا من تحليل تأثير الشروط الخارجية والداخلية في تشكيل وعي الفرد وتوازنه النفسي. وبعبارة أخرى يمكننا القول بأنه لا يمكن اختزال مفهوم الاغتراب إلى أحد أبعاده النفسية والاجتماعية يجد المفهوم ماهيته وخصوصيته في وحدته الجدلية الجامعة مابين النفسي والاجتماعي في دائرة خارج الدلالة الإيديولوجية”.(علي أسعد وطفة 2008)
- محاولة في تحديد مفهوم العولمة :العولمة في أبسط معانيها هي التكامل الاقتصادي على مستوى العالم و تحويل اقتصادات العالم المتعددة إلى اقتصاد عالمي واحد و يعتبر تسليع التربية من أهم المضامين التربوية للعولمة حيث إن العولمة تعتمد كثيرا على الخصخصة التي تشجع الحكومات على رفع يدها تدريجيا عن قطاع الخدمات كالتربية و غيرها و دعم الحكومي المالي.
إن ظاهرة العولمة التي تمس الاقتصاد والثقافة والمعلومات وعالمية العلاقات وتزايد حركة الأفراد، والتطور الهائل لوسائل الاتصالات وتدخل المعلوماتية في حياتنا اليومية ومجالات العمل كلها ظواهر تمثل تحدياً وفرصة أمام النظم التربوية لاشك أن الناظر إلى آثار العولمة وخصوصا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية يجد أن اخطر ما فيها هو العولمة الثقافية وذلك بسبب التغييرات الكثيرة التي أحدثتها في هذا لمجال ، فالعولمة الثقافية تهدف أول ما تهدف إلى تعميم ثقافة واحدة على كل مجتمعات الدنيا بعيدا عن خصوصيات الأمم والشعوب، وهذا ما بدا واضحا في العقود الأخيرة بسبب تطور الوسائل التكنولوجية التي تسهم في غرس وتعميق العولمة الثقافية والتي من أهمها وسائل الإعلام بكل ما تحتويه هذه الوسائل من إمكانيات وطاقات. (خالد الصمدي، 2008).
فالعولمة إذن “إما أن تعبر عن النزعة الدولية في العلاقات بين الدول والثقافات الدولية أو العالمية أو الأمركة أو الخوصصة أو الاستعمار الجديد تحت مسميات مغايرة أو تلاشي الحدود الجغرافية باتجاه تكثيف وتسريع انتقال واتصال وتفاعل وتبادل الأفكار والأشخاص والأشياء بصورة معينة.
ومهما يكن الأمر فإن كل هذه التحولات تؤدي إلى إحداث واقع إنساني جديد يتسم بـ:
– انفتاح مجالات الثقافات البشرية على بعضها البعض سواء بصورة إيجابية أو سلبية،
– تلاقي الأديان والأجناس على خطوط التدافع الحضاري
– انتقال الأفكار والأشخاص والأشياء والسلع والخدمات وتداولها عالميا،
– تسارع انتقال المعلومات وزيادة حركة الاتصال مما يزيد في سرعة نقل القيم والثقافات داخل مدارات المجتمعات المختلفة
– انتقال قيم ومفاهيم ونماذج وأنساق المجتمعات المتحضرة من مراكزها الأصلية إلى عالم الثقافات والقيم الأخرى مما يحدث الصراع بين الوافد والأصيل
– تكريس فلسفات وأنماط التعليم الغربية المتغلبة حضاريا على فلسفات وقيم المجتمعات المتخلفة حضاريا،
– نقل القيم الحياتية والثقافية بصورة متسارعة ومتكاثفة مما يؤدي إلى ذوبان الشخصية التابعة والضعيفة، 8) اصطدام الإنسان المتخلف بثقافته المتخلفة مع قيم واقع حضاري مغاير وغلاب في حركته وأهدافه ومسيرته مما يضع بعض المجتمعات في أوضاع المواجهة غير المتكافئة أو الاضطرار إلى الانصياع وبالتالي فقدان الكثير من المقومات الأساسية،
– إحياء القوميات الدينية والثقافية كوسيلة من وسائل المقاومة والاستجابة للتحدي،
-نشر مفاهيم ومنطق الصراع والمواجهة كأسلوب لتكريس مقولات العولمة بكل أنواعها،
– إن هذا الواقع الجديد يؤدي إلى عولمة الأمراض والجرائم والمشكلات البيئية والصحية وغيرها،
– إن هذا الواقع الجديد يؤدي على نشر قيم التحرر الخاصة بالمرأة والديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها على وفق النموذج الغالب اليوم،
– انتشار ثقافة الاستهلاك والترفيه والتسلية الملهية في كثير من المجتمعات. “
فإذا كان هذا هو الوضع بصورة عامة فإن هذا لا يمنع من القول أن العولمة قد تخلق فرصا مهمة جدا للتحضر والتقدم لكثير من المجتمعات الواعية والذكية والتي تمتلك القدرة على التفاعل والتعامل بصورة متكافئة وبناءة. فالمجتمعات الذكية تستطيع أن تستفيد بصورة فعالة جدا من العولمة وتتجنب أكبر قدر ممكن من تأثيراتها السلبية القاتلة.(برغوث ،عبد العزيز “.2009)
محاولة حول تحديد مفهوم القيمة و القيم
تعددت وجهات النظر بشأن تحديد مفهوم القيمة على الرغم من التطورات الكثيرة التى طرأت على هذا الميدان المعرفى لذلك نجد تعددا لزوايا النظر فمنهم من .
1– ينظر للقيم من منظور فلسفي:ينظرالمثاليون للقيم على أنها مطلقة وثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان ومصدرها عالم المثل، ويرى الواقعيون والبراجماتيون والوجوديون أن القيم على أنها تعتمد على خبرة الإنسان وذكائه وتجاربه الحياتية.
2-وآخرينظر من للقيم على أنها اعتقاد :فالقيمة هي المعتقدات التى توجه الإنسان إلى السلوك الذى يرغبه أو يفضله، فالقيم هي مفاهيم مجردة تبرز أفكار الأفراد ومعتقداتهم كالعدل والإيثار والتعاون والإخلاص والتضحية
- وثمة من ينظر للقيم على أنها معايير: أي “معايير اجتماعية ذات صبغة انفعالية قوية تتصل من قريب بالمستويات الخلقية التى تقدمها الجماعة، يتشربها الفرد من بيئته الاجتماعية الخارجية ويقيم منها موازين يبرر بها أفعاله ويتخذها هادياً ومرشداً.
4-وهناك من ينظر للقيم على أنها تفضيلات وسلوك تفضيلي.
5-وهناك من يربط بين القيمة والاتجاه : فيعتبر القيمة تنظيم للخبرة التي تنشأ فى موقف تفاضلي، فتنمو وتتناسق حتى تصبح وحدة معيارية ثابتة في الضمير الاجتماعي للفرد، فى حين أن الاتجاه هو تنظيم للخبرة من نوع خاص يلون سلوك الفرد.”
“أما المقصود في استراتيجية تطوير التربية 2006 فهو ما ذكرناه سابقا أي تلك القيم التي تقترب من معنى المعايير العقلية والوجدانية المستندة إلى مرجعيات حضارية والتي تمكن صاحبها من الاختيار بإرادة حرة واعية.”
محاولة تحديد مفهوم العنف:
لغة:
يعرّف (المعجم الوسيط الجزء الثاني،631) “العنف فيحيل إلى الجذر عنف به وعليه،أي أخذه بشدة وقسوة ولامه و لذا فهو عنيف.”
(المنجد في اللغة العربية المعاصرة 2000م) “فهوالشدة والقسوة والحدة وعنّف بمعنى لام وأنكر وعامل بعنف معاملة سيئة.”
اصطلاحا:
يعتبر معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية لأحمد زكي بدوي”العنف أو الإكراه استخداما للضغط أو القوة استخداما غير مشروع أو غير مطابق للقانون من شأنه التأثير على إرادة فرد ما.”
ويعرف(خليل أحمد خليل،1995) “العنف بأنه السلوك الذي يستخدم الإيذاء باليد أو بالفعل أو بالكلمة،في الحقل التصادمي”فهو ذلك الفيروس الحامل للقسوة و والمانع للمودة.”
كما يصفه (بن عسكر،2003) “العنف المدرسي بكونه كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى الجسمي أو النفسي بالآخرين من معلمين وأعوان وزملاء الدراسة، من خلال السخرية والاستهزاء من الآخر وفرض الآراء بالقوة وإسماع الكلمات البذيئة.”
تعرف الباحثتان (تهاني منيب وعزة سليمان،2007) العنف بكونه “سلوك يهدف إلى إيقاع الأذى بالآخرين وقيام بأفعال عدوانية وتحطيم وتخريب للممتلكات الخاصة والعامة تعبيرا عن الاعتراض المعبر عن الظلم والمهانة.”
أما العنف الجماعي فهو”اشتراك فرد مع مجموعة من الأفراد في الهجوم اللفظي أو المادي في أفعال عدوانية تجاه فرد أو مجموعة أخرى قد تمثل السلطة أو رموزها وقد يأخذ شكل التمرد والعصيان أو التظاهر السلبي وتحطيم الممتلكات العامة أو الخاصة تعبيرا عن الاعتراض نتيجة الإحساس بالظلم أو بالمهانة.”
نقصد بالعنف المدرسي في هذا المبحث كل تصرف طلابي يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين وكل إيذاء يمارس بين التلاميذ أنفسهم وكل ما يصدر عنهم من تدمير للممتلكات المدرسية والعبث بها، والاعتداء ماديا على الإطار التربوي و تمزيق الكتب المدرسية والكراسات أمام المعاهد والمدارس أو حرقها إضافة إلى العنف اللفظي الذي يلخص عدة دلالات تعبيرية(سب الجلالة، التحرش، الشتم، اللّعن، التعيير، التحقير…).
ومهما كانت المقاربات المعرّفة للعنف ورغم اختلافاتها وتباينها أحيانا في إعطاء المفهوم الصحيح لمصطلح العنف يعتبر هذا الأخير فعلا عدوانيا ضد الآخر أي أنه السلوك الذي يهدف إلى إيذاء شخص آخر أو الإضرار به. ذلك ما ذكرت به (آمال بن جماعة، 2004) في دراستها المعمقة المناقشة بجامعة تونس حول العنف الشبابي قائلة بأن: “العنف يؤشر عليه بمجموعة من السمات والخصائص المميزة له وهي على التوالي:
-“حالة مركبة من حيث أداؤها وترابطها في حالة ذاتية لها موضوعها(الأنا،الآخر،نحن ، الآخرون) .”
-“يتسم العنف بسمات الأداء الفردي أو الجماعي المنطلق من مبادرة عنيفة والمنبني على استجابات عدوانية.”
-“العنف تجربة نفسية اجتماعية قوامها إيذاء الآخر لكنها لا تنفصل عن تغيرات المجتمع وثقافاته السياسية.”
-محاولة في تحديد مفهوم الغش الطلابي:
تعد ظاهرة الغش في المدارس وتحديدا بالامتحانات المدرسية من اخطر المشاكل التي يواجهها التعليم وأكثرها تأثيرا على الحياة المدرسية والاجتماعية ومن”الناحية السوسيولوجية يمكن نعت الظاهرة بالاجتماعية لأنها ظاهرة متعددة الأبعاد والترابطات وتتصف بالتعقيد والكلية فضلا عن اتصالها الوثيق بكائن اجتماعي معين”.(حسين الحريش،2009).
تدل ظاهرة الغش على سلوك غير سوي، منحرف وغير أخلاقي، وهو سلوك مرضي يهدف إلى تزييف الواقع لتحقيق مكسب مادي أو معنوي أو من أجل إشباع بعض الرغبات والحاجات لدى الفرد وهو حلقة من متلازمة ثلاثية معروفة تتكون من الكذب والسرقة وخيانة الأمانة، فهو إذن خيانة للنفس وخيانة للآخرين تنطلق مع الامتحانات وتنتهي إلى كل مناحي الحياة.
فالغش عموما هو كل سلوك يهدف إلى تزييف الواقع لتحقيق كسب غير مشروع مادي أو معنوي أو إرضاء حاجة نفسية والغش المدرسي هو تزييف لنتائج التقويم الذي هو من أهم عناصر المنهج.
فهو إذن سلوك انحرافي يخل بالعملية التعليمية يضعف من فاعلية النظام التعليمي ويعوقه عن تحقيق أهدافه التي يسعى إلى بلوغها ( فضيلة عرفات،2009).
وهو بالإضافة إلى كل ذلك ” استخدام لوسائل غير مشروعة للحصول على إجابات صحيحة ينقلها الطالب أو الطالبة من دون وجه حق فهو ضرب من السرقة والادعاء والتزييف وهو إهدار لقيمة تكافؤ الفرص وهو عدوان صارخ على الأمانة والصدق والمجتمع كله “( فضيلة عرفات،2009) وهو مؤشر على التواكل والكسل والخمول وعلى ضعف الإيمان وضعف الضمير والوجدان كما أنه مؤشر على تدني مستوى التربية الأسرية وضعف التوجيه والإرشاد الأبوي”.(فيصل الزراد،2009).
6 – الحاجة للبحث:
لقد كان بناء مشروع إحياء تربية أصيلة جامعة بين النظري الأصيل المتفتح والمعاصر الجيد، ومن ثم بناء نموذج قابل للحياة فاعل في مجتمعات تبحث عن التطوير والجودة والأمن الاجتماعي في أشد الحاجة إلى انطلاقة منهجية إجرائية تنطلق من تحليل الحاجات المتأكدة والدالة ووصف الحالة التي عليها الواقع التربوي.
لذلك كان لزاما علينا اعتماد مقاربة تقويمية إجرائية تتأمل وتفحص وتنقل صورة أمينة عن الدال من الاختلالات في المجال التربوي وفي جل مراحله تقريبا.
إن محطة التشخيص هذه هي ضربة البداية لتحديد المظاهر والبحث في الأسباب والظروف والعوامل الفكرية والتطبيقية وبالتالي تهتم بالانعكاسات على الأجيال والمجتمعات و تقترح فرضيات جديدة بناء عليها.
فالتشخيص لتحليل الحاجات وتحليل المظاهر الدالة الإيجابية والسلبية هما منطلقا مقاربات المشاريع التنموية، الصغرى والكبرى، المتوسطة المدى وبعيدة المدى .
7- علاقة البحث بالمشروع:
جاء في وثيقة الخيط الناظم أن الهدف من كل هذه الأبحاث هو الوصول إلى رسم ملامح نظرية ممهدة لبناء النموذج التطبيقي المنشود. وعليه فإن انطلاقة علمية لا تكون إلا بعد تشخيص دقيق لجوانب المعضلة التربوية وتحليل لمحتوى البحوث والأدبيات والتقارير الدولية والعربية الواصفة أو حتى المشيرة لبعض المشكلات ذات العلاقة.
لا يتأتى لنا تصور نظري إلا إذا اقتربنا من الواقع وشخصنا وفسرنا الأسباب الفكرية والتطبيقية واستبقنا الانعكاسات على مستوى تكوين الأجيال وتتبعنا الآثار المحتملة في أوضاع المجتمعات العربية والإسلامية مستقبلا.
نحاول الإجابة فنقول بأن تحري الحذر والجودة في مثل هذه المشاريع التنموية والمستديمة في قطاع استراتيجي حساس كالتربية يستوجب النظرة المعمقة والتحديد الدقيق للمطلوب منا جميعا نحن كمنظرين ومطبقين وتحديد الوجهة والغاية واختيار الطريقة والنهوج .
فالعلاقة بين موضوعات بحثنا والنظرية علاقة عضوية فبحثنا هو المنطلق ونتائج تشخيصنا هي البوصلة الهادية إلى نحت مكونات وملامح النموذج التطبيقي.
لذلك نعتبر أن البحث الراهن هو ذو طبيعة إجرائية بالأساس ويستجيب بصفة جلية إلى شروط الخيط الناظم ووثيقة الاستكتاب في جل أسسها وشروطها.
8– منهجيّة البحث وأدواته:
ولما كانت طبيعة البحث إجرائية وكانت المقاربة التي فرضتها علينا إشكالية الدراسة تقييمية وذات منحى واتجاه تشخيصي للمعضلة التربوية في العالم العربي والإسلامي سنعتمد بإذن الله منهج الوصف والتحليل الكمي والنوعي للمعطيات المجمعة من التقارير العالمية والوطنية المهتمة .
كذلك نذكر هنا ما دامت طبيعة البحث الراهن تنظيرية ومادامت رافدا داعما للتقصي النظري وللأجرة التطبيقية اعتمدنا منهجا تحليليا معفى من مناهج التجريب الوضعية والتكميمية. لذلك حاولنا استقراء الأدبيات المحكمة والأبحاث الجامعية (رسائل الماجستير والدكتوراه) واستفتاء الباحثين المتعاونين معنا (عبد المجيد بن مسعود، عماد الدين خليل ،مصدق الجليدي ،حميدة النيفر، الخليل النحوي ،عبد السلام الأحمر، أبو دف) حول تحديد شبه جامع للمعضلة التربوية ولمظاهرها.
وبعد تنسيق واتصالات مكثفة جمعنا وفكرنا في انتقاء وحدات خطابية مكتوبة لاعتمادها كشواهد ممثلة على الواقع التربوي العربي موضوع الأبحاث و اتفقنا بعد تشاور مكثف أنا والباحث مصدق الجليدي وبتزكية من الباحث حميدة النيفر على ما يمثل المعضلة وعلى طريقة البحث في أسبابها و انعكاساتها وعلى ما يمكن أن يشكل فرضيات للمشروع.
كذلك حددنا معا مظاهر المعضلة التربوية بتعريفها بالموضوع المتعلق بها وهو مجموع ما يعتبر معضلات جزئية.
هذه المعضلات الجزئية هي مظاهر المعضلة، التي إذا ما تضافرت كونت معضلة كبرى ومعقدة..
تكون ثمة معضلة إذان إذا ما مثلت مشكلة مستفحلة عند اتجاهنا ناحية مخرجات النظام التربوي و عند اكتشافنا أنها مناقضة
أو مخالفة للأهداف المرسومة أو المفترضة أن تكون.
لكن كيف حددنا أسباب المعضلة التربوية؟
لقد رأينا أن المعضلات الجزئية التي هي عينها مظاهر المعضلة التربوية تقع ضمن مخرجات النظام التربوي أي المخرجات السلبية الدالة والمستفحلة.
أما الأسباب فتقع قبل هذه المرحلة، أي في مستوى المدخلات أو في مستوى التمشيات الوسيطة.
فالفلسفة التربوية مثلا قد تكون مغالية في نفعيتها أو في ماديتها وهذا من المدخلات، وقد تكون الطرق البيداغوجية تسلطية أو لا تساعد على الفهم وهذهمن المدخلات أيضا.
أمّا الانعكاسات فتسبق الآثار والانعكاسات فهي متغيرات وسيطة بين مظاهر المعضلة (المعضلات الجزئية) والآثار السلبية. فالإخفاق في اكتساب المشرفين التربويين قبل الخدمة لكفايات جيدة في مهنة الإشراف ينعكس سلبا على علاقاتهم بالمعلمين والآثار هي تدن في كفايات المعلمين أنفسهم في التدريس.
فيكون النموذج التفسيري كالتالي:
عدم تحقيق الأهداف المرسومة أو التي كان يجب أن ترسم يؤدي إلى ظهور أزمات ومعضلات تنعكس سلبا على مستوى أداء الفاعلين الاجتماعيين الذين كانوا فاعلين تربويين فتترسب بسبب ذلك آثارا طويلة المدى من نوع الفقر المتواصل –التبعية الاقتصادية المزمنة- الوقوع تحت الاحتلال- ارتفاع معدلات الطلاق – ارتفاع معدلات الجريمة…الخ.
لقد اعتبرنا الأسباب فرضيات جزئية، لأن الخروج من المعضلة التربوية يتم أولا بمعرفة أسبابها. وسبب الأسباب جميعها هو ما يمثل الفرضية المركزية للمشروع.
نحن نلاحظ مثلا أن الآثار السلبية للمعضلة التربوية التي هي جملة أزمات المجتمعات العربية (التخلف- الفقر- المديونية-التبعية-الاحتلال- الحرب الأهلية…الخ) لا توجد في البلدان الغربية أو لا توجد فيها بنفس الدرجة.
ذلك ما حاولنا اختزاله فيالنموذج الأستراتيجي التالي:
استراتيجيةالخطة البحثية المتعلقة بتشخيص المعضلة التربوية في العالم العربي الإسلامي (رضا ساسي)
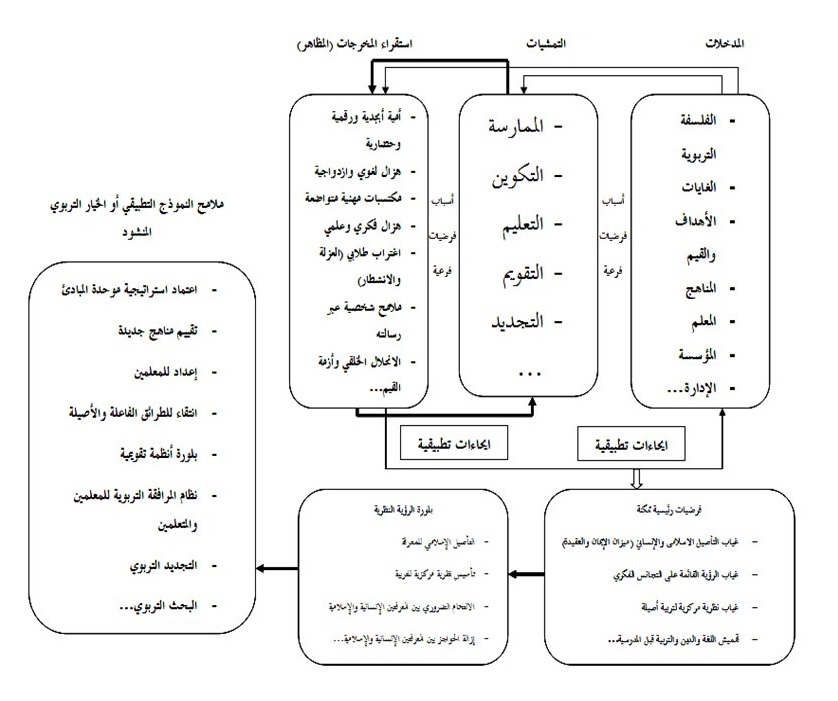
وللتذكير حاولنا أن نتحرى في هذا البحث درجة مقبولة من الصدق والثبات والأمانة عند تحديد الفئات المحورية والمتعلقة بما يرتبط بالدال من العناصر الواصفة للمدخلات أو المخرجات أو التمشيات التعليمية وبعد متابعة يقظة لوحدات الخطاب المتكررة والمنتظمة الواصفة لبعض مظاهر المعضلة التربوية لعلنا نتمكن من صياغة رئيسية للمشروع.
9– الدراسات السابقة والأدبيات ذات العلاقة:
عدنا إلى بعض الدراسات التي تعمّقت في المسألة التربوية واهتمت بواقع التعليم في كل المراحل من الكتاتيب والمدارس الابتدائية إلى المعاهد الثانوية والكليات والمعاهد العليا فسجّلنا تألّما من الواقع وإجماعا على ضرورة التدخّل والنجدة لإنقاذ الأمر والتأمّل في الممارسات والمنطلقات.
ومن الدراسات السابقة التي عدنا إليها ودفعتنا إلى التقدم في البحث نصف ما يلي:
1-لقد كان “كتاب” أشتات مجتمعات في التربية والتنمية دار الفكر العربي القاهرة 2003 (لأحمد المهدي عبد الحليم) منطلقا للبحث ومرجعا رجعنا إليه كلّما حاولنا التعرف على جوانب المعضلة التربوية في العالم العربي والإسلامي وذلك للأسباب التالية:
- احتواؤه على معطيات وبيانات كميّة (إحصائيات تؤشّر لوجود معضلة تربوية عربية).
- إبرازه للدال من مظاهر (الأزمة، التخلّف، المعضلة).
- اختياره لخطاب تأصيلي تحديثي يذكّر بمقوّمات الأصالة المضاعفة (استنارة واستفادة واضحة من القرآن والسنّة ومن كتب التراث التربوي القديم والمعاصر).
- محاولته الجادة في تحليل الأسباب الفكرية والتنظيمية المفسّرة لأوجه الخلل التربوي في العالم العربي والإسلامي.
- محاولته في توقع لواقع الانعكاسات التي يمكن أن تنجرّ على الأجيال وتكوينها.
- اقتراحه لعديد المقترحات الهادفة إلى صياغة فرضيات جديدة أو حلول مؤقّتة لمعالجة جوانب المعضلة.
ضمّ هذا الكتاب مجموعة من الدراسات والبحوث وصفها المؤلّف بكونها أشتات مجتمعات في التربية والتنمية لما تبدو عليه النصوص لأول وهلة كموضوعات متفرّقة تكاد لا تكون كتابا “تقليديا” يبنى فيه كل فصل على سابقه.
إلا أنّ القارئ المتأمل في محتويات العمل يدرك بعد ربط علاقات معنوية بين النصوص أن خيطا فكريا رابطا ونسجا إبداعيا اهتمّ بالمعضلة التربوية وبجوانبها المختلفة فعمل على توظيف مظاهر الخلل العام في الأنظمة التربوية العربية الإسلامية من ذلك مشكلة قصور المناهج التعليمية وأزمة منظومة القيم المنشودة والمبثوثة، المكانة الهامشية للغة العربية في المنهج وفي التدريس.
أما القيمة المضافة في هذا الكتاب فتتمثل في المنهجية العلمية المذكّرة بالمفهوم النظري والإجرائي قبل شروعه في أي تحليل وفي حسّه النّقدي وأساسا في سعيه لتقديم الإضافة ومحاولة صياغته لحلول مساعدة على المعالجة والإصلاح وفي جهده المتمثل في تقديم رؤى جديدة ميسرة لمشاريع إنتاج نماذج تأصيلية متأملة في التجارب الكونية الحديثة.
لقد بذل الباحث جهدا يحسب له تمثل بالأساس في تحقيق مختلف أغراض الكتاب إلا أنّ المؤلّف لم يتطرّق بصفة مستفيضة لجل الأسباب الفكرية والتطبيقية التي حالت وتحول دون تطوير المنظومة التربوية العربية ولم نتوقع إلا انعكاسات محدودة لمثل تلك العوائق والصعوبات الموصوفة.
لقد اجتهد الباحث في التأمل في عديد مظاهر التأزم التربوي وركز محاضراته الملقاة في مناسبات علميةعديدة وفي مقالاته المنشورة في دوريات محكمة وغير محكمة وجمع عديد المعلومات إلا أنه لم يتوخ منهجا منظوميا في تناوله لمظاهر الإعضال.
لقد ساعدنا هذا المؤلّف على استكناه الخطاب المبثوث في فصول فأثار فينا عديد التساؤلات الواقعية وولد فينا أفكارا وتصورات عديدة.
2-أما الكتاب الثاني فهو مؤلّف لـ: محمود الذواديالدي جاء تحت عنوان ” التخلّف الآخر. عولمة أزمة الهويات الثقافية في الوطن العربي والعالم الثالث”، الأطلسية للنشر، تونس 2002م).
تعتبر كتابات محمود الذوادي الباحث في علم الاجتماع والمهتمّ بالظاهرة الثقافية والتربوية في العالم العربي والإسلامي والعالم الغربي من الكتابات القيمة والمسكونة بهاجس التغيير الاجتماعي انطلاقا من الثقافة والخصوصيات التي تميّز الشعوب والمجتمعات العربية.
دارت فصول هذا المؤلّف القيم حول ما يسميه الذوادي “التخلف الآخر” المتمثل في ظاهرة لغربة ثقافية نفسية تنتشر في مجتمعات العالم الثالث والمغرب وبلدان الوطن العربي.
فهو يرى أن اللغة والثقافة تصبحان متخلفتين في مجتمعهما إذا لم تستعملا بالكامل في كل شؤون مجتمعهما وبصفة خاصة في التربية والتعليم والتكوين للأجيال والأطر المهنية.
فاللغة العربية أصبحت مكون الهوية العربية الإسلامية متخلفة بسبب الاستعمار والتغريب للشعوب العربية الإسلامية مما أدى إلى تهميشها وإقصائها.
أما التخلف اللغوي النفسي الذي بحث فيه الباحث فيتمثل في شعور الإنسان العربي بمركب النقص والدونية إزاء الغرب.
مكننا هذا المؤلف من وصف دقيق للتخلف اللغوي الذي لحق باللغة العربية بسبب الاستعمار والتغريب بالعالم العربي و بصفة أخص في منطقة المغرب العربي حيث أكد فيه على انعكاسات الازدواجية و إحياء اللهجات البربرية و الأمازيغية على الهوية العربية الإسلامية .بذل هذا الباحث جهدا مضيف و ظف فيه مقاربات انتروبولوجية و نفسية اجتماعية إلا أننا لم نعثر في خطابه على اتجاه منهجي ينحو نحو تشخيص علمي للمعضلة التربوية في العالم العربي و الإسلامي ما عدا فرضيته التفسيرية المتعلقة بالتراجع في استعمال لغة الام في الجامعات و التغاظي عن منافسة اللغة الأجنبية على حسابها.
- أما الدراسة الثالثة فهي مؤلف(السلطوية في التربية العربية ) ليزيد عيسى السورطي الصادر بالكويت ضمن سلسلة عالم المعرفة لسنة 2009 م.
جاء هذا الكتاب محاولة لإلقاء بعض الضوء على مظاهر السلطوية في التربية العربية ونتائجها، في وقت أخذت تشهد فيه المنطقة العربية مرحلة بدأت تتعالى فيها أصوات كثيرة تدعو إلى مراجعة التربية العربية، وإعادة النظر فيها وإخضاعها للفحص والتدقيق.
كل ذلك أملا في زيادة جرعة الحرية فيها وتخليصها من القيود التي تكبل الطلاب وتحريرها من كل إشكال التسلط والقهر والتعسف والعنف، لعلها تتمكن من خلق فرد قادر على مواجهة زمان أصبح للعولمة فيه تأثير كبير بشكل خاص في الوطن العربي لما تفرضه من تحديات.
أكد السورطي في هذا المؤلف أن التربية التي تقوم على العنف والتعسف والقهر والتسلط ومصادرة الحرية هي أقصر الطرق لتحطيم الفرد وتدمير المجتمع.
لقد أكد تقرير التنمية العربية الرابع أن التربية في العالم العربي والإسلامي تخنق حرية الطالب والمعلم معاًفهي تعاني أمراضاً مستعصية تمثلت في مشكلات كثيرة وأزمات حقيقية تعيق مسيرتها وتقف حجر عثرة أمام تحقيق أهدافها.
أكد الكاتب أن السلطوية هي من أهم تلك الأمراض التي يعانيها الجسم التربوي العربي و من أهم المشكلات التي التي تستعصى على الشفاء، فهي نقيض الحرية، أو بالأحرى نقيض للتربية في أجل أهدافها، يقوّض مهارات الفرد ويعطل طاقاته، ويصيب قدرته بالشلل، ويحول بينه وبين الإبداع و تفجير طاقاته ودفعه للإنتاج، وإعداده ليكون مفكراً متفوقاً معتمدا على ذاته .
فهو يرى “أن السلطوية ظاهرة تتفشى في كثير من نظم التربية والتعليم في الوطن العربي، فتعمل على الحد من كفايتها وفاعليتها، وتسهم في إعاقة تحقيقها أهدافها، فالجو الذي يسيطر على عدد كبير من المؤسسات التربوية العربية هو جو الكبت الفكري الذي يعمل على تعطيل طاقات النمو، ويؤدي أحياناً إلى رفض الطالب لتلك المؤسسات”.( يزيد عيسى السورطي،2009).
يؤكد السورطي أن التربية الحرة لا تتحقق إلا في ظل وجود مجتمع متحرر من التسلط، لأنها ليست سوى نسق فرعي من النظم الاجتماعية تتأثر بها، وتستجيب لها، وتؤثر فيها أيضاً.فالسلطوية في التربية العربية بشكل عام هي ظاهرة مرضية تمتد جذورها في البنية الاجتماعية العربية التقليدية التي تخشى إطلاق القوى الإبداعية وتنكرها، وتحاول كبتها، وتشجع الانقياد والامتثال والإذعان والاتكال والتقليد والمحاكاة، وتعمل على التكيف والاندماج ضمن البنى الاجتماعية القائمة.
يرى الباحث أن المجتمع السلطوي بمؤسساته الاجتماعية (العائلة، والطائفة، والعشيرة، والقبيلة) ينتج معلمين متسلطين، كما أن المعلمين السلطويين يسهمون في إنتاج طلاب سلطويين أيضاً.
يري الباحث أيضا “أن العملية التعليمية تقتصر على ” التلقين ” و”التعليم البنكي”، الذي يحصر دور الطلاب في الحفظ والتذكر وإعادة ما يسمعونه، من دون أن يتعمقوا في مضمونه واستقبال المعلومات وتخزينها من دون وعي”وأن المناهج العربية التي تبقي الطالب أسيراً للكتاب المقرر والمدرس الذي يدرسه تجعل الطلاب عيسيري الانقياد وعاجزين عن بناء التفكير أو الحكم المستقل والناقد.
أما الإشراف التربوي فهو أسلوب يقوم على تحديد الأهداف ووسائل تحقيقها وتقييم النتائج، ويهدف إلى مساعدة المعلم وتوجيهه ورفع مستواه، لكن الإشراف كثيراً ما يمارس في عدد من المدارس العربية كعملية سلطوية مزاجية تفتيشية تهدف إلى تخويف المعلم وإحراجه وإظهار نقاط ضعفه من دون بذل جهد كبير لمساعدته على التغلب عليها ويتحول فيها المعلم بذلك إلى تلميذ ويصبح المشرف معلماً تقليدياً سلطوياً يلقن ويعاقب من يشاء بطريقة عشوائية في أحيان كثيرة.
ويوضح السورطي أن جوهر الإشراف التربوي هو إقامة تفاعل بين المعلم والمشرف يؤدي إلى تغيير إيجابي في سلوك المعلم.
ينتقل السورطي إلى الإدارة التربوية، حيث يرى أنها تتميز بغلبة طابع التسلط عليها، وكثيراً ما يأخذ ذلك شكل المركزية الشديدة التي تعني الاتجاه نحو تركيز السلطة والرجوع إلى المركز في كل القرارات المنظمة للعمل.
ولعل من كبرى المشكلات التي تواجه المدارس العربية، على المستوى المدرسي، بشكل عام هي مشكلة المركزية الإدارية المتطرفة التي تجعل من الهيئات أدوات لتنفيذ تعليمات الجهاز المركزي وأوامره إضافة إلى الضعف في كفاءة مديري المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.
فسر الباحث غياب الحرية الأكاديمية بالسلطوية التي تحرم الطالب حرية التفكير والتعبير والاعتقاد.فهو يعتقد أن العملية التعليمية برمتها تعتمد تكافؤ في فرص النمو المعرفي وتطورها، وتوفيرا لمناخ الاستفادة من منجزات العلم والتراث الحضاري الإنساني في إثراء المناهج الجامعية، وهذا لا يتمرأيه إلا من خلال مبادئ تشمل حرية الاختيار، وحرية التفكير والتبصر، والاستنتاج، فالحرية الأكاديمية إذن ضرورة للجامعة بها تتطور و و بهاتتقدم.
ينعى السورطي على اللفظية التربوية بمعنى استخدام كلمات رنانة لا تحتوي في حقيقة الأمر على مضمون كبير، فالكلمات تستخدم في حد ذاتها على حساب المعنى، وهذه السيطرة اللفظية تحول التربية من أفعال تنبض بالحياة إلى أقوال جامدة، ومن سلوكيات عملية حية إلى تنظير منفصل عن الواقع، ومن تركيز على الجوهر إلى اهتمام بالشكل، ومن روح تسري في المجتمع إلى مجرد ظاهرة صوتية، والعملية التعليمية العربية بشكل عام تقوم على اللفظية شرحاً وتوضيحاً وتلخيصاً، وخطباً، أما نصيب العمل فقليل.
يبرز الكاتب في نهاية كتابه أن للسلطوية التربوية آثارها ونتائج وخيمة منها إعادة إنتاج التسلط في معاهد التعليم التي يلتحق بها الطلاب في كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وعدم تحرير الطلاب من تلك المظاهر وإضعاف النظام التعليمي.
لقد أشارت نتائج دراسة أجريت في إحدى الدول العربية بشأن التسرب إلى أن (62%) من الطلبة المتسربين عبروا عن كرههم للمدرسة بسبب سوء التدريس والإدارة وسوء معاملة المعلمين لهم وتعرضهم للعقاب. أما شيوع الأمية فيعتبره السورطي من أخطر مظاهر السلطوية في المجتمعات العربية، وحرمان الفرد من التعليم فهو أحد أساليب القهر عنده وتعدٍّ على حقوق الإنسان وفكره ووعيه السياسي والاجتماعي خاصة في ظل التطور السريع الذي عرفته المعرفة البشرية كما وكيفاً، والتحول الاقتصادي من الاعتماد على الزراعة إلى الصناعة المتقدمة التي تحتاج إلى تدرب وإعداد يعتمد عل قاعدة ثقافية تقنية متجددة.
تمثل الأمية للديه أحد مظاهر الإخفاق في النظم التربوية العربية بشكل عام، وتعتبر واحدة من صور الأزمة التربوية التي تعتريها، فالوطن العربي لا يزال مقيداً بأغلال الأمية وما يرافقها من آثار ونتائج ضارة تنعكس سلباً على الإنسان العربي الذي هو محور التنمية وهدفها.
أما النتيجة الأخطر في رأي الكاتب فهي زيادة مستوى الاغتراب لدى المعلمين والطلاب والتي تعني الوجود الجسدي أو المادي للمجتمع والانفصال الروحي والنفسي عنه، وعدم المشاركة في الأنشطة الاجتماعية وعدم الرضا عن أوضاع المجتمع ونظمه وقيمه وعقليته السائدة مع الشعور بعدم القدرة على التأثير في الشؤون الخاصة والعامة، بالإضافة لشعور الفرد بغياب المعنى في حياته وغياب القيم الثابتة أو انحلالها وتناقضها وازدواجيتها، مما ينتج عن ذلك الفردية المتطرفة والانتهازية والنفعية والاعتماد على الحظ والمصادفات.
ساعدنا هذا المؤلف إلى حد كبير على التعرف إلى أهم الأسباب المفسرة للمعضلة في العالم العربي والإسلامي و مكننا من استقراء الواقع التربوي العربي ويسر علينا مهمة التشخيص النسقي للمعضلة التربوية و التعليمية وأمدنا ببنك أبحاث عربية وأجنبية عدنا إليها عند الحاجة لوصف الإعضال والفشل الذي لصق بالمخرجات التربوية والتعليمية وغابت النظرة النقدية وهيمنت عليه مسحة تجزيئية جعلت الباحث يبحث في أثركل الأشكال السلطوية الدالة وغير الدالة.
كما أنه لم يعتمد كغيره من الباحثين منهجا تشخيصيا ينطلق من مخرجات التعليم و التربية ولم يعتمد مقاربة منظومية في وصف الإعضال المتعلق بسمة سلبية تعد الأخطر على الإطلاق. هذه أهم مزايا هذه الدراسة القيمة إلا أن ما يمكن أن يلاحظ في هذا العمل أنه رغم ما بذل من جهد في التوصيف والتحليل لم يرتق إلى مراق نقدية لمسألة سلطوية التربية العربية واكتفى بوصف المظهر وذكر الدراسات التي اهتمت به.ومهما يكن من أمر يعد مؤلف السورطي عملا جريئا يدفع الباحثين إلى الاهتمام بمثا هذه المسائل المسكوت عنها بسبب انحسار حرية الرأي والكلمة في مجتمعات تنشد النهوض والتحررمن الوصاية الخارجية والداخلية على شعوبها ومؤسساتها.
10– الإضافة النوعية للبحث:
لقد مكننا الإطلاع على عديد الأدبيات(كتب ،مقالات رقمية، ورقة، أبحاث، رسائل ماجستير، أطروحات دكتوراه) أنّه ثمة خلل في المنظومة التربوية وأنّ المخرجات في تدنّ من يوم إلى آخر غير أنها اهتمت بالمشكل (وصف المعضلة) على حساب الانعكاسات على تكوين الأجيال وإثرها في المجتمعات ولم تبلور تصورات لرسم ملاح نظام تربوي أصيل يشمل كل المراحل التعليمية ما عدا بعض المحاولات الأحادية المركزة إما على التراث أو على المعاصرة.
لقد مكنتنا العودة إلى الأدبيات السابقة التي عثرنا عليها لحد تحرير هذه الأسطر من التعرف على أهم الأولويات التي اعتبرها أصحابها في دراسة الأزمة التربوي واستكشاف أبرز المقاربات التي تناولوا بها الواقع التعليمي العربي. ومما تجدر ملاحظته هنا أننا وقفنا على مجهود بحثيي مبذول و بصفة خاصة من قبل كل من الباحثين (أحمد المهدي عبد الحليم و ومحمد جواد رضا ويزيد عيسى السورطي) الذين حاولوا كل من موقعه و اختصاصه تحليل جوانب عديدة من المعضلة التربوية وصياغة فرضيات تفسيرية عديدة و اقتراح حلول وجيهة إلا أنهم لم يحاولوا القيام بتحليل منظومي ينطلق من المخرجات ويصوغوا فرضيات تفسيرية بعد التأمل في العملية التربوية وفي مدخلاتها. هذا ما يمكن أن يعد في حقيقة الأمر خصوصية من خصوصيات مقاربتنا التشخيصية والتقييمية البحثية.
ذالك ما سنحاوله من خلال استقراء للواقع و محاولة التقدم بفرضيات مشروع مستند إلى صيغة تكاملية، يحاول رسم ملامح نظام تربوي أصيل يرسى في سياق عالمي وعربي لم يبق فيه للتعليم نفس القيمة المركزية في عملية التقدم والتنمية الاجتماعية التي كانت له من قبل .
مقدّمة البحث:
أمام هذا الاختناق الحضاري المهدد لأمتنا بالتذويب والتهميش منذ بدايات القرن العشرين تقريبا بدا لزاما على مجتمعاتنا أن تتأمل وتحلل شروط الخلاص في مختلف المجالات الفكرية، الثقافية، الاقتصادية والاجتماعية وقد تقرر في مختلف الرؤى والتصورات الفكرية أن السيل إلى حماية الهوية والوجود والخروج من دوامة التخلف لا يكون إلا بالتأصيل والتجدد والعمل المنهجي الاستراتيجي. وفي ظل الظروف التي تعيشها أمتنا العربية والإسلامية التي دخلت القرن الحادي والعشرين بأمية (41) بالمائة من بين الرجال و (61) بالمائة من بين النساء ناهيك عن أمية ثقافية تستغرق (80) بالمائة تتبين مدى الأهمية القصوى للعناية بالتربية والتعليم كان من الأولويات أن يهتم المختصون والمعتنون بالشأن التربوي لعلهم يسهموا بعلمهم وخبراتهم وتجاربهم في نهضتنا وإقالة عثرتنا.فالتربية والتعليم في العالم العربي الإسلامي يحتاج اليوم إلى مراجعة نقدية شاملة لأهدافها ومناهجها وطرائق عملها.
ولما كانت التربية مدخلا أساسيا لبناء الشخصية المؤمنة بربها والمعتزة بدينها وبسنة رسولها محمد• وإعداد الفرد الفاعل والمبدع الواعي باستخلافه في الأرض كان لزاما علينا أن نشخص مظاهر الخلل في التربية العربية والإسلامية ونتعرف على الأسباب والانعكاسات والآثار التي يمكن أن تنجر عن تلك العطالة.
وكان الأوكد أن نجتهد في إمكانات الإجابة المتعلقة بكيفية إرساء نظام تربوي أصيل يجدد لهذه الأمة دينها ويرفع رايتها ويخرجها من الجمود الذي آلت إليه.
وهنا يجدر التذكير أن الأصالة التي نقصدها هي أصالة مضاعفة، أي تأصيل للتراث الفكري واحترام لحاجات الأفراد وما يستوجبه من تجدد ومواكبة لمقتضيات السياق والعصر، فهي عود إلى الأصل في معنيين متكاملين:
- المعنى الزمني التاريخي (التراث)
- المعنى الطبيعي الإنساني الكوني ( التأصيل عندنا هو تمش وسيرورة يشترك فيها السابقون واللاحقون).
بادئ ذي بدء وقبل الاهتمام بدراسة الإعضال يجدر بنا أن نذكّر بالمجهود الذي قامت به الدول العربية في المجال التربوي والتعليمي:
لقد تعددت سياسات الأقطار العربية وخططت لتطوير التعليم فتتطور الكم (استيعاب أكبر عدد من التلاميذ الذين هم في سنّ الدراسة بسبب ما تشهده الأقطار العربية من تفجّر وزيادة هائلة في السكان) فأتيحت فرص أوفر للمستحقين له من الصغار وتطورت نسب المسجلين بالتعليم الثانوي العام (22,5 مليون طالب سنة 2000م) ومن تطور ملحوظ في أعداد المسجلين في مرحلة التعليم العالي تؤكّده المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التي تتوقع أن يصل سنة (2010م) إلى 6 ملايين طالب.
لقد حظيت عمليات تطوير المناهج التربوية العربية بالاهتمام على المستوى القطري والعربي وحصلت تغييرات بفضل التعليم ومنها مشاركة المرأة في التعليم والعمل وارتفع مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي والسياسي وتطورت بعض مضامين البرامج التربوية وتوسع مفهوم التربية ليشمل التربية السكانية والبيئية والمدنية (محمد نجيب بوطالب 2005).
هذه بعض المظاهر تصف تحقيقا ما لأهداف المنظومة التربوية العربية إلا أنّ تقارير الإستراتيجية العربية تؤكّد على ظهور عديد الأعراض الواصفة لتعثر المنظومة في بعض مخرجاتها وتمشياتها ومدخلاتها.
من ذلك ما أكّده تقرير استراتيجية تطوير التربية العربية (الاستراتيجية المحدثة ) لسنة 2006 من:
- سياسات تربوية أحادية الرؤية والهدف، نمطيّة المضمون تميل إلى التقليد والمحاكاة أكثر منه إلى التجديد.
- طغيان الجانب الكمي على الجانب النوعي في المدخلات والمخرجات التربوية (محدودية النوع والكيف فيما يتعلق
بالإعداد والتدريب للمعلمين وصياغة المناهج وتأليف الكتب وتهيئة الفضاءات التربوية).
- عدم توسّع التعليم المهني والفني بالشكل المطلوب.
اهتمام محدود بالتربية قبل المدرسية تبرره عدم ترجمته إلى خطط وبرامج تربوية وتعليمية تنفيذية (نسبة القيد بين 15% و20%) ممن هم في سنّ هذه المرحلة.
- تهميش للتربية قبل المدرسية : حيث ظلّت مهمشةلسنين طويلة على المستويين الأهلي والوطني ما دامت تعتبر لحد الآن نوعا من الترف للأسرة الميسورة الحال.
- انتشار للأمية: ينتشر في أرجاء الوطن العربي (بين 65 و70 مليون) أمي في الوطن العربي وأغلبهم من النساء وأبناء الريف وبناته.
- استمرار تخرج أعداد كبيرة في مراحل التعليم كافة دون النوعية والمستوى المطلوب (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،2006) أي بمخرجات غير مؤهلة لأخذ الدور المطلوب في المساهمة في التنمية والتطوير.
- تشرب الخريجين لمعلومات يغلب عليها طابع اللفظيةو الحفظ والاستظهار وغياب البناء للمعرفة وتملكها بواسطة التأمل والتقويم الذاتي والممارسة الفردية والجماعية.
فرغم المجهودات المبذولة والتي تحسب للمدرسة العربية التي نشأت مع استقلال تلك الأقطار فإنها تعاني من مشكلات عديدة لعل أبرزها:
- أمية المرأةو تعليمها: رغم تطور تعليمها ودخولها المدرسة في جل مراحلها لازالت أميتها وحضورها في الإنتاج يشكل عائقا للتنمية.
- تطور محدود لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقون والموهوبون) وبالتالي تطور محدود للمؤسسات الخاصة المهتمة بهذه الشريحة من المتعلمين فهم يحتاجون رعاية خاصة وبرامج إفرادية تفريقية وإعدادا خاصا لمعلميهم.
تواضع الإعداد المهني للمعلم فبل الخدمة وأثناءها في جل المراحل التعليمية: حيث لازال دون المؤمل فهو لا يهتم ببناء هوية مهنية فاعلة متأملة مسؤولة مجددة (رضا ساسي،2008) ولا يمكن من اكتساب كفايات تعليمية ومواصفات تؤهلهم تربويا ونفسيا وعلميا لأداء مهمتهم.
- التعليم الفني والمهني: مكانة متواضعة للتعليم الفني والمهني رغم المجهود المبذول بسبب النظرة المتدنية إليه في المجتمع فضلا عن الدخل المحدود للعاملين المهنيين.
- التسرّب: تزايد نسب الرسوب والانقطاع في جل الدول العربية.
هجرة العقول العربية: يهاجر ذوو الكفاءات العالية والتخصصات النادرة إلى خارج الوطن العربي بحثا عن بيئة جديدة تحتضنهم وترعاهم وتمدهم بالدعم المادي والمعنوي.
إضافة إلى ما سبق من وصف مختصر للمشكلات التربوية التي تواجه التربية العربية في فترة ما بعد استقلال البلدان يجدر التأكيد على ما يلي:
- انفصام بين مضامين التربية والتعليم والتكوين وبين الحقل الثقافي والاجتماعي.
- عجز التربية بوضعها الراهن عن توفير مطالب المفهوم الجديد للتربية المؤكد على أولوية التعلم على التعليم.
- عجز أنظمة التربية عن تحقيق ما يسمى بديمقراطية التعليم واستيعاب المستحقين للتعليم وحرمان فئات كبيرة أغلبها من الفتيات الريفيات خاصة.
- ضعف المردودية أو الكفاية الداخلية للأنظمة التعليمية والتكوينية.
- ضعف مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل الفعلية.
- تخرّج أجيال عربية ليس إلماما بالمعرفة الإسلامية والإنسانية وفصل بين المعرفتين.
- ضعف ملاءمة الأنظمة التربوية للأهداف والغايات المستوردة لمطالب المجتمع وبالتالي ضعف كفاياتها الخارجية
- اقتصار التربية العربية على إكساب المعرفة دون الجوانب الروحية والأخلاقية والوجدانية.
- أزمة الجامعة والتعليم العالي.
- اغتراب طلابي مستفحل.
وصفوة القول هنا أن الأنظمة التربوية العربية قد حاولت تحقيق بعض الأهداف والغايات المنشودة من حيث الكم إلا أنها عجزت عن تحقيق مخرجات نوعية عديدة عمقت تخلفها وتبعيتها للمستورد.
لذلك سنهتم في هذا البحث بتشخيص المعضلات – المخرجات وفق منهج تحليلي يحاول وصف مظاهر الإعضال وشرح أسبابها الفكرية والتطبيقية ويسعى لتوقع انعكاساتها على الأجيال وأثرها في المجتمعات العربية والإسلامية.
رجعنا إلى الدراسات والتقارير والأدبيات وأعمال مراكز البحوث العربية والأجنبية معتمدين مقاربة منظومية لتتابع الخطاب المتعلق بهذه المعضلات في جل مراحل التعليم التي مكنتنا من انتقاء المتكرر والمنتظم في خطاب المعضلة فكان أن اخترنا المظاهر التالية التي سنتولى تتبع أسبابها الفكرية والتطبيقية وتوقع انعكاساتها على تكوين الأجيال ونقتفي أثرها على المجتمعات وهي على التوالي:
- معضلة الأمية الأبجدية بالعالم العربي والإسلامي:
- مظاهر معضلة الأميّة الأبجدية
- من الأسباب المفسرة لمظهر الأمية
- من انعكاسات الأمية على تكوين الأجيال وآثارها على المجتمعات
- تدني مخرجات التربية قبل المدرسية:
- معضلة القيد للالتحاق بالتربية قبل المدرسية
- انعكاسات ضعف القيد المسجلة بمرحلة التربية قبل المدرسية في العالم العربي والإسلامي
- أثر ضعف القيد في نهضة المجتمع العربي
- الأسباب الكامنة وراء هذا القصور البيداغوجي
- تدني المخرجات المتعلقة باللغة العربية قراءة وكتابة وتخاطبا:
- مظاهر الضعف في اللغة العربية
- الأسباب الكامنة وراء الضعف اللغوي الموصوف
- انعكاسات تدني المخرجات المتعلقة باللغة العربية
- تدني المخرجات المتعلقة بالرياضيات والعلوم والتفكير النقدي:
- مظهر المعضلة المتعلق بتدني المردود العلمي والفلسفي للمدرسة العربية
- من الأسباب المفسرة لندرة التفكير العلمي والنقدي:
- من الأسباب الفكرية و التطبيقية المفسرة للظاهرة
- من انعكاسات تدني المردود الفكري على مستوى تكوين الأجيال
- من آثار التدني في المخرجات المتعلقة باكتساب التفكير العلمي في أوضاع المجتمعات العربية
5 -مظاهر الاغتراب لدى الطلاب في العالم العربي والإسلامي:
- واقع الاغتراب لدى الطلبة العرب
- من الأسباب المفسرة لظاهرة الاغتراب الطلابي
- من آثار الاغتراب الطلابي
6 – ضعف استبطان القيم الأخلاقية والمدنية:
– العنف المدرسي: بعض مظاهره، انعكاساته ،آثاره،
– الغش الطلابي في الامتحانات المدرسية لدى الطلاب:بعض مظاهره ،انعكاساته ،آثاره
7- صياغة الفرضية الرئيسية للمشروع:
- غياب الأصالة والتأصيل
- تصور ات ومقترحات حول ملامح مشروع نظام تربية أصيلة
المبحث الأول
معضلة الأمية الأبجدية بالعالم العربي الإسلامي
مقدّمة:
تعدّ الأمية ظاهرة اجتماعية معقدة التركيب تمتد من حيث مدلولاتها وأشكالها امتدادا خطيرا تؤطره الأبعاد المتشابكة لقضايا التنمية والتربية في المجتمعات المختلفة وبصفة خاصة في البلدان العربية حيث تبدو الصور أكثر تعقدا رغم إيمانها بضرورة إزالة معوقات التنمية والتغلب على التخلف بأنماطه المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة.
أولا: مظاهر معضلة الأميّة الأبجدية:
على الرغم مما تحقق من مبادرات وبرامج في سبيل تطوير أساليب مواجهة الأمية عجزت الجهود المبذولة بالوفاء بمتطلبات النجاح الكمي الكيفي حيث لا تزال الأمية معضلة تربوية عربية حقيقية، ذلك ما تشير إليه الأرقام التي أوردتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو) نقلا عن دليل التنمية البشرية لسنة (2007م-2008م) الذي أصدرته الأمم المتحدة أن (29,7%) من سكان الوطن العربي أميون أي ما يناهز 99,5 مليون أمي عربي تتجاوز أعمارهم 15 عاما.
وكشف التقرير أن العالم العربي والإسلامي لازال يعاني من أمية معرفية ورقمية، حيث يعاني ثلث السكان الكبار بالمجتمع العربي من العجز عن القراءة والكتابة، وتقدر الإحصائيات أن عدد الأميين بالعالم العربي والإسلامي يصل إلى 60 مليون أمي يتشكل ثلثاهم من النساء كما لا يزال 9 ملايين طفل في سن التمدرس خارج المدرسة. وسجل التقرير أن توزيع الكتب المنشورة بالبلدان العربية يصل في المتوسط إلى كتاب لكل 20 ألف مواطن، وهي نسبة قليلة جدا مقارنة مع بعض البلدان، حيث يصل المعدل إلى كتاب واحد لكل 491 مواطن في بريطانيا، و كتاب واحد لكل 713 في اسبانيا. فبالنسبة للمغرب مثلا صنف تقرير المعرفة العربي لعام 2009م هذا البلد في المراتب المتأخرة من حيث نسب الأمية سجل مستويات متدنية وكشف صورة قاتمة عن وضع المعرفة في البلدان العربية مقارنة مع العديد من دول العالم.
وتكشف المعطيات الواردة في التقرير الذي أصدرته بدبي مؤسسة محمد بن راشد المكتوم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية عن التفاوت الكبير على المستوى المعرفي بين دول العالم العربي والإسلامي، و بين هذا الأخير وبين بلدان العالم المتقدم. فالمغرب مثلا يأتي في المراتب المتأخرة من حيث نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة بين الدول العربية بحوالي 41 في المائة من نسبة الأمية. بينما لا يتجاوز معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي في البلاد عتبة 56 في المائة، حسب تقرير المعرفة العربي لعام 2009م وتنخفض هذه النسبة على مستوى الالتحاق بالتعليم العالي إلى 11 في المائة في المتوسط، وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع العديد من بلدان المنطقة العربية. ويكشف التقرير أن عدد الأطفال في سن التمدرس الذين يوجدون خلف أسوار المدارس بالمغرب يصل إلى حوالي 395 ألف طفل، منهم 237 ألف من الإناث، و157 ألف من الذكور، وهو ما يجعل المغرب رابع أعلى نسبة في الهدر المدرسي، بعد كل من اليمن والعراق والسعودية.
هذا بالنسبة للأميين الذين وصلوا هذه السن ولم يلتحقوا بالمدرسة بتاتا، أما بالنسبة للذين التحقوا بفضاءات التعليم والتعلم فقد تفاوتت معدلات الاهتمام بالقراءة والكتابة من بلد لآخر للبالغين بداية من سن 15 فأكثر حيث سجلت المغرب مثلا بنسبة 52% من الملمين بالقراءة والكتابة وسجلت موريتانيا 51,2% من نفس الفئة.
أما فلسطين المحتلة فقد حققت نسبة 92,4% أي أن نسبة ضئيلة جدا 7,6 % فقط لا تحسن القراءة والكتابة وهو لعمري تحد واضح لمقاومة الجهل يحققه هذا الشعب رغم الاحتلال الصهيوني البغيض والحصار المفروض.
ذلك ما أكده تقرير التنمية الانسانية العربية الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2009م لقد سجّل هذا التقرير أن نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة للشريحة التي بلغت 15 سنة فأكثر بلغت 58,2 % أي أن 41,8 % تردوا إلى الأمية.
تؤكد هذه النسب المفزعة أن الأمية القرائية والكتابية تشكّل فعلا عقبة تعوق التقدم وتعطل التطور الاجتماعي في مختلف النواحي وتقف حجر عثرة أمام تحقيق الأهداف المنشودة.
إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا ماهي الأسباب التي تكمن وراء ذلك؟ سنحاول وباختصار وإيجاز تحليل تلك الأسبابب لنتأملها ونصوغ بعض الفرضيات الفرعية انطلاقا منها:
ثانيا: من الأسباب المفسرة لظاهرة الأمية:
- الأسباب الاجتماعية:
لقد كانت العادات والأفكار والقيم الاجتماعية الخاطئة في الوطن العربي من بين الأسباب الموجدة لمشكلة لأمية، من ذلك ما يعتقده الكثيرون بعدم أهمية تعليم الفتيات مما أدى بالبعض أن أسبغ على الاعتقاد طابعا دينيا وألبسه ثوبا إسلاميا (السورطي، 2009) على الرغم من أن ديننا الحنيف قد شرّف القراءة بأول آية نزلت على محمد ص• ﴿ ٱقْرَأْ بٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ، خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ، ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَم ﴾ (العلق: 1-2-3)، “بلغوا عني ولو آية”[1] ص•.
وجعل العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وهي في حقيقة الأمر دعوة صريحة للتعلم:”من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له به طريقا إلى الجنة” والتحذير من الوقوع في براثن الأمية.
- الأسباب الثقافية:
ومما زاد في انتشار الأمية واستفحالها تدني المستوى الثقافي كالعدد كبير من الآباء والأمهات غير المندفعين لتعليم بناتهم وأبنائهم.
إنّ قلة وعي الأولياء بأهمية التمدرس ينعكس لا محالة على بناتهم وأبنائهم ويقلل من فرص التعلم:”ذلك ما بينته نتائج
إحدى الدراسات أن 16% من الدارسين في مدارس محو الأمية ومراكزها في إحدى الدول العربية لم يلتحقوا بالمدارس عندما كانوا في سن التعليم الإلزامي لأن أولياء أمورهم لم يقدّروا أهمية التعليم واعتبروه شكلا من أشكال الترف وإضاعة الوقت”.
إنّ تدنّي المستوى الثقافي لكثير من الآباء والأمهات وأميتهم قد تفرز أميين كما يفرز المجتمع المتعلم متعلمين.
ج- الأسباب التعليمية:
يمكن القول بأنّ النظام التعليمي السائد في الوطن العربي مسؤول ولو جزئيا عن مشكلة الأميّة من عدّة أوجه أهمها:
1- وجود نسبة لازالت عالية من الفتيات والفتيان هم في سنّ التعليم الإلزامي من الذين لا يجدون لهم مكانا في التعليم الابتدائي تمثّل رصيدا متجددا من الأميين يضاف سنويا خاصة إذا علمنا أن في بعض البلدان العربية (المغرب مثلا) يحرم ما يناهز 44% من الالتحاق بالمدارس الابتدائية.
أما في موريتانيا فتحرم بنسبة 65% من التعليم الإلزامي وذلك ما أظهره (برنامج الأمم المتحدة لسنة 2009م)
- ضعف التكامل بين النظام التربوي التعليمي السائد في الوطن العربي وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار على مستوى التخطيط والتنفيذ ورصد المرتدين إلى الأميّة.
د- الأسباب الجغرافية:
يخضع توزيع المشاريع والميزانيات التربوية والتعليمية في الوطن العربي في بعض الأحيان لأسس ومعايير جغرافية، فالاهتمام ينصب أساسا على العواصم والمدن الكبرى على حساب مناطق الريف والبوادي التي تعاني سوء توزيع الخدمات التربوية والتعليمية (تواضع الإمكانات والمرافق التعليمية وندرة المدرسين ومحدودية قدراتهم…) كل ذلك يؤدّي إلى حرمان عديد المناطق من حقها في التعليم مما يضيف كثيرا من سكانها إلى قائمة الأميين.
لقد همّشت بعض الدول مثلا تعليم بنات الريف وأبنائه رغم تمثيلهم لأكثر من ثلاثة أرباع سكان الوطن العربي.
ذلك ما أظهرته نتائج إحدى الأبحاث في إحدى الدول العربية من نسبة تقرب 15,8% من المتعلمين بمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية الذين لم يلتحقوا بالمدارس الابتدائية لما كانوا في سن السادسة لانعدام المدارس في مناطقهم و9,8% منهم تردّوا إلى الأمية بسبب بعد المدارس عن مقرات سكناهم.
هذه بعض الأسباب المفسّرة لمظهر من مظاهر المعضلة التربوية في العالم العربي الإسلامي وهذه في حقيقة الأمر ما يمكن أن تمثّل فرضيات فرعية أولية مفسرة للخلل والتعطّل الذي طرأ على النظم التربوية العربية.
فإذا كانت هذه بعض الفرضيات المفسرة لمظاهر معضلة الأميّة الأبجدية فماهي انعكاساتها وآثارها على مستوى تكوين الأجيال وعلى المجتمعات بصفة عامة؟
ثالثا:من انعكاسات الأمية على تكوين الأجيال وآثارها على المجتمعات:
كيف تنعكس نسبة تناهز الأربعين في المائة تقريبا من الأميين والراشدين العرب على الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي والديني والاقتصادي في العالم العربي والإسلامي؟ وماذا يترتب عنها من انعكاسات؟
1- هو تكريس التقليد عند الأفراد والمجتمعات إنّ الانعكاس الأخطر على الأجيال العربية وغياب التجديد والتجدد على كل الصعد.
ستكون هي النتيجة المباشرة لسيطرة الأمية الأبجدية على ما يقارب نصف الكتلة البشرية العربية.
سوف لن يتوفّر لهذا الكم الهائل من الأميين أيّة وسيلة لاكتساب المعرفة سوى بعض الوسائل الشفهية والسمعية البصرية ولن تتوفر لهم وسيلة للتعبير عن آرائهم سوى عبر أدوات إخبارية.
ولعل أخطر انعكاس للأمية الأبجدية هو التناقض الذي وصفه (نبيل علي، 2006) في كتابه “الفجوة الرقمية بين ارتفاع
نسبة الأمية وطبيعة مجتمع المعرفة ومفهوم الذكاء الجمعي القائم على احتشاد العقول الذي لا مكان للأميين فيه “وهم بغيابهم عن عالم مجتمع المعرفة لا يضرون أنفسهم فحسب بل “قد يمررون ذلك إلى غيرهم بطرق مباشرة وغير مباشرة.”
2- أما الانعكاس الثاني هو أن هذه الكتلة الضخمة من الأميين ستصبح عديمة الفعالية في عصر غزاه عالم المكتوب وستكون غير قادرة على ممارسة حقها بكل عقلانية وتدير في الحياة الاجتماعية والسياسية.
ومن آثار كل تلك الانعكاسات هو الخوف كل الخوف من تحول تلك الكتل وفي حالات الدمقرطة الجزئية إلى مجموعة حاسمة في تحديد الخيارات الوطنية وأخذ القرارات، فيحكم الشعب برعاعه .
إضافة إلى خطر ارتفاع نسبة أمية عربية قد تضرب في عمق أي تنمية اقتصادية مرغوبة أو تخطيط تنموي بعيد المدى.
فإذا كانت نسبة البطالة في العالم العربي والإسلامي تعد من أعلى النسب في العالم (بين 16% و20%) فإنّ بينها وبين الأمية عامل ارتباط قوي ودال فما العمل أمام التحديات الكبرى التي تواجه الأمة العربية في السنوات القادمة والمتمثلة أساسا في الظفر بفرص العمل لملايين الأيدي الداخلة إلى السوق والباحثة عن موارد للرزق الدائم؟
- انعكاسات الأمية على الأجيال:
تكريس واقع الجهل والتعصب الأمر الذي يترتب عليه إعضال للتعامل الايجابي مع الرأي والرأي المخالف وانسداد قنوات التواصل والحوار وغياب أخلاق التواضع وثقافة التسامح والتعايش السلمي بين الأفراد والجماعات والشعوب.
أما في مجال المرأة فتعرقل الأمية الجهود المبذولة لترقيتها والرفع من مستوى نوعية تربية أجيال المستقبل وتعضل مساهمتها الاقتصادية وتأثيرها الاجتماعي.
كذلك تحول الأمية دون ممارسة الشباب الذي يعدّ القلب النابض في الأمة لحقه في التكوين المهني وتضعف حظوظه في
الحصول على شغل مشرّف وتقف حجر عثرة في طريق اندماجه الاجتماعي وما قد يترتب عن ذلك من جنوح وانحراف وآفات اجتماعية أخرى.
إذن كانت هذه مخاطر الأميّة الأبجدية وأهم انعكاساتها على الفرد وآثارها على المجتمع و بعد أن تعرفنا على لائحة من أسبابها البنيوية والوظيفية المفسرة بعض الشيء لاستفحالها وتغلغلها في المجتمع فماهي الحلول الأصيلة والإنسانية التي يمكن أن تحدّ من خطرها الداهم يوما بعد يوم وخاصة بعد هجوم أمية رقمية عميقة؟
هكذا إذن لم تعدّ مشكلة الأمية في كل أبعادها مشكلة تعلمية بل هي في الأساس مشكلة حضارية لذا ينبغي تحرير مفهوم الأمية من إطاره الضيق المقصور على القراءة والكتابة والحساب ومن اعتباره أيضا نشاطا تعليميا من الدرجة الثانية ليستوعب الأبعاد الحضارية والاجتماعية المنبثقة عنها.
المبحث الثاني
معضلة التربية قبل المدرسية المدرسية
مقدمة:
يستوجب منا صوغ فرضية لمشروع إحياء مستفيد من تجارب التراث ومعطيات الفكر الإنساني الحديث العمل بداية على فهم الواقع التربوي العربي وتشخيص المعضلة التربوية التي كتب عنها الكثيرون من الباحثين واهتمت مراكز البحث العديدة وأفردها الباحثون بالدراسة والتعمق.
لذلك سنحاول في هذا المبحث التذكير بأوجه الخلل الدالة ومحاولة شرح الأسباب الفكرية والعملية التي تكمن وراءها وتوقع انعكاساتها على مستوى تكوين الأجيال محاولين التعرف إلى أثرها على أوضاع المجتمعات نهضة وتعثرا.
إن وصف المشكل (إبراز مظاهر الخلل) والاهتمام بمحاولة الإجابة عن تلك الأسئلة يفرض علينا إذن الارتقاء إلى أهم سؤال في هذا البحث هو كيف يمكننا رسم ملامح نموذج نظام تربوي أصيل يحقق النجاح والامتياز لأبنائنا في جل المحطات التي تفرض عليهم خوض تحديات الواقع وفي الآن نفسه يمكنهم من اكتساب روح الاعتزاز بالهوية العربية الإسلامية والتشبع بالأخلاق القرآنية السامية ويقوي لديهم روحا رسالية وتمثلا لمعنى الإستخلاف القرآني.
لذلك سنحاول العودة إلى الدراسات العلمية والتقارير والأدبيات الواصفة لأوجه الخلل الدالة على انفصالها عن بعضها وسنعمل على تجميعها في فئة واصفة للمعضلة في المرحلة قبل المدرسية لتيسر لنا شرح الأسباب وتوقع الانعكاسات والأثر على الأجيال والمجتمع ومنها إلى محاولة صوغ فرضيات تسهم في بناء رؤية تكاملية للإنسان ولفعله الحضاري ترجمة لملامح نموذج تطبيقي. فماهي مظاهر الخلل الدالة في التربية قبل المدرسية أو التحضيرية للتعليم الأساسي في عالمنا العربي والإسلامي؟
لقد بينت العودة إلى الدراسات والتقارير والأدبيات المتعلقة بمظاهرالخلل في التربية ما قبل المدرسية في العالم العربي والإسلامي من استقراء ما يلي:
- ضعفا يقيد الالتحاق بمؤسسات التربية قبل المدرسية .
- ضعف الإعداد والتأهيل للمربين والمربيات المتخصصين والمتخصصات في التربية قبل المدرسية .
- تذبذب مناهج التربية في العالم العربي والإسلامي بين الطابع الديني والطابع الثقافي الغربي.
هذه بعض أوجه الخلل الدالة في التربية قبل المدرسية اخترناها لأهميتها دون التنقيص من أهمية غيرها من المظاهر أو الحد من أثرها وتفاعلها مع أخرى.
فماهو توصيف الدراسات والأبحاث والتقارير لمشكلة ضعف التسجيل بالمؤسسات قبل المدرسية في العالم العربي والإسلامي مقارنة بغيرها من المؤسسات في العالم الغربي مثلا؟
أولا: معضلة القيد للالتحاق بالتربية قبل المدرسية :
مقدمة:
وصف التقرير العالمي لمتابعة التربية للجميع سنة 2009 واقع الطفولة في العالم وسجل أن مائة وتسعة وثلاثين مليونا (139000000) طفلا تمتعوا سنة 2006م بخدمات التربية قبل المدرسية مقابل مائة واثنين وعشرين مليونا (122000000) سنة 1999م وأن النسبة الخام للتمدرس في الفضاءات التحضيرية للمدرسة بلغت (79%) في الدول المتقدمة مقابل (36%) في الدول المعبر عنها بالسائرة في طريق النمو.
أما الملفت للنظر في هذا التقرير الحديث أن ست دول عربية من ثمانية عشرة سجلت نسبة تغطية أقل من (10%) و أنّ ثلاث دول عربية فقط ارتقت إلى نسبة أقل من (20%).
كذلك أفادتنا حوليات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الصادرة سنة 2006 أنّ عدد رياض الأطفال (مثلا) بالدول العربية لم يعرف استقرارا ولا تحسنا دالا.
لقد بينت الإحصاءات التي أجرتها المنظمة المذكورة سابقا أن أعلى نسبة للتطور بين سنتي 2001م و2002م عرفتها مدارس ما قبل الإبتدائي سجلت بلبنان حيث بلغت (154%) تلتها تونس (106,9%) وكانت أدناها في كل من المملكة العربية السعودية (%3,8) ثم قطر (2,1%).
هكذا إذن وباختصار فإن الواقع الراهن للتربية قبل في العالم العربي والإسلامي يشير إلى تطور كمي ونوعي محتشم في بعض البلدان وتراجع واضح في دول أخرى.
فعلى الرغم من أهمية السنوات الخمس الأولى في حياة الطفل من حيث تكوينه وتوجيهه، فإن الاهتمام بالتعليم قبل المدرسي لم يترجم بعد إلى خطط وبرامج تربوية وتعليمية تنفيذية ولذا بقيت نسبة الملتحقين بهذا التعليم ضعيفة جدا في أغلب الأقطار(15%-20%) من عدد السكان ممن هم في سن هذه المرحلة (استراتيجية تطور التربية 2006). ولقائل أن يقول ماهي الأسباب التي تكمن وراء مؤشر التقصير هذا؟
ذلك ما سنحاول الإجابة عنه في المقال الموالي المتعلق بالأسباب الفكرية والعملية التي حالت دون تطور التربية قبل المدرسية.
1-من الأسباب المفسرة للظاهرة:
من الأسباب التي يمكن أن تفسر ذلك التقصير :
- أسباب تاريخية:
لقد ظلت التربية قبل المدرسية مهمشة لسنوات طويلة على مستوى الأسرة أو على المستوى الحكومي، حيث أن الكثير من السياسات تعتبره خارج نطاق المنظومة التربوية.
وتعود نشأة هذه التربية قبل المدرسية (في رياض الأطفال) إلى الستينات وذلك بمبادرة خاصة في بعض البلدان إلا التي اعتبرتها ترفا لا تتمتع به إلا الأسرة المحظوظة ماديا.
لذلك اهتم به القطاع الخاص لكلفته الباهضة وبذلك بقيت نسبة المتمتعين بهذه التربية ضعيفة في معظم أرجاء العالم العربي والإسلامي، هذا إذا كان القصد من ذلك رياض الأطفال المتأثرة بتجارب الغرب.
أما إذا كان المعني به “الكتّاب” الذي يعلّم فيه القرآن الكريم فإن لهذه المؤسسة تاريخا عريقا حيث حفظ فيها العديد من أجيال الأمة كتاب الله العزيز رغم الظروف المتواضعة التي كانت عليها بنيتها التحتية ورغم تواضع الأساليب والأدوات البيداغوجية المعتمدة آنذاك والتي زادها الاستعمار جهلا على جهل.
- الأسباب الثقافية:
قد يعود عزوف الأولياء عن تسجيل أبنائهم بمؤسسات التربية قبل المدرسية إلى وعي ثقافي ومعرفة دقيقة بخصائص الطفولة المبكرة ومرحلة التربية قبل المدرسية وإلى عدم اطلاع على مستجدات علم النفس الطفل الذي عرف انتشارا
واسعا في القرن الماضي. ألا يعود ذلك إلى جهل الأولياء بأبسط حقوق الطفل التربوية؟
كيف لا وعدد كبير من الأولياء في المجتمع العربي وإلى الآن يرزح تحت نير الأمية التي بلغت نسبة مخيفة تقترب من الأربعين بالمائة (40%) سنة 2009 (تقرير التنمية).
لكن ألا يكون وراء ذلك سياسة الاستعمار الثقافي للبلدان العربية والإسلامية؟
فما الذي يفسر تواضع الاهتمام بتربية تحضيرية للمدرسة ومجتمعنا الإسلامي يستمد ثقافته من سماحة دينية جعلت من تربية الأطفال واجبا دينيا وأمانة أودعها الله للوالدين.
أليس الإسلام هو الذي أقر منهاجا ربانيا كانت الأسوة قيه باتباع محمد• ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً﴾) الأحزاب:21(، لتكون تربية للقلب وللروح فيتعلم الطفل “القرآن وأحاديث الأخيار وحكايات الأبرار وأحوالهم فينغرس في نفسه حب الصالحين” (الغزالي) [2].
- من الأسباب الاقتصادية:
جاء في التقرير العالمي لمتابعة التربية للجميع الصادر سنة 2009م أن نمو التعليم قبل المدرسي في ارتباط مع تحسن الدخل وهذا ربما ما يفسر عدم استعداد عديد الأولياء في العالم العربي والإسلامي من تسجيل أبنائهم بمؤسسات التربية قبل المدرسية .
يبدو إذن أن الوضع الاقتصادي للعائلة وحتى للبلد مؤشرا إلى حد ما في نسب القيد، ويتحسن بتحسن الوضع المادي ويتراجع بتراجع الحالة المادية خاصة إذا علمنا أن هذه المرحلة قبل لم تتمتع من قبل دول المكان على الأغلب بمجانية التسجيل.
إلا أن الحذر يستوجب منا التذكير بأن التقارير الدولية والدراسات المجراة في هذا الاتجاه تشير إلى أن الارتباط بين متغيري الوضع المادي للعائلة أو للبلد وبين نمو التعليم قبل المدرسي ليس دالا. أليس ذلك ما يفسر تغطية أفضل لبعض الدول الفقيرة (غانا،كينيا،النيبال، مقارنة ببعض دول غربية نفطية(.
كذلك سجلت الدراسات العلمية الموصوفة في التقرير المذكور آنفا أن نسبة المزاولة في بلد عربي كسوريا كانت نسبة المزاولة لدى أطفال الأغنياء خمسة أضعاف نسبة أبناء الفقراء في نسبة مثلت (20%) من كل طبقة.
د- الأسباب الجغرافية:
كذلك البعد عن فضاءات التربية قبل المدرسية والتواجد بالريف كانا من الأسباب التي تشجع على تطور نسب القيد.
ومما يؤكد ذلك نسب الأمية المنتشرة في العالم العربي والإسلامي وبالتحديد لدى إناث الأرياف العربية وتخوم البوادي.
كل هذه الأسباب منفصلة أو مجمعة،أحادية أو متفاعلة قد تلعب دورا في ذلك التوزيع غير العادل في نسب القيد وفي التطور البطيء لتعميم التأطير والرعاية للأطفال العرب والمسلمين في فترة حساسة من فترات عمرهم (العتيبي، السويلم بندر بن محمود، 2002م) [3] يصنفها عديد الباحثين والتربويين “بالمرحلة الحرجة” لما لها من تأثير بالغ في تشكيل شخصية الطفل وتنمية قدراته للتعلم القريب المدى وحتى البعيد المدى “(سعاد عبد الواحد،2002م ) وهو ما دفع بعديد الباحثين في العالم الغربي إلى القول بأن ما يكتسبه الأطفال في المدرسة متأثر إلى حد كبير بما اكتسبوه قبل الدخول إليها.
هذا ما يجرنا إلى التساؤل عن انعكاسات المشكل في هذا المستوى من التحليل وهذا ما سنتناوله في الفقرات الموالية.
2: انعكاسات ضعف الاتحاق المسجل بمرحلة التربية قبل المدرسية في العالم العربي والإسلامي:
إن لعدم الاهتمام بالتربية قبل المدرسية وعدم إزالة العوائق الاقتصادية والثقافية من طريقها أثرا سلبيا على قدرات الاستعداد والتعلم بالمدارس الإبتدائية وعلى الكقايات اللغوية والعلمية والحياتية المبرمجة في مناهجها.
ذلك ما أكدته دراسات كل من (سعاد عبد الواحد 2002م) التي أجرتها على واقع التربية قبل المدرسية بتونس وما أجرته (وهيبة العايب 2005م) على المدارس القرآنية المحتضنة للتربية التحضيرية بالجزائر.
- الانعكاسات على الكفايات والمهارات في السنوات الأولى من التعليم الإبتدائي:
ليس من قبيل الترف أن يؤكد المجتمعون من (30) دولة بداكار سنة (2000) تبني قوانين جعلت من السنة التحضيرية سنة إجبارية مادام قد تبين أن للإدماج المناسب للطفل في فضاءات التربية قبل المدرسية أثر إيجابي على النتائج وعلى الإنصاف المدرسي.
ذلك ما أكدته البرامج التي نشطتها أجهزة تقييم بالولايات المتحدة (التقرير العالمي للتربية للجميع،2009م) وذلك ما أكدت عليه دراسات كل من (عجاوي ومحمود أحمد و ماهر محمد أبو هلال ،1994م) الذين أبرزا علاقة ارتباط بين أثر رياض الأطفال في التحصيل الأكاديمي في المرحلة الإبتدائية وما استنتجته دراسة (سعاد عبد الواحد) من أثر إيجابي على الكفايات التواصلية والعلمية على الطفل التونسي.
- الانعكاسات على كفايات ومهارات التلاميذ في الأقسام النهائية قبيل وبعد دخول الجامعة:
لا تقف انعكاسات التمتع بالتربية في المرحلة التي تسبق المدرسة الإبتدائية عند أثرها في كفايات المتعلمين التواصلية واللّغوية والاجتماعية بالإبتدائي وإنما تجاوزت ذلك إلى المراحل الإعدادية والثانوية وحتى الجامعة.
ذلك ما وصفه التقرير المذكور سابقا من تأكد بالتحليل الدقيق أن نسبة كبيرة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالولايات المتحدة هم من الذين تمتعوا بتربية قبل مدرسية، بل تأكد لهم أن نسبة عالية من الذين تمكنوا من التسجيل في التعليم العالي هم من الذين تابعوا تعليما قبل مدرسي.
هكذا إذن أكدت كل البحوث التي أجريت في مجالات علم نفس النمو والطب وعلم الاجتماع وعلوم التربية الأثر الحاسم للتنمية في المرحلة المبكرة للطفولة في تكوين القدرات الذهبية وتكوين الشخصية واكتساب السلوك الاجتماعي وما يمكن للتأثيرات التراكمية المترتبة على الإهمال في هذه الفترة من خطر قد يستمر طيلة الحياة (اليونسيف،2008).
إن للإهمال التربوي في هذه الفترة الحرجة من عمر الطفل انعكاسات عديدة، على الفرد قبل المجتمع.
لقد أبرزت عديد الدراسات المهتمة بصعوبات التعلم لدى فئة لا بأس بها من المتعثرين في القراءة ان العوائق تجد جذورها في المرحلة قبل فهي إما تركيبة تكوينية ذاتية وإما مكتسبة من المحيط الاجتماعي الأسري أو التربوي قبل المدرسي الذي لا يستجيب لشروط المرحلة.
3- من الأسباب المتعلقة بالقصور الهندسة البيداغوجية
تسميات عديدة عثرنا عليها عند استكشافنا للأدبيات المتعلقة بالتربية قبل المدرسية في العالم العربي والإسلامي سجلنا منها ما عبر عنه البعض بالتعليم الأولي أو التعليم قبل المدرسي وأطلق عليه آخرون بالتعليم ما قبل المدرسة أو الأقسام التحضيرية.
لئن عبر هذا الاختلاف في التحديد وفي التسميات عن خصوصيات البلدان الممارسة لهذا النوع من التربية إلا أنه يخفي وراءه غموضا في الأهداف المنشودة منها وبالخصوص في مناهجها العشوائية وطرائقها وأساليبها وشروطها التعليمية.
لئن مكنتنا العودة إلى الدراسات والأدبيات المهتمة بالمشكلة التربوية في هذه المرحلة قبل أنه رغم المحاولات هنا وهناك لتحسين الواقع التربوي بمؤسساتها إلا أنها تفتقر إلى الشروط البيداغوجية فهي تعتمد التلقين والحفظ في المقام الأول.
لقد مكنتنا الأدبيات التي اطلعنا عليها أن العديد من مؤسسات التربية قبل المدرسية بالعالم العربي والإسلامي تفتقر إلى عدم التجانس في بنياتها وفي تأهيل مربيها، فهي تقترب من التعليم وتبتعد عن فهم المرحلة وعن تأهيل كلي يساعد على ولوج المدرسة الإبتدائية.
أبرزت لنا العودة المتأنية لواقع التربية قبل المدرسية في العالم العربي والإسلامي وجود مشكلات عديدة بنيوية وأخرى وظيفية كالتي كنا بصدد تحليلها في الفقرات السابقة.
برزت إذن مشكلات بنيوية عديدة كالمكانة الهامشية للتربية قبل والانتشار الواسع وغير المنظم لمؤسساتها (كتاتيب ورياض أطفال)، البعد النفعي والتجاري السائد، الضعف في الإمكانيات المادية وغياب البنيات التحتية الضرورية للممارسة التربوية إضافة إلى مشكلات وظيفية عديدة كتعدد البرامج بتعدد المؤسسات وضعف المراقبة والتأطير التربوي وضعف التشريع، عدم تكافؤ الفرص بين كل الأطفال في استفادتهم من هذه التربية قبل المدرسية، الأجور الزهيدة التي يتلقاها المربون وانعكاسها على عطائهم ومردودهم التربوي، التفاوت الكبير في المؤسسات قبل المدرسية ، إلخ…
وإذا أردنا أن نجمع بين هذه الأعراض ونبحث عن ما يربط بينها نتأكد من وجود معضلة حقيقية بنيوية ووظيفية تعكس هامشية المرحلة والمؤسسة في نفس الوقت.
فماهي الأسباب التي تكمن وراء غياب الفعل في هوية مؤسسات التربية قبل المدرسية في العالم والإسلامي؟
هذا الإقرار هو ما جاء في تقرير البنك الدولي للتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (2006م) والذي مفاده أن
هذه الدول مدعوة أمام النواتج المحدودة أن تستفيد اصلاحات التعليم مستقبلا أطرا ومسالك جديدة تستند إلى ثلاثة عناصر هي:
- الهندسة البيداغوجية الجيدة أي تحسين نوعية المدخلات التربوية ( المربون،الفضاءات،الأجهزة)
- تحفيز سلوك الفاعلين بالتوازي مع النواتج
- إرساء شراكة مع أولياء الأمور تمكن من التأثير في صياغة الأهداف وسياسة التعليم .
- الأسباب الفكرية:
إن السبب حسما في تعويق التربية قبل المدرسية في العالم العربي والإسلامي أن تكون آلية نماء ودفع للمنظومة التربوية لا يكمن في الموارد المادية بالأساس بل في التصورات التي يحملها كل من المربي والولي عن طبيعة المرحلة التحضيرية وبالتالي عن خصائص الطفل والطفولة.
ذلك ما يتواتر يويميا على السنة الأولياء:”أريد لابني أن يتعلم القراءة والكفاية في طفولته المبكرة”، ما فائدة فصل تحضيري لا يتعلم فيه الطفل القراءة والكتاب والحساب والقرآن؟
وأمام غياب الرؤية الواضحة وقصور العارفين بالمسألة في إقناع أولياء الأمور والمربين أولى القائمون على المؤسسات الخاصة (الكتاتيب،رياض الأطفال) أهمية للتعليم على حساب اللعب والإنماء اللغوي والحياتي رغم تجذر مثل هذه المبادئ والأساليب في مدونتنا التربية العربية وفي الأدبيات الغربية الوافدة والتي أحدثت ثورة المناهج النشطة في منتصف القرن الماضي.
لقد كانت الكتاتيب قبلة أبناء المسلمين، حرص الخلفاء على تعليم أولادهم فيها فعلا شأنه وبلغ أوج عزه وازدهاره في العصر العباسي.
أما بالنسبة لسن الالتحاق بالكتاب فلم تكن آنذاك سن محددة، فبعض الآباء يفضل إلحاق أبنائه بالكتاب في سن الرابعة بينما يفضل الآخرون إرسالهم في السابعة أو الثامنة غير أن أصحاب المصادر التاريخية يذهب بهم القول بأن السن التي كان يلتحق بها الأطفال بالكتاتيب هي سن الخامسة أو السادسة[4].
لقد كان التعليم في الكتاب تقليديا، يعمد معلم القرآن الكريم تحفيظ الأطفال من المصحف وكتاتيبه على اللوح دون أخطاء إملائية معتمدا في ذلك على القراءة والكتابة وتلاوته من الذاكرة من أوله إلى آخره دون شرح لمفرداته ولا تحليل لمعانيه أو تفسير لمقاصده الدينية والأخلاقية والاجتماعية والتربوية (رابح تركي،1981م)[5].
هكذا إذن يبدو حسب الصورة التي وصفت أن الكتّاب ليس فضاءا تحضيريا وإنما هو مرحلة من مراحل التعليم للقرآن وللضروري من علوم الدين (الحديث الشريف، فقه العبادات، تعليم مبادئ الكتابة والقراءة)، حفظ الأدعية والتدريب على بعض الآداب الحميدة.
فلا الكتاتيب التي عُرفت منذ فجر الإسلام تجاوزت تقليدية التمرير والتأكيد على الحفظ والتكرار (رغم أثرها الإيجابي
أحيانا) ولا رياض الأطفال الممثلة للنموذج التربوي الغربي التزمت في ما بشرت به أدبياتها من احترام طبيعة الطفل ومراعاة ميوله والاستجابة لحاجاته.
إن عودة لتاريخ المؤسسات التربوية قبل (الكتّاب،الرياض،الخلوة،الدار،الروضة) في العالم العربي والإسلامي تبدو متأكدة لعلنا نبرهن على القصور البيداغوجي وغموض الرؤية والتذبذب الحاصل في المهمات والطرائق البيداغوجية المكرسة لتعليم تلقيني جماعي تمريري.
فالكتاب هو فضاء تربوي عُرف حتى قبل مجيء الإسلام،وهو اسم مشتق من التكتيب وتعليم الكتابة، فهو من أقدم مؤسسات التعليم والتأديب حيث يرجع تاريخه إلى عصر الجاهلية ومع توسع الدعوة الإسلامية أصبح مكانا رئيسا للتعلم خاصة بعد انتقال العرب من حال البداوة إلى حالة الحضارة (الكنوني عبد السلام ، أحمد،1981م) “فهو أول معهد استقل بمهمة تعليم القرآن على وجه الاختصاص مع ما يحتاج إليه الصبيان بداية من سن الرابعة أو أكثر مع تعلم القراءة والكتابة ومبادئ الدين على يد فقيه يحفظ القرآن للأطفال كله أو بعضه”[6]، إلى أن أدمجت شيئا فشيئا بعض المواد الحياتية، الأشغال اليدوية والتربية البدنية.
هكذا يبدو أن إدماج الأطفال في الكتاب كان متروكا لحرية الوالد إن شاء ألحقه وإن شاء أبقاه إلا أن اعتزاز المسلمين بالقرآن فرض كفاية حث الرسول محمد• صغار الأمة حيث جاء في الأثر أن تعليم الصغار كتاب الله يطفئ غضب الله” وفتحت الكتاتيب لتعليم أطفال السبع سنوات قبل غيرهم لتعليم القرآن وحفظه بالتكرار والإملاء ثم أدمجت تدريجيا بعض المعارف الحياتية والدنيوية إلى أن فتحت الأمصار وامتدت رفعة المسلمين ثم أفل عزهم وأصبحوا عرضة للاستعمار والغزو الفكري والثقافي.
لقد كانت بداية القرن الماضي فترة استعمار وضربا للهوية العربية الإسلامية ودفع خريجي الكتاتيب والمدارس القرآنية إلى المقاومة وإخراج المستعمر ثم آل الأمر إثر ذلك إلى حكومات رفعت شعار التحديث والاستفادة من تجارب الغالب الذي تفرغ للبحث العلمي وتجهيز المخابر وانتاج النظريات الجديدة.
لقد كانت الأيام الأولى للحكومات العربية الجديدة فترة مقاومة للجهل والفقر والدين انتشر آنذاك، ولم يكن أمامهم سوى الاهتمام بالتربية والتعليم المتردي عندها فتحت بعض الرياض الخاصة لتقديم نموذج تربوي يتجاوز تقليدية الكتاتيب ويوظف مستجدات علم نفس الطفل النمو ويجعل من اللعب محورا أساسيا في المنهاج.
عملت الرياض لفترة طويلة شاع فيها اللعب والمرح وإنماء القدرات الحركية واللغوية وأدمج فيها تحفيظ محدود جدا لبعض سور القرآن الكريم إلا أن السنوات الأخيرة عرفت استجابة لرغبات السواد الأعظم من الأولياء الراغبين في تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن قبل اللعب والحركة.
هذه بعض الأسباب التاريخية والفكرية والعقائدية التي يمكن أن تفسر تذبذبا وتأرجحا وقصورا في هندسة بيداغوجية تلائم أطفال يتهيأون لولوج المدرسة.
وهنا يمكن القول دون التعميم أنه لا الكتاتيب ولا الرياض المنتشرة في عالمنا العربي والإسلامي تهيء فعلا للمدرسة الإبتدائية وتستجيب لحاجات طفل في مرحلة ما قبل المدرسية إجرائية حس حركية مادامت تضع التعليم قبل الإعداد في مناهجها.
إن الكتاتيب رغم إضافاتها وتحفيظها لكلام الله العزيز بقيت تقليدية، متأرجحة الهوية فلاهي شرقية ولا غربية.
كما أن رياض الأطفال رغم إضافتها وسعيها للتأهيل والإعداد بانت تقليدية ما دامت قد سقطت في النفعية والاستجابة لمطلب الأولياء الملح على التعليم قبل التأهيل.
وأمام هذا التأرجح في الهوية التربوية لفضاء الكتّاب والروضة ألا يمكن تصور لنموذج يؤسس لتربية قبل مدرسية عربية تعتز بقرآنها العزيز وتطور تعليمه وتستلهم النظرة التكاملية التي تنادي بها المدرسة النفسية.
– ماهي انعكاسات ذلك الفهم الخاطئ لدور المؤسسة قبل المدرسية في العالم العربي والإسلامي؟
إن لهذا الفهم الخاطئ الذي ساد لسنوات طويلة والذي أثر على الدور التعليمي لهذه المؤسسة (كتّب،روضة) نزولا عند رغبة الأولياء الذين يرغبون في تدريس أطفالهم القراءة والكتابة منذ سن الأربع سنوات تقريبا، انعكاسات عديدة على الطفل نفسه، وعلى تكوينه المستقبلي وعلى نجاحه وحتى على اندماجه في عالم الشغل وعلى المجتمع بصفة عامة. فماهي تلك الانعكاسات عليه وماهو أثرها على المجتمع بصفة عامة؟
انعكاسات ذلك الفهم الخاطئ على الطفل نفسه وعلى تكوينه:
إن إجبار الأطفال قبل نضجهم على التعليم وتهميش التأهيل والإعداد لدخول المدرسة في المرحلة قبل مفسدة قد تحرمه لذة لعبه وقد تنغص عليه اكتشافه للمدرسة.
ذلك ما نجد أثره في تراثنا من تنوع في تجاربهم فيما ذكره مثلا القاضي ابن العربي في كتاب “أحكام القرآن” أن لأهل الأندلس خاصية تميزهم عن سائر المغاربة في تعليم الصبيان حيث قال: “وللقوم في التعليم سيرة بديعة وهو أن الصغير منهم إذا عقل بعثوه إلى المكتب أي أنه لم تكن هناك سن محدودة لتلقي العلم بل يظل الأمر متروكا لنضج الصغار وتقدير آبائهم حرصا على نجاعة المؤسسة التربوية وسعيا إلى أمثل انتفاع بها (حميدة النيفر،2009م)[7] ذلك كان القدر المشترك بين صغار الأندلسيين في طور التمدن وذلك بالحرص على إيلاء العلوم العقلية منزلة متقدمة عن العلوم النقلية، هذا ما يعلن عنه صاحب “أحكام القرآن” حين يقول: “ومنهم (صغار المتعلمين) وهم الأكثر من يؤخر حفظ القرآن ويتعلم الفقه والحديث وماشاء الله…
هكذا تبرز لنا تجارب التراث بين الأندلسيين والمغاربة تنوعا رغم إيمانهم بأن الأصل هو القرآن العزيز، هذا التنوع في مناهج التعليم في زمن ابن خلدون أدى به إلى ترجيح المنهج الأندلسي لأن الاقتصار على حفظ القرآن يفضي إلى “القصور عن ملكة اللسان جملة وإلى قلة الحذق في العلوم المختلفة وقصور الهمة المبدعة في الفنون والمعارف”.
يدعم صاحب المقدمة هذا الرأي بقوله إن: “القرآن لا ينشأ عنه في الغالب ملكة لأن البشر مصروفون عن الإتيان بمثله.”
4: أثر ضعف القيد في نهضة المجتمع العربي:
لقد تاكد أنه لا نهضة بدون علم وتربية هادفة إلى بناء الشخصية المؤمنة المتوازنة والفاعلة.
لذا فإن لإهمال الطفل في تلك الفترة الخاصة أثر سلبي في النجاح الدال وفي انحسار الكفاية الداخلية والخارجية للمؤسسات التعليمية الاساسية، الثانوية،والعالية وما يترتب على ذلك من غياب للجودة وتفاقم للبطالة ومن زحف للأمية التي لازالت أرقامها مرعبة في العالم العربي والإسلامي.
هذا ما أبرزته الدراسات الطولية التي تابعت أجيالا من الأطفال من الطفولة الاولى إلى المراهقة…
هكذا إذن تمكنا في هذه الفقرات من تحليل مؤشرات التقصير هذا (ضعف القيد والتمدرس) وحاولنا وصف ما أبرزته بعض التقارير العالمية والبحوث العربية والأجنبية من أسباب تكمن وراء هذه المعضلة واجتهدنا في توقع ما تعرضنا إليه لحد الآن من انعكاسات على مستوى التكوين المعرفي، المهاري والوجداني الاجتماعي لأجيال هذه الأمة.
كما تطرقنا ولو باقتضاب إلى بعض آثار إهمال الطفل في المرحلة قبل وماقد يترتب عليه من مخرجات متواضعة (أمية،انحراف،فقر،بطالة) ومن عوائق تقف حجر عثرة أمام تقدم المجتمعات العربية والإسلامية.
هذا بالنسبة للمؤشر الأول والأهم في هذا التشخيص إلا أنه ليس الأوحد بل تمكننا من خلال استقراء الأدبيات والبحوث والتقارير المتعلقة بالمرحلة قبل أن تذبذب مناهج التجارب التربوية يعد كذلك من أوجه الخلل في المنظومة التربوية العربية والإسلامية، ففيم يتمثل هذا التذبذب وماهي انعكاساته وآثاره على الأجيال وعلى أوضاع المجتمع العربي الإسلامي بصفة عامة؟
المبحث الثالث
تدني المخرجات المتعلقة باللغة العربية قراءة وكتابة وتخاطبا
مكننا مسح عديد الأدبيات التربوية العربية والتعمق في وصف مكانة اللغة العربية في مناهجنا التعليمية من الأساسي إلى العالي من استنتاج أزمة مضاعفة، أزمة اللغة وأزمة في تعليمها، وهو لعمري أمر ملفت للانتباه واليقظة في مصير مقوم من مقومات هويتنا المهددة بالتلاشي والفصام والذوبان.
جاء في تقرير التنمية الإنسانية سنة 2003م تحت عنوان أزمة اللغة العربية توصيف لأعراض أهمها:
- غياب رؤية واضحة للاصلاح اللغوي
- جمود التنظير اللغوي وقصور العتاد المعرفي لدى اللغويين
- ازدواجية الاستعمال بين الفصحى والعامية
- ضعف النشر الرقمي باللغة العربية وقلة البرمجيات (رشدي أحمد طعيمة،2005م)[8].
يُجمِع كثير من الملاحظين من المثقفين عموماً، ومن المهتمين بالتربية والتعليم في العالم العربي والإسلامي على ظاهرة الضعف اللغوي، والتدني الهائل لمستوى التعبير باللغة العربية لدى الأجيال الجديدة؛ كتابةً وخطابةً وتحدثاً؛ إلى درجة أن هذه الظاهرة صارت تصحب كثيراً من المتعلمين من الابتدائي حتى مرحلة التخرج، ولم نعد نرى بـروز العبـقريات اللغـوية والتعبيرية التي سادت في مرحلة ما اصطـلح عليه (بجيل النهضة)، بل سـاد عَـيٌّ لغوي فادح حتى في المعاهد والجامعات التي اشتهرت بتخريج اللغويين والأدباء كذلك جاء في نفس التقرير تأكيد على وجود أزمة في تعليم اللغة العربية في جل مراحل التعليم من الأساسي إلى التعليم العالي نوجزه فيما يلي: يشكو تعليم اللغة العربية من أزمة حادة في محتوى المادة التعليمية وفي مناهج التدريس على حد السواء ولعل أبرز الأعراض تمثلت أساسا في:
- هيمنة الحفظ والتلقين لإكساب معارف متجددة
- عزوف الصغار والكبار عن استعمال معاجم اللغة العربية
- الاقتصار على الكتابة دون القراءة في تنمية القدرات الإبداعية
إن التأمل في التقارير والأدبيات ذات العلاقة يؤكد إذن دون شك تفاقم أزمة لا تقل خطورة وتعقيدا عن الأزمات الأخرى وغيابا للتأصيل العربي الإسلامي في مناهجنا يعرقل بناء الإنسان العربي المسلم.
ذلك ما يؤكده (محمود الذوادي،2002م)[9] من وجود أزمة لغوية فعلية في كتابه التخلف الآخر وذلك بعد إجراء أبحاث نظرية وميدانية قابل فيها عديد المثقفين والجامعيين والطلبة من شتى الشرائح والأعمال.
ينطلق محمود الذوادي من ملاحظتين أساسيتين يعتبران من انعكاسات غياب التأصيل على أجيال الأمة:
- ” أمية خريجي الأنظمة التعليمية والتكوينية من الطلبة العرب في المشرق والمغرب وبعد الاستقلال.”
- “قدرات محدودة جدا على القراءة والكتابة وعلى التحدث السليم والسهل والمتسلسل بالفصحى.”
- “ميل بالمغرب العربي خاصة إلى استعمال اللغة الفرنسية و”شعور بالاستحياء والرهبة والتوتر النفسي عند التخاطب بالفصحى.”[10]
هكذا يتضح أن تدهور اللغة العربية بين المتعلمين العرب وحتى لدى الجامعيين بات يهدد ما يسمى بالأمن اللغوي الذي لا يتجزأ من الأمن الثقافي للأمة.
هذا التدني والتدهور للغة العربية الفصحى يؤشر لوجود معضلة تعليمية وقصور أو تقصير بيداغوجيين أو فلسفة غير واضحة المعالم والغايات مما يضع الأنظمة التربوية العربية أمام تحديات جسام.
ولمزيد التعمق غاص الباحث (محمود الذوادي) في الواقع الراهن للمجتمعات المغاربية (تونس،الجزائر،المغرب) فاستنتج “ازدواجية غريبة في التربية اللغوية الثقافية لهذه المجتمعات جعلها تعاني من فقدان للتكامل الثقافي.”[11]
أولا: مظاهر الضعف في اللغة العربية:
رغم المجهودات التي تبذلها الأنظمة التربوية العربية تشريعا وممارسة إلا أنها تتعالى بين الحين والآخر صيحات أوردتها التقارير الدولية والعربية ومن كل الأقطار، لتعبر عن ضعف عام في اللغة العربية كما ترتفع أصوات الشكوى والألم من وضع مؤسف آلت إليه حالة اللغة العربية بين أبنائها.
كل ذلك أحدث توجسا من خطر داهم قد يزداد مع الأيام سوءا ويتفاقم إن لم يجد رجالا صدقوا.
هذه صيحات صادقة في التعبير عن هذه المحنة الواقعية” ولا ينكر أحد وصف الأخطار التي قد تترتب عليها إن استمرت ولم يسارع أهل اللغة الغيارى على لغتهم إلى علاج ضعفها لدى القوم والعمل على إعادة العافية إليها” (عبد اللطيف أحمد الشويرف،2002م).
دلك ما يشير إليه تقرير التنمية الانسانية العربية الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الانمائي لسنة 2009م والذي يرتب الدول العربية في المرتبة السادسة من أصل ثماني مناطق في العالم، على مستوى معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة والالتحاق بالتعليم الأساسي، حيث سجلت نسبة (73) في المائة من حيث معدل الإلمام بالقراءة والكتابة أي بعد كل من أمريكا الشمالية وأوربا الغربية و أوربا الوسطى والشرقية.
هذه صورة عن المخرجات المتعلقة بالقراءة والكتابة بالعالم العربي والإسلامي اخترنا لتكون مقدمة لتشخيص نسقي للمعضلة المتعلقة بالتراجع القرائي والكتابي والتواصلي عسانا نسهم في اقتراح فرضيات تفسيرية تساعدنا على الفهم و التجاوز والاجتهاد في بلورة رؤية تأصيلية تجديدية وبناء نموذج تطبيقي لتربية أصيلة.
لقد تعددت مظاهر الضعف والتدني لمخرجات الأنظمة التربوية والتعليمية في العالم العربي والإسلامي فشملت المكتوب والمقروء فكان منها:
– جهل بقواعد الاملاء ومصطلحاته (رسم الهمزة/التاء …)
– الجهل بقواعد النحو العربي جهلا تفشّى حتى أصبح ملازما لكل كتابة إلا فيما ندر فنُصب المرفوعُ وجُرّ المنصوب…
– جهل بمعاني الأدوات اللغوية ووظائفها بحيث تستعمل استعمالا اعتباطيا لا تراعي فيه دقة التوظيف.
– عدم السلامة في الأسلوب وتركيب الجمل تركيبا ينم على التكلف.
– كثرة الأخطاء اللغوية الشائعة المخالفة للمسموع من اللغة وأصولها.
– غلبة اللهجات المحلية على الفصحى حتى بعض الفصول الدراسية.
لا بد أن نشير هنا وللأسف الشديد أن النظام التربوي العربي قد فشل في ترغيب الطفل والشاب في القراءة ولم يستطع أن يؤالف بين المتعلم والكتاب ولم يتمكن من تأسيس لذة القراءة الفاعلة وبالتالي لم يبْن القارئ الفاعلُ الباني للمعاني في أجيالنا، ذلك ما تبيّنه نسبة القراء المتدنية جدا في الوطن العربي مقارنة بنسبتهم في الدول الغربية.
هذه نماذج وأمثلة معينة من مظاهر للضعف اللغوي في فصولنا ووسائلنا المكتوبة والمجموعة فماهي الأسباب التي تكمن وراءها وماهي آثارها حاضرا ومستقبلا على مستوى تكوين الأجيال وأوضاع المجتمع العربي.
فجوة تعليم وتعلم اللغة العربية:
تواجه اللغة العربية اليوم وعلى أبواب مجتمع المعرفة والمستقبل تحديات قاسية وأزمة حقيقية تنظيرا وتعليما ونحوا ومعجما واستخداما وإنتاجا ونقدا إضافة إلى ما تثيره تقانة المعلومات من القضايا.
وفي ضوء هذا كله يمكن القول أن ازمة العربية مركزية لا تقل خطورة وتعقيدا عن الأزمات الأخرى التي تواجهها المجتمعات العربية الواقفة على عتبة نقلة نوعية حادة.
تشكو اللغة العربية ازدواجية الفصحى والعامية وثنائية الفصحى واللغات الأجنبية الأخرى وتعاني المناهج الخاصة باكتساب مهارات التواصل اللغوية المختلفة بأزمة أبرزتها عديد الأبحاث والتقارير تصف غياب التخطيط وفقرا في الطرائق والأساليب (تحجر في التقليد والتلقين وقصور في التنشيط).
هذا قليل من كثير عثرنا عليه في الدراسات تصف الواقع المؤسف للغة القرآن وتؤكد تفاقم المعضلة رغم المحاولات المحدودة هنا وهناك لتعديل التشريع والدعوة لإحياء التراث الأصيل.
يشكو تعليم اللغة العربية أزمة حادة في محتوى المادة التعليمية وفي مناهج التدريس على حد السواء ولعل من أهم أعراض هذه الأزمة التركيز على الجوانب الصورية في تعليم الصرف والنحو وعدم النفاد إلى مضامين النصوص العميقة والكشف عن بناها الكلية وعدم الاهتمام بوجه الدلالة اللغوية والمعنى وإهمال الجانب الوظيفي في استخدام اللغة وعدم تنمية المهارات اللغوية في الحياة العملية والاقتصار على جانب الكتابة دون جانب القراءة في تنمية القدرات الإبداعية وعزوف الصغار والكبار على استعمال معاجم اللغة وقصور البحث اللغوي التربوي في تعليم اللغة وفي تجديد الأسس المنهجية لتعلمها (تقرير التنمية الإنسانية العربية 2003م).
إلا أن الأمر الذي يجدر التأكيد عليه بعد توصيف هذا الواقع اللغوي المؤلم وبعد التعرف على ما فعله ويفعله فينا الاستعمار والتغريب ودعوات تقبل العولمة “بخيرها وشرها وحلوها ومرها” وبعد توقع الانعكاسات الخطيرة على تكوين الأجيال مستقبلا لما قد يلحقها من طمس للهوية العربية الإسلامية و”إيغال في تغريب الناشئة وترسيخ لإشعارهم بدونية ثقافتهم وعجز لغتهم عن الوفاء بمستوجبات العلم والثقافة والتحضر.”[12]
إنّ ما آل إليه مستوى الخريجين من تدنّ للاكتساب في لغة الأمن والمنشأ يعود على ما يبدو إلى غياب التأصيل التربوي لهذا المكون الأساسي من مكونات الهوية العربية الإسلامية “وإلى غياب سياسة لغوية موحدة تأخذ بعين الاعتبار مقومات الثقافة العربية الإسلامية.
- توفير البنى الأساسية اللغوية التي تؤهل لغتنا العربية للتفاعل الحي مع لغات العالم الأخرى سواء من حيث تنظيرها أو من حيث تعليمها وإعداد معاجمها أو من حيث برامج استخدامها عبر الوسائط التكنولوجية”.
- غياب الاعتزاز لدى الدارسين في مختلف المراحل التعليمية باللغة العربية وفقدان الثقة في قدرة اللغة العربية على استيعاب العلوم والتكنولوجيا (الأمر الذي أدى بالبعض من أصحاب المؤسسات التربوية قبل (رياض الأطفال مثلا) إلى إضافة لغة أجنبية على الأقل إلى جانب اللغة العربية ليقال بأنها عصرية مواكبة للحداثة…).
- غياب الخصوصية الثقافية وضمور الاعتزاز بالهوية الثقافية العربية الإسلامية.
ثانيا:الأسباب الكامنة وراء الضعف اللغوي الموصوف:
ولمزيد التعمق نحاول تحليل العوامل والأسباب التي أوصلت اللغة العربية وتعليمها إلى هذا الوضع المزري.
- التغريب وأثره في تعليم العربية وتعلمها:
لقد ساعد التغريب الثقافي في الوطن العربي على إيجاد مظاهر وأشكال من التغريب أولت لغة المستعمر الأولوية القصوى في المناهج (محتوى وحجما زمنيا واتجاها) مقارنة بتعليم اللغة العربية الذي همّش تهميشا مقصودا.
إنّ من أخطر مظاهر التغريب التربوي تهميش اللغة العربية وإخراجها من معظم الجامعات والكليات والمعاهد العربية كلغة تدريس للمعارف العلمية وإحلال اللغات الأجنبية مكانها.
إنّ جلّ المناهج الجامعية العربية تستبعد اللغة العربية من تدريس العلوم رغم التشريع الذي ينصّ على أنّ لغة التدريس الرسمية هي اللغة العربية مدة سنتين فقط بعد الثانوية العامة وغيرهم “وهم كثر من الذين التحقوا بعملهم التعليمي والتربوي بعد تخرّجهم من الجامعة مباشرة دون تكوين نظري أو تطبيقي مؤهّل للمهنة”.
والغريب في الأمر أنه رغم تخرج العديد من المعلمين من المعاهد العليا لتكوين المعلمين أو من كليات التربية التي يفترض فيها برمجة محتويات مهنية وتخصصية في اللغة العربية فإنّ كفايات الخريجين لازالت دون المؤمل من ذلك مثلا:
- هيمنة المحتوى النظري التخصصي على الجانب العملي من التكوين.
- بناء مناهج التكوين استنادا على تقليد لبرامج معاهد الغرب التربوية وتجاهل الخصائص العربية الإسلامية للطلاب وللمجتمع .
- تواضع التمهين للتكوين الأساسي المثمر لتطوير كفايات التدريس (تخطيط،إنجاز،تقييم،مرافقة).
- اعتماد طرائق التكوين على التلقين والمحاضرات.
- ضمور التمفصل النظري-التطبيقي أثناء التكوين الأساسي في دور المعلمين (رضا ساسي،2001).
- غياب التأمل والتحليل للمارسات أثناء التكوين (رضا ساسي،2008)
- يؤكّد (محمد جواد رضا،2000) أنّ في العالم العربي والإسلامي حاجة ملحّة إلى تجديد الوعي بأهمية تربية (الانسان المهذّب) الذي يطوي في ذاته (إنسانا متخصصا) ليكتمل من الاثنين طالب علم خبير ومواطن متخولق في وقت معا”، فهو لا يستبعد أن تكون الرؤية المهنية في تدريس اللغة العربية من ورائها نماذج التكوين مسؤولة عن ضعف القدرة التعبيرية والقرائية لدى الطلاب في جلّ المراحل قبل الجامعية وحتى بعد دراستها أكثر من اثنتي عشرة سنة.
هكذا إذن يمكن القول أن ضعف تكوينهم الأساسي والمثمر قد يكون وراء ضعف التلاميذ الذين يتتلمذون عليهم ويتعلمون على أيديهم القراءة والكتابة وكل أشكال التوصل اللغوي العربي.
يعود ضعف الإعداد على كفايات المعلمين المدعويين لتدريس العربية وكفاياتهم المحدودة يؤثّر سلبا على اكتساب منظورهم وتعلقهم باللغة العربية قراءة وكتابة.
يتأكد لذلك تكوين المعلم تكوينا وظيفيا شاملا ووظيفيا (اكتساب معارف نظرية حول التعليم والتعلم،ممارسة طرائق
متنوعة واتجاهات إيجابية إزاء المتعلم وإزاء المدرسة) لعله يهم في تخرّج معلم مهني ذي هوية مهنية متأملة،ناقدة،فاعلة ومجددة (رضا ساسي،2008).
وإذا أريد للمنظومة التكوينية أن تحدّ من الضعف الموصوف لدى عديد الخريجين.
ومن الأسباب (الفرضيات الفرعية التي قد تفسر الضعف المتنامي لدى الخريجين في الإلمام بالقراءة والكتابة) فقد يعود بالأساس إلى أسباب تعليمية وبيداغوجية فماهي تلك الأسباب وماهي انعكاساتها على مستوى تكوين الأجيال؟
- الأسباب السياسية:
في وقتنا الراهن تتعرض اللغة العربية عموما والفصحى بوجه خاص إلى “هجمة شرسة بالدعوة إلى استخدام للهجات المحلية وبتنا نسمع عن عربية مصرية وأخرى مغربية وعربية خليجية وأخرى شامية مما أدى إلى ضعف نزعة الوحدة بين البلدان العربية الإسلامية.”[13]
- الأسباب التربوية والتعليمية:
يمكن أن نرجع أسباب التدني في مخرجات تعليم اللغة العربية في جل المراحل التعليمية إلى الأسباب التالية:
- التكوين الأساسي والمستمر وإعداد المعلمين:
يقول: (رضا ساسي،2008) في أطروحته أنّ “الصيحات تعالت في الآونة الأخيرة لإعادة النظر في تكوين المعلمين قبل الخدمة وأثناءها والدعوة إلى تأهيل حاث على التأمل والانتباه لمسألة الهوية المهنية للمعلمين”.
ويضيف الباحث مؤكّدا أنّ “البحث في مسألة التكوين الأساسي للمعلمين في اللغة العربية أصبح ضرورة حتى يواكب تنامي الانتظار ويواجه مهنة التعليم في عالم تعددت فيه مصادر المعرفة وقنوات التأثير في المعلم والتلميذ على حدّ السواء”.
يتأكد إذن إعادة النظر في تكوين المعلمين قبل الخدمة وبعدها خاصة إذا علمنا أنه من المشكلات التي يعاني منها كثير من المعلمين العرب دخولهم ميدان التعليم دون إعداد وتأهيل منابين من ذلك اندماج بعضهم في قطاع التربية والتعليم بمؤهل الثانوية العامة (الباكالوريا) دون أن يلجوا التعليم العالي وآخرون منهم التحقوا بسلك التدريس بمؤهل الديبلوم بعد اجتيازهم برنامجا متوسطا.
ثمة من يرى أن جذور الظاهرة (العامية/الفصحى) تمتد تاريخيا حتى عصور الجاهلية وتعدد لغات القبائل ثم اختلاف اللهجات باختلاف الأمصار مع الفتوحات الإسلامية ثم إلى إهمال للفصحى في العهد المملوكي والتركي إضافة إلى آثار الاستعمار البريطاني “وما صاحبه من توجهات استشراقية نالت من اللغة العربية الفصحى”[14] ودعت إلى إحلال العامية بدلا منها والمناداة بكتابتها بالحروف اللاتينية ودعوات التمسك باللهجات البربرية والأمازيغية (كما حصل بالمغرب والجزائر الآن).
- الأسباب النابعة من اللغة ذاتها:
ثمة من يفسر الميل إلى لهجات ولغات غير العربية إلى الزعم بصعوبة الفصحى وعدم تطورها وعجزها عن ملاحقة إيقاع العصر مما خلق بيئة مواتية للعامية لتعويض الفراغ.
- أسباب تعود إلى الجماعة الناطقة بالعربية:
يتمثل ذلك في فشل الذود عن اللغة والمحافظة عليها من قبل المشرعين للسياسة وللتربية وفي فشل أولئك المثقفين الذين تقطعت صلتهم بتاريخهم وتراثهم وتقصير المعلمين الذين أشاعوا استخدام العامية في دروسهم الأكاديمية وحتى اللسانية.
- هيمنة الطرائق التلقينية في ممارسات معلمي اللغة العربية:
لا يخفى على متأمل في الشأن التعليمي أنّ الطرائق الشائعة في المدارس العربية وإلى الآن هي تلك المصنّفة في الطرائق التقليدية المتمحورة على المحتويات والمعارف والهادفة بالأساس إلى نقل إرث ثقافي من جيل إلى آخر من ذلك الطرائق التلقينية والطرائق الاستجوابية.
إلا أنّ الطريقة التي لازالت متفشية في فصول المدرسة العربية هي تلك الموصوفة بالتلقينية المعتمدة على المشافهة والعرض وعلى سلطوية المدرّس.
تضمن هذه الطرائق التلقينية تعليما بنكيا ينحصر دور الطلاب منه في الحفظ والتذكر وترديد ما يسمع دون تأمل أو تعمّق في مضمونه.
لقد جمدت الطريقة التقليدية عقول الطلبة (عبد اللطيف الشويرف،2009) وجعلت أدمغتهم مجرّد أوعية تحشى فيها مجموعة من القواعد والقوالب. إنّ أسلوب الحفظ والتلقين مفيد إلى حدّ إلا أنّ الاقتصار عليه قد عطّل وظيفة علوم اللغة في مدارسنا ومعاهدنا حيث يحفظ الطالب المحتويات المقررة في الكتب ويحفظ الأمثلة والنماذج إلى أن يأتي يوم الامتحان ليردّ بضاعة عرضت بلا روح ولا معنى.
ويشير أحد الباحثين التربويين إلى خصائص التعليم الابتدائي في إحدى الدول العربية قائلا: أصبح التعليم الجيد في أسسه وأهدافه هو مساعدة الطالب على أن يحفظ في ذاكرته القاعدة اللغوية ويخزنها إلى أن يأتي اليوم الموعود لاسترجاع ما خزّن (رضا محمد جواد،1990) لذلك يعتمد المعلمون هذه الطريقة التقليدية وهذا الأسلوب التلقيني لسهولته ولضمان تأمين عدد كثير من المعلومات ولكنهم نسوا أنّ الاكتفاء بالترديد والحفظ والاستظهار لا يمنح الطالب فرصة التأمل والتفكير للتساؤل والبحث والتجريب والفهم والنقد.
ولما كان العثور على طريقة مثلى في تدريس اللغة العربية أمرا يكاد يكون مستحيلا-فلكل طريقة إضافاتها ولكل طريقة هدفها- يبدو التنويع في الطرائق حسب أهداف المراحل أسلم وأكثر ضمانا لتحقيق الأهداف من تدريس اللغة العربية في مدارس الحاضر والمستقبل؟
إنّ الجدل الذي يدور عادة بين أنصار الطرائق التقليدية وبين أنصار الطرائق المسماة بالحديثة لم يعد له ما يبرز ذلك أن الحكم بطريقة أو على الطريقة يتمثل بالأساس فيما تقدمه الطريقة من إمكانات ومن تحقيق أهداف معرفية ومهارية ومواقفية ووجدانية…وما تمنحه من دعم للتفكير والنقد والعمل والإبداع.
من الأسباب الخفية التي يمكن أن تفسّر الضعف الفادح الذي عليه خريجو فصول اللغة العربية هو نظام التقييم المعتمد ونظام الامتحانات وطبيعة الاختبارات المقترحة للانتقال من درجة إلى درجة ومن مرحلة إلى أخرى.
التقويم التربوي في قفص الاتهام:
فإذا كان التقويم التربوي بوظائفه المختلفة (الشخصية/ التكوينية والإشهادية) هو ذلك العمل الدقيق المساعد على ملاحظة التمشيات والنواتج قصد جمع مجموعة من البيانات الثابتة والصادقة والموثوق بها ومقارنتها بإطار مرجعي (لوائح الأهداف المنشودة) ومن ثمّ تقدير “ما تحقق منها” (محمد زياد حمدان، 1986) فهو “إذن وسيلة لتجويد العملية التعليمية-التعلمية وبالتالي تحسين المخرجات اللغوية لدى الطالب في أي مرحلة كانت.”
إلا أنّه بين التقييم والاستفادة هوة سحيقة فالاختبار المعدّ في بعض المدارس قد يثير الرعب والقلق في نفوس الكثير من الطلاب بحيث ينظر إليه الكثير منهم بكونه كابوس مفزع وسيف مسلّط على رقابهم.
والغريب في الأمر أنه في مدارس أخرى يعدّ الاختبار لينجح كل التلاميذ نجاحا غير دال بقيم القدرات الدنيا ويركز فيه على الاسترجاع والتذكير والفهم ويغيب فيه التحليل والتأليف والنقد والإبداع فيكون الخريج في اللغة العربية دون الآمال المنشودة وبعيدا عن إعطاء المعنى لما يتعلّم.
إنّ التقييم الموضوعي التكويني والاشهادي هما صماما الأمان والضامنان للجودة والإتقان إذا ما اتّقى الله فيه ولم يتبع الهوى.
هكذا إذن تحول التقييم في مدارسنا العربية إلى مناورة وأداة تستخدم وفق الهوى بعيدة كل البعد عن الموضوعية تكرس بها الرداءة ويستفحل الضعف والإخفاق اللغوي وبالتالي التسرب والهدر المدرسي.
فإذا كانت هذه بعض الأسباب فماهي انعكاساتها على مستوى تكوين الأجيال وآثارها في المجتمع؟
ثالثا :من انعكاسات تدني المخرجات المتعلقة باللغة العربية:
- من الفشل إلى التسرب المدرسي:
كثيرا ما تسبب الاخفاق أو الفشل المدرسي في التحصيل اللغوي في الرسوب والانقطاع والتسرب فتهدر أموال وتضيع الجهود دون فائدة تذكر.
يعدّ الهدر المدرسي ظاهرة سلبية في المنظومة التربوية والتكوينية التي لها أسبابها المختلفة التي تختلف باختلاف مراجعها الموضوعية والذاتية في ظلّ المسوغات والأسباب التي تدفع بالظاهرة إلى الظهور والتجلي في وضعيات مختلفة (محمد حطاش،2007).
إنّ تسرّب التلاميذ قبل إكمال المرحلة الخاصة بالتعليم الأساسي يسبب ضعفا فادحا في اللغة العربية أفقدته سيطرة على المقرو والمكتوب يجعل العديد منهم مهددا بالتردي إلى الأميّة.
ينعكس ذلك الفشل القرائي على الأجيال المدعوة للتكوين وتعلم الحرف للإندماج في المجتمع ودخول سوق الشغل الذي يفرض انتقاء للكفي والأقدر على القراءة والكتابة إضافة إلى ما يؤثر به على الحالة النفسية للتلميذ مما يجعله عرضة للتوتر النفسي الذي قد يدفعه إلى الانحراف والانخراط في شبكات الاجرام لا قدر الله أو شبكات الهجرة السرية وما يترتب عنها من مشاكل اجتماعية واقتصادية وبالتالي جذب عجلة التنمية إلى الوراء.
بعد استعراض بعض الفرضيات التفسيرية لضعف المخرجات التعلمية المتعلقة باللغة العربية في العالم العربي والإسلامي يجدر بنا توقع انعكاسات ذلك الضعف على مستوى تكوين الأجيال وآثاره على أوضاع المجتمعات العربية نوجزها فيما يلي:
- استمرار الضعف العام في اللغة العربية دون مرافقة علاجية للحد منه قد يؤدّي إلى استفحاله وانتشاره انتشارا قد يجعل التحكّم فيه أمرا مستحيلا.
- يضعف على التدني العام قدرة اللغة على تحقيق التفاهم بين المتعاملين بها ويعطل وظيفتها في توحيد المقاصد ويوقع اللبس والخلط في المعاني أو يشوّه نسقها وبسبب الخلل بين أجزائها (عبد اللطيف الشويرف،2009)
- يؤثر ذلك الضعف اللغوي المتفشي في الوسائل السمعية والبصرية تأثيرا بالغا في القارئين والسامعين وينقل إلى هؤلاء لحنا وهجنة وبصفة خاصّة أولئك الأطفال الصغار الذين لازالوا في مراحل التكوين الأولى.
- يرتبط الضعف اللغوي بضعف ثقافي وفكري فليست اللغة مجرد وسيلة للتواصل ولكنها أيضا عقيدة وفكر وثقافة وعواطف ومشاعر وتراث وتاريخ وهي جوانب متداخلة ومتفاعلة .
إنّ ما نشاهده من هزال الثقافة العامة لدى أجيالنا في زمننا هذا مثلا ليس وما نلاحظه من ضآلة زادهم المعرفي وجهلهم بتراثهم الأصيل إنما هو نتيجة طبيعية لضعفهم في لغتهم العربية رغم عطف البعض عليها وحنينهم إليها بوصفها لغة القرآن.
- يترك ذلك الضعف اللغوي العام فراغا فكريا وثقافيا لدى شباب الأمة وقد يضعِف صلة التأمل في التراث والتجدد من داخله مما يؤدّي بالتدريج إلى ذوبان الشخصية وفقدان الهوية وانقطاع الصلة بالرابطة الموحدة للأمة والماسكة لكيانها ولخصوصياتها في زمن التغريب والعولمة العابرة للقارات.
ارتبط الاسلام باللغة العربية ارتباطا عضويا متلاحما بحيث لا يمكن فصل العربية عن الدين الإسلامي الحنيف فالقرآن نزل بلسان عربي مبين ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴾ (الشعراء:195) العربية مفتاحه وأداة فهمه وهي الباب إلى تنوّره.
ونبي الاسلام محمّد ص• عربي وسنّته لا تُفهم ولا يُستكشف ما فيها من قيم وآداب وأخلاق إلا بلغة الضاد.
فإذا أُصبنا في لغتنا العربية تلتبس علينا الأمور وقد نضلّ ، لذلك صار التقصير في النهوض بها وتحسين مخرجات طلابنا فيها تقصيرا نحاسب عليه يوم القيامة “فما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب”.
إنّ السؤال الذي يفرض نفسه هنا: ماذا نضع في الاعتبار لرفع مكانه اللغة العربية في نموذج تربية أصيلة منشود؟
إنّ ارتباط اللغة العربية بالدين وارتباط سنة نبينا محمد ص. بها يستوجبان منا إيلاء اللغة العربية مكانة مرموقة في أهداف النموذج المنشود وإجراءاته.
يتأكد الاهتمام إذن بلغتنا العربية من المرحلة ما قبل المدرسية (الكتّاب أو الروضة القرآنية) إلى التعليم العالي.
إنّ تعليما جيدا أو صالحا يؤ معلمون صالحون اختاروا مهنة التعليم وتأهلوا تأهيلا مهنيا جيدا بإمكانهم -إن اتّقوا الله في أبناء المسلمين وبناتهم- أن يسهموا في تحقيق الأهداف المنشودة والمطموحة، اعتزاز بلغة القرآن، وملكة لغوية تيسر تواصلا وتنشئ حبا ولذة في القراءة والكتابة والابداع.
فإذا أراد هذا النموذج المنشود تقديم الاضافة النوعية في مخرجات الطلاب اللغوية توجد عليه الاهتمام بتعليم ابتدائي أساسي
يؤسس لكفايات أفقية تتجاوز المرافق الدنيا والاستدلال والنقد المقنن وذلك بأن نختار له أكفأ المعلمين الراغبين والمتفائلين في الطفل والطفولة والمستعدين للبذل والعطاء والابداع التربوي الحر داخل المدرسة وخارجها.
إنّ المدرّس هو حجر الزاوية وقطب الرحى في عملية التعبير المنشود إذا ما أعدّ إعدادا جيدا منوّع الطرائق التربوية وراعى الفروق الفردية وخاف الله في تقييم مكتسبات تلاميذه ورافقهم مرافقة تقيهم الهبوط والتهميش.
هذه بعض المقترحات يسّر الله لي اقتراحها وهي أسباب يجدر الأخذ بها مع اعتبار تداخلها وتكاملها دون تغافل عن دور الحياة الثقافية وفي الاستغلال الأمثل للوسائط المتعددة. (يذكرنا هذا الوصف ما درجت عليه فلندا في نظامها التربوي.(بومار مارلين،2008).
المبحث الرابع
تدني المخرجات المتعلقة بالرياضيات والعلوم والتفكير النقدي
مقدمة :
يمثل تعلم الرياضيات فرصة للطالب تدربه على التحسس والمحاولة والتمرن على الهيكلة والاستدلال والتأليف ووسيلة لإنماء التفكير الرياضي والمنطقي لديه.
كذلك “يعد تعلم المفاهيم الرياضية والتعامل مع الوضعيات المشاكل أي حل المسائل اكتسابا لكفايات أفقية مساعدة على تنمية التفكير النقدي إلى جانب مادة الفلسفة البانية للطريقة النقدية وللشك المنهجي في مجمل قضايا الحياة.وتحتل التربية العلمية مكانة هامة في منظومة القيم المعرفية بجل البلدان العربية حيث يهدف تدريس العلوم في المقام الأول إلى بناء مواقف رشيدة تجاه الكائن الحي في علاقته بالمحيط وإلى التيقظ التدريجي لواقع المحيط الطبيعي والتعامل الرشيد مع مكوناته والسعي إلى تطويرها والمحافظة عليها كما تهتم الأنشطة العلمية التجريبية بتحقيق كفايات أفقية”[15] (كالبحث وإنجاز المشاريع وممارسة الفكر النقدي).
هذه بعض الغايات والأهداف التربوية التي قصدتها جل الأنظمة التربوية في العالم العربي والإسلامي من مواد التفكير العلمي كالرياضيات وعلوم الحياة والأرض والفلسفة فماهو واقع الحال وإلى أي مدى تحققت؟ فماهي مظاهر المعضلة المتعلقة بتدني المردود العلمي والفلسفي للمدرسة العربية؟
يصف محمد الدريج في مؤلفه التدريس الهادف ملامح الإنسان العربي قائلا: “إن من ملامح الانسان العربي المنشود الذي
تسعى المنظومة التربوية لتخريجه وإعداده هو ذاك الفرد الذي يتصف تفكيره بالموضوعية والوضوح والدقة كما يتصف بالنظرة الشمولية ويتخذ من الأسلوب العلمي منهجا في التفكير وفهم الظواهر لمعالجة الأمور كما يتميز بدقة الملاحظة وسداد الرأي وأن يتصف بروح الابتكار والإبداع وتجنب التقليد الأعمى وأن تكون له القدرة على إعمال الفكر واتخاذ المواقف والمبادرات الشخصية وأن يكون متدربا على أساليب النقد والبحث وإبداء الحكم الشخصي ومواجهة الإشكاليات و المواقف المستجدة”. فإذا كانت هذه بعض ملامح الإنسان العربي المنشود الذي تنشده المدرسة العربية في جل مراحل التعليم فإلى أي مدى ترجمت تلك الغايات والأهداف والمبادئ والقيم إلى مخرجات كمية ونوعية ؟
بذلت المنظومات التربوية العربية في هذا الاتجاه مجهودا وصفته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في وثائق استراتيجياتها (2006) بالمحدود رغم ما بذل من تعديل للمناهج وتطوير للجوانب الكمية للتعليم. هذا البون بين النوايا والنتائج يمثل نقطة انطلاقنا في تشخيص هذا المظهر من مظاهر المعضلة التربوية والتعليمية في العالم العربي والاسلامي.
فماهي أسباب ذلك الخلل وما هي انعكاساته على مستوى تكوين الأجيال و ما أثره على أوضاع المجتمع العربي؟
أولا :من مظاهر التردي للمخرجات المتعلقة بالتفكير العلمي والنقدي:
يحتل التفكير العلمي والفلسفي مكانة متميزة في المناهج الدراسية العربية و في كل المراحل من الأساسي إلى الجامعي ويعد المتفوقون فيهما من النخب التي تفتخر بهم المنظومة التربوية و تعتبرهم من أول المسهمين في إنتاج المعرفة وذلك من خلال ما ينشرونه من منشورات وما يسجلونه من براءات واختراعات وابتكارات وما ينجزونه من بحث علمي وتطوير تقني تعده التقارير الدولية في حساب الجودة.
و من المواد المسهمة بامتياز في ذلك المواد العلمية التجريبية و التجريدية المحركة للتفكير والبانية للمعرفة.
لا شك أن الرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والارض والتكنولوجيا والفلسفة من المواد الأساسية في التعليم العام وكذلك التخصصات الجامعية في التعليم العالي لما لها من إسهام في تنمية مهارات التفكير لدى الطلاب والطالبات وتطوير قدراتهم الذهنية.فعلى الرغم مما شهدته التربية العربية من تطور ونمو في بعض الجوانب فإنها بحاجة إلى عمليات تقويمية تطويرية وشاملة (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 2006)
إلا أن التقارير الدولية الواصفةلتوجهات مستويات الأداء في الرياضيات والعلوم TIMSS-2003 والتي تجريها الجمعية الدولية لتقييم الأداء التربوي (IEA) كل أربع سنوات لتقييم تحصيل الطلبة في الرياضيات والعلوم وفرت معلومات وطنية وعالمية قياسية للدول المشاركة حول أداء سياساتها واستراتيجياتها ومؤسساتها المعنية بالتعليم الأساسي،. وقد شارك في دراسة TIMSS-2003 حوالي46 دولة، منها عشر دول عربية هي: مصر، ولبنان، واليمن، وفلسطين، وسوريا تونس، والمغرب، والأردن والسعودية، والبحرين حيث شاركت 8 دولٍ في الصف الثامن، ودولتان في الصفين الثامن والرابع (تونس والمغرب)، ودولة واحدة في الصف الرابع فقط هي اليمن.
وبعد أن تم إعلان التقرير الدولي حول نتائج الدول المشاركة في دراسة TIMSS-2003 قرر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إعداد تقرير إقليمي اشتمل على ستة فصول.
تناول الفصل الأول بشيء من التفصيل إجراءات الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم TIMSS 2003، وإطارها النظري، وأهدافها، وأدواتها، من اختبارات أداء واستبيانات، كما استعرض طبيعة عينات الدول المشاركة وآليات اختيار هذه العينات.
أما الفصل الثاني فقد استعرض متوسطات الأداء في الرياضيات لكل دولة مقارنة بالمتوسطين العربي والدولي، كما وصف متوسطات الأداء وفقاً لبعض المتغيرات ذات العلاقة، كأجزاء المحتوى الرياضي والجنس، ثم تناول طبيعة الأداء في الرياضيات وفق مستويات الأداء الدولي كما حددتها الجهات الدولية المشرفة على الدراسة.
لقد بينت نتائج هذا الفصل فيما يتعلق بالصف الثامن، أن المتوسط العربي لمستويات الأداء في الرياضيات قد بلغ 393 علامة مقارنة بالمتوسط الدولي الذي بلغ 467 علامة، وقد عكس هذا المؤشر تدني المتوسط العربي العام في الرياضيات والذي فسره تدني متوسط أداء جميع عينات طلبة الدول العربية عن المتوسط الدولي.
وقد كشفت نتائج الدراسة للصف الثامن فيما يتعلق بمستويات الأداء الدولية، أن نسبة قليلة جداً (لم تبلـغ 1%) من الطلبة العرب قد وصلوا إلى مستوى الأداء المتقدم ، في حين لم يبلغ (45%) من الطلبة العرب مستوى الأداء المنخفض الذي يمثل الحد الأدنى من الأداء المقبول في الرياضيات. أما بالنسبة للصف الرابع، حيث شاركت ثلاث دول عربية هي تونس والمغرب واليمن، كانت نتائج الرياضيات أسوأ من مثيلتها في الصف الثامن، فقد بلغ متوسط الأداء العربي لهذا الصف 321 علامة مقارنة بـ 495 علامة للمتوسط الدولي.
أما فيما يتعلق بالأداء وفق مستويات الأداء الدولية، فقد تكررت النتيجة ذاتها مع الصف الثامن، وبصورة أكثر سوءاً، حيث بلغت نسبة الطلبة العرب الذين لم يبلغوا مستوى الأداء المنخفض 76%. وفي الفصل الثالث من هذا التقرير تم ربط مؤشرات الأداء في الرياضيات ببعض المتغيرات ذات العلاقة، كالمتغيرات المتعلقة بالطالب والمنهاج والمعلِّم والمدرسة، في محاولة لتوفير مجموعة من البيانات التي تمكن التربويين – على كافة مستوياتهم- من الوصول إلى استنتاجات توجه صناعة القرار التربوي بما يخدم عملية تطوير الأنظمة التربوية العربية. فبالنسبة للمتغيرات المتعلقة بالطالب، تناول هذا الفصل متغيرات الخلفية الأسرية (الاجتماعية والاقتصادية) للطالب، وطموحه وثقته بقدراته، وممارساته الدراسية، واتجاهاته نحو مادة الرياضيات.
أما المتغيرات المتعلقة بالمنهاج فقد شملت وجود منهاج وطني، وامتحانات وطنية ونسبة الوقت المدرسي المخصصّ للرياضيات، وطبيعة المهارات التي تضمنتها مناهج الرياضيات، ومدى تغطية مناهج الرياضيات الوطنية لمهارات الرياضيات التي قاستها اختبارات الدراسة الدولية.
أما المتغيرات المتعلقة بالمعلم فقد شملت متطلبات تعزيز ودعم مهنة التعليم في الرياضيات، والجهات الوطنية المسؤولة عن إجازة مهنة التعليم، والإعداد الأكاديمي والمهني لمعلمي الرياضيات، وتخصصات هؤلاء المعلمين.
أما متغيرات المدرسة، فقد غطت خصائص العمليات الصفية، وخصائص الفصل – الشعبة- التي تقدمت لاختبارات الدراسة الدولية، والزمن المخصص لتدريس الرياضيات، ومحتوى مادة الرياضيات التي تدرّس للطلبة، وطرق التدريس التي يعتمدها المعلّم، واستعمال الآلات الحاسبة والحواسيب في عمليتي التعليم والتعلّم، واستراتيجيات التعليم التي يعتمدها معلمو الرياضيات، ومشاركة المجتمع المحلي وأولياء الأمور في العملية التعليمية، وجودة البيئة ، والأمان داخل المدرسة.
وفي الفصل الرابع من هذا التقرير تم استعراض متوسطات الأداء في العلوم لكل دولة مقارنة بالمتوسطين العربي والدولي، كما تم وصف متوسطات الأداء حسب بعض المتغيرات ذات العلاقة، كأجزاء محتوى مادة العلوم والجنس.
ثم تناول الفصل طبيعة الأداء في العلوم مقارنة بمستويات الأداء الدولية كما حددتها الجهات الدولية المشرفة على الدراسة. وقد بينت نتائج هذا الفصل فيما يتعلق بالصف الثامن، أن المتوسط العربي للأداء في العلوم قد بلغ 419 علامة، مقارنة بالمتوسط الدولي الذي بلغ 474 علامة. وقد عكس هذا المؤشر تدني المتوسط العربي العام في العلوم، ولكن بصورة أقل حدّة مما كانت عليه الحال في الرياضيات، فقد تجاوزت دولة عربية واحدة (الأردن) المتوسط الدولي بعلامة واحدة فقط.
وقد كشفت نتائج الدراسة بالنسبة للصف الثامن فيما يتعلق بمستويات الأداء الدولية، أن نسبة قليلة جداً بلغت (1%) من الطلبة العرب قد وصلوا إلى مستوى الأداء المتقدم في حين لم يبلغ (41%) من الطلبة العرب مستوى الأداء المنخفض الذي يمثل الحد الأدنى من الأداء المقبول في العلوم. أما بالنسبة للصف الرابع، حيث شاركت ثلاث دول عربية هي تونس والمغرب واليمن، فقد كانت نتائج العلوم أسوأ من مثيلتها في الصف الثامن، حيث بلغ متوسط الأداء العربي لهذا الصف 289 علامة مقارنة بـ 489 علامة للمتوسط الدولي.
أما فيما يتعلق بمستوى الأداء مقارنة بمستويات الاداء الدولية للصف الرابع، فقد تكررت نفس نتيجة الصف الثامن وبصورة أكثر سوءاً، حيث بلغت نسبة الطلبة العرب الذين لم يبلغوا مستوى الأداء المنخفض 76%. أما الفصل الخامس من هذا التقرير، فقد تم ربط مؤشرات الأداء في العلوم ببعض المتغيرات ذات العلاقة، كالمتغيرات المتعلقة بالطالب والمنهاج والمعلِّم والمدرسة، في محاولة لتوفير مجموعة من البيانات التي تمكن التربويين – على كافة مستوياتهم- من الوصول إلى استنتاجات توجه صناعة القرار التربوي بما يخدم عملية تطوير الأنظمة التربوية العربية.
كما تناول هذا الفصل متغيرات الخلفية الأسرية (الاجتماعية والاقتصادية) للطالب، وطموحه وثقته بقدراته، وممارساته الدراسية، واتجاهاته نحو مادة العلوم. بالاضافة الى المتغيرات المتعلقة بالمنهاج، التي شملت وجود المنهاج الوطني، والامتحانات الوطنية ونسبة الوقت المدرسي المخصصّ للعلوم، وطبيعة المهارات التي تضمنتها مناهج العلوم، ومدى تغطية مناهج العلوم الوطنية لمهارات العلوم التي قاستها اختبارات الدراسة الدولية.
أما المتغيرات المتعلقة بالمعلّم فقد شملت متطلبات دعم وتعزيز مهنة التعليم في العلوم، والجهات الوطنية المسؤولة عن إجازة مهنة التعليم، والإعداد الأكاديمي والمهني لمعلمي العلوم، وتخصصات هؤلاء المعلمين.
أما المتغيرات المتعلقة بالمدرسة، فقد غطت خصائص العمليات الصفية، وخصائص الفصل – الشعبة- التي تقدمت لاختبارات الدراسة الدولية، والزمن المخصص لتدريس العلوم، ومحتويات مادة العلوم التي تدرّس للطلبة، وطرق التدريس التي يعتمدها المعلّم، واستعمال الحواسيب في عمليتي التعليم والتعلّم، واستراتيجيات التعليم التي يعتمدها معلمو العلوم، ومشاركة المجتمع المحلي وأولياء الأمور في العملية التعليمية، وجودة البيئة ، والأمان داخل المدرسة.
من ذلك ما يؤكده القائمون بتدريس الرياضيات لطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي من ضعف ملحوظ في اكتساب المبادئ الرياضية الأساسية لعدد كبير منهم كالعمليات الحسابية على الكسور، والإلمام بجدول الضرب، وتحليل الأعداد إلى عواملها الأولية، وحل معادلات من الدرجة الأولى والثانية و التعامل مع الجذور، وغيرها من أساسيات الرياضيات التي تعلمها الطالب والطالبة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.
والواقع أن هذه الشكوى لا تصدر ممن يدرس الرياضيات فحسب بل ممن يقوم بتدريس مواد أخرى كالفيزياء والكيمياء والحاسب والهندسة (إبراهيم العليان، 2009).
وبطبيعة الحال هذا لا ينفي وجود طلاب وطالبات متميزين في الرياضيات يملكون مهارات عالية في هذه العلوم، والدليل على ذلك تفوقهم الدراسي في مواد الرياضيات في التعليم العام والجامعي وتفوقهم في اختبار القدرات الدولية ، وكذلك إبداعهم في المسابقات الوطنية المختلفة في الرياضيات و الفيزياء و التكنولوجيا.
ترى ما سبب هذا الضعف في أساسيات الرياضيات و العلوم و التفكير النقدي؟
ثانيا :من الأسباب الفكرية والتطبيقية المفسرة للظاهرة:
1 – أسباب ابستمولوجية تعود إلى طبيعة المعرفة ذاتها و تعامل المتعلم معها:
لعله من الأسباب على سبيل المثال لا الحصر: أن هذا العلم مجرد تراكمي و دقيق، إذ لا يمكن لطالب مهما كان مستوى نبوغه أن يبدأ بدراسة الرياضيات من المرحلة المتوسطة مثلًا بدون أن يدرس المبادئ الأساسية التي تدرس في الابتدائي كالجمع والطرح وجمع الكسور والأشكال الهندسية وجدول الضرب، وغيرها من المفاهيم الأساسيةإضافة إلى ما تستوجبه مادة الرياضيات من تحليل منطقي وفهم وتركيز ومذاكرة مستمرة، وتدرب على حل المسائل غير المألوفة . لقد بينت الدراسات التعلمية المهتمة بدراسة تمشيات اكتساب المعارف المجردة أن المتعلم لا ينجو من عوائق ابستمولوجية تعترضه في حصص الرياضيات ومن أخطاء عديدة يجدر به أن يتجاوزها.إن صعوبات كالتي وصفنا تستوجب في حقيقة الأمر تكوينا خاصا في تعلمية المواد أو الديداكتيك وعلوم التدريس ونظريات التعلم و التعليم.
هذا بالنسبة للرياضيات والعلوم الطبيعية والفيزيائية، أما بالنسبة للفلسفة فإن إسهامها في بناء التفكير النقدي مشروط بالتدرب على السؤال والتسآل والمساءلة فإذا غاب الحوار والنقاش غاب التفكير الحر الباني للرأي المستنير والمستقل .
2 – أسباب بيداغوجية تعود إلى المعلم وطرائقه:
أبرزت جل الدراسات التعلمية أهمية دور المعلم في حصص الرياضيات فهو الذي يجعل من الحصة حصة متعة أو حصة ضجر و نفور فهو إما ميسر يساعد على تجاوز العوائق أو مكبل لها وإما أن يتصور الخطأ ضرورة للتعلم أو أن يعتبره قصورا في ذهن المتعلم.
إن المتأمل في الطرائق التي يتوخاها السواد الأعظم من المعلمين في العالم العربي والإسلامي يجد إصرارا على التمرير و التلقين للمعارف وسرد الحقائق وحفظها دو توجيه للتدبر فيها أو مناقشتها لذلك يلجأ الكثير منهم في تدريسهم إلى الاستظهار و التكرار الممل و المنفر للعلم و أهله.كذلك الأمر عند تدريس المواد العلمية التجريبية حيث يعمد العديد من المعلمين إلى تحويل غرفة الصف إلى ساحة الإلقاء والتلقين وكتابة تملأ السبورات السوداء.
أما بالنسبة لتعليم الفلسفة في العالم العربي والإسلامي فيبدو أنه ” واقع في كماشة متكونة من ثلاثة أقطاب لا يقدر على الفرار منها فهو من جهة واقع تحت ضغط المؤسسة التربوية القائمة ومن جهة ثانية هو مطالب بتحقيق المصالحة مع النسيج الثقافي الدارج ومن جهة ثالثة يطلب منه أن يخصع لمستلزمات القول الفلسفي ذاته و إلا فقد الماهية التي تخصه فكيف تقدر الفلسفة على خدمة ثلاثة أسياد في الآن نفسه؟”( زهير الخويلدي ،2007) فأين لتعليم الفلسفة أن يبني تفكيرا نقديا؟
إن تعليم الفلسفة في جوهره عمل تربوي هادف يرفض الترويض الإيديولوجي والاستغلال السياسي ويقطع مع الشعارات الزائفة والأفكار الدارجة في المجتمع ويستوجب توفر الحرية الفكرية للمعلم و للمتعلم على حد السواء.إن تعليما في مثل هذه الظروف التي وصفها الخويلدي يمكن أن تؤسس لفكر نقدي يعزز الانتماء الخضاري ويصون الهوية من التفتت والضياع في عالم معولم.
ومن هذا المستوى التفسيري لهذا المظهر الدال من مظاهر المعضلة التربوية يجدر بنا أن نوجه عناية جل المهتمين بالبناء النظري والتطبيقي لنموذج التربية الأصيلة إلى أهمية الأهداف والمناهج والطرائق المساعدة على تأسيس تعليم يبني العقول ويحررها و يعلم الحكمة ويزكي النفوس ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالحِكمَةَ وَيُزَكِّيهِم﴾ (البقرة: 129).
رابعا: من انعكاسات تدني المردود الفكري على مستوى تكوين الأجيال:
ومما لا شك فيه أن ضعف الأساسيات لدى الطلاب سوف يؤدي إلى صعوبة في فهم محتوى مواد الرياضيات التي يدرسها الطالب حاليًا مما يؤدي إلى نسب عالية في الرسوب ليس بسبب عدم فهم الطالب للمادة العلمية الجديدة المقدمة. وهنا نجد أن من يقوم بتدريس مواد الرياضيات لديه ثلاث اختيارات، إما إعادة هذه المفاهيم للطلاب في بداية كل مقرر، وهذا بالطبع يحتاج إلى وقت سوف يؤثر على محتوى المقرر الحالي، أو أن يستمر في شرح المقرر مع ارشادات سريعة عند ورود مفهوم أساسي غير مستوعب لدى أغلبية الطلاب. وهنا أيضًا يتم استنـزاف جزء من الوقت المخصص لمحتوى المقرر في شرح أسس يفترض أن الطالب ملم بها أو يخصص لها درس خصوصي.
وهنا يمكن القول أن التعثر في استيعاب مقررات هذه المادة والبحث عن التفوق والتنافس غير النزيه أديا معا إلى استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية التي حولت التعليم إلى شكل من أشكال التجارة الرخيصة. لقد تحولت ظاهرة الدروس الخصوصية إلى مظهر من مظاهر التسليع التربوي أي النظر إل التعليم كسلعة يقدمها البائع – المعلم إلى المشتري- الطالب ويسوقها من أجل المال والتحايل على الكسب غير المشروع والفساد والإفساد وطغيان المنافع الذاتية على المصلحة العامة (السورطي، 2009).
فالتدريس الخصوصي جعل من صورة المدرس في نظر الكثيرين أقرب إلى صورة التاجر النهم وهو في حقيقة الأمر ما يتناقض مع المكانة التي بوأها له ديننا الإسلامي الحنيف،أليس العلماء ورثة الأنبياء؟حديث نبوي شريف ألا يتناقض ذلك مع ما جاء في التراث العربي الاسلامي على لسان ابن جماعة “الذي يرى أن من أهم الصفات التي يجب أن تتوفر في المعلم تنزيه العلم عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة” (الخطيب، 1995)؟
لقد أصبحت الدروس الخصوصية مرضا مزمنا تراكمت أسبابه وتفاقمت أعراضه وتحولت إلى أزمة سرطانية أصاب انتشارها الجسم التعليمي بالضعف و الهزال”( حامد عمار، 1998) مما يؤشر لعجز النظام التربوي العربي عن تحقيق عدالة بين المتعلمين و تهديد مبدإ تكافؤ الفرص التعليمية ما دام معظم اللاجئين إليها ينحدرون من أوساط اجتماعية و اقتصادية مرتفعة و يحرم بالتالي منها عدد كبير من أبناء الطبقات الفقيرة.
هذا بالإضافة إلى إضعاف قيمة المدرسة وتقليل الاحترام لها والتشكيك في مخرجاتها لضعف مردوديتها وكفايتها الداخلية(مصطفى محسن، 1999).
هذا مؤشر ينبئ بأن أزمة النظام التربوي العربي ليس مجرد اختلال وظيفي لا يتطلب سوى بعض التعديلات البسيطة للإصلاح بل هي أزمة مركبة معقدة متشابكة العناصر والمكونات انخرط فيها المعلم و المتعلم و المواطن وتغاضى عنها المؤسسة التربوية والسلطات الرادعة.
خامسا:من آثار تدني المخرجات المتعلقة باكتساب التفكير العلمي في أوضاع المجتمعات العربية:
لقد أدى انحسار المردود الفكري والعلمي إلى عواقب وامتدادات خطيرة تربوي وثقافية واجتماعية.
تراجع التفكير العلمي والناقد ما عدا بعض الموهوبين أو المحضوضين من الأسر المرفهة القادرة على شراء الدروس الخصوصية.
فقدت المدرسة في الظرف الراهن الكثير من قيمتها الاجتماعية والاقتصادية فترتبت على ذلك هشاشة ربط بين ما خطط لأنظمة التعليم والتكوين وبين المحيط الثقافي والاحتماعي الاقتصادي.
هكذا إذن يسجل تراجع لمكانة المدرسة نتيجة لعلاقة اللاتكامل والانفصال القائمة بين النظام التربوي والنظام الانتاجي والاجتماعي.أما على مستوى تحولا ت النسق القيمي والمجتمعي العام فقد تدهورت القيم الاجتماعية والاقتصادية للأسر وتعمق الإحساس بقيمة العلم والتعليم والمعرفة والثقافة والفن وكل أشكال الابتكار والابداع واستبدالها بقيم مناقضة منحطة في مجملها مؤكدة على تصدر قيم المال والوجاهة الاجتماعية وامتدادها.
ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى توقع بروز مشكلات وتفاقمها كتردي المنقطعين والمتسربين من تعليم انتقائي محدود المردودية الفكرية والعملية إلى استفحال ظاهرة الأمية الأبجدية والرقمية والحضارية وانفجار المسألة الشبابية نامي الهجرة السرية والتطرف وهجرة الكفاءات والخبرات العلمية والفنية وبالتالي إفقار المجتمع و إرغامه على التبعية للأجنبي .
وفي خاتمة هذا التحليل لهذا المظهر من مظاهر المعضلة التعليمية والتربوية (انحسار المردود العلمي والفكري وتدني المخرجات المتعلقة بالرياضيات والعلوم والفلسفة) يجدر اقتراح بعض الحدوسات التطبيقية التي يمكن استنتاجها في هذا المستوى على الأقل من ذلك مثلا:
-الصياغة الدقيقة لفلسفة تربوية و تعليمية متجددة تولي مكانة متميزة للعلم و العلماء.
-انتقاء المعلمين المستخلفين والقادرين على ترغيب المتعلمين في العلم وأهله.
-تأهيل المعلمين وتكوينهم في تعلمية المواد العلمية والفكرية ليكونوا على بينة من العوائق الابستمولوجية التي قد تعترض طلبتهم و من الطرائق الجيدة المساعدة على تملك المعارف التجريبية والتجريدية.
-اعتماد الأساليب والطرائق المرغبة في تعلم المفاهيم وحل المشكلات بالاعتماد على الحوار والتشجيع على التأمل في الممارسة و استثمار الميتاعرفانية في التعلم (نبيل علي ،2009).
هذه إيحاءات أولى لعلها تضيء السبيل للمهتمين ببلورة ملامح نموذج تطبيقي لتربية أصيلة مؤمنة مجددة.
المبحث الخامس
مظاهر الاغتراب لدى الطلاب ومعلميهم
أولا: واقع الاغتراب لدى الطلبة العرب:
ذكر (محمد الدريج، 2004) في مؤلفه “التدريس الهادف بالأهداف التربوية العامة التي تواترت في لوائح الأنظمة التربوية العربية و بما تنشده من تفتح وشعور بالحرية والانتماء والاستقلالية والمسؤولية الفاعلة. ونوّه بما تبذله المدرسة العربية من مجهود منذ الأيام الأولى من استقلالها من خلال ما شرعته من قوانين وما وضعته من برامج تنموية عديدة هدفها رفع مكانة الإنسان الاجتماعية والثقافية.
إلا أن المتأمل في المخرجات وفي سلوك الخريجين من المؤسسات التربوية في أنحاء الوطن العربي يلاحظ شعورا بالخيبة والعزلة والعجز عند عدد لا بأس به من الشباب الحائر والتائه يصفه الباحثون بشكل من أشكال الإغتراب والشعور بالانفصال والانفصام.
ذلك ما وصفته عديد الدراسات والأبحاث التي اهتمت بظاهرة الإغتراب لدى عدد كبير من خريجي المؤسسة التربوية العربية من ذلك ما ذكره (السورطي، 2009) في مؤلفه الذي وصف فيه تباعا الدراسات التالية في كل من مصر والكويت والاردن والمملكة العربية السعودية:
1-دراسة( عطية، 1989) التي أبرزت أن من أهم مشكلات الطلاب الجامعيين في مصر وفي تلك الفترة بالذات ما لوحظ من :
– صراع دائم بين ما يعتقده الطلبة وبين القيم السائدة في مجتمعهم ومن تناقض بين ما تعلموه وواقع الحياة اليومية
-شعور بالعجز تمثل في صراع بين بين رغبة في التغيير و استحالة تحقيق الأهداف
-ضياع الجادين من الطلبة وسط زحام الحياة و افتقاد الأمل في جدوى التعليم
2-دراسة (حافظ، 1980) التي أظهرت نتائجها وجود اغتراب بين أفراد عينة من الجامعيين المصريين حيث تمثلت مظاهر اغترابهم في شعورهم بالسخط وعدم الانتماء والقلق والعدوانية.
كما أبرز دراسة (الأشول وآخرون، 1985) وجود الاغتراب والشعور بالعزلة الاجتماعية والعجز واللامعنى واللامعيارية و التمرد بنسبة 66,44 بالمائة لدى أفراد عينة من طلاب وطالبات الجامعات المصرية.
3-لقدأوضحت نتائج دراسة (الكندري، 1998) شعور أفراد عينة (مكونة من1057) طالبا وطالبة اختيروا من مدرسة ثانوية كويتية بالاغتراب الاجتماعي وإحساسا بفقدان القيم
4-كما أجرى (القريطي وآخرون، 1991) دراسة على عينة من الشباب الجامعي السعودي بينت نتائجها انتشار الاغتراب بين أفراد العينة بنسبة 25.29 بالمائة و أظهرت نتائج دراسة أجراها (أبوبكر، 1992) وجود اغتراب اجتماعي لدى عينة من الطلبة السعوديين تمثل بالأساس في:
-عدم قدرتهم على أخذ القرار
-عدم التكيف مع الذات والنفور من الحياة والإحساس بعدم جدواها
– الانعزال عن المجتمع والابتعاد عن الانخراط في النظم الاجتماعية السائدة
5- أجرى (حوامدة، 1999) دراسة أوردها (الرشدان، 2000) وأظهرت نتائجها أن نسبة الاغتراب لدى عينة من طلبة ثلاث جامعات أردنية بلغت 94,30 بالمائة في النسق الأكاديمي علما أن مؤشرات الاغتراب تمثلت في فقدان المعنى، والانعزال الاجتماعي وفقدان السيطرة و اللامبلاة وفقدان المعايير.
فإذا كانت هذه دراسات أجريت منذ عشر سنوات أو أكثر تقريبا فماهو واقع الاغتراب الطلاب في بدايات القرن الحادي والعشرين في البلدان العربية ؟ ونظرا لتعدد الدراسات التي عثرنا عليها نكتفي بعينة حول ظاهرة الاغتراب الطلابي وعلاقتها بالأمن النفسي أجراها (العقيلي، 2005) على مجموعة من الطلبة السعوديين من كافة التخصصات ومن الملتحقين بجامعة الإمام محمد بن سعود بمدينة الرياض أبرزت وجودا دالا لاغتراب لديهم تمثل أساسا في عدم الشعور بالطمأنينة.
هكذا يبدو إذن رغم اختلاف السياق و القطر الذي أجريت فيه الدراسة وجود ظاهرة الاغتراب التي قد تكون أوجدتها عوامل معقدة و متداخلة من بينها التعليم و التربية في تلك المؤسسات التي درسوا بها .
و مهما يمن من أمر” فإن التعليم العربي بشكل عام مسؤول عن تردي أوضاع كثير من الطلاب و تفشي مظاهر الاغتراب لديهم مما يؤثر سلبا على قيمهم واتجاهاتهم و اختياراتهم و طموحاتهم “( السورطي، 2009).
فإذا كان واقع الاغتراب لدى طلبة مؤسساتنا التربوية فماهي الأسباب التي تفسر ذلك ؟
ثانيا:من الأسباب المفسرة لظاهرة الاغتراب الطلابي:
يبدو من خلال هذه العينة من الأبحاث المجراة في أقطار مختلفة من العالم العربي والإسلامي أن عوامل عديدة ساهمت في إفراز هذه الظاهرة منها ما هو تدبيري إجرائي يعود مباشرة إلى النظام التربوي وكيفية اشتغال مدخلاته البشرية والمادية و منها ما هو رؤيوي كامن في فلسفة التربية ومناهجها وفي اختيارات المجتمع الثقافية والاقتصادية، لذلك سنحاول تحليل ذلك مركزين على ما تواتر في الادبيات ذات العلاقة .
- فعل التغريب الثقافي في التربية والتعليم:
لقد ساعد التغريب الثقافي في وطننا العربي على بروز أشكال عديدة ومظاهر غريبة من مظاهر الاغتراب تعود في جلها إلى المناهج الدراسية المتأثرة بالغرب والإدارة التربوية .
لقد أعدت جل فلسفات التربوية العربية من قبل نخب مغتربة ثقافيا -إلا ما رحم ربنا-تأثرت حينا بالبراغماتية واحيانا أخرى بالوجودية كانوا قد تلقوا علومهم التربوية في الجامعات الأمريكية والغربية.
يعد التغريب إذن سمة من السمات الجلية في محتوى المناهج التعليمية العربية بالجامعات حيث عمد المشرعون في تلك البلدان إلى اقتباسها من نظم أجنبية غربية ممايسر تمرير ألوان مختلفة من السلوك وأساليب تفكير وعمل نشأت
معطمها قي بيئة غريبة عنا.
إن التغريب الثقافي سلاح من أمضى الأسلحة التي وظفها الغرب بطرائق مباشرة وغير مباشرة خدمة للمصالح الغربية دعمته هيمنة إعلامية أكثر خطورة وتأثيرا في صفوف الطلبة والطالبات.
لقد تمكن الاعلام الغربي في عصرنا هذا “من الاتصال بالطلبة عبر الشبكة العنكبوتية بشكل يومي منتظم وسريع وبأساليب متنوعة (الصوت والصورة والكلمة) والتي أصبحت أبلغ أثرا من الوسائل التعليمية المعتمدة في فصول المدارس والكليات العربية”(منور، 1995) ذكره السورطي2009م.
لقد ساعد التغريب الثقافي في العالم العربي والإسلامي عبر الإعلام والتدخل في المناهج على تهميش للغة العربية وتكريم خاص للغة الأجنبية(الانجليزية والفرنسية) يقابله تحجيم لحصص التفكير والتربية الاسلامية أنتج فصل العلوم الدينية عن العلوم والمعارف الأخرى وضعفا شديدا في التواصل بلغة القرآن التي تحولت عند العديد من الطلبة إلى مجرد وسيلة هزيلة للتعامل اليومي بينهم وباتت هيكلا من هياكل التخلف ولم تعد أداة تواصل حضاري (غصيب، 1995).
ومما تجدر ملاحظته في مستوى صياغة هذه الفرضية التفسيرية للمعضلة التربوية أنه رغم التشريع الواضح لأهداف تربوية تعتبر اللغة العربية هي لغة التدريس الرسمية والأولى نجد جل الجامعات العربية تستبعد لغة القرآن من تدريس العلوم ماعدا المؤسسات السورية.هذا في حقيقة الأمر من أخطر صور التغريب التربوي المؤدي بدوره إلى عزل اللغة العربية و بالتالي ضرب مكون أساسي من مكونات الهوية العربية الإسلامية وإيجاد اغتراب طلابي تبرزه مؤشرات عديدة نوجز أبرزها فيما يلي:
أ-بروز شعور لدى كثير من الطلبة بقصور اللغة العربية عن تعليم العلوم و الرياضيات و الهندسة و هو ما قد يعمق عقدة النقص ويزيد في احتقارهم لهويتهم و يضعف انتماءهم الثقافي و الحضاري (السورطي، 2009) .
ب-تعريض الطلبة لمشكلة تواصلية بسبب الانفصام اللغوي والازدواج الثقافي
ج_ إعاقة فهم الطلاب للمادة العلمية
د_تبديد وهدر قدرات الطلبة في ترجمة ما يدرسونه
ه_غربة المثقف العربي عن المحتمع الذي يئن من الأمية الأبجدية والرقمية
2-أثر العلاقة التربوية المتسلطة في بروز الاغتراب الطلابي:
أبرز (السورطي،2009) في مؤلفه سلطوية التربية العربية أثر العلاقة التربوية المتسلطة في ظهور أعراض الاغتراب لدى عدد لابأس به من الطلبة والطالبات المتابعين للدروس بمؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي والعالي أو أولئك الذين تخرجوا منها أو تسربوا منها.
لقد بينت نتائج العديد من الدراسات أن المعلم في الوطن العربي يميل إلى التشدد و ويجنح كثيرا إلى التسلط والعقاب من ذلك ما توصلت إليه دراسة كل من (أبو زيد وحيدر،1994) من تسجيل غلبة للنمط التسلطي لدى معلمي المرحلة الإعدادية حيث وجد أن كثيرا منهم يسهمون في تضييق الحرية داخل الفصول الدراسية ويجرحون مشاعر المتعلمين لأبسط الأخطاء و يستمتعون بإصدار الأوامر ويستخدمون العقاب النفسي والجسدي لضبط الفصول.
و المتابع لمسألة العلاقة المتسلطة لمعلمين يلاحظ أن انتشار التوجه التسلطي هذا لم يقتصر على التعليم المدرسي فقط بل صار يشمل كثيرا من أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي حيث بينت نتائج دراسة أجريت على عينة من طلاب إحدى الجامعات العربية أن رغبة الأستاذ في السيطرة الكاملة على الدرس ما زالت تحتل أولوية لديه.لقد أظهرت نتائج بحث أجراه (عبد الموجود،1994) أن العلاقة بين الأستاذ والطالب تقوم أحيانا على الشعور بالخوف من قبل الطالب والاستعلاء من جهة الأستاذ،ما يجعل هذا الأخير يميل إلى أساليب القهر الفكري ويلجأ الطالب في المقابل إلى أساليب التملق والنفاق.
لقد بينت الدراسات المجراة في الوطن العربي أن السيطرة على الفصل و ضبط النظام هما من الأولويات لدى المعلمين فهم يفضلون الاستماع و التلقي،أما التفاعل و المناقشة فتعني عند الكثير منهم و التسيب و إضاعة الوقت.
يلجأ البعض منهم إلى فرض الرأي و آخرون إلى العقاب و القسوة ضد المتعلمين رغم دعوة علماء الأمة إلى الرفق في
التعامل معهم و السير على قدر أدناهم على الرغم من أن القسوة على المتعلمين تؤدي كما أشار ابن خلدون إلى القهر والتضييق على النفس و إضعاف النشاط والتعود على الكسل والكذب و النفاق والخوف والمكر والخديعة والاعتماد على الآخرين وإفساد معاني إنسانيتهم .
هذه العلاقة السلطوية بين المعلم و طلابه تؤدي إذن إلى نتائج وآثارا سلبية من أهمها:
_ إضعاف روح المبادرة وخفض قدرتهم على اتخاذ القرار المستقل
– قلة حماس المتعلمين لعملهم وضعف اهتماهم بدراستهم
– اكتساب تلاميذ المعلمين المتسلطين سلوك التمرد والانسحابية والغضب والعداء والمساومة.
3 – التمييز التربوي وأثره في الاغتراب الطلابي:
- التمييز الطبقي:
يقصد بالتمييز التربوي تغييبا لمبدإ تكافؤ الفرص و هو أيضا شكل من أشكال التسلط المؤدي إلى حرمان المتعلمين من حقوقهم بطريقة تعسفية ومن دون وجه حق(السورطي، 2009). ذلك ماأظهره استقراء واقع التربية في العالم العربي والإسلامي من تأثر فرص التعليم التي يحصل عليها الطلاب بأصولهم الاجتماعية و الاقتصادية فالأغنياء هم المستفيدون على حساب الفقراء.
إن الانتماء الطبقي للأفراد قد يؤثر في الطموح المستقبلي ذلك ما جعل أحد الباحثين يصف ما يلي :” أن صفوة قليلة من الشباب هي التي تتمتع بنعم التعليم العام حقا في مراحله الثلاث و هي التي تحتكر لنفسها ما يترتب على ذلك من المغانم
الاجتماعية فيما بعد.
ب-التمييز على أساس الجنس:
يلاحظ في العالم العربي والإسلامي أنه رغم الجهود المبذولة في تعليم الجنسين و التأكيد على تشجيع البنت على التعلم لا يزال التمييز بين الجنسين و عدم تكافؤ الفرص بينهما واضحا في بعض الأقطار العربية حيث بلغت نسبة الأمية بين الإناث ما يناهز 60 بالمائة في آخر إحصائية أممية.
على الرغم من المجهودات المبذولة لفائدة الفتاة في عديد الدول العربية للترفيع في نسب استيعابها و تمدرسها و مرافقتها في المراحل الأساسية و الثانوية لا يزال التمييز بين الجنسين أح المعوقات الحقيقية أمام تحقيق تكافؤ فعال في الفرص التعليمية (السورطي،2009) قد يحرم الأنثى حقها في التعليم و يشعرها بالغبن و الحرمان.
ج-التمييز الجغرافي:
بذلت حكومات ما بعد الاسقلال القطري في عديد الدول العربية مجهودات لا بأس بها في توسيع شبكة المدارس و اتنشر التعليم في كل القرى و المدن.
إلا إن المتأمل في حظ أبناء الريف وبناته من حق التعليم المجاني يلاحظ أنه لا زال دون المؤمل عربيا.فعلى سبيل الذكر لا الحصر بلغت نسبة التسجيل لأبناء الأسر الريفية في إحدى الأقطار العربية 33,3بالمائة بالمرحلة الإعدادية و12,6 بالمائة بالتعليم الثانوي بسبة 0,9 بالمائة في التعليم العالي.كذلك الأمر بالنسبة لظاهرة الأمية الملفتة للنظر في الريف العربي حيث بلغت نسبا عالية في أرياف المغرب و مصر.
أليس لهذا التمييز التربوي الطبقي والجنسي الذي قد تفسره أسباب تاريخية و اجتماعية و ثقافية و تعليمية و أخرى
اقتصادية وسياسية أثر على ظاهرة الاغتراب والشعور بفقدان المعنى والهدف لدى عدد كبيرمن أبناء وبنات العالم العربي والإسلامي سواء درس وتسرب مترديا إلى الأمية أو واصل تعليمه وتخرج شاعرا بالعزلة وعدم القدرة على مجابهة سوق العمل؟
أليس لهذا التمييز بين الأغنياء و الفقراء وبين الفتى والفتاة في حق التعلم أثر في تثبيت اللامساواة و الظلم والاغتراب ومنه إلى الفشل المدرسي وزيادة الرسوب والتسرب وتهديد الأمن الاجتماعي.
وهكذا يمكن القول في هذا المستوى من تشخيصنا النسقي لمظاهر الإعضال في التربية العربيةإنه رغم الجهود ووضع غاية تحقيق مبدإ تكافؤ الفرص التعليمية للفرد العربي على رأس قائمة القيم التربوية فإن الواقع التربوي لا زال يعاني من الحرمان لبعض الطبقات و الأسر المحدودة الدخل ولعدد من الفتيات اللاتي حرمن حقوقهن في الدراسة أو مواصلاتها مما يؤدي إلى الاغتراب و فقدان المعنى و الهدف في الحياة.
وهنا نرى لزاما علينا أمام الانعكاسات الخطيرة لذلك التمييز التربوي أن نذكر أي عربي ينوي إسهاما في النهوض التربوي لهذه الأمة أن يضع في اعتباره:
– إن “العدل هو أساس العمران” وأن تحقيق المساواة والعدالة للجميع منذ اليوم الأول بالمدرسة شرط أساسي في نجاح الطالب و نجاح المؤسسة
– إن إعطاء المعنى للتعلم و للتعليم هو نقطة الانطلاق الأولى في خلق دافعية كل من المعلم و المتعلم
-إن عملية انتقاء المعلمين والمعلمات ذوي التصورات الإيجابية إزاء الفتى والفتاة و الشاب و الشابة العربيين هي خير ضامن لنجاح المشروع التعليمي وخير واق من الاغتراب.
– إن إرساء علاقة تربوية أفقية على الحب للفهم وللتفاعل البناء مع المتعلمين هي سر ديمومة أي مشروع تربوي ناجح
4-فعل التعليم وأثره في في الاغتراب الطلابي:
لقد تواتر في الأدبيات النقدية المهتمة بمسألة الاغتراب أن للمناهج و الطرائق التي يوظفها المعلمون في الفصول الدراسية ضلعا في تشكل ملامح الاغتراب لدى العديد من الطلبة العرب. ذلك ما جاء في دراسة علمية حول صورة الأستاذ في المدرسة التونسية كان قد أجراها المركز الوطني للتجديد البيداغوجي و البحوث التربوية بتونس سنة 2007 م أظهرت أن نسبة 96.06 بالمائة من تلاميذ المرحلة الثانوية المستجوبين في البحث يحملون الأستاذ مسؤولية الإخفاق الدراسي وأن نسبة 72.52 بالمائة منهم يرون أن الأساتذة جعلوهم يكرهون المادة المدرسة وأن 59.33 بالمائة يرون تشفيا وشماتة في التلاميذ من قبل أساتذتهم.
هكذا يبدو إذن أن المعلم يؤثر بتصوراته وممارساته وطرائق تدريسه وأساليب تقييمه إما إيجابيا أو سلبيا. فهو الذي يسهم في تفتح شخصياتهم و تلميع صورة الذات لديهم و يساعدهم على الاندماج و التكيف الذكي في المجتمع و للأسف هو الذي قد يوقعهم في مربع الاغتراب و مستنقع الإحباط.
إن التعليم التلقيني السائد إلى الآن في المدارس العربية والذي لا يراعي الفروق الفردية بين التلاميذ ولا يستثمر ذكاءهم الانفعالي و العاطفي فيثير دافعيتهم و لا يدعوهم للتأمل والتحليل والاستدلال يؤدي في جل الحالات إلى إحباط كثير منهم و اغترابهم وعزلتهم وعجزهم وعزوفهم عن الدروس والمعلمين والتمرد عليهم. “(الكندري،1998)
فإذا كانت هذه بعض الأسباب المفسرة لظاهرة الاغتراب الطلابي في العالم العربي والإسلامي فماهي انعكاساتها على الأجيال وما أثرها على المجتمعات؟
ثالثا: من انعكاسات الاغتراب الطلابي على الأجيال العربية:
إذا كان الشعور بالإحباط والعزلة وفقدان الهدف والمعنى من مؤشرات الاغتراب البادي على الطالب فأن ذلك سينعكس لا محالة على الأجيال وسيؤثر فيهم عاجلا أو آجلا ما لم تؤخذ احتياطات الإصغاء والمرافقة فما هي إذن تلك الانعكاسات والآثار المحتملة؟
قد يؤدي الاغتراب الطلابي الذي يكون للتعليم التقليدي والتلقيني ضلع إلى نتائج سلبية ومظاهر كالتي وصفت في محطات سابقة أو لاحقة من هذا التشخيص النسقي والمنظومي للمعضلة التربوية والتعليمية في الوطن العربي والتي منها ما يلي:
1 -تراجع التحصيل الدراسي:
قد يؤدي الاغتراب إلى الذي يسهم التعليم في إيجاده إلى الشعور بضعف الانتماء إلى المدرسة و الذي يقود بدوره إلى عدم الرغبة في التعلم و بالتالي إل تدني المخرجات التعلمية و ضعف الكفايات والقدرات ومن ذلك إلى الفشل المدرسي.
لقد أظهرت نتائج بعض الأبحاث المجراة في العالم العربي والإسلامي أن “الطلبة الذين يشعرون أنهم مرفوضون ومعزولون يحصلون على نتائج متدنية و أن الطلاب الأكثر اغترابا تكون معدلاتهم التراكمية متواضعة. “(السورطي،2009).
2- التسرب المدرسي:
يتمثل التسرب المدرسي في انقطاع الطالب المرفوض من المدرسة لأسباب مختلفة قد تعود لأسباب متعلقة بالتحصيل أو بما يتعلق بالسلوك.
هذا ما يمكن أن يعلم به أولياء الأمور إلا أن تحليل الأسباب لا يعلمه إلا قليل من المتابعين عن كثب للحالة.
لقد بينت الدراسات المهتمة بمثل هذه المسائل أن التسرب ناتج في عديد الحالات عن حالة الاغتراب التي يمربها الطالب المتسرب.ذلك ما أظهرته دراسة علمية أجريت على عينة من المتسربين وصف لديهم معاناة من العزلة الانفصال والرفض
وهي مظاهر اغترابية في حقيقة الأمر.
3 -السلبية و إعاقة الإبداع:
يقود الاغتراب إلى شعور الطالب المغترب بالعزلة فيميل إلى السلبية واللامبالاة فينعزل عن المشاركة الاجتماعية.ذلك ما يلاحظ لدى عدد كبير من الخريجين الذين يقيمون حاجزا بينهم وبين مجتمعهم و يفضلون العيش على هامشه فلا يعيرون أي اهتمام للقضايا و الهموم ومشكلات الواقع المعاش.
تؤدي سلبية المغترب إضافة إلى العزلة الاجتماعية إلى الأخطر من ذلك كتتعطل الإبداع لدى الطالب الشاعر بالاغتراب.ذلك ما أبرزه تقرير أعدته لجنة تطوير المناهج الأمريكية أنه من أهم العوامل المسهمة في إعاقة الإبداع في المدرسة هو الامتثال للأوامر والتسلط وإهمال المتعلمين داخل الغرف الصفية والتأكيد على القواعد والقوانين والتعليمات.إن العلاقة بين الإبداع والحرية هي علاقة ارتباط وثيق. إن غياب تدريس متمحور على المتعلم يولي أهمية للإنصات و تبادل الرأي وإفساح المجال للبحث الحر وحل المشكلات تشجيع المبادرات وتقديم الخبرة في مناخ صفي فعال ليعد من أهم العوامل المسهمة في حدوث الاغتراب وبالتالي إعاقة الإبداع.
رابعا-من الآثار الاجتماعية للاغتراب الطلابي في العالم العربي والإسلامي:
ينعكس الاغتراب على تكوين الأجيال وينحسر إبداعهم ويقل إسهامهم الاجتماعي والاقتصادي و يؤثر ذلك على نهضة المجتمعات العربي في مرحلة حساسة من تاريخ العرب و في عالم معولم فما هي الآثار المتوقعة اظاهرة الاغتراب الذي
أسهمت المنظومة التربوية العربية في قسم كبير منه؟
- الاستسلام والاستقالة:
قد يؤدي الاغتراب الطلابي إلى الاستسلام والرضوخ والرضى الظاهري بالأمر الواقع ما دام الاغتراب قد أدى بصاحبه إلى نوع من اليأس في التغيير. ويؤدي ذلك الرضى الظاهري بدوره إلى ّالإذعان الذي يحوله أحيانا إلى كائن مرن موافق يكيف نفسه مع الوضع واللحظة ويلبس جلد الحرباء ويغير مواقفه بسرعة وباستمرار ويلجأ إلى النفاق والمداهنة”(وطفة،1998) ومن ذلك إلى الاستسلام الكامل وعدم التصدي للمشكلات ومواجهتها.هذا ما يترجمه مثلا عزوف عدد كبير من الشباب العربي المغترب الذي مر بالمدرسة والكلية عن المشاركة في الحياة السياسية و عدم اكتراثه في ما يخطط له الساسة في الأروقة والمكاتب.
2-التمرد والتطرف:
قد يؤدي الاغتراب بالبعض إلى الاستسلام و الاستقالة و قد يحمل آخرين على” التمرد و الخروج على معايير المجتمع وقيمه والعمل على تغييره بأي شكل من الأشكال سواء أكان ذلك بطريقة فوضوية أو منظمة، متطرفة أو معتدلة، عنيفة أو سلمية”.أليس ذلك ما يفسر تنامي التطرف لدى فئات عديدة من شبابنا الذي تربى في عائلاتنا و تتلمذ في مدارسنا علة معلمين من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ؟
يعد الاغتراب الطلابي إذن من العوامل الأساسية في توفير أرضية خصبة لنمو وانتشار سلوك التمرد وتنامي معدل الجريمة والانحراف.
إن الاغتراب الذي تسهم المدرسة العربية في إفرازه يؤدي ؟إلى الفشل و الإحباط و الاستسلام و التمرد و الرفض لكل ما هو اجتماعي فيأتي لا قدر الله على الأخضر و اليابس، فلم لايكون شعار مدرستنا :”الوقاية خير من العلاج”؟
3-الهجرة:
ما ذا سيؤدي كل من الفشل والإحباط والشعور بفقدان المعنى والهدف؟ أليس للتمرد والمغامرة في المجهول وإلبى المجهول؟
يصل المغترب إلى درجة من اليأس فيجد نفسه أمام ضرورة ترك الوطن بعد أن درس ولم ينجح. فهو لم ينس”الصورة الزاهية” للحياة في المجتمعات الغربية التي عرضت له في المناهج الدراسية أو تلك التي يراها كل يوم و كل لحظة على القنوات التلفزية و الشبكة العنكبوتية. لذلك تراهم يصممون شبانا و شابات على الهجرة السرية و العلنية و يبحثون عن كل الأساليب المشروعة و غير المشروعة للبحث عن شغل في الأرض المنتظرة .هذا بالنسبة للذين لفظتهم برامج التعليم العربي أما الناجحون المتميزون منهم فهم نسبة منهم هجرة إلى بلاد الغرب عساهم يجدون ضالتهم من الرخاء و الرفاه.
هكذا تبين من خلال هذا التشخيص النسقي لهذا المظهر من مظاهر المعضلة التربوية أن النظام التربوي العربي رغم المجهودات الي بذلها ويبذلها لا زال بعيدا عن تحقيق ما صاغه من غايات وأهداف سامية. إن الاغتراب الطلابي المسجل في عديد البلدان العربية ظاهرة خطيرة، انعكاساته وخيمة و آثاره ثقيلة على الأفراد و المجتمعات.لذلك يتأكد النصح للعازمين على التجديد التربوي و المتوكلين على الله في نصرة الأمة بأن يأخذوا بعين الاعتبار ما يلي:
-التفكير في البيئة المادية والنفسية الملائمة للتعلم (الغرفة الصفية الإيجابية والدافئة الداعمة لنشاط الطلبة وذات المقاعد الفردية المتنقلة وفق طبيعة النشاط والهدف منه…) (الاهتمام بمشاعر الطلاب وانفعالاتهم واتجاهاتهم ودعوتهم للتأمل والتفكير الناقد عوض الإملاء والتلقين.
-تعزيز الدافعية الداخلية والخارجية للمتعلمين في كل مراحل التربية و التعليم من الكتاب إلى الكلية.
– اعتماد المرافقة التربوية والإنصات لحاجات المتعلمين ومساعدتهم على معالجة تمشياتهم بأنفسهم و بالتعاون مع أقرانهم.
-تنويع الطرائق والتقنيات التعليمية مراعاة للفروق الفردية بين المتعلمين.
-إيجاد تكامل بين التوجه الوقائي والتوجه العلاجي في إدارة الصف.
-الاهتمام بالتعلم الذاتي والمجموعي والاعتماد على البحث عن المعلومة بالقراءة الفردية و المناقشة الجماعية.
– تحميل تلاميذ المدرسة مسؤولية المحافظة على مدرستهم بتمكينهم من المبادرة و تقديم الإضافة فيها.
-مشاركة المتعلمين في قرارات المدرسة وتوجهاتها المستقبلية بإبداء آرائهم.
– العمل بنظام المراوحة والترويح بين الدروس النظرية والتطبيقية والمهنية والتدريب المهني والتقني القائم على التقنيات. العليا و التكنولوجيا الحديثة و وجعل البيئة معملا للمدرسة وميدانا لتدريب الطلاب على الحياة.
-التركيز في المناهج الدراسية على التفكير الناقد وعلى مهارات الاتصال والتواصل اللغوي وتنمية الاتجاه العلمي في حل المشكلات.
– تدريبهم وتعليهم القيم والخلق الحسن ودعوتهم للتفاعل مع الثقافات الأخرى لفهمها والاستفادة منها.
– “تأهيل معلمين راغبين في التعليم وإعدادهم ليكونوا متأملين، مفكرين، مسؤولين ومجددين والعمل على مساعدتهم على تشكل ملامح هوية مهنية راشدة، مستقلة، قابلة للتجدد وعارفة بدينها واعية بتحديات العولمة مالكة لكفايات مهنية عالية قادرة إيجاد الحلول للمستجد من الطارئ من المشاكل التربوية ” (رضا ساسي،2008).
المبحث السادس:
ضعف استبطان القيم الأخلاقية والمدنية لدى الطلاب
من خلال بعض السلوك اللاّمدني:
مثالان على ذلك
العنف المدرسي
الغش الطلابي في الامتحانات المدرسية
مقدمة:
لا يجادل اثنان في الدور الذي تضطلع به التربية في توجيه الأمم والشعوب قصد تحقيق غاياتها الكبرى وأهدافها المرصودة على المديين المتوسط والبعيد المؤسسة على منهاج معين ووفق اختيارات ومداخل محددة.
وتأسيسا على ذلك، فإن تحديد معالم السياسة التربوية لبلد ما يمكن أن تتجسد في المنهاج الدراسي بكل مكوناته، بمعنى أن المدرسة تلعب دورا لا يستهان به في توجيه دفة التنمية من أجل تحقيق الحاجات الآنية والمستقبلية لأبناء هذا المجتمع أو ذاك، ومن ثم كانت المدرسة عاملا لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال في
الرفع من القيمة المضافة المدعمة لإنتاجية الأمم والشعور.
فالنظم التربوية في العالم تحدد وتصوغ حاجيات الأمم من منظور مستقبلي في شكل ملامح مخرجات، وتعهد إلى وكلاء التربية مهمة العمل على تحقيقها لدى الناشئة ، فالغايات ينبغي أن تحقق أو على الأقل توضع اللبنات الأساسية لتحقيقها من خلال مخرجات المنظومة التربوية ككل، وهذه الغايات هي التي تحدد مسار التربية المستهدف.
بذلت الأنظمة التربوية العربية والإسلامية مجهودا معتبرا في بلورة الفلسفات التربوية فصاغت الغايات والأهداف التربوية وأعدت استراتيجيات مختلفة مراعية في ذلك الخصوصيات المحلية وتراث الأمة العربية والإسلامية و واقعها الراهن والتحديات العالمية وماشهده العالم من تطور وتقدم في شتى المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية.
لذلك حاولت الأنظمة التربوية العربية مستندة إلى تلك المصادر والمنطلقات اعتبار المبادئ التالية:
1- المبدأ الإنساني المؤكد على مكانة الإنسان و نظام المجتمع
-“تمكين المتعلم من تطوير شخصيته في شتى جوانبها الروحية والفكرية والوجدانية والخلقية والاجتماعية والجسمية” (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 2006).”
-“تبصيره بحقوقه الأصيلة وبواجباته الدينية والقومية والاجتماعية والتمسك بتلك الحقوق والاستمتاع بها ومن النهوض بتلك الواجبات والاضطلاع بممسؤوليتها. “
-“تمكين المتعلم من الاعتماد على الذات في تربية نفسه وتطوير شخصيته والاعتماد على عقله وضميره وقدراته في العمل والابتكار والإبداع.”
2-المبدأ الوطني في التربية.
شمل هذا المبدأ الغايات التالية:
-“غرس الروح الوطنية في نفوس الناشئة و الشعور بالانتماء له.”
-“بناء الإنسان المحترم لأبناء وطنه الذين يعيشون معه في نفس الأرض و المتعاون معهم من أجل الحفاظ على ثروات الوطن.”
3- مبدأ التربية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.
4-التربية للإيمان.
شمل هذا المبدأ من بين دلالاته الغايات التالية:
– اهتمام التربية بترسيخ الإيمان بالله في نفوس المتعلمين الإسلام واعتبار الدين من أخص ما يتميز به الإنسان.
– عناية التربية بما أقره الدين من القيم الإنسانية وتنشئة المتعلمين على الأخلاق الفاضلة وعلى المحبة والتعاون. والسعي إلى خير المجتمع من أجل تماسكه وقوته وتمكينه من البناء والتعمير.
– عناية التربية بالإخاء الإنساني والدعوة إلى الحق والخير والصلاح.
5- مبدأ التربية من أجل التنمية
6 – مبدأ التربية للعلم
7- مبدأ التربية للعمل
8_ مبدأ التربية للقوة والبناء
9- مبدأ التربية المتكاملة
10- مبدأ الأصالة والتجديد
هذه بعض المبادئ من منظومة القيم والغايات التي حددتها استراتيجية تطوير التربية العربية سنة 2006م وتبنتها جل الأنظمة التربوية العربية وعملت على الاستئناس بها في صوغ أهداف مناهجها ووصف ملامح مخرجاتها .
لذلك نصت النظم التربوية العربية على اعتبار القيم مدخلا أساسيا في الإصلاح، إلى جانب المداخل الأخرى.
وفي مجال القيم بالذات حددت تلك النظم التربوية تقريبا التوجهات التالية :
1- قيم العقيدة الإسلامية .
2- قيم الهوية الحضارية، ومبادئها الأخلاقية والثقافية.
3- قيم المواطنة.
4- قيم حقوق الإنسان ومبادئها الكونية .
ولما كان وصف المخرجات أمرا متأكدا قبل تنفيذ أي استراتيجية وتقييمها ورصد مدى تحقق الأهداف والكفايات الداخلية والخارجية للأنظمة التربوية العربية كان لزاما علينا أن نذكر بها لنتساءل عن مظاهر القوة والإعضال المتعلقة بالتربية على القيم المدنية والدينية في مؤسسات التعليم والتربية والتكوين بالعالم العربي والإسلامي. فما هي أهم المظاهر السلبية التي تعلقت بالمخرجات التربوية القيمية المدنية المتواترة في الأدبيات والأبحاث العلمية والمقالات المحكمة؟
يعتبر البحث في مجال القيم بأنواعها من البحوث التي تكتسي أهمية وحساسية شديدتين في العصر الحديث، نظرا لوعي الأمم بأهميتها في بناء المواقف والتمثلات المؤثرة في الأشخاص والجماعات، باعتبار القيم موجهات للسلوك والتصرف الإنساني، ولذلك جعلت منها المنظومات التربوية اختيارا أساسيا ، ومدخلا محوريا في المراجعة والإصلاح.
– محاولة في تحديد المفهوم
تسير الدراسات المهتمة بمفهوم القيمة وفق منظورين متكاملين في حقيقة الأمر، أولهما، المنظور الفلسفي التجريدي الذي يعتبر الخصائص البنائية للقيم، أي معناها العام وخصائصها التجريدية وثانيهما هو المنظور الإجرائي، ويهدف إلى تحديد الخصائص الوظيفية للقيم، أي وظائفها وكيفية قياسها.
نبدأ أولا بتحديد مفهوم القيمة أو القيم وبتحديد مفهوم الخير والشر، والصواب والخطأ، إذ عليهما تدور رحى تقييم القيم المختلفة، حيث أن تحري الخير والصواب كمعايير في السلوكات والتصرفات، هو المقصد والغاية من وراء الرغبة في بث القيم النبيلة بين الناس وفي الناشئة على الخصوص عن طريق التربية والمدرسة، وبغرض خلق أكبر فرص توحيد الرؤى والمعايير بين البشر في كل أنحاء المعمور، أي تحقيق المشترك الإنساني بشكل عام.
إن هدف القيم السامية الحضارية من الناحية السيكولوجية يتجلى في إحداث استعداد نفسي لدى لن يتحقق له الاقتناع والإيمان الراسخ بها فيدفع إلى العمل وبدورها الحيوي في جميع التصرفات والسلوكات سواء اتجاه نفسه أواتجاه خالقه أو محيطه الاجتماعي والطبيعي.
فالقيم هي”معايير عقلية ووجدانية،تستند إلى مرجعية حضارية تمكن صاحبها من الاختيار بإرادة حرة،واعية لنشاط إنساني يتسق فيه الفكر والقول والفعل-يرجحه على ما عداه فيستغرق فيه ويسعد به” (خالد الصمدي، 2008).
تعددت وجهات النظر بشأن تحديد مفهوم القيمة على الرغم من التطورات الكثيرة التى طرأت على هذا الميدان المعرفى.
1– وينظر للقيم من منظور فلسفي:ينظرالمثاليون للقيم على أنها مطلقة وثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان ومصدرها عالم المثل، ويرى الواقعيون والبراجماتيون والوجوديون أن القيم على أنها تعتمد على خبرة الإنسان وذكائه وتجاربه الحياتية.
2-وينظر من للقيم على أنها اعتقاد :فالقيمة هي المعتقدات التى توجه الإنسان إلى السلوك الذى يرغبه أو يفضله، فالقيم هي مفاهيم مجردة تبرز أفكار الأفراد ومعتقداتهم كالعدل والإيثار والتعاون والإخلاص والتضحية
3-ثمة من ينظر للقيم على أنها معايير: أي “معايير اجتماعية ذات صبغة انفعالية قوية تتصل من قريب بالمستويات الخلقية التى تقدمها الجماعة، يتشربها الفرد من بيئته الاجتماعية الخارجية ويقيم منها موازين يبرر بها أفعاله ويتخذها هادياً ومرشداً.
4-ثمة من ينظر للقيم على أنها تفضيلات وسلوك تفضيلي.
5-وهناك من يربط بين القيمة والاتجاه : فيعتبر القيمة تنظيم للخبرة التي تنشأ فى موقف تفاضلي، فتنمو وتتناسق حتى تصبح وحدة معيارية ثابتة في الضمير الاجتماعي للفرد، فى حين أن الاتجاه هو تنظيم للخبرة من نوع خاص يلون سلوك الفرد.”
“أما المقصود في استراتيجية تطوير التربية 2006 فهو ما ذكرناه سابقا أي تلك القيم التي تقترب من معنى المعايير العقلية والوجدانية المستندة إلى مرجعيات حضارية والتي تمكن صاحبها من الاختيار بإرادة حرة واعية.”
مدخل عام لحال السلوكات الطلابية في العالم العربي والإسلامي:
نتيجة للتغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم, وقع شبابنا في تشتت واضح في الأهداف والغايات،حيث أدت التغيرات العالمية المتسارعة إلى عدم مقدرة الشباب على التمييز الواضح بين ما هو صواب وما هو خطأ، وبالتالى أضعفت قدرتهم على الانتقاء والاختيار من بين القيم المتصارعة الموجودة، وعجزهم عن تطبيق ما يؤمنون به من قيم، كل هذا أدى إلى حدوث “أزمة قيمية”، كان لها أثر كبير فى دفع الشباب للتمرد,والثورة على قيم المجتمع ,واغترابهم شبه التام عن القيم التى جاءت بها الثورة العلمية التكنولوجية.
يسوق (عبد السلام الأحمر، 2009) في مقال افتتاحي للعدد (7) من مجلة “تربيتنا” بعض المؤشرات الواقعية الدالة على السلوكات اللاخلقية واللامدنية المتفشية لدى التلاميذ ولدى خريجي المدرسة المغربية.
يصف الباحث المذكور الوضع قائلا: “باستثناء نسبة قليلة جدا من الفئة المتعلمة نجد الاتجاه الطاغي الذي توسم معالم الشخصية المغربية حاليا هو الامسؤولية وتدني الإحساس بالإنتماء للوطن وفقدان الاعتزاز بمقومات الهوية.
يشير (عبد السلام الأحمر،2009) إلى وجود تحديات محلية وأخرى خارجية تتعلق بمعضلة القيم وعلاقتها بالتوظيف التربوي و”يرى” تجسدها في مختلف السلوكات الشائعة في البيئة الاجتماعية المحيطة والتي تتعارض مع تعاليم الإسلام وأخلاقه الحميدة كخيانة الأمانة والاستهانة بالواجبات وعموم ظاهرة الوهن والعجز وضعف الإحساس بالمسؤولية.
ذلك ما يؤكده (خالد الصمدي، 2009) من ضعف للقيم في نفوس المتعلمين وانفلات في تكوين شخصية المتعلمين في عديد الدول الغربية، تبرزه الأرقام المقلقة ” حول ارتفاع نفسية انتشار التدخين بالمؤسسات التعليمية استهلاك المخدرات والفساد الأخلاقي وتعدد أشكال العنف المدرسي والغش الطلابي.
ذلك ما سنستشهد به في الفقرات الموالية.
وأمام تعدد مظاهر هذا الإعضال الخلقي والمدني لدى لعديد من أبنائنا وبناتنا المتعلمين والمتعلمات بمؤسساتنا التربوية يجدر بنا البحث في أسباب هذه الظاهرة الخطيرة وتحديدها أملا في صياغة فرضيات وتقديم النصح لبناة ومناهج التربية الأصيلة ومصمميها و”الدين النصيحة.”
أولا: العنف المدرسي:
مقدمة:
تفاقمت في السنوات الأخيرة وفي عديد المؤسسات التربوية ظاهرة العنف الطلابي سواء أكان فرديا أوجماعيا في العالم الغربي وحتى في عالمنا العربي. ذلك ما يظهر في استخدام طلبة الإعدادي والثانوي والجامعي للعنف عند الشعور باليأس والإحباط والاغتراب أو الإحساس بالضياع و التمزق بين بين القيم الاجتماعية والضغوط الاقتصادية والأسرية.
إنّ “تناول ظاهرة العنف بالمدرسة العربية كما هي معيشة وبحدة لدى طلابنا في الظروف الراهنة، دون الاحتكام للبحث العلمي، غالبا ما تسقطنا كمهتمين تربويين في استباقات ذات مستوى انطباعي ذاتي، يطغى عليها الحكم القيمي أكثر من الحكم الواقعي، و هذا راجع في تقديراتنا لغياب دراسات علمية مؤطرة تتبعية ومؤسساتية لهذه الظاهرة. لذلك سنحاول الاستفادة من النتائج الامبريقية لعلها تساعدنا على بلورة رؤية نظرية واضحة وملامح نموذج تطبيقي لنظام تربوي أصيل تتوازن فيه شخصية الانسان العربي المسلم”.(محمد لمباشري،2009) .
ورغم تنامي الظاهرة لم نعثر في حدود علمنا إلا على نزر قليل من الدراسات العلمية (الرسائل الجامعية والأطروحات) والبحوث الميدانية و المقالات المحكمة في المكتبة البحثية العربية.
ونظرا لأهمية هذا المظهر الذي يمكن أن تكون المنظومة التربوية سببا فيه حاولنا جمع أكثر ما يمكن من المعلومات و المعطيات الكمية والكيفية عن الظاهرة لعلنا نقف على الأسباب التي يمكن لأي نظام تربوي عربي أن يتحكم فيها أو يحد منها على الأقل.
وبذلك نقر بأن ما يمكننا تقديمه في هذا المبحث هو أفكار ومعلومات متناثرة حول ظاهرة العنف بالمدرسة العربية في صيغة إشكالات وافتراضات يمكن للبحث العلمي التجريبي أن ينطلق منها من اجل تزكيتها في حالة تحققها أو التعامل معها كفرضية عدم، بناء على طبيعة المتغيرات المتحكمة في الظاهرة إن على المستوى السيكولوجي أو السيكوسوسيولوجي التربوي والاقتصادي.
لكن تبقى التساؤلات التالية أكثر شرعية من حيث الطرح:
فما المقصود بالعنف الطلابي؟ ماهي أشكاله؟ ما هي مظاهره؟ وما هي العوامل المساعدة على تشكله؟هل مرد ذلك عوامل نفسية اجتماعية تتحمل فيها الأسرة مسؤولية كبرى من جراء نمط التعامل المفروض على الأبناء؟ أم عوامل بيداغوجية وتربوية لها علاقة بسوء تدبير التعلمات لدى المتعلمين، وضعف اندماجهم مع مختلف الأوساط السوسيوثقافية المعدة لهم، و غياب التقدير لذواتهم عبر تربيتهم على اتخاذ القرار في شان مستقبلهم التعليمي التعلمي؟
وما هي التفسيرات الاحتمالية التي يمكن إعطاؤها لظاهرة العنف المدرسي بالمدرسة العربيةالإسلامية في عصرنا الحالي؟
محاولة تحديد المفهوم:
لغة:
يعرّف (المعجم الوسيط الجزء الثاني،631) “العنف فيحيل إلى الجذر عنف به وعليه،أي أخذه بشدة وقسوة ولامه و لذا فهو عنيف.”
(المنجد في اللغة العربية المعاصرة 2000م) “فهوالشدة والقسوة والحدة وعنّف بمعنى لام وأنكر وعامل بعنف معاملة سيئة.”
اصطلاحا:
يعتبر معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية لأحمد زكي بدوي”العنف أو الإكراه استخداما للضغط أو القوة استخداما غير مشروع أو غير مطابق للقانون من شأنه التأثير على إرادة فرد ما.”
ويعرف(خليل أحمد خليل،1995) “العنف بأنه السلوك الذي يستخدم الإيذاء باليد أو بالفعل أو بالكلمة،في الحقل التصادمي”فهو ذلك الفيروس الحامل للقسوة و والمانع للمودة.”
كما يصفه (بن عسكر،2003) “العنف المدرسي بكونه كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى الجسمي أو النفسي بالآخرين من معلمين وأعوان وزملاء الدراسة، من خلال السخرية والاستهزاء من الآخر وفرض الآراء بالقوة وإسماع الكلمات البذيئة.”
تعرف الباحثتان (تهاني منيب وعزة سليمان،2007) العنف بكونه “سلوك يهدف إلى إيقاع الأذى بالآخرين وقيام بأفعال عدوانية وتحطيم وتخريب للممتلكات الخاصة والعامة تعبيرا عن الاعتراض المعبر عن الظلم والمهانة.”
أما العنف الجماعي فهو”اشتراك فرد مع مجموعة من الأفراد في الهجوم اللفظي أو المادي في أفعال عدوانية تجاه فرد أو مجموعة أخرى قد تمثل السلطة أو رموزها وقد يأخذ شكل التمرد والعصيان أو التظاهر السلبي وتحطيم الممتلكات العامة أو الخاصة تعبيرا عن الاعتراض نتيجة الإحساس بالظلم أو بالمهانة.”
نقصد بالعنف المدرسي في هذا المبحث كل تصرف طلابي يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين وكل إيذاء يمارس بين التلاميذ أنفسهم وكل ما يصدر عنهم من تدمير للممتلكات المدرسية والعبث بها، والاعتداء ماديا على الإطار التربوي و تمزيق الكتب المدرسية والكراسات أمام المعاهد والمدارس أو حرقها إضافة إلى العنف اللفظي الذي يلخص عدة دلالات تعبيرية(سب الجلالة، التحرش، الشتم، اللّعن، التعيير، التحقير…).
ومهما كانت المقاربات المعرّفة للعنف ورغم اختلافاتها وتباينها أحيانا في إعطاء المفهوم الصحيح لمصطلح العنف يعتبر هذا الأخير فعلا عدوانيا ضد الآخر أي أنه السلوك الذي يهدف إلى إيذاء شخص آخر أو الإضرار به. ذلك ما ذكرت به (آمال بن جماعة، 2004) في دراستها المعمقة المناقشة بجامعة تونس حول العنف الشبابي قائلة بأن: “العنف يؤشر عليه بمجموعة من السمات والخصائص المميزة له وهي على التوالي:
-“حالة مركبة من حيث أداؤها وترابطها في حالة ذاتية لها موضوعها(الأنا،الآخر،نحن ، الآخرون) .”
-“يتسم العنف بسمات الأداء الفردي أو الجماعي المنطلق من مبادرة عنيفة والمنبني على استجابات عدوانية.”
-“العنف تجربة نفسية اجتماعية قوامها إيذاء الآخر لكنها لا تنفصل عن تغيرات المجتمع وثقافاته السياسية.”
فإذا كانت هذه بعض المحاولات التي عرّفت العنف الطلابي فماهي أشكاله؟
- أشكال العنف الطلابي:
إن المتأمل في النـزر القليل من الدراسات العربية المهتمة بالعنف الطلابي يلاحظ جنوح الطلاب إلى أشكال
مختلفة من بينها العنف :
- العنف البدني أو العنف الجسمي كالضرب أو التشويه و إلقاء الأشياء على الآخرين
- العنف اللفظي (التهديد بالانتقام والقذف والسب والتحريض والاستهزاء بالغير) الذي يؤدي إلى “التعدي على حقوق الآخرين بإيذائهم عن طريق الكلام والألفاظ النابية والبذيئة وكثيرا ما يسبق العنف الجسدي” (فهد الطيار،2005). ذلك هو ما انتشر واستطاع أن يخترق مناعة الفضاءات ويشكل سياقا تداوليا يتبادله الأفراد والمجموعات.
وذلك ما عبرت عنه عينة من المستجوبين من خريجي المدارس التونسية الثانوية ومن المربين أكدوا تزايد العنف اللفظي وتنامي معجميته التي يتداولها التلاميذ في القاعات والساحات المدرسية (جريدة الصباح، 2009).
هذه بعض أشكال العنف المدرسي الممارس من قتل عدد لا يستهان به من المتعلمين في جل المراحل الإعدادية والثانوية حتى والجامعية الموصوفة في الدراسات التي عثرنا عليها لحد الآن.
ب- مظاهر العنف في بعض الدراسات العلمية العربية:
تتمثل أهمية البحث في التركيز على رواد المدرسة من التعليم الأساسي إلى التعليم العالي وبصفة خاصة فئة المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 17-26 سنة باعتبارهم الشريحة الأكثر عرضة للاشتراك في عمليات العنف الفردي الجماعي.
لقد انتشر العنف المدرسي في المجتمع العربي كغيره من المجتمعات الغربية مما يبرهن على وجود خطر يتهدد كيان المدرسة والأسرة والمجتمع بأسره (بن عبد الرحمان الشهري،2003). ففي مصر مثلا اعتدى التلاميذ في إحدى المدارس الثانوية على معلميهم بالضرب وحرق المداخل المدرسية(الجندي،1999) والخروج من مؤسستهم للاعتداء على زملاء لهم في مؤسسات تربوية مجاورة.
فقد أكدت دراسة نشرتها وزارة التربية والتكوين بتونس على أن الوسط المدرسي شهد (2025) حالة عنف خلال السنة الدراسية 2006/2005، في حين كشفت دراسة سوسيولوجية ثقافية أجراها المرصد الوطني للشباب بنفس القطر، شملت ظاهرة العنف اللفظي لدى الشباب التونسي أن المؤسسة التربوية تعد ثاني الفضاءات الأساسية من حيث انتشار العنف اللفظي حيث بلغت نسبة (43،21% ) وأكدت نفس الدراسة أن (93،28%) من شباب العينة أكدوا على وجوب التدخل في الفضاء التعليمي للحد من هذه السلوكات بدرجة أولى.
أظهرت نتائج بعض الدراسات في الأردن في هذا الخصوص أن المشكلات الأكثر تكرارا في المدارس هي تكرار الشجار وضرب الطلاب (عويدان وحمدي 1997) وأن نسبة (98) بالمائة من عينة من الطلاب الأردنيين شاركوا في استفتاء أكدوا وجود العنف في المدارس وبصفة خاصة بين الذكور.
كذلك تفيد المؤشرات والبوادر العامة أن ظاهرة العنف في مدارس المرحلة الثانوية بالتعليم العام السعودي في ازدياد ملحوظ.ذلك ما أظهرته الدراسة المجراة على(180) ألف طالب سعودي في (500) مدرسة تابعتها ميدانيا، بها إدارات تعليمية في وزارة التعليم العام سنة 1322ﻫ والتي كشفت عن ارتفاع نسبة السلوك العدواني في المرحلة المتوسطة حيث بلغت (,944) بالمائة فقد بلغت ونسبة(,517) بالمائة بالمدارس الثانوية.
ومما يؤكد تفاقم هذا المظهر السلبي تطور العنف من لفظي إلى الضرب ومن الضرب إلى الاعتداء البدني والتخريب والتدمير وتحطيم ممتلكات المعلمين (آل الرشود،2000) وحتى إلى التحرش الجنسي.
من ذلك ما وصفته دراسة كل من (النوحي وحداد،1990) التي أجريت على عينة من الطلاب الكويتيين التي أظهرت أن نسبة العدوان البدني على المعلمين بلغت(,732) بالمائة آنذاك وأن نسبة العدوان اللفظي عليهم ناهزت(,237) بالمائة.
أما نسبة الشغب والتمرد والتحطيم فقد بلغت نسبة(,835)بالمائة في دراسة أجراها كل من (عويدات وحمدي،1997) على عينة من الطلاب الذكور أبرزت إضافة إلى ذلك أن أكثر المشكلات السلوكية تكرارا هي الشجار وضرب الطلاب.
أليس هذا بكاف على أن يؤكد لنا وجود ظاهرة العنف المدرسي والطلابي بالمدارس العربية وانتشارها في عديد المؤسسات التربوية العربية.
وبناء على ما سبق تأكد لنا بما لا يدع مجالا للشك وجود هذا المظهر الخطير من مظاهر المعضلة التربوية في عالمنا العربي وأن المؤسسة التربوية العربية هي أمام مشكلة تهددها في كيانها وبالتالي تهدد أجيالا وتترك آثارا نفسية ومادية تمتد إلى ما بعد المدرسة فتهدد المجتمعات بأسرها وتعطل تقدمها ونهضتها.
د-أسبابه ودوافعه:
أسهمت عديد العوامل والظروف والأسباب المتداخلة في رفع درجة العنف المدرسي في العالم العربي والإسلامي، إلا أن العوامل الاجتماعية (الأسرة والمدرسة وجماعة الرفاق) تعد من أهم المتغيرات المؤثرة في الظاهرة (فهد الطيار،2005) وهو أمر لا يشك في أثره لارتباط تلك المؤسسات بحياة الطفل و المراهق منذ ولادته .
فالأسرة هي التي تستقبل المولود وهي التي تتدخل قبل أي مؤسسة أخرى لتشكيل شخصيته وتساعده على الاندماج في مجتمع الكهول و المدرسة هي المؤسسة الثانية المكملة لدور الأسرة في التربية وهي الموكول إليها مرافقة التعليم والتعلم .
أما المدرسة فهي ذلك الفضاء الذي يقضي فيه الطفل و المراهق أكثر وقته فيها يتعلم وفيها يندمج مع أقرانه وفيها يكتسب اتجاهات عديدة إيجابية أو سلبية كميله إلى العنف وانحراف سلوكه.
ففي الدراسة التي أجرتها كل من الباحثتين (تهاني منيب وعزة سليمان،2007) حول حالة العنف لدى عينة من الشباب الجامعي المصري وعلاقته ببعض المتغيرات النفسية والاجتماعية. وانطلاقا من الأسئلة التي ألقيت حول طبيعة سلوك العنف وأبعاده ودوافعه المؤثرة فيه تبين أن هذه المتغيرات النفسية، الاجتماعية، الأسرية والمدرسية، أسهمت وأثرت في بروزه وبأشكاله المختلفة.
كما بينت جل البحوث تقريبا ترتيبا تنازليا لتلك الدوافع وصفت كالتالي:
1 – دوافع نفسية
لقد أثبتت الدراسات العلمية أن عوامل متعددة ومتفاعلة أسهمت في إيجاد السلوكات العنيفة وتفاقمها في المدرسة و خارجها يوجزها فهد الطيار فيما يلي :
– الشعور المتزايد بالإحباط
– الرغبة في الاستقلال عن الكبار والتحرر من السلطات الضاغطة عليهم و التي تحول دون تحقيق رغباتهم
– عدم القدرة على مواجهة المشكلات التي يعاني منه المراهق
– ضعف الثقة بالنفس
– الرغبة في الحصول على ممنوعات أو محرمات
– الشعور بالفشل أو الحرمان من العطف
– عدم القدرة على التكيف مع الواقع
هذه بعض الدوافع المساعدة عل بروز العنف المدرسي التي تذكرنا بما وصف سابقا وبالتحديد في المبحث المتعلق بالاغتراب الطلابي الذي يعاني منه الكثير من المتعلمين و الخريجين.
- دوافع أسرية واقتصادية
تعد الأسرة كما أشرنا سابقا المؤسسة الاجتماعية الأولى المسؤولة عن تكوين الطفل وتكوين شخصيته من النواحي الوجدانية والاجتماعية والأخلاقية والمعرفية فهي الجماعة الإنسانية الأولى التي يبني فيها الطفل أولى صلاته وعلاقاته الإنسانية (رمزية الغريب،1982) وهي المؤسسة التي يمكن أن توجه الفرد إلى الانحراف والسلوك العنفي إذا لم تغرس في الناشئة منذ الصغر أنماطا ونماذج وردود أفعال واستجابات إيجابية تجاه التفكير والقيم والمعايير. تجمع جل الدراسات أن عملية التنشئة الأسرية محدودة الأثر إذا لم تعلم المعايير والأدوار السليمة والمسؤولية الاجتماعية وكرست التسلط والقسوة أوالرعاية الزائدة والتدليل والإهمال والرفض والتفرقة في المعاملة بين الذكر والأنثى بين الكبير والصغير (حامد زهران،1980).
ذلك ما أظهرته دراسة معمقة أجرتها الباحثة التونسية آمال بن جماعة سنة (2004) حول العوامل المحفزة التي قد تساعد على نشوء العنف لدى عينة من الطلبة الشبان القاطنين بمدينة صفاقس حيث استنجت أثرا دالا للتنشئة الأسرية في أهمية الإحاطة العائلية والجو السائد داخل الأسرة وأوصت بضرورة توفر القدوة الصالحة (الأب، الأم، الأخ الأكبر…) إضافة إلى إلى الأدوار التربوية والثقافية المكملة. ذلك ما توصلت إليه الدراسة التي قام بها المرصد الوطني للشباب بتونس (2009) قصد التعرف إلى الأسباب التي تكمن وراء انتشار ظاهرة العنف اللفظي أمام المدارس وفي الشوارع والساحات العامة والملاعب الرياضية إلى ما يلي:
– ضعف التأطير العائلي وتغير الأدوار ووظائف أفراد الأسرة
– تقليد الصغار للكبار ومحاكاتهم في المعجم الذي يستعملونه
– غياب القدوة الحسنة في الشارع وفي الأسرة والمدرسة
– ضعف التأطير والمتابعة على مستوى المؤسسات التربوية
– الاضطرابات النفسية وسرعة الانفعال عند بعض الأفراد
– ضعف المراقبة ونقص الردع العائلي والتربوي والأمني
– غياب دور فاعل للجمعيات المعنية بالأخلاق والقيم والتوجيه
– تدهور القيم الاجتماعية وانتشار نزعة الفردانية
– كثرة أوقات الفراغ وسوء تنظيم الوقت الحر
– دوافع إظهار القوة وفرض الذات على الآخرين
– ظروف نفسية واجتماعية متشابكة ومنها
– عدم الاستقرار العائلي الذي يؤثر في نفسية الطفل او المراهق
– تراكم الدروس وطول ساعات التدريس وأثرها في خلق ضغوطات نفسية تنعكس على سلوك “الطالب”.
2- دوافع تربوية مدرسية
“تعتبر المدرسة قناة أساسية من قنوات التنويع الاجتماعي وبالتالي التحكم في آليات الحراك الاجتماعي وهي مكان لتكريس مبدإ تكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الحظوظ للجميع وعلى قدم المساواة-نظريا على الأقل – إلا أنها قد تدعم عنفا رمزيا إذا ما ساندت طبقة مسيطرة وأهملت أخرى”( آمال بن جماعة ،2004) فمررت أهدافها وثقافتها.عندها قد تتحول المدرسة إلى فضاء يدفع الفرد إلى التمرد والعنف بسبب صعوبات التكيف مع المواد المدرسة والبرامج التعليمية فتتوتر علاقاته بذاته، بالمدرسين والأقران فيخفق الطالب ويهدد بالطرد ويلجأ إلى التسرب.
لقد أثبتت عديد الدراسات التي قام بها باحثون في العالم العربي والإسلامي (الأردن، المملكة العربية السعودية ومصر وتونس) وجود علاقة ارتباط بين مناخ المدرسة وبين العنف الذي قد يبرز من حين لآخر. فالطالب الذي لم يتوفر له هامش من الحرية ومساحة من التعبير عن نفسه والشعور بالمسؤولية قد يصاب بالإحباط والإخفاق والتوتر والقلق وعدم التكيف وبالتالي إلى الجنوح إلى العنف. كذلك قد يكون عدم توفر المقاصف والملاعب الرياضية والمكتبات سببا في حرمان الطالب من تفريغ كبته و ضيقه ومن الترويح عن النفس وراء العدوانية التي تبرز من حين لآخر في حرم المدرسة أو خارجها” (الشهيري علي عبد الرحمان،2005).
لقد أشار علي عبد الرحمان الشهري في رسالته الجامعية أن فشل المدرسة في أداء دورها المتمثل في التنشئة الاجتماعية قد يؤدي إلى العنف داخل المدرسة وخارجها، فإذا غابت المرافقة الإدارية وانعدم التواصل والإنصات النفسي والبيدغوجي أهمل الطالب وانحرف ومال إلى العنف.
تذكر الباحثة التونسية آمال بن جماعة أن جل الباحثين في علوم التربية يرجعون فشل التلميذ إلى فشل المدرسين العائد إلى طرائقهم التقليدية التلقينة الممررة للمعارف والمواعظ وإلى مواقفهم المؤثمة للخطإ وميلهم إلى الضرب والإهانة أحيانا والتفوه بأبشع النعوت.
ذلك ما يصفه يزيد (عيسى السورطي،2009) صاحب مؤلف “السلطوية في التربية العربية” من سلبيات التلقين وسيطرة العقاب البدني، فسلطة المدرس عند أنصار الطرائق التلقينية لا تناقش وما على الطالب إلا أن يطيع ويمتثل.
يؤكد نفس الباحث “أن بعض مدارسنا العربية متسلطة، يسودها الطابع الاستبدادي إلى حد كبير”فلا يعرف طلابها الحرية والشورى بل يمارسون الطاعة و الخضوع والتقبل السلبي والانقياد وقبول نتائجهم .
ويصف السورطي عملية التقويم في بعض النظم التربوية العربية بكونها أداة للتسلط على الطالب وترويعه والتحكم في مستقبله ومصيره فهي لا تقيس إلا مدى الحفظ للمادة الدراسية وتهمل متابعة القدرة على التفكير والنقد وحل المشكلات.
أما الامتحانات فتكمن خطورتها عنده في هشاشة الأحكام والقرارات التي تبنى عليها والتي قد تكون خاطئة ومتهورة فتنتهي إلى نجاح غير دال أو إخفاق متعسف.
يذكر السورطي أن العلاقة بين المعلم والطالب غالبا ما تبنى على التسلط والإجبار والخوف والإذعان من قبل المتعلم. ذلك ما أظهرته دراسة أردنية لكل من (داود وحمدي ،1997) أفادت بأن بعض معلمي المدارس الثانوية في الأردن يستخدمون النمط القهري التسلطي أكثر من غيره في الضبط الصفي (الدراسة ذكرها السورطي) وأن الممارسات تقوم على سيطرة المعلم والأساليب العقابية التي يستخدمونها تسهم في إقامة جو صفي ضاغط يضعف صورة الذات بدعوى حفظ النظام داخل الغرفة الصفية.
هذه السلطوية الموصوفة لدى المعلمين العرب هي مدعاة لإثارة النقمة والانتقام والعنف إضافة إلى تعويد المتعلمين على الكسل والكذب والنفاق والخوف والمكر والخديعة والاعتماد على الآخرين وضعف روح المبادرة.
تتعمق الباحثة في أسباب السلوك العنفي المدرسي وترجعها إلى عوامل تتعلق أساسا بالمدرسين وهي على حد ما توصلت إليه في:
- ضعف الثقة في المدرسين
- غياب القدوة الحسنة
- ممارسة اللوم المستمر من قبل مدرسيهم
- عدم الاهتمام بمشكلات الطلاب
تمثل المدرسة أهمية كبرى في حياة الطلاب وهي المؤسسة المسؤولة بعد الأسرة على التنشئة الاجتماعية ولكنها قد لا تحقق أهدافها المدنية والأخلاقية لأسباب متعددة قد تتعلق بالعلاقة السائدة بين الطلاب ومعلميهم ومعلماتهم وقد تعود إلى تسلط هؤلاء.
- دوافع إعلامية وثقافية
أكدت جل البحوث التي أجرتها منظمة اليونسكو أن مشاهدة العنف المتلفز قوت العنف لدى أطفال المدارس وفي جل المراحل الدراسية تقريبا وأن الأطفال المدمنين على مشاهدة البرامج العنيفة تتغير أمزجتهم فيتحولون إلى عدوانيين.
ذلك ما أكدته دراسة طولية أشار إليها الشهري في بحثه المتعلق بمتابعة ظاهرة العنف في المدارس الثانوية تتبعية شملت (700) مراهق ودامت (17) عاما كان قد أنه ثمة علاقة بين كم الحصص التلفزية التي شاهدها المراهقون و السلوك الذي صار يسلكه هؤلاء عندما أصبحوا يافعين سواء في المدرسة أو خارجها.
إن المشاهدة المستمرة والمتكررة للعنف والقسوة في وسائل الإعلام وعلى شبكة الانترنت تؤدي على المدى الطويل إلى تبطن العنف والقبول به كوسيلة استجابية لمواجهة بعض الصراعات وممارسة السلوك العنيف.
هكذا تبين لنا من خلال بعض الدراسات التي عثرنا عليها لحد الآن أن الجانب النفسي- الاجتماعي يعتبر أهم سبب في تفشي العنف المدرسي.
إن الذين يشعرون بالحرمان وفقدان الأمن والأمان في الحاضر والمستقبل وفقدان الثقة بالنفس، يحسون بالفراغ والفشل والدونية وعدم تقدير الذات “هم الأكثر عرضة للاغتراب وبالتالي للعنف.
أما العوامل الأسرية فقد احتلت المرتبة الثانية في ترتيب الدوافع والأسباب الكامنة وراء العنف المتنامي لدى الطلاب بسبب ضعف الرقابة والتوجيهات الوالدية الدينية للأبناء فضلا عن عدم اهتمام الوالدين بمشكلات أبنائهم وافتقاد الأبناء للقدوة الصالحة.
لقد أبرزت البحوث أثرا واضحا لما يبثه الإعلام من مادة، تنافي الأخلاق السامية والقيم النبيلة وهو مما يؤكد خطورة الإعلام في توجيه سلوك الطلاب نحو العنف والعدوان بسبب ما يبثه من مسلسلات هابطة وأفلام العنف المهيجة.
أما المدرسة (مناخها ومناهجها وثقافتها) فلم تسلم هي كذلك من تسجيل سلبيات حول أدائها ووجهت لها أصابع الاتهام من قبل عديد الباحثين العرب. فالبعض منهم يرى أنها لم تلبّ حاجات الطلبة الدراسية والترفيهية والرياضية .
وهكذا يتضح أن النظام التربوي مسؤول في حقيقة الأمر عن قسط من ذلك العنف الطلابي المتزايد يوما بعد يوم في عالم متغير”زادته العولمة تعقيدا وتهميشا للهوية والانتماء وتنكرا لحقوق المواطن وفرص تشغيله وسحقا لبيئته”(حامد عمار، 1996).
فرغم المجهود الذي تبذله الجامعات وما تحققه من استقطاب لأعداد هائلة من الطلاب وتنمية علمية واجتماعية نسبية إلا أنها ما زالت دون المؤمل. فهي مقصرة في إنتاج المعارف والمهارات المتجددة في تخريج شباب قادر على تحمل المسؤولية مستنير، فاعل ومؤثر في مجتمع الحاضر والمستقبل.
هذه بعض الدوافع والظروف التي وصفها الباحثون والتي قد تكون وراء العنف المتنامي إلا أنه لا يمكن أن تميل إلى مسببات أحادية كلاسيكية بل إلى تصور منظومي يجعل من العوامل في تداخلها سببا للتشكل والظهور.
إنّ مجموع القوى أو العوامل أو الأسباب التي تدفع الطلبة نحو إيقاع الأذى المتمثل في الهجوم اللفظي أو العدوان أو التحطيم للممتلكات العامة أو الخاصة بالسلطة أو برموزها وقد تكون دوافع أسرية اجتماعية أو اقتصادية، نفسية، ثقافية، إعلامية أو تربوية.
وفي هذا المستوى من التحليل نغتنم الفرصة أن نذكر بما تواتر من أثر قد يعود إلى المدرسة وتجربتها التربوية من ذلك أشارت إليه الدراسات وما أوجزناه فيما يلي:
– “عدم تقدير الطالب وعدم احترامه وقمعه أحيانا وعدم السماح له بالتعبير عن مشاعره.”
– “التركيز على جوانب الضعف عند الطالب والإكثار من انتقاده والاستهزاء به والاستهتار من أقواله وأفكاره.”
– “رفض مجموعة الرفاق والزملاء للطالب والسخرية منه على مرآى ومسمع من معلمه.”
– “عدم الاهتمام بالطالب وعدم الاكتراث به وعدم التعامل الفردي مع الطالب، وعدم مراعاة الفروق الفردية.”
– “وجود مسافة كبيرة بين المعلم والطالب، حيث لا يستطيع محاورته أو نقاشه حول علاماته أو عدم رضاه من المادة.”
– “الاعتماد على أساليب التلقين التقليدية.”
– “عدم تلاؤم الطالب مع المنهج المقرر (الدويك، 2000) ذكره صاحب مؤلف سلطوية التربية العربية.”
لقد أجمعت مجموعة من الدراسات والأبحاث التي تنتمي لحقل العلوم الإنسانية أو التربوية على حجج مادية ومعنوية قائمة في عمق المؤسسات التربوية تمثلت في اختلالات علائقية، وتسلط بيداغوجي أو إداري دفع المتعلمين واليافعين إلى ممارسة سلوكات عدوانية قد تعوض الحرمان والقهر النفسي الممارس عليهم، من جراء ممارسات يمكن إجمالها في النقط التالية:
– ضعف دمقرطة الشأن التربوي والتكويني .
– عدم ترسيخ قيم التكافؤ في الفرص التعليمية التعلمية بين الذكور.
– المس في بعض الأحيان بقيمة الاستحقاق.
– تهميش حقوق الطفل سواء تعلق الأمر بالحق في التعلمات، أو الحق في التعبير وإبداء الرأي.
– ضعف المصاحبة البيداغوحية داخل مراكز الإنصات المستحدثة في بعض المؤسسات التعليمية، وغياب بيداغوجية المرافقة من اجل تحقيق النجاح المرتقب لدى المتمدرسين.
– تهميش الحياة المدرسية.
– توجه المدرسة المقصود في البحث عن مقاييس جديدة، تحرض المتعلمين و الشباب على الخروج من النظام المدرسي بشكل مبكر، والدفع بهم إلى البحث عن ملاجئ اصطناعية لضمان مركز اجتماعي خوفا من التهميش والإقصاء.
– غموض الآفاق المستقبلية بالنسبة للمتعلمين، غالبا ما بدفع باليافعين إلى البحث عن التسرب المبكر إلى ممارسة العنف المدرسي أو ممارسة في الامتحانات.
ساهمت تلك الممارسات والإجراءات بشكل كبير في عدم أجرأة السلوك المدني لدى ناشئتنا مما جعل العلاقات المؤسسة بين كل من الأسرة و المدرسة مشوبة بتصدعات و بأزمات تبرزها حدة السلوكات المحتشمة والمرضية التي أصبحنا نلاحظها على متعلمينا.
وأسهمت بشكل قوي في بروز مجموعة من التصرفات العدوانية التي تخرج عن نطاق المألوف، وتبتعد عن طبيعة القيم التي يدافع عنها المجتمع المدني بمختلف مؤسساته.
ونذكر في هذا السياق بعض الانعكاسات والآثار التي يمكن أن تنجم عن تنامي ظاهرة العنف وانتشارها ومنها:
– التغيبات غير المبررة عن الدروس.
– تبرير العنف عند كل نقص أو حاجة.
– عدم الاهتمام بالأنشطة التعليمية التعلمية.
– التسرب من المدرسة والسير في طريق الانحراف.
– الميل إلى العنف في كل مناحي الحياة العامة.
لذلك يجدر بنا أن نوجه مقترحات وتوصيات للفاعلين التربويين في المؤسسة الأصيلة قصد توخي منحى وقائي من العنف المدرسي.
– إكساب المتعلمين الكفايات الأساسية التي تخول لهم فهم الواقع الاجتماعي والمساهمة في تغييره نحو الأفضل وعوض ممارسة الهدم.
– اعتماد بيداغوجية القدوة خصوصا من طرف الآباء والفاعلين التربويين.
– دفع المتعلمين إلى تقدير قيمة الصدق والاستقامة وبذل الجهد والتسامح والإيمان بالاختلاف، واحترام الذات والآخرين من خلال برامج ثقافية تعد لهذا الغرض، وبشراكة مع جمعية التربية والأسرة.
– تفعيل قيم التكافؤ في الفرص التعليمية سواء بين الذكور والإناث أو بين المدينة والقرية للحد من التصدعات التي يمكن أن تنجم عن أي خرق لهذا المبدأ مما يفضي بالمتعلمين إلى ممارسة العنف.
– تفعيل شراكة بين المجالس التربوية وجمعيات أولياء الأمور.
– اعتماد الإجراءات السليمة في فرض القانون الداخلي للمؤسسة والتعريف به، ولم لا إشراك المتعلمين والمتعلمات في بنائه ومناقشة بنوده حتى تمنح لهم كل المسؤوليات في تطبيقه، والتدخل في شجب كل متعلم عمد على خرقه.
– التزام الطاقم الإداري والتربوي بمراعاة حقوق الطفل وحقوق الآباء، واطلاعهم على نتائج أبنائهم.
– مساعدة الأسرة للمؤسسة المدرسية في حل مشكلات العنف إذا ما ظهرت للوجود وأي نوع من أنواع السلوكات غير المقبولة اجتماعيا وأخلاقيا ، و ذلك من خلال تأسيس تعاقد اجتماعي معها بشكل إلزامي.
– قيام الآباء بأنشطة تطوعية في المؤسسة التربوية دعما للسلوك المدني المراهن عليه.
– تصحيح المواقف العنيفة للشباب حيال المدرسة وإعادة ثقتهم بها وبمستقبلهم التعليمي التعلمي، عبر برمجة أنشطة تربوية وسيكولوجيةلفائدة حالات معينة.
وبناء على ما تقدم نذكر بأن تأصيل قيم التسامح ونبذ العنف في مؤسسات التربية الأصيلة يعد من الأولويات في التربية على القيم، ذلك إن التربية على التسامح، وقيمه وتأصيل معانيه يوفر على المجتمعات العربية والإسلامية جهودا كبيرة في مواجهة العنف، والتشدد ورفض الآخر. إن التربية على التسامح وقبول التنوع والاختلاف واحترامهما والاعتراف بالحقوق، والحريات للآخر والشورى والمحبة والوئام والتعاون على البر والتقوى من أهم القيم المضافة في هذا المشروع التأصيلي.
لذلك نتقدم مرة أخرى بمقترحات عملية لعلها تسهم في وقاية كل المتعلمين من أخطار العولمة واستبطان جيد للقيم المدنية و الأخلاقية نوردها على التوالي:
- تعميق الشعور بالانتماء لدى الطلاب والطالبات نحو أسرهم ومجتمعهم ومدرستهم الأصيلة.
- ترغيب الطلاب من الجنسين في اكتساب القيم الدينية(التسامح وكظم الغيظ والعفو عن الناس) وانتقاء أجود المواد الإعلامية و الاتصالية المرغبة في حب الوالدين ونفع الآخر وحب البيئة.
- دعوة الطلاب من الجنسين إلى المساهمة في تنشيط الحياة المدرسية (شغل أوقات الفراغ بأنشطة ترفيهية ثقافية ورياضية و إبداعية يختارونها بأنفسهم…الخ) .
- تشجيع الطلاب من الجنسين على توطيد صلاتهم بأسرهم وبالخيرين من أترابهم والتنافس على العمل الصالح داخل المؤسسة وخارجها.
- عقد لقاءات ودية بين الطلاب من الجنسين والقيادات التربوية والإدارية للاستماع إلى مشاغلهم وعوائقهم ومساعدتهم على حل مشكلاتهم المتعلقة بتكيفهم وبمسارهم التربوي والتعليمي.
- عقد لقاءات ودية وأنشطة اجتماعية كالرحلات والحفلات لتقوية العلاقات بين الطلاب والآباء والمعلمين والقيادات الاجتماعية.
ثانيا: ظاهرة الغش في الامتحانات
مقدمة:
تعد مشكلة الغش في الامتحانات المدرسية من أخطر المشاكل التي يواجهها التعليم المدرسي وأوسعها أثرا على في حياة الطالب والمجتمع حوله. لقد استفحلت وانتشرت في كل المؤسسات التربوية العربية مما جعل العديد من المدرسين والتربويين يشكون من انتشارها ويدقون ناقوس الخطر.ذلك ما يأكده (فيصل الزراد،1997) من تنام لسلوك الغش لدى الطلبة المسجلين بمراحل التعليم الثانوي والعالي ببعض مؤسسات التربوية بكل من سوريا والإمارات العربية المتحدة.
لقد بدأت هذه الظاهرة بالظهور في المرحلة الإعدادية وانتقلت عدواها إلى المرحلة الثانوية وحتى إلى الجامعات حيث أصبحت من أخطر المشكلات التي تواجهها الأنظمة التربوية في العام العربي، وتحديدا عند حلول فترة الامتحانات الثانوية والجامعية.
1-محاولة في تحديد المفهوم:
تعد ظاهرة الغش في المدارس وتحديدا بالامتحانات المدرسية من اخطر المشاكل التي يواجهها التعليم وأكثرها تأثيرا على الحياة المدرسية والاجتماعية ومن”الناحية السوسيولوجية يمكن نعت الظاهرة بالاجتماعية لأنها ظاهرة متعددة الأبعاد والترابطات وتتصف بالتعقيد والكلية فضلا عن اتصالها الوثيق بكائن اجتماعي معين”.(حسين الحريش،2009).
تدل ظاهرة الغش على سلوك غير سوي، منحرف وغير أخلاقي، وهو سلوك مرضي يهدف إلى تزييف الواقع لتحقيق مكسب مادي أو معنوي أو من أجل إشباع بعض الرغبات والحاجات لدى الفرد وهو حلقة من متلازمة ثلاثية معروفة تتكون من الكذب والسرقة وخيانة الأمانة، فهو إذن خيانة للنفس وخيانة للآخرين تنطلق مع الامتحانات وتنتهي إلى كل مناحي الحياة.
فالغش عموما هو كل سلوك يهدف إلى تزييف الواقع لتحقيق كسب غير مشروع مادي أو معنوي أو إرضاء حاجة نفسية والغش المدرسي هو تزييف لنتائج التقويم الذي هو من أهم عناصر المنهج.
فهو إذن سلوك انحرافي يخل بالعملية التعليمية يضعف من فاعلية النظام التعليمي ويعوقه عن تحقيق أهدافه التي يسعى إلى بلوغها ( فضيلة عرفات،2009).
وهو بالإضافة إلى كل ذلك ” استخدام لوسائل غير مشروعة للحصول على إجابات صحيحة ينقلها الطالب أو الطالبة من دون وجه حق فهو ضرب من السرقة والادعاء والتزييف وهو إهدار لقيمة تكافؤ الفرص وهو عدوان صارخ على الأمانة والصدق والمجتمع كله “( فضيلة عرفات،2007) وهو مؤشر على التواكل والكسل والخمول وعلى ضعف الإيمان وضعف الضمير والوجدان كما أنه مؤشر على تدني مستوى التربية الأسرية وضعف التوجيه والإرشاد الأبوي”.(فيصل الزراد،2009).
هكذا تبين لنافي القسم الأول من المبحث الثالث ضعف واضح لاستبطان القيم المدنية والأخلاقية وصفته مظاهر العنف المستفحل بين الطلبة داخل المؤسسة وخارجها.
لقد مكننا مظهر العنف من محاولة التعرف إلى الأسباب والدوافع المساعدة على ظهوره وتناميه من خلال بعض الدراسات العلمية القليلة التي أكد جلها على أهمية المنحى الوقائي في الحد من هذه الآفة والاهتمام بكل العوامل النفسية الاجتماعية والأسرية والتربوية والثقافية في تفاعلها.
ومهما يكن من أمر فإن دورالمدرسة في ترسيخ القيم عبر التأمل والتربية على الحرية والمسؤولية والاستقلالية
يعد من أهم الأدوار الضرورية التي يجدر بها أن تلعبها إذا أرادت تأصيلا وبناء للاستخلاف والتواصي بالحق والصبر.
يلاحظ من خلال ما عرف سابقا أن “الغش يدل على سلوك غير سوي، منحرف وغير أخلاقي يهدف إلى تزييف الواقع لتحقيق كسب مادي أو معنوي أو من أجل إشباع بعض الرغبات أو الحاجات لدى الفرد تعتمد فيه وسائل عديدة يبررها القائم بالغش لنفسه فماهو الشائع منها في مدارسنا؟
2-مظاهر الغش الطلابي:
أجريت بعض الدراسات التربوية كان القصد منها بالأساس معرفة الطرق والأساليب المختلفة التي يستعملها الطلاب العرب في المدارس والجامعات وبصفة خاصة تلك التي يستخدمونها في كل محاولة. وفي كل المواقف التقييمية .
وتمت مقابلة العديد من الطلاب والطالبات الذين الذين جربوا الغش أو أحيلوا إلى مجالس التأديب بسببه أن أساليب الغش عديدة أبرزها ما يلي :
– نقل الإجابة عن السؤال أو الجزء الهام منها من صديق مجاور في قاعة الامتحان
– النقل من كتاب مقرر
– النقل من أوراق خاصة ومصغرة معدة في الغرض
– نقل الإجابة من خلال مذكرات مكتوبة على مقعد الامتحان أو على حائط مجاور
-نقل الإجابة من خلال الكتابة على طرف الثياب أو على جزء من الجسم
– نقل الإجابة من خلال الحديث الشفوي مع زميل مجاورفي قاعة الامتحان
– نقل الإجابة من خلال الأجهزة النقالة والآلات الحاسبة
هذا بالإضافة إلى أساليب أخرى مختلفة ومتنوعة تتطور بتطور التكنولوجيا وتقنيات الاتصال
فإذا كانت هذه بعض مظاهر الغش وأشكاله التي تتطور بتطور التكنولوجيات والاختراعات فما هي الدوافع والأسباب المفسرة لانتشاره ؟
3- من أسباب سلوك الغش الطلابي ودوافعه:
ظاهرة الغش ليست سلوكا منحرفا يمس التلميذ فقط ويستثني غيره فنحن نعلم أن العملية التعليمية وحدة مترابطة بين (المدرس والتلميذ والمنهج ). فكل قصور أو مشكل يطال مكونا من هذه المكونات لاينبغي تناوله بمعزل عن المكونات الأخرى.
فقبل أن نحاسب التلميذ أو نلومه على تعاطيه هذا السلوك المشين ينبغي أن نستحضر أن المدرس حجر الزاوية في العملية التعليمية وبقدر كفاءته تحقق التربية أهدافها وإن كان من أهداف التربية ترسيخ القيم الحسنة فإن سيادة منظومة أخلاق وقيم سلبية قد يضع أكثر من علامة استفهام حول كفاءة المناهج التربوية بكل مكوناتها وفي مقدمتها المدرس. كما يرتبط الغش بخلل ما يمس أحد مكونات العملية التعليمية الأساسية وهو التقويم الذي يكرس بأساليبه الكلاسيكية ظاهرة الغش حين يركز على قياس المستويات المعرفية البسيطة المرتبطة بالحفظ والتذكر ويتجاهل مستويات الفهم والتحليل والمقارنة والتأليف.
كما يرتبط الغش بخلل ما يمس أحد مكونات الحياة المدرسية والبيئة الاجتماعية،فما هذه الظاهرة إلا امتداد طبيعي للغش والقيم السالبة السائدة في المجتمع وأزمة القيم أو سيادة منظومة قيم غير أخلاقية كالخيانة والارتشاء وابتزاز أولياء الأمور وانعدام المسؤولية مما يجعل من المدرسة مجرد وسيلة لتكريس هذه القيم وتجليها وربما التربية عليها وترسيخها عن قصد أو غيره في إطار وظيفتها السوسيولوجية التي يسميها السوسيولوجي الفرنسي بيير بورديو إعادة الانتاج “(حسين حنيش ،2009).
حاولت بعض الدراسات معرفة الأسباب التي تدفع الطلاب إلى ممارسة الغش في الامتحانات، فأشار بعضها إلى دافع الرغبة القوية في الحصول على علامة لتحقيق قبول في كلية أو المحافظة على معدل تراكمي جيد. (حمدان، 2003). وأشارت أخرى إلى ما يرتبط منها بقوة الشخصية أو ضعفها أو قيام أفراد الأسرة بفعل يعزز ذلك السلوك فيتقبله الطالب ويمارسه في حياته. ولكن هل هذه هي الأسباب الوحيدة للغش؟
لقد تعددت العوامل والأسباب المؤدية للغش منها ما يعود لأسباب أسرية ومنها ما يرتبط بالطالب وشخصيته و منها ما يرجع إلى العوامل التربوية و التعليمية داخل المدرسة فماهي أهم عوامل التنشئة الأسرية؟
أ-عوامل التنشئة الأسرية والاتجاهات الوالدية والاجتماعية
تلعب الأسرة دورا هاما في تربية الطفل وفي إكسابه مجموعة من المعايير والقيم الأخلاقية والمدنية فهي تؤثر تأثيرا كبيرا ومباشرا في سلوك الغش وبأكثر من طريقة أو أسلوب، ذلك ما أبرزه (حمزة دودين،2004) في مؤلفه حيث أكد تأثير الأسرة في سلوك الغش لدى منظوريها بتشجيعهم على التواكل وحل المسائل مثلا عوضا عن الطالب نفسه.
ومن العوامل الاجتماعية التي يمكن أن تسهم في التعود على سلوك الغش في الامتحانات المحلية والوطنية النهائية تجدر الإشارة إلى الخلفية الاجتماعية للطالب حيث لوحظ أن أسر الطبقات المحظوظة في المجتمع غالبا ما تشجع أو تضغظ على منظورها من أجل التفوق والحصول على درجات ومعدلات مرتفعة من أجل احتلال مركز مرموق في المجتمع.
ب-العوامل التربوية والتعليمية
يسود معظم مدارسنا وجامعاتنا أيام الامتحانات النهائية والأيام التي تسبقها أو التي تليها جو من الخوف والتوتر والانفعال بسبب اضطراب السير العادي للدروس حيث تعطى الاختبارات أهمية مبالغ فيها فتفرض على الطلبة حفظا سريعا وتذكرا آليا لكم هائل من المعلومات. وهو ما يأسف له الباحث النفسي فيصل الزراد في تعليقه ونقده لمدرستنا العربية التي تؤثر الكم على الكيف وتنمي الحفظ والحشو على حساب بناء التفكير النقدي وحل المشكلات حينما يقول :”إن معظم أجواء الامتحانات في بلداننا العربية بعيدة كليا عن أجواء التقييم والتقويم في البلدان المتميزة تربويا والتي ترى أن المدرسة والجامعة أنشئتا لإعداد التلميذ وتكوين قدراته معارفه و مهاراته و مواقفه و توسيع خبراته للاستفادة منها في الحياة وليس لترويعه وترهيبه.”
كذلك تعد العلاقة الاجتماعية السيئة بين تلاميذ الصف الواحد وبينهم و بين المعلم من العوامل و العوائق التي يمكن أن تدفع المعلم لاتخاذ إجراءات متشددة وبالتالي سيلجأ الطلبة إلى كل الأساليب المشروعة و غير المشروعة لمواجهتها و التي قد يكون سلوك الغش في الامتحانات واحدا منها.
وفي هذا المستوى من التحليل لهذه المشكلة يجدر بنا أن نذكر أنه من العوامل الاجتماعية والتربوية التي يمكن أن تسهم في تغذية هذا السلوك اللاأخلاقي هو ضعف مهنية للمعلم في إعداد الاختبار الصادق والموثوق به وفي قدرته في التدريس والتنشيط والترغيب على تمثل القيم الدينية والإسلامية، واقتصار التعليم على التلقين والحفظ.
يرجع هذا السلوك اللاّأخلاقي الذي استفحل في مؤسساتنا العربية إلى عدة جوانب أسرية وتربوية إلى المجتمع بما فيه من
آباء وأصدقاء ومعلمين ومعلمات كلهم يتحملون المسؤولية في نشوء الغش ورعايته. ولكنه من المؤسف أن نقول أن المجتمع العربي بأسره يعاني من أزمة أخلاق و من أزمة قيم قد تؤدي لا قدر الله إلى انعكاسات خطيرة على تكوين الأجيال وتؤثر تأثيرا سلبيا على أوضاع المجتمع العربي الإسلامي الموصوفة بالتردي و الانحطاطو التخلف فما هي أهم تلك الانعكاسات وما هي أهم الآثار المتوقعة؟
فإذا كانت هذه بعض أسباب هذا السلوك اللاأخلاقي المدرسي فماهي انعكاساته وآثاره على الأجيال والمجتمع بصفة عامة؟
4 –انعكاسات الغش وآثاره:
للغش آثار سلبية تؤثر في الطلاب الذين مارسوه وفي زملائهم فهو” مشكلة تربوية تؤثر سلبيا في تحقيق أهداف التربية والمجتمع إضافة إلى هدر المال العام من خلال إضاعة فرص التعليم الحقيقي على فئة من أفراد المجتمع”(دودين حمزة،2004). يؤثر الغش أولا في الفرد الذي تعود على مثل هذا السلوك فيقلل من تقدير الطالب لذاته واحترامه لنفسه وقدراته وتراجع دافعيته كما تتهاوى الثقة بين المدرس والطالب وقد تتوتر العلاقة بينهما. تنمي ظاهرة الغش إذن في شخصية الطالب الذي تعود على مثل ذلك السلوك بعض الصفات الشخصية السلبية مثل التواكل وضعف العزيمة والإرادة والكسل والخمول، وعدم تحمل المسؤولية وكراهية النظام والاستقامة واللجوء إلى الأساليب المنحرفة في المعاملات إضافة إلى الإحساس الدائم بالخوف والقلق والتوتروالنقص(فيصل الزراد،2002).
وتتجلى خطورة سلوك الغش من الناحية التربوية والتعليمية في عديد الانعكاسات على الطالب وشخصيته وعلى المؤسسة التربوية وسمعتها من ذلك ما أشار إليه فيصل محمد خير الزراد في مؤلفه”ظاهرة الغش في الاختبارات الأكاديمية لدى طلبة المدارس والجامعات” نوجزه فيما يلي :
- تفشي الغش يعطي الاختبارات المدرسية صورة سلبية ومزيفة.
- تعود الطالب على الغش في أدائه المدرسي يمهد له ارتكاب غش أخطر في حياته الاجتماعية سواء داخل المدرسة أو خارجها.
- تفشي ظاهرة الغش في الاختبارات المدرسية من شأنه أن يخرج طلبة محدودي الكفاءة مما قد تكون له الآثار السيئة في مستقبل الأيام على عملهم واندماجهم في سوق الشغل.
ويشكل الغش من الناحية الاجتماعية سلوكا منحرفا بسبب خروجه عن قيم المجتمع وضوابطه ،فالطالب الذي يغش عند إجراء الامتحان و الاختبار ثم يشغل مكانا أو مركزا وظيفيا أو مهنيا بغير حق شرعي هو مخالف للمعايير و القيم السائدة ولمبدإ تكافؤ الفرص. ومن الآثار الاجتماعية للغش إمكانية انتقال ذلك السلوك المنحرف وتبعاته إلى الحياة العملية سواء أثناء فترة الدراسة أو بعدها حيث قد يتعزز ذلك السلوك ويصبح الوسيلة ذات الأولوية في الارتقاء المهني والوظيفي وبالتالي يعسر تعديل ذلك الصنيع .
وفي هذا المستوى من التحليل لبعض مظاهر الإعضال القيمي الموصوفة على سبيل الذكر لا الحصر يجدر بنا أن نذكر قبل بلورة أي نموذج تطبيقي تربوي أصيل أن لعملية إدماج القيم في المنظومة التعليمية أهمية كبرى ويبدو أن مدخلها الطبيعي هو: الأساس يجب تفعيل شعار تخليق الحياة في كل القطاعات والمجالات والقيام بإصلاح شمولي يتحمل فيه جميع الفاعلين الاجتماعيين مسؤوليتهم الأسرة والإعلام والدولة والمجتمع المدني…
ينبغي أن يتحلى الفاعلون التربويون بالشجاعة الكافية لتطوير نظام التقويم التربوي بحيث يرتكز على قواعد علمية حديثة لا مكان للغش فيها.
كما ينبغي أن يعود المدرس اليوم إلى أداء وظيفته بإعطاء النموذج الأمثل لأن القيم تدرس بالقيم فلا معنى أن ندعو إلى محاربة الغش بالمدرسة ونستمر في ممارسته في كل سلوكياتناوأن يهتم بما ب:
-” تكوين المدرس الذي يحمل الرسالة التربوية إلى المتعلمين عبر مقاربات تربوية متنوعة وفي سياقات متنوعة ومتكاملة عبر مواد حاملة (مواد التربية المدنية والإسلامية والفلسفة التاريخ والجغرافيا..).( الحسين حريش،2009).
– استدماج المفاهيم القيمية مع الوعي التام بأهمية دور كل المواد الدراسية في القيام بهذه المهمة التربوية ومراعاة الجوانب البيداغوجية والديداكتيكية التالية :
- اعتماد مناهج التعليم للقيم المدنية والأخلاقية على أسلوب سوسيوبنائي للمفاهيم وتوخي منهجية فكرية واضحة تمكن من التفاعل وتبادل الرأي الحر.
- تناسب طرق التدريس مستوى الطلبة ونضجهم العقلي والنفسي وخبراتهم الفردية.
- تستفز في الطلبة قدراتهم وطاقاتهم على المشاركة والتفاعل وذلك باعتمادها على التشويق والإثارة وشد الانتباه مع تجنب الرتابة والملل.
- التنوع والتغير من مرحلة إلى أخرى في مراحل الدرس بحيث ينوع الطرق من الحوار إلى الإلقاء والتطبيق والتفكير والتحليل والتعليل وغير ذلك مما ينمي الخبرات المتعددة لدى المتعلم.
- مشاركة التلاميذ في بناء العملية التعليمية مع الحضور النسبي للمدرس في دور الموجه والمنشط مما يخلق جوا من التفاعل والتنافس الإيجابي بين التلاميذ ويخلق بينهم فرصا للعمل التعاوني داخل الفصل وخارجه.
– الربط بين عملية التعليم داخل الفصل وخارجه وذلك باستثمار الربط بالظواهر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يعيشها التلميذ خارج الفصل ومعلوم أن التلميذ يتفاعل مع ما يقدم له من معطيات بقدر استجابتها لحاجاته في الواقع (خالد الصمدي،2005).
تأليف حول تشخيص المعضلة التربوية بالعالم العربي والإسلامي
وفي خاتمة هذه المحاولة التشخيصية للمعضلة التربوية في العالم العربي والإسلامي نذكر بأن المنهج التشخيصي الذي اجتهدنا في تحديده بعد استشارة لزمرة من باحثي المشروع وتعاون مكثف مع كل من الباحثين( حميدة النيفر ومصدق الجليدي) مكننا من التعرف إلى المتواتر والدال من أعراض الإعضال التربوي الذي لصق بالمخرجات والتي سجلنا أهمها وهي ما تمثل في:
– انتشار ظاهرة الأمية الأبجدية و الرقمية
– تدني مردود التربية قبل المدرسية بسبب تواضع نسب الالتحاق وتذبذب المناهج
– تدني مردود المخرجات المتعلقة باللغة العربية اللغات الأجنبية
– تدني المخرجات المتعلقة بالتحصيل في مادة الرياضيات و العلوم
– تنامي ظاهرة الاغتراب الطلابي
– ضعف استبطان القيم المدنية و الأخلاقية
إلا أنه يمكننا القول في خاتمة هذه المباحث التشخيصية أن العلوم التربوية وعلم التقويم بالذات لا تفضي، بالضرورة، إلى التوصل إلى معرفة علمية مدققة، قارة ونهائية بالواقع المبحوث بل إلى إنتاج معرفة نسبية ، أو بالأحرى تشكيل خطاطات أو شبكات معرفية تساعد على قراءة الواقع التربوي ومحاولة فهمه وتفسيره.
إن تسارع وتيرة العولمة و التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية في العالم العربي والإسلامي، وتعدد وتشابك عواملها الذاتية والموضوعية، الداخلية والخارجية، واتساع امتداداتها إلى البنيات والهياكل والمؤسسات التربوية والقيم السوسيوثقافية والأطراف الفاعلة ،كل ذلك عقد علينا امتلاك الاقتدار العلمي الكافي للإمساك بزمام المعضلة التربوية و تعقيداتها .
رغم ذلك حاولنا على كل حال في هذا التشخيص للمعضلة التربوية تجاوز اختزال متعسف لها، يحولها من معضلة اجتماعية شمولية متعددة الأبعاد والمدلولات والعوامل إلى اختلال تقنوي .
وهنا يجدر بنا أن نذكر أيضا أن المعضلة التربوية في العالم العربي والإسلامي، “لم تكن ظرفية عابرة، أو وليدة منعطف تاريخي خاص، أو قطاعية محدودة، أو تقنية يرتهن تجاوزها بتوفير شروط وإمكانات مادية معينة، وإنما هي جزء من كل مركب، من أزمة اجتماعية بنيوية شمولية كان من بين عوامل إنتاجها ما يلي:
أ – تذبذب مرجعية فكرية واجتماعية موجهة يمكن الانطلاق منها لبلورة فلسفة أو سياسة تربوية متكاملة واضحة المعالم والأهداف، مستجيبة للحاجات والمطالب الحقيقية للمجتمع، متساوقة مع مستجدات التغير والتحول في شتى أبعادها الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية الشاملة.
ب – ثقل الإرث السوسيوتاريخي والسياسي لمرحلة ما بعد الاستقلال، المتمثل فيما تراكم خلال تطورات البلدان العربية و الإسلامية من مشكلات ومآزق، وما تراكم من اعتماد لتجارب غريبة عنا ولآليات لا عقلانية منافية لقيم التأصيل والتجديد، وشيوع قيم هزيلة منحطة، وممارسات منحرفة ساهمت في ترسيخ الفساد، وتكريس “ثقافة رداءة”، اخترقت العديد من أصناف التفكير والوجدان ونماذج السلوك، الأمر الذي ضرب في الصميم مجمل عمليات الإصلاح ومشاريع الإنماء التربوي”(محسن مصطفى،2009).
تلك العوامل مجمعة أدت إلى الأعراض الكبرى للمعضلة التربوية التي نوجز بعضها وهي :
1 – عجز نظامنا التربوي-التكويني، بكل أنماطه ومستوياته، عن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص التربوية والتعليمية والتكوينية على الرغم مما تحقق من تقدم نسبي في مجال تعميم التعليم وتوحيده وتعريبه.
2 – تنامي حدة انفصال نظام التربية والتكوين في مجتمعنا عن محيطه الاقتصادي والثقافي والاجتماعي العام. سواء فيما يتعلق بالمضامين أو القيم أو العلاقات والتبادلات أو بمجموع آليات وشروط الاشتغال.
هكذا إذن، وبفعل تأثير هذه الشروط والعوامل كلها في تعددها وتعقدها وتداخلاتها البنيوية، أصبح نظام التربية والتكوين بالعالم العربي والإسلامي المعاصر نظاما مأزوما، عاجزا عن أن يشكل، الأمر الذي جعل سؤال التأمل التربوي مطروحا بحدة كبيرة، وعلى أكثر من صعيد.
المبحث السابع
مقترح لصياغة فرضية للمشروع
مقدمة:
وبناء على ما تقدم تأكد لنا وجود مشكلة مستفحلة تعلقت بمخرجات الأنظمة التربوية العربية في بعديها المعرفي والقيمي بعد أن جمعنا عديد المظاهر السلبية نذكربها هنا وهي :
1 – حرمان العدد الهائل من أطفال العالم العربي والإسلامي من تربية أصيلة على القيم في الروضات والأقسام التحضيرية إضافة إلى التذبذب و الازدواجية اللغوية (عربية-أجنبية).
2- انتشار أمية معرفية، حضارية ورقمية يعاني منها ثلث السكان الكبار بالمجتمع العربي أغلبهم من الإناث
3- تدني مستوى المتعلمين والخريجين في القراءة والكتابة بلغتهم العربية
4- تدني مخرجات المتعلمين في الرياضيات وبالأساس في حل المسائل
5- تدني المخرجات المتعلقة بالتفلسف والاجتهاد و ومحدودية التفكير النقدي وانتشار التشدد الفكري
6- تخرّج أجيال عربية ليس لهم إلمام لا بالمعرفة الإسلامية ولا بالمعارف الإنسانية.
7- اغتراب طلابي مستفحل وفقدان للمعنى و الهدف واللامعيارية واللامبالاة
8-تعدد مظاهر الاستلاب والتأثر بالقيم الغربية
9- تنامي العنف المدرسي والتشدد وتدني المخرجات المتعلقة بالتربية على القيم المدنية والقيم الخلقية الإسلامية
10- استفحال الغش الطلابي في الامتحانات والاختبارات في عديد المؤسسات التعليمية العربية.
تأملنا في تلك المظاهر المختلفة وحاولنا البحث عن العوامل و الأسباب التي تكمن وراءها فتوقعنا ما يلي :
– “غياب نظرية مركزية للتربية والتعليم في البلدان العربية وغياب المرجعية الفكرية والاجتماعية المتكاملة المؤطرة والموجهة للنظام التربوي العربي.”
– غياب الاستراتيجية التربوية التعليمية التي تستلهم النظرية في المراحل الدراسية كافة
– “تغييب التأسيسات الإسلامية في القرآن والسنة والتراث في معظم مساحات الاشتغال التعليمي التربوي
– طغيان الرؤية العلمانية، وأحيانا المادية، على المفردات المنهجية للعديد من العلوم الإنسانية (القانون، الاقتصاد، الإدارة، السياسة، الاجتماع، النفس، التربية، التاريخ وفلسفته، الحضارة، الآداب والفنون.. الخ ). “
– “إقامة الجدران الفاصلة بين المعرفتين الإنسانية والإسلامية وبالتالي تخريج نمطين من أجيال الطلبة اللذين لا يملكون في أولهما الماما كافيا بالمعرفة الإسلامية تمكنهم من اعتمادها معيارا للحكم على معطيات ونتائج المعرفة الإنسانية . ولا يحصلون في ثانيهما على قدر كاف من المعارف الإنسانية يجعلهم عناصر فاعلة على وعي بمطالب العصر وتحدياته “(عماد الدين خليل،2009) ذلك ماأفادنا به الباحث في الاستفتاء الذي وجهناه إلى كل من رغب في الإضافة المتعلقة بتحديد المعضلة التربوية.
- انفصام بين مضامين التربية والتعليم والتكوين المستوردة جلها وبين الحقل الثقافي والاجتماعي ومتطلبات سوق الشغل.
– طغيان الرؤية العلمانية، وأاحيانا المادية، على المفردات المنهجية للعديد من العلوم الانسانية (القانون، الاقتصاد، الادارة، السياسة، الاجتماع، النفس، التربية، التاريخ وفلسفته، الحضارة، الادآب والفنون .. الخ )
- هشاشة الربط المخطط والهادف لأنظمة التعليم والتكوين بالمحيط الثقافي والاقتصادي والاجتماعي العربي.
- ضعف ملاءمة الأهداف والغايات التربوية لمطالب المجتمع وضعف الكفايات الخارجية المؤسسة التربوية.
- عجز أنظمة التربية عن تحقيق ما يسمى بتكافؤ الفرص واستيعاب المستحقين للتعليم وحرمان فئات كبيرة أغلبها من الفتيات الريفيات خاصة.
- عجز التربية بوضعها الراهن عن توفير مطالب المفهوم الجديد للتربية المؤكد على أولوية التعلم على التعليم.
- تدهور القيمة الاجتماعية والاقتصادية للمدرس ساعدت على تعميق العديد من التصورات المكرسة لتبخيس العلم والتعليم والمعرفة والثقافة والفن وكل أشكال الإبداع والابتكار واستبدالها يقيم مناقضة،منحطة تؤكد على أولوية قيم المال والوجاهة الاجتماعية.
- تذبذب المناهج من مرحل الروضة إلى مراحل التعليم العالي (تهميش للغة العربية وازدواجية بينها وبين اللغات الأجنبية ذات الحظوة و الأولوية).
- تواضع الإعداد المهني للمعلم قبل الخدمة و أثناءها في جل المراحل التعليمية: حيث لازال دون المؤمل فهو لا يهتم ببناء هوية مهنية فاعلة متأملة مسؤولة مجددة (رضا ساسي،2008) ولا يمكن من اكتساب كفايات تعليمية و مواصفات تؤهلهم تربويا ونفسيا وعلميا لأداء مهمتهم.
هكذا يبدو من خلال هذه المحاولات التفسيرية الأولى أن الفشل والإعضال الذي لحق بمخرجات الأنظمة التربوية العربية قد يفسره تنافر نسبي بين ما تخطط له السياسات التربوية من غايات وأهداف و بين حاجات الأفراد والشعوب وانعدام للتوازن بين التكوين المعرفي والقيمي الروحي الأخلاقي والمدني إضافة إلى قصور وتقصير في إعداد المعلمين والمشرفين التربويين والإداريين وسلطوية تعليمية مستبدة ومتحجرة.
التصور المقترح لفرضية المشروع انطلاقا من التشخيص النسقي للمعضلة التربوية:
يمكن أن نتصور أن سبب الأسباب في ذلك التدني المعرفي و وذلك الانحطاط القيمي الذي لحق المخرجات وفسرته بعض الممارسات التعليمية و المدخلات التربوية قد يعود على الأرجح إلى” غياب الأصالة والتأصيل لمنظوماتنا التربوية العربية والإسلامية واستجلاب نموذج تربوي استقدم من أرض غريبة وزرع في أرض غير أرضه الأصلية”(رضا ساسي ومصدق الجليدي2009)” وتراجع النظام التربوي الإسلامي في عطائه الروحي و الفكري والحضاري وعجزه عن تخريج الإنسان الخليفة في الأرض والمعمر فيها بسبب انحرافه عن الأصول التي قررها القرآن الكريم.
لذلك خصصنا بعد التحليل والتشخيص لمظاهر المعضلة التربوية في العالم العربي و الإسلامي هذا القسم من البحث لصوغ الفرضية الرئيسة لهذا المشروع و المتمثلة أساسا في غياب اللأصالة والتأصيل للمنظومة التربوية وفي تقصير هذه الأمة في الذود عن استقلاليتها المرجعية و العلمية وانبهارها وللأسف الشديد بالفكر الغربي مرة وبالفكر الشرقي تارة أخرى. ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾. (التوبة: 109)
أولا:غياب التأصيل في مناهج التعليم بالعالم العربي والإسلامي:
يواجه العرب في عصرنا الحالي تحديات كبيرة لعل أخطرها فقدان الأصالة الذي أخذ أشكالا متعددة رغم الصحوة واليقظة التي بدأت تدب في شريان الأمة وتواجه التربية العربية عوائق عديدة أهمها ما عبر عنه وأكد عليه اسحاق الفرحان، في حوار أجراه معه (اسماعيل الكيلاني،1983 م) لمجلة الأمة القطرية أن “فقدان الذاتية والأصالة ماهو إلا عدوان على التربية الإسلامية وفقدان للمنهج التربوي الأصيل المستوحي من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه الخاتم•.”
وفي واقع المسلمين اليوم مجموعتان على حد رأيه-من المؤسسات التي تعتبر ميدانا للمواجهة التربوية بين المربين المسلمين وغيرهم:
- المجموعة الأولى: ميدانها المدارس والمعاهد والجامعات
- والمجموعة الثانية: وسائل الإعلام المختلفة
ومن أهم صور المواجهة في المجموعة الأولى: المنهج والكتاب الذي يؤلف وفي إعداد المعلم القدوة الذي يعد بمثابة الأب الثاني للتلميذ الذي منه يتعلم منه و منه يتشرب الاتجاهات والعادات والأخلاق والقيم.
إن ما يطبق في البلاد العربية والإسلامية اليوم من مناهج وما يؤلف من كتب يتراوح اقترابا وابتعادا من الإسلام بقدر قرب أو بعد المجتمع عامة من تطبيق التشريع الإسلامي والالتزام بالإسلام في واقعه.
ويمكن القول إن مناهج التربية والتعليم في بلادنا العربية تأثرت إلى حد ما في مشاريع تطويرها بالأنماط الغربية
على حساب أهداف الأمة وغاياتها المنبثقة من عقيدتها وقيمها وتاريخها وعلى حساب معارفها وحاجات طلبتها، ومجتمعاتها.
فالخلل يكمن إذن في المنطلقات الفلسفية للمناهج والكتب التي لم تنبثق أكثر محتوياتها من فلسفة الإسلام التربوية والتعليمية.
لا تزال هذه المناهج والكتب وللأسف تعتمد النماذج الغربية في التخطيط وتستند في منطلقاتها إلى النظريات المادية في غياب الإرادة السياسية الفاعلة وفي ندرة أبحاث علمائنا في الجامعات والمعاهد وقلة مساهماتهم الدالة في دفع عجلة العلم والثقافة الإنسانية. ذلك ما أكد عليه (محمد جواد رضا،1979)[16] وبإلحاح على تأصيل برامجنا التربوية قائلا: “أن التراث الثقافي العربي جوانب منيرة وقوى دفع نحو الإبداع والتحرر الفكري، أهملنا تجربة أجيالنا عليها رغم حديثنا المكرور عن قداسة هذا التراث ونبله.”
أما الصورة الأخرى للتحدي فتتمثل في تأثر المدرسة بوسائل الإعلام التي سلبتها فعلها الوحيد وبالمدرسة الموازية المؤثرة الأخرى (إذاعة،تلفاز،شبكة عنكبوتية عالمية،جوال…) التي تحاول اقتلاع الأصول وإفساد العقول.
في ضوء هذه الأسس، التي يستحضرها أغلب واضعي مناهج المادة نحاول استعراض أهم الصعوبات العملية التي تعاني منها مناهج التربية الإسلامية.
فغير خاف أن مناهج المادة الحالية في البلدان الإسلامية تعتريها صعوبات منهجية ومعرفية تحول بينها وبين تحقيق مقاصدها المعرفية والتربوية، وتتمثل أهم هذه الصعوبات في:
- غياب مرجعية منهجية نظرية في طرق بناء محتويات المناهج الدراسية، تؤطر بناء مناهج مادة التربية الإسلامية الحالية، وخاصة الاستفادة من نتائج البحث العلمي في استراتجيات التعلم، ومعلوم أن غياب مرجعية منهجية نظرية في بناء محتويات المادة ، يخلق صعوبات جمة في طرق تنفيذ المنهاج، ويكفي أن نشير مثلا إلى تدريس مفاهيم فرعية قبل المفاهيم الأصلية، أو إدراج مفاهيم غير مناسبة للفئة المستهدفة، أو تدريس مفاهيم دون ربطها بسياقها المعرفي والتربوي.
- اعتبار المعرفة الإسلامية هدفا من المادة وليست وسيلة للتربية على القيم، ولذلك يتم التركيز في وحدات المادة على العلوم الإسلامية كعلوم العقيدة وعلوم القرآن وعلوم الحديث والفقه وأصوله والسيرة النبوية.
- التركيز على تلقين المعرفة عوض بنائها باعتماد أحدث استراتيجيات التعلم بمساهمة المتعلم مما يضعه في وضعية المتلقي السلبي، ولا يساعده على تنمية قدراته وكفاياته من خلال ممارسة مهارات ذهنية وسلوكية مفيدة.
- “التركيز على البعد الفردي في السلوك الإسلامي للمتعلم كالعقائد والعبادات والأخلاق، وعدم إدماج قضايا العصر الجماعية في مناهج المادة كالصحة والبيئة والحقوق والفن، والاقتصاد، وغيرها، وإبراز موقف الإسلام منها
وتمكين التلميذ من معرفة شاملة عن الإسلام كنظام حياة.”
- من الأسباب والعوامل الفكرية لتواضع التأصيل للمناهج:
أشارت دراسة علمية أجراها (راضي اسماعيل عطا،1986م) بجامعة المنوفية بمصر إلى سلبية خطيرة شخصت جمودا أصاب المناهج والمؤسسات التربوية وهي انتشار التقليد وغلق باب الاجتهاد بعد أن كان الفكر الإسلامي قادرا على التجدد محتويا لكل مستحدث الأمر الذي أثر على أداء النظم التعليمية وطرائق التدريس التي جعلت من الحفظ والتلقين ديدنها.
وصف الباحث حال المناهج التعليمية في العالم العربي والإسلامي فذكر بالهوة السحيقة بين المحتويات والحاجات الحياتية المتأكدة والتي أدت إلى عدم مسايرة المعارف الإسلامية مع متطلبات المسلمين.
هذه مظاهر خلل تضاف إلى أخرى توصل إليها جل الباحثين المهتمين بالشأن التربوي العربي.
وهذه بعض الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي جمعناها من أبحاث ومقالات عديدة رقمية وورقية نوردها لتنوير المهتمين بشرح قصور المؤسسات التربوية أملا في بلورة نظرية هادية لبناء نموذج تطبيقي لنظام تربوي أصيل.
فماهي القوى التي عوّقت حركة التقدم التربوي العربي الإسلامي وماهي الأسباب الكامنة وراء ذلك؟
يشير البحث السابق في هذا الصدد إلى عاملين أساسين حالا دون التأصيل التربوي:
- عامل خارجي ضاغط
- وعامل داخلي يتحمل فيه المسلمون مسؤوليتهم
تمثل الأول في الثالوث الخطير: “الاستعمار والاستشراق والتعريب” الذي عمل على عزل المسلمين عن مقومات عزتهم وأبعدهم عن قرآنهم وسنة حبيبه محمد• وعن تجاربهم الرائدة. فشكك في الإسلام كدين وحط من مكانة اللغة العربية، ميّع المناهج باسم التطوير وقضى على دور المسجد كمنارة علم وإشعاع تربوي.
أما العامل الثاني الذي حال دون التجدد فيعود إلى ظروف داخلية تعلقت بطبيعة المجتمعات الإسلامية وبمسؤولية المسلمين من حيث قصور وسائلهم التعليمية وإهمال مراجعهم الشاملة ومركزية نظمهم.
- من الانعكاسات على تكوين الأجيال:
انعكس غياب التأصيل للناهج التربوية في العالم العربي والإسلامي انعكاسا واضحا على تكوين الأجيال وعلى المناهج ذاتها، ذلك ما أبرز دراسة علمية أجراها (راضي اسماعيل عطا،1985م) عدّد فيها آلاما عديدة عرفتها وتعرفها المناهج التربوية من ذلك غياب الرؤية التربوية الواضحة عن مجتمعاتنا المعاصرة وواقع المؤسسات في ديار المسلمين على الرغم من أن تراثنا الحضاري يحمل توجيهات سماوية عظيمة.
كذلك تحولت انعكاسات تغييب التأصيل بفعل التغريب والاستعمار القديم و”الجديد” والعولمة الثقافية إلى جمود ملحوظ في المناهج وإلى انتشار التقليد وغلق باب الاجتهاد الذين أثرا في فساد النظم التعليمية وضعف برامج التعليم وطرق التدريس وشيوع التلقين والتمرير السلبي للمعارف.
أثّر غياب التأصيل في المناهج والكتب والممارسات التربوية وفشل مشروع التأصيل المحرك للتغيير والفعل الواعي برسالة القرآن الكريم، ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ (الرعد:11) وبروح الثقافة الإسلامية في تكوين الأجيال فتدنت المخرجات التعليمية والتأهيلية (رضا ساسي،2008م) وتأرجحت الهويات الفردية والمهنية بين التقليد للغرب والتقليد للتقاليد.
فرض ذلك الضمور للتأصيل البنائي على الأجيال معاني ثقافية محددة وخلق خضوعا وتشكيلا لكوادر يسهل التأثير فيها همهم الأول هو الحصول على الشهادة والوظيفة وليس التفكير والتحليل والابتكار المساعد على رفع التحديات.
ثانيا:غربة اللغة العربية:
يبدو أن اللغة العربية اليوم أصبحت بين “فكي رحى، بين عولمة تمارس عليها ضغوطا هائلة وبين فصيل من الفكر والممارسات التعليمية التي تفوق تقدمها تحت دعاوى الطهارة اللغوية والأصالة الفكرية.”[17]
ذلك ما برز في حرص بعض أنظمة التعليم في بعض الأوطان العربية الإسلامية على جعل مرحلة ما قبل التعليم الإبتدائي مرحلة من مراحل التعليم وأنشئت لذلك فضاءات مختلفة (رياض أطفال).
أما الملفت للنظر فهو تباري تلك الدور وبالأخص رياض الأطفال في تعليم لغة أجنبية تدرس لغات أجنبية إلى جانب اللغة العربية.
ومن هنا يتضح لنا اهتمام واضح باللغة العربية في الكتاتيب القرآنية رغم تقليدية الطرق وتهميش لها في رياض الأطفال بتكريس الازدواجية اللغوية وتعميق النفور من لغة الأمة ودعم الانبتات والفصل بينها وبين القرآن الكريم الذي
صان اللغة العربية عبر الأحقاب.
هذا واقع تعليم اللغة العربية في المرحلة ما قبل المدرسية، أما في مدارس التعليم الإبتدائي وهو البيئة الأولى لتمكين الأطفال من تعليم لغة الام فيعاني من عوائق شتى :
- “فرض تعليم لغة اجنبية منذ الصفوف الاولى بالتعليم الأساسي (بالسنة الثالثة أو الرابعة وحتى الأولى في المدارس الخاصة) بدعوى مواكبة العولمةأأا والتفتح على الآخر.”
- ضعف واضح في إعداد معلمي اللغة العربية قبل الخدمة وأثناءها.
- ضعف في كفاية تعليمها في هذه المرحلة مادام عدد هائل من الأطفال ينهون هذه المرحلة الأساسية وهم عاجزون عن القراءة والكتابة والبعض منهم يتردى من جديد إلى الأمية.
- وليس حظ اللغة العربية في المدارس الإعدادية والثانوية أفضل من واقع تدريسها في الإبتدائي، فمناهجهما نجحت إلى حد كبير في تنفير التلاميذ منها من خلال الطرائق والاساليب التلقينية التي تشكل عائقا أمام إنماء مهارات التفكير وترسيخ ثوابت الهوية العربية الإسلامية وتجديدها.
هذا بالنسبة لواقع تعليم اللغة العربية في كل من المرحلة الأولية والأساسية والمرحلة الإعدادية والثانوية، أما بالنسبة للواقع اللغوي في التعليم العالي فماهو إلا امتداد طبيعي لسيئات واقع اللغة العربية في المراحل المشار إليها سابقا.
إن المتأمل في ذلك تستوقفه أعراض عديدة أهمها:
- “تعليم معظم المواد في عديد الكليات والمعاهد العليا باللغة الأجنبية (الأنجليزية والفرنسية) رغم نجاح بعض الدول (سوريا مثلا) في تعريب التعليم الجامعي.
- العدول عن تعليم اللغة العربية في بعض الجامعات بدعوى تفرغ التعليم الجامعي للتخصصات.”[18]
هكذا إذن تأكد الباحثون من وجود فجوة لغوية على المستوى الثقافي والمدرسي فاللغة العربية تشكو من الازدواجية والثنائية اللغوية الجادة بين لغة المستعمر واللغة الفصحى وبين الفصحى والعامية وبين لغة الأم ولغة أجنبية وهذا ما ذهبنا إليه في المبحث الأول من البحث من وجود مخطط جهنمي استعماري جديد لتقطيع أوصال هذه الأمة ومسخ هويتها زادته دعما دعوات التّبع من أبناء الأمة مؤيدي الهيمنة العلمية والفكرية علينا.
إذا كان التعليم والتربية يضطلعان بدور خطير وحاسم في ترسيخ القيم والخصوصيات الحضارية للشعوب، فإن الاستعمار في العالم العربي والإسلامي قد سعى بكل الوسائل إلى تغيير بنية التعليم والتربية كجزء من مخطط واسع للفصل بين الإنسان ومقوماته الحضارية بهذه الدول . فالنموذج الفرنسي بالمغرب العربي مثلا أثر تأثيرا مباشرا وغير مباشر في صياغة مشاريع إصلاح التعليم و في تشكيل المنظومة الفكرية والثقافية به، وبالتالي في تشكيل منظومة القيم. لذلك كانت اللغة الفرنسية العامل الحاسم في التواصل، ونقل الثقافة؛ فشجعت التلقين باللغة الفرنسية، وحسرت مساحة التلقين باللغة العربية، وعدم اعتبارها لغة علم قصد إضعاف الروابط القوية القائمة يبن اللغة العربية والدين باعتبارها لغة القرآن، ولغة مصادر التراث والثقافة الإسلامية.
وللأسف الشديد لا زلنا إلى الآن تبذل جهود كبيرة؛ لتمكين اللغة الفرنسية و دعم تدريس اللغة الفرنسية، في دور الحضانة، ورياض الأطفال، و في كثير من مؤسسات التعليم الخاص والعام رغم التراجع الكبير الذي تعرفه مكانة اللغة الفرنسية في قائمة اللغات الحية العالمية، ورغم القرارات الإدارية الرسمية الداعية إلى اعتماد اللغة العربية في جميع مرافق الدولة مما يرشح استمرار داء الازدواجية.
وفي هذا المستوى من التوصيف لحال اللغة العربية في مهدها ونظرا لأدوارها المتمثلة بالأساس في تحويّل الأفراد من جماعة بشرية إلى مجموعة ثقافية مترابطة، وربطهم بالعقيدة الإسلامية والتراث العربي الإسلامي، وجب أن يكون التجانسُ الثقافيُّ اللغويُّ هدفاً استراتيجياً للناطقين بالضاد على اختلاف أجناسهم، وحارساً أميناً على قوام الشخصية العربية المسلمة.
لذلك نادت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة والبنك الإسلامي للتنمية في الرباط في الفترة من 25 إلى27 شعبان 1423، الموافق لـ 1 و3 نوفمبر 2002م، بتوصيات كان من أهمها ما يلي :
أولاً:” تعزيز الثقة باللغة العربية، والاعتزاز بها حفاظاً على كيان الأمة،وترسيخاً لشخصيتها ووجودها. واعتبار التفريط في اللسان العربي القرآني تفريطاً في الهوية والذاتية الثقافية للأمة، ويتصل بذلك تقدير التراث العربي الإسلامي والعناية به وإبراز دوره في الحضارة الإنسانية من خلال أمثلة واقعية.”
ثانياً :” التوسع في نشر اللغة العربية بمختلف الوسائل، وتقدير ودعم كل الجهود التي تبذل في هذا السبيل على مستوى الدول والمنظمات والمجامع والأفراد، وتهيئة الفرص للمزيد من العناية بنشر لغة الضاد وثقافتها وحضارتها، وتمتين الصلة بين الجهات المعنية بهذا الدور وطنياً وإقليمياً وعالمياً، من أجل تطوير الكيف والكم في نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية.
ثالثا : التأكيد على اشتمال أي خطة لدعم تعليم اللغة العربية على ما يلي :
1. “مناهج متقنة ووسائل تعليمية متطورة لمراحل التعليم المختلفة، ولغير المتخصصين، وغير الناطقين باللغة العربية، تراعي الفروق الفردية، وتستجيب إلى حاجة المتعلم، وتستفيد من إمكانات العصر الحديث وتقنياته المتنوعة.
2. “توجيه المنظمات والدول والمجامع اللغوية إلى تشجيع إجراء مسابقات وطنية وإقليمية لتأليف كتب منفذة لتلك البرامج والمناهج، وتكريم مؤلفي الأعمال القيمة، وإجراء تقويم مستمر لتطوير حركة التأليف في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار تحسين هذه العملية ومقارنتها بالمؤلفات المماثلة لخدمة اللغات الحية الأخرى، بقصد الاستفادة من تجاربها والاستئناس بخبرات واضعيها.
3. المراعاة في هذه المؤلفات للجوانب النفسية، والتربوية، والثقافية واللغوية للمتلقي، بحيث تتناسب مع سنه، وبيئته، وخلفيته الثقافية، وقدراته العقلية، وتعمل على تنمية مهاراته بالطرق العلمية والتربوية.”
4. “الاستعانة في إعداد المناهج والكتب المنفذة لها بنتائج الدراسات اللغوية الحديثة، وأن يُلتفت إلى المشكلات اللغوية القائمة والمتوقعة، مع الاستفادة من الدراسات والبحوث السابقة في هذا الشأن.
5. إنشاء مكتبة خاصة بكتاب تعليم اللغة العربية ومنهجيته ووسائله المعينة واستراتيجياته على جميع الأصعدة، وتكليف الجهات المختصة بإيداع كل كتاب يتضمن تجربة مماثلة في هذه المكتبة، مع تجارب الأمم الأخرى في خدمة لغاتهم، وتيسير السبل لجعل هذه المكتبة مركزاً بحثياً يُطوِّر فيه المختصون أبحاثهم ودراساتهم ويرجعون إلى مصادره من أجل مستقبل أفضل وتقييم مستمر لخدمة تعليم اللغة العربية.”
رابعا” انتقاء مدرس اللغة العربية وإعداد ه إعداداً خلقياً وعلمياً و ومهنياً جيداً وتكريمه وتشجيعه مادياً ومعنوياً حتى يعطي وينجز، وتجنى ثمار عطائه وإنجازه، وأن يمنح الرعاية الوظيفية التي تجعله قادراً على أداء واجبه في خدمة اللغة العربية وثقافتها وقيمها وحضارتها”.
ويشمل التكوين البيداغوجي و العلمي كلَّ ما يسهم في تنمية قدراته ومهاراته ويجعله قادراً على التأثير بفاعلية في هذا المجال الحيوي، مع تمكينه من التكوين المهني المتجدد والحرص على التكوين الأصيل في علوم اللغة العربية والثقافة الإسلامية وآداب اللغة.
سادساً :” ضرورة الاستعانة في تدريس اللغة العربية التكنولوجيا الحديثة، بمختبرات اللغة وأجهزة الاستماع، والأشرطة المرئية، والشرائح المصورة، وأقراص الحاسوب والاستفادة من التقنيات الفضائية لنشر العربية عبر برامج التعليم عن بعد، والاستفادة من تجارب الآخرين في كل هذه المجالات لمعرفة استراتيجيات التدريس ومداخله وأساليبه وتقنياته.”
سابعاً :” الاهتمام ببرامج تعليم العربية لغير الناطقين بها، المقروءة منها والمسموعة والمرئية، ودراسة اهتمامات غير الناطقين وأغراضهم من الاطلاع على اللغة والثقافة العربية الإسلامية، ومراجعة المحتوى الثقافي الذي تقدمه مناهج وكتب تعليم اللغة العربية إلى هذه الشريحة بما يغني حاجتها ويُحقق أغراضها التي لا تتعارض مع قيم الثقافة الإسلامية وأبعادها العقدية والشرعية والأخلاقية.
ثامناً :” الاهتمام بطرق التدريس التي تركز على المتعلم وتجعله محور العملية التعليمية، وتراعي الفروق الفردية والفئات الخاصة.
تاسعا:” ضرورة احترام الوضع الدستوري الذي تحظى به اللغة العربية في الدول العربية ويجعلها لغةً رسميةً تمثل ذاتية الأمة وترمز إلى سيادتها، وتأكيد أهمية تطبيق ذلك على الواقع الملموس في جوانب الحياة المختلفة”.
عاشرا :” استحداث مراكز الجودة و التطوير للغة العربية أسوة بمراكز تطوير اللغات الحية في العالم، وذلك لتلبية الحاجة إلى تطوير أساليب تعليم لغة الضاد وإيجاد مداخل تدريسية علمية جديدة، وإجراء دراسات مشتركة لتعليم اللغة بين اللغويين والتربويين”
هذه مقترحات يمكن الاستئناس بها لتفعيل أهم مقومات هويتنا العربية الإسلامية والتأسيس لمشروع تربوي أصيل ينشد العزة لأمة القرآن الكريم و الكرامة لأتباع النبي المصطفى .
لذلك نادت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة والبنك الإسلامي للتنمية في الرباط في الفترة من 25 إلى27 شعبان 1423، الموافق لـ 1 و 3 نوفمبر 2002م، بتوصيات كان من أهمها ما يلي :
أولاً:” تعزيز الثقة باللغة العربية، والاعتزاز بها حفاظاً على كيان الأمة،وترسيخاً لشخصيتها ووجودها. واعتبار التفريط في اللسان العربي القرآني تفريطاً في الهوية والذاتية الثقافية للأمة، ويتصل بذلك تقدير التراث العربي الإسلامي والعناية به وإبراز دوره في الحضارة الإنسانية من خلال أمثلة واقعية”.
ثانياً :” التوسع في نشر اللغة العربية بمختلف الوسائل، وتقدير ودعم كل الجهود التي تبذل في هذا السبيل على مستوى الدول والمنظمات والمجامع والأفراد، وتهيئة الفرص للمزيد من العناية بنشر لغة الضاد وثقافتها وحضارتها، وتمتين الصلة بين الجهات المعنية بهذا الدور وطنياً وإقليمياً وعالمياً، من أجل تطوير الكيف والكم في نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية.
ثالثاً : أن تتولى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو)، ومجامع اللغة العربية إعداد استراتيجية لنشر تعليم اللغة العربية وخطة شاملة للعناية بها في المناهج الدراسية والكتب المنفذة لها، والوسائل المعينة على نشرها في مختلف المستويات، على أن تسعى هذه الجهات إلى الحصول على الدعم المادي والمعنوي من الدول العربية والإسلامية وجهات التمويل المعنية بتفعيل برامج هذا المشروع.
رابعاً : التأكيد على اشتمال أي خطة لدعم تعليم اللغة العربية على ما يلي :
1. ” مناهج متقنة ووسائل تعليمية متطورة لمراحل التعليم المختلفة، ولغير المتخصصين، وغير الناطقين باللغة العربية، تراعي الفروق الفردية، وتستجيب إلى حاجة المتعلم، وتستفيد من إمكانات العصر الحديث وتقنياته المتنوعة.
2. ” توجيه المنظمات والدول والمجامع اللغوية إلى تشجيع إجراء مسابقات وطنية وإقليمية لتأليف كتب منفذة لتلك البرامج والمناهج، وتكريم مؤلفي الأعمال القيمة، وإجراء تقويم مستمر لتطوير حركة التأليف في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار تحسين هذه العملية ومقارنتها بالمؤلفات المماثلة لخدمة اللغات الحية الأخرى، بقصد الاستفادة من تجاربها والاستئناس بخبرات واضعيها.
3. المراعاة في هذه المؤلفات للجوانب النفسية، والتربوية، والثقافية واللغوية للمتلقي، بحيث تتناسب مع سنه، وبيئته، وخلفيته الثقافية، وقدراته العقلية، وتعمل على تنمية مهاراته بالطرق العلمية والتربوية”.
4. ” الاستعانة في إعداد المناهج والكتب المنفذة لها بنتائج الدراسات اللغوية الحديثة، وأن يُلتفت إلى المشكلات اللغوية القائمة والمتوقعة، مع الاستفادة من الدراسات والبحوث السابقة في هذا الشأن.
5. إنشاء مكتبة خاصة بكتاب تعليم اللغة العربية ومنهجيته ووسائله المعينة واستراتيجياته على جميع الأصعدة، وتكليف الجهات المختصة بإيداع كل كتاب يتضمن تجربة مماثلة في هذه المكتبة، مع تجارب الأمم الأخرى في خدمة لغاتهم، وتيسير السبل لجعل هذه المكتبة مركزاً بحثياً يُطوِّر فيه المختصون أبحاثهم ودراساتهم ويرجعون إلى مصادره من أجل مستقبل أفضل وتقييم مستمر لخدمة تعليم اللغة العربية”.
خامساً : إعداد مدرس اللغة العربية إعداداً علمياً وخلقياً ومهنياً جيداً وتكريمه وتشجيعه مادياً ومعنوياً حتى يعطي وينجز، وتجنى ثمار عطائه وإنجازه، وأن يمنح الرعاية الوظيفية التي تجعله قادراً على أداء واجبه في خدمة اللغة العربية وثقافتها وقيمها وحضارتها.
ويشمل التكوين العلمي و البيداغوجي كلَّ ما يسهم في تنمية قدراته ومهاراته ويجعله قادراً على التأثير بفاعلية في هذا المجال الحيوي، مع تمكينه من التكوين المهني وفق آخر ما وصلت إليه التقنية الحديثة في مجالات التعليم، والاتصال، والتربية، وعلم النفس، والحرص على التكوين الأصيل في علوم اللغة العربية والثقافة الإسلامية وآداب اللغة.
سادساً :” ضرورة الاستعانة في تدريس اللغة العربية بالوسائل السمعية والبصرية الحديثة، لمختبرات اللغة وأجهزة الاستماع، والأشرطة المرئية، والشرائح المصورة، وأقراص الحاسوب والاستفادة من التقنيات الفضائية لنشر العربية عبر برامج التعليم عن بعد، والاستفادة من تجارب الآخرين في كل هذه المجالات لمعرفة استراتيجيات التدريس ومداخله وأساليبه وتقنياته”.
سابعاً :” الاهتمام ببرامج تعليم العربية لغير الناطقين بها، المقروءة منها والمسموعة والمرئية، ودراسة اهتمامات غير الناطقين وأغراضهم من الاطلاع على اللغة والثقافة العربية الإسلامية، ومراجعة المحتوى الثقافي الذي تقدمه مناهج وكتب تعليم اللغة العربية إلى هذه الشريحة بما يغني حاجتها ويُحقق أغراضها التي لا تتعارض مع قيم الثقافة الإسلامية وأبعادها العقدية والشرعية والأخلاقية.
ثامناً :” الاهتمام بطرق التدريس التي تركز على المتعلم وتجعله محور العملية التعليمية، وتراعي الفروق الفردية والفئات الخاصة.
تاسعا:” ضرورة احترام الوضع الدستوري الذي تحظى به اللغة العربية في الدول العربية ويجعلها لغةً رسميةً تمثل ذاتية الأمة وترمز إلى سيادتها، وتأكيد أهمية تطبيق ذلك على الواقع الملموس في جوانب الحياة المختلفة”.
عاشرا :” استحداث مراكز لتطوير اللغة العربية أسوة بمراكز تطوير اللغات الحية في العالم، وذلك لتلبية الحاجة إلى تطوير أساليب تعليم لغة الضاد وإيجاد مداخل تدريسية علمية جديدة، وإجراء دراسات مشتركة لتعليم اللغة بين اللغويين والتربويين”
هذه مقترحات يمكن الاستئناس بها لتفعيل أهم مقومات هويتنا العربية الإسلامية والتأسيس لمشروع تربوي أصيل ينشد العزة لأمة القرآن الكريم وأتباع النبي المصطفى .
ثالثا:أزمة التعليم الديني:
يشير (خالد الصمدي،2008) إلى وجود أزمة في التعليم الديني في العالم العربي والإسلامي، ويؤكد على ما يتمتع به التعليم الديني من سمات ثقافية وتربوية معطلة خاصة بعد فصل العلوم التجريبيةو الاجتماعية والإنسانية عن علوم الشريعة واللغة العربية في كبريات الجامعات الإسلامية.
ويرى الصمدي اندراج أزمة التعليم الديني ضمن أزمة السياسة التربوية واستراتيجياتها في العالم الإسلامي ويطرح عدة تساؤلات إشكالية حول ماهية الأزمة وراهنيتها وسبب اهتمام الغرب المفاجئ بها خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر2001م.
رافق التعليم الديني ظهور ما يسمى بالتعليم العصري بداية فترة الاستعمار الذي جثم على دول العرب والمسلمين وظلت مهمته متمحورة على علوم الشريعة واللغة فقط بعد أن كانت جميع العلوم مدمجة فيها. ظهر إلى جانب ذلك إدماج لمادة ضمن المنهاج العام ، وبقي إدماج القيم الدينية في المناهج التعليميةوقضايا التكوين والتعليم مطمحاً يصطدم بعقبات فكرية أهمها معارضة الداعين إلى علمنة التعليم.
ويمكن القول هنا وللأسف الشديد أن جل بلدان العالم العربي والإسلامي وإلى الآن لا زالت تفتقر إلى رؤية استراتيجية واضحة لنظام التعليم الديني بسبب التبعية السياسية والثقافية ومما يؤف له أيض أن النظام التربوي الإسلامي يعاني تصدع بين الغايات التربوية والقيمية والغايات المعرفية في منظومتهو أصبحت بذلك الغايات المعرفية الصرفة هاجس المدرس وانزوت الغايات التربوية والقيمية وتراجعت وضعف تأثير الأستاذو تفاقمت السلوكات اللاأخلاقية و اللامدنية(مقتطف من حوار أجرته معه مجلة “تربيتنا المغربية سنة2009م).
ينتقد جل الباحثين المهتمين بالشأن التربوي التلقين والحفظ والممارسات التربوية والمناهج التعليمية الخاصة بتدريس علوم الشريعة على المستوى التطبيقي والتخلي عن أسلوب التأمل والتحليل ، وضمورالبناء المعرفي. كما يؤكد جلهم على حالة الجمود وانكفاء الاجتهاد والتجديد للمناهج وطرائق التدريس.
من نتائج التشخيص النسقي للمعضلة التربوية في العالم العربي والإسلامي:
مكننا تحليل مظاهر الإعضال التربوي بالعالم العربي والإسلامي من التعرف على العديد منها فحاولنا صياغة فرضيات فرعية تفسرها فكان منها ماهو مرتبط بالمنظومة ذاتها(تذبذب الفلسفة و المناهج التكوينية و التعليمية وتسلط التلقين و التمرير وغياب الطرائق المنشطة للفكر…) و ما خرج عنها(تغريب وعولمة و..)مما جعلنا نفترض أن غياب الأصالة و التأصيل للنظم التربوية العربية و الإسلامية هو الذي أذاب مقومات هويتنا (المعرفية و القيمية) وأصاب لغتها العربية وأخلاق أبنائها وسماتها الحضارية الفذة.
وبناء على ما تقدم سعينا لصوغ فرضية رئيسة افترضنا فيها أن غياب الأصالة كان سببا مفسرا للتردي و التخلف الخانق للمقومات المعرفية والقيمية الدينية والمدنية. هذا ما توصل إليه العديد من الباحثين المسكونين بهاجس الإصلاح والنهضة الحضارية لهذه الأمة المحمدية وهذا ما توصل إليه على سبيل المثال الباحث بالجامعة الماليزية( الجيلاني بن التوهامي مفتاح، 2008) من تشابه كبيرا يصل إلى حدّ التطابق بين أعراض أزمة المسلمين في عصر ابن خلدون وبين أعراض أزمتنا الراهنة.” فالأزمتان تشتركان في مرض واحد وهو فساد إنسانية الإنسان وضياع قيمته بما ناله من أذى الحبس والقتل والتشريد والعسف والقهر والإذلال. فهذا المناخ التربوي الموبوء قد أدّى في كلتا الحالين إلى سلسلة من النتائج المترتّب بعضها على بعض؛ ففساد إنسانيّة الإنسان أدّى إلى انتشار العجز والكسل والبطالة والتواكل والغش والكذب والنفاق الاجتماعي”، وهو ما أدّى إلى تفكّك المجتمع واختلال العمران وانتشار الفقر والبطالة والصراعات الداخليّة و إلى فتح الباب على مصراعيه للقوى الخارجيّة للاستهتار بنا قديما وحديثا والتدخّل في شؤوننا واستغلالنا وإذلالنا فالأندلس مثال للماضي، وفلسطين والعراق وأفغانستان أمثلة للحاضر. فطبيعة المعضلة في عمقها هي معضلة تربوية و الأزمة تتلخّص في فساد التربية، وجذورها تعود إلى التسلط و التحجروالجمود و فساد المؤسسة السياسيّة المنحرفة عن الأصول و مقوما ت الأصالة المعرفية و القيمية.
وفي هذا المستوى من التحليل يمكننا القول أن حلّ هذه المعضلة يتوقف أوّلا وقبل كلّ شيء على شموليّة التصوّر التربوي لنوعية الإنسان المراد بناؤه ومراعاة كل الأبعاد الرّوحية والخلقيّة ولماديّة والحضارية.
وعليه فإننا نفترض أن تأصيلا استخلافيا و بنائيا للمناهج ولنماذج الإشراف والتكوين والتعليم والتجديد والرصد والتقويم في كل مراحله من الروضة القرآنية إلى الجامعة كفيل بإذن الله بأن يخرج الشخصية الرسالية الموحدة والمؤمنة بربها والواعية بالاستخلاف في الأرض والبانية للفكر و المعمرة للكون.
البنية النظرية التربوية للمشروع بين الأصالة والتأصيل:
يعد تراجع الأداء المعرفي والقيمي، الديني والمدني للنظم التربوية العربية أمرا خطيرا ويبعث على التأمل العميق والبحث
العلمي الممنهج في الأسباب والفرضيات التفسيرية. “ولكن ما يطمْئن في المقابل هو أن هذا المشكل على خطورته لا يمكن اعتباره معضلة ميئوس منها، إذ قد لا يعدو الأمر أن يكون وضعا عارضا ألمّ بالأمة حتى وإن طال مكوثه فينا”(مصدق الجليدي،2009). والذي يدفعنا إلى مثل هذا القول ما أوضحته التجربة العلمية والحضارية الإسلامية الرائدة تاريخيا، والتي تدلّ على أن” الخلل الحاصل في أدائنا العلمي والحضاري الراهن لا يمس في شيء روح الثقافة الإسلامية التي تولدت عنها أصالتنا التربوية والتي كانت مصدر إلهام وإبداع عظيمين طوال قرون مديدة من تاريخ أمتنا ما دام في حافظتها (القرآن الكريم والسنة النبوية والذاكرة الثقافية الجماعية النيرة) مثال أسمى عن معنى التربية الأصيلة المتمحورة أساسا على فكرة الاستخلاف في الأرض وعلى قيم الفعالية والإبداع والإصلاح والإعمار وحفظ الأمانة التي عرضها الله عز وجل على مخلوقاته فحملها الإنسان.
ومن هنا يتجه تفكيرنا إلى البحث بإيجابية وبتفاؤل كبير عن شروط استئناف فعلنا الحضاري وريادتنا العلمية. إن الخروج من هذا الإعضال التربوي في العالم العربي والإسلامي لا يكون إلا بالعودة المتأنية والمتأملة إلى أصالتنا و ربط التربية و التعليم في العالم العربي والإسلامي بالبيئة العربية الإسلامية، أي ثقافة الأمة و صبغتها خاصة إذا علمنا أن التربية الإسلامية ترتبط مع نمط متكامل من التوجيهات يمكن تلخيصها فيما يلي :
- “الإيمان أو ما يمكننا أن نسميه تربويا الارتباط بالرقابة الذاتية النابعة من الجانب العقائدي الذي يربط الأرض بالسماء، وعمل الإنسان بفلسفة الجزاء “الثواب والعقاب “الشيء الذي تعجز عنه القوانين الوضعية لارتباطها بالرقابة الخارجية وتوفر أدلة الإثبات.
- الربط بين مبدأ التربية ومبدأ الاستخلاف﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ (النور: 55)،﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَة﴾ (البقرة : 30) وهذا الربط يشكل جوهر المنظور الحضاري في التصور الإسلامي.
- التوازن والتكامل بين الجوانب العقلية والمادية والنفسية والروحية ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (القصص:77) (خالد الصمدي ،2004).
وبهذا تكون العقيدة الإسلامية الخلفية الأساسية للقيم ، والعنصر المحرك والمؤثر في السلوك العملي
“فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل” الرسول (ص) والأنبياء كانوا نماذج حية لتوظيف العقيدة الإسلامية في إصلاح ما فسد من أحوال اجتماعية اقتصادية وسياسية وتقديم تنمية بديلة.
ومن هنا يأتي قولنا بأن القيمة المضافة الأساسية المرتقبة من النظام التربوي المنشود هي إعادة التوازن إلى تكوين الإنسان الخليفة ومدّه بأسباب حفظ ذلك التوازن والمرور به إلى درجات أرقى فأرقى، وهو ما يعني تنميته تنمية شاملة متوازنة ومستديمة، انطلاقا من قاعدة الإصلاح الأولى و أول تكليف نزل على رسول الله ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (العلق: 1-2-3-4-5) ومن هذه الآيات التي صنع بها النبي• نواة مجتمع حضاري حوَّل مجرى التاريخ في منطقة لا تمتلك أنموذجاً للحضارة .
تعد تنمية الإنسان في أبعاده المختلفة: “الروحي والبيولوجي والعقلي المعرفي والانفعالي العاطفي والسلوكي الأخلاقي والنزوعي والاجتماعي وتربيته انطلاقا من الإيمان بالله ووحدانيته و في مجتمع متضامن قائم على قيم ثابتة خير ضمان بإذن الله لهداية الإنسان إلى الطريق المستقيم ونهج الخير والأمان والسلام”﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، َهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (المائدة : 15 – 16).
وهنا يتأكد علينا التذكير بخصائص التصور الأصيلوالتي منها:
-الربانية ومنها تنبثق بقية التصورات
-الثبات.
-الشمول
-التوازن، أي عدم الإفراط في جانب مع تجاهل الجوانب الأخرى أي التوازن بين عبودية الإنسان المطلقة لله وتوحيده ومقام الإنسان الكريم في الكون إضلفة إلى توازن بين مصادر المعرفة… بين ما هو غيب وما هو مشهود بين الوحي والنص وبين الكون والحياة.
-إيجابية الإنسان.
اتصف أسلافنا بهذه الصفات فنجحوا في ريادة التاريخ وكانت النتيجة تأصيلاً رائداً أنتج حضارة مشهودة. ونحن هنا في هذا المشروع الجديد نريد أن ننتقل إلى جانب من الجوانب التي ارتأينا أن التأصيل فيها ضروري و هو مجال التربية والتعليم في العالم العربي والإسلامي بعد أن تبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أنه يعيش معضلة خانقة.
إن المطلوب منا إذن هو تأصيل الفلسفة التربوية والمنهاج وتأصيل التعليم و التكوين ومحتويياتها لتكون في علوما نافعة وقيما أصيلة تنمي الاستخلاف البناء.
إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المستوى من صوغ فرضية المشروع و الذي يحتاج إلى إجابة ولو أولية هو كيف يتم هذا التأصيل للمادتين النظرية والتطبيقية اللتين يحتاجهما كل من التعليم و التربية والتكوين والبحث و التجديد الأصيل؟
إن هذا الإطار النظري حينما يترجم إلى تطبيقات ميدانية في بناء مناهج التعليم؛ ومنفتحة على تجارب الفكر الإنساني ، سيؤدي لا محالة إلى تجديد تربية تصوراتنا، وتغيير ما ترسب فينا من انبتات عن القيم الأخلاقية والمعاني الغيبية بسبب تأثير النمط المعرفي الحديث. ومن سيؤدي بحول الله وعونه إلى تجديد التربية برجوعها إلى حضن القيم الفطرية: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِـخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾ (الروم: 30).
نؤكد مرة أخرى أنه “بقدر ما تتصف الفلسفة التربوية لمؤسسات التربية الأصيلة بالشمول والتكامل والوضوح والقابلية للتطبيق، وتنأى عن الغموض والتناقض بين أفكارها وقيمها بقدر ما تصبح قادرة على تمثل الصفات والخصائص في معالجة القضايا التربوية المختلفة وحضور السمات الفذة لحضارة متجددة وبالتالي العمل على تفعيلها وتنزيلها في أرض الواقع.”
واتساقاً مع ما سبق، “فإن حضور السمات الفذة في تراثنا لا تتأتى من محض التلاؤم مع ماديات الحياة الحديثة، وإنما يتحدد بموجب ما أسس من ثوابت وأصول في الحضارة الإسلامية. “فالتجدد الحضاري ليس وليد التطور المادي وحده، ولكنه نتاج تفاعل الحضارة القائمة مع هذا التطور. إن التجدد الحضاري ، إذ يستجيب للمستحدثات الطارئة، ما هو إلا نوع من الاستجابة تصدر عن الأطر المرجعية المعبرة عن أوضاع الحضارة السائدة لدى الجماعة، بما استقر لديها من عقائد وبما اختزنته من مواريث التجربة التاريخية لها، وبما يصدر عن ذلك موافقاً للأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية للجماعة المعنية، ومستجيباً لما تواجهه من تحديات وما تتطلع إليه”.)أبو بكر محمد أحمد محمد إبراهيم،2009)
مقترحات وتمفصلات نظرية تطبيقية:
على مستوى المدخلات:
ومحاولة منا لتمثل أفضل لإضافات البحث النظرية و الإجرائية لاحتياجات المشروع و غاياته و قصد الإسهام بشكل واضح في بناء كل من النظرية والنموذج التطبيقي نقترح جملة من المقترحات لعلها تنير سبيل المنظرين و الإجرائين وتساعدهم على إيجاد أجوبة على ما قد يعترضهم من صعوبات و عوائق:
الفلسفة التربوية للمشروع:
– القرآن الكريم وروح الثقافة الإسلامية يحتويان على رؤية تكاملية للإنسان ولفعله الحضاري وهذه الرؤية تشتمل على معاني البناء والفعالية والإبداع و الإصلاح في الأرض وحفظ للأمانة التي عرضت على السماوات و الأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان هذه هي الرؤية التي يجدر اعتمادها في رسم ملامح نظام تربوي أصيل
– ينبثق مشروع التربية الأصيلة من تصور لحقيقة ذلك الإنسان وطبيعته ومن تصور لحقيقة الكون الذي يكتنفه والغاية التي وجد لأجلها ومن الوظيفة التي خلق لأدائها والمآل الذي يصير إليه أي من سياق فلسفة شاملة تعكس موقفا واضحا محددا من الوجود بكل مكوناته.
إزالة الحواجز بين المعرفتين الانسانية والاسلامية وتمكين الطلبة من الالمام بهما معا
– التأصيل الاسلامي للمعرفة الانسانية في ضوء تأسيسات ومعطيات القرآن والسنة والعناصر الفاعلة من التراث إرساء توجه الانفتاح على علوم و خبرات غير المسلمين التي لا تتعارض مع قيم الأمانة و الاستخلاف
– تعزيز القيم الروحية المستقاة من أصولنا (القرآن و السنة) و دعم الهوية العربية الإسلامية والانتماء فلسفة وممارسة من خلال المناهج والمقررات و الكتب وتمشيات تعليم اللغة العربية والتفكير الإسلامي
-تربية الطلاب في كل مراحل التعليم على العمل الصالح و التواصي بالحق(الاجتهاد العام لتحقيق شروط الاستخلاف المعرفي) والتواصي بالصبر لتحقيق شروطه الخلقية (مصدق الجليدي،2009) و(أبو يعرب المرزوقي،2005).
– تأسيس نظرية تربوية مركزية للتربية والتعليم تعطي عملية تأصيل المناهج الصيغة الإسلامية بربط المواد الدراسية بمبادئ الإسلام مثل القيم الخلقية والدينية وربط هذا كله بحياة الطالب في مجتمعه وهو ما يستوجب صياغة الأهداف بطريقة تضع في الاعتبار تربية الطالب ليكون عاملاً ومشاركاً في بناء مجتمعه بصورة جادة ونشطه ، ويتمكن من أداء دوره بإيجابية وفعالية” ذلك ما أفادنا به ( عماد الدين خليل، 2009) في الاستفتاء الذي وجهناه إليه في إطار هذا المشروع.
– السعي لتحقيق الالتحام الضروري في مناهجها بين المعرفتين الانسانية والاسلامية.
– ينبغي لمخططي المناهج أن يأخذوا بعين الاعتبار بعض العوامل الأساسية في إطار البنية العريضة للوظائف الاجتماعية إذا ما أرادوا أن يكون المنهاج المخطط مناسبا ومفيدا.”
– انطلاقا من ذلك يمكننا أن نلخص أسس بناء المناهج الدراسية في:
- أسس عقائدية وإيمانية.
- أسس تربوية بيداغوجية.
- أسس اجتماعية.
- أسس نفسية.
- أسس معرفية.
- ففيما يتعلق “بالأسس العقائدية والإيمانية ينبغي استلهام المرجعية الإسلامية ونظرتها للكون والحياة بما تحمله من قيم ومثل تحكم علاقة الإنسان بخالقه ثم بنفسه ومجتمعه”.
– وينبغي أن تعتمد” أسس اجتماعية في بناء المنهاج أي الاستجابة للحاجات الاجتماعية المرتبطة بتنظيم العلاقات العامة داخل المحيط والاستفادة من ما يقدمه الواقع الاجتماعي المعاصر من إنجازات علمية وفكرية وتكنولوجية”،
– أما فيما يتعلق بالأسس التربوية والبيداغوجية فيحسن أن تعتمد المناهج أحدث النظريات التربوية المناسبة سواء في صياغة الكفايات ومكوناتها أو الأهداف العامة أو المميزةأو الإجرائية أو في بناء هياكل المواد الدراسية أو انتقاء المحتوى التعليمي للمواد أو صياغة طرق ووسائل التدريس أو اعتماد أساليب التقويم أو الأنشطة التربوية الموازية.
-ويعتمد المنهاج الدراسي أيضا على أسس نفسية تتوجه مباشرة إلى المتعلم فتراعي إحساسه ووجدانه وقدراته وتتكيف معها.
– أما الأسس المعرفية فتتمثل في مجمل المعارف التي تحملها المواد التعليمية بالإضافة إلى طرق البحث والتفكير في صعوبات التعلم ومراعاة الفئة العمرية المستهدفة واعتبار التنوع والتكامل والاستجابة لحاجات المتعلم والإجابة عن إشكالاته الذاتية أولا وتلك الناتجة عن تفاعله مع المحيط ثانيا.
وتشمل الأسس النفسية معرفة خصائص الطفل النمائية وحاجاته وطرق تعليمه وميوله واستعداداته في مختلف مراحل نموه، كما تشمل الأسس الاجتماعية معرفة طبيعة المجتمع الذي ينشئ المدارس ، وطبيعة إنتاجه الاقتصادي وتراثه الثقافي، وتغيراته الحضارية إضافة إلى مواكبة للتقدم العلمي والصناعي فيه.
والأسس الفلسفية وتشمل فلسفة المجمع في الحياة، ومثله وأهداف التربية فيه بكل مستوياتها وتصوراته لدور الإنسان في هذا المجتمع. والأسس المعرفية وتشمل البنية المفهومية للمادة وطرق البحث والتفكير فيها. “
لذلك نقترح قبل تنفيذ مشروعنا ما يلي:
- صياغة المناهج من قبل خبراء و مشرفين و موجهين و ممارسين للتدريس بعد استشارة عينات من الذين يطبق عليهم تولي أهمية للتفكير الناقد و مهارات الاتصال و التواصل اللغوي و تنمية الاتجاه العلمي و حل المشكلات.
- إعداد مناهج خاصة بكل مرحلة وبكل شريحة من شرائح المتعلمين و الطلبة (ذوي الحاجات الخصوصية من المعوقين والموهوبين) تأخذ بعين الاعتبار توازنا وتكاملا للمواد (الروحية والدينية والمدنية والعلمية والتكنولوجية المهنية واللغوية و الرياضة والبدنية) و شمولية التربية لكل أبعاد الشخصية والعمل على “تصميم مناهج جديدة لتدريس مادة حضارة الإسلام وتاريخه في المدارس والمعاهد والجامعات عساها تساعد على تخريج نخب متميزة تؤمن برسالتها الحضارية ودورها التاريخي وترى فيه امتدادا طبيعيا لما كان عليه أفذاذ هذه الأمة زمن تفوقهم “(عماد الدين خليل،2009).
- التخطيط لمناهج قبل مدرسية متوازنة ترغب في حفظ القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة تولي أهمية للجوانب و الوجدانية والحركية (اللعب).
– مراعاة المرونة في زمن مدرسي مستجيب لحاجات المتعلمين الفيزيولوجية والروحية(العبادة) والترفيهية (المساهمة في تنشيط الحياة الثقافية والرياضية والفنية الإبداعية و الخيرية للمدرسة).
– إعداد مناهج تولي أهمية لتنويع الطرائق التقويمية والتعليمية والتقنيات المساعدة على تحقيق الأهداف كالاستقلالية والتفكير النقدي وحل المشكلات والمستثمرة للذكاءات المتعددة و الذكاء العاطفي والانفعالي للمتعلم وإنماء قدرة المتعلمين على التحليل والتأمل في تمشياتهم ونقدها وممارسة التقييم التبادلي والذاتي البنائي والحوار المنظم والعمل التشاركي.
ملامح الإطار التربوي المنشود :
المعلم عنصر الفعل الأساسي في نجاح مشروع التربية الأصيلة حيث يشكل دور ه منظومة متكاملة ومركبة ،تتدخل فيه عوامل كثيرة وعناصر متعددة فهو مدعو في النظام التربوي الأصيل أن يلعب الأدوار التالية:
- أدوارا أكاديمية تتمثل في وظيفته وما تتطلبه من تكوين معرفي وعقلي ومنهجي وسلوكي، ومن تمهين و خبرات ومهارات في التصرف في المادة التعليمية وفي طرائق التدريس و الوساطة البيداغوجية والتقويم و التامل في الممارسات و التجديد. وفي استثمار الذكاء الانفعالي و المتعدد للمتعلمين في أي مرحلة من مراحل التعليم .
- أدوارا جتماعية فتتلخص في إسهامه في تطوير وعي المجتمع وتنميته من خلال المشاركة في الفعاليات الاجتماعية المختلفة والمتنوعة، والوعي بالرهانات الاجتماعية.
- أدوارا حضارية وثقافية تتمثل أساسا في:
- دور المربي الناقل لقيم حضارة وثقافة
- دور الإنسان الرسالي الحامل لقيم السلام والأمان والتسامح والحوار والتعارف العالم وأمام هذه الأدوار السامية والأصيلة والمتجددة على الدوام يتأكد ما يلي:
- انتقاء الأخيار من المعلمين الراغبين و المستعدين لحب الطفل و الإنسان و تكريس العدل والأمانة والاستخلاف الباني للسمات الحضارية الفذة و اختيار أصحاب القدرات العالية في التواصل اللغوي و الرقمي وفي بعض اللغات الأجنبية من المؤهلين لتحمل مسؤولية التربية و التعليم في المراحل المدعو للعمل بها.
- التأهيل و إعادة التأهيل لكل الكوادر الإدارية و التعليمية و التربوية للتطوير المتجدد لمهنيتهم حتى يطوروا استقلاليتهم و تأملهم المتجدد و التزامهم بالتجويد التعاوني و المتواصل للممارسات التربوية والإدارية و التصرف في الطرائق و الأساليب و الأجهزة البيداغوجية
الإشراف التربوي والخدمات :
- انتقاء المشرفين (المدير ،المرشد التربوي…) من المقتنعين بالتربية الأصيلة والاستخلاف الباني للسمات الفذة ومن ذوي القدرات التواصلية و البحثية والعلمية العالية والقادرين على التجديد و تأطيره و رعايته و الترويج له المؤمنين برسالة المدرسة الأصيلة والقادرين بيداغوجيا وإداريا على التواصل والتفاوض وأخذ القرار المناسب و تنشيط الحياة المدرسية بها.
الفضاءات التربوية و الرياضية و الثقافية
– إنشاء مؤسسات تعليمية من الروضة القرآنية إلى الكلية و المعهد العالي، جذابة ووظيفية بها قدر مقبول من الاستقلالية ميسرة للتنقل و القيام بكل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية الإبداعية .
– تهيئة فضاءاتالدراسة والراحة و(الحياة المدرسية ،المسجد والورشات العلمية والفنيةو المخابر المكتبات ومراكز التوثيق المبيت المطعم…) بشكل يسمح بالتلاقي والتعارف والتعاون بين كل الفاعلين فيه من متعلمين ومعلمين وأعوان الإدارة وأولياء الأمور إضافة إلى التفاعل الاجتماعي والثقافي من خلال أنشطة المرافقة ومبادرات الجمعيات على العمل الخيري وتحمل المسؤولية الفردية و الجماعية( الغرفة الصفية الإيجابية والدافئة الداعمة لنشاط الطلبة وذات المقاعد الفردية المتنقلة وفق طبيعة النشاط والهدف منه…).
– العمل بنظام المراوحة والترويح بين الدروس النظرية والتطبيقية والمهنية والتدريب المهني والتقني القائم على التقنيات العليا و التكنولوجيا الحديثة في تعلم الفنون و الصنائع و جعل البيئة معملا للمدرسة و ميدانا لتدريب الطلاب على الحياة.
الوسائل:
– وسائل النقل تقريب التربية قبل المدرسية بالرياض القرآنية وتوفير النقل الجماعي عند الضرورة و توفير الغذاء والوقاية الصحية المناسبة ومرافقة ذوي الحاجات الخصوصية منهم و توفير فضاءات التواصل و الحوار مع الأطفال وأولياء الأمور.
– توظيف الوسائل التكنولوجية وتقنيات الاتصال في تطوير تدريس اللغة العربية واللغات الأجنبية وفي الترغيب في القيم الأصيلة بانتقاء أجود المحتويات العلمية الأمينة
على مستوى التمشيات:
قبل بلورة النموذج التطبيقي لمشروع تربية أصيلة يتأكد النصح لله ولقادة هذا المشروع التربوي والتذكير بما يلي:
- ينبغي أن يكون هذا النظام التعليمي الأصيل متجددا على الدوام مستوعبا” لكل التحولات التي قد تتيح تفعيل القدرات البشرية والفكرية والمادية في خدمة التنمية الشاملة للمجتمع دون التأثر القاتل بالعولمة وتحدياتها وغرس في وعي مؤسساته وأفراده بالقيم والمهارات والخبرات والوعي اللازم لفهم العولمة “.
- تفعيل التعليم حضاريا و البحث في الرسالة الحضارية الكبرى للتعليم و” تجاوز غاية تخريج المعلمين والمهنيين الذين نحتاج إليهم في المجتمع إلى محاولة تشكيل الثقافة الحضارية للأمة وتخريج الفرد الحضاري القادر على تكسير قيود التخلف والانطواء والارتجال والفوضى والكسل وخلق شروط التحضر والتفاعل والانفتاح والتخطيط والتنظيم والاجتهاد والجد من أجل المشاركة في التنمية الحضارية المعاصرة”. فالأصالة سيرورة متجددة يشارك فيها السابقون و اللاحقون.
- فك القيود التي تجعل من التعليم عملا روتينيا رتيبا قاتلا وقد تجعله في بعض المجتمعات العربية من أسواء وأتفه وأفقر المهن.
– إعادة ثقة المجتمع بالتعليم باعتباره أكبر وأخطر الوسائل المعاصرة تأثيرا في صناعة الفكر والتقنية والتكنولوجية والقوة.
– إعادة النظر في دور المعلم ونقل ذلك الدور من مجرد نقل المعلومات وتلقين الدروس وتعليم المهارات والخبرات إلى الدور الحضاري المتفاعل والدور التربوي الذي ينقل فيه ثقافة وشخصية وإطارا أخلاقيا ونمطا سلوكيا.”(عبد العزيز برغوث،2009).
- تنويع الطرائق والتقنيات التعليمية (تعليم بالقدوة والمثال والحوار المنظم و الممارسة وحل المشكلات… )المطورة للقدرات الميتاعرفانية والمراعية للفروق الفردية بين المتعلمين وانتقاء المحفزة على التأمل والتفكير النقدي والتأمل الذاتي والتواصل والحوار المنظم والمساعدة على تعلم حل المشكلات ونقل أثر التعلم و التكيف الذكي مع الطارئ و المستجد منها و تجنب التعليم اللفظي والتلقيني.
- إرساء تقليد القراءة والمطالعة البانية للمعاني منذ المرحلة الأساسية بتوفير الفضاءات الجذابة و المريحة وانتقاء أجود النصوص وتثمين مجهود المجتهدين ومرافقة المتعثرين.
– تأسيس العلاقة التربوية بين كل الفاعلين على الاحترام المتبادل و توقير العلم و المعلم و رحمة المتعلمين وتحقيق الأهداف المنشود.
– توظيف المقاربة بالمشروع و التفتح على المحيط و البيئة وتأليف الكتب وتهيئة الفضاءات التربوية (استراتيجية تطوير التربية العربية (الاستراتيجية المحدثة لسنة 2006).
– تطوير النظام التربوي الأصيل وتجديده بصفة دائمة: في مستوى أساليب العمل، الهيكلة، البرامج الطرق البيداغوجية، المؤسسات الرافدة.
– التوزيع العادل والمنصف والمدروس للعمل التربوي و تحديد الأدوار(أولياء الأمور و أسرة المدرسة المجلس التربوي و مجلس المؤسسة).
– إيلاء العقل مكانته والتأكيد على التربية العلمية التجريبية وإنماء الاستقراء و الاستدلال و التأمل الميتاعرفاني لدى الطلاب انطلاقا من السؤال المحير والوضعيات-المشاكل والتوجيه لإنجاز المشاريع البحثية الدالة ومن الملاحظة والممارسة والنشاط الذاتي والفرقي وبصفة خاصة في حصص علم الأحياء والفيزياء والكيمياء والجغرافيا الطبيعية والتكنولوجيا والتربية المهنية .
– تحميل تلاميذ المدرسة مسؤولية المحافظة على مدرستهم بتمكينهم من المبادرة وتقديم الإضافة فيها ومشاركة المتعلمين في قرارات المدرسة و توجهاتها المستقبلية بإبداء آرائهم.
– تدريبهم على الاستقلالية و الاعتماد على الذات و تعليمهم القيم الجماعية والفردية و الخلق الحسن ودعوتهم للتفاعل مع الثقافات الأخرى لفهمها والاستفادة منها.
ومن هنا فمسألة التعمق في دور المعلم وموضوع فلسفة التعليم التي سيتبناها مشروع التربية الأصيلة بإذن الله وتوفيقه يعد من المهام الكبرى التي أوكلت للباحثين منا . لذلك يتأكد التعمق حول مسألة دور المعلم وضرورة التجديد في فلسفة التعليم خاصة بعد أن أبرز لنا التشخيص النسقي للمعضلة التربوية
– عجز الإنسان الذي تخرجه المؤسسات التربوية عن تحديد هويته بين بني الإنسان “
– عجزه عن تحديد منهاج حياته في ضوء المتغيرات المعاصرة التي تؤثر في واقعه، فهو مازال يستورد مناهج الحياة
– عجزه عن التفاعل مع ماضيه وتراثه –أي دراسته وهضمه وتطوير ما كان إيجابيا مفيدا في حاضره، بسبب غياب الأصالة والتأصيل للأدوار و المناهج التكوينية و التعليمية في جل المراحل من الروضة القرآنية إلى الجامعة.
التكوين العلمي والبيداغوجي
– تنظيم كل الأنشطة المدرسية لتكون في خدمة بيداغوجية تفريقية تراعي حاجات كل رواد المؤسسة (رعاية المعوقين و الاهتمام بالموهوبين).
– توعية أولياء الأمور عبر كل وسائل الاتصال بأهمية التربية قبل المدرسية بالروضة القرآنية.
المتابعة والتوجيه ورصد الجودة و الإتقان
- بعث هيكل يعنى برصد عمل المشروع وتقويمه منذ لحظة انطلاقه الفعلي بصفة منظومية (من مداخل متعددة) وبصفة منهجية (الاهتمام بكل الجوانب). ويمكن أن نسمي هذا الهيكل المرصد العام لعمل النظام التربوي القائم.
- نشر ثقافة تقييمية وتقويمية بنائية وتكوينية تكون في خدمة الرصد والمرافقة للعلاج والدعم وتطير الميتاعرفان والتعديل الذاتي.
البحث الميداني
بعث مخبر علم نفس تربوي أصيل وتوعز له مهمتان:
- تطوير نظرية نفس تربوية عامة جديدة، بالاعتماد على المعجمية القرآنية وعلى الملاحظات المنهجية والمقابلات والتجارب الميدانية وبالاستفادة من مجلوبات علم النفس الحديث.
- إجراء تجارب بيداغوجية ميدانية ذات مقاربة إدماجية بين المكونات العرفانية والوجدانية والنزوعية، هدفها تطوير الممارسة البيداغوجية.
التجديد التربوي
– تكوين فرق للتجديد البيداغوجي، في مختف المستويات التعليمية التي يركّزها المشروع، تقترح وتجرّب أفكارا تجديدية أصيلة، مستفيدة من أعمال مخبر علم النفس التربوي الأصيل ومنسقة معه، كما تقوم بتربصات وزيارات للاطلاع على تجارب بيداغوجية ناجحة في العالمين العربي والغربي من منظور فلسفة التربية الأصيلة بغية الاستئناس بها والاقتباس عنها بما يتلاءم مع مقاربة النظام التربوي الأصيل.
خاتمة:
لا مناص في نهاية هذا البحث التشخيصي ذي الطبيعته الإجرائية من التأمل ومدّ الخيط طوليا للإمساك بإضافاته والنظر إليها في الختام وهي متجاورة ومتقاربة في إطار كلي مصغر إذ إنّ ذلك من شأنه أن يساعد في استجماع الفكر وتركيزه وتوجيهه إلى ما يعتقد أنّه من احياجات المشروع المتأكدة و من المستوجبات التي حري بالساهرين الأخيار على التربية في عالمنا العربي و الإسلامي أن يأخذوه بعين الاعتبار.
لقد جاءت محاولتنا هذه بعدأن كتب الكثير عن الأزمة التربوية وعن الخلل و التردي الذي تورده المقالات الصحفية و التقارير المحلية و الدولية و الدراسات العلمية و الجامعية إلا أن جلها على الأرجح ذلك قد وقع في أخطاء منهجية يحذر منها علماء التقييم و التقويم المشتغلين على رصد أداء الأنظمة التربوية لذلك حاولنا التواصي بالبحث الممنهج و بالصبر على العوائق و الصعوبات القاهرة التي اعترضتنا.
توصلنا بعون الله وتوفيقه في هذا البحث الموكول إلينا من الوقوف على معضلة بنيوية مركبة ومعقدة وصفت توجهات واختيارات انشطرت فيها المؤسسة التربوية إلى شقين:
-” شق مدني يرمي إلى سعة الفكر وحيز الوقت وغايته تنموية بالأساس
-وشق ديني قاعدته ترسيخ قيم التراث كما سجلنا حالة فصام ونظامه الاجتماعي ومقصده عقدي وخلقي”(احميدة النيفر،2009)
ذلك ما بدا لنا بعد استقراء لمظاهر الإعضال و التردي و بعد محاولة الكشف عن الفئات التالية :
1 – حظ متواضع جدا للأطفال من تربية أصيلة على القيم في الروضات و الأقسام التحضيرية
2- انتشارواسع للأميةالأبجدية، والرقمية والحضارية حيث يعاني منها ثلث السكان الكبار بالمجتمع العربي أغلبهم من الإناث
- طغيان الجانب الكمي على الجانب النوعي في المدخلات (محدودية النوع والكيف فيما يتعلق بالإعداد والتدريب للمعلمين وصياغة المناهج وتأليف الكتب وتهيئة الفضاءات التربوية (استراتيجية تطوير التربية العربية (الاستراتيجية المحدثة لسنة 2006).
- تدني مستوى المتعلمين و الخريجين في القراءة و الكتابة بلغتهم العربية
- تدني مخرجات المتعلمين في الرياضيات و بالأساس في حل المسائل
- تدني مخرجات المتعلمين في العلوم التجريبية (العلوم الفيزيائية، و الكيمياء، و علوم الحياة و الأرض
- تدني المخرجات المتعلقة بالتفلسف و الاجتهاد و التفكير النقدي
- محدودية المخرجات المتعلقة بالإبداع الأدبي و التشكيلي الفني
- ضعف المردودية أو الكفاية الداخلية للأنظمة التعليمية والتكوينية.
- ضعف مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل الفعلية.
- تخرّج أجيال عربية ليس إلمام بالمعرفة الإسلامية والإنسانية وفصل بين المعرفتين.
- هجرة العقول العربية من ذوي الكفاءات العالية والتخصصات النادرة إلى خارج الوطن العربي
- اغتراب طلابي مستفحل وفقدان للمعنى و الهدف و اللامعيارية و اللامبالاة
- مظاهر عديدة تنم عن الاستلاب و التأثر بالقيم الغربية
- تدني المخرجات المتعلقة بالقيم الخلقية الإسلامية تنامي العنف المدرسي و التشدد استفحال الغش في الامتحانات
- تدني المخرجات المتعلقة بالتربية على القيم المدنية (المواطنة،الشورى،الديمقراطية،حقوق الإنسان، المسؤولية،الحس النقدي وقبول الاختلاف)
هذا الفشل الذي لحق بمخرجات الأنظمة التعليمية و التربوية و الذي يعود بالأساس إلى غياب التأصيل و إلى عوامل عديدة كنا قد وصفناها في مستوى كل مظهر من مظاهر المعضلة و بحثنا لها عن فرضيات تفسيرية ترجع الخلل إما إلى التمشيات التعليمية و إما إلى المدخلات المادية و البشرية و الفكرية أو للظروف الاقتصادية و التغريب و العولمة و الاحتلال التوطيني و الغزو الفكري.
لقد مكنتنا محاولة الفهم لطبيعة المشكلة وتفسيرها في ضوء العوامل المتعددة التي لعبت دورا هامّا في إنتاجها من صياغة
فرضيات فرعية تفسيرية ( ترجع التردي إلى الفلسفة التربوية غير المتجانسة والمنهاج التكويني والتعليمي النمبت عن حاجات الأمة وأبنائها وغياب الدور الحضري للمعلمين و المشرفين) وصياغة فرضية رئيسة ( غياب التأصيل وغياب ميزان العقيدة و الاستخلاف) يسرت علينا توقع خصائص و سمات فذة و أفكار و ممارسات و احتياطات يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار في الرؤية النظرية و بالأساس في الجانب التطبيقي الإجرائي من مشروعنا المنشود.
مكننا تحليل مظاهر الإعضال التربوي بالعالم العربي والإسلامي من التعرف على العديد منها فحاولنا صياغة فرضيات فرعية تفسرها فكان منها ماهو مرتبط بالمنظومة ذاتها(تذبذب الفلسفة و المناهج التكوينية و التعليمية وتسلط التلقين و التمرير وغياب الطرائق المنشطة للفكر…) و ما خرج عنها(تغريب وعولمة و..)مما جعلنا نفترض أن غياب الأصالة و التأصيل للنظم التربوية العربية و الإسلامية هو الذي أذاب مقومات هويتنا (المعرفية و القيمية) وأصاب لغتها العربية وأخلاق أبنائها وسماتها الحضارية الفذة.
- وبناء على ما تقدم سعينا لصوغ فرضية رئيسة افترضنا فيها أن غياب الأصالة كان سببا مفسرا للتردي و التخلف الخانق للمقومات المعرفية والقيمية الدينية والمدنية. هذا ما توصل إليه العديد من الباحثين المسكونين بهاجس الإصلاح والنهضة الحضارية لهذه الأمة المحمدية وهذا ما توصل إليه على سبيل المثال الباحث بالجامعة الماليزية( الجيلاني بن التوهامي مفتاح، 2008) من تشابه كبيرا يصل إلى حدّ التطابق بين أعراض أزمة المسلمين في عصر ابن خلدون وبين أعراض أزمتنا الراهنة.” فالأزمتان تشتركان في مرض واحد وهو فساد إنسانية الإنسان وضياع قيمته. مما أدّى إلى انتشار العجز والكسل والبطالة والتواكل والغش والكذب والنفاق الاجتماعي”، و ما أدّى إلى تفكّك المجتمع واختلال العمران وانتشار الفقر والبطالة والصراعات الداخليّة. فطبيعة المعضلة في عمقها هي معضلة تربوية و الأزمة تتلخّص في فساد التربية، وجذورها تعود إلى التسلط و التحجروالجمود و فساد المؤسسة السياسيّة المنحرفة عن الأصول و مقوما ت الأصالة المعرفية و القيمية.
وفي خاتمة هذه المحاولة البحثية يمكننا القول أن حلّ هذه المعضلة يتوقف أوّلا وقبل كلّ شيء على شموليّة التصوّر التربوي لنوعية الإنسان المراد بناؤه ومراعاة كل الأبعاد الرّوحية والخلقيّة ولماديّة والحضارية.
وعليه فإننا نفترض أن تأصيلا استخلافيا و بنائيا للمناهج ولنماذج الإشراف والتكوين والتعليم والتجديد والرصد والتقويم في كل مراحله من الروضة القرآنية إلى الجامعة كفيل بإذن الله بأن يخرج الشخصية الرسالية الموحدة والمؤمنة بربها والواعية بالاستخلاف في الأرض والبانية للفكر و المعمرة للكون.
كما نفترض بالإضافة إلى ما أكدنا عليه سابقا أن إيجاد نظام تربوي أصيل راق مميز ذي مخرجات واعدة يحقق الأمن المعرفي و ييسر الاندماج في سوق العمل يستوجب بلورة فلسفة واضحة و صياغة لغايات ومناهج وإعدادا مهنيا للمعلمين قبل الخدمة و أثناءها لكل المراحل وممارسات تعليمية تعلمية مراعية للفروق الفردية و مرافقة مضيفة و تقيما بنائيا إضافة إلى أهمية تفعيل لمراكز البحثت والتجديد و المراصد البيداغوجية.
و حتى نكون في مستوى الأمانة و الرسالة سعينا بتوفيق من الله و عونه لأجرأة تحول ما وصف من إعضال إلى أفكار و إجراءات و ممارسات يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار عند صهر الأبحاث النظرية و التطبيقية و إعداد الفلسفة التربوية (المثل العليا و المبادئ و الغايات و الأهداف التربوية العامة للمراحل و الدرجات و المستويات و الشرائح المتعلمة) وصوغ الأدلة ( الكتاب الأبيض أو برنامج البرامج و كراس الشروط الخاصة بكل مؤسسة سترى النور بحول الله و قدرته.
لذلك نقترح ما يلي:
تعزيز القيم الروحية المستقاة من أصولنا (القرآن و السنة) و دعم الهوية العربية الإسلامية و الانتماء فلسفة و ممارسة من خلال المناهج و المقررات و الكتب وتمشيات تعليم اللغة العربية والتفكير الإسلامي
- تربية الطلاب في كل مراحل التعليم على العمل الصالح و التواصي بالحق(الاجتهاد العام لتحقيق شروط الاستخلاف المعرفي )و التواصي بالصبر لتحقيق شروطه الخلقية (مصدق الجليدي ،2009) و(أبو يعرب المرزوقي،2005)
- تخطيط لسياسات تربوية أكثر ديمومة و منظومية وأكثر تفاوضا و مساءلة عامة و خاصة حولها.
- مقاومة الأمية الأبجدية ،الحضارية والرقمية و إيلاء عناية معتبرة بالفتاة و المرأة في الحضر و المدر.
- إنشاء مؤسسات تعليمية من الروضة القرآنية إلى الكلية و المعهد العالي ، جذابة ووظيفية بها قدر مقبول من الاستقلالية ميسرة للتنقل و القيام بكل الأنشطة الرياضية و الثقافية و الفنية الإبداعية .
- تهيئة فضاءات الدراسة والراحة و الحياة المدرسية بشكل يسمح ب:التلاقي و التعارف والتعاون بين كل الفاعلين فيه من متعلمين و معلمين و أعوان الإدارة و أولياء الأمور إضافة إلى التفاعل الاجتماعي و الثقافي من خلال أنشطة المرافقة و مبادرات الجمعيات على العمل الخيري و تحمل المسؤولية الفردية و الجماعية( الغرفة الصفية الإيجابية و الدافئة الداعمة لنشاط الطلبة و ذات المقاعد الفردية المتنقلة وفق طبيعة النشاط و الهدف منه…)
7- تقريب التربية قبل المدرسية بالرياض القرآنية وتوفير النقل الجماعي عند الضرورة و توفير الغذاء و الوقاية الصحية المناسبة ومرافقة ذوي الحاجات الخصوصية منهم و توفير فضاءات التواصل و الحوار مع الأطفال وأولياء الأمور.
8- التوزيع العادل و المنصف و المدروس للعمل التربوي و تحديد الأدوار(أولياء الأمور و أسرة المدرسة المجلس التربوي و مجلس المؤسسة).
9- تنظيم كل الأنشطة المدرسية لتكون في خدمة بيداغوجية تفريقية تراعي حاجات كل رواد المؤسسة (رعاية المعوقين و الاهتمام بالموهوبين).
10- توعية أولياء الأمور عبر كل وسائل الاتصال بأهمية التربية قبل المدرسية بالروضة القرآنية
11- التخطيط لمناهج قبل مدرسية متوازنة ترغب في حفظ القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة تولي أهمية للجوانب و الوجدانية والحركية (اللعب)
12 – صياغة المناهج من قبل خبراء و مشرفين و موجهين و ممارسين للتدريس بعد استشارة عينات من الذين يطبق عليهم تولي أهمية للتفكير الناقد و مهارات الاتصال و التواصل اللغوي و تنمية الاتجاه العلمي و حل المشكلات
13- إعداد مناهج خاصة بكل مرحلة و بكل شريحة من شرائح المتعلمين و الطلبة (ذوي الحاجات الخصوصية من المعوقين و الموهوبين) تأخذ بعين الاعتبار توازنا و تكاملا للمواد ( الروحية و الدينية و المدنية والعلمية والتكنولوجية المهنية واللغوية و الرياضة و البدنية) و شمولية التربية لكل أبعاد الشخصية
14- مراعاة المرونة في زمن مدرسي مستجيب لحاجات المتعلمين الفيزيولوجية والروحية(العبادة) والترفيهية (المساهمة في تنشيط الحياة الثقافية و الرياضية و الفنية الإبداعية و الخيرية للمدرسة) .
15- إعداد مناهج تولي أهمية لتنويع الطرائق التقويمية و التعليمية و التقنيات المساعدة على تحقيق الأهداف كالاستقلالية و التفكير النقدي و حل المشكلات و المستثمرة للذكاءات المتعددة و الذكاء العاطفي والانفعالي للمتعلم وإنماء قدرة المتعلمين على التحليل و التأمل في تمشياتهم و نقدها وممارسة التقييم التبادلي و الذاتي البنائي و الحوار المنظم والعمل التشاركي .
16- توظيف المقاربة بالمشروع و التفتح على المحيط و البيئة وتأليف الكتب وتهيئة الفضاءات التربوية (استراتيجية تطوير التربية العربية (الاستراتيجية المحدثة لسنة 2006).
17- انتقاء الأخيار من المعلمين الراغبين و المستعدين لحب الطفل و الإنسان و أصحاب القدرات العالية في التواصل اللغوي و الرقمي وفي بعض اللغات الأجنبية من المؤهلين لتحمل مسؤولية التربية و التعليم في المراحل المدعو للعمل بها.
18- إعداد المعلمين قبل الخدمة إعدادا عمليا و براكسيولوجيا و نظريا في تعلميات المواد (مبحث علمي نظري ظهر في أواخر الثمانينات بالغرب يهتم بدراسة تمشيات تملك المعرفة و المهارة و الموقف و بتحليل التفاعلات التي تحصل بين كل من أقطاب المثلث التعليمي-التعلمي فتدرس الخطأ التعلمي و العوائق الابستمولوجية و التصورات الأولية…الخ) و في طرائق التدريس و تقنيات التعليم المباشر والرقمي والتنشيط و المرافقة و التفريق و التقييم و البنائي و التكويني و الجزائي
19- التأهيل و إعادة التأهيل لكل الكوادر الإدارية و التعليمية و التربوية للتطوير المتجدد لمهنيتهم حتى يطوروا استقلاليتهم و تأملهم المتجدد و التزامهم بالتجويد التعاوني و المتواصل للممارسات التربوية والإدارية و التصرف في الطرائق و الأساليب و الأجهزة البيداغوجية
20- العمل بنظام المراوحة و الترويح بين الدروس النظرية و التطبيقية و المهنية و التدريب المهني و التقني القائم على التقنيات العليا و التكنولوجيا الحديثة في تعلم الفنون و الصنائع و جعل البيئة معملا للمدرسة و ميدانا لتدريب الطلاب على الحياة.
21- تنويع الطرائق و التقنيات التعليمية المطورة للقدرات الميتاعرفانية و المراعية للفروق الفردية بين المتعلمين وانتقاء المحفزة على التأمل و التفكير النقدي و التأمل الذاتي و التواصل و الحوار المنظم و المساعدة على تعلم حل المشكلات ونقل أثر التعلم و التكيف الذكي مع الطارئ و المستجد منها و تجنب التعليم اللفظي و التلقيني
22- إيلاء العقل مكانته والتأكيد على التربية العلمية التجريبية وإنماء الاستقراء و الاستدلال و التأمل الميتاعرفاني لدى الطلاب انطلاقا من السؤال المحير و الوضعيات-المشاكل والتوجيه لإنجاز المشاريع البحثية الدالة و من الملاحظة و الممارسة و النشاط الذاتي والفرقي و بصفة خاصة في حصص علم الأحياء و الفيزياء و الكيمياء و الجغرافيا الطبيعية و التكنولوجيا والتربية المهنية .
23- إرساء توجه الانفتاح على علوم و خبرات غير المسلمين التي لا تتعارض مع قيم الأمانة و الاستخلاف
24- إرساء تقليد القراءة و المطالعة البانية للمعاني منذ المرحلة الأساسية بتوفير الفضاءات الجذابة و المريحة و انتقاء أجود النصوص وتثمين مجهود المجتهدين و مرافقة المتعثرين- تأسيس العلاقة التربوية بين كل الفاعلين على الاحترام المتبادل و توقير العلم و المعلم و رحمة المتعلمين و تحقيق الأهداف المنشود
25- العدل بين الذكور و الإناث وبين أبناء الريف و المدينة و تكريس مبدأ تكافؤ الفرص و الإنصاف
26- تحميل تلاميذ المدرسة مسؤولية المحافظة على مدرستهم بتمكينهم من المبادرة و تقديم الإضافة فيها ومشاركة المتعلمين في قرارات المدرسة و توجهاتها المستقبلية بإبداء آرائهم
28- تدريبهم و تعليمهم القيم و الخلق الحسن و دعوتهم للتفاعل مع الثقافات الأخرى لفهمها و الاستفادة منها
29- نشر ثقافة تقييمية و تقويمية بنائية و تكوينية تكون في خدمة الرصد و المرافقة للعلاج و الدعم وتطوير للميتاعرفانية و التعديل الذاتي.
وصفة القول نذكر مرة أخرى لنقول أن أي” مشروع تربوي يروم بناء الإنسان المستخلف ينبغي أن ينبثق من تصور لحقيقته وطبيعته، ومن تصور لحقيقة الكون ، ومن فلسفة تربوية شاملةو بنية نظرية تربوية سمتها التكامل والوضوح والاكتمال والقابلية للتطبيق”(عبد المجيد بنمسعود ،2009).
والمشروع التربوي الأصيل المتجدد على الدوام هو ذاك المستند بالأساس إلى الإيمان بالله ووحدانيته، و إلى الفطرة التي فطرنا عليها وإلى سنن قدوتنا محمد ﴿لَقَد كَانَ لَكُم فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرجُو اللَّهَ وَاليَومَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب:21].
هذه هي النتائج والمقترحات التي أردنا إثباتها في نهاية هذا البحث المشروع، علّها تكون معالم وإشارات ولبنات صالحة داعمة للجهود الجبارة والمخلصة التي يتطلبها منا جميعا مشروع التربية الأصيلة المنشود. وأخيرا هذا هو جهد المقلّ وأحمد الله على ما وفَّقَ وأسأله المغفرة فيما قصّرتُ فيه وأسأله العون والتوفيق فيما يأتي إنّه نعم المولى ونعم النصير والحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وسنة خير الأنام.
قائمة المراجع
- الأمم المتحدة . “تقرير التنمية البشرية” 2007م/2008م ،برنامج الأمم المتحدة الانمائي
- الأ مم المتحدة . “التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع”، 2009م
- الأ مم المتحدة . “تقرير التنمية الإنسانية العربية”، 2003م
- الأحمر، عبد السلام.”في التعليم غياب القضية هو القاضية”مجلة تربيتنا عدد مزدوج 6-7 ،الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية ،القنيطرة ، المغرب2009م
- الأهواني.أحمد.”التربية في الإسلام”، دار المعارف بمصر، ط2 القاهرة 1975م
- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.” استراتيجية تطوير التربية العربية (الإستراتيجية المحدثة )”، تونس، 2006م
- إبراهيم، محمد أبو بكر. ” الإصلاح التربوي من منظور المشروع النهضوي الإسلامي”: www.alwasatparty.com
- أيمن، الزمالي. “العنـف “يصفـع” المدرسـة ” مقال بجريدة الصباح، تونس، (2009م)
- بدوي، أحمد زكي.”معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة”، بيروت، مكتبة لبنان، 1986م
- برغوث،عبد العزيز،”الأدوار الحضارية للمعلم ودواعي التجديد في فلسفة التعليم “. ماليزيا :كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية ،الجامعة الإسلامية العالمية، 2009م.
- بن عسكر،منصور،عبد الرحمان.”العنف في المدارس”بحث مقدم إلى الندوة العلمية :مركز الدراسات والبحوث،أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية” ، الرياض ،2004م
- بومار،مارلين.”ما سر امتياز المدرسة الفلندية؟ترجمة محمد عاشور “مجلة الفاعل التربوي،جمعية تطوير التربية المدرسية تونس(2008م)
- بنمسعود، عبد المجيد .” القيم الإسلامية التربوية والمجتمع المعاصر”، الدوحة ، سلسلة كتب الأمة، 1988
- بنمسعود، عبد المجيد.”ملامح المشروع التربوي الإسلامي” 2009م www.oujdacity.net
- تهاني منيب وعزة سليمان .”العنف لدى الشباب الجامعي”، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض، 2007م
- حسين ،جعفر.”أسباب طرد التلاميذ من المعاهد الثانوية”، جامعة تونس، 2002م
- حطاش،محمد.” ظاهرة الهدر المدرسي” www.jeunessearabe.info/article 2007م
- محمد، زياد حمدان, “خطيط المنهج” ،تونس ، الدار العربية للكتاب، 1986م
- خضر ، محسن . “مستقبل التعليم العربي بين الكارثة والأمل” ,الدار المصرية اللبنانية القاهرة ، 2008م
- رابح، تركي. التعليم القومي والشخصية الجزائرية، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،1981م
- رضا ، محمد جواد . العرب والتربية والمستقبل تربية النكوص أو تربية الأمل. الكويت ،الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة،2000م .
- زهران ، حامد . التوجيه والإرشاد النفسي.القاهرة:عالم الكتب،1980م
- ساسي، رضا. ” التكوين الأساسي للمعلمين بالمعاهد العليا بتونس :دراسة التصوّرات لحرفة التدريس و ملامح الهويات المهنية لدى خريجي المعاهد العليا للعلمين بتونس” : (رسالة دكتوراه في علوم التربية كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية جامعة تونس 2008م)
- ساسي، رضا .” أثر التكوين المتمفصل مع الممارسة في كفايات معلمي الرياضيات بالتعليم الأساسي”.(دراسة معمقة جامعة تونس2001م)
- عبد الدائم و آخرون، التربية والتنوير في تنمية المجتمع العربي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ، 2005م
- عبد الحليم، أحمد المهدي .أشتات مجتمعات في التربية والتنمية . القاهرة :دار الفكر العربي، 2003 م.
- عبد الواحد سعاد.” تأثير التربية ما قبل المدرسية في تملّك المتعلم للكفايات (“جامعة تونس) 2000م
- عجاوي محمود أحمد وماهر محمد أبو هلال.”أثر رياض الأطفال على التحصيل الأكاديمي في المرحلة الابتدائية “،المجلة العربية للتربية:المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ع 1 (1994م).
- عذاري حليمة, بناء الفكر العلمي في الحضارة الإسلامية نشر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تونس 2007م
- عبد الموجود،محمد عزت.”الدراسات العليا طبيعتها وإدارتها”مجلة اتحاد الجامعات العربية،عدد خاص:1994م
- علي، نبيل وآخرون.الفجوة الرقمية،رؤية عربية لمجتمع المعرفة. الكويت: سلسلة عالم المعرفة عدد318 ، 2005م
- علي،نبيل.العقل العربي ومجتمع المعرفة:مظاهر الأزمة واقتراحات بالحلول)(الجزء الثاني) الكويت:سلسلة عالم المعرفة عدد 370 ،2009م
- عمار،حامد.من همومنا التربوية والثقافية في التنمية و الثقافة. القاهرة: الدار العربية للكتاب ، 1997م
- فرجاني نادر .”التعليم العالي و التنمية في العالم العربي من مؤلف التربية والتنوير في تنمية المجتمع العربي .بيروت,نشر مركز دراسات الوحدة العربية 2005 م
- لجلال عبد العزيز العبد الله , تربية اليسر وتنمية التخلف ,سلسلة عالم المعرفة الكويت 1985م
- محسن ،مصطفى . الخطاب الإصلاحي التربوي بين أسئلة الأزمة وتحديات التحول الحضاري . ط1،الدار البيضاء بيرو ت :المركز الثقافي العربي ، 1999م
- محمّد جواد رضا، الاصلاح التربوي العربي خارطة طريق مركز دراسات الوحدة العربية 2006م
- وطفة علي ,أسعد الجمود والتجديد في العقلية العربية ,وزارة الثقافة سوريا 2007م
- وطفة ،علي أسعد.الاغتراب خارج حدود الإيديولوجيا، الكويت: مجلة دراسات ع 32، 2008م
- الامم المتحدة ,تقرير التنمية الانسانية العربية ,2009 م
- الأمم المتحدة ,التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2009م
- الأمين عدنان، إصلاح التعليم العام في البلدان العربية ، الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية 2005م
- الأهواني ،أحمد فؤاد . التربية في الإسلام . ط 2 القاهرة : دار المعارف ، 1975م.
- آل الرشود، سعد محمد سعد.”اتجاهات طلاب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض”( رسالة ماجستير أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيةالرياض2000م)
- الدريج ،محمد . التدريس الهادف. العين الإمارات العربية المتحدة: دار الكتاب الجامعي ، 2004م
- الذوادي ،محمود . التخلّف الآخر، عولمة أزمة الهويات الثقافية في الوطن العربي والعالم الثالث. تونس :الأطلسية للنشر، 2002م.
- دودين،. حمزة .مشكلات الطلاب فى الاختبارات وطرق علاجها : الغش ، واستراتيجيات تقديم الاختبار ، وقلق الاختبار. مكتبة الفلاح: فلسطين 2004م
- الرشيد محمد الأحمد التربية ومستقبل الأمة العربية . الكويت :مجلة عالم الفكر م19ع2 1988م
- الزراد ،فيصل. ظاهرة الغش لدى طلبة المدارس و الجامعات دار المريخ 2002م
- الجراح ،مصباح . “ظاهرة انتشار الغش في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في الأردن “مجلة علوم انسانية WWW.ULUM.NL العدد 43: 2009 م
- الجرجاوي زياد, فلسفة أعداد المعلم المسلم الجامعة الإسلامية غزة ,2005م
- الجليدي ،مصدق . روّاد الإصلاح التربوي في تونس دار سحر للنشر، تونس 2009م
- الخويلدي ،زهير.” التجديد في تعليم الفلسفة من وجهة نظر عربية إسلامية” موقع Doroob دروب 2007م.
- السورطي، يزيد عيسى .السلطوية في التربية العربية، الكويت: سلسلة عالم المعرفة ، 2009م
- الشريف محمّد بن شاكر، نحو تربية إسلامية راشدة، من الطفولة حتى البلوغ ، مجلّة البيان 1427هـ 2006 م
- الشهيري، علي عبد الرحمان. العنف في المدارس الثانوية من وجهة نظر المعلمين والطلاب.(رسالة ماجستير جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض2003م).
- الشويرف ،عبد اللطيف أحمد. “الضعف العام في اللغة العربية : مظاهره، آثاره، علاجه” التقرير الختامي لندوة اللغة العربية إلى أين ؟:الرباط : ( 1423هـ 2002م)
- الصمدي، خالد،.أزمة التعليم الديني في العالم الإسلامي. دمشق: دار الفكر، 2007م
- الصمدي، خالد،.القيم الإسلامية في المنظومة التربوية:دراسة للقيم الإسلامية وآليات تعزيزها.منشورات الإيسيسكو1429ﻫ2008م
- الصمدي ،خالد. ” من معرفة القيم إلى قيم المعرفة: دراسة في المناهج التربوية وأثرها في تشكيل منظومة القيم لدى شباب الجامعات بالتعليم ماقبل الجامعي، مادة التربية الإسلامية نموذجا”.المملكة الأردنية الهاشمية جامعة الزرقاء الأردن،2004م
- الطيار، فهد .”العوامل الاجتماعية المؤدية للعنف لدى طلاب المرحلة الثانوية” رسالة ماجستير كلية الدراسات العليا جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض، 2005م
- العتيبي، منير مطني ولآخرون. أهداف التعليم المبكر (رياض الأطفال بالمملكة العربية السعودية). مركز البحوث التربوية الرياض: 2002 م
- العمري، أكرم ضياء، التراث والمعاصرة، كتاب الأمة رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية ،قطر 1405 ﻫ
- العليان، إبراهيم.أسباب وحلول :ضعف الطلاب في المفاهيم الأساسية للرياضيات ع169: 2009م www.almarefh.org
- الكندري، جاسم يوسف .”المدرسة و الاغتراب الاجتماعي” :دراسة ميدانية لطلاب التعليم الثانوي بدولة الكويت .المجلة التربوية،المجلد12 عدد 46 ( 1998 م )
- الكنوني،عبد السلام أحمد. المدرسة القرآنية في المغرب من الفتح الإسلامي. الرباط :منشورات مكتبة 1981م.
- الكيلاني،اسماعيل.”الواقع التربوي ووسيلة التغيير”.مجلة الأمة القطريةعدد 34ا:لدوحة (1983م)
- المرزوقي ، أبو يعرب. “عوائق تحقيق القيم الإسلامية (أصولها المذهبية والتاريخية وعلاجها التربوي والسياسي في الوضع الإسلامي الراهن”2005م موقع الوحدة
- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ,الخطة العربية للتعليم عن بعد, تونس 2006م
- المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم .”تقرير استراتيجية تطوير التربية العربية (الاستراتيجية المحدثة ) ” تونس،2006م.
- النقرابي محمد عبدا لله ، الخرطوم : مركز التنوير المعرفي سلسلة ندوات التنوير رقم (1) ط 1، 2005م
- مفتاح،الجيلاني بن التوهامي.”مفهوم الاستخلاف ودوره في فكر ابن خلدون التربوي والتعليمي”(رسالة دكتوراه ،معهد التربية،الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا،2006م).
- النيفر، احميدة.الحدود والحروف كنوز التراث، 2009 ، www.alfajrnews.net
- النيفر ،احميدة . الصبح القريب: أيّ تعليم إسلامي لمجتمع حديث؟2007م www.almultaka.net
- اليحي، عبدالله بن سعد.”تحديد بعض متطلبات والمعالم لبناء نظرية تربوية اسلامية” مقال في مجلة كلية التربية بالمنصورة.ع 42 2000م
- وزارة التربية و التكوين . “صورة الأستاذ في المدرسة التونسية ” بحث أجراه المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية تونس، 2007 م
[1] حديث صحيح رواه البخاري
[2] الغزالي: إحياء علوم الدين، ذكره محمد بن شاكر الشريف نحو تربية إسلامية راشدة من الطفولة حتى البلوغ
[3] العتيبي منير مطني وآخرون
أحمد. 1975م، ص51. الأهواني، فؤاد[4]
[5] رابح. تركي. ص230.
[6] الكنوني.عبد السلام أحمد. ص36.
[7] حميدة النيفر. ص2
[8] طعيمة،أحمد رشدي.ص4
[9] الذوادي،محمود. ص 83-84.
[10] مرجع سابق ص121
[10] مرجع سابق ص122
[12] مرجع سابق
[13] مرجع سابق
[14] مرجع سابق
[15] المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، استراتيجية تطوير التربية العربية، 2006
[16] رضا محمد جواد.الاصلاح التربوي العربي، خارطة طريق.كتب المستقبل العربي ع 39، مركز دراسات الوحدة العربية 2006 ص20-21.
[17] علي نبيل وآخرون.الفجوة الرقمية،رؤية عربية لمجتمع المعرفة، سلسلة عالم المعرفة عدد 318 2005م، ص311-312.
[18] عبد الحليم أحمد المهدي.أشتات مجتمعات في التربية والتنمية.دار الفكر العربي،القاهرة-2003م.