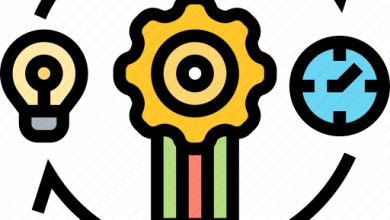09- منظومة المفاهيم المفتاحية المؤسسة لمشروع إحياء نظام تربوي أصيل
مقتبس من الملف التعريفي الخاص بمشروع إحياء نظام تربوي أصيل، والمحرر في شعبان (8) 1433هـ، الموافق يونيو (6) 2012م.
يستند المشروع إلى منظومة من المفاهيم المفتاحية المؤسسة له، باعتبار أن هذه المنظومة هي المقوم الأساس للنسق الناظم لمقاربته النظرية ونموذجه التطبيقي. غير أن الأمر لا يقتصر على اختيار وتحديد مجموعة من المفاهيم فحسب، بل إن المشروع ــــ تجسيدا لخصوصيته النظرية والتطبيقية ــــ يركز على الطبيعة التفاعلية التكاملية المتميزة التي أنشأها بين هذه المفاهيم المؤسسة، ذلك أنه لا مطمع في بناء نظري علمي يُنزّل في الواقع دون تحديد مفاهيمه المعتمدة، ضبطا لمضامينها، ولنوع العلاقة التي تنتظمها، والخصوصية التي تندرج ضمنها مختلفُ عناصرها ومجملُ أجزائها. وهذا ما يجعل تناول المفاهيم الأساسية بهذا التشبيك في هذا السياق خيارا لا بديل عنه، لكونه ــــ بحكم هذا التركيب ــــ يشكل الأساس العلمي لتحليل المكون النظري والتطبيقي للمشروع، مما يفضي إلى بناء فكري وعملي يحقق الإضافة والتميّز. وبفضل هذا التعاطي الواعي بدلالات المفاهيم المؤصـَّلة، والمفعّلة بالعدّة العلمية التي يتيحها العصر، وبما تتضمنه من موجهات موضوعية يضع المشروع حدا للاندفاع في تقليد القديم ومحاكاة الحديث لدى المنضوين في النظام التربوي الأصيل منشئا لديهم دافع الإضافة المبدعة والمتجهة إلى الصعيد العملي، وهذا هو بالذات مقتضى المعاصرة في المشروع؛ إذ المعاصرة إنما هي: “تفاعل واع بين التمكن من معرفة العصر، استيعابا لفتوحاته العلمية وكشوفاته التقنية، ووعيا لمتطلباته التربوية والحضارية، وبين التحقق بمقومات الذات المتأصلة إيمانا راسخا وعلما نافعا وعملا صالحا واقتداء حيا واجتهادا منضبطا وواسعا”، بحيث تكون المعاصرة، بهذا المعنى، هي المحك الذي يتخذه المشروع لاختبار القيمة العلمية والوظيفة العملية لمختلف مفاهيم المنظومة، فضلا عما يُنجَز للمشروع من أعمال.
تنبني هذه المنظومة على نسق من المفاهيم المرجعية الوظيفية لتحقيق المعاني الكبرى للتمكين الحضاري بمعناه الإنساني المتكامل بوصفها الغاية المتوخاة من المشروع، وذلك بتفعيل هذه المفاهيم في بوتقة المعاصرة عبر مسلك التربية في نظام مؤسسي مترابط ومتكامل.
والفقرات التالية تسلط الضوء على هذا النسق المفهومي، ودلالاته الخاصة في المشروع، والتفاعلات بين مكوناته؛ قصد إظهار الجوانب المميزة للمشروع، لا سيما الإجرائية منها، وما تتضمنه من موجهات.
وهذا النسق المفهومي عبارة عن أزواج جدلية خمسة من المفاهيم، وهي كالتالي:
- سلطة النص / استقلال الذات: كان لا بد لهذا المشروع من أن ينطلق من هذا الزوج، وذلك للمكانة التي ينزلها في الفكر الإنساني الحديث عامة والفكر الديني والتربوي خاصة، تلك المكانة التي جعلت من طرفي هذا الزوج عنصرين متعارضين؛ لكن هذا المشروع التربوي، وهو يسعى إلى وضع تصور جديد للمعاصرة، يأبى إلا أن يتجاوز هذا التعارض الظاهر، ليس لأنه يريد أن يستأنف سابق الجدل في هذه المسألة، مضيفا مزيدا من التضارب في الآراء بشأنها، وإنما لأنه يدرك حق الإدراك مدى تعقيد هذه الإشكالية مما أفضى إلى الشك في عطاء الثقافة الأصيلة وفاعليتها.
فسلطة النص، في المشروع، عبارة عن “محور جذب وسلطة لا تقهر إرادة الفرد بقدر ما تُخلِّص هذه الإرادة من الموانع التي تحول دون انطلاقها، وتحقيق اختياراتها”. أما استقلال الذات فهو عبارة عن “خروج الذات من التبعية التدبيرية التي تُجبر عليها قهرا أو تخضع لها تقليدا، وكذلك تمكينها من اتخاذ قراراتها وقوانينها بصفة اختيارية مسددة”.
وعلى ضوء هذين التعريفين، يتبين أن هناك تفاعلا بين عنصري هذا الزوج، ذلك أن النص لا ينفك يجد الإنسان فيه الأسباب التدبيرية التي تحرِّره من القيود الخارجية المانعة من تحقيق قدراته الذاتية، متصديا لتحديات العصر، كما يجد فيه الأسباب التعبّدية التي تُحرّره من الأغلال الداخلية المانعة من تفجّر طاقاته الروحية، مواجها لتقلبات ظروف الحياة؛ فلا يغدو النص ــــ بهذا الفهم ــــ، سلطة تمارَس على الإنسان من خارج قهرا، وإنما، على العكس من ذلك، يضحى سلطةً في يده يتوصَّل بها إلى حريته الخارجية، وأيضا سلطةً في قلبه يتوصّل بها إلى حريته الداخلية. فالنص إذن ــــ وبإيجاز ــــ هو في المشروع: “مصدر التحرّر الشامل للإنسان“. وفي المقابل، إذا كان الاستقلال هو “امتلاك الإنسان لإرادته”، فإن هذه الإرادة لا تتخلّص له للوهلة الأولى، بل يدخل عليها نوعان من العلل التي تغيب عن شعوره، أحدها “العلل النفسية“، وتتمثل في جملة من نوازع الشهوة والهوى التي قد تؤدي إلى أن تستعبده ذاتُه؛ والنوع الثاني “العلل الاجتماعية“، وتتمثل في جملة من العوائد والقيود التي قد تؤدي إلى أن يستعبده غيرُه؛ ولا سبيل إلى تخليص الإرادة من هذه العلل المزدوجة إلا بإرادة علوية فوقها ليست من جنسها، وهي التي تتجلى في النص؛ إذ إن هذا النص ينطوي على أسباب تعبّدية تنفذ إلى أغوار باطن الإنسان، دافعة عنه العبودية لذاته؛ كما ينطوي على أسباب تدبيرية تنفذ إلى طبقات ظاهره، دافعة عنه العبودية لغيره؛ ومتى استطاع الإنسان، بفضل النص، أن يتحرّر من العبوديتين: “الداخلية” و”الخارجية”، أضحت إرادته مستقلة حقا؛ وعلامة استقلالها أنها كلما أتت فعلا من الأفعال، كان هذا الفعل موافقا لإرادة النص.
- الأصالة / الإبداع: إن الأصالة، في السياق التربوي الذي يتنزل فيه المشروع، عبارة عن “التعاطي مع المطالب والأسئلة والإشكالات التي يطرحها واقع تعليمي وقيمي وفكري ومجتمعي، وذلك بالاجتهاد انطلاقا من المصادر الأصلية، والاستمداد البصير من التراث التربوي بوصفه يشتمل على ممكنات تربوية تتطلب تنزيلا واعيا بصورة مبدعة ضمن سياق تربوي وحضاري مغاير، وكذلك الاستفادة من صالح الخبرات والتجارب الإنسانية“.
في ضوء هذا التحديد، تحتل الأصالة موقعا صميميا في كامل النسق المفهومي الناظم لمقاربة المشروع النظرية والتطبيقية، وتـكسبه حمولة فكرية – تربوية خاصة ناتجة عن التلازم الذي يقيمه المشروع بينها وبين مفهوم الإبداع بوصفه مقوما أساسا لمنظومتنا التربوية الأصيلة الفاعلة؛ والإبداع في هذا السياق التربوي عبارة عن “القدرة غير العادية التي تتيح النظر بطريقة مغايرة للطرق المعهودة فيما يتصل بقضايا الفكر والمعرفة والمجتمع من أجل الوصول إلى أفكار جديدة تؤدي إلى نتائج علمية أو عملية، لها من المميزات والفوائد ما قد يفوق ما هو في الحسبان”. ومن إيجاد هذا التلازم بين عنصري هذا الزوج في المنظومة ــــ أي الأصالة والإبداع ــــ تُحصِّل الخصوصيات الثقافية قوة وظيفية جديدة ومتسقة تُفعَّل القدرات الكامنة في الفكر والشخصية.
تبعا لذلك، فإن مقتضى تفعيل القدرات الذاتية اللازمة لعنصري هذا الزوج في المنظومة المفهومية يستلزم من المنتمين للمشروع أن يعوا حق الوعي جذورهم وخصوصياتهم وحدود هذه الخصوصيات، مبادرين إلى اكتساب الكفاءات والمنهجيات المحققة لارتقائهم واجتهادهم في تقديم إضافات نوعية، على اعتبار أن المسلك المتكامل للتربية في المشروع يكسب الأصالة طاقة تَمَثُلية حافزة إلى مزيد إدراك للذات، عبر الفهم المتجدد للماضي بمختلف مظاهر الرقي والضعف فيه، وعبر تفهم الآخر المختلف باستيعاب خصائصه المميزة، بما يكشف المستغلق من خصوصيات الذات الفاعلة في التاريخ المنجز بما يتيح التعامل مع مكوناتها ومع تجاربها في الماضي وخبراتها بصورة بنائية. وبفضل هذا البناء المتدرج والمترابط يزداد الوعي بالإمكانيات التي تنطوي عليها “الذاتية التربوية الفاعلة والمتفاعلة“، وبمميزات التفرد التي تختص بها والتي تمدها بفاعلية تفتح للأصالة طريق الإبداع والتفوق الحضاريين.
من هنا، تتبين طبيعة الإضافة المبدعة التي تكتسبها الأصالة عبر مدارج مسلك التربية، هذا المسلك الذي تتحدد غايته ــــ ضمن هذا السياق ــــ في النهوض المحقِّق للتواصل بين الموروث والمكتسب، وبين النظري والعملي، وبين الفردي والجمعي، وبين الخاص والكوني؛ إذ إن المنخرط في هذا المسلك يكتشف ما يمكن لشخصيته أن تبلغ من أبعاد، ولكفاءته أن تحذق من مهارات، ولنفسه أن تنفتح عليه من آفاق.
- الهُوية / الانفتاح: يندرج ضمن التفاعل البنائي الدقيق المشار إليه تلازم ثالث بين مفهومي الهُوية والانفتاح قائما بدوره في تثبيت وجود الذات المتأصلة في المعاصرة؛ إذ إن الهُوية عبارة عن“جملة العناصر المكوَّنَة من مجمل الخصائص والمعايير المحققة للذات الفردية والجماعية والمحددة لانتمائهما”؛ والانفتاح الذي يقصده المشروع انفتاح مزدوج، “أحدهما: الاستعداد للاستفادة من المكتسبات والعطاءات الإنسانية المختلفة التي تفيد في حفظ مكونات الهُوية وترسيخ وجودها وتوسيع نطاقها؛ والثاني هو: الاستعداد لإسهام الهُوية في إفادة العصر تحديدا لوجهته وتقويما لمساره”؛ وهذا الانفتاح المزدوج توجبه ضرورات تقلب الحياة الإنسانية في أطوار، لكل طور منها مطالب وتحديات أكثر وأعقد من سابقه، وهذا ما يترتب على القاعدة الثانية من الأساس الفكري للمشروع التي سبقت الإشارة إليها.
- القيم / المنافع: يلزم مما أتينا على بيانه بشأن التفاعل بين الهُوية والانفتاح تلازم رابع هو التلازم بين مفهومي القيم والمنافع الذي يحقق هو كذلك التفاعل البنائي المنشود الذي توجبه المعاصرة؛إذ إن القيم هي عبارة عن “المعايير التي تتمتع بمشروعية وفاعلية تجعلان منها قواعد يتأسس عليها الوعي والسلوك، كما يجعل منها معاني سامية ترسم غايات وجود الأفراد والمجموعات؛ مكونة بذلك سلـّما تترقى فيه اختياراتهم وآراؤهم ورؤاهم ويحصل به كمالهم”. والمنافع في المشروع عبارة عن “المصالح والأغراض التي يسعى الإنسان إلى تحصيلها، قضاء لضروريات حياته، وللحاجيات الناجمة عن تطورات مجتمعه، ودفعا للتحديات التي تواجهه بوصفه فردا مستقلا أو منتميا إلى جماعة مخصوصة، وقياما بشرائط الوجود البشري في هذا العالم”. وعلى هذا، فإن تقييد المنافع بالقيم الإنسانية يورث هذه المنافع صفة الصلاح، إذ يرتقي بها إلى رتبة المصالح التي يتعدى نفعها الذات إلى الآخر والحاضر إلى المستقبل. وفي المقابل، فإن المنافع المستجِدّة تولد قيما جديدة قد تتفرع عن القيم الموروثة إن جزءا أو كلا، كما أنها تحفز على التمسك بالقيم الموروثة متى ثبت صلاح هذه المنافع وعمّت فائدتها.
- التعارف / التحاور: ينتج عن التلازم الرابع المذكور تلازم خامس بين مفهومي التعارف والتحاور يحقق مزيدا من التفاعل الذي تقتضيه المعاصرة؛ وليس المقصود بالتعارف هنا مجرد التعرّف على الآخر، وإنما هو: “الاعتراف بشخصه وخصوصيته وإنسانيته، بل أكثر من ذلك التنافس في تبادل العطاء، معارف ومكاسب، وتبادل المعروف، قيما وخصالا، وكذلك التنافس في التمسك بمزايا الاختلاف، تحقيقا للكمال الإنساني والسلام الكوني”. كما أنه ليس المقصود بالتحاور مجرد دخول طرفين في تجاذب الحديث بينهما، وإنما هو: “إنشاء فضاء خطابي مشترك يعمل، بطريق التفاهم، على تجاوز الخلافات بين الأطراف وفض المنازعات بينها على مقتضى الحق والعدل، طلبا لتحقيق التعايش البناء بين مختلف الأمم والشعوب في عالم متنوع أفضل”.
ويقينا أن التحاور بهذا الوصف يفتح للتعارف مجالا واسعا تتواصل فيه الثقافات المختلفة فيما بينها، ويستمد بعضها من بعض، موسعة آفاق مداركها وأبعاد مسالكها، مما يزيد في رصيدها من القيم المشتركة، ومن قدراتها على العطاء المعرفي والسلوك المعروفي. كما أن التعارف، في المقابل، يضفي على التحاورات قيما ومعاني تجعلها تتجه إلى تنمية العلائق والوشائج وفتح آفاق التعاون على المصالح المشتركة والتكامل بين المعارف والمسالك المختلفة.
وهكذا، فإن هذه التلازمات المفهومية الخمسة: سلطة النص واستقلال الذات، الأصالة والإبداع، الهُوية والانفتاح، القيم والمنافع، التعارف والتحاور، تشكل في مجموعها مرتكزا لقوة فكرية راسخة الدعائم في الذات المتأصلة والمتواصلة مع عصرها، فاتحة الباب لحلول لم يعرفها الماضي الخاص لكونها استَلهمت مُنجَزه التربوي والاجتماعي وتمثلت تراثه الثقافي والقيمي ضمن أفق معرفي وفكري مغاير وأكثر تطوّرا؛ وبهذا تتولد عن هذا التركيب التفاعلي إضافة مزدوجة؛ فهي ــــ من جهة ـــ تنقل الذات الواعية بثقافتها وخبراتها التاريخية إلى سياق التحرر من درك التبعية والاستهلاك خاصة في المجال التربوي. وهي ــــ من جهة ثانية ــــ تجعل الذات المُفعّلة أقدر على إثراء المجال الفكري والتربوي الإنساني بمدخلاتها الخاصة والمستمدة من أصول ووضعيات اجتماعية وتاريخية مختلفة ترتقي بها المعاصرة إلى فساحة التعايش النِدّي الثري والتكاملي للذات المتأصلة مع الآخرين في عالم متسم بالتعددية.
بهذا النسق التفاعلي يتجه المشروع بمكونات منظومة مفاهيمه المذكورة إلى تحقيق الغاية المبتغاة منه، ألا وهي التمكين الحضاري، والمراد به ها هنا: “امتلاك المعارف والمهارات والآليات والعُدد والمقاربات التي تجعل المنخرطين في النظام التربوي الأصيل يستوفون الوعي بأوضاعهم وإمكاناتهم، ويقومون على تحقيق ذواتهم تصورا وعملا، مستجيبين إلى متطلبات مجتمعاتهم بما يبوئهم مكانة حضارية قادرة على المنافسة”.
وليس هذا فحسب، بل، أكثر من ذلك، فإن التمكين الحضاري هذا يتخذ منحى إنسانيا تكامليا خاصا؛ ذلك أن مفهوم الإنسانية في المشروع يجمع إلى الخصائص المشتركة خصائص فارقة، بحيث تُضْحي الإنسانية: “ذلك الكيان الاجتماعي الواسع الممتد امتداد العالم والقادر على التطور المتواصل بفضل التكامل والتفاعل بين هذين النوعين من الخصائص”. وبذلك يحقق هذا الكيان حركة فكرية وقيمية ومدنية تجعل هذا المجال الإنساني الواسع يوجه مسلك التربية إلى بناء تكاملي للإنسان يقدره على التجاوز الدائم لوضعه. وعلى هذا، فإن الإنسانية طاقةٌ تفعيلية تجعل المختلفين قادرين على تنمية أنفسهم وتطوير مجتمعاتهم في ضوء خصوصياتهم؛ وبذلك، يكون مفهوم الإنسانية متعديا لمستوى الاختلاف في المواطن والمشارب ليبلغ فضاء أوسع مما يقتضيه مجرد التعامل بين الأطراف المختلفة، مستلزما منها السعي الدؤوب نحو مزيد من الترقي والتحضر.
وبذا؛ فإن مجال الإنسانية يفرض بالأخص على مسلك التربية في المشروع أن ينشئ لدى المنخرطين فيه الاستعدادات والقابليات للتعاطي مع الخصوصيات والتنوعات التي يوفرها ذاك المجال، لكون هذه الخصوصيات والتنوعات تضمن للتربية مسيرة ناهضة ومتوازنة؛ في حين أن إغفال أو استبعاد أو اجتثاث أية مبادرة خصوصية من المحفل الإنساني كفيل بانخرام تلك المسيرة؛ إذ يتجلى في هذا الدعم المستحق للخصوصيات حرص مسلك التربية على استمرارية التنوع؛ لكونه يشكل عماد التطور الحضاري.
من ثم، يظهر أن التمكين يُحصِّن الإنسانية من الوقوع في إعاقات حضارية تُفقدها توازنها، كما يُحصِّن المجتمعات المستبعَدة أو المستعبَدة من أن تفقد ثقتها بإمكانياتها وقدراتها على الفعل والتحول.
وهذا، بالذات، ما يمنح التمكين الحضاري مشروعية وموضوعية على الصعيدين الإنسانيين: العمومي والخصوصي، نظرا لكونه ضرورة حيوية لكل منهما؛ لذلك يتعين على كل من يشغله هَمُّ هذه الضرورة ورعايتها ــــ وفي مقدمتهم المنتـمون لمسـلك التربية ــــ أن يعوا حق الوعي اللحظة التاريخية بمقتضياتها العلمية، وخصائصها المنهجية، ونظامها القيمي واحتياجاتها الفعلية.
ويُتوَّج هذا البناء التنظيري الذي رسمت أساسه عناصر المنظومة ومقاطعها والعلاقات التفاعلية فيما بينها بتنزيله على أرض الواقع في نظام تربوي يحقق كل هذه العناصر بمعانيها وتفاعلاتها المرسومة، واضعا صدقيته على المحك. وعلى هذا، فإن المشروع يتعاطى مع مفهوم النظام التربوي بوصفه: “بناء اجتماعيا ذا دلالة حضارية يجمع منهجيا بين مقتضيات الثبات فيه ولوازم التطوير المدروس لِما يعتمل في الواقع المؤسسي والمجتمعي من تحولات وما تقتضيه تلك التحولات من مراجعات وتعديلات مستمرة ومتواصلة“. وحتى يضمن المشروع لنفسه تجسيدا ناجحا في الواقع العملي، تصورا وفكرا ومناهج، ويضمن ترسيخه فيه وترقيته وتوسيعه، فإنه لا يفتأ يمارس متابعة يقظة نقدية تطويرية لمجمل أجزائه، ولما يتحقق من نسق تلك الأجزاء ومضمونها.