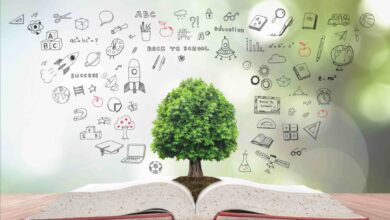08- موقع منظومة القيم في بناء نظام تربوي أصيل
موقع منظومة القيم في بناء نظام تربوي أصيل
بحث مقدم لصالح مشروع إحياء نظام تربوي أصيل
إعداد
الأستاذ: عبد السلام محمد الأحمر
أنجز في:
20 محرم 1431 هـ / 06 يناير 2010م
جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمشروع
ومسجلة رسميـًا ومحمية بموجب القانون
خطة البحث
- توطئة.
من المعلوم في علم النفس أن الإنسان يتأثر فكرا ووجدانا وسلوكا إلى أبعد الحدود بما يحبه وما يكرهه، وبما يكتسب في نفسه قيمة مادية أو معنوية مرتفعة أو متدنية، فينشأ تبعا لتقدير تصرف ما ارتضاء فعله أو تركه، وكلما ازدادت قيمة أمر من الأمور في النفس، ازداد تعلقها به واستحكم حرصها عليه.
من هنا ندرك كيف يمكن أن تتأسس نظرتنا للسلوك البشري انطلاقا من اعتبار العلاقة الثابتة بين فهم قيم الأشياء وتغيير السلوك تجاهها وعن طريقها. فهذه العلاقة تبدو تحصيل حاصل، لكنها هي ما يمكن أن تكون مدخلا طبيعيا وواضحا لدراسة ما أصبح يسمى اليوم بالقيم، والتربية على أساسها.
فموضوع القيم يكتسي اليوم أهمية كبرى، ليس في التربية المدرسية فحسب وإنما في كل وسائل التثقيف والتنشئة الأسرية والاجتماعية، فهي منطلق كل تغيير يرام إحداثه في أعماق النفس، وأغوار الفكر ودوافع السلوك، إذ منظومة القيم شأنها أن توجه الإنسان في دروب الحياة وتصنع له اختياراته كلها، وترسي عقيدته وأخلاقه، بحيث تظل جميع إنجازاته محكومة بما تنطوي عليه من سواء وصواب، ومن حيوية وثبات أو عوج وقصور.
وإذا كانت الأديان السماوية مصدرا غنيا للقيم السامية، فإن الإسلام خاتمها هوا لجامع لما تفرق فيها، والشاهد على ما يستجد في واقع الإنسانية من قيم؛ لها صلة معينة بالمعتقدات أو باختيارات بشرية محضة[1].
وكما لا يخفى أن أهم أبعاد القيم الإسلامية هو البعد الإيماني، الذي تنشأ عنه جميع القيم التي بشر بها الإسلام ودعا إليها، وأدار حولها مختلف التكاليف والممارسات من كل صنف.
ومن هذا المنطلق نتبين أساسية القيم في بناء مشروع تربوي أصيل، يستعيد لأجيالنا السمات الإسلامية الضائعة ويصبغ أخلاقهم بروح الحركية والفاعلية، ويكسبهم الكفاءات العالية في المبادرة والإنجاز.
2 – إشكالية البحث.
غير خاف أن الأمة الإسلامية حازت إرث النبوة، المشتمل على بيان مفصل لعطاءات الإيمان بالله واليوم الآخر، والتي بها تجلب مصالح البشر وخيرهم وسعادتهم وبها تدرأ المفاسد والشرور والشقاء في الدنيا والآخرة، فالرسل عليهم السلام بعثوا لأقوامهم مبشرين بنعيم الجنة الخالد ومنذرين لهم من نار جهنم المقيم، ووعدوهم بالعزة والكرامة والتمكين في الأرض، فهم بذلك قد حددوا أساسا ثابتا للقيم الإيمانية، بالتركيز على نتائج الانخراط في الدين والإيمان بحقائقه التي تنشأ عنها إرادة الصلاح والإصلاح، والتزام الاستقامة على الحق وحب الفضائل والأخلاق السامية، والنهوض بأعباء الاستخلاف في الأرض.
لكن الأمة الإسلامية اليوم تواجه واقعا مأزوما، تلاشت فيه المعاني الإيمانية، وشاعت به السلوكات المنحرفة، واختفت القيم الرفيعة عن الممارسات الشخصية والجماعية، رغم حضورها النسبي في المقررات الدراسية، والخطابات الدينية والسياسية، فصار لنا حال يصدق عليه قول الشاعر:
كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهرها محمول !
فما نحتاجه للخروج من حالة الأزمة ورثناه عن سيد الأنام محمد بن عبد الله ﷺ وهو الإيمان بالله ونهجه في الحياة، الذي يشكل منظومة قيم خالدة صالحة لكل زمان ومكان، وقادرة على تحريكنا بقوة نحو الكمال الروحي والرقي المادي والإنجاز الحضاري المتميز.
وهذه القيم الإيمانية متوافرة في القرآن والسنة وسيرة نبينا ومن سبقه من الأنبياء وفي سير سلفنا الصالح من الصحابة الأجلاء والتابعين لهم ومن تبعهم من العلماء الصالحين والقادة المصلحين على امتداد تاريخنا الإسلامي. مما يضعنا أمام إشكالية كبيرة تفرض علينا البحث لها عن حل يخرج الأمة من حالة التردي الأخلاقي والاضطراب القيمي والتدني السلوكي وانطفاء الفاعلية وتراجع القدرة الإنجازية!
فأمام الأصالة الشرعية للقيم الإسلامية وتميزها باكتساب أعلى تقدير وأرسخ تعلق في النفس الإنسانية، وما يلاحظ من مظاهر الفشل في تمثلها على مستوى الفكر والوجدان وخاصة السلوك، نجد أنفسنا في مواجهة الفرضية التالية:
تحتاج التربية على القيم -لتحتل موقعا متميزا- في النظرية التربوية الإسلامية إلى بناء منظومة القيم على أسس علمية تضمن تجدد فاعليتها في الواقع المعاصر.
3 – الفكرة المحورية للبحث.
يسعى البحث إلى تأكيد أساسية التربية على القيم في بناء تربية أصيلة وفعالة ومنفتحة على العصر وذلك من خلال ما يلي:
- تأصيل مفهوم القيم.
وذلك بتفسير طريقة الوحي في تأسيس مكونات السلوك الديني انطلاقا من تحديد مدى صوابه أو خطئه، وإبراز ما ينجم عنه من منافع أو أضرار في الحياة الدنيا العاجلة، والإخبار بما يترتب عليه من ثواب أو عقاب في الحياة الأخرى الآجلة، وبالتالي تخصيصه بالقيمة التي يستحقها في النفس، واتخاذ قرار بحبه وتقديره أو بغضه واستقباحه، قبل الانخراط في الالتزام بفعله أو اجتنابه.
- تحديد قواعد علمية لبناء منظومة القيم.
يتجه البحث إلى الكشف عن الخلل في التربية على القيم، والكامن في تقديم القيم داخل المدرسة كما هو الشأن خارجها في رحاب المجتمع بطريقة ارتجالية تسوي بين جميع القيم، على ما يوجد بينها من التفاوت الكبير، من حيث اتساع علاقاتها بغيرها، وترتيبها في أولويات التوظيف التربوي، مما يدخل في صلب البناء المنظومي والذي تتميز فيه القيم بخصائص معينة، وترتبط فيما بينها بعلاقات مختلفة تتضافر من خلالها لتحقيق غايات ومقاصد تربوية معلومة.
وهكذا يقترح البحث تصورا إبداعيا لتنظيم عناصر منظومة القيم على أسس منهجية تتوخى تصنيف القيم إلى أصلية أو أساسية وفرعية وثابتة ومتحولة وقيم شاملة، وتحديد نماذج للعلاقات الرابطة بين هذه الأصناف، وانتظام قيم المنظومة في اتجاه قيمي معين.
وسيعمل على توظيف ديناميكية التركيز على اتجاه قيمي عام للمنظومة يتجسد في قيمة شاملة، تتوفر لها ميزات الفعالية القصوى والامتداد الواسع عبر جل القيم والارتباط بجميعها بعلاقة معينة، وامتلاكها القدرة على الحضور اليومي في السلوك الفردي والجماعي.
- اختيار مبدأ الاستخلاف اتجاها قيميا عاما للمنظومة.
انطلاقا من كون السبب الرئيسي لفشل منظومة القيم في تربيتنا رغم انبثاقها عن مصدري الوحي الكتاب والسنة، هو اتساع مجال القيم الإسلامية وغياب خيط يربط بينها ويجعلها تدور كلها حول قيمة مركزية واحدة. والتي اختار البحث افتراضا أن تكون هي الأمانة ، لأنها تملك خاصية الشمول والعموم إلى جانب تجذرها في العقيدة الإيمانية، وقدرتها على تحقيق تعبئة فردية واجتماعية دائمة ومتزايدة للنهوض بكل الأعباء السلوكية والتعميرية.
4- محاور البحث.
خطة البحث
- توطئة.
- إشكالية البحث.
- الفكرة المحورية.
- بنية البحث.
- مصطلحات ومفاهيم البحث الأساسية.
- الحاجة للبحث.
- علاقة البحث بالمشروع.
- منهجية البحث وأدواته.
- الدراسات السابقة.
- الإضافة النوعية للبحث.
صلب البحث
المبحث الأول: طبيعة القيم وخصائصها.
أولا: طبيعة القيم.
1 – الأساس الثقافي والاعتقادي لتكون القيم.
2- البعد الفردي في التفاعل مع القيم.
ثانيا– أهم خصائص القيم.
1 – الأصالة.
2- الثبات والتحول.
3- التكاملية.
4- الفاعلية.
ثالثا: خصوصيات منظومة القيم الإسلامية.
1 – الأساس العقدي للقيم الإسلامية.
أ – أثر الإيمان في تشكيل القيم الإسلامية.
ب – دور الوجدان في ترسيخ القيم الإسلامية.
2 – البعد الاستخلافي للقيم الإسلامية
أ – حقيقة الاستخلاف في الأرض.
ب – القيم الاستخلافية الأساسية.
ج – المعاني الاستخلافية في القيم الإسلامية.
المبحث الثاني: العناصر الأساسية لمنظومة القيم.
أولا- العوامل الفاعلة في بناء منظومة القيم.
1– استخلاص الاتجاه القيمي العام لمنظومة القيم المفترض تحقيقها للريادة
التربوية عبر حقب التاريخ الإسلامي.
2 – ما يلزم اعتباره من أوضاع المجتمع وتحدياته وطموحاته في اختيار
القيم الموجهة للمنظومة.
3 – ما يتعين استحضاره من أحوال النشء وقدراته وحاجاته المعرفية
والوجدانية والمهارية.
4- تحديد اتجاه منظومة القيم الأصيلة المحققة للتجديد التربوي والإقلاع
الحضاري المنشود.
ثانيا: القيمة الشاملة المحددة للاتجاه القيمي للمنظومة.
- اختيار القيم الأصلية المجسدة للاتجاه الأصيل للمنظومة.
- تحديد العلاقة الموجودة بين هذه القيم.
- بحث إمكانية دمجها في قيمة شاملة.
- استعراض سلبيات وإيجابيات منهج القيمة الواحدة المشكلة لاتجاه المنظومة.
- حاجة التربية إلى تركيز.
- الفوائد التربوية لهذا المنهج.
- القيمة الشاملة المقترحة لتجسيد وحدة اتجاه منظومة القيم الأصيلة.
- أن تكون القيمة الشاملة مجسدة للاتجاه القيمي للمنظومة.
- أن تكون القيمة الشاملة ذات وظيفية واسعة.
ج-نموذج المنظومة الاستخلافية.
المبحث الثالث: آليات إدماج القيم في النظام التربوي الأصيل المنشود.
- توضيح المسوغات التربوية للاتجاه القيمي ضمن التوجهات العامة المفسرة
لفلسفة النظرية التربوية المعتمدة.
2 – المنهج العام لتعليم القيم وتعزيزها.
- دمج القيم في المواد الدراسية.
- دور مشروع المؤسسة في التربية على القيم.
ج- الأنشطة التعلمية وتدريس القيم.
3 – إجراءات منهجية في درس القيم.
- المدخل الإشكالي.
- المحتوى الأساسي لانطلاق التعلمات.
ج- نشاط تعلمي لتحديد القيمة.
د- نشاط تعلمي لتحديد مكانة القيمة في الإسلام.
ﻫ- نشاط تعلمي لتحديد المردودية العملية للقيمة.
و- نشاط تعلمي للتعبير الكتابي.
ز- نشاط تعلمي حول مصادقة الفصل على القيمة.
خاتمة:
- مصطلحات ومفاهيم البحث الأساسية.
- القيم
استعمل لفظ قيمة أولا للدلالة على الثمن جاء في المصباح المنير: “القيمة هي الثمن الذي يُقَاوَمُ به المتاع أي يَقُومُ مَقَامَهُ و جمعه القِيَمُ.”[2] وأورد المعجم الوسيط: “القيمة:قيمة الشيء: قدره. وقيمة المتاع:ثمنه. وقيمة من الإنسان:طوله..ويقال ما لفلان قيمة:ماله ثبات ودوام على الأمر.”[3] كما أن القيمة هي صفة في شيء تجعله موضع تقدير واحترام وتجعل ذلك الشيء مطلوباً ومرغوباً فيه.
ثم اتسع نطاق الاستعمال ليشمل المعنويات من مبادئ ومعتقدات وأخلاق فصارت القيمة هي: “الصفة التي تجعل من الشيء أمرا مرغوبا فيه مطلوبا في المجتمع، وهي مثل عليا وانفعالات من الإنسان نحو غايات يصنعها بحرية.”[4]
ولقد ركزت جل التعاريف على البعد الذاتي في تكون القيم الفردية والمجتمعية، وبينت أنها “تقدير نقوم به تجاه شخص أو فرد أو نشاط حسب ما يمكن تحصيله منه. وتتكون القيم من مجموع معتقدات واختيارات وأفكار تمثل أسلوب تصرف الشخص ومواقفه وآراءه وتحدد مدى ارتباطه بجماعته، وتشكل مجموع القيم النظرة إلى العالم”[5] .
فالقيم إذن عبارة عن الأحكام التي يصدرها الفرد بالتفضيل لأشياء أو سلوك، ويكون لحكمه هذا طابع ذاتي اختياري لكونه ناتجا عن حب قلبي، لا إكراه فيه لعامل خارج الذات، ويرقى إلى درجة الاعتقاد الراسخ الذي يملي على صاحبه مواقف وسلوكات وأخلاقا معينة. فهي تشمل كل ما يحتل مكانة عالية في النفس ويحظى بحبها وتقديرها ويدوم تقديسها له واعتزازها به؛ مثل الدين عقيدة وعبادة وأخلاقا، وكل ما يمت له بصلة من آداب ومقاصد ورموز وعلوم، وكذا عادات المجتمع وتقاليده ونظمه العامة، التي اكتسبت مع الأيام قيمة معنوية، وصار لها تأثير في الفكر والوجدان والسلوك بكيفية أو بأخرى.
فللنسب مثلا عند الأشراف قيمة عالية ، وللحكمة عند العٌلماء قيمة عظيمة، وللشجاعة عند الأمراء قيمة كبيرة، وهلم جرا.
وبهذا يتأكد كون القيم فوق كل هذا التزاما شخصيا بتقدير خاص وعميق لمبدأ أو اعتقاد، تنتج عنه أفكار وتوجهات واختيارات وانفعالات وعواطف جياشة وأخلاق ثابتة، وهذه القيم تتبلور في النفس عن طريق التربية والتعليم والتنشئة داخل البيئة الاجتماعية.
ب- المنظومة
المنظومة هي مجموعة من المركبات و الأجزاء التي تعتمد في عملها على بعضها طبقاً لتخطيط محدد يساعدها للوصول إلى أهداف محددة بعينها .
ومن أهم خصائص المنظومة:
1 – يتم تصميم وبناء المنظومة لتحقيق هدف أو أهداف معينة .
2 – ارتباط و اعتماد المكونات و الوظائف للمنظومة يكون واضحا و ظاهرا .
3 – للمنظومة هدف أو مجموعة من الأهداف المحددة مسبقاً .
4 – المنظومة الواحدة يمكن التعامل معها بأكثر من ترتيب لعناصرها “لمكوناتها”.
5 – أن لا يكون هنالك أي تعارض بين أهداف أي مكون من مكونات المنظومة والهدف الرئيسي، أي أن يبقى الهدف المحدد للمنظومة له الأولوية الأولى دائماً .
والمنظومة قد تضم بداخلها عددا من المنظومات الفرعية، كما أن كل منظومة فرعية من الممكن أن تتكون من منظومات فرعية داخلية لها نفس خصائص و قواعد المنظومة و تتفاعل مع المنظومات الفرعية الأخرى.
ج- الاستخلاف.
عرفت لفظة الاستخلاف توسعا في الدلالة على مر الزمان، فمنذ نزول القرآن مخبرا باستخلاف الله للإنسان إلى اليوم تدرج استعمالها بين عدة معانى نستعرضها هنا بشيء من التوضيح. فالآية التي أصلت لمفهوم الاستخلاف، تحدثت عن جعل الإنسان خليفة في الأرض:{وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (البقرة:30). وتطرح كلمة خليفة في هذا السياق بعض الإشكال، لأن “الخليفة ذات قائم بما يقوم به المستخلف على حسب رتبة ذلك الخليفة منه.”[6] والإنسان لا يمكن أن يخلف الله في شيء وظل هذا الفهم مستبعدا لما يؤدي إليه من معنى مخل بما يلزم في حق الله من الاعتقاد بأنه ليس كمثله شيء. فاتجهت التفاسير إلى بعض التأويلات التي تنأى عن ظاهر اللفظة وما قد تعنيه داخل السياق مما لا يليق، وكان مما فسر به “خليفة” “قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل… [أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس فيما يقع بينهم من المظالم ويرد عنهم المحارم والمآثم، قاله القرطبي] “[7] كما نجد محاولة استعمال “خليفة الله” على عهد الصحابة رضي الله عنهم تواجه بعدم القبول في أول الأمر ، فقد قيل لأبي بكر -رضي الله عنه- يا خليفة الله فقال بل خليفة محمد ﷺ وأنا أرضى به[8] وبعد ذلك استعمل هذا الوصف دون اعتراض، فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال : “ولينا أبو بكر فكان خير خليفة الله و أرحمه بنا و أحناه علينا.” [9]
أما لفظة استخلف فغلب على استعمالها تولية العهد من خليفة لمن يأتي بعده، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل لعمر ألا تستخلف؟ قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله ﷺ [10]. كما استعمل الاستخلاف في الصلاة ومعناه “جواز الاستخلاف في الصلاة إذا أحدث الإمام أو منعه من تمام صلاته مانع.”[11] ومن الذين استعملوا مصطلح الاستخلاف في علاقة مع الخلافة الإنسانية ابن قيم الجوزية في بعض كتبه، التي ورد بها: “وقوله تعالى: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم} (النور: 55) ومعلوم أن كيفية الاستخلاف مختلفة وأن ما لهذه الأمة أكمل مما لغيرهم.”[12] وفي كتاب آخر ذكر ما يلي: “فإنه سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم في الأرض كما أخبر سبحانه في كتابه بقوله: إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: ويستخلفكم في الأرض. فأراد سبحانه أن ينقله وذريته من هذا الاستخلاف إلى توريثه جنة الخلد.”[13] وهذا الاستعمال لم يتجاوز المستوى الصرفي من الفعل إلى المصدر. كما وردت لفظة الاستخلاف في تفسير ابن عطية الأندلسي وهو يفسر استغراب الملائكة من إسناد الخلافة لآدم، “قال القاضي أبو محمد فهذا إما على طريق التعجب من استخلاف الله من يعصيه أو من عصيان من يستخلفه الله في أرضه وينعم عليه بذلك وإما على طريق الاستعظام والإكبار للفعلين جميعا الاستخلاف والعصيان”[14]
ولم نصادف توسعا كبيرا في التوظيف والدلالة إلا في القرن العشرين، فقد أورد الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى:{قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ}(الأعراف:129) ” والمراد بالاستخلاف: الاستخلاف عن الله في مُلك الأرض. والاستخلاف إقامة الخليفة ، فالسين والتاء لتأكيد الفعل مثل استجاب له ، أي جعلهم أحراراً غالبين ومؤسسين ملكاً في الأرض المقدسة.”[15] وأثناء تفسيره قوله تعالى:{وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا}قال:” وصاحب هذا الوصف هو الجدير بالاستخلاف في العالم لأن وظيفة هذا الاستخلاف تدبير وإرشاد وهدى ووضع الأشياء مواضعها دون احتياج إلى التوقيف في غالب التصرفات، وكل ذلك محتاج إلى القوة الناطقة أو فروعها.”[16] ولم يعد الحديث عن الاستخلاف رهين الكلام عن آيات الاستخلاف بل تجاوزه ليكون روحا عامة تفهم في إطارها مهام الإنسان وتكاليف الدين المذكورة في القرآن حيث قال الشعراوي في تفسيره:” فالتعاون أمر ضروري للاستخلاف في الحياة . ومادام الاستخلاف في الحياة يقتضي من الإنسان عمارة هذه الحياة، وعمارة الحياة تقتضي ألا نفسد الشيء الصالح بل نزيده صلاحاً، وحين يقول الحق : {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} أي أنه يريد كوناً عامراً لا كوناً خرباً . والشيء الصالح في ذاته يبقيه على صلاحه. إذن فعمارة الحياة تتطلب منا أن نتعاون على الخير لا على الإثم.”[17]وكما هو واضح من هذا المقطع فقد تواصل استعمال مبدأ الاستخلاف باعتباره عقدا وعهدا مع الله والأمانة التي تتفرع عنها كل المسؤوليات الإنسانية في الحياة ورعاية ما يصلحها ودرء ما يفسدها، ونجد هذا الاتجاه أكثر بروزا لدى سيد قطب في تفسيره حيث أورد عند تفسير الآية:{كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ}(الحشر:7).
“وفرض عليهم قيوداً في تنمية المال لا تجعلهم يسلكون إليها سبلاً تؤذي ضمير الفرد وخلقه، أو تؤذي حياة الجماعة وكيانها . وأقام هذا كله على أساس التصور الممثل لحقيقة الواقع في هذا الوجود؛ وعلى أساس عهد الاستخلاف الذي يحكم كل تصرفات الإنسان المستخلف في هذا الملك العريض.”[18] فالذي استقر عليه مفهوم الاستخلاف من المنظور الإسلامي هو أنه منهج شامل لوظيفة الإنسان على الأرض يمارسها بحرية تضبطها المسؤولية أمام الله كما يتراءى ذلك في كلام الدعاة والمفكرين الإسلاميين المعاصرين، منها قول أحدهم “وفي مجال الاستخلاف في الأرض: فالإنسان مأمور أن يسعى في الأرض لإصلاحها وإقامة الحق والعدل فيها، ويسعى في مصالح نفسه ومجتمعه، كل ذلك وفق شريعة الله.”[19]
ويرى آخر أن من صفات القائد المسلم “الاستخلاف: فهدفه عمران الأرض وهمه أن يسهم في تأدية المهمة التي وكل الله الإنسان بها حين قال: (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً)”.[20]
فمصطلح الاستخلاف عرف كل هذه التطورات، ليستقر عند هذا المعنى النهضوي الشامل الذي من شأنه إغناء رؤيتها لدينها وواقعها وتجديد تدينها ومهمتها الإعمارية بين الأمم.
إن المعنى الظاهر لكلمة أمانة هو ما يسمى في الفقه الوديعة وهي:” أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدا”[21] فالمعنى المقصود في هذه الحالة هو الوفاء وعدم الجحود.
وجاء في أساس البلاغة: “أمنته وآمننيه غيري، وهو في أمن منه وأمنة، وهو مؤتمن على كذا. وقد ائتمنته عليه. ” فليؤد الذي أؤتمن أمانته “. وبلغه مأمنه. واستأمن الحربي: استجار ودخل دار الإسلام مستأمناً. وهؤلاء قوم مستأمنة. ويقول الأمير للخائف: لك الأمان أي قد آمنتك. وفلان أمنة أي يأمن كل أحد ويثق به، ويأمنه الناس.”[22]
فإعطاء الأمن لشخص معنى آخر من دلالات الأمانة. والمأمون الذي يأمنه الناس على أموالهم وأعراضهم فهو أمين متصف بالأمانة، ففي الحديث:” و الله لا يؤمن و الله لا يؤمن و الله لا يؤمن قالوا: و ما ذاك يا رسول الله؟ قال : جار لا يأمن جاره بوائقه قالوا : فما بوائقه يا رسول الله ؟ قال : شره”[23]
وتتعدد معاني الأمانة بحسب السياق من ذلك ما جاء في القاموس المحيط: “والأَمانَةُ والأَمَنَةُ: ضِدُّ الخِيانَةِ. وما أحْسَنَ أمْنَكَ ويُحَرَّكُ: دينَكَ وخُلُقَكَ. وآمَنَ به إيماناً: صَدَّقَهُ. والايمانُ: الثِّقَةُ وإظْهارُ الخُضوعِ وقَبولُ الشَّريعَةِ.. وما أَمِنَ أن يَجِدَ صَحابَةً: ما وَثِقَ أو ما كادَ.”[24]
ومن المجاز: فرس أمين القوى، وناقة أمون: قوية مأمون فتورها، وأعطيت فلاناً من آمن مالي أي من أعزه عليّ وأنفسه[25].
ومن الأمثال العربية: “من استرعى الذئب فقد ظلم” فمن استرعى الذئب فقد وضع الأمانة في غير موضعها، وهو ظلم.[26]
إذ من الأمانة إسناد الأمر لمن يتقنه ويحفظه. والأمانة مضنة التحمل والصبر والبذل والتضحية وذلك ما يجعل القيام بها شاقا على النفس، كما في الحديث:” لن تزال أمتي على الفطرة ما لم يجدوا الأمانة مغنما والزكاة مغرما”[27]
والأمانة الوفاء بالالتزام: “قلدته الأمانة أي ألزمته إياها فلزمته لزوم القلادة للعنق، ثم قالوا طوقته الأمانة لان الطوق مثل القلادة”[28]
ولقد أخذت الأمانة في منظور الإسلام بعدا شاملا لما كلف الله به الإنسان من شرع، وما تضمنه من مهام ومسؤوليات متعددة: )إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ( (الأحزاب:72).
وعن ابن عباس، الأمانة: الفرائض، عرضها الله على السموات والأرض والجبال، إن أدوها أثابهم. وإن ضيعوها عذبهم[29] .
وقال آخرون: هي الطاعة.
قال أبي بن كعب: من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها. وقال قتادة: الأمانة: الدين والفرائض والحدود.
وقال بعضهم: الغسل من الجنابة. وعن زيد بن أسلم قال: الأمانة ثلاثة: الصلاة، والصوم، والاغتسال من الجنابة.
وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف، وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، وهو أنه إن قام بذلك أثيب، وإن تركها عُوقِبَ، فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه، إلا مَنْ وفق اللَّهُ، وبالله المستعان.[30]
و إنَّا عَرَضْنا الأمَانَةَ أي: الفَرائِضَ المَفْروضَةَ أو النِّيَّةَ التي يَعتَقِدُها فيما يُظْهِرُه باللسانِ من الإيمان ويُؤَدِّيهِ من جَميع الفَرائِض في الظاهِرِ لأنَّ الله تعالى ائْتَمَنَهُ عليها ولم يُظْهِرْها لأحَدٍ من خَلْقِه . فَمَنْ أضْمَرَ من التَّوْحيدِ مِثْلَ ما أظْهَرَ فقد أدَّى الأمانَةَ.[31] وقال الزجاج: معنى يحملنها يخنها والأمانة هنا الفرائض التي افترضها الله على آدم والطاعة والمعصية.[32] فالطاعة أمانة من حيث طلب فعلها والمعصية أمانة من حيث طلب تركها. ومن الأمانة كتمان الأسرار الزوجية:” إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا”[33].
وكل ما طلب الشرع فعله وامتدحه وأزجل أجره أو نهى عنه وذمه وتحدث عن سوء عاقبته فهو داخل في دائرة الأمانة التي يجب أداؤها وتقدير قدرها، وقد َرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ اصْفَرَّ لَوْنُهُ مَرَّةً وَاحْمَرَّ أُخْرَى فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَتَتْنِي الْأَمَانَةُ الَّتِي عُرِضَتْ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلْتهَا أَنَا فَلَا أَدْرِي أَأُسِيءُ فِيهَا أَمْ أُحْسِنُ.”[34]
ويعتبر كل عمل أمانة وأعظمه عمل القلب من إيمان وتصديق وإخلاص وخشية ونية وصبر وشكر … و “أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة.”[35] فهي ما فطرت عليه القلوب من أعمال الإيمان التي ذكر بها القرآن والسنة. وهي أيضا طهارة القلب مما نهى الله عنه،” وأما الأمانة فهي الطهارة باطنا عن الفسق والكبائر والإصرار على الصغائر.”[36]
كما أن استعمال الحواس والجوارح أمانة قال تعالى:)يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ( (غافر:19) أي يعلم الله تعالى ما تختلسه الأعين من نظرات محرمة، حيث “يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء، جليلها وحقيرها ، صغيرها وكبيرها، دقيقها ولطيفها؛ ليحذر الناس علمه فيهم، فيستحيوا من الله حَقّ الحياء، ويَتَّقُوهُ حق تقواه، ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة، ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر”[37].
وقال تعالى عن أمانة اللسان:) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ( (ق:18) وقال سبحانه:) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا( (الإسراء/36) وكل ما يسأل عنه ويحاسب عليه فهو أمانة.
كما أن الحرف والصناعات أمانات في عنق من يزاولها، وفي هذا الصدد يقول أبو حامد الغزالي:” لا ينبغي أن يخاض مع العوام في حقائق العلوم الدقيقة، بل يقتصر معهم على تعليم العبادات وتعليم الأمانة في الصناعات التي هم بصددها ويملأ قلوبهم من الرغبة والرهبة في الجنة والنار كما نطق به القرآن”[38]
وكل الأمانات التي كلف الإنسان بحملها تفرعت عن الأمانة الكبرى أمانة الاستخلاف الشاملة في النفس والدين والأرض،” والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى.. الأمانة التي ناط الله بها فطرة الإنسان؛ والتي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها «الإنسان».. أمانة الهداية والمعرفة والإيمان بالله عن قصد، وإرادة، وجهد، واتجاه. فهذه أمانة الفطرة الإنسانية خاصة. فكل ما عدا الإنسان ألهمه ربه الإيمان به، والاهتداء إليه، ومعرفته، وعبادته، وطاعته . وألزمه طاعة ناموسه بغير جهد منه ولا قصد ولا إرادة ولا اتجاه. والإنسان وحده هو الذي وكل إلى فطرته، وإلى عقله، وإلى معرفته، وإلى إرادته ، وإلى اتجاهه ، وإلى جهده الذي يبذله للوصول إلى الله ، بعون من الله : {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} وهذه أمانة حملها وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من الأمانات.”[39] فالحرية التي خصص بها الإنسان، والقدرة التي يمتلك بها تحمل المسؤولية عن نفسه وغيره من أشياء الكون هي حقيقة الأمانة التي بموجبها صار مستخلفا في الأرض يصلح فيها أو يفسد ثم يحاسب ويجازى.
6– الحاجة للبحث.
لا يمكن بناء مشروع تربوي إسلامي دون اعتماد خطة محكمة وواضحة، تبين كيفية تعامله مع منظومة القيم الإسلامية الخالدة، التي من مهام أي تربية أصيلة العمل على ترسيخها في نفوس النشء، والسعي بكل وسيلة متاحة للحفاظ عليها وجعلها حية فاعلة في فكرهم ووجدانهم، ومترجمة على مستوى تحديد سلوكهم وبناء مواقفهم تجاه متغيرات الحياة ومعضلاتها وتحدياتها المتزايدة.
ومعلوم أن العصر الحديث يعرف تجاذبا قويا بين قيم الروح وقيم المادة، بين القيم المستمدة من الوحي المعصوم وبين القيم التي يبنيها البشر ويعلون من شأنها في واقعهم، ويحمونها بقوة القانون ويروجون لها في الثقافة والإعلام، الأمر الذي يستدعي أن تضطلع التربية الإسلامية بدور التحصين ضد القيم المجافية لقيم الإسلام الربانية، والتي يلزم تقديمها بمنهجية صحيحة وفعالة تحمل على الاعتزاز بها والاحتكام إلى مقتضياتها الوجدانية والسلوكية إلى جانب الانفتاح على القيم الإيجابية المعاصرة والتي تنسجم مع روح الإسلام بشكل واضح لا شبهة فيه.
7- علاقة البحث بالمشروع.
يعرف العصر الحديث اهتماما متزايدا بموضوع القيم والتربية على أساسها، نظرا لكونها تجسد اتجاه التربية الحديثة، الذي يسعى إلى جعل التربية مسؤولية المتعلم، يضطلع بالدور الأول في جميع مراحلها، وإليه وحده يعود مدى الاستفادة من وسائلها وجميع معطياتها، فقد اتضح أن القيم حكم ذاتي بالإيجاب والقبول بل والتعلق الوجداني العميق بمبدأ أو فكرة أو سلوك، مما ييسر على النفس تمثله على نحو أفضل وأتم، والاحتكام إليه في صياغة تصوراتها وتحديد مواقفها من القضايا الحياتية التي تواجهها بما يعزز استقلاليتها ويؤكد خصوصياتها الشخصية.
من هنا تتأكد ضرورة إيلاء عناية خاصة لموقع القيم في بناء أي مشروع تربوي حديث، أما عندما يتعلق الأمر بمشروع تربوي أصيل يروم إعادة تأسيس النظام التربوي على القيم الإسلامية، فإن الحاجة إلى توظيف القيم تغدو أكثر إلحاحا، لاسيما ما يتعلق بموقع منظومة القيم في بناء نظرية تربوية أصيلة، اعتبارا لتجذر القيم في هذا النوع من التربية، وتزايد مظاهر أزمة القيم لدي الأجيال المعاصرة.
وهذا ما يلزم أي مشروع تربوي أصيل، بالبحث عن كيفيات تفعيل منظومة القيم في النظرية الموجهة له، حتى يكون قادرا على صياغة تربية بديلة، وكفيلة بإخراج الأمة من دائرة التخلف والتبعية والوهن، وتنشئة الأجيال على التربية الاستخلافية.
8- منهجية البحث وأدواته.
ينطلق البحث في البداية من فرضية ترى اشتداد الحاجة إلى تصور جديد وإبداعي لمنظومة قيمية فعالة، يسهم في بناء نظرية تربوية أصيلة. ويتجه في بناء منظومة القيم على أساس وحدة الاتجاه القيمي للمنظومة والذي يضمن تماسك القيم المكونة لها، وييسر تحديد أنماط العلاقات التي تربط فيما بين مختلف المجموعات والأصناف على أساس تقارب المضامين والدلالات، متوسلا في سبيل ذلك بالمنهج الاستقرائي القائم على دقة ملاحظة مدى تردد معنى معين في القيم الفرعية المرتبطة بقيمة أصلية، ثم البحث عن القاسم المشترك بين القيم الأصلية لاقتراح القيم المرشحة لتمثيل القيمة الشاملة المستوعبة لجميع القيم الأصلية والفرعية على السواء على أساس مدى تواتر مضمون قيمي بدرجة أكثر من غيره في المضمون الإسلامي.
بعد ذلك يتواصل البحث لاستخلاص الاتجاه القيمي العام للمنظومة، والذي تدرس جميع قيمها في إطاره وتوجه توجيها لتحقيق غاياته، وترسيخ أخلاقه وروحه ومقاصده التربوية، وتحدد مختلف الأنشطة والممارسات الكفيلة بتثبيت قيم المنظومة وتعزيزها على الدوام.
وفي الأخير يجرى اختبار تطبيقي لعينة عشوائية من القيم للتأكد من مدى هيمنة كل من الاتجاه القيمي والقيمة الشاملة الممثلة له على جميع القيم الإسلامية والإنسانية.
الأول: قيمة القيم.
المهدي المنجرة. ط 1، 2007م، المغرب – بدون دار نشر.
يحاول الدكتور المنجرة عالم المستقبليات المسكون بهموم التفكير المستقبلي، أن ينبه إلى خطورة تجاهل العولمة لقيم مختلف دول العالم، التي تختلف ثقافتها وقيمها مع القيم الغربية السائدة في أمريكا وأوروبا.
فيرى أن “احترام قيم الآخرين شرط أساسي من أجل الوصول إلى فهم نسبية مفهوم “القيم الكونية” التي تمكن من تسهيل عملية التواصل الثقافي بين الشعوب” ويقدم تصوره للكونية التي يؤمن بها والتي صرح في كتابه هذا أنها مستوحاة من ثقافته الخاصة، فيؤكد أنه مع الكونية التي “تكون نتاج تداخل وتفاعل للاختلافات تلك التي يرتكز(لوغاريتمها) على العدالة والإنصاف المطبق بدون تمييز عرقي، أو عقائدي، أو جنسي، أو اجتماعي. أومن بكونية الجمال والحب كما نحس بها فرديا، أومن بكونية الإبداع والخلق حين نطلق لها العنان” ثم يواصل توضيح الكونية التي يؤمن بها، كونية الروحانية التي يتجاوز الإنسان نفسه من خلالها بكل حرية، وكونية البحث والدراسة وطلب العلم، والمصير المشترك للإنسانية.
فهو إذن يدعو إلى اعتماد قيمة شاملة تتسع لمختلف القيم الإنسانية وتسمح بالتفاعل الإيجابي بينها وتتوحد قضايا العالم ومصيره على أساسها، ويقول: “إن مستقبل الإنسانية سيكون رهينا بالثمن المخصص للحياة البشرية بدون أي تمييز؛ والاحترام المتبادل للقيم: روح البقاء البشري في ظل الكرامة. ومن ثم قيمة القيم.”
إن الكاتب ينطلق من مسلمة أن القيم كما وحدت بين الأفراد داخل كل شعب فهي قادرة على توحيد شعوب العالم، وكأني به يرى بأن الاتجاه القيمي للمنظومة القيمية العالمية هو “الاحترام المتبادل للقيم” التي اختلفت بين الناس. وبدون اتجاه قيمي عالمي موحد سيظل الاحتراب القيمي قائما وسيفضي لامحالة إلى نزاعات مسلحة تحدث الدمار المحقق.
الثاني: القيم الإسلامية في المنظومة التربوية – دراسة للقيم الإسلامية وآليات تعزيزها
د. خالد الصمدي ، منشورات منظمة الإيسسكو 1429ﻫ / 2008م.
حدد الدكتور خالد الصمدي الهدف من مؤلفه في القضايا التالية:
- تحديد مفهوم القيم الإسلامية.
- تحديد وحصر القيم الإسلامية من منظور تربوي.
- بيان الأسس النظرية للتربية على القيم.
- الخطوات العملية لتقويم القيم.
وضمن نماذج وتجارب من مشاريع التربية على القيم، يقدم لنا الخطوات العامة للمشروع السعودي، تحت عنوان: “القيم في مناهجنا” الغرض منه تتبع ورصد القيم الإسلامية في التعليم السعودي، وهو مشروع تقويمي يهدف إلى إبراز مدى حضور قيم التسامح والتعايش والحوار والوسطية والاعتدال في مختلف المواد الدراسية والأنشطة التعليمية.
ورغم أن هذا المشروع خاص بتقويم حضور القيم المذكور وتم تحويله فيما يبدو لخطة لتدريس القيم متوسطة المدى تمتد من 2002 إلى 2014، فإنه يمثل إلى حد كبير تجربة ثرية اشتملت على إجراءات منهجية ذات أهمية في مجال بناء مشاريع للتربية على القيم، وقد تمثلت فيما يلي:
- تحديد شعار للمشروع وهو طرف من آية قرآنية: “بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ” إحالة على سبع آيات قرآنية كلها تضمنت هذه العبارة في سياقات مختلفة تدعو إلى التسامح وتسعى لترسيخه منها قوله تعالى:{وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ}(فصلت:34).
فهذا الشعار بمثابة الاتجاه القيمي لمنظومة قيمية تتوخى رد الاعتبار إلى قيمة التسامح وغيرها من القيم الداعمة.
- وهذا الاتجاه القيمي المختزل في هذه العبارة القرآنية البليغة تجسده القيمة الشاملة التي هي التسامح والتي لها من صفة الشمول والعموم ما يجعلها قادرة على تأطير ليس فقط قيم الوسطية والاعتدال والتعايش والحوار، وإنما عدة قيم أخرى مثل العفو، الصبر، الحلم، العفة، كظم الغيظ، الورع، التقوى، سعة الصدر وغيرها كثير.
- ولقد تنبه المشروع إلى كون القيم لا يمكن التعويل في تعليمها وترسيخها على تعليم قيم متقاربة أو على الدروس النظرية فحسب، وإنما لابد من وسائل أخرى متنوعة، وقد حدد المشروع منها ما يلي: المسابقات الثقافية والفنية، الحوارات الطلابية، العروض المسرحية، الرحلات والمخيمات، الملتقيات العلمية من محاضرات وندوات، برنامج لرعاية السلوك وتقويمه، التوعية الأسرية لتكون مساعدة للعمل الصفي.
والنموذج الثاني للتربية على القيم هو مشروع “الوسيط في التربية على القيم الإسلامية” من إعداد المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية بالمدرسة العليا للأساتذة بمدينة تطوان بشمال المغرب والذي يشغل المؤلف موقع الرئاسة فيه.
والمشروع عبارة عن كتاب إلكتروني متعدد الوسائط، يشمل في تصوره العام تسعة مجالات للتربية على القيم الإسلامية مرتبطة بواقع وسلوك المتعلم، وهو نموذج لاستثمار تكنولوجيا الوسائط المتعددة، ومكوناته كما يلي:
- المحتوى العلمي ويشمل تسع وحدات قيمية نورد منها: وحدة القيم الاعتقادية، والتعبدية، الفكرية والمنهجية، الاجتماعية والأسرية، الصحية والوقائية، البيئية، الفنية والجمالية…
- البناء التربوي: يتدرج برنامج الوسيط في تقديم تعلماته التفاعلية عبر المراحل التالية:
- مرحلة التمهيد: ويطرح فيها موقف إشكالي يثير فضول التلاميذ للتعلم.
- مرحلة العرض: يكون فيه عرض معلومات حول الموضوع، مع ربطها بنصوص إسلامية مؤطرة.
- مرحلة الاستنتاج والربط: يساعد البرنامج التلاميذ على تحليل المعلومات المقدمة وربطها بالواقع.
- مرحلة دعم التعلمات: تكون منصبة على تعزيز المكتسبات من خلال أسئلة لها أجوبة متعددة يختار واحدة منها ولها تغذية راجعة سواء كان الجواب صحيحا أو خطأ.
- مرحلة التطبيق والتقويم: وهي مرحلة التدريب والتمرين على استثمار المكتسبات.
- مرحلة توسيع التعلمات: يقترح فيها مجموعة من الوثائق الداعمة للتعلمات إحصائيات وبيانات، مواقع إلكترونية…
ينطوي هذا المشروع على نقطتين إبداعيتين جديرتين بالاهتمام:
أولهما: تعديد مجالات تعليم القيم لتشمل جميع مجالات الحياة التي تهم السلوك البشري، فالقيم حافزة على الفعل المستجيب لها والمتماشي معها.
ثانيهما: اعتماد عنصر التنشيط والإثارة والتشويق، الذى يحبب للنفس الاندماج في الموضوع كلية والتفاعل معه من أعماق القلب، وهذا ما يضمن الانخراط العفوي في الأنشطة التعلمية وترسيخ القيم عن طريقها.
ويبدو أن مشروعا للتربية على القيم يستدمج إيجابيات كل من المشروعين السعودي والمغربي سيكون أنضج وأكمل.
الثالث: أسس ومهارات بناء القيم التربوية وتطبيقاتها في العملية التعليمية.
إبراهيم رمضان الديب.ط2 مؤسسة أم القرى للترجمة والتوزيع. (1427ﻫ/2007م).
يتميز هذا المؤلف بطابعه التطبيقي، فهو يقدم معلوماته في صورة جداول وترسيمات وأشكال مختلفة، مما يجعل قراءته سلسة ومضمونه واضحا ومشتملا على أفكار إبداعية جيدة. ولقد حصر الغاية من كتابه هذا في هدفين:
- توجيه الانتباه لخطورة الفراغ القيمي الذي نعيشه في ظل صراع حضاري وقيمي مفروض علينا من الخارج، وتوجيه الاهتمام نحو أهمية البناء القيمي كأساس للنهضة العربية والإسلامية المنشودة.
- تقديم منظومة قيمية شاملة يمكن الاعتماد عليها في مؤسساتنا في تكوين رؤية ورسالة ومهمة لهذه المؤسسات، وتقديم المادة القيمية الواجب تبنيها وتربية الأفراد والمجتمع والعمل بها لتحقيق النهضة المنشودة.
ومن الأمور التي أكدها في أكثر من مناسبة، هو أهمية الأنشطة التطبيقية في تعلم القيم، مشيرا إلى طغيان المضامين النظرية والسرد والإلقاء على طرق التربية والتعليم في الواقع الإسلامي.
وقد حصر ملامح المنهج العلمي العملي (النهضوي) في تناول برنامج القيم التربوية وهي: الواقعية- الموضوعية- العملية- التواصل- الابتكار. ثم فصل ذلك في النقاط التالية:
- الانطلاق من رؤية دقيقة منبثقة من التحديات التي تواجه واقعنا التربوي والتطلعات المجتمعية لتحقيق النهضة.
- الاعتماد على التمازج بين المعارف والمهارات والخبرات التراثية الإسلامية الأصيلة ووسائل التربية القيمية الحديثة في مجال بناء القيم التربوية.
- تحديد مراحل وخطوات منتظمة وعملية لسير البناء القيمي في نفس الطالب.
- استحداث سلسلة من الأنشطة والوسائل الابتكارية الحديثة المشوقة والجذابة المواكبة للعصر في عملية البناء القيمي للفرد والمجتمع.
وبخصوص بناء منظومة القيم، حدد مصادر القيم الإسلامية في الأمور الآتية: القرآن- السنة- الصحابة- القياس والاستحسان- المصالح المرسلة- الأعراف والتقاليد والثقافة الناتجة عن الحراك الاجتماعي بما لا يخالف الشرع.
ويقدم نموذج تطبيقي في جانب الحقوق والالتزامات لآلية البناء والتوظيف القيمي في منظومة التربية الإسلامية، على الشكل التالي:
الرسالة من الله عز وجل
ــ
– معتقدات من القرآن والسنة بالحساب على الحقوق والالتزامات
ـــــ
فكر إسلامي اقتصادي اجتماعي
ـــــــ
(قيم إسلامية البعث والحساب- حرمة الممتلكات- قيمة العمل- التكافل الاجتماعي)
ـــــــــ
(سلوكيات إسلامية: تسليم الحقوق لأصحابها- التمايز والتفوق بحسب العمل- حفظ كرامة الضعيف لكفالة المجتمع له- تنافس الأغنياء على البذل للفقراء لكسب الثواب في الآخرة).
ثم قدم توضيحا لأهمية القيمة بأنها الأساس المحرك لسلوك الفرد سواء كان خاطرة- فكرة-قول- فعل، وبقدر تمكن القيمة في النفس تكون قوة السلوك والعكس صحيح، والقيمة إفراز طبيعي للمنهج الفكري الذي يتبناه الشخص، ولكل منهج فكري مرتكز عقدي. فثمة سلسلة متصلة وهي:
عقيدة ـ فكرة ـ قيمة ـ سلوك
ويسوق مثالا لذلك:
الإيمان بالله – الرعاية الصحية – النظافة – تنظيف اليدين قبل وبعد الطعام
وبعد أن تساءل: كيف نضمن قوة وفاعلية القيم في نفس الطالب؟
كان الجواب: 1- بيان مصدرها وتأصيلها. 2- بيان حاجته إليها. 3- بيان وإعلاء آثارها ونتائجها. 4- بيان مخاطر وخسائر فقدانها. 5- صحة وجودة العرض والتدريب عليها.
وفي إطار إبراز أهمية النشاط السلوكي في تعليم القيم، يبين القيم التي ترسخها شعيرة الصلاة وهي:
النظام، تنظيم الوقت، الدقة، الطاعة، احترام القائد، التواضع، المساواة، الاستقامة.
ويذكر أن عناصر تفعيل منظومة القيم هي:
المعلم- منظومة القيم- البيئة المحيطة (المدرسة، المجتمع) – البيئة الأساسية (الأسرة)- الوسائل والأنشطة والأدوات. وقد نظمها على شكل دائرة وفي مركزها الطالب المحور الذي تدور حوله باقي العناصر وتكون فاعليتها من فاعليته.
وحدد مراحل بناء القيم في النفس الإنسانية في الخطوات التالية:
مرحلة التوعية ــ مرحلة الفهم ــ مرحلة التطبيق ــ مرحلة التعزيز.
ثم توسع في بيان طريقة إنجاز كل مرحلة على حدة، بتقنات جذابة ومحفزة، يغلب فيها فعل التلميذ على تدخل الأستاذ الذي يقتصر على التنظيم العام والتوجيه الضروري، ويطغى فيها نشاط المتعلم على كلام المعلم.
مثلا من الأنشطة التفاعلية المقترحة لتعلم قيمة “الإيجابية”:
- مشروع محاربة الظواهر السلبية بالمدرسة (التدخين – الألفاظ العامية – ضعف الانضباط – …).
- مسابقة “قدم فكرة إصلاحية جديدة”.
- ندوة: (لو كنت المسؤول عن… ماذا كنت ستفعل؟).
- الأنشطة الخدمية والاجتماعية المتنوعة.
وفي الفصل الأخير خصصه للنماذج العشر التطبيقية لمنظومة القيم المدرسية، وهي: التفوق – الصداقة والأخوة- الحياء والعفة- الحوار- بر الوالدين- الإيجابية- الطموح- التعاون- تقدير الذات.
وقد اتبع المنهجية التالية في تعليم كل قيمة نسوق ملامح عنها بالنسبة لقيمة تقدير الذات:
- تعريف القيمة:
وذلك من خلال مظاهرها السلوكية المستهدفة في حياة الطالب (المدرسة- المنزل- المجتمع). ذكر منها: الاستجابة للتحديات والمناقشات المختلفة، القدرة على تحديد أهداف لنفسه…
- أهمية تقدير الذات في حياة الطالب:
منها: تمنحه الشعور بالأمان والثقة والسعادة والفاعلية الشخصية، تمنحه القدرة والقوة على التحصيل العلمي، …
- في ترسيمة تم حصر العناصر المكونة لقيمة تقدير الذات، وهي: الشعور بالذات – الشعور بالهدف – الشعور بالأمان – الشعور بالاحترام – الشعور بالانتماء – الشعور بالقدرة والكفاية.
- مراحل بناء قيمة تقدير الذات في نفس الطالب.
قدم جدولا يشتمل أفقيا على خانتين: مراحل بناء القيمة- المهارات والأنشطة والوسائل العملية. وعموديا الخانات التالية: التوعية- الفهم- التطبيق- التعزيز، وبين مدلول كل عملية وفي الخانة المقابلة اقتراح للأنشطة العملية.
- دور الأسرة في تعزيز تقدير الذات عند الابن (الأب، الأم، الأخ الأكبر).
حدد نصائح للآباء والأخ الأكبر من مثل: ناقشه وحاوره واسمع منه واحترم رأيه.
- أنشطة عملية مقترحة لبناء وتعزيز قيمة الاعتزاز بالنفس:
- فرق العمل الفصلية. (توجيهات تنظيمية).
- ندوة مقترحة. (توجيهات تنظيمية).
- أنشطة مقترحة: منها على سبيل المثال تعمد إشراك التلاميذ في أداء الواجبات الاجتماعية المختلفة، الحوارات المتبادلة بين المعلم وطلابه.
- نموذج متابعة وقياس تحقق قيمة تقدير الذات: وهو عبارة عن سجل لكل قسم توضع فيه درجات تقديرية لكل تلميذ عن كل قيمة تم تعليمها وتم إعداد صفحاته على الشكل التالي: أفقيا الخانات اسم التلميذ- الثقة بالنفس- الاهتمام بالحفاظ على الشعور باحترام ذاته- الانخراط مع الزملاء وتكوين علاقات جيدة مع معلمه- قبول التكليف بالمهمة والاستجابة للتحدي والمناقشة- الإجمالي- ملاحظات.
تمنح الدرجات على عشرة يقسم الإجمالي على أربعة لتكوين معدل المتعلم في تعلم القيمة، وحددت نسبة % 75 للنجاح الفردي ومثلها للنجاح على مستوى الفصل. كما تعتمد استبيانات في قياس مدى تحقق القيم التي تمارس خارج المدرسة.
ملاحظة ختامية:
يعد العمل المقدم في هذا الكتاب متميزا فيما يتعلق بالمجهود المبذول على مستوى المقترحات الإبداعية لتعليم القيم، وما تمثله من منهجية رائدة ومفيدة في بناء أي مشروع للتربية على القيم، إلا أنه أغفل استحضار أهمية الاتجاه القيمي العام الذي بدونه ستتدنى المردودية التربوية لأي مشروع لتعلم القيم.
الرابع: نحو نظرية للتربية الإسلامية.
تأليف: الدكتور علي جريشة – مكتبة وهبة – ط1، 1986.
في هذا الكتاب حاول المؤلف أن يقدم لنا نظرية إسلامية انسجاما مع عنوانه، وخصص الفصل الأول من الباب الثاني للحديث عن الأسس الفكرية للتربية الإسلامية، ثم اعتبرها هي نظرة الإسلام إلى الإنسان ونظرته إلى المجتمع وذكر في الأولى التوازن، التكريم، تفجير الطاقات وأخيرا الاستعداد لتلقي الأمانة! وأرى أنه لو جعل هذا الاستعداد أول شيء في تلك النظرة لكان أولى، لأن أمانة الإنسان ومسؤوليته في الأرض هي أبرز وأهم ما يشكل هذه النظرة وعلى أساس تلك الأمانة يستحق التكريم وهي أعظم ما يفجر طاقات الخير والهداية والصلاح في نفسه، كما أن التوازن مسؤولية يتحمل الإنسان عبئها ولا يمنح له أو يصل إليه إلا بإرادة وعلم ومجاهدة. فالكلام الذي سيق في هذا الكتاب بعيد عن أن يكون بناء لنظرية التربية الإسلامية.
الخامس: نظريات المناهج التربوية
د علي احمد مدكور- ط1 سنة 1417/1997- دار الفكر العربي
يتناول هذا الكتاب موضوعا في غاية الأهمية، فهو يجيب عن سؤال: ما النظريات الرئيسية التي تحكم الممارسات التربوية في معظم مناطق العالم؟
تناول خمس نظريات وهي: التصور الإسلامي باعتباره الإطار المرجعي للسلوك الفكري الإسلامي عامة، و للسلوك التربوي بصفة خاصة ثم تناول النظريات التالية: الأساسية الانجليزية، والموسوعية الفرنسية، والبرجماتية أو النفعية الأمريكية، و التطبيقية ذات الجدور الشيوعية السوفيتية.
ويبدأ منهج التناول في كل نظرية من هذه النظريات بأسسها الفلسفية ونظريتها الكلية للألوهية والكون والإنسان والحياة.. مرورا بمبادئها وأسسها النظرية التربوية المحددة في صورة أهداف، ومحتوى تربوي، وطرائق، وأساليب تدريس وتقويم.
ثم جاء الختام في صورة معالجة مقارنة بين التصور الاسلامي والنظريات الأخرى في ضوء معايير فلسفية وتربوية ذات قيمة باقية في الصناعة الإنسانية.
ولقد حدد مفهوم النظرية التربوية بما يلي: “النظرية التربوية هي مجموع المبادئ المترابطة التي توجه العملية التربوية وتحكم الممارسات التعليمية فإذا كانت النظرة العلمية وصفية وتفسيرية في الأساس، فإن وظيفة النظرية التربوية كما يقول “بول هيرست”: هي التشخيص والعلاج، وإذا كانت النظرية العلمية تحاول وصف و تفسير ما هو قائم، فإن النظرية التربوية تصف و تقرر ما يجب عمله مع الناشئة، و توجه و ترشد الممارسات التربوية.
ومن هذا المنطلق فان بول هيرست وغيره من المربين الغربيين الذين يرفضون بناء النظرية التربوية على النمط العلمي يدعون الى إعطاء الفلسفة دورا رئيسيا في بناء النظرية التربوية لأنها تمدهم بالقيم التي يودون غرسها في الناشئة ” (ص21).
ويرى د علي أحمد مدكور العدول عن فلسفة التربية وعن النظرية التربوية إلى التصور الإسلامي للتربية لأن النظرية تحنط الإسلام وتجعله كلاما معزولا عن حركية الشريعة وحيويتها، كما أنها تعكس الانبهار بالفكر الغربي و مجاراته في نهج النظريات.
وهذا الكلام غير مسلم له به لأن النظرية إذا صيغت في اتجاه صحيح استطاعت أن تدفع لاكتشاف الكثير مما يخفى من أسرار الشريعة، وأن تعيد لها حيويتها وقدرتها على تعبئة الإنسان في طريق العمل الصالح.
ومن جهة أخرى نجده أكثر توفيقا من على جريشة في صياغة تصور إسلامي شامل في النص التالي:
“الاسلام هو نظام النظم، حيث تندرج تحته نظم عدة، ففيه نظام الاقتصاد، ونظام السياسة، ونظام الأسرة، ونظام التربية.. الخ. وهذه النظم وإن اختلفت في أشكالها وأساليبها ووسائلها من وقت لآخر أو من بيئة لأخرى، إلا أنها تستمد أصولها، وتستلهم أساليبها و وسائلها من خصائص و مقومات النظام الإسلامي العام، كما أنها كلها تهدف إلى غاية واحدة و هي إقدار الإنسان المسلم على القيام بحق الخلافة، و هو عمارة
الأرض، وترقية الحياة على ظهرها وفق منهج الله” (ص14) كما وفق هو الآخر إلى جعل جميع نظم الإسلام تطبيقا لخلافة الإنسان في الأرض والتي هي الأمانة العظمى التي يتحملها بنو آدم في هذه الدنيا.
فنجده يصوغ مفهوم منهج التربية في التصور الإسلامي كما يلي:
“هو نظام من الحقائق والمعايير و القيم الإلهية الثابتة، و المعارف و الخبرات و المهارات الإنسانية المتغيرة، ينبع من التصور الإسلامي للكون و الإنسان و الحياة، و يهدف إلى تربية الإنسان، و إيصاله إلى درجة كماله، التي تمكنه من القيام بواجبات الخلافة في الأرض، عن طريق إعمارها، و ترقية الحياة على ظهرها وفق منهج الله”(ص33).
وكأنه تدارك ما يبدو في هذا التعريف من نقص واضطراب في التقديم والتأخير حيث كان عليه الانطلاق من حقيقة المهمة الإنسانية على الأرض ليكون كل ما بعدها نتيجة لها فقال:
” ونحن لا نملك أن ندرك حقيقة الإنسان إدراكا واضحا حتى ندرك وظيفته الأساسية، أو غاية وجوده الإنساني، وهي أنه خليفة الله في الأرض، و مقتضى الخلافة هي أن يعمل على إعمار الأرض و ترقية الحياة على ظهرها وفق منهج الله”(ص182).
ولقد عمل على الربط بين هذا التصور النظري وتطبيقه داخل المدرسة والمجتمع فقال: “إن الهدف الذي ينبغي أن تعمل المناهج التعليمية على تحقيقه هنا هو تنمية شعور الناشئة و إدراكهم للمسؤولية الاجتماعية”(ص255) .
السادس: فلسفة التربية الإسلامية.
الدكتور ماجد عرسان الكيلاني – مداخلة في المؤتمر العالمي الرابع للفكر الإسلامي بالخرطوم بتاريخ 15 -20 يناير1987/ 15-20 جمادى الأولى 1407.
عرف فلسفة التربية بأنها “يقصد بها صورة الإنسان الذي تتطلع التربية الإسلامية إلى إخراجه في ضوء علاقاته بالخالق والكون والإنسان والحياة وما بعد الحياة”. وأرى أن ما ذكره بهذا الصدد أدنى إلى أن يكون نتيجة للتربية الإسلامية ومواصفات المستفيدين منها وهو ما ينسجم مع بعض تعريفات فلسفة التربية، في حين أن بعضها الآخر يرى أنها الأساس النظري الذي تقوم عليه، فيمنحها وجودها وهدفها وفاعليتها في واقع الناس. فلا يمكننا الحديث عن فلسفة التربية بمجرد تحديد مواصفات للمتربين، وإنما بالجواب عن سؤال لماذا اخترنا تلك المواصفات بالضبط؟ وهل هي الأفضل والأنسب من غيرها؟
وخلافا لما عهدناه لدي المتحدثين من المسلمين في مجال النظرية التربوية، فإن الدكتور الكيلاني يقدم لنا صورة منظمة وواضحة لما يجوز لنا تسميته بفلسفة تربوية ويمكننا تطويره وإغناءه بالنقاش، حيث اختار تقديم هذه الفلسفة على شكل علاقات خمس بين الإنسان وجهات أخرى على المنوال الآتي: علاقة عبودية مع الخالق، وعلاقة تسخير مع الكون وعلاقة عدل وإحسان مع بني الإنسان وعلاقة ابتلاء مع الحياة وعلاقة مسؤولية وجزاء مع الآخرة، فذكر أن الإنسان يبلغ درجة الكمال عندما تتشكل علاقاته بهذه الجهات.
وأرى أن كلامه هذا يستدعى النقاش الآتي:
1-إن درجة الكمال لا تنال بمجرد وجود هذه العلاقات، ولكن ببلوغها حدا عاليا من الجودة والاتقان، فالناس كلهم يرتبطون مع هذه الجهات بتلك العلاقات المذكورة ولكن بكيفيات متفاوتة، فالناس كلهم عبيد لله اعترفوا بذلك أم لم يعترفوا، وكلهم مسخر لهم ما في الكون مؤمنهم وكافرهم، وكلهم مبتلون بالحياة بدون استثناء، وكلهم مسؤولون يوم القيامة بين يدي الله، وهم جميعا مرتبطون بعلاقات مع بعضهم قد لا تخلوا من مظاهر للعدل والإحسان.
لكن ما يميز هذه العلاقات في المنظور الإسلامي هو اندراجها كلها في إطار الوعي بمقتضياتها السلوكية الصحيحة وفق مراد الله تعالى، وحسب تفاصيل التكليف الإلهي للإنسان في كل هذه المجالات.
2-أليست هذه العلاقات الخمس كلها داخلة تحت مسؤولية الإنسان أمام الخالق العظيم؟ فعلاقته بالله هي علاقة مسؤولية وابتلاء وهذه العلاقة تنتظم جميع بني آدم لكن الدخول في الإسلام يدفع بها في طريق أن تكون علاقة عبودية تامة، لكنها لن تكون كاملة ونافعة إلا باستشعار المسلم لحقيقتها وسعيه الجاد للالتزام الاعتقادي والعملي بما يحققها في الواقع، وهذا المستوى من التمثل لا يبلغه الإنسان إلا إذا أدرك جسامة مسؤوليته عنه بين يدي الخالق سبحانه.
كما أن علاقة الإنسان بالكون والتي هي علاقة تسخير ألا تدخل هي الأخرى في إطار الاستخلاف؟ والذي يقتضي أن الإنسان مسؤول في هذا الكون عن القيام بمهمة العمران وفق توجيهات محددة من لدن الله تعالى الخالق المسخر، فيسخر قوانينه في التعرف على حكمة الخالق ومدى رعايته للإنسان وتكريمه له وتفضيله على غيره، وأيضا في تنفيذ أوامره تعالى بالإصلاح في الأرض وإقامة العدل والفضيلة ودرء الفساد والظلم والباطل.
ثم أليست علاقة الإنسان ببني جلدته هي علاقة ابتلاء ومسؤولية؟ وهي في الإسلام مرجوة لأن تكون قائمة على التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر والأمر بالمعرف والنهي عن المنكر فيما بين المسلمين، وعلى العدل والإحسان فيما بين الناس أجمعين.
ولقد فات الكاتب أن يضيف علاقة الإنسان بنفسه وهي علاقة مجاهدة وتربية، وكل إنسان مسؤول بالأساس عن نفسه ماذا جلب لها من خير وماذا دفع عنها من شر؟
9 – الإضافة النوعية للبحث.
تتجلى الإضافة النوعية للبحث في العمل على تحقيق الأهداف الآتية:
- اعتماد التربية على القيم أساسا لتعميق الطابع الأخلاقي والأصيل للمشروع.
- تبني استراتيجية تحريك الإنسان من داخله لتحقيق نهضة حضارية شاملة عن طريق تبني الاستخلاف الإسلامي اتجاها قيميا عاما لمنظومة القيم الإسلامية، واعتبار الأمانة بمفهومها الواسع قيمة شاملة لجميع القيم الإسلامية المكونة للمنظومة.
- بناء منظومة القيم على أسس علمية تمكن من الاستفادة منها في بناء نظرية للمشروع التربوي الأصيل.
- تقديم منهجية فعالة للتربية على القيم، قائمة على تفاعلات المتعلم.
المبحث الأول: طبيعة القيم وخصائصها.
أولا: طبيعة القيم.
تطور مفهوم القيم ليدخل دائرة المثل العليا والقناعات الذاتية والميول الوجدانية، واكتسبت أهمية بارزة في تشكيل منظور الإنسان للحياة وتوجيه سلوكه وبناء مواقفه تجاه قضاياها. ويمكن توضيح طبيعة القيم من خلال المحاور التالية:
- الأساس الثقافي والاعتقادي لتكون القيم.
تعتبر الثقافة وضمنها المعتقدات السائدة مجالا خصبا لتبلور القيم وترسخها في النفوس، فكل ثقافة تتجه إلى الإعلاء من شأن أخلاق ومواقف ومسلمات اعتقادية وعادات وتقاليد معينة، وتقديم تفسيرات مسوغة ومؤكدة لأفضليتها وجدارتها بالتقدير والاحترام بل والتقديس أحيانا، بحيث تنشأ الأجيال وسط المناخ الاجتماعي على حب قيم المجتمع المتعارف عليها، وينمو في نفوسهم تقديرها وتبجيلها مع التدرج في المراحل العمرية، ليبلغ تعلق النفس بتلك القيم أقصى مداه مع دخول فترة الشيخوخة.
ففي كل ثقافة تظهر منظومة من القيم المتبلورة في أحضانها والمعبرة عن ثوابتها وتوجهاتها الكبرى. ففي إطار اللبرالية، التي تؤسس للحرية الاقتصادية بمنع تدخل الدولة في مجال الاقتصاد، نجد القيمة التي تؤصل لهذا التوجه هي الحرية التي اشتق نهجها واسمها منها، أي كلمة liberty والتي رفعت شعارا واضحا وهو laisser faire : والذي يدعو لحرية التصرف في ميدان الاقتصاد بحسب ما تسمح به قوانين السوق، ويجسد هذا الشعار الاتجاه القيمي النسقي العام لمنظومة القيم الليبرالية مثل: حرية المنافسة وحرية الملكية وحرية الإبداع والتصرف..
وفي البيئة القرشية هيمنت عبادة الأصنام، وصار تخصيصها بالتعظيم والتقديس قيمة عالية، وأضحى أهل مكة متشبثين بها لا يبغون عنها بديلا، فلما دعاهم رسول الله لنبذها وتوحيد الله العلي القدير عز عليهم تركها وأعلنوا الحرب على رسول الله ﷺ ومن آمن معه بسببها وتوالى حرصهم عليها ولم يسلموا فيها بسهولة ويسلموا لله بالوحدانية رغم المحاججة القرآنية لهم طيلة ثلاثة عشر عاما. {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ (20) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ (21) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ (22) إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ (23) أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ (24) فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ (25)}(النجم:19-25)
فقيمة التعلق بهذه الأصنام استمدت وجودها من البناء على الظن الذي لا يسنده دليل علمي وعقلي صريح، ومن اتباع أهواء النفس ورغبتها المزاجية المتمكنة عبر ممارسات معتادة منذ التاريخ الغابر ولم يكن ما عرض عليهم من الهدى ليزحزحهم عما تشربته قلوبهم من التمنيات الواهية.
فكما تكون ثقافة المجتمع ومعتقداته تكون القيم الناشئة عنها سوية أو منحرفة، وتكون قيم الأجيال المتعاقبة في ظلها، التي تغدوا نسخا طبق الأصل عن بيئتها حتى يطرأ عليها ما تتغير به طبيعة الثقافة المهيمنة وأطرها الاعتقادية. كما يبين ذلك حديث رسول الله ﷺ (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصراه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء)[40].
فارتباط القيم بالبيئة الاجتماعية يؤكد الدور الحاسم للتربية في تثبيت منظومة القيم التي ارتضاها المجتمع وسعى في ترسيخها عن طريق المدرسة والثقافة والإعلام وممارسة الشعائر الدينية والتقاليد والعادات، وكلما توحد الاتجاه القيمي عبر هذه الوسائل وتمحورت جهوده حول تعزيزه كانت قيم المجتمع فاعلة في الواقع، وإذا أصبحت موضع رفض وتبرم ولم تحض بالإجماع أدى ذلك لإضعاف تأثيرها في النفوس وتراجعت قدرتها على الإسهام في توجيهها، وكان من نتائج اختلاف الناس حول قيم معينة، أن تصير مادة للنقد والتمحيص واستعراض إيجابياتها وسلبياتها، مما يعد محكا قويا لها إما تصمد بعده وتنال ثقة الأغلبية أو تنهار وتتلاشى ويقع استبدال غيرها بها. فشهد المجتمع تحولا قيميا يناسب قناعاته الجديدة ويلائم ظروفه المتغيرة.
2– البعد الفردي في التفاعل مع القيم.
إذا كانت القيم ملكا للمجتمع وأساس نشأته والضامن لاستمراره ووحدته واستقلاله عما سواه، فإن موقف كل فرد من أفراده تجاهها لا يكون بالضرورة موحدا، إذ نجد من بينهم من يكن للقيم السائدة قمة الحب والتقدير ويصدر عنهما على مستوى الفكر والوجدان والسلوك، فتكون تصرفاته ومواقفه منسجمة معها إلى أبعد حد.
كما نجد من يحتفظ في نفسه للقيم المجتمعية بما يليق من التقدير، ولكنه في سلوكه لا يكون منضبطا لها ملتزما بمقتضياتها العملية. ويوجد أيضا من يرفضها ويزدريها معتقدا عدم استحقاقها لأي تقدير أو احترام ممعنا في إبراز نقائصها ومجافاتها لقناعاته واختياراته في الحياة.
فإذا اتسعت دائرة المؤمنين بقيم المجتمع المتجاوبين معها على نحو أمثل، كنا بصدد قيم فاعلة وحقيقية، وإذا ارتفعت نسبة الجاحدين لها كان في ذلك مؤشر قوي على ضرورة إصلاح منظومة القيم وتجديدها بإضافة قيم أخرى ذات فاعلية أكبر وقدرة على التعبئة للبناء والإنجاز الحضاري حتى تحوز رضى أغلبية المجتمع.
فإذا أمكن نسبة قيم معلومة لمجتمع ما فإن نسبة ذات القيم لكل من أفراده ينطوي على مجازفة كبيرة، مما يدعو إلى اعتبار مسؤولية الفرد في التفاعل مع القيم الطاغية داخل المجتمع بطريقته الخاصة، فقد يبدي في الظاهر احترامه لقيمة معتبرة داخل المجتمع حتى لا يثير انتقاد الآخرين، لكنه يضمرعنها في نفسه خلاف ما يظهره، فالذي يعلم حقيقة ما تنطوي عليه القلوب هو الله العليم الخبير، ومن ثم فإن صدق أحاسيس الناس تجاه القيم الإسلامية ناتج عن اعتقادهم باطلاع الله على خبايا نفوسهم، فلا يسع أحدا منهم خداع الناس ومراءاتهم. {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير}ٌ (البقرة:284)
فالقيم الفعالة هي التي تتميز بقدرة خاصة على اكتساب تقدير ومحبة جميع أفراد المجتمع وتحريكهم بوعي وحماس في طريق الابتكار والإنتاج والصلاح.
ثانيا: أهم خصائص القيم.
تتميز القيم بعدة خصائص تحددها معايير معلومة ومن أهم تلك الخصائص نذكر ما يلي:
- الأصالة
والمقصود بها انغراس أصول القيم في ماضي الأمة وثقافتها القديمة، رغم ما قد تخضع له من تحولات وتغيرات تحددها تجربة المجتمع وتقلبه في مختلف أطواره الحضارية، وما يتعرض له خلالها من محاولات التطور أو التراجع عبر مسيرته التاريخية.
ذلك لأن من طبيعة القيم الاستناد في نشأتها إلى المعتقدات الدينية والتوجهات المذهبية التي تعمر حقبا متوالية، وهذا ما يحقق لها الاستقرار النسبي والامتداد الواسع في مسار الأمم.
فأصالة القيم الإسلامية ترجع إلى أعماق التاريخ البشري منذ آدم عليه السلام، والذي توالى الأنبياء من ذريته يذكرون أقوامهم بقيم دين الله الخالدة التي لا تبلى مع تعاقب الأزمان، ولا تنال منها تقلبات الحياة، التي لا تثبت في وجهها قيم الناس طويلا.
2- الثبات والتحول
تتميز القيم بخاصية الثبات، فهي من مقومات وجود الأمم واستمراريتها في الزمان والمكان، كما أنها تدوم بدوام المعتقدات والاختيارات الفكرية المؤطرة لها، وتترسخ برسوخها، ولا يصيبها التغيير إلا بعد حقب طويلة من التألق والعطاء، حيث تتأثر عادة بحركية الأمة، وأوضاع صحتها ومرضها ونهوضها وانحطاطها.
ولقد رصد الوحي كتابا وسنة ظاهرة تغيير المعتقدات التي تنشأ عنها السلوكات والأخلاق والعادات والقيم، لدي بني آدم في مختلف العصور: {إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا} (النساء:137).
وعن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – أنَّ رسول الله ﷺ قال: «كيف بكم إذ فَسَقَ فِتْيانُكم ، وطغى نِساؤُكم ؟ قالوا : يا رسول الله ، وإنَّ ذلك لكائن؟ قال نعم ، وأشدُّ، كيف بكم إذا لمْ تأمروا بالمعروفِ ولم تَنْهَوْا عن المنكر ؟ قالوا: يا رسول الله ، وإنَّ ذلك لكائن ؟ قال : نعم ، وأشدُ ، كيف بكم إذا أمرتُم بالمنكر، ونهيُتم عن المعروف ؟ قالوا : يا رسول الله وإنَّ ذلك لكائن ؟ قال نعم ، وأَشدُّ كيف بكم إذا رأيتُمُ المعروفَ منكرا والمنكرَ معروفا»[41]
فمما يعكس حيوية أمة هو قدرتها في الحفاظ على قيمها الإيجابية التي تحقق وحدتها وتماسك نسيجها الاجتماعي، ويتواصل بها تميزها وخصوصيتها بين الأمم، وتمدها بالفاعلية اللازمة لاستمرار عطائها الحضاري، كما أنها تملك الجرأة لنبذ ما تأكدت سلبيته وعرقلته لنهضتها وانطلاقها في طريق الازدهار والنماء المادي والمعنوي، أو إخضاع ما كان منها قابلا للتجديد للتكيف مع حاجاتها الطارئة وتطلعاتها المستقبلية.
وكما تتغير القيم في مسار الأمم، تتغير في حياة الفرد تبعا لما يجد في حياته من أفكار وظروف حاملة على مراجعة النفس، وإعادة النظر في رؤيتها للأمور ومعتقداتها وأولوياتها واختياراتها وتفاعلها مع الأحداث والقضايا الواقعية.
3- التكاملية:
فالقيم توجد ضمن منظومة متكاملة يشد بعضها بعضا، وتقوي ممارسة كل قيمة ما يرتبط بها من القيم الأخرى، وتحتاج ممارسة كل قيمة، إلى ما يتصل بها من القيم الأخرى، وتستدعي اكتساب أخلاقها ومقتضياتها السلوكية والانفعالية، وكل إخلال بقيمة ما، يؤدي حتما إلى تصدع المنظومة برمتها ويعرضها للانهيار.
وغالبا ما تكون التشريعات القانونية في الدولة خادمة لمنظومة قيمها وحامية لها من الانتهاك والتضييع، حتى تظل مصونة ومهابة وتقدير الأفراد لها جاريا على الدوام. ومن هنا تبدو خطورة الصراع القيمي داخل المجتمع، حيث تدعو كل طائفة إلى ما تؤمن به من قيم ترى طائفة أخرى أنها ليست جديرة بأي تقدير، فتعلن ذلك وتنادي به دون تردد، كما قد تكتفي طائفة أخرى بمعاكسة الاتجاه العام لتلك القيم والعمل على تجاوزها سلوكيا بطريقة أو بأخرى.
فكلما توحدت نظرة الناس في بلد إلى منظومتهم القيمية، توفرت لها إمكانيات التكامل المساعد على تنسيق الجهود وتوحد الاتجاه القيمي العام في المجتمع وتقويته بالحرص على استلهامه في السلوك والمشاعر.
وهي قدرة القيم على إبداع الأفكار، وصبغها بصبغتها الخاصة، و توجيه العواطف وتأجيجها، وضبط السلوك وتقويمه، وتوحيد وجهة الأمة وتعبئتها في ميدان التنمية والبناء الحضاري.
ومن تم فإن قيم الأمة، لا بد أن تحضر بقوة فاعلة، في سياستها واقتصادها وقانونها واجتماعها وتربيتها و فنونها، وأن تشكل القلب النابض لثقافتها و فلسفتها في الحياة.
ومما تتحقق به فاعلية القيم ما سلف ذكره من كونها أصيلة تملك شرعية تاريخية وعمقا اعتقاديا يشهد لها بالتقبل الشعبي الراسخ، وامتلاكها للمرونة اللازمة للتلاؤم مع المتغيرات الحضارية، وحيازتها للرضى والتقديس والتمثل الأخلاقي لدى الغالبية الواسعة من المجتمع، فضلا عن قيامها على أسس خالدة من الحق والسواء والفضيلة. يزاد على ذلك توفرها على اتجاه نسقي عام مهيمن يحمل على تحقيق التكامل بين جميع القيم وامتناع التعارض بينها وتضافرها لإرساء توجه مجتمعي متين.
ثالثا: خصوصيات منظومة القيم الإسلامية.
1– الأساس العقدي للقيم الإسلامية.
- أثر الإيمان في تشكيل القيم الإسلامية.
تعرض المصادر الإسلامية الأساسية الإيمان بأنه القيمة العظمى التي لا تدانيها في القدر والشأن أية قيمة أخرى، فعن طريق الإيمان بالغيب يعرف الإنسان الله الخالق لكل شيء والمدبر لكل أمر ، ويتعرف على حقيقة نفسه باعتباره مخلوقا مكلفا بالتزام شرع الله ومسؤولا عن مدى اتباعه بين يدي الله تعالى يوم الحساب، فيجازى بالخلود في الجنة إن أطاع واستقام، ويعاقب بالجحيم إن ضل وغوى. ويتعلم محتوى الدين الذي اشتمل على التكاليف الشرعية اعتقادا وعبادة ومعاملات وأخلاقا، والذي استوعب ما تتحقق به سعادة الدنيا والآخرة.
فقد أوضح الله فضل الإسلام على الناس وما يحصل لهم بالاهتداء به من خير ومنافع في الدنيا والآخرة، في آيات كثيرة منها حصر تمام النعمة في اكتمال نزول الدين إلى الأرض:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}(المائدة- 3) وبين سبحانه أن قرآنه الذي ختم به الرسالات السماوية يهدي إلى الحق والرشاد والسلام: {قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (المائدة 15 – 16). وأن اتباع نهج الإسلام يحقق للمؤمنين السعادة في الدنيا والآخرة: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}(النحل-97). ويتخلل المتن القرآني وصف للجنة ونعيمها وللنار وعذابها حتى يعلو قدر الدين في النفس ويرتفع تعلقها بما يبشر به من نعيم خالد فوق كل شيء آخر من متاع الدنيا الفاني:{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآَبِ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ} (آل عمران 14 -15).
فتردد مثل هذه الآيات التي تحفل بالبشائر ومعاني تكريم الله لعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة على مسامع الإنسان، يفتح القلب والعقل على ارتضاء هذا الدين وجعله أسمى قيمة في حياة المعتنق له، وبالتالي فإن تعاليمه وتوجيهاته والتزام فعل أوامره واجتناب نواهيه وتعلمه وتعليمه، وحب الله ورسله وأوليائه وبغض أعدائه… كل ذلك من القيم الإسلامية السامية التي لا يمكن أن تضاهيها قيم أخرى غيرها.
- دور الوجدان في ترسيخ القيم الإسلامية.
يطلق الوجدان على كل إحساس أولي باللذة أو الألم، وعلى ضرب من الحالات النفسية من حيث تأثرها باللذة والألم، في مقابل حالات أخرى تمتاز بالإدراك والمعرفة[42] .
والوجدان ليس هو الإحساس العصبي، وإنما هو وعاء الشعور بما ينشأ عن إدراك معنى من المعاني السارة أو المؤلمة وعن التأثر بأحاسيس سارة أو مؤلمة، ثم إنه لا يختص برغبة معينة دون أخرى، وإنما هو وعاء للشعور الذاتي من حيث هو، فهو محل الحب والكراهية، والرضى والرفض. التقبل والحقد.. وهو على هذا الأساس أحد الجوانب التي تسهم في تحديد مواقف الإنسان[43]
ومن ميزات الخطاب القرآني أنه يخاطب من الإنسان عقله ووجدانه، فعندما يسوق الأدلة الضافية والبراهين القاطعة على صحة ما يعرضه من إخبارات وحقائق، فإنه لا يغفل أن يهز المشاعر ويستثير الوجدان بأسلوبه المفعم بالحب والرحمة والجمالية، والترغيب في الأفضل والأحسن، والترهيب من الأسوإ والأشقى والأمر.
ذلك أن الإنسان يحتاج ليسلم بحقيقة وتطمئن بها نفسه إلى ما يؤثر في قلبه بجانب ما يقنع عقله، بل إنه غالبا ما يخضع فيما يقبل ويرفض إلى الحالة الوجدانية أكثر من قوة الدليل العقلي.
ومن الأمثلة الساطعة على ذلك حصول يقين عقلي لدى بعض المخاطبين بصدق الأنبياء ثم رفضهم الانقياد للحق المتضح إعراضا واستكبارا وجحودا واتباعا للهوى الذي يسيطر على الوجدان. فقد جلى القرآن هذه الحقيقة عدة مرات منها أن فرعون يعلم في قرارة نفسه أن الآيات التي جاء بها موسى معجزات من عند الله تأييدا لصدق نبوته، ومع ذلك فهو يرفض الاعتراف بها خوفا على منصب الحكم الذي يشغله والسلطة التي يصول بها ويجول من أن تضيع منه، {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا (101) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (102)}(الإسراء:101- 102). وبين الله لنا بأن كفار قريش جحدوا نبوة رسول الله ﷺ رغم إقرارهم في دخيلة أنفسهم بأنه أمين صادق، وما ذلك إلا لشدة تعلقهم وجدانيا بحب الأصنام وتقديرها، واستعظامهم أمر التخلي عنها مع ما حظيت به لديهم من العبادة والتقديس. {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} (الأنعام:33)
فالخطاب الموجه للإنسان لا يحوز أعلى درجات الإقناع حتى يشتمل على ما يقنع العقل ويستميل القلب، لذا كان القرآن دائما يزاوج في خطابه بين ما هو عقلي وما هو قلبي، لإن النفس مسؤولة بكليتها عما تقبل أو ترفض من الحق والباطل.
ومن هذا المنظور نرى اعتناء القرآن ببناء القيم الإيمانية في النفس عن طريق استثارة الوجدان باستعراض مظاهر التكريم والإنعام والاصطفاء مقرونة بمستلزمات الاستخلاف والتكليف وتحمل الأمانة العظمى. {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (الأحزاب:72- 73). فالله يعلم الإنسان بأن الأمانة التي يتحملها في هذه الحياة قد عظمت إلى الحد الذي جعل مخلوقات في حجم السماوات والأرض والجبال تتهيب حملها وتخشى تبعاتها، وهو ما يثير في القلب شعورا عميقا بارتفاع القدر وعلو الشأن أمام جميع الكائنات، لكنه شعور ممزوج بالرهبة الشديدة من ثقل هذه الأمانة التي تأهل بها الإنسان لاحتلال موقع الأفضلية والتميز والذي هو أيضا موقع المحاسبة والثواب والعقاب. وقد اندرجت آيات عدة في هذا السياق مذكرة الإنسان بأن قيمته من قيمة الأمانة التي اختص بها بين الخلائق، تزيد بحفظها والوفاء بها وتتراجع بتضييعها والتفريط فيها.
{قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} (إبراهيم:31-34).
ففي هذه الآيات نداء مشحون بالرحمة والرفق ومبدوء بالأمر بالصلاة والإنفاق استعدادا ليوم الحساب والجزاء، ومسهبا في تعداد مظاهر التسخير والعناية وهي ضرب من نعم الله السابغة على الإنسان التي يعجز عن حصرها كلها، كما يعجز في الغالب عن شكرها وأداء حقها.
فما تضمنه هذا المقطع من تذكير بنسبة المؤمنين إلى نفسه تعالى وتوالي إنعامه على الإنسان، يحرك القلب في اتجاه حب الله، ويحفزه لما يجسده عمليا من الطاعات المفروضة والقيام بواجب الشكر والامتنان لله قولا وإحساسا وعملا.
وما يلاحظ في القرآن من ترغيب في نعيم الجنة الخالد وترهيب من عذاب جهنم الشديد بأساليب متنوعة وبوتيرة مرتفعة، يندرج في إطار التعبئة المتواصلة للوجدان الذي تحركه مشاعر الرغبة في لذة نعيم خالد والرهبة من ألم الحريق في نار الجحيم -مما يفوق كل تصور- نحو مداومة اليقظة ومواصلة الاستعداد لفعل الصالحات واجتناب السيئات وإيثار متاع الآخرة الدائم على متاع الدنيا الزائل.
فتعلم القيم يتطلب استحضار الميل الوجداني مع الاقتناع العقلي جنبا إلى جنب، كما يؤكد ذلك المهدي المنجرة بقوله: “وأهم عناصر التعلم هي القيم. وعندما نشير إليها كعناصر، فإننا نؤكد على دورها الفعال في عملية التعلم. فقيمة البقاء مع الكرامة، يمكن أن تكون ذات آثار مباشرة في التوجيه. ويلاحظ أن ظهور القيم هو ظهور للحد الفاصل بين الذاتية والموضوعية، وبين الحقائق والأحكام، وبين ما هو كائن وما يجب أن يكون، وبين العلم والأخلاق، وبين المعقول واللامعقول.. وعند إصدار الأحكام، يكون للقيم دور أساسي تِديه، لأن عملية إصدار تنبني على القدرة على وزن الأفضليات، وعلى الموازنة بين المزايا والمساوي، وعلى اختبار النتائج المترتبة مستقبلا على الأحكام الحالية.”[44]
2– البعد الاستخلافي للقيم الإسلامية.
- حقيقة الاستخلاف في الأرض.
يعد الاستخلاف في الأرض الغاية الإلهية من خلق الجنس البشري، كما أوضح الله تعالى في قرآنه: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (البقرة:30). ومن ثم فإن فهم حقيقة الاستخلاف أمر ضروري لإدراك إرادة الله الغالبة وحكمته البالغة من خلق الإنسان على الحالة التي يوجد عليها، كما أن التصور السليم لمهمة الاستخلاف كفيل بتوضيح كثير من الغوامض في الحياة الإنسانية وتصحيح النظر إلى ما يلتبس منها وتخفى حكمته، خصوصا فيما يتعلق بتربيته وإعداده للاضطلاع بالدور الاستخلافي المنوط به.
فكلمة خليفة في هذه الآية أثارت نقاشا عميقا يحاول بعض أطرافه استبعاد أن يكون الإنسان خليفة لله إذ الخلافة في اللغة: تعنى النيابة عن الغير، ولا بد فيها من استخلاف المستخلف بكسر اللام، للمستخلف بفتحها وإذنه له بها، ولا تصح في اللغة بغير هذا المعنى. و”الخلافة النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه وإما لموته وإما لعجزه.”[45] وكل هذه المعاني مجافية لكمال الله واستغنائه عن المعين والنائب.
أما رأي آخر فيرى أن الإنسان خليفة عن الله في تنفيذ شرعه في الأرض فهذا هو المجال الذي أسندت إليه الخلافة فيه دون غيره من أمور الخلق والتدبير مما هو خاص بالله تعالى ولا قدرة لأحد عليه سواه.
فالمقصود بالاستخلاف في الآية تشريف جنس البشر بالتكليف بعد تحمله الأمانة العظمى المقتضية أن تطلق له حرية العمل على ظهر الأرض مدة حياته فوقها، فيعبد الله إن شاء ويعصاه إن شاء، فهو مسؤول عن نفسه كي يزكيها ويقوم اعوجاجها بهدي الوحي أو يدسيها باتباع الهوى واقتراف الآثام والموبقات،”{وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} (الشمس:7-10).
كما أنه مسؤول عن إعمار الأرض بإقامة الدين ونشر أخلاقه والتمكين لنهجه واستغلال خيرات الأرض والانتفاع بها عن طريق مختلف الأنشطة في مجالات الفلاحة والصناعة وإقامة ما تدعو إليه مصالحه من المنشآت الحضارية. {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ} (هود:61). فهذا استخلاف بالمعنى العام ويدل على كون الآدميين مفضلين عما سواهم من المخلوقات الأخرى بالنيابة عن الله في العمل على إحقاق الحق وإزهاق الباطل وإعمار الأرض على هذا الأساس الذي بينته الرسالات السماوية، ففي الحديث النبوي:(إنّ الدنيا حلوةٌ خضِرة، وإنّ الله مستخلفُكم فيها فينظرَ كيف تعملون، فاتّقوا الدنيا، واتّقوا النساء، فإنَّ أوَّل فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)[46] قال النووي: “معنى (مستخلفكم فيها) أي: جاعلُكم خلفاءَ من القرون الذين من قبلكم، فينظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيتِه وشهواتِكم”[47].
ويرى عبد الحميد أبو سليمان أن” الاستخلاف الذي يعني قدرة الإنسان على التصرف في عالمه للتعبير عن إرادته والحصول على حاجاته، هو فطرة وطبع وإرادة تحمل في طياتها تكريم الإنسان بهذا المركز، ثم بالتميز بين الكائنات، مع كل ما يستلزمه هذا الاستخلاف، وهذه القدرات، من حق الحرية، وحق الخيار لاتخاذ القرارات الحياتية، وما يستتبع ذلك بالضرورة أيضا من واجبات ومسؤوليات تلقى على عاتق الإنسان في تصرفاته، واستخدام قدراته وطاقاته في خلافة الكون؛ صلاحا وإعمارا، أو فسادا ودمارا”[48]
والاستخلاف الذي يمنحه الله لقوم بعينه في زمان ومكان من الأرض يكون معناه التعريض للابتلاء ومواجهة الاختبار في مستوى أوسع من دائرة إقليمه المحددة، وذلك ببسط سلطانه وامتداد نفوذه خارج نطاق دولته بعد فلاحه في إحراز أسباب القوة المادية والمعنوية، امتحانا له، هل يقيم العدل في الأرض ويحترز من الظلم والطغيان أم سيصدق عليه قول الملائكة فيقع في سفك الدماء والإفساد في الأرض؟
وهذا المعنى من الاستخلاف يستوي فيه المؤمنون وغير المؤمنين، فهو زيادة في مجال المسؤولية على قدر ما يتحقق من وسائل القوة والغلبة، بحيث إنه يمثل درجة أكبر للاستخلاف البشري العام، وذلك ما يفهم من آيات قرآنية عديدة: {عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} (الأعراف:129). {هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا} (فاطر:39). {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} (الأنعام:165).
فكل جماعة من الناس سلكوا طريقا لبناء بأسهم وسيادتهم عن طريق اتخاذ الأسباب المادية المتاحة، حتى ولو لم يلتزموا بتوجيهات الوحي، وأسسوا نهضتهم على قيم فطرية سليمة وإن شابها عوج، فإن الله تعالى يستخلفها في الأرض بما معها من الحق والسواء، وقد يمكن لها من رقاب المؤمنين الذين ضيعوا دينهم وحادوا عن هديه في استعمار الأرض وامتلاك ناصية التألق الحضاري، وقد ذكر ابن تيمية أنه مما يروى:” الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة.”[49] وأوضح هذه السنة الجارية في قيام الحضارات وزوالها بقوله:” فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل
قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة.”[50]
فأهل الإيمان إذا لم يقوموا بحقه في أنفسهم وفي الحياة عامة، عاقبهم الله باستبدال غيرهم بهم ممن يختلفون عنهم إيمانا وأخلاقا واستعدادا لعمارة الأرض وتحقيق المصالح الإنسانية. وقد قرر القرآن هذه الحقيقة في أكثر من موضع، {وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} (محمد:38). {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (المائدة:54).{وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ} (الأنبياء:105) فقانون البقاء للأصلح يسري على الأمم دون تأخر أو محاباة، فمن استوفى أعلى وأفضل شروط الاستخلاف من غيره كان أحق منه بالنصر والتمكين تبعا لما استوفاه من الشروط إلى أن يتأهل من هو أصلح منه فيرث القيادة والريادة في الأرض من بعده. {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (النور:55).
وخلاصة القول أن الاستخلاف شامل لجميع بني آدم على اختلاف مشاربهم الاعتقادية، سواء منهم المؤمنون بالله والجاحدون لشرعه، فالأمة التي حققت في نفسها شروط الغلبة في الأرض ازدادت أمانة الاستخلاف في حقها ثقلا ولزوما، إلى أن تخل بمقتضياتها النفسية والمادية، فيفلت من يدها زمام التمكين والنصر لتقبض عليه أمة أخرى حازت مؤهلات الاستخلاف الحضاري.
- القيم الاستخلافية الأساسية.
يمكن اعتبار قيمة استخلافية كل قيمة يكون لها تأثير بقدر معين في جعل النفس مقدرة للصفة الاستخلافية، متحفزة للإسهام في تحقيق أبعادها الفكرية الاعتقادية والوجدانية الشعورية والسلوكية العملية والمهارية، وذلك على المستويين الفردي والجماعي.
فإذا اعتمدنا التقسيم الثلاثي السابق، وحاولنا البحث عن قيمة واحدة على الأقل تكون أساسية أو أصلية لغيرها فإننا سنجد قيما أساسية معدودة في قلب المنظومة التصورية الاعتقادية لكل دين سماوي أو أرضي ولكل مذهب وضعي، تشكل المحور الرئيسي الذي تدور حوله مجموعة القيم الأخرى. فبالنسبة للديانات السماوية غير المحرفة يمكن تحديد القيم الأساسية التالية: الإيمان بالغيب-الأمانة-الوحي-العبودية لله-التوحيد، وأما المسيحية الحالية فمن قيمها كذلك ما ذكر عدا التوحيد الذي أصابه التحريف فانقلب تثليثا مركبا من الله والابن والروح القدس.
ويتفرع عن هذه القيم الأصلية قيم فرعية عديدة منها فيما يخص الإسلام الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإيمان بصفات الله العلى وأسمائه الحسنى، والإيمان بتكريم الله للإنسان وتفضيله على كثير من الخلائق واختصاصه بأمانة الاستخلاف في الأرض، وتسخير ما في الكون له، وتكوين الإنسان من قبضة الطين ونفخة من روح الله وأنه يملك قابلية السمو والتطهر والصلاح مع قابلية التسفل والتنجس والفساد.
وفي المجال الوجداني الشعوري يمكن الانطلاق من القيم الأساسية الآتية: حب الله، حب رسوله، خشية الله، مراقبة الله، حب الجنة، بغض جهنم ومن القيم الفرعية: الحب في الله والبغض في الله، الأخوة الإيمانية، حب العبادات والطاعات والواجبات، كره المحرمات والمعصيات والدنايا…
وأما في المجال السلوكي العملي والمهاري، فمن قيمه الأساسية: العبادات المفروضة والمسنونة والأخلاق الحميدة، والصنعة أو الحرفة، ومن قيمها الفرعية: الصلاة والزكاة والصوم… والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة والتعاون على البر والتقوى، وصلة الآرحام، والوفاء بالوعد، وحب العمل…
ج- المعاني الاستخلافية في القيم الإسلامية.
تقرر سابقا بأن الاستخلاف هو الغاية من خلق الإنسان في الأرض، وهذا يسلمنا إلى الاعتقاد بأن الدين بكل شرائعه يرتبط بهذه الغاية الكبرى على وجه من الوجوه، بحيث يكون معه الاستخلاف إطارا عاما لإدراك قيمة كل قيمة إسلامية وازدياد تعلق القلب بحبها وتقديرها.
فلنحاول تبين ذلك عبر ثلة عشوائية من القيم الإسلامية وهي: الوحي- صلة الرحم- الاحتراف.
- الوحي: ينطوي على معان استخلافية هامة، فعن طريقه حصل التواصل بين الله والآدميين ومعهم الجن، فعلموا من مضمونه المنزل على الرسل عليهم السلام بأنهم ما خلقوا سدى وإنما للابتلاء بتلقي الوحي، فمن انتهج نهجه أفلح في الدنيا والآخرة ومن صد عنه خسر سعادة الدارين. فمعرفة الوحي هي أثمن معرفة منها علم الإنسان عن ربه وحقيقته الآدمية ومهمته الاستخلافية في الأرض ومصيره بعد الموت وهي كلها قضايا أساسية لا يتوصل إليها البشر بعقولهم المحدودة، مما يبوء الوحي مكانة رفيعة في نفس المؤمن لا يسمو فوقها أي علم آخر.
- صلة الرحم: وهي ما يكون بين ذوي الأرحام وأهل القرابة الدموية من تواصل بالزيارات والتهادي، والتفقد والتكافل والتعاون، مما يقوي التماسك المجتمعي بما يقع من ترابط بين مختلف العائلات الواسعة حتى يغدو المجتمع وكأنه لحمة واحدة ونسيج متشابك، فيكون بذلك اقدر على تضافر الجهود وتساند الطاقات والخبرات في ميادين البناء والنماء، إلى جانب إقامة الدين والتواصي بالحق وبذل النصح، وتنمية قدرات الأمة للنهوض بأعباء الاستخلاف في الأرض.
- الاحتراف: إن الحرفة خبرة وعمل يساهم به الفرد في التنمية الاقتصادية لمجتمعه ويتولى توفير خدمة معينه لأفراد المجتمع مقابل ما يحصل عليه من خدماتهم في باقي مناحي الحياة وحاجاتها المتنوعة، وعن طرق الحرف يمارس الفرد دوره الاستخلافي في عمارة الأرض ماديا ومعنويا.
المبحث الثاني: العناصر الأساسية لمنظومة القيم.
أولا – العوامل الفاعلة في بناء منظومة القيم.
1– استخلاص الاتجاه القيمي العام لمنظومة القيم المفترض تحقيقها للريادة التربوية عبر حقب التاريخ الإسلامي.
عند استحضار النتائج الباهرة للتربية الإسلامية عبر تاريخنا المجيد يستوقف الباحث التساؤل حول الكيفية التي ظلت بها منظومة القيم الإسلامية فاعلة في كيان الأجيال تمدها بالحيوية والقدرة على تحقيق التألق في حقب تاريخية معلومة.
وفيما يلي محاولة لمقاربة هذا الموضوع من خلال العوامل التالية:
- استمرار المضمون القيمي العام رغم التراجعات. إننا” حين ننظر إلى مسيرة الدفع الإسلامي الأول وما فجرته الرؤية الإسلامية وجيل الرسالة في كيان الأمة الإسلامية والحضارة الإسلامية في التاريخ، وكيف تعوقت وتعثرت مسيرة الرسالة في واقع الأمة فيما بعد، وحتى اليوم؛ فيبدو الأمر وكأن قيم الرسالة، ورؤية الرسالة، وروح الرسالة في الاستخلاف بالإخاء والعدل والبذل وإتقان الأداء، قد تعطلت عن الحركة في واقع الأمة الإسلامية اليوم، أو كادت. وهنا يجب ألا نخلط في فهم تاريخنا بين قوة الدفع النوعية من جهة، وتراكمات البناء والعمران والصنائع المادية من جهة، وعلى الرغم من أن قوة الدفع قد تكون في تناقص، فإن تراكمات العمران والصنائع- لأمد قد يطول- لابد أن نجدها- غالبا-في تزايد بفعل الوقت والجهد والموروث، وتستمر هذه الصورة المضللة في فهم التاريخ إلى أن يبلغ الضعف والظلم والانحراف والفساد في كيان الأمة قدرا يجفف قاع المنابع، ويقضي على روح المبادرة والإبداع والتجديد.”[51]
فقد تواصل في ماضي الأمة، قاسم مشترك بين جميع القيم الإسلامية من ذلك الإيمان بالله واليوم الآخر واستحضار مراقبته تعالى في السر والعلن، واستشعار عزة الانتماء للأمة الإسلامية…كما أن العبادات ومواسمها المتعاقبة وما تجسده من قيم الإيمان والتوحيد والتقرب إلى الله، والتعاون والتآخي والمواساة والتراحم بين المسلمين، كان لها أيضا دور بارز في بقاء القيم الإسلامية حية في النفوس.
- حضور المنظومة القيمية الإسلامية داخل المجتمع. وذلك في عدة صور منها سيرة الرسول ﷺ وصحابته والتابعين التي تتناقلها الأجيال عبر المؤلفات الكثيرة وشفويا في قوالب مبسطة لكنها مؤثرة في اكتساب القيم الإسلامية الأساسية على نحو معين، ومنها القيم المتضمنة في التراث المكتوب المتاح لطلبة العلم والدارسين مما لا يوجد له نظير عند أمة أخرى، وكذا ما تحمله العادات والتقاليد المجتمعية التي تستمد أصولها من هدي الوحي رغم ما يلحق فهمه من تغير وتبدل، والأهم من كل ما ذكر استمرار تلاوة القرآن في حياة المسلمين محاطا بمشاعر التقديس والاعتزاز والتصديق بأنه كلام الله المحفوظ، وتأثرهم بتوجيهاته بدرجات متفاوتة.
- سير العلماء العاملين من أهل الصلاح والإصلاح. والذين إن خلت من وجودهم حقبة تاريخية لم تخل منها الكتب التي كتبوها أو كتبها تلامذتهم في وصف أخلاقهم وأفكارهم ومواقفهم والقيم التي تشبعوا بها وميزت سلوكهم السديد، ومثل ذلك حاصل أيضا بالنسبة للقادة والمصلحين والمشاهير في صنوف المعارف وكل الإنجازات الحضارية.
فالواقع الإسلامي كان دائما مشبعا بالقيم الإسلامية السامية، لكنها تحتاج إلى تفعيل تتجدد به مناهج التربية، وتتم تنقيتها من المفاهيم الدخيلة غير المنسجمة مع قيمنا الأصيلة، والتي تأثرت إلى حد كبير بما استحدثته بعض الفرق المنحرفة من بدع ضالة، وما نجم عن ضعف النظام والإدارة لدى الحاكمين وتضييعهم لحقوق الرعية وتأييدهم لمن يشايعهم من العلماء المجارين لهم، وأصحاب النعرات العرقية والتوجهات الطائفية البعيدة عن نهج الدين القويم.
ويبدو أن الاتجاه القيمي النسقي الذي ظل دافعا وموجها، وإن كان يقوى أحيانا ويضعف أحيانا، هو اعتقاد المسلم بأنه وارث الرسالة الخاتمة المستوعبة للهداية والصلاح في المعاش والمعاد، وأن المسلمين عندما تراجعوا عن التطبيق الصحيح للدين في رحاب حياتهم، لم ينسوا أبدا انهم سادة العالمين وأكرم أمة على الله، إلى أن اجتاحت أراضيهم جحافل المد الاستعماري الغربي، والذي تحول بعد الاستقلال إلى التمكين لفكر الغرب وقيمه ومحاولة فرضها بكل الطرق والمكائد، وعن طريق أبناء الأمة المنخدعين ببريق الحضارة الغربية المادية، والمنسلخين عن قيم الإسلام الأصيلة، ورغم شراسة الهجمة وعلو مكرها، فقد كانت بداية استرجاع الوعي بالخلل الذي أصاب تدين المسلمين، فأثر على مستوى اعتزازهم بقيمهم ودفع بهم نحو الاضطلاع بأمانة إحياء ما اندرس من معالم هذا الدين الحق وأن يتمثلوا هديه اعتقادا وسلوكا ليكونوا قدوة على دربه لمن خلفهم من أمم الأرض.
2 – ما يلزم اعتباره من أوضاع الأمة وتحدياتها وطموحاتها في اختيار القيم الموجهة للمنظومة.
إن القيم من حيث هي ألفاظ لغوية، فإنها قابلة لأن تحمل معاني معينة عندما توضع في نسق قيمي عام، يؤسس له بإيجاد توجه فكري وثقافي، يراد له أن يكون مهيمنا على التربية والإعلام والثقافة والفن، لخدمة غايات عليا يرتضيها المجتمع بحكامه ومحكوميه، وفي هذه الحالة سنجد الألفاظ تتخلى عن ظاهر دلالتها ومعانيها لتتلبس معاني جديدة تتناغم وتتماشى مع الاتجاه القيمي الذي يمنح كل القيم الرائجة المعاني الملائمة، حتى إنه لا يكاد يزيغ واحد منها عن النسق المختار الذي يلزم أن تنتظم في سلكه جميع قيم المنظومة.
فعندما نريد أن نحدد القيم الموجهة لمنظومة القيم، لا نختار منها ما نختار إلا بناء على ما تتيحه المنظومة القيمية ذاتها من إمكانيات لهذا الغرض، ثم ما تفرضه أوضاع المجتمع والتحديات التي تواجهه والطموحات الناشئة عنها وبيان ذلك كما يلي:
- أوضاع الأمة: والتي كلما عمقنا فيها النظر تبين لنا أنها نتيجة منطقية لفهم معوج لتعاليم الإسلام، لم تفلح المحاولات الجارية إلى الآن في تقويمه ورده إلى أصله الأول.
فما زالت العبادة معزولة عن قطاعات الحياة المختلفة، حيث نرى ظاهرة غريبة ومتفشية على امتداد الأمة، وهي الاجتهاد في العبادات المفروضة والمسنونة، والتقصير في إتقان العمل وظيفة أو مهنة والغش في التجارة ومختلف المعاملات الأخرى، والتساهل في دفع الرشوة وأخذها والتواطؤ على تجاوز تطبيق القانون إذا تعارض مع المصلحة الشخصية، فضلا عن سلوكات أخرى ينظر إليها على أنها أمور هينة وقد غدت من الطامات الكبرى في الحضارة المعاصرة: حب عيش الرفاه بدون عمل، الاستماتة في المطالبة بالحقوق والإخلال المزمن بالواجبات، عدم تقدير قيمة الوقت…
فكل هذه الظواهر ومثلها كثير يمكن النظر إليها باعتبارها أعراضا لفقدان الفهم الصحيح للدين وتشوه صورة المتدين في الذهن، والذي يمكن اعتبار نشر ثقافة الاستخلاف وتربية الاستخلاف بمثابة الاتجاه القيمي الذي ينتشل الأمة من وهدة هذا التدين المغشوش والذي لن يزيد واقعنا إلا تخلفا وفسادا.
- التحديات المواجهة للأمة: وعلى رأسها عجز المسلمين إلى الوقت الحالي عن التخلق بأخلاق الإسلام، وتمثل قيمه الربانية السامية، وتطبيق منهجه الراقي في الحكم والسياسة، وفي الاقتصاد والاجتماع والقانون والآداب العامة والتربية والفن والثقافة، بل إن بعض المسلمين لم يستطيعوا أن يسووا صفوفهم في الصلاة التي تتكرر في حياتهم خمس مرات في اليوم.
أما فشلهم في استرجاع فلسطين وبيت المقدس وتحرير أراض إسلامية أخرى من أيدي المستعمرين، وكونهم زهاء مليار ونصف ولا يستطيعون فرض احترامهم في المنتديات الدولية فأمر ما عاد يجادل فيه أحد، أي أن الأمة تزحزحت عن موقع الاستخلاف في الأرض بمعنى امتلاك القدرة على تسخير موارد الأرض وخيراتها الطبيعية فيما يحقق لها القوة والمنعة وتحرير قراراتها من التبعية للشرق أو الغرب.
ومن جهة أخرى علينا ألا ننسى أننا “سوف نعيش في المستقبل تحولات اجتماعية كبرى! فلنكن مستعدين لنعيشها على أكمل وجه، ولا ننسى الحياة الفكرية كعامل مهم كذلك فقد يترتب عن التطور اختيار القيم والمعاملات التي تميز الإنسان وترقيه. ولعلنا في حاجة ماسة إلى تلاق متلاقح لكيلا تتدهور الإنسانية في خضم القطبية الخطيرة.”[52]
فواضح أن هذه التحديات لا يمكن رفعها دون إشاعة نفس استخلافي قوي في فكر الأمة ووجدانها وثقافتها وتربيتها وإعلامها بحيث يمثل الاتجاه القيمي العام.
الطموحات الناشئة عن الأوضاع والتحديات السابقة: إذا كانت الأوضاع المتردية في واقع الأمة تنطوي في جميع جوانبها على العلل والأدواء، التي قادت إلى فسادها وتفاقم خطرها، فإنها في ذات الآن توجه إشارات واضحة إلى طبيعة الدواء اللازم تجرعه، وتحمل ملامح المخرج من الأزمة المحدقة، وترسم في النفس معالم الفرج والنجاة، والمسلك في ذلك هو ربط تشخيص أصل الخلل في تدهور أحوال الأمة بارتدادها عن المهمة الاستخلافية التي تخلت عنها، مع تراخيها في العمل بنهج الإسلام سليما صحيحا، وغدا اعتزازها بقيمه الخالدة صوريا لا شيء ذي بال يترجمه إلى أفعال بانية وإنجازات نهضوية واعدة.
وما من شك أن الطموح القابل للتحقق، هو الذي ينبني على انخراط فردي وجماعي في استيفاء شروطه، وتحمل كل واحد نصيبه من المسؤولية في إحياء القيم الاستخلافية التي خمدت فاعليها في النفوس منذ زمن طويل.
3 – ما يتعين استحضاره من أحوال النشء وقدراته وحاجاته المعرفية والوجدانية والمهارية.
لا غرو أن أطفالنا وشبابنا يواجهون حالة التناقض البين، بين ما تعلموه في المدرسة أو استفادوه من المواد الإعلامية، التي تعرض صورا مشرقة من تاريخ الحضارة الإسلامية الزاهرة، وما درسوه قبل ذلك عن عظمة الإسلام، وحفظ الله لكتابه ورفع رسوله ﷺ فوق جميع الخلائق، وتفضيل أمته على سائر الأمم أولهم وآخرهم، وبين ما يلاحظونه في واقع الأمة من تخلف عن ركب الحضارة المعاصرة في كل الميادين يقاس بعشرات السنين، فيفقدون الثقة في أنفسهم وآبائهم وأجدادهم وفي دينهم وقدرته على مواصلة العطاء في ظل الظروف الحالية.
ومن الوارد جدا أن تكون حالة الإحباط والقلق الحضاري الناجمين عن أوضاع الأمة الراهنة، هي السبب في الكثير من المظاهر المقلقة التي أخذت تستفحل في أوساط الشباب منها التعثر الدراسي، والعزوف عن الدرس والتحصيل، وتدهور العلاقة مع الوالدين والمربين، وتفشي الانحرافات السلوكية المختلفة وبعض الاضطرابات النفسية، وفقدان الثقة في النفس واليأس من المستقبل، وضعف الإرادة والهمة وغياب الاعتزاز بالانتماء للأمة.
ويعاني الشباب من ضعف منهجي كبير وافتقاد الرؤية الشمولية العاصمة من التيه والخلط والفوضى، “ونظراً لتغير كثير من التحديات التي تواجه الأجيال الجديدة، فقد بات من المهم جدا العمل على أن نبني لديهم رؤية شاملة للحياة، تنطلق من أفق معتقداتنا ومبادئنا، ثم مما تراكم لدى العالم من خبرات قيمة. كثيرا ما تركز الجامعات على التخصص الجزئي والمعارف المتناثرة، ولا تهتم بتشكيل نظرة كلية تمكن الطالب من فهم عميق لأوضاع عصره، بما تشتمل عليه من فرص وتحديات ومخاطر وتحولات، فيخرج الطالب وهو يعرف أشتاتا من المعلومات حول قضايا وموضوعات لا تحصى، لكنه فقير إلى حد الإدقاع في معرفته بمسؤولياته تجاه نفسه وأهله ودينه وأمته، وفقير إلى معرفة الأولويات التي عليه أن يتحرك على أساسها… وإذا أردنا أن نكون صريحين مع أنفسنا، فإن علينا أن نقول: إن كثيرا من المدارس والجامعات لا تستطيع في أوضاعها الحالية أن تقدم الكثير لطلابها في هذا الشأن؛ لأن كثيرين من أساتذتها ومعلميها غارقون في تخصصاتهم، ويفتقرون إلى الانتباه والتركيز على أشياء عديدة مما يفتقر إليه طلابهم. ولذلك فإن تلك المؤسسات مطالبة بأن تغني نفسها أولا بالمفاهيم والأفكار النهضوية المعاصرة قبل أن تشرع في عمل شيء لطلابها.”[53]
ولن ينفع في مواجهة هذه الظواهر الكلام المشحون بالأماني والوعود إذا لم يعاينوا بأم أعينهم وقائع على الأرض تنعش الأمل في النفوس وتعيد إليها الثقة المفقودة في إقلاع حضاري جديد على أساس قيم الاستخلاف، التي من شأن التربية عليها بجدية وإخلاص أن تخرج جيلا جديدا معافى من حالات العجز والوهن وتراجع القدرة الإنجازية وانطفاء الفاعلية وموت الضمير.
4 – تحديد اتجاه منظومة القيم الأصيلة المحققة للتجديد التربوي
والإقلاع الحضاري المنشود.
من خلال ما تمت بلورته في الفقرات السابقة، يترجح أن الاتجاه الاستخلافي المتأصل في القرآن الكريم والسنة النبوية، تتأكد ملاءمته ليمثل اتجاه منظومة القيم الإسلامية الأصيلة وذلك للاعتبارات الآتية:
- كون مبدأ الاستخلاف من المبادئ الإسلامية الكونية، التي تمثل الغاية الكبرى لوجود الإنسان على الأرض وتكليفه باستعمارها بمنهج الوحي المنزل عليه إن شاء أو بما يرتضيه من مناهج بشرية من ثمرات فكره وتجاربه الخاصة.
والاستخلاف بهذا المعنى مهمة مشتركة بين جميع البشر بغض النظر عن النهج المؤطر له، هل تم استمداده من النقل والعقل أم من العقل وحده.
وأما الاستخلاف الذي ارتضاه الله للإنسان ودعت إليه الكتب السماوية وعملت على التبشير به الرسل عليهم السلام فهو الاستخلاف على نهج الدين والذي تتحقق به السيادة والريادة في استغلال موارد الأرض وخيراتها وتسخير إمكانياتها لإحقاق حق الدين الحق وإبطال باطله، ونشر أخلاقه وإعلاء منهجه الشامل لإصلاح الدنيا بالدين بين جميع الأمم. وفي هذا الصدد يقول عبد الحميد أبو سليمان: “ولما كانت جذور منهجية فكر الأمم الإسلامية والتربة التي تنبت منها مفاهيمها وقيمها إنما هي تنبثق- ولاشك- من رؤية الأمة العقدية القرآنية الكونية، أو ما يدعى “رؤية العالم”؛ لأنها هي التي تحدد فهم الإنسان فردا وأمة وجنسا لذواتهم، ولمعنى وجودهم، وللغاية من هذا الوجود، وعلاقاته بالذات وبالآخر وبالعالم وبالكون في كل أبعاد هذا الوجود، ومآل هذا الوجود، فإن هذه الرؤية هي الجذور والتربة والمنبع الذي يمثل القوة الدافعة العقدية التي تحدد طبيعة القوة الوجدانية المحركة للإنسان وللمجتمع، والتي تحدد توجهاتهم وفاعليتهم، وترسم وجهة مسيرتهم في الحياة، ومدى قوة هذه المسيرة الإنسانية وفاعليتها الإعمارية الحضارية في الوجود والتاريخ.”[54]
- شمول الاستخلاف للدين كله وارتباط تكاليفه به كلها، سواء منها الاعتقادية والتعبدية أو الأخلاق والمعاملات. فكل تكليف من دائرة العقيدة يكون متصلا بالتأسيس الاعتقادي للاستخلاف، مثال ذلك الإيمان بالغيب بكل مكوناته وهو أساس الاستخلاف الإسلامي المبني على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالله تعالى استخلف الإنسان في مجال من عالم الغيب، هو ما كلفه أن يعتقده مما يدخل في أركان الإيمان وما جاء به خبر صحيح من الغيبيات، واستخلفه أيضا في مجال من عالم الشهادة هو كوكب الأرض، وكل استخلاف انعزل في مجال واحد منهما فهو ناقص وخاطئ وفاقد لخاصيتي الشمول والتوازن، فبعض الكتابات التي تناولت قضية الاستخلاف تكاد تحصره في المجال الدنيوي ولا تعير كبير اهتمام للمجال الغيبي الذي هو أساس الاستخلاف الأرضي والضامن لصلاحه والحيلولة دون تحوله إلى افتتان بالدنيا وطغيان فيها.
وكل تكليف من دائرة العبادة والأخلاق فله ارتباط بالأساس التربوي للاستخلاف، حيث تتجه العبادات المفروضة لتربية الإنسان على قدرات وكفايات استخلافية يرمي قسم منها إلى ترسيخ الإيمان في القلب مثل: مراقبة الله في كل آن، وتذكره حينا بعد حين، والخشوع له ودعاؤه والتوكل عليه واستغفاره والتوبة إليه… ويهدف قسم آخر إلى تحسين السلوك وترقيته مثل: الامتثال والانضباط لأمر الله ونهيه، والتعود على النظام وتنظيم الوقت والصبر وتقوية الإرادة، والتحكم بالغرائز والشهوات…
وكل تكليف ينتمي لدائرة المعاملات فله ارتباط بالتدريب على الأعمال المادية الضرورية لممارسة الاستخلاف في واقع الأرض، من ذلك المعاملات المتصلة بأعمال الفلاحة والتجارة والصناعة وتنظيم الحياة العامة بتدوين الأنظمة والقوانين وتنظيم العلاقات داخل المجتمع، بين الحكام والمحكومين وبين المسلمين وغيرهم داخل الدولة المسلمة وخارجها، وإقامة الأمن والنظام في البلاد… فكل هذه التعاملات والتنظيمات والممارسات المنضبطة بالضوابط الشرعية الموجهة، تمثل الجانب العملي التطبيقي لتفاصيل وجزئيات الوظائف الاستخلافية.
- مناسبة الاستخلاف لاستيعاب جميع القيم الإسلامية، فهو يستوفي شرط تأطيرها والتأثير فيها بمنحها قيمة إضافية من معانيه وغاياته ومقاصده، بحيث تنصهر كلها في بوتقته ويخلع عليها من ديناميته وفاعليته، ولعل قدرا من هذه العلاقة قائم بالفعل بين الاستخلاف باعتباره غاية الوجود وبين جميع القيم الإيمانية، لكن بناء منظومة للقيم تحت توجيه الاستخلاف يسمح بتعزيز مختلف أبعاده ومعانيه ويجعلها أكثر بروزا وبداهة، إذ ما من قيمة إسلامية أصيلة إلا وتتواشج مع قيمة الاستخلاف، المهيمنة على جزئيات الدين كلها، بحكم أساسيتها لتشريعه وتنزله من السماء إلى الأرض، ولها قابلية التلاقح معه لإنتاج معاني اسخلافية إضافية تزداد معها قيمتها التربوية.
ولنضرب مثالا على ذلك بالسلام الذي يلقيه المسلم على أخيه، – وهو من القيم التي يعتز بها المسلم- ويعني أنه يسالمه ولا يبغي عليه، عملا بمقتضيات الأخوة في الدين وحق المسلم على المسلم كما في الحديث:” المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة”[55] فالتحية بكلمة السلام قابلة لربطها بمعاني استخلافية واضحة بالتطرق إلى بعض حكمها التشريعية ذات المنحى الاستخلافي، والتي نشير منها إلى كون السلام شديد الصلة بالاستخلاف الإسلامي، الذي من أسمى غاياته تحقيق السلام في الأرض بين الإنسان والخالق، وبين الإنسان ونفسه، وبينه وبين أخيه المسلم وغير المسلم، وبينه وبين الطبيعة، التي يلزمه الله بأن يسخر خيراتها دون تخريب نظامها وإفساده. كما أن الاستخلاف على غير هدي الإسلام يؤدي عاجلا أو آجلا إلى الحروب وسفك الدماء وبطش القوي بالضعيف وانتشار الظلم وترويع الآمنين وقتل الأبرياء.
فتحية الإسلام تعلم المسلمين كيف يحيون بالسلام وكيف يمارسون الاستخلاف في الأرض بالإسلام لتحقيق السلام الذي تنعم به الإنسانية جمعاء إلا من اعتدى وتجبر وطغى فإن حربه من أهم أسباب السلام ومن أوجب واجبات الاستخلاف.
ثانيا: القيمة الشاملة المحددة للاتجاه القيمي للمنظومة
- اختيار القيم الإسلامية المجسدة للاتجاه الأصيل للمنظومة.
إذا كان الاستخلاف هو الاتجاه الأصيل للمنظومة، فإن القيم التي تجسده كثيرة ويمكن اختيار تصنيفها بحسب مجالات التصور والسلوك والمعارف. ففي جانب التصور نجد الإيمان – التكريم – الأمانة – الحرية – الحق – الباطل – الفضيلة – الخير- الريادة – الرسالة – الوحي- الله – الأمة – التنمية…
وفي مجال السلوك يمكن سرد هذه القيم: الإعمار- الإتقان – الإبداع – الإنجاز – الاتحاد – التعاون – المحبة -لتضامن – التعبئة – التفاهم – الإخلاص – الصبر – الكفاح -التناصح…
وأما في مجال المعارف: الثقافة – الفن – الأدب – الشريعة – القرآن – السنة – السيرة – الموعظة – الإرشاد – التأليف – التربية – التعليم – التكوين – التأهيل – التكنولوجيا – العلوم الإنسانية – العلوم التجريبية- الرياضة – الإعلام…
- تحديد العلاقة الموجودة بين هذه القيم.
توجد علاقات بين القيم في المنظومة الواحدة، منشأها وحدة المنطلق والمبدأ وأنها كلها تفصيلات لقيم أصلية قد تؤول بدورها إلى قيمة واحدة تجسد وحدة المنظومة وتمنحها سمة خاصة واتجاها واضحا.
فمن القيم الإسلامية الأصلية يمكن تحديد ما يلي: الإيمان والأمانة والتربية، والعدل، والحرية، والصبر، والعفة… على اعتبار أن لكل منها شأن عظيم في رسم ملامح الواقع الإنساني، والكثير من القيم غيرها تعتبر قيما متفرعة عن واحدة أو أكثر من هذه القيم الأصلية.
فالإيمان يشمل قيما عدة مثل: التصديق، الاعتقاد، اليقين، الإنابة، الإقرار بالغيب، الاقتناع، العلم، التسليم، الانقياد…
فهذه القيم متفرعة عن الإيمان، تتضمن كل واحدة منها معاني مشابهة للإيمان أو تكون موضحة لإحدى خصائصه ومقتضياته. ويمكن أن يلحق به القيم التي تدل على آثاره في النفس مثل الخشية، الخوف، الرجاء، التوكل، المحاسبة، الحب في الله، البغض في الله…
والأمانة تشمل: التكليف، المسؤولية، الواجب، المراقبة، المحاسبة، النزاهة، العفة، الإخلاص، الصدق، التفاني، التقوى… فمعظم هذه القيم تعد ثمارا للأمانة، مثل المحاسبة والمراقبة، والصدق، والعفة وغيرها كثير.
وتشمل التربية: التزكية، التطهر، الصلاح، الاستقامة، التعلم، العلم، الانضباط، التنظيم، الصبر، الوفاء، التوبة، الصدق، الخشية، الاستغفار، الورع، الزهد، التواضع، الإخلاص، التدريب المهاري، التكوين المهني، الإبداع، التفكير، الاعتبار… هذه القيم تعتبر تفاصيل متكاملة للتربية الإسلامية الشاملة لما هو فكري ووجداني وسلوكي ومهاري وتستمد قيمتها من مدى حاجة الإنسان إليها لبناء ذاته وإعدادها للقيام بمهمة الاستخلاف الإسلامي.
فما يلاحظ على هذه القيم الفرعية هو إمكان انبثاقها عن أكثر من قيمة أصلية مثل المراقبة فهي نتيجة للإيمان كما أنها نتيجة للأمانة وللتربية الإسلامية ومثل ذلك بالنسبة للمحاسبة والتقوى والورع والعفة…
- بحث إمكانية دمجها في قيمة شاملة.
يبدو أن هذه القيم الثلاثة الأصلية على قدر من التداخل فيما بينها، بحيث يمكن لكل واحدة منها أن تستوعب الأخريين، فالإيمان يستوعب الأمانة لإنها ناتجه عنه ويستوعب التربية لإنه هو أساسها المكين. كما أن التربية تستوعب الإيمان باعتبار اكتسابه وتنميته في النفس والانطلاق بطاقته نحو العمل الصالح، هو غايتها الأساسية، وتشمل الأمانة من حيث إنها غاية كبرى للتأهيل للاستخلاف. وبنفس التفسير فإن الأمانة قابلة لتكون أسبق على الإيمان فهي التي تحمل الإنسان على اعتناقه بحيث إنها فطرة في النفس تدفعها لاختيار مسلك بعينه وتتحمل مسؤولية اختياراتها كاملة، ويدعم هذا الفهم أن الأمانة التي حملها الإنسان وأشفقت منها السماوات والأرض والجبال يظل متحملا لها ولا ينفك عنها سواء اختار الإيمان أو اختار الكفر إلا أن الأمانة التي يتواصل نموها في إطار الإيمان تختلف عن التي يتواصل الاضطلاع بها في مجال الكفر، وقد وصف الله بالأمانة بعض أهل الكتاب عند معاملتهم للمسلمين مع أن الكتب التي يؤمنون بها ويحتكمون إليها خضعت لانحرافات واسعة: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (آل عمران:75).
ونرى الغربيين اليوم وهم ما بين مسيحيين ولا دينيين يتصفون بخلق الأمانة ويعتبرونها من أسمى قيمهم، لكنها أمانة يحاسب عليها القضاة تنفيذا للقانون الوضعي وليس رب العالمين.
كما أن الأمانة هي أساس التربية الفعالة وغايتها في جميع مذاهب الأرض، والتربية الإسلامية كلها تدور حول الأمانة إحساسا وتطبيقا.
يترجح من التوضيحات المقدمة بأن الأمانة الاستخلافية كما بينها القرآن الكريم والسنة النبوية، أول مجالاتها وأشرفها الإيمان بالغيب الذي هو باب الدين الواسع وركيزته الأساسية، والثاني النفس البشرية والثالث الأرض. فمنذ أن يبلغ الآدمي الرشد وهو يمارس أمانة الاستخلاف، فيستعمل عقله في جلب المصالح ودفع المضار والتكيف مع مستلزمات العيش داخل البيئة الاجتماعية، ويتأمل فيما حوله ويعرض ما يبلغه من معلومات على عقله فيستنتج ويقارن ويتأمل ويتفكر ثم يعزم ويقرر في كل ما يطرح أمامه من قضايا وتساؤلات، وعندما يقتنع بأن يؤمن بدين الله ويتيقن بأنه الحق المبين، يدخل منعطفا جديدا في ممارسة أمانة الاستخلاف من منظور الإسلام، وساعتها تكتسب الأمانة عنده أبعادا مغايرة، حيث يصير المكلف بها والمحدد لمسؤولياتها والمحاسب عليها والمثيب لمن تحملها بصدق وأداها بإتقان، والمعاقب لمن تنكر لها أو تهاون فيها، هو الله تعالى خالق السماوات والأرض وخالق كل مخلوق، السميع العليم البصير وهو على كل شيء قدير.
فمن خلال ما توضح يرجح اعتبار الأمانة قيمة شاملة لغيرها من القيم الاستخلافية الأصلية والفرعية، مع تأكيد بأن تحديد قيمة ما بأنها شمولية وممثلة للنسق القيمي العام يمكن أن يكون مجالا لقدر من المرونة بناء على أن القيمة الشاملة المختارة تصبح لها الهيمنة المطلوبة إلى حد كبير بمجرد التعامل المنهجي معها على هذا الأساس.
- استعراض سلبيات وإيجابيات منهج القيمة الواحدة المشكلة لاتجاه المنظومة.
قد يعترض على نهج الاتجاه القيمي العام للمنظومة القيمية بكونه يوقع في أحادية النظرة والجمود على البعد الواحد وإهمال الأبعاد الأخرى مما يخشى منه تكوين عقلية منغلقة ومنحصرة في دائرة محدودة لا تسمح بالانفتاح على الأبعاد المختلفة والرؤى المخالفة.
كما يجعل القيم المتعددة التي تتميز عن بعضها تندرج كلها في اتجاه واحد وتدور حول معنى محوري واحد، فهذا يحمل القيم المختلفة على الدوران في فلك قيمة واحدة ويمنحها الهيمنة المطلقة عليها، فتغدو كلها وكأنها قيمة واحدة وليس قيما عديدة!
ثم أليست القيم في حقيقتها متعددة، لكل منها غاية تحققها ومهمة تؤديها، فإذا تم إخضاعها لنسق قيمي معين اختفت تلك الغايات وتقلصت تلك المهمات أو توقفت تماماً.
وللرد على الاعتراضات السابقة وتفنيد مستنداتها، يمكن تقديم التوضيحات التالية:
أ – حاجة التربية إلى تركيز.
بداية تدعو الحاجة إلى التذكير بأن من أهداف الفكر المنهجي الذي يسود مختلف العلوم، الانطلاق من الجزئيات في اتجاه ما هو كلي شمولي، يصوب النظر إلى الأساسيات التي قد تختفي في ركام التفصيلات، فيتيه في تتبعها العقل وتصده عن استنتاج أصولها التي تولدت عنها في غياب تصور كلي ورؤية شمولية، “ولعل العلاقة بين النظر الجزئي والنظر الكلي الشمولي في الدراسات الاجتماعية أقرب شبها بمن يأتي بقطعة من الورق ويسكب عليها شيئا من الحبر ويقف أمامها متأملا بعين خياله فيما يتبدى لتهيؤاته من رسوم وأشكال وصور لاوجود لها في الحقيقة، ويعبر عنها بما يشتط إليه خياله حيالها من تصورات وتهويمات…وكثيرا ما يؤدي المنهج الجزئي في تأملاته وإنعامه النظر وخيالاته- لمن لا يحسن استخدامه ولا يدرك حدود فاعليته- إلى تصورات وهمية، ونتائج اعتسافية لا تمت إلى الواقع والحقيقة بصلة”[56]
إن تعدد أهداف التربية يؤدي لامحالة إلى ضعف نتائجها وتشتت اهتمامات الخاضعين لها، وهو ما يجعل المصممين للرؤى التربوية والمخططين لبرامجها يبحثون عن هدف أساسي تدور حوله أهداف فرعية، فهذا النهج له فعالية كبيرة في تحقيق الهدف المركزي وتبعا له الأهداف الفرعية، التي أصبحت جزءا منه وتدور معه وجودا وعدما، وغدا من “أهداف الخبراء الحقيقيين هي أن يغرسوا في أبنائهم تدريجيا دستورا من الأخلاق من خلال الأمثلة التي يقتدى بها والتوجيهات الأخلاقية المباشرة. وهم لا يعنون بكلمة (غرس) أن يعرضوا لها مصادفة حيت تعترضهم، وإنما يعنون إيمانا حقيقيا متأصلا بها.”[57]
فهذا النهج هو المعتمد في التكوين على مختلف المهن والتخصصات، حيث تتمحور جميع المواد النظرية والتدريبات العملية حول ما يتعلق بتخصص علمي أو مهني محدد. فلا طاقة الإنسان الاستيعابية تحتمل أكثر من علم، ولا وقته يتسع للتحصيل الموسع، ولا الممارسة العملية تكون متقنة ويمكن الإبداع فيها مع تعدد المهن أو التخصصات. بل إنه حتى على مستوى تمثل القيم في سلوك الفرد غالبا ما يكون خلق واحد هو الأبرز أكثر من غيره ويعرف به في وسطه. كما يفهم ذلك في قول رسول الله لأشج بن عبد القيس: “إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ”[58]. فيدل تخصيص هاتين الخصلتين على كونهما أظهر من غيرهما، كما أخبر رسول الله ﷺ عن بروز خصال أخرى في صحابة آخرين:” (أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح.)[59].
فمن فوائد اعتماد منهج الاتجاه القيمي الذي هو الاستخلاف الإسلامي بالنسبة لنا، تحقيق فعالية أكبر في تعليم القيم وتيسير ترسيخها في النفوس، بحيث تتعدد فرص توارد معانيه عليها مما يجعلها أكثر تشبعا بها وأعمق فهما لأبعاده، الأمر الذي من نتائجه حصول اقتناع كبير بأهمية الاستخلاف وارتفاع مستوى الاستعداد للعمل وفق أبعاده ومراميه ومقاصده.
ومن آثار تطبيق هذا النهج في الإسلام أن مبدأ التوحيد يتم تكريسه في الفكر والوجدان والسلوك بصورة مكثفة تجعله مفهوما وممارسا بشكل فعال. فالصلاة المتكررة خمس مرات في اليوم ينادى لها بالأذان ومن ألفاظه “أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله” وتعاد نفس الألفاظ عند إقامة الصلاة وفي التحيات يقرأ المصلي:” أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله” وهو شاهر اسبابته مشكلاً بها رمزا للتوحيد كما يتعزز اتجاه التوحيد في الصلاة بالتوجه نحو القبلة من أي موقع على الأرض يوجد فيه، ونفس الاتجاه يتجسد بترديد التكبيرات والقيام بالركوع والسجود الرامزين للخضوع والاستسلام لله وحده، وفي أذكار الصباح والمساء المأثورة ترد معاني التوحيد في صيغ مختلفة منها: “أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص(وهي لا إله إلا الله) وعلى دين نبينا محمد ﷺ وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين” ومثل هذه العبارات والمعاني متوافرة في محتويات هذه الأذكار. وعندما يقرأ القرآن تعود نفس المعني التوحيدية لتحضر في فكره ووجدانه. وفي باقي الممارسات تمثل واضح لحقيقة التوحيد عندما يستعان بالله وحده ويجأر إليه بالدعاء من غير شريك، ويخلص له في الصوم والزكاة والحج الذي تزخر شعائره بعبارات ورموز توحيدية كثيرة.
ب – الفوائد التربوية لهذا النهج.
تتداخل القيم التربوية كما قدمنا أمثلة لذلك، وهذا ما يجعلها تتعاضد فيما بينها ليكمل بعضها بعضا، ويكون ترسيخ بعضها داعيا وميسرا لترسيخ غيرها ممن له بعض الارتباط بها. فالصدق مثلا يؤدي إلى الإتقان في العمل والصراحة في القول، والإخلاص في المعاملة، والنصح للمسلمين… وفي الحديث: “إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا”[60] فكون البر -وهو العمل الصالح- يهدي إلى الجنة معناه أن الصدق الذي يهدي إليه يهدي للتحلي بمعظم الأخلاق والصفات التي حض عليها الإسلام ودعا للاتصاف بها، ويعني أيضا أن الصدق اتجاه قيمي نسقي ينتظم جميع القيم الإسلامية، فمثلا نتساءل ما علاقة الصبر بالصدق؟ علاقته تظهر في كون الصبر على مشقة العمل الصالح الذي يقصد به وجه الله تعالى لا يطيقه إلا صادق الإيمان. وبما أن الإيمان نطق باللسان أي صدق في القول وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، فإن كل طاعة وكل خلق حميد فإنه يعكس حالة للصدق الإيماني الواقر في القلب.
ومن جهة أخرى فإن الخلق الفاعل في السلوك هو المترسخ في النفس على نحو متين بحيث لا يتزعزع أمام هزات الرغبة أو الرهبة، وترسخه لا يتحقق إلا بالممارسة الدائمة وهى ما يتأتى باعتماد الاتجاه القيمي النسقي الذي يترسخ من خلال ممارسة أي من القيم الفرعية التابعة لمنظومته، كما أن التركيز عليه ينعكس على قيمه المختلفة بالتقوية والتنمية المستمرتين.
فعندما يمارس المسلم أي طاعة أو قربة يشعر بازدياد إيمانه الذي هو بمثابة الاتجاه القيمي النسقي الحاضر في جميع الطاعات من عبادات وأخلاق، فيزداد إيمانه في صورته الشعورية الوجدانية كما يزداد في صورته الفعلية بتزايد الاستعداد لأفعال مشابهة أخرى. وقد تقررت هذه القاعدة التربوية في القرآن في آيات منها: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} (محمد:17). {وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا} (مريم:76). ” وكما قيل إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها”[61]. وقيل إن من عقاب السيئة السيئة بعدها وقد رأينا في الحديث السابق كيف أن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، فالحالة النفسية عندما تتضافر مع الحالة الاجتماعية ويندمجان معا في اتجاه قيمي نسقي عام تتهيأ من خلاله أسباب الانخراط التلقائي والعفوي في ذات الاتجاه بيسر وسهولة. وفي القرآن كذلك شواهد لهذه القاعدة النفسية/التربوية فقد بين الله أن بني إسرائيل اتخذوا العجل وتوجهوا له بالعبادة وتشربته قلوبهم بسبب ما كان ثاويا فيها من كفر لم تزل بقيته رغم ما شاهدوه من معجزة إنجاء الله لهم من فرعون بعد انفلاق البحر لهم وإغراق فرعون وجنوده. {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (البقرة:93). فما استقر في القلب من توجهات عقدية يوحي بالعمل الذي ينسجم معها ويترجمها في الواقع، فالعقيدة تدفع نحو العمل وكل عمل يندرج في إطارها يدعو إلى أعمال أخرى في نفس اتجاهه، {قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ} (هود:87). وتلتقي هذه الآية مع ما بينه القرآن الكريم من دور الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر وكل ما يصح أن يثبت له النهي يثبت له الأمر أيضا، وما نسبه قوم شعيب إلى صلاته هو أمر بالانتهاء عن عبادة غير الله وإنفاق الأموال فيما لم يشرعه الله تعالى.
5 – القيمة الشاملة المقترحة لتجسيد اتجاه منظومة القيم الأصيلة.
يحتاج الاتجاه القيمي للمنظومة القيمية إلى قيمة شاملة يتجسد من خلالها وتستوفي الشروط التالية:
- أن تكون القيمة الشاملة مجسدة للاتجاه القيمي للمنظومة.
وهو ما يقتضي توفرها على خصوصيات تمكنها من تمثيل الاتجاه في أهم أبعاده والتعبير الوافي والدقيق عن غاياته ومقاصده. وقد أتبع هذا المنهج في بناء منظومة القيم قبل خمس سنوات: “ففي بريطانيا يقدم D.Beckham – 2004 محاولة لرسم خريطة للقيم الأخلاقية في بريطانيا Britain’sMoral Values Mapping مستندا في ذلك على قيمة الأمانة honesty كقيمة محورية في مجال التنمية الخلقية، وأن الأخلاق تدعمها القاعدة الذهبية (تعامل مع الآخرين بما ترغب أن يتعاملوا به معك).”[62] فهذه القاعدة الأخلاقية تؤدي وظيفة الاتجاه القيمي للمنظومة الذي يجعل الإنسان ملتزما بقيم الشرف والنزاهة والموضوعية والحب وكل المعاملات الرفيعة التي يرغب أن يعامله بها غيره والذي يجسد هذا الاتجاه القيمي هو الأمانة إذ بدونها سيسمح لنفسه بخرق تلك القاعدة إذا وجد ما يغريه بذلك وربما تعلقت نفسه بشيء دنيء ويرغب أن يعامل به الناس ويعاملوه به. لكن الناس ليسوا كلهم مستعدين لممارسة ذلك الخلق، وهنا تتدخل الأمانة لتحسم الوجهة الأخلاقية وتصون القيم، فمحوريتها تخول لها أن تدعم احترام أي خلق وأية قيمة، وتمنع التأويلات والتبريرات للخروج عن القاعدة التي ترسم أمام الإنسان الاتجاه الذي يلزم أن تولي شطره جميع الممارسات القيمية. فهذه القيمة المحورية / الشاملة والتي هي الأمانة تمتلك خاصية ضبط الاتجاه حتى لا ينحرف عن مساره الصحيح فضلا عن كونها تعطي لأية قيمة وزنها الحقيقي وفاعليتها التربوية.
والأمانة التي تم اختيارها لتجسيد اتجاه الاستخلاف الإسلامي، تمثل لب الاستخلاف الذي هو تحمل المسؤولية فيما استخلف الله الإنسان فيه، أي نفسه والدين المنزل عليه والأرض التي يعيش فوقها. فالاستخلاف نيابة عن الله في إنفاذ مراده وتطبيق حكمته من خلق الإنسان حرا ومسؤولا تجاه نفسه وخالقه والحياة، وأن الإنسان يظل خليفة مسؤولا سواء سلك نهج دين الله أو سلك نهجا غيره، فكلا الموقفين من مشيئة الله تعالى {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} (المائدة:48). {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} (هود:118- 119).
أورد الطنطاوي في تفسير الآيتين: “ولو شاء ربك – أيها الرسول الكريم الحريص على إيمان قومه – أن يجعل الناس جميعاً أمة واحدة مجتمعة على الذين الحق لجعلهم، ولكنه – سبحانه – لم يشأ ذلك ، ليتميز الخبيث من الطيب ، وشبيه بهذه الآية قوله – تعالى – {وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأرض كُلُّهُمْ جَمِيعاً} وقوله – سبحانه – {وَلَوْ شَآءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهدى} وقوله {وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ . إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ} تأكيد لما اقتضته سنته من اختلاف الناس.
أي: ولا يزالون ما بقيت الدنيا مختلفين في شأن الدين الحق ، فمنهم من دخل فيه وآمن به ، ومنهم من أعرض عنه ، إلا الذين رحمهم ربك منهم بهدايتهم إلى الصراط المستقيم من أول الأمر ، فإنهم لم يختلفوا ، بل اتفقوا على الإِيمان بالدين الحق فعصمهم الله – تعالى – من الاختلاف المذموم”[63].
إن الاستخلاف بهذا المفهوم الشامل يستوعب جميع بني آدم ويضعهم أمام مسؤولياتهم بخصوص المنهج المعتمد لممارسة الاستخلاف، بحيث لا يمكن إقصاء أي فئة بشرية من صفة الاستخلاف بل لا نعدو الصواب إذا سمينا كل استخلاف بخلفيته الاعتقادية والمذهبية، مثل الاستخلاف الإسلامي والاستخلاف المسيحي والاستخلاف العلماني، وهكذا تتحد البشرية في أصل الاستخلاف وتتساوى أمام أمانته وتختلف في مناهج ممارسته، ومن هذا المنطلق تمتد مساحة شاسعة للتفاهم والحوار والتعاون في النهوض بالمسؤوليات المشتركة تجاه السلم والأمن العالميين ومكافحة الفقر والجوع والجهل والمرض ومشاكل البيئة، وتعزيز الكرامة الإنسانية وتقبل الآخر في إطار الاحترام المتبادل.
والمسلم يقوم بأمانة الاستخلاف الإسلامي من خلال التزامه بمنهج الإسلام الشامل لما يحقق سعادة الدنيا والآخرة.
وتعد الأمانة من منظور الإسلام أنسب قيمة لتجسيد اتجاهه القيمي لما تمتلكه من خاصيات متفردة وهي:
- خاصية العمومية: بمعنى أنها ضرورية لاكتمال أي عمل وتحقيقه للغاية المنتظرة منه، فضلا عن كونها تمثل المعنى الصحيح والواضح للاستخلاف من حيث هو مسؤولية الإنسان عن نفسه وعن دين الله إذا بلغه وعن الأرض التي يحيا في أحضانها.
فما من عمل إلا ويتطلب القيام به على أحسن وجه استشعار أنه أمانة لا ينجي المرء من تبعاتها والعقاب الذي رتبه الله تعالى على من أخل بها إلا أداؤه بإحسان وإتقان جهد المستطاع ودون تقاعس أو تقصير. وهكذا نجد أن الإيمان الذي هو أساس الدين لا ينشأ إلا عن استشعار عميق وصادق للأمانة، أمانة النفس التي توقن بأن من مصلحتها الانخراط في الإيمان والسير على نهجه، ومن خسارتها وشقوتها رفض الدخول فيه والإعراض عنه.
وما الدين إلا مجموعة من التكاليف التي ألزم الله بها الإنسان وجعلها أمانات في عنقه، ووعد الطائعين نعيم الجنة والعاصين عذاب جهنم، فما يحمل العقل على الاعتقاد بيوم الحساب والقيام بالطاعات واجتناب المعصيات هو النظر في عواقبها الجسيمة والتي تؤدي إلى استعظام هول المسؤولية والحرص على عدم التهاون بشأنها.
فإذا قوي الإحساس بالأمانة في النفس، تعبأت للقيام بأية مهمة مهما كانت صعبة ولم تستهن بأي عمل ولوكان بسيطا لأن نسقية المسؤولية تشمل كل ذلك وتأبى على الإنسان احتقار الأعمال أو استقلال ثوابها، كما نبه الشرع على ذلك: {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ} (النور:15) وفي الحديث: “لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.“[64]
- خاصية الفاعلية: يشغل الكلام عن الأمانة الحيز الأكبر من المضمون الشرعي، متناولا حقيقتها وأهميتها في استقامة الإنسان، ومذكرا بنتائجها في الدنيا والآخرة، فكلما تطرق القرآن إلى قضية إيمانية ربطها بما يقوي الإحساس بالأمانة في النفس، حيث إن الإنسان لا يكاد يعير أي وزن لشيء مهما كانت قيمته في ذاته إلا بناء على ما تستشعره النفس تجاهه من أمانة، تتعرض بسببها للمراقبة والمحاسبة فالمعاقبة أو المكافأة.
نسوق من أمثلة ذلك في القرآن: {وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (التوبة:98- 99). فقد عقب الله على سلوك الأعراب غير المؤمنين بأنه مطلع على ما يفعلون ليعاقبهم بما يستحقون، وعقب على سلوك المؤمنين منهم بأنه سيجازيهم عليه بإدخالهم في رحمته ومغفرة ذنوبهم.
ولا يرد في القرآن أمر ولا نهي دون أن يشفع بما يصبغه بصبغة الأمانة ونتائجها جزاء وعقابا، لأن كل عمل تكليفي إذا لم يكن مؤطرا بروح المسؤولية افتقدت النفس الرغبة في الالتزام به فعلا أوتركا، فهان عليها إهماله وعدم الاكتراث به. فمن أمثلة الأمر: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (البقرة:110) ومن أمثلة النهي: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (الفرقان:68-70).
بقى الإشارة إلى أن الأمانة في المنظور الإسلامي تحقق قمة الفاعلية الإيمانية فمن أيقن بالله واليوم الآخر بلغت فاعليته حدا لا يبلغ مثله أحد من البشر، إلا من كان له مثل يقينه الإيماني أو زائدا عليه، بحيث تتضاءل كل الدوافع والحوافز إذا ما قورنت بالفوز بنعيم الجنة الخالد والنجاة من حر جهنم المقيم، ولذلك يتردد الحديث عن الجنة ونعيمها والنار وحريقها في متن القرآن بوتيرة مرتفعة ليظل الوعي بالأمانة في القلب متجددا والاستعداد للقيام بمقتضياتها متزايدا.
- أن تكون القيمة الشاملة ذات وظيفية واسعة.
يتسع مجال الأمانة ليعانق جميع السلوك البشري دون استثناء وتنساب روحها في كل القيم الإسلامية والإنسانية عامة مانحة إياها من شأنها وعلو قدرها وجاعلة منها قيمة محبوبة في النفس لأنها ذات قيمة واضحة وصلة متينة بأصل الأمانة التي علمت قيمتها العظيمة في الشرع والعقل معا، وبسبب تحملها تم تفضيل بني آدم على باقي الكائنات {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} (الإسراء:70). فهذا التكريم الأصلي ممنوح للإنسان من حيث هو كائن حر مسؤول، والتكريم الثاني يستحقه إذا هو تحمل الأمانة بحزم ولم يفرط فيها وجاهد نفسه على النهوض بأعبائها المختلفة ولم يتوان في ذلك.
فما من أمر ذي بال في دين الناس أو دنياهم إلا ويتوقف فلاحهم فيه واتقانهم له باستشعار ثقل الأمانة التي عمت كل عمل فكرا كان أو شعورا أو سلوكا حتى مداعبة الرجل لزوجته بوضع لقمة الطعام في فمها، كما أخبر رسول الله ﷺ أحد أصحابه بقوله:” …وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك…”[65]. فكل أمر أو نهي ورد من الشرع فهو أمانة من قام به على النحو المطلوب فقد أدى أمانة فعل الأمر وترك النهي وبقدر ما يتعامل الإنسان مع مطلوب الدين باعتباره أمانة في عنقه ليس أمامه سوى خيارين أداؤها أو خيانتها.
ومن هذا المنطلق سميت جميع الأعمال الشرعية تكاليف وسمي المعني بأدائها مكلفا، كما سميت ابتلاء أي امتحانا لحرية الإنسان وإرادته هل يختار الاستقامة أم الانحراف وهل يطيع أم يعصى، كما قال تعالى: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ}(الملك:2).
وليست علاقة الأعمال بالأمانة من جهة أنها موضع ثواب وعقاب فحسب، بل لأنه ما من عمل مطلوب فعله أو تركه إلا ويشتمل على معنى من معاني الأمانة والابتلاء، وأكثر من ذلك يمكن القول بأن الأمانة تمتد خارج دائرة التكاليف الشرعية لتستغرق من الإنسان كل حركة وكل لحظة ومن الحياة كل زاوية وبقعة، فمن أمانة الإنسان الشرعية أن يحسن التصرف ويبادر بالخير ويصد الشر وينخرط في الصلاح ويحرص على الفوز والفلاح، في أي ظرف وجد وبأية طريقة متيسرة ولا يكون سلبيا وشحيحا في نفع نفسه وغيره.
فغاية الدين الحق هي أن يرتقي بالإنسان إلى أعلى درجات الإحساس بالمسؤولية فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين نفسه وضميره وفيما بينه وبين الناس والحياة، وما الفروض الكفائية إلا نموذجاً بسيطاً لهذا الأفق السامق الذي تشد إليه الأمانة.
ج – نموذج المنظومة الاستخلافية.
- تتكون المنظومة الاستخلافية من الاتجاه القيمي وهو الاستخلاف ثم القيمة الشاملة الممثلة له وهي الأمانة، فالمجالات القيمية والتي تستوعب القيم المتجانسة، وهي مجالات التصور والسلوك والمعرفة، فالقيم الفرعية المندرجة في كل مجال.
- إن اختيار هذه المجالات عمل إبداعي تنظيمي محكوم بمحاولة التقريب والترجيح، والقصد منه إعطاء صورة توضيحية عن أهم مكونات المنظومة ومدى الانسجام الموجود بين مجموع القيم والقيمة الشاملة فالاتجاه القيمي العام.
- كما أن تحديد القيم أمر تحكمي يخضع بالأساس إلى اعتبار القيمة التقديرية التي تؤهل الموضوع ليأخذ صفة القيمة، وهذا ما يصدق على كثير من القيم الفرعية المذكورة مثل الأمة- الصناعة-الآداب… فإنها تأخذ بعد القيمة ما دامت تحظى بتقدير وتثمين فكري ووجداني باعتبار نفعيتها الكبيرة في حياة الناس، كما أنها مجال لتنمية العديد من القيم، وما له هذه العلاقة القوية بالقيم يأخذ أبعادها وأهميتها في النفس بقدر أكبر.
| الاتجاه القيمي | الاستخــــــلاف | ||
| القيمة الشاملة | الأمـــــانة | ||
| المجال القيمي | التصور | السلوك | المعرفة |
| القيم الفرعية | الإيمان – التكريم – الخير التكليف – الحرية -الحق – الباطل – الفضيلة -الله -الريادة – الرسالة – الوحي – الأمة – الأنبياء -الآخرة – الجنة -البعث – جهنم | الإعمار – الإبداع – الإتقان – الإنجاز- المحبة -الاتحاد – التعاون – الصبر – التضامن – التعبئة -التفاهم – التنمية – الزراعة – الصناعة – الكفاح – الإخلاص – الحرفة – الكفاح – التناصح… | الثقافة – الفن – الأدب – الشريعة -القرآن – السنة – السيرة – الحكمة – الموعظة – الإرشاد – التأليف -التربية – التعليم – الفكر – التكوين – التكنولوجيا – العلوم التجريبية – الرياضة… |
المبحث الثالث: آليات إدماج القيم في النظام التربوي الأصيل.
1 -توضيح المسوغات التربوية للاتجاه القيمي ضمن التوجهات العامة المفسرة لفلسفة النظرية التربوية المعتمدة.
إن صياغة النظرية التربوية، تحتاج وضوحا أكبر حتى يسهل على الفاعلين التربوين استلهامها في مختلف مستويات إعداد المشروع وتطبيقه داخل الفصل، فيستمد كل فاعل منها الفهم اللازم لحسن العمل على هديها في تحقيق التربية التي تؤسس لها، لكن ذلك الوضوح ولو كان باديا فإن النظرية مع ذلك تحتاج إلى توضيحات تفصيلية تكشف عن مختلف مراميها وأبعادها الخفية حتى تفهم في إطارها ويضيق بها مجال التأويلات التي قد تبتعد كثيرا عن غاياتها المحددة.
كما أن عملية إدماج القيم في النظام التربوي الأصيل تتطلب قبل كل شيء إدماجها في بنية النظرية التربوية العامة، حتى يضمن لها موقعا أساسيا في النظام التربوي يتلاءم وأصالته التي ترتكز بشكل كبير على محورية القيم الإسلامية في التربية التي يمنحها للنشء.
ويبدو من الناحية الإجرائية أن الإدماج يلزم أن يطال أساسا الاتجاه القيمي للمنظومة الذي تم تحديده ابتداء، أي الاستخلاف الإسلامي بحيث يمكن استحضار غاياته ومقاصده وقيمه في مختلف أطوار بناء النظام التربوي.
كما أن نسقية القيم التي تسمح بترتيب القيم بحسب أهميتها داخل الهرم القيمي، تخضع عملية الإدماج لمنهجية واضحة تمكن من توظيف أمثل للقيم واستثمار فاعليتها إلى أبعد مدى، فيقع التركيز على القيمة الشاملة وما تمتلكه من قابلية للاندماج في أية قيمة كيفما كانت طبيعتها وفي القيم الأصلية وما يندرج تحتها من قيم فرعية.
2 -المنهج العام لتعليم القيم وتعزيزها.
- دمج القيم في المواد الدراسية.
استبعدت فكرة تخصيص مادة مستقلة لتدريس القيم، “ومع الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه المقاربة في الإدماج وخاصة على مستوى بناء المفاهيم وتركيزها، إلا أن الأمر لا يخلو من سلبيات تتحدد بالأساس في تضخيم عدد المواد التعليمية باعتبارها جزرا مستقلة وغير متكاملة.”[66] والذي يبدو ملائما لتعليم القيم هو دمجها في جميع المواد الحاملة بحسب ما تسمح به خصوصايتها وطبيعتها الديداكتيكية، ومن المبررات التربوية لهذا الاتجاه أن القيم في حقيقتها إنما هي تقدير ينشأ في النفس لتصورات أو أخلاق أو مهارات أو أي أمر آخر كلما أدرك العقل أهميته ونجم عن ذلك تعلق وجداني به. وهذا الاختيار يقتضي أن تدمج القيم في صلب المواد وتخضع لنهجها وتكييفها مع مستلزمات غرس القيم وترسيخها، والتي يتعين أن تحظى باتباع منهجية خاصة تكون نتيجة تفاعل القيمة مع طبيعة المادة الدراسية. فلكل مادة طريقتها الخاصة في التربية على القيم التي تتوفر لها بهذا التنوع في التناول فرص عدة للترسيخ والتنمية.
فمادة التربية الإسلامية تعلم القيم من خلال منهاجها المتمحورة حول العقيدة والعبادات والسلوك والمعاملات، حيث يمكن في بعض الدروس التعامل المباشر مع بعض القيم مثل عناوين: الإيمان، حب الله، العفة، الوفاء، الصدق، وما شابه ذلك، فتطبق عليها منهجية تعليم القيم التي يرد تفصيلها لاحقا. وأما مواضيع أخرى مثل: “أضرار الخمر والمخدرات”، “دور الإيمان في تحقيق الاطمئنان”، “مكانة العمل في الإسلام”… فتحتاج القيم فيها إلى معالجة أقل مباشرة.
وفي مادة الفلسفة أيضا توجد دروس مباشرة عن القيم مثل: الحرية، العدل، الحب، الواجب… ودروس غير مباشرة مثل: الإنسان والحداثة، الجبر والاختيار، إشكالية المكننة وصيانة البيئة… فتعتمد منهجية خاصة لكل من النوعين توائم بين خصوصيات الفلسفة ومستلزمات تعليم القيم.
أما في المواد الأدبية واللغات، فيميز بين النصوص الإبداعية وما تتضمنه من قيم، فتعد لها منهجية تعتمد توظيف الجمالية الأدبية وكل العناصير التشويقية لغرس قيم معينة في الوجدان، وأما النصوص الفكرية، فيترجح فيها منهج النقاش والتحليل لبلورة مواقف وتحديد توجهات تؤدي إلى تقدير القيم الإيجابية وحبها واستهجان القيم السلبية وبغضها.
وبنفس الرؤية تعد مناهج مماثلة ومناسبة لإدماج القيم في المواد الأخرى مثل التاريخ والتربية الوطنية والتربية النسوية والاقتصاد…
وأما المواد العلمية فلها قيمها الخادمة للتربية المنهجية والعقلية، والتي تتعزز من خلال مناهج تدريسها وتحتاج هي أيضا إلى بعض التغييرات المحدودة في منهجية التدريس حتى تستوعب عملية تعزيز بعض القيم العلمية مثل: مراعاة مبدأ السببية، ارتباط النتائج بالمقدمات، قاعدة ما قام على أساس غير صحيح فلا يؤدي إلى ما هو صحيح… ويمكن تثبيت هذه القيم عن طريق تطبيق هذه المبادئ في مناقشة وتحليل بعض القضايا الفكرية بطريقة علمية.
- دور مشروع المؤسسة في تفعيل المقاربة الاندماجية لتعليم القيم.
يعرف المشروع التربوي للمؤسسة بما يلي: “خطة تعدها المؤسسة التربوية وترسم إجراءات تنفيذها ويمكن للمشروع أن يكون متصلا ببنية صغرى مثل مؤسسة أو بنية كبرى أي متصلا بالنظام التربوي الشامل.”[67] .
وتسعى في تنفيذه المدرسة بكل مكوناتها: الإدارة والأساتذة والتلاميذ وأولياؤهم، فكلما استقامت فكرة المشروع واتضحت الغاية منه في أذهان جميع هذه الأطراف، أعان ذلك على تحقيق الانسجام والتعاون، وتوحيد الرؤية وتضافر المجهودات لبلوغ الغاية في أقصر وقت وبأقل جهد.
فجميع العمليات الإدارية والتعليمية والأنشطة الموازية داخل المؤسسة يلزم أن تصبح وسائل لتحقيق المشروع واستلهام روحه وغاياته.
فلا يتوقع نجاح المقاربة الاندماجية في تعليم القيم، إلا في ظل مشروع للمؤسسة يتبنى التربية على القيم ويجند كل الإمكانيات المتوفرة لإنجاحها. ومعلوم أن المشروع الفعال يستحيل إلى مناخ عام يسود المؤسسة ويوجه ما يجرى فيها من عمليات تنظيمية وتعلمات فصلية وأنشطة ثقافية، فيطبعها كلها بطابعه الخاص ويدفعها لتحقيق غاياته وفرض اختياراته بتلقائية وإيجابية. فالقيم الملقنة يلزم أن يتحسسها التلاميذ في سلوك وأخلاق الإداريين والأساتذة قبل مواجهتها في الدروس. فبذلك يعتاد المتعلمون أن ما يتلقونه داخل الفصل من قيم ومبادئ سامية يعد قيما حية وفاعلة في الوسط المدرسي إن لم تكن كذلك خارجه، وهذا ما ينمي في نفوسهم الثقة بالمدرسة ويقنعهم بجديتها في الاضطلاع بمهمتها ويحملهم على الانخراط بمسؤولية في مشروعها المؤسسي، و”لابد للإحساس بالمسؤولية أن ينمو داخليا من بذور الاستقلالية التي يزرعها آباء وأمهات على استعداد لأن يجعلوا أبناءهم يشعرون بمشاعرهم الخاصة ويشكلون هويتهم الذاتية… وأن محاولة التأثير على قرارات أبنائهم الخلقية أو وعظهم بمواعظ معينة هي من أكبر الأخطاء، وهذا لا يعني أنك لا تستطيع أن تشرح وجهة نظرك، بل لابد أن تفعل هذا، هنا يأتي دور الأسلوب المباشر لتعليم الأخلاقيات، لكنه عادة لا يكفي، يحتاج الأبناء لمن يعلمهم كيف يعيشون في إطار أخلاقي.”[68]
وتكون ترجمة الاتجاه القيمي للمشروع في محتويات الشعارات التي تعلق في أماكن بارزة من المدرسة، وفي الموضوعات التي تنشر بالمجلة الحائطية، ومضامين الأنشطة الثقافية الموازية التي يسهر على تنظيمها لجنة من التلاميذ والأساتذة، كما يعاين تمثلها في سلوك رجال الإدارة والطاقم التربوي في صور نموذجية لما يدون ويقرأ ولما يلقى على الأسماع ويساهم التلاميذ في بلورته أثناء بناء الدروس.
وتعتبر الخرجات الترفيهية والرحلات الاستطلاعية والمسابقات الثقافية والإبداعات الفكرية والأدبية والفنية، التي تحتدم فيها المنافسة وتوزع فيها جوائز قيمة، من أفضل وأنجع الوسائل لتعلم القيم وتعزيزها، هذا هو التصور الصحيح لدور المدرسة في التربية على القيم، و”المدرسة الجيدة تترك دائما أمام طلابها مساحات للتنوع الشخصي والسلوكي في إطار الالتزام الشرعي والآداب المرعية.”[69]و”إذا أرادت المدارس أن تنجح في مهامها فإن عليها أن تستعيض عن فرض الأوامر على الطلاب بحثهم على الالتزام الشخصي تجاه الأمور الجيدة.”
ج- الأنشطة التعلمية وتدريس القيم.
تعتبر الأنشطة التعلمية آخر ما انتهت إليه البيداغوجية الحديثة، فهي تمتاز بقدرتها على تحقيق مشاركة فعالة للمتعلم في بناء الدرس، وتعزيز ثقته في قدراته الذاتية. كما أن هذه الطريقة لا تقتصر على جعل المتعلم فاعلا أساسيا في بناء مفاهيم ومضامين الدرس، وإنما تحفزه أكثر من ذلك إلى اتخاذ مواقف وتبريرها والتوصل إلى قناعات والدفاع عنها وتحقيق تفاعل فكري ووجداني كبير مع المحتويات المعرفية والقيمية، مما يحمله على تجاوز مرحلة التعلم إلى مرحلة التمثل السلوكي.
فالقيم لا تنفذ إلى الوجدان عبر خطاب تقريري لا يعبأ بحال الذات المتلقية ولا يحاول أن يتعرف حاجاتها ومشاكلها وموقفها، فهي قائمة على التقدير القلبي الذي يأتي ثمرة لعدة عوامل يتضافر فيها ما هو فكري بما هو وجداني دون تجاهل الواقع وتأثيراته وضغوطاته، لذا لابد من “استحداث سلسلة من الأنشطة والوسائل الابتكارية الحديثة المشوقة والجذابة التي تواكب روح العصر، يمكن استخدامها بنجاح في عملية البناء القيمي للفرد والمجتمع.[70]“
ولقد ظلت القيم مندمجة في التصورات والمضامين والأخلاق والسلوك، قبل أن يقع الاهتمام بها في العصر الحديث، وتنطلق مشاريع التربية عليها ودمجها في الثقافة والإعلام، الأمر الذي استدعى بلورة عدة مقاربات منهجية لتعليمها وإدماجها في المواد الدراسية. وهذا ما يلتقي مع بعض التعاريف المقدمة للقيم الإسلامية مثل التعريف التالي: “القيم الإسلامية مجموعة من المعايير والأحكام النابعة من تصورات أساسية عن الكون والحياة والإنسان والإله كما صورها الإسلام، تتكون لدى الفرد والمجتمع من خلال التفاعل بين المواقف والخبرات الحياتية المختلفة”[71]
لذا فإن دراسة قيمة ما وترسيخها قد لا يكون ممكنا دائما بطريقة مباشرة، والتي لا تتسع لأكثر من درس واحد، لكن عملية الترسيخ والتعزيز على فترات زمنية متتابعة، يحتاج إلى اختيار مجموعة من المواضيع التي تتجسد فيها القيمة وتلامس كل أبعادها التصورية والسلوكية والموقفية والوجدانية، فينشأ تقدير لها في القلب بطريقة خفية ومتدرجة.
كما أن ربط هذه المواضيع بالقيمة المناسبة ثم بالقيمة الشاملة وحسن تأطيرها بالاتجاه القيمي، يساعد المتعلم على التعامل مع القيم باعتبارها منظومة متكاملة ترمي في كليتها إلى خدمة اتجاهها القيمي أي بناء الإنسان الخليفة القادر على الخروج من حالة الدونية والتخلف والوهن واستئناف الإنجاز الحضاري المعطل منذ عقود طويلة.
وفيما يلي مثال لبعض القيم ومواضيع الدروس التي ترسخها عن طريق الربط بينهما من خلال سياق الدرس وأنشطته التعلمية.
| القيمة | مواضيع الدروس التي ترسخها |
| الوقاية | النظافة -نظام التغذية -فوائد الرياضة -أضرار السهر -أضرار التدخين -الوضوء-الحفاظ على البيئة… |
| النظام | الوقت انفس شيء -استغلال الفراغ -ترتيب غرفة النوم -الوفاء بالوعود -كيف أعد برنامج عمل… |
| الصداقة | الصديق المثالي -كيف أكسب الأصدقاء -من هم أصدقاء السوء -التعاون بين الأصدقاء… |
| الواجب | واجبي تجاه نفسي -واجبي تجاه ربي -حب الواجب -كيف أحمل نفسي على أداء الواجب… |
| الإيمان | جمال الطبيعة -دوران الأرض -منافع الشمس -المرئيات والغيبيات -الإنسان سيد الكون… |
3-إجراءات منهجية في درس القيم.
تخضع هذه الإجراءات المنهجية إلى المعايير البيداغوجية للأنشطة التعلمية، التي تحاول وضع المتعلم في موقع الفعل والمبادرة وبناء المواقف الفكرية والوجدانية من المحتوى القيمي والمعرفي للدرس، وهذه الطريقة هي الأكثر ملاءمة لتعليم القيم وترسيخها، من حيث إنها تشغل الذهن والوجدان وتجعلهما في أعلى درجات التفاعل مع المضمون القيمي المتناول. وفيما يلي الخطوات الإجرائية المقترحة لدرس القيم.
- المدخل الإشكالي:
ويكون بسوق مقولة أو مثل أو حادثة أو قصة أو أبيات شعرية أو إحصائيات معينة أو عرض ظاهرة مجتمعية، ويكون القصد من ذلك إثارة إشكالية معينة تستفز عقل المتعلم وتجعله يستشعر الحاجة الملحة لرفع الإشكال الذي طرح، واكتساب المزيد من المعلومات المفيدة حول القضية المثارة والقيمة المستهدفة. وهذا أسلوب إسلامي أصيل متبع في القرآن والسنة.
- المحتوى الأساسي لانطلاق التعلمات.
ويمكن أن يتضمن نصا شرعيا أو قصة أو مضمونا نثريا أو شعريا حول القيمة موضوع الدرس أو سلوكا شائعا أو عادة متبعة ويكون هذا المحتوى بمثابة أرضية معرفية للاشتغال عليها في إنجاز الأنشطة التعلمية جزئيا أو كليا.
- النشاط التعلمي الأول حول تحديد القيمة.
ويكون في الغالب عبارة عن ثلاثة تعاريف أو أربعة ويطلب من التلاميذ اختيار الصحيح منها مع ذكر المرجحات المعتمدة، إذا تعلق الأمر بخلق يكتسي صبغة القيمة مثل الصدق، العفة، الكرم… وأما حين يتعلق الأمر بموضوع له ارتباط بتثبيت قيمة معينة، مثل: “الرياضة البدنية” والتي يمكن الكلام عنها باعتبارها وسيلة لعدة قيم وهي الوقاية، الصحة، النظام، التوازن، الجمال، الثقة بالنفس، الفاعلية… ففي هذه الحالة يطلب من المتعلم تحديد القيمة المراد ترسيخها عن طريق الرياضة مع بيان المستندات التي اعتمدها.
د- النشاط التعلمي الثالث حول تحديد مكانة القيمة من
الدين.
موضوع هذا النشاط قيام المتعلم بتحديد مكانة القيمة في الإسلام من خلال ما يعرض أمامه في جدول من النصوص الشرعية والأقوال المعتبرة التي تطرقت لإبراز أهميتها في سلوك المسلم وما يترتب عليها من أجر أو وزر وما يتبع ذلك من ثواب أو عقاب.
وإذا توفرت الحواسيب المزودة ببرامج مكتبية أمكن اشتغال التلاميذ عليها في البحث عن النصوص المشتملة على المعلومات المطلوبة.
أما الموضوع المرتبط بقيمة ما فيكون البحث عن مكانته من الدين أي “الرياضة البدنية “حسب المثال.
ﻫ – النشاط التعلمي الثاني حول تحديد المردودية العملية للقيمة.
يتجه في هذا النشاط إلى تحديد مزايا ومنافع القيمة ومساوئ ومضار الخلق المضاد لها، على مستوى السلوك الفردي والسلوك الجماعي، توظف فيه جميع الوثائق المفيدة والمتوفرة من تقارير تتبعية وإحصائيات وصور ومستندات، ويستعان بوسائل العرض المتاحة لاستعراض المشاهد والصور والبيانات المتعلقة بالموضوع.
ويستهدف هذا النشاط تمكين المتعلم من اكتشاف فوائد تمثل القيمة في الحياة الشخصية والاجتماعية والوقوف على أضرار الخلق المناقض لها، حتى يتفاعل فكريا ووجدانيا معها.
ومعلوم أنه يمكن دراسة قيمة ما انطلاقا من الصفة السلبية المضادة لها، كدراسة قيمة الصدق عن طريق خلق الكذب. ولقد سلك القرآن والسنة هذا النهج في تثبيت القيم الإسلامية، فيصف العمل الصالح بما يزينه في القلب ويدعو لحبه وتقديره ويذكر العمل السيء بما ينفر منه النفس ويبعث على بغضها له من ذلك:{وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} (الأنفال:46) ففي هذه الآية مدح قيمة وحدة المؤمنين بذكر مخازي التنازع والاختلاف ونتائجهما الوخيمة المفضية إلى الفشل وتلاشي الدولة، كما مدح قيمة الصبر بأن الله يكون مع الصابرين يبارك مسعاهم ويبلغهم رغباتهم.
وأما إذا تعلق الأمر بموضوع مثل “الرياضة البدنية” ففي هذه الحالة يتصب النشاط على إبراز إلى مدى تسهم الرياضة البدنية في ترسيخ القيمة المعينة وكيف يمكن أن يحصل ذلك.
و- النشاط التعلمي الرابع حول التعبير الكتابي.
ويتكون من نشاطين:
أولهما: يطلب من المتعلم أن يحدد علاقة القيمة بالاتجاه القيمي المعتمد، فإن كان مثلا هو الاستخلاف فإنه يحاول إبراز إلى أي حد تسهم القيمة في تحقيق غاياته وأبعاده، حتى تتكامل في ذهنه المنظومة القيمية ويزداد تشبثه بها واقتناعه بأهميتها.
وفي حالة موضوع مثل “الرياضة البدنية” إذا كان الكلام عنها لترسيخ قيمة التوازن مثلا فيمكن تحديد علاقة التوازن بالاتجاه القيمي المعتمد وكذا علاقة الرياضة البدنية به أيضا على اعتبار أن الاتجاه القيمي يمتد إلى كل ما تمتد إليه القيم.
وثانيهما: تطرح مشكلة لها صلة وثيقة بالقيمة المدروسة، ويتولى المتعلم تحليلها واقتراح حلول لها في ضوء ما تلقاه في الدرس من معلومات وما تبلور خلاله من مواقف وميولات.
وبالنسبة لموضوع “الرياضة البدنية” يركز على الممارسات التي لا تؤدي إلى تحقيق التوازن وأسباب ذلك وكيف يمكن إصلاح الخلل الملاحظ.
- النشاط التعلمي الخامس حول المصادقة الفصلية على القيمة.
يحتاج تعلم القيم وترسيخها إلى ما يجعل النفس فكرا ووجدانا تنشغل بها وتتفاعل مع الوسائل المحققة لها والقضايا المتصلة بها، وان تعبر عن موقفها إزاءها بعفوية وصدق واقتناع، ومن هذا المنطلق يقترح هذا النشاط للمصادقة.
ويقتضي أن يتوزع التلاميذ فيما بينهم وحسب رغبتهم إلى ثلاث مجموعات الأولى مناصرة للقيمة (أو “الرياضة البدنية” من أجل ترسيخ قيمة التوازن) والثانية منتقدة لضدها (أو إهمال “الرياضة البدنية” وممارستها بشكل لا يساعد على تحقيق التوازن) والثالثة حاكمة بينهما تقوم بإعداد تساؤلات واستفسارات تمتحن بها كلا من المجموعتين الأولى والثانية. يتولى كل تلميذ في المجموعتين الأولى والثانية قراءة ما كتبه في الموضوع ويقوم مقررها بإعداد تقرير مركز حول مجموعته يتلوه أمام الفصل. وتوجه له أسئلة استيضاحية وانتقادية من طرف المجموعة الحاكمة ويطلب منه الرد عليها والدفاع عن قناعات مجموعته، ويمكنه الاستعانة في ذلك بأحد أفراد مجموعته. بعد ذلك تطرح القيمة (أو “الرياضة البدنية من أجل التوازن” مثلا) للمصادقة عليها، وإذا كان من التلاميذ من صوت ضد القيمة فإنه يشرح موقفه وتفتح لائحة للمتدخلين بمحاولة إقناعه إلى أن يتراجع عن موقفه فإذا حازت الإجماع سجلت في لائحة القيم الخاصة بذلك الفصل وعلقت على الجدران، وأصبح الجميع ملزما باحترامها، وتتكون لجنة من التلاميذ لمتابعة مدى التزام الفصل بكل قيمة تم تعلمها ويحررون تقريرا فصليا في الموضوع يتلونه داخل القسم وينشرونه في المجلة الحائطية للمؤسسة مع مواد داعمة للقيم التي عرفت بعض التراجع. وكل قيمة حصلت على المصادقة تضاف في لائحة القيم الملقنة بمستوى معين داخل المؤسسة.
يمكن تقديم خلاصة البحث في محورين اثنين:
أولا: أساسيات لبناء منظومة القيم الإسلامية.
1 -على مستوى تحديد مفهوم القيم الذي انتهي بشأنه إلى كونها كل اعتقاد أو خلق أو عادة أو ممارسة أو شيء معين تمنحه الذات قيمة عالية سواء على مستوى الفكر والشعور وحدهما أو مشفوعين بالالتزام العملي.
2 -توصل البحث إلى كون القيم الإسلامية ظلت فاعلة في كيان الأجيال من خلال عدة عوامل منها:
- المضمون القيمي العام الذي هو قاسم مشترك بين جميع القيم الإسلامية من ذلك الإيمان بالله واليوم الآخر واستحضار مراقبته تعالى في السر والعلن، واستشعار عزة الانتماء للأمة الإسلامية.
- حضور المنظومة القيمية الإسلامية داخل المجتمع في عدة صور منها سيرة الرسول ﷺ وصحابته والتابعين التي تتناقلها الأجيال شفويا وفي قوالب مبسطة لكنها مؤثرة في اكتساب القيم الإسلامية الأساسية على نحو معين.
- فالواقع الإسلامي مشبع بالقيم الإسلامية السامية لكنها تحتاج إلى تفعيل تتجدد به مناهج التربية، وتتم تنقيتها من المفاهيم الدخيلة غير المنسجمة مع قيمنا الأصيلة.
3 -توصل البحث إلى أن القيم تحتاج لتكون التربية عليها فعالة إلى التعامل معها باعتبارها منظومة متكاملة لها اتجاه قيمي واضح، تصطبغ به جميع القيم المنتظمة فيها، بحيث يتمكن المتعلم من اكتساب جميع قيم المنظومة بكيفية تامة وفعالة، من خلال محورتها حول قيمة شاملة لكل قيم المنظومة وترتبط معها برابط التقارب الدلالي والتوحد المقاصدي، فيكون تعلم أي قيمة مساعدا وداعما لتعلم عدة قيم أخرى، كما أن تعلم قيمة ما يصبح معززا ومرسخا لتعلم طائفة عريضة من القيم المتآلفة معها.
فتدريس القيم بهذه المنهجية ووفق هذا التصور يدفع المتعلم إلى حب جميع القيم الرفيعة دون تمييز، لأنها تمثل وحدة متماسكة غير قابلة للتجزئة، فينشأ عنها أخلاق ثابتة وتشبع قيمي قوي وضمير حي ويقظ وشخصية متوازنة ومتماسكة.
وقد انتهى البحث إلى اقتراح أن يكون الاستخلاف هو الاتجاه الأنسب لتدريس القيم الإسلامية في الظروف الحالية للأمة الإسلامية، فالاستخلاف له حمولة قيمية عامة تضم الإيمان والأمانة ومسؤولية استعمار الأرض وفق منهج الوحي الخاتم، وغيرها من القيم الأخرى، مما يِؤهله ليشغل موقع الاتجاه القيمي العام الناظم لجميع القيم الإسلامية والضامن لفعاليتها التربوية وتحققها بميزات الأصالة والمعاصرة والمستقبلية حيث تؤكد معظم الدراسات التربوية أن اعتبار الذات البشرية منطلقا ومحورا لكل التحولات النوعية الممكن الطموح إليها في المدى القريب والبعيد، اتجاه متنام على مستوى العالم في الوقت الذي يتنامى فيه النزوع إلى التدين والذي أضحى ظاهرة أكثر بروزا في مجال الإسلام على الخصوص.
ثانيا: آليات إدماج منظومة القيم في النموذج التطبيقي للمشروع.
من المعلوم أن التربية الفعالة هي التي تدور كلها حول قيمة مركزية أساسية تتحرك في دائرتها كل القيم المراد ترسيخها لدى النشء، ولها غاية واحدة كبرى تتفرع إلى عدة غايات تفصيلية أخرى تعين على تحقيقها وإدراك أبعادها ومراميها. مما تكون به الوجهة موحدة وواضحة والمقاصد جلية والنفس متهيئة للتمثل السلوكي والتطبيق العملي، بعيدا عن التشتت والارتباك.
وفيما يخص آليات إدماج القيم في النظام التربوي فأجملها البحث في عدة خطوات وهي:
- -إبراز أساسية الاتجاه القيمي والقيمة الشاملة في النظرية التربوية العامة للمشروع.
بما أن النظرية إذا صيغت في عبارات محدودة أو بضعة أسطر تعطي فكرة واضحة عن التربية التي تؤسس لها، فيلزم أن تشير إلى الاتجاه القيمي للمنظومة وقيمتها الشاملة لما سواها من القيم والقادرة على تأطير تعلمها دونما تكلف أو تمحل.
- – المنهج العام لتعليم القيم وتعزيزها.
وتم التطرق فيه إلى اختيار دمج تعليم القيم من خلال مختلف المواد الدراسية، نظرا لكون القيم تتطلب تضافر جميع الوسائل المتاحة لنشرها ودعم تعلمها، وتوفير مناخ اجتماعي عام يشيع تلك القيم في الواقع ويجعل تنساب إلى النفس بتلقائية.
وفي هذا الإطار تم اقتراح اعتماد مشروع المؤسسة وتفعيله بما يخدم تعليم القيم، كما تم اعتماد بيداغوجية الأنشطة التعلمية لتعليم القيم وترسيخها، نظرا لما تتيحه من تفاعلات بين المتعلم ومحتويات الدروس، داخل الفصل وخارجه عندما تأخذ طابع أنشطة تربوية متنوعة: خرجات، رحلات، رسم، كتابة، مجلة حائطية… إذ يضطلع بالنصيب الأوفى من المساهمة في عمليات بناء المفاهيم وتركيب المضامين وتحديد المواقف، وذلك من خلال خطوات إجرائية تدفع المتعلم ليتساءل ويتحاور ويحلل ويناقش ويتفاعل مع محتويات الأنشطة التعلمية بحماس وعفوية.
والله الموفق لما فيه الصلاح والسداد.
قائمة المراجع
- الأحمر، عبد السلام محمد، المسؤولية أساس التربية الإسلامية. (محولة في التأصيل)
كتاب تربيتنا رقم 4. ط1. الرباط: طوب بريس (1428ﻫ/2007م) .
- الأحمر، عبد السلام محمد. “واقع القيم في الإصلاح الجاري” مجلة الفرقان. عدد60. (1429ﻫ/2008م).
- الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن قيم. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. بيروت: دار الكتب العلمية.
- الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله بن قيم. جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام. تحقيق : شعيب الأرناؤوط – عبد القادر الأرناؤوط.ط2. الكويت: دار العروبة (1407ﻫ/ 1987م).
- القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار. تحقيق سالم محمد عطا-محمد علي معوض. بيروت: دار الكتب العلمية. 2000م.
- المنجرة، المهدي. قيمة القيم ، ط 1، (1428ﻫ/2007م)، بدون دار نشر.
- مجلة البصيرة التربوية. عدد خاص بأعمال الندوة الدولية التي نظمتها منظمة الإيسسكو والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، والمركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية بالمدرسة العليا للأساتذة في تطوان بالمغرب في موضوع “القيم الإسلامية ومناهج التربية والتعليم” العدد الأول أكتوبر (1426ﻫ/2005م)..
- “مؤتمر السنة النبوية في الدراسات المعاصرة ” جامعة اليرموك ، إربد ، الأردن
(1428ﻫ/2007م).
- ابن تيمية، أحمد عبد الحليم الحراني أبو العباس. كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.
- ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني. مجموع الفتاوى. المحقق: أنور الباز وعامر الجزار، ط3:دار الوفاء (1426ﻫ/2005م).
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي. تفسير القرآن العظيم. تحقيق: سامي بن محمد سلامة. ط2. دار طيبة للنشر والتوزيع ( 1420ﻫ/1999م)
- أبو سليمان، عبد الحميد أحمد. “أزمة الإرادة والوجدان المسلم” منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، ط3.دمشق: دار الفكر (1428ﻫ/2007م.
- أبو سليمان، عبد الحميد أحمد. “الرؤية الكونية الحضارية القرآنية المنطلق الأساس للإصلاح الإنساني” منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي. ط 1. القاهرة: دار السلام ( 1430ﻫ/2009م).
- بكار، عبد الكريم. بناء الأجيال. كتاب البيان التابع لمجلة البيان الصادرة في لندن، ط2، (1427ﻫ/2007م) .
- بن عاشور، الشيخ محمد الطاهر. التحرير والتنوير. الطبعة التونسية. تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع1997م.تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. مكتبة ابن تيمية.
- الجربوع، عبد الله بن عبد الرحمن. أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة
- الحنبلي ، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب. جامع العلوم والحكم.ط1. بيروت: دار المعرفة،1408ﻫ.
- الديب، إبراهيم رمضان. أسس ومهارات بناء القيم التربوية وتطبيقاتها في العملية التعليمية.ط2: مؤسسة أم القرى للترجمة والتوزيع. (1427ﻫ/2007م).
- الصحبي، العتيك مقدمات في فلسفة التربية الإسلامية، ، ط1. دار السنابل للثقافة والعلوم 1989م.
- الصمدي، خالد. “القيم الإسلامية في المنظومة التربوية، دراسة للقيم الإسلامية وآليات تعزيزها” ط1. الرباط: منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. (1429ﻫ/2008م).
- ط1. بيروت، دمشق: دار الفكر المعاصر، دار الفكر. 1410م
- عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط1، (1423ﻫ/2003م).
- الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. بيروت: المكتبة العلمية.
- الكفومي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني. كتاب الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. تحقيق: عدنان درويش / محمد المصري، بيروت: مؤسسة الرسالة. (1419ﻫ/1998م).
- المجموعة، “القيم الحضارية والإنسانية المشتركة بين الواقع والمتغير”المركز المغربي متعدد التخصصات للدراسات الاستراتيجية والدولية – تحت إشراف عبد الحق عزوزي. طبع الأرمتان.
- المجموعة، المعجم الوسيط. دار الفكر.
- المجموعة، معجم علوم التربية. 1 مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك.ط1. الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 1994م.
- المناوي، محمد عبد الرؤوف. التوقيف على مهمات التعاريف. تحقيق : د. محمد رضوان الداية
[1] – الأحمر، محمد عبد السلام. “واقع القيم في الإصلاح الجاري” مجلة الفرقان. عدد60 (1429ﻫ/2008م).
[2] – الفيومي. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. 2/520
[3] – المجموعة. المعجم الوسيط. 2/768.
[4] – زرزور، نوال كريم. “معجم ألفاظ القيم الأخلاقية وتطورها الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم” نقلا عن الصمدي، خالد. “القيم الإسلامية في المنظومة التربوية” ص17.
[5] – المجموعة، “معجم علوم التربية”، ص 359.
[6] – المناوي، التعاريف. 1 / 326.
[7] – ابن كثير، تفسير القرآن العظيم. 1/216 .
[8] – أحمد، المسند 1/227.
[9] – الحاكم، المستدرك على الصحيحين. 3 /84.
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعليق الذهبي قي التلخيص: صحيح.
[10] – صحيح البخاري. كتاب الهبة وفضلها، باب الاستخلاف.
[11] – ا بن عبد البر النمري. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار. 2 / 311.
[12] – ابن قيم الجوزية، جلاء الأفهام . 1 / 284.
[13] – ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. 1/9.
[14] – الأندلسي، ابن عطية. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 1/102.
[15] – بن عاشور، التحرير والتنوير. 9/62.
[16] – المرجع نفسه 1/ 413.
[17] – الشعراوي – تفسير الشعراوي. 1 / 2008.
[18] – قطب، سيد. في ظلال القرآن 1/300.
[19]- أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة – (ج 2 / ص 508)
[20] – بحوث مؤتمر السنة النبوية في الدراسات المعاصرة – (ج 28 / ص 20)
[21] – التعريفات. مرجع سابق 1 / 325.
[22] – أساس البلاغة. 1 / 11.
[23] – المستدرك على الصحيحين. كتاب البر والصلة. 4 / 182.
[24] – القاموس المحيط. 1 / 1518.
[25] – المرجع السابق.
[26] – الأمثال العربية والأمثال العامية مقارنة دلالية – 1/ 160.
[27] – جامع الأحاديث. حرف اللام. 18/56
[28] – الفروق اللغوية. 1 / 371.
[29] – ابن كثير. 6 / 488.
[30] – نفس المرجع. 6/489.
[31] – القاموس المحيط. المرجع السابق.
[32] – المحكم والمحيط الأعظم. 3/367
[33] – صحيح مسلم – كتاب 21 باب تحريم إفشاء سر المرأة. 4/157.
[34] – الماوردي، أدب الدنيا والدين. 1/ 105.
[35] – صحيح البخاري. كتاب 13 باب إذا بقي في حثالة من الناس. 6 / 96.
[36] – الغزالي، إحياء علوم الدين. 1 / 175.
[37] – ابن كثير. مرجع سابق 7 / 137.
[38] – الغزالي، إحياء علوم الدين. 1/ 58.
[39] – قطب، سيد. في ظلال القرآن. 2 / 160.
[40]- أخرجه البخاري، كتاب 91 باب ما قيل في أولاد المشركين.
[41] – جامع الأصول في أحاديث الرسول. نوع سادس. 10/41.
[42] – انظر المعجم الوسيط.2/1013.
[43] – الصحبي، العتيك. مقدمات في فلسفة التربية الإسلامية. ص 39 ـ 40.
[44] – المنجرة، المهدي. قيمة القيم، ص39-40.
[45] – الكفومى، أبو البقاء. كتاب الكليات. 1/ 670.
[46] – أخرجه مسلم. كتاب 1، باب أكثر أهل الجنة الفقراء.
[47] – شرح النووي على مسلم. باب قصة أصحاب الغار الثلاثة.
[48] – أبو سليمان، عبد الحميد أحمد. الرؤية الكونية الحضارية القرآنية. ص120.
[49] – ابن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى في الفقه. 28/ 63.
[50] – ابن تيمية، مجموع الفتاوى. 28/ 146.
[51] – أبو سليمان، عبد الحميد أحمد. أزمة الإرادة والوجدان المسلم. ص 39.
[52] – المجموعة، القيم الحضارية والإنسانية المشتركة بين الواقع والمتغير. ص255.
[53] – بكار، عبد الكريم. بناء الأجيال. ص 188.
[54] – أبو سليمان، عبد الحميد أحمد. الرؤية الكونية الحضارية القرآنية. ص25.
[55] – صحيح البخاري، كتاب 4 باب لا يظلم المسلم المسلم.
[56] – أبو سليمان، عبد الحميد أحمد. أزمة الإرادة والوجدان المسلم. ص23.
[57] – ديفدسون، كيف ينشئ الآباء الأكفاء أبناء عظاماً. ص 251.
[58] – صحيح مسلم. باب الأمر بالإيمان بالله (ج 1 / ص 36)
[59] – صحيح ابن حبان. كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم (ج 16 / ص 85)
[60] – صحيح مسلم. كتاب 29 باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. جاء في التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوى 1/ 740 يعني: الصدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص من كل مذمة وذلك سبب لدخول الجنة برحمة الله.
[61] – الحنبلي، بن رجب. جامع العلوم والحكم. 1/ 342.
[62] – النقيب، عبد الرحمن عبد الرحمن. البصيرة التربوية. عدد1 ص209.
[63] – طنطاوي، محمد سيد. التفسير الوسيط. 1/ 270.
[64] – صحيح مسلم. باب استحباب طلاقة الوجه. 8 / 37.
[65] – الترمذي، كتاب الفرائض، باب الوصية بالثلث.
[66] – الصمدي، مرجع سابق. ص 65.
[67] – المجموعة، معجم علوم التربية. (بتصرف طفيف) مرجع سابق. ص276.
[68] – المجموعة ديفيدسون، كيف ينشئ الآباء الأكفاء أبناء عظاما. مرجع سابق ص 255.
[69] – بكار، مرجع سابق. ص202.
[70]- الديب، إبراهيم رمضان. أسس ومهارات بناء القيم التربوية وتطبيقاتها في العملية التعليمية. ص 30.
[71] – الصمدي، القيم الإسلامية. مرجع سابق. ص17.