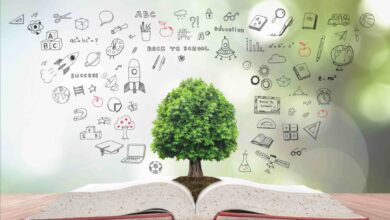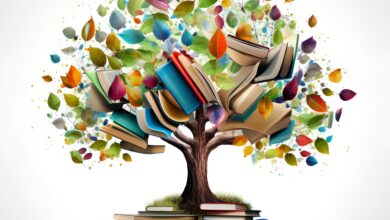10- نحو أساليب وطرق تدريس أصيلة للنظام التربوي المنشود
بحث مقدم لصالح مشروع إحياء نظام تربوي أصيل
إعداد : د. خالد محمد الخطيب
أنجز في: 23 محرم 1431 هـ / 08 يناير 2010 م
جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمشروع ومسجلة رسميـًا ومحمية بموجب القانون.
خطة البحث
1. توطئة :
المنهاج التربوي كما يراه معظم التربويين هو الوعاء الرئيس الذي من خلاله تترجم النظرية التربوية إلى واقع ملموس، كما ويعتبر الركن الأساس لأي نظام تعليمي تظهر من خلاله خصائص ذلك النظام وصورته وصبغته.
أما أساليب وطرائق التدريس فمن خلالها يقدم المحتوى للمتعلمين كي تتحقق لديهم الأهداف المنشودة المنبثقة من فلسفة التربية ونظريتها، ومن المسلم به أن اختيار طريقة التدريس المناسبة وتنفيذها بشكل سليم ليس فقط يزيد من تحقيق الأهداف المخطط لها، بل إنه يساهم في تنمية السمات الشخصية لدى المتعلمين، فمن خلالها يمكن أن يصبح المتعلم إيجابيا أو سلبيا، يمكن أن يصبح متفاعلا مع محيطه أو منطويا، … الخ، كما أن له دورا في تنمية الاتجاهات نحو العلم والتعلم لدى المتعلمين ،فقد تنمى اتجاهات ايجابية أو سلبية، لذلك فإن الذي يسعى لتأصيل العلوم التربوية وبناء نظرية تربوية أصيلة ينبثق عنها نظام تربوي قابل للتطبيق والحياة، لا بد له من التفكير جديا بطرائق التدريس وتقديم نموذج لها يتوافق مع الأطر النظرية الأصيلة ويتجاوب مع معطيات الواقع وسرعة تغيراته.
إذا كان القرآن الكريم قد نزل لتعليم الناس وهدايتهم، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد أرسل لتبليغ تلك الرسالة وتعليمها للناس، فمن الطبيعي أن نجد في كتاب الله وسنة رسوله إشارات وافية دالّة على أسلوب تعليمي متميز يتوافق مع تميز الرسالة، كما أن هناك جهودا كبيرة بذلها علماؤنا من السلف الصالح في هذا المجال جدير بنا أن نطلع عليها ونتفاعل معها، وبما “أن الحكمة ضالّة المؤمن” كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو هريرة في سنن الترمذي، فلا بد أن نفيد من أي جهد بشري يعيننا على رسم معالم واضحة لنموذج أصيل في طرائق التدريس وأساليبه، وهناك جهود واضحة لبعض العلماء والباحثين حاولوا أن يتلمسوا الكثير من الأساليب وطرق والتدريس التي ظهرت معالمها في النصوص القرآنية أو تبين أن الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام قد استخدمها لتعليم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فقد ظهر كتاب للداعية عبد الفتاح أبو غدة بعنوان الرسول المعلم وأساليبه في التعليم عرض فيه للكثير من الأساليب التعليمية التي استخدمها عليه الصلاة والسلام، وهذا الدّاعية الدكتور يوسف القرضاوي يسطر كتابا بعنوان الرسول والعلم يؤكد فيه على فضل العلم والتعلم ويبين الكثير من مبادئ التعلم والتعليم ، وهناك جهود حاولت التأصيل لطرائق التدريس مثل ( جان ،1998) الذي عنون كتابه بـ المرشد النفيس إلى أسلمة طرق التدريس، ذكر فيه العديد من طرائق التدريس الحديثة محاولا أن يدعم تلك الطرائق ببعض النصوص القرآنية أو النبوية أو التراثية، كما أن بعض طلبة الدراسات العليا في تخصصات التربية الإسلامية وطرائق تدريسها درسوا بعض تلك الطرائق وحاولوا تأصيلها من خلال استعراض العديد من النصوص الشرعية المؤيدة لتلك الطرائق ( العمري ،2000) ( المواجدة، 2004) كما أن جهودا رصدت للطرائق التي استخدمها سلفنا الصالح من الدعاة والعلماء والتربويين المسلمين مثل ( قمبر،1985) الذي أجرى دراسة بعنوان طرائق وأساليب التدريس كواحدة من دراساته التراثية في التربية الإسلامية، ومع التقدير لجميع تلك الجهود وغيرها فإننا بحاجة اليوم إلى بناء رؤية كلية حول أساليب وطرق التدريس مستخلصة من الأصول الشرعية ومن تراث أمتنا الإسلامية ومن خلال جمع لشتات تلك الجهود التأصيلية، مع التأكيد على عدم تجاهل ما وصلت إليه الحضارة الإنسانية من تلك العلوم.
2. إشكالية البحث:
من خلال التوطئة السابقة يتبين لنا أننا بحاجة إلى الإجابة عن سؤال يطرح، وهو: ما هي الرؤية الكلية لطرائق التدريس الأصيلة التي تتوافق مع الأصول الشرعية وتناسب معطيات الحاضر الجديد؟ وللإجابة عن تلك الإشكالية فإن هذه الدراسة ستحاول التحقق من صحة فرضية تقول إن أساليب التدريس الأصيلة تنبثق من الدور الذي يقوم به المعلم وهو دور الميسر، فستبحث بـ ( مفهوم المعلم الميسر وعلاقته بفعالية أساليب التعليم في نظام تربوي أصيل )، وهذا الدور قد ورد بنصوص صريحة مثل قوله تعالى âوَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍá (القمر: 17 ) وقد تكررت هذه الآية أربع مرّات في سورة القمر وهناك آيات أخرى، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم “إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا”[1] وفي الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “علّموا ويسروا ولا تعسروا ثلاثا” وقوله صلى الله عليه وسلم “علموا ولا تعنتوا فإن المعلم خير من المعنت”، وإننا لنلمح التيسير في كل ممارسة تعليمية استخدمها الرسول عليه الصلاة والسلام وفي كل نص قرآني متعلق بذلك ، وهذا ما ستظهره الدراسة –إن شاء الله- .
3. الفكرة المحورية للبحث:
تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في بلورة رؤية كلية حول طرائق التدريس الأصيلة ينبثق من خلالها العديد من طرائق التدريس الأصيلة والمناسبة لعصرنا الحاضر وكذلك البحث عن مبادئ للتعلم والتعليم تؤكد تلك الرؤية، وسيتحقق هدف الدراسة من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية:
1. ما هي الرؤية الكلية لطرائق لأساليب وطرق التدريس الأصيلة، المستنبطة من الأصول الشرعية والجهود البشرية ، والمناسبة لواقعنا المعاصر ؟
- ما هي الأساليب والطرائق التدريسية الأصيلة والمقترحة للمؤسسات التربوية الإسلامية المنبثقة من التصور الإسلامي ؟ .
- هل تختلف الأساليب وطرائق التدريس المقترحة باختلاف مجال الهدف المنوي تحقيقه ؟
- هل تختلف الأساليب وطرائق التدريس المقترحة باختلاف نوع المؤسسة التربوية (نظامية، غير نظامية ) ؟
- هل تختلف الأساليب وطرائق التدريس المقترحة باختلاف جنس المتعلم أو عمره أو مستواه التحصيلي ؟
- ما هي المبادئ العامة المستخلصة من القرآن والسنة والتراث والتي توجه عملية التدريس لتكون أكثر فاعلية ؟
4. محاور البحث :
المحور الأول : المقدمة
وتتضمن المقدمة تعريفا للعلم والتعلم والتعليم من وجهة نظر الفكر الإسلامي ومفهوم طريقة التدريس وأهميتها، كما تتضمن توضيحا للفرضية الأساسية للبحث والمتعلقة بدور المعلم في تيسير التعلم ومسؤولية المتعلم في التعلم .
المحور الثاني : طرائق التدريس الأصيلة
وسيتم التعرض للطرائق الآتية :
- العرض المباشر. وتتضمن المحاضرة والخطبة والقصة والعرض العملي.
- السؤال والحوار .
- الممارسة والعمل .
- التوجيه للتعلم الذاتي.
- التعلم التعاوني.
- التعلم بالاكتشاف.
وعند التعرض للطرائق السابقة سيتم الحديث حول الآتي :
- التعريف بكل طريقة .
- التأصيل لكل طريقة .
- دور كل طريقة في تيسير التعلم .
- الخطوات الإجرائية لكل طريقة .
- الظروف المناسبة لاستخدام كل طريقة .
- التحركات التي تزيد من فعالية كل طريقة .
المحور الثالث : تصنيف طرائق التدريس
من خلال الإشارات الواردة في النصوص القرآنية والنبوية والتراثية والمتعلقة بطرائق التدريس فإنه سيتم تصنيف تلك الطرائق بناء على ما يأتي :
- نوع الهدف المراد تحقيقه من عملية التعليم .
- جنس المتعلم .
- عمر المتعلم .
- مستواه التحصيلي.
- نوع المؤسسة التعليمية .
المحور الرابع : مبادئ لتيسير التعلم
وسيتم استعراض المبادئ التالية :
- الفروق الفردية .
- الوسائل التعليمية .
- إثارة الدافعية .
- الثواب والعقاب
وعند استعراض تلك المبادئ سيتم الحديث حول الآتي :
- التعريف بكل مبدأ .
- التأصيل لكل مبدأ .
- دوره في تيسير التعلم .
- كيفية توظيف كل مبدأ من تلك المبادئ لتحقيق تعلم فعّال .
5. مصطلحات ومفاهيم البحث الأساسية :
المصطلحات الرئيسة في هذه الدراسة هي طريقة التدريس وأسلوب التدريس وإستراتيجية التدريس ، لكن هذه المصطلحات وغيرها مثل مدخل التدريس ونموذج التدريس … الخ بينها تداخل شديد وعناصر مشتركة كما يذكر( عبيد ، 2004 ) ويبين أن الكثير من الأدبيات تستخدمها دون تحديد لأي منها وتعاملها معاملة المترادفات ويختم بالقول “بغض النظر عن أوجه الاختلاف أو الاتفاق فان الأمر يتعلق بالطريقة أو الأسلوب الذي يقدم به المعلم مادته بقصد أن يتعلم التلميذ فالهدف الأساسي هو التعلم وأن الإستراتيجية والطريقة والمدخل هي وسائل للغاية الأساسية وهي أن يتعلم التلميذ”.
ونلاحظ ذلك التداخل من كتابات التربويين المتخصصين في المناهج والتدريس وعلم النفس التربوي فبينما يسمي ( أبو زينة ، 2003 ) العرض المباشر والتعلم بالاكتشاف والتعلم الفردي والتعلم التعاوني نماذج تعليم الرياضيات ، نجد أن ( عبيد ، 2004 ) يسميها طرق ومداخل في تعليم وتعلم الرياضيات ، أما ( عبد الحميد ، 1999 ) فيسميها هي نفسها إستراتيجيات التدريس .
رغم ذلك نجد بعض التربويين يميز بين الطريقة والأسلوب والإستراتيجية ، فهذا ( الوهر ، 2004 ) في كتاب المناهج وطرق التدريس العامة المقرر لطلبة كلية التربية في الجامعة العربية المفتوحة يرى أن الطريقة أوسع من الأسلوب وأشمل وذلك لأن الطريقة يمكن أن تقدم بأكثر من أسلوب فطريقة المناقشة مثلا يمكن أن تنفذ على مستوى الصف كله ( مناقشة جماعية ) أو ضمن مجموعات صغيرة … الخ ، كما يرى أن الإستراتيجية أوسع من الطريقة وأشمل .
أما في هذه الدراسة فإنها سنتعامل معها كمصطلحات مترادفة وسنختار واحدا منها للدلالة عليها جميعا وليكن طريقة التدريس ، وسنعرّف طريقة التدريس بصورة أولية كما يأتي :
- طريقة التدريس : هي عبارة عن جملة من الخطوات والإجراءات المنظمة التي يقوم بها المعلم وطلبته لتنفيذ الموقف التعليمي ، سعيا لتحقيق أهدافه . لكن يتوقع الباحث أنه بعد استقراء الشواهد والمواقف المتعلقة بموضوع الدراسة وحصر العديد من طرائق التدريس ، ربما يتم تصنيف تلك الطرائق ضمن مجموعات معينة ذات خصائص متمايزة ويطلق على كل مجموعة مصطلحا مختلفا ، فيصنف بعضها تحت اسم أساليب وبعضها تحت اسم طرائق ، كما يمكن أن يستخدم بعض المصطلحات المتداولة في العلوم التربوية مثل استراتيجيات التدريس أو مداخل التدريس ….. الخ بحيث يكون لكل مصطلح منها دلالته المتمايزة.
6. الحاجة للبحث :
يرى الباحث أن حاجة المشروع لهذا البحث حاجة ماسة كونه متعلق بتأصيل عنصر أساس من عناصر المنهاج ، والمنهاج هو الأداة الفعلية في تحقيق أهداف النظام التربوي وفلسفته ، فهذا البحث سيساهم في بلورة الجانب النظري للمشروع حيث سيكوّن جزئية من النظرية التربوية الأصيلة من خلال الرؤية الكلية التي يتبنّاها ، كما سيساهم في الجانب التطبيقي لأنه سيرسم المعالم الأصيلة لأساليب وطرق التدريس التي سيستخدمها المربون والمعلمون في النظام المنشود .
7. علاقة البحث بالمشروع :
علاقة البحث بالمشروع هي علاقة الجزء بالكل فالنظام التربوي الأصيل يحتاج إلى منهاج تربوي أصيل وأساليب التدريس هي عنصر أساس من عناصر المنهاج التربوي كما تبين ذلك في البند الأول من هذا المخطط ، لذلك فإذا استطعنا أن نكشف اللثام عن الأساليب التدريسية الأصيلة – إن كانت من أصولنا التربوية أو التي لا تتعارض معها – فإننا نكون قد أنجزنا جزءا مهما من أجزاء المنهاج التربوي الأصيل ، وعند اكتمال عناصر المنهاج الأصيل نكون قد حققنا ركنا أساسا من أركان النظام التربوي الأصيل وبهذا نكون قد ساهمنا بصورة مباشرة في تحقيق أجزاء المشروع .
8. منهجية الدراسة وأدواتها :
تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي الاستقرائي ثم منهج التحليل والاستنتاج ، وسيتم تنفيذ هذه المنهجية وفق الخطوات التالية:
- النظر في القرآن الكريم مباشرة و من خلال الفهارس الورقية والإلكترونية وتحديد الآيات والمواقف المتعلقة بموضوع الدراسة ثم التعرف على آراء المفسرين بشرحها ودلالاتها ، واستخلاص الأساليب التعليمية الواردة .
- النظر في الأحاديث النبوية الشريفة مباشرة من كتب الصحاح ومن خلال الفهارس الورقية والإلكترونية وتحديد الأحاديث والمواقف النبوية المتعلقة بموضوع الدراسة والتعرف على شرحها ودلالاتها ، واستخلاص الأساليب التدريسية الواردة .
- الاطلاع على التراث العربي والإسلامي مما يتعلق بموضوع الدراسة والأبحاث المقدمة في ذلك ، ومناقشة ذلك والنظر بما يناسب وقتنا الحاضر من أساليب وطرائق تدريسية .
- الإفادة من نظريات التعلم والتعليم الحديثة وطرائق التدريس المنبثقة عنها والخبرة الشخصية للباحث وتبني أساليب وطرائق تدريسية بحيث لا تتعارض مع الرؤية الإسلامية .
- بعد النظر في كل ما سبق يجري الباحث عملية التبويب والتصنيف والاستدلال للوصول إلى الإجابة عن أسئلة الدراسة .
- عرض الأفكار المستخلصة من القرآن الكريم والحديث الشريف والتراث التربوي على بعض المتخصصين في العلوم التربوية والشرعية ، للنظر فيها وإبداء الرأي .
- إعادة صياغة الأفكار والاستنتاجات بعد النظر بآراء المتخصصين إذا احتاج الأمر ذلك .
9. الدراسات السابقة:
قام الباحث (النعمي ، 1980) بإصدار كتاب وسمه ب المناهج وطرق التعليم عند القابسي وابن خلدون بين أن أساليب التعليم التي أكد عليها ابن خلدون هي التلقين والمحاكاة (التقليد) والتجربة ، والتكرار، واستخدام الوسائل التعليمية المحسوسة. أما التفصيل فكان في عرض طرق التعليم المتعلقة بمواد التعليم الأولي، فعرض أساليب تدريس القرآن الكريم وأساليب تعليم اللغة والخط أما مواد ما بعد التعليم الأولي فذكر أساليب تعليم البلاغة وأساليب تعليم الشعر، وبين الباحث أن ابن خلدون يشجع استخدام المناقشة والحوار وأسلوب الرحلة وكذلك توظيف الكتاب الدراسي في مرحلة ما بعد التعليم الأولي.
أما القابسي فقد أكد على أساليب التعليم التالية:
- التلقين والحفظ.
- الطريقة الفردية والجمعية .
- إشراك المتعلمين في العملية التعليمية .
ويؤكد القابسي على أهمية القدوة والتوجيه في التربية الخلقية ، وأثر الجماعة في الفرد وضرورة أن يتم إقناع المتعلم بأهمية الأخلاق الفاضلة المتعلمة .
كما قام الباحث (الهوال ، 1981) بإصدار كتيب بعنوان التعلم والتعليم في القرآن الكريم بين فيه أن القرآن الكريم استخدم عدة أساليب لتعليم الإنسان منها أسلوب التنبيه أو العرض المباشر خصوصا في مجالات الأمر والنهي، واستخدم أسلوب ضرب الأمثلة بالصورة – رسم المشهد من خلال النص- وذلك لتدريب خيال المتعلم، كما أنه استخدم الأسلوب القصصي، واستشهد الباحث بفرضية الصيام على أسلوب التعلم بالحرمان.
أما الأساليب التي حث عليها القرآن الكريم الإنسان المسلم لاكتساب العلم فقد أمر الله سبحانه وتعالى المسلم بالقراءة بقوله (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5))(العلق: 1-5).
وجعلها الوسيلة الأساسية للتعلم كما أنه وضع الإنسان أمام مسؤولياته لتحمل عواقب تصرفاته (قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ)(الأنعام: 104 ) وختم هذا الفصل بالأسلوب الثالث وهو الحث على التأمل في الكون وفي التاريخ وفي النفس البشرية (وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ )( الذاريات: 21 ).
وهناك دراسة عرضت لأفكار ابن خلدون التربوية قام بها (با نبيلة، 1984) عنوانها ابن خلدون وتراثه التربوي حيث ذكر عدة اقتراحات لابن خلدون متعلقة بالتعلم والتعليم منها:
- البدء بالتعليم الإجمالي ثم التقدم نحو التفاصيل .
- الاقتصار على علم واحد في العليم ، حتى إذا فرغ المتعلم منه وحصلت له الملكة انتقل إلى فن آخر .
- التوسع والاختصار في العلوم مع المتعلم حسب الحاجة .
- الرحلة في طلب العلم .
- التأكيد على أسلوب الحوار والنقاش في عملية التعليم .
ومن الكتب التي ألفت في التعلم والتعليم الإسلامي ما قام به ( الآغا ،1986) حيث نشر كتابا وسمه بأساليب التعلم والتعليم في الإسلام بين فيه أن أسس التعلم في الإسلام هي ( الانتباه، التكرار، التخيل، المقابلة، الدافعية، التدرج في التعلم) أما أساليب التعلم فهي (القدوة، القصة، التعلم بالأمثال، الحوار، الخطبة، أسلوب العمليات العقلية، الممارسة، الترغي والترهيب، الوعظ والارشاد، التعلم بالأحداث التعلم بالعبرة وأسلوب الدرس) مبينا لكل أسلوب الايجابيات والخصائص وبعض المقترحات العملية في الغرفة الصفية .
أما اقلانية (1992) فقد بحث في النظم التعليمية عند المحدّثين في القرون الثلاثة الأولى تعرض فيها لحلقات العلم عند المحدثين ومجالسهم وبين أن هناك نوعين من المجالس ، الأولى مجالس التحديث والثانية مجالس الإملاء ، كما تعرض لأسلوب المذاكرة في التعلم والرحلة في طلب الحديث والإشراف التربوي والتعليمي عند المحدثين ، وختم كتابه بخصائص التعليم عند المحدثين ذكر منها: العمومية والمساواة، المجانية والتكوين المستمر وارتباط العلم بالعمل.
أما الباحث ( أبو دياك، 1995) فقد قام بدراسة عنوانها الأساليب المفرّدة في تعليم وتعلم العقيدة الإسلامية المستخلصة من القرآن والسنة وأثرها في التحصيل الدراسي على طلبة الصف الأول ثانوي، وقد بين فيها أن القرآن الكريم قد استخدم عدة أساليب لعرض العقيدة الإسلامية منها :
- أسلوب المحاكاة العقلية .
- أسلوب الاستجواب : حيث يوجه أسئلة إلى المخاطب تقوده للحقيقة .
- أسلوب المقابلة والمقارنة .
- أسلوب التكرار والتذكير .
- الاستدلال بربط العلة بالمعلول .
- المخاطبة العاطفية والتأثير في الوجدان .
أما جهود الزرنوجي فقد تعرض لها الباحث (العلي، 2005) بدراسة عنوانها إسهامات الزرنوجي في مجال طرائق التدريس: دراسة تحليله لكتاب تعليم المتعلم طريقة التعلم وفيه يؤكد الزرنوجي على الأساليب الآتية للتعلم:
- التعلم عن طريق الفهم
- التعلم عن طريق التأمل .
- التعلم عن طريق التكرار .
- التعلم عن طريق الحفظ.
- التعلم عن طريق المذاكرة والمطارحة والمناظرة.
- التعلم عن طريق السؤال.
من الواضح أن المستقرئ لتلك الدراسات يجد أنها تكلمت عن الأساليب وطرق التدريس التي استخدمها القرآن الكريم أو السنة النبوية أو السلف الصالح لكن دون أن تفصل في شروط استخدام تلك الأساليب أو الخصائص لكل أسلوب أو الخطوات التنفيذية التي تمكن المعلم من تطبيق تلك الأساليب بشكل صحيح .
وقد يرى البعض أن الدراسات التي بحثت في تدريس التربية الإسلامية وقدمت على شكل رسائل علمية أو كتب منهجية ، يمكن أن تكون نماذج لدراسات سابقة يمكن أن تبنى عليها هذه الدراسة ولكن عند استعراض الباحث للعديد من تلك الدراسات وجد أنها تستخدم طرائق التدريس الحديثة وتوظفها في تدريس فروع مادة التربية الإسلامية ، وهذه نماذج من تلك الدراسات :
الرسالة التي قدمها ( السالمي ، 1995 ) بعنوان تأثير طريقتي الاستقصاء والمناقشة في التحصيل الفوري والتحصيل المؤجل لمادة التربية الاسلامية لدى طلاب الصف الأول ثانوي في إحدى مدارس محافظة مسقط .
الرسالة التي قدمها ( العمري ، 2000 ) بعنوان مقارنة أثر التعليم المبرمج المحوسب والتعليم المبرمج المكتوب في تحصيل طلبة الصف الثامن الأساسي في مادة التربية الإسلامية .
الرسالة التي قدمها ( المواجدة ، 2004 ) بعنوان مقارنة بين أثر طريقتي نظام التعليم الشخصي ( خطة كيلر ) والتعلم التعاوني في تحصيل طلبة الصف السابع الأساسي في مبحث التربية الإسلامية في الأردن .
فهذه الدراسات وغيرها يمكن أن يفيد منها الباحث للوصول إلى أفضل ما توصلت إليه التربية الحديثة شريطة أن لا يتعارض مع تصوراتنا الإسلامية .
10. الإضافة النوعية للبحث :
ستحاول هذه الدراسة بناء رؤية كلية متعلقة بأساليب وطرق التدريس الأصيلة من خلال النصوص القرآنية والنبوية والتراثية ومن خلال ما توصلت إليه الدراسات التأصيلية المتعلقة بموضوع الدراسة مع عدم إغفال العلوم التربوية الحديثة ، وما سينبثق عن ذلك من طرائق تدريس أصيلة ومبادئ تعلم وتعليم كلها تؤكد ما قامت عليه الرؤية الكلية ، مع محاولة لتصنيف تلك الطرائق بحيث تربط بعض الأساليب بمجال الهدف المنوي تحقيقه أو نوع المؤسسة التربوية التي ستستخدم تلك الأساليب أو طبيعة المحتوى المقدم ، أو تربطها بالمرحلة العمرية أو جنس الطالب … الخ .
كما ستحاول هذه الدراسة أن تتوصل للخطوات الإجرائية في تطبيق تلك الأساليب حتى يتمكن المعلم من تطبيقها بالكيفية الصحيحة .
المحور الأول : مفاهيم أساسية
الاستعداد للتعلم
يولد الإنسان وليس لديه من العلم شيء، لكنه يمتلك الأدوات التي يحصل من خلالها على العلم، مثل السمع والبصر والعقل وغيرها (وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (النحل: 78)
أي أن لديه استعدادا للتعلم والاستزادة من العلم، فالله سبحانه وتعالى يقول (فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا)(طه: 114) فلولا أن الإنسان قابل ومستعد لتحصيل العلم لما طلب منه التعلم الاستزادة في تحصيل العلم .
والاستعداد للتعلم مرتبط بالنضج، فكلما زاد نضج الإنسان زاد استعداده للتعلم، وفي ذلك يقول (ابن خلدون،1993،ص458) “ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم بالجملة إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال بالأمثلة الحسية، ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا بمخالفة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه حتى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل” وهذا يدل على أن قبول العلم والاستعداد لفهمه ينشأ تدريجيا في ضوء النضج العقلي للمتعلم .
كما يرى الغزالي أن الناس يتفاوتون فيما بينهم في الاستعداد للتعلم ، فمنهم من يكون مستعدا لاستظهار مادة التعلم ويعجز عن استيعابها وإدراك مغزاها، ومنهم من هو مستعد لفهمها وتطبيقها(التل،2005،ص215) ، ويؤكد ابن سينا على ضرورة تعليم المتعلم ما يوافق استعداده فيقول “وليس كل صناعة يرومها الصبي ممكنة له مواتية ، لكن ما شاكل طبعه وناسبه”(باقارش والسبحي،1996،ص187) .
العلم والتعلم
إذا كان العلم بالشيء يعني الإحاطة بكافة جوانبه وفهمه على النحو الصحيح، فضلا عن إدراك القصد من ورائه، أو كما يقول الأصفهاني “العلم هو إدراك الأشياء على حقائقها”(التل ،2005،ص18) فالتعلم هو حصول العلم والفكر للنفس الإنسانية ( ابن خلدون،1993،ص372) أي حصول صورة المعلوم في ذواتهم بعد أن لا تكون حاصلة، وهذا يعني أن ابن خلدون يرى أن العلم البشري كله مكتسب ، على النقيض من رأي الغزالي الذي يرى أن العلم والحكمة يكمنان أصلا في النفس البشرية غير أنه لا بد من سعي لإظهارهما بالفعل كما لا بد من حفر الآبار لخروج الماء(الغزالي،1985) . أما ابن مسكويه فيرى أن جزءا من العلم مكتسب وجزء فطري .
لكن (ابن عبد البر،1968) يرى أن التعلم هو إلهام من الله يجعله في قلب المتعلم إذا أخذ بأسبابه وأدواته ويقرنه بالحكمة ويحدده بحسن الإدراك، ويبين أن التعلم يحدث وفق الخطوات الآتية : النية ، الإنصات ، الاستماع ، الفهم ، الحفظ ، العمل ثم النشر.
كما يرى ابن مسكويه أن “في الإنسان قوتان : قوة عالمة يشتاق بها إلى المعارف والعلوم ، وأخرى عاملة يشتاق بها إلى نظم الأمور وترتيبها ، كمال القوة العالمة أن يبلغ الإنسان في العلم منزلة يصدق فيها نظره وتصح بصيرته فلا يغلط في اعتقاد ولا يخطئ في حقيقة ، وتتدرج هذه القوة من العلم بالموجودات حتى العلم الإلهي آخر مراتب العلوم فيطمئن قلبه وتذهب حيرته ، أما كمال القوة العاملة فيبدأ في ترتيب الأفعال وتناسقها من حياة الفرد وينتهي إلى تدبير أمور المجتمع ولا يتم أي من الكمالين إلا بالآخر لأن العلم بداية والعمل نهاية”(ابن مسكويه،1966،ص38) .
كيف يحصل التعلم ؟
يرى ابن خلدون أن النفس ذات روحانية مدركة بالقوة، ولها مادة وصورة، وهي بالإدراك الذي لها وبما يعود من ذلك الإدراك تقبل مادتها صورة الوجود، التي تتعاقب عليها مرة بعد أخرى فتتم تدريجيا إلى أن تبلغ غايتها أو – صورتها الكاملة – التي هي إدراك محض وتعقل محض، إن لبوس النفس لصور المعلومات التي تتعاقب عليها يكسبها علما وهذا العلم الحاصل لها هو تعلم، كذلك فإن النفس بخروجها من القوة إلى الفعل تدريجيا تكتسب عقلا تحصل به صور الوجود ، وهذا العقل الذي يظهر للنفس ويحصل به العلم هو تعلم أيضا. ( الحسين،1979، ص67).
أما الغزالي فيرى أن النفس تتوهم ما يتكرر أمامها فينطبع فيها هذا الوهم وينعكس على شكل رد فعل نابع من النفس ذاتها وفي ذلك يقول “إن النفس متى تتوهم شيئا طيب المذاق تحلبت أشداقه، وانتهت القوة الملعبة فياضة باللعاب من معادنه وذلك لأن الأجسام والقوى الجسمانية، خلقت خادمة مسخرة للنفوس، ويختلف ذلك باختلاف صفاء النفوس وقوتها فلا يبعد أن تبلغ قوة النفس إلى حد تخدمها القوة الطبيعية في غير بدنه، لأن نفسه ليست منطبعة في بدنه إلا أن لها نزوعا وشوقا إلى تدبيره” (القاضي ويالجن،1981،ص201)
التعليم
التعليم عند ابن خلدون صناعة من الصنائع لها أصولها وقواعدها ولا بد للمعلم من أن يلم بها فإن جودة التعلم تتوقف على جودة التعليم ، ويرى الغزالي أن التعليم تهذيب لنفوس الناس عن الأخلاق الرديئة المهلكة وإرشادها إلى الأخلاق الحميدة المسعدة مصداقا لقوله تعالى (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)(الأحزاب: 33) .فالتعليم يخرج من حد الهمجية إلى حد الإنسانية ، وتبين ( التل ،2005، ص263) أن مفهوم التعليم يتضمن إحداث تعديل على البنية المعرفية للمتعلم بتصويب المفاهيم الخاطئة (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (14) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15)) ( الحجرات: 14-15 ) ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم “أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار”[2]
كما يشير التعليم إلى تعديل في السلوك ، فقد عدل النبي صلى الله عليه وسلم سلوك الصحابي الذي لم يتقن صلاته، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم “دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي فرد النبي السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فصلى ثم جاء فسلم على النبي، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل(ثلاثا)، فقال: والذي بعثك بالحق، فما أحسن غيره فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع، حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها”[3].
طريقة التدريس
الطريقة لغة تعني السيرة والمذهب وهي أيضا الخط في الشيء وطريقة القوم خيارهم ، ويقال هذا رجل طريقة قومه وهؤلاء طريقة قومهم أو طرائقهم ، والطرق تأتي بمعنى العادة ، يقال ما زال على طرقته أي هذا دأبه وعادته ، وجمعها طرائق ( ابن منظور،جزء10،ص215 )(الرازي ص391).
وطريقة التدريس كما عرفها ( عبد الله، 1997، ص5 ) هي أسلوب ملائم لاستخدام محتوى تعليمي لتحقيق غرض محدد لدى فئة معينة من المتعلمين ، كما أنها تتضمن الأنشطة التعليمية الموجهة التي يقوم بها المعلم والمتعلمون في الموقف التعليمي التعلمي .
أما ( قمبر، 1985، ص167 ) فقد بين أن طريقة التدريس هي منهج استراتيجي يخط مسالك العمل ويحدد خطواته للوصول إلى أهداف مرسومة بأقل جهد ممكن وأكثر فاعلية مطلوبة . وتعرف (دروزة ، 2000) طريقة التدريس بأنها النهج الذي يسلكه المعلم في توصيل ما جاء في الكتاب المدرسي أو المنهاج الدراسي من معرفة ومعلومات و مهارات و نشاطات للمتعلم بسهولة ويسر ، بحيث تكفل طريقة التدريس هذه التفاعل بين المعلم والطلاب وبين الطلاب والمادة الدراسية والطلاب بعضهم مع بعض ، ثم بين الطلاب و أفراد البيئة المحلية .
أما في هذه الدراسة فإن طريقة التدريس ستعرف كما مرّ سابقا:
طريقة التدريس : هي عبارة عن جملة من الخطوات والإجراءات المنظمة التي يقوم بها المعلم وطلبته لتنفيذ الموقف التعليمي ، سعيا لتحقيق أهدافه .
وقد أكد ابن خلدون على أهمية طريقة التدريس عندما اعتبر التعليم من جملة الصناعات وقد جاء في المقدمة “ومما يشهد بذلك في المغرب أن المدة المعينة لسكن الطالب بالمدارس عندهم ستة عشرة سنة وهي في تونس خمس سنوات ….. فطال أمدها في المغرب .. من قلة الجودة في التعليم خاصة، لا مما سوى ذلك”. (ابن خلدون،1993،ص343)، فالاختيار السليم لطريقة التدريس يؤدي إلى تعلم جيد، ويوفر الجهد والوقت ويزيد من إقبال الطالب على التعلم، والعكس إذا لم يستخدم المعلم طريقة تدريس مناسبة.
الفرضية الرئيسة للدراسة
تنطلق هذه الدراسة من فرضية أساسية تحدد دور المعلم ودور المتعلم في عملية التدريس، أما بالنسبة لدور المعلم فالدور الأساسي له هو تيسير التعلم على المتعلم، وهذا الدور قد عبرت عنه النصوص القرآنية والنبوية بصورة صريحة وبصورة ضمنية ، أما النصوص القرآنية الصريحة فقد قال الله سبحانه وتعالى (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ) (القمر: 17 ،22، 32، 40 )، أي أن هذه الآية تكررت أربع مرات في سورة القمر.
أما النصوص النبوية الصريحة فقد قال صلى الله عليه وسلم: “إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ، ولكن بعثني معلما ميسرا”[4] .
أما بالنسبة للمواقف التي تدل على تيسير التعلم بصورة ضمنية فهي أكثر من أن تحصى :
يقول الله سبحانه وتعالى (إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (الزخرف: 3).
فقد صرحت هذه الآية أن الحكمة من إنزال القرآن باللغة العربية هي تمكين الذين يؤمنون به من أن يعقلوه ، ويقول (وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا)( الإسراء: 106 ) وقد ورد في تفسير على مكث، أي على مهل وتؤدة ليفهموه .
أما المواقف النبوية فهي كثيرة جدا: فعن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم “كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه” [5]
بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذر من أن يحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم، وهذا عكس التيسير، حيث يقول “ما أحد يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم”[6] وقد كان صلى الله عليه وسلم يتخول صحابته بالموعظة خشية السآمة عليهم، وحتى ييسر التعلم على أتباعه فقد كان ينوع بطرائق تعليمه ، فيستخدم القصة أحيانا ، ويثير التساؤل أحيانا أخرى، كما استخدم أسلوب ضرب الأمثال وطرح السؤال … الخ، وما من موقف تعليمي مارسه عليه السلام إلا وتشتم منه رائحة التيسير على المتعلمين.
أما دور الطالب فهو الإقبال على العلم والرغبة فيه والاستعداد لتحمل مشاقه والقيام بكل مستلزماته ، ويتبين ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم “يا أيها الناس تعلموا ، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين”[7] فاستخدام الرسول صلى الله عليه وسلم لـ إنما بقوله – إنما العلم بالتعلم – وهي أداة حصر تدل دلالة واضحة أن الحصول على العلم لا يمكن أن يتم إلا من خلال التعلم ، والتعلم كما هو معلوم عملية ذاتية داخلية يقوم بها المتعلم وقد صرح بذلك ابن عبد البر بتعريفه للتعلم بقوله عن التعلم بأنه “إلهام من الله يجعله في قلب المتعلم إذا أخذ بأسبابه وأدواته” أي أن التعلم لن يحدث إلا إذا طلب المتعلم العلم وكان راغبا فيه ومندفعا من ذاته دون أن يفرض عليه فرضا ، وعليه فإن التعلم يعني القدرة على الإدراك ويشترط توفر الدافعية الداخلية الذاتية حتى يحدث ( ابن عبد البر،1968،ج1،ص31) . “هكذا قضت سنة الله: أن السماء لا تمطر على الإنسان علما، وهو قاعد في بيته، إنما يدرك العلم من طلبه، وعانى في تحصيله”.( القرضاوي،2001، ص85)
والتربية الحديثة تعرف التعلم بأنه “عمليات سيكولوجية عقلية داخلية تتم داخل المتعلم نتيجة للمثيرات المحيطة به ونتيجة للاستعدادات الموجودة لديه” ( الجامعة العربية المفتوحة، 2004،ص103 ). وهذا يؤكد أن التعلم عملية ذاتية داخلية، فإذا أردنا تعليم طالب أمرا ما وصممنا له أفضل المناهج وأحضرنا أميز المعلمين ووفرنا له أفضل بيئة تعليمية، لن نستطيع تعليم هذا الطالب إلا إذا أراد هو أن يتعلم واستعد لذلك . كما قيل في المثل – تستطيع أن تسحب الحصان إلى النهر ، لكنك لا تستطيع إجباره على الشرب .
ويؤكد الخطيب البغدادي على أن التعلم الحقيقي هو “جهد يبذله المتعلم ونشاط يقوم به في سبيل التحصيل وفي سبيل تثبيت التعلم ، فلا يسارع إليه النسيان ويصبح للتعلم قيمة وتتحقق منه الفائدة”(البغدادي،1389هـ،ج2،ص108) ويقارن بين المقبل على التعلم والمدبر عنه بقوله”إن ذلك بمثابة رجل يشتهي الطعام ولا تكون معدته نقية فإذا أكل أضره ولم يستمره ، وإذا اشتهى والمعدة نقية استمرأ ما أكل وبان على جسمه وهذا حال من تلقى إليه المعارف دون أن تستثير فيه استجابة ونشاطا، فهو كمن يتناول الطعام ولا يستطيع هضمه لمرض في معدته أما الذي تستثيره المعارف والحقائق التي تلقى إليه فيبذل في سبيل تعلمها جهده ونشاطه فإنه يفيد منها كمن يتناول الطعام فيهضمه فتظهر عليه آثاره صحة وعافية” (البغدادي،1389هـ،ج2،ص108).
ولو لم يكن المتعلم مسؤولا عن تعلمه لما كانت النصوص القرآنية والنبوية تحضه على ذلك بل وتأمره أمرا، وتحذره من التقصير في ذلك وتتوعده إذا قصر.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “طلب العلم فريضة على كل مسلم”[8]. وقال: “كن عالما أو متعلما، ولا تكن الثالثة فتهلك”.
تزداد فاعلية التعليم بزيادة تيسير المعلم للتعلم على الطالب، وبزيادة إقبال الطالب على التعلم دافعيته وتحمله .
المحور الثاني: طرائق التدريس الأصيلة
استخدم القرآن والسنة النبوية العديد من الأساليب والطرائق التعليمية لتبيين أمور الدين والدنيا وتعليمها للمسلمين، وقد أفاد علماء أمتنا ومربوها من تلك الطرائق واستخدموها في تعليم طلبتهم، وسنعرض في هذا المحور أهم تلك الطرائق، وأكثرها ظهورا في أصولنا التربوية وتراثنا الإسلامي .
أولا: العرض المباشر ( الإلقاء )
في العرض المباشر أو طريقة الإلقاء نتحدث عن الطرائق التي يكون للمعلم فيها الدور الأكبر في العملية التعليمية-التعلمية حيث يعد المادة العلمية ويلم شملها وينظمها وفق تسلسل مناسب ثم يقوم بعرضها على المتعلمين بصورة حديث شفوي وبتسلسل دقيق وربط كل وحدة أو فكرة بما تم تعلمه سابقا، ليقوم الطلبة بفهمها وإدراكها ثم استذكارها عندما يطلب منهم ذلك، وقد يستخدم خلال العرض ما ييسر التعلم على المتعلم مثل الوسائل التعليمية والتنويع في الحركة والصوت وضرب الأمثال والتكرار … الخ، وتعتبر هذه الطريقة من أقدم الطرائق ومن أكثرها انتشارا خصوصا في المراحل الدراسية العليا ، كما تعتبر من أيسر الطرق وأقلها تكلفة كما وتناسب جميع البيئات التعليمية حتى ذات الإمكانات المحدودة .
والمتحمسون لهذه الطرائق يرون أن المعلم هو الذي يملك المعلومة وهو القادر على تنظيمها بصورة مناسبة للمتعلم وتقديمها بأسلوب مبسط حيث يشرح ويوضح ويطرح الأمثلة ويلخص … الخ .
أما المتعلم فينحصر دوره في الانتباه على المعلم والاستماع الجيد ليتمكن من فهم المطلوب واستيعابه ، وقد يقوم بتدوين بعض الملحوظات خلال عملية الإلقاء .
أما بالنسبة للخطوات الإجرائية التي يقوم بها المعلم خلال عملية الإلقاء فتتفاوت من موقف للآخر ولكن قد تكون هذه الخطوات قاسما مشتركا للكثير منها: (سليمان ، 2005).
- مناقشة محتوى الدرس مع الطلبة بأن يخبرهم المعلم بما هو متوقع منهم أن يتعلموه.
- تسمية الموضوع الجديد (مفهوم أو تعميم أو مهارة) وكتابة الاسم بشكل بارز .
- التأكد من تذكر الطلاب للمتطلبات السابقة لموضوع الدرس وإتقانها وذلك من خلال التقويم القبلي .
- تقديم صيغة لفظية لموضوع الدرس.
- تقديم أمثلة ولا أمثلة (أمثلة عدم انتماء) على موضوع الدرس.
- التقويم البعدي لمعرفة مدى تحقق الأهداف .
إيجابيات طريقة العرض المباشر :
على الرغم من أن طريقة العرض المباشر تعتبر من أقدم طرائق التدريس وهناك الكثير من الانتقادات حولها ، إلا أنها من أكثر طرائق التدريس انتشاراً وذلك لما تتمتع به من إيجابيات ذكر منها ( الخطيب،2009، ص229-230) :
- تقديم كمية كبيرة من المعلومات في وقت قصير فتمكن المعلم من تغطية مفردات المادة في وقت مناسب .
- لا تحتاج لجهد كبير في الإعداد مقارنة مع الطرائق الأخرى .
- تزود الطلبة كافة قدراً متساوياً من المعلومات العلمية .
- يمكن استخدامها مهما كانت إمكانات المدرسة شحيحة .
- سهولة ضبط الصف وفرض الهدوء والنظام داخل الغرفة الصفية .
سلبيات العرض المباشر :
- الدور السلبي للمتعلم مقارنة مع الطرائق الأخرى .
- قد لا تكون مناسبة لبعض المواقف التعليمية .
- يصعب على المعلم مراعاة الفروق الفردية عند استخدامه للعرض المباشر .
- قد تكون مملّة خصوصاً إذا كانت مدة العرض طويلة ولم تكن مشوقة .
- لا تساعد على الاحتفاظ بالمعلومات لمدّة طويلة .
إرشادات لتحسين طريقة العرض المباشر:
- التخطيط الجيد والاستعداد المناسب وذلك بتحديد الأهداف وإعداد المحتوى وتقسيمه إلى أجزاء وترتيبها منطقياً لتنظيم عرضها .
- إثارة اهتمام الطلبة وشد انتباههم .
- الاهتمام بالأداء الصوتي فيكون الأداء بسرعة معتدلة وبصوت واضح ومسموع وتكون نبرة الصوت متنوعة ، وتوافق بين الأداء الصوتي وموضوع الحديث .
- الاهتمام بالمفاهيم الأساسية والتأكد من وضوحها لدى المستمعين .
- تكرار بعض النقاط والأفكار الرئيسية ويمكن عمل خلاصة لها وعرضها أمام الطلبة .
- تجنب المشتتات الداخلية والتخلص من المشتتات الخارجية إن حصلت .
- يمكن تنويع أساليب العرض ووسائله بين الحين والآخر .
- تشجيع الدارسين على تدوين الملاحظات .
- إتباع المحاضرة بنقاش وتشجيع الطلبة على طرح الأسئلة .
- لا بد أن يكون المعلم بشوشاً مرحاً ويتعامل مع طلبته بأريحية ولا يطيل في محاضرته .
وهناك الكثير من طرائق التدريس يمكن أن تندرج تحت مسمى العرض المباشر أو الإلقاء من أهمها :
1. المحاضرة
وهي من الأساليب المعروفة والمألوفة وتستخدم كثيرا في المدارس والجامعات والمراكز العلمية وغيرها ، ويمكن تعريف المحاضرة بأنها الحديث الذي يعرض عرضا شفويا مستمرا دون أن يقطعه المستمعون عادة، يتضمن طائفة من المعلومات والمعارف والخبرات ( الخوالدة وعيد، 2003، ص287) وقد تكون المحاضرة من الأساليب المستحسنة في الظروف التعليمية الصعبة مثل كثرة عدد المتعلمين أو كثرة المادة المراد تعلمها خلال مدة زمنية قصيرة ، كما تكون مناسبة في البيئات التعليمية ذات الموارد المالية القليلة والإمكانات المحدودة .
وقد استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم المحاضرة أو ما يشبهها في الكثير من مواقفه التعليمية ، ومثال ذلك :
عن بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غداة جمع: “يا بلال ، أسكت الناس أو أنصت الناس ، ثم قال إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا ، فوهب مسيئكم لمحسنكم ، وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا باسم الله”[9].
2. الخطبة
في كل أسبوع يجتمع المسلمون للاستماع لخطبة الجمعة ، ليتعلموا أمور دينهم ودنياهم، وكذلك في العيدين وفي كثير من المناسبات مثل النكاح والجهاد وغيرها.
والخطبة “هي قول منثور حسن يخاطب به متكلم فصيح اللسان جمعا من الناس لإقناعهم بقضية معينة أو تعليمهم معلومة أو معرفة محددة ، بإثارة عواطفهم غالبا واستنهاض هممهم لأداء سلوك معين” . ( الخوالدة وعيد، 2003، ص292 ) .
وتتميز الخطبة عن المحاضرة بما يأتي : (الآغا ،1991، ص224)
- تلقى الخطبة عادة في مناسبات محددة يغلب عليها الطابع الرسمي أكثر مما يغلب على المحاضرة .
- تطرق الخطبة عادة الجانب العاطفي أكثر مما تفعله المحاضرة .
- تستخدم الخطبة عادة في الدعوة وتنمية القيم والاتجاهات أما المحاضرة فيمكن أن تستخدم لعرض أي موضوع بما فيها التي تستخدم فيه الخطبة .
- غالبا ما يكون الخطيب شخصا مرموقا في مجتمعه معروفا من قبل المستمعين ويعاملونه باحترام ظاهر .
وقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يقدم النموذج الأمثل من الخطب ليسير على نهجه الخطباء، فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب، احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي”( أبو غدة،1996، ص193).
ومن خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس في أول خطبة له في المدينة المنورة بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله: أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم ، تعلموا والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك ؟ فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل ، ومن لم تجده فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف ، والسلام عليكم وعلى رسول الله ورحمة الله وبركاته ( الخوالد وعيد،2003، ص294) .
3. القصة
القصة حكاية نثرية تستمد أحداثها من الواقع أو من الخيال أو منهما معا وتبنى على قواعد معينة . والقصة لا تنقل معرفة فقط بل تساهم في بناء القيم والاتجاهات الإيجابية بدرجة أكبر من غيرها كما أن فيها من العظة والعبرة الكثير ( فالعاقل من اتعظ بغيره ) وتتميز عن غيرها من طرق الإلقاء بشدة تأثيرها على نفسية المتعلم وشدة جاذبيتها كذلك فالنفس تحب سماع القصص خصوصا الأطفال، فالمستمع عادة لا يقف سلبيا من شخص القصة وأحداثها، بل يتفاعل معها شعوريا أو لا شعوريا، فيتقمص بعض شخصياتها ويحس بأحاسيسهم، ويرتبط بهم فيوافق ويستنكر ويوازن بين المواقف ويحللها ( التل ، 2005،ص294) .
القرآن الكريم روى لنا الكثير من قصص الأنبياء والرسل والأمم الغابرة مفصلا أحيانا ومجملا أحيانا أخرى ، وفي سورة الكهف وحدها يروي لنا قصة أصحاب الكهف وقصة أصحاب الجنة، وقصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر وكذلك قصة ذي القرنين.
أما في السنة النبوية فالقصص كثيرة فهذه قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ويتوب الله عليه ، وقصة المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها ، وقصة الثلاثة الذين آووا للغار وحبستهم الصخرة وما أنقذهم إلا تشفعهم بصالح أعمالهم … الخ .
وتختلف القصة عن الخبر العادي ، فالقصة لا بد لها من عقدة ، والعقدة هي العنصر الأساس وهي السر المخبأ الذي يلوح به القاص من أول القصة ويشوق الذهن إلى معرفته .
4. العرض العملي ( الملاحظة)
حيث يقوم المعلم بالتطبيق التفصيلي لما يريد تعليمه للطلاب والطلاب يلاحظونه ويحاولون تقليده، ليمتلكوا القدرة على تنفيذ ما قام به المعلم.
لقد علّم الله سبحانه وتعالى ابن آدم كيف يدفن أخاه المقتول بإرسال غراب ينفذ أمامه عملية الدفن (فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ)( المائدة:31) .
كما أرسل لنا رسولا ليكون أسوة لنا حيث نرى تعاليم الإسلام تتجسد فعليا في شخصه وسلوكه عليه السلام (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا)(الأحزاب: 21) .
وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه وقال لهم “صلوا كما رأيتموني أصلي” ، وحج معهم وقال “خذوا عني مناسككم” . أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم العرض العملي لتعليم أصحابه الشعائر الدينية التي تتطلب إتقان مهارات حركية حيث لا يمكن الاقتصار في تعليمها على الجانب النظري.
عن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : “رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فاستقبل القبلة وكبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض فلما فرغ أقبل على الناس فقال : أيها الناس إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي”[10]
وروى البخاري عن معاذ بن عبد الرحمن أن أبان أخبره قال : أتيت عثمان ابن عفان بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال : “من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد وصلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه قال وقال صلى الله عليه وسلم لا تغتروا” [11].
كما استخدم العرض العملي لغايات التعليم المهني فقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم بغلام يسلخ شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنح حتى أريك فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط وقال : يا غلام هكذا فاسلخ ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ [12].
ثانيا: السؤال والحوار
في هذه الطرائق يقوم المعلم بإعداد المادة إعدادا جيدا ويصوغ حولها عدة أسئلة وقضايا للنقاش، لكنه لا يقدم المادة بعرضها عرضا مباشرا كما هو الحال بالإلقاء أنما يطرح الأسئلة على طلابه ويعرض المواقف للنقاش ، ليدلي كل بدلوه ويعبر عن رأيه ويدعم حجته بل يحاول كذلك الإصغاء لآراء الآخرين لينقدها ويقومها، فيؤيدها أو يعارضها .
من الواضح أن المتعلم في هذه الطرائق لم يعد دوره مقصورا على الاستماع والفهم والاستذكار، إنما تجاوز ذلك إلى التفاعل مع الموقف التعليمي ومحاولة الوصول مع الآخرين إلى المعرفة المطلوبة والمساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف الموضوعة للموقف التعليمي .
من الواضح كذلك أن هذه الطرق تنمي التفكير عند المتعلم وتشجعه على دعم آرائه بالحجج المنطقية كما تفسح له المجال لنقد آراء الآخرين فتنمو لديه مهارات التحليل والنقد .. الخ .
إذا توقع الطالب أن يطرح عليه السؤال فإنه يشعر بأهمية الموقف وأنه مطالب بالإجابة، فتزداد لديه درجة اليقظة والانتباه والحرص على التوصل للإجابة المطلوبة ، وعندما يشارك المتعلم ببذل الجهد الفكري الذاتي لمعالجة الموقف يؤدي ذلك إلى ثبات الخبرة التي مر بها فتثبت في الذهن وتبقى في الذاكرة .
لقد شجع الإسلام على التساؤل فقال (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)(الأنبياء: 7).
1. طريقة المساءلة (السؤال والجواب)
تعتبر الأسئلة الصفية التي يطرحها المعلم على طلبته من أدوات التواصل المهمة ، كما لا يستطيع المعلم أن يستغني عنها ، فهو يستخدمها في المدخل الذي يبدأ به الدرس ، كما يستخدمها لمعرفة الحصيلة المعرفية عند الطلبة ، ومن خلالها يذكّر الطلبة بما تعلموه سابقاً ، والأسئلة الصفية هي أدوات أسلوب الحوار والمناقشة ، كما يستخدمها المعلم للتقويم يستخدمها كذلك للتعليم .
يعرف السؤال بأنه مثير يوجهه المعلم للمتعلم للاستجابة له كتابة أو مشافهة أو إجراء .
وقد استخدم القرآن أسلوب السؤال للتعليم ولأغراض أخرى مثل التحقيق والتقريع والاستنكار … الخ . ومن الأمثلة على السؤال في القرآن :
- (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) (الرحمن:13)
- (مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا) (نوح:13)
- (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ)( القمر:17 )
- (أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64)) (الواقعة: 63 – 64 ).
أما في السنة النبوية فقد استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال في تعليم أصحابه ليستثير دافعيتهم للتعلم ويفحص ما عندهم من العلم، ثم يجيب لهم عنها بعد أن يفسح المجال لهم للتفكير والإجابة . والمواقف كثيرة جدا سنذكر بعضا منها :
يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فيقول: “إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ، وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي ؟ فوقع الناس في شجر البوادي ، قال عبد الله : ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة” [13] .
عن عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :” تدرون من المسلم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . قال : تدرون من المؤمن ؟ قالوا الله ورسوله أعلم ، قال المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم . والمهاجر من هجر السوء فاجتنبه”[14]. وفي الحديث المشهور الذي تمثل فيه جبريل عليه السلام بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وسأل الرسول عن الإسلام وعن الإيمان والإحسان والساعة وأماراتها . وفي نهاية الحديث يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالسائل بأنه جبريل أتاهم ليعلمهم دينهم .
ويعد الإمام علي كرم الله وجهه من أوائل من اعتمد السؤال طريقة في التعليم فيقول : العلم خزائن ومفاتحه السؤال ، فاسألوا يرحمكم الله ، فإنه يؤجر فيه أربعة : السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم . ( التل ، 2005، 285 ) .
وينصح ابن جماعة المعلم بالاستماع إلى سؤال المتعلم مهما كان صغيرا وإن لم يتمكن من التعبير عن سؤاله فعليه أن يبين ذلك ، وعليه أن يتروى قبل الإجابة وإن لم يعرف ، فعليه أن يقول لا أدري ( ابن جماعة، 1934).
إيجابيات طريقة المساءلة :
- تثير تفكير الطلبة وتولد لديهم حب الاستطلاع .
- تشد انتباه التلاميذ نحو المادة .
- تعتبر من الطرائق التي تفعّل دور الطالب وتجعله إيجابياً .
- تزيد من ثقة الطالب بنفسه عندما يجيب عن الأسئلة وتكون إجابته صحيحة .
- إجابات الطلبة تقدم تغذية راجعة للمعلم عن أدائه و أداء طلبته . ودرجة وضوح الأفكار في أذهانهم .
سلبيات طريقة المساءلة :
- تحتاج لمعلم ماهر في إعداد الأسئلة وصياغتها وتقديمها .
- قد تحتاج لوقت طويل في تقديم المادة .
- لابد أن يكون مستوى الطالب جيداً ومستعداً للمساءلة .
خصائص السؤال الجيد :
- يجب أن يكون السؤال واضحاً وألفاظه مألوفة للطلبة كما يفضل أن يكون قصيراً ويدور حول فكرة واحدة .
- لابد أن يكون السؤال مناسباً لمستوى تفكير الطلبة وضمن حدود معارفهم وخبراتهم.
- أن يكون السؤال ضمن إطار الدرس وفي سياق الأهداف التي يرغب المعلم في تحقيقها عند الطلبة .
- أن يكون دقيقاً ليس فيه مجال للاجتهاد في تفسيره أو التأويل البعيد عن المطلوب أي أنه لا يفهم إلا بطريقة واحدة .
إرشادات لتحسين طريقة المساءلة :
- اطرح السؤال على جميع طلبة الصف ثم كلف أحدهم بالإجابة وذلك لشد انتباههم وتيقظهم وإفساح المجال لكل واحد فيهم أن يفكر في إجابة السؤال، ذلك لأن كل طالب سيتوقع أنه هو الذي سيقع عليه اختيار المعلم للإجابة .
- الانتظار لفترة قصيرة من الزمن بعد طرح السؤال ، ثم بعد ذلك كلف أحد الطلبة بإعطاء الإجابة ، وتشير الدراسات أن أفضل زمن للانتظار هو ما بين ثلاث إلى خمس ثوان (الخليلي وآخرون ، 1996) .
- التوزيع العادل للأسئلة على جميع الطلبة مع ضرورة مراعاة الفروق الفردية .
- تعويد الطلبة على مهارة الاستماع وأدب الحديث .
- عدم التهكم من صاحب الإجابة الخطأ وإزالة الحرج عنه بطريقة تربوية .
- تعزيز الإجابات الصحيحة وتقديم تغذية راجعة للطالب عن إجابته مع تجنب المديح الزائد والإطراء المبالغ فيه ، أي يجب أن يتناسب التعزيز مع أهمية الإجابة و صعوبتها.
- الاهتمام بالأسئلة التي يثيرها الطلبة فمن خلالها يتعرف المعلم عما يدور في أذهان طلبته ويكشف عن أخطائهم وتصوراتهم غير الصحيحة .
- لابد من الاهتمام بالطلبة الضعاف ويمكن اختيار بعض الأسئلة السهلة التي تناسبهم ويظن المعلم أنهم قادرون على إجابتها مع ضرورة عدم إحراجهم .
- الاستعانة بالإيحاءات غير اللفظية لتشجيع الطالب على الاستمرار بالإجابة مثل حركة الرأس الدالة على استحسان الإجابة أو حركة اليدين أو نظرات العيون . . . الخ.
- الاهتمام بالأسئلة ذات المستويات العليا، التي تحتاج إلى تفكير.
- عدم الإلحاح على الطالب الذي لا يتمكن من الإجابة .
- عدم استخدام نفس الألفاظ والصيغ الواردة في كتاب الطالب في صياغة الأسئلة الصفية بل يفضل استخدام صيغ أخرى .
2. الحوار والنقاش
طريقة المناقشة عبارة عن حوار شفوي بين المعلم وطلبته، بحيث تضمن اشتراك الطلبة إيجابياً في عملية التعلم والتعليم. وفي هذه الطريقة يجري تبادل للآراء والأفكار وتفاعل الخبرات بين الطلبة والمعلم، وتقوم هذه الطريقة على أساس أن الأسئلة والمناقشات تتم بين كافة أطراف العملية التعليمية التعلمية فالمدرس قد يسأل وطالب أو أكثر يجيب، وقد يكون السائل هو أحد الطلبة والمجيب هو المعلم أو طلبة آخرون، وقد يدور النقاش بين الطلبة أنفسهم ويكون دور المعلم هو إدارة النقاش فقط، بل قد يدير النقاش أحد الطلبة ويكون دور المعلم هو المراقبة عن بعد فلا يشارك في النقاش ولا يدير الحوار .
ويمكن أن تنفذ هذه الطريقة ضمن الخطوات التالية :
- ما قبل المناقشة : حيث يتم اختيار موضوع النقاش و إعطاء خلفية للطلبة حوله ويمكن أن يخبر المعلم طلبته بموضوع النقاش مسبقاً ليتم الاستعداد له وجمع المعلومات . كما يتم تحديد أهداف المناقشة بدقة و اختيار محاورها .
- أثناء المناقشة : حيث يتم عرض محاور النقاش واحداً تلو الأخر ليتم الحوار حوله ، كما يحدد المعلم خلال النقاش الأسلوب الذي سيتم اتباعه ، فقد يسأل المعلم والطلبة يجيبون ، ويصل المعلم مع طلبته للإجابة المطلوبة ، وقد يفسح المعلم المجال للطلبة أن يناقشوا ويصلوا هم للمطلوب ، وقد يقسم المعلم الطلبة إلى مجموعات صغيرة وتوزيع محاور النقاش عليهم لتصل كل مجموعة إلى المطلوب ، بشكل عام على المعلم أن يحرص على أن يشترك في النقاش معظم الطلبة إن لم يكن كلهم .
- ما بعد المناقشة : يتم الاتفاق على بعض النقاط حول كل محور من محاور النقاش ثم تدون تلك النقاط ليطلع عليها جميع الطلبة ثم ينتهي الأمر بإجراء عملية التقويم .
وبما أن الحوار أو النقاش هو تبادل للأفكار والآراء بين طرفين أو أكثر بتعمق واستقصاء للوصول إلى الحق ( الخوالدة وعيد، 2003، ص365) فقد كان الحوار هو الأسلوب الرئيس الذي استخدمه الأنبياء والرسل عليهم السلام في نشر دعوتهم ومقارعة الكافرين، وقد تبين ذلك في كثير من الشواهد، منها مثلا: قصة إبراهيم عليه السلام وحواره مع النمرود ، وقصة موسى عليه السلام وحواره مع فرعون، ولقد حاور ربنا سبحانه وتعالى الملائكة المكرمين بخلق آدم عليه السلام (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (31) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ (33) )(البقرة: 30 – 33 ).
ونرى أسلوب الحوار في السنة النبوية بصورة واضحة في مواطن كثيرة منها قصة الأعرابي الذي شكا من سوء الظن بأهله لإنجابها ولدا يغايرهما في اللون .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا . فقال : هل لك من إبل ؟ قال : نعم ، قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر ، قال : فيها من أورق ؟ قال : نعم ، قال فأنى كان ذلك ؟ قال : أراه عرق نزعه . قال : فلعل ابنك هذا نزعة عرق[15] . وكذلك الحوار المشهور الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم والشاب الذي جاء يطلب أن يأذن له الرسول في الزنا .
ويشجع ابن خلدون على المناقشة والمناظرة بل إنه يعزو الركود الفكري الشائع في بلاد المغرب في القرن الرابع عشر لطرق التدريس الرديئة التي أهملت فيها المناقشة والمناظرة بقوله ” وأيسر طرق هذه الملكة فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلمية ، فهو الذي يقرب شأنها ويحصل مرامها ، فنجد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثير من أعمارهم في ملازمة المجالس العلمية سكوتا لا ينطقون ولا يفاوضون وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة فلا يحصلون على طائل من ملكة التصرف في العلم والتعليم” ( ابن خلدون، 1993، ص343).
ويرى الزرنوجي أن قضاء ساعة واحدة في المناقشة والمناظرة أجدى من قضاء شهر بأكمله في التكرار والحفظ. ( عبد الدايم ،1973،ص188).
ويذكر ( عبد الدايم ،1973،ص187) عند حديثه عن طرق التعليم عند المسلمين ( ومن أظهر مميزات أساليب التعليم في المراحل العالية شيوع طريقة المناظرة ولعلها من أخص مميزات طرق التربية في تلك العصور ، ولقد وقف المسلمون على أهمية المناظرة في شحذ الذهن وتقوية الحجة وانطلاق البيان والتفوق على الأقران وتعويد الثقة بالنفس ، فأولوها عناية كبرى في طرق تعليمهم وأشاروا إليها في مواضع عدة في مؤلفاتهم).
إيجابيات طريقة المناقشة :
1. تنمية ثقة الطالب بنفسه من خلال المشاركة الفعّالة في عملية التعلم والتعليم ، كما تنمي لديه القدرة على التفكير الناقد ، والقدرة على التعبير عن رأيه ومحاججة الآخرين والدفاع عن رأيه ، والقدرة على التواصل.
2. مما يميز طريقة المناقشة أنها تفعّل دول الطالب ليصبح أكثر إيجابية في عملية التعلم والتعليم .
3. يتعلم الطلبة من بعضهم خلال عملية النقاش .
4. تبصّر المعلم بخلفية الطلاب وحدود معرفتهم وسلوكاتهم .
5. تدرب الطلبة على احترام رأي الآخر والتراجع عن رأيهم إذا رأوا غيره أصح منه.
سلبيات طريقة المناقشة :
1. تحتاج لوقت طويل في عرض المادة .
2. طريقة المناقشة قد لا تكون مناسبة لكثير من المواقف التعليمية.
3. قد يسيطر بعض الطلبة على النقاش أو قد يسيطر المعلم على النقاش .
4. تحتاج لمهارة عالية من قبل المعلم لضبط الصف .
5. لا تصلح هذه الطريقة إذا كانت أعداد الطلبة كبيرة ، كما لا تصلح إذا كان مستوى الطلبة منخفضاَ .
إرشادات لتحسين طريقة المناقشة :
1. لا بد من تحديد هدف أو أهداف المناقشة واختيار محاورها وتقديمها بتسلسل منطقي.
2. الحرص على أن يدور النقاش حول الأهداف المرجوّة واستبعاد الأحاديث التي تخرجه عن مساره .
3. إعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلبة كي يشاركوا بالنقاش .
4. تقبل الآراء بصدر رحب حتى ولو كانت بسيطة أو ساذجة وتجنب الإساءة لأي طالب بالاستهزاء برأيه.
5. لا بد من تلخيص وتدوين ما تم الاتفاق عليه خلال عملية الحوار .
ثالثا: التعلم بالعمل والممارسة
في هذه الطريقة يكون دور المعلم هو تهيئة الظروف والبيئة المناسبة ليتمكن المتعلم من التفاعل مع الخبرة المطلوبة بالممارسة الحقيقية، فيتعلم الطالب من خلال ما يمارسه من تصرفات وما يواجهه من نتائج لتلك التصرفات . فهناك من الأهداف التربوية ما يكون على درجة عالية من الأهمية تستلزم من المتعلم أن يمارس بنفسه الخبرة ويخوض غمار التجربة حتى لو كلفه ذلك الكثير من الوقت والجهد وما قد ينتج عن ذلك من آلام .
فالمعركة بين الإنسان وإبليس قد استعد لها آدم وحواء عليهما السلام قبل أن ينزلا على الأرض ، فالمعركة صعبة وتحتاج إلى درس بليغ، لا بد أن يتعلموا خصائص عدوهم من كذب وخداع ليعرفوا كيف يتعاملون معه (وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (35) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (36) فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37)قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (38)) ( البقرة: 35- 38 ). أما قصة أصحاب الجنة فقد تعلم أبطالها أن السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة تستلزم السير على منهج الله والإنفاق في سبيله والرحمة بالمساكين، هي الطريق التي سار عليها أبوهم من قبل ، فلما تناسوا ذلك كان لا بد من أن يروا نتائج ذلك بأعينهم (إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ (22) فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23) أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ (24) وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (28) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ (30) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (31) عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ (32) كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (33)) (القلم: 17- 23)
أما الدروس التي تعلمها الصحابة الكرام بهذه الطريقة فهي كثيرة، من أهمها :
الدرس الذي تعلموه في غزوة أحد عندما نزل الرماة عن الجبل وعصوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم كانت نتيجة العصيان الدماء والأشلاء وما أبلغه من درس . كذلك درس حنين عندما تراءى لبعضهم أنهم يمكن أن ينتصروا بالكثرة فكانت الهزيمة لولا لطف الله بهم ، لقد تجسدت الآية الكريمة (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) ( الأنفال: 10 ) حقيقة ماثلة أمام أعينهم، وكذلك الدرس العظيم الذي تعلموه من حادثة الإفك ، وقصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك …. الخ .
إيجابيات التعليم بالعمل والممارسة
- تفعيل دور الطالب بصورة كبيرة، حيث يعمل تفكيره ويفعّل حواسه ويستنفر طاقاته .
- تنمية التفكير السليم والقدرة على حل المشكلات وابتكار الحلول واتخاذ القرارات. من خلال المراحل التي يمر بها في معالجة الموقف -التخطيط والتنفيذ والتقويم-.
- يتعلم الطالب معارف جديدة ومهارات إضافية، من جميع محاولاته التي يوظفها في معالجة الموقف، الصائبة منها والخاطئة.
- ثبات التعلم وعدم نسيانه، وانتقال أثره إلى مواقف جديدة.
- تنمية الجانب الإبداعي عند المتعلم.
- هذه الطرق مشوقة بذاتها، وتزيد من حماس الطالب للتعلم.
سلبيات التعليم بالعمل والممارسة
- تحتاج لوقت طويل في الإعداد والتنفيذ.
- يمكن أن تتسبب ببعض المخاطر على الطلاب.
- قد تكون مكلفة ماديا.
إرشادات لتجويد طريقة التعليم بالعمل والممارسة
- اختيار مهمات تتناسب مع قدرات الطلاب وإمكاناتهم.
- التخطيط الجيد وتنظيم سير العمل.
- الحرص الشديد على سلامة الطلاب واتخاذ الإجراءات الوقائية .
- محولة تفعيل جميع الطلاب في العمل، وذلك بتوزيع الأدوار عليهم.
- الإعداد المناسب وتجهيز المواد اللازمة للعمل.
ومن صور التعليم بالعمل والممارسة :
- أسلوب التجريب: حيث يتاح للطالب أو مجموعة الطلاب ليقوموا بالتعرف على الظاهرة موضع الدراسة وإحداث التغيرات التي يرونها مناسبة، للكشف عن الآثار المترتبة عليها، أو التثبت من سلامة القرارات والأحكام المتعلقة بها.
- أسلوب حل المشكلات: حيث يطرح المعلم على الطلاب مشكلة ما، ويكلفهم بصورة فردية أو جماعية بحلها، وقد يساعدهم على تنظيم عملهم بتوجيههم لاستخدام خطوات حل المشكلة، وتمكينهم من تجاوز العقبات التي قد تعترضهم وتحول دون معالجتهم للموقف.
رابعا: أسلوب التوجيه للتعلم الذاتي
التعلم الذاتي هو العملية التي يقوم فيها المتعلم ببذل جهوده الذاتية في اكتساب المعرفة والخبرة والمهارة من مصادرها المتعددة دون التزام بمعايير وضوابط الموقف الصفي الرسمي ولا تتم داخل الغرفة الصفية ( الخوالدة وعيد، 2003، ص262) .
وقد حث الإسلام على التعلم في كل وقت بل طلب الاستزادة الدائمة من العلم ( … وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا) ( طه: 114) بل إن “طلب العلم فريضة على كل مسلم” كما مرّ سابقا.
ويذكر( القرضاوي ، 2001، ص98) عدة أقوال لبعض علماء السلف رضي الله عنهم حول ديمومة طلب العلم ، نذكر منها:
- قال الإمام مالك بن أنس: ما ينبغي لأحد يكون عنده علم أن يترك التعلم .
- قيل لابن المبارك إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله.
- وقيل للمأمون أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ فقال: إن كان يعيبه الجهل، فالتعلم يحسن به.
إذا كان الأمر كذلك فهل يتطلب ذلك من المسلم أن يبقى طول حياته على مقعد الدراسة رغم متطلبات الحياة وظروف العمل … الخ ؟ من المؤكد أن المطلوب أن يتعلم المسلم بغض النظر عن كيفية التعلم أو المكان الذي يتعلم فيه ، والوضع الطبيعي أن يتعلم الإنسان في البيت ثم في المدرسة وقد يصل الأمر إلى الجامعة ثم ماذا ؟ لا بد أن يصل إلى مرحلة يكون التعلم فيها مستقلا ينهل من مصادر المعرفة وهي كثيرة الآن والوصول إليها متيسر، والمتعلم خلال تلك المرحلة لا بد له من توجيه المعلم فيتواصل مع العلماء والمعلمين يسترشد برأيهم ليصحح المسار ويزيل ما اعوج منه ، يذكر ( قمبر،1985، ص203-204) أن ابن سينا بعد أن أتم دراسته الأولية في محيط أسرته وعلى يد أساتذة خصوصيين استقل بشؤون تعليمه حتى وصل إلى أعلى مرتبة يمكن الوصول إليها ، يقول ابن سينا : ثم أخذت أقرأ على نفسي وأطالع الشروح حتى أحكمت علم المنطق ثم رغبت في علم الطب وقرأت الكتب المصنفة فيه وبرزت فيه في أقل مدة حتى بدأ فضلاء الأطباء يقرؤون علي علم الطب .
كذلك ابن حزم ظل يتلقى تربيته الأسرية مع نساء معلمات حتى سن السادسة عشرة ثم نهض بتعليم نفسه حتى فاق الكثير من العلماء الذين سبقوه أو عاصروه أو جاءوا بعده ، ولذا اتهموه حسدا من عند أنفسهم، بأنه صحفي اتخذ من الكتب شيوخا ولم يأخذ العلم الصحيح من أعلامه المشهورين .
ولقد ألف الزرنوجي كتابه الشهير ( تعليم المتعلم طريقة التعلم ) كدليل مرشد في مجالات وطرائق التعلم ، يقول الزرنوجي في مقدمة كتابه موضحا سبب تأليفه : “فلما رأيت كثيرا من طلاب العلم في زماننا يجدون إلى طلب العلم ولا يصلون إليه ، ومن منافعه وثمراته يحرمون، كما أنهم أخطأوا طريقه، وتركوا شرائطه، أردت وأحببت أن أبين لهم طريق العلم”. ( الزرنوجي،1985).
وهناك الكثير من طرائق التدريس التي لم ترتسم معالمها بصورة جلية في الأصول والتراث، لكن يمكن التعامل معها انطلاقا من فرضية البحث الأساسية، والمتعلقة بدور المعلم ودور الطالب، أي نحاول أن نعمق كلا من دور المعلم ودور الطالب في تلك الطرائق لتكون طريقة فاعلة –العلم ييسر التعلم، والطالب يقبل على التعلم- وقد تكون هذه الطرائق ذات حضور الآن في التربية الحديثة وهذا لا يمنع من التعامل معها، خصوصا إذا لم تتعارض مع مبادئنا التربوية، كما أن مجال البحث العلمي التجريبي سيكون له دور كبير في التأكد من مدى فعالية تلك الطرائق وقدرتها على تيسير التعلم على الطالب.
ومن أهم تلك الطرائق ما يأتي :
التعلم التعاوني
يقصد بالتعلم التعاوني أن يعمل الطلبة في مجموعات أو في أزواج لتحقيق أهداف التعلم، بمعنى أن تتعاون كل مجموعة معاً في تعلم خبرة رياضية أو اكتساب مهارة أو الإجابة عن سؤال . . . الخ حيث يسهم كل فرد في المجموعة بما يمتلكه من قدرات أو بما يحفظه من معلومات لتحقيق المطلوب من المجموعة .
والتعاون مبدأ أصيل في ديننا، وإذا كنا مطالبين بالتعاون في أمور الدين والدنيا، فإن التعلم والتعليم من أهم تلك الأمور، يقول سبحانه وتعالى (… وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) ( المائدة: 2)
وما يميز التعلم التعاوني أن أهداف الفرد تتآلف مع أهداف زملائه في الجماعة وتكون العلاقة بين تحقيق الفرد لأهدافه وتحقيق زملائه في الجماعة لأهدافهم علاقة إيجابية .
والعمل من خلال التعلم التعاوني يمكن أن يحقق الكثير من الأهداف المعرفية والوجدانية ، فيمكن أن يتعلم الطالب من زميله مثلما يتعلم من معلمه وربما أكثر في بعض الحالات ، فالطالب الضعيف قد يخجل من سؤال أستاذه لكن الأمر ليس كذلك مع زميله ، أي أن المتعلمين يستفيدون من بعضهم ، كما يحترم الطلاب آراء بعضهم البعض ويزيد اعتمادهم على أنفسهم وتحمل المسؤولية واحترام النظام والتعود على العمل الجماعي .
خصائص التعلم التعاوني :
- وجود هدف مشترك للمجموعة وتوزيع المهام على أفراد المجموعة فيعتمد كل فرد في المجموعة على نفسه وعلى أفراد مجموعته لتحقيق الهدف المطلوب ، فلا نجاح لأي فرد إلا إذا نجحوا جميعاً .
- التنافس في التعلم التعاوني يكون بين المجموعات .
- تنمية الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية والسمات القيادية وتطوير مهارات التواصل والعمل ضمن فريق والرغبة في التعاون .
- تطوير الحس بالمسؤولية تجاه الذات وتجاه المجموعة .
- تنمية التفكير الناقد والتقويم الذاتي حيث يفسح المجال للأفراد النظر بعين النقد لأدائهم في كل مرحلة من مراحله قبل أن يعرضوه على زملائهم أو معلمهم .
- يزيد التعلم التعاوني من دافعية الطلبة نحو التعلم كما يفعّل دورهم ، ويدوم التعلم في ذهن المتعلم لمدّة أطول.
على الرغم من إيجابيات التعلم التعاوني الكثيرة إلا أنه لا يصلح لبعض المواضع التعليمية، أو إذا كانت أعداد الطلبة في الصف كبيرة أو إذا كانت البيئة الصفية غير مهيأة ، كما أنه ربما يستغرق وقتاً للتنفيذ أكثر من غيره.
خطوات تنفيذ التعلم التعاوني :
- اختيار موضوع الدرس وتوضيح الأفكار الرئيسة للطلبة وتوضيح المهام المطلوبة من كل مجموعة وكيفية تنفيذ تلك المهام .
- تقسيم الطلبة إلى مجموعات صفية حسب طبيعة المهام التي سيقومون بتنفيذها ، ويفضل أن تكون المجموعات غير متجانسة ، لتكون الأدوار مكملة لبعضها البعض .
- إفساح المجال للمجموعات لتنفيذ ما هو مطلوب منهم وتحديد مدّة زمنية لذلك .
- بعد الانتهاء من تنفيذ المطلوب تعرض كل مجموعة عملها من خلال تقرير يقدم للمعلم أو من خلال العرض أمام الطلبة أو أي آلية أخرى ، ومن خلال هذه الخطوة يتحدد المجموعة المتميزة عن بقية المجموعات .
- يمكن أن يقوم المعلم بعملية التقويم الفردي للتأكد من أن كل طالب تحقق عنده الهدف أو الأهداف المطلوبة .
( ويظهر من خلال تلك الخطوات الأدوار التي يقوم بها المعلم، والأدوار التي يقوم بها الطلاب ).
إرشادات لتحسين طريقة التعلم التعاوني :
- يفضل أن يكون عدد الطلبة في المجموعة 4 – 5 أفراد ، ولكن ذلك مرهون بطبيعة المهمة التي ستوكل للمجموعة فقد يكون عدد الطلبة في المجموعة اثنين فقط وقد يصل إلى سبعة أفراد .
- يتجول المعلم بين المجموعات خلال تنفيذ المهام ويجلس معها بعض الوقت لتفعيل الأداء والتأكد من سيرهم بصورة صحيحة ، كما يحث الطلبة السلبيين على التفاعل الإيجابي مع أفراد المجموعة .
- توزيع المهام على أفراد المجموعة بحيث يكون أحدهم قائدا للمجموعة .
- يفضل أن يتفق المعلم مع طلبته على تشكيل المجموعات ليتعرف كل طالب على أفراد مجموعته ، كما يفضل أن تكون هذه المجموعات غير متجانسة ، ويتم تبديل الأفراد وإعادة توزيعهم على المجموعات بين الحين والآخر وليكن كل شهر مرّة أو على الأكثر كل فصل مرّة .
- يؤكد المعلم خلال العمل التعاوني على الجوانب الاجتماعية والتعاون واحترام آراء الآخرين وإثارة جو من الود والألفة ، كما يشجع الطلبة المميزين على مساعدة زملائهم ليصلوا لمستوى جيد من تحقيق الأهداف .
- على المعلم أن يختار مواقف مناسبة يمكن تقديمها بأسلوب العمل التعاوني فليس كل موقف تعليمي يصلح أن يقدم بهذا الأسلوب كما عليه أن يحدد الأهداف التي يريد تنفيذها مع طلبته بدقة وأن يعد لحصته بشكل جيد حيث يتأكد من توفير الأدوات اللازمة لكل مجموعة .
- ليس شرطاً ان يستغرق تنفيذ الموقف التعليمي بالأسلوب التعاوني جميع الحصة فقد يستغرق جزءاً منها .
ب. التعلم بالاكتشاف ( الاستقراء والاستنتاج )
ويعرف (أبو زينة ، 2003، ص142) التعلم بالاكتشاف بأنه “أسلوب في التعلم يمكن أن يصف أي موقف تعلمي يمر فيه المتعلم ، ويكون فيه فاعلاً نشطاً ويتمكن من إجراء بعض العمليات التي تقوده للوصول إلى مفهوم أو تعميم أو علاقة أو حل مطلوب ، ويتلقى المتعلم توجيهاً وإشرافاً مقيداً وبالقدر اليسير من قبل المعلم أو الكتاب” .
ومن أفضل المواقف التي يحدث فيها تعلم اكتشافي، هي تلك التي يستخدم فيها المتعلم استراتيجيات التعلم الاستقرائية أو الاستنتاجية ، ففي الاستقراء يمكن أن يقدم المعلم أو الكتاب عدداً من الحالات الخاصة التي تقود الطالب إلى تعميم ما، حيث يطلب من الطلبة استقراء تلك الحالات والوصول إلى التعميم، ويتخلل ذلك نوع من التوجيه والإرشاد من قبل المعلم .
أما الاستنتاج فيقدم المعلم للطلاب الحقائق الكلية، أو التعميمات المطلوبة، ويطلب من الطلاب توظيف تلك التعميمات للوصول إلى حالات خاصة تتحقق فيها تلك التعميمات .
ويمكن أن يحدث التعلم بالاكتشاف أثناء العرض المباشر للدرس وفي المناقشات الجماعية شريطة أن يفسح المعلم المجال للطلبة أن ينفذوا الأنشطة التي خطط لها بأنفسهم ولا يتدخل إلى في الحالات التي تستدعي ذلك ، وقد يكون التعلم بالاكتشاف فردياً عندما تتاح الفرصة لكل متعلم لأن يعمل وحيداً، وقد يكون ضمن مجموعات وذلك عندما يعمل المتعلم بالتعاون مع مجموعة صغيرة من زملائه .
إيجابيات التعلم بالإكتشاف :
يذكر (أبو زينة ، 2003) بعض الأهداف التي يجنيها المتعلم من الاكتشاف وهي :
- تزيد القدرة العقلية الإجمالية للمتعلم فيصبح قادراً على النقد والتوقع والتصنيف ورؤية العلاقات والتمييز بين المعلومات ذات الصلة والمعلومات أو المعطيات التي لا تمت بصلة للموقف التعليمي .
- تكسب الطلبة القدرة على استعمال أساليب البحث والاكتشاف وحل المسائل وبالتالي تؤثر تأثيراً إيجابياً على نواحي أخرى من حياته وذلك من خلال التدريب الذي يحصل عليه المتعلم بمروره في خبرات الاكتشاف.
- تزيد من قدرة الفرد على تذكر المعلومات وإبقاء التعلم ودوامه لفترة طويلة وذلك من خلال المعنى والفهم والاستيعاب لهذه المعلومات الناتج عن التعلم بطريقة الاكتشاف.
- هذه الطريقة مشوقة بحد ذاتها وحافزة للطلبة أن يستمروا في التعلم بشغف نتيجة للحماس الذي يعيشونه أثناء البحث والمتعة التي يحصلون عليها عند حدوث الاكتشاف، أي أن هذه الطريقة تزود الطلبة بحافز داخلي يختلف عن الحوافز التقليدية التي نقدم للطالب من وقت لآخر.
سلبيات التعلم بالاكتشاف
لقد أورد (جابر ، 1999) في أن المدرسين كثيراً ما يترددون في استخدام هذا الأسلوب للأسباب التالية:
- نقص خبرتهم بهذا الأسلوب وعدم تمكنهم أدائه .
- ما يتعرضون له من ضغط لتدريس جميع موضوعات المنهج وتغطيتها خلال السنة الدراسية .
- الصعوبات التي يواجهها التلاميذ خصوصاً ضعاف التحصيل .
- إن كثيراً من الفوائد المتوقعة للتعلم بالاكتشاف لا تظهر في اختبارات التحصيل العادية .
إرشادات لتحسين فعالية التعلم بالاكتشاف
هناك مجموعة من الإرشادات والأنشطة التي يمكن تضمينها في دروس الاكتشاف في العرض المباشر أو الأنشطة العملية نذكر منها :
- يجب أن يبدأ درس الاكتشاف بمعلومات معروفة ويتقدم خطوة خطوة إلى المعلومة الجديدة .
- يجب أن يتأكد المعلم من مدى امتلاك الطلبة للمفاهيم والمبادئ المتطلبة لعمل استكشاف استقرائي أو استنتاجي متوقع .
- من المهم مراعاة التوقيت المناسب لتدخل المعلم ودرجة التدخل .
- من الصعب اكتشاف التعاريف والمسلمات والرموز ، والدروس التي تصمم لاكتشافها ما هي إلا لعبة عن (خمن فيما أفكر) .
- تفيد النماذج المفاهيمية والنماذج الفيزيقية والألعاب والأدوات في تيسير الاكتشاف .
- من الممكن أن تكون استراتيجيات الاكتشاف استهلاكية للوقت ومحبطة للطلاب وذلك إذا أسيء استخدامها أو أفرط فيه .
- في كثير من الأحيان يكون العمل في مجموعة وليس العمل الفردي أفضل في الوصول إلى الاكتشاف وذلك لأن الجماعة تمد بوفرة من الأفكار وأوجه النقد ، ومع ذلك فإنه لا بد من تشجيع وإثابة الأفراد الذين يسهمون بأفكارهم ومعلوماتهم المثمرة في المناقشات والوصول إلى أفكار واكتشافات جديدة .
وسنكتفي بهذا العدد من طرائق التدريس ويمكن التعامل مع أية طريقة تدريس أخرى ضمن نطاق تفعيل دور المعلم ودور الطالب وإخضاعها للبحث العلمي للتأكد من فعاليتها .
كلمة أخيرة
من الضرورة بمكان أن يدرك المعلم أنه لا توجد طريقة واحدة مثلى في التدريس تقابل جميع الظروف والشروط التعليمية المحيطة ، فقد يستعمل المعلم طريقة واحدة لتحقيق عدّة أهداف ، وقد يستخدم عدّة طرائق لتحقيق هدف واحد، وقد تتداخل هذه الطرائق بحيث يستخدم المعلم طريقة الاكتشاف ولكن يفسح المجال للطلاب للعمل في مجموعات حسب التعلم التعاوني، ولكن متى وكيف و لماذا سيختار المعلم طريقة دون أخرى ؟؟ .
بعض العوامل المؤثرة باختيار طريقة التدريس المناسبة :
- الهدف التعليمي التعلمي : اختلاف الأهداف يؤدي لاختلاف طرائق التدريس المناسبة لتقديمها ، فهناك أهداف نظرية وأخرى عملية ، هناك أهداف قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى وهناك أهداف معرفية و أخرى وجدانية وثالثة مهارية ، والأهداف المعرفية تختلف بمستوياتها.
- المادة التعليمية : المفاهيم والتعميمات والمهارات، تعتبر من العناصر الأساسية للمواد الدراسية، ولكل واحدة منها الطريقة الناسبة لتقديمها للطلاب، بل إن اختيار الاسلوب المناسبة لتدريس المفهوم قد تختلف من مفهوم لآخر وكذلك الحال بالنسبة لبقية العناصر .
- الفرد المتعلم : طرائق التدريس الناسبة للصغار قد تختلف عما يناسب الكبار ، وقد تختلف إذا كان الطالب متفوقاً أو متوسطاً أو ضعيفاً . وهل مجموعة الطلاب متجانسون أم غير متجانسين ، مندفعون للتعلم أو غير مندفعين ، كل ذلك يؤدى لاختلاف طريقة التدريس المناسبة .
- حجم الصف : هناك طرائق تدريسية يمكن تنفيذها في الصفوف الكبيرة وأخرى يناسبها الصفوف الصغيرة ويصعب استخدامها إذا كانت أعداد الطلبة كبيرة .
- خبرة المعلم : يميل المعلم عادة لاختيار طريقة التدريس التي يشعر بأنه أكثر فاعلية في استخدامها أو أكثر ألفة بها ، ويتقن أداء خطواتها ويدرك سلبياتها وإيجابياتها ، ومن غير المناسب أن يختار المعلم طريقة تدريس إذا لم تكن معرفته و خبرته كافية لتنفيذها، من ذلك يتبين أهمية إتقان المعلم لعدد كبير من طرائق التدريس ليمتلك القدرة على الاختيار .
- إمكانات المدرسة وميزانيتها : تصنف بعض طرائق التدريس بأنها اقتصادية قليلة التكاليف وطرائق أخرى تحتاج لنفقات أكثر ، كما أن بعض طرائق التدريس تحتاج لتوفير بعض الأدوات قد لا تكون متوفرة في المدرسة .
المحور الثالث: تصنيف طرائق التدريس
في هذا الفصل سيتم الحديث حول تنوع طرائق التدريس بتنوع بعض المتغيرات مثل نوع الهدف، والمؤسسة التعليمية، والجنس والعمر…الخ، لكن الإشارات الواردة في الأصول التربوية والتراث الإسلامي الدالة على التنوع محدودة وقد لا تكون صريحة، ولكن من خلال نظرة كلية لطرائق التدريس الأصيلة يمكن الوصول للاختلافات التالية:
أولا: اختلاف طرائق التدريس باختلاف الهدف المنوي تحقيقه.
الأهداف التربوية التعليمية، قد تصنف إلى أهداف معرفية متعلقة بالجانب العقلي، وأهداف وجدانية، متعلقة بالجانب الشعوري أو القلبي أو العاطفي، وأهداف مهارية تشترك أجهزة الجسم وأطرافه وعضلاته في إنجازها، وطرائق التدريس تختلف باختلاف نوع الهدف، فالأهداف المعرفية، والمتعلقة بالجهد العقلي والذهني، مثل التعرف على الشيء أو فهمه أو تحليله أو تطبيقه …الخ، هذه الأهداف يناسبها طرائق التدريس المعتمدة على الحوار والنقاش، والتجريب وحل المشكلات، كما يناسبها الاستقراء والاستنتاج، وإذا كانت أهدافا بسيطة يمكن تعلمها بطريقة المحاضرة. أما الأهداف الشعورية القلبية، فيناسبها أسلوب التعلم بالملاحظة والقدوة، كما يناسبها أسلوب الوعظ والإرشاد بالترغيب والترهيب، كما يناسبها الأسلوب الخطابي ، وقد توظف طرائق الحوار والنقاش في بعض المراحل في تحقيق تلك الأهداف، وإذا كان الهدف مهاريا، فأنسب الطرائق تلك التي تعتمد على ملاحظة الطالب للمعلم (العروض العملية)، وبعد ذلك يكون التعلم بالممارسة والعمل حتى يصقل المتعلم مهارته.
فالمعلم الذي يريد أن يعلم طلابه بعض أحكام التلاوة النظرية، قد يستخدم أسلوب المحاضرة، أو التعلم الذاتي، وقد يستخدم الاستقراء والاستنتاج، أما إذا كان الهدف يتعلق بحب التعلم للتلاوة الصحيحة والإقبال عليها، فأسلوب الوعظ مناسب، وقبل ذلك مشاهدة النماذج الإيجابية لملاحظتها والرغبة بتقليدها، وهذا يؤدي إلى قناعة قلبية، ويمكن للمعلم أن يقنع طلابه عقليا باستخدام الحوار والنقاش، وإذا كان الهدف أن يتقن الطالب التلاوة أداء، فلا فائدة من استخدام المحاضرة مثلا (الأساليب النظرية)، فهذا يتطلب من المعلم أن يقدم نموذجا للتلاوة الصحيحة على مسمع الطالب، ويوضح له معالم تلك التلاوة، ثم يكلفه بتقليدها وخلال ذلك يتابع المعلم أداء الطالب للتأكد من صحة الأداء، ويصحح له ويرشده إذا أخطأ.
ثانيا: اختلاف الطرائق باختلاف المؤسسة التعليمية
المؤسسات التي يتعلم فيها المتعلم في أيامنا هذه، هي –على الأغلب- البيت والمدرسة والمسجد والجامعة، كما أن الإنسان من الممكن أن يتعلم من مصادر أخرى مثل الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية، والمراكز العلمية والثقافية …الخ.
والحديث هنا سيقتصر على البيت والمدرسة والمسجد والجامعة، وتختلف هذه المؤسسات عن بعضها باختلاف الأهداف التعليمية لكل منها، والإمكانات المتوفرة فيها وطبيعة الجمهور المتعلم، ولذلك تختلف طرائق التدريس في كل منها، ففي البيت يحرص الوالدان –في الغالب- على تعليم أولادهم الآداب والأخلاق والمعارف المتعلقة بحياتهم ومجتمعهم وثقافتهم … الخ، كما أن إمكانات البيوت متفاوتة، لكن يمكن للوالدين حتى يحققوا أهدافهم مع أبنائهم عندما يكونوا قدوة صالحة –التعلم بالملاحظة- في مجال الأخلاق والقيم والاتجاهات وطريقة التفكير …الخ، ويمكن أن يستخدموا الأساليب المباشر في التعليم وقد يكثروا من الوعظ والإرشاد، كما يستخدم الوالدان أسلوب الحوار مع الأبناء، والممارسة العملية في تحقيق بعض الأهداف، ومن المؤكد أن تلك الطرائق لا بد أن تتناسب مع عمر الأولاد ومستوى تفكيرهم.
أما في المدرسة فيمكن أن يمارس المعلم جميع الأساليب ولكن يتخير منها المناسب للطالب وللهدف وللبيئة .. الخ، والجامعة كذلك مع اختلاف في حجم العمل الموكل للطالب في عملية التعلم، فكلما كبر الطالب في العمر، يطلب منه أن يكون فاعلا أكثر، ولذلك يفضل أن يكثر المعلم من استخدام أسلوب الاكتشاف وحل المشكلات والاستقصاء، كما يكثر من أسلوب الحوار والنقاش، وفي كثير من الأحيان يستخدم الأستاذ الجامعي مع تلك الأساليب، أسلوب المحاضرة حتى يتمكن من تقديم جميع المادة العلمية في المدة الزمنية المحددة. لأن المحاضرة تمكنه من ذلك.
المساجد في عصرنا الحالي تخلوا من الحلقات والدروس –في الغالب- كما كان الحال قديما، وهي تختلف عن المدارس والجامعات لأن الجمهور على درجة عالية من التباين، فمنه المتعلم والجاهل، ومنهم الصغير والكبير والمقبل بحماس والمتثاقل… الخ، كما أن الوقت والمقام لا يتسعان للتعامل مع الجمهور كما يتعامل مع المتعلمين في المدارس والجامعات، لذلك فقد تكون الخطبة هي أنسب أسلوب، ولكن لا بد للخطيب أن يبذل جهدا كبيرا لجذب انتباه الحاضرين، فينوع في أدائه الصوتي، ويستخدم الأمثال والقصص ….الخ.
ثالثا: اختلاف الطرائق باختلاف الجنس والعمر والمستوى التحصيلي للمتعلم
لا يوجد ما يؤكد وجود فروق في القدرات العقلية بين الذكور والإناث، ولذلك لا تختلف طرائق التدريس باختلاف جنس المتعلم، فالطرق المناسبة للذكور مناسبة كذلك للإناث، إلا إذا كانت الأهداف وجدانية، فيمكن أن تكون الطرائق التي تعتمد على العقل أكثر مناسبة للذكور، والطرائق المعتمدة على العاطفة أكثر تناسب الإناث، فعند الذكور قد نزيد من جرعة الحوار العقلي، مع جرعة من الوعظ والإرشاد طبعا، أما عند الإناث فقد نزيد من جرعة الوعظ والإرشاد على حساب الحوار والنقاش، واختلاف جنس الطالب يؤدي إلى اختلاف في طرائق إثارة الدافعية وأساليب التعزيز فما يثير دافعية الذكور قد لا يثير دافعية الإناث والعكس، وما يعتبره الذكور معززات قيمة، قد لا يكون كذلك عند الإناث، كما يختلف أسلوب العقاب.
أما بالنسبة للعمر فالأساليب التي تناسب الصغار قد لا تناسب الكبار، فالصغار تناسبهم، الأساليب التي تعتمد على الملاحظة وكذلك التعلم بالعمل، كما يجب على المعلم الإكثار من استخدام الوسائل التعليمية مع الصغار، وإذا استخدم المعلم أسلوب العرض المباشر مع الصغار، لا بد من تبسيط الأمر عليهم وزيادة الشرح والتوضيح واستخدام الكلمات المألوفة لهم، ويمكن استخدام الحوار مع الصغار شريطة أن يكون مبسطا، بالإضافة لكل ذلك يجب على معلم الصغار أن يتودد لهم وأن يتعامل معهم بأساليبهم الصبيانية وألعابهم المحببة لهم، وقد أورد علماء الحديث نصوصا كثيرة في كتبهم تحت عنوان: (استحباب التصابي مع الولد وملاعبته) (الصغير،1429هـ، ص57)، ولا بد من زيادة جرعات الترويح واللعب خلال عملية تعليم الصبيان لأنهم يملون بسرعة ويتشتت انتباههم بصورة متكررة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفّ عبد الله وعبيد الله وكثيرا من بني العباس ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا، قال: فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلزمهم.(رواه أحمد). وبين (النعمي، 1980، ص75) أن ابن خلدون اختار عدة طرائق للتعليم في المراحل الأولية منها: التلقين والمحاكاة والتجربة والوسائل التعليمية الحسية والتكرار، أما في المراحل ما بعد الأولية فيفضل ابن خلدون استخدام أسلوب المناقشة الحوار وكذلك الرحلة في طلب العلم والكتب الدراسية.
أما الكبار فأي أسلوب يكون مناسبا لهم لقدراتهم العقلية المتقدمة، ولكن يتم التركيز على الطرائق التي تفعل دورهم، ويكون الاعتبار في اختيار أسلوب التدريس للهدف والمحتوى والإمكانات …الخ، وليس لعمر الطالب.
والطلبة المتميزون في تحصيلهم يمكن للمعلم أن يستخدم معهم الأساليب التي تفعل دورهم أكثر مثل الحوار وحل المشكلات والاكتشاف إلى غير ذلك، كما يمكن أن يوجههم المعلم للتعلم الذاتي ويدلهم على مصادر المعرفة المناسبة، أما الطلبة ضعاف التحصيل، فلا بد للمعلم أن يبدأ معهم بأساليب العرض المباشر ثم ينتقل بهم تدريجيا للأساليب التي تفعل دورهم، مع الانتباه لسرعة الأداء فيبدأ معهم المعلم ببطء ثم يسرع شيئا فشيئا، وكذلك لا بد من زيادة الشرح والتوضيح وعدد الأمثلة واستخدام الوسائل التعليمية، فلو استخدم المعلم أسلوب الحوار مع الطالب الضعيف، فلن يكون الحوار فاعلا، وإذا كلفه بحل مشكلة أو اكتشاف حقيقة، فلن يتفاعل معها أو يحلها، بل قد تسبب له الإحباط والملل.
المبحث الرابع: مبادئ التعلم والتعليم الأصيلة
سيبحث هذا المحور بالمبادئ المستخلصة من الأصول والتراث الإسلامي، والتي تيسر التعلم على الطلبة، بحيث لو فعّلت خلال عملية التعليم تجعل التعلم أيسر وأمتع، مع توفير الكثير من الجهد والوقت على المعلم والطلاب، ومن هذه المبادئ:
أولا: الفروق الفردية
السمات الشخصية والعقلية الموجودة عند المتعلمين، لا تتوفر لديهم بدرجات متساوية بل إنهم متفاوتون في درجة امتلاكهم لتلك السمات، والإسلام قد أقر بالفروق الفردية بين المتعلمين، فلكل فرد قدراته واستعداداته وطاقاته وخصائصه التي تميزه عن الآخرين، وبناء على ذلك يتحدد حجم التكليف، قال تعالى
(… لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ …(( البقرة: 286) كما أن الحكمة واضحة من وجود هذه الفروق فقال: ( أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ) (الزخرف: 32) فبدون هذه الفروق يكون الفرد في خدمة الآخرين، ولن يكون الآخرون في خدمة الفرد، وحكمة أخرى ذكرت بقوله سبحانه وتعالى (… وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ …) (الأنعام: 165 ) بل إن التكاليف الشرعية قائمة على الاستطاعة (… فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ …) (التغابن: 16)
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “ما أحد يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم” [16]. فالمسألة التي تبلغها بعض العقول قد لا تبلغها عقول أخرى، وقد ورد في الأثر عن علي كرم الله وجهه قال : “حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله”( جان،1998،ص256)
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد المراعاة للفروق الفردية بين المتعلمين من المخاطبين والسائلين “فكان يخاطب كل واحد بقدر فهمه وبما يلائم منزلته ، وكان يحافظ على قلوب المبتدئين فكان لا يعلمهم ما يعلم المنتهين ، وكان يجيب كل سائل عن سؤاله بما يهمه ويناسب حاله” (أبوغدة ،1996،ص81) .
عن عبد الله بن عمرو ابن العاص قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال : يا رسول الله ، أقبل وأنا صائم ؟ قال : لا ، فجاء شيخ فقال : أقبل وأنا صائم ؟ قال : نعم ، فنظر بعضنا إلى بعض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض إن الشيخ يملك نفسه[17] .
يقول ابن سينا كما ورد سابقا: “ليس كل صناعة يرومها الصبي ممكنة له مواتية ولكن ما شاكل طبعه وناسبه”.
وقد أشار الماوردي إلى موضوع الفروق الفردية بقوله “وينبغي أن يكون للعالم فراسة يتوسم بها المتعلم ليعرف مبلغ طاقته وقدر استحقاقه ليعطيه ما يتحمله بذكائه أو يضعف عنه ببلادته، فإنه أروح للعالم وأنجح للمتعلم” ويضيف “وإذا كان العالم في توسم المتعلمين بهذه الصفة وكان بقدر استحقاقهم خبيرا، لم يضع له عناء ولم يخب على يديه صاحب وإن لم يتوسم وخفيت عليه أحوالهم ومبلغ استحقاقهم ، كانوا وإياه في عناء مكد وتعب غير مجد لأنه لا يعدم أن يكون فيهم ذكي محتاج إلى زيادة وبليد يكتفي بالقليل فيضجر الذكي منه ويعجز البليد عنه ومن يردد أصحابه بين عجز وضجر ملوه وملهم”.(الماوردي، د.ت، ص89-90).
ويمكن أن يراعي المعلم الفروق الفردية من خلال مجالات كثيرة منها:
- اختيار المحتوى المناسب من حيث الكم والنوع.
- سرعة الأداء في تقديم المادة العلمية.
- استخدام الوسائل التعليمية المناسبة.
- التنويع بطرائق التدريس، ويمكن استخدام أكثر من طريقة لتقديم الهدف الواحد.
- تنويع الأمثلة التوضيحية المستخدمة، والتدرج بها من حيث درجة الصعوبة.
- اختيار الأسلوب المناسب لإثارة الدافعية، وما يناسب كل طالب من الثواب والعقاب.
- استخدام أسلوب التعليم الفردي، والحث على التعلم الذاتي ما أمكن.
ثانيا: الدافعية للتعلم
ويعرف الماوردي الدافع للتعلم: بأنه الباعث على طلب العلم رغبة أو رهبة، ويرى أنه ضروري للتعلم الفعال حيث يقول: “واعلم أن لكل مطلوب باعثا، والباعث على المطلوب شيئان رغبة ورهبة، فليكن طالب العلم راغبا راهبا، أما الرغبة ففي ثواب الله تعالى لطالبي مرضاته وحافظي مفترضاته، وأما الرهبة فمن عقاب الله تعالى لتاركي أوامره ومهملي زواجره، فإذا اجتمعت الرغبة والرهبة أدتا إلى كنه التعلم”(التل، 2005، ص149).
يقسم ابن خلدون الدافعية إلى نوعين: الأول دافعية داخلية تنشأ من التعلم السابق أو حصول الملكات للنفس، والثاني دافعية خارجية تنشأ عن كيفية التعليم والتأديب ، الدافعية الأولى تتحدد قوة وضعفا بجودة الملكات الحاصلة ، فإذا كانت الملكة قوية أو تامة زاد نشاط النفس لتحصيل ما بقي من العلم، أما إذا كانت الملكة ضعيفة أو ناقصة هبط وفتر أو ربما أنفقت نشاط النفس وهمتها للتحصيل . أما الدافعية الخارجية فتتحدد قوة وضعفا أيضا بحسن التأديب وجودة التعليم، فإذا كان التأديب برفق من غير شدة أو مساهلة، علت همة النفس في التحصيل وزاد نشاطها . ويعتبر أن الشدة في تأديب المتعلم تتسبب في قهر النفس وإذلالها وانقباضها عن السعي لتحقيق وجودها، أما المساهلة في التأديب فتتسبب في ألفة المتعلم للكسل وفي تراخي النفس فتقعد عن بلوغ غايتها. (الحسين،1979،ص79 )
ويؤكد ابن خلدون أنه إذا كان التعليم متدرجا بحسب استعداد المتعلم وطاقته، يخلو في مادته من الغموض والتعقيد، اندفعت النفس إلى التعلم وسعت بنشاط إليه، أما إذا كان التعلم غير متدرج، عويصا في مادته انقبضت النفس عن التعلم وفتر نشاطها. (الحسين،1979،ص79-80 )
وترى (التل،2005، 219) أن الخطوة الأولى في دفع المتعلم للتعلم تكون باستثارة انتباهه لما سيتعلمه ويحصله من معرفة عن طريق الإنصات والاستماع يقول تعالى (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) ( الأعراف: 204 ) ويقول (إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ) (ق: 37 )
عن بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع “يا بلال أسكت الناس أو أنصت الناس، ثم قال إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا باسم الله”[18]
كما أوصى عبد الله بن مسعود أن يحدث المعلم المتعلمين ما داموا يحدقون بأبصارهم فإذا غضوا فعلى المعلم أن يتوقف دفعا للملل والسآمة ( ابن عبد البر،1968)
وتشير (التل، 2005، ص221-226 ) أن الإسلام أثار الدافعية للتعلم بأساليب مختلفة منها :
- استثارة الدافعية بالترغيب والترهيب ( من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة).[19]
- استثارة الدافعية بالقصص القرآني والنبوي (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (يوسف:111).
- استثارة الدافعية بالاستفادة من الحوادث الجارية والهامة ( مثل غزوة حنين )
- استثارة الدافعية بضرب المثل (فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ (50) فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ) (المدثر:49 – 51)
- استثارة الدافعية بوسائل الاتصال غير اللفظية “ن اوكافل اليتيم في الجنة كهاتين أ أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ) وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا”[20] .
لقد ذكرت ( حسن، 2000، ص14) عدة عوامل تسهم في تحقيق التشويق للتعلم منها:
- الترفق بالمتعلمين وتسهيل أمورهم. لقول النبي في الحديث الذي مر سابقا: إنما بعثت معلما ميسرا.
- أن تكون بين العالم والمتعلم صلات حسنة.
- أن يعمل المعلم على بعث الرجاء في نفس المتعلم وطرد اليأس من نفسه .
ثالثا: الوسائل التعليمية
استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم الوسائل التعليمية المتنوعة المتاحة في عهده لتجسيد المعاني المجردة، وتيسير فهمها وتثبيت الاحتفاظ بها، وبالتالي تحقيق الأهداف من الموقف التعليمي بأفضل صورة.
الحواس مفاتيح العقل وهي الطرق الموصلة إليه، وكلما زاد عدد الحواس المستخدمة في التعلم كلما كان التعلم أسهل وأكثر وضوحا وجلاء في النفس من جهة، وأبقى أثرا في الذهن من جهة أخرى ( جان ، 1998،ص229-230)، وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطلب من ربنا أن يريه كيف يحيي الله الموتى (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) ( البقرة: 260) فليس الخبر كالمعاينة. إن أفضل أنواع التعلم هو الذي يتم باشتراك الفرد بنفسه في العملية التعليمية ( جان، 1998، ص232) فالتعلم بالخبرة المباشرة خير من الحديث عن الشيء ووصفه، فالأفضل للمعلم إحضار الشيء إلى الغرفة الصفية إذا استطاع ذلك فعن علي كرم الله وجهه قال: “أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال : إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم” [21]
وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: “قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: قل ربي الله ثم استقم، قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا” [22]
وإذا لم يستطع المعلم إحضار الشيء نفسه لغرفة الصف، لصعوبة ذلك أو لخطورته، أو غير ذلك، فقد يلجأ للمجسمات المعبرة عن الشيء المراد تعليمه أو صور ورسومات له، والبرامج الحاسوبية في حاضرنا تقوم بهذا الدور على أكمل وجه .
لقد استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم العديد من الوسائل التعليمية المتاحة ومن الأمثلة على ذلك : استخدامه لأصابعه الشريفة فقال: “أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه: السبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا”[23]
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: “الشهر هكذا وهكذا وهكذا ( ثم عقد إبهامه في الثالثة ) فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ، فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين”[24] وعن بريدة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: “هل تدرون ما هذه وهذه ؟ ورمى بحصاتين . قالوا : الله ورسوله اعلم ، قال : هذاك الأمل وهذاك الأجل”[25]
عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم “غرز بين يديه غرزا ، ثم غرز إلى جنبه آخر ، ثم غرز الثالث فأبعده ثم قال: هل تدرون ما هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال: هذا الإنسان وهذا أجله وهذا أمله، يتعاطى الأمل، والأجل يختلجه دون ذلك”[26]
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: “خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا -وفي رواية في فتح الباري خطوطا- صغارا إلى هذا الذي في الوسط إلى جانبه الذي في الوسط فقال : هذا الإنسان وهذا أجله محيط به –أو قد أحاط به- وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض ، فإن أخطأه هذا نهشه هذا ، وإن أخطأه هذا نهشه هذا”[27]
بالإضافة إلى ذلك فإن كل الذي ورد في العروض العملية هو من باب الوسائل التعليمية فالغراب الذي تعلم منه ابن آدم دفن أخيه هو وسيلة تعليمية . وقد عرض الرسول أمام الصحابة الكرام كيفية الصلاة والوضوء والحج أداء، فالأداء الجسدي وسيلة تعليمية .
عن عمر بن الخطاب قال : “قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها، تسعى إذ وجدت صبيا لها في السبي، أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها”[28] نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثمر هذا المشهد الحي ليثبّت فكرة عند صحابته الكرام وهي رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وبما أن المشهد مؤثر جدا، والفكرة قدمت والمشاعر متأججة، فالتعلم سيكون أبلغ أثرا وأعمق فهما، وأدوم تذكرا.
ومشهد آخر مشابه في الأسلوب، عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم “مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه فمر بجدي ميت أسك فتناوله فاخذ بأذنه ثم قال : أيكم يحب أن يكون هذا له برهم ؟ قالوا : ما نحب انه لنا بشيء وما نصنع به ، قال : أتحبون أن هذا لكم ، قالوا : والله لو كان حيا كان هذا السكك عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت فقال : فو الله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم”[29].
وكما أن الوسائل التعليمية تستخدم لتجسيد المعاني المجردة، وتوضيحها بالمحسوس أو شبه المحسوس فإن القرآن الكريم والرسول العظيم صلى الله عليه وسلم قد استخدما وسيلة تؤدي نفس الغرض وهي ضرب الأمثال، فما من شك أن ضرب الأمثال يجسد المعاني بتصويرها بأمور مادية محسوسة تقرب المعاني المجردة وتسهل على المتعلم إدراكها وفهمها. بل إن ضرب الأمثال يؤدي أدوارا أبعد من ذلك، يقول الماوردي: “وللأمثال من الكلام موقع في الأسماع، وتأثير في القلوب، لا يكاد الكلام المرسل يبلغ مبلغها، ولا يؤثر تأثيرها، لأن المعاني بها لائحة، والشواهد بها واضحة، والنفوس بها عالقة، والقلوب بها واثقة، والعقول لها موافقة”.( الماوردي، 1955، ص259) يقول الله سبحانه وتعالى: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24)تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ (26)) ( إبراهيم:24-26) نلاحظ ان الله سبحانه وتعالى قد شبه الكلمة الطيبة وهي مفهوم معنوي بالشجرة الطيبة وهي كيان محسوس مألوف للمستمع ليسهل عليه فهم المعنوي وكذلك الكلمة الخبيثة مثل الشجرة الخبيثة، ويقول: (أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ) ( الرعد: 17) الحق والباطل مفهومان مجردان تم تجسيدهما بما هو مألوف ومحسوس. والقرآن مليء بالأمثال والتشبيهات، أما في السنة فالوضع مشابه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم “المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر”[30] والتشبيه هنا واضح.
وقد حدد الماوردي شروطا لضرب الأمثال في التعليم هي: صحة التشبيه، وأن يكون العلم بها سابقا والكل بها موافقا، وأن يسرع وصولها للفهم ويعجل تصورها في الوهم، من غير ارتياب في استخراجها، ولا كدّ في استنباطها، وأن تناسب حال السامع لتكون أبلغ تأثيرا وأحسن موقعا. فإذا اجتمعت في الأمثال المضروبة هذه الشروط الأربعة، كانت زينة للكلام، وجلاء للمعاني، وتدبرا للأفهام. ( الماوردي، 1955، ص259-260).
رابعا: الثواب والعقاب
النفس البشرية مجبولة على الرغبة في الثناء والمكافأة، وعلى الخوف من العقاب والحساب، والثواب من أقوى الدوافع للإنجاز وزيادة معدل التعلم، وهو من أفضل الوسائل التربوية في إشباع حاجة المتعلم إلى الحب والتقدير والثناء والقبول الاجتماعي، لذلك فالسلوك الذي يكون متبوعا بالمكافأة يقوى ويتدعم، ويكون أكثر ميلا للتكرار مستقبلا، ويضعف السلوك الذي تتم معاقبته ويقل احتمال تكراره مستقبلا.
وقد أكد علماء المسلمين على أهمية الثواب والعقاب في تعلم سلوكات جديدة وفي تعديل السلوك الراهن وتهذيبه، يقول الغزالي: “ثم مهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود ينبغي أن يكرم عليه، ويجازى عليه بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس” ( التل، 2005، ص236) فعلى المربي أن يكافئ المتعلم كلما ظهر منه سلوك إيجابي، بحيث يختار المكافأة التي تحظى بقيمة ثوابية لدى المتعلم وتجلب له الفرح، وحتى يتمكن المعلم من حسن الاختيار للثواب المناسب، عليه أن يسبر خصائص المتعلم لتقديم المكافأة المناسبة له.
وقد نبه( الغزالي، 1985) إلى ضرورة تنويع المكافآت والجوائز واللعب حتى تجلب الرغبة والشوق إلى نفس المتعلم فيندفع للتعلم، هذا بالنسبة للصبي، أما بالنسبة للشاب فيتم ترغيبه بالتعلم وحثه عليه بما سيحصل عليه من المراتب العالية والذكر الحسن، كما يرى ضرورة استخدام الثواب لاستثارة المتعلم لبذل الجهد، فإن تم التعلم وجب على المعلم أن يصرف المتعلم عن التعلم بغية الحصول على الجوائز والمكافآت الدنيوية، وأن يوجهه إلى المكافآت الأخروية، يقول النبيصلى الله عليه وسلم “من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه”[31].
كما أكد الرسول صلى الله عليه وسلم على الاقتران الزمني بين حدوث السلوك وتقديم المكافأة الدنيوية في قوله: “أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه”[32] فالقيمة الثوابية للمكافأة في النفس تكون أكبر إذا تم الحصول عليها بعد حدوث السلوك مباشرة.
وقد مارس النبي صلى الله عليه وسلم التعزيز في مناسبات كثير منها ما رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه وكانت كنيته أبا المنذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر”[33]. وكان يمدح أصحابه ويصفهم بما هم أهله فيقول: “أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في الله عمر، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل”[34].
وقد دعا القابسي إلى الرفق بالصبيان بقوله: “ومن حسن رعايته لهم أن يكون رفيقا”، مستشهدا بقول عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ونصح المعلم أن لا يبادر بعقاب الصبي إذا أخطأ بل ينبهه مرة بعد أخرى، فإن لم ينتصح قرّعه بالكلام الذي فيه التواعد من غير شتم ولا سب، وأن لا يلجأ للعقوبة بالضرب إلا بعد استنفاد كافة الوسائل في الإصلاح، وعليه أن يستشير أباه إن كان يستأهل من الأدب فوق الثلاث، وأن يكون العقاب على قدر الذنب، وأن يقوم بالضرب بنفسه وأن يتجنب الوجه والأماكن الحساسة( القابسي، 1961، ص309-311).ويرى ابن خلدون أن الشدة على المتعلم تضر به فيقول: “إن إرهاف الحد بالتعليم مضر بالمتعلم، ولا سيما في أصاغر الولد، لأنه من سوء الملكة، ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهر وضيق عن نفسه في انبساطها، وذهب بنشاطها، ودعا إلى الكسل وحمل على الكذب والخبث” ( ابن خلدون، 1993، ص463).
كما يرى الغزالي “التغافل عن المتعلم إن خالف ذلك في بعض الأحيان مرة واحدة، ولا سيما إذا ستره الصبي واجتهد في إخفائه فإن عاد ثانية فينبغي أن يعاتب سرا ويعظم الأمر فيه، يقال له إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا، وأن يطلع عليك في مثل هذا فتفضح بين الناس، ولا يكثر القول على الصبي بالعقاب في كل حين حتى لا يهون عليه سماع الملامة وركوب القبائح ويسقط وقع الكلام من قلبه”.
وترى ( التل، 2005، ص240) أن تعديل السلوك في الإسلام يتضمن الخطوات الآتية:
- التغافل عن السلوك سيما إذا أدرك المتعلم خطأه واجتهد في إخفائه.
- العتاب سرا إذا تكرر السلوك المذموم.( مع تبيان العقوبة المترتبة على تكرار السلوك مستقبلا).
- عقاب السلوك المذموم إن تكرر.
وهناك العديد من المبادئ التي تيسر التعلم والتعليم بنه لها علماء الأمة، لا يتسع المقام للتفصيل فيها مثل: التكرار وصحبة الأستاذ والتفرغ لطلب العلم، الربط بين الهدف السلوك، التدرج … الخ.
الخلاصة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طرائق التدريس الأصيلة المنبثقة من القرآن والسنة الصحيحة والتراث الإسلامي، دون إهمال لما توصلت له التربية الحديثة، وقد تم استعراض أربعة طرائق رئيسة هي العرض المباشر وما ينبثق عنها من طرائق مثل المحاضرة والخطبة والقصة والعرض العملي، والسؤال والحوار والتعلم بالعمل والممارسة والتوجيه للتعلم الذاتي، بالإضافة إلى التعلم التعاوني والتعلم بالاكتشاف، كما حاولت تصنيف تلك الطرائق بناء على عدة متغيرات هي نوعية الهدف المنوي تحقيقه، ونوع المؤسسة التعليمية وجنس المتعلم وعمره ومستواه التحصيلي.
بالإضافة لذلك فقد توصلت الدراسة إلى عدة مبادئ أصيلة تساهم في تيسير التعلم والتعليم، وتلك المبادئ هي مراعاة الفروق الفردية وإثارة الدافعية واستخدام الوسائل التعليمية والثواب والعقاب، وقد انطلقت هذه الدراسة من فرضية أساسية تجمع شتات تلك الطرائق والمبادئ وتحدد دور المعلم ودور المتعلم، فدور المعلم تيسير التعليم على الطالب ويتم ذلك من خلال اختياره للطريقة المناسبة للتدريس، فكلما كانت الطريقة انسب، كان التعلم أيسر. كما أنه لا بد أن ينفذ تلك الطريقة بصورة صحيحة.
كما يستطيع المعلم تيسير التعلم من خلال تحقيق المبادئ، فمراعاة الفروق الفردية تيسر التعلم للطالب الضعيف وكذلك الطالب المتميز، فلا الضعيف يحبط، ولا المتميز يمل، وبإثارة الدافعية يجعل الطالب يقبل على التعلم دون المعاناة التي يعاني منها الطالب الذي لا يمتلك دافعة قوية، بل يصبح التعليم ممتعا ومفيدا.
أما الوسائل التعليمية فلا غنى عنها لتجسيد الأفكار المعنوية خصوصا عندما يكون التعلم جديدا أو يكون الطالب صغيرا، وكذلك الثواب والعقاب فهما من الأدوات المهمة في إثارة الدافعية وترغيب المتعلم بالتعلم.
وكما أن المعلم يقع على عاتقه مهمة تيسير التعلم على الطالب، فللطالب كذلك دور مهم جدا، وهو الإقبال على التعلم والرغبة فيه، والاستعداد لتحمل مشاقه ومستلزماته، فالفرضية الأساسية للدراسة، تنص على أن التعلم يكون فعالا أكثر كلما قدم المعلم تيسيرا أكثر، وكان الطالب راغبا ومستعدا للتعلم أكثر.
من الضرورة بمكان أن يكون في ذهن المعلم أن الغاية من أية طريقة هي تحقيق الهد ف التعليمي بأقصى درجة وبأقل جهد وبأسرع وقت، فالمفاضلة بين الطرائق التدريسية تكمن في هذه المعايير، ومن الممكن أن تكون بعض طرائق التدريس تستهلك وقتا طويلا، وتحتاج جهدا كبيرا لكنها تحقق تعلما أبعد أثرا وأكثر عمقا ، لا تحققه الطرائق التي تستهلك وقتا أقصر وتحتاج جهدا أقل، فالأفضل أن يختار المعلم الطريقة التي تؤدي إلى تعلم فعال أكثر إذا تمكن من ذلك. مع الاجتهاد في تيسير التعلم على الطلاب ما أمكن.
وقد تتفاوت الآراء في اختيار الطريقة المناسبة للموقف التعليمي، لكن المعلم الخبير يعرف طلابه جيدا ويعرف ما يصلح لهم وما يناسبهم،كما أن للبحث العلمي الرصين دورا رئيسا في تحديد الطريقة المناسبة أكثر، فالحماس لطريقة تدريسية لا يعني أنها تصلح لكل المواقف التعليمية، فالخبرة والتجريب المستمرين لهما كلمة الفصل في هذا.
لقد حاولت النماذج الحديثة للتدريس أن تقدم أفكارا من شأنها أن تيسر التعلم على الطالب فنظرية جانيه مثلا اعتمدت على فكرة تقديم المنهاج بصورة تراكمية، أي أن كل جزئية من المنهاج تعتمد على جزية أبسط منها، والجزئية البسيطة مأخوذة من جزئية أبسط … وهكذا، فالذي تطلبه هذه النظرية من المنهاج ومن المعلم أن يتدرجوا في تقديم المنهاج من البسيط إلى المعقد، لكن أوزوبل كانت نظرته معاكسة، ورأى أن يبدأ المعلم بمقدمة مكثفة مجردة سماها المنظم المتقدم، وإذا كان العالم برونر يرى أن التعلم بالاكتشاف من أفضل طرق التدريس يعارضه أوزوبل ليبين أن العرض المباشر هو الأفضل …الخ، وبعيدا عن الجل القائم فإن نظريات التعليم الحديثة قدمت تصورات لتيسير التعلم، لكنها في نفس الوقت لم تكن هذه التصورات لتشمل كافة المواقف التعليمية، فإذا كانت إحدى النظريات مناسبة لموقف تعليمي ما، فقد لا تكون كذلك في مواقف أخرى، أما الفرضية الأساسية للبحث فإنها ترفع شعار التيسير على الطالب وقدمت عدة طرائق ومبادئ لتحقيق ذلك التيسير.
أما بالنسبة لمشروع إحياء نظام تربوي أصيل فلا بد أن يكون تيسير التعلم أحد شعاراته الرئيسة، فعند بناء المناهج لا بد أن تعرض بصورة تيسر على الطالب التفاعل معها وتسهم في زيادة فهمه واستيعابه، كذلك عند اختيار المعلمين يكون من معايير الاختيار توفر القدرة على تيسير التعلم، وعند إعدادهم للتدريس، لا بد أن يؤهلوا ويدربوا على تيسير التعلم على الطلبة، وكذلك عند تجهيز البيئة التعليمية ومصادر التعلم يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.
أما بالنسبة للطالب فلا بد أن يكون قادرا على تحمل مسؤولية التعلم، راغبا في ذلك مندفعا ذاتيا لتحقيقه، وهذه القدرة والرغبة قد لا تكون متوفرة عند الطالب في بداية الطريق، لذلك يكون على مناهج التعليم الأصيل أن تثير رغبة الطالب في التعلم وتقدم بأسلوب مشوق وتتضمن تعزيزات مناسبة للطلبة، وكذلك المعلم يثير دافعية الطلبة وينمي قدراتهم على التعلم. وقد يصمم بعض المناهج الخاصة لذلك بحيث تصقل مهارات التعلم عند الطلاب وتتضمن مواضيع تبصر الطالب بأهمية العلم ودوره في الحياة وتأثيره على الإنسان، وقبل كل ذلك تنمي استشعار الأجر والثواب الأخروي على تحمل الصعوبات على الطريق.
مراجع البحث ومصادره
- الآغا، إحسان خليل. أساليب التعلم والتعليم في الإسلام، ط1 ، غزّة: من منشورات الجامعة الإسلامية، 1986م.
- ابن جماعة، بدر الدين بن إسحاق. تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، تحقيق محمد هاشم الندوي، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1934م.
- ابن حنبل، أحمد، مسند ابن حنبل، القاهرة: دار الحديث، 1995م.
- ابن خلدون، عبد الرحمن. مقدمة ابن خلدون، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1993م.
- ابن عبد البر، أبو عمر يوسف. جامع بيان العلم وفضله، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، ط2، المدينة المنورة: المكتبة السلفية، 1968م.
- ابن ماجة، محمد بن يزيد. سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار الفكر، د.ت.
- ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم. لسان العرب، بيروت: دار صادر، د.ت.
- أبو دياك، أنور إبراهيم. الأساليب المفردة في تعليم وتعلم العقيدة الإسلامية المستخلصة من الكتاب والسنة وأثرها في التحصيل الدراسي على طلبة الصف الأول الثانوي. ( رسالة ماجستير، كلية العلوم التربوية، جامعة اليرموك، 1995م).
- أبو زينة، فريد. مناهج الرياضيات المدرسية وتدريسها ، ط2، الكويت: مكتبة الفلاح، 2003م.
- أبو العينين، علي خليل. من أعلام التربية العربية الإسلامية ، الرياض: مكتب التربية العربية لدول الخليج، 1988م.
- أقلانية، المكي. النظم التعليمية عند المحدثين في القرون الثلاثة الأولى، ط1، قطر: سلسلة كتاب الأمة، وزارة الأوقاف، 1992م.
- با نبيلة، حسين عبد الله. ابن خلدون وتراثه التربوي، ط1، بيروت: دار الكتاب العربي، 1984م .
- البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري، القاهرة: دار الشعب، 1958م.
- التل، شادية. علم النفس التربوي في الإسلام، ط1، عمان: دار النفائس، 2005م.
- جان، محمد صالح. المرشد النفيس إلى طرق التدريس ، ط1، الطائف: دار الطرفين، 1998م .
- حسن، مرضية الزين. معايير الاختيار في التعلم في الفكر التربوي الإسلامي ودرجة أهميتها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية في جامعات ولاية الخرطوم ( رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم درمان الإسلامية، 2000م).
- الحسين، خندف علي. الفكر التربوي (النظرية التربوي) عند ابن خلدون( رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم التربوية: الجامعة الأردنية، 1979م) .
- الخطيب، خالد محمد. الرياضيات المدرسية: مناهجها. تدريسها. والتفكير الرياضي، ط1، عمان: مكتبة المجتمع العربي، 2009م.
- الخليلي، خليل وآخرون. تدريس العلوم في مراحل التعليم العام، ط1، الإمارات العربية المتحدة: دار القلم، 1996م.
- الخوالدة، ناصر وعيد، يحيى. طرائق تدريس التربية الإسلامية وأساليبها وتطبيقاتها العملية، ط2، الكويت: مكتبة الفلاح، 2003م.
- دروزة، أفنان. النظرية في التدريس وترجمتها عمليا، ط1، الإمارات العربية المتحدة: دار القلم، 2000م.
- الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. مختار الصحاح، بيروت: دار الفكر، د.ت.
- الزرنزجي، برهان الدين. تعليم المتعلم طريق التعلم، تحقيق صلاح الخيمي ونذير حمدان، ط1، دمشق: دار ابن كثير، 1985م.
- السالمي، محسن. تأثير طريقتي الاستقصاء والمناقشة في التحصيل الفوري والتحصيل المؤجل لمادة التربية الإسلامية لدى طلاب الصف الأول ثانوي في إحدى مدارس محافظة مسقط ( رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم التربوية: الجامعة الأردنية، 1995م ).
- سليمان، ممدوح. طرق تدريس الرياضيات في المرحلة الابتدائية، ط1، عمان: الجامعة العربية المفتوحة، 2005م.
- الصغير، حصة بنت محمد. تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال تربويا، ط1، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، 2008م.
- عبد الحميد، جابر. استراتيجيات التدريس والتعلم ، ط1 ، مصر: دار الفكر العربي، 1999م .
- عبد الدايم، عبد الله. التربية عبر التاريخ، ط7، بيروت: دار العلم للملايين، 1997م.
- عبد الله، عبد الرحمن صالح. المرجع في تدريس علوم الشريعة، ط1، عمان: دار البشير ومؤسسة الوراق، 1997م.
- عبيد، وليم. تعليم الرياضيات لجميع الأطفال ، ط1 ، عمان: دار المسيرة، 2004م.
- عثمان، عبد المنعم. علم نفس التعلم والتعليم ، ط1 ، الكويت: من منشورات الجامعة العربية المفتوحة، 2004م .
- عثمان، عبد المنعم. المناهج وطرق التدريس العامة ، ط1 ، الكويت: من منشورات الجامعة العربية المفتوحة، 2004م .
- العلي، صالح. إسهامات برهان الإسلام الزرنوجي في مجال طرائق التدريس: دراسة تحليلية لكتاب تعليم المتعلم طريقة التعلم( رسالة ماجستير، كلية التربية: جامعة دمشق، 2005م).
- العمري ، عمر. مقارنة أثر التعليم المبرمج المحوسب والتعليم المبرمج المكتوب في تحصيل طلبة الصف الثامن الأساسي في مادة التربية الإسلامية ( رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم التربوية: الجامعة الأردنية، 2000م)
- .القرضاوي، يوسف. الرسول والعلم، ط1، القاهرة: دار الصحوة، 2001م.
- قمبر، محمود. دراسات تراثية في التربية الإسلامية( طرائق وأساليب التعليم) ط1، الدوحة: دار الثقافة، 1985م.
- المجمع، التربية العربية الإسلامية : المؤسسات والممارسات ، الأردن: المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ( مؤسسة آل البيت )، 1989م .
- المواجدة ، بكر. مقارنة بين أثر طريقتي نظام التعليم الشخصي ( خطة كيلر ) والتعلم التعاوني في تحصيل طلبة الصف السابع الأساسي في مبحث التربية الإسلامية في الأردن ( رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم التربوية: الجامعة الأردنية، 2004م) .
- النعمي، عبد الأمين. المناهج وطرق التعليم عند القابسي وابن خلدون، ط2، الجماهيرية الليبية: من منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 1980م.
- الهوال، حامد عبده. التعلم والتعليم في القرآن الكريم ،ط1، الكويت: مكتبة الفلاح، 1981م.
[1] (صحيح مسلم، كتاب الطلاق، ج1،ص81)
[2] (مسلم، كتاب البر والصلة).
[3] (البخاري، كتاب الأذان ، رقم 751)
[4] (صحيح مسلم ،كتاب الطلاق، ج1،ص81)
[5] (البخاري، باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه).
[6] (مسلم، كتاب المقدمة )
[7] (البخاري، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل).
[8] (ابن ماجة، كتاب المقدمة، رقم 220
[9] (سنن ابن ماجة : 30)
[10] (مسلم، كتاب المساجد، رقم 2286).
[11] ( البخاري، باب الرقائق)
[12] ( ابن ماجة، كتاب الذبائح، باب السلخ، رقم 3710).
[13] (البخاري،كتاب العلم، رقم 59)
[14] (مسند أحمد، رقم 206)
[15] ( صحيح البخاري، رقم 6847 )
[16] (مسلم، المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع
[17] (مسند أحمد) .
[18] ( سنن ابن ماجة، كتاب المناسك،باب الوقوف بجمع).
[19] ( أخرجه مسلم، كتاب العلم، باب فضل طلب العلم).
[20] (صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب اللعان) .
[21] (ابن ماجة، كتاب اللباس، رقم3585 ).
[22] (الترمذي، كتاب الزهد، رقم2334 ).
[23] ( البخاري، كتاب الطلاق، باب اللعان) .
[24] ( مسلم،2، 759).
[25] (الترمذي، 5، 140) .
[26] (أحمد، 3، 23).
[27] (البخاري، 5، 2359) .
[28] (البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وقبلته ومعانقته ).
[29] ( مسلم، كتاب الزهد والرقائق).
[30] ( البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب من راءى بقراءة القرآن أو تآكل به أو فخر به).
[31] (أبو داوود، كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله).
[32] ( ابن ماجة، كتاب الأحكام، باب أجر الأجراء)
[33] ( مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل سورة الكهف).
[34] ( رواه الترمذي ).