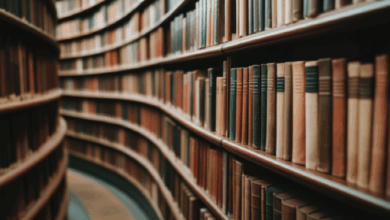07- المنظومة القيمية في النظام التربوي الأصيل المنشود
المنظومة القيمية في النظام التربوي الأصيل المنشود
بحث مقدم لصالح مشروع إحياء نظام تربوي أصيل
إعداد :الأستاذ الدكتور أسعد السحمراني
أنجز في: 19 محرم 1431 هـ / 05 يناير 2010م
جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمشروع ومسجلة رسميـًا ومحمية بموجب القانون.
المنظومة القيمية في النظام التربوي الأصيل المنشود
توطئة:
تشكل التربية الميدان الرئيس لإعداد الأجيال، وتتزايد في الآونة الأخيرة عناية الجهات المعنية بالتربية مناهج ومؤسسات، وعلى المستويين الرسمي والأهلي، إحساساً من الجميع بأهمية التربية ودورها في تحصين الناشئة، وتكوين شخصيات الأبناء وإعدادهم وفق ما تريد الجهات التي ترعى العملية التربوية والتعليمية.
وهناك سبب آخر لتوجيه الإهتمام عند بعض الدول والجهات بالتربية هو الغزو، والسعي لتنشئة أجيال عندها التبعية لهذا الغازي تربوياً وفكرياً، لأنها شكلت شخصية التابعين بناء لمنظومة قيم تربوية تناسبه، ولا تناسب الهوية الثقافية لآخرين يغزوهم ويخترقهم.
يضاف إلى ذلك موضوع التقدم التقني في دنيا الأدوات وفي الصورة والصوت، وأدوات الإتصال والتوصيل، ووسائل الإيضاح، فكل ذلك فرض تحديات على المربين وعلى المعنيين بالعملية التعليمية والتربوية لا بد من سرعة الاستجابة لها لبناء مسار حضاري قويم يؤصل الشخصية للطالب، ويرسخ القيم الدينية فيها بمقابل ما ينشره المستهدفون لأمتنا العربية والإسلامية وأساسه الماديات والكميات والمقادير والأرقام، ولا مكان فيه للإيمان أو للإنسان.
إن اللحظة الراهنة شهدت وتشهد تطوراً متسارعاً في أنظمة التعليم بين أكاديمي ومهني، وبين تعليم مفتوح الصفوف، وتعليم منتظم الصفوف، وبين تعليم مباشر أو تعليم عن بعد أو بالواسطة، هذا عدا تنوع الاختصاصات بدءاً من المرحلة الثانوية، وفي التعليم المهني والتقني يبدأ الاختصاص قبل المرحلة الثانوية أي في مرحلة التعليم الأساسي، أقله في الحلقة الثالثة منه.
لذلك يكون إحياء نظام تربوي أصيل عند المسلمين محتاجاً إلى تأصيل شرعي، وإلى تساند أهل الخبرة ليقدموا ما يناسب العصر والجيل بما يصح أن نقول بشأنه: إنه نظام تربوي راسخ في الأصل شرعاً وتراثاً وقيماً ولغة ومتكيف مع البئة والمحيط هذا مع حضور في العصر لا إحساس بالدونية معه.
أهمية البحث وأفكاره المحورية:
إن منظومة قيمية في النظام التربوي تعدّ ضرورة لا تقوم بدونها أية عملية تربوية بالشكل السليم، والمنظومة القيمية في التربية عند المسلمين تحتاج التزام مرجعية هي الشريعة (القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة)، وتحتاج قواعد تأصيلية تلتزم ضوابط الشريعة ومبادئها وأحكامها، كما أنها تسعى لأنجاز مقاصد الشريعة التي جعلها الأصولين خمسة هي: حفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ الدين، وحفظ النسل، وحفظ المال.
لقد باتت الحاجة ملحة لصياغة مشروع تربوي أصيل للمسلمين لأن نظم التعليم والتربية المعمول بها حالياً في الأمة العربية والإسلامية مستوردة من الغرب الذي تقوم التربية عنده على مرجعية فكرية مادية الطابع، ورقمية الأبعاد، ومجتمعاتنا محتاجة لأن تقوم التربية فيها على مرجعية شرعية تولد فكراً إيماني الطابع، إنساني الأبعاد.
إن طلاب المجتمع العربي والإسلامي يشعرون بغربة عن واقعهم ودينهم إلى حد كبير عندما يتعلمون وفق نظام مدرسي، ومن خلال مناهج لا تستمد مبادئها ومكوناتها الفكرية من الإسلام، وإذا ذهب الطلاب باتجاه رفض التمدرس ليدخلوا التعليم الأصلي المسمى – حسب المواقع – الكتاتيب، أو المحاضر، أو الخلاوي، أو المعاهد الشرعية أو غير ذلك، فإن هذا التعليم الأصلي أو العتيق – كما يسميه المغاربة – لم يعد بإمكانه مواكبة العصر وتطوراته، ولا هو مقتدر على الإستجابة لطموحات الدارسين، لكن هذا لا يعني أن هذا التعليم لا يحمل العديد من الإيجابيات، وهو يحوي مضامين لا تزال لها حضورها وفاعليتها.
هنا تأتي أهمية الكتابة والتنظير في إطار المشروع التربوي التأصيلي، ويتجلى ذلك بالإستفادة من النقاط الحيوية والأسس المتجددة في التعليم الأصلي، وتكون معها الاستفادة والاقتباس من النظم التربوية المدرسية وغير المدرسية التي تكونت وتمت في رحم غير إسلامي.
وإذا كان تكوين الشخصية مقصد العملية التربوية فإن هذا التكوين محتاج لنظام تربوي جلي الرؤية، وواضح الخطوط والخطوات، وثابت الخطى، وإسلامي المرجعية والمصدر، وتقدمي النظرة والنزعة، ومع هذا كله يحتاج المشروع التربوي هذا إلى أن يكون حراكه ضمن الدورة الحضارية الإسلامية التي تختلف عن حراك في دائرة دورة حضارية غير إسلامية، هذا دون أن تكون غفلة عند معدّي هذا النظام الأصيل والأصلي عن مسألة الأخلاق التي تشكل المحور في صلاح الجيل وفي تحقيق الركائز المتينة لبنيان شخصيته.
أهداف البحث:
إن التربية وفق منظومة تربوية تتألف من مكونات يجمعها نسيج منسجم الخيوط، وتنطلق من مبادئ ثابتة الأركان، تشكل ضرورة في كل مكان وزمان على أن تكون لها مرجعية من شريعة الإسلام كي تكتسب الثقة من المعلم والطالب، ويكون بناء عملية تربوية محتاجاً من الأهداف ما يلي:
- يعيش المعنيون بالتربية حالات من تناقص الأفاهيم، وأجواء من العشوائية بسبب عدم تحديد مرجعية منظومة القيم التي تنطلق منها العملية التربوية تخطيطاً ومناهج ومقررات ومضامين، لذلك تكون الحاجة ملحة لمنظومة قيمية يسترشد بها معد المناهج، وتستهدي بها عملية التدريس أو التعلّم.
- إن المنظومة القيمية ضرورية من أجل تحديد المعايير التي تقاس بها عناصر المنهج التربوي أهدافاً ومقررات وطرائق وتقويماً، لأن عملية تربوية لن تكون قويمة دون معايير ضابطة.
- إن النظام التربوي الأصيل الذي يلتزم منظومة قيمية مستمدة من الإسلام يحقق للمتربي أمرين مهمين في تكوين الشخصية السوية هما:
- الانعتاق من التقليد والجمود، والتخلص من المورثات الميتة، فهذا مسلك لا بد منه لمواكبة مقتضيات العصر، وما حصل من تطور في الفكر والتقنية.
- وقف حالة الانبهار بالأجنبي، وهو وافد مسموم يجمل في طياته ما لا يناسب الإسلام عقيدة وشريعة وحضارة، تالياً فهو يقدم عناصر لتكوين الشخصية تؤدي إلى ازدواجية في ذات المتربي من الناشئة في الأمة.
4- إن منظومة قيمية لنظام تربوي أصيل تؤمن الفضاءات الدراسية والتربوية لانتاج شخصية متوازنة لا مكان فيها للإفراط أو التفريط، وهذه الشخصية يتم إعدادها بأبعادها كافة، وأبعادها هي: البعد الروحي، والبعد النفسي، والبعد العقلي، والبعد الجسدي.
5- إن العملية التعليمية الوافدة من الغرب، والعمول بها في التمدرس عربياً وإسلامياً، لا تعير اهتماماً لمسألة التلازم بين التربية والتعليم، وهذا يجعل المناهج عملية تعليم بلا تربية، بينما يهدف نظام تربوي أصيل إلى مناهج يتلازم فيها التعليم مع التربية، ويتحقق ذلك بإدماج القيم الناظمة لحياة إنسان أرقى، وأقوم شخصية، لالمناهج في كل مقومات الأهداف، والمقررات، وأساليب التعليم ووسائله، وعمليات التقويم والاختبار.
6- تريد منظومة قيمية في نظام تربوي أصيل في الإسلام، أن تجعل الإنسان مركزية، وأن العملية التعليمية والتربوية من أجل تحقيق كرامته وعزته وسعادته، ومواجهة المفاهيم الوافدة التي تقدم المادة على الإنسان، ويصل الامر بهم إلى حد تسخير الإنسان للمطالب المادية الإقتصادية ولمقتضيات الآلات، وهذا ما لا يتناسب مع الدين الحق، ولا مع حقوق الإنسان المستخلف في الأرض.
7- إن المنظومة القيمية التربوية ضمن نظام تربوي أصيل تتجه للإصلاح في مواقع التربية كافة، فالإصلاح وفق هذه المنظومة ليس ما يكون في المدرسة والمعهد والجامعة، وإنما تريد المنظومة أن تدخل في الأسرة والمسجد والإعلام، ومسار الحياة في المجتمع.
8- إن التحديات المعاصرة في ميادين السياسة والإقتصاد والإعلام وسائر الميادين، وما يشهده العالم اليوم من أشكال الاستعمار والإحتلال والعدوان والظلم، كل ذلك يضاف إليه محاولات نشر الفتن يحتاج في النظام التربوي الأصيل إلى منظومة قيمية تؤسس جيلاً واعياً للتحديات، وواعداً في ردها طلباً للحرية والعدل والتقدم، وللتحرر وتطهير المقدسات واسترداد الحقوق المسلوبة، هذا مع مواجهة الغزو الثقافي، والإستباحة للقيم الأخلاقية.
إشكاليات البحث أو فرضياته:
- هل تحتاج منظومة القيم في إحياء نظام تربوي أصيل إلى مبادئ ثابتة وموثوقة؟ وما المصدر المؤهل لتقديم هذه المبادئ؟
- هل يعدّ المعنيون بإحياء نظام تربوي أصيل، والمطالبون به، الإسلام قرآناً وسنّة، المرجعية الوحيدة لمشروعهم؟ أم أنهم يريدون أن يأخذوا من الإسلام بطرف، ومن غير الإسلام بأطراف أخرى؟
- إذا كان الإسلام شريعة وعقيدة من مصدر إلهي، وقيمه مطلقة الصحة، هل يكون المرجع الثابت للنظام التربوي في منظومته القيمية، وبالتالي لا داعي للإلتفات إلى سواه؟
- إلى أي مدى يستطيع مشروع نظام تربوي أصيل أن يعبر عن منظومة القيم النابعة من الإسلام؟ وهل يستطيع جهد بشري أن يقارب هذه القيم؟
- ما أبرز مفردات الكتاب المدرسي ومضامينه التي تحقق السبيل إلى عملية تربوية أصيلة؟
- ما الأساليب والوسائل التي تحتاجها عملية تربوية أصيلة، وتكون ملتزمة بمنظومة قيمية إسلامية؟
- هل تحتاج المنظومة القيمية في مشروع تربوي أصيل إلى تنمية روح الفريق عند الطالب؟ أم تقوم على إعداده فرداً مستقلاً بذاته؟ أم إليهما معاً؟
- أين موقع التراث التربوي عند المسلمين في نظام تربوي أصيل بعد مرجعية الإسلام؟ وكيف السبيل للاستفادة من تجارب الآخرين أو تجارب معاصرة؟
- إذا كان المشروع التربوي الأصيل يريد فرداً ملتزماً في قوله وعمله بمنظومة القيم، فهل هذا يستلزم طغيان جانب الزهد والروحانيات؟ أم أنه يعطي مكاناً للميول المادية؟ وكيف السبيل لوضع أسس تحقق انتاج شخص متوازن؟
منهجية البحث:
إن البحث في أمر منظومة القيم انطلاقاً من مرجعية الإسلام عقيدة وشريعة يعتمد المنهج التحليلي للوقوف على النصوص وعندها فهماً وادراكاً ووعياً، ومن ثم المنهج الإستقرائي لتحديد عناصر المنظومة القيمية من المرجعية (القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة)، ومن التراث والمسار الحضاري في الأمة.
ولا يستغني البحث في هذا الميدان عن المنهج النقدي عندما يكون التعامل مع القيم غير الإسلامية، أو مع الوافد الثقافي الأجنبي، أو عندما يتمّ استعراض واقع السلوك عند قبيل من التربويين المسلمين الذين اختلط عليهم الأمر بين الأصالة والإستعارة، وبين الانفتاح والانبهار، وبين الاستفادة من خبرات الآخرين والتبعية لهم.
يبقى أن منهج الدراسات المقارنة له مكان ومكانة في البحث لأن البحث يقوم على أسس معيارية، ولا يظهر سمو منظومة القيم الأصلية المنطلقة من ثوابت الإسلام إلا بالمقارنة مع تلك المنظومات المستمدة من مصادر وضعية فلسفية أو فكرية.
الفصل الأول
مصطلحات البحث
العنوان: “المنظومة القيمية في النظام التربوي الأصيل المنشود”
المنظومة:
من نظم الشيء، والانتظام والتنظيم هو عكس الفوضى والعشوائية. وإذا كانت العشوائية تبعثر الطاقات، وتشتت الجهود، وتنتج الخلط والغموض، فإن الانتظام يحقق الدقة والإحكام في الصنع، والمنهجية في العمل.
والمنظومة في أمر ما سلسلة منسجمة الحلقات، ومتجانسة الشكل والمضمون، وما هو منظومة تكون له مرجعية محددة، ونسق ثابت متآلف الأجزاء، كما أن المنظومة توجه إلى مقاصد واضحة، ولا تقبل أي دخيل أو وافد إلا إذا كان منسجماً مع طبيعهتا وسياقها.
أما عند اللغويين فالقول هو: “نظم الأشياء: ألّفها وضمّها بعضها إلى بعض. انتظم الشيء: تألّف واتسق. انتظم أمره: استقام. تناظمت الأشياء: تضامّت وتلاصقت. النظام: الخيط ينتظم فيه اللؤلؤ وغيره، والنظام: الترتيب والإتساق. ويقال: نظام الأمر: قوامه وعماده. المنظوم من كل شيء: ما تناسقت أجزاؤه على نسق واحد.”[1]
وفي معجم آخر: “نظم الشيء إلى الشيء: ضمّه وألّفه. ناظم اللؤلؤ ونحوه، ج: نُظُم: ملاك الأمر وقوامه. مجموعة مبادئ مرتبطة الموضوع تشكّل نهجاً أو انتماءً خاصاً.”[2]
ما انتهى إليه التعريف يفيد أن المنظومة هي ترتيب الأفكار والمعايير بناء لركائز ثابتة، ولأهداف جلية واضحة بما يحقق المصالح المنشودة من المنظومة، كما أن المنظومة تساعد في تأصيل الهوية وتأكيد الانتماء، وكأن من لا منظومة قيمية معيارية له، لا هوية لها. فالمنظومة إذن ضرورة للإنتماء والهوية.
والإسلام جاء مؤكداً على الانتظام والمنهجية الواضحة كي يكون للحياة معنى عند الفرد وعند المجتمع لأن فقدان المنظومة يحول الحياة إلى حالة عبثية، ومع العبثية يضيع الهدى والرشاد، ويحلّ التّيه والضياع.
إن النظام والانتظام والمنظومة أساس في الإسلام، وذلك: “أن من أبرز المفاهيم التي يستهدف الإسلام بناءها في المسلم، أو بناء الشخصية المسلمة على أساسها، مفهوم النظام… ولا شك أن ترسيخ مفهوم النظام الشامل لدى الإنسان المسلم، يحرّره من الشعور بالعبثية، كما يحرّره من وطأة الشعور بالفراغ الذي يقتل طاقاته ويسلمه إلى اليأس.”[3]
وهناك من ذهب أن الانتظام كالإصطفاف، والنظام كالصف. فالمعاني متقاربة وكذلك الدلالات. وعند ابن منظور: “الصفّ: السطر السمتوي من كل شيء… وصففت الاقوام فاصطفوا: إذا أقمتهم في الحرب صفاً… فهو مصافّ؛ إذا رتّب صفوفه مقابل صفوف العدو.”[4] بناء على ما تقدم درج بعضهم على القول مصفوفة بدل منظومة، والقصد أن المصفوفة تتكون من مجموعة معايير منتظمة أو مصطفة في مقابل مصفوفة من المعايير المقابلة التي تناقضها وتخالفها.
وإذا افتقد الانتظام أو الاصطفاف يكون الهلاك، وكذلك الأمر في التربية، فإنها إذا ابتليت بفقدان المنظومات القيمية، وبفقدان المرجعية، فإنها تكون ذاهبة إلى البوار ودار الهلاك. والحديث النبوي في موضوع أشراط الساعة جاء فيه: “وآياتٌ تتابع كنظام بالٍ قُطِع سلكه.”
تأسيساً على ما تقدم يتبيّن أن المنظومة وقاية ومنهج وتماسك واستقرار وتحقيق للهوية والانتماء، وعدم وجود المنظومة أو المصفوفة يذهب بالعملية التربوية أو سواها إلى البوار والعبثية وضياع الجهود. وبالتالي يكون الموقف: إن كل عملية ناجحة تحتاج إلى منظومة، والنظام التربوي الأصلي لا يقوم إلا مع وجود منظومة يرتكز إليها ويقوم المنهج التربوي مسترشداً بها وملتزماً معاييرها.
القيمة والقيمية:
القيمة وأصلها القومة، ومنها: قوم – تقويم – واللفظة حاضرة بقوة، ولها تصريف على وجوه متعددة. وفي معاجم اللغة: “القيمة: النوع، والثمن الذي يقاوم المتاع؛ أي يقوم مقامه. ج: قيم؛ وما له قيمة أي: ثبات ودوام على أمر. قيمة الإنسان: قامته.
… وقيّم القوم: الذي يقوم بشأنهم ويسوس أمرهم… ومنه قولهم إذا أرادوا مدح إنسان: أنت قيّم وخلقك قيم. أي: مستقيم حسن.”[5]
“القوام: العدل… ورمح قوام: مستقيم. القوام: قوام كل شيء: عماده ونظامه القويم: المعتدل. القيمة: قيمة كل الشيء؛ قدره. ويقال: ما لفلان من قيمة: ما له ثبات ودوام في الأمر.”[6]
وقوام الأمر: ملاكه الذي يقوم به.. نظامه وعماده.
“القيام والقوام: إسم لما يقوم به الشيء؛ أي يثبت.”[7]
ولأن القيمة والقيم دلالة على الاعتدال والاستقامة والثبات والقدر، وكلها تصريفات لها دلالات إيجابية فقد احتلت تصريفات لفظة قيمة مكانة في النص القرآني، وذلك يؤكد على ما للقيم من دور فعّال في كل ميادين الحياة وشؤونها، فهناك القيم الاجتماعية، وهناك القيم السياسية، وهناك القيم الاقتصادية… الخ.
لأن كل فعل وميدان له منظومة قيمية تضبط مساره وتوجهه الوجهة السليمة.
قال الله تعالى: ﴿قل إنني هداني ربّي إلى صراط مستقيم ديناً قِيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين.﴾ (الأنعام:161).
جاء في تفسير القرطبي حول ” قِيماً”: ” قرأه الكوفيون وابن عامر بكسر القاف والتخفيف وفتح الياء، مصدر كالشّع، فوصف به. والباقون بفتح القاف وكسر الياء وشدّها، وهما لغتان. وأصل الياء الواو: قَيْوم، ثمّ أدغمت الواو في الياء كميّت، ومعناه: ديناً مستقيماً لا عوج فيه.”[8]
وفي تفسير آخر: “إن ربي أرشدني ووفقني إلى طريق مستقيم. بلغ نهاية الكمال في الاستقامة.”[9] وعند الراغب الأصفهاني: “ديناً قيماً: أي ثابتاً مقوّماً لأمور معاشهم ومعادهم.”[10]
إن القيم لها مصدر ومرجعية تحدد معاييرها، والقيم تتناول كل جوانب سيرورة الحياة، ولا تكون القيم في وجه، ونقيضها في وجه آخر، ومن خصائص القيم أنها تنتظم في سلك كانتظام اللؤلؤ في سلك معين، ووفق ترتيب أساسه الانسجام. والقيم توجه سلوك الفرد والمجتمع في الحراك الاجتماعي، وتضبط هذا السلوك وفق ما تستلزمه الصراط المستقيم، والقيم ليست أطراً نظرية، وإنما قواعد ومعايير تتجسد أفعالاً في سيرورة حياة الفرد والمجتمع.
وإذا كانت العادات والتقاليد حالات من تكرار نمط معين من الحركة والسلوك فإن القيم غير ذلك لأن القيم في كل مرة تستند إلى المعايير التي تمكن الملتزم بمنظومة قيمية من النقد والموازنة تمهيداً للتمييز والترجيح من خلال الاختيار المبني على العقل الذي يثمر الأفعال الإرادية. فمنظومة القيم هي التي تعطي المعايير للفصل والتميير بين الخير والشر، وبين الفضيلة والرذيلة، وبين الحق والباطل، وبين العدل والظلم، … الخ.
تمت صياغة تعريفات عديدة للقيمة، منها هذا التعريف: القيمة “مفهوم يدلّ على مجموعة من المعايير والأحكام، تتكون لدى الفرد من خلال تفاعله مع المواقف والخبرات الفردية والاجتماعية، بحيث تمكنه من اختيار أهداف وتوجهات لحياته، يراها جديرة بتوظيف إمكانياته، وتتجسد خلال الاهتمامات أو الاجتهادات أو السلوك العملي أو اللفظي بطريقة مباشرة وغير مباشرة.”[11]
وقد اختلفت المواقف حول مصدر المعايير والأحكام، والمسلمون على موقف هو: إن الإسلام قرآناً وسنّة هو المصدر لهذه المعايير، وهناك من المسلمين (المعتزلة) وسواهم من قال: إن العقل البشري هو الذي يحدد هذه المعايير بين الحسن والقبح ولأن العقل البشري يختلف في قدراته وخلفياته الثقافية، ناهيك عن اختلاف الدوافع والميول عند الأفراد والمجموعات البشرية، لذلك لا يكون من الصحيح أن تستمد المعايير القيمية من مصدر بشري.
وإذا كانت حجة بعضهم أن أحوال الأمم في معاشها وعلومها وظروفها لا تستمر على وتيرة واحدة، وهذه صحيح، وبالتالي فإن ذلك يستلزم مرونة في منظومة القيم كي تستجيب للواقع والتحديات والمتغيرات، فإن الرد هو: إن الإسلام في العقيدة والشريعة قد حدد مبادئ ومقاصد تنطلق منها المنظومة القيمية دون أن يتدخل في الأجزاء وهي محل تغيّر حسب المكان والزمان، لذلك تكون مسألة التكيف مع المستجدات، والمرونة أمام المتغيرات في أساسات المنظومة القيمية، هذا مع التأكيد على الأصالة.
ليس المطلوب أن تسيطر حالة من الجمود عند الماضي وما ساد فيه، ولا المطلوب مغادرة التأصيل والثوابت، والأخذ من الوافد تحت شعار العصرنة، وإنما الصحيح الالتزام بالأصل مع التكيف مع العصر.
وقد ذهب خالد الصمدي هذا المذهب حيث قال: “ولذلك لم تضع التربية الإسلامية لقيمها قوالب منظمة جاهزة لا بد أن تفرغ فيها. وإنما أمرت بضرورة تحقق الجوهر بأشكال مختلفة تستجيب لحاجات الزمان والمكان والأحوال، فأمرت بتحقيق الشورى في المجتمع ولم تحدد الكيفية والوسيلة، وأمرت بأداء الأمانات إلى أهلها، مطلق الامانات، بعد حفظها ولم تحدد وسائل الحفظ لأنها متغيّرة.
وأمرت بالتكافل الاجتماعي وتركت طرق تحقيقه مفتوحة على اجتهادات المقدمين عليه، وأمرت بالإنفاق في سبيل الله بإطلاقٍ ليعمّ الخير كل مناحي الحياة ويغطي حاجات الناس المتجددة.
… ومن مظاهر التكيف في القيم الإسلامية قابليتها للتداول بكل أنواع الخطاب.
… ومن مظاهر التكيّف، أيضاً قدرة هذه القيم على الاستجابة لحالة متلقيها العمرية والنفسية والوجدانية والعقلية.”[12]
إن هذه الميزة أو الحالة في النظام التربوي ومنظومة قيمه المنطلقة من الإسلام إنما ترد على دعاة الحداثة واللادينية، وعلى من يزعمون أن الحاجة هي لنظام تربوي من مدارس علم النفس والتربية التي تتنازع في الموقع غير الإسلامي المنظومات دون أن ترسو على شاطئ معين، وهذا يجعل أية منظومة غير أصيلة في حالة من القلق، ومن يستخدمها معلماً وطالباً لا يشعر معها بالأمان، بينما تتميز المنظومة القيمية ذات المرجعية الإسلامية بالثبات والاستقرار، وتثمر حالة اطمئنان عند المربي والطالب على حدّ سواء لأنهما معاً يحتكمان إلى قيم واحدة.
وإذا كان العالم اليوم يتخبط في مشكلات لم ينجُ منها أي مجتمع على المستوى الأخلاقي والاجتماعي، فإن هذه المشكلات تحتاج إلى معالجات أساسها أن تتسلح العملية التعليمية والتربوية بالقيم والمثل العليا لأن سفينة النجاة التي تخلص الأجيال من الغرق، وتوصلهم إلى شاطئ الامان إنما هي منظومة قيمية أصيلة الجذور شجرتها ضاربة الأعراق في مبادئ الإسلام ومقاصده.
والإنسان المفطور على الاجتماع البشري، والذي لا يمكنه أن يواصل مسار حياته في عزلة وغربة عن غيره من الناس لا يمكنه أن يكون معهم في مجتمع ولا أن تنتظم علاقاته معهم، ولا يمكن أن تؤمن حقوق الجميع وبعدها سعادتهم إلا حال وجود أحكام ومعايير ناظمة للعلاقات، وليست هذه الأخيرة سوى القيم. فالسبيل القويم، والصراط المستقيم أساسها القيم.
خلاصة القول: إن القيم أساس مكين للعملية التربوية، وهي ملازمة لشخصية الإنسان فرداً ومجتمعاً، ولها تدخل في كل ميدان من ميادين الحياة. فكل شأن من الشؤون فيه ثنائية هي الخير والشر، والحق والباطل، والحلال والحرام، والمسموح والممنوع، إلى آخر الثنائية، وعند كل موقف تدخل القيمة لتكون المعيار الذي على أساسه يكون الحكم، وعلى أساسه يكون القرار، وبهديه يكون الفعل.
التربية والتربوي:
جاء في “لسان العرب”: “ربّ ولده والصبي يربّه ربًّا.. بمعنى ربّاه. وفي الحديث: لك نعمة تربّها؛ أي تحفظها وترعاها وتربّيها، كما يربّى الرجل ولده…. وربّاه تربية… أحسن القيام عليه، ووليه حتى يفارق الطفولة، كان ابنه أو لم يكن.”[13]
وقال الراغب الأصفهاني: “الرّبّ؛ التربية، وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حدّ التمام.”[14]
وفي “معجم النفائس الكبير”: “ربّ الشيء ربًّا: جمعه. و-ملكه- و-القوم: ساسهم وكان فوقهم. و-النعمة: زادها. و-بالمكان: لزمه وأقام به. و-الأمر: أصلحه وأتمه. … والصبي: ربّا حتى أدرك. … تربّى الصبي: أحسن القيام عليه.”[15]
أما “المعجم العربي الأساسي” فقد جاء فيه: “ربّ يربّ ربًّا رابّ: الأب ولده: وليه وتعهده بما يغذيه وينميه ويؤدبّه. –الأمر: أصلحه وقام بتدبيره. –القوم: ساسهم وكان فوقهم. …-بالمكان: لزمه وأقام به فلم يبرحه.”[16]
إن هذه المعاني المتعددة التي تدور في فضاء دلالات كلمة ربّ وتربية إنما تبيّن بأن كل إنسان يكون في بدايه عهده في الحياة الدنيا إنما هو محتاج لمن يتعهده ويرعاه، ويمدّه بما يحتاج إليه لقوام حياته، ولتحصيل تمام النشأة وكمالها، وكل قوم يحتاجون من يسوسهم شرط أن يكون فوقهم؛ أي متفوقاً عليهم بخبرته ومتقدماً عليهم في كفاياته وقدراته، كما الحال مع الأبوين اللذين يقومان على تربية ولدهما وهما متفوقان عليه. ومن يقوم بتربية شخص والسهر عليه هو وليه ومربيه سواء أكان من يحظى بالرعاية ابن المربّى أو لم يكن، إذ الأساس في الوالدية هو التربية وليس الحمل والإنجاب بدليل قوله تعالى: ﴿وقل ربّي ارحمهما كما ربّياني صغيراً.﴾ (الإسراء: 23).
والنص القرآني يأتي ليؤكّد على أهمية التربية، وأنها الأساس في تكوين الشخصية عند الإنسان، وهي من القواعد الأصلية التي لا يستغني عنها، ومن الحاجات الضرورية التي يكون إشباعها في أساسات ما يتقوّم به الإنسان.
الغذاء والشراب والتنفّس حاجات فيزيولوجية بها يكون النمو واكتمال التكوين الجسدي، والتربية بها يكون اكتمال النمو العقلي/الفكري، والنمو العاطفي/الوجداني، والتكوين القيمي/الخلقي والجمالي. وإذا كان الإنسان منفرداً بالعقل وأنه ذو فكر وقدرة على التمييز، فإن العناية بتنمية طاقاته العقلية وجوانب شخصيته فكراً ووجداناً تكون الأساس، وهذا الأمر يكون تمامه وكماله بالتربية.
الإنسان ينفرد بانه مركّب من جسدٍ وروح ونفس، والجسد من طين أساسه التراب وإليه يعود بعد الموت والتحلّل، والروح والنفس من أصل غير مادي يؤهل الإنسان للإرتقاء والمعراج السماوي. والتربية لها الكلمة الفصل وبها يسمو الإنسان علوياً، أو ينحط إلى الأدنى فيقرب حاله من الدواب. فإن سما الفكر والمشاعر ارتقت بصاحبها إلى المستوى الملائكي، وإن التصق الفرد بالمطالب الغريزية وطغت على فكره وقوته العاقلة استحقّ الصفة التي حددها الله تعالى لأمثاله في الآية:﴿إن شرّ الدوابّ عند الله الصمّ البكم الذين لا يعقلون﴾ (الأنفال: 22 )
وقد عبر عن ذلك علي شريعتي بشكل لطيف، إذ قال: “الإنسان مخلوق من قطبين متناقضين، واحد: الطين، والآخر: روح الله، وهذا هو سرّ عظمة الإنسان. إنه كائن ذو بعدين، وموجود ذو قطبين متناقضين. ومن ثمّ وبفضل إرادته، يتمكّن من أن يتجه إما إلى بعده الأرضي وينشدّ إلى قطب التراب والترسّب. أو ينطلق في بعده السماوي ويصعد في قطب السّمو الإلهي والروح الإلهية.
يبدأ هذا الصراع والتجاذب بين القطبين داخل الإنسان، حتى يختار الإنسان أحدهما ويقرّر مصيره.”[17]
لكن اختيار الإنسان لأحد القطبين أو البعدين، يقوم على الخلفية الثقافية التي تربّى عليها، وكانت في أساس نشأته، لأن الطفل يولد على الفطرة وهي نقية صافية لا كدر فيها ولا شوائب، والاهل والمربون والمحيطون بالطفل هم من يغرس فيه جواذب باتجاه أحد القطبين: السماوي أو الارضي. هذا ما وجّه إليه الحديث النبوي الشريف: “ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.”[18]
وإذا كان موضوعنا هو التربية من منظور إسلامي فإن المطلوب أن تقوم العملية من مرجعية الإسلام دونما تسليم باستلاب الشخصية بواسطة منظومات غربية مستوردة، ودون انغلاق عن شؤون العصر وما حصل من تقدم تقني في عالم الآلة والأداة.
جاء في إحدى وثائق “المنظمة الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة”: “إأن مهمة التربية الإسلامية تتمثل في مساهمة في خلق مجتمع إسلامي أصيل يعرف كيف يستفيد من التطورات التقنية والفكرية التي يشهدها العصر الحالي دون أن يفرط في هويته الثقافية وشخصيته الإسلامية.”[19]
والتربية المجدية في إعداد الجيل هي تلك التي ترعى كل جوانب شخصية الفرد ولا تهمل جانباً دون آخر، فهي تربية تؤمن بالتكامل، وتقوم على أساس تكاملي. والإستراتيجية التي أقرتها “المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة” وقد وجهت إلى ذلك فجأة في نصّها: “يجب أن تعتبر التربية الإسلامية كل مكونات شخصية الفرد (الجانب الروحي والفكري والجسدي) على أنها متصلة ببعضها ومتكاملة فيما بينها بحيث إن أي خلل في إحداها قد يؤثّر على البقية وعلى شخصية الفرد بصفة عامة.”[20]
لقد اتخذ هذا البحث عنواناً يربط بين المنظومة القيمية وبين التربية الاصيلة في رحاب الإسلام، ويكون مفيداً أن يُعرف بأن هذه التربية تعتني بالقيم كلها لأن الشخصية السوية لا تكون بغير التكامل، واكتمال عقد القيم، والمربي الناجح لا يقبل أن يوجه إلى قيمة دون أخرى. هذه حال التربية الإسلامية وهذا هو المطلوب من العملية التربوية وفق منظومة قيمية تجمع بين الوحدة والتعدد قيمياً. فالقيمة وحدة قائمة لها اعتبارها، والقيمة منتظمة في عقد القيم وسلكها تنمو وتتألق.
تأسيساً على ما تقدم يمكن أن يقال التالي: “إن المنظومة التربوية هي ذلك الكل الذي يتألف من مختلف العناصر والمكونات والأركان التي يسهم كلّ منها في التخطيط للفعل التربوي، وفي صياغته وإنجازه، وتحويله إلى واقع ملموس، ومن البديهي أن المنظومة التربوية أصبحت على جانب كبير من التعقيد، بحيث تعدد أبعادها ومؤسساتها.”[21]
إلا أن العملية التربوية في العالم العربي والإسلامي تعاني من الإستيراد الذي أوجد المناهج التي تقلد ما هو قائم في الغرب وتواكبه دون أن تراعي الهوية الثقافية، والخصائص الحضارية، وهذا منحى له مردوداته السلبية، لذا تكون الحاجة لنظام تربوي أصلي ملحة وهذا ما لا خلاف حوله. وقد أشار إلى ذلك أحد التربويين قائلاً: “هنا يبرز دور التربية الإسلامية كضرورة ملزمة، حيث تعمل على تجذير وتأصيل الشخصية العربية الإسلامية في غير غياب لعملية التجديد المطلوبة، من الموقف النّدّي الذي يملك حرية الإختيار، ويستطيع الإبداع، لا مجرد التأثّر السالب؛ إن الأمرين مطلوبان لأن الإندفاع وراء التجديد والتحديث فقط يؤدي إلى نتيجة أسوأ من نتائج التخلف، والحياة في الماضي هو الإغتراب والإستلاب، وفقد المستقبل والماضي جميعاً دفعة واحدة، لذا فإن الملاذ الوحيد هو ما في القرآن الكريم والسّنّة المطهّرة من قيم وتوجيهات.”[22]
إن ما انتهى إليه الكلام هو الأساس للتربية والتربوي، فلا تربية صالحة ناجحة إلا إذا كانت لها مرجعية، والمشروع التربوي المنشود هو الذي يلوذ بحمى القرآن الكريم والسنة النبوية وبعدهما بالفكر المستنير والإجتهاد المتميّز إن من التراث أو ما هو معاصر وحديث مما خطته وتخطه الأقلام العاملة من أجل الإصلاح انطلاقاً من الموقع الحضاري الدائر في فضاء الإسلام، واما التغيير القائم على التنكر للدين والقيم والتراث المسمى الحداثة فإنه تدمير ليس بعده تدمير. وبمقابل ذلك لا تكون تربية وتربويون مسلمون في موقع ردة الفعل والإنغلاق في كهوف التراث، أو في أنفاق التعصب والفئوية، بل إن النظام التربوي الاصيل اسلامياً يقوم على التوازن وتقوده الحكمة ومقاصده بناء الشخصية السوية.
خلاصة القول: إن النظرية التربوية في الإسلام تشكل سفينة النجاة لأجيال الامة العربية والإسلامية، لا بل العالم كله لانها تتميز بمصدرها الشرعي، وقد دفع ذلك تربوياً مسلماً إلى القول وهو على الحق: “إن التصوّر الإسلامي في التربية تجاوز ذلك التخبط الرهيب، الذي ظلّ يلاحق النظريات الغربية؛ لأنه ينطلق من أسس واصول وفهم شامل حول الكون والإنسان والمجتمع بني على وحي ممن خلق الإنسان ويعلم حقيقته وجوهره: { ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير } (الملك: 14) وهو يتعامل مع الإنسان على بصيرة، بمكوناته كلّها، دون إغفال إحداها لصالح الأخرى؛ لأن مطبقيه يعلمون أن ذلك الإعفاء هو مدخل الخلل في الكيان البشري وانعدام التوازن فيه، وبالتالي إفلات الزمام تماماً من قبضة المربين الذين يتولون تنشئة الإنسان، وتعرّض هذا الأخير للدمار والانتكاس.”[23] ولأن أحداً لا يريد لأجياله الانتكاس والتقهقر فإن الانقاذ يكون في عملية تربوية مسارها منطلق في خط بياني يسير من مبادئ الإسلام إلى مقاصد الشريعة. لأن ما كان مصدره ربانياً لا يعتريه نقص، ولا يأتيه باطل من أية جهة من الجهات. هذا مفهوم التربية والتربوي في مشروع الأمة.
الأصلي والأصيل والتأصيل:
إن الأصلي خلاف الفرعي إذ الفرع منبثق عن الأصل دوماً. والأصلي ما كان متأصل الجذور في الأسس الخاصة لا ما يكون مزيجاً أصوله من منابع شتى. والتأصيل عمل يقوم به من يريد تقعيد العلوم وسائر الأمور على قواعدها، ومن يرد كل ثمرة إلى شجرتها الأم كي يضمن لها الحياة والنماء والديمومة.
ويقال في ميدان التعليم والتربية: التعليم الأصلي عند المسلمين، والكلام يكون عن مؤسسات التعليم التي قامت تاريخياً ولا تزال لها حضورها وإن تعددت التسميات فهي في المشرق الكتاتيب ومفردها: كتّاب. وفي السودان: الخلاوي ومفردها الخلوة وهي للصوفية وهم من يرعى التعليم الأصل في السودان. وفي موريتانيا: المحاضر ومفردها محضرة، وفي المملكة المغربية: التعليم العتيق. ويقال: المعاهد الشرعية لتمييزها عن معاهد لا تنطلق في عملها التربوي من الإسلام قرآناً وسنة، ويقال: الحوزات وهذا إسم يستخدمه الشيعة الإمامية. لكن رغم تنوع الأسماء فإن الأساس واحد وهو أن التعليم الأصلي يبدأ مع كتاب الله القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وبعدها تفسيراً وفهماً، وبعدها مع السيرة والحديث النبوي الشريف ومعهما اللغة العربية، ومن ثمّ الانتقال إلى سائر العلوم وأولها الحساب، وبعد ذلك ينتقل الطالب إلى تحصيل العلوم الأخرى حسب مؤهلاته واستعدادته ومقاصده كالفلك والطب، والهندسة وغيرها من العلوم.
ويتلازم في التعليم الأصلي التعليم مع التربية، فالشيخ الذي يدرس عليه الطالب يرعى الطالب في كل جوانب الشخصية صقلاً وتهذيباً، ويرافق الطالب شيخه كي يتعلم منه بناء لنظام القدوة وليس بالنظرية فقط. وأبرز خصائص التعليم الأصلي أو الأصيل عند المسلمين هي مسألة تلازم التعليم والتربية، وهذا عنصر أساسي في أي مشروع تربوي أصلي يقوم ضمن دائرة الإسلام وعلى هديه، بينما يجد المتابع أن نظام التمدرس المأخوذ عن الغرب يمارس الجميع فيه التعليم بلا تربية، وهذا ما يترك الناشئة في حالات من القلق والتيه كما أن هذا التمدرس لا يبدأ مع كتاب الله ليضع اللبنات الإيمانية الضرورية في نفس الطالب، وبذلك لا تبدأ مسيرة التعليم بتحقيق الصلة مع الله تعالى.
وعند اللغويين: “أصّله: قتله علماً فعرف أصله… الأصول: أصول العلوم: قواعدها التي تبنى عليها الأحكام، والنسبة إليها أصولي. الأصيل: من له أصل والمحكم الرأي.”[24]
وفي معجم آخر: “أصّل يؤصّل تأصيلاً: الشيء: جعل له أصلاً ثابتاً يبنى عليه أصالة الثقافة العربية، سماتها الأصيلة المميّزة. أصل الشيء: أساسه الذي يقوم عليه.”[25]
أما الراغب الأصفهاني فإنه قد قال: “أصل الشيء: قاعدته التي لو تُوهمت مرتفعة لارتفع بارتفاعه سائره.”[26]
إن هذه المعاني تبيّن أهمية التأصيل في كل موضوع، لأنه لا بد لكل علم من أصول يبنى عليها، وقواعد تضبطه وترتقي به، كما أن لكل علم ومشروع حضاري سمات تميّزه عن مشروعات أخرى، وسبب الاختلاف الهوية الثقافية. والبشر – كما هو معلوم – متفاوتون فهماً وقدرة وميولاً ومصالح، وهم مختلفون من حيث الثقافة المكونة للشخصية، لذلك لا يكون ممكناً أن نترك أمر العملية التربوية لما يميل إليه كل فرد، ولا أن نترك العشوائية حليفها لأن ذلك يحدث الإرباك وعدم الاستقرار.
والمشروع التربوي الأصلي يحتاج إلى تأصيل أساسه قواعد وثوابت مستمدة من الإسلام قرآناً وسنة واجتهادات. والتأصيل أمر ضروري لكل علم معرفة وابداعاً. قال ابن خلدون: “إن الحذق في العلم والتفنن فيه، والإستيلاء عليه، إنما هو يحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده، والوقوف على مسائله، واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفنّ الممتول حاصلاً، وهذه الملكة هي غير الفهم والوعي، لأنّا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد، ووعيها مشتركاً بين من شدا في ذلك الفن، وبين من هو مبتدئ فيه، وبين العامّي الذي لم يحصل علماً، وبين العالم التّحرير، والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون سواهما، فدل على أن هذه الملكة (التأصيل) غير الفهم والوعي.”[27]
فعلم الأصول حاجة لكل علم وفنّ، ولا يستقيم أي نوع من المعرفة أو العلم دون منهج له أصوله. والمشروع التربوي الأصلي لا يشذّ عن هذه القاعدة فبمقدار أصالته ورسوخ عناصر في الشريعة يسير في طريق امتلاك القدرة على العطاء، وإذا اجتثت جذوره ونأى عن الأصالة فإنه يصبح مشروعاً بلا مشروع وبلا مقاصد وغايات.
لقد جاء تصوير هذين الحالين في الآيتين التاليتين: “ألم تر كيف ضرب له مثلاً كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء * تؤتي كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون * ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ” (ابراهيم: 24 – 25 – 26)
فالشجرة المعطاءة المثمرة، والتي لا ينقطع عطاؤها إنما هي تلك التي تجذرت، ورسخت في الأصل الثابت، وأما التي اجتثت من فوق الأرض، ولم تتجذر في الأصل فإنها شجرة لا تستقر على حال، تتقاذفها الرياح في كل الاتجاهات.
تنطبق هذه الحالة على كل الميادين ومجالات الحياة، وأولها التربية، فالتربية الملتزمة بالأصول والثوابت هي كالشجرة التي يكون أصلها ثابتاً، فهذه التربية تقدم جيلاً صالحاً فاعلاً وواعداً بمستقبل أرقى، والمشروع التربوي الذي لا تأصيل له كالشجرة التي اجتثت من فوق الأرض، وكذلك يكون إنتاجه، فإنتاجه جيل تتقاذفه الأهواء ورياح التيارات، ولا يستقر على مسلك ولا على حال.
“نحو مشروع تربوي أصلي”؛ عنوان عماده الأصالة مع مرونة لمواكبة المعاصرة، والمشروع التربوي العربي الإسلامي لا مكان فيه للجمود والصنمية الفكرية، كما أنه لا يقبل التخلي عن التأصيل والثوابت.
تأسيساً على ما تقدم يقرر البحث القاعدة التالية: “إن الرجوع إلى الفكر العربي الإسلامي الأصيل، في بناء الفلسفة التربوية العربية، ليس مجرد رجوع إلى تراثٍ ماضٍ يجب الحفاظ عليه لتأكيد أصالة الفكر التربوي العربي المعاصر، بل هو رجوع إلى مصدر حيوي دينامي متجدد ومتطور على مر العصوروالأزمان، يمتلك من المرونة في مبادئه وقواعده العامة المتعلقة بتنظيم الحياة البشرية ما يجعله صالحاً لكل زمان ومكان… والدين الإسلامي الذي يستمد منه الفكر الإسلامي بجميع ضروبه ومجالاته أصوله، فيه من المبادئ والقواعد العامة الثابتة ما يصلح لكل زمان ومكان ويناسب البشرية على اختلاف أزمانها وظروفها، ويتناسب مع فطرة الإنسان الثابتة، ويزكي الفطرة ويحافظ عليها.”[28]
خلاصة القول: إن إعداد أجيال عربية ومسلمة بناء لتربية أصيلة مع مواكبة للتقدم تحتاج مشروعاً تربوياً أصلياً خاصاً، ولا تكون من خلال ثوب تربوي مستورد أو مستعار.
الفصل الثاني
المنظومة القيمية:
إن المنظومة القيمية التي يحتاجها مشروع تربوي أصيل لها وجوه وتجليات، وتقوم على أسس مركزية، وبعدها تتوزع في مكونات متعددة العناصر. وهي منظومة تتحول إلى فعل وممارسة، وليس من طبيعتها أن تبقى حبيسة في الذهن، أو مسطرة على أوراق، أو مسجلة على وسائل فقط معدّة لهذه الغاية. فالأساس في المنظومة القيمية في نظام تربوي إسلامي أنها تقرن العلم بالعمل، وتتلازم فيها التربية مع التعليم، وتتحول فيها النظرية إلى حيّز التطبيق والممارسة.
وتكون المنظومة القيمية في ثلاثة عناوين رئيسة هي: مركزيات المنظومة – مكونات المنظومة وعناصرها – ميادين ظهور المنظومة وأساليب تطبيقها.
مركزيات المنظومة القيمية:
المقصود بمركزيات المنظومة القيمية التي تشكل الوجه الأبرز في نظام تربوي إسلامي أصيل يحلّ مكان نظام غربي المصدر مادي الأسس، أنها الأسس التي يحتاجها تكوين شخصية الطالب المسلم الذي يشكل الغاية لهذا النظام، وهو المحور الذي من أجله يتمّ العمل كي تتوقف عملية الغزو الأجنبي من خلال المناهج التعليمية المستوردة أما الأسس التي يصح تصنيفها تحت عنوان المركزيات فهي:
- العقيدة؛ ومعها الأمان النفسي والتفكير والضمير والحرية:
الإنسان مفطور على حقيقة ذهنية هي التسليم بوجود قدرة خلقت الكون بكل ما فيه من كواكب وكائنات، وما تتكون على أساسه هذه الكونيات، وما يحكم مسارها من سنن وقوانين، وفضول الإنسان المبني على هذه الفطرة؛ فطرة إسلام الربوبية التي تبحث عن معرفة الخالق كي يتمّ إشباع هذا الفضول وتذهب إلى أحد اتجاهين:
- إتجاه سليم يناسب الفطرة، وهو الإيمان بالله تعالى وعبادته، وهو ما جاء به الإسلام وقبله رسالات السماء تحت عنوان: “عقيدة التوحيد”.
ب-إتجاه يذهب بأصحابه إلى الأوهام والأباطيل التي تفسد معها العقيدة، وتكون فيها العبادة لمظهر طبيعي أو لمخلوق أو لهوى.
وفطرة التدين إن سلمت من شوائب شطحات الفكر المادي، ونزعات الهوى المضلّ توصل دوماً إلى التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبودية.
جاء في النص القرآني: ﴿فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون.﴾ (سورة الروم: 30)
وإذا كان الإنسان مفطوراً على مطالب متعددة منها العضوي المادي، ومنها الأمان الإجتماعي، ومنها الأخلاقي الجمالي المرتبط بالمشاعر، إلا أن أهم هذه الفطر يبقى ما هو متعلق بالإيمان والعقيدة.
هذا ما دفع أحد المفكرين إلى القول: “ومن هذه الإحساسات الفطرية الصادقة فينا، إحساس الإنسان بوجود الخالق، وتلهّفه دائماً لمعونته وإمداداته، وشعوره بحاجة هذا الكون الكبير – في نظامه وأتقانه، وما فيه من إبداع، وحياة وموت – إلى قدرته وعلمه وحكمته سبحانه.
إنه شعور فطري تشترك بالإحساس به جميع الخلائق المدركة، على اختلاف نزعاتها، ومستويات ثقافتها: في البيئات البدائية، وفي المدن المتحضرة، وفي منتديات المثقفين، وفي قاعات العلوم والفنون والمختبرات.
إنه شعور مشترك بين جميع الناس: يقوم في نفس الطفل الصغير، والإنسان البدائي، والإنسان المتحضر، والجاهل والعالم، والباحث والفيلسوف، والعبقري والبدائي، والخبير في المعمل. كل هؤلاء يشعرون بشعور مشترك أن الله حقّ، وأنه القوة القابضة على ناصية كل شيء، العالمة بكل شيء، الحكيمة المريدة لا شكّ فيها.
هذه هي صبغة الله في كل مخلوق مدرك، وفطرته التي فطر الناس عليها.”[29]
العقيدة ضرورة لكل إنسان لأنه أمام التحديات العديدة التي تواجهه، أو يراقبها في غيره، يجد أنه لا بد من الخالق المتصف بالكمال والقدرة والعلم والحكمة كي يمد الإنسان وكل كائن بما يحتاجه، وما من إنسان أو شعب إلا وكان عندهم بحث عن خالق ومعبود (إله)، وأحياناً كان التفكير الخاطئ يوصل أصحابه إلى وضع تصور لإله يتجهون إليه بالتقديس والعبادة. وأما أصحاب الفطر السليمة فإنهم بواسطة الرسل ومن ورثهم من المبشرين والمنذرين قد اهتدوا إلى الإيمان بالله الواحد. والحقيقة الدامغة هي: “إن الإنسان دائماً في حاجة إلى الإيمان، والتدين، والعقيدة، وأن الدين من ضرورات حياته، وحاجة من حاجات نفسه، فلا غنى له عن الإيمان بربه، وعن عبادته بحال من الأحوال.”[30]
وعبادة الله تعالى تحقق للمؤمن عقدياً الإيمان بسائر أركان الإيمان مما لا مجال لبحثه في هذا الموقع، وإنما ما تحتاجه المنظومة القيمية لنظام تربوي من موضوع الإيمان هو أن العقيدة السليمة الموافقة للفطرة، وهذا ما يتحقق بالإسلام تحقق لصاحبها الأمور التالية: الأمان النفسي – الضمير – التفكير – الحرية.
أ- الأمان النفسي:
إن الإيمان الحق، والعقيدة السليمة يحققان للإنسان الأمان النفسي الذي يزيل كل قلق، فالمؤمن عنده توازن أمام كل الحالات التي يمرّ بها، فلا يبطر إذا جاءته النعمة، ولا يجزع عند المصاب، وإنما يأمل الأجر من الله تعالى.
والإيمان بالثواب الأخروي إن حُرم الإنسان من النصيب الدنيوي يسهم كذلك في توليد هذا الأمان النفسي فيبعد صاحبه عن الإنفعال والخوف. إن مسيرة الحياة فيها سعادة وفيها شقاء ومتاعب، وأمام الشدائد – مهما كان الإنسان بعيداً من العقيدة الإيمانية السليمة – تتحرك الفطرة فيتجه الإنسان إلى الله تعالى.
أمام العجز والقصور، وأمام الملمات والمصائب لا يتجه المصاب إلى عرض دنيوي، وإنما توجهه الفطرة إلى حيث يجب إلى الخالق القادر سبحانه. جاء البلاغ الإلهي حول هذا الأمر في الآية الكريمة: ﴿هو الذي يسيّركم في البرّ والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبةٍ وفرحوا بها جاءتها ريحٌ عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنّوا أنهم أحبط بهم دعووا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين.﴾ (سورة يونس: 22).
إن الإرتباط بالعهد مع الله تعالى يشعر الإنسان بالقوة، والشجاعة والثبات أمام المواقف الصعبة بحيث لا يخضعه سوى المشيئة الإلهية والقضاء الإلهي.
ويزيد في الأمان النفسي تلك البشارة بالخير للمؤمن في كل أحواله التي أبلغ عنها الحديث النبوي الشريف: “عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن إن امره كلّه له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً له.”[31]
إن المؤمن لا مكان عنده للهلع أو الجبن، أو الحسابات للأمور الصغيرة، وإنما يكون ذا عزم وإرادة لا يؤثر فيه تهديد بشري، والأصل عنده أنه ثابت بإيمانه. قال تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.﴾ (سورة آل عمران: 173).
جاء عند القرطبي حول هذه الآية: “قال أبو معشر: دخل ناس من هذيل من أهل تهامة المدينة، فسألهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سفيان، فقالوا: قد جمعوا لكم جموعاً كثيرة فاخشوهم، أي فخافوهم، واحذروهم، فإنه لا طاقة لكم بهم… قوله تعالى” (فزادهم إيماناً)، أي: فزادهم قول الناس إيماناً، أي: تصديقاً ويقيناً في دينهم، وإقامة على نصرته، وقوة وجراءةً واستعداداً.”[32]
هذه الحال تكون لكل من كانت بنية شخصيته مؤسسة على الإيمان الحق، فالمؤمن الصادق لا مكان للخوف عنده، وإذا ازدادت عليه التحديات وأنواع البلاء، فإن ذلك يزيده رسوخاً في إيمانه، ويؤمن بأن الله تعالى يكفيه من كل شر أو خطر.
وكتاب الله تعالى؛ القرآن الكريم، له فعله في نفس المؤمن، وتلاوته والإنصات له تزيل كل حزن، وتثبت المؤمن، وتجعل إيمانه مضاعفاً فيتحول ذلك به إلى الفعل والعبادة. قال تعالى معرفاً المؤمنين: ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون.﴾ (سورة الأنفال: 2).
لقد “وصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوف والوجل عند ذكره. وذلك لقوة إيمانهم ومراعاتهم لربّهم، وكأنهم بين يديه.”[33]
إن الأمان النفسي لا يتحقق إلا بزيادة الإيمان وأن يكون يقيناً مستقراً في قلب المؤمن، ويكون مع ذلك دوام الذكر، والثمرة طمأنينة تصل بصاحبها إلى درجة التمكين. هذا الشخص المطلوب في النظام التربوي الأصيل إنه شخص تأصل الإيمان في نفسه، وصفا قلبه بذكر الله فاطمأن. قال تعالى: ﴿الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.﴾ (سورة الرعد: 28).
“يهدي الله الذين آمنوا… (وتطمئن قلوبهم بذكر الله) أي: تسكن وتستأنس بتوحيد الله… وهم تطمئن قلوبهم على الدوام بذكر الله بألسنتهم… وقال ابن عباس: بالحلف باسمه، أو تطمئن بذكر فضله وإنعامه، كما توجل بذكر عدله وانتقامه وقضائه، وقيل: (بذكر الله) أي: يذكرون الله ويتاملون آياته، فيعرفون كمال قدرته عن بصيرة.”[34]
تأسيساً على ما تقدم يكون الإيمان اليقيني مع الذكر سبيلين إلى الاطمئنان والامان النفسي، وهذا الأمان مرتكز أساسي للشخصية السوية.
ب- الضمير:
إن الضمير حالة من الرقابة الداخلية تتكون داخل الحياة النفسية لكل فرد، وتكوينها يكون بالتربية على روح المسؤولية من جهة، وعلى ترسيخ المثل الأعلى النابع من المنظومة القيمية التي ينشأ عليها الطالب في الأسرة والمدرسة وما يشاركها في التوجيه والتثقيف.
جاء في “لسان العرب”: “الضمير: السّرّ وداخل الخاطر، والجمع: الضمائر. الليث: الضمير: الشيء الذي تضمره في قلبك.”[35]
وفي “معجم النفائس الكبير”: “الضمير: قلب الإنسان وباطنه – و – استعداد نفسي لإدراك الخبيث واستقباحه، وإدراك الطيّب واستحسانه.”[36]
أما الراغب الأصفهاني فإنه يعرف الضمير قائلاً: “والضمير ما ينطوي عليه القلب ويدقّ على الوقوف عليه، وقد تسمّى القوة الحافظة لذلك ضميراً.”[37]
إن المنظومة التربوية تحتاج إلى السهر على هذه القوة التي تسمى الضمير، لأنها تشكل الرادع أو المحفّز للإنسان أمام المواقف كلها، وهو الذي يتولى إطلاق الأوامر بالفعل، أو النهي عن فعل، وعندما يتعرض الإنسان لموقف يحتاج قراراًً تبدأ عنده عملية الإدراك والمعرفة، ومعها الموازنة والإستعراض، وكل ذلك يحتاج للمعايير قبل الإرادة والقرار والفعل، وهنا يكون دور الضمير في اتخاذ القرار المبني على معايير وقيم. وأما من نشأ ولا قيم ولا ضمير له ولا مرجعية فكرية فإن مواقفه تكون عشوائية، وفي أحسن الاحوال تستند إلى المصالح والمكاسب، ولا تعنيها المبادئ أوالمنظومات القيمية، وهذا ما يسمى الفلسفة البراجماتية (paragatisme) بالعربية يقال لها: الذرائعية، وهي فلسفة تحكم السياسة والإجتماع ثقافياً في الولايات المتحدة الاميركية، من أوائل من نظّر لها الأمريكي تشارلز بيرس (1839 – 1914)، ووليام جيمس (1842 – 1910)، وجون ديوي (1859 – 1952) وسواهم.تطورت الفكرة حتى وصلت إلى المفهوم التالي: تسخير الافكار والمبادئ للغايات والمقاصد التي يريدها صاحب السلوك. ويصح في هذه المدرسة الفلسفية أن يقال فيها: إنها تنشر ثقافة تربوية الرتبة الأعلى فيها هي للمصالح.
لذلك تكون مثل هذه المدارس نقيض ما تريده منظومة قيمية لنظام تربوي أصيل نابع من الإسلام عقيدة وشريعة. وهذا يكون معه التحذير للمهتمين بالعملية التربوية الذين استوردوا دون تمحيص نظريات في علم النفس والتربية مثل البراجمانية (الذرائعية) أو سواها من المدارس كالتجريبية (empirisme) التي تعدّ الإحساس والخبرة الحسية مصدراً وحيداً للأفكار، أو كالسلوكية Béhaviorisme التي لا تقيم وزناً للحياة النفسية عند الفرد، وتقف عند ظاهر السلوك، وأن كل فعل يؤديه الإنسان إنما هو استجابة أو ردة فعل لمثير أو مؤثر خارجي، ولم تلحظ السلوكية دوراً للإدراك الذي يلي المثير ويسبق الإستجابة.
التحذير من الإستيراد العشوائي لنظريات مادية المنطلقات أو مصلحية لا قيم فيها، لأن تطبيق نظام تربوي على أساس منها سيجعل الناشئة في حيرة من أمرهم، وسيخلق عندهم ازدواجية في الشخصية تكون نتائجها خطيرة لأنها ستقدم للأمة جيلاً قلقاً ضائعاً بين المنظومات والنظريات المتعددة المصادرة، لا بل المتناقضة المصادر.
إن الضمير يتكون بداية من الإجابة عن سؤالين هما: من أنا؟ وماذا أريد؟ لأن تحديد الهوية والإنتماء يؤمن معرفة الذات، وبعدها يكون تحديد المقاصد والغايات وهي الجواب على السّؤال الثاني: ماذا أريد؟
فالطالب المسلم يحتاج العقيدة والشريعة ليبني عليها مكونات قوة الضمير، ويكون ذلك تربوياً “حالما يختار الطفل مثله الأعلى، ونماذج القدوة، فإنه يتساءل ما هو إذن العمل الصحيح الذي يجب أن أفعله؟ وهنا يبدأ ضميره في توجيهه وبدون تطوير مقياس الضمير يصعب نمو القيم الأخلاقية وتعاني التربية الحديثة من فشل ذريع في تطوير هذا الضمير عند الطفل بسبب غياب الشعور بالمسؤولية أمام قوة حقيقية يحسب الفرد لها حساباً حقيقياً.”[38]
تكمن عند هذا الواقع مركزية العقيدة في بناء منظومة قيمية للنظام التربوي لأن عقيدة التوحيد مع قيم مصدرها الإسلام تشكل دفقاً من مشاعر المسؤولية دنيوياً وأُخروياً أمام الله تعالى تتابعه في كل موقع وموقف، وهذا النوع من الإحساس الرقابي يسمى الضمير الديني الذي هو أقوى من أية رقابة أو ضمير او إحساس بالمسؤولية.
تحتاج المنظومة القيمية إلى تربية تتجه بالناشئة باتجاه درجة الإحسان. والإحسان حسب الحديث النبوي الشريف: “أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك.”[39]
إن للعقيدة أثراً حاسماً في الضمير والأخلاق لأن الإنسان الذي فُطر على الإجتماع البشري لا تستقيم حاله بلا قيم نابعة من العقيدة. “وفي مراقبتنا لتاريخ العلاقات البشرية نلاحظ أنه قد تحركت الدوافع منذ وعي الإنسان على ما حوله، إلى ضرورة السلوك وفق ضوابط يستمدها من عقيدته وتربيته ومحيطه. ولذلك فإن سلامة العقيدة، وحسن الإلتزام بأسسها، هي السبيل إلى سلامة الأخلاق، لأن الضمير، وهو الرقيب الذاتي الكامن في كل إنسان، هو قوة معنوية تتشكل من مجموع المفاهيم التي تحكم عقيدة المرء وقناعاته، وانطلاقاً من هذا التكوين الشخصي يمكن أن يحدّد عند كل فرد نوع الضمير.”[40]
ج- التفكير:
التفكير ما يتميز به الإنسان عن سائر المخلوقات، وهو صادر عن نعمة العقل المخلوق الأكرم عند الله تعالى. وبواسطة التفكير يعرف الإنسان نفسه، ويعرف ربه تعالى، ويعرف من الكون المحيط به مخلوقات وقوانين وسنناً مما يستطيع أن يعرف اكتساباً مما توصل إليه غيره، أو اكتشافاً مما توصل إليه هو.
والتفكير هو حالة داخلية يتفاعل فيها الإنسان المفكر مع ذاته، ومع منبهات الكون الذي يعيش فيه، ومنه مثيرات صادرة عن تحديات وظروف تطرأ أو تتبدل، وهو في كل ذلك يجد نفسه إن كانت قد بنيت مقومات شخصيته على أسس عقدية سليمة موافقة للفطرة، وقد اتجه إلى القدرة المطلقة، والكمال المطلق، والإرادة المطلقة؛ أي أنه يتجه إلى الله الواحد القادر المريد المنعم المدبر، فيقوده بذلك التفكير القويم إلى العقيدة السليمة. وهذه ركيزة مهمة في تكوين شخصية الطالب المسلم، وخلاف ذلك منهج تربوي غير إسلامي يتحرك فيه التفكير باتجاه الاكتساب المعرفي أو الاكتشاف والبحث لكن دون وجود بعد إيماني عقدي فتلتصق اهتماماته بالدنيويات والكونيات المحيطة، ولا يخرج من قيودها ليرتقي في معراج روحي باتجاه علوي ليصل إلى العهد مع الله وإلى الدين القيّم.
ما هو التفكير والفكر عند اللغويين؟ جاء في “معجم مفردات ألفاظ القرآن”: “فكّر: الفكرة قوة مطرقة للعلم والمعلوم، والتفكير جولان تلك القوة بحسب نظر العقل وذلك للإنسان دون الحيوان، ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب، ولهذا روي: (تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله إذ كان الله منزهاً أن يوصف بصورة)… قال بعض الأدباء: الفكر مقلوب من الفرك لكن يستعمل الفكر في المعاني وهو فرك الأمور وبحثها طلباً للوصول إلى حقيقتها.”[41]
أما “معجم النفائس الكبير” فقد ورد فيه: “فكر: فكر في الشيء… أعمل النظر فيه وتأملّه… التفكير: قصد و عمل العقل الذي يفحص ما يجول فيه من أفكار وخواطر وصور، ينظر فيها ويقابل بينها، يقال: استغرق في التفكير. و- تكوين الرأي. و- إعمال العقل في قضية بغية التوصل إلى حلّها… الفكر: تردد القلب بالنظر والتدبر بطلب المعاني، ج أفكار. لي في الأمر فكر أي: نظر وروية مالي فيه فكرٌ وفكرٌ أي: حاجة، والفتح أفصح. وفي الأساس يقال: لا فكر لي في هذا: إذا لم تحتج إليه لم تبال به… والفكرة، أيضاً: الصورة الذهنية لأمر ما.”[42]
وجاء في “لسان العرب”: “فكر: الفكر والفكر: إعمال الخاطر في الشيء… جوهري: التفكر: التأمل… قال يعقوب: يقال: ليس لي في هذا الأمر فكر، أي ليس لي فيه حاجة.”[43]
إن تقليبات المعاني للفكر والفكرة والتفكير في المعاجم تبين مكانة التفكير في شخصية الإنسان، وفي البحث والاكتشاف، وفي العقيدة ومعرفة الله تعالى بالنظر العقلي والتأمل في الكون وفي الذات، ولذلك يكون التفكير من تجليات العقيدة، وهو فريضة لا يكون نظام تربوي ولا تعليم بدونها.
لقد أكد النص القرآني على موقع التفكير في السبيل إلى معرفة الله، وفي تدبير أمور الحياة، وفي العبادة والسعي والعمل، وفي كل ميدان من ميادين الحياة للفرد أو للمجتمع. ومن الآيات الكريمات التي جاءت بهذا الصدد؛ قوله تعالى: ﴿كذلك يبيّن الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.﴾ (سورة البقرة: 219). وقوله تعالى: ﴿ قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.﴾ (سورة الانعام: 50). وقوله تعالى: ﴿أو لم يتفكروا بأنفسهم.﴾ (سورة الروم:8).﴿الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض.﴾ (سورة آل عمران: 191). وقوله تعالى: ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.﴾ (سورة الحشر: 21). وقال الله تعالى: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق أو لم يكفِ بربك أنه على كل شيء شهيد.﴾ (سورة فصلت: 53).
التفكير هنا في الآية الأخيرة يتجه إلى الكون والكائنات والسنن، أو يتجه إلى النفس والمكونات في الإنسان جسداً وروحاً ونفساً، وهذا سبيل لمعرفة العالم وأنظمته وللإكتشاف والابتكار العلمي من جهة وللوصول إلى معرفة الله تعالى من خلال آياته. وهناك سبيل آخر هو تحريك الفطرة السليمة لتحس من ذاتها؛ أي من النفس وما فيها من نقص وحاجات بأن الله تعالى موجود، وبذلك تعرف الله تعالى مباشرة من التأمل والفطرة، ومعرفة الله تعالى تقود إلى البحث والنظر في العالم والمخلوقات. لكن في الحالين معاً هناك ارتباط بين العقيدة والعلم، ولا يتحقق ذلك إلا بالتفكير والنظر العقلي، وعندها يصبح القرار: لا نظام تربوي ناجح دون تفكير مبني على العقيدة.
وإذا كان الإتجاه هو لصياغة مشروع تربوي إسلامي أصيل، فإن قيمة التفكير من ركائز هذا المشروع، وهذا يوجب إصلاح التفكير، وتنزيه الفكر عند المعلم والطالب مما يعلق به إذ التفكير عند النظام التربوي الإسلامي معني بالدنيا والآخرة، وبالعقيدة والعبادات كما هو معني بالماديات والصناعات والاكتشافات.
وقد كان موفقاً محمد الطاهر بن عاشور في بيانه التالي: “أما إصلاح التفكير المبحوث عنه هنا فهو التفكير فيما يرجع إلى الشؤون في الحياة العاجلة والآجلة لتحصيل العلم بما يجب سلوكه للنجاح في الحياتين كي يسلم صاحبه من الوقوع في مهاوي الأغلاط في الحياة العاجلة وفي مهاوي الخسران في الحياة الآخرة.”[44]
ويقول كذلك: “إن كل فرد مأمور بصحة التفكير في دائرة ما يحتاجه من الأعمال تفكيراً يعصمه من الوقوع في مهاوي الأخطاء سواء كان ذلك فيما يصدره عنه من الأعمال الضعيفة، أم كان فيما يتلقاه من التسيير الذي يسيره به من له حق تسييره كذلك، فالمقدار الذي يستطيعه من التفكير يجب عليه تصحيح تفكيره فيه، والمقدار الذي لا يستطعيه يجب عليه تطلب الإعانة فيه بمن يبلغه إلى الحق الصحيح فيه من أهل الإرشاد في ذلك الباب.”[45]
هذا هو منهج التفكير فهو اكتساب وإعمال نظر شرط أن يكون التلقي من أهل الذكر والعلم، والتأمل شاملاً لكل جوانب مكونات الشخصيات، ولكل يحقق منظومة قيمية تحقق سعادة الدارين الدنيا والآخرة.
د- الحرية:
الحر خلاف العبد، والحرية نقيض العبودية. وقد باتت مفردة الحرية من المفردات الواسعة الإنتشار، والكثيرة الإستخدام، وينسبها المستخدمون لها إلى أمور كثيرة منها: حرية الإعتقاد – حرية الفكر، حرية التعبير وإبداء الرأي – حرية التصرف بالممتلكات – الحرية الإقتصادية… الخ.
والحرية في العقيدة – هي موضوع الحديث – لا تعني حرية الإنسان في اختيار معتقده ودينه، وهذا أمر مضمون إذ القاعدة هي ما جاء في قول الله تعالى: ﴿لا إكراه في الدين﴾ (سورة البقرة: 256).
وإنما المقصود هو أن العبودية لله تعالى، وعقيدة التوحيد يحققان للمؤمن الانعتاق من القيود الدنيوية، فالإنسان المؤمن لا مكان عنده للخضوع لغير الله تعالى، وهو إنسان يتمرد على المطالب المادية والشهوات، ويتحرر من قيود الكميات والمقادير والحاجات المادية ليكون فكره مشغولاً بالتفكر في عظمة الله تعالى وقدرته ونعمه، وإن فكر بالكون المحيط به فإنما يتخذ ذلك معراجاً إلى الله تعالى.
فالمؤمن حرّ يدين لله تعالى ويخضع له، وحريته ليست حالة من الفوضى، ولا هي عبث وعشوائية، وإنما حريته تقترن بإلزام ذاتي تمليه العقيدة، إنه إلزام المؤمن نفسه بما أمر به الحق سبحانه في الشرع، والامتناع الإرادي عما نهى جلّ وعلا.
وإذا كان عند الإنسان نوعان من الأفعال: الفعل التكويني، والفعل التكليفي، فإن الحرية من النوع الأول، أي في الأصل التكويني لكل إنسان، وبذلك تكون حقاً يتساوى فيه الجميع لكن الحرية المبنية على عقيدة التوحيد حرية مسؤولة، أي أن صاحبها يبني أفكاره ومواقفه وأفعاله على أساس من الانضباط والوقوف عند حدود الأنا واحترام حدود الآخر، أو ما يسمى منظومة الحقوق والواجبات.
“الحرية بهذا المعنى حق للبشر على الجملة لأن الله لما خلق للإنسان العقل والإرادة، وأودع فيه القدرة على العمل فقد أكنّ فيه حقيقة الحرية وخوّله استخدامها بالإذن التكويني المستقر في الخلقة.
ولما كان أفراد البشر سواء في هذا الإذن التكويني كل على حسب استطاعته، كان إذا توارد عدد من الناس على عمل يبتغونه ولم يضايق عمل أحدهم مراد غيره بقيت حرية كلّ خالصة سالمة عن المعارض فاستوفى ما يريد كالذي يقيم منفرداً في مكان. ولكن إذا تساكن الناس وتعاشروا وتعاملوا طرأ بينهم تزاحم الرغبات فلم يكن لأحد بدّ من أن يقصر في استعمال حريته وعياً لمقتضيات حرية الغير.”[46]
إن هذه الحرية المسؤولة هي خلاف الاستبداد والاستعباد، والحرّ مقاوم دائم لكل طاغية وطغيان، ولكل مستبد واستبداد، وأكثر ما يحفز الإنسان على هذه المقاومة إيمانة وعهده مع الله تعالى بأن يحفظ كرامته وكرامة غيره، فلا يذل لأحد من العباد، ولا يجعل من نفسه عبداً لمطلب من مال أو منصب أو مصلحة.
والطغاة لا يزعجهم أن يتسابق الناس على المصالح والمكاسب، ولا أن يكونوا من نهازي الفرص، كما أنهم لا يجدون خطراً على سلطانهم الإستبدادي إذا أدى الإنسان عبادته وفروضه الدينية، لكن ما يخيفهم أن يعرف المؤمن حقيقة توحيد الله تعالى، وحقيقة الفطرة والأساس التكويني للإنسان، وأن يعرف حقوقه وأن يعرف الجهاد ورفع الظلم، كل هذه تقلق المستبد، ولذلك يعمل على إطفاء جذوة العلم الموقظ للهمم، والذي تنفسح من خلاله الطموحات والآمال.
إن عقيدة التوحيد القائمة على عبودية لله تعالى تحرر الذات عند المؤمن، وهي أرقى مستويات الحرية، بينما العبودية لغير الله تعالى والخضوع لأي مخلوق يؤديان إلى تحطيم الذات الإنسانية وإهدار الكرامة، والمعادلة هي: كلما تحققت العبودية لله تعالى عند إنسان كلما ارتقى باتجاه الكمال الإنساني.
أمّا مقاوم الاستبداد والاستعباد، وداعية العدل والتحرر عبد الرحمن الكواكبي (ت 1320 هـ / 1902م)، فإنه يقول عن الإرتباط بين الإسلام والحرية: “إن الإسلامية مؤسسة على أصول الحرية برفعها كل سيطرة وتحكّم، بأمرها بالعدل والمساواة والقسط والإخاء، وبحضّها على الإحسان والتحابب.”[47]
إن المستبدين يخافون العلم والعلماء، ويخافون أصحاب العقول المستنيرة، والعقيدة السليمة لأن من عرف دلالة الشهادة لا إله إلا الله واستنار عقله يكون متحرراً متمرداً لا يخاف في الله تعالى لومة لائم، ويفيد أن يكون المرجع هو عبد الرحمن الكواكبي الذي قال: “قال المدققون إن أخوف ما يخافه المستبدون الغربيون من العلم أن يعرف الناس حقيقة أن الحرية أفضل من الحياة، وأن يعرفوا النفس وعزّها والشرف وعظمته، والحقوق وكيف تحفظ والظلم وكيف يرفع، والإنسانية وما هي وظائفها، والرحمة وما هي لذتها.
أما المستبدون الشرقيون فأفئدتهم هواء ترتجف من صولة العلم، كأن العلم نار وأجسامهم من بارود. المستبدون يخافون من العلم حتى من علم الناس معنى كلمة (لا إله إلا الله) (لا يستحق الخضوع شيء غير الله).”[48]
إن العقيدة عقيدة التوحيد بهذا المعنى تعلم الإنسان الحرية، وواجب من يخططون المناهج التربوية، ومن يصوغون المقررات، ويعدّون المدرسين، أن ينتبهوا إلى هذه الحقيقة، وإلى هذه القيمة المركزية يحتاج المنهج التربوي الأصيل لأن قيمة الحرية تعلم الرقي والسمو، وتعلم الثورة والعمل للتغيير، وتنزع من النفس كل ركون للظلم أو ميل إلى الإستسلام.
كما أن الحرية ضرورة تربوية لأنها ركيزة الإبداع وأسّه، ومنطلق الابتكار والمحفزة إليه، ومحركة الهمم إلى البحث والإكتشاف. أن أي منهج تربوي لا يعطي مساحة كافية للحرية لا يكون مناسباً للإسلام وعقيدة التوحيد. فالعبيد يتقنون حمل الحجارة، ولا يستطيعون صناعة التقدم والرقي والازدهار.
وإذا كانت الحرية مطلباً فإن أول أنواعها التي تقوم عليها الشخصية السوية هي حرية العقيدة. “تبدأ حكاية حقوق الإنسان أول ما تبدأ من حرية الاعتقاد، حيث أن الله تعالى وهو ربّ الناس، خالقهم ومالكهم، بيّن لهم سبحانه طريقي الشكر والكفر، وترك لهم أن يختاروا سبيل الإيمان أو الشرك، لأن محاسبة الإنسان في اليوم الآخر تستوجب أن تكون له حرية الاختيار.”[49]
تأسيساً على ما تقدم يتبيّن موقع الحرية في المنظومة القيمية الضابطة لنظام تربوي أصيل، ولا تربية صالحة دون عقيدة وحرية أساسها الاختيار وحق حرية الاعتقاد وما يتبعها من حريات أخرى.
- الإنسان:
الإنسان هو المخلوق الأكرم عند الله تعالى، وقد حباه الخالق من النعم والعطاءات ما لم يكن لسواه من الكائنات، وأبرز ما يسمو به الإنسان القوة العاقلة والناطقة حيث يمارس بواسطتها المعرفة والإدراك والوعي والتمييز والإرادة والاختيار والترجيح وإطلاق الأحكام والمواقف، ناهيك عن أن هذه القوة العاقلة تمكن الإنسان من الإستجابات لكل ما يتعرّض له من تحديات بيئية أو اجتماعية أو صحية بيولوجية، ولكل ما يعرض له من مشكلات تحتاج المخارج والحلول والمنافذ.
ونعمة القوة العاقلة هي التي تمكن الإنسان من ترويض نفسه وقواه الشهوانية والغضبية التي تجلب الانفعالات، وهذا يقوده إلى المنافسة وتحصيل الفضائل وممارستها. فكمال الإنسانية في الفكر ينطلق من العناية بهذه القوة المفكرة.
قال يحيى بن عدي (ت 974 م): “إعلم أن الإنسان، من بين سائر الحيوان، ذو فكر وتمييز، وهو أبداً يحبّ من الأمور أفضلها، ومن المراتب أشرفها، ومن المقتنيات أنفسها، إذا لم يعدل عن التمييز في اختياره، ولم يغلبه هواه في اتباع أغراضه.
وأول ما اختاره الإنسان لنفسه، ولم يقف دون بلوغ الغاية منه، ولم يرض بالتقصير عن نهايته، تمامه وكماله. ومن تمام الإنسان وكماله أن يكون مرتاضاً يمكارم الأخلاق ومحاسنها، ومتنزهاً عن مساوئها ومقابحها. آخذاً في جميع أحواله بقوانين الفضائل، عادلاً في كل أفعاله عن طرق الرذائل.”[50]
الإنسان مخلوق مكلّف لأنه منح نعمة العقل، ولأن الله تعالى أعطاه ما لم يعط سواه، وبعدها منّ عليه ببعثة الأنبياء والرسل ليحملوا له شرع الله تعالى فمتى كان الإنسان سوياً عاقلاً وجاءه البلاغ فلا ذريعة له بأن لا يكون ملتزماً بالطريق القويم.
ويحتاج النظام التربوي، والمنظومة القيمية الحاضنة له أن يعرف المعنيون بإعداد المناهج والتخطيط لها. ومن ثمّ من يسهرون على إعداد الجيل من الأهل والمربين أن الإنسان له خصوصيات تتمحور فيما يلي:
أ- الإستخلاف:
إن الله تعالى استخلف الإنسان في الأرض، وهذا الإستخلاف مقرون بإعطاء الإنسان العلم بالأسماء والمسميات، ومقرون بتحديد السبيل التي هي إما التسبيح والحمد والطاعة للخالق سبحانه، وإما المعصية والإفساد وسفك الدماء، وهذا ليكون الإنسان مسؤولاً أمام الله تعالى.
النص القرآني هو: ﴿وإذا قال ربّك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس له قال إنّي أعلم ما لا تعلمون * وعلّم آدم الأسماء كلّها ثمّ عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين * قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إنك أنت العليم الحكيم.﴾ (سورة البقرة: 30، 31، 32).
استخلف الله تعالى الإنسان في الأرض، وأعطاه العقل وبعده أنزل له الرسالة والشريعة، وترك له حرية الإختيار بين طريقين هما: طريق العبادة والطاعة والتسبيح والحمد، أو طريق الفساد وسفك الدماء. وكي يكون التكليف لا بد وأن يسبقه العلم كي يستطيع الإنسان حمل الأمانة وقيادة العالم، ولكي يستطيع التعامل مع من حوله وما حوله كان لا بد له من سلاح العلم، وهكذا كان حيث وهب الله تعالى آدم العلم باللغات والأسماء والوقائع والاحتياجات، وهذا ليس إلا للإنسان.
لذلك كان تكوين الفرد تربوياً هدفاً رئيساً لأن الاستخلاف تكليف لا تشريف تترتب عليه واجبات ومسؤوليات لا تستقيم الحياة دون القيام بها. لا بد لهذه الغاية من إعداد الفرد المستخلف بوصفه عضواً في جماعة الأمة لا على أنه معزول لوحده.
وقيمة الإستخلاف ضمن المنظومة التربوية قيمة أساسية، ويفيد ترك التعبير عنها للمصلح الجزائري مالك بن نبي الذي قال: “إن الحل الوحيد منوط بتكوين الفرد الحامل لرسالته في التاريخ، فقد صار مؤكداً أن التركة الكبرى التي ورثنا عنها جيلاً من المتعالمين، ورثنا عنها التنافس على المقاعد الأولى، حتى لجان الإنقاذ في كارثة فلسطين في البلاد الإسلامية، كل هذه الفضائح التي يغذيها الإستعمار بكل عناية، لا يمكن أن نضع لها حداً إلا بتحديد الثقافة، وإن الإماكانات البسيطة في البلاد الإسلامية لتسمح لنا بأن نحقق هذا التحديد، سريعاً، وأن نكوّن القيادة الفنية التي نحتاج إليها الآن.”[51]
الإنسان الخليفة لا يستطيع إتمام استخلافه إلا بالعلوم والمعارف كما كان أمر تزويد آدم عليه السلام بها، يضاف إلى ذلك أن يعتمد هذا الإنسان منهجاً تربوياً تغييراً مؤصلاً على النص القرآني، ومنه قوله تعالى: ﴿إن الله لا يغيّر ما يقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم.﴾ (سورة الرعد:11).
ب- أحسن تقويم:
إن الله تعالى أعطى الإنسان في التكوين ما لم يعطِ لأي مخلوق آخر. وقد أبلغت بذلك الآية الكريمة: ﴿ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.﴾ (سورة التين: 4).
جاء عند القرطبي في تفسير هذه الآية: “قيل: المراد بالإنسان آدم وذريته. {في أحسن تقويم} وهو اعتداله واستواء شبابه؛ كما قال عامّة المفسّرين، وهو أحسن ما يكون؛ لأنه خلق كل شيء منكباً على وجهه، وخلقه هو مستوياً، وله لسان ذلق، وأصابع يقبض بها.
وقال أبو بكر بن طاهر: مزيّناً بالعقل، مؤدياً للأمر، مهدياً بالتمييز، مديد القامة، يتناول مأكوله بيده.
ابن العربي: ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان، فإن الله خلقه حيّاً عالماً، قادراً مريداً متكلماً، سميعاً بصيراً، مدبّراً حكيماً.”[52]
وعند القرطبي كذلك: “إن الإنسان أحسن خلق الله باطناً وظاهراً، جمال هيئة، وبديع تركيب: الرأس بما فيه، والصدر بما جمعه، والبطن بما حواه، والفرج وما طواه، واليدان وما بطشتاه، والرجلان وما احتملتاه. ولذلك قالت الفلاسفة: إنه العالم الأصغر؛ إذ كل ما في المخلوقات جُمع فيه.”[53]
كل هذه الصفات والقدرات المتنوعة التي أعطيت للإنسان ومنها البدني، ومنها العقلي، ومنها ما يتعلق بالمشاعر والحياة النفسية، لم تكن لغير الإنسان المستخلف في الأرض.
والإنسان الذي خلقه الله تعالى في أحسن تقويم، وغمره بالنعم والعطاءات عليه أن يكون بسبب ذلك عبداً شكوراً، وعابداً طائعاً. وأما القوام المتميّز فإنه يلقي على كاهل الإنسان بسبب ذلك الكثير من المسؤوليات والأعباء. والإنسان مؤهل لحملها لأنه أعطي الكيان العضوي المتميّز، والقدرة العقلية مع الأحاسيس والمشاعر، وما كان ذلك إلا للإنسان.
أما النظام التربوي الأصيل فعليه أن يرعى ويحضن الطالب الذي هو بالنتيجة إنسان، والواجب أن يفهم الطالب واجباته تجاه ما جاءه من مِنح، أولّها أنه أحسن المخلوقات وأكملها تكويناً.
وهذا الإنسان المخلوق في أحسن تقويم واجبه أن يحافظ على نفسه لأن نفسه وبدنه أمانتان لا يجوز أن يفرّط بهما، وعليه أن يزكي نفسه، ويؤمن مطالب بدنه بما يحقق التقويم الأحسن تنفيذاً لمشيئة الله تعالى. وأما الآخرون فواجبهم أن يحافظوا على الإنسان وأن يؤمنوا له كل ما يحقق له القاعدة القرآنية {في أحسن تقويم}، وأما من يفرط بقوام الإنسان وآدميته فقد ورد في حقّه أثر إسلامي هو: “الإنسان بنيان الله ملعون من هدمه.”
ج- التكريم:
قال الله تعالى: ﴿ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيّبات وفضّلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً.﴾ (سورة الإسراء: 70).
إنها إرادة إلهية جعلت الإنسان مكرّماً مفضلاً على سائر المخلوقات، وهذا التكريم الذي تساق بشأنه مبررات كثيرة أمر ملزم لكل إنسان؛ والإلزام هو أن يحفظ كرامته الإنسانية، وأن يحافظ على كرامة كل إنسان أيّاً كان انتماؤه ولونه وقوميته ومعتقده ومذهبه واختصاصه وعمله، وقد عبّر عن ذلك الشاعر أحمد شوقي في شطر من بيت في قصيدته الهمزية، حيث قال: “فالكل في حقّ الحياة سواء.”
وقد ذكر القرطبي في تفسيره مجموعة مواقف للسلف تعمل لتبرير التكريم، وما عوامله التي كانت ميّزات للإنسان دون سواه، وعنده: “كرّمنا: تضعيف كرم، أي جعلنا لهم كرماً، أي شرفاً وفضلاًوهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال. وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم على هذه الهيئة في امتداد القامة وحسن الصورة، وحملهم في البر والبحر مما لا يصلح لحيوانٍ سوى بني آدم أن يكون يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره، وتخصيصهم بما خصّهم به من المطاعم والمشارب والملابس، وهذا لا يتسع فيه حيوان اتساع بني آدم، لأنهم يكسبون المال خاصّة دون الحيوان، ويلبسون الثياب، ويأكلون المركبات من الأطعمة. وغاية كل حيوان أن يأكل لحماً نيئاً أو طعاماً غير مركب. وحكى الطبري عن جماعة أن التفضيل هو أن يأكل بيده، وسائر الحيوان بالفم… وقال الضحّاك: كرّمهم بالنطق والتمييز. عطاء: كرّمهم بتعديل القامة وامتدادها. يمان: بحسن الصورة. محمد بن كعب: بأن جعل محمد صلى الله عليه وسلم منهم.
… وقال محمد بن جرير الطبري: بتسليطهم على سائر الخلق، وتسخير سائر الخلق لهم. وقيل: بالكلام والخط. وقيل: بالفهم والتمييز. والصحيح الذي يعوّل عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف، وبه يُعرف الله ويُفهم كلامه، ويُوصل إلى نعيمه، وتصديق رسله.”[54]
إن هذا التجوال الواسع بشأن تبرير التكريم انتهاء بالعقل الذي هو مناط التكليف، وهو الطاقة الأهم الذي كُرّم به الإنسان إنما يدل على أن التكريم ميزة وعطاء، وأنه بالتالي قيمة تربوية يحتاجها النظام التربوي في أصوله وأساساته، ويكون الواجب أن يغرس المنهاج التربوي أهدافاً ومقررات، وفي وسائله وأساليبه هذه القيمة في الناشئة، لأن من أكرم نفسه ولم يذلّها لمطلب دنيوي، ومن أكرم سواه من البشر كما يكرم نفسه يكون قد التزم قيمة أساسية من المنظومة القيمية الإسلامية.
إن مركزية قيمة التكريم قائمة على قاعدتي الاستخلاف والأحسن تقويماً، والنظام التربوي الأصيل إسلامياً هو ذلك الذي يعزّز هذه القيمة ولا يسمح لأحد بأن يستهين بالإنسان مكانة وموقعاً وحقوقاً، ولا يقبل له أو لسواه أن تقوم عليهم عملية التشييء التي يمارسها بعض الyارقين في مفاهيم وفلسفات مادية الأبعاد، لا تنظر إلا بعين الكم والرقم.
لقد عبر عن ذلك مالك بن نبي تعبيراً طيباً حين قال: “إن الإنسان ليس في نظر المسلم الكم الذي تجري عليه الاحصائية والوزن، أي الشيء الذي تجري عليه تجارب المختبر، وعمليات المصنع، وحاجات الجيش. فالإنسان ليس الكم بل الصفة التي قرنها الله بالتكريم في سلالة آدم، فالمسلم يكرم هذه الصفة بصورة مطلقة. وكما هو منتظر فإن هذا التكريم له آثاره المحسوسة في الحياة، في التشريع وفي الآداب وفي العادات.”[55]
والظاهرة الخطيرة التي تتنافى مع الكرامة الإنسانية هي ظاهرة الدونية والصّغار التي تهيمن على نفوس بعضهم، والتي تتشكل في مواجهة حملات الغزو للأمة أو احتلال بعض أرضها، وفي القلب منها فلسطين والقدس، إنها ظاهرة القابلية للاستعمار كما سمّاها مالك بن نبي.
تأسيساً على ما تقدم تكون كرامة الانسان في “أن نحدد له إطاره الحضاري في مجال الثقافة والأخلاق والاقتصاد وكافة المجالات الأخرى، وبشكل آخر أن نقتلع ونصفّي القابلية للإستعمار من عالمه الداخلي، حتى تنطلق طاقاته لتصفيته من عالمه الخارجي.”[56]
د- المسؤولية وحملها:
حياة الإنسان ليست لعباً ولهواً، وإنما هي أوقات لها جدوى، توظّف فيها الطاقات والجهود في سبل الخير والصلاح والنفع العام، أو يجنح فريق ليوظف جهده وكفاياته وقدراته في ما يناقض ذلك.
الإنسان مسؤول؛ قاعدة تحتاجها المنظومة القيمية في النظام التربوي الإسلامي، وهي قيمة يحتاجها الناشئة وهم في عمر الورود كي ينشأوا عليها ويتعودوها، تطبيقاً لما قاله الشاعر أبو الطيب المتنبي: “لكلّ امرئٍ من دهره ما تعوّدا.”
قال الله تعالى: ﴿إنّا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً.﴾ (سورة الأحزاب: 72).
جاء عند القرطبي في تفسير الآية: “فالأمانة هي الفرائض التي ائتمن عليها العباد. وقد اختلف في تفاصيل بعضها على أقوال؛ فقال ابن مسعود، هي في أمانات الأموال كالودائع وغيرها. وروي أنه في كل الفرائض… وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: أول ما خلق الله تعالى من الإنسان فرجه، وقال هذه أمانة استودعتكها، فلا تلبسها إلا بحق فإن حفظتها حفظتك، فالفرج أمانة، والأذن أمانة، والعين أمانة، واللسان أمانة، والبطن أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة، ولا إيمان لمن لا أمان له.”[57]
“وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس… قال: الأمانة الفرائض، عرضها الله عزّ وجل على السماوات والأرض والجبال، إن أدّوها أثابهم، وإن ضيّعوها عذّبهم، فكرهوا ذلك واشفقوا من غير معصية، ولكن تعظيماً لدين الله عزّ وجل ألا يقوموا به، ثم عرضها على آدم فقبلها.”[58]
الإنسان مكلف لأنه أعطي نعمة العقل، والسماوات والأراضين والجبال غير مكلفة، والنص عنها يوجه الإنسان إلى أن الأمانة التي هي توحيد الله تعالى، وأداء الفرائض، وإعمار الأرض، وحفظ التوازن، وإمضاء السنن، ونشر الصلاح، وحمل الخير ومقاومة الشر، والانتصار للحق، وإزهاق الباطل، والتعامل مع الثروة والبيئة باعتدال دون تقتير ولا تبذير، والسهر على المخلوقات والحقوق، وغير ذلك، كلها أمانات لا يقوى على حملها إلا العاقل المميّز وذو الفكر؛ أي الإنسان.
وٍإذا حصل وحُرم الإنسان من نعمة العقل يصبح عاجزاً عن حمل الأمانة، وفي هذه الحالة يُعفى من المسؤولية ومن الأمانة، فقد جاء في الأثر: “إذا أخذ الله تعالى ما وهب (العقل) سقط ما وجب.”
والأمانة يكون حملها بالاقتدار والمواهب والملكات، وبما اختص به الإنسان بالفطرة أو بما اكتسبه وتعلّمه وتدرب عليه. والإنسان العاقل المستخلف في الأرض يعلم بأن الأمانة من واجباته، ولذلك حمل الأمانة إحساساً منه بالمسؤولية وهذا من القراءة: (حَمَلَها)؛ وهناك قراءة للآية: (حُمِّلَها)، وهذه القراءة تبيّن بأن إسناد المسؤولية للإنسان قرار إلهي ومشيئة ربانية.
عند هذا يكون السؤال: كيف ذلك ويكون الإنسان معه ظلوماً جهولاً؟ والجواب: الأمانة يحتاج حملها للعلم والمعرفة، والجهل يقود صاحبه إلى التفريط بالأمانة.
جاء نص الآية الكريمة يوجّه الإنسان إلى ذلك ففي قوله تعالى: “إنّه كان ظلوماً جهولاً”؛ والتوجيه للإنسان: إن واجبك أن تلتزم العدل والإعتدال والتوسط، وأن تسعى جاهداً مجتهداً لتحصيل العلم، وللبحث والاكتشاف والابتكار.
أولى المسؤوليات – وهي أساسية في موضوع البحث – هي العلم واحترام الاختصاص والكفاية التي يملكها الشخص، وألا يذهب الإنسان إلى ما لا يتقنه، ولا يدخل في خبرته، بل الصحيح أن يكون الشخص في إطار ما هو ميسر له، ومؤهل له. قال تعالى: ﴿ولا تقفُ ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً.﴾ (سورة الإسراء: 36).
“ألا يُسأل كل واحد منهم عمّا اكتسب، فالفؤاد يسأل عما افتكر فيه واعتقده، والسمع والبصر عما رأى من ذلك وسمع وقيل: المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفؤاده… وعبّر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئك؛ لأنها حواس لها إدراك، وجعلها في هذه الآية مسؤولة، فهي حالة من يعقل؛ فلذلك عبّر عنها بأولئك.”[59]
الإنسان مسؤول عما يقول ويفعل، ومحاسب على ما يصدر منه في عالم الدنيا أمام سواه وأمام الشريعة والقوانين والأنظمة، وهو مسؤول عنه أمام الله تعالى في اليوم الآخر.
قال تعالى: ﴿أيحسب الإنسان أن يترك سدى.﴾ (سورة القيامة: 36).
إن الأمانة تحتاج من المناهج التربوية، ومن المربين أن يعدّوا الجيل على مقاعد الدراسة على الروح المسؤولة، مع تقوية الإرادة وتعويدها على الثبات والتحمل والعطاء، وتدريبها على مخالفة الهوى، وتنظيم المطالب المتعلقة بالغرائز وبالميول المادية؛ إن الإنسان وحده هو الذي يستطيع ضبط ذاته والتحكم بها.
إن تقوية الإرادة وشحذها من أسس أي نظام تربوي أصيل، وقد عبر عن ذلك علي شريعتي بشكل جيّد في قوله: “الفضيلة الوحيدة التي يتميّز بها الإنسان على جميع الموجودات في العالم هي إرادته… أي أنه الموجود الوحيد الذي يتمكن من العمل حتى بخلاف طبيعته وضد غريزته. في حين أن كلاً من الحيوان والنبات لا يتمكن من التصرف خلافاً لطبيعته أو خلافاً لغريزته…
الإنسان هو الوحيد الذي يتمكن أن يتمرد على الصورة التي خًلق عليها، وحتى على احتياجاته المعنوية والمادية وغرائزه الجسدية. يتمكن من عمل الخير وعمل الشرّ، يتمكن أن يعمل بعقله أو خلافه، وهو حرّ أن يكون خيّراً أو شريراً، أن يصير ترابياً أو ربانياً. وهكذا فالإرادة من أعظم خصائص الإنسان العاقل صاحب الإرادة هو الحرّ في اختياراته، وبذلك يكون مسؤولاً عن الأمانات التي أعطي السلطة عليها أو أنها مسخرة له.
الإنسان المسؤول هو من يتصدى لما هو واقع ومحيط به كي يطور ويحرك عجلة التقدم والتنمية والاكتشاف والابداع في كل الإتجاهات، هذا ما يحتاجه النظام التربوي. الإنسان هو المحور وهو المنطلق وهو قائد العملية الحضارية باتجاه الحرص على حمل الأمانة بكل مسؤولية.
تأسيساً على ما تقدم، ولأن التقدم مطلب، يصح القول: “تبدأ عملية التطور من الإنسان لأنه المخلوق الوحيد القادر على قيادة حركة البناء، وتحقيق قفزات نوعية، تمهّد لظهور الحضارة. أما المادة فمهما يكن من أمرها تكديساً وزيادة، فإنها تبقى تجميعاً كمياً لا يعطي معنى كيفياً نوعياً، إلا بسلامة استخدام الإنسان له. لذلك يكون التركيز في عملية التحضير على ضرورة البدء بالإنسان.”[60]
والإنسان بوصفه إحدى مركزيات المنظومة القيمية في مشروع النظام التربوي الأصيل يتمتع في حالته البنيوية بشخصية لها أربعة أبعاد هي: البعد الجسدي، والبعد الروحي، والبعد العقلي، والبعد النفسي.
أ- البعد الجسدي:
إن التكوين الجسدي يحتلّ موقعاً في العملية التربوية، إذ الإعداد التربوي والتعليمي والتأهيلي ينطلق بالأصل من هذه الحقيقة، ومن ولدوا بعاهات جسدية، أو تعرضوا لحوادث جلبت لهم إعاقات يحتاجون لتعليم وتأهيل يختلفان عما هو للشخص العادي.
فالبدن السليم، والقوى العضلية ضرورة، ويتكاملان مع القوى الذهنية والفكرية لإنجاز الأعمال. والقاعدة هي: “إن لبدنك عليك حقاً”. وهذا الحق يكون في إشباع الحاجات العضوية (الفزيولوجية) بالحلال دون إسراف ولا تقتير، هذا مع النظافة والطهارة، وممارسة أنواع الرياضات التي تقوي البدن كالسباحة والرماية وسواهما.
وعندما جاء ثلاثة رجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شدّدوا على أنفسهم فواظبوا على الصيام والقيام، وأعرضوا عن الزواج ظناً منهم أن ذلك من باب التقوى، نهاهم رسول الله عن ذلك، وطالبهم أن يعتدلوا في سلوكهم تجاه مطالبهم الجسدية، لأن الدين لم يطالب أحداً بقتل غرائزه، وإنما الصحيح أن يشبعها بالحلال الطيب. وفي الحديث النبوي: “جاء ثلاثة رهط (رجال) إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالّوها (وجدوها قليلة) وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليم وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلّي الليل أبداً، وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إنّي لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكنّي أصوم وأفطر، وأصلّي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن عن رغب سنّتي فليس منّي.”[61]
فالتوازن والاعتدال مطلوبان في مسألة تعاطي الإنسان مع مطالب البدن لأن تجاوز حد التوسط والاعتدال بالإسراف أو التقتير له مردودات سلبية على الصحة، ومن يفعل ذلك يكون قد فرّط بجسده وعليه إثم. وفي إعلان عمّان لتعزيز الصحة ورد في البند الثالث:”يستطيع الإنسان حفظ صحته، بأن يحافظ على الميزان الصحي في حالة اعتدال، فلا يطغى في هذا الميزان ولا يخسر الميزان.”[62]
قال الله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.﴾ (سورة الأعراف: 31). وفي الحديث النبوي الشريف: “ما ملأ آدمي وعاءً شرًّا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه.”[63]
كما أن الإنسان المسلم مطالب بعد التوازن ألا يعرّض نفسه لخطر لا بل إن حفظ النفس من مقاصد الشريعة الخمسة – كما هو معلوم – والنص القرآني في هذا: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.﴾ (سورة البقرة: 195).
كما أن الإسلام أمر بأمور كثيرة تعدّ أساساً في الحفاظ على البدن منها:
- النظافة.
- أكل الحلال والإمتناع عن الخبيث من الطعام والشراب.
- تحريم الخمر والمخدرات والمسكرات التي لها فعل في تعطيل فعل الكريات البيضاء في الدم لبعض الوقت، وهذه الكريات هي المدافع عن الجسد ضد كل غزو ميكروبي.
- تحريم الزنا والفواحش وكل أشكال الشذوذ.
كل هذه القواعد تشكل الأسس للحفاظ على الجسد، ويحتاجها النظام التربوي الإسلامي الأصيل كي نحفظ صحة الشباب خاصة وأن مغريات كثيرة تحاول إفساد الجيل، والصحة السليمة عامل مساعد على السوية الشخصية والمتوازنة، والذي يحتاجه المقرر في النظام التربوي هو تعليم القواعد الصحية، والسهر على صحة الطلاب، ومع ذلك إدخال مواد في المقررات في أنواع الرياضة التي تؤهل الشباب تأهيلاً جسدياً كافياً ليستطيع القيام بما هو مناط به.
ويفيد في هذا الباب أن يتمّ عرض ما قاله التربوي عمر محمد التومي الشيباني: “إن الإسلام يعترف بالبعد الجسمي أو المادي في الإنسان، كما يعترف بحق هذا البعد في الرعاية والعناية الضروريتين، بل يعتبر هذه العناية وتلك الرعاية أمرين ضروريين، على أن يحاط هذا البعد بسياج الدين والخلق، فيتكامل بذلك مع بقية العنصرين للطبيعة البشرية، وهما: العقل والروح. فالإسلام يرفض في الإنسان القوة المادية التي لا ترتبط بالإيمان والأخلاق والرحمة، ولا يرضى للإنسان أن يكون قوياً في بدنه، ولكنه قزم في روحه، ضحلٌ في عقله وتفكيره.”[64]
تأسيساً على ما تقدم يكون في أسس التربية الحفاظ على الجسد، وإعداده وتأهيله، والامتناع عن كل ما يجلب الأذى، وإذا طرأ عليه أي مرض فالتداوي ضرورة. وفي الحديث النبوي: “عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أفنتداوى؟ قال: نعم عباد الله، تداووا، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له شفاءً غير داءٍ واحد وهو الهرم.”[65]
ملاحظة منهجية:
درج المتحدثون في التربية، وأبعاد شخصية الإنسان على الخلط بين الروح والنفس، وذلك بتأثير فلسفة اليونان القدماء، وفلسفة أوروبا وملحقاتها الحضارية لأنهم كانوا يقولون: “النفس جوهر روحاني”.
لكن المصطلحين في اللغة العربية، والمصطلح القرآني ليسا واحداً.
جاء في “لسان العرب”: “والرّوح هو الذي يعيش به الإنسان، لم يخبر الله تعالى به أحداً من خلقه، ولم يُعط علمه العباد… إنّ المراد بالروح الذي يقوم به الجسد وتكون به الحياة.”[66]
وفي “لسان العرب” كذلك: “النفس: العرب قد تجعل النفس التي يكون بها التمييز نفسين: وذلك أن النفس قد تأمره بالشيء وتنهى عنه، وذلك عند الإقدام على أمر مكروه، فجعلوا التي تأمره نفساً، وجعلوا التي تنهاه كأنها نفس أخرى… والنفس يعبّر بها عن الإنسان جميعه.”[67]
أما النص القرآني ففيه قول الله تعالى: ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربّي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً.﴾ (سورة الإسراء: 85).
فالروح قوة إحياء تنفخ في الإنسان عند تكوينه وهو جنين فتدب فيه الحياة، وتنزع منه عندما يكون أجله فيموت، لكن هذه الروح لا يستطيع أحد من البشر أن يحيط علماً بماهيتها ولا بكيفيتها، وإنما أمرها وحقيقتها لله تعالى وحده.
والنفس جاء فيها قول الله تعالى: ﴿ونفس وما سواها * فألهمها فجورها وتقواها * قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دسّاها.﴾ (سورة الشمس: 7، 8، 9، 10). فقد أنشأ الله تعالى النفس وهداها السبيل، وعرّفها الحسن والقبيح، والخير والشر إلى آخر هذه الثنائيات، وبعدها يكون الأمر متروكاً لصاحب هذه النفس فهو من يطهرها بالفضائل والطاعات قولاً وفعلاً، أو أنه يختار النقيض فيفسدها بالرذائل والمعاصي. الأول مفلح فائز بسعادة الدارين، والثاني خائب من أهل الخسران.
لذلك يكون من اللازم في المنظومة القيمية لنظام تربوي أصيل في الإسلام مفيد أن يتمّ الفصل في أبعاد الشخصية عند الإنسان بين البعد الروحي والبعد النفسي.
ب- البعد الروحي:
إن التكوين الروحي السليم يكون بالإيمان، وبأن يكون الإنسان ذا عقيدة سليمة هي عقيدة التوحيد التي تجعله مرتبطاً مع الله تعالى مما يولّد عنده الإطمئنان، والأمان، ويحقق له الصفاء والاستعداد لتلقي الفيوضات الربانية.
“تتغذى الروح بالإيمان والعقيدة، والإستئناس بالخالق المدبّر، الحيّ القيوم، الرحمن الرحيم، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وتلجأ الروح إلى الذات الإلهية لتنعم بالخير والأمن والطمأنينة، وتناجيها في دفع الأذى والضرر، ولهذا فرض الإسلام العبادات والشعائر الدينية والأذكار اليومية لتهذيب الروح، ودعم الصلة بالله تعالى، وربط القلب به مباشرةً.”[68]
وأول ركائز هذه التربية الروحية أن ينشأ الطفل في الأسرة، ومن ثمّ في المدرسة في فضاء النصوص القرآنية لما تمثله من حالة جذب باتجاه المعرفة والتهذيب مع الأنوار التي تفعل فعلها في تنشئة الشخصية السوية وتكوينها. وقد جاءت الآيات الأولى من سورة الرحمن توجه إلى هذا المنهج. قال الله تعالى: ﴿الرحمن * علم القرآن * خلق الإنسان * علّمه البيان.﴾ (سورة الرحمن: 1، 2، 3، 4). فعندما أبلغ الله تعالى بخلق القرآن قبل خلق الإنسان كان في ذلك توجيه إلى أن الإنسان الرباني هو من تأسست الأسرة التي أنجبته على أساس قرآني، وبعد ذلك كان التعليم الأول له هو نصوص كتاب الله تعالى.
قوت الروح الأساي هو الذكر الذي به تطمئن القلوب لأن هذا الذكر يقرّب العبد من الله تعالى، فيكون الإنسان عنده مستشعراً الصلة مع الله تعالى في كل فكر أو قول أو فعل، وإذا ما تبع ذلك الإخلاص لله تحصل عندها حالة النشوة الروحية التي قال فيها أبو حامد الغزالي حين طلب أحدهم منه أن يصف تلك الحال:
فكان ما كان مما لست أذكره فظنّ خيراً ولا تسأل عن الخبر
وفي الحديث النبوي الشريف: “ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله له أحبّ إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبّه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار.”[69]
إن حلاوة الإيمان ثمرة روحية للحب وأول هذا الحب هو لله تعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحب من أهم عوامل الطاعة عند العبد، إذ القاعدة: “المرء يطيع من يحب”، وبذلك يكون في أهداف النظام التربوي الإسلامي الأصيل المنشود أن يغرس المنهج في قلب الطالب إيماناً راسخاً أساسه الحب المذكور ليكون هذا الطالب في حالة غنى روحي تتحول طاعة والتزاماً بالشريعة.
والروح الغنية بالإيمان تجعل صاحبها متوازناً حيث لا يعرف كلّ من الإفراط أو التفريط إليه سبيلاً، كما أنه يكون شجاعاً ثابت الخطى لا مكان عنده للجبن أو التردد أو اليأس. إن الغذاء الروحي الإيماني هو النصير في الملمات، وهو الحليف أمام كل التحديات.
وقد بيّن موقع هذا البعد الروحي أحد التربويين قائلاً: “ومما يساعد على صفاء الروح وصقلها، وعلى زيادة استعدادها للإتصال بالملأ الأعلى، وتلقّي الإلهامات والفيوضات والإمدادات الخفيّة التي تنير للإنسان الدرب وتشعّ أمامه ما ظلم من جوانب الوجود، وعلى زيادة قدرتها على إدراك المغيّبات، الرياضة والمجاهدة عن طريق الذكر وضبط النزوات والشهوات، والتخلّص من الشواغل والعوائق، ونبذ الآفات والمفاسد. فإذا صفت روح الإنسان بهذه الرياضة والمجاهدة أصبح يرى الأشياء بنور الله.”[70]
لقد وعد الله تعالى من تقرب إليه بالطاعات والنوافل بعد الفرائض بأن يمنحه هذه المنهج ليكون كل ما يقوم به بتوفيق الله تعالى. ففي الحديث القدسي: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله – عزّ وجلّ- قال: من عادى لي وليًّا،فقد آذنته بالحرب، وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه، فإذا أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينّه، ولئن استعاذني لأعيذنّه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن، يكره الموت، وأن أكره مساءته.”[71]
تأسيساً على ما تقدم بشأن البعد الروحي يصح القول: “إن ربط الإنسان دائماً بالله، يجعله يعيش حريته بفهم خاص واسع يساعده على مجابهة صعاب الحياة، وتخطيها، وتحفظ عليه استقلاله إزاء الإنسان وكل ما هو إنساني، وما هو غير إنساني، إلا ما تجدّده طبيعة الألوهية وسيادتها، والعبودية وواجباتها، وهذا يعني الانفتاح على الحقيقة ومعايشتها في صفائها.”[72]
هذا هو البعد الروحي في التربية إنه بعد يربط الإنسان مع خالقه ويمنحه الحرية والشجاعة، والقدرة على مقاومة التحديات والثبات في الشدائد.
ج- البعد النفسي:
يقوم البعد النفسي على أساس منظومة قيمية مثالية أساسها الأخلاق. فالنفس تتزكى وتسمو بالفضائل ومحاسن الأخلاق، وتفسد وتنحط حين ينشأ صاحبها على الرذائل ومفاسد الأخلاق. والنفس هي محل المشاعر والعواطف والأحاسيس، وتحتاج لعناية من المناهج التربوية، ومن الوالدين والمربين، وإذا ما قام هؤلاء بواجبهم من خلال ما يتوافق مع الفطرة السليمة تصبح المسؤولية على صاحب النفس.
إن الدين هو النبع الثرّ لما تحتاجه النفس من أنواع الإشباع بالقيم التي تسمو بهذه النفس، وتهذبها، وتقيم مكوناتها على التوازن والاعتدال، وهذه القيم تقي النفس من السقوط في مهاوي الشهوات المادية والغرائز.
ويشكل النظام التربوي الإسلامي الأصيل ركناً مكيناً لتحقيق الركن الأول من مقاصد الشريعة: حفظ النفس، وهو الدواء الناجع “لمعالجة الأمراض النفسية في الإنسان كالهم والحزن والقلق واليأس والخوف والقنوط والتردد والحيرة… كل ذلك عن طريق الإيمان بالله تعالى، وأنه الملجأ للإنسان في كل الأحوال، والموئل للمرء في الخير والشر، والسّرّاء والضّرّاء وكل تصرفات الكون، فإن أصاب المؤمن خير شكر، وإن أصابه شر صبر، وإن انتابه الخوف أمن بجانب الله، وإن وسوس له الشيطان باليأس والقنوط استعان بالله واستعاذ به.”[73]
وقد أرشد إلى هذا المنهج المعالج، والمطمئن للنفس الحديث النبوي الشريف، الذي جاء فيه: “عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضرّاء صبر، فكان خيراً له.”[74]
إن البعد النفسي في بنية شخصية الطالب يحتاج أن يعطى معاني العزّة والعنفوان جرعة بعد جرعة، وأن لا يقبل بظلم ولا ذلّ، وإنما الواجب أن يواجه معتمداً كل السبل المتاحة بما في ذلك تبديل مكان الإقامة، وإنه لا عذر لأحد في أن يقبل ظلماً أو تسلطاً من أحد. قال الله تعالى: ﴿إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنّا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً.﴾ (سورة النساء: 97)
لكن هذا القرار في المواجهة، ومعه الاستعداد للتضحية والفداء بالمال والوقت والسكن والمنصب وصولاً إلى التضحية بالنفس لن يكون إلا عند إنسان تربّى على قيم الثبات، وطرد من نفسه كل هلع أو جزع بل الأصل عنده أن لا يخاف أية قوة في الأرض، وأن يعلم أن الله وحده هو من على الإنسان أن يخشاه.
والإنسان الذي يترسخ الإيمان في قلبه ويتعلق قلبه بالله تعالى لا يهمه شيء أكثر من السعادة الأخروية غير آبه بالمطالب الشخصية يل يقدم إخوانه على نفسه، هذا ما فعله الأنصار يوم الهجرة في المدينة المنورة، وهذا ما يُفعل كل مؤمن من أهل الإيثار الذين يرفعون شعاراً: “كل شيء للآخرين ولو كان على حسابي”. وهو نقيض من تعززت في نفسه الأثرة وحب الأنا الذي يرفع شعاراً هو: “كل شيء لي ولو كان ذلك على حساب غيري”.
قال الله تعالى: ﴿والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شحّ نفسه فأولئك هم المفلحون.﴾ (سورة الحشر: 9)
ما الإيثار؟ “هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية، رغبة في الحظوظ الدينية. وذلك ينشأ عن قوة اليقين، وتوكيد المحبة، والصبر على المشقّة. يُعال: آثرته بكذا، أي: خصصته به وفضّلته. ومفعول الإيثار محذوف، أي يؤثرونهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم.”[75]
إن هذه التربية مهمة لتنمي في الطالب مقومات نفسية أساسها الغيرية لا الأنانية، ومن هذا القبيل يحتاج النظام التربوي الإسلامي أن يعالج فلسفة الليبرالية التي تقوم على تقديس الأنا، وعلى إعلاء شأن الفردية.
د- البعد العقلي:
النظام التربوي عماده مهمة تكوين البنية الذهنية أو العقلية للطالب حيث التعاطي مع القوة الأكرم: العقل. تبدأ رحلة الإنسان مع العقل من كتاب الله المسطور (القرآن الكريم) وهو أساس العقيدة والإيمان ومصدرهما، وهو الغذاء للعقل والنفس والروح، وبعدها يكون النظر العقلي في كتاب الكون المنظور الذي تحرك موجوداته وسننه وقواننيه فضولنا إلى المعرفة من خلال المراقبة والبحث فالاكتشاف والابتكار.
قال الله تعالى: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تيبّين لهم أنه الحق أو لم يكفِ بربّك أنه على كل شيء شهيد.﴾ (سورة فصلت: 53.)
إن العقل البشري يقف متسائلاً متفكراً أمام قدرة الله تعالى التي تظهر من خلال الآيات البادية في تكوين الإنسان أو في نظام الكائنات كلها من أدقِّ جزيء من المادة أو الكائنات الحية إلى الكواكب والمجرات، وهذا الموقف من العقل يفتح أمامه النظر والبحث، والواجب أن تكون في النظام التربوي محفّزات في هذا الإتجاه كي ينفسح أفق البحث العلمي وإعمال العقل إلى ما شاء الله تعالى، وكلما استوعب الذهن حقائق من الكون ازداد إيمانه ويقينه، وكلما تقدم البحث كان في ذلك توفير ما يحقق هناءة الإنسان وسعادته.
لقد فتح النص القرآني الأفق واسعاً أمام الإنسان العاقل باتجاه متابعة البحث، والمثابرة على النظر العقلي، وذلك بما يحيط بالإنسان من حقائق ووقائع، وبما يسير وفقه النظام الكوني من السنن والقوانين. قال الله تعالى: ﴿إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل من السماء من جاء فأحيا به الأرض بعد موتها وبثّ فيها من كل دابّه وتصريف الرياح والسحاب المسخّر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.﴾ (سورة البقرة: 164).
جاء عند القرطبي حول هذه الآية: “فبيّن لهم دليل التوحيد، وأن هذا العالم والبناء العجيب لا بدّ له من بانٍ وصانع… فآية السماوات: ارتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها، ودلّ ذلك على القدرة وخرق العادة. ولو جاء نبي فتُحدّي بوقوف جبل في الهواء دون علاقة، كان معجزاً. ثمّ ما فيها من الشمس والقمر والنجوم السائرة والكواكب الزاهرة، شارقة وغاربة، نيّرة وممحوّة، آيةٌ ثانية.
وآية الأرض: بحارها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووعرها.
الثانية: قوله تعالى: ﴿واختلاف الليل والنهار.﴾ قيل: اختلافهما بإقبال أحدهما وإدبار الآخر من حيث لا يُعلم. وقيل: اختلافهما في الأوصاف من النور والظلمة والطول والقصر.”[76]
وقال الله تعالى: ﴿إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب.﴾ (سورة آل عمران: 190).
لقد “ختم تعالى هذه الآية بالأمر بالنظر والاستدلال في آياته؛ إذ لا تصدر إلا عن حيّ قيوم، قدير، قدوس، سلام، غني عن العالمين؛ حتى يكون إيمانهم مستنداً إلى اليقين، لا إلى التقليد.
{لآيات لأولي}: الذين يستعملون عقولهم في تأمل الدلائل.”[77]
العلم وتحصيله فطرة في الإنسان، وهو موجه إلى سنن الكون وكائناته، كي يعرف الإنسان الخالق سبحانه، وكي يقف على أسرار وقوانين ويصل إلى صناعات، وكي يستقيم سلوكه عبادياً ومعاشياً فتكون له السعادة في الدارين: الدنيا والآخرة.
العقل له وظيفة، والعلم له مقاصد هذا ما توافق عليه الباحثون في هذا الباب، ومنهم ابن خلدون الذي قال في “المقدمة”: “إن الإنسان قد شاركته جميع الحيوانات في حيوانيته من الحس والحركة والغذاء والسكن وغير ذلك، وإنما تميّز عنها بالفكر الذي يهتدي به لتحصيل معاشه والتعاون عليه بأبناء جنسه، والاجتماع المهيئ لذلك التعاون، وقبول ما جاءت به الأنبياء عن الله تعالى والعمل به، واتباع صلاح أخراه، فهو مفكر في ذلك كله دائماً لا يغتر عن الفكر فيه طرفة عين… وعن هذا الفكر تنشأ العلوم وما قدمناه من الصنائع.”[78]
إلا أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن العقل البشري يستطيع التفكير فيما هو محل للتصورات الذهنية، وما هو ضمن نطاق البحث، ولكن ما وراء الحسن وعالم الطبيعة من عالم الغيب والروحانيات مصدره الدين لأن الإنسان لا يستطيع الإحاطة به. وقد قال ابن خلدون في ذلك: “وأما ما كان منها في الموجودات التي وراء الحسن وفي الروحانيات، ويسمونه العلم الإلهي، وعلم ما بعد الطبيعة فإن ذواتها مجهولة رأساً، ولا يمكن التوصل إليها ولا البرهان عليها.”[79]
إن العقل مستعيناً بالحواس وما صممته يد الإنسان من أدوات استطاع أن يلبي نهم البشر للمعرفة، وجاء الدين يلبي جانباً آخر، ولذلك يكون في النظام التربوي أن تترسخ هذه القاعدة عند الطلاب؛ إنها قاعدة تكامل دور مصدري المعرفة: الدين والمعارف التي توصل إليها الجهد البشري.
ثمّ يكون مفيداً أن يتمّ التذكير بأنه لا قيمة لشيء اسمه العلم للعلم، وإنما الأصل هو العلم الوظيفي؛ أي العلم الذي يتحول إلى سلوك أو إنتاج، فالعلم تهذيب للسلوك أو باب إشباع للحاجات أي أن العلم له مقاصد، وقيمته بمقدار ما ينجز من الغايات والمقاصد.
تحت عنوان غاية المعرفة في النظام التربوي الإسلامي الأصيل يصح القول: “إن الغرض من المعرفة هو تمكين الإنسان من عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج الله. فالمعرفة الحقيقية في الإسلام هي المعرفة القائمة على أساس من تقوى الله وما يستتبع ذلك من السير وفق منهج الله وشريعته. ﴿واتقوا الله ويعلم الله﴾ (سورة البقرة: 28). فالتقوى بمعناها الشامل الكامل هي أساس المعرفة.
ومن هنا فإن المعرفة التي يهدف للوصول إليها منهج التربية الإسلامية هي المعرفة التي تؤدي إلى تغيّر في السلوك الإنساني وفي واقع الحياة الإنسانية. أما مجرد المعرفة الذهنية أو العلم الذي لا يؤثر في سلوك الإنسان وفي واقع حياته، فإنها لا قيمة لها، ولا يعتدِ منهج التربية الإسلامية بها إن الإسلام يبتغي الحركة من وراء المعرفة. وينبغي أن تستحيل هذه المعرفة قوة دافعة، لتحقيق مدلولها في عالم الواقع.”[80]
إن العمل العقلي والجهد الذهني لا يكون ذا قيمة إلا إذا أدّى وظيفة ضمن إطار المسؤولية التي يحملها الإنسان المستخلف في الأرض، والأمر الآخر هو أن عناصر بنية الشخصية يجب أن تتكامل من أجل إنتاج إنسان سوي وجيل سوي لا غلو عنده ولا تهاون، هذا ما يعرف بالتكامل في الشخصية، وإنتاج مثل هذا الفرد السوي مسؤولية النظام التربوي.
لذلك قيل: “يجب أن تعتبر التربية الإسلامية كل مكونات شخصية الفرد (الجانب الروحي والفكري والجسدي) على أنها متصلة ببعضها ومتكاملة فيما بينها بحيث أن أي خلل في إحداها يؤثر على البقية وعلى شخصية الفرد بصفة عامة.”[81]
3- الرحمة:
تعدّ الرحمة بين مركزيات المنظومة القيمية لنظام تربوي أصيل لأنها منهج إنساني يحفظ الحرث والنسل، ولأنها مفردة لها أبعاد. فهناك الرحمة لإلهية، وهناك الرحمة التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك التراحم المطلوب بين بني البشر، وهناك الرحمة المطلوبة من الإنسان تجاه الكائنات المسخرة له حيّة كانت أم غير حيّة.
قال الراغب الأصفهاني: “والرحمة رقّة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، وقد تستعمل تارة في الرقّة المجردة، وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة نحو: رحم الله فلاناً. وإذا وصف بها الباري فليس يُراد به إلا الإحسان المجرد دون الرقة، وعلى هذا رُوي أن الرحمة من الله إنعام وإفضال، ومن الآدميين رقة وتعطّف. وعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاكراً عن ربه: (أنه لما خلق الرحم، قال له: أنا الرحمن وأنت الرحم، شققت إسمك من إسمي فمن وصلك وصلته ومن قطعك بتّته.)[82] فذلك إشارة إلى ما تقدم، وهو أن الرحمة منطوية على معنيين: الرقة والإحسان، فركز تعالى في طبائع الناس الرقة وتفرّد بالإحسان.”[83]
وفي البسملة: الرحمن الرحيم. والرحمن من الأسماء التي تخصّ الله تعالى ولا تقال لسواه. أما الرحيم فتقال لغير الله تعالى، والدليل ما جاء في النص القرآني عن النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿بالمؤمنين رؤوف الرحيم.﴾ (سورة التبوة: 128).
والرحمة التي هي أساس تربوي، ومكون مهم من مكونات شخصية الإنسان تتولد عنها حالة من التواضع واللين يحتاجها المجتمع لا بل يحتاجها الإنسان في تعاطيه مع كل ما في الكون. وتبدأ المسألة مع إقرار الإنسان بمحدودية قدراته ومكوناته، وأن ذلك مدعاة للتواضع، والتعامل في الحلّ والترحال بعيداً من الغرور والعُجب والكبر. قال الله تعالى: ﴿ولا تمشِ في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً.﴾ (سورة الإسراء: 37.)
إن نص الآية جاء ينهى الإنسان عن الخيلاء والتكبر مذكراً إياه بأنك إنسان محدود القدرات، وبذلك فليس من الصواب أن يظن الإنسان أنه يمتلك قوة خارقة فيدفعه ذلك إلى القسوة والظلم، والأصل أن يكون رحيماً في كل قول وفعل. جاء في تفسير القرطبي: “هذا نهي عن الخيلاء وأمر بالتواضع… وقيل: التكبّر في المشي، وقيل تجاوز الإنسان قدره. وقال قتادة: هو الخيلاء في المشي… يعني: لن تتولج باطنها فتعلم ما فيها… …أي: لن تساوي الجبال بطولك ولا بتطولك… لن تخرق الأرض بكبرك ومشيك عليها… بل أنت عبد ذليل، محاطٌ بك من تحتك ومن تحتك ومن فوقك، والمحاط عليها… بل أنت عبد ذليل، محاطٌ بك من تحتك ومن فوقك، والمحاط محصور ضعيف، فلا يليق بك التكبر.”[84]
إذا دعت الإنسان نفسه إلى الظلم فعليه أن يتذكر المعاني والأفاهيم السابقة الذكر فتتحول عنده القسوة ليناً، والتكبر رحمة، والظلم عدلاً، والقسوة رحمة. هذه الرحمة يحتاجها النظام التربوي ليكون من يتخرج من المؤسسات التعليمية عندما يدخل سوق العمل من الراحمين الذين يتخذون الرحمة منهجاً في علمهم كله.
فمن يمشي خيلاء على الأرض تئن الأرض من خطاه وتقاضيه يوم القيامة ومن ظلم دابة يحاسب عليها، وأبلغ دليل على ذلك الحديث الذي جاء بشأن المرأة التي كانت لها هرة وقد حبستها، فلم تطعمها، ولا هي تركتها كي تأكل من خشاش الأرض، فوقع عليها العقاب بسبب فعلها هذا.
أما إذا انتقل البحث إلى عالم البشر فإن الرحمة في صياغة العلاقات بينهم تبدأ مع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى نبي الرحمة فعرّفه بمقاصد دوره الرسالي في قوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.﴾ (روسة الأنبياء: 107.)
ومجتمع الإسلام يقوم على قاعدة التراحم بين المؤمنين، واستخدام القوة والشّدّة ضد الأعداء. قال الله تعالى: ﴿محمد رسول الله والذين معه أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم.﴾ (سورة الفتح: 29).
الشّدة تكون بتعليم الناشئة على الإستخدام المشروع للقوة في سبيل حفظ الكرامة والحقوق، وتحرير الأرض وتطهير المقدسات، والقوة لا تكون القوة العسكرية فقط على أهميتها، وإنما تشمل كذلك القوة الاقتصادية، والفكرية، والإعلامية، والأدبية، والفنية، وقوة التحصين للأجيال أخلاقياً. أما من جهة منهج “رحماء بينهم”، فإن هذا المنهج يوجب الألفة والوحدة بعيداً من التنازع البيني، أو الخصام بين الإخوة في مجتمع الأمة والوطن، بل المطلوب تعزيز روح المواطنة القائمة على التضامن والتكافل في الميادين كافة بحيث يشعر كل مواطن أنه جزء من جماعة كبيرة، وأسرة متماسكة توفر له الأمان الاجتماعي والنفسي والاقتصادي والسياسي، وأن حقوقه مصانة.
يحتاج النظام التربوي هذا المنهجح كي لا يكون بأس أهل الأمة بينهم شديد مما يثير الفتن، ويشيع الفساد والغشّ والرشوة وسائر ما يفكك المجتمع، ولكي ينشر الأمانة والصدق والتآلف والتحابب، وهذا ما يوجه إليه الإسلام.
4- الوسطية:
إن النظام التربوي الإسلامي الأصيل يحتاج الوسطية منهجاً من أجل إبعاد أجيال الأمة من الطلاب عن نوعين خطيرين من السلوك هما: الإفراط والتفريط. وقد سبب في ظهور هذين المرضين بحدة تحديات على الأمة من أعدائها الصهاينة وأصحاب المنظومات الفكرية والسياسية الاستعمارية الأجنبية فكان الإفراط والغلوّ مقابل دعوات التفريط والتهاون بالمبادئ والقيم.
الوسط هو العدل، وهو الخير وهو الأحسن والأفضل، وفي “لسان العرب”: “إن الوسط قد يأتي صفة وإن كان أصله أن يكون إسماً من جهة أن أوسط الشيء أفضله وخياره… ومنه الحديث: خيار الأمور أوساطها… فلما كان وسط الشيء أفضله وأعد له جاز أن يقع صفة… وواسطة القلادة: الدرّة التي في وسطها… وهو أجودها… كل خصلة محمودة فلها طرفان مذمومان. فإن السخاء وسط بين البخل والتبذير، والشجاعة وسط بين الجبن والتهور.
… وفي الحديث: إنه كان من أوسط قومه؛ أي من أشرفهم وأحسبهم… ومنه سميت الصلاة الوسطى لأنها أفضل الصلوات وأعظمها أجراً.”[85]
أما الراغب الأصفهاني فقد قال: “يقال هذا أوسطهم حسباً إذ كان في واسطة قومه، وأرفعهم محلاً وكالجود الذي هو بين البخل والسرف، فيستعمل استعمال القصد المصون عن الإفراط والتفريط، فيُمدح به نحو السّواء والعدل والنصّفة.”[86]
وهوية الأمة هي الوسطية؛ قال الله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً.﴾ (سورة البقرة: 143.) إن موقع الشهادة ووظيفة الشهود الدعوي والحضاري قد منحها الله للأمة على أن تلتزم الوسط والاعتدال في كل قول أو فعل، وفي التصور الذهني والمشاعر والانفعالات إضافة إلى الميول وأنواع السلوك.
أما مخالفة الوسطية بالتطرف فهي أمر ذميم، لأن من غادر الوسطية تكون مراكبه قد ذهبت باتجاه التطرف وهو أمر غير مأمون العواقب. وقد نبه النص القرآني إلى خطر ذلك في قوله تعالى: ﴿ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.﴾ (سورة الحج: 11.) والآية هنا تبيّن حال القلق المتشكك غير المستقر في التزامه العقدي ولا الشرعي والبعيد عن التمكين والتوسط، ومثل هذا الشخص ينهار ويسقط حين التهديد أو الإغراء، وبذلك يصل إلى الخسران الذي لا مفر منه. فمثل هذه النتيجة السلبية هي مصير كل من تطرف وابتعد عن الوسطية. والتطرف مذموم، وقد ورد في معانيه: “رجل طرف ومتطرف ومستطرف:لا يثبت على أمر. وامرأة مطروفة بالرجال إذا كانت لا خير فيها، تطمح عينها إلى الرجال وتصرف عينها عن بعلها إلى سواه… ورجل طَرْف: لا يثبت على امرأة ولا صاحب.”[87]
خلاف الوسطية التطرف وهو مذهب سلبي أساسه اتباع الهوى، والتقلّب في المواقف، وعدم الثبات على حال بعينها، والتطرف بأي اتجاه أمر مذموم، والإنسان بفطرته وطبعه يطمئن إلى التوسط والاعتدال، ويأنس في ظلهما، وتنفر طباعه من التوتر والمبالغة سلباً أو ايجاباً.
إن التأكد من أن الوسطية تعني الخيري، وخلافها يجلب الشر، يحتاج من الباحث المتابع براجع مسار الحضارات كلها عبر قوائم تاريخية طويلة، ليكتشف أنه في كل المحطات والمواقف والماجريات، وفي كل مكان وزمان، كيف أن الغلوّ في كل مرة ساد وانتشر كان يقود إلى ما لا تحمد عقباه. فالغلو في أداء العبادات يحمل سمة نفاق وادّعاء ولا يتناسب مع جوهر الدين الحنيف. والغلو في استخدام ما تجود به الطبيعة من الماء إلى البيئة والهواء والثروة عموماً إنما هو تبذير، وهدر للإمكانات، يقود إلى الفوضى والعبث بالنعم من جهة، وإلى الطمع والجشع من جهة أخرى.
والغلو في استخدام القوة يتحول عدواناً وجرائم، وينشر الرعب والخوف ويذهب بالأمن والأمان والاستقرار. والغلو في استخدام الحق يصبح تعسفاً وتكون نتائجه سلبية. والغلو في الحب يتحول عشقاً وهوساً، وتنطبق عليه القاعدة: “ومن الحب ما قتل”. والغلو في البخل والحرص على المال والملكيات يصبح مرضاً يمنع المعروف، ويعطل فعل الخير.
مقابل مخاطر الغلو وسلبيات التطرف يكون بين مركزيات النظام التربوي الأصيل أن يتم التركيز على الوسط، وأنها خير أمة أخرجت للناس، ومن هذا بيان واضح أن الوسط الخير، وخلافه شر وخطير.
وقد اعتمد علماء الأمة الوسطية بأنه المثالية في كل أمر لأن أوسط الناس هو أمثلهم وأكثر عدلاً، وأصدقهم قولاً، وأدقهم توازناً وبعداً عن التطرف والمواقف المتسرعة، وأبعدهم عن الجنوح إلى السلبية.
قال الإمام محمد أبو زهرة: “لقد فسر كثيرون معنى الوسطية بأنها وسط بين الروحانية والمادية، وأنها لم تهمل مطالب الجسم بجوار عنايتها بالروح وتهذيب النفس وتربية الوجدان ونقول إن كلا التفسرين سليم، وهما متلاقيان غير متضادين، ولا مفترقين، فهي لا تعاندها ولا تقاومها، وهي شريعة الروح ترفع الإنسان إلى المعارج العليا، وتهذب النفس، فلا تنحط إلى سفساف المادة، وهي تعطي الجسم حقّه وحظّّه، ولا تميت الغرائز بل تهذبها، ولا تقتل شهوات النفس بل توجهها إلى الطريق المثمر المنتج، وتبعدها عن طريق الوباء والمهلك.”[88]
لقد أكد الإسلام على هذا التوازن تحقيقاً للتوسط في كل فعل في العبادات أو المعاملات، وفي السعي من أجل المطالب الدنيوية، أو العمل من أجل الفوز العظيم في الآخرة. فالمؤمن مطالب أن يتجنب الغلو لأن السبيل ضلال وانحراف عن السبيل القويم. قال الله تعالى: ﴿قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحقّ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلّوا وأضلّوا كثيراً وضلّوا عن سواء السبيل.﴾ (سورة المائدة:77).
إن الآية الكريمة جاءت تحذر من الميل عن التوسط لأن الغلو والانحراف عن التوازنات المحققة للوسطية تفتح الباب للأهواء، ونتيجة ذلك هي الضلال والإضلال.
إن الطلاب يحتاجون مقررات دراسية تؤصل الوسطية في العملية التعليمية في الكتاب المدرسي، وفي أداء المدرس وسلوكه، وفي عملية التقويم، هذا مع اختبارات من خلال الطرق الناشطة تعتمد المنهج الوسط، وترسخ فكرة التوازن الروحي/المادي، فمثل هذا النظام التربوي يسهم في تنشئة جيل لا عقد عنده بل هو جيل واعد لا يقبل التعصب والتسرع في الأحكام التي يصل بعضهم من خلالها إلى حد تكفير الآخر، وفي الوقت عينه لا يقبل الوافد الذي يحمل أنماطاً من السلوك وأفاهيم تختزن المهلكات التي تضيّع الناشئة.
الوسطية المطلوبة تربوياً تتمثل في مناهج دراسية تشمل كل ما يحتاجه الجيل، وما تحتاجه الأمة، وما فيه النجاة والسعادة في الدارين: الدنيا والآخرة. لقد وجه الله تعالى إلى ذلك في الخطاب الإلهي الذي جاء فيه: ﴿وابتغِ فيما آتاك الله الدار الآخر ولا تنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغِ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.﴾ (سورة القصص: 77.)
5- السماحة:
تحتل السماحة موقعاً متميّزاً في النظام التربوي لأنها تسهم في صياغة النسيج الإجتماعي على قواعد التسامح واللين، وعكس ذلك ونقيضه يولد النفور والتعصب والتنازع. والسماحة تحمل عناصر مشتركة مع العفو والحِلم والرشاد وغيرها من المصطلحات التي تشي بالمعنى نفسه.
ورد في “لسان العرب”: “السماحة: الجود… ويقال: سمح وأسمح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء؛ وقيل: إنما يقال في السّخاء سمح، وأما أسمح فإنما يقال في المتابعة والإنقياد؛ ويقال: أسمحت نفسه إذا انقادت… وسمح لي فلان: أعطاني… وأسمح وسامح: وافقني على المطلوب… والمسامحة: المساهلة.”[89]
هذه المفاهيم الإيجابية للسماحة التي تشمل جوانب عديد ة في العلاقات الإجتماعية من الجود، إلى التساهل، إلى الانقياد، إلى موافقة الآخر على مطلوبه، كلها دلالات وأفاهيم يحتاجها المجتمع، وهي ذلك حاجة للنظام التربوي لتتم زراعة هذه القيم في شخصية الطالب. وقد جاء في “المعجم الوسيط” ما يفيد المعاني نفسها، وهو: “سمح، أسمح؛ يقال: أسمحت نفسه، ذلّت وأطاعت وانقادت. سامحه بكذا وفيه: وافقه على مطلوبه. سمّح وسمح: سار سيراً سهلاً. وسمّح الشيء: جعله ليّناً سهلاً. وسمّح فلاناً: ساهله. وتسامح في كذا: تساهل. بيع السماح: هو البيع بأقلّ من الثمن المناسب. السماحة: الجود والكرم. فلان سمح: جواد سخي. عود سمح: مستوٍ ليّن سهل لا عقد فيه ويقال: شريعة سمحة: فيها يسر وسهولة.”[90]
وغير بعيد عن السماحة يأتي مصطلح العفو. والعفو عند اللغويين هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه. ومن يعفو يتجاوز عن أمر حصلت له منه إساءة، وعفا الشيء: انمحى، ومن يعفو يمحو متسامحاً الإساءات يتغاضى عن أمور تستلزمها إقامة العلاقات على أساس التسامح، والعفو كالتسامح أساسه الجود وفعل المعروف، وقد حضّ الإسلام على ذلك ليعطي شرعية للتسامح والعفو، وأنهما من العناصر المهمة في منظومة القيم المؤسسة لنظام تربوي أصيل. قال تعالى في خصائص شخصية المؤمنين: ﴿والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.﴾ (سورة آل عمران: 134.)
ويأتي في هذا السياق مصطلح الحِلم، وهو من مكارم الأخلاق، والحِلم يشكل الذروة من الصبر ورحابة الصدر، وكظم الغيظ، كما أنه قيمة تصون الإنسان من السفه والطيش. وقيمة الحِلم يعرفها من يطلع على البشرى لإبراهيم باسماعيل عليهما السلام، وكيف أن هذا المولود قد أعطاه الله تعالى صفة الحلم ليميّزه بها. قال تعالى: ﴿فبشرناه بغلام حليم.﴾ (سورة الصافات: 101.)
إن تربية الجيل وفق منظومة قيمية تناسب روح الإسلام تحتاج لكل هذه القيم؛ السماحة والعفو والحِلم.
إن هذه القيم التي وجه إليها الإسلام قد مورست من العهد الأول للمجتمعات في تطبيق الإسلام، وقد تجلت في منهج عماده الرحمة وقبول الآخر لم يعرف له التاريخ مثيلاً. بدأ هذا المنهج مع المجتمع الأول في المدينة المنورة يوم كانت “الصحيفة” دستور المدينة أو الميثاق الوطني بين المسلمين وغيرهم من سكان المدينة وفيهم الكتابي والمشرك والمجوسي، وكان الأساس هو حق المواطنة الذي قام العقد على أساسه، ويوم نقض العقد يهود المدينة وقع عليهم العقاب. إن هذا الميثاق الوطني في المدينة جاء ليرد على مزاعم بعض المسيئين للإسلام وأنه لا يقبل التعددية ولا يقبل الآخر. وقد أسست “الصحيفة” إلى مواثيق وعهود أعطيت للبلدان التي دخلها الإسلام بالفتح ما دفع الفرنسي غوستاف لوبون إلى القول: “ما عرف العالم فاتحاً أرحم من العرب.”
الإسلام رحمة وسماحة وعفو، وقد جاء ليزيل العصبيات والفتن وعادات الثأر والانتقام، وليؤسس لمنظومة قيمية تقيم مجتمع التراحم والتوادد والمحبة، ومما يؤسس لذلك خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه: “إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية، وتعظّمها بالآباء، الناس من آدم، وآدم من تراب.” ثم تلا هذه الآية: ﴿يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.﴾ (سورة الحجرات: 13.)
إن هذه التوجيهات تطرح قيم البعد الحضاري حيث الناس متساوون في الأصل من آدم، وهو من تراب، ووحدة الأصل هذه تؤشّر إلى ضرورة احترام الكرامة الإنسانية أيًّأ كان الإنتماء لأن التنوّع سنّة كونية إنفاذاً لمشيئة ربانية.
إن جهات خارجية تعمل هذه الأيام لتشويه صورة الإسلام والمسلمين، وتستخدم لهذه الغاية أفكاراً لا تمت للإسلام بصلة؛ مثل رفض التعددية، وعدم قبول الآخر، وسوى ذلك. لذلك يحتاجالنظام التربوي المنشود أن يعرف الطالب كيف أن الإسلام يؤصل للتنوع وقبول الآخر، وكيف أن السماحة أساس مكين فيه.
إن التأصيل لمنهج السماحة، وقيمة السماحة في منظومة قيمية تضبط مسار النظام التربوي يقوم على النص القرآني، ومنه في هذا الباب قول الله تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبّروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحبّ المقسطين.﴾ (سورة الممتحنة: 8).
إن هذه الآية الكريمة توجه إلى السماحة بين أهل مجتمع بينهم تنوّع، والشرط ألا يكون من أحد عدوان على الدين والديار، أي الوطن، ولا على أي حقّ من الحقوق. ضمن هذه الضوابط يكون الواجب على المسلم ليس التسامح فحسب، وإنما العدل في معاملة غير المسلمين وأن يبرّهم، والبر في الإسلام مطلوب للوالدين ومن في مقامهما، وهذا سموّ في التعامل لا يدانيه شيء، وهو موقف قيمي لم تعرفه قوانين ولا دساتير قبل الإسلام ولا بعده. وقد وصل الأمر في السماحة وقبول الآخر إلى حدّ يجير فيه المسلم المشرك، وهو ما يعرف اليوم باللجوء السياسي. قال الله تعالى: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثمّ أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.﴾ (سورة التوبة: 6).
فالسماحة في الإسلام وصلت إلى مستوى تأمين الجيرة والحماية للمشرك، وأن يتمّ تبليغه شرع الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وبعد ذلك لا يُكره على شيء، وإنما يتمّ نقله إلى المكان الذي يرغب فيه، ويجد فيه مأمنه.
لقد برزت السماحة في محطات ومواقف كثيرة مع غير المسلمين، كما أن السماحة واليسر أمران مطلوبان في سلوك المسلم ومفاهيمه، إذ لا مكان في الإسلام للتعصب أو الاستعلاء أو القسوة أو الغلو. وفي الحديث النبوي الشريف: “يسّروا ولا تعسّروا.”[91]
يفيد في ختام الحديث عن قيمة السماحة أن يرد هذا القول لمؤرخين مسيحيين يتحدثون فيه عن سماحة المسلمين مع المسيحيين، وقد قالوا: “ولكن النصارى… تمتعوا، في ظلّ الخلافة بقسط وافر من الحرية، ونالوا كثيراً من التساهل والعطف، كما تشهد بذلك عدة حوادث. فقد جرت مناقشات دينية في بلاط العباسيين كتلك التي جرت في بلاط معاوية وعبد الملك، وقد ألقى ثيماوثوس بطريرك النساطرة[92]، في سنة 781م، دفاعاً عن النصرانية أمام المهدي لا يزال محفوظاً حتى اليوم.”[93]
6- العزّة:
الإنسان مستخلف في الأرض، وقد كتب الله تعالى له التكريم، ولا يتحقق ذلك إلا بالمنعة والعزّة، والعزّة تكون مع التحرر والحرية والانعتاق من كل قيد واستبداد أو استعباد، لأن فطرة الإنسان تأبى الظلم، وتمقت التعسف، وتتوق إلى الحرية.
قال الراغب الأصفهاني: “العِزّة حالة مانعة للإنسان من أن يُغلب من قولهم: أرض عزاز أي صلبة… وتعزّز اللحم اشتد وعزّ كأنه حصل في عزاز يصعب الوصول إليه.”[94]
وفي “لسان العرب”: “العزّة: الشّدة والقوة. ويقال: عزّ، يعزّ بالفتح، إذا اشتد… وعزّزت القوم وأعززتهم وعزّزتهم: قويتهم وشدّدتهم، وفي التنزيل العزيز {فعززنا بثالث} أي: قوّينا وشدّدنا.”[95]
قال الله تعالى: ﴿ولله العزّة ولرسوله وللمؤمنين.﴾ (سورة المنافقون: 8). عزّة المؤمن قاعدة في بنية شخصيته، وهذه العزّة تغرسها منظومة قيم النظام التربوي كي يكون من يغادر مقاعد الدراسة إلى الحياة العامة محصناً منيعاً عزيزاً، لكن العزّة تحتاج من طالبيها مواقف وأفعالاً كي تتحصل، فنيل المطالب لم يكن مرّّة بالتمني، وإنما باعتماد الأسباب والوسائل، وسلوك الدروب الموصلة إلى ذلك.
والإيمان الحقّ هو تمام الخضوع ومنتهى العبودية لله الواحد سبحانه، ومقاومة كل شكل من أشكال العبودية لمطلب مادي أو دنيوي. فالمؤمن يحثّه معتقده والتزامه على المقاومة، والممانعة من أجل توفير المناخات اللازمة لإحقاق الحق، ودفع الظلم.
النظام التربوي الإسلامي الأصيل يدعو إلى تعزيز روح الممانعة، وتقوية العزيمة وشحذها ضد الهوان والتذلل لأن ذلك مرفوض مع الإيمان الحق؛ ولهذه الغاية نهى الله تعالى المؤمنين عن الهوان أو التذلل، أو القلق والخوف، لأن ذلك لا يتناسب مع الإيمان، ولا مع موقع المؤمن. قال الله تعالى: ﴿ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.﴾ (سورة آل عمران: 139.)
ما توجّه إليه الآية الكريمة هو الإبقاء على الروح المعنوية العالية المستوى بحيث لا تأخذ الحروب النفسية وأساليب التهويل التي يشنّها الأعداء أي مكان أو موقع يفتّ من عزيمة أهل الأمة، أو يولد عندهم حالات من اليأس والإحباط.
وتحقيق العزّة التي هي القوة والمنعة يسبقه الإعداد الذي هو شرط أساسي لنيل العزّة وديمومتها. والأمر الإلهي الدائم لأجيال الأمة هو: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.﴾ (سورة الأنفال: 60). والإعداد الذي يكون موزعاً في المقررات الدراسية للطلاب حسب الفئة العمرية، وحسب المستوى، وحسب الاختصاص، يكون في وجوه متنوعة وميادين لا حصر لها, فالإعداد المطلوب يكون معنوياً ومادياً، ويتوزع في الحقول الفكرية والتربوية والإعلامية والاقتصادية والعسكرية والأدبية والفنية… الخ.
العزّة تقترن بالسماحة ولكل منهما ميدانها وظروحها. وقد مرّ في باب السماحة، أن الله تعالى قد أمر المؤمنين بأن يبروا سواهم ممن لم يؤذوهم في دينهم أو يخرجوهم من ديارهم. وبالمقابل فإن المؤمنين مطالبون بأن يتخذوا موقف المقاطعة والمقاومة لكل من اعتدى على الدين والوطن والديار والحقوق، أو عاون في العدوان وتحالف مع الاعداء.
قال الله تعالى: ﴿إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.﴾ (سورة الممتحنة:9.)
السماحة لها حدود وضوابط، وعند حد معين يكون البديل هو المقاومة، وصد العدوان، ومقاتلة كل ظالم معتدٍ، وبهذا تتحقق العزّة.
العزّة أساس إنساني واجتماعي يتحقق بالإعداد وامتلاك القوة، ويلي ذلك فعل الرباط الذي يتسع “لكل ما عرف ويعرف من تحصين الثغور والمداخل التي يمكن أن ينفذ منها الأعداء، والرباط امتلاك قوى الدفاع والمواجهة كافة والبلاغ القرآني هو أن فائدة هذا الإعداد العام الشامل ليست في صناعة المواقع الحربية فقط، إنما هي، قبل ذلك، وسيلة لإقرار الحق، ومنع الأعداء من التفكير في زلزلته والطغيان عليه.”[96] ﴿ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم.﴾ (سورة الأنفال: 60).
وقد أرشد إلى الأمر نفسه شيخ الأزهر الأسبق المرحوم الأمام محمود شلتوت، حيث قال: “ومن هذا الجانب تكون القوة المادية عاملاً من عوامل السلم تحفظ الحقوق، وتقيها شرّ الإعتداء، وتنشر على العالم ظلال الأمن والاستقرار. وكما يرشد القرآن إلى القوة المادية من جهة العدد والآلات يرشد أيضاً في دائرة القوة المادية أن تكون الأمة كلها جنداً مدرباً على السلاح، مدافعاً عن الحوزة.”[97] ما وجه إليه الإمام محمود شلتوت يعني تربوياً أن يكون ضمن مقررات النظام التربوي الأصيل إعداد للطلاب على الوسائل والأساليب التي تمكنهم من الدفاع عن دينهم وأمتهم ووطنهم وأمنهم وحقوقهم، وهذا ما يتمثل في اعتماد الخدمة الوطنية الإلزامية إما لمدة سنة، أو أن تكون موزعة على فصول في الإجازات الصيفية، لكنه من غير السليم أن يعتمد العدو الجندية لكل شاب وفتاة بلغ السادسة عشرة في فلسطين المحتلة بحيث يعسكر كيانه الغاصب المحتل ويعمل لتهوّيد المقدسات، وبالمقابل لا تكون تدريبات ولا حالات إعداد لشبابنا ليدافعوا عن بلادهم ومقدساتهم، وليحفظوا عزتهم وكرامتهم.
الفصل الثالث
مكونات المنظومة القيمية وعناصرها
تمهيد:
عندما يقال: منظومة قيمية يحضر في الذهن فوراً موضوع الأخلاق، والاخلاق لا بدّ لها من عناصر ومكونات تشمل مجموعة القيم التي تشكل معايير الإنسان التي يتخذ منها الأحكام التي يطلقها على أي فعل أو قول. وإذا ذكر مصطلح الاخلاق كان المقصود المفاهيم والتحديات، وإذا قيل هذا قول أو فعل أخلاقي أو غير أخلاقي كان الكلام حكماً لما هو مقبول أو غير مقبول.
إن الإجتماع البشري ضرورة تقترن بها ضرورة أخرى هي منظومة القيم التي تحكم نسيج العلاقات في هذا الإجتماع، لذلك تكون القيم الأخلاقية ملازمة للإنسان فرداً ومجتمعاً، وقد تسابقت مدارس الفكر والفلسفة إلى هذا الموضوع تعالجه، وأما رسالات السماء الخالدة وخاتمها الإسلام فإنها قد أعطت للمنظومة القيمية الموقع الرئيس من أجل صياغة مجتمع أرقى، وكان بيان ذلك حين جاء النصّ القرآني يحمل تعريفاً ووصفاً لشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الآية الكريمة: ﴿وإنّك لعلى خلقٍ عظيم.﴾(سورة القلم، الآية4).
وإذا كان مشروع النظام التربوي الإسلامي الأصيل يريد جيلاً يعجب الزراع، ويكون محل رضى للمربين، ويكون جيلاً واعداً، فإن الشخص ومفاهيمه، ويشبع مشاعره وأحاسيسه وجدانياً، ويغذي ضميره بثوابت الخير وقيم الحقّ.
مكونات المنظمومة القيمية تبدأ من الاخلاق، لأن “الأخلاق هي الفكر العملي، والسلوك التنفيذي للمرء، فكل فعل يصدر عن وعي من صاحبه هو ثمرة التقاء عقله مع وجدانه وضميره، فالثلاثة معاً يكونون شخصية الإنسان، ويحكمون سلوكه الذي نحكم من خلاله عليه إذا كان ذا أخلاق خيّرة، أو شرّيرة.”[98]
والنظام التربوي يحتاج مكونات قيمية في البرامج والإعداد تستطيع إشباع ذات الفرد بهذه المنظومة القيمية، وتستطيع إخراجه من الأنا إلى الآخر، ومن الفرد إلى المجتمع، ومن العزلة إلى الإنفتاح والتفاعل. فما هي أبرز هذه المكونات القيمية الأخلاقية اللازمة للنظام التربوي الإسلامي الأصيل في يومنا هذا؟
1-التآخي:
إن التآخي من القيم التي يحتاجها النظام التربوي الإسلامي لأن الوافد الثقافي الليبرالي يركز على الأنا، ويزرع في الفرد حبّ الذات، وتقديم المصالح الخاصة، وقد يصل إلى تقديس الذات حيث يطلق لها العنان غير آبه برابطة من صلة الرحم أو القرابة أو العقيدة أو مجتمع الامة والوطن.
لقد أسس الإسلام في شريعته وبعدها الفقه والمسار الحضاري منذ العهد النبوي لقاعدة الاخوة التي تربط المؤمنين ببعضهم، فقول الله تعالى هو:﴿ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ﴾(سورة الحجرات، الآية 10).
جاء عند القرطبي: “قوله تعالى:{إنما المؤمنون أخوة} أي: في الدين والحرمة لا في النسب؛ ولهذا قيل: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخواناً.). وفي رواية: (لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره.) التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات؛ (بحسب امرئ من الشرّ أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.). لفظ مسلم.”[99]
أما عند اللغويين فقد جاء في “لسان العرب”: “الأخ كان في الأصل أخو، فحذفت الواو لأنها وقعت طرفاً وحركت الخاء، وكذلك الأب كان في الأصل أبو،… وقال بعض النحويين: سمّي الأخ أخاً لأن قصده قصد أخيه، وأصله من وحى أي قصد، فقلبت الواو همزة.”[100]
وفي “معجم النفائس الكبير”: “الأخ: من جمعك وإياه صُلب أو بطن. والصاحب، والصديق،… وقيل: الإخوة: ج الأخ من النسب، والإخوان ج الأخ من الصداقة، ومنه: إخوان الوداد أقرب من إخوان الولاد. والأخ: كل مشارك لغيره في القبيلة أو في الدين أو في الصنعة أو في معاملة أو في مودة.”[101]
لكن المنظومة القيمية تحتاج من المناهج والمقررات الدراسية أن تركز على أخوة الإيمان، والأخوة في مجتمع الأمة التي تؤسس للألفة، والوحدة، ووحدة الكلمة، ووحدة الموقف، ووحدة الصف. وقد ورد في الأثر: “ربّ أخٍ لم تلده لك أمك.”
ولعل المحطة التأسيسية للتآخي هي تلك التي كانت يوم الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنوّرة حيث كان الخطاب الأول للمؤمنين عند لقاء الأنصار من أهل المدينة المهاجرين من أهل مكة المكرمة من النبي صلى الله عليه وسلم: “تآخوا في الله أخوين أخوين؛ ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب، فقال: هذا أخي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيّد المرسلين، وإمام المتقين، ورسول رب العالمين، الذي ليس نظير (مثل) ولا تطير في العباد، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخوين؛ وكان حمزة بن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخوين، إليه أوصى حمزة يوم أحد حين حضره القتال إن حدث به حادث الموت.”[102]
ويكمل ابن هاشم:”وبلال مولى أبي بكر رضي الله عنهما، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو رويحة، عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي، ثم أحد الفزع، أخوين،… فلما دوّن عمر بن الخطاب الدواوين بالشام، وكان بلال قد خرج إلى الشام فأقام بها مجاهداً، فقال عمر لبلال: إلى من تجعل ديوانك يا بلال؟ قال: مع ابي رويحة، لا أفارقه أبداً، للأخوة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد بينه وبيني، فضم إليه، وضم ديوان الحبشة إلى خثعم، لمكان بلال منهم.”[103]
يحوي النص الذي رواه ابن هشام بشأن المؤاخاة لطائف تحتاج التحديد لتكون في ثوابت المنهج التربوي، وفي أساس منظومته القيمية، من هذه اللطائف:
- إن قاعدة الأخوة شملت الجميع فالرسول صلى الله عليه وسلم بدأها بنفسه فآخى الإمام علي كرّم الله وجهه، وحمزة رضي الله عنه وهو في الأصل من أعيان قريش وأسد الله في الإسلام لم يجد مشكلة في أن يؤاخي مولى رسول الله زيد بن حارثة رضي الله عنه. وأبو رويحة الخثعمى لم ير مشكلة في التآخي مع بلال رضي الله عنه وهو من أعتقه أبو بكر رضي الله عنه من الرّق بماله فأصبح مولاه.
- إن هذه الأخوة لم تكن سحابة صيف عابرة وإنما قامت على أساسها علاقات ثابتة راسخة، وثمرة ذلك أن حمزة بن عبد المطلب أوصى لزيد بن حارثة لأنه تآخى معه، وبلال اختار أن يكون ديوانه لأبي رويحة لأنه تأخى معه يوم الهجرة، وقبيلة خثعم قابلت بلال بن رباح المتآخي مع أحد أبنائها أبي رويحة بالوفاء والود فقبلت أن تضم ديوان الحبشة إليها إكراماً لبلال ولمكانته فيها.
إن هذا السياق لمفاعيل التآخي في الله تعالى يؤسس لعلاقات سليمة بين أبناء الأمة، ويجعل الطلاب والناشئة يتربون على هذه الأسس بدل بعض المفاهيم الدخيلة التي تسربت إلى فكر بعض أهل الأمة، وهي أفكار تخريبية تناقض ما دعا إليه الإسلام من روابط الأخوة بين المؤمنين.
لقد ارتقى الإسلام بالعلاقات من الرفقة والصداقة والزمالة إلى الأخوة، لكن النظام التربوي يحتاج إلى تحديد الضوابط والقواعد التي يجب أن يتربى عليها الطلاب كي يحسنوا اختيار الأخ التي لم تلده أم الشخص له، وقد يكون مفيداً قبل التآخي مع آخر أن يتّم اختبار الأمور التالية فيه:
“أ- الدين الذي يجعل صاحبه من الذين يسارعون في الخيرات، ويبتعدون عن منكر الأفعال، لأن تارك الدين عدو لنفسه يعرّضها للخسران المبين في الدنيا والآخرة. فكيف يرجى منه مودة غيره، أو النفع لغيره؟
ب-التعقّل الذي يقود إلى السلوك الراشد المتزن، لأن الحمق لا تثبت معه مودة ولا علاقة، فالأحمق لا يستقر على حال، ولهذا قال الحكماء: العدو العاقل أقل ضرراً من الصديق الجاهل.
ج-الأخلاق المحمودة التي تجعل صاحبها من أهل الخير الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بدءاً من أنفسهم وذلك لأن العلاقة مع الشرير المفسد في الأرض خطر على دنياك وعلى آخرتك فمودته تكثر أعداءك وتفسد أخلاقك، ولا خير في مودة تجلب العداوة وتورث مذمّة وملامة.”[104]
هكذا يحتاج النظام التربوي التأكيد على قيمة الأخوة شرط أن تقوم على بيّنة ومعرفة واضحة من كل من المتأخين للآخر كي لا تكون في مسار حياة المتآخين أية أشراك أو كمائن تفسد هذه الأخوة أمام استحقاق معين.
2-التضامن والتكافل الإجتماعي:
الكفالة والضمان مفردتان متقاربتان في المعنى. قال ابن منظور: “الكافل: العائل… والكافل: القائم بأمر اليتيم المربّي له، وهو من الكفيل الضمين… والكافل والكفيل: الضامن… وكفل المال وبالمال: ضمنه… أكفلت فلاناً المال إكفالاً إذا ضمنته إياه… ابن الأعرابي كفيل وكافل وضمين وضامن بمعنى واحد. التهذيب: وأما الكافل فهو الذي كفل إنساناً يعوله وينفق عليه… والكافل: المجاور المحالف، وهو أيضاً المعاقد المعاهد.”[105]
إن المعنيين متقاربان إلا أن النص القرآني وفي الحديث النبوي الشريف قد استخدم “التكافل”، وكان في هذا السياق ما جاء في قصة مريم عليها السلام وكفالة زكريا عليه السلام لها. قال الله تعالى: ﴿فتقبّلها ربّها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفّلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم أنّي لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.﴾(سورة آل عمران: 37).
وقال تعالى: ﴿ذلك من أبناء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيّهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.﴾ (سورة آل عمران: 44).
ورد عند القرطبي في تفسيره: “قوله تعالى: {وكفّلها زكريا} أي: ضمّها إليه. أبو عبيدة: ضمن القيام بها… وكفّلها ربّها زكريا، أي: ألزمه كفالتها، وقدّر ذلك عليه، ويسّره له.”[106]
وورد عنده كذلك: “أيّهم يكفل مريم”: “أي: يحضنها، فقال زكريا: أنا أحقّ بها، خالتها عندي.”[107] “ودلت الآية أيضاً على أن الخالة أحقّ بالحضانة من سائر القرابات ما عدا الجدّة، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة -واسمها أمة الله- لجعفر، وكانت عنده خالتها، وقال: إنما الخالة بمنزلة الأم.”[108]
والكفالة لمريم من قبل الخالة وزوجها إنما هي لأن مريم عليها السلام تحتاج الحضانة والتربية والرعاية، وهكذا الحال بالنسبة لكل إنسان، وبذلك تكون الأسرة هي موقع الحضانة الذي لا يستغنى عنه، والواجب أن يعتني التربويون بهذا الجانب، وأن لا يظنّ أحد أن بإمكان أحد فرداً أو مؤسسة أن يحل مكان الأسرة في التكوين الأول لشخصية الطفل. وبذلك تكون الكفالة ضرورة وقيمة.
كما أتى تأصيل قرآني آخر لموضوع الكفالة في قصة موسى عليه السلام، وذلك في قوله تعالى: ﴿إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكلفه فرجعتك إلى أمك كي تقرّ عينها ولا تحزن.﴾ (سورة طه: 40).
جاء في تفسير القرطبي: “فتقول هل أدلكم على من يكلفه” “وذلك انها خرجت متعرفة خبره، وكان موسى لما وهبه فرعون لامرأته طلبت له المراضع، وكان لا يأخذ من أحدٍ، حتى أقبلت أخته، فأخذته ووضعته في حجرها وناولته ثديها، فمصّه وفرح به فقالوا: تقيمين عندنا، فقالت: إنه لا لبن لي، ولكن أدلكم على من يكفله وهم له ناصحون. قالوا: ومن هي؟ قالت: أمي، فقالوا: لها لبن؟ قالت: لبن أخي هارون؟ وكان هارون أكبر من موسى بسنة، وقيل: بثلاث، وقيل: بأربع… وأقر الله عينه، أي: أعطاه حتى تقرّ، فلا تصمح إلى من هو فوقه… ولا تحزن أي: على فقدك.”[109]
هذه حالة أخرى من الكفالة يسّر الله تعالى فيها الأمر للنبي موسى عليه السلام بأن يعاج إلى حضانة أمه وإرضاعها له بعد أن فارقها حيث القته في صندوق على سطح الماء، لكن عندما أخرج وقدمه الفرعون لزوجته التي ليس لها أولاد لم يرتضع موسى سوى من أخته والأخت بمقام الأم كما الخالة في قصة مريم عليها السلام، وبعدها أرجع لأمه ليكون في الكفالة المناسبة من جهة، وكي تقرّ عين الأم بإرجاع ولدها لها، وهذا البيان القرآني يأتي ليؤكد التكافل وأهميته فالإنسان لا يستغني عنه.
إن حضور المادة: التكافل والتضامن في المناهج التعليمية، وفي قيم التربية ترسخ هذه القيمة عند الناشئة في مواجهة فلسفات تربوية تغرس تقديس الأنا، وعشق الذات، ونزعة الفردية فتصبح معها ميول الشخص أنانية.
الواجب أن تلتفت المنظومة القيمية في النظام التربوي إلى أنه يندرج في سياق “الأسس الهامة التي تقوم عليها الأخلاق الإسلامية مسألة التكافل في التعامل مع الثروة والإنفاق، وفي موقفي السّرّاء والضّرّاء. فالمجتمع في الإسلام يقوم على أساس من تكامل أبنائه في بوتقة تصهر طاقاتهم، وتوحّد أهدافهم وحتى مشاعرهم قدر المستطاع، فيصبحون كالجسد الواحد، أو كالبنيان المرصوص يشدّ بعضه بعضاً، فلا فردية ولا حبّ للذات ولا أثرة.”[110]
إن مواجهة التحديات بتنوعها وميادينها لا تكون ممكنة دون حالة من التضامن المتين، والتكافل القائم على قاعدة التآخي، فذلك يرضي الله تعالى، ويحقق النجاحات في شتى الميادين. قال الله تعالى: ﴿إنّ الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص.﴾ (سورة الصف: 4).
وقد جاء في الحديث النبوي الشريف عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من كان معه فضل ظهر، فليعد به على من لا ظهر له، ومن له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له.”[111] وذكر عليه الصلاة والسلام من أصناف المال والرزق حتى رأينا أنه لا حقّ لأحد منّا في الفضل.
كما جاء في الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الأشعريين وأثنى عليهم لأنهم مارسوا التكافل بأبهى صوره، والمأثور هو: “بارك الله في الأشعريين، فإنهم كانوا إذا أرملوا (أصابهم الفقر) وشحّ زادهم يضعون مابقي عندهم في ثوب واحد ويقتسمونه بينهم بالتساوي.”
إن الأمة تحتاج إلى جيل مشبع بهذه القيم الداعية إلى التضامن والتعاضد والتآزر بحيث يكفل أبناء المجتمع بعضهم بعضاً ولا يكون بينهم فقير أو من يواجه مشكلاته منفرداً بل في كل موقع يجد حوله من يأخذ بيده ويفرج من كروبه، ويمد يد العون له.
عند العودة إلى التأصيل القرآني لهذه القيمة الإجتماعية السامية يمكن الرجوع إلى الآيات الأولى من سورة الماعون، وهي قول الله تعالى: ﴿أرأيت الذي يكذب بالدين * فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحضّ على طعام المسكين.﴾ (سورة الماعون: 1 – 2)
والمكذب بالدين كافر ومن لم يعرف هذا المكذب الذي مرق من الإسلام، يدلّه عليه الله تعالى: “فذلك” الذي يعنّف اليتيم ويقسو عليه، فكيف الحال لو أنه ظلمه أو سرق رزقه وأغتصبه؟ وهو، أي المكذب بالدين، من لا يحثّ الناس الميسورين على كفالة المسكين وتقديم العون له والمساعدة، فكيف لو أنه كان يملك المال والإمكانات التي يحتاجها هذا المسكين؟
هذا هو الأمر الرباني للمؤمنين، ولا مجال للتهاون في هذا الأمر أمر التكافل والتضامن ما دام من لم يقم بذلك سيصنّف بين المكذبين بالدين.
إن الوافد الثقافي، وفيه الوافد القيمي التربوي والأخلاقي، وبعضه في مناهج التعليم وفي المادة الإعلامية لا يقيم وزناً لمفاهيم قيمية إسلامية كثيرة، منها قيم التكافل بحيث بات يتولد ثمة خطر من هذه المستوردات والأفاهيم الدخيلة التي “تقوم على أساس مادي تكاد تفسد علاقته مع ذاته حيث نلاحظ التناقض بين معتقده وعمله، وبين مفهومه وسلوكه. ولذلك من المفيد أن نعلم بأن عملية بناء لا تقوم إلا عندما نبدأ من الإنسان الذي يعدّ الثروة الحقيقية التي تساعد على النهوض والتقدم، فالمادة مهما نمت تبقى تكديساً كمياً، أما التشكيل الثقافي للإنسان وإخضاع الاقتصاد لهذا التشكيل وفق قاعدة التكافل التي فرضها الدين فهو مفتاح الحضارة الحقيقية… إن تطبيق قاعدة التكافل الاجتماعي في توزيع الثروة بما يضمن تطبيق قاعدة الإستخلاف في الأرض تولّد مفهوماً أخلاقياً إنساني الطابع والتوجهات يلفظ التعلق بالمادة على حساب تكريم الإنسان، وهذا يقود إلى النهضة المرجوة في عصرنا الحاضر.”[112]
تأسيساً على ما تقدم يكون الواجب أن يغرس المربون في الطلاب قيمة التكافل من خلال نصوص ودروس المناهج التعليمية، وهذا يتحقق مع المقررات المؤصّلة إسلامياً من القرآن الكريم والسّنّة النبوية، ومع تأمين المدرس القدوة، والإدارة المدرسية التي تمارس العمل الفريقي أثناء أداء مهامها، ومع التخطيط فالتنفيذ لأنشطة لاصفية للطلاب يمارسون من خلالها عملية التضامن والتكافل كي يتخرجوا من دراستهم، ويدخلوا سوق العمل وميادين الحياة مشبعين بهذه القيمة.
3-الحوار والجدل:
يأتي البشر إلى هذه الدنيا متنوعين في ما فطروا عليه، ويزداد هذا التنوع مع التربية والإكتساب والتعلّم، بحيث يظهر الناس بذكاء متفاوت، وتكون لهم ميول متباينة، وأفاهيم مختلفة، هذا غير التنوع في العقيدة، وما هو معتمد من أنظمة وقوانين، وما هو سائد من أعراف وقيم، لكل هذه المعطيات يكون الحوار ضرورة كي يتبادل أبناء المجتمع الواحد الرؤى والتصورات الذهنية، وليؤسسوا لعلاقات تقوم على التكامل والتقارب، والأمر نفسه يصح بالنسبة لعلاقات الأمم والشعوب ببعضها.
يناء على ما تقدم تكون المنظومة القيمية لنظام تربوي إسلامي أصيل محتاجة في مكوناتها إلى الحوار منهجاً يتدرب عليه الطلاب كي يستطيعوا التفاعل فيما بينهم، ومع أفراد أسرتهم وعائلتهم، ومحيطهم الإجتماعي، وأبناء وطنهم وأمتهم وصولاً إلى التعايش مع أبناء الأمم الأخرى وسائر الشعوب.
والحوار بأوسع معانيه ووجوهه أصبح مكوناً أساسياً لأي نظام تربوي مع تقدم تقنيات الاتصال والتواصل حيث بات من المستحيل أن يعيش أي شعب منعزلاً ضمن أسوار، أو حدود، بل الواقع أن الإنفتاح سمة إنسانية عالمية. وهذا الانفتاح الذي يحتاج الحوار منهجاً غرضه أن يعرف الناس بعضهم بعضاً ليؤسسوا للعلاقات بينهم. هذا الأفهوم كان الأصل فيه قرآنياً ينطلق من قوله تعالى: ﴿يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.﴾ (سورة الحجرات: 13).
بناء على ما تقدم يكون المطلوب أن يتضمن المقرر الدراسي في النظام التربوي الإسلامي مواد تعرف بالحوار وتحدد أسسه، ويكون واجب المعلمين والمربين أن يمارسوا الأسلوب الحواري مع الطلاب أثناء العملية التعليمية، أو حين إجراء الاختيارات، أو عند معالجة المشكلات والحوادث، أو في ملتقيات نقاشية تدريبية يمارس فيها الطلاب الحوار عملياً بإشراف أساتذتهم كي يخرجوا إلى الحياة وقد امتلكوا الاستعدادات الكافية لممارسة الحوار مع الآخر.
قال ابن منظور: “الحَوْر: الرجوع عن الشيء، حار على الشيء وعنه حواراً ومحاورة وحؤوراً: رجع عنه وإليه… الحوار: التحيّر، والحوار: الرجوع. يقال: حار بعد ما طار. والحوار: النقصان بعد الزيادة، لأنه رجوع من حال إلى حال، وفي الحديث: “تعوّذ بالله من الحور بعد الكَوْر.”، معناه من النقصان بعد الزيادة، وقيل: معناه من فساد أمورنا بعد صلاحها، وأصله من نقص العمامة بعد لفّها، مأخوذ من كَوْر العمامة إذا انتقص ليّها وبعضه يقرب من بعض، وكذلك الحور بالضم. وفي رواية: بعد الكون. قال أبو عبيد: سُئل عاصم عن هذا فقال: ألم تسمع إلى قولهم: حار بعد ما كان؟ يقول: إنه كان على حالة جميلة فحار من ذلك أي: رجع… وفي المثل: حور في محارة، فمعناه في نقصان، ورجوع في رجوع.”[113]
قال الله تعالى: ﴿إنّه ظنّ أن لن يحور.﴾ (سورة الانشقاق: 14)؛ أي ظن أنه لن يرجع مبعوثاً يوم القيامة. هذا ما يؤكد المعنى الإصطلاحي لمفردة حوار، ويتحاورون: يتراجعون الكلام. فالحوار أخذ وردّ في الكلام بين طرفين يبدأ طرحاً لفكرة يقوم به أحد الطرفين، فيقوم الطرف الآخر بتمثّل هذا الطرح، ويردّ عليه فينتج من ذلك تجاوب يولد عند كل من الطرفين مراجعة لما طرحه الطرف الآخر، ولذلك يجب أن يكون المحاور مستعداً للتحول من حال إلى حال، والحوار لا يلتزم أسلوباً واحداً، بل قد يكون المحاور مستفسراً طارحاً الأسئلة، وقد يكون في حالة التفنيد ودحض ما طرحه الآخر، وقد يعمد إلى طرح البراهين والحجج دعماً لموقفه الذي طرحه.
إن العملية التعليمية تحتاج الحوار من أجل تثبيت المعلومات أو بيانها، وبعد ذلك من أجل اختيار فهم الطالب لها ومدى استيعابه هذا مع تعليمه أن المعارف والعلوم محل أخذ ورد، ومراجعة لأن أحداً لا يملك الحقيقة المطلقة، وإنما كل العلوم بقوانينها ونظرياتها إنما هي احتمالية، وكل ما يطرحه طالب أو أستاذ إنما هو صواب يحتمل الخطأ أو خطأ يحتمل الصواب.
إن منظومتنا القيمية تحتاج أن تكون ذاخرة بالحوار وأساليبه بوصفه حاجة لا يستغني عنها أي اجتماع بشري أيًّا كان عدد أعضائه إلا أن الحوار قد يتخذ المنحى السلبي وأساليب القسوة والعنف، فتكون بسببه القطيعة والنفور والتباغض، ويصحّ القول: إن الحوار الإيجابي الفاعل هو ما رافقه العلم والوعي، وحضور العقل في كل خطوة. أما إذا قام الحوار على الجهل والعصبية فإن نتائجه تكون وخيمة.
هذا الحوار المطلوب يكون في الأمور المشتركة والقيم والأعداد ونشر العلم والمعرفة، ويكون حوار في أمر العقيدة ونصوص الشريعة فهي ثوابت أكيدة الواجب هو الالتزام بها، وهنا يأتي دور الجدل. ويكون السؤال مجدداً: ما الجدل؟ وهل الجدل والحوار متماثلان؟
ورد في لسان العرب: “الجدل: اللّدد في الخصومة والقدرة عليها… ويقال: جادلت الرجل فجدلته أي: غلبته. ورجل جدل إذا كان أقوى في الخصام. وجادله أي: خاصمه مجادلة وجدالاً، الإسم: الجدل، وهو شدة الخصومة… ويقال: إنه لجدل إذا كان شديد الخصام.”[114]
أما عند الجرجاني في التعريفات: “الجدل: هو القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات والغرض منه إلزام الخصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان. والجدل دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة، أو بقصد به تصحيح كلامه، وهو الخصومة الحقيقية.”[115]
النظام التربوي الأصيل إسلامياً يجب أن يعلم الطلاب أن الجدل ينطلق من أسس راسخة يؤمن بها من يحملها، ويلتزمها بثبات دونما ميل إلى التنازل أو التراجع عن أي شيء فيها، وهو خلاف الحوار الذي يقوم على المراجعة والتنازل إذا لزم الأمر، والجدل يكون على نوعين:
- جدل مذموم: وهو الذي يكون مرتكزاً إلى الباطل، ويقصد به صاحبه المراء، أو الكِبر، أو حبّ الظهور، والشهرة مع المعاندة بما هو فاسد.
ب-جدل محمود مطلوب: وهو الذي يهدف إلى استمالة الخصم بقوة الدليل والحجة، وهذا النوع من الجدل يرتكز على الحقّ، ويكون صاحبه صلباً، وهمّه الأساسي أن يظهر الحقّ.
والمجادل المحقّ الذي يمتلك الحجة يواجه خصومه من دعاة الباطل استناداً إلى بيان وبرهان ليعجزهم لأنهم لا يمتلكون من قوة الدليل ما يملك، ومن النصوص القرآنية التي تبين ذلك الآية الكريمة التي واجهت من زعموا أن الجنّة مآبهم من غير المسلمين، وفيها قول الله تعالى: ﴿قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.﴾ (سورة البقرة: 111).
تأسيساً على ما تقدم يكون المطلوب في النظام التربوي الإسلامي وما يعتمد من مقررات وأساليب ووسائل أن يتمّ تدريب الطلاب على أساليب الجدل الذي يلتزم فيه الطالب عقيدة الإسلام وشريعته، ويكون ذا مخزون معرفي، وزاد فقهي، وفكر نيّر ليمكنه ذلك من المحاججة والإقناع واستمالة الناس إلى دين الله وإلى القيم التي يلتزمها المسلم، وبالتالي ما يجب أن يكون معلوماً هو أن الحوار في العقيدة والشريعة والدعوة لا يكون بل البديل هو الجدل لذلك وجّه الخطاب الإلهي في قوله تعالى: ﴿ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنةوجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.﴾ (سورة النحل: 125). وقوله تعالى: ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنّا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.﴾ (سورة العنكبوت: 46).
إن الخطاب الإلهي جاء هنا ليقول لكل مؤمن: “ادعُ إلى الطريق الذي شرعه ربك مع قومك، واسلك في دعوتهم الطريق الذي يناسب كل واحد منهم، فادعُ معتمداً إيراد المواعظ، وضرب الأمثال التي توجههم إلى الحقّ، وترشدهم من أقرب طريق مناسب لهم، وجادل أصحاب الملل السابقة من أهل الكتب بالمنطق والقول الليّن، والمجادلة الحسنة التي لا يشوبها عنف ولا سباب، حتى تتمكن من إقناعهم واستمالتهم. هذا هو الطريق لدعوة الناس إلى الله على اختلاف ميولهم، فاسلك هذا الطريق معهم، واترك أمرهم بعد ذلك إلى ربّك الذي يعلم من غرق في الضلال منهم وابتعد عن طريق النجاة، ومن سلم طبعه فاهتدى وآمن بما جئتم به.”[116]
إذن الأمر في الدعوة إلى الإسلام هو جدل لا حوار، ولكن هذا الجدل يحتاج لأسلوب ولأداء مميّزان يحققان الإستمالة والإقناع، ومن مقومات ذلك الابتعاد عن الكلام الفظّ واللهجة القاسية، هذا مع مخاطبة كل إنسان بما تقبله مداركه من الحجج أو الخطاب.
ويفيد في هذا الباب أن يعرف القائمون على العملية التربوية ما قاله علماء السلف في أهمية اقتران الجدل بالأدب، ومن هؤلاء أبي المعالي الجويني إمام الحرمين الذي قال: “وأحسن شيء في الجدل المحافظة من كل واحد من المتجادلين على أدب الجدل، فإن الأدب في كل شيء حليته. فالأدب في الجدل يزيّن صاحبه، وترك الأدب فيه يزري به ويشينه. ومعظم الأدب في كل صناعة استعمال ما يختص بها، والاشتغال بما يعود نفعه إلى تقويمها والإعراض عمّا لا يعود بنفع إليها.”[117]
يضاف إلى الحوار والجدل المناظرة، وهي أسلوب في المواجهة بين شخصين هدفه إظهار الحقيقة، وأدب المناظرة أساسه أن المناظرة لا يهمه إن ظهر الحق على يده أو على يد غيره، بل الأساس هو بيان الحقيقة والوصول إلى ما هو صواب.
بناء على ما تقدم يكون الحوار أو التقابل بين شخصين أو مجموعتين ثلاثة أنواع هي:
- الجدل: وهو الحوار الدعوي الذي لا مجال فيه للتراجع والمراجعة، وإنما هو حوار تبليغي يحمل فيه المسلم الدعوة لدين الله، وكما أمر الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وأما الجدل الذي يعمد إليه بعضهم ليدحض الحقّ وينصر الباطل فهو مكابرة وفساد في الرأي لا يقبله الإسلام.
ب- المناظرة: وهي الحوار بمقابلة الرأي بالرأي، والغرض من ذلك هو جلاء الحقيقة التي يقرّها الإسلام، ولها نماذج في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والمناظرات منها ما يكون بين علماء الإسلام وفقهائه، ومن المناظرات ما تكون مع أتباع العقائد والشرائع الأخرى حتى لو كان مع أهل الشّرك، ومن نماذج ذلك الحوار مناظرة جاءت آيات بيّنات بلسان ابراهيم عليه السلام في محاورة مشرك يقال إنه النمرود، والذي بُهت عندما أعطاه حجة لا يمكنه الردّ عليها تتعلق بحركة الأرض وشروق الشمس وغروبها. (النص في سورة البقرة، الآية 258).
ج- الحوار: ويكون الحوار الذي هو المجاوبة والأخذ والرد، وهو أمر أجازه الإسلام في الأمور التي تستند إلى الحكمة والنظر العقلي، وإلى المعارف البشرية وإلى الخبرات والمواهب. لكن لا حوار في المسائل العقدية أو في الثوابت الشرعية والأحكام المنصوص عليها.
إن حاجة النظام التربوي الإسلامي في هذه الحقبة لمعرفة حدود الحوار وأصوله حاجة ملحة لأنه يكثر هذه الأيام الكلام حول الحوار، وتعقد المؤتمرات بشأنه، ولهذا تحتاج منظومة قيمية لنظام تربوي إسلامي إلى مادة تبيّن تأصيل الموضوع، ومن مفرداته أن يتم تصحيح مقولة: حوار الأديان؛ فالصحيح أن يقال: حوار أتباع الأديان والمعتقدات والفلسفات. ثمّ التنبيه إلى أن الحوار لا يكون في العقيدة ونصوص الشريعة وأحكامها، وإنما ساحة الحوار ومادته البحثية إنما هو المشترك الإنساني الذي يعني الجميع، ويعاني فيه كثيرون، وطلابنا بحاجة أن يتعلموا ذلك، وأن يتعرفوا عليه، فالحوار يكون في كل القيم الناظمة لشبكة العلاقات الإجتماعية في الأمة الواحدة، وبين الأمم والشعوب، أما أن يتعدى الحوار ذلك كي يتمكن الغزاة ثقافياً من ممارسة التشويه والتشويش فهذا ما لا يصح.
وبالمقابل لا يصح من النظام التربوي أن يغفل ذلك سواء في المقررات الدراسية، أو في أساليب التعليم وطرق التعلم، أو من قبل المدرسين، وأول التأهيل أن يكون المدرس محاوراً عندما يتقابل مع طلابه في الصفوف وقاعات التدريس، وأن يكون ذا حلم وصبر وسعة صدر كي يستوعب طلابه، وأن لا يضيق ذرعاً بحواراتهم معه لأنه بذلك يفسد مفهومهم للحوار وموقفهم منه، وقد يجعلهم ذلك في موقف النفور من الحوار، وفي حالة من السطحية تنتقل معهم إلى ميادين الحياة، وهذا أمر لا تحمد عاقبته.
4- الشورى:
إن الشورى من ثوابت الإسلام، وهي من الأمور التي تؤلف بين أبناء المجتمع كما أنها سبيل قويم من أجل تفجير الطاقات وبروز الإبداعات، وهي ميدان رحب لتلاقح الأفكار، وتبادل الخبرات، وفي ضرورة لممارسة العصف الذهني الذي يؤمن الفضاءات المناسبة من أجل قرارات ومواقف رصينة وحكيمة.
الشورى من قيم الإسلام، ومن أسس منظومات القيم في التربية، حيث تشكل المؤسسات التعليمية والتربوية المساحة الملائمة لتنمو شخصية الطالب مع التعويد على الشورى في مخلتف شؤون الحياة وفي كل الحالات والظروف حتى إذا خرج مشبّعاً بهذه القيمة، يكون حريصاً على ممارسة الشورى في الأسرة مع الأصدقاء والأقران وفي سوق العمل وأنواعه، وفي كل شأن وأمر أيًّا كان حقله.
إن الشورى ضرورة تؤسس لمجتمع تقوم العلاقات فيه على قاعدة حقّ الأمة، كل الأمة في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة، والوقوف معاً أمام التحديات والقضايا الكبرى، وهذه الشورى تمنع الطغيان والفساد سواء كان من جهة الأفراد أو الجماعات، لأن الشورى تؤمن المناخ ليشترك الجميع في السياسي والتربوي والاقتصادي والإعلامي والفكري والإجتماعي وغير ذلك.
الشورى عند الجرجاني هي: “بمعنى التشاور وطلب الرأي، وهو منهج الإسلام في الحكم وفي السياسة، والصفة التي لا ينبغي أن تفقدها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولفضلها سميت بها سورة في القرآن الكريم، ولأن الشورى في الإسلام قاعدة النظام السياسي والاجتماعي بل والعام والخاص في الحياة، لما لها من مكانة وأهمية بالغة في تحقيق المصلحة والغاية الناجحة، ولأن الاستبداد بالرأي يؤدي دائماً إلى أوخم العواقب، قال تعالى: ﴿وأمرهم شورى بينهم.﴾ (سورة الشورى: 38) أي أمرهم ذو شورى، يتشاورون، ولا ينفردون برأي حتى يتشاوروا، وذلك من فرط تيقظهم في الأمور، وإحكام الخطوات، والظفر بالمطلوب.
والشورى تبادل الآراء لمعرفة الصواب منها.”[118]
لقد جاء في النصوص القرآنية أية أخرى فيها لفظة الشورى هي:
قول الله تعالى: ﴿فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفُ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحبّ المتوكلين.﴾ (سورة آل عمران: 159).
ورد في تفسير القرطبي: “قال ابن عطية: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه… وقال ابن خويزمنداد: واجبٌ على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتّاب والوزراء والعمال فيما يتعلّق بمصالح البلاد وعمارتها.
وكان يقال: ما ندم من استشار. وكان يقال: من أعجب برأيه ضلّ… واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أمر الله نبيه عليه السلاة والسلام أن يشاور فيه أصحابه، فقالت طائفة: ذلك في مكايد الحروب، وعند لقاء العدو، وتطييباً لنفوسهم، ورفعاً لأقدارهم، وتألفاً على دينهم، وإن الله تعالى قد أغناه عن رأيهم بوحيه… وقال مقاتل وقتادة والربيع: كانت سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شقّ عليهم، فأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يشاورهم في الأمر؛ فإن ذلك أعطف لهم عليه، وأذهب لأضفانهم، وأطيب لنفوسهم، فإذا شاورهم عرفوا إكرامه لهم.”[119]
كل هذه المعاني والدلالات التي حشدها القرطبي يحتاجها النظام التربوي الإسلامي من أجل تكوين شخصية لأبناء أجيال الأمة. فمن الاهمية بمكان أن تحقق في حراك مجتمع الأمة ومساره الحضاري الأمور المستفادة مما أورده القرطبي، وهو:
- الاستفادة من العلماء المؤمنين، ومن ذوي الخبرة والمعرفة، وهذا يحتاج أن يُدرّب الطالب على المشاورة لأن طلاب اليوم هم رجال المستقبل الذين سيتولون مواقع القيادة والإدارة، والأبرز في هذا تثبيت قاعدة الشورى فيما لا يعلمه المسؤول في موقعه القيادي، وذلك لا ينتقص من مكانته، لأن الله تعالى قد أمر بذلك، وقد مارس الشورى رسول الله وهو من يتلقى الوحي، فكيف سواه من البشر؟ كما أن الشورى تعطل العقل الاستبدادي، وتعلم الجماعية وقبول الآخر واحترام الحريات.
ب- إن الشورى تشعر فريق العمل في قطاع ما، أن العاملين الناشطين في ميدان ما بأنهم محترمون، وأنهم شركاء في القرار قبل أن يطلب الاشتراك في التنفيذ، كما أن مشاورة من حول صاحب المسؤولية يشعرهم بالتقدير فيشحذ همتهم على العطاء. وهذا يحتاج من الاستاذ أثناء العملية التعليمية أن يتشاور مع طلابه وأن يشركهم في النشاط الصفي واللاصفي في كل مرة تسمح حالة العملية التعليمية بذلك.
ج-إن الشورى تكون لأهل الاختصاص في ميدان اختصاصهم وعلمهم وخبرتهم فالتربوي يستشار في التربية، والاقتصادي يستشار في الاقتصاد وخطط التنمية والاتفاق الانتاجي، والعسكري يستشار في إعداد الجيوش وحركات المقاومة والتحرير وفي تطوير السلاح، والإعلامي يستشار في صناعة المادة الإعلامية الملائمة للهوية الثقافية للأمة والملتزمة بقيم الأمة ودينها…الخ.
أما النص القرآني في سورة الشورى، فقد جاء في تفسير القرطبي حوله: “كانت الأنصار قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أمراً تشاوروا فيه، ثمّ عملوا عليه؛ فمدحهم الله تعالى به؛ قال النقّاس، وقال الحسن: أي: إنهم لانقايدهم إلى الرأي في أمورهم متفقون لا يختلفون؛ فمُدحوا باتفاق كلمتهم. قال الحسن: ما تشاور قوم قطّ إلا هُدوا لأرشد أمورهم. وقال الضحاك: هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد النقباء إليهم حتى اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على الإيمان به والنصرة له. وقيل: تشاورهم فيما يعرض له، فلا يستأثر بعضهم بخبر دون بعض.
وقال ابن العربي: الشورى أُلفة للجماعة ومسيار للعقول وسبب إلى الصواب، وما تشاور قطّ إلا هدوا. وقد قال حكيم (بشار بن برد):
أذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي لبيب أو مشورة حازم
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي نافع للقوادم[120]
فمدح الله المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يتمثلون ذلك.”[121]
إن الحياة العامة في مجتمع الأمة تحتاج الشورى منهجاً وقيمة، وإلى ذلك وجه الحقّ سبحانه عندما خصّ سورة من سور القرآن الكريم بهذا الإسم: “الشورى”. ولبيان موقع الشورى يحتاج الأمر إلى الوقوف عند السياق في النصّ القرآني:﴿ والذين استجابوا لربّهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ﴾(سورة الشورى، الآية38).
البلاغ الإلهي جاء يضع الشورى بين الصلاة والإنفاق (الزكاة)، وهما ركنان من أركان الإسلام “لأن الشورى تحقق الإستقرار في شبكة العلاقات الإجتماعية، وتوحّد الجهود والطاقات، فقد وردت في الآية الكريمة هنا بين فريضة في باب العبادات هي الصلاة، والصلاة من أركان الإسلام الخمسة، وبين فريضة في باب المعاملات تحقق التكافل الإجتماعي والتضامن في أعلى مستوياته هي الزكاة، وهذه الأخيرة هي كذلك ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولولا أن الشورى كمنهج عظيمة الفائدة في حياة الناس، عبادات ومعاملات، واجتماعياً لما كان موقعها في الآية الكريمة كما وردت، ولما حملت السورة بكاملها اسم الشورى.”[122]
لقد حصلت حالة التباس في التعاطي مع الشورى بوصفها قيمة ومنهجاً من جهة ظنّ قبيل من أهل الأمة أنها خاصة بالسياسة وأنها لازمة لإدارة الحكم والسلطة، وهذا ظنّ فاسد لأن الشورى تدخل في كل شأن من شؤون الحياة، وفي الموقف النقيض لها يكون الإستبداد والتعسّف، وغياب الشورى يفسد المجتمع أخلاقاً وسلوكاً لذا يحتاج النظام التربوي الإسلامي أن يؤصلها في الناشئة، ويحتاجها النظام مقررات وأسلوباً.
وقد كان موفقاً صاحب كتاب “الشورى وأثرها في الديمقراطية” عندما بيّن فساد الإستبداد ومخاطر تعطيل الشورى، حيث قال:” وفي المجال الأخلاقي لوحظ أن الكبت وانعدام الحرية يؤديان إلى الإنحراف والأمراض الخلقية والنفسية المتمثلة في كثرة الصياح والصراخ عند الشعوب المكبوتة، وكره النظام والميل للفوضى، وذلك طبيعي فالذي يحسّ بالإضطهاد يعتقد أنه لن يصل إلى حقّه بالإنتظار، وكذلك ازدياد الجبن والنفاق، وكثرة سوء الظنّ والمسارعة إلى الإتهام وشيوع الحقد نتيجة للأوضاع والإمتيازات الغير عادلة وضعف روح الولاء للوطن نتيجة عدم التقدير، وزوال صفة الامانة وضعف شخصية المواطن وعدم حماسته للعمل، وانتشار الرشوة والتحايل لقضاء المصالح نتيجة التعقيدات الإدارية.”[123]
إن الإستبداد كما تبيّن له مخاطره على الفضائل ومنظومة القيم، ولا يكون العلاج بغير الشورى التي تعزّز الثقة والألفة وتؤمن كل أسباب الإستقرار للمجتمع.
الفصل الرابع
ميادين المنظومة القيمية
تمهيد:
إن الإنسان ينمو ويترعرع في مجتمع، وترعاه مؤسسات وتحضنه فيلتقي فيه الفطري مع المكتسب ليكون ذلك مع تكيّفه مع المحيط الأساس في تكوين شخصيته ولغته وفكره.
والمكتسب هو العامل الحاسم في عناصر بنية الشخصية لذلك يكون الأمر التربوي محتاجاً للمأسسة كي تقوم المؤسسات في توفير الفضاءات المناسبة، ولا تجدي كثيراً الجهود الفردية في هذا الباب.
كما أن المأسسة تحتاج إلى التزام منظومة قيمية تضع الحدود والضوابط للمناهج، وللمدارس، وللمعلمين، وتحتاج إلى اعتماد المنظومة القيمية في كل المؤسسات الفاعلة في العملية التربوية، والمؤسسات الأكثر فعلاً من الناحية التربوية والتي تشكل ميادين سيرورة المنظومة القيمية هي: الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام.
1- الأسرة:
قد يسأل سائل: كيف تكون الأسرة بين مكونات المنظومة القيمية لنظام تربوي إسلامي أصيل؟
والجواب هو: إن الأسرة هي الحاضن الأول للمولود وللطفل قبل أن يدخل المدرسة وأثناء مراحل الدراسة والتأهيل، وهي من تؤسس ركائز شخصية الطفل، وهي من تغرس فيه المبادئ والقيم.
والأسرة اليوم تتعرض لغارات غير مسبوقة تستهدف كينونتها وصيرورتها وسيرورتها، والحال ظاهر لو راقب المرء مجتمع الغرب، وأمريكا ملحق أوروبي؛ لعرف كيف أن الغالب عندهم هو تفكك الأسرة وتشتت أطرافها، مع عدم الإقرار من قبل أكثر الناس بشيء إسمه صلة الرحم أو رابطة الأسرة والعائلة.
هذا الأمر يحول الأسرة من ميدان للقيم، ومن مؤسسة اجتماعية، إلى أن تكون قيمة والحفاظ عليها وفق الأسس الأصيلة والسليمة هو حفاظ على واحدة من أبرز القيم وأكثرها فعلاً في المجتمع.
يرتكز الاجتماع البشري في أي تكوين وطني وقومي على حلقة رئيسه، وخلية أولى هي الأسرة، وهذه الأسرة قد تكون من زوج وزوجة وأولاد وتسمى: الأسرة النواة؛ وقد تكون أسرة تضم الأشقاء والوالدين والزوجات والاولاد والأعمام والأخوال وهذه تدعى: الأسرة الممتدة، والأسرة بكلا نوعيها درة ثمينة لا بد من الحفاظ عليها، وتحصينها من الوافد القيمي الذي يريد القضاء عليها، لهذا يحتاج النظام التربوي الإسلامي أن يجعلها بين الأبرز من عناصر المنظومة القيمية، وهذا يحتاج للتنشئة على هذه المفاهيم، والروابط الاجتماعية.
تبدأ الأسرة من زوجين تكون بينهما علاقات عمادها الودّ والتراحم، ويكون كل واحد منهما مطمئناً للآخر واثقاً به. هذا ما كان تأصيله في قوله تعالى: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.﴾ (سورة الأنعام: 21).
إن الأسرة بوصفها القيمة الرئيسة في التنشئة تحتاج للتحصين، ويبدأ ذلك من ضبط مسار تكوين أشخاصها وفق الأخلاق القويمة، ويصح القول: “إن الأخلاق المطلوبة لكي تستقيم العلاقات في الأسرة لا تكون للأفراد ذكوراً وإناثاً إلا بالإعداد السليم، والتربية القويمة التي تقوم بها أمّ صالحة، فإذا أردنا أن نبني مجتمعاً صحيح الأخلاق، قويم العلاقات فعلينا الاعتناء بتأهيل المرأة.
فالرجل ذو مهمة في أعماله أقلّ دقّة من مهمة المرأة، لأن خطأ الرجل في زراعته أو صناعته أو وظيفته يمكن تصحيحه، أما خطأ المرأة تربوياً فليس من السهل إزالة آثاره السلبية على الأجيال.”[124]
إن الإعلام والإعلان يحملان السموم الناقعة للأسرة وللاجتماع البشري عموماً بسبب النفوذ الفكري المادي الطابع واللاديني المنهج، ويستطيع أي متابع _ولو لوقت قصير_ لوسيلة إعلامية أو لفقرات إعلانية أن يلاحظ ذلك. فلقد مارسوا ويمارسون تشييء المرأة، وربطها بالسلعة، لأن المفسدين يعلمون بأن المرأة _الأم هي المحور والركن المكين في الأسرة، وفي البناء الاجتماعي عموماً فإن نجحوا في إفسادها يكونوا قد نجحوا في تهديم الجيل.
والنظام التربوي الإسلامي المنشود يحتاج بالمقابل أن نبني شخصية الفتاة في مراحل التعليم والتربية على أسس إسلامية تحصنها من شرور المفاسدد، وتغرس فيها قيم الأخلاق ومحاسن الفضائل لذلك يكون الواجب أن يعتمد النظام التعليمي الإسلامي الفصل بين النوعين: الإناث والذكور في مراحل التعليم التي يبدأ معها البلوغ؛ أي بدءاً من الصف السابع الأساسي حتى نهاية المرحلة الثانوية، وذلك ليكون الإعداد على أساس الوظيفة المطلوبة من الأنثى والذكر وفق التالي:
- الذكور محتاجون إلى التحويل إلى رجال آياء من خلال تدريبهم على حمل المسؤولية وإعدادهم وفق أسس قيمية تجعلهم ناجحين في الدور الأبوي، هذا مع تصحيح الفهم عندهم تجاه المرأة؛ أي إزالة ما علق في الثقافة من عقد الذكورة، ومفاهيم المجتمع الأبوي الذي يتصرف أصحابه على أن الإسلام دين الذكور، وأن المرأة دوماً عرضة للتهميش وللنظرة الدونية حيالها.
ب-الإناث يحتجن إلى إعداد يجعل من كل أثنى امرأةً – أماً، تتمتع بالثقة بالنفس والرضا بالدور الأمي (نسبة للأم) دون استعلاء ولا غرور، ودون عقد الدونية. والأم ليست من تزوجت وأنجبت فقط، وإنما من حضنت وربّت ورعت، وقد تكون الأنثى أماً دون زواج ولا إنجاب، فكل مربية أم وكل حاضنة أم، وكل راعية لآخرين هي في موقع الأم لهم. ونجاحها هو المعيار وهو الأساس لمجتمع راقٍ مزدهر.
ج-الأم المستعارة وهذه مسألةباتت عبئاً ثقيلاً يهدد الجيل إذ أصبحت بعض من ينجبن الأطفال في موقع الآلة، وأصبح ارتباطها مع الطفل بيولوجياً فقط، حيث نجدها تسلمه للخادمة أو المربية التي تسمى الأم البديلة، أو تلقيه في دور الحضانة غير آبهة بدورها التربوي علماً أن النص القرآني جاء مبنياً للوالدية وعلاقتها بالأبناء في قول الله تعالى: ﴿وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً.﴾ (سورة الإسراء:24).
إن العملية التربوية الناجحة هي تلك التي تعد كلاً من النوعين: الفتاة والشاب، ليكونا مكونين متكاملين وظيفياً لا متماثلين، فالتكامل يبحر بسفينة المجتمع إلى برّ الأمان، أما التماثل فإنه يولد النفور ويعرض الدور الوظيفي للبوار والفشل لذلك نهى الحديث النبوي عن تشبه الرجال بالنساء، ونهى عن تشبه النساء بالرجال، لأن الأصل التكامل كما حال الكهرباء، فالتيار فيها يحتاج للموجب والسالب، ولا تكون كهرباء من الموجب لوحده أو السالب لوحده.
والأسرة التي تقدم لمجتمع الأمة طفلاً سوياً هي تلك التي تتوزع فيها الأدوار بين ركيزتيها الأم والأب بحيث لا يطغى عنصر على آخر، هذا مع عامل آخر هو أن تسود الروابط الأسرية الألفة والمودة والاستقرار لأن الطفل الذي يتربى في كنف مثل هذه الأسرة يكون متوازناًَ في ميوله وعواطفه وتصوراته الذهنية وكل وجوه حياته.
إلا أن المشكلة في ظواهر التفكك الأسري تحت تأثير الوافد الثقافي من خارج الحدود الشرعية والفكرية والاجتماعية، هذا التفكك الذي يكون طلاقاً منجزاً على السجلات ومدوناً، أو الطلاق والتباعد في المفاهيم والعلاقات مع بقاء الزواج على الورق، كل هذا يشكل خطراً على الأجيال، ويقدم أطفالاً منحرفي المزاج متقلبي الميول، مشتتي الفكر، وهؤلاء مشاريع شذاذ آفاق ومنحرفين.
لكن ما يجب أن تلتفت إليه عملية الإعداد والتربية هو أن المناهج التربوية والمناخ القيمي والأخلاقي في المدرسة إن من جهة البرامج أو المعلمين قد يشكل حاضنة بديل تجبر النقص، وتعوّض عن الأسرة، وهذا كما يرى كثيرون من الخبراء في الأنظمة التربوية، وفي العمل التربوي عموماً –وكاتب هذا البحث منهم- يستلزم أن تسند العملية التعليمية في المرحلة الابتدائية؛ أي من الصف الأول إلى الصف السادس لمدرسات من النساء لأن الولد في هذه المرحلة محتاج للمعلمة الأم أكثر من حاجته للمدرس الحامل للمعرفة الذي لا يمتلك عنصر الحضانة الملازم لمخزون عاطفي تملكه المعلمة الأنثى التي تؤمن للتلميذ ما فاته من عناصر الشخصية في أسرته.
وهنا تصبح المؤسسة التعليمية أسرة بديلة، ولأن عدداً غير قليل بسبب الجهل والتقصير، أو الانهماك بتوفير مطالب الحياة المادية لا يستطيعون العناية بأولادهم في أبعاد شخصيتهم النفسية والروحية والفكرية العقلية، ويقتصر دورهم على توفير الاشباع المادي وإعداد الجسد فإن النظام التربوي الإسلامي الأصيل يحتاج منظومات قيمية، ومناهج تعليمية، ومدرسات ومدرسين واداريين، وتقنيات تؤمن الفضاءات اللازمة لتكامل الأسرة والمدرسة، وبشكل خاص أن تسد المدرسة والتربية نقصاً خلفته الأسرة على الطفل.
وقد يكون من المفيد أن تتجه بعض فعاليات النظام التربوي الإسلامي الأصيل إلى الأسرة لتوجيهها وتعليمها ما ينقصها كي يحصل تعاون وتفاعل بين الأسرة والمدرسة، وتقارب في المفاهيم وفي القيم المعتمدة حتى لا يشعر الطالب بالتناقض بين ما يقوله أهله أو يمارسونه، وبين ما يتعلّمه في مدرسته أو يمارسه مدرسوه، أو يوجهونه إليه.
وإذا تدخلت المدرسة من خلال الإدارة في توجيه الأهل والتفاعل معهم، والتواصل من أجل عملية تربوية تعليمية ناجحة فإن واجب أفراد الأسرة والمعنيين وبشكل خاص أن يعلموا بأن “المطلوب من الوالدين أن يكونا فعلاً قدوة صالحة، ليتلقى الطفل منهما مباشرة وبدون مباشرة ما يؤكّد ذاتيته واستقلاله في إطار التصور الإسلامي الصحيح.
وينبغي أن تكون سياسة الاسرة قائمة على التفتح واختيار الجيّد، والبعد عن سياسة الإنغلاق والحرمان وإبعاد الأبواب، وتعتمد على تكوين الحسّ الإسلامي في نفوس الاطفال، وبالتدرّج وإنضاج القدرة على الإختيار الجيّد، واختيار الأشياء الجيدة والبعد عن السفاسف والرذائل.”[125]
إن الاسرة في هذه الحالة بحاجة إلى التعرف على المنظومة القيمية في النظام التربوي الإسلامي الأصيل كما الحال بالنسبة لمن يقومون بالعملية التعليمية، وهنا قد يستفاد من الإعلام بوسائله المتنوعة لخلق وعي عام بذلك، وباللقاءات التثقيفية مع أولياء أمور الطلاب ضمن المستطاع والممكن.
2- المدرسة:
إن المدرسة هي المؤسسة الحاضنة الثانية ترتيباً بعد الاسرة التي تستقبل الطفل في سنّ مبكرة، وهي الرابعة أو الخامسة، ويقضي الطفل فالفتى فالشباب في رحابها ساعات طوال يومياً، وهي المؤسسات الأولى غير الأسرة أو خارج الاسرة وقبل مؤسسات العمل والإنتاج التي تستقبل الطالب هذا الوفت الطويل. كما أن الأهل يسلمون المدرسة أولادهم واثقين بها وبدورها الإعدادي، وكثيرون من الأهل قد يهملون توجيه أولادهم وإعداد شخصيتهم متكلين في ذلك على المدرسة برامج وإدارة ومدرسين.
لذلك تشكل المدرسة مؤسسة اجتماعية “أنشأها المجتمع خاصة لتربية وتعليم صغاره، وكالة عن الكبار المشغولين في مشاغل الحياة، ونيابة عن المجتمع في نقل تراثه الثقافي إلى الصغار، وللمدرسة وظائفها الهامة في المجتمع، فيها المتخصصون في مجالات العلم والمعرفة لتقوم بتلك الوظائف، ومن ثمّ فهي تبلور اتجاهات المجتمع وتعكس إطار حياته.
وتمتاز المدرسة عن بقية المؤسسات الاجتماعية والوسائط الثقافية بأنها بيئة تربوية مُبسّطة للمواد العلمية والثقافية، وأنها بيئة تربوية موسعة تضمّ جميع أبناء المجتمع الواحد، وتوسع أفق الناشئ عن طريق تعليمه المباشر من خلال خبراته الشخصية وخبرات الآخرين. وأنها بيئة تربوية جاهزة وموحدة لميول ونزعات التلاميذ وصهرهم في بوتقة ثقافية واحدة مما ييسر التفاهم والتعاون بينهم بعد الخروج إلى معترك الحياة العملية.”[126]
إذن مهمة المدرسة تربوية وتعليمية والمشكلة هي في أن التمدرس في الأمة العربية والعالم الإسلامي منذ أكثر من قرن بدأ يستورد النظم الوافدة من أوروبا خاصة وبعدها من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد حملت معها المستوردات ما فيه تناقض كامل مع الهوية والثوابت، وما هو تفريط بالمنظومة القيمية؛ وقد بات الطالب يسبب ذلك في حالة من الحيرة من أمره، وبات قلقاً غير مستقر الفكر، تائهاً بين أصالة ومنطلقات تأصيلية من الدين وقيم المجتمع، وبين وافد مدرسي يقدم له على أنه صادر عن التقدم والتطور والتحديث.
هذا الضياع يظهر أهمية بلورة نظام تربوي إسلامي أصيل يلتزم منظومة قيمية تناسب الناشئة داخل المدرسة وفي المجتمع. والعملية التربوية في المدرسة تقتضي الخروج من أسلوب القول والأوامر والنواهي والوعظ إلى عملية ممارسة القيم في الأداء والتواصل والممارسة، وأن يكون بين الاعداد المدرسي ما يسمى الأنشطة اللاصفية التي يكون فيها المدرس قدوة لطلابه لجهة التزام المنظومة القيمية فيأتي، والحالة هذه، الفعل أبلغ من القول في التأثير على الناشئة الذين يبدأون تقليد أساتذتهم أولاً، وبعد التقليد ومع نمو الوعي يصبح السلوك إرادياً، وعندها تقدم المدرسة للمجتمع العناصر الصالحة.
إن الحديث عن المدرسة والتمدرس يقود إلى العودة إلى الأصول حيث كان التعليم الأصلي عند المسلمين معتمداً منذ بدء الدعوة إلى يومنا هذا، والتعليم الأصلي كان يسمى كتاتيب (ج كتّاب) أو خلاوي (ج خلوة) أو محاضر (ج محضرة)، أو يسمى المعهد أو الحوزة، وكل هذا التعليم كان أساسه ملازمة الطلاب لشيخ المحضرة والمعهد أو شيوخها، وكان ذلك يؤمن فرصة التربية الخلقية والعملية مع تلقي المعارف والعلوم، وكان هذا التعليم يحتل أقوم الأمكنة وأفضلها نظراً لموقع التربية والتعليم إسلامياً. قال محمد بن سحنون: “ولم يزل شأن الكتاتيب في نمو، وعددها في ازدياد، وتكاثر في العاصمة، وفي المدائن الأفريقية الكبيرة كتونس وسوسة وصفاقس حتى لم يخلُ منها درب من الدروب أو حيّ من الأحياء… وربما تعددت الكتاتيب في الحارة الواحدة مثلما تعددت المساجد في الحارات. ولا عجب أن اعتبرت الكتاتيب في القديم كملحقات بالمساجد وتابع لها، بل إنها وجدت أيضاً في دور الأعيان والأغنياء، وبالأحرى قصور الوزراء والأمراء.”[127]
وقد كان انتشار الكتاتيب أمراً قائماً في الأمة العربية والعالم الإسلامي وهذا التعليم الأصلي كان يشمل الذكور والإناث، وتتساوى جميع فئات المجتمع في حق التحصيل العلمي، وتعطى الفرصة فيه لأبناء الناس جميعاً هذا مع التركيز على آداب السلوك. ولعل ما قاله الخليفة العباسي هارون الرشيد لأحد المعلمين عندما أرسل إليه ولده محمد الأمين يصلح في الأسس الرئيسة للنظام التربوي الإسلامي الأصيل، ومن الخطاب ما يلي: “يا أحمر إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه، وثمرة قلبه، فصيّر يدك عليه مبسوطة، وطاعته لك واجبة، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين، أقرئه القرآن وعرّفه الأخبار، وعلّمه السنن، وبصّره بمواقع الكلام وبدئه، وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، … لا تمرّّنّ بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن تحزنه فنميت ذهنه، ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه، وقوّمه ما استطعت بالقرب والملاينة فإن أباهما فعليك بالشّدّة والغلظة.”[128]
يحوي هذا النص من مقدمة ابن خلدون قواعد للتعامل المدرسي مع الطالب لها حضورها في كل مكان وزمان، وقسم منها صاغه معاصرون غربيون في نظريات للتعلم استقبلها قبيل من أبناء أمتنا، وكان الأولي أن يراجع هؤلاء التراث، ومنه ما حوته مقدمة ابن خلدون.
القواعد التربوية التي حواها النص تحتاج البيان والتفصيل وهي ما يلي:
- الطلاب أولاد لأبوين يقعان منهما موقع القلب، والطالب إنسان هو المخلوق الأكرم، لذلك يكون الواجب أن يرتقي التعامل مع الطالب والعناية به إلى المستوى المناسب.
ب-طاعة الطالب للأستاذ المربي ضرورة لإنجاح العملية التربوية فالأستاذ هو راعٍ وحاضن للطالب وليس نداً له.
ج- أول العلوم المطلوبة هي العكوف على كتاب الله قراءة وحفظاً وفهماً، وبعدها دراسة التاريخ وروايات الأثر والتراث لكي يكون الطالب على صلة مع ربه سبحانه من خلال القرآن الكريم، وليكون على صلة مع التاريخ ومحطاته والإرث الحضاري، ومن لا تاريخ له لا ذاكرة له، إذ أمجاد الماضي تشكل دافعاً مهماً للإنجاز.
د- اللغة هي وجه الفكر الآخر تغذيه وبواسطتها يكون التعبير، هي من عناصر الهوية يضاف إلى ذلك إسلامياً أن اللغة العربية هي لغة الوحي، لهذه كله تكون دراسة اللغة العربية والتمكن منها ضرورة تربوية تعليمية.
هـ- العملية التربوية الناجحة هي تلك التي تعوّد الطالب الجدّيّة والرصانة، وتبعد به من الهزل وكثرة الضحك، لأن الوقار من مكونات الشخصية الناجحة ومقوماتها. وبمقابل ذلك ليس مقبولاً من الناحية التربوية أن يكثر المربون والمعلمون من مظاهر الحزن التي تولد الكآبة عند الطالب.
و- الوقت يمضي، والساعات تنقضي، والعمر محدود، وهذا يفيد أن الزمن عنصر مهم، وتوظيفه واستثماره في الأعمال المفيدة أمران مطلوبان، والأمر يبدأ في رحاب المدرسة وبحضانة المربي الذي يرتب الأعمال في الأوقات بين أنشطة صفية وأخرى لا صفية كي لا تذهب الساعات هدراً، ويضيع العمر سدى. والمعلوم أن الإنسان سيسأل في اليوم الآخر عن عمره فيما أمضاه.
ز- أما أسلوب التعامل والتأديب فيكون بالحزم دون القسوة، وبالضبط دون تعسف، وأن يكون الأسلوب المناسب حسب كل ظرف فحيناً يكون اللين مطلوباً، وآخر تكون الشّدّة هي العلاج الشافي.
إن هذه القواعد من أساسات النظام المدرسي الناجح الذي يأتي ليؤسس لنظام تربوي إسلامي أصيل منشود، وهو الصالح ليكون البديل عن الوافد المستورد، القائم ضمن منظومة قيمية ثقافية تختلف عن المنظومة الإسلامية والعربية.
إن أطراف العملية التعليمية في المدرسة هم: المعلم والطالب والمناهج، وأساليب التعليم ووسائله وتقنياته. وابن خلدون لم يهمل موضوع المناهج والمضامين في الكتب وأسلوب تقديم المعارف للطالب، ولأن النظام التربوي الإسلامي يكون في المدرسة فإن المفيد أن ترد القواعد القيمية تحت هذا العنوان، وما أبرزه ابن خلدون، ويعدّ مهماً للنظام التربوي في رحاب المدرسة ما يلي:
- “إن تعليم الولدان للقرآن شعار من شعار الدين أخذ به أهل الملّة ودرحوا عليه في جميع أمصارهم لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات القرآن، وبعض متون الأحاديث، وصار القرآن أصل التعليم الذي يبني عليه ما يحصل بعض من الملكات، وسبب ذلك أن التعليم في الصغر أشدّ رسوخاً وهو أصل لما بعده.”[129]
ب-” إنه مما أضرّ بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة التآليف، واختلاف الاصطلاحات في التعليم، وتعدد طرقها ثمّ مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك، وحينئذ يسلم له منصب التحصيل، فيحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرها ومراعاة طرقها، ولا يفي عمره بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد لها فيفع القصور.”[130]
ج- “ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم يولعون بها، ويدونون منها برنامجاً مختصراً في كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باختصار في الألفاظ، وحشد القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن، وصار ذلك مخلاً بالبلاغة، وعسراً على الفهم.”[131]
د- “إعلم أن تقليل العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيداً إذا كان على التدريج شيئاً فشيئاً، وقليلاً قليلاً؛ يلقي عليه أولاً مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم.”[132]
بقي أن يضاف إلى أسس العملية التعليمية والتربوية في المدرسة أمر أخير هو اعتماد التعلّم بدل التعليم لأن التعلّم الذي يكون فيه الطالب محور العملية التعليمية في النظام المدرسي أكثر جدوى في سرعة رسوخ المعلومات. وهذا يقتضي تخفيف عملية التلقين حيث كان القائم قديماً التعليم لا التعلم، وفي التعليم يكون المدرس أساس العملية التعليمية بخلاف التعلّم، وهذا ما يطلق عليه اسم: الطرق الناشطة. ولو كان المثال من طفل نريد تعليمه الإمساك بالقلم والكتابة، فإن الطريقة التقليدية القائمة على الإمساك بيد الطفل ومساعدته على الكتابة بطيئة النتائج، وتطول المدة كي يتمكن الطالب الكتابة بمفرده، ولو تمّ الإكتفاء بالتوجيه والتسديد، وتسلّم الطالب الورقة والقلم ليمارس المحاولات بنفسه لكان الوقت لإتقان الكتابة اقصر من الحالة الاولى، وتنطبق هذه القاعدة على عملية التحصيل العلمي عموماً.
هذه قواعد ومفاهيم تحتاجها المدرسة التي تريد أن يكون فيها نظام تربوي إسلامي أصيل، وتكون فيه منظومة قيمية إسلامية تعمل على تنشئة الطلاب تنشئة تناسب الإسلام عقيدة وشريعة.
3- المسجد:
كل موضع يُسجد فيه لله تعالى في أطار أداء العبادات، خاصة الصلاة، إنما هو مسجد. وهنا تمّ اشتقاق الإسم من ركن واحد من أركان الصلاة هو السجود، وفي ذلك عبرة -والله أعلم- هذه العبرة هي أن الساجد يكون في الحالة الاكثر خضوعاً لخالقه، وفي الهيئة الأكثر تذللاً لله تعالى، والساجد حال سجوده يكون أقرب ما يكون لله تعالى.
والمسجد بيت لله تعالى يقصده المؤمن بدافع عقدي إيماني ولا يبتغي من وراء ذلك مصلحة مادية أو دنيوية لذلك كان المسجد وسيبقى الموقع الفاعل في نفس المؤمن ذهنياً وفكرياً من جهة، وعاطفياً وروحياً من جهة أخرى. المؤمن يشعر في داخل المسجد بالمهابة ويتولّد عنده الخشوع، وتنمو عنده التقوى لأن المساجد تبنى وتقوم على التقوى أصلاً.
إن المسجد هو من أكثر المؤسسات الدينية والإجتماعية تأثيراً على الإنسان، وبشكل خاص حديث السّن، وبذلك يكون المسجد من المؤسسات التربوية الأساسية لصقل شخصية الطفل اليافع فالكبير، وهو الذي يهذبها ويؤدبها ويغرس فيها القيم والمثل العليا.
وإذا كان النظام التربوي الإسلامي الاصيل يقوم في أحد أساساته على المنظومة القيمية فإن المسجد وما يكون في أرجائه من تلاوة وعبادة ووعظ وخطب وتوجيه وتعليم هو الذي يغرس عناصر المنظومة القيمية ذات المتربي.
فالإسلام الذي أبلغ من خلال الحديث النبوي الشريف: “جعلت الأرض مسجداً وطهوراً.”[133] قد أمر ببناء المسجد وكان قول الله تعالى: “في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح فيها بالغدوّ والأصال. رجالٌ لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلّب فيه القلوب والأبصار.”(سورة النور: 36، 37).
حول هذا النصّ القرآني ورد أن بعض العلماء جمعوا خمسة عشرة فضيلة هي: “من حرمة المسجد أن يسلّم وقت الدخول إن كان القوم جلوساً، وإن لم يكن في المسجد أحد قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأن يركع ركعتين قبل أن يجلس، وألا يشتري فيه ولا يبيع، ولا يسلّ فيه سهماً ولا سيفاً، ولا يطلب فيه ضالّته، ولا يرفع فيه صوتاً بغير ذكر الله تعالى، ولا يتكلم فيه بأحاديث الدنيا، ولا يتخطّى رقاب الناس، ولا ينازع في المكان، ولا يضيّق على أحد في الصف، ولا يمر بين يدي مصلٍّ، ولا يبصق، ولا يتنخّم؟ ولا يتمخّط فيه، ولا يفرقع أصابعه، ولا يعبث بشيء من جسده، وأن ينزّه عن النجاسات والصبيان والمجانين، وإقامة الحدود، وأن يكثر ذكر الله تعالى ولا يغفل عنه فإذا فعل هذه الخصال، فقد أدّى حقّ المسجد، وكان المسجد حرزاً له وحصناً من الشيطان الرجيم.”[134]
إن هذه الخصال المطلوبة ممن دخل مسجداً خصال تلحظ معظم عناصر المنظومة القيمية المطلوب الإلتزام بها من قبل إنسان معين ليكون ملتزماً ما يصلح به المجتمع. هذه القواعد السلوكية سيضاف إليها ما يكون في المسجد من تعليم وتوجيه؛ هذا ما جعل المسجد مؤسسة محورية في تربية الأجيال، وترسيخ العقيدة السليمة فيها، لذلك كان بناء المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة يوم الهجرة، فالمسجد جامع للناس، مؤلف بين قلوبهم، موحد لمفاهيمهم، محقق للتواصل والإتصال بينهم.
لقد حضّ الإسلام على أجر صلاة الجماعة، وفرض صلاة الجمعة في المساجد، لأنه في رحاب المساجد “تتم عملية تربية الفرد وبناء المجتمع، ويربط المسجد خضوع الجسد بخضوع الروح لله، والعبادة بالهدف الأخلاقي منها، وبهذه العبادة في المسجد مع الجماعة ينمّي الإسلام التربية الروحية وتزكية النفس الأمّارة بالسوء، ويخلّصها من أنانيتها وفرديتها وأثرتها وعُجبها وكبرها وريائها وحبّها للشهوات، ويتجه بهذه النفس بعد تزكيتها لتتفاعل مع غيرها، وتتحد وتتمازج حتى يصبح المجتمع جسداً واحداًً إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى، ففي الجسد كل شؤون الحياة النقية الصافية، فلا انفصال بين العلاقة الروحية بين العبد وربه، وبين العلاقة الإجتماعية التي تربط المسلم بالمجتمع.”[135]
لكن الحديث عن المسجد يحتاج إلى بيان أمر هو أن المساجد ككل المؤسسات، فقد يؤسس المسجد على التقوى ويؤدي رسالته، وقد يؤسس بعض أهل الأهواء مساجد سماها الإسلام: المساجد الضرار وتكون الأولى في ما يوجه إليه الإسلام، وهذه الأخيرة يكون الحكم فيها أن تهدم ويعطل دورها، وهذا الموقف مستفاد من قول الله تعالى: ﴿والذين اتخذوا مسجداً ضراراًً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفنّ إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون * لا تقم فيه أبداً لمسجد أسّس على التقوى من أول يوم أحقّ أن تقوم فيه رجال يحبّون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين.﴾ (سورة التوبة: 107 – 108).
لقد بنى مجموعة من المنافقين مسجداً، وعندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجهز لغزوة تبوك، أتاه هؤلاء يطلبون منه أن يصلي فيه، فكان الأمر بإحراقه لأنه ضرار. والواقعة حسب ابن اسحاق فيما رواه ابن هشام كالآتي: “كان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنّا قد بنينا مسجداً…وإنّا نحب أن تأتينا، فتصلي لنا فيه، فقال: إنّي على جناح سفر، وحال شُغل…فلما نزل بذي أوان (بلدة تبعد مسيرة ساعة عن المدينة) أتاه خبر المسجد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن بني الدّخشم، أخا بني سالم بن عوف، ومعن بن عدي، أو أخاه عاصم بن عدي، أخا بني العجلان، فقال: انطلقاً إلى هذا المسجد الظالم أهله، فاهدماه وحرّقاه…فأشعلا فيه ناراً، ثمّ خرجا يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله، فحرّفاه وهدّماه.”[136]
أما المساجد المؤسسة على التقوى فإنها مقصد لكل مؤمن يحب أن يتطهر بدنياً بالاغتسال والوضوء وطهارة الثوب، ونفسياً بالتزكية والذكر والعبادة متقرباً إلى الله تعالى.
إن مساجد التقوى هي صاحبة دور رئيس في التربية، وهي منارات للهدى، ونشر الدعوة، وهي مواضع للذكر والعبادة والألفة وتعزيز نسيج العلاقات الاجتماعية في المستوى الأرقى والأنقى، والشرط الأساسي فيها أن تكون مخصصة للدعوة إلى الله، وأن لا يحيد أحد بها عن أهدافها ورسالتها، والله تعالى هو القائل: ﴿وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً﴾ (سورة الجن:18).
لقد ازدادت الحاجة إلى دور المساجد في التربية وترسيخ القيم في نفوس الناشئة، ويتحقق ذلك من خلال أسلوبين هما:
- أن يبنى مسجد في كل مدرسة ليؤدي فيه الطلاب مع مدرسيهم الصلوات، وأن تنظم فيه دروس على شكل حلقات تضاف إلى ما يتلقاه الطلاب في صفوفهم من دروس على أن تكون هذه الحلقات مفتوحة للطلاب من أكثر من صف ليكون التفاعل بينهم في رحاب المسجد.
ب-أن يعاد للمسجد دوره من خلال إقامة مؤسسات ملحقة به هي: مكتبة عامة، ومراكز طبية (مستوصفات)، ومعاهد للحفظ والتلاوة، وملاعب رياضية ومنشآت للترفيه عن الأولاد وسوى ذلك مما يجعل المسجد مؤسسة محورية تستقطب الراغبين في النشاط أيًّا كان نوعه.
بقي القول: إن إعداد الدعاة العاملين من خلال المساجد مهمة كي يكون للمساجد دورها الفاعل. أما الداعية المطلوب فهو تربوي مسلح بالصبر والأناة يتمتع بعقل استيعابي يمكنه من تعليم الآخرين وتربيتهم، وهو مشحون بالرحمة، والغيرة عليهم، وفي حساباته أن يأخذ بيدهم مع التدرج في طرح الأفكار تماماً كما تفعل مدربة الطفل للمشي على قدميه. والداعية المطلوب هو الذي يجعل من المسجد مؤسسة تتكامل مع المؤسسات الأخرى في سبيل إعداد الجيل الواعد، وهذه هي مهمة التربوي الإسلامي الأصيل.
4- الإعلام:
يشكل الإعلام ميداناً فسيحاً لتكوين القناعات، ونشر العقائد والأفكار والمفاهيم، وله دور رئيس في غرس القيم وتزيينها لاستمالة الناس إليها.
والإعلام يبدأ من الحوار بين شخصين إلى مخاطبة جماعة ما، إلى المحاضرة والندوة والاحتفال، إلى المعرض والفنون والكتاب، وصولاً إلى المجلة والجريدة والمذياع والتلفاز والشبكة البينية (inter.net)، يضاف إلى ذلك كل شكل من أشكال الإتصال بين طرفين بالكلمة أو الإشارة أو الرمز أو غير ذلك.
يشهد الإنسان هذه الأيام حجم تدخل الإعلام في كل شأن من الشؤون، كما يشهد كل متابع تعداد فاعلية الإعلام في توجيه الرأي، وتكوينه، وقد تقدم الإعلام في ميدان التربية على مواضع أخرى تتم في رحابها العملية التربوية بما في ذلك الأسرة والمسجد، وفي بعض الحالات نجد دور الإعلام قد تقدم على دور المدرسة.
“فالإعلام بمختلف وسائله وميادينه تدخل في كل شأن من الشؤون، من الوعظ الديني إلى النشاط السياسي، ومن التعليم والثقافة إلى الاقتصاد والصناعة، ومن الإعلان والأخبار إلى الفن والتسلية.
والإعلام ككل سلاح له حدّان: فإما أن يوظف في مصلحة الأمة، من خلال الإعداد الدقيق لبرامجه بحيث تكون ملتزمة بمبادئ الأمة وأهدافها وحضارتها، وإما أن يكون إعلاماً للإعلام غير واضح الأهداف ينشر من خلاله كل ما تقع عليه يد الإعلاميين، وفي هذه الحالة يكون الإعلام سلاحاً فتاكاً بيد أعداء الأمة، فمن خلاله تنتشر الشائعات، ويتولد الإحباط، وينتشر الفساد.”[137]
لقد بات للإعلام دور بارز في العملية التربوية، وفي نشر القيم، أو نشر المفاسد والرذائل، وبالتالي فإن منظومة قيمية تضبط السلوك عند الطلاب في نظام تربوي أصيل تحتاج إلى إعلام تربوي – تعليمي مضبوط الإيقاع يلتزم الثوابت وينطلق من المبادئ باتجاه المقاصد النبيلة، والغايات السامية،
إن وسائل الإعلام تتناول في برامجها وموادها كل جوانب الحياة العامة والخاصة إضافة إلى المعارف لذلك يكون تأثيرها “في مجال تنمية المفاهيم والقيم والاتجاهات بالغ الأهمية، فهي تنقل إلى الناس معتقدات واتجاهات وقيماً، في شكل قصة أو في شكل أنماط سلوكية قد تحظى بالقبول وقد تحظى بالرفض، ومن خلال وسائل الإعلام هذه يتلقى الناشئة تلك المعتقدات والاتجاهات والقيم، والتي من المفروض أن تكون موافقة مع ما ترتضيه ثقافته، وأن تعرض المثل الأعلى المنشود في هذا المجتمع أو ذاك، ويمعنى آخر أن تعكس أهداف المجتمع من الإنسان والحياة.”[138]
إن ما يبيّن دور الإعلام المنظومات القيمية تربوياً ما نراه اليوم من تسابق على تمويل القنوات الفضائية وصناعة المواد الإعلامية في أفلام أو برامج أو إعلانات، وما نراه من تهافت على تمضية ساعات طويلة أمام شاشة الحاسوب الآلي (الكمبيوتر) سواء مع الأقراص المبرمجة أو عند اتصال من خلال الشبكة البينية (الأنترنت)، وهنا يجوز طرح السؤال التالي: لماذا هذا الانفاق من قبل دول وجهات ومؤسسات؟ أليس من أجل تسويق المفاهيم والأفكار بشتى أنواعها الإيجابي منها والسلبي؟
كل شاشة تحتاج سنوياً لملايين الدولارات ولو لا أنها تحقق مصلحة أو تخدم هوى لمن يمولونها لم يكونوا ليفعلوا ذلك. وفي الاتجاه المقابل يكون واجب الغيارى على الدين وعلى الأجيال أن يوظفوا الامكانات الكافية لصناعة إعلام يحصن، ويزرع القيم، وينشر الفضائل، ليكون إعلاماً فاعلاً في تعزيز حضور المنظومة القيمية والهوية الثقافية العربية الإسلامية في وجدان الجيل الناشئ، وإلا إذا أصر بعضهم على الأنماط التقليدية في التعليم والتربية، فإنه سوف يستيقظ بعد حين ليجد أنهم قد سرقوا منه الأجيال إلى المواقع التي تعادي الهوية، وتفرّط بالقيم، ولا تبالي بالأخلاق والمثل العليا، أو تلك التي تغرس مفاهيم الغلو والتطرف فيصبح الجيل بين الإفراط والتفريط، وكلاهما مهلك.
أما الوسائل والأساليب فهي التي تحتاج للدرس والعناية من خلال الوجوه التالية:
- أن توظف جهود إبداعية في صناعة مواد إعلامية مشبعة بالمنظومة القيمية الإسلامية، وتزين محاسن الأخلاق والفضائل، ويتجسد ذلك في نصوص لزوم المقررات الدراسية أو مسرحيات وحلقات تتخذ الصورة والصوت وسيلة كي تكون الاستفادة من المادة الإعلامية متيسرة للجميع.
- الاستفادة من تقنيات العصر بأنواعها كلها في العملية التربوية وكذلك في عمليات الوعظ والإرشاد، ومغادرة ما بات من الأساليب والوسائل غير فاعل أو مؤثر على الأجيال انطلاقاً من القاعدة القائلة: “ربّوا أبناءكم على غير ما تربيتم عليه لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم”.
ج- تصنيع مواد إعلامية تحقق الاستمالة والاستقطاب للطلاب، وطرح البدائل التي تحقق التحصين، ويكون ذلك باستخدام الإعلام لعرض مضار ما هو محرم. ويكون ذلك مثلاً بعرض مضار الخمر على الصحة وكيف أنها تذهب العقل لبعض الوقت، وحين السكر يصدر من الشخص أفعال مشينة، ومشهد يبيّن أثر الخمور على الأجنة إذا تعاطت الحامل المسكر، كل ذلك ينفر المتلقين من الخمر وسواها، وهذا الأسلوب ناجع لأنه لا يكفي اعتماد الأوامر والإرشادات.
د- التنبيه من الإعلام الذي يستهلك الوقت والطاقة البدنية من غير جدوى، ومن الأمثلة على ذلك الإعلام الرياضي الذي تخصص له قنوات وصفحات في الدوريات والشبكة البينية، والأجدى أن يمارس الطالب هواية الرياضة لسلامة بدنه وأن يخفف من متابعة الإعلام الرياضي لأن الإكثار منه يذهب الوقت والجهد في غير المكان المناسب.
هـ- أن يعمل الإعلام على تنمية قيمة الجمال بوصفها قيمة ترتقي بالذوق والحسّ، وتطلع الإنسان على آيات الله الباهرات، ولأن الجماليات هي المدخل الأكثر أهمية في قبول الفكرة، فكلما ارتدت الأفكار والمواقف ثوب الجمال في الشكل والمضمون وأساليب العرض كلما كان تأثيرها أكبر، وقبولها أسرع.
و- أن يلتزم الإعلام هوية الأمة الثقافية محذراً من الوافد المسموم، وهذا لا يعني الذهاب إلى الانغلاق والإنعزال، وإنما الانفتاح ودراسة ما عند الآخرين تمهيداً لقبول ما هو نافع، ورفض كل ما هو ضار بالعقيدة أو الشريعة، ويخالف منظومتنا القيمية.
ز- التأكيد على نظام القدوة في التربية، وهنا يكون الموقف سليماً حين يحصل التكامل بين كل المؤسسات المعنية بالناشئة وبين القائمين عليها كذلك، لأن التربية الإسلامية الأصيلة تحتاج لجهودهم المتكاملة، هذا إضافة إلى اعتماد التخطيط وامتلاك الحجة وأساليب الاستمالة والاقناع. فلا يفيد إذا عاش الطالب مناخاً تربوياً سليماً في موقع، ووجد ما يخالفه في ميادين آخرى، فالأمر يحتاج أن تكون المنظومة القيمية واحدة في الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام، وفي كل محبط الطالب كي نبني جيلاً راقياً واعداً.
ختاماً نقول: “إن الإعلام الذي نريده إعلام يشخّص المرسلون من خلاله أمراض الأمة، ويعون التحديات التي تواجهها كي يكون ما ينتجونه ويعرضونه مشروع مجابهة لهذه التحديات، وعلاجاً لما يسود من إشكالات، وغرساً لما تتمير به حضارة الأمة من خصائص تميّزها عن غيرها من الأمم كي تحفظ شخصيتها واستقلالها، ولا مانع أن يقوم بينها ن غيرها نظام تبادلي، وإطار تفاعلي لكن من غير المقبول أن تكون في موقع التابع الذي يُملى عليه ويتأثر دون أن يحتل دوره في التأثير.”[139]
هذا هو الإعلام الذي يستطيع لعب دور تربوي كبير خدمة للمنظومة القيمية من أجل نظام تربوي إسلامي أصيل.
الفصل الخامس
المنظومة القيمية من النصوص
إن من يمارس مهمة التربية يحتاج في عمله إلى نصوص من القرآن الكريم ومن السّنّة النبوية الشريفة، كي تشكل مادة في مقررات التدريس، وفي التوجيه والإرشاد، وفي تهذيب نفوس الطلاب، وصقل شخصيتهم، تأسيساً على ذلك يأتي هذا الثبت من النصوص ليلبي الحاجة ضمن المنظومة القيمة من أجل نظام تربوي إسلامي أصيل، هذه النصوص هي:
1-الأخلاق:
– ﴿وإنك لعلى خلق عظيم.﴾ (سورة القلم: 4).
– “الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، والخلق السوء يفسد كما يفسد الخل العسل”. رواه المنذري في الترغيب والترهيب – كتاب الأدب.
– “بُعِثت لأتمم حُسن الأخلاق.” رواه الإمام مالك في “الموطأ” – كتاب الجامع.
– “أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً، وخياركم خياركم لنسائه.” رواه الترمذي في السنن، وراه النووي في “رياض الصالحين” – باب في الوصية بالنساء، ورواه المنذري في الترهيب والترغيب – كتاب الأدب.
2- بر الوالدين:
– ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغنّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً * واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربّ ارحمهما كما ربياني صغيراً.﴾ (سورة الإسراء: 23، 24).
– ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهنٍ وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إليّ المصير.﴾ (سورة لقمان: 14).
– “جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحقّ الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمّك، قال: ثمّ من؟ قال: أمّك، قال: ثمّ من؟ قال: أمّك. قال: ثمّ من؟ قال: أبوك.” حديث متفق عليه، ورواه النووي في “رياض الصالحين” – باب: في بر الوالدين وصلة الأرحام.
– “إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسبّ الرجل أب الرجل، فيسبّ أباه، ويسبّ أمه، فيسبّ أمه.” رواه البخاري في الصحيح- كتاب الأدب.
3- الخير:
– ﴿ولكل وجهة هو مولّيها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأتِ بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير.﴾ (سورة البقرة: 148).
– ﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدو واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.﴾ (سورة الحج: 77).
– “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت.” رواه البخاري في الصحيح-كتاب الأدب.
– “من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله.” رواه مسلم في الصحيح.
4- الأمانة:
– ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً.﴾ (سورة النساء: 58).
– ﴿والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.﴾ (سورة المؤمنون: 8).
– ﴿والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.﴾ (سورة المعارج: 32).
– “آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.” حديث متفق عليه، ورواه النووي “في رياض الصالحين” – باب في الأمر بأداء الأمانة.
– “إذا ضُيّعت الأمانة فانتظر الساعة، فقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وُسّد الأمر إلى غير أهله، فانتظر الساعة.” رواه البخاري في الصحيح – باب العلم.
5- الصدق:
– ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.﴾ (سورة التوبة: 119).
– ﴿والذي جاء بالصدق وصدّق به أولئك هم المتقون.﴾ (سورة المزمل: 33).
– ﴿ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحته ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلاً.﴾ (سورة الأحزاب: 23).
– “إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صدّيقاً، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذباً.” رواه البخاري في الصحيح – كتاب الأدب.
– “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة.” رواه الترمذي، والنووي في “رياض الصالحين” – باب: في الصدق.
6- التعاون:
– ﴿وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.﴾ (سورة المائدة: 2).
– ﴿إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.﴾ (سورة الحجرات: 10).
– ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا.﴾ (سورة آل عمران: 103).
– “لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام.” رواه البخاري في الصحيح – كتاب الأدب.
– “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قلّ طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم، في ثوب واحد، ثمّ اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم منى وأنا منهم.” متفق عليه، ورواه النووي في رياض الصالحين – باب في الإيثار والمواساة.
7- الكرم:
– ﴿ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً.﴾ (سورة الإنسان: 8).
– ﴿فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شحّ نفسه فأولئك هم المفلحون.﴾ (سورة التغابن: 16).
– “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.” رواه البخاري في الصحيح – كتاب الأدب.
– “لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالاً، فسلّطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضي بها ويعلّمها.” حديث متفق عليه ورواه النووي في رياض الصالحين – باب في الكرم والجود.
8- التقوى:
– ﴿يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حقّ تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.﴾ (سورة آل عمران: 102).
– ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً.﴾ (سورة الطلاق: 2).
– ﴿فاتقوا الله ما استطعتم.﴾ (سورة التغابن: 16).
– “عن أنس بن مالك، قال: سمعت عمر بن الخطاب وخرجت معه حتى دخل حائطاً، فسمعته وهو يقول: – وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط – عمر بن الخطاب أمير المؤمنين؟ بخٍ بخٍ، والله لتتقينّ الله أو ليعذبنك.” رواه الإمام مالك في الموطأ – كتاب الجامع.
– “قيل: يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم.” حديث متفق عليه، ورواه النووي في رياض الصالحين – باب في التقوى.
9- الصبر:
– ﴿واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.﴾ (سورة البقرة: 45).
– ﴿ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشّر الصابرين.﴾(سورة البقرة:155).
– ﴿يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.﴾(سورة آل عمران:200).
– “عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً له.” رواه مسلم في الصحيح، وورد في مجموع الحديث النجدية-باب التوكل والصبر.
10- كظم الغيظ والحِلم:
– ﴿الذين ينفقون في السّرّاء والضّرّاء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.﴾(سورة آل عمران:134).
– ﴿ولا تستوي الحسنة ولا السّيّئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليّ حميم.﴾(سورة فصلت:34)
– ﴿فبشّرناه بغلام حليم.﴾(سورة الصافات:101)
– ” ما من جرعة أعظم أجراً عند الله من جرعة غيظ كظمها عبدٌ ابتغاء وجه الله.” رواه ابن ماجة في السنن.
– “إن الله يحبّ الرفق في الأمر كله.” رواه البخاري في الصحيح- كتاب الأدب.
– “ليس الشديد بالصّرّعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.” رواه البخاري في الصحيح – كتاب الأدب.
– “بال أعرابي في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سَجْلاً (دلواً) من ماء، أو ذنوباً من ماء، فإنما بُعثتم ميسّرين، ولم تبعثوا معسّرين.” رواه النووي في رياض الصالحين – باب: في الحلم والأناة والرفق.
– ” من كظم غيظاً، وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة.” رواه أبو داود والترمذي في السنن.
11- العِفّة:
– ﴿للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفّف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.﴾(سورة البقرة:273)
– ﴿ومن كان غنياً فليستعفف.﴾(سورة النساء:6)
– ﴿وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله.﴾(سورة النور:24)
– “اللهم، إنّي أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.” رواه مسلم في الصحيح.
– “من طالب حقًّا، فليطلبه في عفافٍ وافٍ أو غير وافٍ.” رواه ابن ماجة في السنن.
– “اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعف يعِفّه الله، ومن يستغن يغنه الله.” رواه البخاري في الصحيح – كتاب الزكاة.
12- الكلمة الطيّبة:
– ﴿ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيّبة كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء * تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون * ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.﴾ (سورة إبراهيم: 23-24-25).
– “إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم.” رواه البخاري في الصحيح – كتاب الرقاق.
– “من آمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت.” رواه البخاري في الصحيح كتاب الأدب.
13- التواضع وهجر الكِبر والعُجب:
– ﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتدّ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلّة على المؤمنين أعزة على الكافرين.﴾ (سورة المائدة: 54).
– ﴿ولا تمشِ في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً.﴾ (سورة الإسراء: 37).
– قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد.” رواه مسلم في الصحيح، ورواه النووي في رياض الصالحين- باب: في التواضع وخفض الجناح للمؤمنين ورواه المنذري في الترغيب والترهيب – كتاب الأدب.
-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “طوبى لمن تواضع في غير منقصة، وذلّ في نفسه من غير مسألة.” رواه المنذري في الترغيب والترهيب – كتاب الأدب.
– “من تواضع لأخيه المسلم رفعه الله، ومن ارتفع عليه وضعه الله.” رواه الطبراني في الأوسط، والمنذري في الترغيب والترهيب – كتاب الأدب.
– حديث قدسي: يقول الله جل وعلا: “الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في النار.” رواه المنذري في الترغيب والترهيب – كتاب الأدب – وابن ماجة في السنن.
14- الإصلاح بين الناس:
– ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتعاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً.﴾ (سورة النساء: 114).
– ﴿يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.﴾ (سورة الأنفال: 1).
– ﴿إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.﴾ (سورة الحجرات: 10).
– قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة.” رواه أبو داود والترمذي في السنن، ورواه المنذري في الترغيب والترهيب – كتاب الأدب.
-“أفضل الصدقة إصلاح ذات البين.” رواه المنذري في الترغيب والترهيب – كتاب الأدب.
15- الحسد:
– ﴿أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً.﴾ (سورة النساء: 54).
– ﴿فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً.﴾ (سورة الفتح: 15).
– ﴿ومن شرّ حاسد إذا حسد.﴾ (سورة الفلق: 5).
– “إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات، كما تأكل النار الحطب، أو قال: العشب.” رواه أبو داود في السنن، والنووي في رياض الصالحين – باب: في تحريم الحسد.
– “لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا.” رواه المنذري في الترغيب والترهيب – كتاب الأدب.
– من حديث طويل حول رجل من أهل الجنة جاء بلسانه: “ما هو إلا ما رأيت غير أنّي لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشًّا ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه.” رواه المنذري في الترغيب والترهيب – كتاب الأدب.
16- الرياء:
– ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر.﴾ (سورة البقرة، 264).
– ﴿ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.﴾ (سورة الأنفال: 47).
– ﴿الذين هم يراءون.﴾ (سورة الماعون: 6).
– “من سمّع سمّع الله به، ومن يرائي يرائي الله به.” رواه البخاري في الصحيح – كتاب الرقاق.
– عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: “إن ناساً قالوا له: إنّا ندخل على سلاطيننا، فنقول لهم بخلاف ما نتكلم، إذا خرجنا من عندهم؟ قال ابن عمر: كنّا نعدّ ذلك نفاقاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.” رواه النووي في رياض الصالحين – باب: في تحريم الرياء.
– “وتجدون شرّ الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه.” رواه المنذري في الترغيب والترهيب – كتاب الأدب.
17- صلة الرحم:
– ﴿واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً.﴾ (سورة النساء: 1).
– ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.﴾ (سورة الأنفال: 75).
– ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطّعوا أرحامكم.﴾ (سورة محمد: 22).
– “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه.” رواه البخاري في الصحيح – كتاب الأدب.
– “من سرّه أن يبسط له في رزقه، أو يُنسأ له في أثره فليصل رحمه.” رواه البخاري في الصحيح – كتاب البيوع.
– قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ثلاث متعلقات بالعرش: الرحم تقول اللهم إني بك فلا أقطع، والأمانة تقول: اللهم إني بك فلا أخان، والنعمة تقول: اللهم إني بك فلا أكفر.” رواه المنذري في الترغيب والترهيب – كتاب البر والصلة.
18- كفالة اليتيم:
– ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً.﴾ (سورة النساء: 10).
– ﴿وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب.﴾ (سورة النساء: 2).
– ﴿فأما اليتيم فلا تقهر.﴾ (سورة الضحى: 9).
– قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أنا وكافل اليتيم في الجنّة هكذا – وأشار بالسبابة والوسطى – وفرّج بينهما.” رواه النووي في رياض الصالحين – باب في ملاطفة اليتيم.
– “من ضمّ يتيماً من بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه وجبت له الجنة.” رواه المنذري في الترغيب والترهيب – كتاب البر والصلة.
19- الجار:
– ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً.﴾ (سورة النساء: 36).
– “من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فلا يؤذِ جاره.” رواه البخاري في الصحيح – كتاب الأدب.
– “وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوّرثه.” رواه البخاري في الصحيح– كتاب الأدب.
– “إن الرجل لا يكون مؤمناً حتى يأمن جاره بوائقه، يبيت حين يبيت وهو آمنٌ من شرّه.” رواه المنذري في الترغيب والترهيب – كتاب البر والصلة.
20- الجمال:
– ﴿إنّا زيّنا السماء الدينا بزينة الكواكب.﴾ (سورة الصافات: 6).
– ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق.﴾ (سورة الأعراف:32).
– ﴿يا بني آدم خذوا رينتكم عند كل مسجد.﴾ (سورة الأعراف: 31).
– ﴿حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت.﴾ (سورة يونس: 24).
– “لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر، فقال رجل: إن الرجل يحبّ أن يكون ثوبه حسناً وفعله حسن، فقال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال.” رواه مسلم في الصحيح – كتاب الإيمان.
– “قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: “إنّي لو علمت أنك تستمع لقراءتي، لحسّنت صوتي بالقرآن، وزينته به، ورتلته.” رواه القرطبي في مقدمة تفسيره: “الجامع لأحكام القرآن” – باب: كيفية التلاوة.
– “رينوا القرآن بأصواتكم” رواه النسائي في السنن – كتاب الافتتاح.
المصادر والمراجع:
1-ابن خلدون، عبد الرحمن، بيروت، دار القلم، بدون تاريخ.
2- ابن سحنون، كتاب آداب المعلمين، مراجعة وتعليق محمد العروسي المطوي، تونس، دار الكتاب، سنة 1972.
3- ابن عاشور، محمد الطاهر، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، تونس، الشركة التونسية للتوزيع – الدار العربية للكتاب، سنة 1977.
4- ابن عدي، يحيى، تهذيب الأخلاق، دراسة وتقديم جاد حاتم، بيروت، المكتبة الشرقية، سنة 1986م.
5- ابن نبي، مالك، في مهب المعركة، دمشق، دار الفكر، سنة 1981م.
6- ابن بني، مالك، مشكلة الثقافة، دمشق، دار الفكر، سنة 1979م.
7- ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، م2، بيرون، دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ.
8- أبو العينين، د. علي خليل مصطفى، القيم الإسلامية والتربية، ط1، المدينة المنورة، مكتبة إبراهيم الحلبي، سنة 1408هـ / 1988م.
9- الأصول والمبادئ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، سنة 1987م.
10- الأنصاري،د. عبد الحميد اسماعيل، الشورى وأثرها في الديمقراطية، ط3، صيدا-بيروت، المكتبة العصرية، بدون تاريخ.
11- بنمسعود، عبد المجيد، منظومتنا التربوية إلى أين؟، الدار البيضاء، منشورات الفرقان، سنة 2000 م.
12- الجزائري، أبو بكر جابر، عقيدة المؤمن، ط3، جدّة، دار الشروق، سنة 1402 هـ – 1982م.
13- الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي، الكافية في أصول الجدل، تحقيق د. فوقية حسين محمود، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، سنة 1399هـ – 1979م.
14- حبنكة الميداني، عبد الرحمن حسن، العقيدة الإسلامية وأسسها، ط3، دمشق، دار القلم، سنة 1403 هـ – 1983م.
15-السحمراني، أسعد، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، ط4، بيروت، دار النفائس، سنة 1428هـ / 2007م.
16- السحمراني، أسعد، الإعلام أولاً، ط1، بيروت، دار النفائس، سنة 1415هـ – 1994م.
17-السحمراني، أسعد، صراع الامم بين العولمة والديمقراطية، ط1، بيروت، دار النفائس، سنة 1420هـ – 2000م.
18- السحمراني، أسعد، العدل فريضة إسلامية والحرية ضرورة إنسانية، ط1، بيروت، دار النفائس، سنة 1411هـ/1991.
19- السحمراني، أسعد، مالك بن نبي مفكراً إصلاحياً، ط2، بيروت، دار النفائس، سنة 1406 هـ / 1986م.
20- السحمراني، أسعد، المرأة في التاريخ والشريعة، ط2، بيرون، دار النفائس، سنة 1417هـ – 1997م.
21- شريعتي، د. علي، الإنسان والإسلام، ط1، بيروت، دار الروضة، ترجمة عباس الترجمان، سنة 1422هـ – 1992م.
22- الصباغ، د.بسام، دور المسجد في تكوين الرأي العام، ط1، دمشق، دار الإيمان، سنة 1427هـ – 2006م.
23- الصمدي، خالد، القيم الإسلامية في مناهج الدراسية، الرباط، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، سنة1424هـ /2003م.
24- نحو استراتيجية لتطوير التربية في البلاد الإسلامية، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، الرباط، سنة 1410 هـ – 1990 م.
المعاجم:
25- ابن منظور، لسان العرب، م4، تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرين، القاهرة، دار المعارف، بدون تاريخ.
26- الجرجاني، علي بن محمد الشريف، التعريفات، تحقيق د. محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط1، بيروت، دار النفائس، سنة 1424 هـ – 2003م.
27-الراغب الاصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن، بيروت، دار الكتاب العربي، سنة 1392هـ / 1972م.
28- معجم النفائس الكبير، م2، ط1، بيروت، دار النفائس، سنة 1428هـ / 2007م.
29- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مصر، سنة 1393هـ / 1973م.
التفاسير:
30- القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، ج9، تحقيق د. عبد الله بن المحسن التركي وآخرين، ط1، بيروت، مؤسسة الرسالة، سنة 1427هـ / 2006م.
31- المنتخب في تفسير القرآن الكريم، ط18، مصر، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية – وزارة الأوقاف، سنة 1416هـ / 1995م.
[1] المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مصر، سنة 1393هـ / 1973م، ص 933.
[2] معجم النفائس الكبير، م2، ط1، بيروت، دار النفائس، سنة 1428هـ / 2007م، ص 2019.
[3] بنمسعود، عبد المجيد، منظومتنا التربوية إلى أين؟، الدار البيضاء، منشورات الفرقان، سنة 2000 م، ص 32.
[4] ابن منظور، لسان العرب، م4، تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرين، القاهرة، دار المعارف، بدون تاريخ، ص 246.
[5] معجم النفائس الكبير، م2، م.س.، ص 1655.
[6] المعجم الوسيط، ج2، م.س.، ص 768.
[7] الراغب الاصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن، بيروت، دار الكتاب العربي، سنة 1392هـ / 1972م.
[8] القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، ج9، تحقيق د. عبد الله بن المحسن التركي وآخرين، ط1، بيروت، مؤسسة الرسالة، سنة 1427هـ / 2006م، ص 138.
[9] المنتخب في تفسير القرآن الكريم، ط18، مصر، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية – وزارة الأوقاف، سنة 1416هـ / 1995م، ص 202.
[10] الراغب الأصفهاني، ص 432.
[11] أبو العينين، د. علي خليل مصطفى، القيم الإسلامية والتربية، ط1، المدينة المنورة، مكتبة إبراهيم الحلبي، سنة 1408هـ / 1988م، ص 34.
[12] الصمدي، خالد، القيم الإسلامية في مناهج الدراسية، الرباط، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، سنة 1424هـ /2003م، ص 33، 34.
[13] ابن منظور، لسان العرب، م3، م.س.، ص1547.
[14] الراغب الأصفهاني، م.س.، ص189.
[15] معجم النفائس الكبير، م.س.، ص655.
[16] المعجم العربي الأساسي، م.س.، ص497.
[17] شريعتي، د. علي، الإنسان والإسلام، ط1، بيروت، دار الروضة، ترجمة عباس الترجمان، سنة 1422هـ – 1992م، ص15.
[18] رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما قيل في اولاد المسلمين.
[19] نحو استراتيجية لتطوير التربية في البلاد الإسلامية، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، الرباط، سنة 1410 هـ – 1990 م، ص 39.
[20] نحو استراتيجية لتطوير التربية في البلاد الإسلامية، م.س.، ص41.
[21] بنمسعود، عبدالمجيد، م.س.، ص13.
[22] أبو العينين، د. علي خليل مصطفى، م.س.، ص123.
[23] بنمسعود، عبد المجيد، م.س.، ص 203.
[24] معجم النفائس الكبير، م1، م.س.، ص 38، 39.
[25] المعجم العربي الأساسي، م. س.، ص 94.
[26] الراغب الأصفهاني، م.س.، ص 15.
[27] ابن خلدون، عبد الرحمن، بيروت، دار القلم، بدون تاريخ، ص 341.
[28] الشيباني، د. عمر محمد التومي، قضايا الإنسان، في الفكر التربوي العربي الإسلامي: الأصول والمبادئ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، سنة 1987م، ص 136.
[29]- حبنكة الميداني، عبد الرحمن حسن، العقيدة الإسلامية وأسسها، ط3، دمشق، دار القلم، سنة 1403 هـ – 1983م، ص 98، 99.
-[30] الجزائري، أبو بكر جابر، عقيدة المؤمن، ط3، جدّة، دار الشروق، سنة 1402 هـ – 1982م، ص 26.
-[31] رواه مسلم في صحيحه، ويحيى بن شريف في رياض الصالحين، باب في الصبر.
-[32] القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، م.س.، ج5، ص 423.
-[33] القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، م.س.، ج9، ص 499.
-[34] القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، م.س.، ج12، ص 65.
-[35] ابن منظور، م.س.، م4، ص 2606، 2607.
-[36] معجم النفائس الكبير، م1، م.س.، ص 1118.
-[37] الراغب الأصفهاني، م.س.، ص 308.
-[38] الكيلاني، د. ماجد عسان، اتجاهات معاصرة في التربية الأخلاقية، ط1، عمّان، دار البشير، سنة 1412هـ/ 1992م، ص66، 67.
[39]- رواه النسائي في السنن في كتاب الإيمان وشرائعه.
-[40] السحمراني، أسعد، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، ط4، بيروت، دار النفائس، سنة 1428هـ / 2007م، ص 24.
-[41] الراغب الأصفهاني، م.س.، ص 398، 399.
-[42] معجم النفائس الكبير، م.س.، ص 1488.
-[43] ابن منظور، م.س.، م 5، ص 3451.
-[44] ابن عاشور، محمد الطاهر، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، تونس، الشركة التونسية للتوزيع – الدار العربية للكتاب، سنة 1977، ص 51.
-[45] ابن عاشور، محمد الطاهر، م.س.، ص 53.
[46]- ابن عاشور، محمد الطاهر، م.س.، ص 169.
-[47] الكواكبي، عبد الرحمن، طبائع الإستبداد ومصارع الإستعباد، تقديم أسعد السحمراني، ط3، بيروت، دار النفائس، سنة 1427 هـ / 2006م، ص 56.
-[48] الكواكبي، عبد الرحمن، م.س.، ص 71، 72.
-[49] السحمراني، أسعد، العدل فريضة إسلامية والحرية ضرورة إنسانية، ط1، بيروت، دار النفائس، سنة 1411هـ/1991، ص 69.
-[50] ابن عدي، يحيى، تهذيب الأخلاق، دراسة وتقديم جاد حاتم، بيروت، المكتبة الشرقية، سنة 1986م، ص 45.
-[51] مالك بن بني، مشكلة الثقافة، دمشق، دار الفكر، سنة 1979، ص 86.
-[52] القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، م.س.، ج22، ص 368.
-[53] القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد/ م. س.، ج22، ص 369، 370.
-[54] القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، م.س.، ج13، ص 125، 126.
[55]- ابن نبي، مالك، في مهب المعركة، دمشق، دار الفكر، سنة 1981م، ص 163، 164.
-[56] السحمراني، أسعد، مالك بن نبي مفكراً إصلاحياً، ط2، بيروت، دار النفائس، سنة 1406 هـ / 1986م، ص 194.
-[57] القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، م.س.، ج 17، ص 245.
-[58] القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، م.س.، ج 17، ص 246.
-[59] القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، م.س.، ج13، ص 80.
-[60] السحمراني، أسعد، مالك بن نبي مفكراً إصلاحياً، م.س.، ص 20، 21.
[61] – متفق عليه، ورواه النسائي في السنن في كتاب النكاح (باب التبتل).
[62] – إعلان عمان لتعزيز الصحة باتباع أنماط الحياة الإسلامية، منظمة الصحة العالمية. المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، طبع في الإسكندرية، منشورات منظمة الصحة العالمية، سنة 1995، ص5.
[63] – رواه الترمذي وابن ماجة في السنن عن المقدام بن معدي كرب والنسائي في كتاب آداب الأكل.
[64] – الشيباني، د. عمر محمد التومي، قضايا الإنسان في الفكر التربوي العربي الإسلامي: الأصول والمبادئ، م.س.، ص 145، 146.
[65] – رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب ورواه آخرون كذلك.
[66] – ابن منظور، م.س.، م3، ص 1768.
[67] – ابن منظور، م.س.، م6، ص 4500.
[68] – العش، د. يوسف، والزحيلي، د. محمد، تاريخ الأديان، دمشق، جامعة دمشق، سنة 1401هـ / 1981م، ص 60.
[69] – متفق عليه ورواه النووي في رياض الصالحين، في باب فضل الحب في الله.
[70] – الشيباني، د. عمر محمد التومي، م.س.، ص 150.
[71] – رواه البخاري، باب التواضع.
[72] – أبو العينين، د. علي خليل مصطفى، م.س.، ص 210.
[73] – العش، د. يوسف، والزحيلي، د, محمد، م.س.، ص 57.
[74] – رواه مسلم، والنووي في رياض الصالحين في باب: في الصبر.
[75] – القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، م.س.، ج 20، ص 365.
[76] – القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، م.س.، ج2، ص 490، 491.
[77] -القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، م.س.، ج5، ص 465.
[78] – ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، بيروت، دار القلم، بدون تاريخ، ص 340.
[79] – ابن خلدون، عبد الرحمن، م.س.، ص 430.
[80] – مدكور، د.علي أحمد، منهج التربية الإسلامية، الكويت، مكتبة الفلاح، ط1، سنة 1407هـ – 1987م، ص 196.
[81] – نحو استراتيجية لتطوير التربية الإسلامية، م.س.، ص 41.
[82] رواه أبو داود في السنن في باب: في صلة الرحم، وبلفظ آخر رواه البخاري في الصحيح في كتاب: التفسير من سورة القتال.
[83] الراغب الأصفهاني، م.س.، ص 196.
[84] القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، م.س.، ج13، ص 81 وما بعدها.
[85] ابن منظور، لسان العرب، م.س.، م6، ص 4831 وما بعدها.
[86] الراغب الأصفهاني، م.ٍ.، ص 559.
[87] ابن منظور، لسان العرب، م.س.، م4، ص 2658.
[88] أبو زهرة، الإمام محمد، المجتمع الإنساني في ظل الإسلام، جدّة، الدار السعودية، ط2، سنة 1402 هـ – 1982م، ص 148.
[89] ابن منظور، لسان العرب، م.س.، م3، ص 2088.
[90] المعجم الوسيط، ج1، مجموعة مؤلفين، القاهرة، مجمع اللغة العربية، دار المعارف، ط2، سنة 1392 هـ – 1972م، ص 447.
[91] رواه البخاري في صحيحه في كتاب العلم، والحديث متفق عليه.
[92] النساطرة: نسبة للبطريرك تسطوريوس (ت 451) الذي طرح مفهوماً عقدياً لطبيعة المسيح عليه السلام يوماً كان بطريركاً في القسطنطنية عام 431م، حيث قال: إن يسوع كان في الواقع شخصين، شخصاً إلهياً وشخصاً بشرياً، فالتالي ولدته مريم والأول هو كلمة الله الأزلية، ولا يزال الكلدان الكاثوليك على هذه العقيدة.
[93] حتى، د.فيليب، العرب، ج2، بيروت، دار الكشاف، ط4، سنة 1965م، ص 434.
[94] الراغب الأصفهاني، م.س.، ص 344.
[95] ابن منظور، لسان العرب، م.س.، م4، ص 2926.
[96] السحمراني، أسعد، التطرف والمتطرفون، ط1، بيروت، دار النفائس، سنة 1419 هـ / 1999م، ص 98.
[97] شلتوت، الإمام الأكبر محمود، من توجيهات الإسلام، ط8، القاهرة، دار الشروق، سنة 1407 هـ / 1987م، ص 239.
[98] السحمراني، أسعد، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، م.س.، ص27.
[99] القرطبي، أبو عبدالله محمد بن احمد، م.س.، ج19، ص383، 384..
[100] ابن منظور، لسان العرب، م.س.، م1، ص 41.
[101] معجم النفائس الكبير، م1، م.س.، ص 21.
[102] ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، م2، بيرون، دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ، ص 150، 151.
[103] ابن هشام، م.س.، م2، ص 153.
[104] السحمراني، أسعد، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، م.س.، ص 113، 114.
[105] ابن منظور، لسان العرب، م5، م.س.، ص 3906.
[106] القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، م.ٍ.، ج5، ص 106.
[107] القرطبي، م.ٍ.، ص 131.
[108] القرطبي، م.ٍ.، ص 134. والحديث: “إنما الخالة بمنزلة الأم”. رواه البخاري.
[109] القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، م.س.، ج14، ص 60.
[110] السحمراني، أسعد، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، م.س.، ص 114.
[111] رواه أبو داود في السنن.
[112] السحمراني، أسعد، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، م.س.، ص 116.
[113] ابن منظور، لسان العرب، م2، م.س.، ص 1042.
[114] ابن منظور، لسان العرب، م.س.، ص 571.
[115] الجرجاني، علي بن محمد الشريف، التعريفات، تحقيق د. محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط1، بيروت، دار النفائس، سنة 1424 هـ – 2003م، ص 137.
[116] المنتخب في تفسير القرآن العظيم، م.س.، ص 407.
[117] الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي، الكافية في أصول الجدل، تحقيق د. فوقية حسين محمود، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، سنة 1399هـ – 1979م، ص 538.
[118] الجرجاني، علي بن أحمد الشريف، م.س.، ص 204.
[119] القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، م.س.، ج5، ص 380، 381.
[120] الخوافي: ريشات في جناح الطائر غير كبيرة إذا ضم الطائر جناحيه خفيت.
القوادم: ريشات في مقدم جناح الطائر كبيرة تساعده على الطيران.
[121] القرطبي، أبو عبد الله بن أحمد، م.س.، ج 18، ص 486، 487.
[122] السحمراني، أسعد، صراع الامم بين العولمة والديمقراطية، ط1، بيروت، دار النفائس، سنة 1420هـ – 2000م، ص62.
[123] الأنصاري،د. عبد الحميد اسماعيل، الشورى وأثرها في الديمقراطية، ط3، صيدا-بيروت، المكتبة العصرية، بدون تاريخ، ص19.
[124] السحمراني، أسعد، المرأة في التاريخ والشريعة، ط2، بيرون، دار النفائس، سنة 1417هـ – 1997م، ص 230.
[125] أبو العينين، د. علي خليل مصطفى، م.س.، ص164.
[126] أبو العينين، د. علي خليل مصطفى، م.س.، ص 172، 173.
[127] ابن سحنون، كتاب آداب المعلمين، مراجعة وتعليق محمد العروسي المطوي، تونس، دار الكتاب، سنة 1972، ص 37، 38.
[128] ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، بيروت، دار القلم، بدون تاريخ، ص 450.
[129] ابن خلدون، عبد الرحمن، م.س.، ص 447.
[130] ابن خلدون، م.س.، ص 442.
[131] ابن خلدون، ص 443.
[132] ابن خلدون، م.س.، ص 443، 444.
[133] رواه البخاري في الصحيح عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.
[134] القرطبي، أبوعبدالله محمد بن أحمد، م.س.، ج15، ص291.
[135] الصباغ، د.بسام، دور المسجد في تكوين الرأي العام، ط1، دمشق، دار الإيمان، سنة 1427هـ – 2006م، ص54، 55.
[136] ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، م.س.، ص 173، 174.
[137] السحمراني، أسعد، الإعلام أولاً، ط1، بيروت، دار النفائس، سنة 1415هـ – 1994م، ص 13.
[138] أبو العينين، د. علي خليل مصطفى، م. س.، ص 177.
[139] السحمراني، أسعد، الإعلام أولاً، م. س.، ص 135.